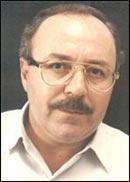 يعكس أدب البحر لدى كلّ الشعوب البحرية حالة متناقضة وإشكالية تجاه هذا الأزرق الواسع غير المتناهي، وربّما يأتي هذا التناقض من غموض البحر ذاته كقوة مطلقة في حين، وكائن وديع لا يخشاه حتى الأطفال في حين آخر؛ من الزرقة الصاخبة المتماوجة مع أشعة الشمس الذهبية المعلنة منذ لحظة بزوغها أن موعد مصارعة الأمواج طلباً للرزق قد حان، أو مع فضّة القمر التي تغزو قلوب السهارى على شطآنه الرملية أو الصخرية لتنفتح مواسم الحكايات لمغامرين عبروا بوابته إلى العالم.. إنه على الدوام حاضر في الذاكرة الجمعية سواء في الكتابة عنه، أو في تداول مفرداته عبر الحياة اليومية لجيرانه الراصدين متغيراته وأهوائه، ككائن مشخصن بصورة أب متعال يحنو ويقسو، ولكنه إلى ذلك يستوطن ذاكرة تشكّلت من خلاله؛ مما جعله مركزاً أو إطاراً مرجعياً لا يمكن الاستغناء عنه، والأدباء والشعراء والفنانين الذين تربوا بين أحضانه، سيظلون مرتبطين به كما يرتبط الجنين بأمه عبر حبل السرة. ومازلت أعتقد أن هذا الحبل ذاته ما انفكّ يربط أدب البحر به كمركز، ليتغذى من نسغ حكاياته واقعياً وبصرياً ومجازياً، فينعكس كلّ ذلك على حياة الشخوص في القصّة والرواية، أو على اللغة والصورة لدى الشعراء، وألواناً متجددة على الدوام بالنسبة للفنان.
يعكس أدب البحر لدى كلّ الشعوب البحرية حالة متناقضة وإشكالية تجاه هذا الأزرق الواسع غير المتناهي، وربّما يأتي هذا التناقض من غموض البحر ذاته كقوة مطلقة في حين، وكائن وديع لا يخشاه حتى الأطفال في حين آخر؛ من الزرقة الصاخبة المتماوجة مع أشعة الشمس الذهبية المعلنة منذ لحظة بزوغها أن موعد مصارعة الأمواج طلباً للرزق قد حان، أو مع فضّة القمر التي تغزو قلوب السهارى على شطآنه الرملية أو الصخرية لتنفتح مواسم الحكايات لمغامرين عبروا بوابته إلى العالم.. إنه على الدوام حاضر في الذاكرة الجمعية سواء في الكتابة عنه، أو في تداول مفرداته عبر الحياة اليومية لجيرانه الراصدين متغيراته وأهوائه، ككائن مشخصن بصورة أب متعال يحنو ويقسو، ولكنه إلى ذلك يستوطن ذاكرة تشكّلت من خلاله؛ مما جعله مركزاً أو إطاراً مرجعياً لا يمكن الاستغناء عنه، والأدباء والشعراء والفنانين الذين تربوا بين أحضانه، سيظلون مرتبطين به كما يرتبط الجنين بأمه عبر حبل السرة. ومازلت أعتقد أن هذا الحبل ذاته ما انفكّ يربط أدب البحر به كمركز، ليتغذى من نسغ حكاياته واقعياً وبصرياً ومجازياً، فينعكس كلّ ذلك على حياة الشخوص في القصّة والرواية، أو على اللغة والصورة لدى الشعراء، وألواناً متجددة على الدوام بالنسبة للفنان.
والمطلع على أدب الخليج العربي، سيدرك أهمية هذا الوجود البحري في أدبهم، وكبير أثره على أعمالهم كفضاء دلالي يلون بزرقته خلفية المشهد أو الصورة الملتقطة في الزمان والمكان المتعينين، وبذلك لن يكون ثمة مبالغة عندما تجتمع مجموعة من الكتاب ليعبروا عن محبّتهم لبحرهم في مجموعة شعرية أو قصصية، كما في المجموعة الأولى التي أصدرها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات "كلنا، كلنا.. نحب البحر"، ليتحول هذا البحر المحبوب إلى ممارسة ثقافية تمارس إبداعاتها عبر أقلام أبناء الصيادين والغواصين والتجار الذين تعلّموا من آبائهم محبة واحترام البحر، ولكنهم إلى ذلك قفزوا ببحرهم من فضائه الطبيعي كضرورة طقسية ومعاشية، إلى فضاءات الإبداع المعبّرة عما يشكّله في الذات الثقافية من حضور دلالي ورمزي كبيرين، يمكن رصده من خلال جملة الإبداعات الشعرية والنثرية، وكنا في كتابنا " مرايا البحر" قد تناولنا جانباً من هذه الكتابات عبر تناولنا لبعض الأعمال القصصية، وهانحن اليوم نعود لتعزيز ما تناولناه عبر هذه الدراسة لمجموعة الشاعرة حمده خميس وفق ما سمّيناه الأنساق الدلالية والرمزية لأدب البحر.
حمده خميس في محموعتها "مس من الماء" ستكشف عن جوانب عديدة من علاقتها ببحرها عبر خطاب شعري نابض بالحب والحياة، كثّفت من خلاله خلاصة رؤيتها لعالم الماء بانتمائها إليه، وعن حبّها لهذا الأزرق الغامض، الشفاف: رمز الأبوة الكامنة، والحوض الذي يضمّ كلّ ممكنات الوجود. والتعبير عن هذا الانتماء، لن يكون ممكناً دون إدراك بعض الأسرار التي يختزنها في أعماق لجّته، عبر ما تختزنه الذاكرة الجمعية من حكايات ومرويات جاءت على ألسنة البحّارة، والقصاصين، والشعراء، ومؤرّخي الأساطير. وعلى الرغم من ذلك تبقى رموز البحر كشبكة عنكبوت معقّدة، كإحدى متاهات بورخيس، التي مهما كنت ضالعاً في غوايتها، لن تتمكّن إلاّ من كشف جانب من جوانبه الغنية:
"أيها المكتنز بالجروح
بالنبوءة والهياج
بسهو الشواطئ وغرورها
بالنشيج المرجع: بضلالة النوارس وهجراتها
بنزق الكروم
وزغب الرغبات
لماذا لا تأخذك المحيطات
إلى حيث القلب.."
والبحر إلى ذلك لم يسمّ عبثاً مدمّر الأشكال، كدلالة على ذكورته المتجلية في عنفه وقوّته وبطشه. ولكنه أبداً محبوب كعاشق نبيل، وهنا يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك فلمَ كلّ هذا الحبّ إذاً؟ ثمّ كيف عبرت الشاعرة عن هذا التناقض الإشكالي؟
لكي نذهب إلى الفهم أولاً، لابدّ لنا من التذكير بلحظة المواجهة الأزلية بين أنوثة مستفيضة بالخصب، وبين ماء مستفيض بالقوّة إلى حدّ الموت. ولابدّ أيضاً من أن نشير إلى العنصر الإحيائي المشترك بالتقاء عنصري الماء والتراب، وما سيسفر عن هذا اللقاء من حياة جديدة تنمو وتزدهر طالما تواظبت اللقاءات، طالما استمرت سيرة الماء والتراب في تقديم الخير لجميع الناس. أليس دوام الخير النابع من أحشاء أمنا الأرض، هو الغاية التي نعيش من أجلها؟!
نعم، ولكن هذه الخيرات لن تدوم بدوام الاعتداء عليها من قبل أبناء "تيامى"، أولئك الذين ذهبوا بعيداً في إقصاء طرفيّ المعادلة عن بعضهما، فما انفكوا منذ ذلك اليوم يعتدون على الجسد الأمومي، ويلوّثون المياه: المادة الأولى وباعث الخصب، حتى استغاثت السماء من هذه الأفعال، وراحت تستعد لإرسال طوفان جديد، يدمّر الأشكال، يلغيها، كي من جديد تعود مسيرة الخير والخيرات، كي من جديد يزهر الأمل على الشفاه، وتبزغ شمس العدالة ضاحكة مستبشرة، وإلى ذلك الحين سنتابع بعضاً من نداء الأرض لذلك الأزرق عبر هذه الحوارات الجميلة من حمده خميس:
"أيها البحرُ الهيوج
اتئد..
أيّ نزق هذا؟
إذ تلقي رذاذك فضّةً
أتشبهني؟
من قال أن مسكنك الغياب
والمدى وطنك؟
من دلّك على اهتياجي.."
والنداء الذاهب إلى تبيان التشابه والافتراق بين الطرفين، هو نداء أموميّ فطريّ.. إنه أشبه بنداء الطبيعة لاستكمال مسيرة الزهر والثمر، فكلا الطرفين يمتلكان إمكانية الخصب والإحياء، كحالتين مطلقتين قادرتين على الإحياء وعلى الأموات، والتقابل على هذا المستوى من القول، هو تقابل بين ضرورتين لا غنى عنهما: الأمومة تقابل الذكورة وكلّ يمتلك عناصره المتشابهة، وإذا كان البحر كما يتراءى لنا عبر العديد من كتابات البحر: أبّ كلّي، له صوته الخاص تعبّر عنه أمواجه المتدفقة أبداً إلى البرّ حيث التراب.. فإن الأمومة بدورها فيّاضة بالعناصر: لها موجها، ومدّها وجزرها وعواصفها أيضاً، وإلاّ فإن التقابل سيغدو مستحيلاً في ظلّّّّّ المعطيات القارة عن البحر في الذاكرة البشرية:
"لا أشبه البحر
لكن لي موجي
ولي مدّي وجزري
ولي اعتصافي
وأهوالي
ولي غموض الموت
والميلاد
وفتنة اللؤلؤ
ورقّة الماء.."
الرمز ومشترك المكان
بمزيد من الأسئلة ستعزز الشاعرة رؤيتها تلك عبر الحوار الدائم والمستمر مع بحرها، وهي إلى ذلك ستكشف عن حالة افتراق تمّت، عززها إنشاء استفهاميّ في الغالب عن أحوال الغربة والقطيعة بين الشاعرة وبحرها، ليصبح السؤال مشروعاً عما تخلّفه الغربة من آثار على النفس المحبّة، فنراها بكثير من الشفافية تواظب على إرسال رسائلها الصباحية المتضمنة دعوة صريحة لتدارك هذه الجفوة، وذلك من خلال جملة من العبارات والتراكيب ذات الإيحاء الرغائبي الإيروسي، وستعزز الصورة الوجد الضارب في الفؤاد، فنقف على حال الأحبة، وقد أضناهم الهجر:
"كم غبت أنا عنك؟
كم يومٍ مرّ ولم تبعث حلزوناً
يتأوّد في مشيته
يطرق بابي
يسأل عني
يسأل عن أسبابي؟
لم تبعث أصدافك أو مرجانك،
أو حتى موجاً يتدحرج
نحو غيابي؟.."
ولا نظنّ هنا أن هذه الصورة الناضحة بالألق تحتاج إلى شرح، إذ لا نجد لوناً أو ضوءاً يخرج عن الذائقة العامة، ولا حركة تشذّ، أو صوتاً قبيحاً يأتي من مكان ما، إنها لحظة انسجام رائع لمختلف العناصر فالكلّ خاضع لمشترك المكان، ولكن ما تنبغي الإشارة له هو القدرة الفذّة على توليد الصورة الذاهبة إلى وجد مفرط، والخيال الجامح في تناول المفردة الإيحائية، أو مدلولاتها الرمزية، لنتوقف برهة عند الأصداف والمرجان.. عند الحلزون المتأوّد في مشيته، ونحاول تفسير دخول هذه الكائنات مشترك المكان، ومدى قربها أو بعدها عن الوعي البشريّ الحديث كرموز للحبّ والإخصاب، أو على حدّ تعبير مرسيا إلياد: "في كلّ مكان، الصدفة البحرية، واللؤلؤة والحلزون تعدّ من شعارات الحبّ والزواج.. إن رمزية الجنس والمرأة في الأصداف البحرية والمحارات تنطوي على دلالة روحية. وإن الولادة الثانية بفعل التنسيب لتغدو ممكنة بفضل ذلك المعين الروحيّ الذي لا ينضب.."
وإذا كان هذا المشترك قد أصابه خلل ما فإنما بفعل التحديث والحياة الجديدة كما لدى الكثير من الشعراء والقصاصين، إلاّ أنه جاء كحالة إقصاء لا نعرف مسبباتها البعيدة لدى الشاعرة حمده، حيث نجدها تشتكي من غربة في المدن البعيدة، أضاعت خلالها السبيل إلى مشترك المكان مع بحرها، وعبر الذكرى ستنقطع خيوط السرد، إلى ماض حافل بلحظات الفرح والحبّ، وهي بلا شكّ أيام الطفولة فتذهب لغة الشاعرة في الأسى، للأيام التي أمضتها بعيداً عن بحرها، فتعتذر منه مراراً، ثمّ ما تلبث أن تنكسر أمام جبروته تكفيراً عن زمن أمضته بعيداً عن "صفيّ الصبا" فتتجه اللغة لإضفاء شكل من القداسة على الأزرق:
"آه يا ملك الماء.. والكائنات، يا بهياً
سلام عليك
من عاشقة
أطاحت بها الذاريات
ونثّ على جرحها الملح
حتّى تماهى دم الروح بالموج
فأنّت عليك، وأنّت على أسرها
كما أنّت الصاريات حين انهمار البروق
سلام عليك
يا شبيهي
ويا مَلَكي وصديقي الغريق.."
ولاشكّ أن أسلوب التضرّع هذا سيأخذنا بعيداً نحو المنابع القصيّة وبداية البدايات، كما في ابتهالات "إنانا" و "إنهيدوانا" السومريتين، وذلك عندما كانت الفطرة الإنسانية تنظر إلى قوى الطبيعة كآلهة كلية القدرات، فكان لا بدّ في حال كهذا من أسطرة الأشياء بإعطائها مسميات تليق بجبروتها، ثمّ عملت على أداء طقوس العبادة عبر التمثيل والأداء الدرامي، اللذين سيواظبان في تكثيف الرمز حتى حدوده القصوى، سواء خلال الأداء الطقسي وتقديم القرابين، أو من خلال علاقة التبتّل الخاصّة بين الإنسان ومعبوده. وما انفكّ الشعر منذ تلك اللحظة الموغلة في القدم، يعيد صياغة الوجدان الإنساني عبر إعادة إنتاج تلك الميثولوجيا بأشكال مختلفة، ولنلحظ هذا الأداء الطقسي في مطلع النصّ الذي أوردناه للتوّ: "يا ملك الماء والكائنات، يا بهيّاً، سلام عليك.." ، لتبدأ معها في تمثيل الحالة، فهي عاشقة لكنّ الذاريات أو الرياح أطاحت بها، والإطاحة هنا مجاز يذهب في تفاصيل إضافية، فالرياح لا تذرو سوى التراب والرمل، تحملهما أنى اتّجهت ومن ثمّ ترمي بهما في أصقاع مختلفة، وهذا يدفعنا للاستنتاج أن الحياة عصفت بالشاعرة، مزقّتها، فتتتها فتتاً، ولكنها رغم مسيرة الآلام تلك، ما كانت لتنشغل لحظة عن ذكره، تتوجع وتتألم على الدوام من أجله.
"هل تذكر كيف تمرغت
برملك، ذات أسى
وتنهدّت:
(أنا التي أضاعتني المدائن
ولم تهدني السبل)
فهمست كي لا يسمعنا الرمل:
(هل مسّك مسٌّ
أم أضاءك خبل!)
قلت:
(أيّ الوهاد إذن
تفتّحت
لتحتوي رهجي
وأيّ موج علا نهدي
وأسلسني.."
الحوار المعزز بغنائية شجية
على هذا النحو من الحوار بين الشاعرة وبحرها، سيتصاعد الإيقاع الشعري على نحو دراميّ، تؤكّده جملة من الأساليب المتراوحة بين إنشاء وإخبار، بقواف داخلية وتكرار لمفردات ذات خاصية إيقاعية
سيلحظها القارئ، نظراً لأن الشاعرة، كما نوّهنا من قبل، موضعت نفسها كندّ أو كذات مطلقة قادرة على الفعل، شأنها في ذلك شأن البحر. والخطاب في هذا المستوى سيأخذ هذا الشكل الحواري الذي اجتزأناه للتوّ بين ذاتين مطلقتين، وبالتالي فإنه لا بدّ أن يكون متكافئاً ولا ضير حينها في استخدام الشاعرة لضمير المخطابة المعبر عنه بـ"أنت" و"كاف الخطاف":
"هل تعرف كم غبنا عنا
كم يوم مرّ
ولم يلمس رئتي
لطف هواك
وتنفّس مرجانك
ولم ألق عليك صباح الخير
كي ينهض نومي من عتمته
ويصير شفيفاً وجميلاً
مثل الفيروز بمائك.."
في نصّها المعنون بـ "نشيد الملك" ستواظب الشاعرة على هذا النحو من الأسلبة الغنائية الشجيّة، حتى ليخال المرء أن الزمان قد توقف تماماً، وراح كبقية العناصر يرقب هذه المنافسة بين ندّين قويين، وليس ثمة حركة في المكان سوى حركة الرسل الذاهبة والآيبة في المسافة الفاصلة بينهما، علماً أن الموقف ليس موقف حرب، ولكنه أشبه بذلك لأنه موقف وصال بين ندّين، وهكذا فإن الشاعرة ستذهب بعيداً في تفعيل الرمز عبر كائنات البحر حيث "الرياح تهمس، وتغني الصدفات، أما النوارس فإنها ستحلّق في الأعالي، بينما البجعات ستودع أسرارها في الرمال" وكلّ ينتظر لحظة المكاشفة والبوح الشبيه ببوح المتصوفة:
"آه.. يا ملك الماء
والكائنات
يا بهياً تجلّى
لقلبي الذي جللك.."
"سلام عليك
ياشبيهي
ويا ملكي
وصديقي الغريق!"
وهكذا في الختام، فإنه يجدر بنا التنويه، إلى أن الرأي القائل بصدقية السرد القصصي في التعبير عن البيئة أكثر من الشعر لأنه أشد التصاقاً بحياة الناس، ربّما لن يجد له صدى كبيراً في مجموعة الشاعرة حمده خميس "مسّ من الماء"، بل ربما في غيره من الأعمال أيضاً، وكنت مقتنعاً إلى حين بهذه المقولة الشائعة، وبذلك فإنني آمل أن يعود القارئ إلى هذه المجموعة كي يلتمس ذلك بنفسه أيضاَ.
*مسّ من الماء، شعر حمده خميس، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2000.
www.izzatomar.com
إقرأ أيضاً: