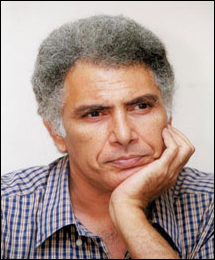 يرتكز رفعت سلام ـ في ديوانه 'هكذا تكلم الكركدن' الصادر عن هيئة قصور الثقافة المصرية 2012 ـ على تجديد مشروعه الإبداعي، وكتابته الطليعية من داخل بحثه عن لغة جديدة تتداخل مع مستويات عديدة، ومعقدة من العوالم التصويرية، والأصوات، والإحالة إلى متكلم يتصل روحيا، وجماليا بهذة العوالم، دون أن يفقد حضوره الأول، وقدرته على تخييل ذاته في سياقات عديدة؛ وهو ما يمنح مشروع رفعت سلام خصوصية فنية في بحثه عن الهوية، ومستويات تشكلها في الوجود الذاتي، والإنساني، والاجتماعي في الوقت نفسه.
يرتكز رفعت سلام ـ في ديوانه 'هكذا تكلم الكركدن' الصادر عن هيئة قصور الثقافة المصرية 2012 ـ على تجديد مشروعه الإبداعي، وكتابته الطليعية من داخل بحثه عن لغة جديدة تتداخل مع مستويات عديدة، ومعقدة من العوالم التصويرية، والأصوات، والإحالة إلى متكلم يتصل روحيا، وجماليا بهذة العوالم، دون أن يفقد حضوره الأول، وقدرته على تخييل ذاته في سياقات عديدة؛ وهو ما يمنح مشروع رفعت سلام خصوصية فنية في بحثه عن الهوية، ومستويات تشكلها في الوجود الذاتي، والإنساني، والاجتماعي في الوقت نفسه.
تقوم كتابة سلام ـ إذا- على ثراء المدلول، والتجريب في أداة اتساع الصوت الشعري، وألعابه اللغوية، ولقائه السري بعناصر الكون، والأساطير، والثقافات، وتداعيات الكتابة، واستعاراتها البكر المولدة من لقاء الوعي بالنتاج المعرفي، وأطياف الفن، وأخيلته. إنها كتابة تصل المتكلم بالعوالم الممكنة، والمحتملة التي تكشف عنها تداعيات الدوال في الصيرورة المجازية للكتابة، وتعيد من خلالها تأويل صوت يبحث عن نقاء، أو تطهر من داخل حالات الصخب، والتمرد، وأخيلة الحروب، والعنف، والعدم.
هل يكتب رفعت سلام نشيدا يعبر عن روح الوجود الإنساني في أزمنته القديمة، والحاضرة، والمستقبلية؟ أم أنه يعيد إنتاج الذات وفق جماليات الأثر، وتداعياته؟
إن النص ليتسع لرؤى تأويلية عديدة، وأرى أن قارئه النموذجي يبدأ بتتبع التعددية، والمساحات التأويلية المحتملة، والكامنة في مستويات الكتابة، وشكولها المتنوعة بين التكثيف، وتناظر النصوص، والهوامش الإبداعية، وغيرها؛ فقد نجد استطرادا تصويريا في المتن، وميلا إلى التناقض، والحزن في النصوص الأكثر كثافة، ورغبة في الإكمال في النصوص السميكة المناظرة للأصل، وغيرها من الأدوات التي تصب في الإنتاجية المتجاوزة لمركزية المدلول في النص، والقراءة النموذجية معا.
ويمكننا رصد ثلاث تيمات رئيسية في الديوان؛ هي:
أولا: الصوت باتجاه التعدد، والاختلاف.
ثانيا: بين الصخب، والتلاشي المحتمل.
ثالثا: تداعيات الكتابة، وخصوصيتها التجريبية.
أولا: الصوت باتجاه التعدد، والاختلاف:
يجدد الصوت بنيته في ممارسته المستمرة لتجربة الاختلاف؛ فالصوت يتصل جماليا بمواقع، وأطياف متباينة عديدة تمثل في مجموعها مستويين من الدلالة:
الأول: استعادة التاريخ البشري بمعارفه، وحكمته، ونزواته التدميرية، وشيخوخته، وبحثه عن التوسع، ومخاوفه من الذاكرة الجمعية؛ ومن ثم تفجر الكتابة للتناقضات الجمالية المصاحبة لذلك المشهد الشعري / السردي الذي تتناثر فيه الأصوات، والرؤى، والمواقع، والأطياف الفنية، والتاريخية، دون أن تنتهي الإحالة إلى الصوت الأول الذي يستعير الآخر في مساحة من الاختلاف، تسمح بانفتاح مدلولي الذات، والآخر الإنساني دائما.
الثاني: الإكمال؛ وفيه يرتكز الشاعر على إنتاجية الوعي لهويته، ومدلوله من خلال الصوت الآخر المكمل؛ ومن ثم يقوم الصوت الأول بقراءة تحويرية للصوت الآخر، بحيث يعكس الأخير ـ بصورة غير مباشرة ـ موقف المتكلم، ووجوده الذاتي في لحظة حضارية بعينها؛ ويسمح هذا المستوى بقراءة رؤية الشاعر الاجتماعية للعالم انطلاقا من مرجعيته الذاتية، وفاعليته المشكلة للصوت الآخر.
و تتنوع أصوات النص التي تجمع بين الواحد، والمجموع؛ فتشير إلى الصوت الأبوي بين الصخب البدائي، والشيخوخة الحضارية، والمرأة التي تتحد برغبات الهو، وصور الانتهاك، والفراغ، والخراب، وكذلك الارتقاء الروحي، والفضاءات الأسطورية؛ أما المتكلم فيتنقل بين مواقع الهزيمة، والتلاشي، والصفاء المتجاوز لسطوة العنف، والتهميش، والتعارضات الداخلية المتعددة.
وأرى أن الإحالات المتواترة إلى صورة الكركدن تذكرنا بالتناقضات الأصلية في نماذج المجتمع الأبوي، ولكن الشاعر يكسبها حضورا جديدا في سردية الكتابة التي تستبدل حالة التابو القديمة بالتمرد، أو التلاشي، أو الأصالة المفقودة.
يقول في المتن: 'أنا أصل السلالة، والكل ظلال باهتة..، استعاروا قامتي وسيرتي، سلبوني مني، وارتدوا قناعي الذهبي في غفلة من الزمن...، غبار لاذع يسد الأفق والعينين والأنف، يملأ الشرايين المعتمة، وجسدي قش وتراب'.
ثم يقول في النص المناظر: 'أنا اللحظة المارقة الفالتة... وجهي قناع من حجر'.
يتخذ المتكلم ذلك الموقع الأبوي القديم، وما يحويه من أصالة القوة، وأطيافها، ثم تنهمر صورته في حالة من المفعولية، والتلاشي، كأنه قفز إلى مرحلة حضارية جديدة، ثم نجده كالريشة أمام الغبار؛ فيعاين الموت، دون أن يختفي إدراكه للعالم. وفي المستوى النصي المناظر يختلط الصوت الأبوي بانفلات الشاعر المتمرد، وتخييله الصاخب للتلاشي، وطمس الهوية، واستعادتها المحتملة خارج هيمنة تلك اللحظة المتناقضة.
وبصدد صورة الكركدن يرى جيمس فريزر في الغصن الذهبي أن الخوف من أرواح الأعداء هو ما يدفع المحارب، أو الصياد للعزلة، والنزوع إلى حفظ النفس من أشباح البهائم، والطيور، ثم يذكر بطولة من يقتل الكركدن، وأدائه لفعل العزلة ثلاثة أيام عقب قتله (راجع / James Frazer / The Golden Bough / Temple of earth publishing / p.198.202).
وتتراوح مثل هذه الإيماءات التي صاحبت الكركدن على الوعي المبدع؛ فيشكل منها نقطة البدء، ثم يمنح الكركدن إرادة واعية تعبر عن تناقضات موقعه الأصلية بين التابو، والموت، ويضيف إليها مواقعه، وأطيافه في الآخر، وفي طبقات اللاوعي، ونشاطه الإبداعي في النص.
و قد يستعير الشاعر أطيافا كونية، وفنية مركبة تعبر عن صخب الهزيمة، ووهجها الذي يشبه الانتصار المجازي على الواقع، وسطوة التهميش؛ فاحتمالات الخروج، والطيران تزدوج دوما بأخيلة التلاشي.
يقول: 'أنا الطائر من رماد/ لا يعرفني الوقت / ولا تشبهني البلاد / وقالت لا تلتفت إلى الوراء؛ فالتفت فصرت حجرا من ملح يسعى في الأسواق مرحا، رأسي عش للغربان، وأعضائي حيات تهفو للجحر'.
إن الشاعر يكثر من دوال السلب في هذه المقاطع المكثفة ذات الإيقاع، ولكنه يحتفي بجماليات الحياة الطيفية المصاحبة للموت؛ فقد أنتج الوعي المبدع طيفا مركبا من أسطورتي الميدوزا، وأورفيوس، ومن طفرات الاستعارة، وجمالياتها، وتداعياتها في الكتابة؛ كي ينتصر على هيمنة الموت، والتحجر، والرماد؛ فقد صار موت زوجة أورفيوس عند التفاتها حياة صاخبة لغربان، وحيات مجازية، بينما صار التحول إلى حجر بفعل عيني الميدوزا مرحا للكينونة من داخل أثر الهزيمة اللامركزي.
ويأتي صوت المرأة منشقا عن الهو من خلال التحامه الصاخب به؛ ومن ثم يزدوج فيه الموت بالحياة الكامنة؛ وهو ما يذكرنا بتصور فرويد، وإن جاء هنا باتجاه التزام كوني، وحضاري يعلن عن موقفه من خلال تناقضات الصوت، وثرائه.
يقول: 'لا أحد. لا قطرة مطر (أيها الخواء). ليل بلا نجوم، ومدن بلا بشر...، والبلاد متاهة من سرابات؛ أشباح تجوس في الظهيرة إلى هاوية غامضة، وغمغمات من القاع تعلو فتملأ الأفق'.
يذكرنا الصوت بنموذجه الأصلي في الالتحام بالحياة، والانفتاح على الآخر، ثم يضعنا أمام معاينة المرأة للخواء، وانتشار أطياف الموت الجمالية التي تشير إلى إدانة تلك الحالة، ومرجعياتها الحضارية من جهة، والرغبة في تشكيل حياة صاخبة جديدة للمجموع من جهة أخرى.
ثانيا: بين الصخب، والتلاشي المحتمل:
تنتج الكتابة مجموعة من الإيماءات، والإيحاءات الفنية التي تشبه السيمفونية في مراوحتها بين حركتي التلاشي، والصخب؛ فالذات تعاين الغياب، والصمت، والفراغ، بينما تتجدد في مشاهد أخرى تجمع بين أصداء الحروب، وأخيلة النشوء الآخر الذي يكمن وراء طيفية المشهد السلبي، وجمالياته الديناميكية؛ ومن ثم يظل الصوت حاضرا ضمن نهاياته الفنية؛ كي يفكك بنيته المستقرة، ويعيد إنتاجها في ثراء حالات النص، وإيقاعاته المتباينة.
إن الشاعر يرتكز في تكراره لبعض الدلالات على إحداث الأثر الجمالي للصور، والأصوات، وما تحويه من نغمات مجردة ذات تأثير قوي في العالم الداخلي للمتلقي.
تتوالى نغمات العنف، والصخب، والازدهار، والتلاشي، ثم الذوبان الروحي على الذات الأنثوية في النص؛ فنجدها مادة لتلك النماذج الأولى من المعاني، والإيقاعات التي تعيد تشكيلها انطلاقا من تجربة الاختلاف التي تثري الصوت المتكلم، وتجدد سياقه، وتتجاوز مركزية النهايات الحاسمة.
يقول على لسان المرأة: 'يجتاحونني بالسنابك، والمجانيق جميعا بلا هوادة، بالرماح والسيوف والمقاليع، بالحوافر والأنياب، في النوم وأحلام اليقظة... هكذا ساقني إلى مرعاه في حديقة الليل (أشجار الشهوات سامقة، تنز حليبها وعسلها...)... كلما مس نجمة تصاعدت بي إلى السماء، ورمتني أتأرجح طافية في فضاء من رقى وأرق'.
لقد انتقل النص من الإيقاع الدموي المصاحب لهيمنة القوة الصاخبة الشبحية المستعادة من حروب قديمة، إلى بزوغ ربيعي في الوعي يحمل دلالات تجدد العالم، ثم انتهى برقي، وقلق روحي سماوي داخل الذات؛ وكأن الوعي يعيد تشكيل بنيته من خلال تباين تلك النماذج، والنغمات، وحركيتها التي تشبه توالي حركات السيمفونية، واستمراريتها النسبية التي تجعل التلاشي احتمالا، لا أصلا في المشهد.
ثالثا: تداعيات الكتابة، وخصوصيتها التجريبية:
كتابة رفعت سلام تفاعلية؛ أي تجدد تكويناتها الفنية باستمرار من خلال تلاحق الإيماءات التصويرية الاستعارية، والنصوص الوليدة، والهوامش المكملة، والحكايات، والأسئلة، والالتحام مع بعض النصوص الدينية، والأدبية من خلال التناص، والبحث عن شكل متناغم، ومتناسق جديد للنص يقوم على التفاعل الجمالي بين الحركات النصية المتوازية، والمعاني، والإيقاعات، والأصوات التي تؤكد الاختلاف، والتجدد. إنها كتابة فريدة ذات خصوصية تجريبية تقوم على التداعي، والانفتاح الدلالي، والجمالي بين الفنون، والأنواع، والأصوات الممتدة من المعارف، والذاكرة الجمعية، ودوال الكتابة نفسها في صيرورتها المستقبلية.
تقمص تمثيلي مركب
يضعنا رفعت سلام أمام مسرح متخيل؛ وكأننا نعاين فعلا أدائيا تمثيليا للأصوات التي يتقمصها المتكلم الأول، ثم يضيف إليها تأويلاته الفنية؛ فهل تنتج الكتابة فضاء مسرحيا متغيرا يقع بين بنيتها ووعي المتلقي؟ أم أنها تؤكد حضور الفعل الحواري المسرحي كمدلول فني مضاف لشاعرية المتكلم؟
إننا أمام بحث تجريبي في الكتابة تتوازى فيه رؤى الكاتب مع تجدد الشكل، وطرحه لأسئلة جديدة حول الأنواع، والعلاقات التداخلية بين الفنون.
يقول: 'أيها السادة والسيدات؛ حضيض بض جميل؛ أرتع فيه بلا سوء، مع خزعبلاتي وكائناتي الخرافية..'.
الصوت يخيل الجمهور المسرحي، ويؤكد الفعل التمثيلي من داخل تلك الدوال، والصور المستمدة من تداعيات الكتابة في سياق جمالي فريد.
الهامش المكمل
للهامش وظائف عديدة في النص؛ فقد يعرف، أو يؤول، ولكنه يقوم أيضا بعملية إكمال استعاري داخل تداعيات الكتابة؛ فيتداخل مع المتن، ويعمق الرؤى، والأخيلة، ويضيف إليها إيماءات، ودلالات جديدة.
يقول في المتن: 'أقضم الوقت، لا يقضمني، كسرة فكسرة مرة حامضة.....'.
و في الهامش: 'أقضم الوقت من جوع وشراهة، هنيئا.. مريئا. ما ألذه ما أطعمه! لم يكن ثدي أمي العجوز كافيا، وما انفطمت. فشببت على جوع أزلي وشراهة أبدية'.
لقد عمق الشاعر الصورة الحلمية في الهامش حين اتسعت لدونة المعنوي / الوقت، ومادته التي ارتبطت بالشراهة الدائرية، واللذة؛ وكأن المتكلم يتجاوز ذاته التاريخية في الهامش بينما يصارعها في المتن.
النص الوليد
النص الوليد في كتابة رفعت سلام ينبثق من المتن، أو من تداعيات دواله، وصوره؛ ولكنه يحمل دلالة الإضافة، أو البداية الجديدة، وقد يولد في المتن نفسه، أو في الهامش؛ فهو يعمق أخيلة النص الأصلي، دون أن يكون تابعا له تماما؛ إذ يتميز بحضور خاص، أو يدخل المتلقي في فضاء جديد للكتابة تتجسد فيه رؤى تأويلية، وحلمية مغايرة للمتن، وإن ولدت من آثاره.
يقول في المتن: 'أنا لحبيبي حديقته السرية، يحرثني فيقتلع الحشائش الشيطانية...'.
ثم يقول في النص المولد بالهامش: 'حديقة غضة بضة، لا تعرفها الجغرافيا والزراعة. تكتنز الفواكه المحرمة، والطعوم اللاذعة. مزدهرة بلا خريف'.
لقد عمقت صورة الحديقة الأخرى في النص الوليد من المدلول الروحي المتجاوز للزمكانية في الحديقة الأولى؛ وقد كان كامنا في المتن، وإن جاء تابعا لصخب المرأة، بينما اتحد في النص الآخر بمعنى الخلود، والاتساع الكوني في عوالم اللاوعي.
التناص، وتأويل التراث:
تقوم كتابة رفعت سلام على تناص إبداعي يعيد تشكيل أصداء التراث الثقافي في سياق تصويري جديد، بحيث يصير المدلول القديم في حالة من الفاعلية في اللحظة الحضارية الراهنة، أو في لحظة الكتابة.
الصوت يواجه تناقضاته، وبحثه عن الصفاء، والمعرفة باستحضار مآسي نقصان المعرفة، أو اكتشاف ظلام المأساة نفسه.
يقول: 'دليلي: كاهن أعمى البصر والبصيرة، يسوقني إلى البحار الجافة والحقول المريرة. دليل لا يدل، بل يضل'.
ويقول في موضع آخر: 'أرفرف في فضاء من البهاء. أطفو في الهباء الجميل... لا بصر ولا بصيرة'.
و تذكرنا تلك الصور بشخصية تيريزياس في مسرحية الملك أوديب لسوفوكليس؛ فقد كشف حقيقة اللعنة أمام أوديب بينما كان هو ملعونا بالعمى، ولكنه يأتي في نص رفعت سلام جامعا بين عمى أوديب، وغفلته، ومأساته، وكذلك عماه الشخصي؛ ومن ثم فقد قدرته على الإدراك، والمعرفة الأصلية، وإن استشرف تأويلا آخر لكينونته يقوم على مجازات الحزن، والسلب نفسها.
نحو رؤية اجتماعية:
تتجه البنى الاجتماعية الكامنة في النص إلى تغليب مدلول التلاشي الصاخب على ضمير المتكلم بحيث تبدو الذات في حالة من التلقي السلبي لضربات التناقض، والبزوغ البدائي لسطوة القوة، وانهيارها في آن، ولكن الوعي المبدع يظل قائما خلف سطوة الحالات الصاخبة، والأصوات؛ فيشكلها بلغة جديدة، وينتج من البنى القاهرة الأولى رقصته الصافية، وتجليه المتجاوز لتاريخ العنف، وإمكانية اختفاء الأثر الجمالي المصاحب للمجموع الإنساني.
يقول: 'أيتها الرقصة المجنونة، هبي في أعضائنا النائمة، حتى مطلع الفجر؛ صنعت لك جناحا من عقيق، وجناحا من لازورد..'.
ويشير دال الفجر هنا إلى صفاء الرقصة الإبداعية في فضاء واسع تشكل فيه الذات هويتها، وصوتها النقي المحمل بثراء الماضي، وجمالياته خارج الأطر.
القدس العربي- 2012-08-17