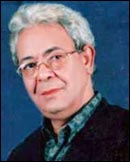 في ديوانه (سماء على طاولة) الصادر عن هيئة الكتاب 2005يحاول الشاعر الأستاذ محمد فريد أبو سعدة أن يحور الأثر المفهومي للظواهر الكونية والواقعية المدركة في الوعي؛ وذلك عن طريق ازدواج فانتازيا الشعر بالصيرورة السردية في آن، فما تلبث الظاهرة أن تتبلور كصورة مجازية قيد التشكل حتى يكسبها التحول السردي حضورا جديدا يتجاوز الواقع من داخله؛ إذ لا يمكن تعريف الظاهرة إلا من خلال المؤول السردي ذي الكينونة الجديدة / فوق الواقعية .
في ديوانه (سماء على طاولة) الصادر عن هيئة الكتاب 2005يحاول الشاعر الأستاذ محمد فريد أبو سعدة أن يحور الأثر المفهومي للظواهر الكونية والواقعية المدركة في الوعي؛ وذلك عن طريق ازدواج فانتازيا الشعر بالصيرورة السردية في آن، فما تلبث الظاهرة أن تتبلور كصورة مجازية قيد التشكل حتى يكسبها التحول السردي حضورا جديدا يتجاوز الواقع من داخله؛ إذ لا يمكن تعريف الظاهرة إلا من خلال المؤول السردي ذي الكينونة الجديدة / فوق الواقعية .
إن الشاعر يحاول أن يمسك بالمادة في براءتها الأولى و قدرتها الأسطورية على التحول واكتساب القداسة الشعرية.
في الحركة الأولى من الديوان، بعنوان (ما أذكره من كلام السماء) يعايش الشاعر الظواهر معايشة جسدية؛ بمعنى أنه يتحدث بصوت المادة حين تتحرر وتصير فاعلة في لعبة الشعر أو احتمالها لتناقضات الإنسان وأرقه،يقول:
"لماذا تدلف السحب من النافذة / و تتكوم على سريره هكذا / مثل قطة / كثيفة الشعر / لماذا تتمدد السماء على الطاولة / لماذا تتقلب فلا يجد مكانا يضع فيه القهوة "
لقد امتزجت الذات المتعالية – في الرجل – بالسماء التي احتلت موقعه فاكتسب القداسة الأبوية في الحضارات القديمة، ولكنه ملتبس أيضا بهوية كونية مجهولة تعزز من احتمالات الغياب في هويته .
فهل كان الغياب عدما؟ أم أنه اندماج بمادة إبداعية لا تنتهي؟
وجاءت الحركة الأولى من كلام السماء مشبعة بانتشار الدوال الصوتية المعزولة عن أصولها المرجعية، إنها البديل الإبداعي المتغير عن حضور الكائن في المشهد؛ فهي كالألوان، لها تأثير الطاقة دون صخب مادي، فذاكرة الوعل تنثر أحلامها على هيئة أصوات لا أصل لها في بوق يشبه الهواء؛ وصوت السماء لم يأت مرتبطا بقداسة الروح، ولكنه غناء كوني يستدعي فناء الجسد (جسد المغنية أو الشاعر/صاحب الموبايل)، وكان قد تركه في قفص الكناريا كبديل عن حلم الذات بتحقيق الوجود من خلال الصوت المجرد من رقابة الوعي، يقول الشاعر :
"كنت هنا بالأمس وتركت الموبايل لأسمع الوعول/ وهي تتكلم في أحلامها / ما الغريب في ذلك ؟ "
ونلاحظ هنا تكرار استخدام الشاعر للصور فوق – الواقعية كمبدأ وجودي؛ وفي ما فوق الواقعية/ hyperrealism لا يمكن تمييز الواقع من عمليات إعادة الإنتاج التي تصير أكثر واقعية رغم ارتكازها على محاكاة الصور للصور (راجع / ر. ك ويلكيرسون/المماثلة الاستعاضية وبنية الحلم عند جان بودريار /ت / سامح فهمي / الفن العاصر عدد4 / 2002)
فمثلما صار الموبايل جزءا من مخيلة الوعول و العصافير، فارتفع عن مرجعيته، استحالت الذات – في مقطع آخر من كلام السماء – إلى مادة تندمج بالسحابة، كأنها جزء من حركتها الكونية، أما السيارة الحمراء المكشوفة، فقد سالت كنقطة دم أو بقعة سماوية على اللوحة في وعي القارئ .
إن ارتباط الشاعر بالسحابة، ثم تحول السيارة كحدثين، يمكن وضعهما في سياق تأويلي للمعاينة الواقعية الأولى، و رغم الصياغة السردية التي تؤكد التعاقب بين المشهدين، فإنهما حدثا في وقت واحد ؛ فالواقع و تأويله / الفائق قد حدثا معا، و يؤكد هذا المنظور قراءة الشاعر للقلاع وفق مظهرها الحضاري القديم و لكن من منظور جمالي يرتبط بالواقع التاريخي نفسه، فالقلاع ليست فضاء للعظمة أو أداة للصراع، فقد حفرت من أصوات معذبة و سقطات مفاجئة للملوك، و أناس يحملون رؤوسهم على أيديهم، و مماليك ذبحوا كالدجاج .
إن مادة القلاع طيفية بالأساس، إذ إن آثار الأصوات و الأجزاء المقطعة تقيم احتفالية بالموت، ثم تؤول اللحظة الراهنة وفق حياتها الجديدة :
" المماليك لا يزالون هناك في الممر الضيق / يتخبطون كالدجاج المذبوح / إنني أسمع أصواتهم من هنا / من فوق المقطم "
و في مقطع آخر من كلام السماء، يظل الشاعر في موقف المراقبة التأملية للأبراص، إذ ينتظر تحول الذيل إلى برص كامل، و لكنه لم يفلح . إن المعجزة التي ينتظرها الشاعر تتعلق بالبعث، بالوجود الآخر من داخل التشتت والانفصال.
إن هذه المراقبة ذات النزعة السردية الواضحة، توازي حلما وجوديا بتناثر صور الحياة، و يبدو أن هذا يحدث كظاهرة في الوعي تستبدل الموت، وكل ما يتعلق بالواقع التقليدي ومفرداته ذات الطابع الشمولي، فالتعاقب بين انقطاع الذيل وعملية التحول الأسطوري يمنح الحدث الأول فتنة وسحرا .
"يبدأ من جديد/ آملا/ كما جاء في الكتاب/ أن يرى المعجزة /حيث يتحول الذيل إلى برص كامل/ ويتحول كل ما يمشي عليه / إلى ذهب إبريز "
وفي الحركة الثانية من الديوان، بعنوان (ما أذكره من كلام العائلة)، يستعيد الشاعر الخبرات الكونية من مخزون اللاوعي الجمعي، وما يحمله من عناصر مشتركة مع جماعات الحيوان والطيور والحشرات، فالشاعر يقتنص اللحظة التي يواجه الكائن فيها حالات العبث، والانفصال عن المجموع/ العائلة، ومن ثم فتاريخ العائلة فردي الطابع، حيث التكوين في مواجهة التلاشي، ولكن اللحظة السابقة تعيد إحياء الألم في ذاكرة الشاعر إذ يعيد تمثيل المشهد كأنه بداخله في حياة جديدة، يقول :
"فصلت الديوك وأرسلتهم/مع زوجة البواب إلى الذبح/كنت أتأمل الجملة الأخيرة / هل الحياة رهان بين الموت و الألم (أما الدجاجات) تميل رءوسها وتنظر إلينا بعين واحدة "
وقد يعيد الشاعر قراءة الوعي بالجسد من خلال اللقاء الأسطوري بالصورة السابقة على الوجود الآني. إن الجسد في هذه الصورة يعايش جنته الأولى، رافضا سجنه الوجودي، ومن ثم تصير اللوحة المتخيلة مادة جسدية أكثر تحررا و حضورا وقدرة على تجاوز العدم.
"قالت أنت تهذي يا حبيبي/ انتبه /هذه يدي/ انظر هذا صدري/بدأ ينشج /أنت هناك. هناك. وأنا هنا وحدي"
وفي مقطع آخر من هذه الحركة يولد الشعور بالانفصال رقصة أسطورية للموجودات رغم حتمية الموت .
"زارتني الديوك/ بلا رؤوس/ راحت تحرك أجنحتها/ و تهاجمني بعنف/ كانت بجواري / في يدها السكين لا تزال / وفي الطبق اثنتا عشرة عينا تنظر لي"
إنها لحظة شديدة الكثافة، تتجاوز المنطق التاريخي للاستاطيقا ؛ إذ إنها تنتج الحياة من داخل الموت وتقيم انشطارا بين الوجود الراقص في اللوحة، واحتمالات التشيؤ بعد الذبح، كما أن معاينة الشاعر لاثنتي عشرة عينا في الطبق/بديل الأرض أو الوجود، توحي بتفجر الحياة من المعجزة رغم ثقل الموت .
ويتناص الشاعر هنا مع القرآن الكريم، ليحقق القداسة الملازمة للصورة، ولو كانت في مواجهة العدم .
والتناص أداة متواترة عند فريد أبو سعدة، في هذا الديوان و من قبله (ذاكرة الوعل)، وأرى أن الشاعر يولد من خلاله اندماجا إبداعيا بين عدد كبير من الرؤى والفلسفات والحضارات في بوتقة (ذات كونية) تتجاوز إغلاق الحدود الثقافية، وتنفتح دون مركزية على صور الحضارة بعد تجريدها من الأيديولوجيا .
و يلتقي هذا البعد مع النزعات الطليعية المتجاوزة للحداثة و ما بعدها، حيث يلتقي النص بالثقافة و الواقع دون حدود واضحة .
وفي الحركة الأخيرة بعنوان (ما أذكره من كلام الرجل الوحيد) يخترق النص مدلول الذات المتعالية، و يضعها في حقل التلاشي أو الغياب؛ فالشعر ينفصل عن هوية الشاعر كمادة غريبة محجوبة :
"صاحبت الشعر ثلاثين عاما /ولم يثق بي/يبتسم في وجهك/ ويبدو متفهما ولبقا / لكنه لا يعطيك سره أبدا "
وفي مقطع آخر يبحث الشاعر في أبجدية اللغة، ليقصي تراتبيتها إلى الهامش، فأي سياق – وفق مبدأ الإنتاجية - سيكون محتملا، يقول:
"الصحف تتساقط علينا نتفا كأصابع مجزوم/ ودم يبقع قمصاننا و لا ندري من أين"
لقد اقترن التدمير بالبهجة، لأن الوعي مازال يستمتع بحرية الدوال والثقافات في النص
إقرأ أيضاً: