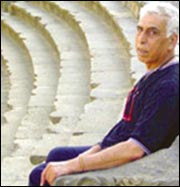 منذ أن كتب قصيدته الأولي وهو لا يتوقف عن إنتاج الدهشة!
منذ أن كتب قصيدته الأولي وهو لا يتوقف عن إنتاج الدهشة!
فصاحب (الأخضر بن يوسف) الذي ما إن يصل إلي مقترح جمالي وفني في قصيدته حتى يغادره إلي مقترح جديد وكأنه يمتلك تلك الروح القلقة أو (روح الطائر) كما يسميها عباس بيضون
ومن هنا كان سعدي يوسف فاتحا للسكك التي استلهما الكثيرون من الشعراء فيما بعد، أصبحت الحياة اليومية هدفا شعريا بالنسبة له ... أي موقف عابر لا يمكن أن يخطر في بال أحد يصلح لكي يكون قصيدة شعرية عنده... فهو الشاعر الذي درب نفسه علي طريقة في الكتابة حمته من الوقوع في 'الرطرطة' اللغوية بالتعامل مع سمات أصبحت جزءا من قصيدته، حيث الإيقاع الخافت والكثافة اللغوية، قصيدة )مقنعة( يهرب بها من الأنماط الجاهزة والمعدة سلفا ... تحتاج ¬كما يقول¬) إلي وعي حاد باللغة وجمالياتها، وجماليات الشعر، والمشروعية الفنية في التعبير عن الفكرة، عن السياسة (مشروعية الفرد).
عرف السجن والمنفي، وفي )بيروت 82) كان مع المحاصرين يقاسمهم خبزهم وتهديد الموت المستمر لهم. ولم تفلح عروض كثيرة للنجاة¬ قدمت له¬ في أن تثنيه عما رأي أنه الأشرف والأجدر بالشعراء .لم يكن كونه شاعرا كبيرا يحمل _ عنده¬ سوى معنى واحد (يؤكده حلمي سالم) : (هو أن يكون، كما ينبغي لشاعر كبير أن يكون).... وعندما خرج الفلسطينيون من بيروت كان أول من خرج معهم بملابس عسكرية رغم أنه قد تجاوز الأربعين وقتها !
منذ ست سنوات تقريبا كان من المقرر أن يشارك سعدي في أحد الاحتفالات الثقافية بدمشق وكان قادما من عمان... وأثناء دخوله تم إيقاف الأتوبيس الذي يحمله وتفتيشه وتم توقيف عاملين أردنيين كانا معه ومنعا من الدخول، أعترض سعدي يومها بشده وقرر العودة من حيث آتي معتبرا أن عبوره وحده نوع من الخيانة لأفكاره.
لم تمض أسابيع قليلة حتى طلب اللجوء السياسي إلى لندن، بعد أن أيقن أن منافيه العربية أصبحت (كالمستجير من الرمضاء بالنار) وأن الشروط الحالية للمنطقة العربية لا تسمح باختراق ثقافي بعد أن أصبح المثقف يقمع نفسه لصالح السلطة .
وفي أرض الضباب لم يتوانى أن يهجو بلير رئيس وزراءها بل وينتقد بشده موقف المملكة المتحدة من الحرب على العراق، خرج في مظاهرات ليعلن أنه ضد الحرب، ورغم البلبلة التي اشتعلت بين المثقفين العراقيين إزاء الموقف من الغزو، مع أو ضد الدكتاتور ... ظل سعدي يحمل العراق في قلبه ممنوعا من دخولها في ظل الطغيان والاحتلال !!.
وإن كان الاحتفاء بسعدي لا يحتاج إلى مناسبة، فما بالنا وهو يبلغ السبعين....إنه الشاعر الذي لا يشبه أحدا ولكن يشبهه الكثيرون كما يقول محمود درويش في شهادته التي ننشرها في هذا الملف. درويش لم يتردد في الكتابة إلينا فور أن طلبنا مشاركته معنا، وكذا الأمر بالنسبة للشاعر البحريني قاسم حداد، ومن مصر الشاعرين عبد المنعم رمضان وأحمد طه ومن العراق محمد مظلوم .
****
 أنا متعب أكثر ممٌا تتصور.
أنا متعب أكثر ممٌا تتصور.
كانت هذه العبارة خاتمة لحوار طويل مع الشاعر سعدي يوسف...
فلم يكن صاحب (الأخضر بن يوسف) يريد أن يفصح عن نفسه كثيرا، يحيط حياته بسياج محكم... ونادرا ما يتحدث عن تجاربه !
أرسلت إليه أسئلتي وسميتها دفعة أولي... أجاب على ما شاء منها...عن حياته والقصيدة والسجن والسياسة....
وعندما أرسلت إليه الدفعة الثانية وكانت عن المنفى.... أختار أن يتحدث عن هذه التجربة كما يكتب الشعر، بجمل قصيرة و عبارة مكثفة واضحة المعنى ولكنها قابلة للتأويل، لذا سنفهم منه مثلا أن بيروت مدينة صعبة... لكننا لا نعرف لماذا ؟!
ربما كانت إجاباته المكثفة منسجمة مع حالته ومع الوضع العام، إذ ما فائدة الكلام....وما فائدة القصيدة... بل وما فائدة الحياة نفسها ؟!
وربما أيضا لأن الحوار جرى بالبريد الإلكتروني أو ( الآلة)... التي لا يتيح العمل عليها تواصلا حقيقيا أو حديثا متدفقا !!
مع إجاباته الأخيرة كان رجاء منه : آمل في أن يكون هذا خاتمة المطاف !
ولكنه لم يكن، طلبت منه أن يجيب على سؤال يضعه بنفسه فاختار أن يتحدث عن القصيدة وكيف تأتي ؟!
... انتهى الحوار وظل كثير من الأسئلة التي فجرتها إجابات سعدي معلق الإجابة!
****
بلغت السبعين... ناضلت طويلا و تنقلت كثيرا بين بلدان شتٌى، عربية وغربية.شهدت حروبا، وحروبا أهلية، و كتبت شعرا وقصة ورواية ومسرح وترجمة...كيف تنظر إلى رحلة السبعين التي قطعتها ؟
لا يملك المرء أن يستبدل بحياته، حياة أخرى : هكذا يحاول قدرَ الإمكان أن تكون حياته ذات جدوى، لنفسه، ولمن حوله. لكنٌ الجدوى المرتجاة لن تأتي إنْ لم يكن للمتعة نصيب، بل نصيب وافر. أنا أستمتع بحياتي، وأعتني بالمطعم والمشرب والملبس. أسعد بالمرأة، وأسعِدها إنْ اقتربتْ من فهمي. حياتي، أعني حياتي اليومية، ملأى.
والطبيعة تمنحني قوٌة داخلية. أنا لا أشكو من وهَن أو علٌة. لكنٌ سؤالا يظلٌ يلحّ عليٌ باستمرار، ومنذ أمَد : أليست إقامة البشر على هذه الأرض ضربا من اللامعنى؟
بداية من اسمك ( سعدي )... هل لك من اسمك نصيب؟ هل ترى في اختيار الاسم دلالة؟ هل الاسم حجاب كما يقول المتصوفة؟ هل ترى أن ثمة علاقة بينك وبين الشاعر الفارسي الشهير الذي يحمل الاسم ذاته؟ هل حكى لك أحد من والديك لماذا أطلقوا عليك هذا الاسم؟ لو أتيح لك أن تختار اسما غير هذا يعبر عنك ويتوافق مع مسيرة حياتك ما هو ؟
فهمت من المرحوم، شقيقي، يعقوب، الأكبر سنٌا، وكان يرعاني بعد فقدِ الأبِ مبكٌِرا، فهمت منه أن اسمي كان في الأصل: محمد سعدي يوسف، لكن التعليمات المستحدثة آنذاك حول تسجيل الناس منعت الأسماءَ المركٌبة، فصار اسمي سعدي يوسف. قرأت سعدي الشيرازي في وقت مبكر جدا، قصائده التي كتبها باللغة العربية، مقلٌِدا المتنبي وقصائده المترجمة عن الفارسية وهي الأجمل، قرأت حافظ الشيرازي أيضا، وأعجِبت بالشاعرين، حتى قصدت مدينة شيراز، حيث ضريحهما يتوسط المدينة، محفوفا بالورد (بستان الورد) ! قبل نصف قرن كان هذا. وفي شيراز نبيذ أحمر مائل إلى الحلاوة، ذكره أوسكار وايلد في عمله (بيت رمٌان). ابنتي الصغرى سميتها شيراز. إنها: شيراز سعدي !
ماذا عن البدايات منذ ميلادك في أبي الخصيب بالقرب من البصرة....ما الذي أضافته لك هذه المدينة؟ وماذا عن الأسرة التي نشأت فيها، ما هي الروافد التي شكلت تجربتك الإبداعية؟
لم تكن أبو الخصيب مدينة. ولم تصبح مدينة حتى الآن، بسبب قربها من ساحات المعارك غير المجدية، واقتصار التنمية والتطوير حتى في الحدود الدنيا التي عرفناها، على العاصمة وتكريت. لكن البلدة كانت ذات أهمية سياسية وفكرية، كانت مركزا لحركة الاجتهاد، حتى لقد زارها جمال الدين الأفغاني. كما كانت من معاقل اليسار.
وفي أبو الخصيب جمال الطبيعة: غابات النخل والجداول التي تتخللها. الماء حاضر، يحمل الأعناب والسمك إلى عتبات البيوت. بين حين وآخر أرى صورا لما حلَّ بالنخل، كيف تقصٌفَ وتراجَعَ، وصار أعجازا خاوية، فأحزن حقا لأن صورة من الطفولةِ مزٌِقتْ بهذه القسوة البالغة. أسرتي كانت في منتهى التسامح. أي أنها لم تفرضْ على أي فرد فيها اختيارا. كنا نقرأ ما نشاء، ونتصرٌف بحرية. الطبيعة كانت رافدي الأول. قراءاتي الأولى كانت في المسجد، وفي التكيٌة النقشبندية بأبي الخصيب. هناك اطٌلعت على رسائل إخوان الصفا.
من هم آباؤك الشعريون ؟
أبونا جميعا، وحامل لوائنا إلي النار (كما يقال) هو امرؤ القيس. وكما هي العادة في بدء المسيرة، نبتدئ بامرئ القيس، وهكذا فعلت. اكتشفت أن الرجل جميل، مغامر، ميسَّر حتى في اللغة. تعلمت عروضَ الشٌِعر العربي من ميزان الذهب الشهير لأحمد الهاشمي، وطبٌقته على ديوان امرئ القيس. كانت المتعة والمنفعة بلا حدود ! ومتزامنا مع امرئ القيس كان المتنبي العظيم. وفجأة أطلَّ عليّ محمود طه، وجاء إلياس أبو شبكة مع (أفاعي الفردوس)، ثمٌ جاء ديوان (أين المفرٌ ؟) لمحمود حسن إسماعيل، أنيقا بالأصفر والأسود من شركة فنٌ الطباعة:
ألقيتَني بين شِباكِ العذابْ
وقلتَ لي : غَنٌِ
وفي أيام لاحقة جاء بدر شاكر السياب. إنه ابن أبي الخصيب، ونحن من قريتين متجاورتين: هو من جيكور التي خلٌدها، وأنا من بقيع المتٌصلة بجيكور، وبين أسرتَينا معرفة ونسب. كان بدر مرموقا بقصائده المبكرة التي كانت تلقى في التظاهرات. الحق أن بدرا اللاحقَ كان الأعمقَ تأثيرا فيّ. وأنا حتى اليوم، أري أنه قدٌمَ أسئلة في القصيدة لم يجب عنها بعد. سيظل بدر معلٌِما لي.
من المفيد أن أذكر أنني كنت أمتلك طبعة من الأعمال الكاملة لشكسبير باللغة الإنجليزية منذ أواخر الأربعينيات.
كيف استطعت أن تتجاوز هؤلاء الآباء لتصل إلى صوتك الخاص؟ وهل كنت واعيا منذ البداية بفكرة التجاوز، أي كنت مخططا لها؟ أم أن الأمر جاء بلا تخطيط؟ هل كنت تعي أنك تمهد لأرض بكر أو تشق مجرى جديدا في الشعرية العربية يختلف عن تجارب من سبقوك : السياب ونازك والبياتي على وجه التحديد؟
ليس في الفنٌ تجاوز. في الفنٌ إضافة جهد. الفنٌ لا يتجاوَز. الفنّ يخدَم. ومهما فعلتَ فلن تبلغ من الفن إلاٌ التخومَ. لنتواضعْ إذن.
ماذا فعلت؟ لقد فكٌرت، حقا، في تناول خاص، شخصيٌ، فرديٌ، وهذا حق لكل فنان. قلت مع نفسي: هذه الخارطة الشعرية العربية عمرها أربعة عشر قرنا، ولسوف أضيع فيها إن لم أجد لي سبيلا خاصٌا. أين وجدت ضالتي؟ في عموم الشعر العربي، لم يكن للفرد العادي نصيب من النصٌ الشعري. كانت القصيدة للمجموع. الفرد غائب أو مغيَّب. إذا هي فرصتي !
لأتحدٌثْ عن الإنسان البسيط في حياته اليومية، لأتابع المنسيَّ، والمهملَ، والمسكوتَ عنه، لأكنْ بسيطا. لتكن لغتي متساوقة مع هذا المبدأ. كانت نازك الملائكة الأكثر بحثا في الشكل الشعريٌ. عبد الوهاب البياتي ركب الموجةَ متأخرا. ولم يكن ذا جهد مرموق في تطوير الشكل الشعريٌ. نازك ظلٌت المؤهٌلةَ لذلك بعد الرحيل المبكر والفاجع لبدر، لكنٌ إقامتها في الكويت أضرٌتْ بها، وجعلتها تنكفئ وتتخلٌى عن ثوريٌتها التي استلهمناها جميعا. التقيت بها مرة في بغداد، قادمة من الكويت، كنا في أحد فنادق الاستضافة، وكانت محجٌبة، بينما كنت أحمل في يدي كأسا. تخليت عن الكأس احتراما لها. قلت لها : يا سيدتي نازك أنتِ علٌمتِنا انتهاكَ المحرٌمات (أقصد في فن الشعر ). ردٌتْ عليَّ : أستغفر الله !
عليٌ الإشارة أيضا إلى التأثير المبكر للشعر الأميركيٌ عبر والت ويتمان في أوراق العشب، وإلى عموم فن القصة الأميركي في التشكل النهائي للنصٌ الشعري لديٌ. أنا أعتبر القصة القصيرة الأميركية الأنموذجَ الأعلى ليس في فنٌ القَصٌ فقط.
هناك أمر جدير بالتنبيه إليه وهو: احترام الواقع والوقائع في النص الشعري. أنا تعلٌمت هذا الاحترام وطبٌقته (بقسوة أحيانا) مستفيدا من القصة الأميركية القصيرة. قد يعتبَر هذا المورد إشارة إلى تداخلي في الفنون الأدبية (فنون القول)، وهو تمهيد إل ما سيجري من تداخل لاحقاً بين النص الشعريٌ لديٌ، وبين فنون أخرى ليست من فنون القول، كالرسم والموسيقي والسينما .
ارتبطت في بداياتك بمجلة (شعر) البيروتية... كيف تقيم الآن تجربة هذه المجلة ودورها في تحديث الشعر العربي؟
العدد الأول من مجلة (شعر) حمل في صفحته الأولى قصيدة لي، وكنت شاعرا مجهولا تماما، لا أعرف أحدا، ولا يعرفني أحد، لكنهم، أعني يوسف الخال تحديدا، نشروا قصيدتي، ومنِع العدد بسببها من دخول العراق. دور مجلة (شعر) كان تحديثيا وأساسيا. لِمَ جرى ما جرى ؟ الاتهامات والاتهامات المضادٌة، حين نراجع اليومَ، ما حدثَ أمسِ، نأسى لأنٌ المنافسات المحدودة أعطِيَتْ صفة عالية من المبدأ والمنطلَق. العروبة وأعداء العروبة.. الخ. لم يكن الأمر هكذا، بإطلاق.
ثمة عديد من التجارب التي مررت بها مثل تجربة السجن... رغم قسوة مثل هذه التجربة... هل تحدثنا عنها ؟ وعلى أي مستوى أفادتك؟
تجربة السجن بدأت زمن الجمهورية الأولى، أعني زمن عبد الكريم قاسم. شاركت في تظاهرات لإيقاف القتال في كردستان، وكان الشعار الذي صاغه الحزب الشيوعي هو : السلم في كردستان، يا شعب طَفي النيران !
ثم جاء البعثيون في 1963، وقدٌموني إلى محكمة عسكرية، وحكِمَ عليٌ بالسجن. تنقلت في سجون عدة، سجن البصرة، سجن نقرة السلمان الصحراوي على الحدود العراقية السعودية، عند بادية السماوة التي قتِلَ فيها أبو الطيٌب المتنبي، ثم إلى سجن بعقوبة. أطلِقَ سراحي مصادفة، ليلةَ انقلاب عبد السلام عارف على العبثيين في 1963. كان حسين مردان الشاعر الصديق، صديقا لعلي صالح السعدي، نائب رئيس الوزراء، والشخصية البارزة في الحكم، وفي التراتبية الحزبية البعثية، وسأله علي صالح السعدي إن كان هناك شعراء لا يزالون سجناء. ذكر حسين مردان اسمي، فصدرت برقية فورية بإطلاق سراحي. وردت البرقية إلى سجن بعقوبة مساء.
استفسرت مني إدارة السجن إن كنت أريد الانتظار حتى الصباح لآخذ ملابسي وبعض المال المودَع، قلت: أذهب الآن ! وهكذا خرجت من السجن بالبيجامة إلى بغداد حيث اتصلت بأقاربي ليتسلٌموني من مديرية أمن بغداد. لو تأخرت يوما لبقيت في السجن عشر سنين.
ملحوظة: حين توفى علي صالح السعدي، مغضوبا عليه، زمن صدام حسين، حضرت مجلس العزاء، امتنانا له. كان نصّ البرقية كما أتذكره الآن، بالرغم من كل لعنة السنين: يطلَق فور سراح الشاعر التقدمي سعدي يوسف.
أنا مَدِين للسجن !
لقد تعلٌمت في السجن أمورا كثيرة، منها الاعتماد على النفس، والاكتفاء بالقليل، واحترام خصوصية الآخر. وممارسة أفعال قد تبدو غير مناسبة كأن ترقع نعلك بنفسكَ أو ترفو جوربكَ وسوى ذلك 'يقال إن المرءَ يعرَف على حقيقته في السجن وفي الترحّلِ. في السجنِ تنظر إل الداخل، داخلكَ. وفي الترحّلِ تنظر إلى الخارج، خارجِكَ. وأنت في الحالَينِ حاضر.
في أكثر من مكاني وقارة، أكون مع قاسم حدٌاد، الشاعر، والسجين السابق، مثلي. أشكو له هذا الأمرَ أو ذاكَ. الغرفة في الفندق غير مناسبة، أو الاستقبال في المطار لم يكن في موعده، أو أن الطعام ليس شهيٌا... الخ. جواب قاسم الدائم الذي لم يتبدٌل مع السنين : لكنْ.. أحسن من السجن !
تماماً، يا قاسم، تماماً.. أحسن من السجن !
هل أحِنّ إلى السجن ؟
كنت شيوعياً في سن مبكرة، ما الذي قادك إلى الشيوعية.... على أي مستوى أفادتك تجربة العمل السياسي؟ وهل الشاعر ينبغي أن يكون ملتزما أم أن الالتزام يحد كثيرا من تجربته الإبداعية؟ ما هو تقيمك لتجربتك مع الحزب الشيوعي العراقي؟
شيوعي في سنٌ مبكٌِرة !حقا ' كنت في الخامسة عشرة حين انضممت إلى الحزب الشيوعي العراقي. الدوافع: الفقر والمغامرة. ليست لي تجربة في العمل السياسي. اعتنقت الشيوعيةَ منطلَقا في الحياة، تحوَّلَ مع الزمن والممارسة إلى منطلَق في الفن، أي أن نظرتي إلى قضايا فنية صِرف مثل الصورة وتناول التاريخ والخصيصة اللغوية والاتصال تستمدّ الكثير من الفكر الماركسي. التزام الشاعر هو التزام أخلاقيٌ.
وكما قال أفلاطون : الأخلاق قبل السياسة. تجربتي مع الحزب الشيوعي العراقي عاديٌة، بمعنى أنني لم أخضْ في إشكاليات تنظيمية أو فكرية لأنني لم أكن عضوا بالمعني التنظيمي الدقيق إلاٌ فترة قصيرة جدا. ولست مَعْنيٌا الآنَ كثيرا بمتابعة الجدل القائم حول ما يفعله الحزب الشيوعي في العراق هذه الأيام. وعلى أي حال، سأظلّ الشيوعي الأخيرَ في عالَم يزداد قسوة.
(المنفى المحترف) يصلح الوصف بامتياز على سعدي!
ففي 1957 كان خروجه الأول إلى الكويت و1964 لجأ إلى الجزائر...وفي 1979 لجأ إلى بيروت ثم إلى الجزائر مرة أخرى...وأنتقل إلى عدن فدمشق وروسيا وباريس وقبرص وبلجراد وتونس قبل أن يستقر لفترة في العاصمة الأردنية (عمان) التي تركها لاجئا سياسيا في لندن !
في كل مرة كان سعدي يتصور أن هذا المكان أو ذاك هو منفاه الأخير ولكن لم يحدث ذلك إلا في لندن حتى الآن حيث يرى أن سنوات المنفى العربي كانت (كالمستجير من الرمضاء بالنار ).
سألته:بعد هذه الرحلة الطويلة من المنافي الممتدة هل وجدت في لندن، مستقرا لك، أم أنها محطة أخرى مؤقتة على درب هجرتك الطويل؟
أعتقد أنني حططت الرحالَ هنا في لندن. لم تتبقَّ أماكن كثيرة للذهاب. لقد ضاق بنا العالم.
خلال هذه المنافي المتعددة... كيف توصلت إلى حالة التوازن في الكتابة بين الوطن والمنفى؟
التوازن في الكتابة متعلٌِق بالحرفة والاستعداد. لست متوازنا على الدوام. لكني توصلت منذ أمَد إلى أن حياتي الطبيعية هي خارج بلدي. في بلدي لم أكن أشعر بالحرية مطلقا. كان التهديد مستمرا، متراوحا بين الحدٌ من حريٌتك ووضع حدٌ لحياتك.
هل ثمة مدينة من مدن المنفى المتعددة استعصت عليك أو عاندتك لم تعطك سرها...كيف تستطيع أن تمتلك مفاتيح هذه المدن ؟
أعتقد أن بيروت من أصعب المدن.
ما الذي أضافه المنفى إلى قصيدتك ؟ وهل تظن أن اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة يعود إلى هذه التجربة (التنقل والترحال) ؟
المنفى أضافَ إلى حياتي. الاهتمام بالتفاصيل كان جزءا من مقاربة للشعر. ليست للأمر علاقة بالمنفى.
هل روض المنفى أن يكون لديك رغبة في امتلاك شيء ما وليكن كتاب تعشقه أو تحبه؟ وهل أعاقك مثلا من أن يكون لك مكتبة تعود إليها؟
دائما أكوٌِن مكتبة وأتركها، حتى لقد أطلقت على المسلسَل: لعنة المكتبة. الآنَ لديٌ مكتبة أيضا. الفارق أن كتبها باللغة الإنجليزية، ولا تضمٌ إلاٌ القليل من الكتب العربية. ربما انتهت اللعنة!
هامش خارج الحوار:
تحت عنوان (المكتبة الملعونة) كتب سعدي في أوائل الثمانينيات مقالا طريفا ومؤثرا، نشره في كتابه (يوميات المنفي الأخير) يستدعي فيه ذكرياته مع مكتباته المختلفة التي ما إن يشرع في الانتهاء من تكوينها حتى يفاجأ بأن عليه أن يغادرها.... يكتب: (قبل أيام، اشتريت مطرقة ومنشارا وحفنة مسامير. وقد كنت جمعت من علية الشقة ومن سطح العمارة، ألواحا، بعضها جديد، وبعضها مسود من المطر الشمس. اتخذت الشرفة مشغلا، وبدأت أصنع مكتبة... والحق أن ما صنعته يداي، لم يكن الشيء الذي توهم به كلمة مكتبة.... بل كان رفوفا هزيلة مترنحة، لا أدري كيف انضمت إلى بعضها، وتضامت وكيف نهضت متعمدة على نفسها، وكيف تحملت ما ألقيت عليها من كتب...
المهم أن هذه الرفوف الهزيلة المترنحة انتقلت بكتبي من أرضية الغرفة إلى مستوى آخر، ووهبتني الإحساس اللذيذ بأن لديّ مكتبة أو ما يشبه مكتبة، لكن ابنتي حين دخلت الغرفة، خرجت ضاحكة مني ومما صنعت.... قائلة أن هذه الرفوف سوف تهوي على رأسي يوما من الأيام.
أتراها لعنة المكتبة ما تزال تطاردني ؟
أم هي اللعنة التي ما تزال تطارد مكتبتي؟
عام 1957 كانت لدي مكتبة، اخترت كتبها، متأنيا، طوال سنوات دراستي الأربع في الكلية، وخلال سنوات عملي الثلاث، ومازلت أتذكر بعض ما فيها: دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، والمؤلفات الكاملة لشكسبير في مؤلف واحد، طبعة حسين مؤنس لديوان أبي تمام... هذه المكتبة الأولى فارقتها، حين غادرت وطني إلى المنفى، عام 1957.ومن جديد، أجمع مكتبة....أجمعها في هوس وحمى، وأتذكر أنني اشتريت يوما حمولة عربة خضار، كتبا إنجليزية... لقد تضخمت مكتبتي فجعلت لها فهرسا، ورقمت كتبها، وكانت لها غرفة خاصة.
ويلقي علي القبض ويفتش منزلي، وتغدو المكتبة عبئا على ذوي...
كان ذلك عام 1963.
الكتب تطعم تنور الخبز بالوقود الجزل، والجدول الصغير قبالة بيتنا، يحمل حين يمتلئ بمياه المد، الكراريس والكتب الصغيرة، والأوراق التي تضم محاولاتي المبكرة في الشعر، تلك المحاولات التي لم أنشرها، ولن أنشرها، لكنها كانت ستفيدني يوما ما في مراجعة بداياتي والتعرف على مصادر شعري.
عام 1964، التجئ إلى الأرض الجزائرية، أدرس في ثانوية بمدينة سيدي بلعباس، في الغرب الوهراني.
واجمع، ثالثة، أصول مكتبة، وأهيئ لها رفوفا. إن جمع مكتبة في ظروف الجزائر، آنذاك، عمل غير هين، بسبب ندرة الكتاب العربي، وغياب الكتاب الإنجليزي....
لكني احتفظت بدأبي.
كنت أقضي أوقاتا طويلة في المكتبات الفرنسية. وأقلب كتب الأرصفة، لأعثر بعد طول تقليب وتنقيب، علn كتاب إنجليزي، قد يكون مسرحية لشكسبير، أو رواية بوليسية لأجاثا كريستي... وأدرس اللغة الفرنسية، فينضم إلn مكتبتي مخلوق جديد هو الكتاب الفرنسي. وأغادر الجزائر في أواخر عام 1971... ما تراني صانعا بالمكتبة؟
قلت: أهديها إلى صديق...
لكنني أهديتها، أخيرا، إلى مكتبة الثانوية التي درست فيها تلك السنين بين 1964 و1971...ثانوية الحواس.
في بغداد 1971، بدت لي الأمور، للوهلة الأولى، أكثر مدعاة للاستقرار، أي أكثر مدعاة لتكوين مكتبة معتبرة.
هكذا خصصت حجرة للمكتبة، وأوصيت نجارا بعمل خزانات لكتب، وأثثت الحجرة بمكتب وكرسي عمل، ومستلزمات أخرى....
وشرعت أجمع الكتب. لكنني قررت أن تكون مكتبتي، هذه المرة أكثر تخصصا.... مكتبة شعر وما يدور حول الشعر من نقد وتاريخ وسيرة.
وتمتلئ الخزانات والرفوف...
في أوائل 1979 أغادر الوطن، طلبا للحرية... وفي أسابيع قليلة ينهار كل ما بنيته طوال ثماني سنوات... وتنهار المكتبة أيضا. لكن انهيار المكتبة كان الأصعب. فالأثاث يمكن بيعه... ولكن من يشتري الكتب؟ بل من يقبلها هدية أو أمانة؟
كان الكتاب كالعقرب. لا سبيل إلى التخلص من المكتبة إلا النار.....
وترتفع الحرائق الصغيرة، محاطة بالتوجس والخوف... والكتاب..كما نعرف، لا يحترق بسهولة الوقود.
عدت إلى سؤاله : ماذا عن متعلقاتك الشخصية، صورك، أشياءك الحميمة هل كنت تتركها بسهولة؟
الصور، الرسائل، الشهادات .. الخ، تضيع وتتبدد. أواخر 1968 حين غادرنا عدن تحت الرصاص المنهمر، في رحلة أسطورية عبر البحر الأحمر، سقطت أوراقي وأوراق أسرتي في البحر (كانت في حقيبة صغيرة)، وهكذا وجدت نفسي فجأة بلا ورقة ولا هوية ولا شهادة ميلاد.. ولا .. ولا . لست أدري كيف دبرت أموري في ما بعد ! أنا حتى الآن بلا أي وثيقة، سوى وثيقة السفر البريطانية، وهي ليست جواز سفر كاملا.
ما هو الكتاب / الأشياء الذي كنت تحرص على ألا يفارقك / تفارقك في كل مكان تذهب إليه ؟
أحتفظ بالقرآن دائما. و لسان العرب.
هل لديك الآن طبعات أعمالك المختلفة أم فقدتها.... ما الذي تشعر به عندما تري مثلا طبعة من أحد أعمالك لا تمتلكها أو فقدتها؟ هل تتشبث بها وتريد أن تحصل عليها من صاحبها أم تتركها.....؟
كانت لديٌ. آخر مرة استطعت جمعها يومَ كنت في الأردنٌ. بذلت جهدا كي أجمعها. الآنَ لست أهتمّ بالأمر .
هناك كثير من المقترحات الجمالية والفنية في قصيدتك لم تمض بها إلى نهايتها... تنقلت أيضا بين أشكال أدبية مختلفة (الرواية والمسرح والترجمة... وغيرها).. هل الأمر متعلق بتلك الروح القلقة لديك (روح الطائر) كما يسميها عباس بيضون، والتي اكتسبتها من المنفى أم لأسباب جمالية ؟
عدم المضيٌ طويلا في توصّل فنيٌ وجماليٌ معيٌن، عائد أساسا إلى رغبتي المستمرة في تجديد حالي، وإلى انفتاحي على منابع وأشكال جديدة. للمنفى دوره الإيجابي هنا، إذ هيٌأ لي إمكان الإطلاع المستمرٌ على منجزات الآخرين.
هل استسلم سعدي يوسف إلى الغربة؟ ماذا عن العراق؟ هل تحلم بالعودة إليها؟
ما الذي يمنعك أو يحول بينك وبينها؟ وهل وجدت بغداد أخرى كما قلت مرة : المدينة بالناس......ولكنهم أنت؟ إذن سوف أطلب أهلا سواهم وأقصد بغداد أخرى ؟
لن أعود إلى العراق حتى زائرا. أنا لم أغادر العراقَ مستعبَدا لأعودَ إليه مستعمَرا. والسنوات القليلة المتبقية لديٌ لا أريد أن أبددها في بحث غيرِ مجْدي عن عراق غيرِ قائم.
هل تشعر الآن بهدوء روحك القلقة أم أنها مازالت تعتكر بوحول الذاكرة والحنين إلى ماضي بعيد؟
روٌضت نفسي على مكافحة الحنين (النوستالجيا)، وهذا الترويض بدأ منذ عشرات السنين. النوستالجيا معوٌِقة، لأنها تفقِد الفنانَ توازنَه الضروري للسيطرة على مادٌته.
يشغل المكان بمفرداته المختلفة حيزا كبيرا في قصيدتك... هل هي محاولة لاستحضار المكان شعريا كأنك لم تفارقه؟ كما أن تحرص دائما أن تلحق بالقصيدة دائما مكان كتابتها. هل هو محاولة للفت نظر المتلقي إلى خصوصية الفضاء الذي ولدت فيه هذه القصائد بعيد عن السماء الأول كما يقول جابر عصفور ؟
الاهتمام بالمكان جانب من مدخلي الفني إلى كتابة النص ٌ. إنه نابع من رؤيتي النصَّ مؤسَّسا على حقيقة : ماديٌة في الغالب، وشعورية أيضا.
هكذا يأتي المكان العراقي وغير العراقي. ثم أن عليٌ واجبا صعبا بسبب الترحال المستمر، هو توطين النصٌ. إنْ كنت أنا بلا وطن، فإنٌ النصٌ لا يتحمل أن يكون بلا أرض ثابتة. من هنا يتأكٌد المكان باعتباره ضرورة فنية.
نعود مرة أخرى إلي الشعر أو فن انتهاك المحرمات كما تسميه... كيف تأتي القصيدة ؟
الكلمات الثلاث التي تشكٌِل السؤال، تعتبَر أصولا بحد ذاتها : الكيفية السيرورة طبيعة النص (القصيدة معَرَّفة). أنت في حالة من الاستغراق بشؤون أخري، غير متٌصلة بالشعر، ربما كنتَ مَعْنيٌا بمتابعة خبر، أو عنكبوت منهمك بنسج شبكته على طرف سياج، ربما كنتَ ضجِرا، أو تتهيٌأ لوجبة طعام. وفجأة يتبدل كل شيء: حالة الاستغراق في شؤون اليوم تختفي، وتنقطع متابعتكَ هذا الأمرَ أو ذاك. طرف خيط يصل إلى أناملك، حريرا لامعا ذا ألوان بهيٌة. كلمة واحدة، عادة، أو كلمتان، ثلاث كحدٌ أقصى. أهي البداية؟ أعني بداية النصٌ؟ طرف الخيط، سوف يعود بك إلى المنبع الأول، إلى لحظة الارتطام البعيدة، الغائرة في الزمن وفي اللاوعي، اللحظة التي تكاد لا تَبِين، لفرط خفائها. هذه اللحظة التي نبتتْ فجأة، مع ما حملته من قِيَم قابلة للتفاعل، ستكون الأساسَ لِما سيتلو الارتطام، يقصَد به، الشرارة المتأتية من علاقة مباغِتة للحاسٌة (البصر السمع الشمٌ اللمس) بنقطة تماسٌ ملموسة : أنت تتمشٌى في درب بالغابة، أو على ضفة نهر. تلتقط عيناكَ جذعَ شجرة. تتملٌى تضاريسَ اللحاءِ ' ثم تمضي لشأنكَ. تكمل مَمشاكَ، وتعود إلى منزلك، أو تدخل مقهى (كل شيء عاديٌ)، لكنك لستَ أنتَ' أنت مسكون بأمر لا يبدو أنك مسكون به. في الليل، وأنت تحاول النومَ، سيأتيك جذع الشجرة ! وبين اليقظة والمنام، تتحاوران، أنت وجذع الشجرة، ثمٌ تغِطّ في نومك، الأحلام تأتي أيضا. هل سيتحدث. أتفيق، الشجرة؟ وفي الصباح تفيق، كأنٌ شيئا لم يكن. تعود حياتك اليومية إلى سيرتها الأولى، كل شيء عاديٌ. لكنٌ الجذع ينتأ فجأة، كأنه يطالبك بالحوار الذي أهملتَه ! ولأيامي، أو ساعاتي، أو أسابيعَ، أو شهور أحيانا، ستظل في هذا الحوار الخفي، المنسيٌ تقريبا، الحاضر دوما، الغائب دوما، وفي ساعة مبارَكة، لحظة من النّعمى والتوتر ' سوف تتمتم البيت الأول من القصيدة. إنها التمتمة الشهيرة : الشعر الخالص إذ يتكوٌن. الشعر الذي تحاول اللغة أن تستوعبه، فلا تكاد تفْلِح إلاٌ نادرا. هل أغدقتْ عليكَ الآلهة بَرَكتها ؟ هل أنتَ بالغ تخومَ القصيدةِ ؟ بعد البيت الأول، تتسنٌي لكَ، تدريجا، استعادة ما كنتَ فيه من ارتطام، لكنك الآنَ تتوافَر على تفاصيل ودقائق أمور لم تكن واضحة. إنك تستعيد، وتصنع، سلسلةَ علائقَ، ولسوف تمضي بالسلسلة إلى نهايتها: إلى استكمال النصٌِ.
أخيرا: ما هي أحلام سعدي يوسف المؤجلة؟ وهل ثمة مشروع أدبي شعري روائي ¬مذكرات شخصية.... لم تكتبه حتى الآن وتتمنى كتابته؟ وما الذي يمنعك عن كتابته؟
قد كنت شرعت في الخطوات الأولى لعمل قد يكون أكثر أعمالي طموحا. أوديسٌة شخصية؟ ربما. ولقد أعددت الخطة العامة للعمل : تقع الأوديسة في 500 صفحة تضمٌ الأوديسة وقفات: كل كتاب يبلغ خمسين صفحة، الصفحات الخمسون تقسَم إلى خمسةأقسام في كل قسم عشر صفحات في الصفحة الواحدة ثلاثون بيتا عدد أبيات القسم الواحد 300 بيت في كل كتاب، ومثالا لمسعاي الذي هو في دور التخطيط، أقدم تصوري للكتاب الأول في خمس وقفات: النهر والقرية، البحر، العاصفة، شاطئ الهند، المعركة والأَسْر. أما أسباب التوقف عن استكمال هذا العمل: منذ حوالي العامين بدأت طبول الحرب تدقّ، إيذانا باحتلال العراق، ثم جاء الاحتلال، مع كوابيسه وآلامه. كنت أعيش أكثر فترات حياتي توتّرا. كتبت كثيرا، بل كثيرا جدا، أتابع الأحداثَ، حتى شرعت أعصابي تنهار.
الآنَ، سأفتح خطٌتي، وسأشرع أكتب. لقد اعتذرت عن عدم تلبية دعوات كثيرة إلى الذهاب هنا وهناك، لأنني أريد البدء بالعمل. سوف أكتب أسطورتي الشخصية .
****
 منذ قرأت شعر سعدي يوسف، صار هو الأقرب إلي ذائقتي الشعرية. في قصيدته الشفَّافة صفاء اللوحة المائية، وفي صوتها الخافت إيقاع الحياة اليومية.
منذ قرأت شعر سعدي يوسف، صار هو الأقرب إلي ذائقتي الشعرية. في قصيدته الشفَّافة صفاء اللوحة المائية، وفي صوتها الخافت إيقاع الحياة اليومية.
وقد أجازف بالظن أنه، ودون أن يكتب (قصيدة النثر) السائدة اليوم، أَحد الذين أصبحوا من ملهميها الكبار، فهي تتحرٌك في المناخ التعبيري الذي أَشاعه شعر سعدي في الذائقة الجمالية، منذ أَتقن فَنَّ المزج بين الغنائية والسردية.
وهو أَحد شعرائنا الكبار الذين قادهم الشعر أَو قادوه إلي التمرٌد على تعالي اللغة الشعرية، وإلى تأسيس بلاغة جديدة، ظاهرها الزهْد، وباطنها البحث عن الجوهر... ليصبح الشعر في قصيدته هو الحياة بسليقتها وتلقائيتها، والحياة هي الشعر، حين تكتبه ذات ليست ذاتية تماما. فقد تماهت الذات مع الموضوع، وتآلف الموضوع مع الخصوصية الذاتية... دون أن يتخلَّي الشاعر عن قدر من (حياد) موضوعي، يخفٌِف عن القصيدة طابعها الأوتوغرافي، ويوَفٌِر لها استقلالا عن سيرة صاحبها.
الشاعر أم القصيدة؟
ليس هذا سؤال سعدي يوسف، فقد بلغ من النضج خبرة قادرة علي أن تجعل حياة الشاعر وحياة النَصٌِ واحدة ومنفصلة في آن واحد، فهو يعبٌر عن نفسه، ولا يعبّر عنها وحدها، في اللقاء الحميم بين داخله الذاتي وخارجه الموضوعي في عملية مركٌبة يتبادلان فيها الأدوار.
سعدي يوسف، الذي يحاور نَصّه الشعري تاريخ الشعر، لا يشبه شاعرا عربيا آخر، لكن الكثيرين من الشعراء أرادوا أن يشبهوا سعدي، وعانوا مما أَسماه هارولد بلوم (قلق التأثير(.
لقد بهرتني بساطة سعدي المعقٌدة، في نزوعها إلى البحث عن شعرية الأشياء الصغيرة الكامنة في نثر الحياة، والبحث عن العلاقات السرية بين اليومي والتاريخي. وبهرني أكثر من ذلك إلحاحه علي محاولة الإمساك بالحاضر الهارب.
وإذا كان صحيحا أَن في داخل كل شاعر مجموعة من الشعراء كما يقول أوكتافيو باز، وأن النص هو محاورة مع نصوص أخرى، فإن سعدي يوسف كان أحد الشعراء الذين درَّبني شعرهم على التنقيب عن الشعري في ما لا يبدو أنه شعري، وأَغراني بمقاومة الإغراء الإيقاعي الصاخب، وبالاقتصاد في البلاغة.
وكم سئلت عن فترات َبيَاتي شعري مررت بها، وكنت أَقول دائما: ما دام سعدي يوسف يكتب، فإنني أَشعر بأنه يكتب نيابة عنٌِي!
صديقي منذ ثلاثة عقود. لم نتوقف عن صيانة المودٌة المتبادلة، النادرة بين الشعراء، منذ التقينا للمرٌة الأولى في بغداد. كان في آخر الليل متهوٌرا يقود سيارة هرمة، كادت تسقط بنا في دجلة. كم خفت من موت عبثي ينتظرنا في قاع النهر. لكننا اليوم، نحتفل بعيد ميلاده السبعين. هو في لندن، وأنا في رام الله.
أتذكره في منافيه العديدة، في بيروت، وفي عدن، وفي نيقوسيا، وفي باريس، وفي عمٌان... يعتني بأصص الصبَّار.
لقد أدمن سعدي يوسف المنفى، فصار جزءا عضويا من حياته ومن لغته، لا باعتباره مكانا جغرافيا نقيضا للوطن فحسب، بل باعتباره مجالا حيويا لتعرٌف الذات إلى نفسها في الآخر، وللتأمل في الأشياء الأولى من بعيد، وباعتباره قيمة أدبية تعبٌِر عن غربة وجودية.
كنا دائما نؤمن بأن الغد أَجمل. لكن التاريخ يفاجئنا دائما بخيبة أَمل جديدة، تغري الشاعر بمديح أمس. بيد أَنَّ الشعر لا يمتثل إلى هذه المحنة، لأنه أَدمن النظر إلى أَبعد... وإلى أعلى.
*****
 هذا الشاعر الرقيق، برشاقته التي لا تحتمل. سوف تأسرني دائما قدرته على الانتقال بين الكلمات والجمل والتجارب، كمن يريد أن يشرد من وضوح الصورة فيما هو يغزل الغموض العميق في الأوزان. هذه هي واحدة من بين أجمل مواهب سعدي يوسف. هذا التفلت الفذ من أسر الوزن ليذهب حراً في الموسيقى. منذ سنوات طويلة سوف لن يكتب سعدي قصيدته في حدود الوزن والإيقاع (المألوفين تقنيا) لكنه يصوغ نصه في فضاء أكثر رحابة وجمالا هو الهارموني الشامل للموسيقي بالمعنى الشعري الأعمق لإيقاع الكتابة الأدبية. وهذا ما سيوقع قارئيه في الارتباك وهو يقودهم عبر التخوم الغامضة (الممحوة برشاقة) بين الشعر والسرد الشعري و النثر، حتي يكاد بعضهم يزعم (دون أن يكون مبالغا) بأن سعدي بات يكتب خارج الوزن (لئلا أقول قصيدة نثر(.
هذا الشاعر الرقيق، برشاقته التي لا تحتمل. سوف تأسرني دائما قدرته على الانتقال بين الكلمات والجمل والتجارب، كمن يريد أن يشرد من وضوح الصورة فيما هو يغزل الغموض العميق في الأوزان. هذه هي واحدة من بين أجمل مواهب سعدي يوسف. هذا التفلت الفذ من أسر الوزن ليذهب حراً في الموسيقى. منذ سنوات طويلة سوف لن يكتب سعدي قصيدته في حدود الوزن والإيقاع (المألوفين تقنيا) لكنه يصوغ نصه في فضاء أكثر رحابة وجمالا هو الهارموني الشامل للموسيقي بالمعنى الشعري الأعمق لإيقاع الكتابة الأدبية. وهذا ما سيوقع قارئيه في الارتباك وهو يقودهم عبر التخوم الغامضة (الممحوة برشاقة) بين الشعر والسرد الشعري و النثر، حتي يكاد بعضهم يزعم (دون أن يكون مبالغا) بأن سعدي بات يكتب خارج الوزن (لئلا أقول قصيدة نثر(.
هذه هي موهبة الشاعر، لا أقل، لا أكثر.
الشعراء فقط. بعض الشعراء خصوصا. المأخوذون بجماليات الإيقاع في اللغة العربية، يستطيعون اكتشاف هذا السهل الممتنع في بنية أهم نصوص سعدي الشعرية، التي خرج بها من سرب شعري كثيف التجارب، ليصوغ له نكهة لغوية لن تصلح (كثيرا) لشاعر آخر سواه.
ليس من العدل، عند الكلام عن تجربة سعدي يوسف، الوقوف (حد التعثر) عند مكابداته السياسية والأيديولوجية، التي لم ينج منها شاعر عربي معاصر بدرجات مختلفة من العذاب. ففي هذا الوقوف خسارة لنعمة اكتشاف الجماليات الشعرية التي سهر عليها سعدي يوسف في صنيع القصيدة العربية الحديثة. أكثر من هذا، سوف أشعر بأن ثمة صعوبات بات يواجهها النقد السائد، فيما يرى الى تجربة سعدي الكثيفة، لفرط التنوع المذهل والاجتهادات المتماهية بالفوضى (الفنية) في شعر هذا الشاعر.
غير أنني سأجد في الكثير من نصوصه الجميلة خروجيات ممتعة لا يحققها، بهذه الجرأة، غير شاعر يحسن اجتراح أشكاله لكي يستمتع بما يفعل. سعدي يكتب شعره للمتعة الذاتية بالدرجة الأولى، وهذا شرط صرت مؤمنا به كثيرا في وقت مبكر، فالشاعر الذي لا يستمتع في لحظة الكتابة، ليس من المتوقع أن يمنح قارئ قصيدته المتعة والجمال.
من هنا سيبدو سعدي يوسف للنظرة العجولة أنه شاعر يدخل في حدود الفوضى. وسوف يفوت على صاحب هذه النظرة أن شاعرا مثل سعدي، أختبر التجارب واختبرته تحولات الحياة والإبداع، لن يصدر، في كتابته، إلا عن ذلك الوعي العميق بالمسؤولية. وهو وعي يتوجب علينا أن نحترمه ونتفهم تركيبه النوعي في سياق الكتابة الشعرية في العالم.
علينا أن نقرا سعدي، بعد كل هذا العمر، بوصفه طاقة متفجرة (لا تزال) من التوق الحار للحرية. هذا التوق الذي لا يستطيع (أعني لا يريد) نصه أن يتفاداه، حيث سينتقل في نصوصه المتلاحقة، برشاقته الفذة مكتشفا ما يسعف هذا التوق ليظل حرا، متبرما، خارجا، ليس خارج السرب الشعري فحسب، ولكن خارج الأسراب كلها.
كلما التقيت بسعدي يوسف، شعرت أنني في حضرة كائن شعري بامتياز، واشعر أنني، معه، قد استعدت ثقتي في نفسي قليلا، لفرط الشعور الذي يمنحني إياه هذا الصديق الجسور، بأن ثمة حياة تستحق أن تعاش بشروط الشاعر، بزهده، باستعداده للتخلي عن كل شي في الحياة من أجل الشعر.
وظني أن الشاعر، (وسعدي يوسف نموذجا ودليلا) لا يحتاج لأكثر من كسرة الخبز وشمس صغيرة وهامش علي مقربة من المجرة.
سأحب هذا الصديق دائما.
*****
'كلما خطوت خطوة في طريق الشعر الطويل.
أحسست بأني أقترب أكثر من الحرية'
سعدي يوسف
مثل قراء أبواب الحظ في الصحف اليومية، أحيانا أتعامل مع الكتابة والكتاب، خاصة الذين ينتمون الى منطقة الشرق الأوسط الموسع، فاقسمهم إلى ما يشبه الخريطة 'الإبداعية/ الثقافية' مثلما يوزع مؤلفو الأبراج البشر إلى فئات تحددها تواريخ ميلادهم، فهناك قسم للكتاب الجنوبيين وآخر لسكان أهل الشمال، وهناك قسم لسكان الصحارى والبراري وغيره لسكان السهول الزراعية، كذا أهل المدن الصغيرة وأهل المدن الكبيرة الصناعية أو التجارية، وقد وضعت طبعا لهذا التصنيف. الشاعر سعدي يوسف ضمن زمرة الشعراء الجنوبيين، وقد صدق هذا المرة حدسي وهو غالبا مايخيب رغم كون أدواتي في تصنيف الكتاب، ربما تخالف الأعراف والنظريات العلمية لدي علماء الانثروبولوجيا وعلم اجتماع الأدب.
لاحظت أن الشعراء الجنوبيين تهيمن على رؤاهم أحاسيس الاقتلاع والاغتراب والرفض، وهو ما نراه عند السياب وأمل دنقل، فالجنوب في هذه المنطقة من الشرق الأوسط طارد بطبيعته، فقد ولد سعدي يوسف في نفس المنطقة التي ولد فيها السياب جنوب البصرة عام 1934 في 'أبي الخصيب'، بل انه، كما السياب، ترعرع يتيما في كنف أخيه الكبير، ثم رحل مثله مثل شعراء العراق في هذا الجيل الى بغداد ليلتحق بكلية المعلمين وهي المعهد الذي خرج منه جميع شعراء قصيدة التفعيلة الرواد في العراق مثل نازك الملائكة والسياب وغيرهم، ومرحلة الاغتراب والنفي هي المعلم الرئيسي في مسيرة 'سعدي يوسف' الشعرية، فلم يقتصر فعل الاقتلاع على هجرته الى الشمال المحلي، بل انه وحتى وقتنا هذا مازال منفيا خارج وطنه، ينتقل من منفى إلى منفى، ولكنه رغم هذا لايبكي مدارج الصبا، كما بكاها السياب طوال مسيرته الشعرية، لقد أصبح إنسانا وشاعرا أمميا وليس كوزمو بوليتانيا، فهو لايزخرف روحه بالثقافات المتعددة التي عاشها ويعيشها، فقد أصبحت جزءا من كيانه وطاقته الإبداعية، بحيث يصعب ردها إلى عناصرها الأولى.
****
قيمة سعدي يوسف تكمن فيما أحدثه من تغيرات في الشعر المكتوب بالعربية، هناك شعراء كبار استطاعوا التنظير لاتجاهات شعرية جديدة مثل شعراء مجلة شعر' اللبنانية لكنهم لم يستطيعوا تأكيد وترسيخ نظرياتهم إبداعيا وهناك شعراء قدموا الشعر والشعر فقط بينما يفتقرون الى ملكة التنظير والترويج، 'سعدي يوسف' في الفصيل الثاني، َمَثلْ شعره الموجة الأولى في التجديد الثالث لشعر العربية، كان التجديد الأول في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وهو ما أطلق عليه 'شكري عياد' النموذج الرومنسي، الذي تثبت أقدامه بجماعتي 'الديوان' و'ابوللو' وكان التجديد الثاني بعد الحرب العالمية الثانية وهو ماعرف 'بجيل التفعيلة' أو جيل 'رواد الشعر الحديث' وكان منهم شاعرنا سعدي يوسف، أما التجديد الثالث فكان مواكبا لحركة 1968 الشبابية العالمية، وهو ما عرف بجيل السبعينيات.
هناك مفاصل تربط بين جيلين في الإبداع، وفي إبداعهم نجد عناصر التجديد مجاورة لعناصر التقليد، في مركب تمثل أدوات التفاعل والربط فيه الموهبة الاستثنائية للمبدع، هكذا كان شوقي ومطران في حركة التجديد الأولى، وكان محمود حسن اسماعيل في الحركة الثاني وفي حركة التجديد الثالثة كان أدونيس و'سعدي يوسف' الرابطة بين جيل السبعينيات وماقبله، ومابقي من جيل السبعينيات، هو نتاج رؤيتين للشعر واحدة ميتافيزيقية ومثلها أدونيس، والآخر واقعية جديدة، ومثلها 'سعدي يوسف' وهي واقعية بلا ضفاف كما وصفها روجيه جارودي، سحرية في ثقافة، ويومية جارحة في اخرى، فهي واقعية تنتمي إلى الثقافة التي أنتجتها وليست تلك الواقعية المعيارية العابرة للحضارات.
في بداية حركة التجديد الثالثة، كان لأدونيس تنظيرا وإبداعا الغلبة على الرؤية الأخرى، التي مثلها 'سعدي يوسف' ولكننا الآن عندما نلقي نظرة على شعر العربية الراهن سنجد أن الاتجاه الذي حفر له سعدي يوسف مجراه، قد امتلأ بالمياه، وأصبح نهرا هادرا، يتجه إلى مصبه في محيط الشعر العميق والمترامي الأطراف، فقد ولدت حركة تجديدية رابعة، تعود سماتها إلى رائدها الأول 'سعدي يوسف' الذي جمع بين عناصر التجديد التي مثلت العنصر المهيمن على شعره وبين عناصر التقليد التي نشأ 'سعدي يوسف' في أحضانها، ولكنها لم تستطع ابتلاعه، كما فعلت مع رفاقه من جيل الرواد.
لقد جمعت نصوص 'سعدي يوسف' بين مستويات عدة من التقنيات الشعرية، فقد اعتمدت هذه النصوص الحد الأدنى من البلاغة العربية التقليدية، فهي تكاد تخلو من الاستعارات والكنايات حيث تعتمد المفارقة كبديل للاستعارة والتشبيه فيها من الدرجة الأولى تسبقه أداة التشبيه، التي تؤدي وظيفة إضافية، غير وظيفتها في خلق الصورة، فهي أداة لقتل العاطفية والتقريب بين القارئ والصورة، وإزاحة الغموض والإبهام في النص، فالنص عند 'سعدي يوسف' يعتمد الشائع والمألوف واليومي كأدوات خلق لشعريته.
****
شعراء حركة التجديد الرابعة يعتمدون التفاصيل اليومية واللغة العربية المعاصرة، وخلق المشهد الشبيه بالمشهد السينمائي والمسرحي في نصوصهم، وكل هذه العناصر يعتمد نص 'سعدي يوسف' كعناصر أساسية تمثل بؤرة، النص، أي إنها ليست عناصر مساعدة أو هامشية، وفي دراسة فخري صالح في مجلة فصول، المجلد الخامس عشر العدد الثالث، خريف 1996 وعنوانها 'سعدي يوسف' شعرية قصيدة التفاصيل يقول الناقد.: 'الاتكاء على السرد وعناصره البنيوية، واستخدام المفارقة التي تعد عنصرا أساسيا في بناء الأنواع السردية، من رواية ومسرح وقصة قصيرة وسينما، يجعل شعر 'سعدي يوسف' شديد القرب من تجربة قصيدة النثر خلال العشرين عاما الأخيرة'.
قراءة 'سعدي يوسف' رغم بساطة نصوصه الظاهرة تحتاج الى وعي واشتباك مع العالم، لهذا فهو كما قيل عنه 'شاعر الشعراء' فلن يغفر له غير شاعر تغريده في منافيه بعيدا عن السرب البالغ من العمر أكثر من ستة عشر قرنا من الزمان.
بالنسبة لي يمثل 'سعدي يوسف' أحد روافدي الثقافية والشعرية بجوار بيرم التونسي وصلاح جاهين، وقد كتبت قصيدة من جزءين أوائل التثمانينات عندما كنت غارقا في تقصي نصوص التصوف الكبرى في الحضارة الإسلامية، وقد نشرت القصيدة ناقصة في مجلة 'الكرمل' الفلسطينية عام 1984 في العدد الخاص بالأدب المصري، كما قدمتها لمراقبي النصوص في مهرجان المربد العراقي عام 1985 ولم القها بالطبع وهذه القصيدة ذات الجزءين كانت بعنوان 'سعدي يوسف (1)' و'سعدي يوسف (2)' وقد ضمها ديواني الطاولة 48 الذي صدرت له طبعة خاصة عام 1989، وطبعة ثانية عن الهيئة العامة للكتاب عام 1993.
****
رسالة
أيها الشاعر سعدي، لا أحب أن أكتب الكلمات الاحتفالية البشوش المختصرة المتعالية. سوف أكتب إليك دون ترتيب، دون نظام، دون ضوابط، كأنني مجذوب، كأنني أعمى، وآمل ألا تأخذك مني سنة من النوم، آمل أن تراقبني، ترى أطرافي وهي تتحسس قلوب أبطالك وحيواناتك ونباتاتك وجمادك سوف أستهل وأهمس في أذنيك وأقول:
الكتابة عما لا نحبه سهلة، ليس عسيرا أن ندس أصابعنا في ثقوب الآخرين، خاصة معاصرينا ومجايلينا، أن ندس عيوننا في عيوبهم، أستفهم دائما لماذا لا نجرب الكتابة عمن نحب، صحيح أن ميكروبات الفساد تميل الى الارتياب فينا إذا أعلنا محبتنا وجاهرنا بها، ميكروبات الفساد تظن أننا طلاب حاجات، طلاب مصالح، طلاب رجاوات، لابد أن نقنعها أننا محبون فقط، أعترف أنني عانيت كثيرا من جراء تلك الشهوة، شهوة التصريح، عانيت بسبب أسماء قد لا تمل وتتململ من حرصي على طولها فيروز ونضال الأشقر وأدونيس وأنسي الحاج ويوسف الخال وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقه وعصام محفوظ ورينه حبشي وسعيد عقل وميشال طراد ومارون عبود وسعيد تقي الدين وفؤاد سليمان وفؤاد كنعان وحنان الشيخ وهدي ونجوى بركات ورشيد الضعيف وسليم بركات وحسن داوود وسنية صالح وليلي بعلبكي وغادة السمان وخالدة.. الخ الخ، عانيت أخيرا بسبب يوم الدين ورشا الأمير، الأسماء كثيرة لأنني أحب الاحتفال بالأسماء، ولأنك الشاعر الذي يمتلئ شعره بها، سواء النكرات والإعلام، أقول عانيت من أجل بيروت ودمشق، وها أنذا ألبس قميصي وجوربي وحذائي وانتقل الى مكان تعرفه الجرافات وتدهس أرضه فيما يبحث البخار والأنفاس والطيور عن سمائه، انتقل الى البصرة، وأبحث عن منزلك الذي سكنه الأشرار فيما بعد، كأنني أبحث عن منزل أليف، كأنني أبحث عن كلمة غالية ضاعت مني، هل تعرف العلة التي تجعل الكلمة أشبه بخليط ظلام ونور يمكن أن يتغلغل فينا، كلمة مستهلكة ومباشرة، ولكنها إذا ظهرت لم تستطع أن تمنع ظهور حكاية أو قصيدة أو شخص ما في إثرها، كلمة كانت مبتذلة الى أن صاغها أحدهم فأصبحت كلمة ذات عشيرة ذات ذرية، إذا اعترضنني على سبيل المثال كلمة الكلينكس مهما كان موقعها، رأيت زهرة بطلة رواية حنان الشيخ تستخدمه بعد مضاجعة القناص لها، هل ترغب أن أحكي لك حكاية كان صديقي الشاعر محمد سليمان الذي ولد في بلدة مليج من أعمال محافظة المنوفية، يرويها لي، يقول أن بلدته سبق وأخرجت شاعرا، أذكر أن لهذا الشاعر بيتين قالهما متوجها بالحديث فيهما الى صديقه الشاعر محمود الخفيف، وكان قد دعاه مع آخرين على عشاء في بيته:
إيه يا محمود جعنا
واسقنا شايا ثقيلا
هات لحما ورغيفا
لعن الله الخفيفا
كان شاعرا تقليديا جهير الصوت عاليه، وكان أيضا صاحب نوادر وطرائف، وله كما يروي سليمان أخ أكبر يدعي الشيخ محمد، كان الشيخ يختار الليالي السوداء بلا قمر، ويلبس جلبابه هكذا علn اللحم دون ملابس داخلية، ولما سئل: لماذا يا شيخ، قال: لأصبح عاريا في أسرع وقت، ثم أضاف: ولكي لا يتمكن أحد من الإمساك بي إذا ضبطني وجرى خلفي، في آخر الليل ينزل الشيخ الى الحقول، عله يصادف امرأة تأخر رجوعها فينقض عليها آملا أن تلين أو تخجل من الصراخ، ذات ليلة فعلها، وفي الصباح فاجأه الرجال المرحون وقالوا له: هل تعرف مع من يا شيخ فعلتها بالأمس؟ لم يستح وقال: من، قالوا: أختك، أجابهم: فليكن، ومنذها تغير اسمه ليصبح الشيخ محمد فليكن، أعترف لك أنني وقعت في أسر الحكاية كما وقعت في أسر كلينكس زهرة، كانت إذا ظهرت كلمة فليكن برزت عمامة الشيخ محمد وجلبابه على اللحم، حتى أن الكلمة صارت تطاردني كمزحة، عندما قرأت قصيدتك الوطن الصغير في مجموعة (51 قصيدة) والتي ترتفع هكذا: وليكن، إن أغانيها عنيفة، كلها تسعي وراء الجوع سوداء مخيفة، يا محمد، إنها الأرض التي نحيا عليها، ونموت، أذكر أنني وصديقي الشاعر الوحشي المظلوم محمد عيد ابراهيم كنا نردد هذا المطلع، منذ ذلك الوقت أصبحت كلمة فليكن كلمة جديدة، لقد ضمرت حكاية الشيخ محمد، وبرزت حكاية الوطن الصغير، وبعد أن كانت الكلمة فليكن تطاردني كمزحة تعقبها قهقهة عالية أصبحت تظللني كصوت تعقبه سحابة عالية أيضا، أيها الشاعر سعدي، صمتك أطمعني فيك، وغرامي بالحكايات أطمعني في الحكايات، وجذوة محمد سليمان في قلبي مازالت مشتعلة، يحكي سليمان وحكايته هذه المرة قد تكون خشنة بعض الشيء، جارحة بعض الشيء، يحكي أن واحدا من أصدقائنا الشعراء زاره في بيته أوائل السبعينات، واستعار منه أحد دواوينك، الشاعر الزائر كان قد بدأ النشر في الستينيات بقصائد لافتة تتميز بنفس صوفي أقرب الى التصوف الشعبي، هو شيخ طريقة ورثها عن أبيه، ويميل الى استلهام التراث ومحاكاته وإلى اللعب الساذج باللغة كصوت، ويجيد إلقاء شعره في لهجة مؤثرة، المهم أنه استعاد ديوانك، بعد أن قرأه، أو قرأ بعضه، أعاده الى سليمان وقال له: هذه الشاعرة سعدي بضم السين وفتح الدال شاعرة جميلة، وانصرف، انتهت الحكاية، وللحكاية قفص تأويلات ودلائل، الأول أن الشعر المصري والشعراء المصريين المحافظين آنذاك كانوا مكتفين بمعارفهم عما يحدث في مصر، وعلى غير علم بما يحدث خارجها، كانوا يشبهون بشر الأقفاص، ولذلك كثر بينهم من يأتم بصلاح عبدالصبور ويقلده، مما دعم الاتجاه الشعري الذي يمثله صلاح، ومما دعم فكرة أن أغلبهم ينتسبون الى جيل مدشوت حسب عبارة لويس عوض، قليلون منهم ارتضوا إمامة أحمد حجازي وتابعوه وتبعوه، الثاني أنه على الرغم من صوفية الشاعر الزائر إلا أن صوفيته الشعبية التقليدية الساذجة لم تسمح له حتي أن يتذكر اسم سعدي شيرازي ومالت ذاكرته فورا الى نساء الخليل بن أحمد المرحات، معشوقات الشعراء العرب القدامى هند وعفراء وورد وفوز وليلي ولبني وعزة وبثينة وعبلة وسعدي، الثالث أن الشعر في هذه الفترة كان بطوليا جهوريا مناضلا، حنجرته بحجم مائة مليون حنجرة، حتى إذا عشق وأحب، حتى إذا يئس، كان شعرا عاما بحق، وكان الشعر الخاص ينبت في أماكن نادرة متناثرة، ويبحث عن حناجر، كل حنجرة بحجم حنجرة واحدة فقط، ويمثل استثناءات قليلة، حتى الشعر المهموس كان يمثل استثناءات قليلة، والنفوذ الكبير لصلاح عبدالصبور لم يؤد الى سريان نبرته الخافتة في الشعر المصري، لأن أتباعه أهملوا بعض خواصه وخصائصه، أهملوا أهمية الثقافة العالية، وأهملوا أهمية نبرته الخافتة، ثم أخذوا عنه العناصر التي تلائمهم وأفقروها، لذلك فإن همسك اصطدم بالطابع البطولي الجهوري المناضل لدي الشاعر الزائر مرتاد حلقات الذكر، اصطدم بالطابع الذي لقساوته وغلظته يكاد عنده وعند غيره أن يكون طابعا ذكوريا، مما جعله يتبلبل، ويظن أنه هكذا، أنه قرأ شعرا جميلا للسيدة سعدي، هذه البلبلة أعتقد الآن أنها كانت الشاهد الأول لشعرك عندي، الشاهد الذي دلني فيما بعد على سعيك حثيثا في دروب الشعر الخاص، ودلني فيما قبل على أنني سوف أتمادى في النأي عن أغلب الشعر الستيني، وفي النأي عن بعض البارزين فيه، الآن أعرف بوضوح أنك أحد الشعراء الذين يمكن لقصائدهم أن تخدع قراءها، أن تخدع بعض السياسيين فيظنون أنها لهم، وبعض الشعراء الشباب الذين يظنون أن أقاليم الليل والنهار قد غسلت أرضها وسماءها من الايدولوجيا وأن قصائدك ضدهم، إن هواء السياسة ونقرة السمان والجواهري والبياتي وشوقي بغدادي وخان أيوب وفائق حسن والثورة الفلسطينيية ويوميات بيروت وذكريات الحصار، هذه العلاقات وغيرها كان لابد أن تظهر معها قصائدك وكأنها قصائد شاعر عام، الغريب أن قصائدك تنجح فيما فشل فيه أغلب معاصريك، بين هلالين أعترف أن أحمد حجازي نجح الى حد كبير في أن يغمس فرشاته ويبللها بماء الكلاسيكية الجديدة من أجل أن يقلل من الشعور الفادح بحضور الشاعر العام، وأن عبدالوهاب البياتي حاول ونال أجرا واحدا، وأن محمود درويش استطاع أن يقلل من ذلك الشعور الفادح بفضل غنائيته الفريدة والقادرة، وكلاهما الكلاسيكية والغنائية في مجملهما لا تتعارضان مع الشعر العام، قد تتآزران معه، بين هلالين آخرين أعترف أن آخرين كثيرين مشهورين لم يستطيعوا إلا أن يكونوا شعراء عامين بفجاجة، ويكاد يكون تاريخ الشعر العربي في الغالب منه تاريخ شعر عام.
****
أيها الشاعر سعدي، الإطلالة الأولى على شعرك تكشف عن هموم مشتركة ومتداخلة مع هموم الجماعة، الذين اكتفوا بهذا المستوى من الرؤية وقنعوا به أيديولوجيون عازمون على تربية الشعر في حظائر بملايين الجدران، عند المستوى الثاني سنكتشف أن الموضوع مهما كان جلاله مجرد ذريعة لكتابة الشعر، ذريعة لن تختلف سواء كان الموضوع السياسة أو ذات الشاعر أو الحب أو الايروتيكا، إنه مجرد ذريعة تكفل الاقتراب من الشعر لأن الشعر يحتاج الى ذرائع، عند المستوي الثالث سنكتشف أن قصائدك الفائقة نجحت في ضبط المسافة بينك وبين موضوعك، فلا هو قريب القرب الذي يجعله غالبا، ولا هو بعيد البعد الذي يجعله غائبا، انه في المكان الذي لا يسمح بأن يكون أكثر من ذريعة، مكان الضرورة، في هذا المكان يتحول الموضوع الى مادة خام يشتغل عليها الشعر والشاعر دون اعتبار كبير لنوع هذه المادة، عند المستوي الرابع يغتسل الشعر تماما ونهائيا من طابعه الميداني، ليصبح الشأن العام أحد الشئون الحميمة، ليصبح شأنا خاصا، ويصبح شاعر هذا الحقل من الشعر شاعرا مقتدرا من شعراء الحجرة، يتغني بأمور يظن البعض أنها لا تصلح إلا لشاعر ميداني، عند المستوى الخامس يتحرر شكل القصيدة ولا يخضع لإرادة الشاعر، يتحرر ويتبع إرادة القصيدة ذاتها وتكون القصيدة حداثية لا لرغبة الشاعر في أن يكون حداثيا بل لرغبة القصيدة، ومن يشاء له حظه وذوقه وثقافته أن يحب قصيدة كهذه، سيحبها لأنها ترده الى ذاته، تجعله يحتفل بما هو شخصي، صحيح أننا كجماعة أصبحنا لا نعرف الأشياء، يستحيل علينا معرفة الأشياء مادمنا لا نقدر على إنتاجها، إننا نعيش منذ انحطاطنا في كهف أصغر من كهف أفلاطون، ونرى صور الأشياء وظلالها ونتعامل مع الصور والظلال على أنها الأشياء ذاتها، واللغة كشيء مادي ملموس لها ظلال بينها ظل رئيس هو المعنى، يعادله ظل رئيس آخر هو الصوت وكثير من الشعراء يتعامل مع المعني وكأنه اللغة، كذلك كثير من النقاد، أكاد أجزم أنهم الشعراء والنقاد هؤلاء لا يعرفون قراءة القصيدة قراءة تتعامل مع اللغة كأصل، كشيء، ومعي المعنى كظل، كصورة، أنهم يكتفون بالتعرف على المعاني والأفكار، أنٌِبه خشية سوء الظن الى أنني لا أعني نفي المعني وإلغاءه والاستعلاء عليه، ولكنني أعني مراعاة موقعه كظل، قليلون هم الشعراء الذين يتعاملون مع الصوت وكأنه اللغة، كذلك يفعل قليل من النقاد، لأن هندسة الصوت أعطى من هندسة المعنى، ولأن المعنى أكثر قدرة على إثارة السجال حوله، ولأن الظل المعنى لا يحتاج الى الدربة التي يحتاجها الظل الصوت، عند المستوي السادس تتضافر العوامل جميعا، اللغة كأصل، وخفوت الصوت، والشعر الخاص، لتدخل بنا منطقة جديدة يشيع فيها السحر وتتوالى طبقاته.
****
أيها الشاعر سعدي التقيت بشعرك في طبقات سحره، وفطنت الى أنه يختلف عن أغلب الشعر الستيني، وضد بعض البارزين فيه، هل يمكن أن تتذكرهم، الأصح هل يجب أن تنساهم، الطبيعي ألا تتذكر أحدا منهم، وألا تتذكر أول مرة التقينا، الطبيعي أن أتذكرها أنا، كنا في أمستردام، هولندا، أوائل التسعينيات، بدعوة من مكتبة الهجرة، لفتني انك تخشي الصور الفوتوغرافية آنذاك، قلت لنفسي: إنه الشاعر المنفي المطارد المرصود من سلطة تبطش بخصومها، لابد أن يخشى التصوير لفتني أنك سألتني عن سيد البحراوي وإبراهيم داوود، لفتني أنك صاحب صوت خفيض، تميل الى الصمت، انك على مائدة الخطابات الثقافية لا تأكل كثيرا، لقيمات فقط، وأنك رقيق، تجامل، وبعدها تستغفر وتتوب عن مجاملتك رأيتك في أكثر من موقف تقول لأحدهم: قصيدتك جميلة، ثم بعد أن ينصرف تتساءل في هدوء وحميمية كأنك تفشي سرا: والله يا أخي لا أعرف ما علاقة فلان بالشعر، أحسست في كل مرة رأيتك فيها، أن النفاذ الى داخلك صعب، أن ضفدع الجواهري مبتل ومختل، وأن سلحفاتك ذات صدفة صلبة، كدت أقول قنفذك لكنني تراجعت، تصورت أن طائرا حساسا يختبئ خلف تلك الصدفة، وأنني أعرف شعرك أكثر مما أعرفك، هل أعترف أكثر، هل تسمح لي أن أقول أنني أحببت شعرك أكثر مما أحببتك، هل تعتقد أن السبب يرجع الى أنه لم تنشأ بيننا علاقة حميمة تتيح ما لم يتح، هل يا ترى لاسمك الثاني علاقة بالأمر، في حياتي كلها لا أعرف لماذا لم يكن لذلك الاسم يوسف حضور وألفة، بداية كنت لا أحب النبي يوسف، ذلك الجميل الذي يتسبب في أن تجرح النساء راحاتهن دون أن يشعرن، كنت أحس بالغثيان والقرف، لم تستطع قصته مع زليخة والفرعون أن تفتنني، كرهت الحجاج بن يوسف، ويوسف بن تاشفين، والقاضي أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة وعامل أبي جعفر المنصور على القضاء، وصلاح الدين يوسف صاحب السمعة التي تفوق حقيقته والذي اعتذر العقاد عن إدخاله في سلسلة عبقرياته، وحرص أنور السادات علي إظهاره كقرين له، شعرت أنني وقعت لزمن طويل في خدعة يوسف شاهين، وها أنذا أندم علي هذا الوقت الضائع لم أحب يوسف جوهر ويوسف وهبي ويوسف السباعي وإبراهيم يوسف وبحر يوسف والشيخ علي يوسف، ولم أحب يوسف النجار، وجوزيف ستالين هناك يواسف منذ البداية لم أعرهم انتباها لأنهم الأدنى، لولا يوسف إدريس ويوسف الشاروني ويوسف الخال وقرصان طفولتي يوسف كامل شرارة والجميلة ليليان جوزيف، واليوسفندي (أعني اليوسفي) وسعدي يوسف، لاعتقدت أن هذا الاسم أحد خصومي، وسوف أظل أحب الأخضر بن يوسف ومشاغله، وكيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته الأخيرة، إنه على أي حال شخص غير متزن، وإن بدا شديد الهدوء، ولأنه غير متزن ولأنه مشتت الذهن ولأنه لم ينم منذ ستة أيام لم يستطع أن يكتب قصيدة، في أواخر الثمانينيات دعي كل الشعراء و الكتاب، وكل سنة الى العراق لحضور مهرجان المربد الشعري ولقد ذهب الجميع، حتى أصبح من المضحك أن تعتذر وترفض، ومع ذلك فقد قبلنا أن نصبح مضحكين محمد سليمان وأحمد طه وأنا لمدة سنتين متتاليتين، في السنة الثالثة انفرد طه بالموافقة على الذهاب، يريد أن يزور العتبات المقدسة ومقابر الطالبين وكربلاء والنجف، وسوف يقرأ قصيدة يهديها إليك، كان يعلم عمق معاداة النظام لك، ولكنه على منصة المربد أعلن رغبته، الى سعدي يوسف، ستظل لأحمد طه مكانته الانسانية الخاصة في داخلي، صحيح أنه يحشوها طوال الوقت بالالتباسات، وسوف أظل على حبه بغض النظر عن تقلباته وأقواله وأحواله ومواقفه وشئونه الصغيرة وكائناته غير المرغوب فيها، وأحمد طه يا سيدي سعدي شاعر وابن مدينة ومثقف مصري بمعنى ناجز، لذلك ولغيره أظن أنه قد خانك الإنصاف أو غلبك ما يغلب الكتاب والشعراء العرب عندما يكتبون عن مصر، ذلك عندما كتبت تقول: إن شريحة سائدة من المثقفين المصريين في الوقت الحاضر قد اتخذت الفهلوة الثقافية صنعة وحرفة، أن المشهد الشعري المصري ليس بالفتنة المرجوة، انتهت عبارتك التي يمكن تعديلها آلاف المرات ووضع السوريين أو اللبنانيين أو المغاربة أو الصقالية أو المماليك أو العراقيين بدلا من المصريين، ولكن العبارة بشكلها جعلت من المثقفين المصريين حالة سيئة خاصة، عموما لم يحدث أن اهتممت بنثرك كثيرا، إلا بدواعي الفضول، وليس بدواعي المتعة، أراك دائما الشاعر الذي يعتني كثيرا بكونه شاعرا، والذي يتعامل مع النثر كما يتعامل الحوذي مع حماره، إنه فقط أداة للتوصيل، أداة للسجال، إنه فقط أداة، وهكذا يفقد نثرك الميزات والمبررات الجمالية، ويصبح نثرا قابلا للزوال، قابلا للاستعمال ثم الزوال، وهذه الحالة هي الحالة الغالبة علي نثر الشعراء المصريين من الأجيال المختلفة، وأظنك ستوافقني أنها الحالة الغالبة علي نثر الشعراء العراقيين، أيضا من الأجيال المختلفة، الاستثناء يأتي من الشام الكبير، نثر لبنان، ونثر محمود درويش، ونثر سوريا، هذا الاستثناء غالبا ما يستند الى مفهوم الشاعر عن الشعر وعن نفسه، يستند الى مفهوم الشاعر عن النثر وعن نفسه، الى مفهومه عن تراتبية موروثة تضع الشعر تاجا فوق الرأس المرفوع، وفوق الرأس المقطوع، أو عن انعدام أية تراتبية بحيث يصبح الشعر والنثر شقيقين أحدهما لا يفوق الآخر ولا يتقدمه، عند البعض يضح النثر متمما للشعر ومكافئا ومضيئا له، وعند البعض الآخر يصبح متمما للكائن السياسي أو الكائن اليومي ومكافئا لأيهما، و هكذا يكون موكبك وطوافك السري، أنت الشيوعي في عربتك الملكية، تقودها وإلى جوارك على المقعد الذهبي قصائدك ومسوداتك الشعرية، وعلى ظهر العربة يتعلق النثر في وضعية الموشك دائما على السقوط، أحيانا توقف العربة وتزيحه، وأحيانا يتعلق مشرذما على هيئة مقالات وقصص وروايات ورايات ومعه تتعلق ترجماتك، فأنت تمارس الترجمة بالطريقة ذاتها، ليس باعتبارها متممة للشاعر مكافئة له، بل كنشاط واسع مفتوح على كل الاتجاهات نشاط تقني يقوم به أحد التكنوقراطيين النشطين، لا يسعي الشاعر من ورائه الى تزويد شعره بقوي إنتاج متميزة، أول تعارفي علي شعر كفافي كان سنة 1979 في وداعا للإسكندرية التي تفقدها، مائة وعشرون قصيدة، ومقدمة لرجل لا أعرف اسمه ريكس وارنر، وأصبحت إيثاكا بفضل ترجمتك مدينة بعيدة لا أصل إليها أبدا، وأنت تزمع الرحيل الى إيثاكا فلتصلٌِ من أجل أن يكون الدرب طويلا، مليئا بالمغامرات والتجاريب، بعد كفافي كان أونجاريتي في سماء صافية، وبريفير في كلمات، وفلاديمير مولان في قصائد مختارة، وفاسكوبويا في شجرة ليمون في القلب، ولوركا في الأغاني وما بعدها، وغونار أكلف في ديوان الأمير وحكاية فاطمة،و سارة ماجواير في حليب مراقد، ويانيس ريتسوس في إيماءات . بعض الشعراء الشباب يرون أن ريتسوس بين الآخرين هو الأقرب إليك وروايات افريقية من الصومال وكينيا، وروايتان لم أحبهما لديفيد معلوف الاسترالي من أصول عربية، حرصت أن أعرض عناوين ترجماتك المتاحة أمامي لأتعرف علي اتجاه ما للبوصلة لكن التنوع وغياب المشروع جعل البوصلة تهتز وتجري في أكثر من اتجاه، أوشكت أن أقول لنفسي! إنها ترجمة محترفين، إنها عمل يقوم به صاحبه في أوقات الفراغ بين قصيدة وقصيدة، هذا الرجل أقصدك لا يحب أن ينتسب الى شيء غير شعره، ولا يحب أن ينتسب إليه شيء غير شعره، سنتبين طوال الوقت أن الترجمة كانت متممة للكائن اليومي غالبا، كانت تعمل بدأب علي بعض ما يقابله مصادفة ويعجب به، كانت مهنة أحيانا، ونادرا كما في حال ريتسوس وهنري ميلر ما تكون متممة للشاعر ومكافئة له، النثر والترجمة عندك هما ركعتان بلا قلب، بلا إيمان، تقوم بأدائهما خارج محرابك ومسجدك، ربما علي قارعة الطريق، ربما في البيت، ربما في المقهى، ومعهما تظل القارعة والبيت والمقهى على حالها كقارعة وبيت ومقهى، أما الشعر الذي يحدث في بعض هذه الأماكن إنه يحول أيا منها الى محراب أو متاهة، شعرك أيها الشاعر سعدي هو نباتك الطبيعي الذي تحتوي عليه وترويه يوميا وتحميه من الغوائل، نثرك وترجماتك هما نباتاتك البلاستيكية التي ينتجها مصنعك، غزارة شعرك لا تمنع عنه أن يكون طبيعيا، قد تتسبب في كثرة الحشائش والأعشاب، أشهد أن الحشائش والأعشاب هذه تفوق كثيرا من حيث العدد، تفوق الأشجار الجميلة، غزارة شعرك قد تتسبب في أن تكون المسافة شاسعة بين جيده ورديئة، وهذه آية من آيات الشعراء الكبار، آية من آيات أبي تمام مثلا، تذكر أبا تمام، لو جئت عالمنا لكنت معي سجينا، هذه الآية لا يستطيع البحتري أن يبلغها، هناك آية ثانية هي عدم قابلية هذا الشعر للصف والتصنيف داخل اتجاه، عدم الاطمئنان الى التصنيف إذا جربنا وفعلنا، عبودية الشاعر وخضوعه لاتجاه قد تعني أنه محض معبد طريق، محض جندي، محض مؤمن بعقيدة، وأنه قد وضع العقيدة فوق الشعر، وأنه أكثر إخلاصا لها، انفلات الشاعر من حدود كل اتجاه تعني اقترافه للخيانة الجميلة، الخيانة الضرورية، خيانة العقيدة، الشعراء مثلك خونة بامتياز، خونة العادة والتقليد والاتجاه والدعوة والاستمرار على الوتيرة ذاتها، ما آلمني حقا، وأرجو أن تسامحني، هو ارتدادك الى ديوان الموضوع، ديوان المعاني، تجميع القصائد التي تقع تحت عنوان واحد، تجميعها ونزعها من دواوينها الأولى المتفرقة، ليكون هناك كتاب الموضوع، كتاب كل حانات العالم من جلجامش الى مراكش، كتاب الايروتيكا، كتاب المدن، ما آلمني في هذا التقليد، أنه من زاوية خفية يعيد الاعتبار الى شعر المعنى، ويجعله وكأنه امتداد لشعر الأغراض، إن هذا التجميع ينطوي على الجزء التالف من التقليدية والذي شاء أن ينشع على جلد شعرية حديثة، هذا النشع يؤيده مسرب آخر هو شعور الشاعر شعورك أنه الشاعر الضخم الوحيد والنبي والذي لا يقرأ أحدا ويختفي خلف قناع سميك من التواضع، نبي يقاسمني شقتي، هذا الشعور ينطوي على الجزء التالف أيضا من التقليدية ويشترك فيه كل الشعراء العاميين بنسب متفاوتة تضيق مثلا عند صلاح عبدالصبور الأجمل بينهم وتنفرط الى حد إثارة الشفقة عن أحمد حجازي وتلبس قناع التواضع عند بعض المهرة الآخرين، ما آلمني حقا، وسوف تسامحني، أنني عندما دخلت ساحتي ديوانيك حياة صريحة وقصائد العاصمة القديمة، وجدت أتربة كثيرة تملأ المكانين، وشممت رائحة عطنة بعض الشيء أجبرتني على العودة الى ساحات الأخضر وفائق حسن والشمال الإفريقي والليالي كلها، ومع ذلك ستظل تدهشني تلك الحماقات التي نمارسها جميعا تلك المحبات والكراهات غير المفهومة، سأقرأ كثيرا قصيدتك الأشرار وأتخيل أبطالها وفرسانها يتحركون في شوارع القاهرة بعد أن نزحوا من بغداد، أتخيلهم وعلى كتفي كل منهم أعباء نظافته وطهره الظاهرين وأعباء اتساخه وعهره الباطنين، سأقرأ مرثيتك النثرية عن عبدالوهاب البياتي بعد أن أقرأ قصيدتك المهداة إليه سنة 1955، كنت أيامها في العشرين، ربما كنت مبهورا بعد، أترى ستومض في ندى عينيك بصرتنا القديمة، وهجا وأغنية عظيمة، وسأرى ذلك الموت الغادر، الموت النقاد، موت عبدالوهاب، كيف استطاع أن يغسل الغبار ويزيله عن عينيك فترى عبدالوهاب هكذا زائفا قليل الشاعرية والشعرية، سأقرأ مختاراتك من شعر الجواهري بعد أن أقرأ قصيدتك المهداة إليه، وسوف تزلق سبابتي وابهامي فوق جلد ضفدع الجواهري المبتل والمختل، وسوف أتبين أن الموت الغادر، الموت النقٌاد موت أبي فرات استطاع أن يصالحك مع قيمته الكبرى، عندئذ سوف أنظر الى الموت الذي أخشاه جدا، سوف أناديه وأقول له وأداهنه، أيها الموت، أيها الموت، الى أي حد أنت ساحر، وسوف أسمع سعدي يتنهد. أيها الشاعر سعدي، هل يمكن أن تقوم لنا علاقة حميمة تسمح أن أراك في أبعد نقاط داخلك، وأن تراني في الأبعد، أن نمشي متلاصقين يدا بيد، نبحث عن إيثاكا، عن خان أيوب، عن البصرة، عن ليليان جوزيف، وعن أبي تمام وعن المنفيين، المنفيون يحبون ملابسهم ونباتات الزينة والقطط، المنفيون يحبون اللغة الأخرى ومواعيد قطارات الليل،المنفيون يحبون حسابات ما كانوا ليحبوها، وروايات رايات ما كانوا ل.... المنفيون، سوف يفيقون صباحا ما، ليروا انهمو منفيون، حتي عن معني المنفي.
****
 تفصح مجموعة سعدي يوسف الجديدة (صلاة الوثني) عن ميزات عدة، فهي ابتداء، تمثل أول مجموعة شعرية يجمع فيها سعدي ما كتبه من أشعار كتبها بعد احتلال العراق، ولعلها أول مجموعة شعرية عربية تصدر في هذا الموضوع!
تفصح مجموعة سعدي يوسف الجديدة (صلاة الوثني) عن ميزات عدة، فهي ابتداء، تمثل أول مجموعة شعرية يجمع فيها سعدي ما كتبه من أشعار كتبها بعد احتلال العراق، ولعلها أول مجموعة شعرية عربية تصدر في هذا الموضوع!
وهي لم تصدر عن دار المدى التي اعتاد نشر أعماله من خلالها طيلة العقد الماضي، فالمجموعة الجديدة صادرة عن دار نينوى بدمشق، وعدا عما تفصح عنه، في ما حولها، وتضمره في محتواها، فهي تشي من خلال عنوانها نفسه بطبيعة نوعية لمستوي اللغة التي ينحتها سعدي في قصائد هذه المجموعة.
فمفردة الصلاة هنا، هي من تلك الألفاظ التي تهجر معناها لتذهب إلي نقيضه، وليس مرد ذلك إلي التصاقها أو نسبتها للوثني، بل لأن الصلاة في مجمل القصائد، تخرج عن كونها دعاء واستغفارا وتوسلا، إلي رفض صريح، رفض يبدو كصرخة ممتدة عبر خريطة المنفي، وضجيج الوطن تحت الذبح!
إنها سيل من المشاعر يجتاح الشاعر في عزلته! لكن هذه المشاعر، تبدو قسرية إذ كان الشاعر يأمل أن يعمق عزلته بدونها، أن يطيل التأمل في زخات الربيع الأخير، أن يأنس لشتاء ينعكس بياضه شيئا فشيئا علي الشاعر، وهو لا يضيق بمقدمه، بل يتهيأ له، بيد أنه في هذه اللحظة بالذات تنقلب دورة الفصول علي قرن الزمن المترنح فتفسد العزلة وليس ثمة من مناص سوي التهيؤ لاستقبال ريح من نوع آخر، ليست ريح شتاء الطبيعة، التي تدرع لها الشاعر وأعد لعصفها، بل ريح المتغيرات التي أحدثها التاريخ علي الأرض، وما بين حركة الطبيعة وحركة التاريخ يفترش سعدي يوسف سجادة عزلته في العراء المتبقي، ويؤدي صلاته الوثنية، وهذه الصلاة التي حملت عنوان مجموعته الأخيرة هي عنوان لقصيدة مهداة إلي عبد الرحمن منيف في رحيله!
تبدو الصلاة بمعناها الضدي، هي الانتماء الأخير، لسعدي وهو يغرق في مونولوج طويل، يأخذه صوب الأفكار الأولية التي يفرزها تكوّن الأشياء في صيغتها الأولي، ويري كل ما عداها وكأنه باطل وقبض ريح، وليس هاملت المصنوع هنا من حكمة الكتاب المقدس هذه، سوي ممر لعبور نحو ضفة بعيدة يمنحها التأمل في الخلق والخليقة! وليس ثمة أمام الشاعر سوي الخروج من زلزال العقائد، إلي عراء الوثنية حيث لا جديد تحت الشمس!
فتبدأ مجموعة القصائد بهذا الحس التأملي ذي النبرة التي تحاول مقاربة السكون وتقريبها من اللغة الباطنة، وهو ما طبع المجموعات الشعرية التي أصدرها سعدي يوسف خلال عقد التسعينات،ابتداء بقصائد باريس، مرورا بالوحيد يستيقظ، وجنة المنسيات، وإيروتيكا، ويوميات أسير القلعة، وربما انتهاء بحياة صريحة 2001، لكن سرعان ما تبدأ المجموعة بجنوح واضح يتناسب مع جنوح الأحداث في العراق، لتبدأ منذ القصيدة الرابعة (تحقق) بالانعطاف نحو مكان آخر، ليس غريبا علي سعدي يوسف علي كل حال، فهو استعادة فنية حية لتجارب أخري له، أقربها كما يبدو لي (إعلان سياحي عن حاج عمران) ذات البناء الملحمي متعدد الأصوات، والتي نشرها خلال الحرب العراقية الإيرانية عند دخول الإيرانيين لتلك القرية العراقية الحدودية.
لكن العراق اليوم أصبح كله رهن الإعلان السياحي! ربما لهذا يكتفي سعدي بالملصقات السريعة هذه المرة، متخليا عن النفس الملحمي، فبينما كان المنفي قبل عقدين مسافة، يلوح عبرها الوعد، أصبح اليوم مصيرا، ومستقرا.
استحضار متعدد..
الشواطئ والرعيان والبحيرات والكوانين، الفصول والجبل والفراشات، وصوت البحر، تختلط مع مشهد تحرك فيه دبابات إبرامز الأمريكية في ساحة التحرير(يعرب سعدي اسم الدبابة ويجعله إبراهيم) وشيخ العشيرة الذي يطرح أرضا تحت جزمة المحتل، ليتسمع أصوات الخيل التي لا تأتي، سجن أبي غريب، وقصف الفلوجة والنجف والثورة والكوفة! سامراء، وسرداب الغيبة، نخيل العراق، الجواهري والمتنبي، اللذان يحضران بقوة ليجسدا تماهيا في حالة العزلة التي لا يحضر فيها الكثيرون، ربما سوي الأموات بقصائدهم الحية!
فيجرب سعدي تنويعا صعبا علي مقصورة الجواهري، لكنه سرعان ما يجنح نحو بحر آخر، إيقاع آخر ومورد آخر وإن بدا مرا.
تتبدل صورة لندن عاصمة الكولونيالية القديمة، وكانون العزلة التي لجأ إليها، لتصبح (أرض نخلة) التي أنشد فيها أبو الطيب، أشهر أبيات اغترابه متعدد الطبقات، فيدوٌِر الجملة في بحر الخفيف، ويستعيد رؤية ليل العراق الطويل، من هناك، لكن ليس ثمة من تبقي في الضفة الأخرى بين النخل سوي وجه الأب!
يأتي الحدث إذن ليطيح بعزلة هشة طلبها الشاعر، فلم يطلها!
فيعمد سعدي في هذا الديوان، إلي تجسير صلة لا تخفي مع شعره في السبعينات بل إنه يستعيد في قصيدة القطار الايرلندي، البناء التحاوري والتجاوري للمقطع الشعري:
(يا ليل أين الصفا؟ أين انطفا المأمول!
أرض السواد انتهت للشوك والعاقول
كل الجيوش اقتضت منها وحال الحول
يا حسرتي للضمير المشتري المقتول!)
ليس هذا المقطع وحده من يعيد إلي الذاكرة قصيدته (في الأول من أيار) في أواسط السبعينات، بل يكاد المبني العام للقصيدة يلتصق فنيا وروحيا بتجربة السبعينات تلك.
بيد أن ثمة نبرة صوفية غير معهودة في تجربة سعدي تكاد تختفي في ظلال المستوي اللغوي الخاص لشعره، ولأن الصلاة وثنية، فإن الصوفية هنا ليست دينية عرفانية، والقصيدة ليست إنشادية، وبلاغية، بل تعتمد علي تهييج الأرواح الثاوية للأسلاف في الطبيعة تلك التي تمر عليها حادثات التاريخ وأحداثه، لتزيح عنها جلدها المستعار، وتكشفها مرة واحدة عارية!
فهو الباحث عن (سعدي) في قطارات الأنفاق، وهو السائل نفسه عن أسرار ما جري منذ ألفي سنة قبل الميلاد وما يرتكبه الشعراء اليوم من مديح (للتجار وضباط الحامية الأكدية!) وهو اللائذ باسمه من بئر الخوف.
لكأن سعدي يستشعر هذه النبرة المثنية في بعض جمله فيسارع في قصيدة (الليلة أقلد بازوليني) إلي تأويلها:
(لست المتصوف
لست السريالي
ولست النادم عما أحببت:
النخل ورايتك الحمراء.)
ولعل فكرة بازوليني في فيلمه الشهير (إنجيل متي) تندفع هنا كمعادل لتلاصق فكرة ابن السماء، الواعظ والفادي بطبقة المهمشين والمقهورين، وأهل القاع المحرومين، البروليتاريا الاجتماعية بأحلام الشعراء والأنبياء، العقيدة بالأسطورة، والثورة برموزها، ويبدو سعدي عنيدا في هذا الحلم، فيؤكده في صوت جماعي بدا نادرا ونافرا وسط موج من المونولوج الداخلي المعتمد في عموم المجموعة:
(لن نرفع أيدينا في الساحة
حتي لو كانت أيدينا لا تحمل أسلحة
نحن سلالة أفعى الماء الأول
نحن سلالة من عبدوا ثيرانا تحمل أجنحة
وسلالة من عبدوا نارا في قنن الثلج)
وإذ يحقق سعدي يوسف مفهوم قصيدته داخل الشعر، فليس من خلال البناء النسيجي المتماسك الذي عرف عنه فحسب، لكن أيضا من خلال ارتباط كل قصيدة بحدثها، وملازمتها له، مشهدا علي الشاشة أو خبرا في جريدة، أو ترجيعا في الذاكرة (والذاكرة لديه مختبر ساخن) ويأتي حجم القصيدة التي لا تتجاوز في الغالب مساحة الورقة التي كتبت عليها! ويوميتها (أعني إنجازها في اليوم ذاته كما تشير تذييلات تاريخ القصائد) ليلخص طبيعة القصيدة التي يكتبها سعدي في هذه المرحلة!
لكنه في (لزوم ما لا يلزم) يوغل أكثر في الحوار الداخلي، واستحضار الموتى، فيلتزم البدايات ويترك نهايات الأشطر مفتوحة، وعبر قراءة عمودية تذكر بالتعزيمات السومرية القديمة، وبشعر ما اصطلح عليه ( الفترة المظلمة ) وربما لهذا دلالة أيضا، ليلم حروف اسمه بالتدريج من عزلة المعري، ومن تعازيم السومريين، ومن شكليات شعر ما قبل النهضة! تعويذة في العراء الزمني الفاضح.
العودة إلي الأرض!
يواصل الحدث استدراج الشاعر من عزلته، من انشغاله بالطبيعة ومراقبة ثلج الشتاء في الخارج والباطن! ووسط نيران العراق يزدهر شعر سعدي مرة أخري! ليكون مستوي الاستجابة قيامة متعددة العناصر، فتستيقظ في عالمه عوالم خرافية شتي.
ومع هذا يقارب الشعر من الشعار، فليس من المناسب لصاحب إيروتيكا وحانات كل العالم وقصائد باريس، في هذا الوقت إلا أن يلتفت إلي (الليالي كلها) و (جدارية فائق حسن) و(نهايات الشمال الأفريقي) والواقع أن شعر سعدي في تلك المجموعات كان شعارا ولافتات مضمرة تقرأ في ظلام القمع والدكتاتورية.
بيد أن المكان الذي أنشد له سعدي في تلك المجموعات كان مكانا مرتبطا بذاكرة شخصية، وذات شأن يومي، متمثلا بمقهى وبار وسجن، وجدارية، تتجمع تحتها أذرع العمال والحمامات، وامرأة تبيع أكباد الأبقار، لكنه هنا يتجلي ببعده الكلي، وبذاكرة جمعية، لتأخذ الأرض شكلا نهائيا وخلاصة للمكان وخميرة لكل الذاكرة وشتي الأحداث، ومع هذا يبدو سعدي كمن يمتلك حكاية قديمة في زمن لم يعد معنيا كثيرا بكل أنواع الحكايات، لذلك يتسمع نصيحة غامضة لسرد حكايته( أذهب وقلها للجبل):
(هذه الأرض لنا
نحن برأناها من الماء
وأعلينا علي مضطرب من طينها سقف المساء
النخلَ
والذاكرة الأولي..
وكنا أول الأسلاف والموتى بها
والقادمين!)
ويعدو في برية قديمة مستعينا بحكمة (الرعيان) أول السارحين في الأرض بمواشيهم، وطواطمهم وأحلامهم، ليسرد الحكاية من موضع آخر، من الأثر البدائي بوصفها أول مكان تركه الإنسان علي الأرض:
(قد تعني الأرض لمن ينبتها البقل كثيرا
أما نحن فإن الأرض لدينا متطايرة
وهشيم
أخضر أحيانا
أصفر أحيانا
ورماد في الريح)
وحالما يعود التاريخ لينشب مخالبه في الطبيعة تتغير المعادلة وينهض السؤال القديم مرة أخري:
قيل لنا الأرض لمن يفتحها...
(عجبا
نحن هنا منذ قرون:
لم نَمْلك/ لم نجمْلك.
أحسسنا اليومَ، بان الأرضَ لها معني)
لا يضاهي تكرار مفردة الأرض وحضورها كهيولي أولي، في قصائد سعدي، سوي تكرار أليجوري جلي، لمفردة النخل، ليعيد صياغة العراق، من مادته الأولي: الفكرة وليس الدولة، المسمي وليس التسمية، الطبيعة وليس التاريخ! وواقع الحال في العراق اليوم، يشير إلي إن الصدمة كانت قوية بحيث كان من شانها أن تعيد سؤال صغيرا إلي هذا العراء الواسع من الأسئلة!
(وسلام علي هضَباتِ العراقِ ...
الذبيحة في العيدِ، بغداد في العيدِ،
تلك المقاهي: لها الشاي مرٌا،
وتلك الفنادق: سكانها الأبعدونَ.
الصلاة أقيمتْ
صحون الحساءِ بها مرَق من عظامي
ومن لحمِ سحْليٌة ...
والمساجد مغصوبة الأرضِ
أبوابها للجنودِ، مشاة، وبحٌارة
وملائكة طائرينَ)
ليست الصلاة هنا صلة مع عقيدة أو رمز، إنها قطيعة نحو مبتدأ قديم! فلا صلاة للحرية في غيابها! كأن صلاته هنا تنحاز بوضوح إلي فكرة الخوارج عنها بوصفها معادلا للرفض، عندما وضعها أحدهم في ميزان الأرض بسؤال مرير وأجاب عنه بمرارة أشد:
أصلي ولا شبر من الأرض يحتوي
عليه يميني؟ إنني لمنافق!
أخبار الأدب - البستان
10/10/2004
****