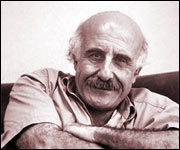 أذن من أين تجيء أعراس عباس بيضون؟
أذن من أين تجيء أعراس عباس بيضون؟
من أين يأتي بأقنعته لهذا الرقص غير المقدس؟
وبأي روح نازفة يجلد الضجة، وليس في حقوله من قمح غير الملائكة، وليس في أقاليمه غير هذا الموت الذي يشع كنزهة في ريف الدم، ويمجد بالقهقهة مشاجرات الرعد فوق التلال.
كيف نبعثر رفات هذا البهلول يا بيضون؟.
وأية أباريق نستعمل لغسل الفضيحة؟.
وهل سيكون في حيازتنا تلك البراري والينابيع والباحات لنمرجحن بمرجيحة الخيال، يا وصيفات، يا وصيفات المهزلة، كيف نخدع المكان بالفتيلة، كيف ننقش الملائكة كتجريد في يد الضياع؟.
الشعر عند عباس بيضون يصعد درج المنزل والقصيدة هي البستاني المنهمك في تهذيب السياج، يرتدي سلاميات العازف، ويكحل المسافات بمنجل الغيب، كأنه فاتح يتقدم بلا رايات خفاقة ولا أناشيد حماسية، تتبعه كتيبة صغيرة لاقتحام المتاريس، لكنه يرسم الدم بشكل الدفوف ويصرخ بالكلمات: لا حاجة بك إلى الحروب، الأرض بأسرها ستكون لك.
وللشاعر الإصدارات التالية: "الوقت بجرعات كبيرة" 1982 – دار الفارابي. "صور" 1985 – توزيع مؤسسة الأبحاث العربية. "زوار الشتوة الأولى" مسبوقاً بـ "صيدا الأمثال" يليه "مدافن زجاجية" 1985- دار المطبوعات الشرقية. " نقد الألم " 1987 – دار المطبوعات الشرقية. "خلاء هذا القدح " 1990- دار الجديد. " حجرات" 1992 – دار الجديد. لكنه يعلن بأن شفراته ومقصاته لا تزال مخفية، أذن، لنتبع السنجاب في منفاه، وهو يحفر خندقه العميق في أرض الشعر.
*الشعر دائما يعيش في الاختلاف وينبع منه، والشعرية العربية لا تملك حتى الآن جسور عبور إلى مناطق مختلفة، لهذا يأتي وقوفها المنظم داخل منطقة محدودة، وتعارضها الدائم لكتابة الاختلاف، كيف يصوغ عباس بيضون اختلافه؟.
كل كلام للشاعر عن شعره هو في الغالب نرجسية معلنة، فالواقع الحالي أشبه بالخفير الذي يسابق زيزان الحلم، والشاعر هو كائن متوار وراء نصه، ربما كان مثال الشاعر في الخمسينات أو الستينات في هذا القرن هو البطل الذي يزعم بأنه يصوغ في شعره نموذجه الشخصي، وربما كان نموذج البطل سائد في ثلاثينيات الشعر العالمي، لكننا نملك هنا ما يكفي من الأسباب لنكون متوارين، أن نوجد نصوصنا التي لا نقدمها على أنها كاملة ومنتهية بل على أنها التباس للشعر.
هل أنا مختلف أو فريد؟ هذا سؤال يقلق العربي عادة، الأرجح أن دائرة الكلام عن الاختلاف تتسع كلما يعوزنا مسمى حقيقي نستند أليه، وكلما افتقرنا إلى سدوم التسمية، والفرادة والاختلاف مسألتين مختلفتين : كأن الشاعر يكون متفردا إذا جاء بصور لم يسبق أليها، في هذا كل شاعر فريد ومختلف وبوسع كل شاعر وكل كاتب على قدر من المهارة والتجربة أن يصنع عبارته وان يوحي بدرجة أو بأخرى بطابع شخصي، وهكذا، يكثر المختلفون والمتفردون إلى ما لا نهاية له ودون أن نقع في الواقع على كثير من الفرادة والاختلاف، وبالتالي فهما ليست مسألة تقنية كما أن الشعر ليس مسألة تقنية،
الفرادة والاختلاف مسألة ثقافية، هما في أساس تناولنا إلى العالم وقدرتنا على ابتداع توهمه وتسميته وتخيله، أي انهما في صناعة عالم مختلف لا حملة مختلفة، عالم مختلف، بأشيائه ومسمياته، وكائناته، فنحن لا نملك ثقافة مختلفة ولا نملك أدبا مختلفا، أي حين تكون ثقافتنا أسيرة تغني بمثال فولكلوري، محلي، تبريري، مثال ذلك العقل المستقر في روح الماضي والساعي باستمرار إلى التطابق والتماهي معه،
* ألا ترى بأن التجارب الجديدة ما هي إلا اختلاف مرجأ في شكل أتلاف، ألا ترى بأن المختلف في الشعر العربي هو قبول متخالف، بمعنى قبول يختلف وليس اختلاف، ثم ألا ترى بأن هذا التعارض يتبدد ويبدو أشبه بالمحافظ داخل الترتيب النظامي للتماثل؟.
هذا الارتباك داخل غيبوبة دوغمائية هو بعض من أوهامنا الثقافية، الاختلاف ليس مطلقا وليس مطلبا بذاته ويبدو أن الشاعر لا يفعل شيئا سوى التغني بالاختلاف، والكثير من النصوص لا تفعل شيئا سوى التغني بالاختلاف والرفض، كل هذه مترادفات، فالتكرار الببغاوي لكلمة اختلاف لا يصنع اختلافا كما أن التكرار لكلمة وطن لا يصنع وطنا.
أنت مختلف لأنك معاصر، لأنك في عالم تحطمت فيه الماهيات المختلفة والعالم، عالم المدينة حيث البشر أفرادا ولا يصلهم الا مكان قائم في حد ذاته على التباين والاختلاف فان تنتمي إلى مكان وتأريخ وثقافة لا تخصك ولست ابنها يبقى الاختلاف حلما يتسرب حتى أقصى هوامش النوم، الاختلاف أمر جوهري، أو لنقل الأعراض أمر جوهري في الكتابة، أنت تكتب لأنك تعترض بشكل أو بأخر تصنع مكانا لنفسك.
بالنسبة لي وبهذا المعنى، لا يعنيني في شيء التغني بالاختلاف ولا امتداحه، ولا أحسب أن إدعاء الاختلاف يكفي لصناعة الأدب، بل، العكس، أظن الكاتب الشقي باختلافه، إلى حد، يسعى أحيانا إلى التنفس خارجه قليلا.
حين ظهرت تسمية شعراء الجنوب استمدت ممكنات تواجدها من خلال بعدين أساسيين : الأول، سياسي، والثاني، دعائي، ألا ترى معي الآن، أن شعراء الجنوب هي تسمية سريعة التلف ومن المناسب تربيتها في حاضنات، أو أوعية جديدة. خصوصا ونحن نلاحظ أن بعض الأسماء انتهت لأن تصبح مجرد خرائب مشبوهة في خارطة الشعر، رغم أن هؤلاء لا يجتمعون حول مائدة واحدة.
عندما كانت تسمية شعراء الجنوب قائمة لم أكن أكتب الشعر، كنت أزاول أعمالا أخرى، وكنت منصرفا للسياسة، والمرة الأولى التي نشرت وعدت فيها إلى الشعر 1974 التي كتبت فيها " صور" فوق ذلك لا اعتبر نفسي ضمن شعراء الجنوب أصلا، رغم أن بعض الذين شملتهم هذه التسمية شعراء أحبهم وتعنيني أعمالهم، ثم لا تنسى أن التسمية نفسها انتهت، ولم تصمد، وهذا لمصلحة الشعراء أنفسهم، إذ أن انهيار التسمية يعني من جملة ما يعني أن هناك شعراء تجاوزوها، ثم أن التسمية نفسها كانت واحدة من ظلال شعر المقاومة الفلسطينية، الجنوب كأرض من تجليات فلسطين، ايجاد شعر قوامه التغني بالأرض، وهكذا لمرة ثانية نقع في لفظية أرضية تجعل من الشعر الوطني مديحاً،
فكما جرى تصنيم الزعتر مثلا في الشعر الفلسطيني الأول جرى تصنيم البرتقال في شعر الجنوب، وهذا ما بنى نموذجا شعريا لا يختلف كثيرا عن السابقة الفلسطينية، نموذجا قائما على التغني والحماس والمديح، كما هو قائم على نفايات أيديولوجية، وكان الشعر هو مرآة الوطن، لهذا نجد مدح الحرمان وعبادة البؤس، وهذه تشكل جزءا من الأيديولوجيا الشعبية القائمة عندنا، ولعلها عدت كل الفكر السياسي عندنا،
لم أكن لسبب ظرفي وزمني بين شعراء الجنوب ولا أحسب شعريا وثقافيا بينهم، فأنا بصورة أو بأخرى لا أحتمل مثال التغني الحماسي والمديح، وقصيدة " صور " مثلا لا تمتدح ولا تتغنى بالمدينة بل ترسمها أحيانا بخطوط سوداء وترسمها بالوحل والقذارة، والحب يصدر عن هذا المكان الضيق المؤبوء.
الواقع العربي جعلنا لا نستطيع أن نميز بين الحقول والمعسكرات، بين الحرية والنازية، لهذا جاءت التجارب الجديدة أشبه " بغريب " كامو، هل تعيش نصوص عباس بيضون هذه الغربة.
أنت تتحدث عن الطغيان، فهذا الطغيان الذي يحول شعبا كاملا إلى مادي هلالي ويجعل من الدكتاتور أو الطاغية هو الفنان الوحيد كما يقول أحد الأصدقاء، والشعب والتأريخ والتراث هي مواد إبداعه الخاص، هذا النموذج السائد للطغيان، مر في لبنان بشكل أكثر فظاعة ولكن بصورة أكثر كاريكاتيرية، وأنا ككل مثقف عربي لا أستطيع أن أتتجاهل هذا، لا أستطيع أن أختزل دوري إلى مجرد متفرج يتأمل – فاغر الفاه – فخامة الديناصورات في المتحف، يعنيني مصير الشعب الذي أكتب بلغته، وأعرف أن جرح انتمائي أليه أو انفصالي عنه هو دائما موضع تمزق مستمر، وأي كان تأريخ " صور " أو غير صور إلا أنني سعيت إلى أن أكتب من موضع هذا الجرح، جرح الانتماء المؤلم والانفصال المؤلم.
ما تكاد الشعرية العربية تكتشف حالة شعرية حتى تحيط بها المؤسسات السائدة وتجبرها على القتال في زوايا مظلمة، وعلى خوض معارك لم تعد نفسها لها، هل يمكن لنا أن نسوق التشبيه التالي : الشعر بيت قديم وقصيدة النثر هي صيحة الدمار بين جدرانه الآيلة للسقوط.
* صيحة الدمار أم صيحة الإنقاذ؟.
سمها ما شئت.
أنا لا أقيم قصيدة النثر حزبا، أنا أكتب القصيدة لأن هذا ما أعرف كتابته، لست على كل حال داعية لشيء على الإطلاق، كل ما أعرفه هو أن الإرث الوزني في الشعر العربي لا ينهار في لحظة، وأقول بأسى حقيقي أن نماذج الشعر الوزني الراهن، في حال من الانحدار، وبصورة خاصة، شعراء الوزن الجدد، في حالة من الخفة والانحدار، ولا أرد هذا إلى الوزن نفسه ولا أحمل الوزن تبعية هذا الانحدار، يرعبني هذا الانحدار، لأنه يريني بأي خفة نستهلك نحن الشعر ونستهلك نتاجنا الثقافي.
ولا أحسب زمن الوزن ولى، مثل هذا الكلام أتركه للذين يتربون في التظاهرات وينتقلون من هتاف إلى هتاف، ويدعون كل يوم أنهم ينقذون العالم، بمعنى لا نستطيع كل لحظة أن نلغي الإرث، لا نستطيع كل لحظة أن نطيح بالسياب، فالسياب مثلا من الشعراء الذين تربيت أنا شخصيا عليهم، والسجال الشعري لا يتم كما تتم الانقلابات العسكرية، لست داعية إلغاء، كل ما يهمني، هو أن نتخلص من هذا السجال البائس حول شرعية هذا النوع أو ذاك، وننتقل إلى مشكلات الكتابة الفعلية إلى مشكلات الشعر.
لنسم لك بعض الأسماء الشعرية والتي نعتقد بأنها قريبة إلى نفسك، ما هو تعليقك عليها :
سركون بولص
مخيلة صادرة عن عنف ليس لفظيا، مخيلة انهيارات متلاحقة.
صلاح فائق
أحسه أيلواري له قدرة على إنتاج سياحة غرائبية
جريدة "الرأي" الأردنية- 23 / 7 / 1993