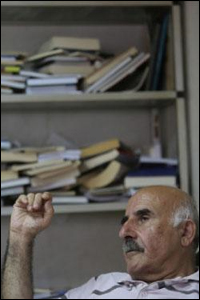 هو أحد أبرز الأصوات التي صنعت منعطف «الحداثة الثانية» في الشعر العربي في سبعينيات القرن الماضي، بعد حداثة الرواد ومن تلاهم في الخمسينيات والستينيات. مكانته بين أقرانه ولدى الأجيال التي تلته لم تعطِه يقيناً شعرياً بقدر ما زاد ذلك من حيرته في الشعر والكتابة. حيرةٌ جعلت شعره أجمل وجعلت كلامه عن الشعر أكثر جاذبية وعمقاً.
هو أحد أبرز الأصوات التي صنعت منعطف «الحداثة الثانية» في الشعر العربي في سبعينيات القرن الماضي، بعد حداثة الرواد ومن تلاهم في الخمسينيات والستينيات. مكانته بين أقرانه ولدى الأجيال التي تلته لم تعطِه يقيناً شعرياً بقدر ما زاد ذلك من حيرته في الشعر والكتابة. حيرةٌ جعلت شعره أجمل وجعلت كلامه عن الشعر أكثر جاذبية وعمقاً.
عباس بيضون الذي جاء إلى الشعر من تجربة سياسية ماركسية، وعمل في الصحافة والنقد، ثم جرّب في الرواية، لا يزال ذلك الاسم الذي لا تحيلُ تجربته على مثال آخر. كأنه «ربّى جملته» كما كتب هو، وظلت هذه الجملة تغذي شعره وتتغذى عليه، وتصنع فرادته وحيرته في الوقت نفسه.
بعد عدد من الروايات التي استثمر في بعضها أجزاءً ومحطات وحكايات من سيرته الذاتية، عاد صاحب «الوقت بجرعات كبيرة» إلى الشعر بديوان حمل عنوان «صلاة لبداية الصقيع» (دار الساقي). هل هي عودة إلى الشعر أم مجرد «جرعة» شعرية، يعود بعدها إلى الرواية؟ «كلمات» التقى عباس بيضون، وكان هذا الحوار عن الشعر والرواية و... السياسة أيضاً:
بعد ثلاث روايات أو أربع تعود إلى الشعر، ويصدر لك ديوان جديد. ماذا تسمي هذه العودة؟
- لا أجد تسمية واضحة لهذه العودة. لا أشعر بأنها عودة، رغم أنني افترقتُ عن الشعر أربع سنوات متصلة. لم أفترق عنه كتابةً فحسب، بل أجسرُ على القول إنني افترقت عنه قراءةً أيضاً، وإنني في أربع سنوات لم أفكر كثيراً في الشعر.
وخلتُ في لحظات أنني انتهيت كشاعر. ولم يُسئني ذلك إلا أنني تعودت أن أقبل نهاية الاشياء. هل هي عودة؟ لا أحب هذا التوصيف. فقد تركت الشعر هكذا فجأة ودون أي وعي أو تفكير في أن أعود بالطريقة ذاتها. كل ما في الأمر هو أنني كنت في تونس، ووقعت بين يدي كتب شعر فوجدت نفسي أحاول أن أجاريها، وكانت المجاراة في البداية سيئة، لكنني أعطيت نفسي بذلك نوعاً من الدافع الذي استمر وانطلقتُ به ووجدتني أكتب مجموعة كاملة. أريد أن أقول لك إنني في ذلك لا أجد فرقاً كبيراً بين أن أكتب نثراً أو أن أكتب شعراً. إذا كنت قد عدت الى الشعر فإنني انتهيت كشاعر، وصرت كاتباً بعموم الكلمة. أكتب شعراً أو نثراً كما أكتب مقالة، كما أكتب حياتي. لأنني أشعر تقريباً بأن الكتابة هي ما بقي لي.
هل تجد الشعر في انتظارك؟ ما الذي يتغير أثناء الانقطاع؟
- في الفترة الأخيرة حدث معي شيء مماثل، تصفحت كتاباً شعرياً وكنت في مكتبي، ووجدتني أمسك القلم وأحاول أن أكتب شعراً أو أحاول أن أؤكد لنفسي أن في استطاعتي أن أكتب شعراً. وهكذا عدت عودة طويلة أثمرت ديواناً آخر. أريد أن أقول إن الفارق بين الشعر والنثر يتضاءل عندي. أريد أن أتكلم عن كتابة، ولا يهمني كثيراً اسمها. ولذلك لا يتغير الكثير. أفكر أحياناً في أن باستطاعة الشعر على طريقته الخاصة أن يقوم بكل ما يتوافر للنثر. أكون أنا حين أكتب شعراً وحين أكتب نثراً، ولا أجد أنني في أيٍّ من الاثنين أغترب عن نفسي. بل أريد أن اقول إنني أكون في الخارج حين أكتب شعراً أو نثراً. وإنني في الحالتين لا أكون نفسي، فيما بين الخارج والداخل، في هذا المجال، لا فارق كبيراً. أحياناً نكتب شعراً احتفاءً بالخارج الذي وجد فجأة لغةً له. أحياناً يكون الشعر عريضاً كالنثر وليس بحت أغنية صغيرة، أو لا يكون أغنية على الإطلاق.
هل يسهّل هذا كونك ناثراً أصلاً في شعرك؟ فقد حضرت اللغة الواقعية والدقيقة منذ باكورتك «الوقت بجرعات كبيرة».
- قد يصحّ هذا، ولكني أظن أن هذه المسألة لا تنطلق من هنا فقط، بل من علاقة باللغة. عندما يتحول المرء نفسه إلى لغة، إلى نوع من كائن لغوي، وعندما تكون الكلمات أقرب إليه من الأشياء، أو تكون في قرب الأشياء، عندما تكون الكلمات حقيقية كالحقيقة نفسها. حين تقتصر لعبة المرء على الكلمات، وحين يمكنه إعادة إنتاج حياته من الكلمات نفسها، عندئذ تغدو اللغة بكل ما فيها إقامة وتاريخاً وسيرة.
لا نستطيع أن
نلقي بالشعر في سلة المهملات لمجرد أن صاحبه لا تعجبنا سياسته أو مواقفه
وهي إقامة تجعلك تتحدث عن الكتابة أثناء الكتابة، وعن «تربيتك» للكلمات. في الديوان الجديد تقول: «تلزمني كلمة واحدة لأبدأ». هل تعيد ذلك إلى رغبة وقدرة ومهارة في ...
- لا أستخف بشيء قدْر ما أستخف بالمهارة. الأدب الذي ينمُّ عن مهارة هو الأدب الذي أشعر فوراً بثقله وأشعر فوراً بحذلقته. ليست الكتابة بالنسبة إليّ شطارة وبراعة. أظن أن الشاعر الذي أحبه هو الذي يتلخص أكثر ما يستطيع من شبهة المهارة هذه.
قصدنا مهارة إظهار الأسى والألم الذي ينبعث من هذه الاستعارات التي تبدو مثل دعوة للقارئ إلى الباحة الخلفية للكتابة وأسرارها. هناك ألمٌ ما في الحديث عن الكتابة أثناء الكتابة.
- آه... هذه حاجة إلى الكلام قريبة من الحاجة إلى التنفس، لأن الكلام يتراكم في الداخل، ويبحث عن لغة. العثور على هذه اللغة، العثور عليها في الأقل القليل، لأننا لا نعثر عليها بالأطنان. إننا نعثر عليها وهي على وشك أن تصمت. نعثر عليها وقد تحولت الى رمز. عندئذٍ يبدو استخراجها ولفظها الى الخارج شيئاً من مقاساة الروح، كأنك تعثر على اسمك. كأنما تجد شارتك الخاصة. كأنك تتحول بذلك الى سبيكة، تجد لنفسك هيكلاً.
هل هذا التضييق والصمت في اللغة أحد أسباب كتابتك للرواية، حيث السرد أرحب والاسترسال مبرر؟
- يصح هذا ولا يصح بالدرجة نفسها، فكتابة النثر ليست فقط توسعاً وترسلاً. كتابة النثر هي مقام، مستوى، هو حاجة إلى الترسّل. حاجة إلى كلام متصل. كتابة النثر بهذا المعنى، نوع من معاركة الصمت، ذلك لا ينفي أننا في كل الحالات لا نقول شيئاً يستحق أن نثبت عنده، فالترسّل هو أيضاً بحثٌ عن الكلمة الوحيدة التي نعثر عليها إبان ثرثرتنا. وحين نعثر عليها، نجمد عندها. إنه شعرٌ في النثر.
ولكن ذلك أحدث نقلات وانعطافات في شعرك، ولم تكن الكتابة هي ذاتها في كل قصيدة أو في كل ديوان.
- هذا انتقال من جملة إلى جملة، ولا أقول من أسلوب إلى أسلوب. في كل كتاب جديد أُعمّر جملة، هي ذلك البديل من الكلمة المفقودة التي تحدثنا عنها منذ قليل. قد أردّ هذا الى طبعي الضّجِر، لكنني أرده أيضاً الى صلتي بالكلام. الكلام الذي يتراكم في داخلنا، ومن فترة الى فترة، نجابهه ونتركه يتهيكل. لا تكون الجملة الجديدة سوى هذه الهيكلة، سوى ما يتخذه الكلام من رسم ومن قامة ومن شكل، قد يكون الشعر هو هذا. هو الكلام وقد تهيكل، لكن هذه التجربة تنتهي في أوانها. يعود الكلام سديمياً ومشعثاً ومركوماً وجامداً. لذا لا بد من إعادة التجربة من هيكلة الكلام على ايقاع آخر. وهذا يجدّد ولادة الكلام، ويجدّد العثور على الكلمة المفقودة. عندئذٍ تنتج جملة أخرى ولا تفعل هذه الجملة إلا أن تتفتح شيئاً فشيئاً وتزداد تفتحاً على مدى النص، إلى أن تستنفد نفسها. كان همنغواي يتكلم عن «عُصارة»، وأنا لا أشعر بمائية هذه الكلام لكنني لا أجد أفضل من كلمة العصارة لوصف هذا النزف الكلامي الذي يتصل ويتتابع إلا أن يصل إلى نفسه.
رغم وصفك الوقائعي والدقيق للكتابة والعثور دوماً على الكلمة المفقودة، إلا أنك قلت عن مجموعتك الجديدة: «كتبتُ أشعاراً أحارُ في وصفها حالياً». وقد سبق أن قلت شيئاً مماثلاً في مناسبات عديدة. لماذا تشكك دائماً في ما تكتبه؟
- هذه حيرة حقيقية، لأنني كلما توغلت في الكتابة غاب عني مفهومها. أي إنني في وسط الشعر لا أعرف ما هو الشعر، وأشك كثيراً في أن ما بين يدي هو شعر. أشك كثيراً في أن هذا الكلام الذي يتهيكل هو حقاً متجسد وذو كيان. أظن أننا كلما أوغلنا في الأشياء، زدنا جهلاً بها. في شبابي وفي أول نشأتي، كنت أجد أجوبة، وكنت أجد الأجوبة حاضرة لي. أظن أن التجربة لا تفعل شيئاً سوى أن تُعمّي الأشياء أو أن تُعمينا عنها، حين يصبح مطلبنا دقيقاً وحساساً يغيب عنا. الآن لا أعرف حقاً ما هو الشعر. لا أعرف إن كان ما أكتبه أو ما أقرأه شعراً. أظن أن تحديث الشعر جعلنا أكثر حيرةً، وأن السعي إلى التحديث ليس سوى مغالبة للذات ومغالبة للشعر لا نصل منها إلا الى مزيد من الشك والحيرة، وربما الخوف من أن نفقدها أو نكون لفرط ما طلبناها قد ضيّعناها.
هل يحدث هذا في الرواية؟
- تجربتي مع الرواية مختلفة، فأنا لم أدخل الى تلافيف الرواية، ولم أتوغل فيها بالقدر الذي أضيّع فيه بدايتي، لكن في روايتي الأخيرة «الشافيات» مثلاً خطوت قليلاً في هذا المجال، وربما في رواية أخرى سأجد نفسي في ذات الحيرة.
حيرة من أي نوع؟
- أفكر أحياناً، صادقاً، ما هي رواية اليوم؟ ما هي رواية ما بعد الإنترنت؟ ما هي رواية العولمة؟ ما هي رواية ما بعد الفرد الذي يتم هتكه وحصاره من كل جانب.
هل تقصد أنك لا تزال «زائراً» أو «مجرّباً» في كتابتك للرواية، وأنك لم تتورط بالكامل كما فعلتَ في الشعر؟
- أظن أن فكرتي عن التورط مختلفة، فأنا أتورط إلى الأخير. وأظن أن التجربة هي نوع من الإيغال إلى آخر حدّ، وأن التجربة هي تقريباً تجريبُ كل شيء. ما فعلته في الشعر على هذا النحو لم أفعله في الرواية. ربما لهذا أرتاح في الرواية ولا أرتاح في الشعر. لأنني في الشعر وصلت الى اللحظة الخطرة، أو اللحظة المليئة بالشكوك والشُّبُهات.هناك بضعُ روايات ورائي، ما يجعلني اقترب كثيراً من الأسئلة الخطرة القريبة من سؤالي عن الشعر. ما هو جوهر الرواية؟ وكيف يمكن الرواية أن تكون متقدمة وأن تكون في آخر تجلياتها، وأن تشتمل على التجريب كله، أو على قدر كاف من التجريب.
هل حصلت على «هوية» روائي الى جانب كونك شاعراً؟ كيف ينظر الروائيون إلى رواياتك؟
- ليست عندي فكرة. لا أعرف أين يضعني الروائيون، وإن كنت أظن أن قراءً ليسوا بالضرورة روائيين لا يرحبون بالهجوم على الرواية، ويظنون أن عليّ أن اكتفي بنعمة الشعر، وأن أقتنع به. بالنسبة إليّ، ذهابي الى الرواية ليس كفراً بالشعر ولا استزادةً من شيء. أذهب الى الرواية لأنني أحب أن أكتبها، ولأنني في وقت من الأوقات، أجد نفسي قادراً على كتابها، وأتمتع بذلك، بقدر ما أعانيه أيضاً.
لكونك كتبت الرواية، ولكونك أحد أبرز التجارب التي صنعت منعطف «الحداثة الثانية» في الشعر العربي المعاصر، ما هو توصيفك لما يحدث في الشعر والرواية اليوم؟
- أظن أن التجريب هو الآن في الرواية أكثر من الشعر. التجريب في الشعر هو تجريب في فنٍّ قريب من الصمت. أظن أن الشعر توسّع ولكن ضمن بياناته الأولى. قصيدة النثر تختبر من جديد صلتها بالنثر، وقصيدة التفعيلة تحاول أن تختبر اليوميات والأشياء، وتحاول أن تجدد في غنائها. كل هذا يدور في حلقات ضيقة تصل أحياناً الى أن تُشعرنا بأن لا شيء يحدث، وأن ما يحدث لا يجد بعد أنساقه وأشكاله، وأنه في أحيان كثيرة يبدو خَبْطاً أعمى. لكنني وأنا الذي ازداد جهلاً بماهية الشعر لا أزال أجد لدى الشبان ما يزيدني حيرةً وجهلاً بالشعر. أعني بذلك أنني حين أقرأهم لا أجد أن فارق العمر بيني وبينهم يعطيني أي ميزة، وأنهم في بداياتهم استوعبوا ما وصل إليه أمثالي في كهولتهم، وأن جزءاً من قلق الشعر هو هذا القدر من المساواة بين النصوص، والعجر عن تمييزها وفرزها.
إلى جانب ما يحدث داخل اللغة والكلام، كيف ترى الآن علاقة الشاعر بالواقع.
- كان همي دائماً أن أُوكل الى الشعر أن يقول أكثر ما يستطيعه، ولكن هذا لا يُلزم الشعر بشيء، فلكل شاعر فسحته من الكلام، ولكل شاعر جملته الخاصة، ولا نستطيع أن نطالب الشعراء بأكثر من أن يكونوا شعراء. هناك قصائد ذات نبض سياسي في مجموعتي. السياسة بالنسبة إليّ هي جزء من ذاتي. إنها تطرح ذات الأسئلة الجوهرية والميتافيزيقية التي هي أسئلتنا عن الوجود. لا أستغرب أن يملك شاعر هذه الكثافة السياسية التي أرجو أن أملكها، لكني لا أحاكم شاعراً على وجودها أو على فقدانها.
ولكن ماذا تقول عن هذا الهيجان في تخوين الشعراء والكتّاب على خلفية أحداث الربيع العربي حالياً؟ وهو ما حدث لأدونيس وسعدي يوسف ونزيه أبو عفش وغيرهم.
- لدى كل أزمة سياسية نجد من يُعيدنا الى المسألة ذاتها: ماذا فعل الشعراء؟ تبدو الكلمات ترفاً لا يستحقونه. نريدهم أن يملكوا شيئاً كالرصاص وكالدم. نريد من الشعر أن يكون سلاحاً. بالنسبة إليّ ليس الشعر ولا يكون سلاحاً. واذا كان سلاحاً بَطُلَ أن يكون شعراً. يمكن الشعر أن يواجه على طريقته. هذا يعني أن يجد طريقته التي لا تشبه سواه. يمكن الشاعر أن يقول بإفصاحٍ أو بإلغاز، بمباشرة أو غير مباشرة، من بعيد أو من قريب، معاناته للخارج، لكن السياسة ليست خارجاً بحتاً. إنها في المكان نفسه الذي يسكن فيه سؤال الوجود. أنا بالطبع أستهجن أن نفصل بين الشعر والسياسة، لكنني لا أُلزم البتّة الشاعر بأن يكون سياسياً أو يعبّر عن معاناة سياسية.
ولكن ما يحدث اليوم أخطر بكثير. الشاعر (والمثقف عموماً) بات مطالباً بشكل ضاغط بأن يقول رأيه في الأنظمة، في التطرف الإسلامي المسلح، في داعش...
- أنا شخص يملك ماضياً سياسياً وتجربة سياسية، والسياسة كانت ولا تزال جزءاً من إرثي الروحي. وقد كتبت مقالات سياسية كانت ضريبة التزامي السياسي، لكني لا أجد قصائدي أو قصائد غيري بعيدة عن السياسة، ما دامت ثمرة الحرية، وما دامت تضمر دعوة الى الحرية، أو تبدأ من الحرية. لا يمكن الشعر بهذا المعنى أن يكون عبودياً. لستُ من القائلين بأن الفن تقدمي أياً كان وأين ما كان. أعرف أن مشاعر فاشية يمكن أن تنتج شعراً. أظن أن هناك شعراء فاشيين أو ينزعون إلى الفاشية. لست أُنكر هذا ولا أحاكمهم عليه. لم يعد إزرا باوند النازيَ القديم، إنه الآن من أمراء الشعر، ولم يعد سيلين أيضاً ذلك النازي، إنه من أمراء الرواية، ولا يسعنا أن نستمر في محاكمتهما إلى الأبد. لا تستطيع ان نأخذ هايدغر على أنه فقط مسايرةٌ للنازية. كذلك لا أريد أن أحاكم شاعراً على فاشيته إذا كانت هذه الفاشية حصيلة نعرة قومية أو طبقية لا يمكن تجنبها. الشعر أو الأدب بالنسبة إليّ مدينٌ للحرية. من هذه النقطة فقط، علينا أن نقبله أو نرفضه. أنا أحاكم الناس في السياسة سياسياً، ولكن لا أحاكم شعرهم. لا نستطيع أن نلقي بالشعر في سلة المهملات لمجرد أن صاحب الشعر لا تعجبنا سياسته أو مواقفه.
أخيراً، ماذا عن حضورك في الفايسبوك. هل تخفف اللايكات والتعليقات «حيرتك» تجاه شعرك؟
- تجربتي في الفايسبوك ليست تجربة مفصلية، فهو ليس جزءاً من يومياتي أو من علاقاتي. هو بالنسب إليّ استراحة فحسب. أنشر قصائدي أحياناً أو أتلقى لايكات وتعليقات بقدر كثير أو قليل، لكنني لا أعوّل كثيراً على ذلك. بين القصائد التي نشرتها على الفايسبوك هناك واحدة هي الأقل شعرية، وأكاد لا أعتبرها شعراً، وربما لن أعيد نشرها، هذه القصيدة حظيت بـ 21 share، أي إن 21 شخصاً نقلوها الى صفحتهم. مع ذلك لا أنكر تماماً أنني أتأثر بردود الأصدقاء على قصائدي. لا أريد أن أقول إن المسألة اجتماعية وإن هؤلاء «الأصدقاء» يعاملونني بلياقة ويجاملونني بلايكاتهم، فأغلبهم لا أعرفه شخصياً، لكنني لا أطمئن كثيراً لتقديرهم ولا أجده معياراً.
ماذا ستنشر بعد ديوانك الجديد؟ ستكمل عودتك إلى الشعر أم سترجع إلى الرواية؟
- لقد كتبت ديواناً آخر بعد الديوان الذي صدر، ولكن هناك رواية في رأسي. عودتي إلى الشعر أخّرتني عنها، ولكني الآن لن أتأخر في إنجازها.
هل ستحضر فيها أجزاء من سيرة ذاتية كما حدث سابقاً؟
- لا. بعد أن كتبت ثلاثة كتب مستقلة من سيرتي، وهي ليست اعترافات أو مذكرات وليست سيرة كاملة، بل محاولة انفصال عن حياتي وعن سيرتي، وكتابتها من الخارج وتحويلها إلى موضوع. كما لو أنها لا تخصّني. في روايتيّ الأخيرتين «ساعة التخلي» و«الشافيات»، خرجت من سيرتي. ما أفعله الآن هو أن أختار أحياناً أناساً أعرفهم. أن أستفيد من معرفتي بالحياة ومن خبراتي. أن أكتب الرواية بكل بساطة. أن لا يكون المقصود أن أُؤرّخ لنفسي، فأنا لم أفعل هذا حتى في كتبي ذات الأساس البيوغرافي. لقد تعاملتُ مع نفسي ومع حياتي كموضوع للكتابة.
تقصد أنك ستكتب روايتك الجديدة كما يفعل أي روائي؟
- نعم طبعاً، هذا ما أريده.
الاخبار – 12 -12- 2014