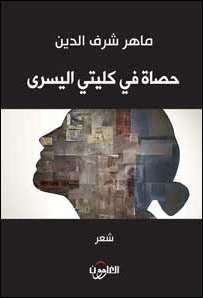 لم أقرأ له سوى ‘العروس′ وهذا الديوان ‘حصاةٌ في كليتي اليسرى’ بين كليهما بونٌ كما بين مجرّة ومجرّة. تباينٌ حدّ القطيعة، ما عدا انهما ينتميان إليه.
لم أقرأ له سوى ‘العروس′ وهذا الديوان ‘حصاةٌ في كليتي اليسرى’ بين كليهما بونٌ كما بين مجرّة ومجرّة. تباينٌ حدّ القطيعة، ما عدا انهما ينتميان إليه.
هنا في حصاته جرأة ٌلم نعهدها لدى شاعر عربي، وصراحة ٌعارية ٌمن كلّ ثياب، وخوض فيما لم نألفه. فلأول مرّة، في ظنّي، يُتصدّى لأفيون التقاليد ومحرّمات العرف الاجتماعي. هنا في ‘حصاة’ يتصيّدُ الشاعرُ ويلتقطُ ما وراء المخادع والغرف المغلقة، يفتحُ نافذته وستائره امام العيان. فاذا كان المكبوتُ موجوداً فلمَ النفاقُ والتسترُ عليه: ‘كآبةُ ما بعد الجنس لا تُشبهُها إلا كآبة ُ البقاء بعد موت الأصدقاء’ (ص 38). وثمة فقراتٌ قبلها لا أجرؤ على ذكرها. وليعتبرّني ماهرٌ جباناً ترتعد أمامه دمائي. وأصدقُ الشعر أكثره جرأةً.
في القصيدة الأولى (ص 11 35) فذلكةٌ ابداعية: قصة معاناة يحكيها شعرٌ، وأعذبُ ما في الحكاية تجسيدها ساعاتِ غياب واعيته اثناء العملية الجراحية. انه يعرّي لُغزاً فلسفياً عن الموت: ‘خمسُ ساعات وأنا غائبٌ، لكنّي لستُ في أيّ مكان… لا أحلام، لا ذاكرة، ولا أحاسيس… هذا هو الموتُ إذاً، أنت غائبٌ، لكنّك لستَ موجوداً في أيّ مكان’ (ص 34 35). هنا ثابتٌ جدليّ يُركّزُ على أن الموتَ نهاية ٌلا رجعة بعدها، لا افقَ، ولا ذاكرة. ولا مستقبل في انتظارك. فقد مررتُ بمثل هذه التجربة وغادرني الوعي ثلاث ساعات في آذار عام 2008، كنتُ إبانئذ ٍ موجوداً جسداً، غائباً واعية ًوذاكرة في كنف زمن منسي سديم. لكنّ ماهرشرف الدين رصد موته أو حلمه في سكون هبائه ومتاهه.
فلو كُتبتْ هذه القصيدة كما نكتب قصة لكانت إياها، كونها تنطوي على شروطها الفنيّة. لكنّ ما يضعها في خانة الشعر ِانطواؤها على لوحات صغيرة تشكّلُ بمجموعها قصيدة نثر متكاملة. ماهر شرف الدين في هذا الديوان، وكذا في ‘العروس′ يتمسّكُ باطار شاعري وغير شاعري، فلديه ما يُريدُ قوله، فليكنْ وعاؤه أيّ طرح كان: ‘أحبّها دون أن أفهمها، لأنّها بالنسبة اليّ موسيقى’ (ص 26).. ‘ثمّ عاد الى النوم كما يعودُ ميّتٌ الى الموت’ (ص 28). ‘أشعرُ بالخدر، خدر الاستسلام للماء الجاري، وأنا اخترقُ الممرّات، مستلقياً على سرير كالقارب’ (ص 32)… وما أكثر مَنْ يُؤخذون الى غرف العمليات، ويمرّون بذات التجربة، لكنّهم لم يُسجّلوا هذا الإنطباع الذاتي، فالألمُ يُنسيهم كلّ شيء. بينما التقط ماهر صورَ كائنات المساحة الممتدة ما بين رحلته من غرفته حتى غرفة العمليات بنفس شعري وفوتغرافي في آن ٍ.
أمّا قصائدُه التالية فانثيالاتٌ عاطفية مستغرقة في اللذة والألم والأمل والتأمل. اجتياحٌ لما هو طيّ المستور المُغلق المقبور بين الهواجس والمشاعر. لقد ازاح عن رؤانا الستائرَ والحُجب التي نختفي خلفها ونحتفي بتحقيق واشباع جوعنا العاطفي: ‘دمي عقودٌ حمراءُ، حجارة ٌ كريمة ٌ حمراء، إكمشي منها، وشكّي والبسي… لسوء حظي، لقد وقع النهرُ في البحر، وغرق كما يغرق الخاتم’ (ص 42).
ولدنُ ماهر الطوباوي المتمرّدِ العاشق المجنون الناسك الفوضوي الغائص في خضم الوضوح والغموض والتماهيات الجارية في الوعي واللاوعي قدرة ُ على التشبّث بما لا يُمكنُ الإمساكُ به وعيانه: ‘شعرتُ بأنّي دُرْجٌ قديم، أكثرُ ما يُمكنُ أن يجدوا فيه هو مفتاحٌ لباب بيت لم يعد موجوداً’ (ص 48). ولو تحرّى قاريء عن هذه العبارة لفُتحتْ له ابوابُ الحزن والخزي العربي منذ ولادته حتى ساعة افوله. فنحن في اوطاننا مواطنون بلا وطن. العربي وحدَه بلا مستقبل ٍ يحتضنُ رأسه. ولنسمعْ الى يأسه الذي يعبّرُ عنه: ‘أكثرُ ما يُؤلمني في غيابكِ…. هو هذا الشللُ الذي يُصابُ به بيتُنا، هو أنْ لا شيءَ يتحرّكُ حولي في غيابكِ’ (ص54). وقبل ذلك مرّ على سلة الغسيل الفارغة، والصحون المُتّسخة التي لا يُضافُ اليها صحنٌ آخرُ، والكراسي التي لا تتغيّرُ أمكنتُها. ولربما يمرّ قاريءٌ ما على هذه العبارات بهامشية لا واعية، على الرغم من أنّ فيها عمقاً جدليّاً ووجوديّاً وفيزيائيّاً تشي بتيه الآنسان العربي ومُكابداته اللامُنتهية واللامُنتمية الى أيّ وطن… ربعُ سكان الأوطان العربية مغتربون مشتتون في اصقاع المنافي، هربوا من فزع وجوع وملاحقة. فلمَ لا تكون اوطانُنا كسائر بلدان العالم الغربي؟.. وقد يبدو لقاريءٍ ما سؤالي هذا ساذجاً بدائيّاً، لكنّنا نظلُّ طوال سني أعمارنا نطرحُه بإلحاح. وأغلبنا يعرفُ الجواب ولا يستطيع اعلانه جهراً وصراحة.
مع ذلك ففي هذا الديوان أنفاسٌ شعرية تشفّ كالنسائم وتُلامس الذائقة: ‘يا إلهي، الأشجارُ نساءٌ’ (ص 56)… ‘الهواءُ يتعطّرُ كالنساء في هذه البلاد’ (ص 57)… ‘بلا انذار انتهى الخريفُ’ (ص 58)… ‘كالزنوج الذين بصَمْتِهم صنعوا سمعة امريكا’ (ص 59)… ‘في السرير، لا حاجة الى الصوت بين فم رجل واذن امرأة’ (ص 65).
ولئن كان اخذنا معه في اجوائه العبثية التي تلامسُ المُزاح وتقتربُ من الهذيان، الا أنه التقطُ أيضاً استثناءات فجائعية غريبة: ‘رأيتُه يسقطُ من الطابق المئة كما تسقطُ الدمعة ُ من العين/… ما زال يسقطُ حتى اليوم/… التقطتُه يدُ الكاميرا… لولا تلك اليد لكان الآن قد مات’ (عن 11 ايلول – ص 93، 94، 95). وبعيداً عن رصد الصور المحيطة بنا ومزاج العاطفة يبذل جهداً ابداعيّاً ومعرفياً ليدلنا على خلائق أخرى هي لوحاتٌ ملوّنة تُزيّنُ واجهة الزمن انطباعاً وتعبيراً. او عنواناتٌ مستقلة تمتح ُرواءَ تفرّدها: ‘الذين فكّروا في الحياة كما تُفكّرُ الأعشابُ في الشقوق’، ‘صفاءُ الدمع هو الأصل… أمّا المطرُ فببغاءُ’ (ص 100، 101)… ‘الصورُ مقابرُ أيضاً أيّها الجالسُ في الصورة’ (ص 104)… ‘وكي يعرفني يُضيءُ وجهي الشحيح ببعض السعادة’ (ص 110)… ‘هطلَ المطرُ على جسدي، وبدَلَ أن يُبلله بعثرَه’ (ص 115)… ‘الفراشة ُ وردةٌ أتعبها الوقوفُ’ (ص 122)… ‘يا عاصري العنبَ اعصروني معه’ (ص 124)… ‘في الهاوية لا معنى للمسافة’ (ص 126)… ‘الدموعُ منافقة: تسيلُ في الحزن وتسيلُ في الفرح’ (ص 127)… ‘أحلمُ بشباك اطلُّ منه على حياتي’ (ص 131)… ‘ليتني زجاجُ هذا الشباك فيأتي طفلٌ ويرميني بحجر’ (ص 107).
اخيراً ليست قراءةُ هذا الديوان عبوراً عبثيّا سهلاً نمرّ على كائناته بعشوائية وتسطح بل تكتنفه تضاريسُ وجع وساحات فرح وتحولات كما الفصول ُالأربعة تعرو القاريء وتهزّه. فقريحةُ ماهر شرف الدين لوّنتها بعصير ارهاصاته شعوراً ومشاهدة ًوذاكرة وفكراً وتأملاً بلغت حدّ الكونية والسريالية والرمزية المُغلقة على الرغم من تمظهر وضوحها. لكنّها مُتخمة بواقعية جارحة حتى حين يهزلُ ويمزح. انزياحه فجائعي ذو طبقات كما اللونُ الواحد يستحيلُ طبقة ً فطبقة. باهتة، شفيفة عاتمة عميقة. مزاجُه الشعري في ‘حصاة…’ متقلب كما مناخ سياسات أنظمة حكوماتنا وساستنا ومؤسساتنا العربية التي تفتقرالى افق. والأفق ُ الجدلي في شعره متفاوتٌ: نازلٌ وصاعدٌ، متعرّج ذو مطبّات عسيرة. ولا يخدَعنّكم هذا الإنزياح العاطفي. لقد كان قاسيّاً وجارحاً وصادقاً برغم عبثية الطرح. فاذا كان الشعراءُ يتبعهم الغاوون، فقد افلح في غوايتنا بمعرفية باذخة وايقاع شاعري رفيف وصدق لا يتوفّرّ لدى كلّ شاعر.حسبُه إنّ قصائده في هذا الديوان تمخر في ممرّات التنوع لا يعترفُ بالنمطية ولا يغترف منها…
وقبل أن أنهي انطباعي عن هذا الديوان شاركوني في قراءة هذه الفقرات: ‘يا امّي، لقد فجرّوا لي آخرَ ذكرى أحملها من مكان طفولتي’ (يتحدّثُ عن حصاة كليته) الألمُ قنفذٌ في الكلية… يتمرّغُ في الخاصرة’ (ص 11، 12)… ‘الذكرياتُ تعودُ آخرَ العمر كما تعود القطعانُ آخر النهار’ (ص 17)… ‘قبلَ اختراع الكاميرا، كيف كان الناسُ يتأكّدون بأنّ الذين ماتوا كانوا أحياء حقّاً؟’ (ص 104)… ‘وعُلقتِ الدلاءُ في عيوننا’ (ص 105)… ‘ولدتُ بلا حظ ّفي الحياة، ولم التق ِحظّاً ضلّ طريقه فآخذُه لنفسي’ (ص 109)… ‘ولأني أعلمُ أنْ لا أحدَ في انتظاري أتيتُ’ (ص 113)…
القدس العربي- May 16, 2013