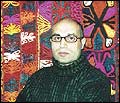 * لنستعر محمود درويش، فقد سماك مرة ديك الحي الفصيح، وأضاف بأنه لا يعرف متى يبدأ فيك الروائي السارد ومتى ينتهي الشاعر. هل تعرف أنت الحدود بين المكانين؟
* لنستعر محمود درويش، فقد سماك مرة ديك الحي الفصيح، وأضاف بأنه لا يعرف متى يبدأ فيك الروائي السارد ومتى ينتهي الشاعر. هل تعرف أنت الحدود بين المكانين؟
لي عينان تريان المشهد ذاته. الكثافات سرد، والظلال شعر في اختزال إشاراته. لا كثافة بلا ظل. لا ظل بلا كثافة. الكلمات، بقيامة واحدة، تحشر الموصوفات أمام ميزانها بلا تفصيل: ما يصلح للشعر في كفة منها يصلح للسرد أيضاً. أنا لا أصنف اللغة، في عرف إنشائي، طبقات ومراتب فأذل بعضها، وأكرم بعضها الآخر. هي نبؤة الخيال النهائية، وهدى ضلالها الطاهر. هدى نفسها في الإسراف خروجاً على أسر المعنى وقانونه. وفي هذا المتاح العميم من شساعتها أذهب إليها بجسد واحد، كثافة واحدة لها قوام ظلها: فيها لا أعرف حدوداً بين الشعري في مسالك وبين المسرد النثري تدويناً، حكياً. فأنا على نحو ما، أحرر الرواية من طابع الحكاية لتنقال إشارة، وفتنة إشارة، لتكون معرفة في مراتب الأحوال بسيطها ومركبها؛ لتأخذ بجواذبها ما تقدر على نهبه. وأمكن الشعر من ترتيب إيحاءاته، لا بانتخاب المختزل من نواظم الرؤى، وانكشاف البرازخ الأكثر خفاء في تجاوزات الألفاظ كعلائق خلخلة، بل بدفعه إلى امتحان أقصى بإيراده مورد النثر السارد ليفتنه، ويدفئه، ويصوغه بكمال الضلال في ذاته شعراً. هكذا يعود النثري إلى الشعري الذي هو خاصيته كسحر مذ كان الأزل ساحراً، والوجود ساحراً، والكائنات ساحرة بجلال نشوتها.
* في "الجندب الحديدي" كتبت "سيرة الطفولة"، وفي "هاته عالياً" كتبت "سيرة الصبا". لكن لابد من لحظة محورية ثالثة في تكوينك؛ متى تنطبع على الشريط الفوتوغرافي؟
الكتابة بعيني طفل معابثات غير جارحة، كما لو كانت الصور مجروحة، وممزقة. الشخوص التي خرجت في سطور السيرتين وقرأت أخبار نفسها، كانت عارفة أنها معفاة من مساءلة الأخلاق وقوانين العلاقات. هي شخوص كانت صغيرة في مملكة الحبر الذي دونت به الكلمات، ولا يطاولها الاقتصاص على الجناية، ولا تحاسب محاسبة البالغ. الكبار، أنفسهم، يجدون أعذاراً لوقائع تمس مقاماتهم، فالتدوين تدوين طفل لا يؤخذ حكمه على محمل الإفتاء. كلهم ضحكوا، كما قيل لي، إذ قرأوا (أو قرئ لهم) أنفسهم على النحو الذي ألبستهم قناع الحبر. لكنني إن أفتيت الآن، وجاهدت في إخراج الحيوات الممزقة إلى سردها سيرة، فسيكون لي حكم الريح على بيدر. وليس بي نزوع، على أية حال، إلى أن أكون مرشد القضاء إلى الأقدار، إنما ربة سائل يعترض ما أقول، مقترحاً تدوين مالا يعذب، أو يجرح، أو يخذل، أو يفضح، أو يطعن، أو يفصح، أو ينكأ ما التأم، أو يعير، أو يكشف، فأضع تدوينا بالصفح عن عثرات الآدميين، وستر عيوب، وحفظ عورات، وتفاض عن التنكيل بالحياة، مع إيثار السلامة في المرور بين حطام العلاقات. لربما أمكن وضع سيرة ثالثة نصفها بهاء في بلاغة أشيائنا الصغيرة، وقبلنا الصغيرة، وأسفارنا، وجيراننا الطيبين والمزعجين لكنها ستكون، قطعاً، تزويراً في جانب ما. الجارح، المغتصب، الحماقة، السري، العاصف، هي وحدها شؤون تليق بقيادة السيرة؛ فعلى من سأقوض الهيكل؟
* اليوم، ونحن نرى أن ما يسمى بالأدب السائد يشبه آلة كسولة تبذل جهداً جباراً لكي تملأ فراغات ما قيل. ونرى أن الكثير من النتاج العربي الحالي لم يخرج من حدائق حيواناته إلا نادراً (ظروف قاهرة للغاية في الوقت الذي تقدم فيه نماذج الإبداعية الشعرية لتعارض الإفادة المعلنة للشعر، والصادرة عن المراجع الرسمية للكلام). قصائدك تشحن الكتابة بسؤال يصرخ: الآن هذا يكفي، فقد نال الشعر حصته من الصدأ. ما رأيك؟
حين اجتهد الخيال الشعري في خمسينيات هذا القرن، وستيناته، للخروج من نمطية الإنشاء المتشابه للقصيدة العربية، اتخذ سنداً لدعواه أنه سيرفد الشعر بعلوم أكثر جسامة من أن تقدر النواظم الرتيبة على اكتناهها؛ على القصيدة أن تكون ثقافة الجهات؛ وعيها؛ انعتاقها من ثورية الخصائص المستنسخة.
عاش هذا الخيال الشعري، الحسن النية، عقداً ونصف عقد لا غير. من الستينات إلى أوائل السبعينات، ثم انحدرت القصيدة "الغضة الإهاب" إلى فوضى، ثم صارت الفوضى ذاتها نمطاً، لها خصائصها التي يمكن ترتيبها، وتوبيبها كما كانت تبوب "أغراض" الشعر المنظوم: الركاكة. البناء على فراغ. الجهل باللغة كلياً. استحسان القطيعة مع قواعد التدوين. الترفع العميم للجهالة عن تراث الماضي، من غير تحصيل لتراث الحاضر. التجرؤ على الخفة. ولهذه السخرية من جلال الشعر أسباب، في أساسها "موت النقد الأدبي"، بعد موجة هبوب أموال النفط العربي، قبل أواسط السبعينات بقليل، فتكاثرت الصحف، والمجلات الدعائية للأنظمة. وفي هذه الكثرة من الأوراق المطبوعة بحبر مدفوع الثمن بسخاء، بات تقليد وجود صفحات ثقافية أمراً على صخب في شيوعه. وجرى توظيف عاملين فيها بلا اختصاص، بل من باب إسناد الوظيفة إلى "نشيط" في جمع ما يقدر به على ملء صفحاته المتسعة عرضاً وطولاً.
قتل التقويم، قتل الانتخاب المصاحب بوعي نقدي. قتل الاختيار بالتفصيل. أميون في القراءة تداعوا إلى تزوير الذائقة بانطباعات تصلح في لغة التعميم الكسولة على كل نص.
كان ثمة مجلات قليلة جداً، قبل هذا الباء، بمهمة "ترشيد" الذائقة بقدر معقول من الصرامة في اختيار النصوص. وكان يقوم على الصحف القليلة أدباء مختصون في مذاهبهم، ما كان يجرؤ المبتدؤن في علوم النصوص أن يحملوها إليهم بالثقة التي يفعلونها الآن، تبعثر النقاد العارفون بآلات لغتهم. انحسروا وذابوا في الحشد المتقدم إلى الحلبة، ساذجين ينقدون الشعر بلا معرفة في العروض، وينقدون اللغة بلا فهم في الإعراب، وأما الفقه فهو لفظ من علم مقفل.
* كيف، إذاً، سيميز "الخبراء الجدد في الركاكة" هؤلاء أن شخصاً ما ينحو إلى ابتكار في علامات اللغة وعلاقاتها؟ كيف سيعرفون أن هذا يخطئ في العروض، وذاك يخضع المجزوءات لفتوح في الأوزان؟
كيف سيعرفون اختلافات البناء اللغوي بين واحد وآخر؟ ومع ذلك هم "نقاد" الذائقة الشعرية الراهنة، و"مسوقو" الجهالات.
في كل عصر، قطعاً، يتكرر المشهد ذاته، بصورة أو بأخرى، فيكون الجيد الحقيقي نادراً، والنمطي المتوارث سائداً. غير أن الجهل في تصنيف النصوص، راهناً، فاق كل جهالة. إذ بات النشر في المنابر متاحاً بتساهل القائمين عليها في إفراط ما بعده إفراط، وباتت علاقات الشاعر الركيك الشخصية على سعة تؤهل لكتابه المهلهل مقالات لا تحصى في إفراط عافية نصه.
فوضى يصححها، من وقت إلى آخر، قارئ حقيقي، مجهول، لا يشتغل في تدوين مدائح معلنة في الصحائف، يبارك روحك بعناء قراءته الخالقة لنصك المتعطش إليه.
* في ديوانك الأخير "طيش الياقوت" تبدأ "بتصانيف النهب"، ونقرأ حوارات مع الموت بلغة المتخيل، كأن الموت هو الفعل، أو هو الحضور الذي نقيم فيه. هذا هو الحيز لا الإطار، الشاقول الذي يعتمده أفق النص. هل لأن المنظر لم يتغير؟ أم أن خيالنا مازال مليئاً بطواحين وهمية، وديكة مدجنة، ومازلنا في المنظر التجريدي نشبه تمثالاً منكسر العنق؟
الجسد هو الذي يصنع الموت. بعطالته تيدأ آلته الخفية في اختراع ما ندعوه موتاً. الموت ليس المجهول الجاثم هناك، في غيبه. ليس ذلك الصقيع المنتظر القادم إليك. هو أسيرك؛ أسير خلاياك. تلده في هايتك التي تهديه إلى يقينه. وجوده أن تكون حاصلاً موجوداً. بلا كونك لا يكون. حياتك تمرين على تأهيل الموت كي يخرج معافى إلى المشيئة. الموت هو أنت مذ ظهرت مرتدياً قناع الحي. ولأن الواحد الآدمي يستقصي ذاته، عادة، في علاقاته المتعددة بالكائنات، أحياء وجمادا، كي يتعرف إلى خاصية نفسه ومرتبتها، فإنما يتعرف ـ بالضرورة ـ إلى خاصية الموت الذي هو كيانه أيضاً.
الحديقة الشارع. الشاحنة. الغبار. العبث. اليقين. البسيط. الطبع. الصديقة. الصديق. الأنيس. الأرض. الله. اللامعقول. الشفافة. النور. الظلام: كلها جزئيات ذاتك الواحدة. وأنا إذ أحاور الموت في جزئيات هي نسبة إلى وجودي؛ بل أحاور ذاتي وقد وزعتها في أشياء، وخلائق، مزمعاً أن أستردها في سياق قيامتها ـ أعني اللغة.
* في أغلب نصوصك الشعرية تتواقع كلمات مثل "الفحل"، "الوعل"، الوشق"، التي تذكرنا بمفهوم "الحرية" و"الوحشية" و"الضراوة". أما سمات اللغة الدلالية لديك فهي تذكرنا بمفهوم "الترويض"، أو "الحذق". ألا تعتقد معنا أن النموذج الدلالي (الصياد)، الذي اقترحته في مجموعتك "البازيار" هو الذي تنسج حوله أغلب أعمالك؟
ربما، لقد اخترتما ألفاظاً تدل على الحيوان، الذي هو في صلب خيالي الجاثم بين الكلمات. ولطالما ذهبت إلى أن الحيوان (في مقالات كثيرة وأحاديث) هو حرية، بتماهيه المطلق مع الغريزي. قوانين صغيرة للضرورات، ثم لاشيء آخر. إنه معفى من مساءلة نفسه ومساءلة الآخر. ساهر على الرغبة، لا على غيرها. طليق كخياله المشرف على جهالة الوجود النبيلة، وعيه أن يكون وفياً لحضوره المنبثق أعجم بين الكائنات. الطبيعة تلتقي نفسها نختزله في وفائه للعدم. قادم من الفكرة عمياء. عبور بلا صخب، أو رثاء، أو ندم. بلا أمل بلا يأس. هو السهو الذي انبثق خارج فكر العقاب والثواب، سهو صحيح، ممتلئ بعافية الدور الأعمى، الأكثر جمالا. الحيوان هو اللادنس.
ينبغي أخذ مفهوم "الترويض" على نحو آخر أجده في كلمة "استنطاق". أنا لأريد ترويض الوحشي النبيل، بل استنطاق الماهيات. إنه معنى آخر للقنص، أقرب إلى "استحواذ" الساحر على الخاصيات و"البازيار"، عندي" أخصه بمعنى تأويلي، لكن مشهد الطبيعة، الذي أفتحه على مصراعيه أمام البازي القناص قد يوحي بغلبة الجنوح الحسي، بسبب التصوير الحسي، دلالة. والتدقيق يصحح هذا الفهم.
* قصيدتك "مهاباد" ذات طبيعة حديثة (وقائعية)، وبالرغم من رؤيتك الدلالية في هذه القصيدة فإنها تحمل دلالة أيديولوجية تحيلنا إلى طبيعة المكان المتخيل، مكان تقصي الزمني والفكري، وتحتفظ بالمكاني، وبسبب من هذا تظهر لنا ما كان مستتراً، المكان ـ مهاباد.
أظن أن ثمة التباسات في هذا السؤال. فأنا لم أتخيل مكانا يخص دلالة اللفظ في "مهاباد"، التي سميت جمهورية كردية بهذا الاسم، في العقد الرابع من هذا القرن. ووقائع ظهور هذه الجمهورية، والقضاء عليها بعد عدة عشرات من الأيام على قيامها، فيها مفارقات تخص الروح الكردية. استعرت الاسم، لا غير، في وقت ذبح فيه أكراد بالجملة كيماويا. كانت حدثا، نعم. لكنني بنيت السياق على محايثة وقائع أولمبياد جرت تلك السنة. حتى أنني أهديت القصيدة إلى "أولمبياد الله"، ذلك القدر الذي سيؤكد شقاء العداء الخاسر بين أقرانه اللاعبين، قدر من الركض اللاهث في حلبة لا حدود لدائرتها. كردي منذور (بلا أي ملمح إيديولوجي في إنشاء القصيدة) للعبة كلها أمام حكام أصدروا أحكاما قبل أن يبدأ. إنني أقدم "خطة" منطقية في تفسيراتي هذه، والقصيدة أبعدها تكون عن ذلك. إنها وقائع عذابات مجنحة.
* يلاحظ أن أغلب نصوصك الشعرية تجد أساسها في مفهوم التأويل، وأنك توحد بين سيمياء الأرموزة وسيماء النص. هل مازلت تشتغل على متابعة هذا الخطاب والسير فيه؟
قصيدتي مبنية على جموح الوفرة خيالا، وللنقد أن يجد طريقه إليها بخاصية التأويل، وهي الخاصية المرادفة لقراءات "النص السحري"، الذي يباشر مثولة لغة من سديم المعنى: أنا والكون في مجابهة لاستدراج الملغز، المحير، المشكل، المتنافر، الضاري، الهادئ، والخارق. ضرورات من نوع آخر تستولد للألفاظ علائقها، وللمعاني الشبهات. لا يقين. ذهول الكينونة يعصف بآلات العقل ذي النازع القانوني. القصيدة هناك، في قدمها، وأنا راوية القضاء الشارد.
* عناوين مجاميعك الشعرية (وحتى رواياتك) عبارة عن صور مؤولة. إنها أشبه بالبيان الذهني الموصوف بحواس جلية. كيف يهتدي بركات إلى العنوان؟
حقاً، العنوان ـ نفسه ـ مسألة غامضة. قد يصلح هذا العنوان لكتاب ما، وقد يصلح له عنوان آخر. كلنا يقلب جملة من مفاتيحه على باب النص. واحد منها يماثل قفل الرؤيا. واحد هو خيارك المطمئن، خطأ أو صوابا، إلى أنك استوفيت السهم اندفاعا إلى صميم حبرك.
يختلف "شقاء" اختيار الاسم المؤكد لوليدك الورقي بين الشعر والرواية. الرواية بزوغ متجانس للبهاء وللأنقاض معا. حدود وتخوم ترصدها بمنظار المساح، وتحدد الحروف الضرورية لقياس ما يكفيها من غطاء الليل. الأشعار المجموعة رزمة هي التي تحير: كيف تسمي فضاء سديمك الشاسع برق واحد؟ قد تكون المسألة، في الكتاب الشعري ما تشاء، ببلاغة أقل أو أكثر؛ بتورية أو بتصريح.
لا. أؤمن، بزعم شخصي لا يلزم غيري، أن السديم الصاخب، الهاذي، الجامع، اللامتقيد، ينتظمه حبر واحد يصاح فيه اختيار للون. عناوين مجموعاتي هي ألوانها.
* قصيدتك.. "حقل معجمي"، وهناك من يعتقد أن سليم بركات يكثر من استخدام البلاغة. والشعر العربي، طوال تاريخه، أثقلته البلاغة. وعلينا الآن أن نخلصه من تلك الصفة. كيف ترد على هذه الإدعاءات؟
هاأنتما تسميانها ادعاءات. هي كذلك. غير أنني أود التوضيح.
شعري آت من قواعد اللغة، ودربة الألفاظ، ومناهج البيان التي توصف حمائل لتدبير القول الشعري.
هي قوانين للتشييد عليها من غير تماثل مع بناء أحد. حين تتماثل تصير نمطيا. وحين تكرر المعطى تلغي ذاتك في المشاع من اللاقول.
إذا كان علي أن أتخلى عن البلاغة، فالأجدى التخلي عن اللغة كلها، لأنها مفردات متوارثاة من سلف إلى خلف. لكننا، قطعاً، نستطيع السير إلى متاهة الشعر الرحيمة بما نستحدثه من علائق بين الألفاظ المتوارثة ذاتها. نجلس كل كلمة مجلسا آخر في فسطاط المعنى. وما نفصله بالألفاظ يستولد بلاغة "ثانية" على قدر ما نحرر اللفظ من عبودية استخدامه الأحادي في سياق طويل من الإرث.
كان الرواد الكبار، من ويتمان إلى سان جون بيرس، وإليوت (باعتذار من الحصر) تقاس "فتوحهم" اللغوية بالمقدار الذي يعيدون إلى كلمات "مهملة، و"وحشية" وغير مطروقة،ألقا حيا في سياق حي من مهاراتهم. العرب "الراهنون" يجدون في "الوحشي" و"المهمل" و" الغريب" دنسا لا تقربه "الحداثة الطاهرة(!!!!). من أين تقدر لغة "هاربة" من ماضي خيالها أن تصنع مستقبلا للغة بوحشيتها وأليفها؛ مهملها ومطروقها؛ غريبها وأنيسها؟ لغة "المحدثين" تتهرأ في نمطية التكرر الميت بلا خيال، بلا أمل في توليد ما يحييها. شعر مستنسخ، متطابق، فقير اللفظ إلى درجة الترحم على أي رومنسي عربي. يتباهون باطلاعهم على "ثراء" الشاعر الغربي من غير نظر إلى العناء المبذول لحفظ ذلك الثراء لغة، وسهرا على لغة وبيانها.
نكتب بالعربية، وللعربية أصول. نمشي بأقدام يتعدد بها مقع الخطو، وطرائق المشي والرقص، لكنها أقدام لا خراطيم. احذر اللغة تحذرك. استهن بها تستهن بك. والبلاغة بوصلة لغتك إلى جسارتها.
سأبقى مع هذه البلاغة كي يعرف حاضر لغتي أنه حاضر يليه حاضر آخر هو مستقبله. إنه سعي في إجلال الشعر، الذي قوامه اللغة المتسعة، والبلاغة الطاهية.
* في الفلسفة نظرية تقول بأخوة كل الكائنات، ونلاحظ في أغلب نصوصك الشعرية صلات روحية ومادية بين الكائنات، والحيوانات، والمعادن، والأحجار، وحتى الكتبة. كيف تخلق هذا التجمع السوسيولوجي المليء بالتوافقات تماما مثل علامات الفلك، أو الأبراج، حتى أن نصوصك الشعرية تشبه العرافة. هل الشعر بالنسبة إليك هو فن التخمين، أم هو وسيلة للاتصال مع ماوراء المصير؟
الشعر، كما يقول أسلاف، هو الحقل الذي تنمو فيه كل معرفة. و"حقل" بهذا الاتساع لن يكون، قطعاً، إلا كون الكون، وقد تدبرت فيه أفلاك وأبراج، ومعارج وبرازخ، وأجرام وشفافات، ومغاليق وآفاق وراء المغاليق، وانكشافات، وانخطافات، وجواذب ونوابذ، وهرطقات سديم ومجون نواظم. الشعر هو لغة الذهول الأول الذي اعترى الحضورات مبصرة نفسها في بذخ الظاهر؛ هو رنين الحدوث الغامض للنشآت؛ هو التدوين الهاذي لابنلاج الكون الصاعق من عدمه.
كل شيء، في نظر الشعر، سحري على مبدأ السر الذي فيه. كل شيء حلقة في الصيرورات المستبطنة بزوغها اللامعقول. هو ليس فن التخمين، لأن التخمين ذاته يتوسل العلوم كي يستجلي المخمن. وهو ليس اتصال مع الماوراء كونه لغة الماوراء وقد صار حادثا.
الشعر امتنان اللانهاية لفراغها الذي هو أشكال متناظرة في الوجود المتناظر لمقاديرنا وأقدارنا. الكل يعبر الكل وينمو به. يسمي بعض الخاصة هذا القيام بالحق "وحدة وجود"، فيما الأرجح أنه "وحدة السر".
* الشعرية العربية، اليوم، هي شعرية مبتورة. إنها تعيش في بيئة مستغلة عليها، ومهما تضطلع في المعرفة فستبقى على الدوام تائهة. فثمة فجوة سحيقة مستحيل عبورها. لقد استنزف نسغ البعد التاريخي الذي كلن يغذي معرفتها، واشتدت وطأة العزلة عليها من قبل المغلق الممثل بالرقابة السياسية، تلك التي لا تثق بأعضائها، وتعادي الاختلاف. كيف تتخلص ـ برأيك ـ الشعري العربية المعاصرة من مأساة كهذه؟
قد استطيع تشخيص الشعر، بقدر كثير أو قليل، مقنع أو غير مقنع؛ وتبيان مزالقه، ونواقصه، وهناته، ومأزقه، على هذا النحو أو ذاك، أما "الشعرية" فهي خاصية انتخاب "الشعري" ذوقا، وقوام هيكل الناظم اللغوي للأحاسيس. أن تعيش في بيئة مغلقة أو مفتوحة، بسند معرفي كبير أو صغير، تلك ليست مشكلتها، بل مشكلة "الموهبة" في الاقتدار على ترميم السحر المتقوض في الواقع؛ في الاقتدار على تدبير الشفاعة اللغوية للروح.
الخلل الذي يصيب قدر الشعر هو ذاته الذي يجرف "الشعرية": شعر مطحون بنواقصه يعني شعرية مطحونة. شعر معافى باشتغاله على القوي في ملكاته يعني شعرية معافاة.
* الرواية عندك أعقد من القصيدة، وأغنى بالمسائل سيميائيا. ومع ذلك نلاحظ في السنوات الأخيرة أنك أوسع نتاجا في الرواية من الشعر. لماذا؟
لم يكن اشتغالي، وأنا في الثانية والثلاثين، على الرواية، قياما بنزهة "تجريب". وأنا، مذ ذاك، أنجز عملا واحدا كل سنتين، بدأت كدأب الساعة، بلا انقطاع؛ بلا استراحة؛ لقد استدرج أحدنا الآخر (أنا والرواية) إلى حيلته.
أعني أنني، في اليوم الأول لجلوسي إلى ورقة بيضاء كي أكتب الرواية، قررت خوضها بجسارة اليائس من واقع الرواية، بجسارة الأمل في تدوين ذاتي على مقام سطر مختلف في علوم الكتابة، بلا حذر من أن أستنهض كل شيء، وأستنفر كل آلة.
لك أكتب الرواية لأستميل قارئا إلى "مقدرة" إضافية بعد سخاء الشعر المؤلم. كنت أحادث نفسي كالتالي/ "في ختام كل رواية أنجزها سأقول لي/ هالقد قرأت رواية". أكتب كي أنتهي منها فأعرف أنني قرأت. رواياتي صعبة: أعرف ذلك. فسيفساء مدروسة: أعرف ذلك. متقاطعة الوقائع كلعبة بلا ميثاق: أعرف ذلك. يحضر الشعر فيها مستأنسا بمقعده كاستئناس النثر. مصائر إشكالية: تلك هي جسارتي.
لا أبدأ رواية بلا إشكال. الحياة إشكال. الأمل إشكال كاليأس. الحضور والغياب إشكالان. أمتحن الواقعة لتمتحن الواقعة دربتي في الوصول إلى مخرج. أحيانا يقع كلانا في المتاهة. ليكن. لو رغبت في سهل من السرد، وحيوات مبذولة في الشارع، كنت فتحت على نفسي، في الواقع الضحل للرواية العربية المحطمة الخيال والإشكال، سخاء من المديح والترجمة، تحديدا. أنا صعب، قدري صعب، وكتابتي اشتغال قدري علي واشتغالي على قدري.
* يرى البعض أن سليم بركات حين يكتب يحكم بنيته الروائية، ويسبك الغسق، ويحترز أن يجعل العالم في رق، ويلويه ليا قويا حتى يخرج التاريخ من مسام الرق. وغالبا يستعمل ما يستعمله البناؤون من دهان المعنى ولقاح الصورة. هل حقا من هذه الزاوية تتأمل طبيعة الكون وتسترد هباته؟
لم ألتقط تماما قصد هذا السؤال. أأنا أقسر الرواية على استيلاد التأريخ؟ كل رواية، بإطلاق، هي تأريخ "للداخل" و" الخارج". التأريخ قوام جوهرها.
* "بيكاس" بطل روايتك "فقهاء الظلام"، والذي يعني في اللغة الكردية "الوحيد" أو "الغريب"، من أين جئت بهذه الشخصية؟ وما هو طابعها المنسوب إليها؟ وهل كانت هذه الشخصية ترفض تبادل المواقع مع الشخصيات المحيطة بها، في رمزها وواقعها، أم هي بعيدة عن كل بطولة، أو قريبة من بطولة مغيبة في مغارة لا تستطيع عظاية الواقع أن تدلنا عليها؛ مغيبة في الداخل، ساكنة في التهميش، مرسلة نظرات لا مبالية للراوي الذي يوتر قوسه ليرمينا به؟
قلت أنني لا أبدأ رواية من غير إشكال. وبيكاس هو "إشكال قدري" بامتياز. كل الذين من حوله يجاهدون في تقديم برهان على حقيقته. حضوره مأزق للمنطق. غامض يصير أليفا غامضا. لامعقول يصير معقولا بتبريرات ينسجها المحيطون به ليقتنعوا، سأشرح الأمر قليلا، وأعود إلى بيكاس:
لكل وجود مأزقه وإشكاله. الوجود الكردي يشكل إسهاما مضاعفا في هذا الإشكال، قلت لمعلم اللغة العربية إنني كردي فحملق في هلعا، ودمدم: "ماذا تفعل هنا؟ إذهب إلى تركيا". عليك أن تتعلم كتمان أنك أنت. البعض يلد ويكبر، ويهرم، في المكان ذاته محتجب الجنسية. عليك أن تحمل معك ورقة "إخراج قيد" مكتوب على قفاها "منذ متى أنت عربي؟" للتأكد من نقاء عرقك. لا تستطيع التصريح بحبك لبلدك، مثلا، من غير أن تكون عربيا. اسمك غير العربي، إذا تجرأت على تسمية نفسك بألفاعرقك، سيصمك بالإذلال. صبي اسمه "برزان" طرد من الصف الثالث الابتدائي. بيكاس تيلو، شاب يعيش متزوجا في قبرص. تدبر أوراقا مزورة، في مطلع شبابه، واستقل حلمه إلى موسكو. درس وتخرج. ثم ماذا؟ تدبرت له زوجته القبرصية دخولا مشروعا، بلا أوراق ثبوتية، إلى بلدها. يعيش هنا على نداء القلق: كل صاحب عمل يطلب منه جواز سفر. ليس عنده جواز سفر. سوري بلا جنسية. في ورقة إخراج القيد الوحيدة التي يملكها أنه من فئة "غير المسجل" كلمات غامضة. بشرح للقبارصة أن جنسيته "مطعون في أمرها" فلا يفهمون. حاول تدبير ورقة ما من سفارة سورية لزيارة أهله فصعقوا: " كيف خرجت من سورية؟". ليس له حق خروج. إذا، ليس له حق دخول.
تجتمع أعراق متنافرة في بلد واحد، مثل الولايات الأمريكية، فتجني لنفسها خصائص انتماء إلى الموقع قانونا. أعراق جاءت من بلاد أخرى قبل قرون قليلة لتؤسس لنفسها خصيصة الجماعة الواحدة، المختلفة الهويات، "المحترمة" كيانا (مع الصفح عن إبادة الهنود). مجرمون، محكومون، سجناء أفظاظ، غير مرغوب فيهم، منفيون، يلقى بهم على شواطئ استراليا، فيعترف لهم الزمن، حالا بعد حال، "بإنجاب" تأريخ متجانس النعمة تحت سقف الدولة. الكردي؟؟؟ تاريخ، وأحقاب، ومواريث في المكان الواحد، لا تشفع له إلا "بوجود إشكالي" هكذا ولد بيكاس في "فقهاء الظلام": القدر يحمل إلى عائلة حيرة الكون وذهوله. طفل يلد ويكبر ويستولد ويختفي في يوم واحد محسوب بساعات الإنسان. في كل مرحلة من نموه إشكال على أهله أن يستسلموا له، وأن يؤكدوه كجزء من قدر عادي.
بالطبع، ليس صوابا اختزال بيكاس على هذا النحو. فهو رديف العبث في المعرفة أيضا، والحقيقي الذي ينقلب لا معقولا، وصورة أعماق علاقتها بالخرافة ترسم سلوكا في الواقع. وهذه الأمور الثلاث تدفع صوغ المعنى في بيكاس أبعد سياقه الكردي الذي أوردته فيه.
إنه المعرفة الشيقة، المعذبة والمعذبة في آن واحد.
* روايتك "أرواح هندسية" هي شبكة نصية، حيث تصبح الشخصيات والأفعال والعبارات المكتوبة لغايات تواصلية، مفتوحة، بالإضافة إلى الأفعال التي تحث عليها، عناصر في نسيج سيمائي، حيث بمقدور العناصر أن تؤول عناصر أخرى. كيف يحقق سليم بركات تلك الأرموزة المجازية؟
كيف نستطيع نقل واقع شديد الهذيان، والجنون، والمفارقة، والعبث، واللامعقول، إلى الكتابة؟ لا يمكن ذلك بالتأكيد. الحرب اللبنانية كانت أكبر من جنون كل نص. كانت خيالا يبتكر كل يوم جموحا يضيفه إلى جموحه باستيلاد تفاصيل شيطانية للقتل. قلت سأجردها من صفة المكان، وأصعد بها إلى "تعميم" يصلح لحال كل حرب ماضية وآتية. مهمة مفرطة في طموحها لا أعرف ما الذي أنجزته منها.
اسمان فقط في الرواية: اسم شخص له أول حرف في الهجاء، يضافا إلى نسب هو الزمن الأشمل المشوب بصفة الخالد؛ واسم عمارة استعرته من آلة وقد النار. (وفي الاسمين إمكانات تأويل أبعد، لا أجد أن من مهمتي الإشارة إلى بعضها). أيام مفقودة من سياقها المحسوب في التقويم الشهري. سفن ذاهبة في اتجاه كأنها عائدة منه. رجال غيبيون يرتبون مصيرا أشكل عليهم ترتيبه. لم أعد أتذكر تفاصيل ذلك العمل المهموم، الذي كتبت فصوله بجملة تبدأ من أول سطر فيها فلا تتوقف إلا في نهايات. لكنني عدت مضطرا (متنازلا) إلى تقسيم الكتابة إلى فقرات عادية، كل فقرة بضعة أسطر لها بداية ونهاية، ثم تبدأ بعدها فقرة أخرى، بعدما كانت استرسالا متلاحقا يقطع الأنفاس كالحرب ذاتها. خشيت أن لا يتمكن القارئ من المتابعة في ذلك الهدير.
هي رواية هندسية، حقا، كعنوانها. لذلك تتقابل عناصرها كما في مرآة، وتتوازى الوقائع. المصائر بحسب ما هي عليه، وما كانت عليه، وما ستكون عليه. الغيب، نفسه، يبحث في حطام الواقع عن برهان يؤكد به أنه هو الغيب.
إنها من أعقد رواياتي في الأرجح، ويحبها المقامرون.
بنية الحدث في رواية "الريش" هي بنية مركبة، تحددها رغبة قوية في تحطيم تقاليد السرد التي اعتادها القارئ، كأنك تمسك بخيوط مغزل لا يشاهده القارئ لكي ينسج الأخير تصوره الوهمي في الفصل الأول من الرواية... ذلك التصور، الذي يتخيله الكاتب في الفصل ليجد القارئ نفسه إزاء متاهة جديدة، كأنك تضع مخاضك ولا تخبرنا عن الفرق بين الزائف والحقيقي، بل تدخل معنا في حقول اللغز لتجمع وإيانا فخاخ المعنى.
قد يكون ذلك صحيحا. فأنا عمدت، مثلا، في سياق تقانة السرد، أن أحرر كل شيء من الدليل عليه بعبارات الرواية وبصره: النبات يحاور النبات. الطيور تحاور الطيور. الأشياء تحاور الأشياء. العناصر حية ناطقة، تخلق لنفسها الحيز الذي تختاره من السياق. المكان مفكرا، شريكا في تدبير اللعبة، هو حاصل النص.
هنالك، خارج السرد ذاته، إشكال يخص حضور "مم آزاد": هل جاء إلى قبرص حقا يبحث فيها عن "الرجل الكبير"، الذي سيرتب قدره مع يقينه، أم أن ما جرى له في قبرص هو حلم من أحلام أخيه التوأم "دينو"؟ إنه هنا وهناك. جاء ولم يجيء. بحثه في اليقين كبحث أبيه عن أشباح تتسلم رسائله المرسلة إلى "مهاباد" الضائعة المفقودة. انتظاره انتظار أبيه. يغدو حرا، باذخ الوجود، إذ ينتحل، في صقع خفي من أصقاع أعماقه، شكل الحيوان رشيقا طليقا في الحدود الممنوعة على الكردي.
على القارئ، نفسه، أن ينتحل كيانا آخر، حيوانيا، كي يخرج إلى حقول "الريش".
* في روايتك "معسكرات الأبد" يواجهنا سؤال الإرادة المختمر في بطن الزلزال، سؤال الوجود الذي يصوغ شكله المادي لنجد أنفسنا إزاء ميثولوجيا شخصية، وسردية، تطردها بشكل أقرب ما يكون إلى البعد العمودي والمتوحد للفكر، وتكون علاقتها بالميثولوجيا وليس بالتاريخ. وبالهدوء الذي يتقن الترويج عن العويل تنقلنا إلى ميثولوجيا عن الميثولوجيا؛ تنقلنا إلى الكتابة الجوهرية، التي تحيل الأبنية الشامخة والقديمة إلى دهاليز مظلمة تقودنا، في الأخير، إلى هذا الجديد، إلى المتحدي، إلى الكتابة الرهان. كيف يؤسس سليم بركات هذا القدر المفتضح بكلمات يعمق حفرها على صلصال الأرض المهيأ لأزاميل العبث؟
أربعة صياغات للقدر تتساوى في هذه الرواية الأثيرة على قلبي: حياة عائلة عادية على هضبة يتبدى دخول الآلة الصناعية إليها كظهور الخارق؛ التاريخ الذي أقصى الأكراد، واستثنوا، من شراكتهم في صنعه؛ الأحياء في نظر الموتى؛ الشيطان. وقد صهرتها جميعا في كثافة واحدة، ملتحمة، يفتتح النظر إليها عراك ديكين عراكا قدريا من الأزل إلى الأبد، منضدة في لغة تحفظ لكل مرتبة حظها من مطارحات القول.
أقدار متعددة لهضبة واحدة يصعد إليها الفرنسيون، والملائكة لتي تتحرى عن المخلوق المختبئ في مكان ما، والمقتولون، وأشباح قواد الثورة الكردية ضد الفرنسيين، وفيها وقائع حقيقية، استقيت معلوماتها من شيوخ أحياء بعد، لم يأت التاريخ المدون، الملقى بين أيدي طلبة المدارس، على حرف منها، فيما وزع كرامات الوطنية محاصصة على طوائف ثلاث: ثورة في منطقة سنية وأخرى درزية وثالثة علوية أي أن التقسيم "العادل"، "المنصف" لم ينظر إلى الدولة، في أصلها، ككيان واحد، تجمعها "ثورة" منتمين إليها بحسب "وطني" لا غير، بل "أقر" بالتوزنات الطائفية في احتساب "الشرع" المكاني، وهو ما يجري تدريسه علنا، فيما لم تدون أسماء قادة "ثورة عامودا" الكردية حتى ضمن "السياق السني".
هذا استرسال خفيف رأيت توضيح أسبابه. أما الجانب الميثولوجي في "معسكرات الأبد"، والماورائي أيضا، فمرده إلى أسئلة وجودنا عن نشآتها، وألغازها الطاهرة، وعن الصوغ الديني في الجبر والقدر، والخير والشر، والحقيقة والوهم، إلى آخر ذلك من المتقابلات المتضادة في ترتيب "الغيب" للمعرفة، وتأسيس الحضور على مبدأي الثواب والعقاب.
لا أريد أن أصف شيطان "معسكرات الأبد". هو، نفسه، قدر المياه التي وصفت نقيضا لكيانه، وكانت فسطاط الإقامة الإلهية.
* روايتك "الفلكيون في ثلثاء الموت" كأنها مكتوبة بلسان الفلكي، الذي يحرض الكواكب على السير في اتجاهه، اتجاه المشيئة المتعثرة بثيابها الطويلة. وهكذا يبرز الحاجة التي يسميها الرمزيون "دائمة النضارة"، حاجة للذاكرة التي لا تتذكر، بل تبدع التاريخ؛ حاجة للنص الذي يستصرخ الإبداع ليسترد الإيمان بشجاعته وجدواه. هل الرواية التي يحلم بإنجازها بركات هي تلك الرواية السديمية، الخارجة عن المدار التأريخي، لذلك هو يكتب بفطنة العراف وبحذر الإحصائي؟
هنالك تأكيد في التسمية، التي تشمل ثلاث روايات (صدر منها اثنتان)، على لفظ "الموت": ثلاثة مصائر في مكان واحد. هي قريبة التصنيف من "النبوءات" من غير اهتمام بتحققها أم لا. القدر معلن سلفا. الوجود الملتبس لهذا الشخص يحدد طرائق موته الرمزية: ينتحر فيما يروي هو سيرة انتحاره. أو يقرر الذهاب إلى "تاف" المجهول. غير أنني لم أحدد، في الحركة الثالثة من هذه الرواية، بعد، مته الجديد. والأرجح أن يكون انسحابه من الواقع إلى الخيال، الذي اخترعه مكانا لإقامة غيابه (والأرجح أن الأمر لن يكون بهذا التبسيط).
ولأن السياق السردي في تدبير مصائر، واستشرافها، هو سياق الرصد الكهاني في أصله، فقد حشرت له لغة علوم ملتبسة، تكاد من شدة قربها إلى صياغات الفكر الرياضي، هندسية وجبرا وطبيعيات وفلسفة، أن تكون لغة معرفة في البرزخ بين اليقين واللايقين، بين الفيزياء والغيب، بين الرؤيا والشهادة العينية، فيما الكل متداخل بموجب الرباط "الفلكي" الجاذب للكثافات إلى الكثافات، واستيلاد المراتب الوجودية من قياسات البروج كونها مراتب في طبقات الخلق.
* الوصف الدلالي لروايتك الأخيرة "الكون" أنها رواية عالية الترميز، تقوم على البنية الموسوعية. هل تسعى إلى بناء قارئ الخاص عبر تلك الاستراتيجية النصية؟
أظن أنني سأقصر (عن قصد) في إجلاء بعض "شبهات" هذه الرواية، القائمة في قسمها الأول على "غيب" هو مصدر "الأسلحة" لحروب الجماعات المختلفة، حيث لا أحد يعترف بلغة الآخر، أي يلغيه، لأن اللغة حضور وجدان وكيان. سوء فهم مطبق. تربص مطلق. قد يسحب القارئ الأمر على كل مذهبية، وايديولوجيا، إذ تجاهد الجماعات في "الاستئثار" بخلافتها لله قانونا، ونظاما، ومعرفة، فيما "الآخر" خارج مارق ينبغي رده طاهرا إلى فلكها، أو إعدامه. هذا هو واقع العالم الراهن، والقديم، والأتي أيضا.
إنه "الخلاف" الدموي، الذي من كثرة تجذره، يخفي علينا التدليل على منشأ علته: أعراق ضد أعراق؛ مذاهب ضد مذاهب؛ أفكار لا تقبل إلا المطابقة أو المطاحنة. نزعات الارتداد من "الجماعة الكونية" تزداد ضراوة بنكوصها إلى كنف "العائلة"، واللون، والدم.
"الكون" حقل ألغام لمن يريد الإمساك برمز موقوف على دلالة، أو معادلها، لأنني، أنا نفسي، أصطدم بجدار حين أحاول فهم شاب روسي، في العشرين، "درب" أبوه من قبله، و"درب" هو، في ظل نظام مديد الحنكة والعمر في "تربية" النزعات، أن ينهض في أعماقه غضب أعمى على شاب أفريقي في نفق حافلات النقل. لم يلقنه أحد غضبه على الإطلاق، ولم يكن في واقعه، قط، مشهد من ذاك يزين لقلبه أن يكرره.
قارئ موجود، يبني معي المعرفة ذاتها، المجرحة الغامضة.
* عالمك الروائي يفيض إلى ملاحد له بالمظاهر السيميائية الطيفية. ألا ترى معنا أنك تمت إلى الواقعية الأنطولوجية أكثر من الواقعية التداولية؟
لا أعرف الواقعية الأنطولوجية، أو التداولية. انتمائي، بحسب معرفتي القاصرة المحدودة، انتماء إلى "الواقعية المعرفية"، ذات الخصائص المشمولة بعلوم المجهول، والخفاء، والمعلوم والظاهر، فأستعير لغة المعلوم والظاهر لاستقصاء الغامض كي أكتمل به وجودا. وبما أننا لن نكتمل في القريب المحتسب من أيامنا هذه وحتى بوابة الأبدية، فستبقى لغة الاستقصاء، التي هي آلتي، لغة التوسل بطيفية المعنى إلى "الطيف" الخالد في لانهائيته.
* نلاحظ أن أعمالك الروائية لا تعتمد على الطابع الحواري إلا فيما ندر، في الوقت الذي تتضح فيه طاقتك الكبيرة على السرد، الذي تكون من خلاله بنيتك الحكائية، هل لأن الطابع الحواري لا يخدم البنية الحكائية لديك؟
أم......؟
في أعمالي محاورات، لكنها قليلة وإشكالية. ساخرة في حجاب التورية. فأنا، بعامة، في نزوعي إلى تأمل المصائر في انخلاقها، وانعتاقها، لا أجد للمحاورات إلا هامشا صغيرا في تدبير السياق. وأرى المحاورات لائقة، من غير تعميم بالطبع، بالرواية "الواقعية"، التي على شخوصها أن يثرثروا على سجيتهم كي يتماهوا مع "واقعيتهم". وأنا أنفر من هذا الصنف نفور الشيطان من بول الذئب (بحسب موصوف تراثي). فالأشخاص "الواقعيون" هم أكثر ثراء من أشخاص مكتوبون على الورق واقعيا. كما أنك ستلتقي كل يوم بألف نموذج من النماذج المكتوبة هذه (والفكرة لإتيالو كالفينو)، فما حاجتك إلى قراءة سكناتهم، وثرثراتهم، في كتاب؟ أريد أن أقرأ ـ وأكتب ـ شخوصا لن ألتقيهم في حياتي قط، وأن أقرأ ـ وأكتب ـ وقائع لن تحدث قط: إن أولئك الشخوص، وتلك الوقائع، اللاحادثة، تصير موجودة في كتابي، الذي سيتجسد "إضافة" صغيرة إلى ملا يعرفه "العالم".
* في روايتك يزحف المتخيل ليكمل سرد الواقع، بما يمكن له أن يكمله، واستمرار السرد خديعة للقارئ بعد أن توهمه بالخروج من المتخيل إلى الواقع، لكنك تسقطه في متاهة أوسع من الأولى. وعندما ينتهي القارئ من الرواية يفطن إلى المكيدة التي حملتها إليه. كيف تصنع هذه الألغام التي تعمق النص وتفجره؟
في الحقيقة أن القارئ ينصب لنفسه مكيدة منذ البداية، بمحاولاته البحث عن التقاطعات الواقعية والمتخيلة في الرواية.
مرة هتف بي صديق مندهشا: "كيف، بحق الله، لم نر المقبرة التي رأيتها في الأرض هناك، ونحن نجلس معا منذ عشر سنين، كل ظهيرة. خصصت تلك الرقعة من الأرض قبرا غريبا للراوية المنتحر في رواية "عبور البشروش". لم أستعر ـ ولم أحس قط، ـ تلك الأرض "الواقعية" لأختلق عليها حادثا متخيلا. كانت المقبرة هناك، كامنة، في المكان. كانت واضحة لعيني عشر سنين، حتى اهتديت إلى شخص أدفنه فيها.
إن ما يظنه القارئ واقعيا، هو ـ في حقيقة الحرف الأول الذي أبدأ به الكتابة ـ متخيل موصوف في صياغة واقعية.
* أعمالك الروائية تصرخ: أنا وعي المؤلف مشخصا؛ أنا المؤلف في حالة روائية. ما رأيك؟
هو الأمر هكذا. كل رواية تدعي غير ذلك هي تلفيق ساذج. كلما أنجزت رواية قلت هذه تمرين آخر في تماريني للتعرف إلي. تكتشفني روايتي وأكتشفها.
* يعتقد البعض أن أعمالك الروائية تبشر بعهد نهوض السيمياء في الرواية العربية، بوصفها "الحقل المعجمي بامتياز". ما رأيك؟
ذلك كثير علي. لكنه يعزيني وسط صمت النقد.
* في أعمالك الروائية تطرح تقنيات سردية مبتكرة، لكنها لم تحظ باهتمام النقد. نعتقد بأنك لم تدرس من قبل النقد لأن أرموزة الجملة لديك تحتاج إلى شرح، والنقد السائد، بمجمله، أقرب إلى نصوصك، فلا يبقى أمامه سوى احتمالين: إما اللجوء إلى سياقات جاهزة تفسرك عبارات غير ميزية، أو الدخول في جولات تأويلية.
لهذا لم يجد النقد حجته، فآثر الابتعاد عن تناولك. ما رأيك؟
لا أوهام لدي. موت النقد الأدبي المتخصص أمر مفروغ منه. هنا، الآن، نقد انطباعي، صحافي، إنشائي العبارة، يصلح لحال كل نص. وهو نقد لتصفية حسابات شخصية، ولتدبير علاقات. خائف مذعور من النص غير الكسول. عشر مقالات عن كتاب ردئ، تتواصل بلا انقطاع، فيما يحظى كتاب "صعب"، مشغول بأخلاق، بعمود ما، أو خبر، لا أكثر. إنه نقد على صورة المذهبية، والعرقية. الصداقة، والقرابة؛ والمنفعة هي قوامها. وبالطبع لن يكون نقد ما معافى وسط الخراب في كل صعيد. أمر محزن. كان يمكن للنقد، في الصحافة، أن يقدم "ذائقة" ما إلى قارئ مأمول، لكن "الوظيفية" فيه نكصت به إما إلى حجب مالا يستطيع مقاربته قراءة، أو امتداح السهل بلا ضابط. إنها خفة بحجم الوجود العربي ذاته.
* هل تعتقد أن ستكون هناك، في المستقبل، مغامرة تأويلية من قبل النقد لمقاربة نصوصك؟
بالتأكيد، إنما قد تبدأ تلك المغامرة حين تبلغ "الركاكة" الكتابية حالا من اللاأخلاق يضجر منها حتى "الركيكون". سيكون عائدة "المعنوي" علي متأخرا. كلنا يطمح في قليل من الثناء كي يعرف أنه في وضع "المسؤولية" أمام قلبه وحبره. الصمت اللامنصف، الراهن، يثير شعورا بالاجدوى، وبالاكتئاب.
لا أعرف لماذا ينبغي أن أصعد الدرج الخشبي إلى العلية، كل مساء سبعة أيام في الأسبوع، صيفا شتاءا خريفا ربيعا، في الساعة ذاتها، لأمتحن نفسي، بجسارة تخيفني، في ميزان ورق أبيض ذي براثن، وحيل، ومهاو، ومتاهات، وكمائن، وغدر، وتربص، واستغلاق، وفتن؟ لا بأس، إنها لعبة قدرية أيضا كسياق في رواياتي. غير أن لي قراء لا تستطيع النصوص أن تستخف بملكاتهم. متطلبون، وعادلون.
* إذا كانت الكتابة عند "جاك دريدا" هي الاختلاف، وعند "جوليا كريستيفا" هي الممارسة الدالية ـ الانتاجية ـ التدليل ـ التناص، وعند "جينيت" هي التعالي النصي، وعند "بارت" تعني عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم اللذة، فما هي الكتابة عند سليم بركات؟
هي التمرين الأكثر جسارة على امتحان الخيال، الذي نحن كائناته المختارة بإطلاق. هي ذلك العبور إلى ما يصنفك خيالا.
* لديك خيال السينمائي. ونصوصك تشبه ما يقوله المصور معتمدا على عدسته، أو كاميرته المتجولة. روايتك سرد متحرك: شيء من الكتابة، وشيء من الصورة؛ كل هذا معا. وشعرك نفسه عبارة عن سينما. فلا شيء غير الأفعال ونوايا الأفعال، ولا وجود لهواجس الداخل، كأن ذاكرتك كاميرا محمولة على الكتف، وقولك اصطياد اللقطة في الهواء. كيف يستطيع سليم بركات أن يصنع تلك الفخاخ الماهرة؟
لا أعرف، على نحو يقين، ما هي المكونات التي تجعل معرفتي وخيالي بصريين. أرتب المشهد عاصفا أو رخيا بعيني، ثم أدونه كلاما. الشكل وأبعاده قوامان ثابتان في كلماتي. ليس ذلك مرده إلى إعجابي، تكوينا ثقافيا، بكل أدب يؤسس لشهوات النظر. فأنا أحببت، على نحو روحي، رواية "الكريات الزجاجية" لهرمان هسة، مثلا، بتجريديتها الفكرية، كحبي حيوانات ناطقة في "كليلة ودمنة". غير أن "الظاهر؟، كمعطى بصري قوامه الشكل، هو الغاية النهائية، في علوم الضرورة والإلهيات، للباطن كي يتخذ من الظاهر معنى ختامه كمالا.
"الباطن، في التفسير، هو عموم الحاصل المعرفي، الحق، المجتمع في خلوة المعنى. "الباطن" هو الغيب "المؤسس" للممكنات المتعينة. إنه العدم البدئي الذي انبثق منه الشكل؛ وهو الرحم المعتمة التي ستلد؛ وهو القبر المظلم المغلق الذي سينهض منه الميت قائما إلى امتحانه.
في كل خاتمة من هذه "البواطن" ـ أي: العدم، والرحم، والقبر ـ تكون ولادة الظاهر، وهي ولادة كالتي تقال في الغايات النهائية (غاية الزهرة أن تصير ثمرة ـ تقول الفلسفة الوضعية). فالوجود هو غاية العدم الظاهرة، والوليد هو غاية الرحم الظاهرة، ونهوض الميت هو غاية القبر الظاهرة، والختام الكلي في الإلهيات هو الفردوس الظاهر والجحيم الظاهر. كما أن الله، الخفي، الذي لا تحده صفات، سيظهر متصفا بالمرئي على أتقيائه.
ربما أوضحت في هذا المختزل من التبيين ان المعنى الحق، الصرف، يؤول ـ أبدا ـ إلى أن يتجسد في صورة، وهو ما أفعله. تمام المشهد البصري، عندي، هو دلالته الفكرية تفسيرا وتأويلا. أحشد للقارئ "مقدمات" بصرية ليدون، هو "نتائج" خلوصه إلى المعنى تأملا وتدبرا بالتفكير. أعطيه عينين ـ سليمه إلى برهان قلبه وأحاسيسه.
هواجس الداخل ـ في نصي ـ هي هناك: الظاهر بلا نهاية، الظاهر الخالد.
* ميثولوجيا الأكراد هي مصدر تقطيرك (على شكل شعر. روايات كتابات أخرى). ما هي مرجعيات سليم بركات الأخرى؟
الوجود في مراتبه، ونشآته. الغامض ـ الحيلة.
* عندما بدأ جنون الوقت في حصار الموت في بيروت، كنت، وبخلاف البعض ممن كانت مواقفهم باهتة في الأصل، قد حملت السلاح كمحارب، وانخرطت في معركة الحياة الحقيقية، ولم تحسب للموت أي حساب، كنت تكتب خاف المتاريس وأكياس الرمل (كما عبرت، وبحدس خارق، في "كنيسة المحارب" عن ذلك). بمعنى أن فكرة المحارب قبل أن تكون فكرة ـ بالنسبة لك ـ كانت تجربة. هل كنت تعبث بالمستحيل؟ أم تمتحن القناص؟ أن كنت تطارد المجزرة؟ هل لك أن تحدثنا عن أركيولوجيا المقاومة لديك؟
فكرة العدالة، مطلقة، هي التي قادتني، كغيري، إلى "أمل: الفلسطيني. وعلى نحو ما لم أستطيع تقسيم تلك الفكرة على سياقين من ممارستها عملا. كنت أكتب ما يقتضيه "إعلام"، من غير استخفاف بمهمة الكتابة على طريقة ذلك الفهم الغوغائي، التبسيطي، لمهمة الإعلام. منذ الأيام الأولى لي، هناك، علق بقلبي، وعقلي، استخفاف بإدارة "نجباء" الدعاوة التحريضية الخرقاء لـ"أمل" الفلسطيني إعلاما. "النضال" فهما، كان ينسحب إلى صراخ إيديولوجي فظ، وتسطح للشعارات، ومخاطبات في المستوى الأدنى من اختبارات الفكر.
حين صدحت الحرب، ودارت الرحى، وجدت أن الذهاب إلى حيث الحريق، لتأمل الفكرة عن كثب في معقلها، هو التفكير الضروري عن إهانة الكلمات بتحميلها مالا تحتمله إلا الحرب.
* ترى، هل يصبح منطق النعامة هو الحل؟ هل يدفن الثوري رأسه في رمال اللاثورة؟
أسيئ استخدام معنى "الثوري" في الأساس. قنن فأذل وسفه حتى الإعياء. مرتجلو أفكار ارتجلوا مفاهيم الثورة. دخل أدعياء، لصوص، وناهبو شعوب، على خيمة المصطلح فناهبوها. كل نظام عندنا ثوري. كل أمي ثوري. كل حامل شعار ميت ثوري. ذهب الحابل بالنابل. لا بأس. فلتنته الثورية بالموجبات التي تجعلنا نجهل اليوم، وفق مقتضيات لا تحصى، أين نوجه "ثورة" نا.
فكرة العدالة، وحدها، هي الكمين الباقي. هذه الفكرة التي لم تنج، بدورها، من تسفيه بسبب سوء التطبيق في الأنظمة الشمولية. لكن المؤلم ان ترى بعض من حملوها في سنوات ما ينخرطون في تأنيب ضمير، ونقد يصل إلى درجة الندم.
كيف يندم من انتمى بخياله غلى العدالة، حتى لو أخطأت العدالة؟
* ماذا عن مجلة "الكرمل"؟ ولماذا لم تستوعبها اللعبة؟ ولحساب من توقفت؟
ستعود "الكرمل" إلى الصدور كما قال لي صديقي وأخي محمود درويش. فاتحني برغبته أن أتولى ما كنت أتولاه منها، في رام الله. قاس تدبير رحيل جديد لأمور يطول شرحها، بالغم من أوضاعنا المتهالكة معيشيا، بلا مورد إلا الضئيل الضئيل الضئيل.
ستصدر، في الأرجح، مطلع السنة القادمة. وسأكون حزينا لغيابي عنها. أما سؤالك التوضيحي أن اللعبة لم تستوعبها فذلك مرده أمران جوهريان: أولا ـ شخصية محمود الاعتبارية على رأس المجلة. تلك كانت حصانتها فلم يقربها القادرون على التسفيه. ثانيا ـ لم نخضعها إلا لاعتبارات الإبداع، قدر ما هو متوفر، ومن غير ادعاء. فهي كانت المجلة التي يمولها الفلسطينيون، في المنفى، وتحمل نتاج الثقافة العربية والغربية معا. وقد توقفت، من ثم، لتداخل اعتبارات سياسية يصعب شرحها.
* سؤال أخير: هلا وضعت لنا سليم بركات في جملة واحدة؟
عراب المتاهات، وخيال الهاوية.