ودّعت الجزائر أمس، ومعها العرب، كاتباً استثنائيّاً يكاد مساره يختصر المحطات المفصليّة في تاريخ بلاده. من الجهاد ضد الاستعمار إلى المدّ الإسلامي، مروراً بعلاقته الملتبسة بالحزب الواحد. مع انشغال دائم بالعلاقة الإشكاليّة بين المثقّف والسلطة

الطاهر وطّار: عاد إلى مقامه الزكي
كان دائم الارتياب من النخبة، ورفض تأييد النظام الجزائري ضد «جبهة الإنقاذ»كان «أحد الأنبياء المنسيين في تلك المدينة»، بتعبير واسيني الأعرج. بين السلطة والإسلاميين لم يقبل بالخيار السهل. عدّ نفسه يساريّاً، ودافع بشراسة عن اللغة العربيّة. كان عدوّ النخبة حاداً في سجالاته، إشكالياً في مواقفه... لكنّه يبقى أبرز آباء الرواية الجزائريّة الحديثة. «عمّي الطاهر» وداعاً!
ياسين عدنان
«الشهداء سيعودون. قالها عمّي الطاهر، وربما هذا الأسبوع. عمّي الطاهر أحد الأنبياء المنسيّين في هذه المدينة. عينه ترى كل التفاصيل التي تغيب عنّا». هكذا تحدث الحسين بن المهدي بطل رواية «ضمير الغائب» لواسيني الأعرج عن الطاهر وطار (1936ـــــ 2010): عمُّ الأدباء الجزائريين والمغاربة، الطائر الحر والكاتب المثير للجدل، غادرنا أول من أمس عن 74 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.
في بداية الستينيات، نشر الطاهر وطار مجموعة قصصية بعنوان «دخان من قلبي». وفي 1974 صدرت روايته الأولى «اللاز». ومن يومها، تخصّص في كتابة تاريخه الموازي الخاص، وغير الرسمي، لجزائر ما بعد الاستقلال. في «اللاز»، رصدَ تناقضات الثورة الوطنية الجزائرية. وفي «الزلزال» (1974) راقب التحولات الزراعية للبلد، فيما حاول في «العشق والموت في الزمن الحراشي» (1982) التأريخ لمرحلة الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات. وعالج في «الحوات والقصر» (1974) و«تجربة في العشق» (1989) إيديولوجيا البورجوازية الصغيرة القائمة على الازدواجيّة.
اختيارات طبيعية لكاتب طليعي تموقع منذ البداية في خندق «الواقعية الاشتراكية». لكنّه واقعي اشتراكي على طريقته الخاصة. وظف البطل المُضاد بدل البطل الإيجابي، كذلك وظف التجريد والسريالية في «عرس بغل» (1983) و«الحوات والقصر» قبل أن يستلهم التراث الصوفي، ويلبس جُبَّة الولاية في أعماله الأخيرة «الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي» (1999) و«الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء» (2005).
«يا خافي الألطاف نجِّنا مما نخاف»، هكذا كان الولي الطاهر يردّد مسائلاً التاريخ العربي الإسلامي في لحظاته الأكثر التباساً، منذ غزوة بدر وقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة... حتى اعتقال صدام حسين. خلال الأشهر القليلة التي سبقت مرضه، كان وطار يعكف في إقامته الصيفية على شاطئ مدينة تيبازة الجزائريّة، على كتابة عمل روائي جديد بعنوان «قصيدٌ في التذلل» يتناول «مسار اليسار في الجزائر وثنائية الثقافي والسياسي، وكيف يسعى الثاني إلى تدجين الأول». ولا يبخل بالهجاء على الشعراء والمثقفين الذين استهوتهم إغراءات السلطة.
الطاهر وطار ليس مجرد كاتب روائي، بل فاعل ثقافي من طراز خاص. و«8 شارع رضا حوحو» في الجزائر العاصمة ليس مجرد عنوان عادي لجمعية صغيرة اسمها «الجاحظية» يرأسها الرجل، بل عنوان دينامية خلاقة لمشهد ثقافي جزائري حيّ. كان وطار يردّد متحسراً: «لسنا سوى جمعية صغيرة تضمّ عدداً محدوداً من الغيورين، ولسنا بديلاً لاتحاد الكتّاب ولا للوزارة، ولا ندعي تمثيل جميع مثقفي الجزائر. مع ذلك، نعاني الحصار الذي تفرضه علينا ثلاث جهات: البيروقراطية التي ترى فينا الدليل على إمكان الفعل الثقافي بإمكانات محدودة. الفرنكوفونيون الذين يقاوموننا على اعتبارنا البديل الصحيح للمشاريع اللاوطنية واللاشعبية التي يُروّجون لها. ثمّ هناك بعض المُعرَّبين الذين يزعجهم نشاطنا على اعتبار أنه يفضح اتّكاليتهم. «الجاحظية» هي ملحمة اصطدام العقل العربي الواعي هنا في الجزائر بغيره من عقل غيبي متخلّف، وعقل غربي متعالٍ، وآخر عروبي اتكالي».
منذ «اللاز» تخصّص في كتابة تاريخه الموازي الخاص وغير الرسمي لجزائر ما بعد الاستقلال، ورصدَ تناقضات الثورة الوطنية
بالنسبة إلى وطار، لم تكن «الجاحظية» مجرد جمعيّة يرأسها، بل صارت له مبرر وجود. خلال ظهيرة حارة من أيلول (سبتمبر) 1992، كنا نسامر الولي الطاهر في مكتبه في «الجاحظية»، عندما تلقّى مكالمة من مجهول تهدّد بأن هناك قنبلة زرعت في المقر ستنفجر بعد ثلاث دقائق. بعدما أطلعني عمّي الطاهر على مضمون المكالمة، غادرتُ المقر فوراً، وخصوصاً أنّ عملية تفجير مطار الهواري بومدين كانت لا تزال جرحاً طرياً، لكن وطّار أصر على البقاء في تحدّ أعمى وعناد غريب. بعد ربع ساعة تقريباً، عدت لأجده متخشباً فوق كرسيه. اتضح أن البلاغ كاذب... كانت مناسبةً لأكتشف أنّ «الجاحظية» صارت للطاهر وطار جسداً ثانياً ومقاماً زكياً آخر لا يمكن روحه أن تغادره إلا في اتجاه السماء.
الآن بعدما صارت عودة الولي الطاهر إلى مقامه الزكي حقيقة مؤلمة لا أدباً ومجازاً، فإنّ الكثير من أسئلته الثقافية تفرض نفسها على الشارع الثقافي الجزائري والعربي. وطار كان دائماً مرتاباً من النخبة. حتى حين اصطف الجميع إلى جانب النظام الجزائري ضد «جبهة الإنقاذ»، تقمّص وطار دور أبي ذر الغفاري وأصر على المشي وحده خارج الاصطفاف.
كان موقفه الثقافي من الأصولية واضحاً، لكنّه لم يتردد مع ذلك في التصريح بأنه إذا خُيِّر بين هويته وحريته الشخصية لاختار هويته. «إذا استولى الفرنكوفونيون على الحكم في الجزائر وانفردوا بقيادة الشعب الجزائري وتوجيهه، فسيجعلون من الجزائر بعد فترة من الزمن سينيغالاً أبيض. وبعد عشر سنوات فقط، سنفقد كل شيء: لغتنا، آدابنا، أعلامنا، وتاريخنا. أما إذا استولى على الحكم غير هؤلاء، وليكونوا إسلاميين، فإنهم قد يعبثون، ويعيثون فساداً، بل قد يُسيلون الدماء رقراقة، لكنني واثق من أنه حتى بعد قرن، سيبقى الشعب الجزائري محافظاً على شخصيته».
الكثير من الغمز طال موقف الطاهر وطار تلك السنوات. حتى إن العديد من أدباء المشرق كانوا يستغربون حين يلتقون صاحب «اللاز» كيف أن الرجل لا يزال بلا لحية. وكان وطار يجد صعوبة في شرح موقفه: «أنا لا أدافع عن الإسلاميين، بل عن الشعب. نحن أمام شعب خائف من الذوبان. شعب فقد الثقة تماماً في بورجوازيته الوطنية. لقد خدعته بالأمس باسم الاشتراكية. واليوم حاولت أن تعيد الكرّة باسم الديموقراطية واقتصاد السوق. والشعب يرى أن هذه البورجوازية وقحة لا تريد الاعتراف بالأمر الواقع كما هو شأن بورجوازيات المعسكر الاشتراكي التي أعلنت إفلاسها».
أما النخبة الثقافية، فقد ظلّ وطار على خلاف دائم معها. وسر الخلاف هو القطيعة الثقافية التي تفصل هذه النخبة عن مجتمعها. وهنا يطرح وطار السؤال الموجع بوضوح: «لماذا لا يثق فيَّ شعبي؟ طوال حياتي أنا أقاوم النظام، وأنا مهدّد من النظام، أو منفيّ في باريس أو هارب إلى هذا البلد أو ذاك، وبعد ذلك، يأتي النظام ليحرسني ويحميني من شعبي. إنها مفارقة تاريخية كبيرة».
هكذا تكلم وطار، عدّه العديدون شعبوياً، وآخرون متذبذباً. قال بعضهم إن التعليم الديني الذي تلقاه في مقتبل عمره في جامع الزيتونة (تونس) قد أعطى ثماره المتأخّرة، ورأى آخرون أن المدير السابق للإذاعة الوطنية جرَّب هو الآخر أن يتعاون مع النظام في فترة من حياته ففشل. لكن عمي الطاهر الذي عرف دائماً كيف يخلق الزوابع وينسحب منها، كانت له دوماً وجهة نظر أخرى.
الكادر البارز في حزب جبهة التحرير الوطني الذي التحق بالجبهة منذ 1956 ليُحال على المعاش وهو في السابعة والأربعين بإيعاز من العسكر بسبب قصة قصيرة نشرها سنة 1984 في مجلة «الآداب» البيروتية بعنوان «الزنجية والضابط»، لم يتقبل إبعاده عن المسؤولية الحزبية، فقرر الانتحار. لكن ديواناً شعرياً لفرنسيس كومب وضعته الأقدار في طريقه سيطرد الفكرة من رأسه. هكذا عوض الانتحار، عكف وطار على ترجمة ديوان «الربيع الأزرق» Les apprentis du printemps.
وبعدها ألحّ عليه طيف أبي ذر. هكذا قرر عمي الطاهر من جديد أن يمشي وحده، ويأكل وحده، ويموت وحده في باريس بعيداً عن بيته في حي «حيدرة» الهادئ في الجزائر العاصمة، وعن ملاذه الصيفي في «شنوة بلاج». ووحده، واصل صاحب «الحوات والقصر» الطريق «خلية وحيدة في حزب وحيد، وهو الحزب الذي أُطلق عليه فيما بعد اسم: عمي الطاهر».
«الشيوعي» الذي تفهّم الإسلاميين
ياسين تملالي
رغم أنّ أول نص روائي جزائري عربي اللغة كان «ريح الجنوب» لعبد الحميد بن هدوقة (1971)، إلا أن الطاهر وطار بغزارة إنتاجه (10 أعمال) وتنوّع مواضيعه أسّس الروايةَ الجزائرية المكتوبة بالعربية في منتصف السبعينيات، بعد بضعة عقود على ولادة نظيرتها المكتوبة بالفرنسية.
بدأت مسيرته الأدبية في تونس خلال حرب التحرير الجزائرية (1954 ــــ 1962) بنشر بعض النصوص وكتابة مسرحيات، لكن أول مؤلفاته صدر عام 1961، على شكل مجموعة قصصيّة («دخان من قلبي») بينها قصة «نوة». هذه الأخيرة بوصفها البليغ لتحالف الإدارة الاستعمارية مع ملاك الأرض، كانت إيذاناً بما سيكون عليه كاتبُها من إيمان بصراع الطبقات المرير وراء واجهة الأمة الواحدة المتحدة.
نشر وطار أولى رواياته «اللاز» عام 1974، فجاءت صدمة لمن كان يعتقد بأنّ مناقضة تاريخ الثورة الرسمي مهمةٌ مستحيلة على رجل هو ــــ عدا كونه عضواً في «الحزب الواحد» ــــ كاتبٌ لغتُه العربية. وما ألصقَ العربية آنذاك لدى قطاع كبير من الأنتلجنسيا بـ«الرجعية الدينية» من جهة، والأيديولوجية الرسمية من جهة أخرى. عبر «اللاز»، روى انتقال الشعب الجزائري من مرحلة تلقي ضربات الاستعمار إلى مرحلة الثورة. لكنّه روى أيضاً ما تخلل هذه المرحلة من مآس، منها تصفية جبهة التحرير لشيوعييها إثر رفضهم حلّ تنظيمهم والالتحاق بها.
ليست «اللاز» رواية واقعية ــــ اشتراكية. التصفيات الجسدية في أوساط الثوار تلقي بظلالها على التعبئة البطولية من أجل الاستقلال. لكن كاتبها كان اشتراكياً، لم يمنعه الانتماء إلى الحزب الواحد من إدراج الشيوعيين في عداد محرري البلاد، ما كان تابوهاً في أوساط هذا التنظيم الأحادي رغم يساريته الرسمية.
قناعات وطار السياسية تجلت في اختياره مواضيع رواياته: «الزلزال» تروي سعي البورجوازية إلى إفشال التأميم والإصلاح الزراعي. «العشق والموت في الزمن الحراشي» تصف الصراع في البلاد بعد استقلالها بين مؤيدي الثورة الزراعية و«الرجعيين» الذين يرفضونها لأن الطبقات «سنّة الله في الكون». في هاتين الروايتين أيضاً، لم يكن وطار بالكاتب الواقعي ــــ الاشتراكي المتفائل بـ«طبعه» أو بأمر من الحكام. بالعكس، سعى إلى تدمير أسطورة توازي الاستقلال والرفاهية، فرسم الجزائر في أبشع ما عرفته من فقر ورشوة بعد رحيل المستعمرين الفرنسيين.
ثم نشر روايتين «غير سياسيتين»: «الحوات والقصر» و«عرس بغل». تصف الأولى في قالب أسطوري رمزي إحباط «الرعية» (الحوات) العميق وهي تكتشف «راعيها» (القصر) في أفظع وجوه استبداده. فيما يتركّز «الخطاب الأيديولوجي» للثانية على فضح التاريخ الرسمي للدولة الإسلامية، والتذكير بما عرفته من حركات انتفضت على الإسلام المؤسساتي المهادن.
كان هذان النصان ختام مرحلة أولى من مسيرة الكاتب الأدبية، تلتها أخرى راوحت اهتماماته فيها بين تجذير نقده للنظام ووصف صعود الحركات الإسلامية. ونذكر من أعمال هذه المرحلة الثانية «تجربة في العشق» (1989) و«الشمعة والدهاليز» (1995) وكذلك «الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي» (1999).
تبدو أولى هذه الروايات سيرة ذاتية من خلال حكاية مثقف يُفصل من عمله في وزارة الثقافة (وطار كان «مراقباً» في الحزب ثم أحيل إلى التقاعد). ويُسَلَّطُ الضوء على علاقة الأنتلجنسيا الجزائرية بالسلطة، وتردد الحكام بين الرغبة في كسب ودها ومصادمتها. ثم تتطرق الروايات الأخرى إلى صعود التيارات الدينية الأصولية في الجزائر (والعالم العربي). لم يعد يبدو التدين هنا، كما في نصوص سابقة، مرادفاً للرجعية ونصرة الإقطاع والبورجوازية. لكنّه ركز على مفارقات هذه الحركات الدينية وتأرجحها بين الرغبة في تحرير الإنسان وسعيها إلى ذلك بوسائل العنف والترهيب.
لم يكن وطار أديباً فحسب. كان أيضاً مجادلاً ماضي اللسان، ويمكن القول إن ازدياد وعيه بطاقة الدين التعبوية ــــ وهو يرى جبهة الإنقاذ تكاد تصل إلى سدة الحكم في التسعينيات ــــ ترافق مع تعمّق مقته لمن كان يسمّيهم «الفرنكوفونيين»، على اعتبار أنّهم كلهم لا يقفون في صف الشعب ولا يحترمون لغاته. وقد اتخذ هذا المقت أحياناً أشكالاً بالغة العنف كما حين علّق على اغتيال الكاتب الجزائري طاهر جاووت عام 1993: «لا أحد سيفتقده سوى أمه وفرنسا».
هذا الكلام رسّخ لدى مَن لا يعرف عن صاحب «اللاز» سوى مواقفه السياسية في التسعينيات، صورة كاتب محافظ بل إسلامي متطرف. وطار بتصريحاته المثيرة للجدل، مسؤول عن هذه الصورة، إلا أنها قطعاً كليشيه يهمل أنّه على «تعرّبه»، كان من أول من طالب بالاعتراف باللغة الأمازيغية... وأن «محافظته» لم تحبّبه يوماً إلى الإسلاميين الذين ظلّوا ينعتونه بـ«الكاتب الشيوعي».
وتوحّد المثقّفون خلف نعش «عمّي الطيّب»
الجزائر ـ سعيد خطيبي
دفن على مقربة من ضريح الأمير عبد القادرفي روايته «التلميذ والدرس» يكتب الشاعر والمفكّر الجزائري مالك حداد (1927 ـــــ 1987) أنّ «المناسبات الحزينة تجمع الناس أكثر من المناسبات السعيدة». هذا ما لاحظناه أمس على مُحيّا جميع من حَضَروا مراسم جنازة الروائي الطاهر وطار. جنازة جمعت بعض المتنازعين، وجذبت شخصيات كثيرة كانت حتّى وقت قريب على خلاف مع وطار.
أقيمت مراسم تشييع صاحب «تجربة في العشق» صباح أمس، في «قصر الثقافة» في الجزائر العاصمة، ثم نقل جثمانه إلى «مقبرة العالية» على مقربة من ضريح الأمير عبد القادر. وقد شيّع صاحب «عرس بغل» بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة الثقافة خليدة تومي التي وصفته بـ«رمز الفحولة الأدبيّة».
الروائي مرزاق بقطاش قال لـ«الأخبار»: «لم أكن اتفق مع بعض طروحات وطّار. كنت أقف في الموقع النقيض منه أحياناً. لكن لا يجب أن ننسى أنّ الساحة الأدبية تظلّ واحدة وتتسع للجميع». كان وطار قد وقّع مقدّمة أولى روايات مرزاق بقطاش «طيور في الظهيرة» (1981)، إلا أنّ العلاقة بين الاثنين ساءت لأسباب واختلافات إيديولوجية، قبل أن تصفو الأجواء بينهما السنة الماضية خلال فترة علاج وطار في فرنسا. ويعلّق بقطاش: «المبدع بطبعه نرجسي. قد يتقلّب أحياناً، لكنّ الجوهر يبقى ثابتاً».
المسرحي محمد بن قطاف المدير الحالي لـ«المسرح الوطني الجزائري»، بدت عليه علامات التأثر واكتفى بالقول: «سنكتشف الآن قيمة هؤلاء الكبار. لا نلمس قيمتهم سوى لحظة الرحيل». وكان بن قطاف قد نقل إلى الخشبة نصّ قصّة وطار «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» الذي أخرجه الزياني شريف عيّاد...
وبينما خيّمت مشاعر الحداد والحزن على جنازة الطاهر وطار، ذكر المسرحي مخلوف بوكروح أنّ الراحل كان «واحداً من المثقفين القلائل الذين آمنوا بالتأسيس للفعل الثقافي الذي تجسد مع تأسيس جمعية «الجاحظية» في مرحلة صعبة من تاريخ الجزائر. ويكفيه شرفاً أنّه لم يغادر الجزائر كما فعل مثقفون كثر خلال التسعينيات... ولم ينعزل عن الحياة العادية».
بين الحاضرين وقف الروائي واسيني الأعرج وزوجته الشاعرة زينب الأعوج. وقال الأعرج لـ«الأخبار» إنّه «رغم خلافاته مع الكثيرين، بقي الطاهر وطار حاضراً في صلب النقاشات الأدبية والفكريّة في بلاده». وأضاف: «وطار كتب وقاوم التحولات التاريخية والسياسية. هو علامة مؤثرة ومؤسسة في الأدب الجزائري. السؤال الذي يجب طرحه اليوم، هو كيفية الحفاظ على تراث الطاهر وطار وذاكرته الأدبيّة والثقافيّة؟»
واصل إشعال الحرائق حتّى الرمق الأخير...
فضّل مصطلح «العنف المتبادل» على كليشيه «الإرهاب»ما إن أصدر الطاهر وطار باكورته الروائيّة «اللاز» عام 1974، حتّى تحوّلت إلى أحد النصوص المفصليّة، وجعلت صاحبها أحد أبرز رموز الجيل المؤسس للرواية الجزائرية، في اللغة العربيّة (كاتب ياسين ومحمد ديب كتبا بالفرنسيّة وقتذاك).
ولد عام 1936 لأسرة بربريّة في ولاية سوق أهراس شرق الجزائر. عام 1950، التحق بمدرسة تابعة لـ«جمعية العلماء المسلمين»، ثمّ أرسله والده إلى قسطنطينة للدراسة في معهد الإمام عبد الحميد بن باديس، قبل أن يلتحق بجامع الزيتونة عام 1954 ثم يتركه للالتحاق بصفوف الثورة الجزائرية، و«جبهة التحرير الوطني»، حيث بقي يحتلّ منصب «مراقب سياسي» حتّى عام 1984.
نشط في الصحافة، وأسس عام ١٩٦٢ في قسطنطينة، أول أسبوعية في الجزائر المستقلة بعنوان «الأحرار». لكن السلطات أغلقتها. المصير نفسه ستلقاه أسبوعية «الجماهير» في الجزائر العاصمة بعد عام... ثم أسبوعية «الشعب» التابعة لجريدة الشعب (1973) التي أوقفت بعد تحوّلها منبراً للمثقفين اليساريين. وقد شهدت السبعينيات توتراً في العلاقة بين نظام الهواري بومدين، وصاحب «عرس بغل» على خلفيّة كتابات هذا الأخير. إلى جانب نضاله السياسي الإشكالي، كرّس حياته للعمل الثقافي التطوعي، فأسس جمعية «الجاحظية» عام 1989، مع الشاعر يوسف سبتي، الذي ذبحه الإسلاميّون عام ١٩٩٤. أنجز ثلاث مجموعات قصصية أولاها عام 1961 «دخان من قلبي»... له في المسرح عملان صدرا في مجلة «الفكر» التونسيّة أواخر الخمسينيات وهما «على الضفة الأخرى»، و«الهارب». أمّا أعماله الروائيّة، فلاقت شهرة منذ «اللاز» مروراً بـ«العشق والموت في الزمن الحراشي» (1981)، و«عرس بغل» (1983)، و«تجربة في العشق» (1989)، وصولاً إلى «الشمعة والدهاليز» (1995)، و«الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي» (1999)، وآخرها «الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء»، ثمّ «قصيد في التذلّل» العام الماضي. حاز «جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربية» التي تمنحها «الأونيسكو» (2005)، و«جائزة العويس». بعدما ألمّ به المرض، أمضى فترات علاج في باريس في العامين الماضيين. لكنّه لم يتوقّف عن إثارة إشعال الحرائق في بلاده. وكان معروفاً بدفاعه الشرس عن الثقافة العربيّة في مواجهة «نخبة فرنكوفونيّة تتحكّم في الحياة العامة». كذلك بقي ضدّ قمع السلطة للإسلاميّين، مفضّلاً مصطلح «العنف المتبادل» على كليشيه «الإرهاب» الذي تبنّته النخبة الثقافيّة والإعلام.
راجع البورتريه الذي أعدّه عنه الزميل محمد شعير لصفحة «أشخاص»، (الأخبار، ٥ أيار/ مايو ٢٠٠٩)
الاخبار
14 اغسطس 2010
***
الطاهر وطار أبو الرواية الجزائرية الحديثة
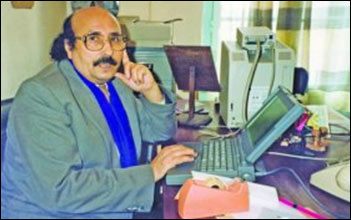
غيّب الموت أول من أمس أبا الرواية الجزائرية الحديثة الطاهر وطار عن أربع وسبعين سنةً في الجزائر العاصمة، بعد صراع طويل مع المرض العضال.
ولد الطاهر عام 1936 في بيئة ريفية وأسرة بربرية وكانت أمّه فقدت ثلاثة مواليد قبله، فكان الابن المدلل للأسرة الكبيرة. التحق الطاهر بمدرسة جمعية العلماء في 1950. ثم أرسله أبوه الى قسنطينة ليتفقه في معهد الإمام عبدالحميد بن باديس في 1952. وانتبه الى ان هناك ثقافة أخرى موازية للفقه ولعلوم الشريعة، هي الأدب. راسل مدارس في مصر فتعلم الصحافة والسينما، في مطلع الخمسينات. التحق بتونس في مغامرة شخصية في 1954 حيث درس قليلاً في جامع الزيتونة. في 1956 انضم الى جبهة التحرير الوطني وظل يعمل في صفوفها حتى 1984. تعرف عام 1955 إلى أدب جديد هو أدب السرد الملحمي.
التحق وطار عام 1963 بحزب جبهة التحرير الوطني عضواً في اللجنة الوطنية للإعلام، ثم عمل مراقباً وطنياً حتى أحيل على التقاعد وهو في سن 47. شغل منصب مدير عام للإذاعة الجزائرية عامي 1991 و1992. كرس حياته للعمل الثقافي التطوعي وأسس «الجمعية الثقافية الجاحظية» عام 1989 وقبلها كان حوّل بيته منتدى يلتقي فيه المثقفون كل شهر.
من مؤلفاته:
- «دخان من قلبي» (1961)
- «الطعنات الجزائر» (1971)
- «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» (1974)
- على الضفة الأخرى (مجلة الفكر تونس أواخر الخمسينات). «الهارب» (1971)
- اللاز (1974)
- الزلزال (1974)
- عرس بغل (1983)
- تجربة في العشق (1989)
- الشمعة والدهاليز (1995)
- الولي الطاهر يعود الى مقامه الزكي (1999).
هل الموت نهاية؟ في نظر المبدع والفنان، طبعاً لا. فالموت مجرد حالة كيمياء طارئة في الزمن والمكان. لكن المشكل أنه في وطننا العربي كثيراً ما يحمل الميت حياته معه. كثيرة هي الأسماء الكبيرة التي ملأت زمانها صخباً ونقاشاً وإنتاجاً، من يتذكرها اليوم؟ على العكس مما يحدث في كل أصقاع الدنيا بحيث يظل النص هو الأبقى متجاوزاً صاحبه في كل شيء حتى في القدرة الاستثنائية على الاستمرار. أعتقد أن الذي يضمن ذلك هو القراءات المتجددة: إلى اليوم ما زلنا نفاجأ بقراءات جديدة لسرفانتس، بالزاك، فلوبير، جيمس جويس وغيرهم... هذه الدينامية تضع أسئلة الأجيال السابقة في مواجهة إرباكات الأجيال الجديدة، مما يضمن الاستمرارية وربما الأبدية. لكن... على رغم اليباس العربي، نحاول أن نقنع أنفسنا بأن الموت لا يقتل المبدع، بل يضعه على الأقل في أفق التساؤل بكل تجرد ومحبة أيضاً.
عندما نودع عزيزاً يفترض أن نصمت طويلاً قبل أن نطلق العنان للنحيب الذي لا يسمعه أحد غيرنا، لكن في الكتابة تتخذ الوضعيات حالة خاصة، إذ إن الصمت هو قبول مبدئي بحالة الموت، ونحتاج إلى زمن آخر لنقبل بأن الذين قاسمونا قسوة الحياة ونبلها يموتون أيضاً. في النهاية هم لا يموتون إلا قليلاً، لأن كتبهم وإهداءاتهم ومناوشاتهم وطيبتهم واختلافهم تظل تذكرنا بأن يتماً حقيقياً أصبح ملازماً لنا وأن علينا أن نتحمل مشقة حياة قاسية في غيابهم.
لم يكن وطار كاتباً هادئاً ومستقراً. ببساطة كان إشكالياً ككل الكتاب الكبار، بكبر القضايا الحياتية التي أثاروها في كتاباتهم الكثيرة والمتنوعة. من القصة والرواية والسيرة، مروراً بالمسرحية والمقالة السياسية والفكرية وانتهاء بالنقاشات اليومية، كان وطار يرسم رحلة مثقف عضوي، ارتبط بوطنه وبقضايا حركة التحرر الوطني مثله مثل جيل عربي بكامله ظل مقتنعاً بأن ما كان يحدث من انكسارات في عمق المؤسسة الفكرية القومية ليس إلا حالة طارئة وليس ضرراً هيكلياً في العمق والجوهر.
وطار الروائي كان شيئاً أكبر من ذلك كله، فقد ظلت نصوصه الروائية، من بداياتها، حتى في حالاتها الفردية مثلما هو الحال بدءاً من نص تجربة في العشق وانتهاء بالولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء (أستثني قصيدة في التذلل لأن الطاهر عاد إلى خصوصيات تجربته الأولى القريبة من الزلزال حيث أصبحت المؤسسة هي رهانه وليس الحالات الفردية، لأن الأفراد يظلون سجناء هذه المؤسسة التي تصغّرهم وتمتص كل حالات الخلق والإبداع الموجودة فيهم، وكأن الطاهر وهو يكتب نصه الأخير تحت حالات الألم التي لم يكن شيء قادر على إسكاتها إلا مورفين الكتابة عاد إلى نبعه الأول) ترسم التراجيديا الخفية لطبقة بكاملها خانت مثلها الكبرى مثلما حدث مع البورجوازية الفرنسية. ولكن أيضاً تراجيديا من الكتاب والفنانين والسياسيين، من الذين استماتوا على هذه المثل ليفتحوا أعينهم على أنظمة خسرت في مجملها موعدها مع التاريخ، وعلى طبقات اجتماعية جديدة لا رهان لها إلا رهان الربح والخسارة والمصالح الذاتية الضيقة.
قراءة جديدة
تتوجب اليوم قراءة الطاهر وطار لا من موقع انتصارات الحركة الوطنية التي حققت الاستقلالات الوطنية في الوطن العربي كما فعلنا في السبعينات من القرن الفارط، ولكن في إخفاقاتها ومؤدياتها. في نصوص وطار وبعض نقاشاته الكثيرة، ما يقدم عناصر أولية للتأمل.
ترك الوطار وراءه مادة ثقافية ضخمة تتطلب الكثير من الموضوعية والتجرد والعمل الجاد. فقد ظل الطاهر إلى آخر أيامه مقتنعاً بجدوى مشروعه ودافع عنه باستماتة مع كل ما يمكن أن يتركه من جراحات وردود فعل. في جلسات حميمية في خلوته المرضية سواء في مستشفى سانت أنطوان، أو في بيت النقاهة في درانسي أو في بيتي في باريس، ظل صفاء ذهنه هو الغالب. وهي نقاشات يمكن اليوم أن تشكل كتاباً مستفرداً. في مثل هذه الحالات يجب أن نخرج من دائرة رد الفعل المباشر ونذهب نحو المنظومة الفكرية التي حكمت جيلاً بكامله، ودعْنا في السنوات الأخيرة فقط جزءاً كبيراً من أقطابه: سهيل إدريس، عفيفي مطر، محمد عابد الجابري، نصر حامد أبو زيد وغيرهم كثيرون. حتى عندما استضفته قبل انتقاله إلى باريس في الورشة الروائية التي خصصت له على مدار السنة مع طلبة الماجستير في جامعة الجزائر المركزية، كانت فكرته عن البحث الجامعي غير دقيقة، ولكنه بمجرد أن استمع إلى مداخلات طلبة الماجستير الذين خصصوا أبحاث السنة لأعماله الروائية والقصصية والسيرية، فوجئ بالجدية التي تم بها تناول أعماله الأدبية، إذ نوقشت بكل تجرد وموضوعية وتحدث يومها الطاهر عن تجربته الروائية الغنية وحتى عن قضايا التي كانت في مدارات المسائل الشخصية جداً، وخرج بفكرة ظلت تلازمه في تصريحاته: إنه على رغم ما يمكن أن يقال عن جامعتنا، تظل المكان الأكثر جدية في تناول أعماله وأعمال غيره من المبدعين.
قلت لطلبتي يومها ان وجود وطار بيننا مكسب كبير وحظ استثنائي إذ نادراً ما نجد مؤسساً حياً نناقشه ونستمع إليه. تجربته منحته هذه الخاصية التي لا تمنح لكل الناس. أن تكون مؤسساً هو أن يمنحك التاريخ حظاً استثنائياً لا يمنح لغيرك ولهذا تصبح المسؤولية في غاية الكبر. فقد ذهب بن هدوقة تاركاً وراءه فراغاً قاسياً، لم نعرف جيداً كيف نستثمره في حياته من موقع التأسيس، وظل وطار علامة تذكرنا دائماً بأن الجيل التأسيسي لا يزال مستمراً لا كتاريخ فقط، ولكن كفاعلية إبداعية حيوية. ذهاب الطاهر خسارة لا تعوض، ترك فراغاً قاسياً بين عشاقه ومحبيه، ولكن من قال إن الأدباء يموتون؟ سؤال صعب ومعقد، في وضع عربي لا يحفل كثيراً بما سيؤول إليه قريباً من فداحة لامسها الكاتب بحدة وبصدق أيضاً في وقت مبكر، ولكن لم يحفل بها إلا بقايا المجانين، من محبي الأدب والفن، الذين يدركون جيداً أن الكاتب إذا مات فهو لا يموت إلا قليلاً.
الحياة
السبت, 14 أغسطس 2010
***
صيف وطّار الأخير
 في صيف 1989، وقعت بين يدي رواية "عرس بغل" للطاهر وطّار. شدّتني منذ العنوان، لأجدني منغمساً في أجواء ماخور العنّابية وصويحباتها أتعرّف على روّاده وعلى رأسهم بطل الرواية الحاج كيان. الحاج كيان خرّيج جامعة الزيتونة الذي حاول الترويج لدعوة شيخه حسن المصري في ماخور العنّابية قبل أن تريَه هذه الأخيرة جنّته في الدنيا قبل الآخرة. هذا البطل السلبي (نكايةً بالبطل الإيجابي الذي يهيمن في أدب الواقعية الاشتراكية التي يُعدّ الطاهر وطّار أحد فرسانها العرب) كانت تداعياتُه وتأملاتُه طوال الرواية تقرّبنا من ملامح حقبةٍ من تاريخ جزائر ما بعد الاستعمار. ورغم أنني قرأتُ الرواية بعد كتابتها بقرابة عقد ونصف، إلا أن أجواء بداية الانهيار الكبير للاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، وتنامي المدّ الأصولي في الجامعة المغربية جعلاني أجد فيها قدراً كبيراً من الرّاهنية. "عرس بغل" لم تكن مجرّد رواية، بل كانت درساً بليغاً في السياسة والحياة للشاب الذي كنتُه. كانت تحريضاً على الهروب من ذلك الاصطفاف المريع الذي كانت تعرفه رحبة السياسة إلى رحابة الأدب حيث لا صفوف ولا طوابير.
في صيف 1989، وقعت بين يدي رواية "عرس بغل" للطاهر وطّار. شدّتني منذ العنوان، لأجدني منغمساً في أجواء ماخور العنّابية وصويحباتها أتعرّف على روّاده وعلى رأسهم بطل الرواية الحاج كيان. الحاج كيان خرّيج جامعة الزيتونة الذي حاول الترويج لدعوة شيخه حسن المصري في ماخور العنّابية قبل أن تريَه هذه الأخيرة جنّته في الدنيا قبل الآخرة. هذا البطل السلبي (نكايةً بالبطل الإيجابي الذي يهيمن في أدب الواقعية الاشتراكية التي يُعدّ الطاهر وطّار أحد فرسانها العرب) كانت تداعياتُه وتأملاتُه طوال الرواية تقرّبنا من ملامح حقبةٍ من تاريخ جزائر ما بعد الاستعمار. ورغم أنني قرأتُ الرواية بعد كتابتها بقرابة عقد ونصف، إلا أن أجواء بداية الانهيار الكبير للاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، وتنامي المدّ الأصولي في الجامعة المغربية جعلاني أجد فيها قدراً كبيراً من الرّاهنية. "عرس بغل" لم تكن مجرّد رواية، بل كانت درساً بليغاً في السياسة والحياة للشاب الذي كنتُه. كانت تحريضاً على الهروب من ذلك الاصطفاف المريع الذي كانت تعرفه رحبة السياسة إلى رحابة الأدب حيث لا صفوف ولا طوابير.
في صيف 1993، كنتُ أقيم رفقة أخي ياسين في فندق بشارع ديدوش مراد في قلب العاصمة الجزائرية. وهناك تعرّفتُ على عمي الطاهر لأول مرة. كان يشتغل في "الجاحظية" بهمّة شاب في مقتبل الحلم. وكنّا نزوره بمقر الجمعية ليعزمنا على طبق الشكشوكة بالمطعم المجاور. كان صديقه الشاعر الراحل يوسف سبتي على قيد الشعر والحياة لا يزال. لم تمتدّ إليه أيادي الغدر والظلام التي كانت تعيث اغتيالاً في جزائر تعمّها حالة فلتان أمني على إثر انتخابات 1992. كانت "الجاحظية" مرتعاً لخيرة أدباء الجزائر الجدد من جيل ما بعد انتفاضة 88: عمّار مرياش، عادل صيّاد، نجيب أنزار، سليمى رحال. وكان الطاهر وطّار عمّ الجميع الذي يفيض حبّه ليشمل الكلّ.
في صيف 2007، عدتُ إلى الجزائر بعد زهاء عقد ونصف من الغياب. كنتُ مشاركا في إقامات الإبداع التي أشرف عليها الشاعر حرز الله بوزيد بمناسبة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية". في الخامس عشر من أوت، أخبرنا بوزيد أنه يوم عيد ميلاد عمّي الطاهر. هكذا قررنا زيارته بشكل جماعي في مصيفه الصغير على شاطئ "شينوا بلاج" بمدينة تيبازة الساحلية. كان وطّار سعيدا بنا. وكانت مدام رتيبة أسعد وهي تهيئ لنا المجلس وتتعهّد زوارها الطارئين بالحبّ والمشروب. أطللتُ على كومبيوتر عمّي الطاهر لأجد صفحة وورد مكتوب عليها بالخط العريض: "قصيدٌ في التذلل". لم يكن أحد يخمّن أن هذا القصيد سيكون مشروع الطاهر وطّار الروائي الأخير.
عندما عدتُ إلى الفندق، كتبتُ الآتي: ولمّا رسونا / على شاطئ "تيبازة" / كنّا خفافاً من الشعر / وكان الوليّ الطّاهر / المتوحّد في "لازه" / الأشعرَ فينا / بالقصيد الذي من تذلّل / وملام / هناك في مقامه الزّكي / كان يرقب انكسار الوقت / على صخر الحطام / مثل ملاح أبيّ / أحاطت به الريح / من كلّ غمام / فأبحر في الغواية / والرواية / والمقام / وأوعز للموج / أن لا تُخاطر / نثر الجزائر / شعرٌ / وشعرٌ / حديث الجزائر / مقام الجزائر / عمرٌ / من البوح / والحرف ثائر.
في صيف 2009، كان وطّار يتابع حصص العلاج الكيميائي بالعاصمة الفرنسية. أعطاني الشاعر الصديق عمّار مرياش رقم هاتف شقته الباريسية القريبة من مستشفى سان أنطوان لأتصل به. كان صوته ضعيفاً، لكنه بدا سعيدا بالمكالمة. وطفق يسألني عن ياسين وعن برنامجه "مشارف". كما كلّفني بأن أوصيه بالاهتمام بوزنه الذي يجد أنه قد زاد قليلاً عن آخر مرة حلّ فيها ضيفاً على برنامجه. رجوتُه أن ينسى ياسين ووزنه ويهتمّ فقط بصحته، وبروايته "قصيدٌ في التذلل" التي كان يشتغل عليها كما لو يسابق الموت.
في صيف 2010، على بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده الرابع والسبعين، كتب الشاعر الجزائري عادل صيّاد على صفحتي في الفايسبوك هذا النعي: "قبل لحظات ودّعنا إلى الأبد الروائي الجزائري الكبير عمّي الطاهر وطّار بعد صراع طويل مع المرض، إنا لله وإنا إليه راجعون". رجعتُ إلى مذكرات الطاهر وطّار "أراه..." لأقرأ ما يلي: "الموت لا يرهبني، وهو بالنسبة لي تجربة لا بد من التعرّف عليها. لا بد من الإطلال عمّا هنالك، وراء العالم الحالي، وراء هذا الجدار البلوري الرهيف". كان بيني وبين عمّي الطاهر حاجزٌ بلوري جعلني أقتنع بغير قليل من الأسى أن صيف 2010، كان صيف وطّار الأخير.
بروكسل، 13 أوت 2010