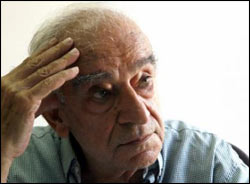 زاوج بين الفلسفة والشعر وألّف جنازاً لنفسه
زاوج بين الفلسفة والشعر وألّف جنازاً لنفسه
غادرنا أمس، بعد صراعٍ مقتضب مع المرض، تاركاً بصماته على القصيدة العربية الحديثة. صاحب «أنهار بريّة» واكب تجربة «شعر»، واستلهم أقرانه الألمان الذين نقلهم برفق إلى الضاد. يوارى في الثرى في كفرون، قريته على الساحل السوري
بين أقرانه في مجلة «شعر»، وبينما كان التجريب الشعري في أوجه، اكتفى فؤاد رفقة (1930 - 2011) بكتابة قصيدة مخلصة لمزاجه الخافت وروحه الرومانتيكية الميالة إلى لغة شعرية مخلوطة بالتأمل الفلسفي. في الوقت الذي نقّب فيه أدونيس عن حداثة قصيدته في التراث العربي، وعامل أنسي الحاج الجملة العربية بفظاظة، وغطّس الماغوط سيرته الشخصية في نهر الحياة العادية ومشهدياتها المهملة، ونزّه شوقي أبي شقرا قصيدته في طيّات المعجم اللبناني الريفي، كان فؤاد رفقة ينجز قصيدة خالية من الطموحات المتلاطمة حوله. بدا ذلك جلياً في باكورته «مرساة على الخليج» (1961) التي سجّلت اسمه في سجلّ رواد تلك الحقبة، لكنّها لم تضعه في الصفوف الأولى.
كتب رفقة قصيدة على مقاسه. الآن، ونحن نودعه، يخيّل إلينا أنّه أمضى حياته كلها في كتابة قصيدة واحدة تقريباً. لم نكن نجد فرقاً كبيراً في نبرته وعوالمه، ونحن نتلقّى مجموعاته الشعرية الجديدة. بطريقة ما، تحوّل دأبه الحثيث على استخدام النبرة نفسها إلى فن شخصي كامل. كأنّ الشاعر كان ينافس نفسه، لا بقصد التفوق عليها بل بقصد مجاراتها فقط. النبرة المحلّقة بجناحي التأمل الفلسفي والكآبة الشخصية، قادته لاحقاً إلى الشعر الألماني الذي «تقيم فيه الكتابة والفلسفة تحت سقف واحد»، وحيث «الكلمة الشعرية تفكر، والكلمة الفكرية تشعر»، بحسب قوله في إحدى مقابلاته. هناك وجد صاحب «أنهار برية» (1982) أجوبة عن الأسئلة التي أكثر من تردادها في أعماله، أو لنقل إنه وجد أسئلة أكثر حيرةً تصلح لحكّ أسئلته بها.
الشاعر الذي شغف بحركة الزمان وآلام الوجود، وجد لدى أقرانه الألمان شراكة روحيّة، لم تصالحه مع نصّه فقط، بل أوجدت لهذا النصّ هوية أو جنسية مكتسبة في لغة غوته. تعزّز هذا التصور أكثر مع توالي ترجماته لريلكه وهولدرلين وتراكل ونوفاليس وغوته. ترجمات منحته أسبقية وريادة في تعريف القارئ العربي بأهم التجارب الألمانية، قبل أن تتكلل بترجمة مجلد ضخم ضم مختارات لنحو أربعين شاعراً. أحياناً كنّا نظن أن شغله في الترجمة تفوّق على كتابته للشعر. كأنّ ترجماته كانت قصائد حلم بإنجازها، أو أَمِل أن تتكفّل الترجمة بجعله شريكاً في كتابتها. هكذا، ارتبط اسم فؤاد رفقة بالشعر الألماني. عامله الألمان كممثل لهم في الثقافة العربية. في البداية، قدّموا له منحة دراسية تُوّجت بحصوله على شهادة الدكتوراه في بحث حمل عنوان «الجمال عند هايدغر». ومع صدور ترجماته، كرّموه أكثر من مرة، واستضافوه كاتباً زائراً في جامعاتهم، ومنحوه جوائز عدّة كانت أخيرتها ميدالية «غوته».
من فلسفة هايدغر وشعرية ريلكه وأصحابه، تسرّب «شيءٌ ألماني» إلى نصوصه الشخصية. تعززت مناخات الزهد والطبيعة والتأمل والخلود والعزلة. المفردة لأخيرة لم تكن ممارسة شعرية فقط، بل طريقة في العيش تفاقمت في سنواته الأخيرة، وأبعدته عن مجتمعات الشعراء والصحافة. لكنّ عزلةً من نوع آخر جاءت من بقاء الشاعر على حاله وسط تغيّرات هائلة وعميقة أصابت الشعر. صاحب «عودة المراكب» (2009) الذي فضَّل مجاراة نفسه، لم يفكر أحدٌ من لاحقيه بمجاراته. احترم الآخرون تجربته، لكنّ ذلك لم يترافق مع تقدير نقدي لنصوص هذه التجربة التي ظلت ترواح بين وضوح المعنى وبساطة التعبير. بالنسبة إلى كثيرين، بدت تجربته في الترجمة متفوّقة على تجربته في الكتابة.
أسئلة الوجود والموت حضرت بكثافة في أعمال فؤاد رفقة كلها. لهذا لم يكن غريباً أن يحضر الموت في عنوان مجموعته الأخيرة «محدلة الموت وهموم لا تنتهي» (دار نلسن - 2011). مع ذلك، يُباغتنا أن الشاعر كتب قصائد المجموعة كمن يؤلف جنّازاً لنفسه. هناك نوع من الوداع لغياب شخصي في سبيله إلى الاكتمال. في المقطع الأول، نقرأ حواراً بين أبدية الموت وزوال الكائن: «- من أنت؟/ - صاحبُ الأرض/ - ماذا تريد؟/ - أن تُخلي المكان/ - لمن؟/ لمستأجر جديد». وفي مقطع آخر، يضع المنجل الأعمى للموت داخل فكرة أوسع: «أبعدَ من الأفق/ ومن سديم الغيب/ كنتَ البارحة/ واليوم/ أقرب للعين من البصر/ أيها المنجل الأعمى». ثم يراهن على نيتشوية «العَوْد الأبدي»، ويرى الشاعرَ «أبدياً لا يموت»، رغم أنّه «يُبطئ/ يُقصر الخطى/ عسى الطريق يطول/ فلا يصل باكراً/ قبل الأوان». الكتابة هنا تعوم على رؤيا وجودية يسعى فيها الشاعر إلى ملامسة المطلق، حيث الشعر «ثمرةٌ/ طائرٌ ينقرها/ فتقطرُ/ تحتها فلاحُ الشعر/ يمدُّ رجليه/ يفرش المائدة»، والموت «محدلة لا تعرف الضجر». ما نقرأه هو «عناق بين الشعر والفلسفة» كما كان يطيب للراحل أن يصف مزاجه الشعري، لكن هذا العناق ظل يُترجم باستعارات وصور تجاوزها الآخرون.
اللقاء بريلكه
تُرى كيف كانت ستكون تجربة فؤاد رفقة لو لم يعثر بالمصادفة على ترجمة إنكليزية لـ«مراثي دوينو» في احدى مكتبات بيروت؟ هذا اللقاء بريلكه كان حاسماً في مسار صاحب «كاهن الوقت»، وارتباط اسمه بالشعر الألماني تحول في أذهاننا إلى نوع من البداهة، إلى حدّ أن ترجمات الآخرين كانت تذكرنا بريادة ترجماته. هذا ما حدث، مثلاً، حين أصدر الشاعر العراقي كاظم جهاد ترجمة كاملة ومميزة لأعمال ريلكه قبل سنتين.
نتذكر أن الترجمة عن الفرنسية والانكليزية كانت أشبه بمرجعية مقترحة لحداثة الشعر العربي في خمسينيات القرن الماضي. وهذا يعني أنّ جهود فؤاد رفقة تمتلك قيمة إضافية من خلال إنزاله لبضاعة مختلفة إلى سوق الشعر في تلك الحقبة. لا بد للأبدية التي طاردها الشاعر في أعمال أقرانه الألمان من أن تحفظ اسمه في ذاكرتنا بعد غيابه.
الاخبار
13- 5-2011
***
فؤاد رفقة الشاعر الزاهد الرومنطيقي المكتفي (1930 – 2011)
لم يشأ فؤاد رفقة يوماً أن يكون "الشاعر النجم"، أو "الشاعر الأول". لطالما سمعنا اسمه، أو قرأناه على غلاف كتاب مترجم عن الألمانية، من دون أن نراه. حضوره قليل، كما هي الحال مع المعلومات المتعلقة به.
كان فؤاد رفقة في شعره يقودنا إلى مناخات ربما كانت ذاكرته تستعيرها من البلاد التي أهدت اليه شعلة الشعر: ألمانيا. وعلى الرغم من كونه أحد ربابنة مجلة "شعر" الأساسيين، إلا أن قصيدته كانت تُكتَب لتخالف الاتجاهات الجديدة، لتقبع في نبرته، غير مكترثة بالضجيج المثار حول اللغة، والنثر، والمستجدات السياسية والنظرية في القصيدة العربية. ظل رفقة منشغلاً بالقبض على عناصر رومنطيقية، واستثمارها في قصيدته، ليكوِّن بذلك نصاً باعد من جهة، ما بينه وبين أبناء جيله من الشعراء، ومن جهة أخرى، ما بينه وبين القارئ. لم يلتفت إلى خبط النوافذ التي كانت تنفتح وتنغلق أمام عينيه، بقوة، على أيدي زملائه الشعراء، ومجايليه. انسحب مبكراً من صالون النقاشات حول شكل القصيدة، على رغم مساهماته المقتضبة بها، لينفرد بما أُعطي له في الشعر الألماني والفلسفة، وليصبح تالياً في ما بعد، رسول الترجمات من لغة ريلكه، وغوته، وهايدغر. ظل انعزاله في عوالم محددة، مثار تساؤلات لقرّاء ونقّاد وشعراء، حتى بات ممكنا توقع ما سيُقرأ لفؤاد رفقة من دون فتح الصفحة على قصيدة جديدة.
ونحن نكتب عن رفقة الذي غادرنا، نتخيل شاباً، قبل عقود، داخلاً معهد غوته في بيروت، حاملاً في يديه، "مراثي دوينو"، المجموعة الشعرية التي كتبها ريلكه، بدفق شعري استثنائي، على ما قال هذا الأخير في خطاب إلى والدة صديقته. لن يعود رفقة من بعدها، كما كان. ستحفر فيه المراثي التي كُتبت في قصر معزول، علامات عدوله عن المعاصر في الشعر، وستزرع له ذاكرة شعرية. ستمارس السحر عليه وستأخذه شعوذة الأصوات والتونات التي لطالما اهتم بها ريلكه في أشعاره. سيبقى رفقة معزولا بدوره، لكن في المساحة ذات اللون الأخضر. الطبيعة الساكنة، والمتأهبة للمعان في جملة أو مفردتين على الأقل، وهي التي أحاطت بكاتب "مراثي دوينو"، ستظل البئر الوحيدة التي يُنزل إليها رفقة دلوه ليشرب. ونحن نقرأ قصيدته، لن نعرف الطريق التي نسلكها. يتركنا رفقة تماماً عند باب مخيلته الحادة، التي تتمدد في الصورة الشعرية عموديا وأفقيا بمنهجية، يحاول من خلالها تفسير النفس، وربما التآلف بين قوتها وقوة الطبيعة، وترجمة الذات من خلال إعادة تكوين توازنات هذه الطبيعة، لكن بنبرة خافتة وقاسية، تزيد من حجم تساؤلاتنا حول الكتابة عنده. قراءة رفقة، تعني، أن تقرأ طبقات عدة تتداخل وتتلاطم وتتفتت، لتعيد في مخيلتنا تمركزها، بحلة لا تشبه ما كانت عليه. هذه الطبقات، تبدأ أولاً من النبرة الداخلية، موسيقى جنيّات الشعر لديه، اللواتي يقدنه دائماً إلى تفكيك مفاصل قيم ثابتة، التأمل بها، وإعادة موضعة الذات من خلالها. هناك أيضا الامتداد النفسي والفلسفي في شعره، التداخل ما بين الميتافيزيقي والذاتي، المثالي والبراغماتي من حيث اعادة تدويره الثوابت والظواهر. بحث حثيث عن حضور الأنا، مكانها، فضائها، صيغتها، انتمائها، سياقها، علاقتها بالحياة، وجودها الهش في المدينة. الأنا التي يسعى الى تجميع فتاتها، وملء فراغات أسئلته الفلسفية بها. إنه جامع لآثارها من دون هداية، أكثر منه متمكناً من شكلها النهائي. لن تعود الطبيعة في دواوينه، محض حاجة تقنية، أو سبيلا لبلوغ القصيدة، بل ستؤول القاموس الاكثر مرونة له، لاختبار مفرداتها مرة أخرى، متصلاً على الدوام بأشباح شعراء عالميين، وفلاسفة، وأشخاص أسطوريين كذلك.
من الصعوبة بمكان إرساء أحكام نقدية جازمة في قصيدة فؤاد رفقة، هذا لأن الشاعر ثبَّت ملامح كونه الشعري، منذ البدايات، وحدّده، وتحرّك داخله، وهذا ما وجّه أبصاره في الاستعارة، نحو صياغات ظلت لصيقة به. لذلك، فإن خلو قصيدته من السياسي، أو اليومي، أو التفاصيل، أو السرد، وإبقاءه مسارات جوانية في المقابل، ومعالجات حادة للصورة الشعرية والمجاز، لا يمكن إلا أن يشير بالبنان الى توحده ككائن يرى العالم بعيني الشجرة والحقل والغيمة والغصن والاخضرار والفسحة وتزاحم كائنات بدائية وتوحشها. انفراده بلغة التراكيب الرومنطيقية، حد التطرف، دفع به إلى تسجيل موقف نافر من شعراء عرب كبار، آثروا الاشتغال على تجليات جديدة في النص الشعري، متمسكاً بالشعلة التي حمَّله إياها الالمان القدماء، رافضاً إفلاتها كرماً لإغراءات الحداثة التي لم يستثغها كما نستنتج من مقابلاته في السنوات الأخيرة. تجربته مع ألمانيا، زلزال أو هزة في عالمه الشعري، كما يقول، وقد شعر براحة كبيرة عندما اكتشفها. لا شك أن رفقة الذي فاجأنا رحيله، اشتملت ذاكرته الثقافية على ثالوث شعري، فلسفي، موسيقي، لا سيما أن كلاسيكيي ألمانيا، لم يغفلوا لحظة، الاصوات التي تختزنها لغتهم، وهذا ما حدا به إلى إدانة مترجمين اعتبر أنهم أفرغوا النص الألماني من محتواه الصوتي.
ربما كان رفقة الرسول الذي دوَّر عنه الألمان طويلا، ليبعث بأدبهم إلى البلاد العربية. كان كساعي بريد يغيب عنا ليوصل الأمانة إلينا بعد حين، وجعلنا نبني صورته على أساس أنه الشاعر الغائب، تنوب عنه قصيدته، وتشدد على انطوائيتها وإخلاصها لكينونة محددة، ولا تغامر في معترك التفاصيل. لكن، أين مكث رفقة بالتحديد؟ أفي الترجمة؟ أم الشعر؟ أم الفلسفة؟ مهما يكن من أمر، فقد قال ذات مرة "في طبيعتي، شعرية فكرية"، وهذا ما يعكس حرصه على التوأمة بين الشعر والفكر، وتغليف إحساسه بأشياء العالم بتلك الكسوة الفلسفية التي كانت تردّه إلى بدائيات هذا العالم، كما إلى ذاته المتقشفة، والساعية لملء فراغ ذاتها.
نبذة
ولد فؤاد رفقة (1930 - 2011) في قرية الكفرون السورية على أطراف وادي النصارى. حين بلغ العاشرة، انتقل مع عائلته الى بيروت، حيث تابع دراسته التكميلية والثانوية في طرابلس. انتقل بعدها (1949) الى الجامعة الاميركية في بيروت، واتم دراسته فيها حتى نال الماجستير في الفلسفة الغربية، عن اطروحة تناول فيها فيلسوفاً انكليزياً ينتمي الى المدرسة الوضعية. لكن ألمانيا فتحت له ذراعيها بمنحة دراسية من جامعة توربينغن ليحمل الدكتوراه عن أطروحة بعنوان "نظرية الشعر عند مارتن هايدغر". في الكفرون، لطالما شعر فؤاد رفقة بميل الى الطبيعة والتأمل، فكان يمضي غالب وقته في البساتين والبراري، وحيداً مع رائحة الارض والهواء والماء. وهذ ما بلور ذاكرته الشعرية ووسمها بذلك الفضاء. كان عمره 13 سنة، حين ألقى أول قصيدة له اثناء عرض مسرحي في المدرسة. ترجم فؤاد رفقة ريلكه وتراكل وهولدلرن وهرمان هيسه ونوفاليس وسواهم. من أعماله الشعرية "مرساة على الخليج”، “حنين العتبة”، “العشب الذي يموت”، “علامات الزمن الأخير”، “قصائد هندي أحمر”، “جرّة السامري”، “سلة الشيخ درويش”، “أنهار برية”، “عودة المراكب”، “خربة الصوفي”، “كاهن الوقت”، “أمطار قديمة”، “خربشات في جسد الوقت”، “بيدر”، “مرثية طائر القطا”، “تمارين على الهايكو”، و”محدلة الموت وهموم لا تنتهي”.
مازن معروف
النهار
15-5-2011
*******
فؤاد رفقة... غياب ناسك البراري
رحل الشاعر فؤاد رفقة (1930 – 2011) بصمت تماماً كما قصيدته، وهو منذ ديوانه «مرساة على الخليج» الذي صدر عام 1961 عن «دار مجلة شعر»، كان مشغولاً بمسألة الوجود، وهو الشاعر الذي انتمى الى مجلة «شعر» عام 1957، فكان الى جانب يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ ومحمد الماغوط، لكنه بالقدر نفسه لم يكن صاخباً مثل أقرانه أو رعيله، فكان أحد الرواد لكنه لم يكن نجماً ولا «صاحب مدرسة»، فبقي حتى أيامه الأخيرة مشغولاً بالشعر الألماني الممزوج بالفلسفة وفي كتابته انهمك في أسئلته وهواجسه الوجودية والطبيعية.
فؤاد رفقة الذي زاوج بين الشعر والفلسفة، ترك وراءه مجموعة من الدواوين أبرزها: «مرساة على الخليج»، «حنين العتبة»، «العشب الذي يموت»، «علامات الزمن الأخير» «أنهار برية»، «عودة المراكب»، «خربة الصوفي»، «كاهن الوقت»، «بيدر»، «مرثية طائر القطا»، «تمارين على الهايكو»، «محدلة الموت وهموم لا تنتهي»، و{عودة المراكب» التي يستهلها بشبه مقدمة أسماها «إشارة»، وقال فيها: «سنة 1961 ظهرت مجموعة شعرية عنوانها «مرساة على الخليج»، في هذه المجموعة البكرية رفع الشاعر مرساته وغامر صوب الأفق من دون أن يعرف الى أين، في هذه المغامرة عرف الأقاليم والخلجان، تعلم لغات غير موطوءة، وفي نهاية المطاف أدرك أن النجوم البعيدة تظل بعيدة، فعاد الى شباكه الممزقة صيد أقل بكثير من الحلم.
يعرف الآن أنّ المهمّ في هذه المغامرة هو المغامرة ذاتها، لا نتائجها، فالنتائج كلها حشيش يابس في النّار، كذلك يعرف الآن أنه في هذه المغامرة كان عليه أن يسكن العزلة القداسة، فالخصومة بين الإبداع ونداء الجسد قديمة ودائمة الهدير، وهو يعرف الآن أنّ ما أصابه في هذه المغامرة لم يكن مصادفة، فالأقدار أبداً ودائما ترسم الخرائط والاتجاه». وختم رفقة بقصيدة: «أيتها الأرض/ هو ذا ابنك الضال/ من التيه في الأنواء/ بلا وجه يعود/ فضمدي شظاياه/ مدي له السرير/ أغلقي النوافذ/ واطفئي الشموع../ رائعة كانت البحار/ تحت الشمس/ رغم الصواعق».
كتب فؤاد رفقة سكونه الروحي وطقوسه الدينية، وتجلياته بين الكلمة والذات، بين الطبيعة والإنسان، بين الأرض والحياة، بين الزمان والمكان، فهو كأنه يجلس في صومعة تارةً، وبين أحضان الطبيعة طورًا، متأملاً، غارقًا في ما يسميه «وادي الطقوس» (عنوان أحد كتبه)، تلك الطقوس التي تنتج العبارات الدافئة، وبخور المعنى، وصلاة الكلمات، وقداديس الشعر، تلك الطقوس التي ترشدنا الى أن كل شيء يصل الى اللاشيء، أو السيزيفية التي أيضًا هي مرآة كل شيء.
وفي قصيدة «باشق» من ديوان «عودة المراكب»، قال رفقة: «قفص معدني/ من ثقوبه/ باشق يلمح الأحراج/ رائحة الوعر: يدور/ حول نفسه يدور/ يتعثر/ يسقط/ في ريشه يغيب/ تحت أشلاء الصور/ صديقان هو وحطاب الشعر». هل الشاعر حطاب؟ كتب رفقة شعر الحداثة في أجواء الريف والأرض والفلاحين بعيداً عن المدينة وأحوالها وزحمتها. بل كتب ما يشبه التنديد بالتقنية الحربية: «تحت رمانة خريفية/ آخر النهار،/ نعاس،/ لا ذاكرة ولا أحلام،/ فجأة/ عبر الأطلسي/ إف 16 تشق المحيط/ في سماء النجوم والأقمار/ ترسم خرائط الدماء».
رأى رفقة أنه لا يمكن فهم أي شاعر من دون خلفية فلسفية، «مثلما لا يمكن فهم هايدغر من دون الاطلاع على ريلكه وهولدرلن وتراكل... حتى أن بعض الفلاسفة في ألمانيا يعتبرون الشعر أهم من الفلسفة. إذا أردت أن تعرف نظريتك مضبوطة أم لا، إقرأ الشعر».
كتب رفقة أطروحة الدكتوراه في الفلسفة حول مفهوم «الجمال عند هايدغر»، وهو اعتبر أن الثقافة، الشعر والفلسفة تتواءم في داخله. وشعره يستلهم من الفلسفة، تمامًا كما يستلهم فكره من الشعر. وعلى هذا فقصيدته «إف 16» تذكّرنا بالفلسفة الهايدغرية، إذ أشار هايدغر الى أن انتشار التقنية يصاحب بانسحاب لـ{موضوعات» الطبيعة التي تترك المكان للأشياء القابلة للاستهلاك. فـ{الراين» مثلاً، لم يعد ذلك النهر العظيم، نهر شومان وهولدرلن، نهر المنظر الجميل، وإنما «غدا موضوع زيارات تنظّمها وكالة أسفار أقامت على ضفافه صناعة خاصة بالعطل».أما الغابات فأصبحت «مناطق خضراء» أي كائناً داخلاً في مخطط استهلاكي».
مع انتشار التقنية إذاً أصبحت الطبيعة كلّها «مدخرات». لكن الغريب أن الادخار لا يحيل هنا الى الثبات والبقاء والدوام. وإنما، على العكس من ذلك، الى الحركة والانتقال والزوال. لذا قال هايدغر «إن الكائن اليوم هو الكائن القابل للاستبدال». حتى الموت فقد اخترقته الطائرات، «فعلى/ على إصابة الرأس/ يتدرب الطيار». وفي مجموعته الأخيرة «محدلة الموت وهموم لا تنتهي» سأل رفقة الحياة والما – وراء، مثلما سأل الشعر، الذي كان يغريه ويدفعه إلى الكتابة في رحلة غنية ومليئة بالتشعبات. ونرى أن مناخات هذه المجموعة الأخيرة لا تشذ عن أجواء مجموعاته الأخرى حيث «لو يرى الموت/ أنه الجمجمة/ ألا يشتهي المقصلة؟».
من خلال ترجمات ?عمال الشعراء ا?لمان ريلكه ونوفاليس وهيسه وسيلان وبريشت وغوته، عمل رفقة – وكثيراً ما كان ا?ول في ذلك - على تعريف الدول التي تتحدث العربية بروائع الشعر ا?لماني. كذلك، أدى دور الوسيط بين العوالم الفكرية للشرق والغرب من خلال عمله أستاذاً للفلسفة فى الجامعة اللبنانية ا?ميركية في بيروت. والالتقاء بين الشعر ا?لماني والفلسفة والذي وصفه رفقة يوماً بأنه «زلزال هزّ كيانه»، كان له تأثير مستمر حتى ا?ن على إنتاجه الشعري.
باختصار، يمكن القول إن فؤاد رفقة ساهم في إغناء التلاقي الألماني العربي من خلال الثقافة والشعر، فهو كان المطلع تماماً على هولدرلن وهايدغر وواسع الاطلاع على الشعر الألماني، وكان يعرف تراث هذا الشعر والكثير من الشعراء الألمان.
فؤاد رفقة، «السوري الأصل»، المولود في الكفرون (قرب حمص) قلّ ما يُعرف أنه من سورية، بل يُعرف على أنه شاعر لبنانيّ.
من قصائده
خربشات في جسد الوقت
من الظلم أن نتوقع من الكرمة ثمراً غير العنب، ومن الإنسان غير ما عنده.
في حفلة البارحة كان ساطع الحضور: سلامات، أحاديث، نظريات، نبيذ متعدد اللون. لكنه في الأمسية عينها كان الغائب الأكبر. بين اللحظات كانت تبرق من ثقوب العمر ملامح قديمة، متآكلة، في هدوء تتسرب إلى القلب وتصمت، كطائر في قفص، بين عينيه روائح إحراج لن تعود.
الحياة سلسلة من البدايات: شفق يتسرب من جدائل الليل، شمس تنحني على شفة البحر، لحن وراء نافذة، طائر يوقظ الفجر، عجوز في الشارع، غيمة، ثمرة فجة تلطم الأرض، وجه امرأة في المطار: هذه التفاصيل وسواها مفارق للرؤية الصاحية، للرؤية الواسعة الأحداق.
اليوم ذكرى ولادته. يخاف الالتفات إلى الخلف، يخاف أن يقوم بجرد حساب. فالغلَّة أقل بكثير من الدمع والأوجاع.
الطبيعة كائن حيٌّ، طاقة غير محدودة الأوتار والأحاسيس. ومع هذا، يعرِّيها الإنسان المعاصر، يجرِّدها من عباءتها، من أساطيرها وأسرارها، يحوِّلها إلى جسدٍ ميتٍ طمعاً بالمال والسلطة.
طويلاً تصبر، لكنها في النهاية تنفجر. فلا الصواريخ تجدي، ولا مركبات الفضاء، وقت الأعاصير وهدير البراكين
 |  |
| متسلماً جائزة غوته |
الجريدة
15-5-2011
* * *
فؤاد رفقة الذي مات وفيه شيء من ريلكه
عندما دخل الشاب الصغير إلى معهد غوتة في بيروت لم يعتقد أن تلك اللحظة ستقرر مستقبل حياته. هناك على أحد الرفوف لفت نظره كتاب جعله يتوقف عنده، مَنْ منا نحن عشاق الكتب النادرة لا يعرف ذلك، هناك بعض الكتب تظل مستلقية على الرفوف زمناً طويلاً، ربما غطاها الغبار، لكنها لا تصرخ إلا عندما ترى مَنْ إنتظرته طويلاً. «مراثي دوينو»، هو أحد هذه الكتب، وإلا ما الذي جعل الشاب القادم أصلاً من «كفرون»، قرية سورية صغيرة واقعة في إقليم النصارى، لم تعرف كتاباً غير الإنجيل، أن يتجه صوب الكتاب ذاك مباشرة، ليس فقط يأخذه بين يديه، يقلبه ثم يبدأ بقراءة قصائده المترجمة عن لغة وسيطة، الإنكليزية، وحسب، بل أن يضعه في جيبه ويأخذه معه إلى البيت؟
عندما يروي الشاعر اللبناني السوري الأصل فؤاد رفقة تلك الحادثة التي حدثت له قبل ستين عاماً، حين كان ما يزال في العشرين من عمره، يحمر وجهه خجلاً، لا يريد أن يُقال عنه إنه سارق، أن سارق الشعر، هذا ربما لتربيته المسيحية، أو ربما لحبه أن يقرأ آخرون القصائد، ذهب بعد أسبوع إلى مدير معهد غوتة في دمشق، وأعترف له بسرقة الكتاب. ضحك المدير في حينه، يقول رفقة، وطلب منه أن يحتفظ بالكتاب، سيوصون بجلب نسخة جديدة إلى المكتبة. ولمفاجأته، لم يعرف رفقة أن المدير سيكافئه أيضاً بمنحة دراسية في الجامعات الألمانية عن طريق مؤسسة دي. آ دي. للتبادل الثقافي ليبدأ بعدها مشواره الحياتي، وأين؟ في مدينة توبينغين في إقليم بادين فوتينبيرغ، هناك حيث أقام قريباً من جامعتها قبله بعقود الشاعر الذي سترتبط حياته به كلها: راينر ماريا ريلكة.
المدينة التي تشتهر جامعتها حتى اليوم بتدريسها الفلسفة، والتي درس فيها العديد من الفلاسفة الألمان، كانت على الدوام مزاراً للشعراء الألمان. من هنا مرّ شيللير وغوتة. هنا أقام هولديرلين وريلكه. فؤاد رفقة يعرف ذلك، الدرس الأول الذي تعلمه هناك هو إرتباط الشعر الألماني بالفلسفة، من الصعب الفصل بين الإثنين، الشعر الإنكليزي مثلاً يعتبر الفلسفة هرطقة، الشعر الفرنسي يلعب باللغة، أما الفلاسفة الألمان فنظروا إلى الشعر نظرة إحترام والعكس صحيح أيضاً، بعض الفلاسفة كتبوا الشعر أيضاً، نيتشة مثلاً، أما هيديجر فمن الصعب تصور فلسفته بدون علاقتها بهولديرلن. كل ذلك جعل ترجماته للشعر الألماني تحمل نكهة خاصة، خاصة ترجمات رفقة التي توازت مع دارسته الجامعية للفلسفة الألمانية، أو رافقت سنوات عمله أستاذاً للفسلفة (الفلسفة الألمانية بصورة خاصة) في الجامعة الأميركية في بيروت. رفقة يعرف ذلك، ولا أظن أن مترجماً في البلدان الناطقة بالعربية إعترف مرة بخطأ أو قصور ترجمات له كما صرح رفقة بخصوص ترجماته الأولى لريلكه. تلك هي ميزته، أن يظل أميناً لمشروعه الذي أسس حياته عليه: أن يكون جسراً روحياً ووجدانيا بين الثقافتين الألمانية والعربية.
ولكن حتى الترجمات هذه، «الهرمة» أو «الركيكة» كما وصفها محرر ثقافي لبناني «نمام»، أثرت في جيل كامل من الشباب. أتذكر دهشتي وأنا أتصفح كتاب «مراثي دوينو». كانت بداية قراءاتي، ولحسن الحظ كان مبلغ مصروف الجيب الذي كان في حوزتي قد سمح لي بشراء الكتاب، كانت تلك هي المرة الأولى التي عرفت بها بإسم ريلكة، وشكراً لفؤاد رفقة الذي جعل شاباً صغيراً مثلي يعثر على رفيق روحي له، وأين؟ في المكتبة الوحيدة في العمارة، في مدينة صغيرة بجنوب العراق. «مراثي دوينو» وبعدها «أغاني أورفيوس»، أصبحا بمثابة إنجيلين لجيلي، تناقلناهما من يد إلى يد.
«مراثي دوينو»، الذي هو بداية علاقتي بالثقافة الألمانية، والتي إنتهت بدراستي للأدب الألماني أولاً في جامعة بغداد، ثم تكملة الدراسات العليا في جامعة هامبورغ، هو أيضاً بداية لرحلة طويلة للشاب فؤاد رفقة، حصيلتها ترجمة إحدى عشر مجموعة شعرية ألمانية إلى العربية، آخرها «قصائد ألمانية معاصرة»، والتي ترجم فيها رفقة أكثر من 36 شاعراً إلى العربية، حتى أن أحد النقاد الألمان علق قائلاً، أن الرجل هذا أنجز العمل هذا وهو ما يزال يمشي على قدميه.
أنا الآخر تعرفت على رفقة وهو ما يزال يمشي على قدميه. التقينا قبل عامين في مبنى وزارة الخارجية الألمانية، ليبدأ لي معه مشوار بتقديم الثقافة الألمانية في البلدان العربية، كم رأيته سعيداً وهو يتنقل معي، كأنه عثر على المهمة التي إنتظرها طوال حياته، أن يكون سفيراً للثقافة الألمانية، سواء في جولتنا الأولى في كانون الثاني 2009 عبر مدن وجامعات الإمارات العربية المتحدة، أو في جولتنا الثانية في نيسان 2010 عبر بعض مدن المملكة العربية السعودية. في الجولتين، وبدعوة من السفارتين الألمانيتين هناك، عشت مع رفقة المثقف الجدي، واستاذ الجامعة الدقيق في كل شيء، رفقة الملتزم بالبرنامج أكثر من الألمان، وعندما أراه يقف عند باب غرفتي في الفندق في الساعة الثامنة صباحاً، كما هو المطلوب، اقول له، فؤاد نحن لسنا في ألمانيا، فيضحك، ويقول لي، «والله؟ مو هيك؟»، ثم حدثني عما حصل له في عام 1961 عندما بدأ التدريس في الجامعة الأميركية في بيروت، كان يمنع الطلاب المتأخرين، حتى ولو لدقيقتين أو ثلاث من دخول الصف. وحين علم رئيس الجامعة، وأرسل بطلبه، قال له، إن الجامعة أهلية، وتعيش من المبالغ التي يدفعها الطلاب للدراسة، وهو بهذه الطريقة سيجعل الجامعة تفلس، «نحن لسنا في ألمانيا، يا أستاذ»، قال له الرئيس!
في الجولتين «الشعريتين»، تعرفت أيضاً على فؤاد رفقة الإنسان «المتواضع» (وليس «الشاعر المتواضع»، كما نعته المحرر الثقافي النمام ذاته»!)، شكى لي سياسة التهميش والعزل التي تعرض لها على الصفحات الثقافية الصادرة في بيروت، «لا أعرف ماذا فعلت لهم»، كان يقول لي بصوت هادىء، سواء في حديثه عن الشاعر «الكبير» شريكه في المواطنة، الذي يتجاهله تماماً في كل أحاديثه أو كتاباته عن الشعر العربي الحديث أو عن جماعة مجلة شعر الذي ينعته بالشاعر «المتواضع» الضعيف أيضاً، أو سواء في حديثه عن الروائي اللبناني والمسؤول السابق للملحق الثقافي لجريدة لبنانية معروفة: ذات مرة سألني إذا كان ذكر لي كيف أن محرراً أعاب عليه ترجماته لهولديرن وريلكة، وسألني إذا كان تعلم اللغة الألمانية أو درس الفلسفة دون علمه؟ وإلا كيف يمكنه أن يكتب عن ترجمة لـ «مراثي دوينو» و»أغاني أورفيوس» لريلكة نفذها مترجم لا يعرف اللغة الألمانية، بأنها ، «تعد مرجعاً شعرياً ونقدياً في آن..»، وأن صاحبها «ترجمها عن الفرنسية مع الإتكاء على الألمانية«؟ وإذا كان المترجم يعرف اللغة الألمانية، فلماذا لم يترجمها عن الأصل إذن؟ لم أقل له أن المترجم هذا، قال نفسه بترجمته الشاعر البرتغالي بيسوا، ترجمه عن الأسبانية «بعد مراجعة النص الأصلي في البرتغالية»!
في بداية شهر نيسان الماضي كان يجب أن يكون فؤاد رفقة معي في فيلا فالدبيرتا في ضيعة «فالدافينغ» القريبة من عاصمة إقليم بافاريا الألمانية، ميونيخ، وكان يجب أن نعمل لمدة ثلاثة شهور سوية هناك على مشروع ترجمة مشترك. قبل اسبوع من بداية إقامتنا إعتذر رفقة عن المجيء بسبب مرضه، قال لي، أرسل المواد التي تنتهي منها عن طريق الإيميل، الإيميل الأخير الذي تسلمته منه، طلب مني فيه أن أرسل له المواد بسرعة، لأنه سيكون «غير قابل للوصول» في الأسبوع القادم، ولم أعرف، أن «غير قابل للوصول» التي كتبها لي بالألمانية، والتي تعني أنه لن يكون هناك، تعني أنه سيموت. الشقة، التي خصصت لسكنه وزوجته في الفيلا، الشقة التي تطل على بحيرة شتارنبيرغيرسه، يسكنها الآن بدلاً عنه شاب قيرغيزي، يكتب الشعر، عمره عشرون عاماً، ليس في السنّ التي تعرف فيها رفقة على ريلكة وحسب، بل أن آيكة، القرغيزي، هو هنا أيضاً...من أجل ريلكة..فهل عليّ أن أدق عليه الباب الآن!
المستقبل
الاحد 29 أيار 2011