حاوره: خلف علي الخلف
 الناقد محمد العباس يشكل علامة فارقة في الوسط الثقافي السعودي، رغم أنه لا يتمتع بأي نجومية إعلامية، فقد بقي في الظل كخيار ثقافي يدافع عنه، غير أنه لا يغيب عن الراهن الثقافي في السعودية، فهو من أكثر المثقفين اشتباكاًمعه. خاض حورات نقدية مع المشهد الثقافي بشخوصه واصداراته ممارساً فعل التسمية كلما كان ذلك متاحاً إذ – كما يقول عن نفسه - "لا أخشى التوضح ومعالنة الآخرين بانفضاحي، ولكن ككل المخلوقات أستشعر بعض الإعاقة والوقار الماكر في التعبير عن حقيقتي، وفي مقابلة ضآلة وعيي الذاتي بوعي الحياة المتمادي." خلال العقد الفائت تمكن العباس من تكريس اسمه ناقداً متمرساً، ممتلكاً لأدواته. صائغاً لجملته النقدية بوصفها إبداعاً موازياً للنص، لا متطفلة عليه، وهو مما أخذه عليه البعض بوصفه تعالياً على القارئ، إضافة لكثرة استشهاداته فيما يكتبه بكتاب ومصطلحات غربية في الغالب.
الناقد محمد العباس يشكل علامة فارقة في الوسط الثقافي السعودي، رغم أنه لا يتمتع بأي نجومية إعلامية، فقد بقي في الظل كخيار ثقافي يدافع عنه، غير أنه لا يغيب عن الراهن الثقافي في السعودية، فهو من أكثر المثقفين اشتباكاًمعه. خاض حورات نقدية مع المشهد الثقافي بشخوصه واصداراته ممارساً فعل التسمية كلما كان ذلك متاحاً إذ – كما يقول عن نفسه - "لا أخشى التوضح ومعالنة الآخرين بانفضاحي، ولكن ككل المخلوقات أستشعر بعض الإعاقة والوقار الماكر في التعبير عن حقيقتي، وفي مقابلة ضآلة وعيي الذاتي بوعي الحياة المتمادي." خلال العقد الفائت تمكن العباس من تكريس اسمه ناقداً متمرساً، ممتلكاً لأدواته. صائغاً لجملته النقدية بوصفها إبداعاً موازياً للنص، لا متطفلة عليه، وهو مما أخذه عليه البعض بوصفه تعالياً على القارئ، إضافة لكثرة استشهاداته فيما يكتبه بكتاب ومصطلحات غربية في الغالب.
يكتب وينشر في العديد من الصحف والمجلات الخليجية والعربية بشكل دوري. ولد في سيهات(في المنطقة الشرقية من السعودية) عام 1960 وصدر له حتى الآن: (قصيدتنا النثرية: قراءات لوعي اللحظة الشعرية) دار الكنوز الأدبية – (حداثة مؤجلة) سلسلة كتاب الرياض- (ضد الذاكرة:شعرية قصيدة النثر) المركز الثقافي العربي- (سادنات القمر: سرّانية النص الشعري الأنثوي) مؤسسة الانتشار العربي- (شعرية الحدث النثري) مؤسسة الانتشار العربي في حواره مع إيلاف حاولنا أن نبتعد عم هو نقدي أدبي ونقترب مما هو ثقافي نقدي.
 * هناك تحولات نحو أفق أكثر انفتاحاً (كي لا نقول ديموقراطياً) في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما تحت ضغط "التحولات الجارية في" العالم، وهذا جعل تداول مفاهيم جديدة (على المنطقة) أمراً متاحاً: المواطنة، الحوار الوطني، الاصلاح، السلم الاجتماعي، المجتمع المدني، حرية وحق التعبير... وقد سعت المؤسسات الرسمية الى محاولة الافادة من صوت المثقف "بشروطها" لزحزحة التحكم الكلي لقوى الممانعة التي تنتج نسقاً استبداديا في الحياة.. كيف ترى الى محاولة الدمج التي تقوم بها السلطات؟ هل يستطيع المثقف أن يكون فاعلاً بشروطه بعد أن يوائمها مع شرط "المؤسسة "، خصوصا أن سياسة انكفاء المثقف وعزلته لم تثمر عن شيء؟ وهل تعول على هذه التحولات في أن تنتج تغييراً في الذهنية العامة المتشكلة وفق شروط غياب هذه المفاهيم (الجديدة)؟ إذاً، هل يستطيع المثقف أن يكون فاعلاً من داخل المؤسسة "وهو الشرط المتاح حالياً" ويحافظ على استقلاله؟
* هناك تحولات نحو أفق أكثر انفتاحاً (كي لا نقول ديموقراطياً) في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما تحت ضغط "التحولات الجارية في" العالم، وهذا جعل تداول مفاهيم جديدة (على المنطقة) أمراً متاحاً: المواطنة، الحوار الوطني، الاصلاح، السلم الاجتماعي، المجتمع المدني، حرية وحق التعبير... وقد سعت المؤسسات الرسمية الى محاولة الافادة من صوت المثقف "بشروطها" لزحزحة التحكم الكلي لقوى الممانعة التي تنتج نسقاً استبداديا في الحياة.. كيف ترى الى محاولة الدمج التي تقوم بها السلطات؟ هل يستطيع المثقف أن يكون فاعلاً بشروطه بعد أن يوائمها مع شرط "المؤسسة "، خصوصا أن سياسة انكفاء المثقف وعزلته لم تثمر عن شيء؟ وهل تعول على هذه التحولات في أن تنتج تغييراً في الذهنية العامة المتشكلة وفق شروط غياب هذه المفاهيم (الجديدة)؟ إذاً، هل يستطيع المثقف أن يكون فاعلاً من داخل المؤسسة "وهو الشرط المتاح حالياً" ويحافظ على استقلاله؟
مقولة أن المثقف الخليجي شديد التماهي مع المؤسسة مقولة صحيحة في ظاهرها ولكنها غير مستقرة في جوهرها، وهي بحاجة إلى شيء من الاحتراز والفحص النقدي قبل التسليم بها، فالمثقف نتاج حركة اجتماعية وتاريخية لا يمكن للمؤسسة كوصي ثقافي مهما بلغت من الاستئلاه، بتعبير كونديرا، أن تعيد تخليق الذوات الإنسانية بمعزل عن مجرات التأثير الكونية، وهو أمر يبدو على درجة من الوضوح، حيث الوقوع تحت تأثير مهبات العولمة، وما ذلك التكثّر في مظاهر الربيع الديمقراطي الصوري، الذي تتناسل منه جملة من العناوين الحقوقية إلا نتيجة طبيعية لانفتاح المشهد الثقافي العالمي على فكرة التعدد والتنوع والإختلاف كتداعيات ضاغطة لإعادة تعريف الثقافة وفق تحولات يصعب الإفلات من استتباعاتها. ولأن المؤسسة دائماً على درجة من الدهاء والاستعداد لتفريغ إي لحظة استحقاق من مستوجباتها، كثر الطرق على ذات العناوين من زاوية مغايرة بواسطة طراز من المثقفين المنذورين على الدوام لإجهاض أي محاولة تنويرية حقيقية، من خلال المثقف المؤسلم مثلاً، الذي يشكل حجر الزاوية في مشروع المؤسسة، من حيث ممانعته لاستزراع أي قيمة من قيم الحرية الإنسانية داخل خطاب التغيير الإجتماعي، فالديمقراطية مثلاً، بما هي جوهر الفعل الثقافي، محرّمة، ومرفوضة، وممنوعة من التداول، بحجة أنها منتج من منتجات "الآخر" لفك ذلك التلازم البنيوي بين المركبين، أعني الثقافة والديمقراطية، وبالمقابل تتكئ المؤسسة على مثقف انتهازي، حداثي المظهر، سلفي الروح، يعاد إنتاجه وفق مواصفات تؤهله لأن يكون جهداً تعبوياً مضاداً، حيث يزدحم خطابه بمزيج من الدعاوى والشعارات التي سطا عليها من دوائر ثقافية نائية وصار يلهج بها بلكنة حداثية، وبمزاعم تنويرية، ولكن دون فاعلية، فمهمته تنحصر في الإبقاء على حالة الاحتقان التي تدفع بالمثقف إلى الهامش، وافتعال المعارك الهامشية لمشاغبة الفصيل الثقافي المضاد بدعوى التأصيل وتمتين الجبهة الثقافية الداخلية، وفي هجاء "الآخر" للفرار من استحقاقات نقد "الذات" والتنصل من مهمة إثارة الوعي مكتفياً باستعراض مظاهر الخراب، وهو ما يعني الترويج الاستئثاري لفكرة الوحدوي والشمولي والامتثالي المتعارضة أصلاً مع فكرة "الاختلاف" وما يتداعى من ذلك المكمن الحيوي من نزعات الفردانية والتشظي والإنشقاق. وعليه يمكن القول أن العمل من داخل المؤسسة مجرد حيلة لا يعتنقها إلا أشباه المثقفين لتكريس الصورة الأحدث من صور الاستبداد الثقافي، الذين يجدون في المؤسسة ملاذهم، ويرهنون خطاباتهم الواهية كروافع لمنتجات معطوبة، مهما حاولت المؤسسة إقامة الحجة في المشهد بتبريز أسماء ذات بريق إعلامي، وخواء فكري، فالمثقف المنتج للمعرفة، كما تقول بذلك التاريخانية كصيغة من صيغ النقد التاريخي العابرة للمجالات المعرفية، هو نتاج بنية إختلافية، وليس مجرد صورة من صور التوليد المزوّر للثقافة المؤسساتية، وبالضرورة هو روح ناقدة ومتمردة ومحتجة بل تدميرية، حتى وإن وجد في مجتمع غير ناقد أصلاً، ومثل هذا الكائن نادر الوجود في مشهدنا، ويصعب على المؤسسة استدماجه أو التعاطي معه بشروطه، إن وجد، وبالتالي تلجأ إلى خلق حالة من أحوال الشبه، أي توليد نسخ محرّفة للحداثة والحداثيين الشكلانيين لا الإشكاليين، لفرض شروط الحضور على الذوات المثقفة، ولكن هذا الحصار لا يقنع المثقف الحقيقي بالتنازل عن خطابه التحرري، وإن كان يحد من نشاطه حيث تورطه المؤسسة في صراع مع القاعدة الإجتماعية فيما يشبه الاستنحار الثقافي، بمعنى أن يقبل الترويج لمنتج فاسد، وتسليع الخيبات المعرفية والجمالية، تحت عناوين حداثية مضللة، كما امتهنها طابور من المثقفين الذين ارتقوا بخطابهم إلى مستوى المؤرخين المزّورين، من حيث قراءاتهم التأويلية لكل تلك الهباءات السياسية والاجتماعية والثقافية على حافة الحداثة، وهو أمر لا يطيقه المثقف الحقيقي حتى وإن كان مآله الغياب، حيث ينتج في عزلته المضاءة بذاته المنكسرة خطاب الظل البديل.
 * يبدو حديثك هنا منصباً على نقد المؤسسة، وهذا أمر مبرر ومطلوب، لكنك وفق هذا السياق تنحي جانبا المواجهة مع القاعدة الاجتماعية وتعتبر أن خوضها، ماهو إلا استدراجا من المؤسسة للمثقف لاستنحاره... بينما أرى "كما كثيرين غيري" أن القاعدة الاجتماعية هذه هي أشد قمعاً لكل الاشكاليات التي طرحتها، من المؤسسة ذاتها! بل يمكن تأول تردد السلطات حيال القيم الليبرالية والحداثية انه واقع تحت ضغط وخوف من هذه القاعدة، في أحد جوانبه. ألا ترى أن هذا يبدو هو الأسهل للمثقف؟ أي أن يحمل المؤسسة عدم فاعليته في القاعدة الاجتماعية، التي يتحكم فيها افتراق طروحاته عن الوضع الماثل للعيان للناس والاليات التي تنتج حيواتهم وتفكيرهم. أي أن خطاب الظل ليس اختيارياً للمثقف نتيجة علاقة المؤسسة معه. بل هو خيار تحكمه شروط القاعدة الاجتماعية وأنا أتحدث هان عن العموم، الغالبية؟
* يبدو حديثك هنا منصباً على نقد المؤسسة، وهذا أمر مبرر ومطلوب، لكنك وفق هذا السياق تنحي جانبا المواجهة مع القاعدة الاجتماعية وتعتبر أن خوضها، ماهو إلا استدراجا من المؤسسة للمثقف لاستنحاره... بينما أرى "كما كثيرين غيري" أن القاعدة الاجتماعية هذه هي أشد قمعاً لكل الاشكاليات التي طرحتها، من المؤسسة ذاتها! بل يمكن تأول تردد السلطات حيال القيم الليبرالية والحداثية انه واقع تحت ضغط وخوف من هذه القاعدة، في أحد جوانبه. ألا ترى أن هذا يبدو هو الأسهل للمثقف؟ أي أن يحمل المؤسسة عدم فاعليته في القاعدة الاجتماعية، التي يتحكم فيها افتراق طروحاته عن الوضع الماثل للعيان للناس والاليات التي تنتج حيواتهم وتفكيرهم. أي أن خطاب الظل ليس اختيارياً للمثقف نتيجة علاقة المؤسسة معه. بل هو خيار تحكمه شروط القاعدة الاجتماعية وأنا أتحدث هان عن العموم، الغالبية؟
خطاب الظل خيار من الخيارات وليس مآلاً حتمياً، وهنا تكمن أهميته كخيار للمتحررين من أوهام الوعود والشعارات، والقاعدة الإجتماعية في جانب من أهم جوانبها البنيوية هي آلة مصنّعة بواسطة السلطة، وترتبط تلك القاعدة مع المؤسسة بعلاقة من علاقات التبني الصريح والاسترضاع الدائم، أي أنها لا تقوم على مركبات الخوف والضغط والقسر بقدر ما تحاول زرع هذه الأوهام في الوعي الجمعي لتعطيل الاستحقاقات. ولا أعني هناالسلطة السياسية وحسب، بل كل أشكال التسلط الديني والسياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن مواجهة هذه التشكيلات الضاغطة، يعني التجابه مع الأصل وليس مع الأداة، وما كل ذلك التحجر والقمع والرغبة في مصادرة الرأي الذي تبديه القاعدة الإجتماعية، إلا نتيجة طبيعية ومدروسة من قبل مفاعيل السيطرة التي تجيد تخليق حوائط صد لأي فكرة تنويرية، كما يمكنها تشريس تلك الذوات بدافعية (العرف) مثلاً مقابل وساعات (الشرع) وعليه فإن نصب مرآة كبيرة أمام تلك القاعدة الإجتماعية لكشف عيوبها، أو تضخيمها لا يعني إلا التورط في معركة تدور رحاها في الهامش. صحيح أن القاعدة الإجتماعية لا تمتلك السجون والمعتقلات، وآليات القهر المادية، وليس لديها صلاحية تشريع القوانين القامعة للحريات، ولكنها تمتلك آليات العزل الإجتماعي والتنكيل النفسي، ولديها من الاستعداد لتشكيل ما يسميه فوكو "ميكروفيزيائية السلطة" التي تتمدد في كل أنسجة المجتمع فتفرض رقابات "العيب" ورهاباته المتنوعة كما تتمثل في التلصص والحرمان والإشاهة، والحياة العربية مليئة بالشواهد الحية، خصوصاً مع توفر خطاب إعلامي انتهازي يعزز من قدرات الجماعات الضاغطة. وكل ذلك يتحرك تحت أنظار المؤسسة، ووفق خطة معلنة، وتحالف صريح بينهما، لدرجة يبدو فيها التماهي بين المؤسسة والقاعدة كبيراً الى حد التطابق، وهنا يقع المثقف في خطيئة الاستقطاب، حين يحاول فك الارتباط بين القاعدة الاجتماعية والمؤسسة، واستجلاب ذوات متململة أو شاردة من ذلك الحيز، وهو أمر لا يمكن التعويل عليه ضمن المجابهة الآنية المكشوفة، على اعتبار أن المثقف يؤمن بتاريخانية الأفكار والمعارف والجماليات، ويراهن على أن الوعي يترسب في الكائن البشري عبر مراكمات زمنية، وليس كاستجابة لضرورات اللحظة، لدرجة أنه يصاب بالشك في وعيه ومنهجيته عندما يستشعر شيئاً من التماهي والتماثل مع القاعدة الإجتماعية، حيث ينتفض ليعيد موضعة نفسه بمنأى عما يمكمن أن يكون ملاذاً محرّفاً، أو هذا ما يفترض من الكائن المقيم في "خطاب الظل" سواء كان معزولاً أو منعزلاً، هارباً أو مطروداً، المهم أنه يمارس "القطيعة" كموقف ويعلنها على إيقاع انتاجية مضادة، ليؤسس هو الآخر لشروط بقائه، ومستوجبات حضوره الفاعل، فجمال حمدان أنتج موسوعته وهو في في الظل الأشد عتمة، والمهدي المنجرة حقق فرادته وهو في حالة من التواري داخل الظل الرخيم، رافضاً التعاطي مع القاعدة الاجتماعية وفصيل من المثقفين المزورين إلا من وراء العازل الطبي، فالظل هو الأصل الجمالي إذا ما جاز لنا الإتكاء على فلسفته الجمالية كما أرساها الياباني جونيشيرو تانيزاكي في كتابه "مديح الظل".
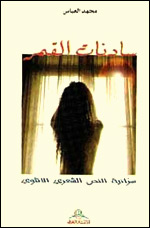 * في الخليج الآن هناك تواطؤ معلن بين النخب الحاكمة وجمهرة المثقفين، لمواجهة "قوى التطرف" كما يسميها الخطاب الرسمي والخطاب المندرج في سياقه، إلا أن الطرفين يقفان (برأيي) عند حافة المعضلة ولا يواجهان أسها الاساسي الفكري، وييدو هذا الأمر "براغماتياً" إذ أنه يعي افتراق الناس "بالعموم" عن هذا الخطاب (التنويري)، بل أن ثقافة ممانعة التغيير(وفق المفاهيم المتداولة الآن) لم تعد بحاجة الى إعادة انتاج حتى، من هذه القوى، فهي أضحت مكرسة بعقل جمعي. المثقف يواجه معضلة لا تتعلق بسقف السلطات المسموح، فهو يصيغ خطابه، مدارياً للبنية الفكرية الاجتماعية السائدة ومحابيا لها ومقلما لافكاره التي يطرحها لتناسب هذه البنية وتماشيها. اذاً هو يلامس هذه البنية من اطرافها دون الولوج الى مركزها وتفكيكها او حتى مسائلتها.. أنت كأحد المشتغلين تحت هذا السقف (كما أرى) كيف ترى الى دور المثقف "الذي يراه البعض بالضرورة تنويرياً" وفق هذا السياق؟ هل يستطيع أن يكون فاعلاً دون أن يكون صادماً، إذا كان صادماً للمستقر الجمعي هل سيلاقي قبولاً عاماً وذلك هو ما يعطيه قوة التأثير؟
* في الخليج الآن هناك تواطؤ معلن بين النخب الحاكمة وجمهرة المثقفين، لمواجهة "قوى التطرف" كما يسميها الخطاب الرسمي والخطاب المندرج في سياقه، إلا أن الطرفين يقفان (برأيي) عند حافة المعضلة ولا يواجهان أسها الاساسي الفكري، وييدو هذا الأمر "براغماتياً" إذ أنه يعي افتراق الناس "بالعموم" عن هذا الخطاب (التنويري)، بل أن ثقافة ممانعة التغيير(وفق المفاهيم المتداولة الآن) لم تعد بحاجة الى إعادة انتاج حتى، من هذه القوى، فهي أضحت مكرسة بعقل جمعي. المثقف يواجه معضلة لا تتعلق بسقف السلطات المسموح، فهو يصيغ خطابه، مدارياً للبنية الفكرية الاجتماعية السائدة ومحابيا لها ومقلما لافكاره التي يطرحها لتناسب هذه البنية وتماشيها. اذاً هو يلامس هذه البنية من اطرافها دون الولوج الى مركزها وتفكيكها او حتى مسائلتها.. أنت كأحد المشتغلين تحت هذا السقف (كما أرى) كيف ترى الى دور المثقف "الذي يراه البعض بالضرورة تنويرياً" وفق هذا السياق؟ هل يستطيع أن يكون فاعلاً دون أن يكون صادماً، إذا كان صادماً للمستقر الجمعي هل سيلاقي قبولاً عاماً وذلك هو ما يعطيه قوة التأثير؟
لم يبالغ سارتر حين وصف فصيلاً من المثقفين الانتهازيين بمجرمي السلم، فهؤلاء يتواجدون في كل مشهد، وليس في الذهنية الخليجية وحسب، حيث تمتلك الذاكرة العربية الكثير من الشواهد الحية على استعداد طابور منالمثقفين لاستخدامهم كبيادق للتصدي للآخر بكافة أطيافه، وليس كأداة تنويرية، فخيانة المثقف توصيف أراده باندا لنسق بشري وليس لفئة أو شريحة دون أخرى، وبعض مثقفي ما يعرف بالمحافظين الجدد كانوا ينتمون إلى اليسار الجديد والليبرالية الجديدة وهكذا. نعم هنالك تحالف معلن بين مختلف القوى لمحاربة قوى التطرف، ولكن هذا الحلف براغماتي بتعبيرك، وغير مقدس ولا مبرأ من النوايا على الإطلاق، فهو مهندس من قبل المؤسسة كقوة غالبة ومحركة بشكل توظيفي أو استخدامي للمثقف، من أجل الحد من تنامي تيار التطرف، وإقصاء المثقف من مركزية الفعل الثقافي إلى وساعات الهامش، حتى لا تتاح له فرصة الحضور المستقل، للتعبير عن رؤيته واستراتيجيته الخاصة لمقاومة مد التطرف، بمعنى أن الخطاب النقدي كثقافة تحريرية ممنوعة من الغوص في طيات إجتماعية أو قدسيات نصية يمكن من خلالها إحداث خلخلة في الأنساق الفكرية والإجتماعية، وللأسف دائما هنالك من يبدي استعداده من المثقفين للتورط في محرقة الثنائيات الحادة لحساب جهة ما من الجهات، وكأنه قد جُرد من ذاكرته، فالمؤسسة ذات تاريخ في الانقلاب على المثقف والتنكيل به عبر وسائط دينية، والأسوأ أن هنالك من يتوهم ويراهن على التواؤم مع صيغ مصنوعة من صيغ الوعي الديني، بدعوى وجود أس حداثي قابل للإنماء، وهو وهم خادع، لا ينبغي للمثقف أن يضع وعيه التاريخي تحت طائلته، فعملية التواطؤ هذه هي شبكة معقدة من التوليفات الرومانسية والنفعية، المصممة في مختبرات مؤسساتية على درجة من المكر لتأجيل لحظة الإستحقاق، وإذا كان من دور للمثقف فينبغي أن يتم على قاعدة إطلاق الحريات دون اشتراطات ولا احترازات ولا ضمانات حتى، بمعنى أن يتاح للمثقف التعبير عن برنامجه التغييري بكل ما يحتويه من قيم تحررية، مقابل خطاب التطرف المتكئ على العنف كمكون بنيوي، فهذا هو الكفيل بفضح بنى ذلك الخطاب، وتعرية المراكمات التاريخية، والتحالفات السياسية التي أبقت على جذوته، بمعنى أولوية التصادم مع القوى الظلامية، وإحداث شروخات ضرورية في الوعي الجمعي، فالحضور التنويري يعتمد في أساسه على ما يسميه فوكو "مبيان قوة" أي رصيد من الرؤى والأفكار والاعتقادات الصادمة التي لا يفترض أن تكون عنفية بالضرورة، وأعتقد أن المثقف الذي يدمن تعداد مظاهر الخراب لا يفعل أكثر من النفخ الهبائي في الهواء، فيما يبدو لي أن المثقف الذي ينذر أدواته ونصه لإثارة الوعي وتعزيز ثقافة الإختلاف وتجذير الإحساس بقيم الحرية هو الأقرب إلى تحويل كل ذلك إلى ممارسة هي الكفيلة بتأسيس قوة مضادة قادرة على قهر القوى الظلامية المتطرفة.
* لكن هذا، بأحد جوانبه هو دور الدولة بشقه النظري (وبعيدا عن عدم تطابق مفهوم الدولة مع وضع الدولة العربية المعاصرة)، الذي هو تنظيم وإدارة الصراع بين القوى الاجتماعية المختلفة أو المتخالفة. أي أن الدولة تقوم بدورها الذي هو مبرر وجودها لماذا ننكر عليها هذا الدور؟
لن أتحدث عن إنسان فوق-تاريخي كما تلمس حضوره اشبنغلر في المجتمعات الغربية لحظة صعودها، ولكن سنقارب فضيحة الغياب لمعنى المواطنة وتحريف مفهوم الدولة أو ما تسميه عدم التطابق، فالدولة العربية الحديثة يا خلف بعيدة كل البعد عن مستوجبات "العقد الاجتماعي" وهي ليست أكثر من قبيلة تعيد إنتاج نفسها. هذه حقيقة علمية مؤكدة منذ ابن خلدون للأسف. ألا تلاحظ كيف تمارس الدولة العربية الحديثة استراتيجية المأسسة الكاملة للقبيلة والطائفة والمذهب؟ الدولة الحديثة تعني تشكيلات حزبية منفتحة غير ممذهبة ولا محقونة بالعصبية والهمجية والشوفينية. نعم الدولة العربية الحديثة تدير الصراع بين الجماعات ولكن بشكله المقلوب، فبدل أن تمارس شيئاً من التوفيق بين الأعراق والمذاهب والطوائف على قاعدة ومفاهيم "المواطنة الدستورية" كما نظّر لها يورغن هابرماس في قراءته للهويات والمجتمعات ما بعد العرقية، نراها تؤلب الأطراف والجماعات ضد بعضها، وتحيي النعرات لتؤكد حضورها كوسيط أحادي لفك النزاعات المصنّعة في مختبراتها أصلاً. كل الدول الحديثة، بما فيها تلك التي تبالغ في ممارسة دور الأخ الأكبر، تتعاطى اليوم أفكار أرنت لينهارت عما يسميه البديل التعددي أو "الديمقراطية التوافقية" وتستدمجها في دساتيرها كقوانين، كما تجرب جوانب هامة منتقاة من تنظيرات تشارلز تيلر حول "التنوع العميق" للمجتمعات التي تحاول تجاوز الأطر التقليدية، لكن الدولة العربية الحديثة لا تسطيع البقاء إلا من خلال إفتعال الأزمات بين شعوبها، والإبقاء على النعرات والعصبيات، وطمس أي فرصة للديمقراطية متذرعة بالمقاومة الاجتماعية والدينية للحداثة، ومتسلحة بضرورة الاصلاح التدريجي، وهو الأمر الذي يوّلد كل تلك المتوالية من الانفجارات ومظاهر الإرهاب، فالفرد عندما يمارس عليه كل ذلك الكم من التهميش والعزل والتشويه يتحول إلى بهيمة متوحشة، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تقرر مؤسسة "نحو إنسان جديد" أن المجتمع السعودي هو وريث المجتمعات المتوحشة بل الأكثر تخلفاً وإرهاباً ولم يماثله شعب عبر --التاريخ في انتهاكه لقيم الانسان عبر تحالف السلطة والدين.
* تشتبك كثيرا مع الشأن العام المتعلق بتشكيل الوعي الجمعي بأدوات المثقف "وفق تعبير لياسين الحاج صالح" وترى (أن الواقع مهزلة كبرى، اشتركنا جميعا في نسجها، ولا نمتلك الحق ولا الشروط ولا الدراية ولا الإستعداد لتغييرها... فالخراب والعطالة والشر وكل متواليات العطب الإنساني أمور يصعب تغييرها، وهنا مكمن الخطورة بالنسبة للكوميديا التي تتصدى كخطاب ثقافي إجتماعي للتغيير لكنها تسقط في مصيدة التوصيف عوضا عن تصعيد الظواهر إلى حد الاستفزاز، وحيث تفشل في تحفيز الكائن على تعضيد وعيه بالفعل ليتغير بؤس الواقع.) هناك من يرى أيضاً أن ما كتبته هنا "عن مسلسل كوميدي سعودي" ينطبق بهذا القدر أو ذاك، دون عسف على ما يكتبه المثقفون (السعوديين بشكل خاص هنا) وللتحديد ساقول ألا ينطبق هذا على تناولك للشأن العام، بجوانبه السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية. فهذا التصعيد أو الاستفزاز الذي تطالب به الآخرين أجد أنه كامن في خطابك مغطى بطبقة من التعميم، توزيع المسؤولية، تنميط الظاهرة و ترميزها، ليسهل تعميمها... الخ، وأرى أنه عندما يصل خطابك الى مستوى الاستفزاز تعيد تدويره لتخفيف "تصادميته"...
تعرف يا خلف بالتأكيد أن المثقف الممزق هو حالة استظهارية لتمزق اجتماعي أشمل، وكلنا بشكل أو بآخر صورة من صور ذلك الإهتراء والتيه والإنفعال، وعليه فإن الاستسلام للتردي، والكف عن قراءة مستبطنات الظواهر الاجتماعية والفنية والثقافية هو فشل مركب تتقنه الذوات الخائبة اليائسة. أما عندما تتجرأ ذات معنية بالشأن الثقافي على المكاشفة، أو أداء فعل "التسمية" كفريضة معرفية ونقدية غائبة في الحياة العربية، فإنها تقترب من حافة الخطر، والخروج على النسق، والفرار بالذات من القراءت المنمّطة، أو المفروضة كتعليمات مدرسية ومؤسساتية تجيد برمجة الكائن وحبسه في اضطرارات حتمية لها ملامح وسطوة القدر، لدرجة يبدو من المستحيل عليها التعارض حتى مع السلبي والشائه من الظواهر. ما فعلته بقراءتي لمسلسل "طاش ما طاش" التي تسببت لي بالمزيد من النبذ، كان محاولة لفك الحلف بين الدراما وخطابالمؤسسة، أي تسمية تلك المقاربات السطحية التخديرية بمسماها الصحيح، إذ لم تعد تلك المعالجات الإضحاكية صالحة ولا ناجعة لمواجهة جملة من الأخطار الأشد فتكاً بالنسيج الإجتماعي، فالمسلسل أصلاً خطاب مؤسسة فقد صلاحيته الفنية والمضمونية منذ زمن، حتى تحول إلى حالة من حالات تزوير الوعي، وكان المطلوب حينها بتصوري هو توليد حالة من الوعي المضاد، الكفيل باستنهاض قوى تتوازى مع مستوجبات اللحظة، أي توتير الوعي، فحين يرفض جاك دريدا تحقيب العالم على إيقاع حدث الحادي عشر من سبتمبر فإنه يستفز وعي الكائن ويعلي من أهمية التصادم مع ما تفرضه سطوة الخطاب الإعلامي، وهكذا يفعل بورديو وغيره من المفكرين الذين لا يكتفون بمشاهدة عصرهم بقدر ما يكونون شهوده، وأعتقد أن مقاربة الظواهر المحلية على هذا المحك الرافض لفكرة الاكتفاء بالتوصيف وتعزيز مركزوية النسق مهمة ضرورية، وتتجاوز محدودية التعميم إلى مهمة أكثر قدسية تتمثل في الهتك، وخدش التماثيل المصقولة، فمقاربة الحداثة من حيث كونها ضجة إعلامية، أو مجرد رنين، بتعبير بختي بن عودة، كما تنبئ عن ذلك القراءة التاريخية المعّمقة، لا أظنها تندرج في فكرة التعميم والتخفيف من حدة التجابه، بل العكس هو الصحيح، فما تراه كموناً وتنميطاً وترميزاً أظنه أختبر بجدية في مقاربة كتاب الغذامي المثير للجدل "النقد الثقافي" كأكبر هدية للحاكم العربي، وفي كشف كتاب "ثقافة الصحراء" كرغبة واعية لتعزيز مركزوية نسق الصحراء على حساب أنساق القرية والريف والبحر، وفي المقاربات السردية لجملة من الروايات المنتجة بواسطة قامات غير قابلة للمساءلة. قد لا تكون مراوحاتي الحفرية عميقة وصدامية بما يكفي، فلم أصل بعد إلى حالة المثقف الإٌشكالي الذي يُختلف به وعليه، ولكنها - أي مقارباتي المتواضعة - ليست إنتقائية للدرجة التي تفقد طاقتها الجمالية والمعرفية الكفيلة بإخراج الآخرين من كمونهم. وبالتأكيد لا أطمح أبداً إلى أن أكون حجة جمالية ومعرفية أشبه بالمرجعيات المحنّطة، بقدر ما أحلم بالعيش في صيغة من صيغ التيه الدولوزي، بارستقراطية روحي أمارس تهوامي في الأفكار، وأمعن في تقويض ما يستقر عليه، وأكرس شرعة الإنشقاق. هذا ما أعتقده كإنشقاقي يرى خطابه الذي لا يخلو من الارتباك ينمو في أرضية رجراجة، فالمثقف الذي يجد في الكلمة والتحليل والتشخيص أدوات لإعادة إنتاج ذاته إنما يمارس بطولة الضمير، هكذا كنت وما زلت أرى أن من كان يتصدى لما يسميه فوزي كريم "الجمالانية البعثية" بنص فرداني فإنه لا ينشق عن القبيلة وحسب، بل يجسد بطولة الرفض الواعي والمكلف للشمولية وأحادية ومركزية النسق المفروض من المؤسسة والممرّر على الوعي في غفلة من الزمن.
* يبدو لي في كثير من مقاراباتك النقدية أنك تحاول أن تربط ماهو أدب بما هو اجتماعي بل وسياسي أيضاً، أي أنك في العموم توسع إضاءة المحيط بالقضية التي تتناولها سواء كانت كتاباً أو غيره، ففي "حداثة مؤجلة" تريد أن تقول كل شئ، وأنت تفكك منظومة الإعاقة التي واجهتها الحداثة (الادبية) في السعودية. وتبدو خياراتك النقدية موجهة بعناية بشكل عام، لتخدم هذا الغرض. ولا تخفي استياءك من عدم تشكل الحداثة كتيار عام وفاعل. هل هو ضيق هامش سقف الرأي والتعبير والكشف وهو ما يجعلك تتخذ الأدب مدخلاً للحديث في الشأن العام.؟ بصيغة أخرى ما هي الاعتبارت التي تحكم خياراتك النقدية وأنت تتابع المشهد الثقافي بشكل عام؟
النص، أي نص، مهما بدا خائفاً ومرتبكاً، إلا أنه يختزن الكثير من رهابات وتطلعات الذوات المنتجة له، ويكفيه أن يكون مجرد حفر أولي يهيء لحفر أعمق في زوايا المسكوت عنه، وهذه مهمة المنهج الاستقرائي في كشف الاجتماعي عبر الثقافي، وتحليل الموقف السياسي من خلال الوقوف على المعطى الجمالي، فالعوالم السردية مثلاً، تمنحنا راحة كبرى، كما يحلل أمبرتو إيكو، وعليه يمكن قراءة هذا العالم الواقعي باعتباره رواية. ذلك هو أحد مداخلي الجمالية في تناول المنجز السردي مثلاً لمفهمة ما يجري، حيث أميل إلى الكشف عن مكونات أو تبرعمات ما بات يطرح تحت مسمى "المجتمع المدني" مثلاً من خلال ملفوظات النصوص ومضامينها الخفية، أو ريزوماتها بالمعنى النقدي، عوضاً عن التفاعل مع هذا المعطى كعناوين سياسية صارخة، فالقراءة العميقة للنص، وتقصي المعاني والمفاهيم مهمة أبلغ وأجمل وأجدى من محاولة استزراع قيمة حقوقية أو سياسية أو حتى إجتماعية لم يقاربها النص أصلاً، وهكذا أتفاعل مع بقية المركبات القبلية والطائفية والمعاني المتعددة للآخر، وحتى ثيمات المكان المتباينة، وأجد في كل ذلك التقصي لذة معرفية وجمالية، إذ أتعرف من خلال ذلك الاشتباك على هويات وذوات وكيانات تتفاعل كلها داخل بوتقة صاهرة من أجل التشكل في سحنة إجتماعية موحدة قد لا أوافقعلى انسجامها التام بالضرورة، بل أدين المحاولات القسرية لتأوينها أو فرضها. والمسألة بالنسبة لي ليست رهاباً تعبيرياً، ولا خضوعاً لسقف رقابي على درجة من الانخفاض، لأنني أؤمن بفعل "التسمية" في الكتابة، وأراه ضرورة لأي مشهد ثقافي، إذ لا وعي ولا ثقافة ولا حضور للذات بدونه، لكن المجس الجمالي الذي أحاول استدعائه وتفعيله لقراءة الظواهر السوسيو- ثقافية هو الأجدى بتصوري، بل الأقدر على تجذير الوعي بالذات وإعداد الكائن القادر على الصمود في وجه القبح والتحريف، أما الخطابات المباشرة فليست أكثر دعاوى ارتكاسية تحت ذريعة التأصيل والخصوصية والثوابت. أعيش كل هذا تحت عنوان بودليري يختصر معنى الحداثة "أحب زمني" نعم يا خلف أحب هذه اللحظة التي أعبرها وتعبرني. أتموضع على خط الزمن، وأجترح حداثة حضوري من خلال النص، وعليه أجادل الآخرين في معنى حضورهم من خلال الشكل الذي يتنصصون به، فذلك هو الكفيل ليس بتوفير مادة فنية للقراءة، إنما بتوليد نصوص مغايرة هي الرهان الحقيقي على خلخلة الأنساق الثقافية والاجتماعية، وأعرف أن تجذير الوعي بهذا الشكل من الحضور يعني الرهان على البعد التاريخي دون استخفاف بالمعطى اليومي، ويعني مقاومة آلة طاحنة بمقدورها "تصحيف الثقافة" ويعني فيما يعنيه تفعيل الوعي النقدي لتحطيم أصنام حداثة لم يجترحوها أصلاً. ومن خلال كل هذا الانفعال بالظواهر والذوات والمنتجات الثقافية أقر بمديونية صريحة للآخر، ولا أفصل بين الظواهر لأن من يريد أن يحيل المشهد إلى ورشة عمرانية من منظور إقتصادي، ومن يبالغ في استزراع الأرض التي نمشي عليها بغابة من المآذن إعلاء من شأن الديني والطقسي، ومن لا يتورع عن تحويل فضاءاتنا إلى أسواق تصعيداً واستثماراً للاستهلاكي، كلهم لا يتحركون إلا من خلال رؤية ثقافية، وأحسنّي في حالة من التحدي معها، بالبحث عن نص متجاوز، ناتج بالضرورة عن وعي مضاد ومشاكس دون أي جرعات أو أحلام مثالية، وبإدانة النص البارد الذي يتواءم مع كل ذلك ويحاول تبريره، وما أكثره، خصوصاً ذلك المنتج المؤسس على مراوغات شكلانية مهجوسة بعقلنة الارتكاسات الإجتماعية، وإنهاض معتقدات القبيلة، وحقن الوعي الديني بجرعات حداثية. هكذا أقارب المشهد من منظور نقدي، وأراه مكاناً للإختلاف، والتنوع، والتشظي، إذ لا مشهد بدون قضية، ولا ثقافة بدون صراع تتناهبه تيارات متخلقة على حافة التجابه المعرفي والجمالي.
* قلت قبل قليل أنك لا تطمح أن تكون حجة جمالية ومعرفية.. وكذلك كتبت كثيراً عن الأب سواء بصفته مثالاً إبداعياً، أو بصفته ناقداً مكرِساً ومباركاً لهذا الاسم أو تلك القضية، بل كان احتجاجك واضحاً وعالياً ضد ما اسميته التكثّر الفطري للأبوات في مشهدنا الثقافي الذي اعتبرته السبب في الإجهاز الدائم على أي قضية جدلية يمكن أن يتحلّق حولها المشهد الثقافي. ألا ترى أن المشهد الثقافي في ظل الخلط والاختلاط السائد في النقديات (التعويمية) للأدب، وفي ظل سطوة البهرجة الاعلامية التي لا تعتمد الشرط الابداعي في العموم للتكريس والإشهار... بحاجة الى مرجعيات مؤسسة ونزيهة يمكن أن تقول في لحظة "أن الامبراطور عار"، مستمدة قدرتها هذه من تملكها لادواتها النقدية ومن نزاهة ممارستها؟
الأبوة الإبداعية ضرورة لأي مشهد، إذا توفرت اشتراطاتها المادية والمعنوية. ما أستهجنه هو ذلك الشكل من الأبوات التي اختطفت إمتيازات الأبوة بدون إقتدار على إتيان مستوجباتها. ثمة خدعة يا خلف يجيدها اليوم الكثير من القامات الابداعية التي اكتسبت سمعتها من خلال رافعة إعلامية، وليس من خلال منجز ثقافي، وبإمكانك مراجعة سلالة الأبوات العربية المزوّرة لتتأكد من منسوب وعيها بالغائية التاريخية، وبالضرورات أو الأولويات الثقافية، التي لم تكن أكثر من نقديات تعويمية، حسب تعبيرك، فهي تمارس قراءاتها التضليلية على هامش النص، ولا تعتمد الخطاب النقدي كآلية إفهامية. هذه الأبوات تشبه ما يسميه فارغاس يوسا "الديمقراتور" أي ذلك الذي يمثل دور الديمقراطي مظهرياً فيما يمارس الدكتاتورية وفق آلية سلطوية حين يتعلق الأمر بامتيازاته، وهو فصيل يتوفر الآن بكثرة في الحياة الثقافية العربية، خصوصاً مع بروز جيل مصاب باليتم، يلهث دون هوادة وراء الأبوات فيما يزعم الرغبة والقدرة على قتلها. الأبوة الإبداعية كما أفهمها قامة شاهقة تمتلك الوعي والارادة، ولديها القدرة على توحيدهما في ممارسة يتغير بموجبها وجه التاريخ، أو على الأقل تولد من خلال حضورها منعطفات إبداعية لافتة، وأعتقدها تتمثل في معلم هائل لا يعرف عدد تلاميذ فصله، بما يمتلكه من قدره على اختراق السياقات والأجيال والذائقة. أحيانا أساويه بالمثقف الإشكالي الذي يُحتج به وعليه، الذي ينقسم المشهد الثقافي من أجله وعليه، الذي يحرض أبناءه على المروق والعقوق. مثل هذا الأب أظنه بعيد المنال عربياً، وغالباً ما أتساءل، إن كانت الحياة الثقافية العربية تحتمل بالفعل أباً مجنوناً مرعباً كنيتشه مثلاً، الذي لا يرى أي إمكانية لحياة جديرة، إلا على حافة الخطر، وأوافقه بما يشبه الفضيحة للذات المدعية عندما يصف المثقف النظري بالسقراطي، وإلا كيف نفسر فروض الطاعة التي يبديها بعض الآباء لجيل الغضب الالكتروني مثلاً. إنه الرهان على الجماهيرية وليس على القيمة، وهذا بالتأكيد لا يعني عدم وجود مرجعيات يمكن التتلمذ على منتجها والاقتداء بها، فمن الظلم والبلاهة والجحود نصب المشانق لآباء تنسكوا من أجل المعرفة، والعكس صحيح أيضاً، أي عدم وأد الأبناء بهذه الصورة من الإبادة الجماعية للجيل الجديد لمجرد إبدائهم لبعض العقوق والتململ.
* تتحدث عن قطيعة بين الاجيال الشعرية الجديدة وبين من سبقهم وتخص بذكرك "الشعراء الكبار" وترى أن التفنن في إقصاء الاجيال الجديدة من سياق التجربة الشعرية أصبح (لازمة منبرية، يعيد تدويرها أغلب الأبوات الثقافية في نوبات دورية...) ألا ترى أنك هنا تبتسر المشهد العام للاقصاء العربي بقصره على هذا النوع الضيق من الاقصاء؟ فهناك اقصاءات شاملة داخل المشهد الابداعي والنقدي العربي لا تتعلق بجيل. فهناك اقصاء يتم داخل الاجيال نفسها هناك اقصاء له علاقة بالانتماء الجغرافي هناك اقصاء له علاقة بعائدية المنابر النشرية.. الخ، فالامر (كما أرى) يتعلق بمفهوم "الاوحد" في الثقافة العربية، الذهنية التي لا تقبل التجاور ولا التعدد ولا الاختلاف ولا النقد.. وفي ظل الغياب النقدي الجاد والنزيه، المرشح والمفلتر لهذه التجارب تختلط المعايير، ويصبح الامر متروكاً للممارسة الفردية لتطلق أحكامها العشوائية و ممارسة اقصاءاتها دون ضابط أو رقيب. ألا ترى للغياب النقدي كجزء معزز لهذه الحالة الاقصائية؟
استنتاجك صحيح ومؤلم، لاحظ التقسيم الثقافي البغيض المتأتي من آليات الفرز والطرد السياسي حيث الدائرة المشرقية مقابل الدائرة المغاربية وعلى هامشهما الدائرة الخليجية، حيث الادعاء بالثراء والريادة مقابل الخواء والفراغ حسب التصنيفات الإقليمية. ولاحظ المشاريع الفكرية للجابري وأدونيس والطيب تيزيني وحسن حنفي ومحمد أركون وغيرهم كلها محاولات ابستمولوجية متعالية لا تتكامل، ولا تتصارع حتى بقدر ما تحاول العودة بالمعنى إلى درجة الصفر، حيث الذات الموسوعية الحاملة لإرث ابن رشد في قدراته وطاقته على "القول الفصل" في كل القضايا الشائكة والعالقة منذ ذلك الحين، فالثقافة العربية لم تحل أي قضية لأنها لا تمارس ما يعرف بالتكرار الحركي إلى الأمام، ولأنها تصرف من الجهد والمال وإهدار العامل الزمني لمقاومة الحداثة ما يكفي لتعطيل أجيال و"إنتاج التخلف" كعلامة مميزة من علامات الوهن، وتلك هي "أيدلوجيا الفراغ" التي يمتهنها العقل العربي بسخاء للإيغال في الغياب، وهو ما يعني أن المعضلة ليست أدبية في المقام الأول، بل متجذرة في الذات العربية العارفة التي تعيش لحظة هبوط حضاري تقوم على عدم الإيمان بأهمية "النقديات" كعامل من عوامل نهوض الأمم، إن لم يكن الأبرز. لاحظ شهادات الشعراء الكبار الذين طرحوا أنفسهم كمفكرين في مؤتمر قصيدة النثر في بيروت العام الماضي، ولاحظ التوبات والنكوصات وارتكاسات البيانات اللغوية البائسة، تحت عنوان "المراجعات" فيما هي مجرد "تراجعات" صريحة، وتوبات عن حداثة لم يستوعبوا خطورة وأهمية اجتراحها. نعم يا خلف الإقصاء والإلغاء والتهمش نتائج طبيعية لقصور الخطاب النقدي أو غيابه، وأعتقد أن هذا الحقل الجمالي المعرفي مصاب بأمراض الأصولية والسلفية والتقليدية والاستساخ، وأظن أن أغلبه، وأكثره نشاطاً يتعيش على اللعبة الشكلانية للغة، إذ يقيم في مناطق رهابية على حافة المسكوت عنه، فالقليل منه يعي بالفعل مهمته الهدمية البنائية، ويتجاوز سطوح الظواهر إلى أعماقها، ويقارب قدسية النص والحاكمية وهرمية السلطة التي تزحف من السياسي إلى الاجتماعي وصولا إلى الأدبي. وذلك بالتحديد هو ما يفسر غياب "مثقفي الإختلاف" فالحياة العربية تفتقر بالفعل إلى هذا الطراز التصادمي من المثقفين. نعم هناك نقاد يمارسون حالة الاستقواء المنهجي على مكامن ميتة من الموروث فيعودون إليه عودة انتقائية هروباً من استحقاقات التجابه مع الآني والحاضر والملح حقوقياً واجتماعياً وسياسياً، ومثلهم يفعل الكثير من نقاد الأدب الذين يفرون من أمام الشعرية العربية الحديثة مثلاً بذريعة الغموض، مقابل صيحات عالية في الفراغ مطالبة بنظرية نقدية عربية يفترض أن ينتحها إنسان لا يمتلك أدنى مقومات الحياة الطبيعية سواء من الوجهة الحقوقية أو المعاشية، لتبقى المسألة محصورة في جهود فردية محتّمة بقدرة الفرد على استيراد المنهج أو النظرية أو المصطلح ثم تعريبه كيفما اتفق بدون قدرة على استهلاكه بوعي ضمن ما يمكن تأوينه تحت عنوان "توطين المعرفة".
إيلاف
إقرأ أيضاً:-