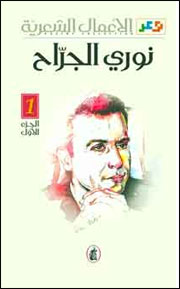 يعتبر صدور الأعمال الشعريّة الكاملة لشاعر من الشعراء (في حياته) محاولة لإنصاف تلك الحياة، وهي مناسبة أيضا يطلع خلالها القارئ على التجربة منذ بزوغها إلى حين نضوجها، وهنا يعقد ذاك القارئ علاقة انتظار مع ذاك الشاعر، فماذا يكتب الشاعر بعد أعماله الكاملة؟. لهذا مثلت أعمال نوري الجرّاح، الشاعر السوري المقيم في اللاوطن ، مناسبة للاقتراب من هذه التجربة التي لا يمكن إلا الانتباه إليها وهي أعمال شعريّة صادرة عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر في مجلّدين احتويا على دواوينه الشعريّة التي جاءت على التوالي: “ديوان الصّبي” دائرة الطباشير الدمشقيّة 1978-1982، “مجاراة الصّوت” ورجل تذكاريّ 1981-1988، “كأس سوداء” 1986-1993، “طفولة موت” 1991-1992، صعود ابريل 1990-1995، حدائق هاملت 1986-1997، طريق دمشق 1990-1997، الحديقة الفارسيّة 1990-2001...
يعتبر صدور الأعمال الشعريّة الكاملة لشاعر من الشعراء (في حياته) محاولة لإنصاف تلك الحياة، وهي مناسبة أيضا يطلع خلالها القارئ على التجربة منذ بزوغها إلى حين نضوجها، وهنا يعقد ذاك القارئ علاقة انتظار مع ذاك الشاعر، فماذا يكتب الشاعر بعد أعماله الكاملة؟. لهذا مثلت أعمال نوري الجرّاح، الشاعر السوري المقيم في اللاوطن ، مناسبة للاقتراب من هذه التجربة التي لا يمكن إلا الانتباه إليها وهي أعمال شعريّة صادرة عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر في مجلّدين احتويا على دواوينه الشعريّة التي جاءت على التوالي: “ديوان الصّبي” دائرة الطباشير الدمشقيّة 1978-1982، “مجاراة الصّوت” ورجل تذكاريّ 1981-1988، “كأس سوداء” 1986-1993، “طفولة موت” 1991-1992، صعود ابريل 1990-1995، حدائق هاملت 1986-1997، طريق دمشق 1990-1997، الحديقة الفارسيّة 1990-2001...
المجموعات مهداة جلّها إمّا شخوص من فئة الإنسان (الأصدقاء، الابن)، إلى الشاعر نفسه (إلى من كنتُ) أعلن ذلك في مجموعته الشعريّة الثانية لا أكثر “مجاراة الصّوت”، وعلى المتثبّت من الأماكن التي كتبت فيها قصائده نلاحظ أن الشاعر ينط من أرض إلى أخرى، دمشق، لندن، نيقوسيا، بيروت... ملتفتا لمواسم تلك البلدان من شتاء نيقوسيا إلى خريف لندن، موسم من مواسم أبو ظبي إلى لاشيء اللاشيء حال مجموعته الحديقة الفارسيّة، مطلق الشاعر ربّما، عدم انتباهه للوقت، هروب منه، تعال عليه، كلّ هذه التفاصيل التي نحاول قراءتها مع شيء من الانتباه لتصديراته المتنوعة التي تسم الدّواوين، نكتشف هذا الضنى البحثيّ، هذا التلمس المتوتّر لأشياء الشعر البسيطة العميقة، هذه الورشة الكبرى التي يتحرّك فيها الشاعر بحثا عن سطوره. ذلك لأن للشاعر ورشته أيضا لا للرسّام فقط. فإذا ما كان فضاء الأخير أكثر واقعيّة وتنظيما واستقرارا فإن ورشة الشاعر ورشة ذهنيّة المنحى، شاسعة، ضيّقة فأحيانا يكفي شبّاك للكتابة وأحيان لا يكفي العالم برمّته. والشاعر من خلال إهداءاته وتصديراته مفجّر بارع لمحيطه وعلاقاته، وحامل صبور للشعر أينما حلّ، الشعر الذي يصبح الحمل الأكثر ثقلا في هذا الزمن.
نحاول في هذه القراءة التي سيكون جلّها بين قوسين - لبعدها على طاولة الناقد ومحكمته - أن نتبع خطوات الذي انطلق صبيّا في “ديوان الصبيّ” إلى القاطف وردة من “حدائق هاملت” الشكسبيريّ، و”الحديقة الفارسية”، تأكيدا على أن الشاعر ما هو سوى باحث مطلق عن الشعر.
جدير بالذكر كما لا يخفى عمّن يعرفون الشاعر أن للجراح عين جائلة في أدب الرّحلة، مشرف على مشروع طالما أكد أهمية كبرى على المستوى العربي”ارتياد الأفاق” وما تلك الكتب التي تمتعنا بين الحين والحين سوى من لمسات الجرّاح وأمثاله المهووسين، لأن على متتبع طرق الرّحالة القدماء من تراثنا العربي أن يتحلّى بما يكفي من شعر ومن جنون.
في ديوان الصّبيّ، مشروع الشاعر وبرعمه المتفجّر للتوّ، صبيّ مصاب بالإطلالة “من وراء النّافذة” ليرى برؤية شعريّة لصبيّ مصاب بالانتباه المضني ل:” الوردة [التي] ليست للإناء”، “مقصوف العمر”، عرف هذا من البدء في رحلة للوراء، الصبيّ الدمشقيّ المتثبت من كلّ شيء الطامح إلى تحرير كائنه من “الأكاديميا”، كلّ ما أعجبه من القسم الدراسيّ هو النافذة متسائلا من أين يشتهي إطلاق “طائرته الورقيّة” في اتجاه المطلق، وكلّ ما أعجبه من المعلّمة ساقيها العاريتين، “لقلق” على ساق واحدة يرفض الأناشيد ويخيّر أنشودة شخصيّة تمامها “أنا ذاهب كي أضحك”. ديوان الصبّي إذن باب متاهة الشاعر منه دخل ولا زال يمارس المشي على أرض الشعر الوعرة بحثا على فواكهه الأكثر غرابة. هذا الديوان يعلن ولادات الشاعر التي ستتجدد.
الولادة مع كلّ قصيدة هذا الخط الغليظ في مسيرة الجرّاح التي أعلنها في مقدّمته لأعماله. وأن يقدّم الشاعر أعماله وهو الذي لا يقوى مبدع على إعلانه هو شكّ في القراءة وفي المتقبّل، خاصّة ذاك القارئ الشائع في عالمنا العربيّ لنمط قراءة وحيدة، نقصد الذي يفتح ديوان الشعر للبحث عمّا توقّعه. أن يقدّم شاعر لأعماله تطرّف أيضا، التطرّف الذي من شيم المبدع والذي أعلن عليه الجرّاح في مقدّمته تلك ومنذ أوّل سطر شعريّ كتبه وأول زقاق هام فيه. القفزة هائلة بين الديوان الأول وبين “مجاراة الصّوت”، الحمل هائل أيضا. هنا، يتخلّى الشاعر عن “أناه” ليمضي بعيدا في المكان ومكوّناته، “الباص”، “الرّايات”، “الأزهار”، “القطار”، شعر لا يأتي به الوحي، خصيصة من خصائص الشعر الحديث المتخلّي على ما نعتبره جورا في “الشعر النبويّ”“ أو “الشيطانيّ”، لأنّ القصيدة في دواوين الجرّاح وأمثاله أقرب إلى القارئ دون أن ينتبه هذا الأخير لذلك: (قصيدة حانة، من مجموعة مجاراة الصّوت).
الحانةُ مُغْتَسَلُ الرجالِ
يَجرفونَ بمعاطفهم ضبابا
يَختارونَ كراسي الزوايا
ويُوقدونَ عيونَهم.
سيدلّ هذا المقطع الشعريّ على لا سحريّة القريحة، فقط هي هنا في ركن من أركان الحانة منتبهة وحسّاسة، شاعرة في نهاية المطاف.
“مجاراة الصوت” قصائد لندنيّة مرفهة، ملعونة، تحمل اليوميّ في معاطفها، التفاصيل في عناوينها. لا فلسفة سوى ما نرى ولا معنى سوى ما يخطر لنا تحت “دم غروب قديم” (عزلة الملاك، ديوان مجاراة الصوت). لم يتخلّ الشاعر في مجموعته الثانية عن ارثه الطفوليّ، من مشاغبة ومن انتباه، ها هو في قفلة الديوان يقول:
انتبهُ / أيها النسّاج الأعمى /إنك تفلت الخيط.
هذا الانتباه ما هو سوى وجه آخر للقريحة القديمة، انتباه مسلّط على النفس وعلى المحيطين والعالم. انتباه سيجعل من كائن الشاعر كائنا مختلفا وصاحب “كأس سوداء” لا ترى ما بداخلها، كائنا يقلّب التجربة على كلّ وجوهها:
“التوقُّعُ مغمورٌ بالضوء / وكذلك المَعْرِفَةُ الحَادَّة /بالذي يجري/ الآن / وراءَ الباب/ ويمكن أن يُحْدَسَ / أو يُرى من النَّافذةِ” (مجموعة كأس سوداء).
سنلحظ أن العالم دائما ما يكون بتفاصيله مختبرا للشّاعر يجرّب فيه رؤاه ويطلق على أرضه حدسه ويطلّ على فناه من “نافذة” متيقّظة ومتلصّصة. اغتراب “رؤيويّ” في اختلافات الفضاءات، هل يكتب نوري الجرّاح قصيدته في “لندن” بنفْس النفَس الذي يكتب به في بيروت أو حتى في نيقوسيا كي لا يصبح الأمر أمرا قوميّا. عبر هذه الفضاءات المختلفة تتنقّل عين واحدة وتتبلور تجربة واحدة. عين وتجربة الشاعر. في لندن يقترب “هاملت” أكثر وفي بيروت يقترب الشاعر نفسه بنفسه: هي على “الطريق إلى دمشق”: “على الطَّرف الآخر مِنَ النَّهر / انْتهى الزَّمنُ. الرُّخامُ يَهيمُ، والشُّعاعُ ينفذُ من الكَتِفِ”.
هل يحلو منفى المنفيّ؟. كيف يمكن لنوري الجرّاح أن يكون بلا منفى؟. نكاد نجزم أن المنفى من تقنيات الكتابة، خارج سياق الوطن يتشكّل وطن آخر أكثر رحابة ورؤية أخرى أكثر عمقا، فالتذكّر الذي يصيب مجموعة “طريق دمشق”، الماضي المنتمي والحاضر الجوّال يجعل من القصيدة قصيدة أكثر تخلّصا من درن الاستقرار وإعلانها للرتابة التي يتعرّض إليها الباركون في الوطن الواحد.
نحن في لندن؛ الصِّقْعُ الذي لا يَعرفه أَحَدٌ
لندن أَواسطَ الَّليلِ، وقْتَ يؤوبُ السكّيرونَ إلى مقاعدهم في الأزهارِ
وتَنْضَحُ الأَرضُ بُخاراً رَطْباً؛ (طريق دمشق).
أما في سورية: (ربّما) “الجَفافُ يَضرِبُ مِعولَهُ ويَقتلعُ المواطىءَ” (طريق دمشق).
التجوال في العالم قد يحول بين الشاعر وذاته، ففي لذّته ينصرف “الرّحالة” إلى لذة اسمها الفضاء. لهذا نجد أن قصائد الشاعر نوري الجرّاح غارقة ومشدوهة أمام تبدل المشاهد وتلويها. إلا أن سرّا ما يجعل الشاعر يعود إلى نفسه ويمسها كما لم يمسسها منذ باكورته “ديوان الصّبي” في مجموعة “حدائق هاملت” هذه المرة، فلا يغرّنك العنوان الخدّاع المحيل إلى ملهاة شكسبير العظيمة.
في هذه المجموعة تزدهر التجربة فجأة وتذهب بعيدا في نضجها، حساسية عالية ورهافة ملحوظة تحيطان السطور واستخدامات الرّجل لأبطال يأتي بهم من مسرحيّة شغلت الناس والأقلام. هروب من نفس إلى نفس أكثر عمقا، ها هو يخاطب أوفيليا في خطواتها: “ خُذيني، بلا وَجَلٍ ولا مَشَقَّةٍ /إنما،/أَعْمَقَ في لاهِبِ الجَّسَدِ /الشُّعْلَةَ والعِنَبَ / لمَّا تَتَسارَعُ النّأْماتُ، ونَنْهَض”
الأنا الشاعرة في التراجيديا الشهيرة تلك، حاضرة، فاعلة، ومتحمّلة للحرقة، حرقة ما: “خلِّني أَكونُ هناكَ في تلك السَّاعةِ”(...)
“لأنني لم أكنْ في كلماتكِ غيرَ الألم”. الشاعر وقد ارتمى بألمه في العظمة والخلود، الشاعر وقد قطع كم ديوانا وكم بلادا وكم حكاية، يلتجئ إلى ما وراء العالم في إحدى أروع حكايات الإنسان. الأسئلة الشاقة تصحو في حدائق هاملت أشواكا وطريقا وعرة. الشعر من هنا يأتي هذه المرّة، لا من مكان حلّ به الجرّاح أو من حانة أو من نساء، إنه يأتي من النفس التائقة إلى تعظيم الألم الشخصيّ عظمة التراجيديا الشكسبيريّة:
“أنا، يا ربُّ فمي ممسوكٌ بالصَّمْغِ
وكلمتي مرساةٌ ثقيلةٌ.
مِنْ هنا، من هذه الأعماق
رأيتُ صرختي في فِراشٍ وجسدي في فِراشٍ،
ولمْ أبرحْ
مسحوراً، أطوفُ حيثُ هلكتُ” (من قصيدة خفة محترقة، مرثيّة لاهية، ديوان حدائق هاملت).
في هذه المجموعة سنكتشف أن ما هاملت سوى الشاعر نفسه، هاملت العاشق المتألم وما “أوفيليا” سوى الحلم الذي مضى:
“أنا برهةُ البِلَّور، أنا هاملت والحبُّ، لأنَّ الفأسَ تَسْتَعدُّ”.
في هذه المجموعة نلمس جليّا أيضا بحث الشاعر عن التنوّع وهروبه من التكرار، الآفة السوداء التي تحدق بالواحد ما إن لمس صوته الخاص، لذلك كان أعلن الجراح في مقدّمته: “القصيدةُ التي لا تختلف عن غيرها من قصائد الشاعر تنذرُ بموت روحٍ من أرواحه”. هنا تختلف تربة الشاعر وتصعد درة أخرى من سلّم تمتم التجربة الشعريّة. وهنا يبعد التأمل أكثر في العالم وفي الذات. هنا يتجلّى الغضب الشعريّ من موضع الشاعر في العالم.
قد تكون “حدائق هاملت” منعرجا هامّا في تجربة الشاعر فتحت الكوّة أمامه على عوالم أخرى، “المراثي الإغريقية” في مجموعته “الحديقة الفارسيّة” يزاوج الشاعر بدهشة بين النصوص العظيمة والتفاصيل اليوميّة، كأن ينزل بالأسطورة من عليائها المزعومة إلى علم قد يعتبره البعض أقل شأنا. متحلّيا بشهوة المغامرة إذ يتنقل الشاعر في هذه المجموعة بين الأنا وشخوص من نوع “تيلماخوس” وأوزوريس و”سيت” الإله القادم من سماء الفراعنة وأودوسيوس وغيره، كما لم يتردد عن خلق ظلّ شعريّ من مسرحيات شكسبير مرّة أخرى في قصيدة “حلم يقظة صيفيّ “.
مثلت هذه الأعمال الكاملة مناسبة للتعرّف على اسم هام من الشعر السوري والعربيّ الحديث، التجربة مجتمعة في مجلّدين، تقرؤها باتزان وبعمق، لتلامس مختلف زوايا البناء منذ أوّل حجر إلى ما وصل إليه. لنا أيضا بعد تلك القراءة أن نصاب بانتظار ما يمكن أن يكتبه الجرّاح وفي أيّ من الوديان سيهيم بعد صدور أعماله؟.
09/12/2009