جريدة السفير
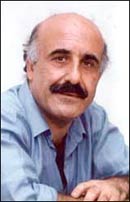 كنا خمسة. ذهبنا في دروب خمسة. لن أستمر في الحكاية، اليوم أجملنا وأفضلنا نام تحت الشجرة التي من ثلاثين عاماً يحدق فيها واستحال عليه أن يستيقظ. لقد كان فتياً والأشجار لا تؤذي، وغالباً ما كان يحيط نفسه بجدران أربعة. كان محمياً ولم نخف عليه. لكنه في موضعه غلبه نوم أصعب من السفر، وها هو مع جداره وشجرته واحد. لقد اكتملت اللوحة وهذا المكان الذي صنع بقوة الانزواء والتأمل والنظر المثابر غدا حقيقياً أكثر من أي مكان آخر. وحين يمر الغياب من هناك سيجد وجهاً، حين يقترب الصمت سيجد ما يساويه حين يمر العدم نفسه سيشف ويجد كلمة. ذلك أن الذي لم يسافر كثيراً ابتعد أكثر. كان الوضوح عذابه، الوضوح الذي يجعل النظر مساوياً للأشياء. الوضوح الذي لا تزيد الأشياء فيه بقدر ما تتضاءل وتنسحب. كانت الكلمات أشياءه ويفقد منها كل يوم. كان العالم بسيطاً وواضحاً كترسيمة عذاب. الخامس الذي لم يعد كان هو الشاعر.
كنا خمسة. ذهبنا في دروب خمسة. لن أستمر في الحكاية، اليوم أجملنا وأفضلنا نام تحت الشجرة التي من ثلاثين عاماً يحدق فيها واستحال عليه أن يستيقظ. لقد كان فتياً والأشجار لا تؤذي، وغالباً ما كان يحيط نفسه بجدران أربعة. كان محمياً ولم نخف عليه. لكنه في موضعه غلبه نوم أصعب من السفر، وها هو مع جداره وشجرته واحد. لقد اكتملت اللوحة وهذا المكان الذي صنع بقوة الانزواء والتأمل والنظر المثابر غدا حقيقياً أكثر من أي مكان آخر. وحين يمر الغياب من هناك سيجد وجهاً، حين يقترب الصمت سيجد ما يساويه حين يمر العدم نفسه سيشف ويجد كلمة. ذلك أن الذي لم يسافر كثيراً ابتعد أكثر. كان الوضوح عذابه، الوضوح الذي يجعل النظر مساوياً للأشياء. الوضوح الذي لا تزيد الأشياء فيه بقدر ما تتضاءل وتنسحب. كانت الكلمات أشياءه ويفقد منها كل يوم. كان العالم بسيطاً وواضحاً كترسيمة عذاب. الخامس الذي لم يعد كان هو الشاعر.
بسام حجار كان هو الشاعر. لقد لحق العالم إلى مربَّعهِ الأخير. تحت الحائط الذي يفصل بين كل شيء وكل شيء عاش كناسك. كان يصغي إلى الغياب يداعب الذكريات. إلى النسيان يمشي على آثار الغائبين. كان يصغي إلى الرمل وإلى الأطلال والمعاني المفقودة. بسام حجار كان يصغي إلى الكون يتدفق من ذلك الثقب. إلى المعاني تتولد بين الأغصان نفسها، إلى الأسرار وهي تتواتر من الظلال والضواحي، إلى النظرة التي لا تشبه أختها ولا تكون هي نفسها مرة ثانية. بسام حجار كان الشاعر.
كان الشاعر، لأنه أقام حيث يجد، ولأنه لم يرهب الكلمات بل استأنسها، ولأنه أصغى ولم يخترع، ولأنه لم يسحر ما حوله بل نظر وأحب، ولأنه لم يبحث في أوقيانوسات وهمية بل استقبل ما حوله، ولأنه رأى أن السر هو حقاً في ما بين يديه وتحت بصره. لطالما أذهلني أن يكتب بسام ابنته ما كتب فمن له ابنة لا يحتاج إلى أن يتكلم في الأثير. من له قلب لا يحتاج إلى أن يجد الحب وراء الحدود، من هو شاعر لا يحتاج إلى أن يخترع. لطالما رأيت بسام وهو يكتب تماماً ما يريده. لم يكن الشعر هو الطيران ولم تكن الكلمات بجعات هاربة، ولم تكن القصيدة أعجوبة. المهم أننا نملك ما نقوله وبسام حجار كان مليئاً بالمعاني. كان الشعر موجوداً كعصب لا كأحبولة، كان الشعر هنا عارياً وبسيطاً ومكتملاً ولا يحتاج إلا إلى أقل كلام ليوجد، لا يحتاج إلا إلى شرارة وحيدة لينبض. بسام حجار كان الشاعر.
الأعمق والأكثر ثقافة والأكثر دراية بأحابيل الفكر كان يقول كل ذلك بدون أن يقوله. كان يخفي عمقه كما يخفي سحره كما يخفي درايته ولا يبقى في النهاية إلا الأثر. تبقى في النهاية الهندسة الأخيرة لمخاض عسير. تبقى الخلاصات العذبة والهادئة لاحتدامات مطمورة. ما كان يبقى هو العذاب أنيساً ومستأنساً في هندسة كلامية. في أبسط الأشكال وأكثرها تماماً. في قلق يجد خطه وبصمته في سؤال يتظاهر بأنه جواب. في إيجاب جارح ومجروح. في قبول وشكر، ربما، معذبان. بسام حجار هو الشاعر.
الصداقة تولي وجهها للغياب إذ الغياب واسع وكبير. إنها ثلاثون سنة ولن يتسع لها سوى البحر. الخمسة صاروا قوساً من كلمات خمس، أفقاً يبتلع الكلمات.
الرجل الذي أحبّ الكناري
 «في المرّة الأولى، تقول، حسناً لم أفقد سوى روحي وهي متعبة. فلا بأس.
«في المرّة الأولى، تقول، حسناً لم أفقد سوى روحي وهي متعبة. فلا بأس.
في المرّة الثانية تقول : تعب جسدي منّي وأبى أن يحملني أعواماً أخرى وغادرني.
وفي المرّة الثالثة لا تقول شيئاً . فما الذي تبقّى؟ لم يبق شيء ليغادرك، فلا تنتبه. تصبح ظلاً بين الظلال الكثيرة».
من كتــاب حكايــة الرّجــل الذي أحبّ الكناري الـصّادر عن دار الجـديد في العام 1996.
أشجار بسّام حجّار باســقة وظــلاله، شعراً وترجمة، ســتظلّ وارفــة. أنبــأنا مراراً في كتبه بـ«لــيلته الأخيرة» وتمنّى علينا أن لا نبكي ... أن نتذكّر، وهذا ما سنصدع إليه.
كتبه حدائقه وإليها، إلى سروته، شجرته الأثيرة المخاطبة السّماء،سنلجأ.
كائن الشعر
«لا أبالي بي
إن بقيت حياً
لأيام
لأعوام أخرى..» (تفسير الرخام ـ ص: 78
لا. لا. عشرين مرة أقولها. ألف مرة. لقد انصرفت الروح! أهذا الشوق الهائل، والشعر العظيم حتى الأغوار، والروح التياهة تأفل؟! أهذا المجند جسمه لسطر واحد، بل لكتاب في مرثاة العالم، في مرثاة الذات يهوي؟!
انتظرنا. انتظرناك لتطمئننا، فرفعت نفسك الى هنالك، أحببناك أيها الرجل ايها الرجل الطيف، والطيف الرجل. أحببنا حبك الغريب، يوم استضفت الغريب، كاتب هذه السطور لديك. أدخلتنا الى رحابة روحك، أسكنتنا في دمعك. أفرحتنا بألفة صوتك الذي لن يغادر الصدر الى المنتهى. خففت من وطأة الغربة علينا، بسكبك بعضا من عذوبتك في كؤوسنا المترعة بالخوف. أم تراك أغمضت، بلا استئذان، هذه المرة، رحلت من دون أن نحظى منك بكلمة وداع، سوى السانحة القصيرة، لسنتين خلتا؟
أم تراك كائن الشعر، لا تريد أن تغلبه لا تريد أن تدعه شاردا في اللفظ، في الصوت؟ أنك أبيت إلا أن تسكنه، كائن الشعر، في صدرك، أن تترك له كل الصدر، فتلتصقا، وتصيرا روحا واحدة، مخففة من الآلام، مصونة من مرارات الطريق، مجلببة بإكسير الدمع، هذا الذي سكبته لنا قطرة دم، تلو قطرة دم، من عروق لك حقيقية، وقلت: «خذوا، اشربوا، هذا هو دمعي»؟ أم تراه جوق الآلام العلوي أبى إلا أن يصنع لك، ربما لغياب أحد المرنمين الكبار من غير ما سبب، مرقى مخصوصا بك تردد منه أنغام انفرادك وخفتك اللذين لم تصدقهما، أنت نفسك، ولا نحن طبعا؟
أخي «بسام»، عرفناك، فقدناك وكأن الفقد ظل المعرفة، نارها الآكلة ليلها المذيب، شمسها القاتلة، والأسر الذي لا خلاص منه. ليته ما كان!
أخي «بسام»، لولا يقيني بأنك سوف تغتاظ مني، لقلت: «إني كرهت الشعر الآن!» لأنه أسلمك، كما اليهوذا إلى طريق الآلام. فصرت سبيلك الآلام، شعرك من وهجها، في عروقك، في صدرك، في فؤادك، في كبدك. «شهيد الآلام». لو صح لقلت إنك سقطت «شهيد الآلام»، ولو ان العبارة ممجوجة، ضيقة. سقطت شهيد الآلام، بل لأنت من كرام شهداء الآلام، في تاريخ عنجهياتنا، وتحجر حماسيتنا، وعمومية لهونا وإسفافه. ولم تخف. بل خفت قليلا، على ما قال لنا حسن داوود، من أيام، وأنت تنزف نهرا من الاشواق لمن سبقوا، ولمن انفصلوا، ولمن أحبوا ولم يقووا على ملازمة أحبتهم.
اصمت ايها العالم الخؤون! اخرسي ايتها الحياة الفاجرة، لليلٍ واحد فقط! ليوم طويل، كيوم الجوع، لأن روحا، كروح بسام خرجت وحدها الى البهاء، الى الينبوع الذي منه صدرت. وأنت أيها الموت مُت غصصا، لأنك لن تغلبه، لن توهن راحته، ولا عناقه المهيب للحبيب!
لا! عدت أنت. لم تفارق. لن. صنعت من الزخرف روحا، ومن الروح حسما، حسمك، ومن الكلام عينا، ومن الجملة صدرا، ومن المقطع عنقا، ومن النشيد يدين، وقدمين، ومن الألم قلبا نابضا بين ضلوع الهمسات والصور، ومن القصيدة دمعا وغناء، دمعا وغناء، لا يتناهيان، لا يحدان، بحرا رديفا، صنعت، شاطئا رديفا، سلما، جسرا بين ضفتين الحياة والموت، ثم اجتزته للتو، دخلت الضفة الأخرى، دخول الفتى في لوحة غوغان، بأحد الأفلام، ولم تعد، ولم يعد.
نشتاقك «بسام». نشتاق الى محياك الى حيائك الخليق بالمتصوفة، الى شمسك المتوارية. بين حدقتين غائمتين على مألوفك. اما أنت، فرددتنا «غصبا عنا» او دهاء منك ـ وهذا نادر لديك ـ او إلهاء لنا، لا نعلم، عن ذلك المشروع المستــغرق حيوات لا تحصى، عنيت التــأمل في ما يصنع مزق الروح، في ما يصــنع الرحيل، والكلام عليه، التأمل في هذا الانوجاد المهشم، كصورتنا في هذي الحياة.
أيها الصديق، وداعا، لا أصدقه.
«بسام»، ايا أخي، شهيد الآلام، أعذر سلامي الناقص الآن. الناقص نقصانا كاملا.
عطية الصمت
من بيروت يأتيني صوت الصديق الشاعر عباس بيضون ينبئني بالخسارة المروّعة، وأنا في مطار الدار البيضاء أتهيّأ للصعود إلى الطائرة عائداً إلى باريس. رحلة عودةٍ ولا أمضّ كانت هذه الرحلة. كابوساً في وضح النهار صارت شمس المتوسّط فيه لا أكثر من كرة مشتعلة تمطر عليّ نوراً عدوانيّاً ووضوحاً تشوبه غمرة من الظلام. كانت الظلمة آتيةً من دواخلي أنا نفسي. هو حزني على الصديق الراحل ينتشر على المكان ويحيل أضواءه الباهرة آلة تعذيب. صوَر بسّام حجّار تتوالى في فكري وتعيده إليّ في مواقف عديدة. زارني في أواسط الثمانينيّات بباريس. كنتُ في ذروة فراغ روحيّ لفتّني دوّامته الطاغية طيلة أعوام. راح كلّ منّا يشرب الشاي وتلقّفَنا حوار طويل صامت. خشيتُ أن أخدش حضوره النبيل بصمتي، لا بل بغياب الكلام عندي، فإذا بي أجدني في ضيافة كائن هو نفسه مقتصد في كلماته. لن أنسى ما حييتُ عطيّة الصمت هذه، أنعمَ عليّ بها بسّام في يوم بقي يحمل ختمه الخاصّ بين أيّام حياتي. سألتُه عمّا كان يشتغل عليه يومذاك فأخبرني بأنّه يضع خلاصة (هذه هي كلمته) لتفكير هايدغر في الشعر. بعد شهور صدرت دراسته فوجدتُ في تعريفه لها بكونها «خلاصة» علامة تواضع كبير يقرب من أن يكون ظلماً للنفس.
لطالما بدا لي بسّام كائناً مولعاً بالكمال. ولقد كان مكتملاً في أشعاره المتميّزة بنبرتها الروحانيّة التي لا تخطئها بصيرة قارئ، وفي كتاباته النثريّة المكتنزة بمقارباته الشعرية للعالَم وبنوع من السرد يضطلع فيه الإضمار بدور معتبَر يساهم في بلورة رؤياه، مثلما تعمل مساحات صمته العريضة على بلورة كلامه. كما كان مكتملاً في ترجماته، وأنا أحسب أنّه كان المترجم الأمهر والأكثر إبداعيّة في فترتنا. لم يدجِّن الكلام الغريب بقدر ما حرصَ على إنقاذ أفضل ما فيه، ولم يغرّب العربيّة على كثرة ما كان يسعى إلى ضخّها بجرعات عالية من غرابة الغريب.
في المهرجانات واللقاءات الأدبية القليلة التي جمعتني به كنتُ غالباً ما أراه واقفاً هو والعزيزة نجلاء على مبعدة من «الحلبة»، حلبة الأضواء التي هي حلبة عراك أدبيّ أيضاً ومناسبة للظهور يستميت آخرون في احتلالها أطول زمنٍ ممكن. في لبنان أيضاً كانت العزلة دأبه، هو الذي رفض الإقامة في العاصمة وأصرّ على ألاّ تفصله عن صيدا سوى سويعات العمل الصحفيّ وما يكفي من الوقت للوصول إلى بيروت والعودة منها بباص عموميّ.
لقد اقترن بسّام باللّغة، لغة كان هو من شعرائها الأساسيّين حتّى عندما يترجم أو يكتب مقالة نقديّة. وحتّى لا يخفت حواره مع اللغة واشتغاله المستميت عليها بجميع الصيَغ الإبداعيّة الممكنة، كان لا بدّ من وقود يسمح بإطالة المكابدة وتأبيد العناق القاتل الذي قرّر هو منذ نعومة أظفاره أن يبادلها إيّاه. كان يريدها ضمّة مبرمة لا تستكين لتعب الجسد ولا لتململ الرّوح. وها هو يغادرنا شهيداً للّغة بعدما كان عريسها الحقيقيّ. السجائر التي كان يرتشف عصارتها بالعشرات كلّ يوم، والتي ربّما كانت تقف وراء اعتلاله الذي أودى بحياته، لم تكن في حقيقة الأمر سوى الوجه الظاهريّ لظاهرة اشتعال فريد واحتراق إراديّ قطباها هما اللّغة وبسّام، وإذ أسمّي بسّاماً فأنا أقصد سائر كيانه، وعصبه الكيانيّ والشعريّ كلّه.
وراء كلّ شاعر حقيقيّ تقف لعبة تماهياتٍ تكون قاتلة أحياناً ولكنّها لا رادّ لها ولا معْدل عنها. إلى تماهي بسّام واللّغة، لغة صارت بسّاماً أو صارَها بسّام، أحسب أنّ لعلاقة الصديق الرّاحل بأبيه مكانة محوريّة في تجربته الخاصّة وشاكلته في إنهاك جسده لأنّ تجربة الاشتعال الدائم والوهج المستمرّ لا يمكن إلاّ أن تمرّ بهذه المحرقة الشخصيّة. لقد ارتجفتُ ذات يوم وأنا أقرأ في مجموعة كتابات تأمليّة لبسّام نصّاً يصف فيه أباه في أيّامه الأخيرة. كان الأب يمضي سحابة نهاره ملتصقاً بكرسيّ وضعه في ركن من الحجرة أو صالة الاستقبال يقدر أن ينعم انطلاقاً منه بمعانقة الشمس ومشاهدة العالَم. كانت السيجارة لا تفارق شفتيه مع أنّها كانت قد شلّت رئتيه وراحت تُمعن في إعاقته عن الحركة. وكان يطلق سعلات متواصلة صنعَ منها بسّام ترنيمة يقوم عليها نشيده لأبيه، كمثْل قافية داخليّة أو كلمة مفتاحيّة باهرة. ارتجفتُ لأنّني رأيتُ شبَه التوأمين بين الأب الرّاحل وناعيه الكبير، ابنه الذي كان مثله يحرق حياته لأنّه لا يريد لها إلاّ أن تكون جملة طويلة من النّور. من أراد أن يعرف عظمة هذا النور اللاّهب فما عليه إلاّ أن يعود ليكتوي بجمرات شعر بسّام ونثره، إبداعه الخاصّ وإبداعاته الأخرى المتمثّلة في صنيعه الترجميّ. ولن يظفر من جرّاء ذلك إلاّ بمزيد من الحياة. فلئن كان من أعراف الشمعة أن تلغي ذاتها ليكون نور، فإنّ بسّاماً قد عرفَ أن يذوب في جمر سجائره الدائمة الاشتعال وأن يحترق في عناقه القاتل مع اللّغة، كي ننعم نحن بخيط من الضياء باهر ولا انتهاء له.
قصيــدة بشــرية
ليلة أمس كنت تحتضر. لم أنم. رافقت احتضارك، أم لعلي غفوت قليلاً وحلمت. أنت الذي عشت حلماً، ورويت حلماً، حلمت بك توضّب ملابسك في حقيبة سفر توسّلتك أن تضع بينها معطفك الأسود لأن الجو بارد. خطر في بالي متذكرة ان معطفك الأسود هذا نفس لون ثياب الرهبان. لاحظت أنك تشبههم لأول مرة واستغربت الأمر. ينبغي على الوسامات الموازية لوسامتك أن تبلغ القمة في اتخاذ رمز عظيم لها. ينبغي لها أن تأسر قلب العالم، كما أسرت قلبي. لم يكفك أن تكون شاعراً عظيما فحسب، بل قصيدة بشرية وعلامة طريق إنساني، يحدق فيها العالم غير اللطيف فيحمّر وجهه خجلاً. من لطفك أيها اللطيف، نرى الى وجه المثقف الحقيقي، كما يجدر بالأساطير عنهم، فلا نستطيع ان ننساك بعد ذلك أبداً.
لقد بلغت الآن نهاية روايتك، وتركتها لنا كقوة منقذة. ينبغي على الموهبة والأخلاق ان تؤثر في العالم، وما يؤثر الآن، هو استعراض قوة، وبطش، وتفاهة، ولم تكن هذه المهاترات تناسب عيشك الذي عشته ورويته، ولا جرحك المعروف من كثرة النزف. قصيدتك التي بددت الحياة الى تفاصيل براقة. قصيدتك التي تستقر في القلب كيفما اتفق، شمعية كما في بيت للعجائب.
كان لنا امتياز ان عرفناك وقرأناك وعشنا معك. كان لنا امتياز معرفة شاعر لم تتضرر علاقته بنفسه أو اصابها الدلال والخواء. امتياز ما يُمكن ان نُمسيه ثبات الضمير، وثبات الأخلاق، أي خوض النزال بجدارة ما بين التفاهة والثقافة الحقة، وانعكاسها في سلسلة افعال الشاعر وحياته، التي بقيت حدثه الشخصي كما لو سنبلة مفردة في حقل.
ماذا بسّام؟ تعبت كثيرا جدا! تريد ان ترتاح. ان تستلقي تفكّ القصائد وتربطها ثانية. أنت في المقلب الآخر، حيث أملت ان تلعب مرة دورا، ولقد تكيفت في حياتك وقصائدك مع «دور الميت» ذاك. لم تكن تخشى الموت، في الكبرياء السالبة لرجل تألم كثيرا، ومنعه الألم من خشية الموت. كنت تقول إنها حياة منهكة فقط، حارّة ومغبّرة.. لو كان بإمكانك ان تتحدث إليّ الآن.
ليــس هــذا بالصــمت!
هو الموت يا بسام وقد عرفتَه المعرفة الحقيقية أخيراً. وصلتَ إليه، لكن هل كنت تسير إلا معه طوال رحلتك العابرة؟ وكان ساكناً متأملاً في عينيك وهدوء نظراتك كأنك كنت تنظر إلى العالم من خلاله. وكنت مأخوذاً بتلك الأشياء والأغراض والأواني، تلك الأدراج والزوايا وروائح الذكريات التي تعبق في نتاجك ولها، هي أيضاً، حيواتها الخاصة، تحاول إيقاظها بكلماتك البسيطة، الكثيفة والنافذة.
كنت، حين تكتب، إنما تحفر في الصمت وتمعن في الإصغاء. وما كنت تصغي إليه كان صدى للكسور «وفتنة لمعانها البارد». كنت تقترب، لحظة الكتابة، من هول ما لا تمكن رؤيته بالعين المجردة.
من يقترب من الموت إلى هذا الحد يرأف بالعالم. وأنت كنت شديد الرأفة، أنيق الروح. خفيفاً جئت وخفيفاً ذهبت. أنت من عاش في كنف الموت، موت شقيقتك بالأخص، وفي كنف الحروب الخصيبة.
«تفسير الرخام» هو تفسير لموت الذين أحببتهم، لموتك ولموتنا جميعاً. انجلى الموضوع لفرط غموضه وأضحى الغياب هو الحضور. تقول: «لا تسمى القبور/ ولو مأهولة بالموتى/ قبوراً»، «لا تسمى المواكب إليها جنازات/ بل أسفاراً». هي هذه الأسفار موعدك الجديد، دهشتك الجديدة!
في ذلك الصيف، في مهرجان «لوديف» في الجنوب الفرنسي، التقينا، وكنت برفقة نجلا. شربنا «السانغريا». حملناها من المقهى المجاور وجئنا بها إلى شرفة الفندق. والتحق بنا الجميع. وكم ضحكنا ذلك النهار. قلما رأيتك تضحك بهذا العمق، أم أنك كنت توهمني بالفرح حتى لا تنغّص فرحي بلقائك. كانت الحرارة تملأ الفضاء والشمس تأبى أن تغيب.
يقول رينيه شار الذي تحدثنا عنه في آخر لقاء لنا في باريس، من على شرفة وزارة الثقافة المطلّة على حديقة «باليه رويال»: «ما عاد بإمكاننا أن نتحدّث مع من نحب، وليس هذا بالصمت».
الأنبــل
(مشاغل رجل هادئ جداً) لم يكن الكتاب الذي عرّفني على بسام حجار، عرفته عندما كانت قصائده تجاور قصائدي وقصائد محمود شريح وآخرين في ملحق النهار في بداية عقد ثمانينيات الماضي. لكنني عندما استطعت الحصول على المجموعة بعد صدورها بسنتين.. كانت ملاحظتي أن كلمة (جداً) تصدر من الضجة ما يعكر هدوء ذلك الرجل. في أول لقاء لي مع بسام مازحته بهذا، لكنه أثبت لي مع السنين أن كل ما كان يفعله هو أنه يوغل في هدوئه.. ليس في شعرنا الجديد ما يعادل (فقط لو يدك) ألفة وحميمية. من ذاك الذي كتب هذا على غلاف (صحبة الظلال)، من قال إن قصائده (أصوات وروائح ولمسات.. ) وكأنها تريد أن (.. تخرج من جسديتها لتلتحق بالأثير والهواء.. بالنور.. أي بما يقرب أن تصير روحا).. كما ليس في شعرنا الجديد ما يعادل (صحبة الظلال) بعداً .. في ختام (معجم الأشواق) يقول: / بيان الجسد صمت يقتضيه السر.. ما لا يقال هو تمام معجم الأشواق/. وفي (حكاية الرجل الذي أحب الكناري) يقول: /كنت طيفاً رآني ولم يصدق/.
إذاً إلى هذا الحد يشف بسام حجار وإلى هذا الحد له أن يبتعد!؟ ولكن ليس بمناسبة موته أريد أن أردد، ما كان دائماً يمر بخاطري برفقة اسمه، ذلك القول عن (شيللر): (الأنبل بين الشعراء الألمان). هذا إن كان بيننا، نحن الشعراء العرب، من يهمه ادعاء خصلة كهذه.
شاعر السأم العربي
لا أصدق إنني أنعى الشاعر الجميل بسام حجار، ليس لأنه عصياً على الموت، بل لأن بسام هو الذي كتب عن الموت كأنه شقيقه الأصغر، كأنه رسالته الأخيرة التي لم يكن عليه أن يكتبها، بل إن يجلسَ لكي يرسمها الموتُ على ملامحِهِ.
نعم كان بسام حجار هو بودلير القصيدة العربية، وكانت بيروت باريسه، كان شاعر السأم العربي، والصباحات التي يتعطّل فيها اليوم، والتاريخ، وإذا كان الماغوط هو شاعر المدن العربية الفقيرة والمــهدّمة، وكان درويش شاعر الجيوش العربية التي لم تحارب، فإن بسام حجــار هو شـاعر السأم العربي، يقول في إحدى قصائده:
بجانب هذا الحائط/نقفُ/ظلّي المائل وأنا/نبترد/بالهواء الخفيض المُشبّع/بغبار الرَّمل/وروائح النفايات/والينسون.
بسام هو الشاعر الذي بلغَ به السأمُ حداً يدفعه لترك النهار كله لابنته، أو لجاره الذي «يشغله بضحكته الصباحية وبمئة وعشرين كيلوفراما من الرضا والعافية والسعادة».
عن نفسي أحببته في دواوين «بضعة أشياء» و«مهن القسوة» وبدا لي دائماُ ـ أنا الرجل الذي لن يلتــقي به أبداً ـ أنه رجل يخـفي حبـاً عظيماً عن العالم بقسوة كهذه.
أعترف أن ترجمات بسام حجار كانت دليلاً لا تخطئه عين عاشق للروايات المترجمة مثلي، أصبح ماركة مسجلة عندي بعد قراءة ترجمته الرائقة لرواية «أمس» للكاتبة «أغوتا كريستوف» ومن بعدها صرتُ لا أذهب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أن يكون صديقي بسام معي،
وداعاً أيها الشاعر الكبير..
المثـــال
أرقى المكافآت التي نلتها منذ ادعائي كتابة الشعر وامتهاني العمل الصحافي كانت صحبة ظلال بسام حجار.
أجمل صدف الوظيفة والحياة اليومية كانت صداقة شخص بسام حجار. وأفضل عاديات نهاري كانت رفقة الشاعر بسام حجار.
قبل بسام حجار كان هناك دوماً «تمثيل» للشاعر، «أداء» مدبر للمثقف، «استعراض» مفتكر به للكاتب... قبل بسام حجار كانت الشخصيات الموصوفة اختراعاً واصطناعاً ومسرحاً ودوراً وتصوّراًَ افتراضياً.
وذلك كان فقط حقيقياً وأصيلاً في بسام حجار إلى درجة لا تصدق، الى حد أننا كنا دوماً نروي للآخرين انه هو ذاته ودوماً، ويندهش الذين لا يعرفونه عن قرب «غريباً»، وكنا نشعر باستمرار أن تعلقنا به وبصداقته وشغفنا به هو ان نحفظ له «غربته» عنا، وأن نبقي فواصله وحواجزه اللامرئية بينا وبينه، لكي يظل مطمئناً إلينا ويمدّنا بكل هذه المودة النقية، هذه المحبة المستمدة من مسيحية فيه تبدو إعجازية وفوق بشرية.
معه كنا نتمرن على الدوام لنجاريه في الرقة والعذوبة والتواضع. ونتمرن بأن نكون «شعراء» لا في الكتابة، إنما في التنفس والتحدث والسكوت. ان نكون أرهف وحقيقيين مثله قدر المستطاع.
شخصياً، خسرت المثال الذي أخجل أمامه، وأتهرب منه كي لا ينفضح نقصاني.
رأى في القبر وطناً
كان الموت حاضرا في قصائد حجار. كأنما كان يناديه. كنت أرى عبر قصائده انه قرر ان يتخذ القبر وطنا. ولم يكن حديثه عن الموت حديثا تقليديا ولا حتى غير تقليدي فلم اكن اراه مشغولا بكونه تقليديا بقدر انشغاله بالقصيدة ومعاناته فيها. في مجموعته «فقط لو يدك» جمل تصلح ان تكتب فعليا على شواهد القبور. هكذا كانت رؤيته للموت تبدأ من شاهد القبر لتصل الي معان عميقة في هذا السؤال تخص حجار وتخصنا معه جميعا.
راح حجار الذي استطاع عبر مجموعاته وترجماته ان يخلق ركنا يخصه ويغني ـ كما أراه ـ بصوت فريد استطاع تكوينه من حياته اليومية من انكساراته من صدمة الموت من تراث الادباء العالمين الكبار الذين توحد بهم عبر الترجمة.
خلق حجار حساسية رهيفة توسلت مفردات العادي لخلق ما يشبه اسطورة تحتفي بالعزلة والفقد في قصائد تحفر عميقا في داخلنا وتجعلنا مرة اخرى نرى الالم بشكل جديد.. وداعا بسام.
موتي الشخصي
كنت أظن أن بسام حجار كأغلب الشعراء البعيدين عنا، نحن سكان الجزر المعزولة بمسوّغات شتّى، غير موجود في الحيّز الذي يشغله لحم ودم وما تستتبعه تصاريف الحياة من زواج وترجمة وتدخين ووو.. وأن ما يصلني منه، خارج الشعر هو محض عمل هام لكنه «ناشف» لآخر يشبهه، له نفس النظرة الغائمة ويرتدي نفس الملابس وربما نفس ظل الدركي الشفيف يحوم فوق رأسه، وأكاد أقول: له نفس الإله الذاهل.
وكنت أظن أن بسام حجار نبيل من القرون الموغلة في القدم والعاطفة، شخصية نسجنا حسناتها نحن شعراء الأقاليم، الذين تختلط لديهم قصائد الشعراء بأساطيرهم الشخصية وطواحين هوائهم, يعيشون في الظن ويقتاتون على الوهم الذي تبلّره كآباتهم وكنت أظن الشاعر عصياً على الموت، بل إن الموت خوفا أو حياء لا يمرّ بناصية مقهاه المفضل. كنت أظن كتاباته عن والده الدركي وأخته وابنته هي كتابة عن والدي وأختي وابنتي، وانه يتعمّد ملاحقة أوهامي ووساوسي ويكتب عنها وكأنها أوهامه ووساوسه.
وحده الموت إذاً، يعيد الظنون إلى افتراضها الأولي المباشر، وحده يمنح القرائن والأدلة.
يا لهذا الموت الذي ما إن فرغ من الآباء (إلا قليلا) حتى انبرى للأعمام، فكأن الملائكة ملّت تسجيل حياة الشاعر وتهيئة الظلال لعبور ألاعيبه البريئة، فألقت ـ دفعة واحدة ـ الملف إلى الموت، وكأن اللغة الأم، الحارسة، مجّانا، لفائف تبغ النخبة، قد رغبت عن المهمة المقدسة، فتركت الشاعر للعبث.
بسام حجار... «إني أتحدث عنك, بفصاحة التوّهم»
صنـدوق أسـرار
بسام من الشعراء الذين كنا ننتظر ما يكتبه ولم يكن يخلفنا حقا. بسام شاعر عرف كيف يقبض على الحزن ويصفيه ليقدمه لنا نحن القراء عذبا صافيا مقطرا. ولم يخلف هذا الوعد في معظم ما كتبه بسام صاحب عبارة خافتة تجعل كل كلمة، وكل استعارة، أشبه بثمرة جديدة ظل يرعاها طويلا كي تثمر في الأخير طمعا مغايرا لم يقدمه الا بسام في اعماله.
التقينا مرتين مرة تلفونيا ومرة وجها لوجه في المرتين كان اشبه بصندوق مغلق علي أسراره. صندوق ربما لم استطع فتحه عندما التقيته ولكن استطعت الاستمتاع بخفايا هذا الكنز عبر قصائده فاعتبرت ان هذه مقايضة عادلة.
عمل بسام على عدد ليس بكثير من المفردات لكنه استطاع تخليق حياة كاملة من هذه المفردات كانت مهملة في الكتابة.. عاملا على انتشالها من سيرتها العادية واعادة بث الروح في حقولها واستعمالها في آفاق الكتابة وتأسيسها لخلق جمالي وشعري شفيف والتلذذ في ترجيع الكتابة بها وصوغ اشياء متروكة التدوين لهيئتها وتفعيل المجرد من غرائزها.
واستطاع الراحل أيضا مد جسور عبر ترجماته. التي كانت في ما اشعر قطعا تمضي حية منه الينا في اختياراته، في اللغة التي ينقل اليها النص الذي اختاره للترجمة من كاواباتا، الى الطاهر بن جلون مرورا بهيدجر وامبرتو ايكو. كانت ترجمة اشبه بما تكون بخلق نص مواز ومد جذور له في اللغة العربية. كنا ننتظر بسام ولكن الموت خطفه منا. لكن بالتأكيد ستبقى قصائده ترسخ لخصوصيته الهادئة التي ستبقى طويلا.