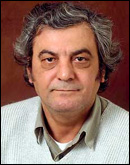 كان الشاعر اللبناني بسام حجار (1955-2009) بين قلّة قليلة من الشعراء العرب المعاصرين الذين كتبوا قصيدة نثر يمكن لنماذجها أن تسدي "خدمة" نوعية خاصة للدراسة النقدية التي تسعى إلى إنصاف جماليات هذه القصيدة، ليس عن طريق القفز مباشرة إلى بلاغة تنصيبها كخيار في الكتابة الشعرية اكتسب شرعيته النوعية والكمية والزمنية، بل قبلئذ عن طريق تناولها كإشكالية ما تزال عالقة في حقل القراءة العريضة والقارىء العريض. وقد يكون هذا الشطر الثاني هو الحيوي والأكثر ضرورة، خصوصاً وأنه يستوجب زجّ قصيدة النثر ـ وعبر نصوصها الأفضل بطبيعة الحال ـ في منطقة التحدي المعقدة حيث تستوطن الذائقة، تقليدية كانت أم حداثية، متحركة أم راكدة، أحادية أم تعددية.
كان الشاعر اللبناني بسام حجار (1955-2009) بين قلّة قليلة من الشعراء العرب المعاصرين الذين كتبوا قصيدة نثر يمكن لنماذجها أن تسدي "خدمة" نوعية خاصة للدراسة النقدية التي تسعى إلى إنصاف جماليات هذه القصيدة، ليس عن طريق القفز مباشرة إلى بلاغة تنصيبها كخيار في الكتابة الشعرية اكتسب شرعيته النوعية والكمية والزمنية، بل قبلئذ عن طريق تناولها كإشكالية ما تزال عالقة في حقل القراءة العريضة والقارىء العريض. وقد يكون هذا الشطر الثاني هو الحيوي والأكثر ضرورة، خصوصاً وأنه يستوجب زجّ قصيدة النثر ـ وعبر نصوصها الأفضل بطبيعة الحال ـ في منطقة التحدي المعقدة حيث تستوطن الذائقة، تقليدية كانت أم حداثية، متحركة أم راكدة، أحادية أم تعددية.
وفي مجموعته "بضعة أشياء" (1) بصفة خاصة، ولكن أيضاً منذ مجموعته الثالثة المتميّزة "فقط لو يدك" (1990)، تسدي قصيدة حجار خدمة خاصة ثمينة لأي نقاش نقدي حول إشكالية الكتابة التي تعتمد النثر لكي تتوسّل شعرية القصيدة، أو الشعر الذي لا اعتراض على تصنيفه في مختلف خانات تصنيف "القصيدة"، ذلك لأنها كتابة تشتغل على شعريات النثر بوصفه نثراً من سلالة النثر، والنثر وحده، فلا تهرب به إلى وراء أو أمام، ولا ترحّله إلى مناطق أخرى غير شعريّته. وهي أيضاً كتابة/قصيدة تقطع الخطوة الضرورية التالية، حين تقترح "غريزة شكل" خاصة بها، تتكوّن أثناء برهة القراءة وبسبب من معطيات القراءة، فيصبح من نافل القول إنها تقطع الطريق على قدوم القارىء إلى القصيدة متأبطاً غرائزه المسبقة الصنع حول الشكل، أو تختزل كثيراً فرصة قدومه متشبثاً بأعراف جاهزة حول شكل واحد وحيد ترسّب طويلاً في قرارته ولا ينوي اللجوء إلى سواه إذ يقرأ القصيدة.
في المقطع التالي من "حين تكون السماء ليلاً، حين يكون الليل سماء"، وهي أطول قصائد المجموعة ( 189 سطراً) ولعلها بين أرفع نماذج قصيدة النثر العربية في عقد التسعينيات بأسره، يكتب حجار:
وأحببتُ الوردة ولشدّة
ما أحببتُ
جفّت البتلات
وما علمتُ قبل الآن أنّ
يدي البلا ملمس
هي يد الميت الذي كنتُه
وقلبي قربة من البكاء،
وجسمي فزّاعة طير
نُصبت في برّية موحشة
حيث لا تنضج ثمار.
فيزجّ قارئه في تلك الشبكة الغامضة/الأليفة من عمارة شعرية تبدو غاية في حدّ ذاتها، وليست نتاجاً لتعالق المعنى والصور والتراكيب والألفاظ والأصوات. وتبدو كمَنْ يجرّ اللغة إلى ما هو أبعد من اللغة، وإلى كثافة رهيفة منتقاة من تجربة إنسانية يتعذّر على أية لغة أن تعبّر عن كامل أبعادها. هي برهة فريدة من ائتلاف عناصر الشكل على النحو الشعائري "الخام" الذي يتيح انطلاق العبارة، أبعد بكثير من حدود ما هو موروث في المفردات والجمل والمعاني. وهي نموذج رفيع لذلك المستوى الذي بحث عنه الشاعر الفرنسي ستيفان مالارميه في أي شعر عظيم: التقاط "سديم لا يُثمّن، هو ذاك الذي يسبح في اللجّة السرية لأي فكر إنساني".
في مثل هذا النوع من الشعر، الذي ظلّ يكتبه حجار، ونفر (قليل، لسوء الحظ) من شعراء قصيدة النثر، يتعالى صوت الشعر، وليس استيهامات "الإيقاع الداخلي" و"انفجار اللغة" و"الانزياح المجازي"، وسواها من مصطلحات تسفيه الشعر والشعرية. ويصعب على قارئ متوسط الدربة (فكيف بذاك المتمرّس!) أن يخضع هذا الشعر إلى مرجعية شكل مسبقة الصنع والاستقرار، كأن ينقّب فيه عن معيار الإيقاع التفعيلي مثلاً، أو أن يلتمس طرائق "الإيقاع" الذي عوّدته عليه النماذج الركيكة من النثر الشعري المبتذل (التكرار بصفة خاصة، والتوزيع البهلواني لعشرات الصور والاستعارات). الإيقاعات هنا ليست "داخلية" كما أنها ليست "خارجية" أيضاً. وهي ليست فيزياء الوَقْع وحده، ولا سيمياء اللغة وحدها. إنها، ببساطة فنيّة بارعة، معجزة تجريدية مفتوحة على فضاء بالغ الخصوصية من حوار المعنى والصوت في برهة شكل صافية، وبوسيلة لغة ساعية أبداً إلى ما هو أبعد من أي تصريح لغوي مسبق.
كذلك يصعب على قارىء هذا النوع من الشعر أن يخسفه إلى قراءة "محايدة" متحللة من معيار اللغة الشعرية الأمّ، كما هي حال القارىء إذ يقرأ قصيدة مترجمة، فيصبح في حلّ من التماس خصوصيات نسيجها اللفظي، أو أبنيتها الإيقاعية. قصيدة حجار مكتوبة بلغة واحدة وحيدة هي العربية، أو الفصحى وهي تؤدّي عشرات الوظائف الشعرية الرفيعة، والفصحى التي لا تتردد أصداء "عجماء" في جملها وتراكيبها واشتقاقاتها ومعانيها وظلال معانيها. وحين يكتب حجار:
قالَ اتبعني
وما أحببتُ شيئاً
إلا أماتني
وأحياني كطيفٍ
ثمّ صار غريبي
فإن لغته العربية هذه ليست النظير الشعري للعربية التي يستخدمها القارىء عند قراءة نصّ مترجم من أرتور رامبو أو ت. س. إليوت أو يانيس ريتسوس، أياً كانت سويّة الترجمة. اللغة هنا جزء عضوي صانع لغريزة شكل خاصة بقصيدة حجار، وعنصر مشارك في برهة تكوّن الشكل أثناء قراءة محددة لقصيدة محددة بدورها، اسمها في المثال أعلاه "اتبعني قال الملاك". ولأنّ قرينة الشكل المسبق، المترسب عميقاً في قرارة القارىء، ينبغي أن تسقط سريعاً من حساب قراءة هذا الشعر، فإنّ رهان القصيدة الأكبر سوف ينحصر في مدى قدرة الشاعر على اقتراح الشعر وحده، وتوريط القارىء في جهد العثور على ما هو شعر فقط وليس تحايلاً خطابياً على قول الشعر. ذلك يرقى ـ بضرورة الشكل أوّلاً، ثمّ ميادين اشتغال النصّ الشعري الأخرى ـ إلى مستوى تخليص النثر مما فيه من "قول نثري" يردّه ويرتد به إلى أرومته الخطابية المصنفة: نثر المسيو جوردان دون سواه، صاحب موليير، الذي هو فنّ بدوره، ولكنه غير الشعر!
وفي مقابل السؤالين الشهيرين حول القول الشعري: "لماذا لا تقول ما يُفهم" و"لماذا لا تفهم ما يُقال"، وقف حجار قاب قوسين أو أدنى من اقتراح سؤال ثالث: لِمَ لا تفهم ما لا يُقال؟ إذْ "لعل الجدوى، كلّ الجدوى، في إبراء حدّ الشعر مما يكتنف القول من لغو ورطانة" (2). وأن يفهم القارىء ما لا يُقال في القصيدة مسألة تعنى ذهابه إلى صمت القصيدة، واستنطاق صخبها الخفيّ أو المتخفي، أو قيام القارىء نفسه بصياغة هذا الصخب إذا تعذّر استنطاقه من واقع القصيدة. (وبسام حجار تساءل، بالفعل، عما إذا كان الشعر "حدّ استقراء الصمت. فقط").
ولكنّ عمليات كهذه لا تجرى في مستوى "تفكيك" القصيدة إلى وحدات من القول الذي لا يُقال، إذ أنّ نشاطاً كهذا لن يتجاوز حدود التنقيب عن وحدات المعنى والدلالة والأفكار... التي يمكن العثور عليها مهما تستّرت واستترت، وأياً كنت وجهتها في "تضييع" القول وتحويله إلى "ما لا يُقال". ذهاب القارىء إلى صمت القصيدة، وبالتالي إلى جوهرها الذي يتوجب أن لا يُقال بالفعل، هو في المقام الأوّل صيغة تعاقد مع الشكل الشعري، الذي يصنع وحده سلسلة المعطيات التعبيرية الكفيلة بتقديم وحدات المعنى والدلالة والأفكار: بهذه الوجهة البارعة (حين ينقلب نثر الحياة اليومية إلى لغة شعرية فقط)، أو بتلك الوجهة الرديئة (حين يراوح نثر الحياة اليومية بين توظيف "الشاعرية" الطبيعية الكامنة في اللغة والمشاعر والأشياء والملقاة في الشوارع، وبين تشويه هذه الشاعرية عن طريق تصنيعها إلى "شعر" ليست قرينته الكبرى سوى الترتيب الطباعي للنصّ في صيغة سطور شعرية!).
وإذا كان لنثر الحياة اليومية أن يحتوي ما شاء من لغو ومن معنى، من رطانة ومن فصاحة، من ابتذال أو جزالة، فإنّ "نثر الحياة" ـ وهو ليس سوى اللغة الشعرية كما حلم بها بودلير ذات يوم ـ لا يمكن أن يكون لغة شعرية ونثر حياة يومية في آن معاً، وليس له أن يتبرأ من معضلة القول النثري لمجرّد أنه يطلق على النثر تسمية الشعر. إمّا أن يكون لغة شعرية، لها ما لها وعليها ما عليها في حساب الشعر قبل حيثيات ما يُقال وما لا يُقال، أو هو لغة نثرية حسابها التعاقدي الأول يدور حول وظائف خطابية مثل الإيصال والاتصال.
وكان حجار أستاذاً ماهراً في صياغة تلك التعاقدات مع الشكل الشعري، وفنّاناً متمرّساً في تنويع بنودها وشروطها وآجالها ضمن القصيدة الواحدة أو في مجموعة قصائد، وشاعراً مرهفاً مثقَلاً بوطأة نفسه. وكان دائم التوغّل في سطوحها حيث يتّسق الصخب الناجم عن احتشاد الأشياء والعناصر في العالم الخارجي، مع الصمت المطبق الآسر الذي يخيّم على الأعماق السحيقة من العوالم الداخلية لنفس آدمية الحسّ والحساسية. في قصيدة "المنام" يكتب حجار:
أكانَ في وهمنا فقط
أن الشمعة كانت تنزّ ضوءاً
تالفاً
وظلال الأيدي تثرثر على الجدران،
وأن الجسد المسجّى
ليس أختاً
لأن الأخت منامٌ أبيض
لرجل
تريّث في نومه
أو ضلّ طريقه إليها
فآوته الشجرة المستوحدة
في ظلّها.
غريزة الشكل في هذا المقطع يمكن أن تبدأ من إيحائية لامحدودة في تحوّلات وتجاورات مفردة واحدة مثل الأخت: جسد مسجّى ليس أختاً/ منام أبيض/ منام لرجل تريّث في نومه/ الأخت رجل ضلّ طريقه إلى الأخت/ الشجرة المستوحدة آوت الرجل ـ الأخت في ظلها/ الظل المرتد إلى ظلال أيدٍ تثرثر على الجدران/ الظلال التي تصنعها شمعة تنزّ ضوءاً تالفاً/ أكان وهماً؟ أو يمكن أن تبدأ من انفصال الدلالة بين مفردات مثل وهم، شمعة، تالف، تثرثر، أخت منام، أبيض، شجرة؛ أو اتصال العلاقات المجازية في جمل صُوَرية مثل: شمعة تنزّ، جسد مسجّى ليس أختاً، أخت منام أبيض، رجل تريّث في نومه، شجرة مستوحدة في ظلها.
أو قد تبدأ من الدور الإيقاعي الذي تلعبه وحدات نحوية مثل أدوات وحروف الاستفهام والنصب والعطف والاستئناف، في سياق أزمنة فعلية متغايرة. والأرجح أنّ غريزة الشكل سوف تبدأ من هذه العناصر بأجمعها، فضلاً عن الكثير سواها من عناصر القراءة الفردية التي قد يستولدها كلّ قارىء لنفسه، بوحي من معطيات نفسه كما قرأت "صمت" المقطع، وكما استلمت ما لم تقله السطور الشعرية جهاراً، وذلك لأسباب فردية تماماً، وليس في وسع أي رصد تحليلي معياري (وقياسي، بالضرورة) أن يلمّ بها، بل ومن الخير له ألا يفعل في الأساس!
ولقد مارس حجار الكثير من النواس البارع بين الإيحاء بما لا يوصف لأنه يفوق الوصف، ومقاربة العديد مما يوصف بالفعل لأنه يساهم في توسيع إيحائية ما لا يوصف. الحالة الأولى هي حصّة النفس من التجربة الداخلية، الإنسانية بكلّ ما تعنيه الكلمة وعلى العكس مما يلوح للوهلة الأولى. والمرء يسمع في كل يوم تلك العبارات البسيطة (المدهشة!) التي تقول: "لا أستطيع أن أصف شعوري حيال..."، أو "لا أعرف كيف أصف حالتي عندما..."، أو "إنني عاجز عن التعبير عن...". وفي ذلك كله ميل إلى تثمين تجربة إنسانية فريدة، مع إعلان العجز (وربما العزوف) عن إيصال خصوصيتها إلى الآخر. والقصائد العشرون في "بضعة أشياء" تتوغّل في قرارات عميقة من تجارب شعورية ووجودية إنسانية كبرى، وتنجز مستويات رفيعة من التجسيد الشعري لتلك التجارب، والأهمّ من ذلك أنها لا تصادر حق القارىء في حسن (أو حتى في اساءة) استخدام المستويات ذاتها لصناعة تجسيدات أخرى حول التجارب ذاتها.
في الشطر الثاني من حالة النواس البارع، يصف حجار سلسلة من الأشياء (بضعة أشياء!)، من منظورات مكان داخلي بدوره قد يكون حجرة أو رواقاً أو نفقاً، ولكن دون أن تنفصل الأشياء وأمكنتها عن الشراكة الإنسانية (وهذه بدورها حصة إضافية لتوسيع التجربة الإنسانية). وعلى سبيل المثال، تنقسم قصيدة "المراثي الثانية" إلى ثلاث قصائد، حول ثلاث علاقات مع الأشياء: "بضعة أشياء لا أعرفها"، "بضعة أشياء أعرفها وحدي"، "بضعة أشياء فقط". الرثاء هو الموضوعة المشتركة بين القصائد الثلاث، ومناخات الرحيل الجسدي تتكثّف على نحو وجداني مؤثّر، وإنساني فذّ. براعة حجار تبلغ أفضل مستوياتها حين يسند إلى الأشياء دور الحامل الدلالي غير المباشر لموضوعة الموت، بعد أن ينتقيها بعناية، ويستعرض ما في باطنها من قدرة غامضة ـ وطازجة ابتدائية من مادّة خام ـ على الإيحاء المفتوح بمناخات الموت. لكن مفردة الموت ذاتها لا تَرِد البتة إلا بصدد الكناري الذي أماته البرد، وباستثناء مفردة واحدة هي "نعش"، ليست ثمة وحدة معجمية تدلّ مباشرة على الموت، وثمة بالمقابل الكثير الكثير الذي يوحي بمستويات موت متضاعف، استثنائي لأنه مشحون بهاجس إنساني فريد.
وليس بغير مغزى خاص أن تسعة أعشار الأشياء التي تحتشد في هذه القصيدة الثلاثية البارعة، والتي ليست سوى العناصر التكوينية الصانعة لموضوعة الموت، كانت قد احتشدت من قبل على نحو شبه تسجيلي في نصّ نثري، فاتن بدوره، عنوانه "ما قاله أبي عن الشجرة والكناري والسعال" (3). ورغم ما انطوى عليه ذلك النصّ من مهارات عالية في التماس شعريات النثر، فإن حجار ظلّ حريصاً على انتماء مادة النصّ إلى نثر الحياة اليومية، لكي تكون "المراثي الثانية" قصيدة شعر، خالصة، مخلَّصة من كلّ ما هو لغو يقتل الشعر.
وحين اختار حجار، بنفسه، جمهرة قصائده المنشورة التي اعتبر أنها سوف تحيا من بعده (4)، بدا أكثر تصميماً على إبراز تلك السمة المركزية التي طغت على مسيرته الشعرية، وحكمت غالبية خياراته الأسلوبية: إبراء الشعر من أمراض اللغو، التي قد تنقلب بالفعل إلى أوبئة. ولقد كتب في المقدّمة: "خشيتي من الوفرة والاتساع جعلت منّي كاتباً بمفردات قليلة. وقد أحصيتها، إذا جاز لي، في كتاب أخير، فلم أعثر منها إلا على اثنتي عشرة مفردة هي: مفردة، غريب، درب، حكاية، ظلّ، أبي، صحراء، رمل، بئر، أثر، كتاب، معجم. فإذا حذفنا "كتاب" و"معجم"، لالتباس تعريفهما، لم يتبقّ سوى عشر مفردات"...
وبتواضع الفنّان الكبير، ختم حجار هكذا: "لم أصدّق من الخبر إلا صنعتَه وهي سابقة عليه؛ ومن الرواية إلا شتاتها؛ ولم آنس من الأحاديث الخافتة إلا انقطاعها في موضع سرّ. وحاولت القول في كلّ المواضع، ولم أهتدِ إلى القول. خُبْرٌ ضئيل لحياة قليلة. أيكون هذا ما يشبه الشعر؟ لقارىء الشعر فقط أن يدلّني".
" ناقد من سورية
القدس العربي
26/02/2009
***
بسام حجار يرحل إلى حيث سعى بشعره وقدميه
عاش قريباً من الموت وكتب عن الزهد والفقد والهجر والخسارة
20-2-2009
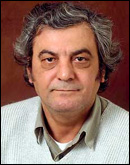 بيروت- “القدس العربي” رحل أمس الأول الشاعر اللبناني بسام حجار مخلفاً وراءه نحو اثنتي عشرة مجموعة شعرية وأكثر من ستين كتاباً في الترجمة.
بيروت- “القدس العربي” رحل أمس الأول الشاعر اللبناني بسام حجار مخلفاً وراءه نحو اثنتي عشرة مجموعة شعرية وأكثر من ستين كتاباً في الترجمة.
الشاعر الذي كتب عن الموت أكثر من أي شاعر آخر في العالم العربي عاش في عزلة شبه تامة، ولا سيما في السنوات العشر الأخيرة. سكن حجار في صيدا (جنوب لبنان) ولم يكن يزور بيروت إلا للعمل في ملحق “نوافذ” في صحيفة المستقبل، ليعود مسرعاً إلى عزلته المنزلية. هناك حيث كتب وكتب وكتب عن المنزل وعائلته وهذه الأشياء البسيطة والقليلة من حوله. كتب بسام حجار بكلمات قليلة عن موضوعات قليلة، مكرراً حقله المعجمي وموضوعاته الحميمية الأثيرة. لكنه كان من هذا التقشف والتكرار يصنع عالماً واسعاً من الدهشة هو الذي فقد الدهشة منذ زمن. كتب حجار بلغة غنائية، شفافة، رقيقة، خافتة، زاهدة، مؤلفاً صوتاً خاصاً به ودالاً عليه.
ولد بسام حجار في صور، جنوبي لبنان، في 13 آب (أغسطس) 1955. درس الفلسفة في الجامعة اللبنانية، قبل أن يتخرج من جامعة السوربون في باريس في الدراسات المعمّقة في الفلسفة. عمل في الصحافة منذ عام 1978 فكتب في “النداء”، قبل أن ينتقل إلى “النهار” حيث ظل يكتب أكثر من عقد حتى عام 1990، وكان أحد مؤسسي ملحق النهار الأدبي. وفي عام 1999 انتقل إلى صحيفة “المستقبل” حيث عمل في ملحق “نوافذ”.
في الترجمة ترك حجار أكثر من ستين كتاباً تنوعت ما بين الرواية والفلسفة والاجتماع، ناقلاً أبرز الأسماء العالمية أمثال ياسوناري كواباتا، بورخيس، سالنجر، بيتر هاندكه، الطاهر بن جلون، بوهوميل هرابال، يوكو أوغاوا، جان أشينوز، كارلوس ليسكانو، أمبرتو أيكو، آغوتا كريستوف، إميلي نوثومب، إيتالو كالفينو، جيزوالدو بوفالينو، كريستا وولف، جان بودريار، مارتن هايدغر، ألكسي دو توكفيل، جاك دريدا وأسماء أخرى كثيرة. كما صدر له كتاب حول تجربته في الترجمة بعنوان “مديح الخيانة”.
ترك بسام حجار مجموعات شعرية غدت علامات في قصيدة النثر اللبنانية: “مشاغل رجل هادئ جداً” (1979) “لأروي كمن يخاف أن يرى” (1985)، “فقط لو يدك” (1990)، “صحبة الظلال” (1992) “مهن القسوة” (1993)، “معجم الأشواق”، (1994)، “مجرد تعب” (1994)، “حكاية الرجل الذي أحب الكناري” (1996)، “كتاب الرمل” (1999)، “بضعة أشياء” (2000)، “ألبوم العائلة يليه العابر في منظر ليلي لإدوار هوبر” (2002)، و”تفسير الرخام” (2006). كما صدرت له مختارات شعرية بعنوان “سوف تحيا من بعدي”.
هنا شهادات في الراحل:
إيجاد التطابق بين اللغة ومشاغل الحياة
حمزة عبود (شاعر)
لا أعرف إذا كنت أستطيع (أو إذا كان يحق لي) أن أتحدث عن بسام في الساعات الأولى لغيابه- ويبدو لي أن اختصار سنوات صداقتنا التي تشكل مساحة هي الأكثر تعبيراً ووضوحاً في مسيرتنا الشعرية والذاتية، وأنا أقرأ تجربته الشعرية منذ صدور ديوانه الأول “مشاغل رجل هادئ جداً”- يبدو أن هذا الإيجاز وهذه القراءة ليسا ممكنين في هذه السطور القليلة. ومع ذلك فإنني أحاول استعادة ملامح بسام من لقاءات ومناسبات ومن قراءات وحوارات وأحلام وهواجس عشناها معاً كانت تعيد صياغة علاقتنا بالعالم. كان بسام المنهمك دائماً في البحث عن عناوين ونصوص (شعرية وأدبية وفلسفية) جديدة منشغلاً في ترتيب حياته بين البيت والكتب والأصدقاء. وكان هذا المثلث يعيده إلى علاقات وأفكار أكثر ألفة وتواصلاً مع الحياة.
جِدة بسام وتميزه يعودان إلى محاولة إيجاد تطابق بين اللغة وعلاقات ومشاغل ظلت متوارية في خطابنا الثقافي والنقدي، بل هي تكاد تتوارى في حواراتنا اليومية مع ذاتنا ومع الآخر.
كانت لغة بسام الخافتة وراء الأبواب وبين الأصدقاء والكتب وفي أرجاء غرفته وأدراج خزانته ومكتبه وخلف الستائر... كانت لغته الخافتة هذه أكثر نفاذاً إلى حقيقة الأشياء وربما إلى حقيقة وجودنا.
عرف بسام حجار أن ملامسة عالمه أو ما يحيط به ليس ممكناً دون الخروج من ثوب اللغة الفضفاض والموشّى بزوائد لا قيمة لها. وهو عرف كيف يضع ذلك في تجربة أكثر استشرافاً للواقع سوف نتعلمها في تجاربنا اللاحقة.
ثمة عناوين وقراءات أخرى لا تتسع لها هذه السطور يمكن أن تضيء تجربة بسام لتأخذ حقها ولتحتل مكانتها في الحركة الشعرية الحديثة...
أظنني أوجزت نقاطاً وعلامات تحتاج إلى شرح أكثر توسعاً وإيضاحاً حول تجربة بسام الشعرية، هذه التجربة التي شهدتُ ملامحها ومكوناتها يوماً بيوم وكلمة بكلمة خلال سنوات صداقتنا، تلك التي أحب أن أفرد لها أيضاً وقتاً وقراءة تستحقهما.
من المكان الضيق
كتب العالم الواسع
حسن داوود (روائي)
صلتي ببسام تعود إلى ثلاثين سنة. كنا معاً نقرأ كتاباتنا الأولى التي لم تكن الأولى في الحقيقة لأنها نُشرت في ما بعد في كتب وصحف.
بسام شاعر نادر، صوته الشعري متميز. أنا شخصياً لم أقرأ في الشعر العربي ما يماثل هذا الشعر، ولا أتكلم هنا عن القيمة فقط رغم القيمة الكبيرة لشعره، أتكلم عن هذه الظلية إذا أمكن التعبير في كتاباته، حيث الحياة كأنها جارية في الظل أو في عالم ضبابي كثيف. بسام كان أقرب إلى نفسه، ميالاً إلى الانكفاء والعزلة. في عمر الكتابة الأول كان مقبلاً على الحياة، وراغباً في استقبال الناس والسهر إنما في بيته. حتى في ذلك الوقت لم يكن يحب الخروج كثيراً. قلما أتذكره إلا في بيته، باستثناء قبرص حيث عشنا معاً بسام وعباس بيضون وأنا في ليماسول، وقد كتب كل واحد منا عن تلك التجربة.
بما خص صداقتي لبسام، هذه الصداقة التي كان عليها بعد بدء سنوات عزلته الشخصية، كان عليها أن تصبح صداقة صامتة. لكن المودة والألفة ظلتا قائمتين، إنما بنوع من لغة التخاطر والصمت، لأنه كان قليل الكلام وقليل الرغبة في إظهار الوجود. بدا في السنوات الأخيرة كأنه طيف. وهذا الشيء كان يظهر في أدبه. مثلاً، الحيز المكاني في كتابة بسام كان ضيقاً لا يتعدى عتبات البيت. لكنه استطاع من هذا المكان الضيق أن يصنع عالماً هائل الاتساع والعلو، ذهب به إلى مكان أعمق. وهنا أذكر قصيدته التي كتبها في رثاء أبيه. كان شعره أقرب إلى الرثاء أو مجاوراً للرثاء حتى لو لم يكن يتكلم عن الموت. هناك جانب آخر من شخصيته النهمة والمحبة للاطلاع، وأقصد به ترجماته التي زادت على الستين كتاباً، وهي ترجمات مشغولة بحرفة عالية، وذات خيارات جيدة تمتد من فرنسا إلى وسط أوروبا إلى البلدان التي انشقت عن المعسكر الاشتراكي. لهذا يعود إليه الفضل في كثير من ثقافة القراء وذلك من خلال جهده في الترجمة.
فضلاً عن ذلك كان بسام متابعاً لمسائل لا يحب الشاعر عادة متابعتها من رياضة وسياسة وغير ذلك.
بسام طبعاً خسارة كبيرة. أعتقد أن اهتداء الناس إليه، وخصوصاً الآن بعد وفاته، هذا الاهتداء سيغلب ميله إلى العزلة والانكفاء. بسام خسارة كبيرة للشعر.
الأكثر تأثيراً
شوقي بزيع (شاعر)
لطالما كان بسام حجار قد فتح منذ يفاعته أبواباً سرية على الموت، وهو ما لا يحتاج إلى جهد كبير لكي نتحقق منه. فسلوكه الشخصي كان ينمُّ عن ضيق بالحياة وتبرّم بأحوالها. لم يكن قابلاً للدهشة من أي شيء حتى حين كان جيلنا يقف فاغراً فاه أمام فتنة النساء أو لمعان الكؤوس أو دهشة اكتشاف العالم. بدا بسام كأنه قد خبر الحياة وتعب منها حتى قبل أن تبدأ. وربما كانت النافذة الأهم التي تربطه بها هي نافذة بيته وعالمه العائلي. الشيء الوحيد الذي أدهشه أنه كان ينتمي إلى أسرة أحبها فكتب عن أشياء المنزل ومقتنياته وكتب عن الزوجة والحبيبة والابنة. وبدا أنه شاعر الفقدان بامتياز فلم يكتب عن شيء إلا وخسره في الخطوة التالية. أحب أخته دلال الممتلئة بالأنوثة والخفر في الآن ذاته. وحين فقدها في حادث سيارة مروّع حملها معه إلى القصيدة في كتابه المؤثر “مهن القسوة”. وخسر أباه أيضاً ثم حمله بدوره إلى الشعر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة التي أحبها والتي شاطرته جزءاً من حياته. الشيء الأهم بالنسبة الى بسام أنه حين يهم بالكتابة كان يتخفف من كل قراءاته وأفكاره النظرية وثقافته الواسعة ويرى إلى الأشياء ببساطة طفل مستنفداً بصره وبصيرته وقدرته على التصوير المشهدي وتقليب الأشياء على وجوهها عبر لغة حسية جارحة لا أثر فيها للمثاقفة أو التنظير أو الادعاء. وكانت لغته تغوص في أحشاء الحياة بحثاً عن لقية أو جوهرة ما تلمع في الداخل. أعتقد أنه واحد من الأصوات الأكثر تأثيراً في الأجيال التي أعقبته وقد ترك بصماته حتى على بعض أبناء جيله وبعض السابقين عليه في العمر.
لا تذهب إلى الجوار المخيف
إسكندر حبش (شاعر)
“أوصيكِ ألا تذهبي إلى الجوار/ الذي أخافه/ كم أغضب منك لأنك فعلت/ قولي إنك أسأت استخدام الوقت/ ما بعد الظهيرة/ وإنك ذهبت/ أبعد ممّا أظن/ أبعد ممّا أعرف/. ولكن قولي هل بيتك الآن أرحب؟”...
بهذه الكلمات تحدث بسام حجار في قصيدته “لا تذهبي إلى الجوار المخيف” مخاطباً أخته دلال التي رحلت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. ولا أعرف أيضاً، لِمَ اخترت، أنا، هذه القصيدة لأضعها في مختارات الشعر اللبناني الذي صدر ضمن مشروع كتاب في جريدة، في الصيف الماضي.
أشعر بثقل ذلك الآن. وكأني كنت أرثيه قبل الأوان حين استعرت صوته وكلماته. كنت أريد أن أظهر رثاء الحياة أيضاً التي كتب عنها بسام في غالبية كتبه الشعرية. لكنها الحياة التي تغادرنا الآن، التي تغدرنا الآن، وتترك خلفها الكثير من الحرقة ومن الألم الذي لا نعرف ماذا نفعل به، سوى أن نحمله معاً حتى نهاية الذاكرة، حتى نهاية هذه اللعبة السمجة التي نسميها اصطلاحاً... حياة. حتى نهاية الألم نفسه إذا كان ذلك ممكناً.
“سوف تحيا من بعدي”، كان العنوان الذي اختاره بسام حجار عنواناً لمختاراته الشعرية التي أصدرها عن “المركز الثقافي العربي” في بيروت العام 2001 والتي ضمّ فيها بعضاً من شعره الذي نثره سابقاً في غير كتاب ومجموعة. يومها كتب لي الإهداء التالي: “إلى الصديق الشاعر... إذا كان هذا كلّه وهمّاً بوهم، عسانا من نكون؟”.
عنوان وجملة، يجعلانني أستعيد هذه الأوهام التي غادرها بسام، صبيحة الأمس. بالتأكيد سوف نقول إننا سنحيا من بعده، (وسننتظر أن نقولها لغيرنا أيضاً) ولكنها حياة أليمة فعلاً، حين ينسلخ منها هذا الجزء الذي كان بسام حاضراً فيه. هي صداقة وتفاصيل عديدة وكتب ولقاءات وشعر والكثير من الكلام الذي كنّا نتبادله في شتى المناسبات. لكن ذلك، في هذه اللحظة، ليس سوى وهم بوهم. إذ فعلاً “عسانا من نكون؟”.
لست شيئاً الآن. ولم يعد باستطاعتي أن أوصي أحداً بأن لا يذهب إلى الجوار المخيف. كل ما أستطيعه أن أصرخ معه، مستعيداً ما قاله عن شقيقته: “كم أغضب منكَ لأنك فعلت”.
الزاهد في عيشه وشعره
صباح زوين (شاعرة)
“لا أبالي بي إذا متُّ أمس أو اليوم أو اليوم الذي يلي. ولا أدري ما الحكمة من اختصار عمري برقمين وفاصلة... وقال الرجل حارس التراب: لكن المكان ههنا ليس هو المكان. قال الرجل حارس التراب: تحلقوا حول الضريح متلاصقين فلا سعة في الأرض ولا تتركوا أثراً إن غادرتم” (من كتابه: “ تفسير الرخام).
“من تكون؟ لست بالتأكيد الجالس على الكرسي خلف الطاولة، قبالة الحائط، ولست المرتحل في وهم الصحراء، ولست مصدر الضوء والانعكاس، ولست الأشكال التي ترتسم متراوحة على صفحة الجدارالأبيض، فما من جدار. إذاًً من أنت؟ هل رفعك السراب شخصاً؟” (من كتابه: “كتاب الرمل)”.
إنه بسام حجار. هذا الشاعر الهادىء، والدمث، والذي يحبه كل من يتعرف إليه، والصامت، والمبتعد عن أي شهوة إعلامية، والمكتفي بوجوده بعيداً عن الضجة والأضواء، والذي لا يؤذي نملة كما نقول، والذي يكتب ولا يدّعي، والذي كتب الشعر في عمق الرؤيا وعميق الوعي، والذي كتب الترجمة دون كلل ولا ملل، والذي تالياًً أغنى المكتبة العربية بالكتب الأجنبية المنقولة بيديه إلى لغتنا .
هل ما قاله بسام حجار في كتبه من قصائد (وأمثلة منها وردت أعلاه)، هل كان نبوءة ذاتية أم حدساً غامضاً أم أن الشعر بذاته نوعٌ من البصيرة و”التبصير” في الغيب وضربٌ من السحر في الفن والمعرفة، السحر الذي يقع من ثم على عاتق الشاعر أن يحوله كلمات وصوراً؟
بدأتُ أقرأ بسام حجار في الصفحة الثقافية في “النهار”، أوائل الثمانينات. هكذا تعرفت إلى بسام. أرى اسمه ومقاله ولا أراه هو. ثم قرأت شعره. ثم غادرت بضع سنوات إلى كندا، وعند أولى زياراتي إلى لبنان سنة 1994، قمت بجولة على زملائي في الجريدة، وفي الطابق الثامن، في مكتب “الملحق”، رأيت بسام للمرة الأولى في حياتي. كان اللقاء دافئاً وهادئاً وتبادلنا كلمات طفيفة وشبه ساكتة، وكان هذا كل شيء. ثم واصلت متابعته شعرياً، وكنت أتأمل عن بعد هذا الشاعر الإنسان المتباعد وغير اللاهث وراء أي متعة اجتماعية (وما الصخب الإعلامي سوى حاجة اجتماعية إلى الظهور)، إنما المنكب بتواضع ورضى على الترجمات وعلى كل كتاباته إجمالاً من شعرية وغيرها.
قبل سنة ونيف: كنت واقفة أمام مقهى ليناز، على الرصيف، في شارع الحمرا. كنت أنتظر آرنيم هاينيمان إذ كنا على موعد، وبمن فينا، بسام. وإذ بشخص يتوجه إلي بالسلام والسؤال عن الصحة، “كيفك صباح؟”. نظرت إليه (كما أنظر إلى الجميع إذ من عادتي أن أنسى الوجوه لا بل أن لا أتعرف إليها بسهولة، وهكذا أنا دائماً)، نظرت إذا ً إليه مستفسرة وشبه غائبة، فقلت له إني “منيحة، لكن عفواً لا أتذكر من أنت”. عندما ذكرني، فوجئت لأنه تغير كثيراً عما كانه في 1994، إضافة إلى سهوي الدائم. هذه كانت المرة الثانية. المرة. الثالثة والأخيرة، عندما سافرنا معاً إلى ألمانيا. وهناك تعرفت إليه عن قرب، وعرفت كم هذا الشخص لائقٌ وكم أعجز عن وصفه. رأيته في ألمانيا يدخن كثيراً ويشرب كثيراً. وكنت أشكو له من دخانه الذي كان يتسرب إلى غرفتي الملاصقة لغرفته في الفندق، وكان يضحك. يضحك كان بسام، هو الذي كان على الأرجح يضحك على ذاته، وعلى الحياة، وعلى هذه الدنيا بكل ما فيها.
بعدما خرج من المستشفى قبل بضعة أشهر، اتصلت به لأهنئه بالسلامة ونصحته بأن لا يستعجل على المداومة في عمله إذ الصحة أهم، وما من شيء يستحق العناء من بعدها. فقال بهدوئه المعهود والزاهد: “الحياة ما فيها شي”.
صحيح يا بسام أن الحياة ما فيها شيء يستحق كل عذابنا وعنائنا، وصحيح أنني أتساءل لماذا علينا أن نذوق دائماً طعم الأسى أثناء وجودنا الموقت وغير المبرَّر، ولماذا يحصل لنا كل ما يحصل، لكنك على الأقل برهنت أنك عشت، وبرهنت أنك كتبت، وبرهنت أنك شاعر ترك كلمة سوف نقرأها دائماً، فبرهنت تالياً أنك استطعت أن تترك أثراً خلافاً لما تمنيته أنت في قصيدتك أعلاه، وبرهنت أن وحدها المحبة تثمر في الحياة وما بعد الحياة، وبرهنت أن الشاعر لا يترك وراءه بعد رحيله سوى قصيدته وطيبته، وأعني بقصيدة بسام حجار، تلك الخاصة في نوعيتها وفي اختلاف صوتها وفي تميزها عن غيرها.
قصيدة بشرية
عناية جابر (شاعرة)
ليلة أمس كنت تحتضر. لم أنم. رافقت احتضارك، أم لعلني غفوت قليلاً وحلمت. أنت الذي عشت حلماً، ورويت حلماً، حلمت بك توضّب ملابسك في حقيبة سفر توسّلتك أن تضع بينها معطفك الأسود لأن الجو بارد. خطر في بالي متذكرة أن معطفك الأسود هذا نفس لون ثياب الرهبان. لاحظت أنك تشبههم لأول مرة واستغربت الأمر. ينبغي على الوسامات الموازية لوسامتك أن تبلغ القمة في اتخاذ رمز عظيم لها. ينبغي لها أن تأسر قلب العالم، كما أسرت قلبي. لم يكفك أن تكون شاعراً عظيماً فحسب، إنما قصيدة بشرية وعلامة طريق إنساني، يحدق فيها العالم غير اللطيف فيحمر وجهه خجلاً. من لطفك أيها اللطيف، نرى إلى وجه المثقف الحقيقي، كما يجدر بالأساطير عنهم، فلا نستطيع أن ننساك بعد ذلك أبداً.
لقد بلغت الآن نهاية روايتك، وتركتها لنا كقوة منقذة. ينبغي على الموهبة والأخلاق أن تؤثر في العالم، وما يؤثر الآن، هو استعراض قوة، وبطش، وتفاهة، ولم تكن هذه المهاترات تناسب عيشك الذي عشته ورويته، ولا جرحك المعروف من كثرة النزف. قصيدتك التي بددت الحياة إلى تفاصيل براقة. قصيدتك التي تستقر في القلب كيفما اتفق، شمعية كما في بيت للعجائب.
كان لنا امتياز أن عرفناك وقرأناك وعشنا معك. كان لنا امتياز معرفة شاعر لم تتضرر علاقته بنفسه أو أصابها الدلال والخواء. امتياز ما يُمكن أن نسميه ثبات الضمير، وثبات الأخلاق، أي خوض النزال بجدارة ما بين التفاهة والثقافة الحقة، وانعكاسها في سلسلة أفعال الشاعر وحياته، التي بقيت حدثه الشخصي كما لو سنبلة مفردة في حقل.
ماذا بسّام؟ تعبت كثيراً جداً! تريد أن ترتاح. أن تستلقي تفكّ القصائد وتربطها ثانية. أنت في المقلب الآخر، حيث أملت أن تلعب مرة دوراً، ولقد تكيفت في حياتك وقصائدك مع “دور الميت” ذاك. لم تكن تخشى الموت، في الكبرياء السالبة لرجل تألم كثيراً، ومنعه الألم من خشية الموت. كنت تقول إنها حياة منهكة فقط، حارّة ومغبّرة.. لو كان بإمكانك أن تتحدث إليّ الآن.
عن الرجل المُوحشة ضواحي قلبه كهواء صفصاف
باسم المرعبي (شاعر)
رجلٌ نحيل هادىء منحنٍ على أوراق أمامه وقرب هذه الأوراق علبة دواء وسيجارة متقدة دائماً. هذه هي صورة بسام حجّار الملازمة لذاكرتي رغم مرور أكثر من عقد ونصف عقد على رؤيتي له وتعرفي عليه للمرة الأولى في “ملحق النهار” وقد كان في أمانة التحرير وقتها حيث شرعتُ بنشر بعض القصائد ومن ثمّ عدد من عروض الكتب وموادّ أخرى كان يستحثّني لنشرها مُبدياً حرصاً واهتماماً حميماً بها لا يزال أثره في نفسي حتى اليوم.
صورة بسام حجّار التي في ذهني، بسام المثقف الشاعر المترجم والدارس المتعمّق ـ كما في دراسته الفلسفة الإسلامية واهتمامه الخاص بابن عربي ـ هي صورة المكدود المجتهد الدؤوب والمنتج بالضرورة فعشرات الكتب التي قدمها للقارىء تأليفاً وترجمة كما مئات المقالات لها القول الفصل في ذلك. ومثل هذه الغزارة، مع الحرص على النوع، لا بدّ أنها تمّت على حساب حياة الشاعر الخاصة ومصادرة الكثير من المباهج ـ إن كان للشعراء، حقاً، أمثال بسّام من مباهج ـ وهو الذي ارتبطت حياته بالألم والفقد فـالكآبة: (قربي جاف وضواحي قلبي موحشة كهواء صفصاف) كما يكتب في “مهن القسوة”، هذا الكتاب الذي أهداه لذكرى أبيه وأخته دلال.
صورة بسام حجّار هي الصورة النضرة للمثقف والشاعر الفاعل، المنتج المنضوي للظلال ـ وله معها صحبة ـ بعيداً عن صخب الادعاءات والاستعراضات التي تسمّم المشهد الثقافي العربي برمته عدا استثناءات قليلة. بهذا المعنى فإنّ قيمة بسام حجّار الشاعر والإنسان مضاعفة كونه علامة مهمة من علامات الشعرية العربية في الثلاثين سنة الأخيرة وصاحب منجز ثقافي كبير (على الأقل عبر ترجماته الكثيرة والمتنوعة) كل ذلك “مكتوماً” بغلالة التواضع والنأي والانصراف إلى العمل. وبهذا تكون الخسارة بغياب شاعر ومثقف من طرازه مضاعفة بكل تأكيد وأسف.
شاعر الخجل
يحيى جابر (شاعر)
مات شاعر الخجل، مات أحد أبرز الشعرية العربية الذي أطلق قصيدة الألم. بسام اشتغل على الألم وذكر الموت، موت أخته وموت أبيه وموته الداخلي. مفردات الموت والفقدان والهجران كانت جزءاً أساسياً من شعره. إنه الشخص الذي تنطبق عليه كلمة شاعر. وهو المترجم الأفضل الذي عرّفنا إلى الغرب والآخر بلغته الرائعة وترجماته الوفية والمخلصة. من المؤكد أننا سنفتقد إلى مثل هذه الترجمات أيضاً.
الآتي من بدائية المكان والطقوس الوثنية
حسين نصرالله (شاعر)
من أين ندخل إلى حياة بسام حجار الشعرية والإنسانية؟
مع هذا الشاعر يخرج النص الشعري عن المألوف من العناصر التي اعتدنا عليها في صياغة التجربة الشعرية، ليذهب إلى المناطق الحميمية والبعيدة والأليفة والغريبة في حدود اشتغاله الإبداعي.
شجر السرو وما يتصل به. الصخر ومشتقاته من حجر وحصى. الليل والريح والهواء. الغيم والغياب. السراب والحياة العدمية للكائن الوحيد، جميعها مفردات احتوتها قصائده، وأظنها جميعها تدفعنا إلى صياغة أو رسم لوحة عن الفقد والعزلة والمصير المعتم للكائن البشري.
مع قصيدته تتملكنا الرغبة في الاستسلام للنهايات، للقدر المأساوي الذي يجعل أخطبوط الموت يلف حباله على أعناقنا. قصيدته عين الذات التي أعطت أو فتنت حاستها البصرية، بتنقيتها لعناصر الاشتغال البصري، حيث ان التشكيل المعتنى به، والمباغت أحياناً كثيرة، التشكيل الذي قد يخلو من أي نص، اقتصر في قيامه على عناصر بعينها من دون إسراف أو بهرجة. وفي المساحة المستنزفة والمدمرة، بين الإرادة والرغبة، يتنامى الشعر ويتمايز كإرادة ملتبسة. كنافذة تطل على صحراء، تصل وتفصل بين خارج قدري ميت ومشلول، وداخل يتمرأى به، ويتشكل على صورته.
“لا أبالي بي/ إذا مت أمس/ أو اليوم/ أو اليوم الذي يلي/ ولا أبالي بي/ أم بقيت حياً،/ لأيام / لأعوام أخرى/ فلم يبق لي ما أصنعه برجائي/ بالشهوات التي تبقت/ لم يبق ما أصنعه بمتسع اليوم/ كل يوم”.
إنها صحراء أخرى، سديم يرافق الانتظار! غياب في الغياب. بينما منصة الموت المعدة لارتجال النهايات الخفيفة، تشرف على نهاراتنا كلها. بل نحن خدمها المخلصون إلى أن يكتمل العرض ونلتقي في جوقة النسيان.
بسام حجار لم يكن معانداً أو شرياً في مقاربته للحياة. عاش خجولاً من حركة الشهيق والزفير وكان يخاف على النسيم من الهواء، لكن رغم ذلك كان يدرك أن كائنات الطاعة لا نصيب لها في الاختلاف، وهذا التيه الذي رصده في شعره، هذا الموت المنتصب في كلماته والمغرق في قسوته، والبارع في جحيميته نجح في دفعنا فوق حافة الريح التي انكسرت إلى هاوية جعلتنا نتلمس أحزاننا بالمشارط والإبر.
بسام حجار أتى إلينا من بدائية المكان ووحشيته، ومن الطقوس الوثنية للإبداع المعمدة بالصمت فوق أكوام الأمكنة المنسية وجوار النبيذ المسفوح. وحين نقرأ له ينهض الشعر ممتحناً قدرتنا على احتمال كل هذا الفقد.
بسام حجار لقد كنا صديقين في شبابنا الشعري الأول واليوم يغادر القلب نبضه.
غائب في حضوره،
حاضر في غيابه
حسان الزين (شاعر)
مع الحزن، وعلى الرغم من شدته، لم يفاجئني موت بسام. لا لكونه يعاني منذ مدة مرضاً خطيراً ولا لأن الموت، حتى موت الأحباء، بات لا يفاجئنا، لتكراره ولكثرته ومجانيتنا إزاءه وتحت قبضة آلته. لم يفاجئني غيابه لأنه بسام. هو كذلك. هذا بسام، هو، شخصاً وشاعراً، غائب حاضر. قوته، أو قوة حضوره، في غيابه. لقد صادق الموت وسقاه كشتلة، ودخنه كسيجارة، منذ بدأ الأحباء يغيبون، بل يحضرون.
حاضر لا في قصائده وكتبه وحسب، وإنما في الشعر والكتابة، لا في قصائد الآخرين بل في شعرهم، لا في علاقات يومية متواصلة مع الآخرين وإنما في الصداقة. هذا بسام، حاضر في غيابه. كحضوره في صديقه عباس بيضون. لننتبه إلى اسميهما: بسام وعباس. ها هو، إذاً يحضر في عباس بيضون، وحتى عباس لا ينسى ذلك. بينما هو يتألم لحضوره وفي غيابه.
فبسام حاضر حاضر في غيابه. أينما غاب هو حاضر. هو غائب غائب حتى الحضور، ومن دون أن يفتعل ذلك. هو غائب لأنه يريد أن يرتاح من تعبه المزمن الذي لا مفر منه، ولأنه لا يرى نفسه في الحضور، ولا في أي حضور. يتعبه الحضور المحض، ويتعبه حتى الشعور بأنه حاضر غائب. وعلى الرغم من ذلك حضوره قوي، ولم يسعَ لذلك ولم يغره. أراد التخفف أكثر. كأن وجوده، بين جدران بيته والستائر، يقلقه. يقلقه أن يفكر فيه الآخر من دون حب. يرهقه ذلك، يرهقه حتى الموت. يرهقه أن يكون أثراً في قصيدة غيره. وهذا كثير.
لا أعرف أكثر من هذا
حسن ياغي (ناشر)
شهادة، ما هي الشهادة، هل هي مديح أعرف أنك ستضحك منه مدارياً خجلك؟ هل هي حكاية حصلت لي معك وفيها ما يعبّر عن قيمتك الكبيرة كشاعر وكاتب ومترجم وإنسان وصديق؟
لا أعرف أشياء كثيرة عنك، ولم أعرف سوى متعة اكتشاف المعاني الجميلة التي تحملها الكلمات. كلماتك القليلة، مفرداتك القليلة. مطالبك القليلة.
لا أعرف عنك أكثر مما عرفته، وأنا أقرأ أكثر من مرّة “سوف تحيا من بعدي” وقد يعرفه الذين سوف يحيون من بعدك ويقرأون “ما يشبه الشعر” الذي كُتب “بمفردات قليلة”.
لم يكن في لقاءاتنا الكثيرة حكايات عن الطفولة، ولا عن المشاريع، ولا عن السيارات، ولاحتى عن 8 و14 آذار والتيارات الأصولية والخوف من المستقبل. مرات قليلة تحدثنا عن مروى ونديم ومدارس الأولاد وأعباء الحياة التي تستنزفنا.
كان حديثنا عن الكتب الجميلة واكتشاف روعة المعنى والكلمات. هل كانت حياتك قليلة هكذا؟ اليوم عرفت أن حياتك كانت قليلة.
عدا القسوة والنزق والرقّة والضحكات المجلجلة والفرح في العيون والرحابة والمحبة والضيق والغضب... مصبوبة في مفردات قليلة... لم أعرف عنك شيئاً.
الساكن إلى جوار الموت
جهاد الترك (ناقد أدبي)
كم تبدو الواقعة غريبة، مستهجنة، كاذبة، وكأنها وهم الأوهام. ولأنها كذلك فهي حقيقية تصدم الحواس، قبل أن تتملك الذهن والذاكرة. من كان يصدّق أن ذلك الكاتب الودود، هادئ الطباع، المعتكف على ذاته بصمت شفاف، يغادر على جناح السرعة من دون إنذار مسبق؟ ولو سئل بسام حجار رحمه الله، عن ذلك، لأجاب على الأرجح بالإيجاب. ثمة في ملامحه ما كان يوحي، على الدوام، بأنه يسكن إلى جوار الموت أو عتباته القريبة أو البعيدة. والأصح، وفقاً لشخصية بسام الحاضرة في عزلتها، أن الموت كان يسكن فيه، يخيم عليه بظلاله الثقيلة. ومع ذلك، وفقاً لعارفيه وزملائه والمقرّبين منه، أن بسام حجار لم يكن يتذمر من تلك المساكنة مع الموت. غريب هذا الرجل الذي حوّل فكرة الموت شعراً عميقاً سرعان ما يستولي على قارئه. لم يدر بسام ظهره للموت إطلاقاً. لم يجبن أمامه حتى أثناء مرضه الخطير. وقبل ذلك في نصوصه الشعرية التي ترصّد فيها فعل الموت وظله وتداعياته. رحم الله بسام حجار، ذلك الكاتب المرهف الذي لا يشبه أحداً في اللغة والتعبير.
شموس من قبو وحدته
مازن معروف (شاعر)
بسام حجار واحد من شعراء لم تأخذهم متعة الحياة يوماً أبعد من متعة الشعر والاستسلام لقصيدة ذات شكل كتابي واحد. ونكون منصفين جداً إذ نقول بأن هذا الشاعر والمترجم والأديب، اختار لحياته بريقاً شبه سري، رفعه دوماً إلى درجات من التركيز التام نحو استنباط أشكال كتابية جديدة في قصيدة النثر، فكان في كل مرة من مرّاته القليلة، يخرج إلينا مما يشبه السبات، رافعاً في وجوهنا ضوءه، أو شمسه التي صنعها في قبو وحدته. كل عمل من أعماله، نسميه شمساً صغيرة غير أنها كانت دائماً شموساً كبيرة الحجم على أكواننا الذاتية. كان ينسج علاقاته ذات المصلحة الأدبية ولغرض أدبي بحت، أي انه كان يشعر بأن عليه التزاماً تجاه الفرد العربي، التزاماً بنشل هذا الفرد من كسله ووضعه أمام بعض أكثر الأعمال الروائية والفكرية جمالية. تشكل جماليات أسلوبه المنتهج في الترجمة إحدى المفارقات والتي قلما وجدنا ما ينافسها عند المترجمين العرب عموماً. فاللغة العربية الممسوكة بقبضة بسام لا تتشتت أمام لغة العمل الأصلي والصور والمعالجات الدرامية أو الأدبية، وبذلك فإن لبسام أكثر من دماغ واحد، لأنه يقرأ، ويحب ويُجذب، يخزن ويحفظ، يتماسك، ويمسك بلغتين: اللغة الأصلية-اللغة الأم للعمل الأدبي، واللغة العربية كإحدى نتاجات العمل ذلك، وهو بذلك كمن يحمل في كلتا يديه معجونة أطفال، ثم يساوي بينهما في الشكل واللون والرائحة، وإذ يحفر الأسماء الأولى لصاحب العمل الأصلي، على إحدى المعجونتين، فإنه يحفر اسمه على الأخرى. هو واحد من أولئك الشعراء، الذين خرجوا في الظل، وكتبوا في الظل ليخرجوا علناً بمجموعات مثلت منهجاً جديداً ومربكاً للنقاد فيما يختص بقصيدة النثر. أراد أن يضيء وحشته، ألمه، حزنه ووحدته بتقاسيم دلالية لم تكن أبداً متوارثة أو مكتسبة بتأثير ما، لذلك كانت تجيء قصيدة بسام إلينا كعروس بيضاء كبياض فستانها، فنمد أصابعنا لننزع عنها الثوب ونلمس جلدها الطري، والذي كان طرياً لأنه جِلد القصيدة التي كتبها بسام بأصابع قاسية وبأنفاس مرهفة تتلاطم مع الكلمات على الورقة. وعلى الرغم من التوجه العام لبعض الشعراء في فرض شكل كتابي جديد، إلا أنه بقي عازفاً منفرداً، لم يقلده أحد ولم يجرؤ شاعر على الاقتراب من الغابة التي اتخذها سكنى له. وهي غابة وجدانية، إلا أنه عرف تفاصيلها، لأنه واضع خريطتها من الأساس. ولأنها الغابة التي تختزل كل قلقه، وانغلاقه على الذات لتقطيع أسئلتها وإخراجها في تلك القصائد القاسية. عبارة بسام حجار الشعرية، تشبه ولداً عنيداً لا يريد الإفصاح عما يعتريه من شكوك وتجارب ذاتية وفنية، ولداً يخيل لك بأن عمره مئات السنين، ولداً لا يثق بالشعر المفتوح كذراعين يقدمان كل ما لديهما من حب ومن ثم ينخفسان بعد ذلك، ويخفتان ويموتان، بل يدعوك كل مرة إلى تقاسمه نبش المعنى والتوغل في غابة استدراكه وأنت عارف مسبقاً بأن عليك الخروج من تلك الغابة لتدخلها من جديد لآلاف المرات. تطعنك عباراته، وتفج صوره في وجهك بالحزن والوحدة والعمق الذي لطالما حمله كقاسم مشترك في جميع كتاباته. كلما مات شاعر، ذهلت. أو كلما جاءتني مكالمة عن موت شاعر، أصبت بالأسى، وتوقف لساني عن العمل، مع أني لا أعرف أولئك الشعراء. هل يصبح الفقد أشد وطأة حين يكون فقداً لأحد أولئك الذين لطالما تلاعبوا بالعبارة من أجل تفكيك مفردات الوحدة، الفقدان، الأمل، الوحشة، الحب، الصمت، والموت؟ ألأن تلك المفردات تنجح عند موت كل شاعر، في الانفلات مرة أخرى والتعري أمامنا ببهاء قد لا ننجذب إليه؟ ألأنها تعلن لنا أن السيد، سيد الكينونات هو الموت، الموت فقط، وأن الوحدة والعزلة والمناخات المشابهة للإنسان، كلها حبوب مهدئة بانتظار الانطفاء الأخير؟ وهل كان بسام حجار متصالحاً مع فكرة الموت ولذلك ظل طوال تلك السنوات، معززاً وجوده ككائن بملامح خاصة في القصيدة، كائن معزول وغير مبال بإغراءات الحياة والمديح، طالما أنه يعرف مسبقاً ماذا يعني الاختفاء؟ سيظل الشعراء دائما مهجوسين بالموت، وبالكتابة عنه، لأن الموت رحيل بمسار واحد، والذي يرحل، يتجمد قلمه وتتوقف فكرته في مكان بانتظار أن يلتقطها شاعر آخر ويكمل المشوار الماراتوني الذي يسابق الموت الذي لا نفهمه رغم تماريننا على استقباله. عندما تخسر شاعراً كبسام حجار، فإن عليك أن تصلي كثيراً، لأن الشعراء هم دعامات الحياة التي لا يتنبه كثيرون لها. الشاعر وحده من يلتقط إشارات العالم ويفسرها في الكلام الشعري أو يسعى إلى ذلك. والشعراء الاستثنائيون كبسام حجار، يصنعون إضافة إلى كل قلقهم المفرط بشأن أمور الحياة، أماناً في الموت. لقد كنا كثيراً ما نتمنى لو أن بسام حجار كان أكثر كرماً معنا، بأن نتعرف على شخصه، ذلك لأننا طامعون، فنحن لم نكتف أيها الشاعر الراحل، بكل ما أوردت إلينا من جهود أدبية، كنا نريد فقط مصافحة منك قبل أن تموت. لكن ما الذي يجعل شاعراً يقترب من الموت في الكتابة قبل أن يقترب الموت منه في الحياة؟ أهو استباق لفعل الموت وبالتالي تصريف هذا الفعل خارج القناة التي تؤدي إلى بسام حجار؟ أم هو مباغتة الكائن للكائن ضمن لعبة الغدر وأن من يباغت أولاً يفوز؟ بل هل هو انتصار الشعر في الجولة الأولى على الموت، ما يضمن للشاعر على الأقل تعادلاً إذا لم يكن ربحاً أو هزيمة؟ نحن نُودِّع ذلك الشاعر، رافعين أكفنا السائلة في الهواء، السائلة كقطعة هلام غير ناضجة كفاية، نلوّح لبسام حجار في مساره الأخير، في دبدبته الأخيرة على الإسفلت أو على أذرع الأصدقاء، ونلوّح أيضاً للموت الذي نعرف أنه سيجيئنا ذات يوم، نحييه منذ الآن فلربما لم نستطع مقارعته على الورقة كما فعل بسام، ولذا ربما نسجل بذلك انتصارنا الطفولي عليه بشهادة شاعر تفرد منذ لحظاته الشعرية الأولى. نحن نؤمن بالموت، لكننا نؤمن بالشعر كقشة نُدخِلُ العالم فيها، وننفخه ليتطاير بعيداً كسرب من الفراشات، والتي بعض منها تقف على نافذة بسام حجار وتنتظر أن يصل، ويكتب ويشرب الماء ويغادر كما غادر الآن وبقيت أوراقه على الطاولة، وفيها شعر سنقرأه بعد قليل.
***
عاش شحيحاً وكتب بخفوت لكن ما تركه كان كثيفا في الرأس والمكتبة
بسام حجار منح قصيدة النثر مشروعية جديدة ورحل
بيروت ـ 'القدس العربي' 
توفي أمس الشاعر اللبناني بسام حجار عن عمر 54 سنة أمضاها في الشعر والترجمة والصحافة، وذلك بعد إصابته قبل أشهر بمرض السرطان. وكان أجرى عملية جراحية لاستئصال الورم، لكن المرض امتد إلى الكبد، مما تسبب في وفاته. وقد دفن الشاعر في مقبرة صيدا حيث عاش معظم حياته.
نشر بسام حجار منذ 1979 عدداً من الكتب الشعرية التي شكلت محطات أساسية في قصيدة النثر اللبنانية، ولا سيما بين الجيل الثاني من شعراء هذه القصيدة. من 'مشاغل رجل هادئ جداً' (1979) إلى 'تفسير الرخام' (2006)، كان بسام حجار يعطي قصيدة النثر العربية مشروعية قلما أعطاها شاعر أسوة بشعراء راحلين أمثال محمد الماغوط وسركون بولص. بلغة أصيلة، خافتة، بسيطة، عميقة، حميمة، غنائية، كتب بسام حجار نصاً شعرياً ذا بنية واضحة. صنع من أشياء بسيطة وقليلة عالماً واسعاً. من الحب والعائلة والموت، من حب الزوجة وموت الأب والأخت، كان بسام يؤلف كوكبه الشعري. كتب بمفردات قليلة، بقاموس لم يتخط هذا المحيط الضيق، قصائد فتحت آفاقاً في التعبير والجمالية. لم يعنَ كثيراً بالتأويلات، لم يهتم للإنشاءات اللغوية، لم يعقلن نصه، لم يسع إلى بهرجة زائفة وألاعيب حداثوية، بل انصب اهتمامه على كتابة نص بسيط وشفيف، ذي بنية نفسية وجمالية سردية، متأثراً بما ترجمه من عشرات الروايات إلى العربية.
نشر حجار في الشعر كتباً لم تلبث أن غدت محل إجماع الشعراء والقرّاء من بينها: 'لأروي كمن يخاف أن يرى'، 'مهن القسوة'، 'فقط لو يدك'، 'مجرد تعب'، 'بضعة أشياء'، 'معجم الأشواق'، 'ألبوم العائلة' وغيرها. كما نشر كتاباً عن تجربته في الترجمة بعنوان 'مديح الخيانة'. ترجمة طاولت عشرات الكتب والأسماء، أبرزها: ياسوناري كواباتا، بورخيس، سالنجر، بيتر هاندكه، الطاهر بن جلون، بوهوميل هرابال، يوكو أوغاوا، جان أشينوز، كارلوس ليسكانو، أمبرتو أيكو، آغوتا كريستوف، إميلي نوثومب، إيتالو كالفينو، جيزوالدو بوفالينو، كريستا وولف، جان بودريار، مارتن هايدغر وأسماء أخرى كثيرة.
عمل بسام حجار في عدد من الصحف، فكتب في 'النداء' و'الحياة' و'السفير' و'ملحق النهار الأدبي'. وظلَّ يكتب في ملحق 'نوافذ' الذي تصدره صحيفة 'المستقبل' حتى وفاته.
شعرياً، منح بسام حجار عبر جملته الغنائية البسيطة، وبنية قصيدته الواضحة، ولغته غير المتحذلقة، المباشرة لكن بعمق، منح مشروعية أخرى لقصيدة النثر. على يديه غدت هذه القصيدة أكثر أصالة وجدة معاً. من جهة هي قصيدة متأصلة بلغتها العربية، ومن جهة أخرى هي قصيدة مفتوحة على النثر والسرد، على احتمالات أخرى للشعر. لكن بساطة هذا الشاعر كانت مخادعة، هي بساطة تخفي تراكماً من الثقافة حيناً ونكراناً للثقافة حيناً آخر. من جهة نستطيع أن نلمح هذا التراكم الثقافي كما في قصيدته المطولة 'العابر في منظر ليلي لإدوارد هوبر'، ومن جهة أخرى نحن أمام قصيدة لا تقول شيئاً سوى رهافتها ورقتها وجماليتها التي تتأتى من ليونة اللغة وعلو الإحساس كما في قصيدة 'لا تذهبي إلى الجوار' التي كتبها إلى شقيقته التي فقدها في حادث سير. على أن بسام حجار شاعر الإحساس المرهف في المقام الأول. هو شاعر الحب الذي يؤلمه أنه عاشق وأنه معشوق، وهو شاعر الموت الذي عاش قريباً من النهاية طوال حياته، وهو شاعر الخسارات: خسارة الاب والأخت والزوجة.
كتب بسام حجار الموت منذ أول مجموعة إلى آخر مجموعة صدرت له. لم يبتعد عن الموت في كل ما كتبه، موته الشخصي الجواني، وموت بعض أفراد أسرته، وموت الأمكنة في عينه. كان الموت رفيقاً ملازماً للشاعر. ليس هناك كتاب شعري لبسام لا يكون الموت بطله الأول. حياة الشاعر نفسه بدت نوعاً من الإخلاص لشعره. لا نعرف من كان يفي للآخر: شعره لحياته أم حياته لشعره. لكن في الحالين كان الرجل يطابق قوله عمله، وكلامه سعيه، وإحساسه واقعه. عاش بسام في عزلة شبيهة بعزلة نصه ليس من حيث الاهتمام بهذا النص وإنما من حيث معنى هذا النص. لقد كتب حجار العزلة والموت والفقدان والخسارة وعاش هذه المشاعر والحالات في حياته. لم يكن بسام يأتي إلى مقهى ليشرب قهوة مع الأصدقاء أو يقيم نميمة أو نقاشاً. كان يأتي إلى بيروت ليجلس بضع ساعات في مكتبه ثم يغادر بسرعة إلى صيدا حيث يقيم. هو ابن المدن الثانية كما صديقه حمزة عبود الذي نال إهداء مبكراً من الراحل في كتاب 'مشاغل رجل هادئ جداً'.
المرة الوحيدة التي التقيت فيها بسام حجار، أنا الذي لم أخف إعجابي بشعره في كل تصريح لي، كانت في مقهى 'جدل بيزنطي'. جاء بسام خجولاً، هادئاً، غير مرئي لفرط علاقته الواهية بالحياة، وجلس على كرسي منزوٍ. قلت له: أحب شعرك يا بسام. رفع بثقل ابتسامته وقال: وأنا أحب ما تكتب. لم يدر بيننا أكثر من هاتين الجملتين.
لقد أحسست أنني أمام شخص أشبهه. لهذا لم أستطع أن أتواصل أكثر معه. يكفيني أن أحمل نفسي فكيف باثنين مني؟ لكني كتابة، كنت أكثر تصريحاً. مراراً ذكرت أنني أحب هذا الرجل. حتى إن الصديقة عناية جابر سألتني ذات مرة في حوار معها في 'السفير': لماذا تذكر دائماً أنك تحب بسام حجار؟ وقتها قلت إنني أحب شعره. الآن أضيف: لأنني أرى نفسي فيه.
أيضاً يمكن القول إن المكتبة العربية افتقدت ليس شاعراً توفي في عز عطائه كبسام حجار فحسب، وإنما مترجم على قدرة عالية في الترجمة. نقل حجار إلى العربية عشرات الكتب لكتّاب عالميين كما سبق. وكانت ترجماته في هذه الكتب من أجمل الترجمات لغة وبنية وأناقة ودقة. من يذكر الكتب الأولى التي نقلها هذا الشاعر؟ من يذكر 'الشقاء العادي'، الرواية الأولى لبيتر هاندكه، والتي نقلها حجار إلى العربية؟ من يذكر شقاء الأم في هذه الرواية والشبيه بشقاء الشاعر نفسه؟ من يذكر 'بلد الثلوج' لكواباتا؟ من يذكر 'قطارات تحت حراسة مشددة' لبوهوميل هرابال؟ من يذكر 'غرفة مثالية لرجل مريض' ليوكو أوغاوا؟ هذه الغرفة التي بدت أنها غرفة الشاعر نفسه حيث كان ينتظر شقيق الروائية الموت. الموت الذي رافق الشاعر في حياته وشعره. الشاعر الذي عاش ظلاً مربوطاً إلى الحياة بخيط رفيع بالكاد كنا نراه أو نحس به.
مديح (هذه) الخيانة
مديح (هذه) الخيانة
ما هذا إلاّ عبور آخر. كانت الرّحلة هائلة أمّا الموتُ فهو تفصيل صغير.لا ندري حقاً كيفَ فَعَلْتَ، لكنّك صنَعتَ لكَ بلاداً من مفردات. كلّما كتبتَ سطراً كنتَ تستردّ منها شيئاً، حتّى اجتمَعَت كلّها بين يديك، وأقامَت في قلبك المنهوك.لا ندري حقاً كيفَ فعل؟أنتَ المُطمَئِنُّ إلى ما يسرّ به قلبُكَ إلى أصابِعِكَ فتكتبُ الأصابعُ، في كلّ مرّة، نشيداً لأملٍ لم يبرح صدرك.نُفِيْتَ وبَقيت في قلب فلسطين.نُفيَتْ فلسطين وبَقيتْ في قلبك.لا ندري حقاً كيف فَعَلتَ؟ ما العبارة التي تستخدمها لكي تأتيكَ طائعةً وتجلس بين يديكَ وتتسمّى بالأسماء والصفات التي تطلقها عليها.لستَ ساحراً ولا هي حمامة بيضاء، ومع ذلك تُصغي إلى صمتِك العميق، وصوتك الأعمق.الترابُ، حتّى التراب الذي سوف يهمي على جسدِكَ تسمّيه بَرداً لأنّه ترابها.والسروات حول الحفرة أشجاناً.
والضريح ليس الضريح.
رَجُلٌ وأرض يتبادلان اسميهما بيُسرٍ كأنّما حبّ الرجل للأرض لعبة طفل.حبّ غير مشروط.
رجلٌ وأرض،
رفيقان. غريبان على الدوام.
معاً، على الدوام.
لا ندري حقّاً كيف فَعَلْتَ غير أن تردادك اسمها أقامها مِن القَبْر.
لم تكفّ عن المناداة حتّى سمعت.
لم تكفّ عن توبيخ الموت حتّى زال عنها.
وعندما تضرّعتَ أن تصمتَ الأسلحة لأجلها، استجابت الأسلحةُ الصُمّ.
كأنّك لشدّة ما أردتَ أن تكون لكَ وحدكَ، أخفيتها كلّها، أعواماً، في أوراقك. كلّها. بلى. لا ما تشتهيه منها فحسب. ولا ما تمقت فحسب.هي كلّها. أرضٌ وسماء. جبلٌ وهاوية.
هل كنتَ تنادي كلّما شئتَ: يا لِعازر، قُم!
ولِعازَر في لغتك قد يكون بيتاً أو شجرة؛ امرأةً أو رجلاً؛ شيخاً أو طفلاً؛ولِعازَر قد يكون أرضاً. قد يكون أنتَ. وقد يكونُ أملاً مُلَفّقاً. لكنّك آمنتَ ولمّا دحرج الملاكُ الحجَرَ عن باب القبرِ سطعَ نورٌ.لا ندري حقاً كيف فَعَلْتَ؟
آمنّا طويلاً بِعَتمٍ مُقيم، فلفّقتَ، بالمفردات، نوراً. وقلتَ قبلنا جميعاً: أنا أصدّق هذا النور. أنا أكذّب العَتْمَ. فصدّقنا.فلِمَ تغادر الآن؟
قامَ لِعازَر ثمّ اختار أن يقيم في القبر.
وحدّثتنا الأسلحة مجدّداً حديثها الطويل: وكلّ صوت غير صوت الأسلحة خيانة.وانكمشت الأرض ولم يبق منها إلاّ اتساع جلد حيّة.
وحُفِرَ قبرٌ عميق.تحته قبرٌ عميق.
تحته قبرٌ ...
18/02/2009