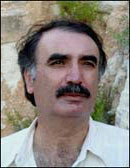 كل حكاية في الدنيا لها بداية ونهاية، إلا حكايتي، فليس لها بداية ولا نهاية، وقد عودتنا جداتنا وأمهاتنا أن للحكاية بدايةً وحبكة ونهاية، فكن يروين لنا القصص الخرافية وهنَّ يهدهدننا قبل أن ننام؛ يا الله ما أجمل النوم بعد سماع تلك الحكايا، يُحَلِق خيالك في البعيد، تتخيل نفسك فارسا أو بطلا، ترفع الظلم عن طفل ضعيف أو صبية صغيرة أو امرأة مظلومة، تسبح في أحلامك وبطولاتك، تهزم الجيوش تقتحم الكهوف والعتمة، وتطير فوق القلاع والحصون، وقد تواصل الطيران حتى بعد أن يلاعبك سلطان النعاس، وتغط في نوم لذيذ!
كل حكاية في الدنيا لها بداية ونهاية، إلا حكايتي، فليس لها بداية ولا نهاية، وقد عودتنا جداتنا وأمهاتنا أن للحكاية بدايةً وحبكة ونهاية، فكن يروين لنا القصص الخرافية وهنَّ يهدهدننا قبل أن ننام؛ يا الله ما أجمل النوم بعد سماع تلك الحكايا، يُحَلِق خيالك في البعيد، تتخيل نفسك فارسا أو بطلا، ترفع الظلم عن طفل ضعيف أو صبية صغيرة أو امرأة مظلومة، تسبح في أحلامك وبطولاتك، تهزم الجيوش تقتحم الكهوف والعتمة، وتطير فوق القلاع والحصون، وقد تواصل الطيران حتى بعد أن يلاعبك سلطان النعاس، وتغط في نوم لذيذ!
(حديدون، محمد الشاطر، الزير سالم، جسّاس، كليب، التبع حسان، زيناتي خليفة، محمد العابد والسفيرة عزيزة..) ؛ نمتُ سنوات طويلة على وقع تلك الشخصيات، وأنا أرسم صورهم وأتخيل ملامحهم، وأشاركهم المغامرات والطموحات، يسرقني النوم، وأنا أسمع خبط حوافر خيولهم، وأرى لمعان سيوفهم، وأترنم على صدى قعقعاتهم أو غنائهم وشجوهم.
والدتي كانت تسيّس الحكايات، تدس في ثناياها شارة موحية ؛ بَقْرُ بطن امرأة حامل في دير ياسين، هدم مسجد في بئر السبع، أو صفد، خطف ولد تائه في الرملة، حرق بيارة برتقال في يافا، إعدام شاب خليلي في سجن عكا، حكاية من أيام الأتراك، حدوثه من سنوات الثورة، وأيام الاستعمار الانجليزي والانتداب على فلسطين.
لكنها لم تكن تتحدث عن السياسة أو الاحتلال بشكل مباشر، تؤشر على نتائجه وآثاره،هوامشه وتبعاته، تبتعد لتقترب، تروي لِتشُد، تحكي لِتُسمّي:
(... الله يرحم سيدك سلامة، ذات ليلة، جاء الثوار عندنا وجه الصبح سرا، ذبح لهم رحمة سيدك، نعجتين كبيرتين، وطبخنا لهم بسرعة،ثم أطعمناهم وطلب سيدك منا أن ندفن بقايا الذبائح في باطن الأرض،كي لا يبقى ما يدل على آثارهم، ولما جاء الانجليز،بعد يومين يبحثون عنهم، حيث وضعوا مكافأة لمن يقبض عليهم، أنكر سيدك زيارتهم، ولم يعترف أنه رآهم أو أطعمهم أو سمع شيئا عنهم، لكن خالك (علي) الله يسامحه، والذي أخفينا عنه زيارتهم بناء على طلب سيدك، أصر أن يحصل على المكافأة، فأخذ يركض وراء الثوار،ويقص على آثارهم حتى وصل الى المنطقة التي يتجمعون فيها، كان ثوبه الأبيض يرفرف بين سيقانه وهو يتوعد أن يمسك بساكت العبد وعيسى البطاط، (وهما من رجالات الثورة في الأربعينات الأول من بلدتنا والثاني من قرية الظاهرية المجاورة للسموع)، ولما لحق بهم، قال له البطاط: ارجع يا زلمة لاقتلك، والله لولا أبوك عزيز علي لأطخك بالطبنجة.)
سألتها حانقا على خالي : وهل أمسكهم يا أمي ؟ فضحكت: إذا كل جيش الانجليز يمه ما قدروا عليهم، بدك خالك (علي) الله يسامحه ويرحمه يمسكهم، كانوا مسلحين وهو لم يكن يحمل غير دشداشته بيديه، وقال له ساكت العبد: إرجع يا علي إرجع، والله لولا لحم أبوك في بطني لأقتلك، وعرف خالك أننا ذبحنا لهم وأطعمناهم، فعاد يهدد ويتوعد، فقال له رحمة سيدك: اسكت، يا مهبول،هل تريد أن تبلينا وتخرب بيتنا، استح على دمك، أكيد أن ساكت العبد كان يحكي لك عن أيام زمان، قبل أن يلتحق بالثورة.
كان مسؤول المنطقة الانجليزي، ضابط اسمه مهن. كان ظالما وجبارا، حتى أنه دفع بأحد رجال الثورة من على سطح علية العنيد الشاهقة العلو، يا إلهي، وجروا سيدك سلامة إلى العلية ليعترف، وأوقفه مهن عاريا ليلة كاملة في عز البرد،
وهل اعترف سيدي سلامة يا أمي ؟ سيدك يعترف ! أعوذ بالله، كان الموت عليه أسهل...)
احكي لي يا أمي احكي، احكي لي عن الانجليز والثورة والثوار، أحب حكاياتهم، أحب حكاياتِك ؛ زهقت حديدون، ودلى (......) في الطابون، كرهت قصص الشاطر محمد والتبع حسان، لم تعد تعجبني خراريف الكلاب والجمال والذئاب والضباع.
آه، نسيت ان اقول لكم حكايتي، حدثتكم عن سيدي سلامة ولم أرو حكايتي، ألم أقل لكم أنها حكاية غريبة ليس لها بداية أو وسط أو خاصرة، كما ليست لها نهاية، إنها حكاية غريبة فعلا، تُدرك ولا تروى، تُعاش ولا تقال، ليست حكاية سيدي أو جدي ولا حكايتي،فلست بطلها ولا صاحبها، إنها حكاية أمي، نعم أمي، التي أرضعتني، لبن الحكايات وحليب القصص، وأمسكتني بيديها حرير القصائد، وسرَّبت إلى روحي، أنين المواويل وشجن الميجانا، وعلمتني كل شيء، كل شيء، وفاضت علي من طيبتها، ما يكفي لأظل استذكرها إلى آخر حرف في شفتي، وآخر نفحة أوكسجين في رئتي، أو آخر صوت في حنجرتي، أو آخر خاطر قد يلمح في دماغي، وأقر وأعترف أنني مجرد شعاع من تلك الأم الرائعة، وتلك الإنسانة العظيمة، والتي لو عرفتموها كما أعرفها، ونهلتم من طيبتها، كما نهلت، لبكيتم فراقها مثلي أو أكثر مني، ولسامحتموني إن قلت لكم إن حكايتها،هذه ليست كاملة أو وافية، بل جزء يسير مما عرفته عنها ومنها. وما قد أنسى تذكره أو حضوره أهم مما سيرد وأكثر، ولكن لم يسعفني الوقت بعد، لأرطب الذاكرة، وأبلل الحنين، وأكون قادرا على رسم الصورة كاملة.
مات أبي في الاول من ايار عام 2003، وماتت أمي بعده بسبعة عشر يوما فقط، مات الاثنان في أقل من شهر واحد، دفعة واحدة، أو مرة واحدة، فتكسرت داخلي جبال عالية، وانهدت هضاب راسخة، وانخلع عنفوان كبير، وطمأنينة تتخطى طمأنينة الانبياء والاولياء، وشعرت للمرة الاولى في حياتي وبعد أربع وأربعين سنة شمسية أن جذوري انبتت، وحياتي انشرخت، وسعادتي ولّت. لقد آلمني اشد الألم ان يموتا وأنا بعيد عنهما فلم اظفر حتى بوداعهما الوداع الاخير، حيث ظلا في السموع جنوب مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة، بينما أقعدتني ظروف الدراسة والاعتقال، ثم مشاغل الحياة في المنفى عن العودة الى هناك فصرت مواطنا أردنيا وظلا فلسطينيين، وكأننا بتنا من دولتين مختلفتين وعالمين متغايرين،تفصل بيننا مسافة جغرافية قصيرة، ولكن دونها اهوال وإجراءات وتعقيدات واغلاقات وجسور وجيوش وشرطة وما لا يمكن اجتيازه بسهولة ويسر، دون تصاريح او موافقات وكفالات ورفض من هنا وعدم ممانعة من هناك.
مات أبو حسين، أو الحاج محمد حسين بن حسين جابر، بعد مرض ونزع ومستشفيات واطباء، وماتت أم حسين او الحاجة مليحة سلامة ابو عقيل، فجأة وبلا مقدمات او اشارات، ماتا واختفى عني صوتهما وظلهما للابد، رحلا دون ان أكحل عيني برؤيتهما،ودون ان أبلل وجهيهما بالدموع، ودون أن أقبل أرجلهما قبل أيديهما، وأعبّ من رائحتهما ما ينعش صدري للابد.
لا اقول ذلك، لأقيم مناحة لطم شخصية،تستدر الشفقة، ولا لأكسب تعاطف احد، فهذه ليست وظيفتي، ولا هواية تستهويني، بعد ان كرهت الشفقة مذ كنت صغيرا، حينما مات اخي اسماعيل الاول، الذي كان يصغرني بعامين، وانا في الصف الرابع الابتدائي، وكانت آخر وفاة تصيب عائلتي الصغيرة، ولكن ما زعزع ايماني، واعظم مصيبتي، أن غيابهما في مكيدة واحدة، جرحني جرحا بليغا لن يندمل، وحطم زهوا وخيلاء وعنفوانا كان يسكنني بفضل وجودهما دون أن أعرف، وكسر أغصان شجرة ظلت عصية على الريح والانحناء والارتخاء. وبدأت أدرك الان، أن تلك الارادة التي كانت تشد خيط حياتي، قد تقوست، وصارت واهية لا تساعدني على رد صفعة او طعنة او حفز عزيمة وهمة.
خسرت، وللابد، أمي وأبي اللذين تعودت على وجودهما، كأنهما جبلان، من جبال قريتنا الرابضة على كتف النقب، والمطلة على البحر الميت بلا اكتراث، او كأنهما شجرتا زيتون رومانيتان قرب مدرسة السموع القريبة من بلدة يطا المجاورة، والمحاطة بغابة كثيفة من الزيتون الروماني المزروع منذ الاف السنين، ولذا كنت دائما مطمئنا،الى جدار صلب وارض قوية، رغم نأي المسافة بيني وبينهما منذ جئت للدراسة في الجامعة الاردنية عام 1977، ورغم كل ما تعرضت له في الحياة، ظل بقاؤهما رافعتي الداخلية وعزتي غير القابلة للتراجع، ولكنهما رحلا الى غير رجعة.
واذا كان الموت حقا، كما تقول الشرائع والاديان والطبيعة، فلمْ يكنْ حقا ألا احفر قبريهما بساعديّ هذين، وألا اكفنهما بيديّ هاتين، وألا أهبط معهما الى القبر، وألا أرتل على روحيهما صلاتي الخاصة، والا أختلس فترة انصراف المعزين والمشيعين لأعود خفية، أناجيهما وأهمس لهما وأسمع هسهساتهما ورجع صوتهما، وآخذ الحكمة منهما في نهاية تلك الحياة العسيرة، وأتجرع كأس الصبر والاقرار بالهزيمة دون حضور شهودها، وتحت ستار العتمة التي تلف تلك المقبرة البعيدة، في تلك القرية النائية.
ماتا اذن، دون ان يتسنى لي ان اذرف جدول عيوني، ونهر جسدي، و ماء روحي فوق تراب اغلى واجمل جسدين وأزكى رائحتين عبّ منهما قلبي وصدري وذاكرتي مذ هبطت الى هذه الدنيا. ولولا هذا الذي يسمونه وهم البقاء، ورعاية كائنات الخرافة، ولولا هذا الذي يزيح خيالك عن حتفك، ولولا بعض عزاء ورضا حزته وافيا كاملا منهما، لما تمكنت من النهوض من وهدة الفجيعة، ولا تحركت بتلات الأمل في صدري، ولا أعدت تماسك حقيقتي المتلاشية، خلف رحيلهما الذي لا رجعة منه !
وأقر لنفسي اولا، ولمن يأبه للأمر تاليا، أنني بت يتيما في الاربعين، اكتشف للتو أن حليب الام ما زال على شفتيه، وأنه لم يتجاوز الرابعة من عمره بعد، وأن تلك الشامة التي على يد أمه اليمنى، وتلك العروق التي في يديها، وذلك الخاتم المصفر حتى العظم، أبهى من كل تضاريس الكون وجغرافيا الوطن، وان ذلك الحزام الازرق (الكشمير) الذي ظل يلف خصرها، وتلك »العراقية« التي لم تفارق رأسها ابدا، وتحمل فوقها بعض القطع الذهبية المعدودة، (الدوبليات)، والتي تتدلى منها المحنكة الذهبية التي تطوق رقبتها، وهي كل ثروتها التي ظلت تتناقص باستمرار، تحت تلك »الغدفة« البيضاء المطرزة، وتلك القَبة والعروق المزركشة بخيوط طبب المونس الملونة، فوق صدر ذلك الثوب الفلسطيني الأسود المطرز، والذي ظل يلف جسدها حتى آخر أيام حياتها،أجمل عندي من أرقى أزياء المصممين العالميين، وأحدث الموضات العصرية الجميلة !!
ولا أستطيع الحديث عنها، دون ان أقر أن خسارتي بوالدي لا تعدلها خسارة، وغيابه عني كسر عمري كسرا، وجعلني مستسلما تائها مشردا، لا يربطني بالأرض ولد أو مكسب، ولا يشدني للغد كتاب أو نشيد أو جلجلة، فقد انهدم داخلي، مرتقى عال، وتناثر مني وطن كامل، لم أشعر باحتلاله وفجيعته وضياعه، الا بوفاته ثم وفاتها، كأنهما نجمان تتابعا وهويا من قبة السماء، وسقطا نثرا متكسرة في حجري، ولعمري أنني لم أعد ذلك الفتى المشاكس ولا ذاك الولد الجريء، وأن تمسكي بالطموحات والاحلام، لم يعد كما كان، حيث ما زلت أشعر أن رجلي اللتين أمشي عليهما شلّتا مرة واحدة، وأن مشوار المليون خطوة، الذي كنت اؤمن بحكمته الصينية القديمة، لم يعد يستحق القطع او السير او حتى المحاولة.
وبعد، فإنني لا أتلذذ بعقدة قتل الأب علي طريقة بعض الأدباء الأوديبيين من العرب ومن غيرهم، بل أنا مريض بفقده وخسارته ويداهمني شعور بضرورة إنشاء مدرسة في التحليل النفسي تسمى عقدة إحياء الأب، وليس قتله.
أما والدتي فلم اكن متعلقا بها تعلقا مرضيا لكنها كانت عالما مختلفا ومغايرا، عالما مليئا بالحنان والطيبة لكل الناس وليس لأبنائها فقط، كانت تفيض سخاء وبشاشة بغير تكلف وتصنع،كيف يمكن لي ان أكتب عنها؟ بعد خسارتها هذه الخسارة المفاجئة والصادمة؟؟ كيف أعيد ترتيب كلماتي وذاكرتي وإقبالي ومنطلقي لأكتب عنه وعنها ؟ أجد الكتابة اليوم ضرورة نفسية بالنسبة لي، كما انها وفاء لذكرى عزيزين، لم يمنعهما الفقر والاحتلال والقهر والمرض والبعد من مواصلة الدعاء واستمرار تدفق العسل والرعاية والحنو، مع التشديد الذي كان يبديه الأب الراحل،ولكن عمن وبمن أبدأ منهما ؟
لقد اختلط الامر علي، فهل أقيم مبكاة لوالدي الذي ظل متعلقا بي الى آخر نفس؟ أم أستعيد صورة أمي التي ظلت تحثني على الصبر والصمود وهي تتعجب من كوني بحاجة الى أب، وأنني لست صغيرا لمثل هذه الامور؟
»انتبه لاولادك، ابوك شبع من عمره، ولم يقصر معه احد، ان موته افضل له، لانه مرض في الايام الاخيرة انت لم تره، كل من رآه طلب له الموت لراحته«.
قلت لها وكل ذلك على الهاتف: لقد رأيت حلما غريبا، رأيت أن طاحونتي اليمنى وكأنها بقايا طاحونة قد سقطت في يدي، ورأيت طاحونة مثلها، تقابلها في الفك الأعلى قد هوت أيضا في كفي، أعرف ان سقوط الطاحونة في الحلم موت شخص عزيز واذا كانت الأولى تعني أبي، ولكن من تكون الطاحونة الثانية؟ فردت قائلة: لا يموت المرء الا في ساعته، دعك من الاحلام، انتبه لنفسك ولأولادك، نحن كبرنا بما فيه الكفاية، كيف حال الصغيرة راما- الوحيدة التي لم ترها أمي من بين أولادي الخمسة - قبّلها عني، لقد رأيت صورتها على شريط الفيديو، انها تشبهك، نفس الشعر الناعم ونفس تدويرة الوجه، قلت لها: تعالي اذن لزيارتنا ورؤيتها: قالت لن أغادر الدار الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام قلت : وِلمَ كل هذا الوقت ؟ قالت: أيام العدة، حسب الشرع يا ابني، قلت لها الضرورات تبيح المحظورات، ما هذا الكلام هل سأزوجك هنا ؟ تعالي اريد ان أشم رائحة أبي فيك أريد ان ألثم يديك ووجهك، لقد حرمت من رؤية أبي وأريد ان أراك أنت، كما ان الاولاد بحاجة لك، قالت: تماسك وكف عن الولولة والبكاء، امام أولادك على الأقل، وسأزورك واجلس عندك سنة كاملة، اذا كان لي نصيب!
لكن النصيب كان يذهب باتجاه آخر تماما ؛ صبيحة الاحد يوم 18ايار، وبعد ان أوصلت ابنتيّ الصغيرتين الى المدرسة، أرسل لي أخي الأصغر يعقوب أو يوسف والذي يسكن في الخليل رسالة بالموبايل يقول فيها: الحاجة تعبانة ولا أدري ما هي القصة، رددت عليه : كن رجلا وقل لي الحقيقة. ردّ بعد دقيقة واحدة وعبر المسج: الحاجة بتنازع، حاولت الاتصال به، أو باهلي في البلد، كل الخطوط مشغولة،وبعد لحظة جاء صوته عبر الهاتف الارضي: موسى.. موسى.. الحاجة ما..، رحمها الله، ماتت... اغلق الهاتف وهو يبكي!
داهمني الضحك فجأة، تخيلت ان هناك مكيدة كونية تدبر ضدي، لماذا يموتان معا ؟ لماذا يتركاني غريبا بعيدا عنهما، استعدت طفولتي مرة واحدة، الصور تتزاحم تتراكض، بدأت أرطن بالعبرية وبالانجليزية، أخبرت ابن خالي عن عمته وانا أضحك وبلغة انجليزية، وكنت أتلفظ بألفاظ لا تقال، وحينما نهضت زوجتي من النوم أغمي عليها عندما قلت لها بألفاظ نابية أن أمي ماتت، لم انتبه لشيء من حولي كنت في حالة غير طبيعية، لكنني شعرت بنوع من الشماتة، لم يبكوا على أبي كما فعلت، لعلهم و ربما انزعجوا من مرضه وعصبيته وحِدة طبعه، وبعد رحيله مكروا، أقول لعلهم ولا أريد ان أظلمهم، لكنني تخيلتهم يقولون لانفسهم: »سنستأثر بأمنا وحدها الان، فهي لنا وحدنا«، ولكنه كان اذكى منكم جميعا. قلت ذلك لشقيقتي الكبرى على الهاتف وكانت مصدومة بوفاة الوالدة، فردت: الله لا يجبره أبوك حتى أمي أخذها منا، ضحكت شامتاً وقلت: يا نعمة لا تنسي أنها زوجته قبل أن تكون أمك وأمي، وأضفت: يبدو أن الختيار ذكي حيا وميتا أتوقع أنه رفض الاجابة على أسئلة منكر ونكير، واشترط ان يلبيا طلبه ويحضرا زوجته قبل أن ينبس ببنت شفة،فلم يستغن عنها لحظة طيلة عمره، ويبدو انه كان مفاوضا اكثر دهاء من أبي عمار وأبي مازن فلبى الملائكة طلبه!
لحقت الحاجة مليحة بزوجها الحاج محمد، لقد عرفت هذا الثنائي الذي يبدأ اسمه بضم الفم للنطق بحرف القبلة، ويتكئ على فضائحية الحاء وفحيحها، منذ تفتحت عيني على الدنيا، كانا على الدوام النار والماء: مسبات أبي المتلاحقة، شتائمه، وابتسامتها الصافية العذبة. اكثر من مرة اطلب منها ان تقف موقفا »رجوليا« تجاهه، فكانت تضحك وهي تقول: انتم مالكم ومالنا! ثم تشير إلى أنها لا تستطيع ان تقف ذلك الموقف لأنها ليست رجلا على الأقل، نضحك، تقول: »يمه احنا جيلنا غير جيلكم طاعة الزوج لدينا عبادة، والرسول طلب ان تطيع المراة زوجها مهما طلب«. كانت تتذمر أحيانا، لكنها مجرد فشة خلق لا يعقبها أي موقف او تصرف، وكما عاشت ظلا لأبي ماتت ايضا في اثر رحيله شبحا باهتا.
كيف ماتت؟ قيل لي فيما بعد: انها قامت بتنظيف »الصيرة« الحوش ورشها بالماء. جهزت اسماعيل اخي الاصغر وابنته لانهما كانا ذاهبين الى رام الله لاجراء الفحص الطبي لنجوى الصغيرة، لديها ثقب خَلقي في جدار القلب، وقد قام فريق طبي نيوزيلندي متطوع لمعالجة الاطفال الفلسطينيين، بإجراء عملية ناجحة لها فيما بعد.
كان الاغلاق الامني المكثف الذي تفرضه اسرائيل يشل الحركة، لكنهما سيسلكان طرقا متعرجة وصولا إلى رام الله،ولهذا نهضا مبكرا مع الأذان، هيأتْ لاسماعيل الافطار والشاي، ثم ذهبا وهي تدعو لهما بالنجاة والوصول بالسلامة. زبَّلت الطابون، نظفت ما استطاعت من البيت، لعلها استذكرت مكان أبي، فراشه، ملابسه، سريره، عكازه، صوت سعاله. ودّعت اختي حمدة المعلمة في مدرسة البلدة أيضا، عجنت العجين، ثم ذهبت الى المغسلة لكي تغسل يديها، لكنها سقطت على الارض.
ابن اختها يونس وهو معلم في مدرسة البلد الثانوية، وقبل ذهابه الى الدوام صباحا يمر ليسأل عنها. كانت في حالة جيدة الليلة الماضية، لكنه كان دائما يحذرها باستمرار: ستموتين في الطابون يا خالتي، هل تريدين ان تفضحينا، كي يقول الناس خالتك ماتت في الطابون، ولما انعطف ليسأل عنها، كانت قد سقطت على الارض، لحق بها لكنها ماتت بين يديه وقبل وصول الطبيب...
هل جاء موتها هامشياً كدورها ايضا في الحياة؟ وهل تأتي كتابتي عنها أثراً لرحيل الوالد قبلها؟ او تكون كتابة غير خالصة لها، بسبب ارهاصات الكتابة عن الراحل الاول؟ ربما، وهو ما تنبغي الاشارة للاحتراس منه.
كانت لأبي الكلمة الفصل والرأي المسموع، وكانت المسكينة ترتبك حين يتحدث ولا تقاطعه او تعارضه، وان ارادت امراً مخالفا لأمره فضلت قبول رأيه على اغضابه، ولهذا لم يكن لها ذلك الدور الذي اراه لبعض الامهات صاحبات القرار،حيث يتصرفن كما يشأن ويتدخلن ويأمرن ويقررن وما على الآباء الا التنفيذ. كانت أمي غير ذلك: راضية هانئة تتقبل الامور بصدر رحب ولا تتخذ مواقف حادة، ولهذا عاشت ظلا لأبي في حياتها، وجاء موتها ايضا كأنه تكريس لهذا الدور.
لكن ابي لم يكن الشخصية الوحيدة التي كانت تهيمن عليها. خالتي الكبرى فاطمة، والتي ماتت قبل سنوات قليلة، كانت تنازعه هذا النفوذ وكانت شخصيتها مختلفة تماما عن أمي، قوية صاحبة حضور وقرار، هدم بيتها ثلاث مرتين على يد الجيش الاسرائيلي، (أول مرة عام 1966عندما قام الجيش الاسرائيلي باجتياح بلدتنا وهدم بيوتنا)، واختفى ابنها يوسف في حرب الـ67 ولم يظهر حتى اليوم، وسجن زوجها، بتهمة »إيواء مخربين واسلحة«، وتشكيل اول خلية لحركة فتح في جبل الخليل، وهدم بيتهم، لكنها ظلت صلبة قوية رغم كل ما اصابها. وربما سلمت لها امي في فترة من الفترات مقاليدها وقراراتها فهي التي قالت لها: »اسمعي يا مليحة لن نأخذ نصيبنا من ارض اخوتنا، انا حصتي محَرمة علي«. وهكذا رفضت امي، رغم كل نصائح الاهل والجيران، أخذ حصتها من ميراث ابيها، والتي تزيد على ستين دونماً في اراضي السيميا، القريبة من طريق الخليل بئر السبع، والتي تعتبر من أفضل أراضي البلدة للبناء، وهي تعوم على بئر ماء عملاق، سرقته اسرائيل بعد حرب الـ?? وتغذي به مستوطناتها الجديدة، قبل ان يصل الى القدس الغربية نفسها.
كانت خالتي تكبر أمي بأكثر من عشرسنوات، وكانت أمي لا تعتبرها اختاً فقط، بل أمّاً أيضا، وقالت لي مرة ليس لنا صديقة الا الحاجة فاطمة، ومن محبتها لتلك الخالة انغرس حب الأخيرة في قلوبنا وتأثرت شخصيا لوفاتها كثيرا، وصدقت المثل القائل: الخالة أمّ، وتذكرت معاناتها في البحث عن يوسف ابنها الغائب الذي لم تره حتى توفيت عام 1997، ولم تقتنع بكل ما قيل لها عن وفاة يوسف، احترق في شاحنته العسكرية في غور اريحا، وظلت تنتظر اوبته حتى آخر ايام حياتها.
رضيت امي بدورها الهامشي بعد أبي وخالتي، وظلت طائعة مستسلمة لهما يتنازعانها كيفما يشاءان، لكن العلاقة بين أبي وخالتي أيضا رغم جدية الاثنين،كانت متينة مليئة بالتقدير والاحترام، الا أن خالتي كانت توجه لأبي بعض النقد فيتقبله بصدر رحب وان لم يتبعه، وفي نفس الوقت توجه لاختها نقدا »صارما« مماثلاً، لكنه مليء بالحب، ولم تكن أمي تغضب او تتبرم بل تكون سعيدة هانئة لا يعكر صفوها أمر مهما كان !
لم تكن أمي تحت مظلة ابي وخالتي فقط، بل شاركتهما عمتي الثانية آمنة ذلك الدور، حيث ظلت تعيش مع أبي الذي لم يفرط بها، وشاركتنا السكن، ومنذ تزوجت والدتي عام 1950 وحتى أكملت أنا الثانوية، أي ما يزيد على تسعة وعشرين عاما ظلت عمتي آمنة واحدة من أسرتنا، حيث كانت ترفض الزواج ممن يتقدمون لخطبتها، ويسكت ابي لا يريد اغضابها على عكس معاملته لوالدتي، وكانت أمي لا تعترض على وجودها او تدخلها في كل صغيرة وكبيرة، ولا تغضب من احترام ابي الشديد لها وسماعه لكلامها،او تربيتها لنا وحرصها الكبير علينا، حيث كانت بمثابة أمنا الثانية، وكانت اكثر حرصاً علينا حتى من والدتي نفسها في بعض الاحيان، وحين تزوجت عمتي لم تشعر أمي بأي نوع من الاستقلال او الفرح، بل حزنت لذهابها، وظلت غير راضية عن زواجها، وبقيت حتى وفاتها تطلب من آمنة العودة للسكن معهم، لانها لم ترزق من زواجها ببنت او ولد حيث تزوجت كبيرة، وتزوج عليها زوجها المتزوج قبلها، والذي يحمل الهوية الاسرائيلية ويحتال على القانون الاسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات. وقد فضلت عمتي بعد رحيل اخيها وامي سماع النصيحة ولو متأخرة، وعادت الآن تقيم مع اختي الصغرى.
كنا قد كبرنا، عندما تزوجت عمتي، انا انهيت الثانوية العامة، وكنت على وشك السفر الى عمّان للدراسة، واخي الاكبر حسين بدأ يعمل في مصنع ديمونا للكتان وظل به حتى تم فصله في انتفاضة الاقصى مؤخراً. كان أبي قد خطب لحسين، على طريقة البدل ايضا، بأختي الوسطى نجوى وكانا مقبلين على الزواج، اما أختي الكبرى فكانت قد تزوجت منذ زمن بعيد، من ابن عمها الذي بنينا جواره في السبعينات، لنظل قريبين من أختنا الكبرى ومن كرمنا الكبير، والممتلئ بالعنب والتين. وحتى المعاصر التي بناها جدي الذي كان يعشق الزراعة، في منطقة الصفيّ. كان زوج اختي وابن عمي الوحيد يكره والدتي ووالدي ويشعر بالغيظ والحقد تجاهنا دون سبب واضح. وظل على حاله حتى تدهورت أموره الصحية واضطربت تماما حتى بات مريضاً نفسياً، أدخلوه عنوة الى مستشفى بيت لحم، ثم ترك أولاده وبناته وهرب عنهم منذ اكثر من اربعة عشر عاما الى الاردن. وساهمت والدتي بدور كبير في رعاية ابنائه وتربيتهم واطعامهم، وقد حفظ الاولاد لها ذلك المعروف وكانت اقرب لهم منا جميعا، بل ان ابن اختي الاكبر أحمد غاب عن الوعي عند وفاتها. وعندما لمته على ذلك الموقف أمام امه واخواته وخالتيه قال لي على الهاتف: »ألا يحق لي ان أجن على جدتي؟ أنت خسرت امك، أما انا يا خال فقد خسرت أبي وأمي وجدتي وجدي وكل العالم بوفاتها«!
كان سيدي سلامة، الذي لا اعرفه ولم ادركه، صاحب اراضٍ شاسعة منذ ايام الاتراك، حيث كان الاقدر على دفع ضرائب الاراضي العثمانية من بين اهالي البلدة، فاصبحت له مئات الدونمات، وكان كريماً ذائع الصيت في تلك المنطقة،صاحب ايادي بيضاء، لكنه كان مزواجاً يحب النساء، تزوج خمس نساء على الأقل، وانجب منهن خمسة اولاد وثماني بنات، كانت امي اصغرهم جميعا، حيث انها ولدت في بداية الثلاثينات من القرن الماضي، ليس هناك من تاريخ محدد لولادتها، وقد قمنا باستخراج تقدير سنّ لها عندما اصدرت جواز سفر للمرة الاولى، وقدرت ولادتها عام 1930.
كان قد تمّ الاتفاق، في اواخر الاربعينات وبحضور سيدي سلامة، على تزويجها الى رجل آخر من عائلة الحوامدة ايضاً. تمت الخطبة رسمياً ولم يكن للخطيبة في ذلك الوقت أي رأي في تزويجها على الاطلاق. وكانت أمي على وشك الزواج، الا أن سيدي أعاد النظر في تلك المصاهرة او الصفقة، وشعر بأنه مظلوم لأن ابنته اجمل من بديلتها، فطلب ثلاثين جنيهاً فلسطينيا زيادة، فرفض الاخرون الأمر، لأنه لم يطرح ذلك وقت الخطوبة، وانقطعت المصاهرة. بعد ذلك، توفي سيدي وحلت نكبة الـ 48، واختلف ابي مع احد اعمامه على خطبة ابنته، وتحركت الرياح في اتجاه اخر، حين اقترح جدي على ابي ان يخطب له أمي. وتمّ الامر فعلاً، واتفقا مع اخوالي على التصاهر، وهو ما يعرف بزواج البدل في فلسطين، والذي يردد اغلب الناس في بلدنا ان الرسول نهى عنه، لكنهم يفعلونه حتى الآن بكل أريحية. وقد كتب عقد زواج امي في الخليل، على يد شيخ من آل الجعبري، وكان مهرها ?? جنيهاً فلسطينياً، وربما حصل اخوتها على زيادة معينة، او ان الزيادة أضيفت للمهر، لست متأكدا من ذلك. لكنني متأكد أن أمي لم تقبض من تلك الزيادة او المهر فلساً واحداً، وقد أقيم عرسها بعد سقوط بئر السبع وضياع ثلثي أراضي بلدتنا الجنوبية أيضا، مع ذلك الاحتلال. وزفت امي في هودج محترم، وعلى ظهر جمل عملاق، وكان هادئا تعوّد على حمل العرايس والأولاد المُطهرين، حيث كان اهالي بلدتنا ما زالوا يستخدمون الجمال والحمير، بشكل كبير في تلك الايام. فقد كانت قريتنا قرية زراعية يغلب عليها الطابع الرعوي اكثر، لقربها من مناطق البدو، ولاهتمام اهلها بتربية الاغنام والمواشي عموماً، قبل أن تكتشف فيها المحاجر، وقبل ان يتحول أغلب شبانها فيما بعد للعمل في إسرائيل.
أمي كانت تجيد كل اعمال الزراعة والفلاحة وتتقن تربية الأغنام، واطعامها وحلبها وتصنيع مشتقات الحليب مثل السمن البلدي والرايب والجميد والجبنة والقشدة، وصناعة الشكوة التي تستخدم للخض أو السِعن الذي يصنع من جلد الجدي او الخروف ويستخدم لنقل الماء. ومن مشتقات صوف الاغنام الذي كان يجز في ايام الصيف القائظ، كانت ايضا تجيد استخدامه وتصنيعه، حيث كانت تبدع في عملية الغزل والبرم ونسج البسط والكنوف والمصليات والمزاود. وكانت تتقن هذه المهنة من ألفها الى يائها، وبينما اختار ابي مهنة التجارة منذ نهاية الاربعينات ظلت هي متمسكة بتربية الاغنام والحصاد والزراعة والفلاحة، وطحن الحبوب وتخزينها، وقطاف الزيتون وتشميس البندورة، وصناعة العنبية والدبس والزبيب والقطين، وتصنيع دخان الهيشة الثقيل الذي كانت تزرعه وتنشفه وتصنِعه وتخزنه للوالد. كما كانت تتقن الخياطة والتفصيل والتطريز، ولم أر امرأة تفوقها في أي عمل من تلك الأعمال، بل كانت أوّل من اشترت ماكنة خياطة سنجر في الحارة، وكانت لا تتوانى عن تقديم الخدمة لكل من يطلبها من الاقارب والجيران.
إذاً، وبالرغم من دورها الهامشي كما قلت، لكنها استطاعت ان تخلق لها فسحة واسعة ومكانة مؤثرة فاعلة، ليس في بيتنا فقط بل بين الاهل والاقارب والبلدة كلها. وفي نفس الوقت نأت بنفسها عن المشاحنات او المشادات، حيث كانت تتمتع بقدرة كبيرة على حب الآخرين، وتحملهم ومساعدتهم وتقديم كل ما تستطيع لهم، وكانت محبوبة الى ابعد الحدود، اجتماعية لا يخلو بيتنا من زائرات او جارات، ولم تكن لحوحة او طماعة او بخيلة او ثرثارة لكنها كانت مرحة لطيفة، صحيح انها لم تكن منظمة، لكنها كانت تقوم بعملها وتترك الأمور للتساهيل وتتقبل كل أمر، مؤمنة بالقدر والنصيب، راضية بكل شيء وان اعترضت، يكون اعتراضها مجردا من أي ألم او موقف، مجرد كلمة قد تسر بها لمن تثق به ليس الا، وكان حبها للاخرين من ابناء البلدة الذين تجد في كل واحد منهم، مهما بعد، صلة نسب او قرابة، فالعائلة الفلانية اخوالها وهذه اعمامها وأولئك من اعمام امها او اخوال ابيها، كانت تبحث دائما عما يربط ويوحد ويقرب، وتنفر من المشاجرات والاذى والكره والحقد، وظني انها ماتت ولم يكن في صدرها كره لأحد أو حقد على مخلوق، حتى اليهود، رغم ما كان يجري من تصرفات للجنود الاسرائيليين، ورغم انهم هدموا بلدتنا مرتين قبل حرب حزيران، وتناول احد المختبئين معنا في متبن تحت الارض، غدفتها البيضاء يوم دخول القوات الاسرائيلية، وتم تعليقها كراية بيضاء، على سطح العقد الكبير الذي ولدنا فيه. لم تكن تحقد عليهم، او تشتمهم باوصاف مقذعة فاحشة، لكنها لم تكن تحبهم، وتخاف من وجودهم، وكانت تعتبر دخولهم الى فلسطين قضاء ربانيا، لن يخرجوا منها الى بارادة الله وبهمة ابنائها، (ما يحرث الارض الا عجولها) كما تقول. ذات مرة كانت تخرج من الطابون، وهي تحمل على رأسها صينية القش، مليئة بالخبز الساخن، ولم تنتبه الى وجود الدورية الاسرائيلية على الشارع، حيث قفز منها احد الجنود المسلحين،عندما شاهد الخبز، وتخطى الحائط، ونزل نحوها. وعندما فوجئت به أمي راكضا تجاهها، خافت ووقعت على الارض وتناثرت الارغفة، ومد الجندي الذي ادرك غلطته، بعض الشواكل (الليرات الاسرائيلية)، وهو يعتذر ببعض الكلمات العربية الثقيلة، طالبا أن تبيعه رغيف خبز. وبعد أن نهضت من سقطتها، لملمت الارغفة واعطته رغيفا ورفضت ان تأخذ ثمنه وهي تقول: نحن لا نبيع خبزنا، لكنك تبدو جائعا، خذ هذا الرغيف ومع السلامة. وعندما عاتبناها على عملها هذا، اذ كيف تعطي الجندي الذي يطلق النار علينا ويحتل بلادنا من خبزنا، وقد أخافها بتصرفه الوقح فقالت: بلكي الولد جوعان، اشفقت عليه، وربما كان ذلك في نفسه، فحرام أحرمه من الأكل، المعاملة مع الله يمه مش معه، ربنا اوصانا أن نطعم الاسير. ضحكنا وقال أحدنا: لكننا نحن الأسرى يا امي،وليسوا هم، فلم تصغ لرأينا، وهي تقول: ربنا اعلم، وألله يبعدهم عنا،وتمتمت: لعل أمه تنتظر رجوعه !
وفي احدى المرات جاء يهودي عراقي اسمه متقي الى دار خالتي، وتعرفت عليه وكان يأتي ويصطحب معه اولاده وزوجته، لزيارة زوج خالتي الذي يمارس الطب العربي، ونشأت علاقة غريبة من نوعها بينه وبين خالتي وامي، حيث كان يحبهن ويسأل عنهن ويقدمن له ما يستطعن، وكان بالمقابل يسمع كلامهن وياخذ معه بعض الاولاد للعمل، في القرى الزراعية التي تسمى بالعبرية »المشاف« داخل الـ 48، والتي اقيمت في منطقة عراق المنشية، بناء على طلبهن. وحين سمعن انه سجن لأسباب مالية على ما يبدو غضبتا على سجانيه، وكانتا تسبان على من تسبب في ايذائه وسجنه وتدعوان ان يفرج الله كربته. وحين خرج من السجن جاء الى البلدة فورا للسلام عليهما، ففرحتا لتلك المفاجأة، وقامتا بتقبيله أمام الجميع، ودعت له خالتي قائلة: الله ينصرك على من يعاديك. وحين عاتب البعض خالتي وامي على ذلك قالت خالتي: هذا ابن حلال،لم يؤذنا ولم يطلق علينا النار، ويمكن يكون فيه خير احسن من اولاد فلانة، واضافت امي: انه مسكين طيب، واولاده ما زالوا صغارا بحاجة له، قلت وكيف تدعوان له بالنصر على من يعاديه، ألسنا نحن من نعاديه، كما انه نصاب وحرامي، يحتال على العالم. فقالت خالتي: لا تصدق، اولاد حرام اشتكوا عليه وانسجن ظلماً. قال احدنا: إنه يهودي فردت أمي: والله يمه انه يهودي صحيح لكنه لم يضرنا ويحبنا.
سامحك الله يا امي، ألا تذكري ان ابنه الاصغر، قال لي ذات مرة، أنه يريد ان يصبح طياراً ليقصف العرب، وحين قلت له وانا ايضا سأتعلم الطيران وأحاربك في الجو، سأل اباه ولماذا يحاربني موسى؟ فقال له ابوه: لا تنس انه فلسطيني، فصعق الولد وصار ينظر لي بهلع وهو يرتجف من الخوف حين اكتشف أنني فلسطيني ولم يكن يعرف ان كل العرب في فلسطين فلسطينيون، وطلب من أبيه، سرعة الذهاب فوراً، فردّت أمي بلا مبالاة: ابنه جاهل، لكن أبوه عربي من العراق، الله يهدي بالنا جميعا.
لم تكن تحب الثرثرة، او يستهويها الجلوس لطق الحنك على عباد الله فقط،وتجد لكل الناس أعذارا، وهي تردد:( اللي ما بعذر الناس مش منهم)، ولم تكن تقعد بدون عمل، الا اذا كانت مريضة فعلا أو تعاني من الصداع، الذي كان يلازمها أغلب الاحيان، كنت أراها دائما تعمل بلا توقف، يداها لا ترتاحان بجانبها، وكأنهما في حالة تأهب دائمة. فكانت إما تشعل بابور الكاز، او تحضر للطبيخ، أو تعجن او تخبز او تنقي الحبوب او تغزل او تنظف الصوف او تقوم بصباغته او نسج النول او تذهب للحصاد اوالدراسة او تنقية الحبوب أو صناعة اللبن الجميد او حلب الاغنام وصناعة الزبدة أوالسمن البلدي، وكانت ايام الربيع تخرج الى الخلاء كي تحش للغنم او تلم الحطب او الجلة للطابون، او تلقط الفريكة او السعيسعه، وتاخذنا معها وتقترح علينا ان نطارد الشنار، ونبحث عن بيضه، وحين نعود محملين بخيرات الارض تقلي لنا بيض الشنار في زبدة الغنم الطازجة.
كانت لا تتبرم او تعتب او تعاتب او تلوم احدا، تبادر للعمل من نفسها، تذهب للحصاد بمفردها، وكانت تقترح علي أو على أحد إخوتي أن يساعدها في بذار الارض او حرثها، وقد كنت استجيب لطلباتها أحيانا، واذهب معها لبعض الاعمال، وقد علمتني كيف اكون بذارا وامسك بالمحراث واحرث، وعلمتني كيف امسك المنجل والقالوش وكيف اصبح حصادا واحصد وعلمتني ان الغناء يشد همة الحصاد؛ (يا منجلي يا منجلاه، راح للصايغ جلاه، يا منجلي يا ابو سيفين، ما عندي للتاجر دين، يا قالوش ويا قالوش، يللي بالزرع بتحوش، يا قالوش يا بو تم، يلي بالقمح بتلم......الخ)، او ألف وراء البقر او الحمير خلال درس الحبوب وقبل شيوع الدرّاسات الزراعية. كنت استجيب لطلباتها، وربما كنت الاكثر استجابة، لكنني سرعان ما كنت أمل من تلك الاعمال، وأتخلى عنها، فتسخر مني وهي تقول: الحصاد فلّس، لكنها لا تشكو ولا تتذمر ولا تعتب،ولا تنقل لأبي تقصيري، بل تحاول اطراء ما عملته أمام أبي واخوتي.
رأيتها في موقفين عصيبين في حياتي. الاول عندما احترق طابونها، واخذت تصيح طالبة المساعدة، كنت صغيرا ولم تتوقع ان أسعفها لاطفاء النار، ولكن لم يأبه لها أحد، الكل كان يقول لها اتركي الطابون يا أم حسين، بدأ الناس يشترون الخبز من الفرن او الدكاكين. كنت الوحيد الذي لبى طلبها وبت احضر لها الماء بالجرادل، وهي ترش على النار حتى خمدت، وحفظت لي ذلك المعروف وظلت تقول: موسى الوحيد الذي أنقذ طابوني من النار، وهو الوحيد الذي كان يساعدني للمّ الحشيش والجلة لتزبيل الطابون، وهو الوحيد الذي يساعدني، ويرد علي !
اما الموقف الثاني فقد كان صبيحة احد ايام المدرسة. أيقظتني من النوم متأخرا كعادتي، لكنني رأيت وجهها اصفر مثل ورقة تين يابسة، ورأيت الغضب باديا عليها ؛ مابك يا أمي؟ قالت: قم انظر الى النمل ماذا فعل بالنول. وحين اتيت للنول الذي كنت اساعدها على تركيبه، وبسط الارض لتوضيبه، ووضع حجارته وعمدانه ومد خيطانه، وجدت ان النمل قد حز النول حزا، وكأن سكينا قد قطعته قطعاً، سألتها: وماذا ستفعلين؟ قالت: اذهب لمدرستك، سأتدبر امري، قلت: سأبقى لأساعدك، قالت: أنا ادبر حالي، أسرع لقد تأخرت عن دروسك، الله يرضي عليك،ولا يرد النوال، واللي بنولوهن.
بقيت طيلة اليوم، أفكر بها، واتمنى دعس النمل الذي جز نولها جزا، وأتمنى لو بقيت معها أساعدها، كي أفتك بالنمل واحرقه حرقاً، وكنت مشغولا طيلة النهار، كيف ستتدبر امرها، لقد ضاع نولها وتعبها مسكينة. وعندما انتهت الحصص، عدت راكضا من المدرسة رغم بعدها عن بيتنا، وما أن وصلت الدار، حتى سمعت صوت طقطقة قرون النسيج الحديدية على خشبة النول. نظرت فكانت امي والسرور يطفح من وجهها، وبجانبها نساجتان ماهرتان، يواصلن ثلاثتهن النسيج بهمة عالية وسريعة،وكأن شيئا لم يحدث. قلت: ماذا فعلت يا أمي ؟ كيف رتقت النول، قالت: دبرت حالي، غداك جاهز روح يمه حط لك أكل واتغدى، وقفت مشدوها، قلت: ليس قبل ان أعرف كيف صنعت بهذا النول، أشارت وراءها أنظر،ورأيت انها قطبت بالإبرة كل الخيوط التي انقطعت، واعادت لحمتها وصارت القطب كأنها أثر غابر. وظلت تلك الندبة في البساط تذكرني بمنظرها المحزن تلك الصبيحة وبحكاية النمل.
كانت طويلة جميلة، لطيفة، ودودة، اجتماعية، معطاءة، يحبها كل من عرفها ويرتاح لمجالستها والحديث معها. لم نسمع عنها يوما انها تشاجرت مع جارة او كنة او امرأة، أو وقفت ترد على أحد الناس، حتى الذين كانوا يحاولون استفزازها، كانت تتجنبهم ولا تفكر بهم، كانت متسامحة الى درجة غريبة، متصالحة مع نفسها، واثقة ان كل الناس طيبون ويستحقون المساعدة والاحترام.
كنت مثل غيري من الصغار، أحب سماع الحكايات قبل النوم. لم يكن هناك تلفزيونات وكنا نستخدم لمبة الكاز، وكانت عمتي تقص علينا نفس القصص المعروفة، فطلبت من امي ان تحكي لي قصصاً غير مألوفة فكانت تروي لي حكايات الثوار وكيف كانوا يتخفون ويقاومون الانجليز، وتجترح حكايات متواصلة عنهم. وكنت كلما اطلب منها المزيد، تعيد نفس القصص وتبدع في رويها مجدداً. وكانت تروي لي حكايات كأنها من نسجها وتأليفها، وتحاول في كل مرة ان تضيف لها بعض الكلمات الجديدة او مقطعاً جديداً، او ابياتاً من الشعر الشعبي، وتنظم احيانا بعض الابيات الفولكلورية، او الحكم او الأمثال الملائمة. وقد ساهم ذلك في حبي لتلك الحكايات وللشعر وللغناء، وللموسيقى في اللغة، وخاصة الإيقاع، او الطباق والجناس، وكنت اسألها عن نوع الاغاني الشعبية في الأعراس والحصاد او البناء والعمل، وكانت مليئة حاضرة الذهن، وكنت اشعر احياناً انها كانت تسرد اشياء تعرفها او نقلتها نقلاً، ومرّات تضطر للتأليف، كي ترد على اسئلتي. وكنت كثيراً ما أحضر دفتراً، وابدأ اكتب ما ترويه من اغان ومواويل وبدائع. لكنها كانت تغير بعض الكلمات حين اطلب منها اعادتها للكتابة، وهنا علمتني ان بالامكان اللعب بالالفاظ والكلمات حسب الرغبة واللحظة.
وحين بدأت اعشق سماع الغناء الشعبي، مثل الدحية والبديع وأغاني الدلعونا والمواويل، وصرت أحاول تأليف بعضها او على غرارها، كنت أجلس ساعات طويلة، وانا اغني على سجيتي مما حفظت او سمعت منها، أو من تأليفي او تلفيقي على الأصح، لم تكن تتضايق او تغضب، وكانت تسمح بكل تلك الضجة، وتضيف من عندها او تصحح بعض الاشياء، وترجوني فقط ان اخفض صوتي قليلاً، لا خشية ازعاج، بل خشية ان اتعب أو يبحّ صوتي، كما حدث لما كنت الصبي الذي رفعه المتظاهرون، وكان يردد تلك الشعارات الجنائزية والوطنية، حين توفي الرئيس المصري جمال عبدالناصر الذي كانت تحبه جدا وتترحم عليه، وتشير له بلقبه، الله يرحمك يا »ابو خالد«.
هل أقول أنها حبّبت لي الأدب والكتابة و علمتني الشعر؟ أعتقد انها غرست فيّ البذرة الأولى للشعر وللحكاية والكتابة، لكنها ببساطة علمتني ان الحكي الحلو او الاغاني العذبة يجب ان تكون جديدة او مبتكرة او فيها شيء ما، هذا »الشيء الما«، والذي كانت بعفوية تفهم انه ليس من المتداول، فتح ذهني على تفكيك ما اسمع واعادة تشكيله، أو تأليف ما يشبهه،او يناقضه، حتى أغاني الشبابة او اليرغول او العتابا او الميجنا او السامر، أو حتى الهاهاويات التي تطلقها النساء مع الزغاريد. وكنت قادراً على تحوير بعض الكلمات لتصبح تلك الاغاني ذات معنى وطني مثلاً، او تحمل مدلولا جنسيا فاضحا.
لقد اكتشفت وانا اكتب، او أغرف من مخزون الطفولة والحكايات، أنني كنت أكرر وأعيد حكاية واحدة، هي حكاية أمي وإنْ بشكل واسلوب مختلفين. وما زلت اظن ان كل ما أكتبه من شعر وحكاية ليس الا ترديداً لتلك اللثغة الاولى على صدرها!
لكنني لا اعرف كيف سيظهر أثر رحيلها فيما سأكتبه لاحقاً، ولا أدري حتى الآن إن كنت سأكتب لها او عنها أو عنهما، لكن الشيء الوحيد الذي أنا واثق منه أنني لم أعد كما كنت قبل رحيلها ورحيله، ولن تكون كلماتي كما كانت من قبل، ولن تنشف ينابيع الطفولة الغزيرة منها ومنه ما حييت.
مجلة نزوى
عمان