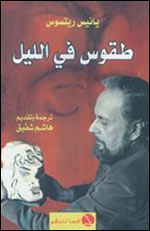 لا يُشكل اسم الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس أيّ غرابة أو «دهشة» في المشهد الثقافي العربي، وبخاصة في المشهد الشعري. عديدة هي الترجمات التي نقلت جزءا لا بأس به من شعره إلى لغة الضاد، أكان ذلك عبر كتب نُشرت هنا وهناك، في أكثر من دار للنشر وفي أكثر من دولة عربية، أو في الصحف والمجلات المتفرقة، وأخيرا (وليس آخرا) على المواقع الالكترونية العديدة والمختلفة. ليس ذلك فقط، أيّ تعدت الترجمات لأن تكون أكثر من ذلك، إذ نجد أننا لكثرة ما تحدثنا عن ريتسوس وجعلناه يقيم بيننا، تحول الشاعر إلى «شاعر عربي» وأقصد بذلك أنه أصبح مصدرا من مصادر القصيدة العربية الحديثة، وليذهب حتى إلى أكثر من ذلك، أيّ أصبح مصدرا مؤثرا، مارس الكثير من سحره على عدد من الشعراء الذين وجدوا فيه، حيّزا وفضاء لقصيدتهم، من هنا ليس من المستغرب أن يتحدث بعض الشعراء عن نسب وسلالة مع القصيدة «الريتسوسية» (نسبة إلى ريتسوس، على الأقل أتذكر الآن الزميل عباس بيضون ومقالاته المتعددة حول هذه القضية)، كما ليس من المستغرب أن يعتبر بعض النقاد أن ريتسوس حاضر في القصيدة الجديدة من حيث كونها ذهبت إلى شعرية التفاصيل والحدث اليومي.
لا يُشكل اسم الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس أيّ غرابة أو «دهشة» في المشهد الثقافي العربي، وبخاصة في المشهد الشعري. عديدة هي الترجمات التي نقلت جزءا لا بأس به من شعره إلى لغة الضاد، أكان ذلك عبر كتب نُشرت هنا وهناك، في أكثر من دار للنشر وفي أكثر من دولة عربية، أو في الصحف والمجلات المتفرقة، وأخيرا (وليس آخرا) على المواقع الالكترونية العديدة والمختلفة. ليس ذلك فقط، أيّ تعدت الترجمات لأن تكون أكثر من ذلك، إذ نجد أننا لكثرة ما تحدثنا عن ريتسوس وجعلناه يقيم بيننا، تحول الشاعر إلى «شاعر عربي» وأقصد بذلك أنه أصبح مصدرا من مصادر القصيدة العربية الحديثة، وليذهب حتى إلى أكثر من ذلك، أيّ أصبح مصدرا مؤثرا، مارس الكثير من سحره على عدد من الشعراء الذين وجدوا فيه، حيّزا وفضاء لقصيدتهم، من هنا ليس من المستغرب أن يتحدث بعض الشعراء عن نسب وسلالة مع القصيدة «الريتسوسية» (نسبة إلى ريتسوس، على الأقل أتذكر الآن الزميل عباس بيضون ومقالاته المتعددة حول هذه القضية)، كما ليس من المستغرب أن يعتبر بعض النقاد أن ريتسوس حاضر في القصيدة الجديدة من حيث كونها ذهبت إلى شعرية التفاصيل والحدث اليومي.
ومع ذلك كلّه، هل قرأنا ريتسوس حقا، وأقصد بفعل القراءة، هل نعرفه جيدا ونعرف خفاياه وخفايا قصيدته التي جعلت منه واحدا من كبار شعراء القرن العشرين؟ سؤال أحاول أن أجد شرعيته، بدءا من الفكرة التالية: لا يزال ريتسوس «غامضا»، على الرغم من الترجمات العربية المتعددة، والسبب؟ أنها أتت في غالبيتها عن لغات وسيطة وبخاصة الفرنسية والإنكليزية، بينما كانت الترجمات عن اللغة الأصلية، اليونانية، قليلة جدا، حتى لنكاد نقول شبه معدومة. لست، بالتأكيد، في وارد مهاجمة هذه الترجمات عن اللغات الوسيطة، بشكل مطلق (إلا وفق ما يقتضيه النص العربي، فعلى سبيل المثال ينجح الشاعر سعدي يوسف بتقديم نص جميل بالعربية على الرغم من كونه ترجم من الإنكليزية) فكلّ الشعوب بحاجة إليها حين لا تجد من يعرف اللغة الأصلية، ولكيّ لا يشعر أيّ واحد منكم بأيّ «إهانة» (وهي غير مقصودة ولم أفكر فيها أصلا) أسارع إلى القول إني ارتكبت أنا نفسي هذه الحماقات في كثير من الأحيان، أي «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». هل تعرفون مثلا أن فرنسا ترجمت، في البداية، دوستويفسكي من اللغة الإنكليزية (قام بها الروائي أندريه جيد) قبل أن تجد مترجمين يجيدون الروسية (وبخاصة بعد هجرة الروس البيض، عقب الثورة البولشفية)، كما العديد من الترجمات الأخرى التي لن يتسع المجال هنا للحديث عنها.
إذًا، لا يكمن سؤالي هنا، في هذه الزاوية، بل يحاول أن يقترب من شيء آخر، وهو الفكرة المسيطرة على الجميع، حين نتحدث عن ريتسوس، بأنه شاعر التفاصيل واليومي، ولا شيء آخر.
فكرة أستعيدها وأنا أقرأ الترجمات الجديدة التي قام بها الشاعر العراقي هاشم شفيق لريتسوس والصادرة حديثا عن «لارسا للنشر» بعنوان «طقوس في الليل». بداية، لا أستطيع إلا أن أحيي جهد الشاعر شفيق في نقل قصائد واحد من الشعراء الذين أحبهم والذين يعتبرون من كبار شعراء القرن العشرين. لكن ما يستوقفني – ولنؤجل النص المترجم إلى ما بعد – المقدمة القصيرة التي كتبها تعريفا بالشاعر وبشعره، إذ تثير عدة ملاحظات أجد أنه من المفيد التعليق عليها.
الفكرة المسيطرة
لا يخرج هاشم شفيق عن الفكرة المسيطرة على الجميع بأن ريتسوس شاعر التفاصيل، وهو يختار قصائد تدعم هذه الفكرة ليترجمها إلى العربية. يقول المترجم (ص 5) «شعر ريتسوس مشبع بأشياء الحياة وتفاصيلها، شعره اليومي الأليف والمرهف هو خزين للظلال والضوء والحركة...» الخ. صحيح أن جزءا من شعر ريتسوس يقع ضمن هذا المفهوم، وقد أسس لـ «شعرية التفاصيل» (في ما لو استعدنا عبارة وعنوان أحد كتب الناقد الأردني فخري صالح الذي يخصصه لريتسوس)، لكن ابتسار ريتسوس على هذا الحيّز لا بدّ أن يجعلنا نتساءل عمّا إذا لم يكن هناك جهل فعلي بكامل تجربة الشاعر اليوناني. هناك جانب آخر لم يترجم بكثرة، بل بالأحرى يبدو مغيبا ولا أعرف إن كانت صعوبته تحول دون ذلك، أم ثمة أسباب أخرى. فإلى جانب قصائده القصيرة، نجد أن ريتسوس كتب قصائد طويلة، جاءت أشبه بالملاحم الحديثة، وهي في جزء منها أيضا ترتكز على بعض شخصيات الملاحم الإغريقية كمثل قصائده «أوريست» و«فيدرا» و«هيلانة» و«إيفيجيني» و«فيلوكتيت» وغيرها العديد، وهي القصائد التي وضعت ريتسوس حقا في قلب المشهد الشعري اليوناني المعاصر، وبخاصة أن المترجم يشير إلى أنه «سليل أسخيليوس وهوميروس» (ص 6) لكنه لا يشير إلى هذه القصائد مطلقا، بل يقع في خطأ مميت حين يعتبره سليل «سيفيريس». «ولكي لا أكون سيئ النيّة» سأعتبر أنه ربما لم نستطع التمييز بين هاتين التجربتين المختلفتين بسبب الترجمة، إذ يفترق ريتسوس عن سيفيريس بما لا يقاس ولا علاقة للتجربتين بعضهما ببعض، على الأقل بكون سيفيريس كتب بما يسمى «لغة الديموتيك» أي اللغة الشعبية وهي تنويع دارج (بالمعنى ألألسني) عن لغة الشعب من حيث استدارتها واستعمالها اليومي، وهي لغة بدأت بالدخول والتحول إلى لغة أدبية مع بداية القرن التاسع عشر ولم تدرس في المدارس إلا في القرن العشرين. ناهيك عن افتراق الرجلين سياسيا، إذ كما هو معروف أن ريتسوس بقي يساريا وشيوعيا لغاية أيامه الأخيرة، وسجن واعتقل لمرات عدة، بينما كان سيفيريس ينتمي إلى اليمين ومرتبطا بالسلطة حيث عيُن سفيرا لبلاده في غير دولة، وهل تعرفون أنه كان في بداية الخمسينيات سفير اليونان في بيروت!!! سيفيريس من كان يأتي من ثقافة أرثوذكسية على الأقل كما يتبدى في قصيدته الطويلة «أكسيون استي» (التي ترجمها الشاعر العراقي شاكر لعيبي تحت عنوان «له المجد»، وهي العبارة التي يمتدح بها الأرثوذكس الله في صلواتهم). لم يكن ريتسوس أرثوذكسيا بهذا المعنى الديني الذي يشير إليه هاشم شفيق في مقدمته (ص 6) إذ يقول إنه، أي ريتسوس، «وريث الثقافة الإغريقية المتنوعة، وريث فلسفتها وجدلها وتحولاتها عبر التاريخ، منذ أرسطو وسقراط وأفلاطون، هو نتاج هذا التراث الفلسفي المترع بثقافة دينية – أرثوذكسية». هل لاحظ هذه الجملة كيف يمكن أن تكون الفلسفة الإغريقية أرثوذكسية بينما نجد أن أرسطو وأفلاطون وسقراط قد عاشوا قبل المسيح، أي لم تكن هناك فكرة المسيحية بعد!!!
اللغة الوسيطة
هذه النقطة أجدها مهمة جدا، وتستحق أن نقف عندها، إذ وقع فيها أغلب الذين نقلوا ريتسوس من لغات وسيطة، ولعل أبرز ما أوجد هذا الإبهام قصيدته «روميوسيني» (وهي من القصائد الطويلة الملحمية في نتاج الشاعر) وقد ترجمت تحت عناوين عدة لم ينجح المترجمون في التقاط كنهه. منهم من ترجم هذه القصيدة بعنوان «إغريقيات» (كالزميل فواز طرابلسي، عن دار المدى) ومنهم من ترجمها بعنوان «يونانيات» (وهناك العديد من العبارات الأخرى). السبب الوحيد في هذه الإشكالية، اللغة الوسيطة، لعلّ أبرزها الفرنسية، إذ ترجمت كلمة «روميوسيني» بعبارة (Grècité) لترفق بالشرح التالي إنها كلمة من الصعب ترجمتها. قد يكون من الصعب ترجمتها إلى لغات أخرى غير العربية، إذ إن الكلمة موجودة بلغتنا وهي «النشيد الرومي» (أتعرفون الروم؟ ألم تقرأوا سورة الروم في القرآن، على سبيل المثال؟ ألم يتحدث تاريخنا عن الروم الذين كانوا هنا قبل الفتح العربي – الإسلامي؟ هي كلمة الروم التي يستعملها ريتسوس، لكن ليس بالمعنى الديني (الأرثوذكسي) بل بالمعنى الحضاري حين كانت بيزنطة تسيطر على بلدان عدة في الشرق.
في أي حال، كنت أرغب في الاكتفاء بهذه الملاحظات على المقدمة، لولا جملة أخرى، هي الأولى في الكتاب: «في مدينة بحرية، ذات صخور حادة... هناك في مدينة مونمفاسيا ولد الشاعر».. جملة تجعلني أجزم بالتأكيد أن هاشم شفيق لم يقرأ حتى قصيدة ريتسوس عن مسقط رأس الشاعر (إذ لا أستطيع أن أطالبه بزيارة ذاك المكان) والتي تحمل عنوان «مونيمفاسيا» (أفضل زيادة الياء لمد الصوت كما تلفظ باليونانية) إذ لو قرأها لعرف أن هذه «المدينة» (القرية الصغيرة الريفية) مكونة من جبل صخري واحد يشرف على البحر. ألم يبدأ ريتسوس القصيدة هذه بالقول (الحركة الأولى):
«الصخرة. لا شيء آخر. التينة البريّة والحجر المعدني.
البحر المدرّع بأكمله. لا مكان لنركع فيه.
أمام معبد إلكومينوس،
يفيض الأرجواني في السواد....».
ويتابع الشاعر بالقول:
«القناطر البيزنطية الأربع والأربعون. الشمس،
صديقة مُحرقة، شعاعها يلتوي مقابل المتاريس،
والموت المحروم في هذا التوهج العملاق
حيث يقطع المتوفون في كلّ لحظة نومهم الذي
في صلابة ومشاعل صدئة، صاعدين وهابطين
الدرجات المحفورة في الصخر».
مقطع يبدأ بتحديد وصف مقطع رأسه، لكنه أيضا يشير إلى بيزنطة هذه التي يأتي منها بالمعنى الحضاري لا بالمعنى الديني...
السفير
12-8-10