
شاهدت، في عرض خاص، الفيلم البحريني «الشجرة النائمة»، الذي أثار إعجابي من بعض النواحي، ووجدت فيه محاولة جادة وجريئة وطموحة ضمن مسار الفيلم السينمائي في دول الخليج.
أمر جيد أن نجد فيلماً (أي فيلم) يكون مفتوحاً على عدد من التأويلات، ويكون قابلاً للقراءة عبر مستويات وطبقات متعددة، وأن نكتشف في عمقه أبعاداً فلسفية وسياسية وغرائبية. إذ ليس مطلوباً من الفيلم أن يوضّح كل شيء، وأن يعرض التفسيرات والتبريرات على نحو متواصل، وأن يحدّد معنى ودلالة كل ما يُرى ويُسمع، على نحو مبتذل ينمّ عن ازدراء للمتفرج وتعالٍ عليه بوصفه كائناً لا يفهم ويحتاج إلى من يأخذ بيده عند كل خطوة. عوضاً عن ذلك، على الفيلم أن يحرّك مشاعرنا وعواطفنا، ويحثّنا على التفكير والتأمل، ويتيح لنا استنباط مختلف المعاني.
هذا ما نطلبه من أي نتاج فني، لكن ينبغي أن تكون التأويلات والتفسيرات والاستنتاجات نابعة أو مستمدة من معطيات وأبعاد الفيلم نفسه، ومعتمدة على العناصر الموظفة في الفيلم من نص وإخراج وأداء وتصوير، وليس أمراً مفروضاً من خارجه ومما يتوهمه الناقد أو المتلقي، وليس متكئاً على المزاج الخاص، أو المحاباة الصرفة، من نقاده أو متلقيه.
لست ناقداً، بالمعنى الحقيقي، لذلك سوف لن أتناول الفيلم من وجهة نظر نقدية، إنما من وجهة نظر شخصية كمتفرج.
من خلال متابعتي لما كُتب عن فيلم «الشجرة النائمة»، هنا وأثناء عرضه في مهرجان دبي، استوقفتني تلك الكتابات «النقدية» التي رافقت عرض الفيلم، وتحديداً تلك التي أسبغت على الفيلم، بمجانية وعشوائية ملفتة للنظر، توصيفات وتقييمات لا تنسجم مع معطيات الفيلم ومضمونه وشكله، وحمّلته ما لا يستطيع تحمله.
هذه الكتابات التي تتوافر على درجة كبيرة من المبالغة والاستخفاف، ولا تكترث كثيراً بالمسئولية النقدية، لا تخدم الفيلم ولا تساهم في ترويجه، كما يتصوّر أصحابها، بل على العكس، تعطي تأثيراً سلبياً معاكساً، لأنها تشغل المتلقي بأمور أخرى بعيدة وغريبة عن فكرة الفيلم ومضمونه وما يريد أن يعبّر عنه ويناقشه. وتوجّه المتلقي الوجهة الخاطئة، فتضيع البوصلة وتتشوش الخرائط وتلتبس عليه الجهات، ذلك لأن علامات الطريق وإشاراته وتضاريسه ومحطاته تكون مختلفة ومتباينة عن تلك العلامات والإشارات التي وضعها الناقد.
من حق أي ناقد أن يبدي إعجابه بالفيلم ويكيل له الإطراء ويعطيه صفة الجودة والامتياز، حتى لو بالغ في تقديره واعتبره تحفة فنية، فهذا شأن نقدي لا نستنكره بل نحترمه ويمكننا مناقشته والجدال معه.
لكن عندما يأتي ناقد أو مهتم ويطرح توصيفاً ليس نابعاً من الفيلم نفسه، بل مفروضاً من خارجه أو من رغباته الخاصة، ويحاول إقناع المتلقي بأشياء وحالات لا يجدها هذا المتلقى على الشاشة، يكون من حقنا أن ننبّه إلى خطورة مثل هذه الممارسة (مجانية التقييم، عشوائية التوصيف، العبث بالمفاهيم أو الاستعانة بها في مجال وموضع ليس مجالها وموضعها) وضررها على السينمائيين الشبان من جهة، والمتلقين الذين يصعب عليهم التمييز وإدراك حقيقة المفاهيم والأطروحات من جهة أخرى.
الرحلة
يقول السينمائي مسعود أمرالله: «الفيلم رحلة صوفية موسيقية بصرية فيها عمق شخصيتين، زوج وزوجة، أصاب حياتهما الجفاف بسبب مرض أولادهما».
وتقول الناقدة منصورة عبدالأمير: «يندفع جاسم، المأخوذ بحزن شديد ويأس من أي قدرة على مساعدة الصغيرة، في رحلة تأخذ به إلى شجرة الحياة وإلى كل ما ترمز إليه هذه الشجرة وما تحمله من تناقضات تعطي لمفهومي الحياة والموت فلسفة مختلفة».
ويقول الناقد مصعب شريف: «مدفوعاً بحزنه والأسى الذي يلفُّه، يجد جاسم نفسه ماضياً في رحلة أمل نحو الشجرة الأسطورية، ليوقظ بها سعادته التي تسربت من بين يديه هو وزوجته نورة ليحاولا أن يعيشا حياتهما من جديد».
في السينما، في الأفلام التي تتّخذ من الرحلة ثيمة أساسية لها، وفي الفن والأدب عموماً، كل رحلة، فيزيائية أو مجازية، مادية أو روحية، خارجية أو باطنية، تقتضي حركةً، انتقالاً من موضع إلى آخر، من محطة إلى أخرى، من حالة إلى أخرى، قد تكون مختلفة وقد تكون متعارضة. إنها رحلة نحو المجهول، نحو ما لم يُكتشف بعد. وخلال الانتقال يحدث التحوّل والتجاوز وإدراك الذات.
وكل رحلة تقتضي بحثاً عن شيء ما، قد يكون مادياً ملموساً أو روحياً خفيّاً. غالباً هو بحث عن التحرر أو الخلاص أو الأمان أو المأوى أو الهوية أو الانتماء... عن التناسق والانسجام والإيمان والأمل. هو سعى وراء استعادة الأشياء المفقودة، أو تلك التي حرم منها الباحث، ليجدّد بها صلته بالحياة، بالآخرين.
هذا البحث يتحوّل إلى عملية سبر واستنطاق للعالم، لألغازه واحتمالاته، وذلك لمعرفة معنى الحياة واكتشاف جوهر الذات. وكل رحلة تحدث عبر الزمن والمكان معاً، لكن في فيلم «الشجرة النائمة» لا نجد انتقالاً (بل تنقلاً روتينياً يومياً للأب من البيت إلى المكتب أو المطعم أو مجلس الطرب، أما الأم فلا نراها تتحرك إلا في محيط المنزل) ولا نجد بحثاً (كلاهما - الأب والأم - لا يبحثان عن شيء، حتى أنهما يأسا من إيجاد أي علاج لابنتهما، واكتفيا باجترار الحزن والألم والعذاب. والأمور تبدو محسومة: هي تريد ابناً وهو لا يريد أن يجلب المزيد من الأبناء المرضى... وكل التوتر بينهما ناجم عن هذه الوضعية).
الرحلة، إذن، تحدث لكن ليس في الفيلم بل على الورق، في ذهن ومخيلة صانعيه وبعض نقاده.
المخرج والكاتب يؤكدان، في أحاديثهما عن الفيلم، أن هناك رحلة يقوم بها بطل الفيلم، ويأتي بعض النقاد ليدعموا هذا التوكيد، حتى تبدأ في الارتياب بنفسك وتتساءل: هل هناك نسختان للفيلم، وأنت شاهدت النسخة التي لا تحتوي على أية رحلة، بينما غيرك شاهد النسخة التي تصوّر حقاً هذه الرحلة!!
في مقابلة المخرج محمد راشد بوعلي مع CNN العربية يقول: «مدفوعاً بيأسه، ووجوده الذي يتلاعب به الأسى، لا يجد جاسم نفسه، إلا وهو يمضي في رحلة أمل نحو شجرة الحياة الأسطورية، وكل قاصديها مأخوذون بها، وما يحيط بها جارف لا يعترف بالزمن والفناء، فتستعيد الحياة معناها، وتصحو السعادة التي تسرّبت من بين أصابع جاسم ونورة، ويعيشان زواجهما من جديد».
شخصياً، شاهدت معاناة الأب والأم، نتيجة مرض البنت، وتعاطفت معهما وتفاعلت مع الحكاية لكنني لم أرَ ما حكى عنه المخرج من رحلة وأناس مأخوذين بالشجرة، لم أجد ما يقوله متجسداً على الشاشة في شكل صور وحوارات وعلاقات، لم أرَ البطل يبادر أو حتى يفكر بالقيام بالرحلة بل يذهب إلى حيث الشجرة مكرهاً ومرافقاً بالصدفة... بمعنى آخر، ليست هناك رحلة (بالمعنى الفيزيائي والروحي والواقعي والمجازي) على الإطلاق.
الشجرة
نلاحظ بأن بطل الفيلم (جاسم) لا يعي حقيقة الشجرة وسبب مجيء أحد إليها وممارسة أي طقس عندها... هو يأتي مجبراً، وبالمصادفة، ثم يرصد ما يجري بقليل من الفضول وبكثير من اللامبالاة (أو ربما التشكيك) ثم يستلقي على الجذع في كسل واسترخاء، وفجأة يتخيل ابنته المريضة على فرع الشجرة وقد كبرت (وهو تخيل عابر وغير مبرّر ضمن وضعية الأب). وفي طريق العودة، بداخل السيارة، يوجه إلى الزائر سؤالاً جوهرياً لاشك أن كل متفرج يود طرحه ويهفو للحصول على إجابة له: لماذا جئت إلى هنا؟ ليتلقى رداً مبهماً ومخيباً لكل توقع، إذ يقول إنهما جاءا ليشهدا سر هذه المعجزة التي لا تموت... وهي إجابة مجردة، غير مفهومة، وقد لا تعني شيئاً بالنسبة للمتلقي المتعطش للمعرفة، أو أنها ناقصة ومبتورة. والغريب أن البطل يقبل بهذه الإجابة، التي لا أعتقد شخصياً أنه فهمها، ويصمت، وكأنه تلقى حكمة عميقة تقتضي الصمت والتأمل.
إذن البطل ذهب مرافقاً وليس شخصاً باحثاً عن بصيص أمل من إمكانية تحقق معجزة شفاء ابنته. بالأحرى، هو لا يبدو من النوع الذي يؤمن بالمعجزات.
ضمن هذه العلاقة الضعيفة الواهنة، بخيوطها الواهية، بين البطل والشجرة، كيف يمكن لنا أن نصدّق بأن الشجرة كريمة وسخية، ومتسامحة أيضاً، إلى حد أنها اجترحت معجزة لشخص في الأصل لم يطلب منها أن تجترح المعجزة... شخص لا يثق بها أصلاً، ولا يحمل أي ذرة إيمان بكينونتها ووجودها وطبيعتها، رغم أنه يعرف موقعها وربما تاريخها.
في حضور المعجز، من حق المرء أن يتساءل أين إذن جموع البشر المرضى واليائسين، وخصوصاً أن المنطقة مفتوحة، مباحة، غير محظورة، والناس يعلمون بما تحققه الشجرة من معجزات. هل هو زهد؟ ترفّع؟ تعفّف؟ انعدام الحاجة؟
من جهة أخرى، لا شيء يمنع من إضفاء طابع أسطوري على أشياء أو مواقع معينة، يريد الفنان أن يوظفها، لكن لابد من أن تحمل هذه الأشياء أو المواقع أبعاداً أسطورية، وقدرات غير عادية، ضمن رؤية فنية تحكم الأحداث عبر نسيج فني يجمع الواقعي والغرائبي في علاقة متداخلة.
نحن هنا، وتحديداً في المشاهد التي تصور الشجرة، لا نلحظ أي بعد أسطوري ولا نكتشف أي دلالة ذات منحى غرائبي وما ورائي أو خارق.
الشجرة ذاتها، كواقع وكينونة، تمتلك حقيقتها التاريخية والجغرافية (اسمها شجرة الحياة ووجدت منذ 400 سنة) حتى أضحت معلماً سياحياً يفد إليها السياح والزائرون بوصفها ظاهرة طبيعية عجيبة.
يشار إلى أن هدف الكاتب والمخرج من صنع الفيلم كان في الأساس تقديم قصة واقعية تشتمل على عادات وتقاليد محلية... فقد صرح المخرج بوعلي، في المقابلة ذاتها، قائلاً: «هدفي كان أن أقدم قصة تلامس أحاسيس الجمهور وتفكيره، وحياته، وتقدم فكرة عن بعض العادات والتقاليد والتراث البحريني».
وأضاف بوعلي أن «الفيلم يمثل قصة حقيقية وواقعية استمديتها من حياتي الشخصية، وأضفت عليها العادات والتقاليد والتراث البحريني».
لو أردنا أن نضفي الطابع الأسطوري على مثل هذه الشجرة فإنه يلزمنا أن نُظهر الجانب أو البعد الذي يوحي للمتلقي أن هذه الشجرة خارقة بالفعل، أو ذات تأثير سحري، فيجري الكلام عمّا تجترحه من معجزات، وتوافد الناس طلباً لتحقيق الرغبات، واتخاذ السلطة إجراءات صارمة تنظم أو تقنن الزيارات، وغير ذلك من التدابير التي تشعرنا فعلاً بأننا أمام ظاهرة خارقة تستدعي الحماية من جهة والقيام بشعائر خاصة للتواصل مع الشجرة. أما أن تكون الشجرة وحيدة ومهجورة بلا عناية ولا حماية، كما في الفيلم، ويأتي من يرغب ليكتفي فقط برشّها بالماء (كما لو يزور قبراً أو ضريحاً) من دون أن نرى طقوساً وشعائر، أو صلاة تتلى، أو ما شابه، ثم نرى البنت تصحو من سباتها وتعود إلى الحياة لنبرر ذلك بالقول إن الشجرة فعلت ذلك بعد زيارة الأب الكسول والضجر لها، فذلك أمر لا يمكن استيعابه وهضمه، سواء بالمنطق الواقعي أو الغرائبي.
إننا نقرأ في كتيب العرض: «زوجان على وشك الانهيار بسبب ابنتهما النائمة، إلا أن حياتهما تتغير حين تقرر الشجرة إيقاظها».
كيف يمكن للشجرة أن تقرّر!! هكذا، وبكل بساطة؟!
ويقول مسعود أمرالله: «صوت القربة الخفي هذا، يعادله شجرة الحياة التي ما أن ينبض قلبها، إلا ويتحرك الساكن، ويموت المتحرك، شجرة نائمة، لكنها يقظة وحارسة لكل الأرواح التائهة»...
الفيلم لا يعطينا صورة واحدة تشير إلى، أو تدلّ على، يقظة الشجرة وتحرّك نبضات قلبها. ولا صورة واحدة تشير إلى أن ثمة علاقة بين البطل والشجرة. ولا صورة واحدة للحبل السري بين الشجرة والبنت المريضة. مع ذلك يأتي النقاد ويفترضون أشياء غير موجودة، ويجعلونك ترتاب فيما ترى.. رغم أننا تعلمنا أن الأشجار لا تنام، وأن الأشجار حيّة طالما هناك مياه تروي جذورها، وأن الأشجار تموت واقفة.
نكرر: كان بإمكان صناع الفيلم إضفاء البعد الأسطوري والسحري على الشجرة لكن ضمن شروط فنية وبعناصر تنتسب إلى الواقعي والغرائبي معاً، الحياتي والحلمي معاً، الظاهري والتخيلي معاً، تحكمها رؤية فنية وفكرية، قادرة على نسج علاقات محكمة بين المرئي والمسموع. عندئذٍ لن نشعر بالتشوش والحيرة والالتباس والغرابة عندما يفترض الناقد أن الشجرة كانت نائمة واستيقظت لتحرك الساكن وتهلك المتحرك، وأن الشجرة يقظة حتى في نومها!!
وبدوره يتطرق الناقد زياد عبدالله إلى فكرة يقظة الشجرة، عندما يقول: «ومع الفصل المعنون (يخرج الحي من الميت) تستيقظ الشجرة النائمة التي ليست إلا شجرة الحياة، وهنا يكون المشتهى قادماً من الأسطوري، ومن أثر الشجرة، التي تكون كفيلة بشفاء أمينة وإعادة الحياة لما هو ميت».
بودّنا أن نرى هذا متجسداً بصرياً لا نظرياً، بودّنا أن نرى الشجرة وهي تجترح المعجز لأشخاص لم يطلبوا منها اجتراح المعجز... وبدلاً من «الحديث» عن سحر الشجرة، كان بودّنا أن «نرى» شعاعاً من هذا السحر. في الأخير، كيف يمكن لنا أن نصف شجرة الحياة بأنها شجرة نائمة... أي ميتة مجازياً؟ أرجو ألا يكون في الأمر حذلقة.
وتقول منصورة عبدالأمير: «شجرة الحياة... هذا المعلم التاريخي البحريني، يحضر بقوة في الفيلم حاملاً رمزية عالية كاشفاً عن فلسفة عميقة يتبناها جاسم المكلوم بألمه ويأسه وبفقده لأبنائه. تستعيد الحياة معناها عند هذه الشجرة ويتجدد الأمل بغد أفضل».
الكاتبة منصورة، من بين أكثر النقاد في الخليج ثقافةً ومتابعةً، وتمتلك من الوعي ما يكفي ليجنبها إطلاق أحكام مجردة لا تستقي حيثياتها ومعطياتها مما تشاهده إنما من افتراضات يحركها انحيازها للعمل ولصانعيه، وحماستها إزاء عمل أثار إعجابها فبالغت في تجميله وإضفاء دلالات لا يحتملها العمل... وإلا كيف نفسر الرمزية العالية للشجرة، بينما حضورها في محيط الأب والأم عابر وباهت، فلا الأب اهتم كثيراً بزيارة من رافقهما، ولا الأم استجوبت حقيقة ما حدث أو ما تخيلته. ثم ما هي الفلسفة العميقة التي تبناها الأب والتي لم نجد لها إشارة واحدة لا صراحةً ولا ضمنياً، لا فعلياً ولا حتى عن طريق الإيحاء.
أخشى أن الناقدة تُسقط أمنياتها الخاصة التي بها تكمل الجوانب الناقصة من عمل أعجبها كثيراً لكنها لم تجد فيه تلك الإسقاطات أو الافتراضات التي ترغب في تحققها عملياً، فلجأت إلى تحقيقها نظرياً.
الصوفية
أيضاً لاحظت إطلاق بعضٍ ممن تناول الفيلم، على المستويين النقدي والترويجي، صفة الصوفية على فيلم «الشجرة النائمة» من غير أن يوضحوا سبب اختيارهم هذا التوصيف، وما هي الأوجه، من أحداث وأفكار وسلوكيات، في الفيلم، التي أوحت لهم بالبعد أو المنحى الصوفي، وكأن الأمر افتراض ينبغي التسليم به بلا مناقشة ولا ارتياب.
عندما يقول حسن حداد: «نجح كل من فريد رمضان ومحمد بوعلي وفريقه الفني، في تقديم رؤية صوفية جمالية للحياة والموت، للحزن والفرح، ولكن بتقاطعات زمنية يتداخل فيها الحاضر والماضي والافتراضي الأسطوري... ليعزف سيمفونية رائعة للزمن بأشكاله المتعددة».
ويقول مسعود أمرالله: «تسمعون؟... وتبدأ الرحلة الصوفية في عرس جليل، تصدح فيه الطبول، وينام فيه الزمن، وتشتعل الأحلام، وتختلط الرؤى، وما يبقى فقط... هو الحب الخالص، حب أمينة الذي لا يموت».
ويقول زياد عبدالله: «لعله مغرٍ تماماً بتوصيفه بأهم تجربة خليجية روائية طويلة، تستدعي المكان والزمان وفق المعطى الثقافي العربي والخليجي، وآليات السرد العربية في سياق صوفي لا يكون الفلاش باك عودة بالزمن بل كسراً لحواجز الزمن أو ما يخرج الحي من الميت».
ويقول مصعب شريف: «يختتم الفيلم بذات الصورة الغارقة في صوفيتها والضاجة بصخب إيقاعاتها وعلى ذات الشجرة».
فإنه يحق لنا أن نتساءل عما تعنيه «الرؤية الصوفية الجمالية» و «الرحلة الصوفية» و «السياق الصوفي». فقد صرنا نبحث عن معنى الصوفية في فيلم لا يحتوي على أي منحى صوفي.
بالمعنى المتعارف عليه، الصوفية منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى الله... وهي نزعة فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، ثم تطورت حتى صارت طرقاً مميزة متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية.
إذن الصوفية متصلة على نحو وثيق بالدين، بالعبادة، بالإيمان... بينما في الفيلم لا نجد أي استحواذ ديني، ولا يتحلى بطل الفيلم، أو غيره، بالإيمان، بالرغبة في التواصل مع الخالق. إن الإيمان الذي يتحدث عنه النقاد هو في حقيقته إيمان افتراضي، نظري، تجريدي، لكنهم يعتقدون بوجوده في واقع الفيلم، وعلى أساسه يبنون استنتاجات لا علاقة لها بواقع الفيلم وشخوصه وأحداثه. بالتالي، فإن أي حديث عن الصوفية هو استنتاج خاطئ لا يتصل بأي معطى في الفيلم، سواء فيما يتعلق بالأحداث أو بمسلك الشخصيات.
أما العناوين الجانبية، التي قد تستدرج المرء للاعتقاد بالملمح الصوفي، فهي محض عناوين ذات خاصية أدبية، لا تتصل بالصوفية، إنما تتصل ببناء العمل في تقسيمه إلى فصول.
أخيراً
أود أن أوضح بأن الفيلم الذي شاهدته شخصياً هو ما تحدث عنه الكاتب فريد رمضان في إحدى لقاءاته:
«الفيلم يتناول موضوع الحياة والموت، اليقظة والنوم، انتظار المعجزة أو انتظار الأجل المحتم أمام حالة مرضية يعاني منها زوجان تتجسد في وجود بنت مصابة بمرض يوصف طبياً بأنه الشلل الدماغي. الفيلم يطرح هذه الثيمات من خلال وجود شجرة الحياة النابضة بالحياة وسط الصحراء ووجود بنت صغيرة مصابة بمرض الشلل الدماغي تنمو ولكنها شبه ميتة أو في غيبوبة، وكذلك من خلال علاقة الزوجين وهما يراقبان ابنتهما وينتظران حدوث المعجزة بشفائها».
هكذا، ببساطة... وبلا ادعاء
الفيلم سيكون أكثر جمالاً وصدقاً لو تحدثت صوره إلينا مباشرة، بعناصرها الفنية، بعيداً عن الافتراضات والتفسيرات والاستنتاجات الضاجة، المصطنعة، الصادرة من صانعيه ونقاده على حد سواء.
الوسط- بتاريخ 07-10-2015م
فيلم «الشجرة النائمة» بين الوهم والواقع

من أجمل مزايا أمين صالح الذي يثري حياتنا السينمائية بالمستوى الرفيع من الترجمات التي لا تبدو مترجمة بل مكتوبة من القلب.
كتبت من قبل عن محنة ترجمة الكتاب السينمائي وتوقفت أمام المترجمين الذين يقدمون على ترجمة هذا النوع من الكتب، دون معرفة أو دراية حقيقية بفن السينما ومصطلحاته وأفلامه وأعلامه، مما يوقعهم في الكثير من الأخطاء الكارثية والمضحكة.
اليوم أتوقف أمام نموذج آخر مغاير، يتميز بالدقة والمعرفة والبراعة والأسلـوب الـرشيق البديـع الـذي يجعـلك تريـد أن تلتهم ما يتـرجمه التهـاما.
أكتب اليوم عن الشاعر والأديب وكاتب السيناريو والمترجم البحريني أمين صالح، الذي أثرى المكتبة العربية ببعض أهم ما صدر من كتب سينمائية، كما ترجم وأعدّ عشرات المقالات والدراسات عن أعمال ومساهمات عدد من أهم السينمائيين في العالم، وبوجه خاص من نطلق عليهم “المبدعين” السينمائيين، أي أولئك الذين يتعاملون مع الفيلم كرؤية فلسفية إبداعية، وليس كسلعة للتسلية.
ترجم أمين صالح “النحت في الزمن” الذي ضم كتابات المخرج الروسي الراحل المرموق أندريه تاركوفسكي، وهو كتاب لا تسهل ترجمته بسبب إحالاته الكثيرة إلى الشعر والأدب الروسي، وتأملات كاتبه الفلسفية والفكرية، ونظريته الخاصة في السينما التي لا تشبه أيا مما طرحه سابقوه.
وترجم أمين صالح أيضا أحد أهم الكتب السينمائية على الإطلاق، وهو كتاب آموس فوغل “السينما التدميرية”، الذي يسلط الأضواء على سينما الفن والتجريب التي تألقت في ستينات القرن الماضي.
ويعتبر كتابه “الوجه والظل في التمثيل السينمائي” موسوعة شاملة لا غنى عنها لكل من يفكر في العمل بالتمثيل في السينما، ولا يتميز الكتاب فقط بما بذله مؤلفه من جهد في العثور على المادة من بين آلاف المقابلات الشاملة المنشورة مع عدد من أشهر الممثلين في العالم، بل بأسلوبه السلس الممتع الذي يعكس فهما دقيقا للموضوع.
أعد أمين صالح وترجم أيضا كتاب “براءة التحديقة الأولى: عالم أنغلوبولوس السينمائي” عن أعمال المخرج اليوناني الراحل الكبير الذي يعتبره صالح عن حق “صوتا فريدا في عالم السينما، وواحدا من رموز السينما “الفنية” الحديثة، ومن أكثر السينمائيين أهمية وتميزا، وإثارة للجدل أيضا، في السينما العالمية المعاصرة”.
ولصالح أيضا كتاب شامل وشديد الأهمية عن السينمائي الإيراني الأشهر عباس كياروستمي، ويعتبر الكتاب الذي ترجمـه ويحمل عنوان “سينما فرنر هيـرزوغ: ذهـاب إلى التخوم الأبعـد” (سبق أن قدمنا له في “العرب”) مفتاحا أساسيا لفهم تجربة المخرج الألماني الشهير، كما أصدر كتاب “حوار مع فيدريكو فيلليني” الذي يضم حوارا مطوّلا أجراه -في بداية الثمانينات من القرن الماضي- الناقد السينمائي الإيطالي جيوفاني غرازيني مع فلليني، الذي يعد أحد أكثر المخرجين شهرة وتأثيرا في السينما العالمية.
يترجم أمين صالح حديثا المحاضرة التي ألقاها المخرج الألماني فيم فيندرز بعنوان “دفاعا عن المكان في السينما”. وفيها نقرأ باستمتاع “لم تعد الأمكنة شخصيات رئيسية في الأفلام، بالطبع هناك القليل من الأمثلة المتألقة والرائعة التي تهتم بالأماكن، لكن ليس ثمة قوانين بلا استثناءات.. في ما يتعلق بي، أرى أن فقدان المكان خاصية مفقودة في الأفلام، إنـه يأتي مع فقدان الواقع، فقـدان الهوية”.
ولعل من أجمل مزايا أمين صالح الذي يثري حياتنا السينمائية بهذا المستوى الرفيع من الترجمات التي لا تبدو مترجمة، بل مكتوبة من القلب، شدة تواضعه، فهو يميل إلى الابتعاد عن الأضواء، ولا يظهر في المهرجانات السينمائية العربية، بل يفضل أن ينكب على العمل ليفاجئنا بكتاب جديد ممتع، وفي قراءة ما يترجمه أمين متعة لا تعادلها متعة.
العرب - العدد: 10059
ناقد وكاتب سينمائي من مصر
ترجمة: أمين صالح
دعوني أبدأ بتوجيه سؤال إليكم: في اعتقادكم، ما الذي يحرّك الفيلم؟ أنا لا أعني المال والاستثمار، أو الرغبة في جني الأرباح، كما هو حال عدد من الأفلام التي هي غير واردة في بحثنا ولا تؤخذ بعين الاعتبار هنا، إنما أعني: ما هي القوة المحرّكة بداخل الفيلم، ما هي الروح المحرّكة؟ ما الذي يجعل الفيلم يدور؟ ما الذي يمنحه القدرة على إقناع المنتج كي يستثمر أمواله في صنعه، وإقناع المخرج والممثلين كي يوظفوا أوقاتهم في تنفيذه؟
في السينما المعاصرة، سرعان ما تجدون أن هذه القوة تأتي من "القصة". الكثير من الطاقة تكون موظفة في القصة. المخرجون والكتّاب والمنتجون يعملون أحياناً لسنوات من أجل تنمية وتطوير القصة. الممثلون يشاركون في المشروع لأنهم يؤمنون بالقصة أكثر من إيمانهم بالمخرج أو بالميزانية أو بأي شيء آخر.
شخصياً أحب القصص. مهنتي أن أروي القصص.. لذلك، لا تسيئوا فهمي. أنا لا أريد أن أقلل من شأنها، أنا أستجوب فحسب مسألة وضعها في المرتبة الأولى، وجعلها محور الاهتمام.
القصص، من ناحية أخرى، يمكن أن تكون في خدمة قوة أخرى قادرة على التحكم في الفيلم، قوة أخرى قادرة على خلق الرغبة في تحقيقه في المقام الأول. أريد أن أعرّفكم على هذه "القوة"، خصوصاً وأنها الخيار الأقل توظيفاً، والأكثر مجهوليةً، في السينما المعاصرة، بينما هي الكينونة الأكثر رسوخاً في التصوير الفوتوغرافي.
أنا هنا أتحدث عن المكان. الأماكن، كموضوع، لا تحصل إلا على القليل من الاهتمام، ذلك لأنها عادةً تؤخذ باستخفاف، وهي في كل الأحوال "موجودة هناك" على نحو حتمي ومسلّم به جدلاً. بلغة السينما، الأماكن غالباً ما تعيّن هويتها بوصفها "مناظر" أو "مواقع" أو "خلفية".. هي بالتأكيد تعتبر العنصر الأكثر سلبية، ليس في الفيلم فقط بل حتى في التصوير الفوتوغرافي.
أنا معارض تماماً لهذه النظرة، وأظن أنها نظرة خاطئة جداً. لذا أود هنا أن أمنح "المكان" موضعاً جليلاً ومقاماً رفيعاً.
للناس من يمثّلهم: وكلاء ومحامون. وثمة نقابات تدافع عن مصالحهم. لكن ليس هناك من يدافع عن الأماكن. لذلك أود هنا، اليوم، أن أتولى القيام بهذا الدور. ولهذا السبب اخترت عنواناً ملائماً لمحاضرتي: دفاعاً عن المكان.
دعوني أشرح قليلاً عن المصدر الذي جئت منه مع حجتي. أنا واثق من أن بعضكم سوف يتعرّف على مشاعر أو بواعث مماثلة.
أنا أسافر كثيراً. بل إني أحياناً أحسب أن مهنتي الحقيقية: مسافر. في أحوال كثيرة، أصل إلى أماكن لم أزرها من قبل، أو أماكن لم أرها منذ وقت طويل. أسير هنا وهناك. أرى المدن والشوارع والبيوت. أرى الناس يذهبون إلى أعمالهم. أرى الأطفال يلعبون. أنظر إلى مبنى مؤلف من عدة وحدات سكنية، فأرى نوافذ مضاءة، وظلالاً تتحرك خلفها.. ربما امرأة تنحني وتنادي ولدها. ربما هناك إجابة من مكان ما: أنا قادم.
لا أستطيع أن أمنع نفسي، في الحال، من الإحساس بأني أرغب في معرفة كل شيء عن هذا المكان: كيف العيش هناك. كيف تنقضي الفصول. كيف يقضي هؤلاء الناس حياتهم في هذا المكان. من أين يحصلون على المتعة والمرح. ما الذي يقلقهم. كيف يأكلون، يشربون، ينامون، يعملون.
أو أصل إلى مكان لا يعيش فيه أحد.. لنقل، الصحراء. هنا أتخيّل البدو يتنقلون هائمين هنا وهناك، أو أتخيّل الصيادين يمرون أحياناً. أو أول كائن بشري مرّ من هنا وألقى نظرة على تلك الجبال، وتلك البحيرة، وهذا السهل الواسع المرتفع. من الذي رسم أول خارطة في العالم؟
هكذا ترى أن الأماكن لديها جاذبية لا تقاوَم بالنسبة لي. إنها منبع إلهام لا ينضب أبداً.
عشت في أمريكا مدة ثمان سنوات، من أواخر السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات، في سان فرانسسكو، لوس انجلس، نيويورك. ثم انتقلت إلى ألمانيا، ولأول مرة أستقر في برلين.
ظللت أتجوّل في برلين لأسابيع، لشهور، محدّقاً في المباني والأماكن، ملتقطاً الصور، منصتاً إلى اللغة الأم، الألمانية، كما لو أسمعها للمرة الأولى. كنت أعيد اكتشاف بلادي.
كنت أرغب في معرفة كل شيء عن سكان برلين، ماضيهم، تاريخهم، أفكارهم السريّة. المدينة هي التي استمالت هذه الرغبة. أردت أن أروي قصة هذه المدينة. كانت لا تزال مدينة منقسمة. شعبان مختلفان كانا يعيشان هناك، رغم أنهما يتحدثان اللغة نفسها. إنها المدينة ذات السماء المنقسمة، إذا جاز التعبير. سمّيت مشروعي "السماء فوق برلين"، لكن لم تكن هناك قصة على الإطلاق، ولا أي مفتاح. بل حتى لم تكن لدي شخصيات مرسومة. لا شيء غير الرغبة في الحفر عميقاً داخل هذا المكان.
بالطبع كنت أبحث عن الشخصيات. لقد حاولت أن أجد بعضاً ممن يتواجدون كثيراً هنا وهناك، مصادفين العديد من الأشخاص، من أجل أن أكون قادراً على النظر إلى الكثير من الشقق، وأن أدرس حيواتهم. فكرت أن أجعل بطل الفيلم ساعي بريد، أو سائق تاكسي، أو اطفائياً. فكرت أن يكون طبيباً أو بائع متجول. فكرت في الغرباء الذين يصلون ويضيعون، مثلي. لكن ولا واحد من شخصياتي الرئيسية المحتملة حقق، حتى على نحو ضئيل، رغبتي في اكتشاف هذه المدينة، وفي كشف النقاب عنها.
كنت بالفعل ممسوساً بذلك المكان. شعرت بوضوح تام أن المدينة ترغب في أن تتحوّل إلى فيلم، وتريد أن تستخدمني كأداة لفعل ذلك. وأنا بدوري كنت راغباً في ذلك.
فيما كنت أتجوّل، وأحدّق في البيوت، رأيت كمية هائلة من التصاميم والديكورات والدعامات والنصُب والأقواس وأشياء لم ألاحظها من قبل. الكثير منها كانت تحتوي على أشكال أو رسوم لملائكة.. وهذا الشيء أدهشني حقاً. المقابر أيضاً كانت مزدحمة بأشكال الملائكة. بالنتيجة، راحت المدينة على مهل تفرض هذه الأشكال عليّ.
في البداية، لم أرد أن أصدّق ذلك. لم يكن ذلك من طبعي، فاهتمامي بالملائكة كان محدوداً. تلك المخلوقات السماوية كانت تقطن تخيلات طفولتي، ربما لأنني نشأت كطفل كاثوليكي، لكن حدث ذلك منذ زمن طويل.
ها هنا جملة غامضة، مكتوبة على عجل ومن غير عناية في دفتر ملاحظاتي: "تحدث عن المدينة من خلال وجهة نظر ملاك حارس". هذه الجملة ظلت ثابتة في مكانها، عالقة حتى قبلت أخيراً قدري، بينما تعرضت الملاحظات الأخرى للمحو. المدينة فرضت الشخصيات الرئيسية، وكنت واثقاً من أن المدينة أيضاً سوف تعتني بقصتهم.
شرعت في هذا الفيلم من غير أن يتوفر لديّ سيناريو. على الجدران في مكتبي ألصقت الكثير من الصور التي التقطتها للأماكن التي من المفترض أن تظهر في الفيلم، ولمختلف الأشخاص الذين أردت أن أكتشفهم بواسطة الملائكة، والكثير من الأفكار للمشاهد. الاحتمالات كانت لا نهائية. بوسع الملائكة أن يظهروا في أي مكان. ومن خلال إدراكهم الحسي، يمكن لأي شيء أن يتكشف. ليس فقط لأنهم غير مرئيين، بل أن بمقدورهم أيضاً سماع أكثر أفكار البشر سريّةً.
إن عملية تحقيق فيلم من غير وجود سيناريو يشبه إلى حد بعيد كتابة الشاعر لقصيدته. مثلما هو لا يعرف سلفاً ما الذي سيقوله في البيت التالي من القصيدة، كذلك أنا لا أعرف ما الذي سأصوره في اليوم التالي. كل شيء ممكن مع هؤلاء الملائكة. الأماكن كانت كلها مصطفة على ذلك الجدار في مكتبي، وبمجرد التحديق فيها أجد الإلهام الذي يساعدني في اليوم التالي من التصوير.
اليوم، فيلم "أجنحة الرغبة" Wings of Desireيعد وثيقة تاريخية عن المكان الذي زال نهائياً. هذه المدينة لم تعد موجودة. مدينة جديدة حلّت مكانها. لا أظن أن أي عمل وثائقي قادر أن ينصف برلين الثمانينيات (من القرن الماضي) أكثر من هذا الفيلم الدرامي الذي يفتقر إلى القصة.
ربما تعلمون أن هوليوود أعادت تحقيق هذا الفيلم بعد عشر سنوات من إنتاجه، بعنوان "مدينة الملائكة" City of Angels، والمدينة المقصودة هي لوس أنجلس. بلغ عدد الذين شاهدوا الإعادة عشرة أضعاف عدد من شاهد الأصل.
لقد بعت حقوق الإعادة وأنا أقول لنفسي: يا للغرابة! ها هم يشترون حقوق قصة فيلم حققته من دون وجود قصة.
كانت الإعادة جيدة. لا تسيئوا فهمي. لا أريد هنا أن أقلل من شأن الفيلم. لكن إذا اعتقدتم أنكم عرفتم شيئاً عن مدينة لوس أنجلس من مشاهدة "مدينة الملائكة"، فأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن القصة هي المحرك الأساسي لهذا الفيلم الأمريكي. القصة قوية، الممثلون بارعون. لكن ليس هناك أي إحساس بالمكان على الإطلاق. "الإحساس بالمكان" يحتاج أيضاً إلى مكان كي يتمدّد، ليمنح حيزاً للتنفس. "القصة" لا تحب المنافسة على حيّز ترغب هي في احتلاله.
أنا لا أقول كل هذا لكي أقلل من شأن فيلم "مدينة الملائكة". أنا فخور جداً لأنني صرت جدّاً لهذا الرضيع. لكنكم ترون طريقتين مختلفتين جداً لمباشرة العمل: التحدث عن المكان، أو سرد قصة.
الأماكن في الأفلام الأمريكية تكون في أغلب الأحيان قابلة للاستبدال. إنها لا تحمل إلا القليل جداً من اللون المحلي، إذا جاز التعبير. أغلب القصص يمكن أن تحدث في أي مكان آخر. (لا عجب أن الموقع المفضّل لهم في هذه الأيام هي تلك الشاشة الزرقاء).
المدن والمناظر الطبيعية هي مجرد "خلفية"، مجرد "مواقع"، يعثر عليها شخص متخصص في البحث عن مواقع التصوير. لم تعد الأمكنة شخصيات رئيسية في الأفلام، كما كان Monument Valley في أفلام جون فورد. بالطبع هناك القليل من الأمثلة المتألقة والرائعة التي تهتم بالأماكن، لكن ليس ثمة قوانين بلا استثناءات.
في ما يتعلق بي، أرى أن فقدان المكان هي خاصية مفقودة في الأفلام. إنه يأتي مع فقدان الواقع، فقدان الهوية. ربما هي علامة فارقة أوروبية أن يكون لدينا ذلك الإحساس العميق بالمكان. بالطبع، هناك تخوم أكثر، لغات أكثر، هويات قومية أكثر.
هكذا غالباً ما سوف تجدون أفلاماً ذات أجواء محلية قوية، لمسات قوية، لهجات عامية. هناك قلة من الأفلام الأمريكية التي تبدو محددة ودقيقة، أو تبدي اهتماماً بالصفات المميزة. الأفلام الأمريكية تتجنب ذلك لأنها تخشى أن يفقد الجمهور اهتمامه. كما لو أن الكثير من "الواقعية" و "الحقيقة المحلية" سوف يتعارض أو يتضارب مع "القصة". القصص تبدو أكثر وضوحاً، وتهيمن بجلاء أكثر، إذا كانت في المركز، في بؤرة الاهتمام. القصص تريد أن تكون الأولى في ترتيب الأسماء، أن تكون في موقع متقدم.
مرّة أخرى، أنا لست هنا لكي أنتقد، أنا هنا لكي أتحدث عن طريقة مختلفة في الفهم، وكيفية تأويل ذلك.. ليس بشكل عام بل بشكل شخصي.
عندما جلسنا معاً، أنا وسام شيبرد (كاتب السيناريو، وهو ممثل وكاتب مسرحي)، في العام 1982، للبدء بتشكيل النص، روى كل منا الكثير من القصص من أجل اكتشاف أرضية مشتركة. لكننا أدركنا أننا سوف لن نجد ذلك في "قصة ما". ثمة الكثير من القصص، كانت متصلة ولا نهائية، فيما كنا نتبادل الحديث.
بالأحرى، اكتشفنا الأرضية المشتركة في المكان: الغرب الأمريكي، وبصورة دقيقة أكثر، في صحراء الغرب، التخم الذي يفصلها عن المكسيك. تلك الأماكن المنسية، المهمَلة، الصغيرة، في منتصف اللامكان.
لم يتعيّن علينا أن يقنع أحدنا الآخر بأن ذلك المكان جدير بأن ننطلق منه لتحقيق فيلمنا هناك. كنا نعرف. لا مجال للشك أو الاعتراض. لا إعادة نظر.
لذا عندما اتفقنا على أن فيلمنا سوف يبدأ من هناك، من دون أي نقاش، تقريباً أشبه باتفاق صامت، منحتنا الصحراء شخصيتنا وقصتنا. رجل بلا ذاكرة يحاول أن يعيد اتصاله بالماضي، وأن يجد عائلته المفقودة.
شخصياً سافرت لشهور عبر تكساس، أريزونا، نيو مكسيكو، حتى صرت أعرف كل طريق هناك، أو على الأقل هذا ما شعرت به.
عندما استحضرنا، أنا وسام، اسماً للمكان، صار بوسعنا كتابة المشهد التالي. خط سير الرحلة أضحى هو مجرى قصتنا. وعنوان الفيلم، باريس - تكساس، لم يكن اسم مدينة، بقدر ما صار مجازاً لسيرة بطلنا الممزقة.
أنا وسام شيبارد لم نكتب أبداً سيناريو كاملاً. كتبنا نصفه، وكان في نيّتنا أن نصوّر حتى المنتصف، وأن نتعرف جيداً على شخصياتنا، أن نعرف كل شيء عنها ثم نكتب النهاية التي سوف تتجلى من هذه الشخصيات على نحو عضوي، وعلى نحو طبيعي، وليس من رحم قصة اخترعناها منذ وقت طويل، قبل أن تسنح لشخصياتنا الفرصة لأن توجد. سام كان يرافقنا أثناء التصوير، يسافر معنا، يختبر معي المكان والممثلين، بعدئذ يكتب المشاهد فيما نتقدم ونعمل متعاونين.
كانت فكرة جميلة، غير أنها لم تنجح. عندما صورنا الفيلم أخيراً، بعد تأجيل لفترات متعددة، لأسباب تتصل بالتمويل، في الدرجة الأولى، كان سام قد وقّع عقداً كممثل في فيلم آخر يصوّر بعيداً في الشمال. لذلك باشرت تصوير فيلمي من غير وجود كاتب إلى جواري. بعد وقت، بدأ السيناريو يتناقص حتى لم تعد هناك صفحات مكتوبة، وأنا لم أكمل بعد نصف الفيلم. توقفنا عن التصوير. وآنذاك لم تكن هناك أجهزة الفاكس، بل آلة تدعى "تليكس".. شيء سيء ولا يمكن وصفه، ولن أتكلم عنه حتى لا أستحضر الرعب الذي واجهناه بسبب تلك الآلة.
على كل حال، كنت أفكر في النصف الثاني من القصة، وأنا في حالة يأس شديد، ولا أعرف كيف أنهي الفيلم. كل ما أعرفه أنه سينتهي في مكان ما في تكساس. (لأني هنا لا أريد أن أختبر ذاكرة من شاهد الفيلم، فسوف أشرح: بطل الفيلم فاقد للذاكرة، وهو أخيراً يعثر على ابنه في لوس أنجلس، ثم يعود مع ابنه الصغير إلى تكساس ليعثر على زوجته، أم الطفل). هكذا، فإن كل ما نعرفه هو أن الأحداث سوف تعود لتدور في تكساس.
لم أستطع أن أفكر في أية طريقة مرضية ومقبولة لإنهاء قصتنا، إلى أن تخليت عن محاولة اختراعها وشرعت في التفكير في الأماكن التي كنت أعرفها. تذكرت إلى أي مدى أثّرت فيّ مدينة هوستون بوصفها "مدينة الفُطْر" التي نمت بمثل لمح البصر، طالعةً من اللامكان. تذكرت وفرة "الفضاء" في تكساس. والقصة أخذت في التشكّل. تذكرت بورت آرثر، أكثر البلدات التي زرتها في حياتي إثارةً لليأس. تذكرت صورةً التقطتها لحانة رخيصة تضم مكاناً فيه يمكن إشباع الرغبة الجنسية عن طريق اختلاس النظر. والقصة بدأت تتخذ المسار الصحيح.
تحدثت إلى سام عبر الهاتف ووصفت له تلك الأماكن. هو على الفور فهم ما أريد. بناءً على وصفي لتلك الأماكن، كتب ما اعتبره من أكثر الصفحات إدهاشاً في أي سيناريو قرأته في حياتي. لقد كتب تلك الشخصيات المضطربة بناءً على معرفته بالأماكن المضطربة.
عبر الهاتف أملى عليّ المشاهد. كان ذلك قبل انتشار أجهزة الفاكس. ثم باشرت تصوير الجزء الثاني من فيلمي بناءً على المعرفة الكثيفة للأماكن. لم يكن لدينا أي وقت للقيام بمزيد من البحث عن مواقع. لم تكن هناك حاجة لذلك: تلك المواقع قد ارتادت قصصها ، وليس العكس.
والآن، لا تظنوا أني التقطت تلك الأمثلة من ذهني، وأن بقية أفلامي تنتمي إلى القاعدة بدلاً من الاستثناء. أضمن لكم، ثمة الكثير من التوكيدات الجلية بشأن فرضيتي.
أية فرضية؟ تلك التي تقول أن الأماكن تكشف القصص وتجعلها تحدث. ليس صحيحاً أن القصص تحدث بأية طريقة كانت، وهي تحتاج فحسب إلى "مواقع" لكي تحدث. لعل فيلمي "حتى نهاية العالم" المثال الأفضل. ذلك الفيلم بأسره بدأ قبل أن نباشر بتنفيذه بـ 12 عاماً، حين صادفت أولاً تلك القارة الجميلة، القديمة، المباركة. بالصدفة تقريباً، سافرت عبر جنوب شرقي آسيا. في بالي، انتقيت رواية وجدتها في محل للكتب المستعملة. بلدة تشبه ألِس. التهمت الرواية، أحببتها، وقررت أن أسافر إلى ذلك المكان.
هكذا جئت من خلال الباب الخلفي، ودخلت أستراليا عن طريق داروين، في ديسمبر 1977. كنت غير مهيأ تماماً لما سوف أراه. استأجرت سيارة وبدأت أقودها. أول نهر عبرته، سبحت فيه. اكتشفت مدى غبائي عندما رأيت تلك الليلة تمساحاً - كان يعيش في ذلك النهر - معروضاً في الفندق المحلي الصغير الذي أقمت فيه. لكن إلى حد أبعد، كنت غير مهيأ تماماً لالتقائي بالثقافة المحلية التي أنتجها السكان الأصليون. أولئك الناس كانوا رائعين، استثنائيين، في العديد من الأوجه. ومن أكون أنا لكي أحدثكم عنهم؟ أنا، مثل بعضكم، أقل اطلاعاً ومعرفة بهم. بالنسبة لي، هم كانوا اكتشافاً، منذ اللحظة التي أدركت فيها مفهوم إحساسهم بالمكان.
إن وجودهم بأسره كان مبنياً على ذلك.. وهذا ما بدأت أفهمه. إيمانهم، دينهم، كان "الأرض"، والقدرة على رواية قصص. علمت أنهم ملزمون، كل واحد فيهم، بالإبقاء على امتداد الأرض حياً عن طريق الإبقاء على قصتها حيةً. عندما يدعون القصة تموت، عندما يدعون الأرض تموت مع قصتها، عندئذ هم أيضاً يموتون معها. إنهم "يغنون" بلادهم. مثلما حدث مع هوميروس، الذي لم يكن يقرأ الأوديسة بل ينشدها.
التقائي بثقافة سكان البلاد الأصليين، في ما يتصل بعبادة أماكنهم، حثني على البدء في مشروعي السينمائي الأكثر طموحاً، والذي يبحث في الإدراك الحسي والأحلام، ومسألة مِلكية الأحلام. هل مسموح لك بأن تسجلها، بأن تجعلها عامة، علنية، وتعدّدها؟
كانت أيضاً المرة الأولى التي فيها شعر البدويّ فيّ بأنه في موطنه، والتي فيها فهمت بأن ثمة سياقاً لتقديري العميق واللاواعي تقريباً للأماكن.
في ما بعد، العديد من الأشياء صارت في الموضع الصحيح بالنسبة لي. سمو الأماكن، الطريقة التي بها يرتبط مثولها المادي بالوجود الغيبي، والتي غالباً ما ننكرها بشأن المواقع الطبيعية في ثقافتنا الغربية. نحن غالباً ما نتباهى بكوننا "خالقين"، بأننا نمتلك قدرات خلاقة، بينما نحن في الحقيقة لسنا أكثر من باحثين، نصطاد ونجمع. إننا نعثر على الأشياء مصادفةً. في طريقنا نجد الصور أو القصص. نحن، في أفضل الأحوال، مكتشفين لها، ولسنا مخترعين. هكذا، في أحوال كثيرة، نحن نرغب في جعل أنفسنا تشبه مصدر الإلهام، مصدر الفن، في حين أن المؤلف الحقيقي هي الطبيعة، وأن رواة القصص الحقيقيين هي الأماكن.
دعوني أطرح المثال الأخير، فيلمي Buena Vista Social Club (ربما بعضكم شاهد الفيلم). ذهبت إلى هافانا لتصوير الفيلم هناك، المكان الذي لم أزره من قبل. لم أكن أعرف غير تلك الموسيقى التي أنتجها أولئك الرجال المسنين.. موسيقى مكهربة، مسكرة، ومعْدية.
ما إن شاهدت هافانا وصورتها، حتى أدركت بوضوح الشيء الذي هو مميز واستثنائي بشأن هذه الموسيقى. إنها تنبع من هذه المدينة. تلك الموسيقى هي دم هذه المدينة. المكان وجد سموّه في الصوت، إذا جاز التعبير، ووجد شكلاً آخر للوجود في هذه الأغاني. وهؤلاء الرجال المسنين كانوا قادرين على إنتاج، وإعادة إنتاج، تلك القصة عن مكانهم الخاص، لأنهم لم يتخلوا عنه، مثلما فعل قبلهم الكثيرون من الموسيقيين الذين هربوا من كوبا ليستقروا في فلوريدا، وفي المكسيك، وفي أسبانيا. (وأنا هنا لا أقصد التجريح في أولئك الذين غادروا).
إحساسهم بالهوية وبالإنتماء، عشقهم البالغ للمكان الخاص بهم، هو الذي جعل هؤلاء المسنين يتحملون الكثير من الألم، الكثير من المعاناة.. وهو الذي صار أيضاً مصدر قوّتهم.
الموسيقي، الموسيقى العظيمة والمحركة للمشاعر، لا تحدث من غير أن يكون هناك إحساس بالمكان. إنها تحتاج إلى جذور لتستل منها، تحتاج إلى "قصة" و"تاريخ" لكي تتغذى. أحياناً، غياب مكان ما، الحنين إليه، النفي منه، يمكن أن ينتج الجذور ذاتها. سوف لن يكون هناك أي بلوز blues (الأغاني الكئيبة زنجية الأصل) من غير الجنوب الأمريكي، من غير الدلتا، من غير العبودية، وأخيراً من غير البيت المفقود في قارة أفريقيا، البعيد إلى الأبد مثل مجرّة بعيدة.
على كل حال، بإمكاني أن أواصل في ذكر القائمة الكاملة بأفلامي، مبرهناً لكم أنها كلها تبدأ هكذا: كمكان يرغب في أن يُروى، كمكان يحتاج لأن يُروى. تلك القائمة سوف لن تكون مكتملة لو احتفظت باخفاقاتي الكبرى في الخفاء. الآن، لكي أثبت وجهة نظري من خلال النقيض، فإن فيلمين لي يُظهران الحالة الي بلغتها عندما تشوّش إحساسي بالمكان.
"الحرف القرمزي" Scarlet Letter، رواية أمريكية جميلة تأليف ناثانييل هاوثورن. ذلك كان فيلمي الثاني، كنت في الأصل أنوي تحقيقه في نيو إنجلاند، حيث تنتمي القصة: سيلم، ماساشوسيتس.
نحن فقدنا جزءاً من التمويل.. لكن تلك قصة طويلة، لن أضجركم بسردها. عندما باشرت أخيراً بتنفيذ الفيلم، تعيّن عليّ تصويره، من بين كل الأماكن، في أسبانيا، وأدوار كل المتزمتين دينياً أسندتها إلى كاثوليكيين أسبان. "الهندي الأمريكي" الوحيد كان مصارع ثيران عاطلاً عن العمل. كان بإمكان العمل أن ينجح، الممثلون بوسعهم العمل على الرغم من وجود العديد من العوائق، لكن ما لم ينجح هو أننا صورنا الفيلم في "قرية غربية" بالقرب من مدريد، حيث صور الإيطاليون أغلب أفلام "الويسترن السباجيتي" في هذا المكان. إن تصوير قصة تنتمي إلى الساحل الشرقي من الولايات المتحدة في منتصف أسبانيا كان خطأ جسيماً. القصة ماتت بمجرد نقلها إلى مكان آخر.
المثال الآخر، هو فيلمي "هاميت" Hammett، وهو عن الكاتب الأمريكي العظيم هاميت الذي أثّر في العديد من الكتّاب، من بينهم: همنجواي وفولكنر. اعتمدت على قصة متخيلة، فيها يعيش هاميت في سان فرانسسكو، ويعمل كتحر خاص، ويشرع في كتابة قصص التحري التي غيّرت وجه الكتابة الحافلة بالإثارة والألغاز.
صورنا الفيلم في سان فرانسسكو. كان ذلك عظيماً. حقيقياً. صادقاً. كان هناك إحساس بالمكان. القصة كانت حيث تنتمي. المدينة سان فرانسسكو عزّزت القصة، أعطتها مبرراً، حرضتها. لكن الأستوديو (الجهة الممولة) لم يعجب بالفيلم. لم يجد فيه ما يكفي من مشاهد الحركة والأكشن والخيال. وجده متجذراً أكثر مما ينبغي في الواقع. على أية حال، انتهى الأمر بي إلى إعادة تصوير أغلب مشاهد الفيلم في لوس أنجلس، في الأستوديو وفي شوارع قلب المدينة التجاري. كل شيء في الفيلم صار زائفاً، وهمياً. المزيد من القصة، هذا مؤكد، لكن القليل من الروح.
الفيلم انفصل عن مكانه الأصلي. هذا ما تعلمته في حالتين، حيث القصة والمكان لا يتصلان على نحو حيوي، لكن يجتمعان على نحو اعتباطي. مثل هذا الفيلم محكوم عليه بالإخفاق. على الأقل، في كتابي، ذلك يبدو أشبه بقاعدة راسخة ووطيدة، لكن لا يتم تطبيقها على أغلب الأفلام الأمريكية المعاصرة. بل إن صانعي هذه الأفلام لا يكترثون كثيراً بإنصاف المكان وتقديره. هم، قبل كل شيء، يقدّرون قصصهم.
لكن بأي ثمن؟ الأفلام الأمريكية تنزع إلى التعويض عن افتقارها إلى المكان بالأسطح الصقيلة دوماً، مع توظيف المزيد من المؤثرات الخاصة المثيرة، والميزانيات الضخمة الخيالية، والديكورات المنمقة المترفة. إنهم يملأون الفجوة التي صنعوها بمادة متألقة. لكن هل ساوركم شك خفي بأنه شيء لملء الفراغ.
أعترف أنني ربما أبالغ قليلاً في تقدير دور المكان ضمن السياق القصصي. المصدر الآخر للقصص، ولعله بنفس القدر من الأهمية، نجده في الشخصيات. (سوف ألجأ إلى الاختزال وتخطي بعض الأمور، وذلك لأن الموضوع واسع وقد يأخذنا بعيداً جداً)
القصص تخرج من الشخصيات المدهشة، من الناس. لكن مرة أخرى، تماماً كما الحال مع الأماكن، التي تحوّلت من عنصر محرّض على القيام بعمل ما إلى مجرد خلفية أصبحنا نقبلها ونصدّق الفكرة الخاطئة عن الناس أيضاً. بدلاً من أن يكون الناس والشخصيات متحكمة في مصائرها، تعلّمنا الأفلام نقيض ذلك، أكثر فأكثر، والذي هو مفهوم خاطئ تماماً، قائم على فكرة أن القصص هي التي تشكّل الشخصيات، وأن الناس خاضعون للقصص.. هم ضحاياها، إذا جاز التعبير، وليس العكس.
الناس والأماكن أصبحوا مشاهد ضمن القصص، ولم يعودوا الأصل، والمنبع. في معظم الأفلام الأمريكية اليوم، نجد أن الحبكات تتلاعب بالشخصيات. الأحداث تحث الشخوص هنا وهناك.. والأحداث، في أغلب الأوقات، ليست إلا سلسلة من المؤثرات المثيرة.
هل تفهمون السبب الذي جعلني أعتقد أن الأفلام تمثّل، أكثر فأكثر، العالم مقلوباً رأساً على عقب: الناس ليسوا متحكمين في أقدارهم، ولا يحولون حيواتهم إلى قصص، بل أن القصص هي التي تحوّل الناس إلى عبيد لها، إلى موجودات أو أشياء نافعة. الأماكن لم تعد في لبّ القصص، مثبّتة الشخوص في الأرض كما تفعل المراسي، بل أضحت "مواقع" قابلة للاستبدال.
القصة، كنتاج صناعي، تمتلكه الكتل المختلطة المجهولة ذاتها التي تمتلك الموارد الأخرى، مثل النفط. قصص كهذه تجد التشجيع لأن تكون القوة الأعظم لتحريك الصور والمخيلة على حساب قوة بناء القصة عن الناس والأماكن.
ذلك التحول الذي نشهده هذه الأيام سوف تصوغ أجيال المستقبل وتشكلهم على نحو عنيف أو متطرف. ليس فقط مخيلتهم التي سوف تتغيّر، لكن جوهرياً تلك الصورة التي كوّنوها عن أنفسهم، احترامهم للذات، ومعرفتهم بالمكان المشترك: كوكب الأرض.
الآن، ربما لم يعد يتعيّن عليّ أن أفسّر الكثير، بشأن السبب الذي جعلني أسمّي معرضي: صور من سطح الأرض، كما لو أنها من نجم غير معروف. أو لماذا أحب التقاط الصور. بعد هذه المحاضرة الطويلة كصانع فيلم تستطيع أن تتخيّل، ربما، وأنا مفعم بالأمل، كيف أشعر حين أقف وحيداً، لا أملك غير كاميرتي، في حضرة مكان ما.
كمصور فوتوغرافي، بوسعي أن أقف هنا وحيداً. لا حاجة بي إلى مئة شخص يحيطون بي. لا أحتاج إلى مساعد يزعق طالباً من الجميع السكوت. هنا الصمت يشملني معظم الوقت. هكذا بوسعي أن أقف هناك وأصغي فحسب. أستطيع أن أستخدم كاميرتي كما لو إنها جهاز تسجيل للأصوات، وألتقط أصوات المكان، وقبل كل شيء، أسجل الصوت وهو يسرد قصته وتاريخه.
الأماكن، التي قد تبدو مجازية، هي دائماً حقيقية. بإمكانك أن تتمشى حولها أو تستلقي على الأرض. بإمكانك أن تأخذ حجارة معك أو تأخذ حفنة من الرمل. لكن لا يمكنك أن تأخذ المكان معك.
في الواقع ليس بمقدورك أبداً أن تملك المكان. حتى الكاميرا لا تستطيع أن تستحوذ عليه. وإذا التقطنا صورةً له فإننا نكون قد استعرنا مظهر المكان لفترة من الوقت. نكون قد استعرنا جلده الخارجي، سطحه فحسب.
بعض الأماكن التي صوّرتها هي على وشك أن تختفي، ربما تكون قد تلاشت عن سطح الأرض. هي سوف لن تنجو إلا في الصور الفوتوغرافية، أو على نحو أفضل: ذاكرة الأماكن سيكون عليها أن تتشبث بالصور التي التقطناها لها.
الأماكن الأخرى سوف تعمّر أكثر منا، بل سوف تتحاشى مساعينا لأسرها في صور فوتوغرافية. أكثر من ذلك: الأماكن سوف تنجو وتبقى بعد زوال كل أثر لنا.
بعد مليون سنة، عندما لا يعود هناك أحد ليتذكرنا، حتى ولو بشكل باهت، فإن بعض الأماكن سوف تتذكرنا. للأمكنة ذاكرة. إنها تتذكر كل شيء. ستكون محفورةً على الحجر. إنها أعمق من المياه الأكثر عمقاً. الذكريات ستكون أشبه بالكثبان الرملية، تهيم بغير انقطاع.
أظن لهذا السبب أنا ألتقط صوراً للأماكن. لا أريد أن أسلّم بها جدلاً. أريد أن أطلب منها بإلحاح ألا تنسانا.
وأريد أن أستحثكم بألا تنسوا هذه القدرة النفيسة الممنوحة لنا: لحل شفرة القصص التي يمكن للأماكن أن ترويها لنا.
وإلا فسوف نصبح جميعاً ضحايا للفقد.. فقدان ما هو فذ، ما هو محدد، ما هو جلي، ما هو متجذر بعمق.. باختصار، أحلامنا.
ما تُعرف بـ "الثقافة العالمية" هي ليست إلا امتداداً لفقدان الهوية إلى بقية أنحاء العالم.
نحن جميعاً نعاني، في هذا القرن 21، من الكمية الهائلة للصور والقصص القابلة للمبادلة، والانسحاب من التجربة المستقاة من المصدر الأول.
هذا يفضي، ببطء لكن بثبات، إلى فقدان الإحساس بالواقع، وفقدان الإيمان، مرةً أخرى، بقدرة القصة على سرد الأماكن.
وفقاً للسكان الأصليين في أستراليا، الأماكن تموت إن لم يحافظوا على بقائها، كذلك سنموت نحن معها..
وهم محقون تماماً.
نشرت هذه المحاضرة في نوفمبر 2003
*فيم فيندرز مخرج ألماني شهير، حقق عدداً من الأعمال الهامة في السينما العالمية: ألِس في المدن، الصديق الأمريكي، باريس تكساس، أجنحة الرغبة.

بين كل مرحلة عمرية وأخرى، من حياتي، أعود إلى "ألف ليلة وليلة" بنظرة مختلفة عن سابقتها، برؤية مختلفة، بوعي مختلف، بشغف مختلف، بروح مختلفة.. كأن الحكايات تكبر معي، أو تتحوّل معي.
كأني عابر زمن لا يجرؤ على خوض ينابيع الحكايات لأنه، في كل مرّة، لا يزال يفتقر إلى اليقين بشأن ما يسمع وما يقرأ وما يرى.
عندما وقع بين يديّ، مصادفةً، وأنا في المرحلة الثانوية، كتاب صغير اهترأت أوراقه واصفرّت أطرافه من فرط الاستعمال، يحتوي على عدد من حكايات "ألف ليلة وليلة"، مسّتني الدهشة والفضول، فها أنا أقرأ ما سمعته من جدتي من حكايات في صيغتها الشعبية المبسطة، وما شاهدته من أفلام هوليوودية مقتبسة من قصص الليالي العربية.
مع تلك الحكايات، عشت أجواء السحر والمغامرة، مفتوناً بالسفر والحيل والتنكر والمكائد والحِكم والأمثال والمجازفات التي لا تنتهي. البحث عن مكامن الإثارة والتشويق كان المحرك الأساسي لشغفي بالحكايات في تلك الفترة من المراهقة.
لكن قيل لي أن ما قرأته من "ألف ليلة وليلة" مجرد نسخة مختزلة، مبسطة، معدّة للفتيان، وناقصة. هناك نسخة أخرى مؤلفة من صفحات أكثر، وحكايات أوفر، ومتع لا تضاهى.
كنت وقتذاك أبحث عن عمل بعد أن أنهيت المرحلة الثانوية، وفي الوقت ذاته أبحث عن كتب تشبع نهمي إلى القراءة والمعرفة. وجدت مجلداً يحتوي على أجزاء من كتاب "ألف ليلة وليلة".
كان ذلك أشبه بكنز.. نبعٍ لا ينضب.. كلما غرفت منه حكايةً تناسلت حكايات أخرى. تعرّفت على العديد من الشخصيات والمجازفات والمكائد والتحولات. أجواء ساحرة، زاخرة بكل ما يفتن ويسلب اللبّ. علاقات متشابكة. خيال مجنّح لا يقف عند حدود المنطق والعقل والتاريخ. كثير من العواصف، كثير من الرحلات، كثير من الجزر المجهولة، كثير من العوالم المتباينة التي تتعايش في ما بينها في وئام وانسجام، بحيث يتجاور - بتناغم مدهش - الواقع والخيال، التاريخ والأسطورة، العادي والخارق، المألوف والعجيب، الإنس والجن، الملوك والرعايا، البذخ والشظف، المحن والمباهج، وكثير من النساء، كثير من الفكاهة، كثير من الشعر، كثير من العشق.
بعد سنوات، علمت أن هناك نسخة من "ألف ليلة وليلة" سريّة وغير متداولة لأنها محظورة، محرّمة، مكبوحة، مخبأة، لأنها تحتوي على حكايات محورها العلاقات الجنسية، وتتضمن صوراً أو عبارات لا تحمل إيحاءات جنسية فحسب، بل أنها تستخدم، في السرد والوصف، لغة جنسية صريحة ومكشوفة، لكنها ليست فاحشة وإباحية بقصد إثارة الغرائز كهدف أساسي ووحيد، بل إن الكتاب ذاته صار يعد من بين أوائل الكتب الإيروسية في الأدب العالمي التي تمجّد الحب والرغبة الإنسانية، وتصور العلاقات الإنسانية في أنقى وأرقى تجلياتها، وأكثرها تعدداً وتنوعاً.
الحكايات التي نشأت وانطلقت من فم شهرزاد، الجميلة والذكية والفصيحة، بدافع أساسي وجوهري، هو محاولة إرجاء الموت ليلة بعد أخرى بسرد حكايات جميلة وممتعة وآسرة، وتزداد فتنة وتشويقاً ليلة بعد أخرى، كي تسحر الملك شهريار - الشغوف بالقتل - وتأسر اهتمامه وفضوله فيطلب المزيد منها ليلة بعد أخرى، حتى تخفت رغبته في القتل وتتلاشى، أضحت - هذه الحكايات - من روائع الأدب العالمي، وأكثرها شهرة وتأثيراً بعد أن تعدت الحدود الشرقية لتخترق تخوم الغرب وتسحر (تماماً كما فعلت مع شهريار) باحثيها ومفكريها ومبدعيها الذين راحوا يستلهمون منها قصصهم ولوحاتهم وموسيقاهم وأفلامهم. من بين المشاهير الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالليالي العربية، واعترفوا بتأثرهم المباشر بها، نذكر: فولتير، بورخيس، ماركيز. وقيل أن الواقعية السحرية، التي اشتهر بها أدب أمريكا اللاتينية، كانت مستمدة من "ألف ليلة وليلة".
وعندما أخرج السينمائي الإيطالي بيير باولو بازوليني فيلمه الشهير عن "ألف ليلة وليلة" كتب مقالة قيّمة يوضح فيها رؤيته وسبب إنجذابه للحكايات، وأترجم هنا فقرات من المقالة أراها مهمة، وتظهر طريقة فهم المبدع الغربي للكتاب. يقول بازوليني:
[ الاكتشاف الأول، أن الحكايات في "ألف ليلة وليلة" هي نتاجات سلسلة من مراوغات والتواءات القدر. القدر يولّد، في نمط مخفي، كل الحوادث المألوفة (ولادات، أعراس، وفيات). لكن أحياناً هو يستيقظ، يرسم لنا علامات مباشرة. إنه "يظهر"، وهذا يعد شذوذاً، خروجاً عن القياس. كل حكاية في "ألف ليلة" تبدأ بـ "ظهور" للقدر، والذي يُبدي نفسه من خلال الشذوذ، وكل شذوذ ينتج آخر. هكذا تنشأ سلسلة من الأشياء الشاذة، الخارجة عن القياس. وكلما كانت هذه السلسلة أكثر أساسية، ومعقودة بإحكام، ومنطقية، صارت الحكاية أكثر جمالاً.. وبالجمال أعني الحيوية، الانتعاش، البهجة. سلسلة الأشياء الشاذة دوماً تنزع إلى العودة إلى الحالة السوية. إن نهاية كل حكاية في "ألف ليلة" تتألف من "اختفاء" للقدر، والذي ينحدر نحو النعاس السعيد في الحياة اليومية.
إذن ما ألهمني في صنع الفيلم كان رؤية القدر وهو يعمل بخفّة، والمركّز على واقع مربك. أنا لم أكن أريد أن انزلق نحو سحر أو سوريالية (والتي يمكن العثور، في فيلمي، على بضعة آثار متفرقة منها غير أنها أساسية) لكنني أردت أن أقترب من اللاعقلاني بوصفه كشفاً عن الحياة التي لا تصبح ذات دلالة أو مغزى إلا إذا تم استنطاقها بوصفها "حلماً" أو "رؤيةً".]
لكن من الذي ألّف هذا الكتاب العجيب، المجهول المنبع والهوية والمصدر؟ كيف تم إنتاجه؟ من الذي صاغ وشكّل عوالمه الساحرة الأخاذة؟
لا أحد يعرف. لا أحد يعرف متى أنتج العمل، وضمن أي سياق، وأي ظروف، وأي حاجة، وأي ضرورة. وبأي عالم أو محيط خاصين يتصل هذا النص.
المرجّح، وهذا ما يتفق عليه الباحثون، أن هناك أكثر من مؤلف شارك في صياغته. وأنه مشروع جماعي شاركت فيه أجيال متعاقبة ومتعددة، تنتمي إلى جغرافيا ومناخات مختلفة، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إلى مؤلفين محددين، ذي جنسيات مؤكدة، في فترات معينة من التاريخ الإنساني.
إن أسماءهم جميعا ظلت مجهولة، ولا أحد يعرف حتى الآن هوياتهم، أو دوافعهم أو طموحاتهم. ربما هذه المجهولية جعلت مبدعي العمل بمنأى عن أي تدخّل خارجي، أو تأثير سلطة ما، أو تعريض الموهبة لمساءلة ما.
لقد جعلتهم هذه المجهولية، البريئة من الأنانية والغيرة والحسد والنفاق، يبدعون بإيمان وصدق وجمال وتواضع، إنطلاقاً من رؤية خاصة ترتكز على حرية الخلق والتعبير، مدفوعين بالإحساس بالرضا والإشباع، مكتسبين الحصانة والمناعة من هذه الحرية النقيّة. الآن،
أتساءل في فضول شديد، كيف سأقرأ "ألف ليلة وليلة" عندما أبلغ السبعين؟

كينجي ميزوجوشي هو واحد من المخرجين الثلاثة الكبار في العصر الذهبي للسينما اليابانية، ومع ياسوجيرو أوزو وأكيرا كوروساوا يمثل هؤلاء الدعامة الرئيسية لسينما أبدعت روائعها الكلاسيكية منذ الأربعينيات وحتى الستينيات.
ولد ميزوجوشي في 1898، ونشأ ضمن عائلة من الطبقة المتوسطة في مقاطعة هونغو بطوكيو. كان في السابعة من عمره عندما وقعت حادثتان ربما لعبتا دوراً محورياً بالغ الأهمية في نوعية الأفلام التي سوف يحققها مستقبلاً. في الحادثة الأولى، ثروة عائلته أصيبت بنكسة عندما قام الأب، الطموح أكثر مما ينبغي، بتبديد أموال العائلة في مشروع تجاري فاشل، مما أدى إلى انتقالهم إلى منطقة أساكوزا الأكثر فقراً. الحادثة الثانية، والتي نتجت عن الحادثة الأولى، عندما اضطرت العائلة إلى عرض أخته سوزو، البالغة من العمر 14 سنة، لمن يرغب في تبنّيها. وفي ما بعد، بيعت إلى أحد منازل الغايشا geisha .
الحب الشديد الذي كان ميزوجوشي يكنّه لأخته سوزو ولأمه التي توفيت عندما بلغ 17 عاماً، لم يكن يعادله سوى بغضه الشديد لوالده. إن عجز هذا الأب عن دعم ومساعدة عائلته أرغمت الإبن، الذي اتضحت إصابته بالتهاب المفاصل، والذي سوف يعانى من أوجاعه طوال حياته، على الاشتغال بحراثة أراضي بعض أقاربه. إنه من خلال تضحيات أخته سوزو استطاع ميزوجوشي أن يدرس الفن، ويصبح رساماً، ويخرج الأفلام في ما بعد، بدءاً من فيلمه "انبعاث الحب" (1923)
هذه الشخصيات والأحداث من فترة شبابه - النهوض أو الهبوط المفاجئ في المرتبة الطبقية، الشخصية السلطوية الذكورية الجائرة والمستبدة والتي تضلل نفسها، المرأة التي تعطي بلا أنانية وتضحي بنفسها من أجل الغير فلا تحصل في النهاية غير التدمير - أصبحت الأساس لأفلامه العظيمة: مرثية أوساكا، قصة زهرات الذهب الأخيرة، حياة أوهارو، سانشو، أوجتسو.
في هذه الأفلام يوظف ميزوجوشي ببراعة اللقطات المديدة، الكاميرا المتحركة، واللوحات التي تومض لتُظهر عبث الوضع الراهن الإجتماعي والفلسفي، خصوصاً في حالة اتصال ذلك بالمرأة.
أعمال ميزوجوشي الأولى تتألف أغلبها من مشاريع أنتجها الأستوديو، بالتالي لم تكن للمخرج الكلمة الأخيرة أو القرار الأخير، إذ لم يكن متحكماً كلياً في عمله، مع ذلك فقد عكست هذه الأعمال بعضاً من اهتماماته. كان تلميذاً للفن والأدب الياباني والغربي معاً، حقق أفلاماً مبنية على مصادر أدبية متباينة مثل حكايات هوفمان ومسرحيات يوجين أونيل والرسوم الهزلية. ومنذ العام 1936 مع فيلمه "مرثية أوساكا" بدأ يعتمد على مصادره الخاصة.. وقد صرّح قائلاً: "مع هذا الفيلم (مرثية أوساكا) صرت قادراً أخيراً أن أتعلم كيفية عرض الحياة كما أراها".
فيلمه "مرثية أوساكا" أسس نموذجاً للعديد من أعماله اللاحقة. أياكو عاملة تليفون شابة تصبح رغماً عنها عشيقة لرئيسها الذي يهدد بحبس والدها المختلس. ثم تجد نفسها مجبرة على الانحدار حتى تبدأ في ممارسة الدعارة لتعيل عائلتها الذين يصبون عليها اللعنات لكن لا يرفضون ما تقدمه لهم من عون مادي. ينتهي الفيلم بلقطة قريبة مروّعة للبطلة الجريئة.
التحفة الفنية الأخرى التي قدمها في العام نفسه، فيلم "شقيقات جيون" الذي من خلاله يستكشف، على نحو قوي ومعبّر، الإقليم الذي كان ميزوجوشي يعرفه من تجربته الشخصية: بيوت الغايشا في منطقة كيوتو.
فيلم "قصة زهرات الذهب الأخيرة" (1939) كرّس على نحو حاسم شهرة ميزوجوشي كمخرج مدافع عن قضايا المرأة. ممثل متخصص في الكابوكي يقع في غرام فتاة خادمة، لكن لا يدرك ما تؤديه من تضحيات بالغة، لتصنع منه ممثلاً عظيماً، إلا في نهاية حياتها.
هذا الفيلم يكشف عن تأثر ميزوجوشي (حسب اعترافه) بالمخرج فون شتيرنبرغ، خصوصاً في تكويناته التشكيلية، وطرائق توزّع الضوء والظل في اللقطة، وهي المؤثرات التي برع فيها ميزوجوشي آنذاك.
الفيلم أيضاً يحتوي على أحد المشاهد الأكثر إثارة للمشاعر والتي يستخدمها ميزوجوشي على نحو بارع: الخادمة التي تحتضر، مختبئة تحت خشبة المسرح التي يمثل عليها حبيبها، تصلي من أجل أن ينجح.
الفيلم يتحرك بعيداً وراء المازوشية التي يوحيها الوصف البسيط للحبكة. هنا وفي أعمال مماثلة، النقد الاجتماعي القوي يشكّل الأساس للدراما.
ميزوجوشي، اليساري الحساس و"مخرج المرأة"، كان أيضاً ذلك الذي يسعى إلى بلوغ حد الكمال وجعل عمله خالياً من العيوب والشوائب، لذلك كان مستبداً في الموقع. من القصص التي تُروى عنه، والتي هي ربما مشكوك في صحتها، تلك التي تتعلق بفيلمه "مضايق الحب والكراهية"(1938) حيث أرغم الممثل فوميكو ياماجي أن يتدرب على أحد المشاهد سبعمائة مرّة. أما كينويو تاناكا، وهي الممثلة المفضلة لدى ميزوجوشي، وواحدة من أعظم ممثلات السينما، فتتذكر بلا حقد أو ضغينة كيف أنه أجبرها أن تقرأ عملياً محتويات مكتبة كاملة من أجل التحضير لدورٍ ما. الموثوقية كانت واحدة من الأشياء التي لم يكن مستعداً التنازل عنها، وأفلامه التاريخية كانت بوجه خاص موضع تقدير واعجاب الجمهور الياباني بسبب دقتها في التفاصيل التاريخية.
في فترة الأربعينيات، وجد ميزوجوشي نفسه مرغماً على تحقيق أفلام تتلاءم مع توجه الحكومة للدعاية للنظام ومنجزاته. لذلك اتجه إلى إقليم الساموراي، الفاقد لأي صفة مميزة، بأفلام مثل: 47 محارباً مخلصاً (1942) مياموتو موساشي (1944) السيف المشهور (1945).. العديد من هذه الأعمال كانت ناجحة جماهيرياً إلى حد يكفي لكي يكررها في ما بعد، كما في فيلم "حكايات عشيرة تايرا" (1955). لكن حتى في الأعمال الوطنية هو رفض التخلي عن اهتماماته، لنقل هواجسه، ومن بينها ما تتعرض له المرأة من كبح وقمع واضطهاد. أفلام مثل: انتصار النساء (1946) نساء الليل (1948) هي أعمال منشطة للجدل وفي الوقت نفسه دراما موجعة عاطفياً.
حصل ميزوجوشي على الشهرة العالمية بعد أن حاز فيلمه "حياة أوهارو" (1952) على جوائز عديدة في اليابان وأوروبا، وهو عمل يدور في مرحلة تاريخية قديمة، عن ابنة أحد فرسان الساموراي، تدعى أوهارو، تعيش في القصر الإمبراطوري. بعد أن تقع في غرام رجل من الطبقة الأدنى، يقومون بنفيها وقتل الرجل. من هنا تستحيل حياتها إلى كابوس مروّع حيث تحاول أن تقتل نفسها، ثم تصبح عشيقة رجل غني من طبقة النبلاء، بعدها تتحول إلى محظية ثم خادمة وأخيراً تعاني من الفقر الشديد وتصبح عاهرة مقعدة. إن ميزوجوشي يضع بطلته في حالة من الفوضى تسببها قوى اجتماعية وتاريخية، وتبلغ ذروتها في محاولتها، التي تسجلها كاميرا متحركة برشاقة، لاستعادة ابنها الذي أنجبته عندما كانت عشيقة الرجل النبيل، هذا الابن الذي بدوره يصير غنياً وصاحب نفوذ.
أفلام ميزوجوشي، من أواخر الأربعينيات وحتى آخر أعماله "شارع العار" (1955)، تشمل مجموعة من الأعمال التي لا تُضاهى في عالم السينما.. أعمال رائعة وملفتة تتسم بكمال الميزانسين وخلوه من العيوب، وتتميّز بفتنة الصور، والنقد الإجتماعي، وأحياناً بالكثافة العاطفية الغامرة.
في حين أن كوروساوا يحقق مشاركة الجمهور من خلال المونتاج واستخدام اللقطات القريبة، كان ميزوجوشي يتجنب الشيئين ليخلق حالة أقوى من خلال الإضاءة، وضعية الكاميرا وحركتها، والتلاعب غير الاعتيادي بالممثلين ضمن الكادر.
في لحظات الأزمة، تكون الكاميرا عادةً على بُعد مسافة حذرة، كما لو أن المشاعر التي تختبرها الشخصيات هي حادة وكثيفة أكثر مما ينبغي بحيث لا يمكن تسجيلها.
في المشهد الختامي الشهير من فيلم "سانشو"، على سبيل المثال، الشاب الذي سبق بيعه كعبد، يلتقي أخيراً على الشاطئ بأمه التي تعرضت للاغتصاب، وصارت مقعدة ومهجورة. وميزوجوشي ينهي هذا اللقاء المؤثر بلقطة مأخوذة من كاميرا مثبتة على رافعة crane والتي ترتفع عالياً بحيث يبدو الاثنان ضئيلين.
إن المآسي التي تختبرها شخصياته هي محتومة بفعل القدر من جهة، والطبيعة البشرية الممعنة في الضلال، ولا سبيل إلى إصلاحها أو تغييرها.
إن قدرة ميزوجوشي على انتزاع المشاعر المكثفة من أصغر الإيماءات هي بيّنة طوال أحداث فيلم "أوجتسو"، خصوصاً عندما يزور الصبي قبر أمه، التي تعرضت للاغتصاب والقتل، ويضع عليه طبقاً من الرز. بعد انحناءة بسيطة ترتفع الكاميرا المحمولة بالرافعة وتبتعد. هذا المشهد ينجح في التأثير بسبب رفض ميزوجوشي إضفاء صبغة وجدانية عليه وعلى أيّ من الأحداث التراجيدية التي سبقته.
في العام 1956 توفى ميزوجوشي، بعد سنوات قليلة من إحرازه الشهرة العالمية. في فيلمه "أوجتسو" رأينا روح المرأة الميتة تقود الزوج الآثم، الذي يسمع صوتها الحزين لكن الملهم فيما هو يصنع آنية فخارية.
صوت ميزوجوشي يمتلك النوع نفسه من الرنين الروحي، ومثل المرأة في "أوجتسو"، صوته يسمو فوق موته.
************
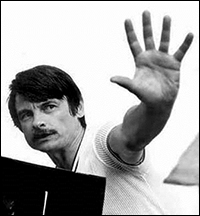
معروف عن أفلام أندريه تاركوفسكي Tarkovsky أنها مغمورة بما يسميه هو "المناخ الحلمي" – التأثير الشبيه بالحلم – الذي يقاوم حاجة الجمهور إلى التأكد من صحة منطق ومصداقية الأحداث المعروضة على الشاشة.
لقد نجح تاركوفسكي، بالذات في "المرآة" The Mirror (75- 1978) و Stalker (1980)، في التعبير عن أحلام اليقظة بشأن الماضي والمستقبل من خلال وسائل سينمائية خالصة: متمماً التعبير الشفهي بواسطة وسائل سمعية بصرية، هو ينجز التنسيق الحركي الذي تتم تجربته على مستوى المحرّك الحسي، غالباً بسبب حركة الكاميرا المتواصلة، اللحوحة، عبر الفضاء.
بدلاً من التحكم في اهتمام المتفرج عن طريق القطع من صورة إلى أخرى، يؤكد تاركوفسكي على الطبيعة المؤقتة أو الزائلة للواقع، والذي بواسطته هو يتخطى الدلالة المألوفة والاعتيادية للمواد الملموسة من أجل بلوغ شيء تهمله العين المجردة وتستخف به، أو يبدو غريباً وغير مألوف عند النظر إليه وملاحظته.
على الرغم من كل المعاني المتضمنة، الاجتماعية وتلك المتصلة بالسيرة الذاتية، فإن "المرآة" هو فيلم حلمي بامتياز، يعكس ما يتذكره مبدعه عن مرحلة شبابه، بينما فيلمه Stalker – الذي يُقرأ عادةً كفنتازيا تنتمي إلى الخيال العلمي – هو حدس هذياني عن عالم "يمثل واقع حياة الفنان الباطنية" (كما يقول تاركوفسكي في كتابه "النحت في الزمن").
في هذين الفيلمين، تنفيذ اللقطات، خصوصاً كثافتها الحركية، هو الذي يجعل الأشياء أو الأحداث، المعروضة على الشاشة، تبدو متخيلة وواقعية معاً. إن معالجة تاركوفسكي للقطات المصاحبة tracking وتفاعلها مع الحركة ضمن اللقطة، إضافة إلى المعالجة اللونية للصورة، تتعارض مباشرة مع التضارب الإيزنشتايني (نسبةً إلى إيزنشتاين) الذي ينتجه تجاور لقطات ساكنة. في كتابه "النحت في الزمن" يعلن تاركوفسكي على نحو صريح أن: "الصورة السينمائية تنشأ أثناء التصوير وتوجد ضمن الكادر، بينما المونتاج يوّحد معاً لقطات كانت ممتلئة بالزمن".
بالنسبة لتاركوفسكي، مفهوم الزمن هو المظهر الأكثر أهمية في وسط الفيلم لأنه "متأصل في السينما ومتضمن في صلبها.. إنه ينبض عبر أوردة الفيلم وشرايينه، ويجعله حياً من خلال ضغوطات إيقاعية متعددة" (النحت في الزمن).
هذا يؤكد محاولة المخرج لإثارة استجابات عاطفية، غالباً ما تكون عميقة جداً، عند المتفرج، بدلاً من إطلاق أفكار مقصود منها أن تدعم موقفاً خاصاً تجاه المجتمع والتاريخ. نجد مثالاً واضحاً لهذا في استخدامه الأشرطة الوثائقية من الأرشيف (مثل: عبور الجيش الأحمر لبحيرة سيفاش في فيلمه "المرآة") التي، من خلال الضغط الإيقاعي، تولّد شعوراً كابوسياً: مفرطاً في التعريض للنور وذا حركة سريعة. الشريط الحقيقي، الموثوق به، يُرى كـ "مسعى فوق بشري للحظة تراجيدية في التاريخ، بالتالي يصبح المركز، الجوهر الفعلي، قلب فيلمي وعصبه" (النحت في الزمن).
هكذا، الدلالة التاريخية للشريط الوثائقي، الذي تم العثور عليه، تتحول إلى رؤية ذاتية لوقائع حقيقية حدثت في الماضي، وتمت تجربتها كرؤية موجعة ونوستالجية معاً للتاريخ.
الميزة الهامة في الصورة الحلمية عند تاركوفسكي هي أن لقطاته لم تكن قط محرفة عن مظهرها التصويري، لكن في الوقت ذاته، الصورة المعروضة تبدو غريبة، معالجة على نحو غير مباشر من أجل تشتيت المعنى "الدرامي" للحدث، في حين يجعل المتفرج متورطاً مع المعاني المتوارية أسفل المستوى السردي. في حثه للمتفرجين بأن يبحثوا عن شيء وراء الصورة كمماثل للواقع، متيحاً لهم أن يفكروا ملياً في الأحداث/ الأشياء المقدمة، فإنه يشاركهم في تأملهم الخاص في ما يرونه على الشاشة. التحليل الدقيق لمشاهد الذروة في كلا الفيلمين يُظهر أنهما يحتويان الكثير من المظاهر المميزة لعملية الحلم.. كغرابة الحالة، الحركة الجسمانية القوية، الرؤية الخارجية المعتمة (إلغاء تخوم الصورة)، استخدام المؤثر الذي يجعل الصورة تومض ثم تخبو (النبض الضوئي)، التغيير غير المتوقع للنسق اللوني، الانقطاع الزماني- المكاني، التحريف التصويري للأشياء، الحركة المتباطئة، البؤرة المتموجة (التضبيب).. كل هذا يسهم في قبول الأحداث الغريبة، غير العادية، التي تدور على الشاشة.
على سبيل المثال، لو أن الجص الموجود في السقف يبدأ في التحلل والسقوط، بحركة بطيئة، على الشخصية (كما في فيلم "المرآة")، أو أن المادة السائلة تبدأ في الانهمار على الشاشات الموضوعة عمودياً في الخلفية (كما في فيلم stalker) فإن المتفرج يكون مجبراً على البحث عن معنى محجوب أو خفي لمثل هذه الحالات الشاذة.
كما سبق توكيده، تاركوفسكي يجد التوازن بين الموثوقية الوجودية لصورة الفيلم وانحرافها الظاهراتي، الذي يساعد صوره الحلمية في تخطي "لغة" الفيلم كنظام من العلامات، واصلاً إلى مستوى التجريد السمعي البصري. بالتالي، التجربة الحركية السينمائية الفذّة تعوق التأويل التحليلي النفسي للحدث المصوّر: بينما هو مثير للاهتمام من غير ريب، مثل هذا التأويل لا يفتقر إلى البرهان التحليلي فحسب بل هو أقل كشفاً من التجربة الفعلية للمزاج الحلمي الذي تنتجه الوسائل السينمائية الخاصة وعلاقتها بالمظهر الموضوعاتي للمشهد.
هناك نوعان من الحركة في "المرآة" و stalker: المسار الجانبي للكاميرا بينما الشخص يهيمن على صدر الصورة القريبة، والحركة التجريدية جزئياً (المضببة) تحدث في الخلفية البعيدة، والكاميرا تنسل عمودياً على أشياء الطبيعة. إن أغلب اللقطات في الجزء الأول من stalker (بعد المقدمة) منفذة بحركة مصاحبة جانبية، مرافقة (عن قرب) الشخصيات الثلاث (المقتفي أو الدليل والكاتب والعالِم) في رحلتهم إلى مركز المنطقة The Zone. هنا الكاميرا تتخيّل شكل الأشياء التي ستوجد من خلال منظر طبيعي خارج البؤرة والذي يُرى خلف رؤوس الثلاثة في مقدمة الصورة (غالباً مع مؤخرة الرأس وهي تواجه الكاميرا) إلى حد أن الجزء غير الواضح من الصورة يصبح معبّراً أكثر من الجزء الواضح. بالنتيجة، الخلفية المضببة تهيمن على الشكل البشري في مقدمة الصورة، كما لو تحكم حصارها على الشخصيات التي تصبح كسولة أكثر فأكثر، محدّقة في الفضاء الخالي، مصابة بخيبة أمل مما صادفته في المكان الذي بحثوا عنه فترة طويلة.
ينبغي على المرء أن يعي الإختلاف بين حركة الكاميرا الجانبية عند تاركوفسكي، وحركة الكاميرا المصاحبة الموازية عند جودار كما وظفها في فيلمه "أراك عند ماو" See You at Mao (1969)، حيث الكاميرا تتحرك عبر صف لا نهائي من السيارات المتوقفة، بينما العمال يقومون بحركات آلية متكررة، أو كما في فيلم "كل شيء على ما يرام" Tout va bien (1972) حيث الكاميرا تتحرك أمام عدد لا يحصى من أمناء الصندوق في سوبرماركت، في موازاة مع اندفاع ضاج لعمال مضربين يدمرون المحل.
إن وظيفة حركة الكاميرا عند جودار هي من أجل تكثيف الفعل الجسماني الذي يحدث أمام الكاميرا، لغايات أيديولوجية، في حين أن كاميرا تاركوفسكي تخترق الحقائق البيئية، إنطلاقاً من إيمان المخرج بأن الكاميرا قادرة على اكتشاف الدلالة الخفية للعالم المادي.
من جهة أخرى، لقطات تاركوفسكي المديدة أيضاً تختلف دلالياً عن لقطات الهنغاري ميكلوش يانشو Miklós Jancsó في فيلميه "ريح الشتاء" Winter Wind (1969) و "الترنيمة الحمراء" The Red Psalm (1972) حيث حركة الكاميرا تصف – ضمن شروط إيقاعية – أحداثاً طقسية مرسومة على نحو راقص أمام الكاميرا مع اهتمام سياسي صريح. أما حركة كاميرا تاركوفسكي فتعكس – ضمن شروط سينمائية – النبض الإيقاعي المخفي تحت المظهر الخارجي للواقع، محدثاً استجابة عاطفية قوية، إضافة إلى التأمل.
في "المرآة" كل اللقطات المصاحبة تقريباً تحيل إلى نفسها، خصوصاً عندما تكون الحركة ضمن الكادر متباطئة، كما في اللقطات المصاحبة للعشب، الشجيرات، وأوراق الشجر، لتنتهي على الطاولة مع قطعة من الخبز، وحامل الشموع ينقلب بلطف بفعل الريح (كإيماءة شعرية، اللقطة ذاتها تتكرر مرتين في مواضع حاسمة). بل أن الحركة الأكثر فتنة هي حركة الكاميرا الأمامية وهي تتابع الشاب أليكسي فيما هو يدخل (بالحركة البطيئة) البيت القديم ويمر من خلال الستائر الشفافة، الطافية، قبل أن يصل إلى المرآة العتيقة حيث يواجه الفتى انعكاسه الوهمي. طاقة حركة كهذه تؤثر في وجهة نظر المتفرج: لأن الكاميرا تنتحل وجهة نظر الفتى الذاتية فإن هذا يجلب المتفرج وحده إلى سطح المرآة. الجمهور يختبر التأثير التغريبي في ما يتصل بالصورة المنعكسة، والحدث كله يبدو غريباً.
في الوقت نفسه، تأثير هذا والحركات المماثلة هو حسي وعاطفي في آن، حيث إيقاع الحركة المصاحبة إما يكون متزامناً أو غير متزامن مع إيقاع النص المنطوق، والمصاحبة الموسيقية، والمظهر الموضوعاتي للحدث.
فيلم "المرآة" يُفتتح بلقطة عامة لحقل فسيح، يُرى من وجهة نظر امرأة جالسة على سياج خشبي، بينما في نهاية الفيلم، الكاميرا تتحرك ببطء عبر غابة مظلمة أشجارها على نحو متزايد تحول دون رؤية الحقل البعيد الذي رأيناه في بداية الفيلم.
فيلم stalker يعرض علاقة مختلفة بين إيقاع افتتاحية الفيلم وخاتمته: إنه يبدأ (بعد أسماء العاملين) بحركة كاميرا أمامية عبر المدخل الضيق لغرفة نوم البطل (ذات الجدران المعتمة المصممة على نحو مهيب)، بينما ينتهي بلقطة ثابتة لابنة البطل وهي تميل بحزن على الطاولة. في الحالة الأولى، ركود الافتتاحية يتوقع الحالة النفسية الكئيبة للفيلم كله، بينما حركة الخاتمة تعزّز الطبيعة النوستالجية للذكريات. في الحالة الثانية، الحركة الاستهلالية تنبئ بالرحلة الغامضة، بينما النهاية الساكنة (بؤرة الكاميرا مركزة على النافذة الموصدة) هي تقريباً تصوّر حرفي لطريق غير نافد.
الحركة البطيئة، المستخدمة عادة في السينما السردية لجعل الحدث الزائد يبدو جذاباً بصرياً (والموظفة في أغاني الفيديو الشعبية على نحو مبتذل ورخيص)، في أفلام تاركوفسكي هي تتخذ الوظيفة التي حددها فسيفولود بودوفكين Vsevolod Pudovkin قبل أكثر من نصف قرن بوصفها "لقطة قريبة للزمن". كلما تباطأت الحركة على شاشة تاركوفسكي، اكتسب الحدث تأثيراً عاطفياً قوياً، خصوصاً في الذكريات النوستالجية، الكوابيس، والتخيلات (كمثال، الطيور المحلقة في فيلم "المرآة").
الحركة المتباطئة هي اللب العاطفي للصورة الحلمية عند تاركوفسكي، والتي في لحظات الذروة تنجز ما تسميه مايا ديرين Maya Deren "الإختراق/ الإستنطاق العمودي" للموضوع المصوّر، جاعلة المتفرج يعي مرور الزمن وضغوطاته الإيقاعية. لاختبار كل هذا، يتعيّن على المرء أن يبحث وراء المعنى السردي للقطة، بما أنه يوجد أسفل المظهر التمثيلي للصورة حيث يمكن العثور على طبقات عديدة من المغزى الخارق الذي يوصف. بناء على ذلك، "المرآة" و stalker يتخطيان المعنى الفرويدي لصور الحلم، ذلك لأنها لا تعمل كرموز كامنة أو مستترة بقدر ما هي تساهم في التجربة اللاواعية لعالم الحلم.
اللقطات المصاحبة tracking الطويلة هي ليست فقط المصدر الوحيد للمناخ الحلمي السينمائي عند تاركوفسكي، فالحالة النفسية المرادفة، الشبيهة بالحلم، تولّدها اللقطات (المحدّقة) الساكنة التي تصوّر الحدث، المتجرّد من البعد الدرامي، كما في اللقطة المديدة، ما قبل الأخيرة، في فيلم stalker عندما يجلس الرجال الثلاثة مسمرين في إحدى غرف المنطقة zone شاعرين بخيبة أمل مع إدراكهم بأن المكان الذي بحثوا عنه طويلاً ليس هو "المكان الذي تتحقق فيه رغبات البشر الصادرة من القلب".
فيما هم يفكرون بقنوط في مغامرتهم، تقع حولهم سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، مع ذلك تظل وراء متناول العالم الخارجي: الزمن يتوقف، في حين أن "الضغوطات الإيقاعية" الداخلية تُظهر نفسها عبر تراجع حاذق جداً للكاميرا الموضوعة في زاوية منخفضة قليلاً والتي تجذب انتباه المتفرج إلى الفضاء خارج الكادر: ما إذا كانت المساحة فوق الرجال الجالسين مسقوفةً, إلى أي مدى يكون تغيّر تكوين اللقطة – المتزامن مع التغييرات اللونية المستمرة – مبنياً على الدافع الجدير ظاهرياً بالتصديق (اللقطة تفتتح كصورة لونية والتي تدريجياً تتغيّر إلى لون بنّي داكن لتنتهي كصورة بالأسود والأبيض)؟ عندما يبدأ المطر، على نحو غير متوقع، في الهطول في مقدمة الصورة (مصحوباً بصوت مضخّم للقطرات وهي ترتطم بالمياه) مشكّلاً دائرة تومض على سطح البركة، كما لو تعكس أشعة الشمس اللامرئية، فإن الصورة تأسر المتفرجين بصرياً وسمعياً: غير معنيين بشأن لا احتمالية الحدث، هم – إضافةً إلى شخصيات الفيلم – يشعرون بالشلل بفعل "الطاقة الغامضة" المنبعثة من المنطقة (zone).
المرء هنا لا يستطيع أن يستبعد فكرة اعتماد تاركوفسكي على حدث مدمر حقيقي حين وقعت كارثة في العام 1957 في منطقة قريبة من شيليابنسك على إثر انفجار كيماوي لم يعلن عنه رسمياً.
الصورة الحلمية الأكثر إفتاناً في stalker هي على الأرجح تلك التي نجدها في "غرفة الكثيب"، في تلك المنطقة المحظورة، المغطاة أرضيتها بأكوام من الرمال. كل ما يحدث في هذه الغرفة مرئي بوصفه "لقطة قريبة للزمن".. أي، الحركة بالتصوير البطئ. عند موضع معيّن، طائران أسودان يدخلان الشاشة من اليسار ويحلّقان في اتجاه الطرف الآخر من الغرفة. مباشرةً قبل وصولهما إلى الجدار (المضاء بشكل ساطع) يختفي الطائر الأول (عبْر حيلة بصرية) فيما الآخر يحط بشكل طبيعي على الكثيب الرملي، محدثاً سحابة من الغبار المتموّج ببطء. أغلب المتفرجين، المفتونين بصرياً، أبدوا حيرتهم إزاء حقيقة ما حدث على الشاشة – أو ما إذا كان قد حدث ذلك بالفعل – وشعروا برغبة تلقائية في مشاهدة اللقطة مرة أخرى. مثل هذه الإيماءة الإخراجية تكثّف الغموض الهذياني عبْر اندماج المظهر التصويري للحدث والتنفيذ السوريالي للقطة. إن تكوين الصورة، تقلّبها اللوني الذي يدوم فترة طويلة، إضافة إلى "غرابة" البيئة (الطائر الذي يختفي، الحركة البطيئة للغبار الذي يطفو فوق الأرض، التصميم الشاذ للغرفة) لا تعكس حالة الشخصيات فحسب، لكن أيضاً تستفز في المتفرج تجربة ناشئة عن هذيان.
في فيلم "المرآة"، التأثير الشبيه بالحلم يتحقق بواسطة اللقطات المصاحبة tracking التي تتابع ليزا، صديقة ماشا، وهي تجري عبر الرواق الطويل (سعيدة لأنها تحررت من الخوف الذي استبد بها من جراء خطأ في تهجئة اسم ستالين أثناء تنضيد الأحرف الطباعية في الجريدة.. هذا الخطأ الذي اكتشفته ماشا). وبينما هي تتقافز فرحاً أثاء جريها، الحركة تتباطأ قليلاً خالقةً الوهم بأن جسدها يطفو في الهواء. التأثير السوريالي يحدث في المكان المناسب (بالحس الموضوعاتي/ السردي) متزامناً إيقاعياً مع إحساس المرأة بالإبتهاج، وبذلك يوازي حالة التذكّر السائدة في المشهد. في مرات أخرى، غالباً في المشاهد الداخلية، يرتب تاركوفسكي الأشياء والممثلين ضمن الكادر بطريقة فيها الميزانسين يتحدى القوانين الفيزيائية إضافةً إلى المصداقية المعتادة. في اللقطة التي تُظهر أم إجنات Ignat وهي ترتفع في الهواء، نلاحظ بأن أجزاء اللقطة، التي في ظرف آخر قد توفّر مفاتيح منظورة ومدرَكة للحيلة البصرية، تكون ممحية بواسطة الإضاءة وتأطير الكادر وحركة الكاميرا. المتفرج، الأعزل من أي إدراك حسّي، يكون مغموراً في تكوين الصورة، قابلاً الصورة، على نحو غريزي، كتخييل لعالم الشاب الداخلي، المحب لأمه.
تاركوفسكي يوجّه عناية خاصة إلى شيئين يثيران دوماً اهتمام السينمائيين الكبار: المنظر الطبيعي، والوجه الإنساني. بالنسبة له، الكاميرا أداة استكشاف مؤهلة لأسر روح اللحظة، فوراً وعلى نحو نابض بالحياة، بدقةٍ فوتوغرافية، بحيث تصبح مشاعر الجمهور مماثلة لمشاعر شاهد، إن لم تكن مشاعر المبدع نفسه. لتحقيق ذلك، غالباً ما يلجأ تاركوفسكي إلى تعديل المظهر الطبيعي للمنظور أمام الكاميرا وفي مرحلة ما بعد الإنتاج أيضاً، لكن من دون إرباك الموثوقية الوجودية للصورة السينمائية. هكذا نرى، في لقطات الإفتتاحية لفيلم "المرآة"، حقلاً فسيحاً من الحنطة السوداء تلاطفها، على نحو إعجازي، هبّة ريح. إنه المنظر الذي، حسبما يصرّح تاركوفسكي، "بقي في ذاكرتي كأحد التفاصيل الأساسية والمميّزة في طفولتي".
إن التدخّل الجلي لصانع الفيلم (الهبوب المفاجئ للريح ثم انقطاعها المفاجئ) يكشف "بصرياً وفورياً" الذبذبة المرافقة لذاكرة المبدع العاطفية. في فيلم stalker، وفيما تتقدم المجموعة عبر منطقة ريفية مهجورة، تكوين اللقطات التي تصوّر المنظر الطبيعي يصبح مكتظاً على نحو متزايد بالتفاصيل في مقدمة الصورة، والتي تهجس بالقلق والحصَر النفسي الذي سوف يختبره الرجال الثلاثة في مركز المنطقة ((zone.. وهذا يستجيب إلى استنتاج تاركوفسكي بأن الفن يجب أن يتخطى، وليس مجرد أن يسجّل، العالم الخارجي. الكاميرا، بالنسبة له، أداة تستكشف وتتحرى أكثر مما ترصد وتلاحظ.
في إشارته إلى لوحة ليوناردو دافنشي التي تظهر في فيلمه "المرآة"، يؤكد تاركوفسكي أن سبب قوة اللوحة الشهيرة التي هي عبارة عن بورتريه لإمرأة "راجع تحديداً لأن أحداً لا يستطيع أن يجد فيها أي شيء قد يفضّله بوجه خاص، ولا يستطيع أن يفرد أية تفصيلة عن الوحدة الكليّة... لذلك هي هناك تفتح أمامنا إمكانية التفاعل مع اللامتناهي".
هو يتقيّد بالمبدأ نفسه بينما يعرض الوجه الإنساني على الشاشة: نابذاً التعبير الوجهي كوسيلة لتوصيل الأفكار، فإن تاركوفسكي يحاول "الوصول إلى المشاعر الأعمق والأوغل، ليذكّرنا ببعض الذكريات والتجارب الغامضة، الخاصة بنا، فيغمرنا، ويحرك أرواحنا مثل كشفٍ يستحيل تأويله بأية طريقة".
هذا الموقف يتصل بمفهوم الصورة كما حددها لوي ديلوك وجان إبشتاين في العشرينيات من القرن الماضي بوصفها المقوّم الفذ للوسط السينمائي. وكانا يريان بأن الكاميرا تمتلك القوة القادرة على استخلاص الكثافة النفسية –العاطفية من الوجه الإنساني.
العديد من اللقطات القريبة للممثلة مرجريتا تيريكوفا (في فيلم المرآة) تبدو جميلة على الشاشة على نحو يفوق الوصف، خصوصاً عندما تدير عينيها نحو العدسات: تحديقتها اللطيفة لكن الثاقبة يمكن مقارنتها بالتحديقة النافذة التي توجهها سيلفانا مانيانو نحو المتفرج في فيلم بازوليني "أوديب ملكاً" (1967) عندما ترضع ابنها المولود حديثاً في الحقل الخالي. مثل بازوليني، تاركوفسكي يوظف تحديقة الممثلين لتأسيس اتصال مباشر بين مشاعرهم الشخصية والحميمة، والإدراك الحسي الغريزي عند المتفرجين. الطريقة التي بها يصوّر هذان المخرجان الوجه الإنساني في لقطات قريبة تتجاوز الإستخدام المألوف والمعتاد للتحديقة في السينما السائدة كأداة لتوصيل رسائل منطقية وعقلانية. عوضاً عن ذلك، التحديقة عندهما تعني تكثيف تواصل المتفرجين مع العالم الداخلي للشخصية.
الدلالة الظاهراتية لرؤية تاركوفسكي الحلمية تتكئ على التفاعل بين التمثيلي والسوريالي: المتفرج يشعر بأن شيئاً ما "خاطئاً" بشأن الطريقة التي تبدو فيها الأمور على الشاشة، لكنه غير قادر على اكتشاف "برهان" كافٍ لتكذيب الأحداث المقدمة على أساس المنطق اليومي. نتيجةً لذلك، اللقطة تكون "مقصيّة" شعرياً في التقليد الأفضل للشعراء الشكلانيين والفنانين البنيويين الروس المشاهير، الذين أصروا على ضرورة أن يكون المتفرجون واعين دائماً في اختبار العمل الفني كتحويل أو كترجمة ذاتية للواقع. في هذا الموضع يكمن إختلاف الصورة الحلمية عند تاركوفسكي عن الصورة عند بيرجمان: في "الفراولة البرية" WILD STRAWBERRIES ، على سبيل المثال، مشاركة بطل بيرجمان كرجل عجوز في أحداث شبابه لها دلالة حلمية موضوعاتية على نحو صريح بالتباين مع بطل تاركوفسكي في "المرآة"، الذي يصبح جزءاً من الحالة الحلمية التي تحركها الطريقة التي بها تُعرض الأشياء على الشاشة، وليس بما تعنيه.
في أحد المشاهد، الشاب إجنات يظهر في الحجرة مع امرأتين تختفيان، على نحو يتعذّر تفسيره، في اللقطة التالية. على الرغم من عنصر المفاجأة، هذا التنافر الظاهراتي ليس شبيهاً بالحلم كما هو الحال مع اللقطة القريبة اللاحقة للبقعة المبتلة التي جفت على الطاولة حيث كانت المرأتان جالستين قبل لحظات. البنية التصويرية للسطح اللامع، الرسم المتموّج للبقعة، الضوء المتغيّر واللون، كل هذا يجعل اللقطة القريبة تبدو محيّرة بطريقة مماثلة للومضة الخاطفة للهب مصباح الغاز القديم الذي يراقبه إجنات فيما يمرّ بحالات لونية متنوعة وهو في طريقه إلى الإنطفاء. إن تركيز الكاميرا الموجع على التغيّرات البطيئة لبنية الإضاءة له تأثير هذياني على المتفرج، الذي يبدأ في إدراك الظاهرة العادية بطريقة مختلفة تماماً: التركيز غير العادي على المظهر البصري للعملية الطبيعية (الصمت لا يُقطع إلا بطقطقة متكررة للهب يخمد) يلغز الحقيقة الشائعة، خالقاً جواً غريباً ومخيفاً.
الغموض المعرفي للقطات تاركوفسكي مقصود منه تحويل انتباه المتفرج من المعنى التمثيلي للحدث المسجّل إلى المعنى الواقع وراء نطاق الخبرة، حتى عندما لا يتعامل الفيلم صراحةً مع محتوى الحلم. في STALKER بعض من أكثر اللقطات سحراً وفتنةً، المشبّعة بحالة شبيهة بالحلم، تنتجها وسائل تصويرية محضة، والتي كلها "تعكس" الذهنية المحبطة للشخصية.. التحويل النفسي لرغبة الشخصية في الهروب من شيء جائر ومستبد إلى شيء يوفّر الحرية.
من بداية الفيلم، التنفيذ السمعي- البصري للقطات في الحانة (التي جدرانها تبدو أشبه بنقوش تجريبية نافرة وهائلة) يمنع النزعة التلقائية عند المتفرج لقراءة الصورة فقط بوصفها تمثيلاً للواقع. عوضاً عن ذلك، هذا التنفيذ يدعو المتفرج إلى غمر نفسه في الإيقاع الواهن للفعل ومحيطه، متماهياً مع العالم الهذياني الذي فيه تجد الشخصية الأمان الروحي.
المتعقب STALKER ، الذي يقتفي ويسعى، يقرّ لفظياً بنيّته على الإنتقال، مع زوجته وابنته، إلى المنطقة ZONE من أجل "العيش في أمن وسلام، حيث لا أحد يستطيع أن يؤذينا". لكن آماله تتلاشى ما إن يصل، هو ورفيقاه، إلى الغرفة المركزية التابعة للمنطقة: الكاميرا هنا تصبح ساكنة، كما لو واقعة في شرَك فضاء عدائي، بينما الشخصيات تتحرك بلا هدف (في الأغلب، في موازاة محور متعامد للكاميرا) خالقةً تكوينات مختلفة ضمن اللقطة. بعد أن تبقى مركزة على المجموعة لفترة من الوقت، تبدأ الكاميرا في التراجع، تاركةً إياهم معزولين في المسافة، وعبر اتساع الكادر تتكشف لنا برك صغيرة خلّفتها الأمطار. الوسائل السمعية البصرية، التي تعمل كمنبهات حسيّة قوية أكثر مما تعمل كرموز تصويرية، تنقل إحساساً قوياً بالعزلة والإنسلاب. لهذا السبب، بدلاً من قراءة فيلم STALKER من وجهة نظر أيديولوجية/ بيوغرافية (سيرة ذاتية)/ سيكولوجية (تحليل نفسي)، يبدو الأكثر تسويغاً وإثارةً هو استنطاق بنية الفيلم كصور حلمية مرسومة عبر وسائل سينمائية تثير استجابة حسية عند المتفرج.
المتفرج لا يختبر فقط رحلة الدليل إلى المنطقة ZONE بأنفاقها الواقعة تحت الأرض، وأنابيب المياه العملاقة، ومنشآتها المعدنية التالفة، بل أيضاً المقدمة والخاتمة اللتين تدوران في الشقة وفي الحانة.
في التقاط المظهر الذي لا يوصف شفهياً من العالم المادي، تاركوفسكي قبل كل شيء يستخدم الإضاءة لتحقيق "لا شفافية" – حسب تعبيره - اللقطات (على سبيل المثال: اهتزاز الأشياء وحركتها غير المفسرة، الاختفاء المتعذر تفسيره للأشياء، التجسيد غير المتوقع للدخان، الضباب، المطر، النار، الريح، والريش العائم)، والذي يتمم الكثافة الفلسفية للحوار. لكن كل هذه الرموز الخاصة بعالم الحلم ممثّلة على الشاشة بوسائل سمعية- بصرية يستحيل معها توصيل "ما لا يوصف" شفهياً: المطر، النار، الضباب، الريح، الأرض – عند تاركوفسكي – مختبرة على الشاشة كظواهر سينمائية أكثر مما هي مرئية كقوى طبيعية.
التجريد السينمائي يكون ظاهراً أكثر قرب نهاية الفيلم، عندما تركّز الكاميرا بؤرتها على ابنة الدليل أو المتعقب stalker التي يكشف وجهها الجامد عن تركيز متوحّد: في البداية نحن لا نرى غير جانب من وجهها يحتل مقدمة الصورة (بينما هي محمولة على كتفيّ أبيها)، شعرها مغطى بلفاع ملوّن، بينما المنظر الطبيعي في الخلفية يتغيّر من محيط مضبّب إلى تصميم لوني زاه. في المشهد الختامي، فيما زوجة الدليل تحاول أن تخفّف عنه لحظاته الأخيرة، نرى التعبير الوجهي للصغيرة يماثل التعبير الكئيب على وجه أبيها. إنها تحدّق في الكأسين (أحدهما ممتلئ إلى نصفه بسائل) وجرّة على الطاولة، وتبدو مسترخية جسمانياً، مع ذلك فإن تحديقتها تطلق شحنة خارقة للطبيعة. بينما الكاميرا تتراجع تدريجياً فوق السطح اللامع للطاولة، الأشياء الثلاثة الموضوعة على الطاولة تبدأ في التحرك، على نحو إعجازي، على سطح الطاولة، في اتجاه الكاميرا، حتى يسقط الكأس الفارغ على الأرض مع صوت ارتطام متضخم. على نحو متزامن، الصوت المتقطع المتواتر، لقطار يقترب (رابطاً، مجازياً هذه المرّة، نهاية الفيلم ببدايته) يمتزج مع نباح كلب وضوضاء طاولة تهتز. الكاميرا، مغيّرة اتجاه حركتها، تدنو ببطء من الصغيرة، التي تغمض عينيها فيما تريح رأسها على الطاولة، بوجه طاهر ومتحرّر من أي انفعال، بينما موسيقى بيتهوفن تطغى على قعقعة قطار يغادر. الكاميرا تواصل اقترابها من الصغيرة حتى تحصر وجهها في لقطة قريبة، بعينين مغمضتين، فيما الموسيقى تتصاعد تدريجياً لتبلغ ذروتها كتمجيد لعبثية الحياة الجدلية – المعادل السينمائي للبيان الذي يقدمه الدليل بعد إدراكه بأن المنطقة الغامضة هي مظهر جوهري، وضروري، من الوجود الإنساني.
إن الكشف الروحي للواقع في السينما، والذي يقوم به تاركوفسكي، يتحدى المفهوم التقليدي الصارم للسينما السردية بوصفها متوالية خطية من الأحداث التمثيلية المصورة. في خلقه صور الحلم التي طاقتها الحركية تتخطى الرصد المجرد للواقع، فيما يوفّر تجربة فذّة لا تكون ممكنة إلا في السينما، يبرهن تاركوفسكي أن التجريب الحقيقي في الفن لا يعني مجرد استخدام حيل أو وسائل بصرية بل إنجاز بنية سينمائية مركّبة ومعقّدة، "الشكل الذي يصبح هو الأقرب في توصيل العالم الداخلي للمبدع ويجسّد توقه إلى المثل الأعلى".
كل صنّاع الفيلم المبدعين انشغلوا حد الإستغراق بمعضلة التعبير عن الأفكار والغايات بلغة بصرية وسمعية، متحدّين بذلك الاعتقاد بأن هذا الوسط لا يلائم إلا الحركة البدنية والأداء الدرامي.
لقد برهن تاركوفسكي، بطريقة خلاقة، على أن من الممكن تحقيق صور حلمية شعرية ضمن النوعية السردية، شريطة أن يتم تخطي القصة بتأثير حركي مؤهل لتوليد شيء أكثر رحابة روحياً، وأكثر كونية، وضمنه يتجسد عالم كامل من المشاعر والأفكار والرؤى.
من الجلي أن الشعور، الأكثر حدّة، بالروحانية التي يختبرها تاركوفسكي، في أحلامه وتخيلاته وهلوساته، لا يمكن توصيلها من خلال الكلمة المنطوقة وحدها، وإنما في الأغلب من خلال الصور السينمائية التي تمثّل انطباعات المبدع المتخلقة بواسطة منطق الحلم، والمتشكلة بطريقة ملائمة لعملية التفكير أو الحلم.
Film Quarterly, Winter 1989/90
************

عبر سلسلة من الأحلام والتخيلات والرؤى التي يعجّ بها فيلم "سحر البورجوازية الخفي" The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)، يقدّم المخرج الأسباني لويس بونويل رؤية هجائية للبورجوازية، ونقداً ضارياً لأعمدة المجتمع الفاسد. وعبر الدعابة السوداء يصوّر الإنهيار التدريجي لعوالمهم التي يحسبون أنها محصّنة ومحمية.
ست شخصيات بورجوازية، ذات نفوذ سياسي واجتماعي، يجدون أنفسهم، عبر سلسلة غريبة من الظروف والمصادفات والملابسات، عاجزين عن الجلوس معاً حول المائدة لإنهاء وجبة عشاء واحدة. إنهم ينتقلون من مكان إلى آخر دون أن يتسنى لهم تحقيق ذلك. بونويل يقدم هنا، بشكل ساخر ولاذع، عالماً فيه حتى أبسط الأفعال – تناول الطعام – يصبح مستحيلاً أو عسيراً، ويتعرّض للمقاطعة أو الاجهاض.
يبدأ الفيلم بوصول عدد من الأشخاص، بينهم سفير إحدى جمهوريات أمريكا اللاتينية، وهو أيضاً مهرّب دولي للمخدرات، إلى بيت صديق لهم دعاهم لتناول العشاء، لكن يتضح أنهم اخطأوا في الموعد، حيث من المفترض أن يأتوا في يوم آخر، لذلك يعتذرون ويغادرون. يذهبون إلى مطعم قريب ليكتشفوا وجود تابوت في القاعة المجاورة، بداخله جثة صاحب المطعم، في انتظار قدوم الحانوتي. الأصدقاء يغادرون وقد فقدوا شهيتهم.
في ظهيرة يوم آخر، يدخلون مقهى مزدحماً ويطلبون شاياً وقهوةً وشوكولا ساخنة، لكن طلباتهم غير متوفرة، الشيء الوحيد المتوفر هو الماء. يدنو جندي شاب من طاولة المجموعة ويسرد قصة مأساوية عن طفولته، حيث الأم الميتة وعشيقها القتيل يظهران للصبي، يخبرانه أن العشيق هو أبوه الحقيقي، وأن الرجل الشرير الذي يعيش معه هو قاتل أبيه الحقيقي، وأن عليه أن يثأر لهما. عندئذ يقوم الصبي بتسميم الأب المزعوم.
في مشهد آخر، يجلسون لتناول العشاء، لكن يقاطع ذلك دخول عدد من الجنود الذين يقومون بمناورات في الخارج. العشاء يتأخر، بينما المضيفة تعد طعاماً إضافياً للجنود الذين يضطرون فجأة للمغادرة.
جندي آخر يأتون به ليسرد حلماً رآه: نراه ضمن أجواء مرعبة يلتقى بأشخاص موتى في شارع خال ومخيف، فيصيح منادياً أمه.
حتى في الحلم لا يتسنى لهم تناول الوجبة، إذ يكتشفون أن الدجاج المقدم إليهم مصنوع من المطاط.
في أحد المشاهد، أثناء جلوسهم حول المائدة، فجأة وعلى نحو غير متوقع، ترتفع ستارة، كما لو على خشبة مسرح، وهم أشبه بممثلين مرتبكين وحائرين، فيما نرى جمهوراً جالساً في الصالة يراقبهم في استياء، ويتصايح باستهجان صاخب، لأنهم لم يحفظوا حواراتهم.
قسيس يُستدعى إلى منزل رجل عجوز (بستاني) يحتضر لكي يستمع إلى اعترافه ويخلصه من آثامه. البستاني يعترف أنه قتل والديّ القسيس اللذين وظفاه وأحسنا إليه. القسيس، بعد أن يمنحه الغفران، يطلق النار عليه ويرديه قتيلاً.
يتعرّض هؤلاء الأصدقاء للإهانة والسجن واستفزاز الثوار.. حتى يتحطم توازنهم أخيراً، ويبدون مرتبكين، حائرين، مشوشين. وواضح أن بونويل يستمتع بتوريط شخصياته والتلاعب بهم وبالظروف المحيطة.
ولأنهم ينتمون إلى الطبقة ذاتها، فإن التماثلات بينهم هي أكثر من الاختلافات. إنها شخصيات متفسخة، أنانية، قاسية، لا يعوّل عليها ولا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها. إنهم يحلمون بكوابيس بعضهم البعض، أو يكملونها على نحو قابل للتبادل.
أربعة من المجموعة يرتكبون أفعالاً شريرة، غير قانونية، مثل جريمة قتل وتهريب مخدرات وغيرهما، لكن يفلتون بسهولة من العقاب، لتوفر حصانة ما. وعندما يلقى القبض عليهم، إثر غارة مفاجئة يقوم بها مفتش شرطة نزيه ومتحمس، فإنه يتلقى مكالمة من وزير الداخلية يطلب منه إخلاء سبيلهم على الفور.
في هذا الفيلم نجد الثيمات الأثيرة، المتكررة، عند بونويل: التوكيد على الطبيعة الزائلة لأسلوب الحياة عند الطبقات العليا، شراك التعلق المرَضي بالأشياء، الحسية (الإيروسية) الهازلة، كبح أي محاولة لإشباع الحاجات الجسمانية الأساسية، الشخصيات المستغرقة في شؤونها الذاتية والتي تحاول بأي ثمن أن تظل في عالمها الثري والمترف بمنأى عن العالم الخارجي الذي يسعى إلى تمزيق عالمها. وأسلوبياً، نجد البناء المفكك الذي يتيح مساحة لما هو حلمي وفنتازي بالتسرب بين الخط السردي بحيث يبدو كما لو أنه جزء من السرد.
بونويل، في أكثر من موضع، يقطع سياق السرد ليظهر لنا لقطات للشخصيات الرئيسية الست وهم يسيرون بلا هدف عبر طريق عام ممتد على نحو لامتناه. ترافق هذه اللقطات أصوات ضاجة أشبه بالأزيز كأنها أصوات طائرات أو ما شابه. وهذه اللقطات تعطي إحساساً بالحركة والركود في آن، حيث الأشخاص يستمرون في السير دون توقف لكن دون أن يصلوا إلى أي مكان.. تماماً كما يحدث في الحلم. البورجوازية هنا، رغم كل العوائق والصدمات، تسير غير مكترثة بما يحدث خارج محيطها، لا يمسّها شيء وغير قابلة للتغيّر.
وبمثل هذه اللقطات ينهي فيلمه. في هذه اللقطات الختامية لا نسمع أصواتاً على الإطلاق، غير أننا نسمع بعد ذلك، وعبر شريط الصوت، صيحات حشد كما لو ضمن حدث رياضي. هنا، وكما في مواضع أخرى مختلفة، يقدّم بونويل توظيفاً سوريالياً لعلاقة الصوت بالصورة.
لكن الفيلم ليس سوريالياً محضاً في مجمله، كما الحال مع فيلمه الأول "كلب أندلسي"، الذي كان مؤلفاً كلياً من صور حلمية غير متصلة ببعضها، بينما في "سحر البورجوازية" يقسم بونويل العالم إلى واقع الشخصيات الست وهم يقومون بمحاولات يائسة لتناول العشاء معاً، والحكايات الملتوية للأحلام المستقلة وتلك المتداخلة مع بعضها، والتي تفضي إلى إعاقة الفعل الواقعي أو مقاطعته.
الفيلم يتحرك على مستويات متعددة: الواقع والحلم والمتخيل. هنا لا نستطيع أن نصدّق ما يقوله الأفراد، ولا نستطيع أن نتنبأ بما سوف يفعلونه لاحقاً. الحدود بين الأحلام والقصص المروية والأحداث تتعرض للمحو، والمتفرج هنا مضطر إلى بذل جهد في محاولة التمييز بين واقع العمل (ما يحدث حقاً للمجموعة) وما هو متخيل وحلمي، حيث اللحظات السوريالية تبدو طبيعية تماماً في سياق الفيلم.
الأحلام تلعب دوراً هاماً وأساسياً في الفيلم لأنها تساعد على الكشف عن القوى العنيفة المكبوحة القاطنة في اللاوعي. ولأن بونويل يعتبر الحلم جزءا من الحياة اليومية فإنه يسعى إلى إلغاء التخم الفاصل بين عوالم الوعي واللاوعي، الحقيقي والحلمي أو التخيلي.
حاز الفيلم على أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وجائزة الجمعية الوطنية لنقاد السينما.
 لماذا الوجوه، ولماذا ظلالها؟ وقبل هذين السؤالين، لماذا أمين صالح؟ أما الوجوه، فهو وجوه أمين المتعددة، وجوهه في "الرحيل في اللايقين والغموض والتشتت" داخل أروقة الكتابة، وارتحاله المستمر من نوع كتابة إلى نوع كتابه أخرى.. من القصة فالرواية فالمسرح فالنص فالسيناريو فالمقال. أما الظلال فهي ظلاله الوارفة على العديد من الأسماء، سواء كانوا أدباء أو كتاب أو فنانين. ولماذا أمين، فهذا أبسط سؤال، نظراً إلى التشكيلة الباهرة من المؤلفات والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمقالات والترجمات التي قدمها لقارئ العربية، وإلى التجربة العريضة الممتدة في الزمن، وفي التميز الإبداعي.
لماذا الوجوه، ولماذا ظلالها؟ وقبل هذين السؤالين، لماذا أمين صالح؟ أما الوجوه، فهو وجوه أمين المتعددة، وجوهه في "الرحيل في اللايقين والغموض والتشتت" داخل أروقة الكتابة، وارتحاله المستمر من نوع كتابة إلى نوع كتابه أخرى.. من القصة فالرواية فالمسرح فالنص فالسيناريو فالمقال. أما الظلال فهي ظلاله الوارفة على العديد من الأسماء، سواء كانوا أدباء أو كتاب أو فنانين. ولماذا أمين، فهذا أبسط سؤال، نظراً إلى التشكيلة الباهرة من المؤلفات والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمقالات والترجمات التي قدمها لقارئ العربية، وإلى التجربة العريضة الممتدة في الزمن، وفي التميز الإبداعي.
أردنا أن يكون الاحتفاء بالتجربة متميزاً، لكن المساحة لا تسعف، فلجأنا إلى تقديم جزء صغير من المرآة التي تعكس قليلاً من الوجوه، وقليلاً كذلك من الظلال. وكان ذلك بتسجيل شهادة مجموعة من الأدباء والفنانين تحدثوا عن أمين صالح الأديب والفنان، وأثره فيهم معرفيا وإنسانياً.. وكما لذنا بالأرشيف تنقيباً في صدى التجربة في الماضي القريب والبعيد، طرحنا الأسئلة عليه ليعرض بنفسه بعضاً من هذه الوجوه. ولما رأينا تقصيراً في المتابعة، أعدنا تقديم واحد من أهم كتبه.. آملين أن تكون هذه التحية المتواضعة من " اليوم الثامن " تلقي الضوء ولو بجزء "طفيف" من عطاء الأديب البحريني أمين صالح.
***
طوال أكثر من ثلاثة عقود لايزال أمين صالح في حرب مع اللغة، ينحت فيها.. يعجنها.. يحاول أن يوضب الكلمة إلى جوار الكلمة، ويهندس الصورة مع الصورة ليخرج نصوصاً مختلفة.. وفي أنواع أدبية منوعة. فإذا كان السرد هو الصنعة الأثيرة، فإن الطاقة الشعرية التي ضمنها نصوصه وقصصه، أربكت المشهد الشعري كما السردي، فهل ما يكتبه يعد شعراً أو شيئاً شبيهاً بالشعر. هذان وجهان فحسب من وجوه أمين صالح الكثيرة.. أما بقية الوجوه فهي موزعة بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والترجمة، وكل ذلك أحياناً يتداخل ويتقاطع مع بعضه بعضاً في كتاب واحد.. ويضاف إلى ذلك تجربة طويلة في الكتابة للصحافة.. فإذا كان الاقتراب من أمين صالح الإنسان من أبسط ما يمكن، فإن الاقتراب منه بالأسئلة، بهدف الظفر بالمثير واللافت مهمة تبلغ صعوبتها درجة الاستحالة أحياناً.
هذه إذاً محاولة من "اليوم الثامن" لإعادة تقليب تجربة أمين الطويلة، بتعرجاها الممتدة، وبأفقها اللامحدود. وفيما يأتي نص اللقاء.
الرغبة هي البوصلة
* من مجموعتك القصصية "هنا الوردة" العام 1973 حتى رواية "رهائن الغيب" 2004 مساحة زمنية كبيرة، وبين هذين العملين تجارب كثيرة منوعة.. ما البوصلة التي قادتك إلى الانتقال في الكتابة من جنس أدبي إلى آخر، ومن شكل كتابة إلى أخرى. علماً أن المتابع لأعمالك يلحظ أن الانتقالات كانت حاسمة ومن دون رجعة، باستثناء عودتك إلى كتابة الرواية بعد أكثر من 20 سنة من كتابتك "أغنية ألف صاد الأولى"؟
- لو قدّر للكاتب أن يرى أو يستشف البوصلة التي تدله إلى الجهة التي يريدها، لما وجد نفسه، في كل خطوة، عالقاً في شرك متاهة تزداد تشابكاً وتعقيداً، ويحتدم فيها الالتباس أكثر فأكثر، كلما أمعن في المجازفة والدخول في مجهول الكتابة.
ما أعنيه هو أن الانتقال من جنس إلى آخر، ومن شكل إلى آخر، لا يحكمه مزاج أو نزوة عابرة أو رغبة في كسر الرتابة أو تجريب مقصود أو ما شابه ذلك. فالأمر غير محكوم دائماً بمنطق وبتوجه عقلاني. إنه اختراق، أو لنقل، عبور - غير مأمون العواقب وغير معروف النتائج - من ضفة إلى أخرى لعلك تجد ما تبحث عنه. ولكنك لن تجد لأنك ببساطة لا تعرف عم تبحث، وماذا تريد، وما الذي تصبو أو تتوق إليه.. شيء واحد فقط تعرفه: أنك، بالكتابة، تتنفس، تحيا. إنك تحاول أن تعطي معنى لما تراه، لما تلمسه، لما تشعر به.. تحاول أن تعطي معنى للحياة، للعالم، لوجودك هنا على الأرض. لكن المعنى دائماً يكون مراوغاً، متملصاً، أشبه بماء تحاول الإمساك به من دون جدوى. الكتابة - مثل الحياة - رغبة وليست معنى. إن مجالات الكتابة، كما أراها، هي فضاءات - غالباً ما تكون مجهولة - لكنها مفتوحة، بل متاحة لكل من يرغب في المجازفة، شريطة أن يكون مسلحاً بالموهبة والمعرفة والشغف.
إذاً، ربما الرغبة هي البوصلة.. الرغبة في التنفس، في المجازفة، في التعبير عن أشياء غامضة.. ويا لها من بوصلة لا تشير إلا إلى المتاهة.
الكتابة ثمرة لحظة متفردة
* المتابع لأعمالك بإمكانه تصنيفها، بحسب فترة الصدور، وكأن كل مرحلة حاملة لثيمتها وأدواتها الخاصة، وبالتالي فإن ترحلك المستمر، قد يجعلنا نتساءل.. هل أنت على قناعة أنك استنفدت الكتابة في هذا الجنس الأدبي أو ذاك (قصة، نص، مسرح، سيناريو، رواية، نص مشترك) وبالتالي حدث إشباع، لابد على إثره من إيجاد منطقة أخرى لإيصال الرسالة المطلوبة؟
- المسألة لا تتصل بالاستنفاد أو الإشباع، بقدر ما تتصل بالرغبة التي أشرت إليها. وهذه الرغبة لا تنفد ويتعذر إشباعها. كثيرون يعتقدون أن الكتابة هي نتاج تخطيط مسبق وأهداف معلنة أو مضمرة. بينما هي ثمرة ما يمليه الوعي واللاوعي، المخيلة والذاكرة، في لحظة معينة لا تشبه على الإطلاق - من حيث المعطيات والغايات والأشكال - اللحظات الأخرى التي تتولد فيها كتابة أخرى مغايرة. ربما يحدث هذا لأنني لا أحمل رسالة ما أريد توصيلها إلى جهة ما، وفي زمن محدد. ولو كنت أحمل هذه الرسالة لأنجزت المهمة وانتقلت إلى مهمة أخرى. لكن الأمر ليس كذلك.. لدي أحلام يقظة وأحلام ليلية، لدي ذكريات وتخيلات، لدي هواجس وكوابيس.. أنثرها وأمشي.
فالأنواع الأدبية والفنية (قصة، نص، مسرح، سيناريو، رواية) هي مجالات أو فضاءات للكتابة، يمكن للكاتب أن يرتادها بحرية، ومن دون أن يشعر بأنه أجنبي أو دخيل. إنها أمكنة يقدر أن يتآلف معها بيسر واطمئنان. وشخصياً لا أشعر بأن ثمة تخوماً من أجل عبورها احتاج إلى إذن أو تأشيرة. التخوم اختلقها النقاد وبعض الكتـاب الخاملين، الذين لا يرغبون في ارتياد مناطق أخرى يعتقدون أنها محفوفة بالمخاطر.
نتاجاتنا تعرضت لنقد قاس
* الكُتاب عموماً يحاولون إخفاء مصادرهم.. وسؤالي إلى من يدين أمين صالح في كتاباته، وما أهم الروافد التي نهلتم منها، خصوصاً أن دينك يكاد يكون غربياً في معظمه؟ وهل تعتقد أن الإلمام باللغة الأجنبية جعل تجربتك مفارقة ومغايرة عن سواها، سواء من معاصريك أو من الأجيال التالية؟
- لا يوجد لدي سبب يجعلني أخفي مصادر التأثر أو الأسماء التي أنا مدين لها.. المشكلة أن الأسماء كثيرة ويصعب حصرها هنا. في الواقع، التأثرات لا تحصى.. من الكتابات القصصية والشعرية العربية في الستينات والسبعينات، والتي كانت تتسم بالجدة والتجريب آنذاك، إلى أعمال كافكا، ودستويفسكي، والسورياليين، وكتاب مسرح العبث، مرورا بالأفلام السينمائية.
فالكاتب عرضة لشتى التأثرات التي ربما لا يعيها في حينها، وهي تنسل في اللاوعي لتستقر هناك وتتجلى في ما بعد - بشكل أو بآخر - في مظاهر متعددة من التجربة الكتابية. والتأثر لا ينحصر في الأشكال الأدبية والفنية فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الفكر، الفلسفة، السيكولوجيا، الدين، والميثولوجيا.
لقد نشأت أدبياً وفنياً، في مناخ كان يعتمد الحوار والجدل والصرامة في التقييم، سواء من خلال حلقات الأصدقاء، أو ندوات أسرة الأدباء والكتاب التي أدين لها بالكثير. كانت نتاجاتنا تتعرض لنقد صارم وقاس من الأصدقاء والزملاء، وهذا أدى إلى تعميق تجربتنا الثقافية وإلى جعلها أكثر مرونة إزاء النقد وأقل استعجالاً في مسألة النشر.
ومن ناحية ثانية، لا أعتقد أن اهتمامي باللغة الإنجليزية جعل تجربتي مغايرة، هذه اللغة أفادتني في الشأن السينمائي أكثر من الشأن الأدبي.
الحدس والغريزة لا المنطق
* الحلم، والفنتازيا، والمراهنة على تصوير الحالات بصور مبتكرة، والاقتضاب في التصوير والوصف، ونحت الصور اللغوية، شكلت مرتكزات أساسية في صياغة القول.. وتالياً لم تعد متمسكاً بهذه الحزمة من العناصر لإيصال ما تريده.. هل العمل نفسه يفرض ذلك، أم حب البحث، أم الموضوع؟
- لا أعرف إن كانت هذه المرتكزات تسمى أسلوباً أم شيئاً آخر.. أحب أن أتحدث عن الرؤية الفنية التي ترتكز أو تعتمد على هذه العناصر. وهذه الرؤية تظل مع الكاتب ولا يستغني عنها وقتما يشاء. إنها متجذرة فيه، في تجربته. قد تتنوع أو تتطور. قد يفرض العمل طرائق مختلفة أو مرتكزات أخرى. وعندما تقرأ كتابي الأخير "والمنازل التي أبحرت أيضاً" *، أظن أنك ستجد تلك العناصر وغيرها حاضرة.
لا أستطيع أن أفسر لك الأمر.. الكتابة وأي شكل فني آخر مسألة في غاية التعقيد والالتباس.. ربما لأنها تعتمد على الحدس والغريزة أكثر من اعتمادها على المنطق. لهذا السبب، الناقد قادر أكثر على ملامسة وتحديد العناصر والسمات التي تميز كتابة عن أخرى، وتجربة عن أخرى.
اختبرت في المسرح حس الدعابة
* كتبت في المسرح، وكتبت عن المسرح.. في مسرحية "حيدر" وقفنا على نص لافت، كما أنك كتبت مسرحيات أخرى لم تر الطريق إلى النشر بعد.. أما كتابتك عن المسرح فكانت حافلة، في واقع الأمر، بالمصارحة، ما أغضب كثيرين.. سؤالي أين يجد أمين صالح نفسه في هذا الفضاء الجميل. وهل تمثل مجهوداته في هذا المجال - إبداعاً ومقاربة - تنويعاً على مشروعه الأساس، أم هي محطة أساس؟ ولماذا؟
- المسرح محض مجال آخر، فضاء مفتوح، أختبر فيه حس الدعابة، واستشرف فيه الأفكار والرؤى المرحب بها في هكذا فضاء: محدود المساحة، تجريدي التكوين، إيحائي الجوهر.. لكن لا نهائي المدى في ما يتصل بالصراع أو التعارض بين الأفكار والحالات النفسية والمواقف الاجتماعية والسياسية.. الخ.
مع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن هذا المجال، كحيز كتابي، لم يعد مغرياً بالنسبة إليّ.. ربما بسبب المناخ المسرحي السائد عندنا، الذي هو غير مرض وغير سار، ويثير الخيبة والإحباط.
لا تنازل عن الشروط الفنية
* على صعيد الكتابة للتلفزيون.. ما الذي راهنتم عليه؟ وهل نسيت الدرس الذي كررته دائماً في كتاباتك وتصريحاتك (إذا لم تستطع تغيير الواقع..)، خصوصاً أن تحقيق الكتابة للتلفزيون لا تنتهي عند الفراغ من كتابة السيناريو، بل إنها تبدأ من هذه النقطة، وتصبح في أياد أخرى كثيرة، غير يد المؤلف، حتى تصبح على الشاشة الفضية. وأخيراً هل كنت تريد من وراء الكتابة للمسلسلات السعي للجماهير إزاء الخروج من عنق القراء المحدودين.
- كتبت للتلفزيون تعويضاً عن غياب السينما، المجال الأكثر ثراء وفتنة، كمساحة بديلة.. لكن هذا لا يعني انتقاصاً من شأن وقيمة وجدية هذا الوسط الذي لا يكف عن إغوائي. إني أنظر إلى التلفزيون كشكل تعبيري، بصري وسمعي، يستدعي لغة مختلفة تماماً عن اللغة المكتوبة في الأدب والمسرح. كما أن العناصر البصرية والسمعية تقتضي تعاملاً مغايراً، من حيث الأسلوب والرؤية وتوظيف المخيلة. إضافة إلى أن الصورة الدرامية تخضع لقراءة وتأويل مختلفين عن قراءة وتأويل الصورة الأدبية.
والتوجه إلى الدراما التلفزيونية يعني بالضرورة التوجه إلى جمهور أوسع، لكن مختلف نوعياً عن جمهور الأدب. ومن المهم أن يسعى الكاتب إلى إقامة وتحقيق اتصال مع جمهور أكبر ومتعدد.. لكن من دون أن يتنازل عن شروطه الفنية من أجل إرضاء هذا الجمهور، ومن دون اللجوء إلى تملقه، واستجداء قبوله واستحسانه.
بالطبع، من السهل تقرير أو الإدعاء بذلك نظرياً، لكن على الصعيد العملي يتعرض كاتب السيناريو إلى ضغوط كثيرة ترغمه على تقديم تنازلات، وإجراء تعديلات عدة. ففي هذا الوسط لا يكون الكاتب مسيطراً وحراً كما في لحظة الكتابة.. عناصر كثيرة تتدخل وتطالب بإجراء تعديلات معينة، بدءاً بالمنتج، والمخرج وانتهاء بالمونتير ومرورا بالممثلين والمصورين.. هذه هي طبيعة العمل الدرامي في السينما والتلفزيون والمسرح أيضاً. وعلينا أن نقبل ونقر بذلك، إذا آمنا بجماعية وتعاونية العمل.
كما يجب أن نعي الاختلافات في جوهر وطبيعة وآلية ولغة وعناصر هذه الأوساط أو المجالات الفنية. ونتعامل مع كل مجال بوصفه مغايراً ومستقلاً، وبالتالي يكون تقييمنا أيضاً مختلفاً. بعضهم يتساءل بدهشة وحيرة: كيف يمكن لهذا الكاتب أن يبدع في مجال النص الأدبي، ولا يكون كذلك في مجال درامي آخر؟
هذا السائل يرى الحال الإبداعية واحدة، أشبه بحقيبة سفر تنتقل معك من محطة إلى أخرى، متجاهلاً الطبيعة والمناخ واللغة المتباينة في كل وسط، وأيضا الشروط التي يعمل الكاتب وفقاً لها.
صفحة أشبه بشاشة
* يأخذ عليك بعض الناس، وخصوصاً في عملك الأخير (رهائن الغيب والذين هبطوا في صحن الدار بلا أجنحة) أن العمل في تكنيك كتابته، وطريقة تصويره أقرب في بنيته العامة والتفصيلية إلى سيناريو المسلسل؟ ما رأيك؟
- مأخذ؟ لا بأس. لابد من وجود الذهنية التقليدية المحافظة، في مكان ما هنا أو هناك. الذهنية التي تستنكر أي خروج على القوانين الموضوعة منذ أزمان سحيقة. لكن، هل يعلم صاحب هذه الذهنية أن السورياليين الفرنسيين، في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، كتبوا نصوصاً أدبية/ سينمائية، حتى أن فيليب سوبو سمى عدداً من نصوصه "قصائد سينمائية". وماذا عن الأعداد الوفيرة من الروايات الحديثة التي تقترب كثيراً من السيناريو السينمائي؟ وفي لحظة قراءة أية رواية، ألا تتمثل المشاهد والشخصيات والمواقع بصرياً.. أي سينمائياً، بمعنى إخراجك الخاص للمشهد على شاشة الذهن، مستعينا بمخيلتك وموظفاً العناصر التي تقرأها؟
كيف يمكن لكاتب أو شاعر معاصر أن يتفادى تأثير السينما، هذا الشكل الفني الباهر والمؤثر بفعالية لا يمكن أن يضاهيه فيها أي شكل آخر؟
خذ نصوصي منذ سنوات، وستجد تأثير السينما حاضراً في غالبيتها.. لكن هذا لا يعني المحاكاة المباشرة، والتأثير السلبي الذي يجعل من النص الأدبي نسخة مشوهة من النص السينمائي. أكرر، يجب أن يعي الكاتب الفروقات الجوهرية في جوهر ولغة كل شكل فني. فـ "رهائن الغيب" تعتمد البناء السينمائي، بحيث تبدو الصفحة أشبه بالشاشة، لكنها تتغاير وتبتعد في السرد والوصف واللغة والحوار والسمات الأخرى الخاصة بعالم النص الأدبي. وبالطبع ليس في التقنية.. فثمة بون شاسع بين التقنيات طالما أنني أتعامل، في "رهائن الغيب"، مع اللغة المكتوبة لا البصرية.. كما في السينما.
لست شغوفاً بالترجمة
* كنت من السباقين في نقل بعض آثار ميشيل فوكو إلى اللغة العربية، لكنك لم تتعمق في هذا الاتجاه، ترى ما السبب الذي جعلك تنأى بنفسك عن المضي في نقل الآثار الفكرية والفلسفية، والانحياز إلى السينما بشكل يكاد يكون مطلقاً، ولماذا السينما تحديداً؟
- الترجمة، بكل أنواعها، لم تمثل لي شغفاً أو استحواذاً. الضرورة هي التي فرضت مثل هذا التوجه. منذ البداية كنت مسكوناً بعشق السينما. في طفولتي كانت السينما وسيلة ترفيه وتسلية، وأيضا كانت ملاذاً سحرياً كلما رغبت في الهروب من الواقع والعيش في عالم يشبه عالم الحلم. وعندما كبرت اكتشفت أن السينما هي هذا وأكثر.. إنها مجال فكري وثقافي غني وعميق وبالغ الحيوية.
والمثقفون العرب، في غالبيتهم، لم يكترثوا كثيراً بالسينما كحقل ثقافي استثنائي، بل نظروا إليها كمجال ترفيهي بحت لا يستحق الاهتمام، ويمكن تجاهله أو حتى ازدرائه.. بل إن بعضهم صار يتباهى بعدم مشاهدته الأفلام، وتبديد وقته الثمين في التعرف على ما ينتجه هذا الوسط. وبالتالي لم تدخل السينما ضمن النسيج الثقافي في الأوساط العربية، كما كان الحال مع الأوساط الثقافية في شتى أنحاء العالم.
ومع اهتمامي بالسينما، في الجانب المعرفي، وجدت نفسي في حقل شاسع من النظريات والأفكار والرؤى، وضمن عوالم من الاتجاهات والتيارات والأساليب. ومثل هذه الذخيرة الهائلة من المعرفة كانت، للأسف، مجهولة عندنا، ومن أجل تعميمها كان لابد من ترجمتها، ولأن الاهتمام بهذا الجانب كان نادراً أو محدوداً، فقد سعيت إلى ترجمة ما قرأت وأثار اهتمامي، معتقداً أنه سيثير اهتمام الآخرين أو على الأقل سيلفت نظرهم إلى وجود حقل يجهلونه تماماً (ويتباهون بجهلهم له(
أما عن الآثار الفكرية والفلسفية فأعتقد أن هناك من يهتم بهذا الجانب على نحو أفضل وأعمق مني. وكما أشرت، لست شغوفا بالترجمة إلى هذا الحد.
للسرد خاصياته الشعرية
* "مدائح" و"موت طفيف" عُدّا من قبل بعض النقاد شعراً، بل إن بعضاً آخر يرى أن أمين صالح هو شاعر في معظم ما كتب.. وهذه الصفة لا ننفيها بدورنا في بعض ما كتبت، وسؤالي بحسب تقييمك الشخصي، هل توجد بظنك حدود واضحة بين ما تكتب وبين الشعر؟
- علينا أن نوضح أولاً مفهومنا للشعر كي نقدر أن نتبيّن الحدود: هل هو، بمعناه الضيق، كشكل أو نوع أدبي محدد بقوانين أو قواعد معينة، كالوزن والقافية وما شابه. أم هو، بمعناه الأوسع والأشمل، كموقف ورؤية وإدراك للحياة وللعالم من منظور حسي وجمالي. ومن خلال لغة ترفع العادي والواقعي إلى مستويات تتداخل فيها مع الحلمي والخيالي، لتنتج حالات لا يمكن تأويلها وفق معطيات عقلانية، بل تحمل منطقها الخاص الذي لا يخضع لشروط ثابتة ومقررة سلفاً.
وتقنياً، ندرك أن للسرد خاصياته الشعرية، وللغة النثرية مكوناتها الشعرية، وللصورة الأدبية جماليتها التي تقربها من الصورة الشعرية. وعندما يتعلق الأمر بكتاباتي فإني أتوقع منك، كناقد أو قارئ، أن تبين هذه الحدود - بين ما أكتب والشعر - من دون الاعتماد على ما أقرره من منطلق ذاتي.
النقد الذاتي إحساس بالمسؤولية
* من المعروف عنك أنك شديد النقد لأعمالك وبدرجة تتجاوز أحياناً ما يكتبه الآخرون عنك.. وسؤالي: على ماذا تتكئ وأنت تمارس نقداً ذاتياً.. وما النتائج التي أسفر عنها هذا النقد؟ وهل هذه العملية مستمرة؟ وكيف تقرأ الآن في 2006 بيان "موت الكورس" على سبيل المثال.. والسجال الصحافي الذي كنت أحد أطرافه، والذي كان يدور حول واقعية الأدب؟
في النقد الذاتي عادة أعتمد، مثلما يعتمد غيري.. حسب ظني، على التجربة والمعرفة والحدس (مدعوما، بالطبع، بنقد خارجي). كل كاتب يسعى إلى الكمال الذي لا يمكن تحققه، وإذا تعامل مع نصه - في لحظة الكتابة - بحزم وصرامة، وبجدية مطلقة، فسوف يشعر بأنه ينجز شيئاً له معنى وقيمة، حتى لو لم يستطع التخلص من بعض الشوائب أو النواقص. أما إذا تعامل بخفة واستسهال، وبثقة مبالغ فيها، فلن ينتج غير نص سهل لا يتسم بالعمق.
عملية النقد الذاتي، واعادات النظر، هي مستمرة ودائمة، وينبغي أن تكون كذلك. إنها تكشف عن مدى جديتك في التعامل مع الكتابة وإحساسك بالمسؤولية تجاه قارئك. عندما تقدم نتاجك إلى الآخر طالباً منه أن يستجيب ويتفاعل مع ما تكتب فينبغي على الأقل أن تحترمه، وتقدم له عصارة جهدك وليس بقايا أو إفرازات وقت بددته في الكتابة.
بيان موت الكورس؟ لا أعرف إلى أي مدى أنا مخلص لمفهومات ونظريات ووجهات نظر كنت مؤمناً بها في وقت من الأوقات.. أذكر أننا قلنا في نهاية البيان: ينبغي إعادة النظر في ما نقول ونفعل. في الكتابة لا أظن أن لدي ثوابت.. كل شيء عرضة للخيانة أو إعادة بناء.
أما عن السجال بشأن الواقعية، فهو سجال طبيعي بين أفراد يريد كل واحد منهم أن يفرض رأيه وتصوره بشأن مفهومات مراوغة لا يمكن الاتفاق حولها. لكنها كانت نقاشات ضرورية وملحة آنذاك. وإذا كانت تتسم بشيء من الحدة والانفعال، فمبعث ذلك الحماس والتعصب. الجدل والخلاف بشأن المفهومات والمصطلحات سيظل قائماً إلى ما لا نهاية، ومن دون حسم.
قراءات متباينة حد التناقض
* حظيت تجربتك بمتابعة نقدية مقبولة إلى حد ما.. ولو طلبنا الآن من أمين فتح أرشيفه، ليعلق لنا عموماً على كيفية تعاطي الآخرين مع كتاباته، ما أبرز ما تحفظه لنا هذه الملفات.. علماً أن بعضهم يرى أن تجاربك الأخيرة كانت حظوظها في التناول والقراءة أكثر من التجارب التي جاءت بعد البدايات على تميزها وشعريتها.. ما مدى دقة هذه الملاحظة، وما السبب في رأيك؟
- في ما يتصل بالمتابعة النقدية، أدرك جيداً أن التوجهات والمنطلقات، وبالتالي القراءات، تتفاوت وتتباين من ناقد إلى آخر. وهذا الإدراك جعلني لا أتوقع استجابة واحدة ومحددة من النقاد، بل أتوقع تعدد القراءات والتأويلات.. ولا أراهن على تقييم واحد أو أخضع له. بعض الكتاب تدفعهم حساسيتهم المفرطة إلى التأزم عندما يصادفون نقداً سلبياً لأعمالهم من ناقد واحد قرأ النص من زاوية قد لا تكون صائبة. ما أريد أن أقوله: ليس ثمة قراءة واحدة.. وعلى الكاتب أن يدع نصه يمر عبر "فلترات" النقد من دون أن يخشى على نصه من الإنجراح أو التقييم السلبي. النص الجيد يصمد ويحتل مكانة بارزة حتى لو قلل النقد الحالي من قيمته.
شخصيا، أشعر بأن النقد، على رغم قلة المتابعات النقدية لأعمالي، أنصف إلى حد ما تجربتي، ولا أستطيع هنا أن أقيّم استجابات النقاد لأعمالي، لأن العلاقة تمتد عبر سنوات طويلة خلالها صادفت عدداً من القراءات المتباينة إلى حد التناقض، ولا يمكن اختزال ذلك في تقييم سريع وموجز.
من ناحية ثانية، من الطبيعي أن تلقى التجارب الأخيرة لأعمال أي كاتب أو فنان اهتماماً نقدياً أكثر من البدايات أو ما بعدها، إذ تنال تجربته حظاً أوفر من الحضور والتماسك وجذب الاهتمام.. أي تكون عادة أكثر نضجاً وقابلية للتحاور معها. أحياناً النقد، خصوصاً عندما يكون سلبياً وقاسياً، يضر الكاتب في بداياته، إذ يكون آنذاك طرياً وهشاً وغير محصن.
لن تجرني للمنطقة الصعبة
* لو طلبنا من أمين صالح أن يرسم لنا شبه خريطة للحركة الأدبية في البحرين اليوم، ترى ما ملامحها الأساس.. خصوصاً أن أمين متهم بعدم متابعته للنتاجات الأدبية التي يقدمها الشباب في البحرين؟
- من يتهمني بعدم متابعتي لنتاجات الشباب الأدبية لابد أنه يقيم معي في المنزل بحيث يعرف عن كثب ما أقرأ وما لا أقرأ، وما أتابع وما لا أتابع. على أية حال، لست ناقداً أو محرراً في صفحة ثقافية بحيث أعبر عن رأيي في تجارب الآخرين.. وبحيث يعرف الآخرون ما أقرأ.
مرة أخرى، أجد نفسي هنا مطالباً بالقيام بدور الناقد لكي أشرح الملامح الأساس للحركة الأدبية. لا، لن تجرني إلى تلك المنطقة الصعبة. من جهة أخرى، هذا سؤال يستدعي بحثاً لا إجابة مختزلة.
* صدرت المجموعة القصصية بعد إجراء المقابلة.
***
في أوائل السبعينيات بدأت أنشر قصصاً قصيرة باسم مستعار كي لا يعرف أحد انني شقيق أمين صالح . فأمين حينها كان قد نشر مجموعة (هنا الوردة .. هنا نرقص) ، وأصبح اسماً مهماً في القصة القصيرة البحرينية.
واستمر نشري للقصص باسم مستعار لسنتين متتاليتين حتى بدأت القصص تثير ردود أفعال متناقضة في أسرة الأدباء والكتاب، ووصل الأمر إلى تخصيص قراءة نقدية لقصصي في إحدى ندوات الأسرة الداخلية. كنت جالساً في الخلف استمع صامتاً إلى ما يدور من حديث حولي وعيني على أمين صالح الذي كان ضمن الحضور. كانت تلك الندوة كشفاً لما كان مستوراً، فلقد عرف أمين بأمري واستغرب أن أكتب باسم مستعار طوال هذه المدة، ونصحني أن اكتب باسمي الحقيقي. ولم يدر بأن قراراً كهذا سيدخلني في دوامة أخرى وهي كيف أكون شقيقاً لأمين صالح وأن لا أكون نسخة منه. فإعجابي الشديد بأسلوبه وكتاباته جعلني أحزم أمري بأن ارتبط به روحيا ولا ارتبط به أدبياً، والأهم من كل هذا أن لا أدخل معه في أي شكل من أشكال المنافسة الأدبية.
بذلك استطاع أمين صالح أن يدفعني ، دون أن يدري ، إلى اكتشاف عوالم أدبية وفنية جديدة بالنسبة إليّ ، فحبه غير العادي للسينما ، منذ طفولته ، وكتاباته الرائعة عنها ، جعلني اتجه إلى البحث والكتابة عن موسيقى الأفلام ، وقصصه ونصوصه المبهرة جعلتني أتجه لأدب الأطفال ، وأسلوبه الحداثي ولغته الشعرية جعلني أتجه إلى التراث الصوفي والديني لخلق لغة مختلفة لا تتطابق مع لغته . أقول أن كل تلك العوالم الأدبية والفنية اكتشفتها كي لا أكون نسخة منه .
حياتياً، كان أمين صالح دائماً بالنسبة لي شقيقاً أصغر، رغم انه يكبرني بأربع سنوات، و إحدى مهماتي في الحياة، هي أن أخدمه، بكل حب. فهو يحتاج إلى عناية خاصة كي يتفرغ للكتابة فقط، ولا يعمل شيئاً آخر، ولا ينشغل بالأمور العائلية والحياتية.
أن أجمل ما حمله لي القدر في حياتي أن يكون أمين صالح شقيقي وأستاذي والأديب الذي افتخر به، مثلما تفتخر به البحرين.
***
(إلى أمين صالح)
بينكما ما يستعير من الله
أرشيفه العاطفيّ
بينكما ما يشي بالغموض
ويمنحنا للخفيّ .
الناسك، الزاهد في كل شيء إلا الصداقة والحب والكتابة،
يسهر على النص حينا من الدهر، فيصقل الشخص للباقي من العمر.
يشحذ الصورة بمخيلته النشيطة مأخوذا بالسينما فلا يغفل عن الشعر في الكتابة.
بيني وبينك مستحيلات من المعنى
دلالاتنا تضيع بنا
ونعرف أن في ليل الكتابة نهر أخبار
ومحتملات
بين وبينك ... كلما تهنا.
موجه يفيض عن البحر، فيغمر القرى والمدينة، ويزور أحياء الناس. لأسلوبه لغة يقلدها البعض بفضيحة صغيرة تكبر كلما بالغ الآخرون في النفي.
موج يمتد ليغسل السواحل، وحين يذهب إلى النوم يتخبط البعض في طين الشاطئ في بلهنية الادعاء.
حين جاء الى السينما، كتب السيناريو عن معرفة الدرس وخبرة الموهبة، لم يكن يكترث بأضواء الشهرة الفارغة، ولم يسع لإعلام بائس يمعن في مسخ المواهب وتشويه الأمل.
ضوءه فيه. في الضوء. في ضوء عينيه. في ما تبقى من الضوء.
في .. كلما ضاءَ فيه.
لنا أن نستعير الوقت كي نمشي على مهلٍ
لنا أن نختفي ونعود في حرية الميزان
لنا أن نفضح العنوان
كي تبقى الكتابة في كتابك
كي نضلل شهوة الإنسان
لنا، لو نستعير الماء، أن نبكي على أملٍ
ونكترث احتفاء بالمرايا
هل لنا، في رفقة تهدي بقايا
لنا في .. كلما لو يفقه الإنسان.
لا تصدقه،
سيأخذ لبك المغرور
سوف ينام فيما حلمك الباقي سيبحث عن دلالته
يضلل ما تبقى من شهيق القلب بالمعنى
سينسى أن في خوف العشيق سلامة العشاق
لا يعبأ بما يسعى لتفسير الزهور
عليك أن تبكي قبيل الجرح كي تنجو
ففي النص الجديد نقائض تهجو الطريق
وتمدح التأويل
تبكي .. كلما في شهوة الأوراق.
مثل النبيذ النادر النبيل، كلما طعن في العمر والتجربة صار أكثر لذة وغنىً وجمالاً.
ومثل النبيذ أيضا، لا يعاتبك كلما ادخرته لمستقبل الوقت. يمنحك حبه في اللحظة التي تعود إليه، كأنك اكتشفته تواً.
ليلي/ داخلي :
لقطة متوسطة/
- الشخص منكباً على دفتر صغير. يكتب. كلما خط كلمة طارت في هيئة فراشة. وكلما قلب ورقة تقاطر تفاح ينسكب من سلة الدفتر. يتحول المخطوط على كتاب. يتوهج مثل موقد على شكل قلب. ويتصاعد منه سربان . سرب الفراش الأصفر المرتعش وسرب التفاح الأخضر المغسول يتقاطر تفاحاً تفاحاً.
- النص يغفو في حضن امرأة مشغوفة بالتآويل. فراشة على كتف وتفاحة على كتف. والشخص يتفلت من المعنى.
نهار / خارجي:
لقطة كبيرة /
كائنات ضئيلة تجرجر أحشائها المسعورة. وتحمل ضغائن تتفسخ على أكتاف ضيقة. كائنات ضئيلة تكاد لا تبدو لفرط الضغائن. ضئيلة حتى أنها أكثر ضآلة من ضغائنها. أحداق زائغة لشدة شهوة الضغن.
تعلن الكتابة فتنال الكآبة. كائنات افتراضية تظن أنها هنا. بينها وبين النص أكثر مما تحسب.
لا تثقْ،
كلما مدّ عينيه في الكائنات لكي يستجير
رأيتَ له شرفة في الشفق
لا تثقْ
كلما نامت الشمسُ في حضنه
سوف ينتابه ما يثير القلق.
- وأنت؟
- كنت نائماً فلم أشهد الحادثة.
- فإذن كنت في الحلم، قل عن الحلم.
- ما دخل ذلك في ما حدث، لقد كان حلماً.
- على العكس، الحقيقة تكمن هناك، لا نكون حقيقيين وصادقين مثلما ونحن في الحلم. هيا قل لي ماذا حدث؟.
- لا أعرف، لكن .. حسناً كانت المرأة وحدها.
- والرجل؟!
- لم يكن هناك رجل، ثمة الطفل معها فقط.
- هل تعني أن الطفل هو الذي...؟ّ!
- نعم،.. يا إلهي كيف يمكنني أن أصف لك ذلك، لقد كان مجرد حلم لا أكثر.
- ... أفهمك، أعرف ذلك. كلما في الحلم .. تكون الحياة ممكنة.
- .. وأنت !، أين كنت ؟
- أنا !؟ أنا لم أكن في مكان.
***
أمين صالح... ذلك الإنسان الذي عشق السينما وعلمني عشقها... إنه المحطة الحقيقية الأولى في حياتي السينمائية... فبه دخلت البحرين عصر السينما،عندما قدم لي سيناريو أول فيلم روائي بحريني بعنوان "الحاجز". وبعد ذلك بسنة قدم بالتعاون مع الشاعر قاسم حداد سيناريو فيلم " الفراشات لا تحلم هنا "إثر غزو العراق للكويت، ليقول مع قاسم إنهما جزء من هذا الخليج... فقد تأثرا بقضية الغزو واعتبرا السينما سلاحاً جباراً للتعرض لكل قضايا الخليج والتأثير فيها.
عندما يهديني أمين صالح فيلماً سينمائياً، لا يكون ذلك من أجل المشاهدة فقط، وكأنه يضمن هديته رسالة تحوي: الجدية والرقي والفن الصادق والالتزام... وكأنه يريد أن ينير لي الطريق في هذا المجال الصعب، ويعيد الأمل بداخلي كي لا أيأس، وأسعى لتحقيق أفلام سينمائية يحتاجها الوطن. أمين صالح هو سينما هذا الوطن، وهو عبقها الذي لن ينتهي لأجيال قادمة.
من يقرأ لأمين صالح سيجد الصورة السينمائية في قصصه ورواياته ومقالاته حاضرة بقوة.. أحياناً أشتم رائحة الفيلم السينمائي، وأسمع تناغم أصوات أجهزة التحميض، وتروس المعدات السينمائية في كلماته المطبوعة.. فلا يمكن أن تقرأ له ولا تتخيل بأنك أحد الأبطال في فيلم سينمائي مليء بالحركة والمشاعر والحب.
في كل مرة أشعر بأن السينما أصبحت بعيدة.. أتصفح أحد كتبه، وأعود محملاً بيقين قربها مني ومن البحرين.
***
في عملي التلفزيوني التقيت بالعديد من الكتاب الخليجيين، سواء ممن تعاملت معهم مباشرة، أو أولئك الذين قرأت لهم أعمالاً ولم ألتق بهم.. لكن وبكل صراحة فما يكتبه أمين صالح يعد مفارقاً ومختلفاً عن السائد. هذا الاختلاف في ظني سببه الخلفية الأدبية التي أتى منها أمين، خصوصاً أنه قاص وروائي قدير. كما أن هذا الاختلاف متأت من عشق أمين وهيامه بالسينما العالمية، مما كان سبباً رئيساً في اختلاف كتابته.
أما الاختلاف أو التميز بمعنى أدق فسببه أن كتابات أمين صالح تهتم اهتماماً كبيراً بالتفاصيل كافة. وهو الأمر المفقود في كتابة الكتاب الآخرين. كما أن الشخصيات التي يكتبها أمين تتميز بأنها متباينة تماماً، لجهة التفاصيل والاهتمامات وغير ذلك. ولا نكاد نجد تشابهاً بين شخصية وشخصية أخرى. كما أن أمين صالح يولي جميع الشخصيات اهتماماً وعناية، ولا حضور على الإطلاق لأية شخصية عابرة أو فائضة عن الحاجة. هذا في نظري ما يعضد فكرة الاختلاف، ويؤكد سمة التميز.
لقد عملت مع أمين في العديد من المسلسلات والبرامج، وهي "السديم، نيران، أبيض وأسود، حالات"، وهناك مسلسل مقبل بعنوان "هديل الليل". هذا العمل المشترك جعلني في حال من الانسجام مع كتاباته، وصرت – كما أعتقد – أفهم ما يريد أن يقوله بين السطور. هذا الفهم والانسجام، فضلاً عن الصداقة التي تربطنا تجعل بيننا مساحات مشتركة، وخصوصاً في أثناء مناقشة أي عمل قيد الإنجاز. وأهمية هذا الأمر تكمن في تقبل أمين بصدر رحب أية ملاحظات،
أو إجراء أية تعديلات.
وأخيراً، من المهم جداً القول هنا إنني لم أشعر بتوأمة مع مؤلف مثل تلك التي تحدث بيني وبين أمين صالح. فعندما يأتي إلى موقع التصوير لمشاهدة تصوير بعض المشاهد، نجده وهو يتابع لا يبدي أية ملاحظات أو يوجه انتقادات أو يتذمر مثلاً.. فهو يؤمن بدور المخرج وبرؤيته للعمل، ويغذي ذلك إحساس عنده بأن ما سيعرض على المشاهد سيكون أفضل من المكتوب، وهذه ميزة ينفرد بها أمين صالح.
***
قد تعد هذه الشهادة مجروحة، إلا أن التأكيد منذ البداية على أن صورة أمين صالح التي تحفل بها الشهادة ليست صورة ذهنية، بل هي صورة حقيقية.. تنطلق من الخاص والحميمي لتصل إلى العام.. فبيني وبين أمين صداقة قديمة، أبرز ما ميزها هو الحوار الذي ينحو نحو الثراء.. فهو من بين القلة الذين تلتقي بهم في حياتك ممن يمتلكون القدرة على الاستماع، وعلى تلمس اتجاه رأيك، واقتناص المعنى من كلامك، فهو ليس شخصاً مغلقاً. بيني وبين أمين صالح سنوات كثيرة يكبرني بها، ورغم ذلك لا يحاول أبداً أن يمارس دور الأبوة أو يتسلط، فهو منفتح، يحدثك باللغة التي تستطيع أن تفهمهما أنت، وليس بلغته. إنه من الأشخاص الذين يمتلكون دربة في الحوار، وفي توصيل المعلومات والأفكار.. وهو في الوقت نفسه على رغم تجربته وخبرته الكبيرة مثل طفل يحاول إعادة اكتشاف الأشياء باستمرار، وإثارة الأسئلة حولها.
وعلى صعيد إنساني كذلك، أمين صالح، يبهرك بالمرونة التي يتحلى بها، وكذلك بتعامله مع القسوة التي قد يصادفها شخصياً بشكل إنساني.. وبطريقة" شر البلية ما يضحك ". وهو يملك القدرة على إخراجك بسهولة من الوحدة والعزلة مثلاً، دافعاً بك إلى البهجة والتفاؤل.
إن أمين صالح من الشخصيات التي تؤمن بالعمل الجماعي، وأذكر في هذا السياق مسرحية "حيدر". فقد كنت ومجموعة من الأصدقاء قد قرأنا دراسة نفسية حول شخص فصامي. فطلب الفنان محمد رضوان آنذاك من أمين أن يكتب نصاً مسرحياً من وحي هذه الدراسة.. كان رضوان مثلاً مهووساً بشخصية الفصامي كما جاءت في الدراسة إلى أبعد الحدود.. ومن فضيلة الاستماع التي يتحلى بها أمين، ومن إصغائه بعناية لمختلف الآراء، وبعد النقاش المستفيض، وطرح التساؤلات الجديدة والعميقة حول الشخصية.. تبدلت القناعات تدريجياً وعليه قام أمين بصياغة الشخصية بعمق أكبر، وبطريقة تبتعد عن النمطية.. فحينما كتب هذا النص أضفى على الشخصية وأضاف لها، والجميع راض على رغم اختلاف الرؤى في البداية. ولو لم يكن أمين من الداعمين للشباب وبصدق كبير، لما كان هذا التعاون، ولا كان هو نفسه قد أصغى إلى التصورات والرؤى التي تقدم على مسامعه.
أخيراً، أود تسجيل نقطة في حق أمين صالح.. إنه العدو اللدود للنمطية، كما أنه كاتب وأديب ومثقف مشاكس إلى أبعد الحدود. ومن ذلك أنه من الكتاب القليلين الذين إذا كتبوا للتلفزيون يصعب شطب جملة أو مشهد أو فقرة من المسلسل، بل إن نصوصه تمثل تحدياً لأغلب المخرجين، الذين يتجهون إليه في حال أرادوا تعديلاً أو إضافة.. من دون أن يكون ذلك مشروطاً.. وهو مشاكس على مستوى المسرح والتلفزيون، لقد طرح مثلاً شكلاً كوميدياً جديداً مختلفاً في مسرحيته "روميو وجوليت" و "اختطاف".. هذه الكوميديا غير متعارف عليها في المنطقة التي تعتمد الإفيه والقفشات. بينما كوميديا أمين مبنية على المواقف، والبناء المتكامل للنص.. وقد فعل ذلك في التلفزيون في برنامج
"بث غير مباشر" وقس على ذلك في كل الحقول التي كتب فيها.
****
مشروع قديم يحوم في كبدي منذ تسعينات القرن الماضي لإيماني الشديد بأهمية الحب الصادق.... بالعلاقات الإنسانية الشفافة القائمة على حب فعل الخير والجمال(أي الجمال الخالص) يحصل تعجب- ولربما تحب- أن تحب شخصاً ما لكاريزما شخصه مثلاً.. شاعراً لشعره وإن كان تافهاً روائياً وإن كان نزقاً ورساماً صادقاً مع فنه وإن يتمثل قمة الغرور والتعالي... فما بالي إذا كان هذا الشخص أمين صالح... هذا الجميل وعالمه الإبداعي المخيف..الأنيق الباذخ..
هذا المشروع الخرافي الباهر دوماً هو دليل فنار بحرنا..دليل فتنة فوقه وانخراط وبحث لمدة لصورة في الرسم والشعر والرد السينما في الحالم بعالم إنساني مرح تعمه... المحبة، لذا أراه يسحر الكون بحكمة صمته... وعمق تأمله وبتواريه وبإخلاصه المتمادي في مشروعه ودوماً وعبر نصوصه الفاتنة أتمثله رساماً تشكيلياً محرضاً منفلتا خارقا..هادماً كل التابوات والأعراف الفنية والتقنية. ذاهباً إلى الذي لم نألفه متذرعاً بالبحث وعشق الاكتشاف... هذا المعرض وبعيداً عن مؤامرة (المفاجأة) التي ضمرناها لفترة ما قبل موعد الافتتاح قاسم حداد وجبار الغضبان وأنا عن أمين كان مفاجأة أبضاً بالنسبة لي عندما أنجزت بعض الأعمال برفقة نصوص المدائح وهندسة أقل...خرائط أقل وأنا في أجواء ثلج أسلو وقت تدفق سواد الأحبار على صقيل الخشب. عددته إنجازا باهرا على المستوى الشخصي كوني استطعت ولو بشكل متواضع أن أقدم تحية لإنسان أمين علينا مثل أمين صالح الذي يستحق منا الكثير الكثير.. أشعر أنه مهما قدمنا له سنبقى مقصرين في حقه. فمنذ جنينه الأول- هنا الوردة.. هنا نرقص ونحن نغذي أرواحنا بعرفان قلبه المتدفق حباً وجمالا الذي ما أنفك يرشق وجوهنا بحناء غسله الازوردي بعيداً بصمته داخل دمه قريباً ببوحه من أعماقنا يا رسول الاستغراق والكلم حاولت التقرب إليك راغباً في جنتك، طامعاً في قراءتك ومعرفتك وترجمتك فمنعتني المرأة من البوح واخترعت لك الصمت طريقة كلمت السواد المكتظ من سطورك فتسلل البياض إلى شقوق مدادي توضأت المطر والشجر فرمتنى حانات أحزاني في جب مياهك أيها الصالح الأمين... ترأف بنا قليلاً، واحفر بالموصد من أبوابك فراديس أحبابنا كي نغسل عهر أخلاقنا * من مقدمة الفنان عباس يوسف لمعرض (البحر عندما يسهو) الذي أقيم في عام ٤٠٠٢ تقاطعاً مع تجربة أمين صالح.
***
في سياق هذا الملف، تأتي هذه القراءة في كتاب أمين صالح
"الوجه والظل في التمثيل السينمائي" كونه من أهم الكتب في الفن السينمائي، وفي الوقت نفسه فمنذ صدوره لم يلق الاهتمام الكافي، وهو عموماً يعد دالاً شاهداً على وجه/ وجوه من عمل أمين المضني والممتع والمفيد.
تزخر المكتبة العربية بالكثير من الإصدارات السينمائية المؤلفة، أو المنقولة إليها من لغات أخرى، وتتراوح هذه المؤلفات ما بين قراءة تجارب محددة، بفحص مختلف الأبعاد التي ترتكز عليها تقنياً وفنياً وفكرياً، أو تنصب لمصلحة معالجة جماليات هذا الفن. ويسير مع هذين التصورين في خط مواز، البعد الذي يستهدف المتلقي، وذلك بتقديم أدلة تساعده على استبطان المفهومات، ولترشده من ثم لإعادة استثمارها في أثناء مشاهدة الفيلم، تماماً كما هي الخارطة الدالة، أو المفاتيح الأساسية التي تفتح ما قد يغلق على المتلقي، أو تسهم في توسيع مداركه لهضم التعقيدات التي تشتملها الصورة السينمائية في تلاحقها وتتابعها لتصبح في المحصلة النهائية فيلماً.
وبالمقابل نجد ندرة في المؤلفات تسعى لاستنطاق مختلف القضايا في الفن السينمائي من منظور وفهم العاملين في الفيلم من ممثلين بشكل أساس. وبالتحديد في القضايا التي تصادفهم قبل وفي أثناء، ومن خلال العمل على تحقيق فيلم معين، أو من خلال رؤيتهم أنفسهم للتمثيل بوصفهم مجموعة من الحالات المتحولة. وكتاب أمين صالح "الوجه والظل في التمثيل السينمائي" ينحاز بأكمله إلى هذه النوعية من المؤلفات، الذي يمثل بحق إضافة تثري وتعزز، تضيف وتؤسس لطرائق نظر مختلفة.
فالكتاب بمجمله لا يصدر من منطلق يسعى إلى بسط مفهومات التمثيل السينمائي وجعلها في أطر وقوالب محددة، بقدر ما يروم تشييد حوارية مترامية الأطراف، تستلهم مادتها من فهم وتجسيد طائفة واسعة من الممثلين الغربيين تحديداً في كيفية نظرهم لهذا الفن، وفي كيفية إحساسهم به، وتجسيدهم له، ثم في كيفية قراءتهم للتمثيل في علاقته الطبيعية أو المتوترة مع مختلف العناصر الأخرى المشكلة للفيلم السينمائي، منذ اللحظة الابتدائية، لحظة قراءة السيناريو، مروراًً بلحظة الإنجاز النهائي، وصولاً إلى لحظة الخبرة بعد مراكمة التجارب الواحدة تلو الأخرى.
وأمين صالح صاحب أول سيناريو فيلم بحريني "الحاجز"، يواصل عمله الدؤوب، ومحاولاته الجادة في تقديم جرعات سينمائية. وسط ثقافة تعتمد أكثر ما تعمد على جهود واجتهادات فردية في سياق يتطلب رساميل ضخمة، وفرق عمل، وإمكانات هائلة. ونجده لايزال متمسكاً ومتشبثاً بخيط أحلامه، يكتب ويترجم ويؤلف. وقد صدرت له ترجمة لكتاب "السينما التدميرية" لـ "عاموس فوغل" العام 1995. إضافة إلى ترجمته ليوميات عملاق السينما الروسية أندريه تاركوفسكي. فضلاً عن عشرات المقالات الصحافية التي قرأ من خلالها كثيرا من الأفلام السينمائية المنتمية لمختلف المدارس والثقافات والاتجاهات. ويتواصل هذا الحب بهذا السفر الضخم الذي يحرك ذاكرتنا صوب نمط تأليف محدد، يعتمد إثارة ومضات تمهيدية معينة، ثم لا يلبث أن يترك شخصيات كتابه/ ممثليه تتحاور فيما بينها. ولمثل هذه الطريقة جذورها التي يعرفها المهتم والمتابع، وهي معروفة منذ أزمان متباعدة إلى القراء، وذلك في القواميس أو المختارات التي تأتي بمصطلح أو فكرة ما، ثم تشرحها من خلال اقتباسات مأخوذة من أقوال وتصريحات ولقاءات الممثلين أو المخرجين حولها. ولكن المختلف المطروح في هذا الكتاب أن موضوعه تحدد في التمثيل.
يقر أمين صالح، بداية، في مفتتح كتابه أنه لا يرنو إلى تقديم دراسة نظرية، بقدر ما ينحو نحو سبر آفاق التمثيل من خلال إدلاءات الفنانين أنفسهم. ومسوغ ذلك فقر المؤلفات عموماً من وجود مؤلفات تكشف الشهادات والخلاصات المتعلقة بالفنانين حول قضايا ذات سمة فنية، وذات سمت إبداعي. إذ تتمحور معظم المؤلفات الموضوعة عن فنانين معينين حول جوانب شخصية حياتية، مع إغفال لرؤية ونظر هذا الفنان، واكتفائها بتتبع الهامشي، وملاحقة اليومي عديم القيمة. وفي التمهيد نفسه يحدد منهج بحثه ذاكراً أنه لا يسعى لفض الاشتباكات والاختلافات بين مختلف الآراء حول أية قضية متصلة بالتمثيل، فهو إذ ينجو بنفسه من المفاضلات والترجيحات والموازنات، فإنه يترك للقارئ هذه العملية واضعاً أمامه مائدة عامرة بالتعريفات والتشخصيات، ومن ثم عليه أن يختار ما يشاء، دون فرض قسري، بل إن كل الخيارات مفتوحة وفي متناوله. وفي الوقت نفسه قد تؤشر هذه العملية – حال كل الفنون – على إدراك مسبق بصعوبة الجزم، واستحالة الحد والحصر، فالتحول والتغير، في مقابل الثبات والاستمرار، شرعة لا يمكن المضي فيها قدماً من دون التسليم بها، أو بنتائجها حد اليقين الذي لا مراء فيه.
يتألف الكتاب من "30" باباً، وكل باب يبحث في قضية فنية معينة، بدءاً من تعريف الممثلين أنفسهم للتمثيل، وحتى سائر الموضوعات الفنية المرتبطة بالتمثيل، ومنها على سبيل المثال، الممثل والسيناريو، الممثل والحوار، الممثل والشخصية، الممثل ومصادره، العلاقة بين الممثل والمخرج، الممثل والكاميرا، الممثل والإضاءة، الممثل والموسيقى، الممثل والمونتاج، الممثل والموقع، الممثل والجوائز، الممثل والدراسة.. بالإضافة إلى تناول بعض الموضوعات ذات الصلة مثل: اختيار الممثلين، البروفات، الارتجال، فترات الانتظار بين اللقطات، اختيار الأدوار، الممثل الثانوي، النجومية، وغير ذلك مما ينطوي عليه عمل الممثل، أو في علاقته بمختلف العناصر والأشياء التي لا يمكن الاستعاضة عنها لإنجاز المطلوب.
ولإيضاح الفكرة بشكل أكبر نتناول أحد أبواب الكتاب لتقديم بعض مفصلياته، وقد وقع الاختيار على الباب الخاص بعلاقة الممثل بالشخصية التي يؤديها، لأكثر من سبب، الأول أنه من أطول فصول الكتاب إذ يقع في "67" صفحة، الثاني أن معد ومترجم الكتاب رفده بآراء العديد من الممثلين من ثقافات مختلفة، ومن مدارس سينمائية متعددة، تتوافق أحياناً، وتتضارب في أحايين أخر، كما أن هذا الموضوع من الموضوعات الشيقة التي تهم القراء المتتبعين للفن السابع عموماً، ولنجوم معينين. بالإضافة إلى أنه يعكس الجهد الكبير المبذول لسبر هذا الموضوع من مختلف النواحي. ويقدم في الوقت نفسه لمحات وافية عن هذه الطريقة في الإعداد.
يبدأ هذا الباب بمقدمة على هيئة تساؤلات: ما الذي يحكم اختيار الممثل للدور؟ وما الأسس التي يرتكز عليها في الاختيار؟ وما العناصر أو المكونات التي تكون مصدر جذب وافتتان؟ وما الشروط التي لابد من توافرها في الشخصية كي يتفاعل معها الممثل، أي إلى مدى يتحقق الانسجام أو التوافق بين الممثل والشخصية؟ وما الذي يرغب الممثل في التعبير عنه من خلال هذه الشخصية أو تلك؟ وانطلاقاً من التساؤلات السابقة يبدأ الكتاب بتقديم وجهات نظر طائفة واسعة من الممثلين. وكانت النتائج الختامية أن بعضهم انحاز إلى الأدوار التي تعكس شيئاً من السيرة الذاتية، وبعضهم كان ميالاً لاختيار الأدوار المركبة والمعقدة، وبعضهم الآخر كانت اختياراته تتم على أساس عاطفي، وفريق رابع كان يضع التناقض شرطاً أساسياً، وهناك ما كان يفضل الشخصيات التي تختلف بشكل كلي عن شخصيته الحقيقية، وهكذا اختلاف مستمر يحدد طبيعة هذه العلاقة.
ثم يأتي أمين صالح بمقدمة نظرية أخرى، يتحدث فيها عن الأساسيات التي ينبغي على الممثلين العمل في إطارها لسبر الشخصية، وفهمها، وخلق ماض لها، واستيعابها في إطار المعطيات الاجتماعية وما إلى ذلك، حتى لو كان السيناريو مقتصداً في هذا المجال، بالإضافة لاستعراض الأدوات الفنية والثقافية والتخيلية اللازمة عند الممثل – وأحياناً بعض النصائح – وبعد هذا التمهيد يترك أمين الحديث للممثلين والمخرجين حول موضوع خلق الشخصية ذهنياً، بالاعتماد على المخيلة والتجربة الحياتية والثقافية، وملء الفراغات في السيناريو حول هذه الجزئية، ثم في الكيفية التي يبني بها الممثلون الشخصيات داخلياً وخارجياً، والأدوات التي يستخدمها الممثلون في قراءة الشخصيات التي سيجسدونها أو جسدوها بالفعل، مثل الحدس والغريزة أو البحث والتحضير، وغير ذلك.
وينتقل الحديث في هذا الباب بعد ذلك لمعالجة موضوع التحول في الشخصية، والفروق الفردية بين ممثل وآخر من ناحية تأدية تشكيلة واسعة من الشخصيات، في مقابل أن تصبح طبيعة أدوار هذا الممثل نمطية ومتكررة، إلى الممثلين الذين يؤدون شخصيات كاملة بعيدة عن ذواتهم في كل التفاصيل، من الإيماءة إلى الصوت إلى أكثر التفاصيل تعقيداً، بما يفضي ذلك إلى قيام بعض الممثلين بمعايشة لصيقة بالتجارب التي تشبه الشخصية التي سيؤدونها، بقراءة كل ما يتعلق بها إن كانت شخصية حقيقية، والالتقاء بها إن أمكن، وتعلم الفنون والمهارات والسلوكيات الخاصة بنمط محدد من الشخصيات بالمعايشة، وبالمراقبة والمتابعة، إلى درجة التماهي التام مع هذه الشخصية ذهنياً ووجدانياً ونفسياً وحتى جسمانياً، أو بقراءة دقيقة وشاملة حول الفئة التي تمثلها هذه الشخصية، والطبقة التي تنتمي إليها من جميع النواحي. ومن هذه المسألة يعالج الباب هذه القضية من زاوية الضغط الذي تمارسه على الممثل من عدمه، في حال، كان أداء بعض هذه الشخصيات يتطلب تقمصاً تاماً، ومعايشة كلية، بحسب الممثل، وطبيعة عمله. كما يتناول هذا الباب بعض القضايا المتصلة بالتمثيل: مثل الفروقات بين الممثل الخلاق والممثل الدمية، وما إلى ذلك من قضايا متصلة. عارضاً في الوقت نفسه لوجهة نظر عشرات الممثلين والمخرجين والنقاد في القضايا المشار إليها.
ومما سبق يتبين – وهذا ينسحب على جميع أبواب الكتاب – أن هذا الباب/ الكتاب يتجه إلى ثلاث وجهات هي:
التعريف.
بيان الفروقات في طبيعة العمل والفهم من فنان أو مخرج لآخر.
تقديم نوع من الدليل للقارئ إلى بعض الأفلام ذات المستوى الفني الرفيع من خلال الممثلين والأفلام التي جرى الاتفاق عليها من قبل النقاد أنها متميزة - وهذه المسألة ألمح إليها أمين صالح، كون اقتباساته واستشهاداته كانت مدروسة، ولا تضع في اعتبارها المتهافتين على التمثيل من باب الارتزاق أو ما شابه.
ولعل أهمية هذا الكتاب الضخم (469 صفحة) أنه يتحدث في الأغلب الأعم عن أفلام سينمائية متوافرة بسهولة، وأنه يمنح المهتم معلومات وفيرة حول مختلف الظروف الإنتاجية لعدد كبير من الأفلام التي شكلت علامات متميزة في تاريخ الفن السينمائي. إن الكتاب، يمثل جهداً كبيراً، يستحق الالتفات والعناية، على رغم صدوره قبل فترة.
***
إن الدور الذي مارسه أمين صالح في تجربتي لا يمكن أن أنساه أبداً، وهذه شهادة حق.. كنت أتخبط في بحر السرد، لكن أمين أعطاني سترة النجاة. فبعد صدور كتابي الأول (البياض) في العام 1986، كنت أعيش متاهة التفكير في الكتاب الثاني، وهو كتاب أردت أن يكون من حيث المبدأ بعيداً عن أجواء البياض. في هذه الأثناء تعرفت على أمين، وقد اقترح عليّ أن نقوم بورشة عمل على أحد النصوص التي كتبتها. وهذا ما تم بالفعل. وقد استمرت هذه الورشة مدة 7 أسابيع متصلة، كنت ألتقي به كل اثنين في مقر أسرة الأدباء والكتاب. وكان يناقشني في كل صغيرة وكبيرة في النص، يحدثني مرة عن الخلل في الحوار، ومرة عن الصور، ويطلب مني إعادة كتابة هذا النص، وهكذا أعدت كتابته 7 مرات. وفي المرة السابعة، قال أمين، الآن هذا النص يصلح للنشر، فما كان منه إلا أن مزق هذا النص، وألقاه في سلة المهملات. كان ذلك مؤلماً جداً بالنسبة لي في ذلك الوقت، وطلبت منه أن أحتفظ بالنص لنفسي، وليس بهدف النشر، فوافق، لكنه ذكّرني أن هذا النص مجرد ورشة في الكتابة. أما الآن فأعتقد أنه من النادر أن تجد كاتباً بمستوى أمين صالح، يعتني بأي كاتب أو أية موهبة بمثل هذه العناية والحرص. وهذه التجربة لها أبلغ الأثر في تجربتي التي تطورت لاحقاً – إن صح أنها تطورت.
لقد علمني أمين صالح من هذه التجربة الصرامة في التعامل مع نصوصي التي أكتبها.. علمني أن أقسو عليها، فكل كتابة قابلة للتعديل والتغيير، وأحياناً النسف وحتى الإلغاء.. وفضيلة ذلك هي التحرر من تقديس النص الذي تكتبه، وهو ما يمدك بطاقة تجعلك تعيد كتابة النص مرة، ومرتين أو ربما ثلاث مرات.
من ناحية ثانية، مما يؤسف له أن تجربة أمين صالح لم تأخذ حقها من الدرس النقدي، ولم توضع التجربة في الموضع الذي تستحقه على رغم تأثيره الكبير ليس محلياً فحسب بل إقليمياً وعربياً كذلك.. وليس في السرد بل حتى في الشعر. فتجربة أمين صالح لها تأثير كبير، حتى مع أكبر الشعراء في البحرين، والدليل على ذلك تأثر قاسم حداد بالحساسية الشعرية عند أمين صالح.
أمين صالح مبدع هضم حقه في الانتشار، حاله في ذلك حال سليم بركات، كلاهما لم تنل أعمالهما العناية النقدية، وكان حظهما من الانتشار محدوداً.. فهما من أصحاب التجارب النادرة.. بينما بالمقابل نجد أسماء أخرى بائسة نالت من الشهرة ما نالته لأن الظروف خدمتها، وبسبب العلاقات الشخصية، والعلاقات العامة، والقدرة على التسويق. وهو المفتقد عند كلا الكاتبين. وربما يتحمل أمين نفسه جزءاً من هذه المسئولية لكسله.. لكن المؤكد، مرة أخرى، إن هذه التجربة لم تسوق بالشكل المطلوب، ولم تحظ بالمكانة التي تستحقها فعلاً.
***
"وقد استمر أمين صالح في كثير من قصصه التجريبية الأخيرة كاتباً لا يرتضي الهزيمة والانهيار أمام لا عقلانية الواقع، لأنه يبحث في الواقع عن الجوهر لا عن فتات التجارب اليومية برتباتها وسكونيتها".
إبراهيم عبدالله غلوم
(القصة القصيرة في الخليج العربي، 1980)
"هكذا تقدم البحرين المعلقة الثانية للعرب، بعدما قدمت معلقة طرفة.. هذا العمل بداية للحرية اللغوية والتقنية للأدب العربي، وانه استفاد من التراث العربي الأصيل قصاً وشعراً وتصوفاً.. التي تلتئم مع عناصر العصر في خلق قصيدة نثر – شعرية".
عن "الجواشن"
سليمان العطار
(كلمات، ع 14، 1991)
"يحلق الكاتب في هذا النص خارج حدود ذاته لكي يصل بنا إلى عالم مذهل من الجمال، عالم جديد وأصيل. ذلك أن طراوة الحلم كما نراه في (الترنيمة) يمثل قمة التألق عند أمين صالح".
عن ترنيمة للحجرة الكونية
نهى بيومي
(البحرين الثقافية، ع 2 ، 1994)
"عندما قرأت ما كان يكتبه الصديق أمين صالح (...) كنت أقول: هذا شاعر أكثر حرية مني.. وكان (...) يأتي من عالم النثر إلى التألق الشعري بسرعة متناهية".
قاسم حداد
(ليس بهذا الشكل ولا بشكل آخر، 1997)
"ينتقل الروائي والقاصّ البحريني من النصّ السردي الى النص الشعري من غير أن يتلبّس صفة الشاعر. فنصوصه النثرية الجديدة مشرعة على فضاء الشعر وحريته.
(إن) علاقة الأديب البحريني أمين صالح باللغة تؤهله لكي يكون شاعراً مهماً. فهو يعنى باللغة من الداخل، لا يقولها، بل يشرق بها".
فاروق يوسف
(صحيفة الحياة، 12 مارس/ آذار 2000)
***
"قبل كل عرض مسرحي عندنا، تنتابني رغبة ملحة في كتابة يوميات حول ما يدور أثناء البروفات.. أي بمعنى آخر الغوص في التجربة الجماعية، بالمتابعة اليومية لما يحدث (...) العمل الجماعي هو الذي يبهرني ويثيرني".
(كتابات، العدد الثالث، 1977)
"لم أكن أصوغ عالماً مألوفاً.. إنما كنت أصوغ واقعاً آخر، واقعاً قصصياً، غير منفصل حتماً عن الواقع الذي نعيشه (...) لم أكن أسجل الأحداث اليومية.. بقدر ما كنت أقوم بعرض لصراع الإنسان ضد واقع يمارس ضده شتى أنواع القهر".
(الأقلام العراقية، 1980)
"كتاباتي لا تغري الكثيرين للاقتراب منها، ربما لأنها تفتقر إلى الجاذبية، أو لأنها لا تثير الاهتمام، أو لأنها تستعصي على الفهم.. رغم وضوحها.. مع ذلك فمازلت أكتب دون خجل لأنني أحب أن ألهو، أن أنثر ألعابي النارية، وأن أستمع إلى أصدائها.
(كلمات، العدد الأول، 1983)
"كتاباتـي الأولى كانت مرفوضة لأنها اعتبرت غامضة أو منفصلة عن الواقع اليـومي الثقافي، فيما بعد صارت مقبولة وداخلة في النسيج الكتابي السائد. الآن يطالبونني بالعودة إلى ذاك الأسلوب وتلك الطريقة واللغة والكتابة".
(مجلة العربي، 1997)
"في (رهائن الغيب) حاولت إعادة بناء زمن لا يكف عن التملص (...) وإعادة رسم أمكنة اكتسبت بذاتها خاصيات جديدة.. وحاولت استحضار شخصيات سكنت إقليم الطفولة والمراهقة.. أما الحدود بين الواقعي والمتخيل فقد أضحت مطموسة".
(مستل من شهادة قدمت
في ملتقى القاهرة الثالث
للإبداع الروائي العربي، 2005)
"في (ندماء المرفأ) كنت أمارس حريتي القصوى، وأيضاً متعتي الكبرى، في التعبير بلغة لا ترتهن إلى المنجز، وبسرد يدمج الشعري بالنثري، وبمخيلة لا تحجم عن الانطلاق نحو أي أفق أشاء".
(منتدى "على هدب طفل" الإلكتروني)
الوقت
البحرين- 13 ابريل 2006
إقرأ أيضاً: