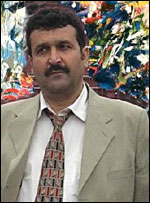 لا بيت لك
لا بيت لك
ارحل إلى الصحراء
كن سائباً كالأغنام
. . الفرار . . الفرار . .
قدمان
سرقتهما الأيام
. . في غرفة صغيرة
تدج الكون مكبلا
هناك
انزع جسدك
وتهيأ للفراغ
سيف الماء - علي العندل
باتت قصيدة النثر الإماراتية، وبعد مرور حوالي ثلاثة عقود على انطلاقة التجارب الناضجة الأولى، لرادتها الأول، تسجل حضورها الإبداعي، وتلفت الأنظار إليها، كأحد مكونات الشعرية الإماراتية، إلى جانب قصيدتي العمود والتفعيلة .
وبدهي، أن ظهور هذه القصيدة إماراتياً، جاء متأخراً قياساً إلى عواصم ثقافية عربية أخرى، بعد تبلور مفهومها على أيدي عدد من فرسانها المعروفين، إلا أن النماذج الإبداعية منها تسجل خصوصيتها، وهي أنها تفتقد إلى محاكاة النموذج الواحد، وذلك لافتقادها إلى الشرط المسبق الذي من الممكن أن يحد من إبداعها، لأن من شأن كل قصيدة أن تقترح معاييرها، الخاصة، وهنا يكمن سر إبداعية قصيدة النثر .
ويبدو - من هنا تماماً- أن قصيدة النثر في خريطتها الإماراتية تتحرك في مستويين: أحدهما عام، والثاني خاص، حيث يدخل في إهاب المستوى الأول، خروجها على كافة القيود التي تكبحها، وإبداعها المستمر لمكونات شعريتها من خلال اللغة والصورة والإيقاع والخيال، بما لا يتقاطع مع الكثير من أدوات سواها من الأشكال الشعرية السابقة عليها، أو اللاحقة بها، وهو ما يمكن أن يوجد خلاله بعض القواسم المشتركة مع عالم قصيدة النثر العربية أو العالمية من خلال بعض النماذج المترجمة، يقول علي العندل:
واقفاً على منضدة العقل الآتي
بلا تلف تمضي الأوراق
والقوافل المضيئة
على هيئة تدرج في السرية المتناهية
أفقاً لمولد الوهج
إذ يكون الوهج
قبيحاً
لبصير أتعبته الرؤيا
أيهذا الوادي
جفافاً
في مواسم الأمل
وأدك
مثلما الأباريق
لحظة الرطم
أما المستوى الثاني، فإنه يتعلق بالروح التي يشيعها الشاعر في مجمل المفردات التي تشكل فضاء نصه، وما يحدد خصوصيته، بما في ذلك خصوصية البيئة - حيث تجاور الصحراء والبحر في آن واحد - وهو ما يترك المجال واسعاً ليسجل الشاعر العلامات الفارقة لقصيدته ضمن سياق تجربته، والتجربة الشعرية الإماراتية كامل يقول الشاعر عادل خزام:
كنت أسأل
وكان السؤال يصف حقيقة الوردة
أنا سادن الرائحة وعنفوان الطيب ونحلة الحب
والوجد
أنا المنهوب من أشواكه وشيخ المحنطين من الظلم
أحب البراري الجرداء ونخلة العدو
ماذا أريد غير وردة تجلس في يدي لأصير غصناً
مباركاً
غصناً أحمر من شدة قلبي
أجل، ضمن هذين المسارين، تحديداً، يمكن النظر إلى تجارب جد مهمة في خريطة الشعرية الإماراتية، وضمن عالم قصيدة النثر، ومنها ظبية خميس وحبيب الصايغ وأحمد راشد ثاني وثاني السويدي وميسون صقر القاسمي ونجوم الغانم وخلود المعلا وعبد العزيز جاسم وإبراهيم الملا وعبد الله عبد الوهاب وإبراهيم الهاشمي ومسعود أمر الله وسعد جمعة وعادل خزام وعارف الخاجة وخالد بدر وعبد الله السبب وأحمد العسم وأحمد المطروشي وعلي العندل، والهنوف محمد، وهاشم المعلم ومحمد بو خشيم وأحمد منصور وخالد الراشد وعائشة البوسميط، وغيرهم كثيرون، من جيلي الثمانينيات، والتسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أحمد المطروشي وجمال علي وغيرهما، من العقد الجديد، من الألفية الثالثة، التي تجر أذيالها، ولما تفرز بعد جيلاً واضح الملامح، لاعتبارات عديدة، برغم وجود أسماء تكتب قصيدة النثر تتعلق بالموقف منها، وعدم تبني أسماء شعرائها بالشكل اللائق، ما جعل مبدعي هذا الجيل يشكلون جزراً تكاد تكون متناثرة، برغم انتمائها لخريطة الشعرية الإماراتية نفسها، بعد أن عزف مبدعون مهمون من شعراء الثمانينيات والتسعينيات عن الكتابة، متوجهين إلى الكتابة في مجالات إبداعية أخرى، وهو ما يمكن تناوله في وقفة خاصة يقول الشاعر إبراهيم الملا:
من التل
دحرجوا قمرهم
كان الهواء رفيقهم والضوء
كان الليل قليلاً مثل أحلامهم
من التل رأيناهم
يقشرون الحنين
وكمن يمشي على الماء
كانوا أخفّ من رنة في الحقل
كانوا ظلالاً نابتة
وسنابل عمياء
لبرهة
ظننا أنهم غابوا
لكنهم فجأة تبرجوا
كما لو كانوا في عيوننا
ويقول الشاعر عبد الله السبب:
كيف لي
إذن
وأنا الطاعن في الغرق؟
كيف لي
وأنا قيصر الأشلاء؟
كيف لي . .
وأنا عربون الحريق؟
كيف لي
وأنا التائه ارتعاشاً
في مساءات الشتاء؟
كيف لي
أن أتمدد على حلمي
وأسافر وعداً
يكسوه الغمام؟
كيف لي . .
أن أتكىء على صوتي
وأباشر دفئاً
مراقاً
عند ناصية الاشتهاء؟
كيف لي
أن أقف اختيالاً
بين برادات الجليد
كيف . .
وكيف . .
وكيف . .؟
إن هذه الأسماء- وعلى اختلاف أجيالها- ومنهم من كتب قصيدة التفعيلة أو حتى العمود أيضاً، جزء من قائمة اتسعت تدريجياً، لتوجد لنفسها فضاءها الإبداعي الخاص، من خلال البصمة الفردية لكل مبدع على حده، بالرغم من أن الطريق لم يكن معبداً أمام أصحابها، وأن قصيدة العمود لا تزال تجسد عمود الشعرية في الذهنية الرسمية، وإن كان ظهور قصيدة النثر قد جعل بعضهم يضطر لمنح قصيدة التفعيلة شيئاً من الشرعية، عبر تأشيرة مرور منقوصة .
وإذا كانت قصيدة النثر، قد أسست لمعايير خاصة بها، إلا أنه- حتى الآن - لا يزال بعض دارسي الشعر، يحكم عليها من خلال مقاييس قصيدة العمود، والتفعيلة، كما أن هناك من لا يزال يحكم عليها-سلباً- كابن ضال، لأنها تفتقد إلى الموسيقا الخارجية، من دون أن يعلم بأن الموسيقا الداخلية لهذه القصيدةعالم مستقل له أصوله، وأن هذه الموسيقا لا يتوخى منها “إطراب” المتلقي، اعتماداً على حاسة السمع، بل إن هذه القصيدة تحرك أكثر من حاسة لدى متلقيها تقول الشاعرة ظبية خميس:
يا عصافيرك المهاجرة . . يا أندلس
رغم القرون
فإنها لا تزال مهاجرة
حطت هنا . . ثم أعشاشها غادرت
قصوراً صارت
وجوامع وطرقات .
اليوم هي متحف . . مفتوح
حجر وماء وشجر
وعصافير
غير أنها . . عصافير الأندلس
أينها؟!
استطاعت قصيدة النثر الإماراتية، أن تترك تأثيرها في المشهد الإبداعي الثقافي الإماراتي، حيث كانت حافزاً جد مهم، لتطوير قصيدة العمود نفسها، من خلال نماذج إبداعية منها، كما استطاعت، في الوقت نفسه، أن تواصل تأثيرها في قصيدة التفعيلة، من خلال الاستفادة من بعض تقنياتها تقول الشاعرة ظبية خميس:
حل، وحال، وترحال
فيما المقام لابث حيث كان
للأبد .
لا تنضو عن المرء حزنه
فالملائكة تزوره بين دمعة، وآهة
واصطبار .
من وجوه الأطفال ترقص وجوه أرواح من رحلوا .
وبين أياديهم
تجلس الدنيا والآخرة
صفو الحبيب في عزلته
وصفو المحب في لوعته .
أكبر من كل زمان هو الآن .
لا تصح ففي الصحو الهذيان .
رفقاً بأولي الحال
فهم هناك . . هناك
فلا تطالبهم بأن يكونوا . . هنا .
ويقول أحمد عبيد المطروشي:
كل شيء بلا وقت، أشعلت كبريت الحياة قذفت بالمرساة عالياً لتستقر في الغيم لنرحل سوية جهة السديم .
في صلاتي الطويلة، وأنا مكبل بالأتربة والضباب، الروح سائل بلا موج، الجسد مجرد عبور، هذي تحت الأقنعة نداء يتبع تراتيل الظهيرة أفتح نافذتي أغلق نافذة الوجد المعلقة في العراء وأمتنع عن الكلام .
احتراق الزرنيخ في الجثة واشتعال الفسفور في الرأس، فلن أفكر بالعشق والموت معا، سأسكن في ذاتي فالخوف إشارة فناءأغرقوه فالبياض ويداه ممدودتان جهة اليباب .
قهوة مرة بطعم الخديعة احتسيتها دفعة وذهلت من الفرار، كائنات أرقتني جعلت طقوساً لها دهنت جسدي بالرماد قرعت الأواني طيلة الليل ملأت الغرفة بالبخور، ولم يحدث شيء، سوى شتيمة سمعتها في الخارج .
وبرغم أن قصيدة النثر الإماراتية، استطاعت أن تتموقع على خريطة الشعرية المحلية والخليجية والعربية، وتكون لها علاماتها الفارقة، وخريطتها وتجاربها المتوهجة، فإنه لا تزال هناك ذهنية إقصائية تمارس في حقها من قبل بعض القائمين على بعض المؤسسات الثقافية المعنية، بل إنه لا يزال هناك بعض النقدة الذين يكيلون اتهامات تخوينية ظالمة ضدها، انطلاقاً من هيمنة ذهنية التآمر، أو نتيجة عجز مواجهتها، معتبرين أن كتابتها في منتهى السهولة، وهو أمر مجانب للصواب، في الوقت الذي يمكن فيه كتابة قصيدة موزونة، على أحد بحور الخليل، تمتلك اللغة والبلاغة والموسيقا، وحتى الصور، من دون أن تكون شعراً البتة، يقول علي العندل:
موسيقا الحضور
وأنا
ولا شيء . .
مراراً أقول
رفقاً
ياداء العظمة . .
إلي كل
عكازات العالم
لأهبط إلى
نفسي صعودا
فوق
ممالك الروح
وماسك الأيادي
لزمام النور
للخلاص . .
ابقروا السماء
تجدوا
رأس أفعى
تحت إبطيها
كل العظماء
يبكون . .
على جناية
الانفعال
والليل السكين
القلب
إغراء القرط
الموت
البحر الحجاب
لا زال
يدخر الأمواج
الأنا مقتل
فماذا هي المرشية؟
الكلمات قاحلة
والأرض الصحراء
تكتب
على أوراق الشجر
طوطم “الرمرام”
لا أفقه . .
تأسيساً على ما سبق، فإن اعتبار قصيدة النثر مكوناً فاعلاً في الشعرية الإماراتية، ليعني إشراكها في كل ما هو متاح لسواها، ورفع ما يشبه الحظر عنها، نتيجة عرقلة خصومها سبل تواصلها بجماهيرها أنى أتيح لهم ذلك (وأكبر دليل على ذلك تهميش شعراء العقد الأول من الألفية الجديدة) لتكون لها مؤتمراتها ونقادها ونصوصها المعتمدة في المناهج التربوية، بل ومسابقاتها الخاصة، وأن يتم تكريم روادها لأنهم من الأصوات الأكثر بروزاً في المشهد الإبداعي المحلي، وإن انحسار هذه القصيدة ليعني قطع شريان جد مهم في الشعرية الإماراتية يقول الشاعر إبراهيم الهاشمي:
صفحاتك الأولى
دم مسفوح
يؤرخ للغياب والحضور
للفجيعة والفرح
يلد التململ
يشجيني
فأضم أطراف الهوى
تأريخ انكسار الروح
أجول أجواء القطيعة
كي يمجدني الحضور
ما عاد اسمك خائفاً
في دفتري
يطوف أطراف البلاد
من البعاد إلى البعاد
وفي فمي حجر
يرد أطراف الحديث
غاب الربيع
على أمل
مزدوج أنا
كقلب الطفل
وأحياناً حجر .
08/01/2011