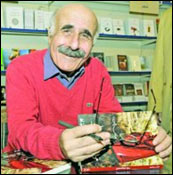 في طفولتي. كان لكل زمرة من الأطفال ولد موجّه، يستشار في أمر اللعب ويختار للزمرة لعبتها. يوزع الأولاد كما يرى ويردّ الواحد الى مكانه إذا شعر بأنه يزوغ منه. كان الأولاد يصادقون على من يتصدى منهم لهذا الموقع ثم يختار هو من يريده للزمرة، انه النموذج البدئي للزعيم. كنت في زمرة من أقارب جمعتنا تلك الخشية من ان ترفضنا الزمر أو ذلك الحرج من ان يسوسنا زعيمها بالتهكم او الهزء فلسنا ممن ينصاع بسهولة، لا لتمرد في طبعنا وانما في الأغلب لخجل وتعثر يمنعاننا من ان نؤدي الأمر على وجه صحيح. نخشى من غلطة أساتذتنا وموجهينا أياً كانوا، ويجعلنا هذا الخجل أقرب الى ان نخطئ ونعثر. ثم اننا كنا غالباً من أسر يصعب وصفها بالشعبية، كان أبي متكلماً وأديباً وكان بعض أهل زمرتي يدلون بنسب مزعوم أو سعة في الرزق او مهنة منظورة. كنا في الحقيقة ابناء هوامش لم تستقر بعد على وضع فأهل النسب يشحب نسبهم مع الأيام وأهل الرزق يشح رزقهم وأهل المهن تتضاءل مهنهم. كنا غير أكيدين من امكنتنا ومواضع أقدامنا. في الحقيقة كنا في نوع من لا مكان. جمعنا الخوف من أمكنة قائمة، والعجز عن أن نتراتب في زمرة حقيقية. كان لبعضنا دالة على الغير لكنها لا تكفي لزعامة. وإذا وجد في نفسه داعياً للزعامة لا يجد من يقرّ له بها، وإذا تسلط فعلاً فعلى واحد أصغر هو في الأغلب أخ صغير. لم يكن بيننا من يحسم والوصول الى الكلمة الأخيرة يتطلّب جدالاً وأحياناً تنازعاً، لم أكن في الغالب مبرزاً فيهما، فمثلي لا يكترث بأن تكون له كلمة في أمر قد تتساوى فيه الخيارات، يهمني ان ألعب ولا أتشبث بلعبة دون غيرها وبخاصة إذا شعرت ان التشبث عناد بحت او مماحكة غايتها الأولى إملاء النفس او الرأي. لم أكن غالباً صاحب رأي في شيء كهذا وأسعى غالباً الى تسوية ما. فأنا لا أفاضل كثيراً بين الألعاب ثم انني لا أجد هيناً عليّ أن أتشبث بشيء لمجرد أنه رغبتي. رغبتي لا تكفي سبباً للوقوف عند أمر إلا إذا كانت مقرونة بميل الى إملاء النفس لم يكن في طبعي. كانت لي أنانيتي بالطبع لكن التصدّر بأي ثمن لم يكن في مزاجي. فتصدر يؤتى بالصراخ وبالشغب ليس مستحقاً ولا أريده لنفسي. أريد لها أن تكون مستحقة ولا تحتال على ذاتها. الخلاصة أنني لم أكن طالب صدارة بأي ثمن، وإذا أحللنا لفظة الزعامة محل الصدارة بدا أني لم أكن طالب زعامة بأي ثمن. نحن الآن رغم كل شيء في السياسة، إذ لا يمكنني أن أفك السياسة عن طلب كهذا. لم يكن لداتنا من متزعمي الزمر لا يصلون الى الزعامة إلا بطلبها والإلحاح في ذلك وتقصّده كل مرة بالنزاع او الشغب او المماحكة. لم يكن هناك سوى ذلك من شرط لتزعمهم. قد يكون للجسم والطبع دخل في ذلك لكن الأولى هو للغريزة إذا كان لنا ان نتكلم عن غريزة للزعامة. لا يتساوى الأولاد في هذه الغريزة فهي ضعيفة في بعضهم او غالبهم. هؤلاء يجيبون على طلب الزعامة بالقبول والإذعان. لم يكن المتزعمون أقدر على سياسة الآخرين فليسوا أذكى ولا أوسع حيلة وليسوا دائماً أقوى جسدياً، فقد يكون بين أتباعهم من يفوقهم ذكاء وحسن تخلص بل وقوة جسد أيضاً. لكن هؤلاء ليسوا ببساطة طلاب زعامة. لن تكون مصائر هؤلاء الزعماء الصغار متطابقة بالضرورة مع أوائلهم. بعضهم انتهى بأوخم عاقبة في مصح عقلي او في أسافل المجتمع. بعضهم بقي زعيماً على زوجته وأولاده وليس له بغير ذلك صدارة او أولوية. وعدد منهم أبّنت ما بينه وبين السياسة منذ ذلك الحين. سيكون غريباً ان نعلم ان بعض الذين تربوا على اللعبة ووجدوها في الأساس هينة وغير ذات بال، إن الذين لم يطلبوا الزعامة ولم يكترثوا لها، أي انهم لم يكترثوا لسياسة الصغار كلها ولم تشغلهم بحال، ان بعض هؤلاء، وهو لا يزال على هذه الصفة، اشتغل بالسياسة بل وجدها على طريقة فكانت سياسته لذلك محكومة بشغف ليس في أصل السياسة ولا من شروطها. فقد كانت سياسة هؤلاء بدرجة أولى محاولة لفهم الذات ومغامرة أخلاقية، كانت السياسة عند هؤلاء تطهيراً من السياسة، بل هي الى حد كبير نقيضها. لا تكفي المحاكمة الأخلاقية التي تدين التحايل والتخابث والتخريج والتخلص والمواربة والمراعاة وهي عناصر لا ينفك عنها الخطاب السياسي، بل الأرجح أن خطابة اخرى حلّت محل خطابة وأقانيم حلت محل اقانيم. حل الشعب محل الأمة، وحرب الشعب محل التحرير ومحل الثورة واستبدلت البورجوازية الصغيرة بالطبقة العاملة، لكن المبدأ الأساسي وهو لا يختلف عن الحلول (أي الحلولية في الشعب والدولة والبروليتاريا) ظل هو نفسه، فالشعب والطبقة الكادحة هما مفهومان فوقيان نتماهى بالروح معهما، ونعزو إليهما قدرات هائلة على الخلق والتجديد. كنت من هؤلاء الذين ألّهوا التاريخ وما عناني من الماركسية أولا هو رؤية التاريخ كمعركة دائمة وقوة خلق اولى، وكأن امتلاك الزمن مرة واحدة والقدرة على تفسيره وتوقعه، هو ما بدا لي انه سحر الماركسية. كان الزمن ولا يزال عقدتنا ووسواسنا فمن ماضٍ ملحمي يملك كل مخيلة الملحمة، أي الإسقاط البطولي على شبه تاريخي الى شبه زمن، لا بد ان ملحمية التاريخ هي بعض ما عنانا من الماركسية، فامتلاك الزمن او القدرة على فك ألغازه كانا يمنحان سلطة على الحاضر العدو وقدرة على استعادة الماضي البهي. امتلاك الزمن كان بدون شك يطابق تعطشنا القاتل لنكون في وقت واحد في الحاضر والماضي، ونوجد هكذا في زمن مطلق تجعله ملحميته واتصاله فوق الواقع او خارجه. كانت السياسة بالنسبة لنا أقل من التاريخ، بل هي شر لا بد منه وعالة على التاريخ. إنها إجراءات وقتية ولا بد فيها من حسابات صغيرة، حسابات الوقت والظرف والإمكان، حسابات ما ينبغي ان يظهر وما يجب ان يختفي، وما نعلنه وما نوارب فيه، وما نراعيه ونسايره. كانت السياسة عندها يوميات العالم بينما التاريخ تحولاته. السياسة تسلسل واتصال والتاريخ قطع وتغيير، السياسة أداء والتاريخ ملحمة، السياسة نثر العالم والتاريخ شعره، نعم السياسة حكاية والتاريخ ملحمة. السياسة تراكم والتاريخ عاصفة. كان التاريخ بالنسبة لنا هو «عشرة أيام هزت العالم» هذه الأيام العشرة كنا نبحث عنها في ماضينا وماضي الآخرين، وقد نجدها وقد نخترعها لكنها على كل حال تبقى زمناً ليس من الزمن. إنه الزمن وقد تحوّل هزة وقد تضاعف وانقلب طاقة خالصة ودينامية صافية، الزمن وقد غدا فعلاً كاملاً، الكلمة وقد صارت قوة. لا بد أن السياسة التي عرفناها لم تزد عن ان تكون حرتقات الضيع وحراك مفاتيح الانتخابات وسير شيوخ العائلات والمتزعمين، لا بد أنها كانت جزءاً من ضجرنا اليومي وشيئاً من فراغنا المداوم ومن رتابة حياتنا وعارها. كنا نفهم من السياسة انها اللامعنى، وانها التكرار، وانها المراكمة الفارغة، وانها القشور والطلاء وانها البلادة وقلة الإحساس، وانها الحساب البطيء ان لم يكن الميت. نفهم من السياسة انها مرض حياتنا ونتأباها. ولم يكن هيناً علينا ان نسمي نضالنا سياسة ونجمعه بالسياسة جمعاً متعسفاً، من دون ان ننتبه او نهتم بأن ننتبه بأنه بمثابة النقيض للسياسة، وانه أيضاً نقيض للتاريخ، واننا لسنا في هذه ولا ذاك. سياستنا مبتورة منقطعة لا تواصل ولا تراكم فيها ومكاننا في التاريخ ضائع مجهول. لم ننتبه او نهتم بأن ننتبه الى اننا مجدداً كما كنا أولاداً، لسنا في أي مكان، وان ما نظنه مكاناً ليس سوى تجنب ومحايدة، ليس سوى ما نملأ به لامكاننا من تصورات وأخيلة، وأننا حين نتصادق ونلتقي وننخرط او نؤسس أحزاباً ومنظمات انما نستعيض بالشغف والتجمع والتواصل عما فاتنا ان نصيبه بالتدخل والعمل والتواجد الفعلي. «كنا نبحث عن أشباه لنا وما ان نجدهم حتى تتكفّل الاجتماعات المتلاحقة والطويلة بتأسيس صداقاتنا فضلاً عن تعميقها. كان التنظيم يتحول إذاً الى رادار روحي كبير وبدون ان ننتبه يلبي لنا حاجات اجتماعية، يتحول شيئاً فشيئاً الى نوع من أخوية نتقاسم فيها، لا الطعام والشراب وحدهما، ولكن السهر واللقاء والتجول وتبادل المعارف والخوض معاً في أشياء نفهمها ولا نفهمها. في ذلك كله كانت السياسة تتحول الى شغف وتلهف وتعطش روحي، ولم يكن واضحاً لنا كيف نباشرها او نطرق أبوابها فقد كنا طوال الوقت على مقربة منها. كنا نفكر اننا لم نبدأ بها بعد، بل هي لم تبدأ بعد ونحن ماثلون إليها، حاضرون متأهبون في انتظارها كما كان هيديغر يتكلم عن الفكر. هذه البداية المرتقبة طالما تلهفنا إليها وطالما تقلبنا في تشوّقها وانتظارها وطالما أيقنا انها لا بد آتية، لكن أوقاتاً كانت تمر علينا نشعر فيها بأننا نتقلب في فراغ، واننا في صلب مغامرة دونكيشوتية لن تنتهي إلا بما يشبه تخيل المردة والعماليق ومحاربة طواحين الهواء». هذه البداية طال توقعها والأرجح انها لم تبدأ أبداً، كنا نواربها وندور حولها لكننا لم نصل في يوم الى عمقها ولم نجد السبيل إليها، حتى بدا لنا اننا لن نبدأ أبداً. ذلك ما ألزم البعض بالرحيل باكراً وألزم الآخرين برواية دونكيشوتية تماماً يتخيّلون فيها، أن اجتماعاتهم الموغلة في الطول واتصالاتهم المحدودة، حرب حقيقية.
في طفولتي. كان لكل زمرة من الأطفال ولد موجّه، يستشار في أمر اللعب ويختار للزمرة لعبتها. يوزع الأولاد كما يرى ويردّ الواحد الى مكانه إذا شعر بأنه يزوغ منه. كان الأولاد يصادقون على من يتصدى منهم لهذا الموقع ثم يختار هو من يريده للزمرة، انه النموذج البدئي للزعيم. كنت في زمرة من أقارب جمعتنا تلك الخشية من ان ترفضنا الزمر أو ذلك الحرج من ان يسوسنا زعيمها بالتهكم او الهزء فلسنا ممن ينصاع بسهولة، لا لتمرد في طبعنا وانما في الأغلب لخجل وتعثر يمنعاننا من ان نؤدي الأمر على وجه صحيح. نخشى من غلطة أساتذتنا وموجهينا أياً كانوا، ويجعلنا هذا الخجل أقرب الى ان نخطئ ونعثر. ثم اننا كنا غالباً من أسر يصعب وصفها بالشعبية، كان أبي متكلماً وأديباً وكان بعض أهل زمرتي يدلون بنسب مزعوم أو سعة في الرزق او مهنة منظورة. كنا في الحقيقة ابناء هوامش لم تستقر بعد على وضع فأهل النسب يشحب نسبهم مع الأيام وأهل الرزق يشح رزقهم وأهل المهن تتضاءل مهنهم. كنا غير أكيدين من امكنتنا ومواضع أقدامنا. في الحقيقة كنا في نوع من لا مكان. جمعنا الخوف من أمكنة قائمة، والعجز عن أن نتراتب في زمرة حقيقية. كان لبعضنا دالة على الغير لكنها لا تكفي لزعامة. وإذا وجد في نفسه داعياً للزعامة لا يجد من يقرّ له بها، وإذا تسلط فعلاً فعلى واحد أصغر هو في الأغلب أخ صغير. لم يكن بيننا من يحسم والوصول الى الكلمة الأخيرة يتطلّب جدالاً وأحياناً تنازعاً، لم أكن في الغالب مبرزاً فيهما، فمثلي لا يكترث بأن تكون له كلمة في أمر قد تتساوى فيه الخيارات، يهمني ان ألعب ولا أتشبث بلعبة دون غيرها وبخاصة إذا شعرت ان التشبث عناد بحت او مماحكة غايتها الأولى إملاء النفس او الرأي. لم أكن غالباً صاحب رأي في شيء كهذا وأسعى غالباً الى تسوية ما. فأنا لا أفاضل كثيراً بين الألعاب ثم انني لا أجد هيناً عليّ أن أتشبث بشيء لمجرد أنه رغبتي. رغبتي لا تكفي سبباً للوقوف عند أمر إلا إذا كانت مقرونة بميل الى إملاء النفس لم يكن في طبعي. كانت لي أنانيتي بالطبع لكن التصدّر بأي ثمن لم يكن في مزاجي. فتصدر يؤتى بالصراخ وبالشغب ليس مستحقاً ولا أريده لنفسي. أريد لها أن تكون مستحقة ولا تحتال على ذاتها. الخلاصة أنني لم أكن طالب صدارة بأي ثمن، وإذا أحللنا لفظة الزعامة محل الصدارة بدا أني لم أكن طالب زعامة بأي ثمن. نحن الآن رغم كل شيء في السياسة، إذ لا يمكنني أن أفك السياسة عن طلب كهذا. لم يكن لداتنا من متزعمي الزمر لا يصلون الى الزعامة إلا بطلبها والإلحاح في ذلك وتقصّده كل مرة بالنزاع او الشغب او المماحكة. لم يكن هناك سوى ذلك من شرط لتزعمهم. قد يكون للجسم والطبع دخل في ذلك لكن الأولى هو للغريزة إذا كان لنا ان نتكلم عن غريزة للزعامة. لا يتساوى الأولاد في هذه الغريزة فهي ضعيفة في بعضهم او غالبهم. هؤلاء يجيبون على طلب الزعامة بالقبول والإذعان. لم يكن المتزعمون أقدر على سياسة الآخرين فليسوا أذكى ولا أوسع حيلة وليسوا دائماً أقوى جسدياً، فقد يكون بين أتباعهم من يفوقهم ذكاء وحسن تخلص بل وقوة جسد أيضاً. لكن هؤلاء ليسوا ببساطة طلاب زعامة. لن تكون مصائر هؤلاء الزعماء الصغار متطابقة بالضرورة مع أوائلهم. بعضهم انتهى بأوخم عاقبة في مصح عقلي او في أسافل المجتمع. بعضهم بقي زعيماً على زوجته وأولاده وليس له بغير ذلك صدارة او أولوية. وعدد منهم أبّنت ما بينه وبين السياسة منذ ذلك الحين. سيكون غريباً ان نعلم ان بعض الذين تربوا على اللعبة ووجدوها في الأساس هينة وغير ذات بال، إن الذين لم يطلبوا الزعامة ولم يكترثوا لها، أي انهم لم يكترثوا لسياسة الصغار كلها ولم تشغلهم بحال، ان بعض هؤلاء، وهو لا يزال على هذه الصفة، اشتغل بالسياسة بل وجدها على طريقة فكانت سياسته لذلك محكومة بشغف ليس في أصل السياسة ولا من شروطها. فقد كانت سياسة هؤلاء بدرجة أولى محاولة لفهم الذات ومغامرة أخلاقية، كانت السياسة عند هؤلاء تطهيراً من السياسة، بل هي الى حد كبير نقيضها. لا تكفي المحاكمة الأخلاقية التي تدين التحايل والتخابث والتخريج والتخلص والمواربة والمراعاة وهي عناصر لا ينفك عنها الخطاب السياسي، بل الأرجح أن خطابة اخرى حلّت محل خطابة وأقانيم حلت محل اقانيم. حل الشعب محل الأمة، وحرب الشعب محل التحرير ومحل الثورة واستبدلت البورجوازية الصغيرة بالطبقة العاملة، لكن المبدأ الأساسي وهو لا يختلف عن الحلول (أي الحلولية في الشعب والدولة والبروليتاريا) ظل هو نفسه، فالشعب والطبقة الكادحة هما مفهومان فوقيان نتماهى بالروح معهما، ونعزو إليهما قدرات هائلة على الخلق والتجديد. كنت من هؤلاء الذين ألّهوا التاريخ وما عناني من الماركسية أولا هو رؤية التاريخ كمعركة دائمة وقوة خلق اولى، وكأن امتلاك الزمن مرة واحدة والقدرة على تفسيره وتوقعه، هو ما بدا لي انه سحر الماركسية. كان الزمن ولا يزال عقدتنا ووسواسنا فمن ماضٍ ملحمي يملك كل مخيلة الملحمة، أي الإسقاط البطولي على شبه تاريخي الى شبه زمن، لا بد ان ملحمية التاريخ هي بعض ما عنانا من الماركسية، فامتلاك الزمن او القدرة على فك ألغازه كانا يمنحان سلطة على الحاضر العدو وقدرة على استعادة الماضي البهي. امتلاك الزمن كان بدون شك يطابق تعطشنا القاتل لنكون في وقت واحد في الحاضر والماضي، ونوجد هكذا في زمن مطلق تجعله ملحميته واتصاله فوق الواقع او خارجه. كانت السياسة بالنسبة لنا أقل من التاريخ، بل هي شر لا بد منه وعالة على التاريخ. إنها إجراءات وقتية ولا بد فيها من حسابات صغيرة، حسابات الوقت والظرف والإمكان، حسابات ما ينبغي ان يظهر وما يجب ان يختفي، وما نعلنه وما نوارب فيه، وما نراعيه ونسايره. كانت السياسة عندها يوميات العالم بينما التاريخ تحولاته. السياسة تسلسل واتصال والتاريخ قطع وتغيير، السياسة أداء والتاريخ ملحمة، السياسة نثر العالم والتاريخ شعره، نعم السياسة حكاية والتاريخ ملحمة. السياسة تراكم والتاريخ عاصفة. كان التاريخ بالنسبة لنا هو «عشرة أيام هزت العالم» هذه الأيام العشرة كنا نبحث عنها في ماضينا وماضي الآخرين، وقد نجدها وقد نخترعها لكنها على كل حال تبقى زمناً ليس من الزمن. إنه الزمن وقد تحوّل هزة وقد تضاعف وانقلب طاقة خالصة ودينامية صافية، الزمن وقد غدا فعلاً كاملاً، الكلمة وقد صارت قوة. لا بد أن السياسة التي عرفناها لم تزد عن ان تكون حرتقات الضيع وحراك مفاتيح الانتخابات وسير شيوخ العائلات والمتزعمين، لا بد أنها كانت جزءاً من ضجرنا اليومي وشيئاً من فراغنا المداوم ومن رتابة حياتنا وعارها. كنا نفهم من السياسة انها اللامعنى، وانها التكرار، وانها المراكمة الفارغة، وانها القشور والطلاء وانها البلادة وقلة الإحساس، وانها الحساب البطيء ان لم يكن الميت. نفهم من السياسة انها مرض حياتنا ونتأباها. ولم يكن هيناً علينا ان نسمي نضالنا سياسة ونجمعه بالسياسة جمعاً متعسفاً، من دون ان ننتبه او نهتم بأن ننتبه بأنه بمثابة النقيض للسياسة، وانه أيضاً نقيض للتاريخ، واننا لسنا في هذه ولا ذاك. سياستنا مبتورة منقطعة لا تواصل ولا تراكم فيها ومكاننا في التاريخ ضائع مجهول. لم ننتبه او نهتم بأن ننتبه الى اننا مجدداً كما كنا أولاداً، لسنا في أي مكان، وان ما نظنه مكاناً ليس سوى تجنب ومحايدة، ليس سوى ما نملأ به لامكاننا من تصورات وأخيلة، وأننا حين نتصادق ونلتقي وننخرط او نؤسس أحزاباً ومنظمات انما نستعيض بالشغف والتجمع والتواصل عما فاتنا ان نصيبه بالتدخل والعمل والتواجد الفعلي. «كنا نبحث عن أشباه لنا وما ان نجدهم حتى تتكفّل الاجتماعات المتلاحقة والطويلة بتأسيس صداقاتنا فضلاً عن تعميقها. كان التنظيم يتحول إذاً الى رادار روحي كبير وبدون ان ننتبه يلبي لنا حاجات اجتماعية، يتحول شيئاً فشيئاً الى نوع من أخوية نتقاسم فيها، لا الطعام والشراب وحدهما، ولكن السهر واللقاء والتجول وتبادل المعارف والخوض معاً في أشياء نفهمها ولا نفهمها. في ذلك كله كانت السياسة تتحول الى شغف وتلهف وتعطش روحي، ولم يكن واضحاً لنا كيف نباشرها او نطرق أبوابها فقد كنا طوال الوقت على مقربة منها. كنا نفكر اننا لم نبدأ بها بعد، بل هي لم تبدأ بعد ونحن ماثلون إليها، حاضرون متأهبون في انتظارها كما كان هيديغر يتكلم عن الفكر. هذه البداية المرتقبة طالما تلهفنا إليها وطالما تقلبنا في تشوّقها وانتظارها وطالما أيقنا انها لا بد آتية، لكن أوقاتاً كانت تمر علينا نشعر فيها بأننا نتقلب في فراغ، واننا في صلب مغامرة دونكيشوتية لن تنتهي إلا بما يشبه تخيل المردة والعماليق ومحاربة طواحين الهواء». هذه البداية طال توقعها والأرجح انها لم تبدأ أبداً، كنا نواربها وندور حولها لكننا لم نصل في يوم الى عمقها ولم نجد السبيل إليها، حتى بدا لنا اننا لن نبدأ أبداً. ذلك ما ألزم البعض بالرحيل باكراً وألزم الآخرين برواية دونكيشوتية تماماً يتخيّلون فيها، أن اجتماعاتهم الموغلة في الطول واتصالاتهم المحدودة، حرب حقيقية.
أما كيف فهمنا السياسة فإن مخيلتنا الملحمية أوجدت لها تصوراً بطولياً. كان مَثَلُنا «سبارتكوس» وهو يقود العبيد وبالأخص وهو يواجه إعدامه، فالبطولية لا تستحق اسمها ان لم تقترن بالخسارة وبالموت. هذا تصوّر غذته تربية شيعية ركنها الخسارة والشهادة، توجّت إمامة عليّ بضربة ابن ملحم وإمامة الحسن بكأس السم وإمامة الحسين بمقتله في كربلاء، فالبطولة التي هي غالباً صراع الوحيد ضد الجماعة لا تصحّ إلا وهي متوّجة بالخسارة والموت. إذا كانت السياسة كما يقال فن الممكن فإنها كانت بالنسبة لي ولصحبتي فن الانهزام والموت. لم يكن الربح غاية ولا النجاح فهما سبيل الفساد والتردي والتغيير ولا ينجح امرؤ إلا ويدير النجاح رأسه فينقلب على بداياته ويرتدّ عليها، وإذا عدنا الى التربية الشيعية فهمنا كيف يجازي البطل بالخذلان وكيف يسلمه هذا الخذلان الى نهاية تراجيدية. لم اكن متديناً ولا صحبتي وبالعكس تطاير منا رشاش ضد الدين كما تطاير رشاش ضد الدولة وضد العائلة وضد التقليد. كان هذا رشاشاً فحسب ففي الداخل كان التاريخ المعذب لأئمتنا الشهداء يتواصل في نفوسنا. كانت القضية، هذا الاسم الغامض لشيء أكبر منا نستمرّ بموتهم وبهذا الموت تزداد نبلاً وفتنة وديمومة. لقد ورثنا هذا التاريخ للسلبي وذلك الجواب بالنفي وتلك الخسارة المتمادية. كانت حمل القضية أهم من نجاحها غير المضمون، وفك لغز هذا الزمن الخوان العامر بأسباب الغدر أقرب بكثير من تبديله وتغيير وجهته. كانت المعرفة بغيتنا لا الكسب ولا الانتصار. كان علينا ان نفهم سر تقلب الأحوال والدول لا تغييرها وتشييد سواها.
كانت الاشتراكية على سبيل المثال قضيتنا لكنها كالإمامة بلا زمن معلوم ولا يعنينا من أمرها إلا أنها قضيتنا ولا نقدر إمكانها او تحققها. يكفينا أنها قضيتنا ولا بأس من أن نحملها كالإمامة من جيل إلى جيل. لم نفكر في شروطها وأدواتها بل كنا في شبه يقين من استحالتها. ذلك لم يثننا عنها ولربما ضاعف هتافنا لها وتغنينا باسمها، حتى إذا قامت الحرب الأهلية وأطاحتنا في جملة ما أطاحت، تحققنا من ان قضيتنا لم تكن سوى فقاعة وأوقعنا هذا في إلحاد ثان أو ثالث. عندها تأكد لنا أننا نبيت ونعيش على غير قضية. وأورثنا هذا كآبة لم تنقشع عنا إلى الآن.
كانت قطيعتي مع أهلي وأسرتي وجماعتي ومنطقتي كما هي الحال مع كثيرين من جيلي هينة، لقد كانت تحرّراً وخفة محتملة. لم نشعر بأننا خرجنا من محيطنا وناسنا إلا حين تأكد لنا ارتياب أوساطنا فينا وضعف تأثيرنا فيها. إذ ذاك بدأنا ندفع ثمن هذا الخروج الذي من المستحيل تداركه. فهمنا أن هذه الخفة وفرت لنا قدرة على الحراك لكن إلى أين وفي أي مكان؟ لم ننعم طويلاً بتحررنا إذ بدأنا نشعر بضآلة أوزاننا وافتقارنا إلى فضاء كاف. كنا هكذا في لا مكان ولا بد أن هذا اللامكان جعلنا نستسهل حجز أمكنة لنا في المستقبل، فكنا اشتراكيين وقوميين وعروبيين حسبما تقضي المناسبة. كان اغترابنا هذا يشطّ بنا إلى التماس اغترابات أوسع فكان هذا الكائن الصغير الذي تجرد من كل صفاته ومتعلقاته يحوم في فضاءات أشمل وأرحب بدون أن يدري أنه يوغل أكثر فأكثر في اغترابه ويداوي اغتراباً باغتراب أعمّ.
* * *
كان انتمائي في الثالثة عشرة من عمري إلى الحزب الشيوعي ثمرة نقاش خسرته مع صديق لي في الثامنة عشرة. كان ذلك بعيد انتفاضة 1958 على الرئيس كميل شمعون، وقبيل المؤتمر العشرين الذي انتقد الستالينية، وإبان خلاف جمال عبد الناصر مع الشيوعيين العرب، وفي عهد دولة الوحدة العربية بين مصر وسوريا التي سرعان ما انفصمت. كنا في مفصل سياسي بيد أن هذا الازدحام لم يوات الحزب الشيوعي الذي ضاع فيه تماماً وجعله النبذ الجماهيري إثر الخلاف مع عبد الناصر مشلولاً أو كالمشلول. كان أكثر ما تعلمناه هو طقوس الاجتماع الحزبي، طقوس السرية التي تقضي بأن نتوافد إلى الاجتماع في أوقات متباينة ومن جهات متباينة، اما الاجتماع نفسه فكنا لا نفعل فيه شيئاً. كنا تلامذة وطالبنا بشيء من التثقيف بيد أن الحزب كان صفراً من المثقفين ووعدنا بأن نتلقى دروساً في تاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي، لكنه وعد لم يتحقق. كنا في بطالة لم تلبث أن تحولت إلى برم جرّ تقاعساً. هكذا بدون أي سبب واضح توقفت الاجتماعات ولم يعن هذا خروجنا من الحزب الذي بقينا فيه وبدون علمنا وإلى أمد غير معلوم.
لن أعود إلى العمل الحزبي الا بعد عشرة أعوام. كان نقد الستالينية قد رسخ خلالها وجر معه نقد التجربة السوفياتية بالكامل، وكانت التروتسكية والماوية قاعدتين لهذا النقد، وصار نقد البيروقراطية وهيمنة الحزب الواحد ونشوء طبقة حزبية مسيطرة من شبه البديهيات. انعكس هذا على نقد ممارسة الحزب الشيوعي اللبناني وعقدته تحالفات الحزب وتقديره للعلاقات الطبقية في المجتمع اللبناني ناهيك عن تبعته للاتحاد السوفياتي. عدت إلى عمل حزبي هو هذه المرة خارج الهوية التقليدية فهو أقرب إلى الانشقاق والهرطقة، كان عملاً يناسب جملة مبادئ تجمعت لي أثناء عطلتي الحزبية. كانت الحرية حرية الفكر وحرية الفرد وحرية القاعدة وحرية الجسد عنوان ثورة مؤجلة، فيما كان المتاح لا يزيد عن نقاش على قارعة الطريق مع مرشح للاتصال الحزبي، وتسلل إلى داخل معمل او محترف في ضاحية بيروتية أو قرية نائية.
كانت منظمة العمل الشيوعي في لبنان ثمرة تأزم ثلاثة أحزاب قومية ويسارية، حركة القوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي. هزيمة، الـ67 شكلت التحدي الذي لم تستطع التنظيمات الثلاثة الجواب عليه بل كانت بتحالفاتها أو سلطاتها جزءاً من خسارة التحدي. من الممكن بالطبع العودة تفصيلياً إلى سجال تلك الآونة. غير ان الرياح حملته بعيداً. لم يبق من الثورة القومية والثورة الاشتراكية الا ذكريات شبحية، حوصرت الثورة الفلسطينية في كل مكان انتقلت إليه وسلمت بوجود عدوها الذي لم يبادلها بالمثل، اما النظم الاشتراكية فتحولت إلى استبداديات كونت بنفسها طبقتها الخاصة واستغلت الدولة لذلك مستثمرة أسوأ ضروب الفساد والتسلط. أما الحلم القومي فانتهى إلى وصايات وتحكم من الكبير بالصغير، لم يبق للعمل الاشتراكي والعمل القومي النسخة التي بدا في يوم أنها متاحة مفتوحة.
لو تمعنا في اسم منظمة العمل الشيوعي في لبنان لاحترنا قليلاً تجاه عبارة «في لبنان». فلماذا لم تكن منظمة العمل الشيوعي اللبناني مثلاً. من الواضح ان «في لبنان» تفتح المجال لغيَّات أخرى وبالفعل نشأت منظمة عمل شيوعي في سوريا لقيت مصيراً فادحاً. في هذه كانت الضامن للبنانية التنظيم بدون الجمود عند هذه اللبنانية وتحويلها إلى مبدأ ثابت وأقنوم. لم يكن انتقال المقاومة الفلسطينية إلى لبنان عارضاً بالنسبة إلى المنظمة فهذا الحدث كان سبباً في وجودها، بل كان وجود المنظمة بالدرجة ذاتها التفافاً على هذا الحدث وتصدياً له. اسم المنظمة يوحي بالخشية من ان يجرف هذا الحدث لبنان ولبنانية العمل السياسي، انه توكيد على هذه اللبنانية بدون اقنمتها واعتبارها جوهراً. توكيد على استقلالها وانفرادها. «في لبنان» مراوحة بين الداخل والخارج. دينامية بين لبنانية الحركة وعروبتها. أي انها فرض استقلال مفتوح.
كانت المنظمة رغم استقلالها النظري ولبنانيتها المتهاودة واستلهامها الأوروبي تستند بالدرجة الأولى إلى دخول المقاومة في الواقع اللبناني. كانت لبنانية لكنها تريد ان تستثمر وجود المقاومة لبلورة هذه اللبنانية وإيجادها في الأساس مع ما في ذلك من مفارقة. لم يكن الواقع اللبناني ثورياً في نظر المنظمة فهذا الواقع يعاني من تكلّس سببه الاستفادة من كل الكوارث العربية فقد استفاد لبنان من سقوط فلسطين وقيام الأنظمة العسكرية واكتشاف البترول، وانتفاعه هذا جعله عصياً على الثورة. كانت المقاومة الفلسطينية بالنسبة إلى المنظمة أداة لتفجير الوضع اللبناني من الداخل وإلحاقه بالعمل الثوري. هذه النظرية كانت نظرية الحرب الأهلية بالكامل، لقد أدى دخول المقاومة الفلسطينية إلى تفجير الوضع اللبناني وعرّضه لحرب أهلية طاحنة بدا لوقت طويل انها لن تنتهي. تفجر الوضع اللبناني وتشظّى لكن الثورة لم تكن تنتظرنا كما حسبنا على الطريق، انتجنا نظرية الحرب الأهلية لكنها لم تكن بحاجة إلى نظرية لتقوم. أنتجنا النظرية ولحسن الحظ توقفت مساهمتنا هنا. فقد كنا ثانويين للغاية في هذه الحرب.
لم يصدمنا الانشقاق الأول. كان صغيراً واعتبرناه تكتلاً شخصياً، لم يخطر لنا أن التوكيد على لبنانية التنظيم المفتوحة وسط حرب، يستحيل فرز لبنانيتها من عربيتها، سيستفزّ بعضاً من منظمة الاشتراكيين اللبنانيين التي تولّدت من حركة القوميين العرب. فاجأنا هذا الانشقاق لكننا لم نعتبره إنذاراً. لم نفهم ان استقلالية التنظيم ستلقي عليه عبئاً باهظاً في حرب لها كلفتها إن على مستوى التفرغ او مستوى التسليح، كان لا بدّ من سند عربي او فلسطيني لكن هذا السند لن يدفع بدون ثمن سياسي.
كان الداعي للمؤتمر الأول والأخير للمنظمة ما اعتبر آنذاك فوضى تنظيمية. كان التنظيم دوامة نقاش لا يهدأ، صاعد هابط يخترق المراتب كلها، يصعد من الأدنى إلى الأعلى ويهبط من الأعلى إلى الأدنى بدون أن يتوقف للحسم في أحدهما. بدا التنظيم لذلك منتدى نقاش مثابر وليس لأي من حلقاته سلطة عليه. كان هذا أبعد ما يكون عن المثال البلشفي، وهال كثيرين من منظميه ان يكون جوّاً ومناخاً أكثر مما هو نواة حديدية. فالبعد عن المثال اللينيني غير مغفور في أي ظرف ولا يبرره ان الانتظام البروليتاري يحتاج إلى بروليتاريا كانت مفقودة تماماً في قاعدة التنظيم وبقية حلقاته. لا يبرره ان التنظيم كان في حقيقة أمره أقرب إلى نادي مثقفين يساريين وكان بوسعه على هذا الشكل ان يكون نافعاً بل وفاعلاً لا كحزب بلشفي بالضرورة، ولكن كمختبر نظري وورشة فكرية. كنا بلاشفة بالنية والتهيؤ والمركزية الديموقراطية كما عبر عنها لينين حجة قاطعة ولا مجال للأخذ والرد معها. لذا استبدّ العجب حين تجاسرت خلية في التنظيم على نقض هذا التنكر البلشفي. أظنها خلية انغلز وأظنه حسن قبيسي الذي كتب تقريراً مفاده ان التنظيم لقاء مثقفين وما يجري فيه يغلب عليه مزاج المثقفين وتنافسهم، فليس علينا ان نبحث في خلافاتهم عن مدلول طبقي او نحكّم فيه قاعدة لينينية كالمركزية الديموقراطية. قال التقرير ما مفاده أيننا من التنظيم البلشفي لنطبق قواعده. لم يطرح مسألة التظاهر البلشفي برمتها، لم يتساءل عن مدى مناسبتها للتنظيم بل للعمل السياسي اليساري في جملته عندنا. قال ان التنظيم تنظيم مثقفين والصراعات في داخله لا تزيد عن مباريات المثقفين وتنافسهم. بدا هذا الكلام في عز تمثل التجربة البلشفية سطحياً وبلا سند، بل بدا وكأنه ينسى الفباء الماركسية، اذ كيف يمكن للأفكار ان تتصارع على غير طائل وبدون عواقب طبقية وسياسية، انحشر تقرير انغلز في هذه الزاوية ومنعه التقليد اللينيني عن الخروج منها، فبدا موقفه ضعيفاً وكأنه يقدم صراعاً للأفكار على صراع المصالح. قال التقرير إنها مباريات مثقفين والحقيقة ان التظاهر البلشفي انتصر في هذه المباراة. في أول ممارسة للمركزية الديموقراطية واجه المكتب السياسي قيادة القطاع العمالي ولا يخدعنا الاسم فقيادة القطاع العمالي كانت من صنف الأساتذة الذين كان منهم المكتب السياسي. مباراة المثقفين كانت هنا لكنّ المكتب السياسي استعمل سلطته بمجرد ان امتلكها، جمّد قيادة القطاع العمالي فانتصر له نصف التنظيم وكان الانشقاق الثاني الذي أطاح بهذا النصف. هكذا اختنقت في مهدها تجربة فريدة حقاً لو توفر لها مزيد من الصبر ومزيد من الحس بالواقع. لكان أمكن لتنظيم المثقفين لو اعترف بحقيقته ان ينتج كثيراً في هذا الحقل فقد أنتج في وقت قصير. كانت العبارات والحركات والمفاهيم تنتقل فيه بسرعة كبيرة حتى كأن كوادره تتلقى التربية النظرية إياها وكأنها تغدو في مدى أشهر مشكّلة من عناصر متقاربة متشابهة. كانت تجربة المنظمة فريدة بهذه القدرة على التربية النظرية فحسب، ولكن أيضاً باستقلالها الحقيقي. لم يجعلها نقد التجربة السوفياتية تنحاز إلى الصين الماوية بدون شروط، فحين أيّدت الصين النظام المصري والنظام السوداني الذي ذبح الشيوعيين انتقدتها بدون هوادة. كانت فريدة أيضا بديموقراطيتها الداخلية التي أتاحت لكل خلية ان يكون لها موقف وأن تعممه على التنظيم كافة وأن تحظى بمناقشته في كل المستويات، أما مثقفوها فامتازوا فعلاً عن ذلك بأخلاقية تترفع عن الأداء البيروقراطي والتزعم الرخيص.
لم تكن المركزية الديموقراطية وحدها تدخل في التظاهر البلشفي بل كان التقرير السياسي للمؤتمر الأول والأخير نفسه خلاصة لهذا التظاهر إذ جمع فتات التجربة القصيرة للتنظيم في المجال العمالي، وهي تجربة تتّصل بمعامل قليلة في بيروت والجنوب ليستنتج منه خارطة طبقية كاملة، بل ليستنتج منها الوضع اللبناني المرئي في حدود المواجهة الطبقية المحتملة علماً بأن هذا التقرير صيغ والبلد على اعتاب الحرب الأهلية. كنا نفتش عن بدايات ونريد لهذه البدايات ان تبدأ منا. أن تكون تجاربنا الصغيرة والمختلفة أحياناً هي البداية. أظن ان هذا ظل زمنا طويلاً علة سياستنا فسياستنا كانت ذلك الحين بحثاً عن بداية لا تبدأ. كنا نتخيل هذه البداية او نختلقها لكننا لا نلبث ان نعود إلى نقطة الصفر. هذا ما جعل السياسة لعبة ميتافيزيقية، انها كن التي لا تكون، او انها ضرب من العبث. انها حراك في مكانه ولا يتحول إلى انتقال، نوع من مراوحة لا تخطو ولا تتغير. كنا نخاطب شعباً لم يتكوّن بعد، وجمهوراً لم يتحقق وطبقة لم توجد. كان علينا أن نجد الشعب أولاً أو نجد الجمهور أو نجد الطبقة. كان هذا بالطبع محالاً، لكن هناك فسحة للخيال بأننا فعلناه وأن اتصالات قليلة بعمال تخلق الطبقة العاملة، وإضراباً صغيراً يخلق التاريخ. كنا هكذا نراكم اجتماعات واتصالات لنفهم في لحظة مؤاتية او غير مؤاتية اننا لم نفعل شيئاً، وإننا لا نزال على العتبة وسنبقى على العتبة، فثمة قوة شبه ميتافيزيقية تمنعنا من تجاوزها وتبقينا صامدين او جامدين عليها.
كان الرأي الواحد يطرد غيره أو يخرج الرأي الآخر حين لا يجد مكاناً لنفسه، هكذا خرج أنصار الصين حين انتقدت قيادة التنظيم سياستها. كان في وسع هذه الأفكار أن تتجاور وتتسالم لولا أن المركزية الديموقراطية كانت تنصّب قيادة واحدة على تنظيم يسير إلى الخواء بسرعة ويفقد أسبابه ووجوده. لم ترد المنظمة أن تكون نادي مثقفين لكنها أتاحت لأضرى حروب المثقفين أن تعصف فيها. اليوم لا ندري اين صارت المنظمة، أظن أنها موجودة في عشرات الخارجين منها الذين يساهمون الآن، كل من موقعه، في صناعة الثقافة في لبنان. لقد كانت المنظمة طوراً من أطوار الثقافة اللبنانية بل يسعنا القول إنها أشرت إلى طور جديد في الثقافة اللبنانية. لا بد أن لها سهماً واضحاً في التفات هذه الثقافة إلى الواقع اللبناني وفي العكوف على تفصيله وأرشفته، ولا بد أن لها سهماً في خروج الثقافة من سبحانيتها وسماويتها وعودتها إلى كثافة الواقع وتعقيده وتناقضاته. يمكننا ان نجد ذلك في الفكر كما نجده في الفن، كانت المنظمة رافعة تحول ثقافي ساد بعد عقود من هيمنة روح نبوية أو مفارقة، ولا بد انها بذلك قدمت الكثير إلى الحداثة العربية.
[ نص محاضرة ألقيت في الجامعة الأميركية في بيروت ضمن برنامج أنيس المقدسي
السفير
10-6-2011