" لنحذر الثورات: فالعنف يولّد العنف، وغالبا ما أثبت لنا التاريخ أن اليوتوبيا أمّ الديكتاتور"
فاتسلاف هافل
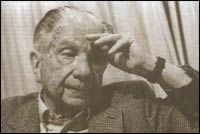 من "خريف البطريرك" و"الجنرال في متاهته" مع غبرييل غارثيا ماركيز، مرورا بـ "عيد التيس" لماريو فارغاس يوسا، وصولا إلى "أنا، فرانكو" بقلم مانويل فاسكيث مونتالبان و "Mea Cuba" لغييرمو كابريرا إنفانتي، فضلا عن أعمال خوسيه غاسبار رودريغيز وغيره من فضّاحي الظلم والاضطهاد والتوتاليتارية، لم ينجُ أي ديكتاتور تقريبا في أميركا اللاتينية واسبانيا من براثن الأدب الشرسة وعدالته المسنّنة: تروخييو، بوليفار، كاسترو، بينوشيه، ستروسنر، فيديلا، فرانكو، الخ... جميع هؤلاء نالوا قسطهم من سكاكين الكبار الذين أظهروا مدى طغيان الأنظمة الديكتاتورية وسخافتها ووحشيتها ومحدوديتها. ومن غير المبالغ أن نقول اليوم إن أبرز "المنصفين"- وإن أقلّهم شهرة- هو الروائي والشاعر الباراغواياني الكبير روا باستوس، الذي توفي منذ أيام عن 88 عاما بجلطة في رأسه. ففي تحفته "أنا، الكائن الأسمى"، انقض باستوس على الديكتاتور خوسيه غاسبار رودرغيز دي فرانثيا الذي حكم بلاده بقبضة من حديد بين 1814 و1840، واستعاد بملكة أدبية استثنائية بعضا من ذاكرة جماعية حاول المستبدّ طمسها.
من "خريف البطريرك" و"الجنرال في متاهته" مع غبرييل غارثيا ماركيز، مرورا بـ "عيد التيس" لماريو فارغاس يوسا، وصولا إلى "أنا، فرانكو" بقلم مانويل فاسكيث مونتالبان و "Mea Cuba" لغييرمو كابريرا إنفانتي، فضلا عن أعمال خوسيه غاسبار رودريغيز وغيره من فضّاحي الظلم والاضطهاد والتوتاليتارية، لم ينجُ أي ديكتاتور تقريبا في أميركا اللاتينية واسبانيا من براثن الأدب الشرسة وعدالته المسنّنة: تروخييو، بوليفار، كاسترو، بينوشيه، ستروسنر، فيديلا، فرانكو، الخ... جميع هؤلاء نالوا قسطهم من سكاكين الكبار الذين أظهروا مدى طغيان الأنظمة الديكتاتورية وسخافتها ووحشيتها ومحدوديتها. ومن غير المبالغ أن نقول اليوم إن أبرز "المنصفين"- وإن أقلّهم شهرة- هو الروائي والشاعر الباراغواياني الكبير روا باستوس، الذي توفي منذ أيام عن 88 عاما بجلطة في رأسه. ففي تحفته "أنا، الكائن الأسمى"، انقض باستوس على الديكتاتور خوسيه غاسبار رودرغيز دي فرانثيا الذي حكم بلاده بقبضة من حديد بين 1814 و1840، واستعاد بملكة أدبية استثنائية بعضا من ذاكرة جماعية حاول المستبدّ طمسها.
وروا باستوس، المولود عام 1917 وأحد أهم كتّاب القارة الحارة ومثقفيها، أمضى طفولة بائسة في معمل للسكّر، وشارك وهو كان بعد مراهقا في الحرب التي دارت بين بوليفيا والباراغواي بين 1932 و1935، وهي تجربة تركت اثرا عميقا في نفسه وطبعته بعنفها مدى الحياة. لكن والدته بثت فيه منذ الصغر حب اللغة الاسبانية وسقت خياله، اذ كانت تقرأ له كل ليلة مقاطع من أعمال شكسبير المترجمة ومن الإنجيل المقدس، فضلا عن سردها على مسامعه حكايات وأساطير بلغة الغواراني، وهي لغة سكّان البلاد الأصليين، المتناقلة شفهيا في الدرجة الأولى. ثم تولت مكتبة عمّه الأسقف تثقيفه، إذ شرّعت أمام نهمه عالم التحف الكلاسيكية الاسبانية. هكذا تكوّن باستوس، في رحم غنيّ قائم على خليط من الغواراني والاسبانية، من الشفهية والمكتوبة، من الكلاسيكية والخرافية، منه غرف الأديب قدرته وأسلوبه الخاصين في مزج ما لا يمزج في كتابته لاحقا.
كانت لباستوس ولادات عديدة متعاقبة إلى الكتابة، اذ انه دخل عالمها بداية من باب المسرح، عندما اصدر مسرحيته الأولى، "القهقهة"، عام 1930، التي نالت استحسان النقاد وترحيبهم بصوته المختلف، والتي تلتها مسرحيات أخرى، أجملها "إبن الندى". وكان الشاب يعمل في تلك المرحلة موظفا في أحد المصارف، ثم صحافيا في جريدة محلية في مسقط رأسه "أسونثيون"، مما أتاح له تمويل رحلاته إلى القارة الأوروبية التي كان متشوقا لاستكشافها. ثم ولد الشاعر- الذي لم يعش طويلا للأسف إذ تخلى باستوس عن الشعر في وقت مبكر- عندما أصدر ديوانه الأول "عندليب الفجر وقصائد أخرى" عام 1942، المتزامن مع مساهمته الجوهرية في تشكيل مجموعة "عشّ السعادة" التي أدت دورا حاسما في تجديد بانوراما الآداب والفنون التشكيلية في الباراغواي.
من دون ان ينخرط باستوس يوما في أي حزب، ظلّ طوال حياته يدافع عن الطبقات المحرومة وعن بؤساء بلاده ومظلوميها. ومن فرط حماسة دفاعه هذا، اضطر عام 1947 إلى مغادرة الباراغواي حيث كان يتعرض للاضطهاد من جانب سلطاتها، فاستقر في بوينس ايرس، حيث اعتاش من وظائف صغيرة متنوعة منكبا على نشر جزء كبير من كتاباته، أبرزها ديوانه "بستان البرتقال المضطرم"، وحيث ولد خصوصا باستوس كاتب القصة مع "قدمان فوق الماء" و"الرعد بين الأوراق" اللتين برهن فيهما عن التزام قوي لواقع بلاده الاجتماعي والسياسي. ولم يمرّ وقت طويل حتى ولد باستوس الروائي أيضا، بداية مع "ابن الإنسان" عام 1960، حيث استثمر الكاتب الأساطير والخرافات والرموز والطبيعة التي نشأ عليها ورضع خيالاتها وجعلها محور روايته، ثم مع "أنا، الكائن الأسمى" عام 1974، التي تعتبر من أهم أعماله، والتي سمحت له بالتطرق إلى مراحل موجعة ومنعطفات حاسمة في تاريخ الباراغواي.
"أنا، الكائن الأسمى" هي من دون شك رواية باستوس "الأسمى"، التي تُرجمت إلى عشرات اللغات ونالت شهرة كبيرة في العالم. فبمعزل عن ثقلها الإنساني والسياسي، تتمتع تقنية السرد فيها بمقومات خاصة، اذ انها تفتقر إلى خط زمني ومكاني محدّد وواضح وقابل للرصد، كما لو ان باستوس أراد بمحوه حدود الزمان والمكان ان يحرّر روايته من سجن التجربة الواحدة الضيق، لكي يكسبها بعدا شموليا تدرك بواسطته حاضر القارئ أينما كان هذا ولأي واقع انتمى، وتنطبق على كل الأنظمة القامعة المشابهة التي عاشتها في شكل رئيسي بلدان أميركا اللاتينية. في هذه الرواية راح باستوس ينقب على عادته عن إمكانات الرواية واحتمالاتها المختلفة، وينقل بواسطة تناقضات الشخصية الرئيسية، أي الديكتاتور المصاب بجنون العظمة، كل التناقضات الكامنة في اللغة نفسها. وأبلغ مثال على هذه الضدية داخل الإنسان وداخل اللغة على السواء هو المقطع التالي حيث نسمع "بطله" يقول: "الأمومة الوحيدة الجدية هي أمومة الرجل. إنها الأمومة الوحيدة الحقيقية والممكنة. أنا استطعت ان أتكوّن من دون امرأة، بفضل طاقة ذهني فحسب. لا تنسبوا اليّ أما، ولا أبا، ولا أشقاء، ولا تلصقوا بي وثيقة ولادة. فأنا بلا عائلة. أنا ولدت مني، ومني فقط". وسوف يحول باستوس لاحقا بعض فصول هذه الرواية- التي تشي بطاقات مسرحية جلية- عملا مسرحيا يحمل العنوان نفسه، حصد شعبية هائلة عند عرضه.
عام 1976، وتحت وطأة ضغوط أخرى من النوع "الديكتاتوري الأرجنتيني"، غادر باستوس بوينس ايرس إلى فرنسا حيث علم آداب أميركا اللاتينية في جامعة تولوز حتى عام 1984. في تلك الأثناء، جُرّد من جنسيته الباراغوايانية ومُنح الجنسية الاسبانية، وهي جنسية البلد الذي كرّمه بجائزة ثرفانتس عام 1989. ورغم كل النكران والعقوق الذي حصده من أرضه الأم، لم يتخلّ هذا الوفي الصبور المثابر عن بلاده، وأصرّ على مر جميع أعماله على إعادة خلق لحظات واستحضار شخصيات من تاريخها النازف، مغنيا إياها أحيانا بملامح من سيرته الخاصة. ولم يكتف بالمسرح والشعر والقصة والرواية، بل نشر بحوثا كثيرة وكتب أيضا سيناريوهات أفلام. شاسع وكثيف هو باستوس، ولكن رغم تعدّد وجوهه سوف يظل بالنسبة إلى كثر رجل الرواية الواحدة: إنه ضرب "الحظ" الذي يطيح غالبا بالكتّاب عندما يحصد احد أعمالهم نجاحا كاسحا وقويا ومستديما، فيخنق ما قبله وما بعده على السواء في نظر القراء.
يقول روا باستوس: "أن نكتب التاريخ يعني أن نزوّره، فالتأريخ ينتمي إلى الكتابة التخييلية بقدر الرواية ان لم يكن أكثر. التاريخ رواية من نوع آخر". ولا يظهر هذا الكلام كفر باستوس بالتاريخ بقدر ما يبيّن إيمانه بقدرات الرواية، واقتناعه بأن جزءا كبيرا مما يسمى واقعا ليس سوى لعبة مرايا وانعكاسات وتناقضات وتخيلات شخصية تقضي على عنصر الموضوعية. وهو غالبا ما اعتمد في تركيبه الروائي إلى منطق الوهم والاختراع والجدليات، واحترم الواقع على طريقته، بتواطوء نافذ مع الخيال الذي هو شرط أساسي من شروط أي عملية إعادة بناء. وعندما كان يُسأل: "لماذا تخليت عن الشعر؟ "، كان يجيب بتواضع وانسحاق مذهلين: "الشعر هو الذي تخلى عني. اكتشف أنني لا استحقه. فعندما وعيت وقرأت لكبار شعراء أميركا اللاتينية قلت في سري: ما الإضافة التي يمكنني ان أحدثها هنا؟ من أنا مقارنة بهؤلاء؟ أنا لم أخن الشعر قط. جل ما فعلته هو إنني نقلته من بيت إلى آخر، أي من القصيدة إلى الرواية، مثلما يفعل عاشق يقظ ومتنبّه مع حبيبته، عندما يصطحبها إلى أمكنة أفضل تليق بها أكثر".
كذلك حمل باستوس بصلابة ودأب لواء الدفاع عن حقوق المرأة، مرددا حيثما أتيح له ذلك أنه يعتبرها الكائن المتفوق بين الجنسين، إن لم يكن لشيء فلتفوقها البيولوجي على الرجل، الكامن في قدرتها على الخلق. المرأة في عين باستوس الإنسان والروائي هي "مانحة حياة"، أما الرجل فليس سوى "ملقّح". وربما يعود سبب موقفه هذا إلى دور المرأة الأساسي في صوغ تاريخ الباراغواي، من الفلاحات البسيطات على غرار والدته وصولا إلى المناضلات المثقفات، يقودهنّ تصميم وبسالة وعناد وقوة روحية وجسدية وقدرة لا مثيل لها على الأمل. كذلك لم يكفّ هذا الباراغواياني الجميل يوما عن التحويم حول مسائل تطرح دور المثقف وضميره، محاربا ما استطاع محاربته، وفاضحا ما عجز عنه، وهو الذي وصف بـ" إنسانوي اليسار". وبواسطة القصيدة أو القصة أو المسرحية أو الرواية أو المقال، لم يشذّ لحظة عن التأمل في الوجع الإنساني وفي تيمة المنفى- وهو الملدوغ الأكبر بها- وفي الشكوك والتساؤلات والقلق الوجودي وآفات القمع والاستبداد والتزوير وخنق الحريات.
"الديكتاتورية هي نظام بلاد لا يحتاج فيها المرء إلى السهر طوال الليل لكي يعرف نتائج الانتخابات"، قال جورج كليمنصو يوما، وردد من بعده روا باستوس وآخرون.
وهل نحتاج بدورنا إلى أن نضيف شيئا؟
عن "النهار"
19-5-2005
Joumana333@hotmail.com
www.joumanahaddad.com