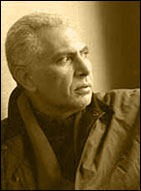 بعد أربع سنوات قضاها الشاعر رفعت سلام في الجزائر مسؤولا عن مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك، عاد إلي أرضه.. ووطنه.. وصراعاته المتجددة كواحد من التيار الشعري السبعيني الفاعل والمثير دائما للشغب والأسئلة كما يتأكد في هذا الحوار.
بعد أربع سنوات قضاها الشاعر رفعت سلام في الجزائر مسؤولا عن مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك، عاد إلي أرضه.. ووطنه.. وصراعاته المتجددة كواحد من التيار الشعري السبعيني الفاعل والمثير دائما للشغب والأسئلة كما يتأكد في هذا الحوار.
وكانت أهمية هذا اللقاء تكمن خلفها نيته لفتح صفحة شبه مغلقة علي الجزائر التي نحبها عن بعد، ولا نستطيع التواصل معها لأسباب ربما يعرفها الجزائريون أكثر منا، وقد حدثنا بالفعل رفعت سلام عن صورة الجزائر كما رآها، وهي وإن كانت صورة تعكس صراعات ضارية وقديمة، إلا أنها تعكس أمراضا لا تختلف عن أمراض النخبة العربية في عمومها.
كذلك سعينا خلف ما فاجأنا به رفعت سلام فيما بتعلق بإنجازه ترجمة كاملة لأشعار الفرنسيين العظيمين شارل بودلير وأرتور رامبو، وهي مسألة مثلت دهشة كبيرة بالنسبة لي لأن سلام معروف كمترجم عن الإنكليزية فحسب وثانيا لأن كلا الشاعرين تمت ترجمتهما أكثر من مرة وفي أكثر من ترجمة، لكن سلام يدافع عن نوعية ترجمته ويدافع أيضا عن قدرته علي الترجمة الفرنسية، بعد أن أنجز مراجعة الترجمة الكاملة لكتاب سوزان برنار قصيدة النثر من بودلير إلي أيامنا وهي الترجمة التي أنجزتها المترجمة راوية صادق .
حول هذه الشؤون وشؤون أخري بينها شعراء السبعينيات والمؤسسة الثقافية هموم الترجمة العربية ومشكلاتها، وهنا نص الحوار:
* لماذا الآن ترجمة كاملة لأعمال بودلير ورامبو رغم أنهما ترجما عدة مرات.. ومنذ متى كان لك تاريخ مع الترجمة من الفرنسية؟
توجد في المكتبة العربية ترجمة كاملة لأعمال بودلير الشعرية وهي مسألة غريبة لأن هناك إجماعا ثقافيا علي ان بودلير هو رائد الحداثة الشعرية والثقافية في أوروبا، وهذا استفاد منه بعض رواد ما يسمي بالحداثة العربية معترفين له بهذه المكانة ورغم ذلك فتجربة بودلير المكتملة شعرياً لم تصل إلينا، هناك شذرات منها أما التجربة الكاملة فلا نعرفها ذلك ما يعني أن الترجمات العربية لأعمال بودلير الشعرية هي ترجمات جزئية مرهونة بذوق المترجم، هناك إذن مختارات شعرية متفاوتة الحجم والأهمية، فضلا عن قدمها النسبي. مثلا فديوان أزهار الشر له ترجمة غير مكتملة صدرت في الخمسينيات تقوم علي ذلك المنهج التقليدي في الترجمة، الذي يسمح للمترجم بحرية تصرف واسعة في التأويل والصياغة اللغوية والإنشائية المستندة علي البلاغة العربية القديمة وهو ما لا يتوافق مع شاعر ينتمي لثقافة أخري فضلا عن حداثيته اللغوية.. وهناك ترجمة أخري صدرت لجورجيت خوري قدمها أدونيس، لكن في أفضل الحالات فهي ترجمات لعمل شعري واحد لبودلير وليست لأعماله الشعرية الكاملة.
* هل ترجمتك تنصرف الى كل ما كتبه بودلير أم تقتصر علي الأعمال الشعرية فقط؟
الترجمة تتعلق فقط بأزهار الشر وسأم باريس ولا تنصرف إلي كل كتابات بودلير، فقد كتب في النقد والفن التشكيلي وترجمة كل ما كتب تحتاج إلي فريق عمل وليس مترجم واحد بجهد ذاتي.
* وبالنسبة لرامبو؟
بالنسبة لرامبو أعرف أن هناك ترجمات متفاوتة الحجم والحساسية لأعمال رامبو، فهناك ترجمة رمسيس يونان لفصل في الجحيم وترجمة خليل خوري لمختارات من أشعاره وترجمة كاظم جهاد، ودون رغبة مني في طعن الترجمات السابقة إلا أنني أعتبر ترجمتي قراءة أخري تمتلك مبررها إزاء هذه الترجمات سواء من حيث الوعي بتجربة رامبو أو حساسية نص شعري مرهف ومعقد ومتعدد المستويات إلي لغة عربية ذات طبيعة شعرية، فالالتصاق بالنص الشعري بدعوي الأمانة نصاً شعريا مقابلا برغم أنه سينتج موازاة لغوية تكاد تقترب من الترجمات الحرفية ولذلك لم أحس بتجربة رامبو الشعرية في الترجمات السابقة، والحق أنني لم أكتشفها في أبعادها الكاملة إلا مع عكوفي علي هذه الترجمة.
* مرة أخري أسألك، متى أجدت الفرنسية إلي الحد الذي يؤهلك للترجمة عنها، وأنت معروف بترجماتك عن الانكليزية؟
أحب ان أوضح أن كتاب قصيدة النثر لسوزان برنار الذي صدرت ترجمته الكاملة منذ سنوات في القاهرة يحمل اسمي كمراجع للكتاب، وهي لم تكن مراجعة للغة العربية بل مراجعة علي النص الفرنسي، فضلا عن اللغة العربية كما تقتضي أصول المراجعة، وإلا لما سمحت لنفسي ولما سمحت لي المترجمة بأن أضع اسمي علي هذا النحو علي الكتاب، ولمن لم ير الكتاب فهو يزيد علي ألف ومائتي صفحة من القطع الكبير ويتناول قصائد لعشرات الشعراء الفرنسيين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، كما أن كتاب ماجريت للشاعر الفرنسي برنار نويل هو أيضا من مراجعتي. ولم يكن للمركز الثقافي الفرنسي أن يوافق علي أن يقوم بالمراجعة وخاصة في ما يتعلق بكتاب قصيدة النثر شخص لا يتقن الفرنسية.
* وكيف تري حال الترجمة في عموم العالم العربي ومصر؟
أريد القول إننا متخلفون كثيرا عن العالم فيما يتعلق بالترجمة، وإلا فما الذي يلجئ شاعرا إلي أن يعود أكثر من قرن ونصف قرن إلي الوراء ليستعيد في لغته شعراء بهذا الحجم والقامة. كان لا بد لأجيال سابقة أن تكون قد قامت بهذه المهمة لتترك لنا البحث في الشعراء المعاصرين لكن ما أكثر الأعمال الهامة التي لم تترجم إلي العربية أبدا أو ترجمت ترجمات مشوهة.
* وهل يصح أن نتهم حركة الترجمة كلها علي عموم هذا الاتهام؟
نعم وحتى إذا كانت ترجماتنا العربية عن اللغتين الأساسيتين، الفرنسية والانكليزية، تعاني من فجوات هائلة بحيث أنها لا تصلح لتقديم الأعمال الرئيسية المنتخبة في مجال معين في سياق معقول، فما بالك بأعمال الثقافات الأخرى، الألمانية والإيطالية والصينية واليابانية. فمعرفتنا بالعالم مشوهة وفقا لحركة الترجمة ولا أحد ولا جهة معنية تقوم بتصحيح هذا التشوه وما أكثر الخطوط الحمراء علي أعمال صدرت حتى في القرن التاسع عشر أو الثامن عشر الأوروبي، فبعض المؤسسات حينما تدعم الترجمة أو تنشئ سلاسل خاصة بها تشترط ألا يكون الكتاب مزعجا لأحد أو يمس أحد التابوهات الكثيرة في حياتنا العربية، فلا يبقي سوي تلك الكتب المستأنسة العادية التي لا تضر ولا تنفع أحدا في نفس الوقت، وحدث ولا حرج عن وضعية المترجم نفسه، فهو في السياق العربي شخص خارج السياق، يكاد أن يتسول نشر ترجمته التي لم يكلفه بها أحد لأن لا احد معني بالموضوع ويتحول النشر إلي نوع من الصدقة ولن يخرج منه، إذا ما خرج، إلا بملاليم لا تغطي ثمن الورق. لا مؤسسات معنية بالموضوع ولا خطة عامة في الترجمة تسد الفجوات السابقة وتتابع ما يصدر من آلاف الكتب كل عام لتنتقي منها ما يمكث في الأرض.
* أنت عائد من الجزائر بعد عملك في وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات.. كيف رأيتها وكيف رأيت تغير حالة العنف الجزائري؟ بل كيف رأيت الأدب الجزائري؟
اكتشفت قارة كاملة اسمها الجزائر. شعوب وقبائل بثقافاتها وتقاليدها وأعرافها وأغانيها وأزيائها. فأغاني الشرق الجزائري مثلا ستسمع مقابلها في الغرب، والرأي الذي خرج من وهران قد يقابله الغناء القبائلي بإيقاعاته الخاصة ولغته الأمازيغية، أما الطوارق فعالم جنوبي يمتد من الصحراء إلي شرق ليبيا مرورا ببعض البلدان الأفريقية في الصحراء الكبرى. ليست هناك أغنية واحدة. هناك أغان وإيقاعات متعايشة في آن واحد، وعلي المستوي اللغوي مثلا قد تفاجأ بأن الجزائريين صنعوا لغة ثالثة ليست الفرنسية ولا العربية هي مزيج في الجملة الواحدة من الاثنتين، وهو ما يطرح إشكالية الهوية اللغوية، هل هي العربية أم الفرنسية. والمفارقة أنهم ليسوا معنيين بهذه المشكلة فالاثنتان تمضيان متوازيتين أحيانا ومتقاطعتين أحيانا ومختلطتين أحيانا والحياة تسير. ينعكس هذا الوضع في الحياة الثقافية حيث ينقسم الأدباء انقساما أوليا بين من يكتبون بالعربية ومن يكتبون بالفرنسية بلا خطوط تماس بينهما كأن كل مجموعة تنتمي إلي بلد آخر وثقافة أخري وكل فريق له كتابه الكبار فعلا سواء في القصة أو الرواية أو الشعر لكن الخصومة بين فريقين لا بد أن تثير الأسئلة حيث النفي هو القانون الأول. علي سبيل المثال فاتحاد الكتاب الجزائري يهيمن عليه بصورة مطلقة من يكتبون بالعربية ولن تجد في مجلس الاتحاد علي مدي سنوات طويلة أديبا يكتب بالفرنسية، وحينما يقيم من يكتبون بالفرنسية ندوات أو منتديات فلن تجد أحدا ممن يكتبون بالعربية في هذه الأنشطة. هذا الانقسام قائم علي مستويات أكثر شمولية من ذلك ولكنهم ليسوا معنيين بالأمر فلا تبدو الإشكالية مطروحة أو مرشحة للحل.
* ألم يحل لتعريب مشكلة الانقسام اللغوي ومن ثم الانقسام القومي؟
يبدو لي أن كل التركيز خلال حرب التحرير الجزائرية كان منصبا علي التحرير بمعناه العسكري والسياسي وحينما استقلت الجزائر عسكريا وسياسيا لم يواجه أحد السؤال الصعب للاستقلال وهو سؤال الهوية، وحينما جاء الحل التعريب تم بقرار فوقي سلطوي ولم يتم حل جذور المشكلة، فسرعان ما عاد المجتمع إلي سيرته اللغوية السابقة مع توقف حملة التعريب.
* إذن كيف ترى الشعر الجزائري بين هذه التيارات المتصارعة؟
هناك ثلاثة تيارات شعرية في الجزائر متوازية وليست متفاعلة. تيار الشعر العمودي المزدهر حتى في أوساط الشبان، وتيار قصيدة التفعيلة علي النمط الذي كان يكتب في الخمسينيات والستينيات وتيار صغير في قصيدة النثر، وهو ضعف هذه التيارات وأقلها حضورا. مشكلة التيارين الأولين تكمن في جوهرهما الماضوي، حيث تحس أنها قصائد قد كتبت من قبل ومنذ زمان بعيد، وأنها خارجة علي الزمن إلي الوراء ولا علاقة لها بما جري في القصيدة العربية كأن هناك حالة اكتفاء ذاتي لدي الشعراء، أعادت إنتاج ما سبق استهلاكه وتجاوزه في الثقافة العربية منذ عقود علي الأقل. والتيار الأخير أضعف من أن يصنع قوسا شعريا مؤثرا أو واضحا. فالتجربة ما تزال هشة تكاد أحيانا أن تختلط بالخواطر ولا أحد يتحاور مع أحد وفيما يبدو حتى مع نفسه حول ما يفعل، كل منهم مكتف بذاته وبنصه، ولا يتساءل حوله ولا حول بعض النصوص العربية التي قد تصل إلي يديه بين حين وآخر.
فالكتابة في حد ذاتها كافية كما تأتي بلا أسئلة ولا قلق. وأيضا لا يطرح أحد سؤال: ما الذي يجري علي الساحة الشعرية؟ ما الذي نكتبه؟ هناك حالة من الرضا عن الذات والثقة المبالغ فيها في تلك النصوص ولا طموح.
* وبماذا تعلل حالة الماضوية في الشعر الجزائري؟
يبدو لي أن الصراع مع الفرنسيين أفضي إلي ضرورة التأكيد علي اللغة العربية كمقابل للمحتل الفرنسي، وأول النصوص الشعرية المكتوبة بالعربية خرج من عباءة جمعية العلماء المسلمين بطابع ديني وبطبيعة الحال عمودي ويبدو أن شعراء العربية قد تملكتهم الرغبة في تأكيد الذات وامتلاكهم لناصية اللغة العربية إلي حد أدي إلي تشبثهم بالتقليدي والمحافظ، كشارة علي هوية عربية في مقابل اللغة والثقافة الفرنسيتين، وربما لم يستطع الشعراء المعاصرون الإفلات من هذا الإرث فواصلوا المسيرة التقليدية فيما وراء الشعر العربي بحوالي خمسين عاما علي الأقل. فمثلا فيما كان شعراء السبعينيات في مصر والبلدان العربية يطرحون قضايا التجريب والخروج علي المنبرية والخطابية والجماهيرية كان نظراؤهم في الجزائر يكتبون قصائد عن الإصلاح الزراعي والتحول الاشتراكي.
* ولماذا توقفت فترة عملك بالجزائر عن كتابة الشعر؟
كنت مسؤولا عن التغطية الصحفية للجزائر كلها لوكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات، كانت حافلة بالأحداث سواء علي الصعيد الأمني أو السياسي أو المؤتمرات الدولية وبالتالي فلم تسمح لي بأن أتفرغ لنفسي وللشعر. وإن كان قد صدرت ترجمة لشاعر فرنسي معاصر ـ جان كلود فيلان ـ من مراجعتي وتقديمي بالجزائر، فضلا عن إنجاز ترجمة كاملة لكل من رامبو وبودلير، أما الشعر فيحتاج ـ بالنسبة إلي ـ إلي مناخ آخر.
* عدت إلي مصر منذ عدة أشهر. كيف رأيت الثقافة المصرية بعد عودتك وكيف رأيت مؤسساتها؟
تبدو لي المؤسسة الثقافية المصرية في حالة انهيار بأسرع مما كنت أتوقع فقبل أربع سنوات هناك حالة من الخراب العام مؤشرها الرمزي أنني قرأت خبر احتراق مسرح بني سويف في الطائرة بما ضم من فنانين ونقاد كأنك مقبل علي كارثة، ومؤشر آخر تلك العريضة التي تطالب ببقاء وزير الثقافة لاستكمال إنجازاته وبدا لي أنهم يريدون من وزير الثقافة استكمال حرق بقية الفنانين المصريين والأسماء الموقعة تتراوح بين جابر عصفور، فوزي فهمي، صلاح عيسي، سلوى بكر، وغيرهم. خراب من نوع آخر لم يكن واردا حتى في الكوابيس. فالمؤسسات وقطيع كبير من المثقفين في حالة انهيار ولم يبق سوي آحاد بلا سلطة ولا قوة تستطيع إصلاح ما أفسده هذا النظام. والمشكلة ان المستقبل المنظور ينذر بما هو أسوأ إذا ما استمر هذا النظام بشكل أو بآخر. فلم تعد هناك ورقة توت يحرصون عليها، بل ربما أصبحوا يتباهون بالجلافة والفظاظة دون رادع أو حياء. فما الذي ينتظر وزير الثقافة المصرية في العقد القادم مثلا؟ لا أحد يدري.
* في النهاية أحب أن أسألك: لماذا لم يتحول شعراء جيل السبعينيات في مصر إلي نجوم.. هل ثمة مشكلة أسفر عنها مشروعهم، أم ان الأسباب تكمن في أشياء أخري؟
سيظل أهم ما أنجزه شعراء السبعينيات في مصر هو ما اسميه تحرير الخيال الشعري من تلك الثبوتية التي كانت تهدده مع الجيل الثاني من قصيدة التفعيلة حيث فتح القصيدة علي مصراعيها لكافة الاحتمالات، وهو ما سمح بعد ذلك لظهور قصيدة النثر كتيار شعري كاسح في مصر، والتي كانت احد التابوهات الأساسية في الثقافة المصرية. ربما كانت المشكلة أن غالبيتهم أسرعوا إلي البحث عن الغنائم قبل الأوان الشعري ففيما بدأت الحركة بشعار الاستقلال عن المؤسسة الحكومية فقد انتهي معظم رموزها منذ سنوات إلي التكالب علي المؤسسات الحكومية، فلم يصمدوا كثيرا أمام إغراءات الدخول في الحظيرة بتعبير وزير الثقافة. دخلوا إلي لجان حكومية واختارتهم بعض هذه اللجان لتمثيل الشعر المصري هنا أو هناك، ونشروا كتبا في مكتبة الأسرة أكثر من مرة، وكتب بعضهم مقالات لتمجيد أصحاب الكراسي الثقافية، فانطفأ الشعر.
* ولكن هذا لا ينطبق علي الكافة.. فهل ثمة أسباب أخري تراها؟
دعني أشير إلي أن الأصوات الحداثية لدي شعراء السبعينيات محدودة العدد أولا، ويبدو أنها انطلقت بفعل الغريزة الشعرية بالأساس دون أن تتوفر علي أساس رؤيوي بما يدفع علي التعرف علي الحداثات الأخرى في العالم. فلم يكن لديهم رصيد سوي الحدود المعرفية المتاحة باللغة العربية فقط ومنها ما يصدر من ترجمات رديئة أو مشوهة فنضبت تجربتهم بأسرع مما ينبغي غالبيتهم إن لم يكونوا كلهم لا يقرأون بلغة أخري غير العربية ، ولا يعرفون شعراء أو حركات شعرية إلا علي المستوي العربي ولم يفض هذا إلا إلي ضيق الأفق الشعري.
* أنت إذن تحصر المشكلة في عدم القراءة بلغة أخري غير العربية، وهذا غير منطقي؟
لم أقل ان اللغة وحدها هي المعول ولكني أشرت إلي دور أحادية اللغة في تقليص أفق تجربة السبعينات وخاصة في ضوء ما سبق ان أشرت إليه فيما يتعلق بالفجوات الهائلة في الترجمة أو تشويه بعض الأعمال الهامة. فالمؤكد أن معرفة الآخر تخصب التجربة الشعرية والثقافية وتفتح آفاقا في الوعي لا يتيحها السجن في لغة واحدة.
*ألا تري أن ما تمت ترجمته في المكتبة العربية لا يحل مشكلة القراءة بلغات أخري، ولو نسبيا؟
لنأخذ الشعر الفرنسي المترجم إلي العربية فأهم الأصوات السابقة علي بودلير ومن بينها تجارب شعرية هامة من قبيل جسبار الليلي لـ ألويزيوس برتران لم تترجم من قبل فضلا عن مالارميه، أبولينير، ماكس جاكوب، والأسهل أن نحصر من ترجم من شعراء القرنين التاسع عشر والعشرين. فعدا رامبو وبودلير هناك ترجمات أساسية لأراجون وسان جون بيرس ومختارات متفاوتة من حيث الكم لبعض الشعراء الفرنسيين لكن الأغلبية غائبة سوء بشكل كامل، أو شبه كامل ولم تفلح تلك الكتب التي صدرت تحت عنوان مختارات من الشعر الفرنسي في سد هذه الثغرة لأن المترجم كان يكتفي بقصيدة أو قصيدتين لكل شاعر وبالتالي فهذا الوضع لا يمكن لمن لا يعرف الفرنسية أن يتعرف من خلاله علي منجزات قرنين شهدا العديد من الحركات الشعرية التي هزت العالم، فكيف يسمح الشاعر لنفسه أن يكون تحت رحمة المترجم!
2005/10/27
القدس العربي
إقرأ أيضاً: