عمى العين يتلوه عمى الدين والهدى
فليــلتـي القصـوى ثلاث ليـالٍ
أبو العلاء المعرّي
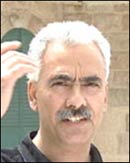 أبو العلاء المعرّي شاعر طريد. بل لعله الطريد الأكبر في تاريخ الشعر العربي. وهو طريد رغم الهالة التي أحاطت به وشكّلت غطاءً لطرده. فوراء هذه الهالة حدثت لعبة الطرد.
أبو العلاء المعرّي شاعر طريد. بل لعله الطريد الأكبر في تاريخ الشعر العربي. وهو طريد رغم الهالة التي أحاطت به وشكّلت غطاءً لطرده. فوراء هذه الهالة حدثت لعبة الطرد.
أبو العلاء طريد التيارين الشعريين الرئيسيين اللذين انقسم إليهما الشعر العربي: تيار الصنعة– تيار الحوليات وعبيد الشعر، وتيار الطبع والإلهام – تيار عبيد جنيات الشعر. فهو لم يحسب من التيار الأول على الرغم من صنعته التي لا تتفوق عليها صنعة. ولم يحسب من التيار الثاني على الرغم من الحريق الروحي الذي يشتعل في شعره. لقد ظلّ خارج التيارين، وحيداً بلا نسب.
وإذا ما أصرّ المرء على إيجاد خيط يربط أبا العلاء بمن قبله، فلن يجد سوى خيط واهٍ متقطع يبدأ من طرفة بن العبد، ثم لا يلبث أن يتمزق ويتبدد، تاركاً فتائل قصيرة منه عند هذا الشاعر أو ذاك، في هذه القصيدة أو تلك.
بذا يمكن القول إن أبا العلاء دون سلف حقيقي، على الرغم من أنه تتلمذ على المتنبي وعلى غيره في وقت ما، فقد خلق عالمه الشعري دون مادة موروثة كافية، أي أنه خلق نفسه بنفسه.
وإذا كان بلا سلف، فإنه دون شك بلا خلف، أيضاً. فلم يتابع الطريق الذي فتحه أحد من بعده، رغم هالة التقدير التي أحاطت به، ورغم الاعتراف الذي محضه.
هو طريد السلف والخلف معاً. أما الاعتراف الذي حظي به فقد تحوّل تدريجياً إلى اعتراف به كلغوي وكحكيم لا كشاعر. فقد قُصد من كل صوب كلغوي، وأعجب الناس بأبيات حكمته لا بجوهر شاعريته. ثم حدث بعد ذلك ما هو أسوأ بكثير. فقد أصبحت قضية معتقده الديني هي القضية الأولى. وانشغل الناس بمعتقده ما بين مكفّر وغير مكفّر، حيث أُدخل في ليلته الرابعة، ليلة الطرد والنسيان الفعلي، ليتضاعف ظلام ليله. ونظرة واحدة إلى كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء الذي جمعت فيه، بإشراف طه حسين، غالبية ما كتبه القدماء عنه، تكفي لإثبات ذلك. فأنصاره وأعداؤه شغلوا، جميعاً، بقضية واحدة هي قضية معتقده الديني. فما من استشهاد يؤتى به إلا ليرد تهمة الإلحاد والكفر أو ليثبتها. أمّا الشعر فقد نسي.
لِمَ تمّ الأمر بهذا الشكل؟ وهل حدث عفواً ومصادفة؟
زعزعة معنى الشاعر
الحق أنه لم يتم عفواً ولا صدفة. ذلك أن هناك سوء فهم عميقاً بين الشعر العربي بخطيه، وبين أبي العلاء. وقد أدى سوء الفهم العميق إلى حذف شعر أبي العلاء وإظهار معتقده الديني كبديل عنه. ولتوضيح ذلك، يمكن مقارنة أبي العلاء بأبي نوّاس. فالأخير شاعر شكاك، زنديق، فاجر، شعوبي، لكن شعره لم يطرد، بل صار أصلاً بني عليه وامتد في من بعده. أما زندقته وشكوكه فقد كانت بهاراً حلّى شعره وجعله نافقاً. هذا يعني أنه شعرياً لم يعتبر زنديقاً، أو أن زندقته كانت زندقةً يمكن احتمالها. أما زندقة أبي العلاء الشعرية فقد كانت زندقةً عميقةً لا تغتفر، ولا يمكن التلاؤم معها. وإذا وضعتنا كلمة حداثة مكان كلمة زندقة لصارت الجملة كما يلي: أما حداثة أبي العلاء الشعرية فكانت حداثة عميقة لا يمكن التلاؤم معها. فقد طالت حداثته الجذور، حتى ليمكن وصفه بأنه الهادم الأعظم لعمود الشعر العربي. فقد أطاح بضربة واحدة بأغراض الشعر كلها. انتهى معه بهذه الضربة: الفخر، والمدح، والغزل، والتشبيب، والأطلال، وكل شيء. ولم يبقَ سوى غرض واحد: ورطة الإنسان في الكون ومأساة وجوده. بهذا المعنى، فأبو العلاء شاعر حديث حتى بالمقارنة بزماننا وعصرنا. لكن هذه الحداثة لم تكن أمراً مألوفاً بالنسبة للشعر العربي والذوق العربي. وكان هذا جذر سوء التفاهم الذي أدى إلى طرد شعر أبي العلاء، طرداً عملياً، رغم الاحترام الذي أحيط به دوماً.
غير أن أبا العلاء فعل أكثر من ذلك. فقد زعزع من الأساس معنى الشاعر ووظيفته، محوّلاً إياه إلى كائن مستقل ينطق باسم الإنسان في مواجهة الإله والموت والطبيعة، وكل ما يعصف بالحياة من تناقضات وأعاصير. وبذا، فقد وضع الشاعر في مرتبة هي، في المحصلة، أكثر علواً من مرتبة السلاطين والخلفاء الذين خدمهم الشعراء واستجدوهم. وكان هذا أيضاً غير مفهوم وغير مقبول، فمنذ العصر الجاهلي ووظيفة الشاعر مصانة ومعروفة. فهو ناطق باسم قبيلته، أو مادح للملوك والخلفاء. إنه مُلغى في القبيلة أو ملغى في الخليفة. أما أبو العلاء فلم يكن له من قبيلة ولا خليفة. وبهذا المعنى، أيضاً، فأبو العلاء ينتمي إلى عصرنا وإلى حداثته أكثر مما ينتمي إلى الماضي بحداثته ولا حداثته. من أجل هذا لم يخلف أبو العلاء أتباعاً، ولم تنشأ على ما بدأه مدرسة. فهو لم يكن مفهوماً في العمق، بل ظلّ نبتاً غريباً في أرض هي أرضه. ومن هذه الزاوية يبدو الشاعر الضرير أقرب إلى الشعر الفارسي منه إلى الشعر العربي، حيث أدخل الشعر في عالمٍ لم يعد له فيه من غرضٍ إلا نفسه.
مع ذلك، فإن أبا العلاء ضروري ضرورة حاسمة من أجل تثبيت وحدة الشعرية العربية. فدونه لا يمكن لمّ هذه الوحدة. فهو حلقة الوصل بين الشعر الرسمي العربي بخطّيه وبين نثر الصوفية الشعري الذي لا يقل قوة عن هذا الشعر. فالهوة الكبيرة بين هذين القطبين، لا يمكن عبورها إلا عبر أبي العلاء. إنه الجسر الذي يوحدهما. فهو يجمع أجزاء من روح الاثنين: روح الصوفية الكونية الملتاعة، وروح الانتظام والقانون السائدين في الشعر العربي.
وإذا أتينا للعصر الحديث، فسوف نجد أن أبا العلاء ما زال مطروداً. وهو الجدير بأن يكون أباً للحداثة. فحداثة ما بعد منتصف القرن رأت في أبي تمام أباً، فيما أزاحت أبا العلاء إلى الوراء. هذا رغم أن حداثة "حبيب إبن أوس" ليست أكثر من لعب بديعي إذا ما قورنت بحداثة أبي العلاء. وهكذا لم تفطن الحداثة إلى عمق حداثة أبي العلاء.
هذا التجاهل، هذا الطرد، يعطي الانطباع بأن الحداثة العربية الجديدة ما زالت أسيرة الخط الدائم للشعر العربي. فهذا الشعر يُوَلِّد حداثة خاصة ويستوعبها انطلاقاً من أصول محدَّدة. لكنه لا يقبل تجاوز هذه الأصول. إنه يقبل حداثة أبي تمام ويدرجه على رأس مدرسة، لكنه يتجاهل أبا العلاء. فالصراع بين الحداثة والمحافظة يتم في دائرة مغلقة: دائرة الصنعة والطبع، أو دائرة الإبداع والإتباع، كما هو اسمها الشائع الآن.
طريد رسالة الغفران
ويمكن أن نلحظ أن طرد أبي العلاء في العصر الحديث، قد تواصل من ناحية مختلفة، لا يفطن لها في العادة. فتحت غطاء الاهتمام بأعمال أبي العلاء النثرية أزيح شعره إلى الوراء. فمنذ الثلث الأول من هذا القرن ارتفع سهم رسالة الغفران لكي تصبح عنواناً للشاعر. والسبب، في رأيي، عقدة النقص تجاه الغرب. فهناك من يظنّ أن لهذه الرسالة تأثيراً على جحيم دانتي. وقد يصحّ ذلك أو لا يصح. إلا أن ما حدث هو أن الرسالة، وهي كتاب لغوي مهم، لكنه مضجر إلى حد ما، صارت، بسبب إطارها الأسطوري الذي فيه بعض نقاط لقاء مع إطار جحيم دانتي، أهم كتاب لأبي العلاء. وصارت تهمنا، بالتالي، استشهاداتها اللغوية من طراز: ستِ إن أعياك حملي فاحمليني زقفونا، أكثر مما تهمنا أشعار أبي العلاء.
الوحيد الذي حاول بجهد أن يعرف بأبي العلاء كان طه حسين. وربما كان ذلك بسبب النسب العميق بينهما، نسب فقدان البصر. فقد تمكّن من تعريف جمهور كبير بأبي العلاء عبر تقديمه له ببساطة ولطافة. ومع ذلك، فإن طه حسين، في رأينا، لم يكشف القيمة الحقيقية لأبي العلاء وتجديداته الثورية. وربما لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك، بحكم الزمن الذي نشأ فيه ومثله.
صناعة الديوان
وإذا كان أبو العلاء قد ألغى أغراض الشعر وجعل من الشاعر كائناً آخر لا عهد لنا به، فإن الديوان الشعري بمعناه الحديث هو من صنعه أيضاً. إذ يمكن القول أن ديوان اللزوميات هو الديوان العربي الأول بالمعنى الحديث لكلمة ديوان. فهو يملك وحدة موضوع لا شك فيها رغم طوله الهائل. وقد نظر إليه صاحبه كوحدة كاملة وقدمه لنا على هذا الأساس. أي أنه كان يفهم هذه الوحدة ويعنيها.
قبل أبي العلاء كانت قصائد كل شاعر تجمع في كتاب يسمى ديوان فلان، دون أي وحدة سوى الوحدة التي يفرضها اسم الشاعر. أبو العلاء خرق هذا التقليد ونسفه من أساسه. فقد ترك سقط الزند وحده ووضع ديوانه الآخر ذا الموضوع الواحد، لأنه كان يدرك أن الديوانين عالمان مختلفان لا يصح جمعهما أبداً.
إقدام أبي العلاء على تسمية ديوانيه عنى شعوراً ما بوحدة كل منهما. هذه الوحدة التي اكتملت في اللزوميات، وصارت وحدة بالمعنى الحديث للكلمة.
قسمة أشعاره في ديوانين تعني شيئاً آخر، وهو إدراك أبي العلاء للاختلاف الحاسم في شعره بين مرحلتين، مرحلة سقط الزند ومرحلة اللزوميات. بل لعله يعني أن أبا العلاء يدرك التطور الذي حصل في شعره بين هذين الديوانين. بذا، فهو الشاعر القديم العربي الوحيد الذي أعطانا دليلا مؤكدا على أنه تمعن بوضوح في مسيرته الشعرية، ورأى التطور الذي حدث فيها. فما بين سقط الزند واللزوميات جرت تحوّلات عميقة على شعر أبي العلاء وعلى فلسفته الفنية والفكرية. فـ سقط الزند، رغم بعض قصائده الفذّة، خربشة أولى وتمرين أول. وهي خربشة جرى فيها أبو العلاء في مجرى الشعر العربي من حيث الأغراض وطريقة البناء. وهو يعترف بذلك بلا مواربة في مقدمة هذا الديوان: (ولم أطرق مسامع الرؤساء بالنشيد، ولا مدحت طلبًا للثواب، وإنما كان بغرض الرياضة وامتحان القريحة). لقد كان يروّض نفسه ويدربها ليتمكن من طريقة الشعراء. لم يكن يمدح حقا، بل كان يتبع طريقة وتقليدا. فقد كان التقليد يرى أن المدح من لوازم الشعر. أما ديوان اللزوميات فكان القطيعة الكاملة. فهو يقف وحده ليعارض أعمق أعماق الطريقة الشعرية العربية وعمود الشعر العربي.
وفي ما بين الاثنين كان أبو العلاء ينحت درعيّاته. وهي قصائد غريبة تتحدث عن الدروع فقط. وتمثِّل نحتاً في الصخر، بدون عاطفة عميقة. ويبدو لي أن أبا العلاء كان يجري فيها التمرينات الأولى لما سيصبح مستقبلاً لزومياته. ففيها كان يريد أن يخرج الشعر من اللاشعر، أو أن يحوّل اللاشعر إلى شعر. هي، إذن، تمرين مدهش لشاعر كان يبحث عن طريق مختلف. تمرين وضع أمام أعيننا كي نتأمله، ونتأمل طريق أبي العلاء عبره. وهي وإن خلت، إلى حد بعيد، من الروح والعاطفة فقد مرّنت يده وأعطته قدرة هائلة على التعامل مع المواضيع الصخرية الجافة، وهيأت له أن يرغم الشعر على أن يقفز ويرقص على كل حرفٍ من حروف القاموس بالضم والفتح والكسر.
الحرب تحتاج إلى قلاع ضخمة
لم يكن أبو العلاء ضريراً يتسلى باللغة في درعياته، كما يعتقد بعضهم. كان يبحث بلا ملل عن استخراج الشعر من موضوعات لا شعرية، لأنه كان يريد أن يرمي بالمهيجات الشعرية المعروفة في الشعر العربي: زيارة الأطلال، الغزل، التشبيب، الحرب، الرحلة في الصحراء. كان يكره هذه المهيجات ويبحث عن بدائل لها. وهو يذكر هذا صراحة في مقدمة لزومياته حين يقول:
"وقد كنت قلت في كلامٍ قديم إني رفضت الشعر رفض السَّقْبِ غرْسَه والرأل تريكته".
أي رفضت الشعر رفض ولد الناقة لقناع مشيمته، وفرخ النعامة لقشرة بيضته بعد أن يغادرها. وهو يؤكد لنا أنه لم يكن يقصد ترك الشعر، بل مغادرة تكلفات الشعراء التي تهدف لتهييج الشعر في دواخلهم. فهم، كما يقول:
"قد زيّنوا ما نظموه بالغزل وصفة النساء ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمر، وتسببوا إلى الجزالة بذكر الحرب. واحتلبوا أخلاف الفكَر، وهم أهل مقام وخفض في معنى ما يدعون أنهم يعانون من حثّ الركائب وقطع المفاوز ومراس الشقاء".
كل هذا هو ما رفضه أبو العلاء. كان يريد لشرارة الشعر أن تنقدح دون كل هذا الزبد. وكان يجرب ليصل إلى هذا، ولا شيء بين يديه سوى اللغة ومأساة الإنسان في الكون. ومن قدحهما معاً كان يريد للشعر أن يأتي. وقد أتى به راقصا على كل حرف من حروف القاموس.
لكن لِمَ ألزم أبو العلاء نفسه بما لا يلزم في ديوانه؟ أكان، مرة أخرى، ضريراً يتسلّى بالعروض واللغة في محبسه؟! ليس لديّ من شك في أنه لم يكن كذلك. فأبو العلاء الذي يقتصد في لغته ويحسبها بالحرف لم يكن ليفعل هذا. لكن مضمون شعره المزعزع كان يقتضي شكلاً راسخاً. من دون هذا ما كان لأبي العلاء أن يحصل على قدر من التوازن الذي يجعله قادراً على العيش. إن الحرب تقتضي قلاعاً ضخمة، كما أن اضطراب الرؤى والمضامين يحتاج إلى شكل ثابت يقيني. وكانت القيود الإضافية، التي لا لزوم لها، لازمة من أجل بناء قلعته. يقول أبو العلاء:
وكيف اعتدالي وهذا النهار
يروح بميزانه المائل
إن الروح المائلة بحاجة إلى شكل ثابت لكي تعتدل. والكون المتموج المخيف بحاجة إلى وتد كي يربطه. وكان أبو العلاء يضاعف عدد الأوتاد التي يضربها في الأرض لكي ترسخ من تحت قدميه. وكان هذا أمراً له لزومه. لهذا جعل ما لا يلزم مُلزماً.
إن إلزام نفسه بما لا يلزم قد أوحى بأن أبا العلاء لا يجدد وإنما يضاعف الالتزام بالقديم. فتجديداته العميقة غُطيت بمحافظته العروضية، مما ساهم، أيضاً، في إبعاد العين عن رؤية هذه التجديدات.
رحلة في أرض أخرى
وإن كان أبو العلاء رفض مهيجات الشعر التقليدية، فقد رفض أيضاً المثال الشعري في عصره والعصر الذي سبقه. وكان هذا المثال يتركز على الرحلة الصحراوية ومكابدة أهوالها، ومَزْج ذلك بالعنف والفخر بالنفس. كان الشاعر كما يظهر في القصيدة، جوال صحراء قاسية بصحبة أشد قسوة لأهداف غامضة في أحيان كثيرة. وكان المتنبي قد أرسى هذا المثال ثم عمم من بعده. وهو مثال يختلف عن المثال الجاهلي، حيث الرحلة إلى الأطلال والمجاهل رحلة ذات غرض واضح، وليس لها لون الدم. أما عند المتنبي فكانت غير ذلك:
ومدقعين بسبروت صحبتهم
عارين من حللٍ كاسين من درن
خرّاب باديةٍ غرثى بطونهم
مكن الضِّباب لهم زاد بلا ثمن
ومن هذه الصحبة الحربية مثلاً:
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة
ويستحل دم الحجاج في الحرم
لقد لوّن المتنبي رحلته بلون الدم. وكان العنف فيها احتجاجاً غامضاً على عصره. لكن هذا المثال صار تدريجياً مثالاً للشعراء في ما بعده. خذ مثلاً الشريف الرضي – معاصر أبي العلاء- فهو لا يفتأ يدخل من مَهْمَة إلى مهمه، ومن آبدة إلى آبدة، مشتركاً في الحروب والدماء، راضياً عن ذاته، فخوراً بها، نافخاً إياها إلى أبعد مدى ممكن.
لكن أبا العلاء، الذي مشى وراء هذا المثال في سقط الزند سرعان ما رفضه وتخلى عنه، بانياً مثاله على أرض أخرى، أرض القعود في البيت والتأمل في دراما الكون، رابطاً هذا باستصغار معلن للذات مضاد للمبالغات الرهيبة للشعراء. وانظر إلى الفرق بين هذه الأبيات والبيت الذي يليها:
أقول للوحش ترميني بأعينها
والطير يعجب مني كيف لم أطر
لمُشمعلّين كالسيفين تحتهما
مثل القناتين من أينٍ ومن ضمر
في بلدةٍ مثل ظهر الظبي بت بها
كأنني فوق ظهر الظبي من حذر
هنا يصنع أبو العلاء كما صنع الشعراء من قبله. فهو يقوم بالرحلة ذاتها، الرحلة الخطرة في الفيافي، أي أنه يتصرف كشاعر بصير، يتصرف وفق التقليد؛ فالوحوش الخطرة ترقبه وترميه بأعينها، والطير تدهش منه كيف أنه ثابت لا يهتز. كما أنه يبيت ليله في هذه الرحلة حذراً كأنه فوق قرني ظبي. لا جديد هنا... فهو يقلد المتنبي وغيره. ثم انظر إلى هذا البيت من اللزوميات:
إذا راكب نالت به الشأو ناقة
فما أينقى إلاّ الظوالع والحسرى
هنا ناقته لا تبلغ به شأوه، فهي ناقة ظالعة متعبة. والحق أنه ليس ثمة من ناقة ليرحل عليها، فالرحلة رحلة في أعماق الذات، وفي أعماق الناس والمجتمع.
وكان نفور أبي العلاء من مثال الشعراء تحول ليصبح نفوراً طاغياً من الشعراء أنفسهم ومن صنعتهم وزخارفهم:
بنى الآداب غرتكم قديماً
زخارف مثل زمزمة الذباب
أأُذهب فيكم أيام شيبي
كما أذهبت أيام الشباب؟
ويضيف:
فما أم الحويرث في كلامي
بعارضة ولا أم الرباب
وإن مقاتل الفرسان عندي
مصارع تلكم الغَنَم الرباب
وألقيت الفصاحة عن لساني
مسلمة إلى العرب اللباب
هنا يوجد أكمل تعبير عن رفض أبي العلاء لمثال الشعراء في عصره. فهو يرفض زمزمتهم وغزلهم وتشبيبهم، ويرى مقاتل الفرسان التي يتحدثون عنها كما لو أنها مقاتل أنعامٍ وأغنام. ثم يقول جملته الأخيرة: ( وألقيت الفصاحة عن لساني)، أي أنه يرفض فصاحتهم ويرمي بها. ففصاحته منذ الآن غير فصاحتهم.
شاعر الاعتراف
ويربط أبو العلاء نفوره من الشعراء برغبة عميقة في تقديم الاعتراف. إنه شاعر الاعتراف بلا منازع في الشعر العربي. فهو يكشف بلا هوادة عن مكامن ضعفه وعن مخازيه. بل إنه يبالغ في ذلك إلى حد جلد النفس، يقول:
أجامل الناس ولو أنني
كشفت ما في السرّ أخزاني
ويضيف:
وقال الفارسون حليف زهد
وأخطأت الظنون بما فرسنه
ولم أعرض عن اللذات إلا
لأن خيارها عني خنسنه
إنه ليس بزاهد كما يظنّ الناس، فإعراضه عن اللّذات نابع من أنه لا يستطيع أن يصل إلى اللذات العظمى. ويقول:
وما كنت في الرزء الجليل بصابر
ولا عند حطبٍ هزّني بحليم
إنها اعترافات لا تجدها إلا في السير الذاتية الحديثة. فهي تطال الأعماق التي عادة ما يتم إخفاؤها. لقد قطع أبو العلاء، إذن، نفسه عن الآخرين وعن الدروب التي ساروا فيها. غير أن القطيعة لم تحدث هذه القطع مرة واحدة. فقط كان في البدء مهووساً، مثله مثل "بشّار" الضرير في ما مضى، بالبحث عن صور بصرية تمكنه من مطاولة الشعراء المبصرين والتفوق عليهم. كان يريد أن ينفي عماه وأن يكون شاعراً بصيراً، كما فعل بشار ببيته الذي طالما تعجب أناس كيف أتى به وهو ضرير:
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
والبيت في الواقع بيت عادي بلونين اثنين: لون الضياء ولون الظلمة. وقد بحث أبو العلاء عن ما بحث عنه بشار في هذا البيت، ونحن نذكر بالبيت المعروف له:
ليلتي هذه عروس من الزنج
عليها قلائد من جمان
وهي صورة بصرية تشابه من حيث عاديتها صورة بشار بلونيها الاثنين. وفي مسعاه كان أبو العلاء يحصل أحيانا على بعض الصور البصرية الأشد جمالاً، مثل الصورة المعروفة التي نالت الإعجاب دائماً:
وكاد الفجر تشربه المطايا
وتُملأ منه أوعية شنانُ
إنها صورة بصرية جميلة. فالنهر جدول توشك المطايا العطشات أن تكرع ماءه. لكنها، مع ذلك، لا تملك تنوعاً في اللون. فهي خليط من اللونين الأساسيين، الأبيض والأسود. ويمكن ردّها إلى التراث المعروف لبعض الشعراء، أو إلى ذاكرة الطفل الضرير التي لا تزال تذكر الظلمة والنور.
بمثل هذه الصورة وصل أبو العلاء إلى ما يشتهيه من منافسة للشعراء المبصرين في حقلهم. لكنه، في ما يبدو، كان غير راضٍ في أعماقه عن هذا الطريق. كان هذا الطريق مفروضاً عليه. وكان مثاله مأخوذاً من مثال الآخرين.
وقد تخلّص أبو العلاء، في ما بعد، من هذا كله، فلم يعد يهتم كثيراً بالصورة البصرية. لقد أدرك أنه شاعر ضرير، وأن عليه أن يقبل بذلك وأن يجعل منه نقطة تفوقه. وحين فعل ذلك صارت القوة التعبيرية، لا الصورة البصرية، هي الأساس عنده. ويمكن للمرء أن يعثر في شعره حتى على نقد لمسلكه القديم، وعلى نقد محدد لصورة الجدول - الفجر الجميلة المذكورة سابقاً، بالذات. إنه ينقدها مباشرة وبلا مواربة:
فلا النور نوار ولا الفجر جدول
وكان خيالاً لا يصحّ التوهم
لقد كان البحث عن فجر كالجدول عبثا. كان خيالا لا نفع فيه. ليس هذا هو طريق الشعر كما يراه أبو العلاء الكهل. وهذا البيت يحمل انتقادا للطريقة التي تبنى بها مثل هذه الصورة من جهة، وللسذاجة القديمة في رؤية العالم من جهة ثانية. وبعد الآن فليس الفجر جدولاً، إنه شيء آخر تماماً:
وكأنما الصبح الفتيق مهنّد
للقهر ماء فرنده موار
هذا هو الفجر إذن. إنه سيف للقهر والضرب، وهذه صورة لا تضع اللون في رأس اهتمامها وإنما الفكرة. لقد عبر أبو العلاء الفجر- الجدول من دون أن يملأ منه قربته. كان يبحث عن جداول أخرى ليملأ بها شنانه.
شاعر مسكون بالشعراء السابقين
وإن كان أبو العلاء قد نفر من شعراء عصره ومثالهم، فما من شاعر عربي حاور التراث الشعري العربي قبله كما فعل هو، من ناحية أخرى. فشعره شعر حوار مع هذا التراث. إنه رغم غربته عن شعراء عصره مسكون بالآخرين. وهو يعمد، في الغالب، إلى الشعراء الأقل شأناً أو إلى المجهولين لكي يحاورهم ويكشف أعماقهم وأساطير حياتهم. إنه يعارضهم ويوسّع مدى أبياتهم ويعطيها مغازي لم يفكروا فيها، ربما. واللزوميات، بالذات، مليئة بهذا الحوار المباشر وغير المباشر. ولن تستطيع أن تفهم كثيراً من أبياته، إذا لم تكن ملماً بتاريخ الشعر العربي. خذ بعض الأمثلة على ذلك. فهناك بيت لقيس بن الخطيم، يقول فيه:
إذا جاء هذا الموت لم يلف حاجةً
بنفسي إلا قد قضيت قضاءها
فيحاوره أبو العلاء قائلاً:
إن كان لم يتّرك قيس له وطراً
إلا قضاه فما قضيت من وطر
هنا يرفع أبو العلاء بيت قيس ليجعله تعبيراً شاملاً عن الامتلاء والرضا عن النفس، وتعبيراً عن الاكتفاء من الحياة عند قدوم الموت. ثم يعارضه بشعور آخر، شعوره، المعبّر عن الخواء والخسران وعدم الرضا. وهو بهذا ينقل الحوار مع ابن الخطيم إلى مستوى فلسفي، لم يفكر فيه الأخير أغلب الظن. ثم أنظر إلى بيت شاعر آخر هو "الثقفي" الذي يقول فيه:
يا رب مثلك في النساء غريرة
بيضاء قد جهزتها بطلاقِ
إنه مرة أخرى ينتزع هذا البيت ويصعد به إلى الأعلى:
لم ألف كالثقفي بل عرسي
هي السوداء ما جهزتها بطلاقِ
إنها القضية النقيض تماماً: الأبيض والأسود، الامتلاء والخواء، القوة والضعف يتواجهان مباشرة. أما عرسه التي لم يطلقها، فهي الدنيا، فهو يتمسك بها رغم كل مراراتها.
وهكذا يمضي أبو العلاء ليحاور الشعر والشعراء قبله. أما حواره غير المباشر فيمكن أن نعثر على نماذج منه في حوار يبدو أنه حوار مع طرفة بن العبد. يقول طرفة في بيته المعروف:
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني
وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد
وهكذا فإنك إن بغيته وجدته في أماكن الفخر، وإن التمسته اصطدته في أماكن اللهو. فهو بين الخمر والفخر. أما أبو العلاء فغير ذلك تماماً. إنه على النقيض من ذلك:
من رامني لم يجدني
إن المنازل غربة
هو ذا من رامه لم يجده. ومن بغاه لم يلقه. فالوجود أصلاً عدم ولا وجود. أما حوانيت الخمر فقد هجرها منذ زمن، رغم أنه يكاد يحن إليها:
أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة
ثم خذ بيت طرفة الثاني المعروف:
ولست بحلاّل التلاعِ مخافةً
ولكن متى يسترفد القوم أرفد
أما أبو العلاء فلا يحل التلاع، إنه يحل الوهاد:
وليس بيتي على الروابي
وإنما آلف الوهودا
إن حوار أبي العلاء يصعد بالعادي إلى الفلسفي. وهو حوار معارض ونقيض ومخالف. حوار يتم بضربات واضحة دون زيادة ولا زخرف يشبه "زمزمة الذباب". وبراعة أبي العلاء تكمن في قدرته على تحويل الواقعي المبتذل إلى فلسفي، والعادي إلى كوني. خذ مثلاً هذا البيت:
لُبت حول الماء من ظمأٍ
إن غربي ما له مرس
كان يمكن لهذا البيت أن يكون لشاعر آخر. لكنه سوف يكون حينها وصفاً لرجل عطش يلوب حول الماء ولا حبل لدلوه. أما هنا، فإنك تحسّ باللوعة الوجودية القاتلة، لوعة الظمأ الذي لا يروى للإنسان في هذا العالم.
استئناس الموت
وقد كان الموت هو الفضاء الذي يتحرك فيه شعر أبي العلاء. وهذا الموت طاحن وساحق يدخل من كل باب ومن "الجهات الست" كما يقول الشاعر. ويمكن القول إن شعر أبي العلاء كله هو محاولة متواصلة لاستئناس الموت وترويضه وقبوله. إنه يقاتله أحياناً بإظهار اللهفة إليه:
أنا صائم طول الحياة وإنما
فطري الحمام ويوم ذاك أعيد
وأحياناً بإظهاره بمظهر مضاد، أي باعتبار الموت حياة وخصباً:
فالنفس أنثى لها بالموت إعراس
أو بإظهاره وكأنه الهدف الحقيقي للرحلة، رحلة الحياة:
والشخص مثل نجيبٍ رام عنبرةً
من المنون فلما سافها بركها
فالجسد، جسد الإنسان يسعى لإلى الموت، مثل جمل يسعى لنبتة ما وحين يشتمها يبرك قربها ليأكل. فالموت هو الهدف والمبتغى. لكن هذه المحاولات التخيلية سرعان ما تتهاوى تحت وطأة الخوف من الموت واليأس منه:
وكيف أقضي ساعة بمسَّرة
وأعلم أن الموت من غرمائي
وإذا كان الموت هو المحور الذي تدور عليه حياة الإنسان ومأساتها، فإنه لا يصح الحديث عن موت وحياة كنقيضين. إنهما شيء واحد هو الموت فقط.
والناس مثل النبت يظهره الحيا
ويكون أول هُلكِه الإظهار
الناس نبات يطلعه المطر، لكنه طلوع للموت. بدء الحياة هو بدء الموت، وأول الهُلك الإظهار. والإنسان إذ يحيا فإنه يموت. إنه لا يمارس حياته، إنه يمارس موته بالأحرى: "فهو يفنى كلما انتسما"؛ أي يموت حين يتنفس، كما يقول الشاعر في موقع آخر.
وأبو العلاء مغرم بالتناقض. فهو يبحث عن المتناقضات ويكشفها في كل لحظة ويستمتع بعرضها. التناقض بين صعود الروح، ونزول الجسد، بين الصعود كصعود والهبوط بشكل عام، بين الاسم والمسمّى، بين الصفة والموصوف، بين الغاية والوسيلة، بين الإرادة الإنسانية والقَدر. فالحياة عنده كتلة من المتناقضات التي يصعب فكها عن بعضها. وهو كثيراً ما يبدأ قصائده بعرض هذا التناقض مباشرة بلا لف ولا دوران. خذ هذا البيت مثلاً:
أعن واقدٍ خيرتني وابن جمرة
وآل شهاب خامد كل واقد
هنا التناقض الحاسم والمأساوي بين الاسم والمسمّى. فالأسماء توحي بالتوقد والاشتعال. لكن الخمود والانطفاء هما النهاية والغاية. فالاشتعال وهم، والانطفاء هو الحقيقة.
وخذ أيضاً هذا البيت:
ومن لصخر بن عمرو أن جثته
صخر وخنساؤه في السرب خنساء
هنا أيضاً يلعب أبو العلاء على التناقض بين الاسم والمسمّى. فصخر أخو الخنساء كان سيتمنى لو كان صخرة تعلو على الموت، في حين أن الخنساء أخته كانت ستكون أفضل لو كانت غزالاً أخنس. إنه يصّر على التناقض في كل مكان، يقول:
لقد طال في هذا الزمان تعجبي
فيا لرواء قوبلوا بظماء
ويضيف:
رقوا ورقدنا فاعتلوا في هوينا
وتلك المراقي غير هذي المراقد
ويزيد:
دعيت أبا العلاء وذاك مين
ولكن الصحيح أبا النزول
أما حقول استعارات أبي العلاء الكبرى فهي لغوية عروضية وفلكية وحيوانية مرتبطة بالإبل، وهو يعثر على منجب لا ينصب في كل حقل من هذه الحقول يدفعه إلى اكتشافات جديدة. فلنأخذ هذا المثال على استعارته الفلكية. فالروضة العارية تمسي غناءً تزدهر فيها الشقائق بعد المطر:
وقد أهبط الروضة الزهراء عارية
سدّى لها الغيث نسجاً، فالنبات سَدِ
تمسى الشقائق فيها وهي قانية
مما سقاها رعاف الجدي والأسد
ازدهار الشقائق نابع من (رعاف الجدي والأسد)؛ أي من المطر الذي يتأتّى عن التقاء برجي الجدي والأسد. هكذا تقول تفاسير هذا البيت في اللزوميات. لكن الاكتفاء بهذا التفسير يقلل من قيمته ومن الذروة التي بلغها فيه أبو العلاء. فواضح لي أن أبا العلاء يقصد معنى آخر بهذا البيت، لعله يكون قصده الرئيسي. فالشقائق حمر من رعاف الدم في الصراع الأبدي بين الجدي والأسد، بين القاتل والضحية. إن حمرة الشقائق هي حمرة الدم المأساوي هذا. وهكذا فقد مكنته استعارته الفلكية من الوصول إلى معانٍ ما كان من السهل الوصول إليها. والمعنى المشار إليه أليق بالروح المأساوية لشعر أبي العلاء. لكن المفسرين القدماء لم يستطيعوا أن يفهموا هذه الروح، ما جعلهم يضيقون من مدى شعر أبي العلاء وتحليقاته.
أقول إن هذا البيت يحمل، أيضاً، إشارة إلى أسطورة أدونيس – تموز التي ظلّت منتشرة في بلاد الشام إلى أيامنا هذه. فازدهار الشقائق أخذت حمرتها من دم أدونيس الذي قتله خنزير بري. كذلك يمكن الاعتقاد بأن النعمان الذي قتل رفيقيه ونبتت مكانهما الشقائق كان موجوداً في خيال الشاعر حين كتب البيت.
أما استعارته اللغوية فقد ضرب على وترها، وكان يصيب ويخطئ. فمرة تأتي استعارات باردة ومرة أخرى تأتي قوية مؤثرة وغير مسبوقة:
والمرء يطلب أمراً ما يبنيه
كالحرف ينطق بين الزاي والصاد
لقد مكّن العمى أبا العلاء من التغلب على التشويش البصري الذي تسببه العين، وهذا ما جعل خياله وفكره يصعدان إلى أفلاك لم يصعدها أحد من قبله. وهذا يعني أنه استطاع، على الصعيد الشعري، أن يستوعب عماه ويحوله إلى قوة فعّالة. ومن الناحية الوجودية فقد حوّله إلى رمز شامل لعمى الإنسان وضلاله في الكون. فالعالم عمى مضاعف. وليس أبو العلاء هو وحده الذي يعيش في ليلة مثلثة العتمة، فالكل يخبطون في الظلام:
وبصير الأقوام مثلي أعمى
فتعالوا في حندس نتصادم
ويضيف:
جميعنا يخبط في حندس
قد استوى الكهل والناشئ.
Zak_cyclamen@yahoo.com