
حل إعصاراً على دمشق السبعينات، حاملاً معه جغرافيا مهملة ومنكوبة على تخوم الكتابة والحياة. ثم هجّ الكردي ابن «الجزيرة السورية» إلى بيروت، ليكرّس واحداً من أشعر شعراء الضاد. من القصيدة إلى الرواية، ومن قبرص إلى استوكهولم، لم يغادر سليم بركات المكان الأول، وبقي صمت مريب يطارد تجربته عبر المنافي
يقع نصّ سليم بركات في خانة الكتابة المارقة والنبرة الشعرية التي لا تشبه غيرها في المعجم. هذا الشاعر الرجيم ألقى حجارة ثقيلة في ماء الكتابة الراكدة، فأحدث زلزالاً في اللغة. وكان على «أباطرة» الشعر السوري أن ينتبهوا بجدية وريبة وحذر إلى أبجدية جديدة، اخترعها الشاب العشريني الذي أتى كالعاصفة إلى دمشق مطلع سبعينيات القرن المنصرم. وإذا به يلفت الانتباه إلى جغرافيا مهملة ومنكوبة ظلت تاريخياً على تخوم الكتابة والحياة والهامش. لم يكن أحد قد سمع في دمشق أو خارجها، بقرية تدعى «موسيسانا» كي تكون عنواناً لقصيدة بتوقيع شاعر مجهول من أقصى شمال البلاد أو ما يسمّى «الجزيرة السورية». هذه المنطقة التي لطالما كان ُينظر إليها كمنفى بعيد وغامض ومخيف.
لكنّ سليم بركات كان كائناً شرساً مثل قصيدته تماماً، وسرعان ما أحس بغريزته أنّ دمشق ضيّقة على نصّه وعلى بلاغته النافرة، فشدّ رحاله إلى بيروت. هناك، أثار عاصفةً أخرى إلى درجة اضطرّ أدونيس معها إلى أن يعترف له: «فاجأتني وقلّما أُفاجأ». هكذا انخرط في مشروع مجلة «مواقف» فور بدايته، قبل أن يفترق عنه لاحقاً بسبب تباعد الأهواء والنيات، لتقوده خطاه إلى دروب محمود درويش إثر صدور مجموعته الشعرية الأولى «كل داخل سيهتف لأجلي، وكل خارج أيضاً» (1971). إذ بادره مرة «أنت وحشيّ، نفور جداً. لماذا لا تقول مرحباً؟».
هكذا، ستنشأ صداقة عميقة بين فتى الشمال الكردي وشاعر الثورة الفلسطينية في رحلة تيه طويلة... وسيردّ محمود درويش التحية إلى صديقه المنفي الأبدي في قصيدة آسرة بعد سنوات طويلة من العمل شريكين في مجلة «الكرمل» وشريكين في التيه. كانت القصيدة بعنوان «ليس للكردي إلا الريح». يقول فيها: «يعرف ما يريد من المعاني. كُلُها عبثُ. وللكلمات حيلتُها لصيد نقيضها عبثاً. يفضّ بكارة الكلمات ثم يعيدها بكراً إلى قاموسه. ويسوس خيل الأبجدية كالخراف إلى مكيدته».
مجلة «حجلنامة» التي تصدر باللغة العربية في استوكهولم، خصّصت عددها الأخير لتجربة صاحب «فقهاء الظلام» الذي استقرّ به المقام في العاصمة السويدية منذ عقد من الزمن.
يقول بركات عن منفاه الحالي: «في المطبخ، تحديداً، أضع خططاً للقيامة:
قراءة في كتب مرهقة. قياس شفير النحو وهاوية الصّرف. نحت علوم هاربة، تتماوج مع البخار في آنية الطبخ. إقامتي هي هنا، في مطبخ دولة من الأفاويه والتوابل تمتحنني وأمتحنُها، مستطلعاً من النافذة، أبدأ، دورة الأزل الصغير: قراءة. صمت كثير. تطريز عائلي على قماش المصادفات العائلية. كتابة. في المساء تتشاجر الصور والكلمات في أسطر الشعر فيها، فلا أتوسّط للجمها. كتابة يُضرِبُ شخوص الرواية فيها، أحياناً، فلا يحضرون. ربع ساعة قبل الثانية عشرة، لا أجاوزها، مغادراً كهف الحياة إلى عراء النوم».
يعترف سليم بركات بأنّ اللغة منفى لأنّها الحدود الاجتماعية والدينية للمخيّلة «أما أكاذيب الشكوى عن منافي اللغات الأخرى (غير الأم المُرضعة)، فعليها أن تُستبدل بالمساءلات الكبيرة في الهوية». ويضيف موضحاً «الهوية هي القلق. واللغة رطانة».
لم يكتب صاحب «الريش» (1990) في اللغة الكردية، لأنّه كما يقول لا يجيدها إلا شفاهاً، وتالياً لم يشعر يوماً بأنّه منفي «لأنني لم أكن في يوم ما أملك ما هو نقيض المنفى». ويرى أنّ اللغة العربية «إثراء هائل لهويتي الكردية. وهي الحرّية التي يُقدم بها ألمي اعترافه إلى المكان».
سطوة المكان ولذة الحكي والمكاشفة سوف تكون بوصلة سليم بركات لاكتشاف خرافة الكون وقلق الكائن المهمل، وتراجيديا المنسيين. هكذا، سيكتب باكراً سيرة طفولته في «الجندب الحديدي» (1979)، ثم سيرة صباه في «هاته عالياً، هات النفير على آخره» (1980). وإذا به يضيء فضاءً سحرياً وغرائبياً معجوناً بالخراب، عن أمكنة مكلّلة بالغبار والنسيان وبروق الشمال وطفولة ممزّقة ومنكوبة ومليئة بالذعر. وبقدر ما كانت هذه الطفولة الخرقاء مدهشة بالنسبة إلى الآخرين، كشفت من جهة أخرى عن محنة لا توصف ومسلخ للألم والقسوة والهباء. كأنّ هذه الطفولة المعذّبة لا تُكتب إلا عبر بلاغة وحشية كالتي اخترعها سليم بركات في وصف «مصائر الشمال» وملهاته السوداء. ولعل هذا ما جعل الطاهر بن جلون يصف السيرة بأنها «أعجوبة نقية وكتابة مجنونة وخطرة مترعة بالشعر رغم كل هذا العنف».
لن يغادر سليم بركات مأساة الشمال وملهاته في رواياته اللاحقة وستكون أعمال مثل «أرواح هندسية» و«الريش» و«معسكرات الأبد» اقتصاصاً أكبر من ذاكرة لا تكفّ عن استدعاء شخوص وأمكنة وحيوانات ونباتات برية. كل ذلك في سجادة لغوية تمزج ما هو شعري بسرد أخّاذ يستدعي شبكة معقّدة من الذكريات والأحلام والتجارب والأسماء الغامضة والألغاز وفلسفة تبيّن «عبثية الوجود وسفاهة شؤون الإنسان» واشتغال صريح على الحدس والغريزة في إعادة بناء عالم متصدّع. عالم لفرط غرابته وواقعيته، يبدو في نهاية المطاف، كما لو أنّه أسطوري. ويفسر سليم بركات وعورة مناخاته الروائية بالقول «رواياتي صعبة. أعرف ذلك. فسيفساء مدروسة متقاطعة الواقع كلعبة بلا ميثاق. كتابتي اشتغال قدري عليّ واشتغالي على قدري».
لكن أين يفترق سليم بركات الشاعر عن سليم بركات الروائي؟.
يفسر هذا الاشتباك البلاغي بقوله «لست حذراً قط في شعري، ما دمتُ غير معنيّ بحدود فيه. ولست حذراً في الرواية أيضاً، ما دامت تتسع أكثر لكمالها المُحيّر». وهو ما يلفت إليه عباس بيضون «إن صنيع سليم بركات في اللغة يشبه صنيع النحّات الذي يستنطق مادته. ولعلنا لا ننسى ذلك النحّات الذي قال إنه لا يفعل سوى أن يزيل الزوائد عن الحجر». أما أمين صالح فيقول «مع سليم بركات، نكتشف سحر اللغة وفتنة الصور وبهاء المخيلة وغفلة الكائن فيما هو يرتقي لاهياً سلالم المأساة».
النص الذي هتك قداسة اللغة بنقيضها وأطاح المألوف الروائي العربي بعناصر تستقطب الجنون والهذيان والشك والحلم واستلهام الرموز وتفكيكها والتنقيب في مضائق المحكي، ظلّ بمنأى عن النقد الرصين ربما بسبب تمنّعه واستراتيجياته المغايرة في التشظّي والغموض والغرابة والفتنة الجارحة. ذلك أنّ شخوص سليم بركات وكائناته السحرية، تثير أسئلة عصيّة ومآزق وجودية وقدرية وميثولوجية، أقرب ما تكون إلى متاهات بورخيس. ما يستدعي سؤالاً جدياً: هل هناك مؤامرة فعليّة ضد سليم بركات وإلا فما تفسير سرّ الصمت المريب تجاه منجزه الاستثنائي وحياته المبعثرة من منفى إلى آخر؟.
**
حشائش الطفولة وكائناتها الغريبة
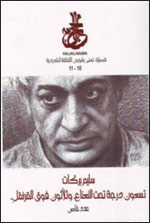 تحتشد في نص سليم بركات أسماء حيوانات وطيور ونباتات وغيرها من عناصر الطبيعة، بما يشبه تظاهرة في العراء. فمن بنات آوى والثعالب والدجاج والخراف إلى قطعان الذئاب.. الكراكي والدّيكة والزرازير وأسراب الإوزّ والحجل والغرانق وأسماء أعشاب مجهولة. هكذا تتمازج الأصوات والروائح بالريح والغيوم والجبال في نداء طويل واستغاثة كائنات مبهمة.
تحتشد في نص سليم بركات أسماء حيوانات وطيور ونباتات وغيرها من عناصر الطبيعة، بما يشبه تظاهرة في العراء. فمن بنات آوى والثعالب والدجاج والخراف إلى قطعان الذئاب.. الكراكي والدّيكة والزرازير وأسراب الإوزّ والحجل والغرانق وأسماء أعشاب مجهولة. هكذا تتمازج الأصوات والروائح بالريح والغيوم والجبال في نداء طويل واستغاثة كائنات مبهمة.
تحتاج هذه الخصوصية إلى وقفة تأمل وفحص جدية. فهو على أي حال، لا يقتفي في مدوّنته أثر ابن المقفع في «كليلة ودمنة» أو الجاحظ في «كتاب الحيوان»، إنما يستحضر هذه الكائنات من موقع مغاير. إذ لا يرتجي حكمة أو رمزاً. ويقول موضحاً هذا الاهتمام «إنني أرى الحيوان كما ينبغي أن أراه، شاغلاً حيزاً من الهواء الإنساني، لا كطبائع بل ككائن». ويضيف «الحيوان هو فراستي. الحيوان طفولتي كلها ـــ ذلك السحر الشيطاني الذي لا ننجو منه». ولعل هذا الحشد من الكائنات والمناخات الغرائبية هو الذي أغوى تيتس رووكي مترجم رواية «الريش» إلى السويدية، في الذهاب إلى مسقط رأس الروائي لمعاينة «مسرح الجريمة» عن كثب. في بلدة عامودا الحدودية، سينام رووكي فوق سرير خشبي في العراء، كما كان يفعل «مَم» بطل «الريش» وينصت ليلاً إلى عواء بنات آوى وخطوات «شبح ميرو المخيف وأكباشه العملاقة ترعد من السماء الملبدة بالغيوم، وتزمجر خلال صفحات الحكاية». إلى ذلك، يشير صاحب «بالشباك ذاتها، بالثعالب التي تقود الريح» إلى اهتمامات أخرى له، كاهتمامه بالطبخ. إذ يعدّ كتاباً عن الطبخ من موقع خبرته الشخصية في الطهو ونكهة حشائش الطفولة ونباتاتها وتوابلها، كما لو أنه يطهو حكاية من حكاياته المثيرة.
مؤلفاته صادرة عن «دار الكرمل» و«النهار» و«المدى» و«المؤسسة العربية للدراسات والنشر»...
الأخبار- ٣١ أيار 2007
إقرأ أيضاً:-