مقدمة أولى: (خاصة بجهة الشعر)
 في البداية، سأتوجه "باعتذار" شخصي للأصدقاء، الكتّاب والكاتبات الذين واللواتي شاركوا وشاركن معي في الاستفتاء الذي نُشر يومي الأثنين والأربعاء (6و8 شباط - فبراير 2006) في صحيفة "السفير" اللبنانية، تحت عنوان "أيها الكاتب ... هل تتعلم من فن آخر؟ ماذا تعرف عن المسرح أو الموسيقى أو الرسم أو الرقص أو السينما؟"، إذ يتطلب الأمر توضيحا بسيطا. نظرا لظروف العمل الصحافي الورقي، اضطررنا إلى حذف العديد من الفقرات من الأجوبة التي استلمناها. فكما يعرف الجميع، تتطلب منا المهنة أن نفعل ما لا نحبذه: الاختصار. سأفترض أن كثيرين لم يرق لهم هذا، ولكن بالتأكيد لم يكن الهدف "التجني" على أحد، إذ لم تسلم أي إجابة من "المقص" على الرغم من أننا حاولنا أن يكون مقصا رحيما، بمعنى أننا لم نتدخل في تغيير أفكار أحد بالطبع، فقط، تحديد المساحة. لذلك شكرا للجميع لأنهم ساهموا فيه وشكرا لهم على تفهمهم.
في البداية، سأتوجه "باعتذار" شخصي للأصدقاء، الكتّاب والكاتبات الذين واللواتي شاركوا وشاركن معي في الاستفتاء الذي نُشر يومي الأثنين والأربعاء (6و8 شباط - فبراير 2006) في صحيفة "السفير" اللبنانية، تحت عنوان "أيها الكاتب ... هل تتعلم من فن آخر؟ ماذا تعرف عن المسرح أو الموسيقى أو الرسم أو الرقص أو السينما؟"، إذ يتطلب الأمر توضيحا بسيطا. نظرا لظروف العمل الصحافي الورقي، اضطررنا إلى حذف العديد من الفقرات من الأجوبة التي استلمناها. فكما يعرف الجميع، تتطلب منا المهنة أن نفعل ما لا نحبذه: الاختصار. سأفترض أن كثيرين لم يرق لهم هذا، ولكن بالتأكيد لم يكن الهدف "التجني" على أحد، إذ لم تسلم أي إجابة من "المقص" على الرغم من أننا حاولنا أن يكون مقصا رحيما، بمعنى أننا لم نتدخل في تغيير أفكار أحد بالطبع، فقط، تحديد المساحة. لذلك شكرا للجميع لأنهم ساهموا فيه وشكرا لهم على تفهمهم.
من هنا، حين طلب مني العزيز قاسم حداد الحلقة الأولى التي لم يستطع الإطلاع عليها، أجبته بأن يتمهل قبل نشرها، لأنني أشعر بوجوب نشر الإجابات كاملة، أي مثلما وصلتني، لا مثلما نُشرت في الصحيفة، لعلي في ذلك أخفف من هذا "الوخز" الذي أصابني وأشعرني بذنب ما. لكن وبعيدا عن هذه الأحاسيس، أتاح لي الأمر أن "أفكر" قليلا بعملية النشر الالكتروني، أي كم أنها تحتمل أكثر مما تحتمل عملية النشر الورقي. ثمة فضاء واسع أمامنا، لا تقيده أي مسافة معينة. من هنا، علينا الاستفادة من هذه الطاقة الجديدة كي تكون هذا الحيز الذي يتيح لنا التصرف والتفكير، بعيدا عن أي ضغوطات مهما اختلف نوعها.
مرة أخرى شكرا لكل من ساهم في هذا الاستفتاء وشكرا لـ "جهة الشعر" التي تعيد نشر الإجابات كاملة.
مقدمة ثانية
غالبا ما نقول في حواراتنا إننا جئنا إلى الكتابة عبر القراءات التي وسمتنا. في ذلك الكثير من الحقيقة بدون شك، إذ ربما لم تكن الكتابة، في حصيلتها النهائية، إلا تحية لمن أحببنا من الكتاب الذين أثروا بنا والذين جعلونا ندخل إلى هذه العوالم التي لا نتوقف من سبر أغوارها لحظة إثر أخرى.
لكن وعلى الرغم من صحة أن الأدب هو الذي قادنا، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر ما يمكن أن تلعبه الفنون الأخرى في تكويننا الثقافي، بمعنى آخر، يمكن أيضا لفنون أخرى أن تقودنا إلى الكتابة، أن تساهم في فتح طاقات ونوافذ، أكثر من الأدب.
من هذه الفكرة حاولنا طرح السؤال التالي، على بعض الكتّاب العرب: "عدا الأدب، بطبيعة الحال، هل تعتقد (ين) أن ثمة فنونا أخرى قد أثرت بك وساهمت في تكوينك الثقافي". هنا الإجابات التي شملت 24 اسما.
(إشارة صغيرة أن عنوان كل إجابة هو من وضع المحرر)
***
 ليس الشعر ما يكوّن الشعرَ، ولا الأدبُ وحده. الفنون كلها والآداب كلها: السينما، المسرح، الرسم، النحت، الرواية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياسة، والحياة كلها، مكوّنات شعرية. والشعر هو كل هذا وإن اعتقد، خطأ، أنه فصيلٌ آخر أو كائن بذاته.
ليس الشعر ما يكوّن الشعرَ، ولا الأدبُ وحده. الفنون كلها والآداب كلها: السينما، المسرح، الرسم، النحت، الرواية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياسة، والحياة كلها، مكوّنات شعرية. والشعر هو كل هذا وإن اعتقد، خطأ، أنه فصيلٌ آخر أو كائن بذاته.
على شعري دَين لكل ما ذكرت، وحتى لرسوم ديزني المتحركة التي بالتأكيد تركت أثراً في مخيلتي وفكري. لا يمكنني أن أفاضل، ولا أن أجزم ما الذي كان له الأثر الأكبر. تلك كلها مختلطة الآن فيَّ، وشعري هو ابنها جميعاً.
***
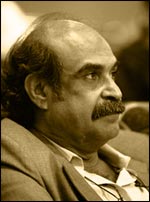 مبكرا أحببت الفنون البصرية عموما، والرسم خصوصاً. فقد تولعت مبكراًُ بالرسم وقرأت فيه أكثر ما قرأت في العشرينات من عمري. وهويت تكوين مكتبة من المطبوعات والكتالوجات واللوحات (المصورة طبعاً). حتى أنني كنت أزين قصائدي ودفاتر أشعاري المخطوطة بأعمال فنية أحببتها في ذلك الوقت.
مبكرا أحببت الفنون البصرية عموما، والرسم خصوصاً. فقد تولعت مبكراًُ بالرسم وقرأت فيه أكثر ما قرأت في العشرينات من عمري. وهويت تكوين مكتبة من المطبوعات والكتالوجات واللوحات (المصورة طبعاً). حتى أنني كنت أزين قصائدي ودفاتر أشعاري المخطوطة بأعمال فنية أحببتها في ذلك الوقت.
أكثر من هذا، أنني حاولت أن أرسم، لكنني فشلت فشلا ذريعاً، فصار ذلك الدرس رادعاً نوعياً، الأمر الذي دفعني إلى ابتكار أشكال مختلفة للذهاب إلى ممارسة ذلك الولع، فقد أغنتني تلك التجربة وذلك الحب الأول للتشكيل وساهما في صقل ذائقتي الفنية بصورة جعلتني قريبا كثيراً من آلية التداخل والتمازج بين الكتابة والتشكيل بوصفهما (في العمق) تقنية تعبير تتكامل في لحظة جامع الفنون الإبداعية.
وظني أن تلك العلاقة المبكرة وذلك الولع أسسا لما أصبح فيما بعد نزوعاً مميزاً من ملامح تجربتي الثقافية على وجه العموم، وسوف يتمثل ذلك في استعدادي العفوي ورغبتي الدائمة لممارسة التجارب الفنية المشتركة التي تصدر عن تقاطع الفنون التعبيرية، مع فنون وفنانين في أشكال تعبير بصرية، رسامين ومصورين.
وقد راقت لي هذه التجارب ولا تزال تمنحني إضافات نوعية من المتعة والمعرفة.
***
 ينبغي للإجابة على السؤال المطروح أن أتعامل مع مفردة "فنّ" باعتبارها دالّة على كلّ هواية أو ممارسة لاعبة وانهماكيّة تأتي لترفد الكتابة وتغذّيها. ذلك أنّ الطبيعة لم تهبني أيّة ملكة فنيّة إذا ما فهمنا المفردة الأخيرة باعتبارها ممارسة للرسم أو النحت أو ما يشبههما من فنون. ولئن حُرمتُ من ممارسات كهذه فأنا لم أفتقر إلى انجذابات عديدة كان للولع أن يتحوّل فيها إلى انخراط فعّال ودأب منعش للشخصيّة ومؤسّس لتجربتي الذاتيّة. وفي أوّل هذه الانجذابات أضع الاستماع إلى الموسيقى. الاستماع وحده، مصعَّداً إلى مصاف هواية دؤوب ومراس فنيّ.
ينبغي للإجابة على السؤال المطروح أن أتعامل مع مفردة "فنّ" باعتبارها دالّة على كلّ هواية أو ممارسة لاعبة وانهماكيّة تأتي لترفد الكتابة وتغذّيها. ذلك أنّ الطبيعة لم تهبني أيّة ملكة فنيّة إذا ما فهمنا المفردة الأخيرة باعتبارها ممارسة للرسم أو النحت أو ما يشبههما من فنون. ولئن حُرمتُ من ممارسات كهذه فأنا لم أفتقر إلى انجذابات عديدة كان للولع أن يتحوّل فيها إلى انخراط فعّال ودأب منعش للشخصيّة ومؤسّس لتجربتي الذاتيّة. وفي أوّل هذه الانجذابات أضع الاستماع إلى الموسيقى. الاستماع وحده، مصعَّداً إلى مصاف هواية دؤوب ومراس فنيّ.
لسنوات عديدة، ومنذ وصولي إلى باريس، رحتُ أرتاد صالات الموسيقى والعروض الغنائيّة، أستمع فيها إلى قديم الألحان وجديدها بخشوع هاديء ومستغرق يكاد أن يبزّ ذهول المتعبّد وحميّته لموضوع عبادته. مررتُ بجميع درجات الانفعال الصّامت التي يصفها مارسيل بروست في الجزء الأوّل من "البحث عن الزمن الضائع"، عبر استغواره العالمَ الداخليّ لبطله "سوان". كان يسيطر عليّ في البدء الانشداد إلى عبارة موسيقيّة واحدة تتكرّر في العمل الكلاسيكيّ كاللازمة وتعاود الظهور بعد طويلِ انتظار، وتعيد للمستمع المشدود إلى عودتها الموعودة فرحه كلّه. ثمّ سرعان ما اكتشفتُ أنّ هذا الانتظار لتجلّي اللازمة المحتجبة إنّما يقوم على انتظار طفوليّ جوهره الحنين والخوف من طول غيبة الأمّ أو موضوع الرّغبة، فرحتُ أتدرّب على تطويع انتظاري والانتباه إلى العمل الموسيقيّ كلّه والنظر إليه كبنيان متلاحم أو مرصوص. لزمني لأبلغ "لحظة الرشد" هذه قراءات كثيرة وتأمّلات استبطانيّة ونقد ذاتيّ لا أحسب أنّني حقّقتُه بنجاح كامل، لأنّ العبارة التي تتكرّر بعد انقطاع وتنبثق كما تعاود الشمس إطلالتها من بين الغيوم ما فتئت تأخذ بتلابيبي أحياناً من دون توقّع. يكفي أن تسقط رقابة الأذن التي تحسب نفسها مرهفة أو مثقّفة حتّى يفرض الطفل فينا أذنه الخاصّة من جديد. ولطالما تساءلتُ إن كان ينبغي الخروج من الطفل أو إخراجه منّا نهائيّاً.
لهذا الولع بالموسيقى جذور بعيدة. أتذكّر أنّ أحد جيراننا، الصديق المهندس قاسم حربي الذي يقيم الآن في منفاه الأسوجيّ، كان ، عندما يعود من بغداد في أثناء العطلة الجامعيّة، يُسمعنا المعزوفة الشهيرة التي وضعَها ميكيس تيودوراكيس للفيلم الشهير هو أيضاً "زوربا اليونانيّ". لم يكن لدى قاسم سوى هذه المعزوفة تشكّل كامل مكتبته الموسيقيّة أو تكاد، كان يُسمعنا إيّاها على حاكٍ قديم. ولقد همتُ بها حتّى صرتُ أفرض نفسي على منزله يوميّاً بلا سابق إنذار أو دعوة، أرجوه أن يُسمعني المعزوفة. حتّى قبل أن أرى الفيلم وأشاهد أنتوني كوين وهو يهب الرّقصة المرافقة للقطعة الموسيقيّة شحنتها العالية من التوثّب والاندفاع، كنتُ، بوعي الصبيّ الذي كان لي يومذاك، وعي يحسّ بالأشياء ولا يقوى على التعبير عنها بكلمات، أتخيّل لدى سماعها احتداماً داخليّاً وملحمة صغيرة، أو بالأحرى موجزة، لكائن يتحرّر من عوائقه ليلاقي وعده الخاصّ.
في فترة إقامتي العابرة ببغداد أيضاً كنتُ أرتاد قاعات الموسيقى الفولكلوريّة وأحاول مرافقة الجهد الذي يبذله مغنّي "المقام" ليفرض على انفعاله الصّاخب ظاهريّاً نظاماً وشكلاً. وأحسب أنّها الفترة نفسها التي وقع فيها بين يديّ كتاب صغير للروائيّ يحيى حقّي أعتقد أنّ عنوانه كان "ذاهب إلى الكونشرتو"، يصف فيها ولعه بارتياد صالات العزف أثناء إقامته الطويلة في باريس. يصف في إحدى الصفحات كيف تبعَ يوماً أحد عازفيه المفضّلين إلى المقهى بعد انتهاء الحفلة الموسيقيّة وراح يتأمّله وهو يشرب الجعة كسائر النّاس ليرى ما يميّزه عن بقيّة البشر الفانين. أنا لم أنخطف بالشخوص أبداً، بل إنّ الموسيقى الصافية تحيلهم لديّ إلى وسائط شبه غير مرئيّة تنقل لي "رحيق الآلهة" هذا. وإذْ أتذكّر الآن كتّيب الأستاذ حقّي عن ولعه بالموسيقى فأنا ألتفت إلى الأهميّة التأسيسيّة في تاريخ الأفراد التي تتمتّع بها بعض القراءات البسيطة المبكّرة.
***
 الرسم... إذا كان هناك فن أميل إليه، فن أميل إليه كثيراً حتى أكاد أقع فيه، وليتني أفعل، هو الرسم. سأل صالح دياب علي الجندي عن رأيه بي كشاعر. أجابه علي: ( منذر مصري... رسام! أليس كذلك؟ )
الرسم... إذا كان هناك فن أميل إليه، فن أميل إليه كثيراً حتى أكاد أقع فيه، وليتني أفعل، هو الرسم. سأل صالح دياب علي الجندي عن رأيه بي كشاعر. أجابه علي: ( منذر مصري... رسام! أليس كذلك؟ )
أحسب أني ولدت لأكون رساماً، هذه حقيقة، فواحدة من أولى مشاهد ذكرياتي، الحاضرة بالصوت والصورة، أنه في الصف الثالث ابتدائي عندما سأل أستاذ الرسم: ( من منكم يرسم جيداً؟) صاح الجميع: ( منذر. أستاذ.)
بعد نيلي الشهادة الثانوية أردت أن أتقدم للدراسة في كلية الفنون الجميلة في دمشق، ولأنه فاتني موعد امتحان القبول... درست الاقتصاد في حلب! لكني بقيت أصدق أن حياتي الحقيقية في الرسم، وكنت جاداً في ذلك حقاُ، حتى أني لم آخذ دراستي للاقتصاد إلا بكونه الحصول على شهادة جامعية! في حلب تعرفت على بسام جبيلي وكان يدرس معي في كلية العلوم الاقتصادية، وبذات الوقت يعتبر الرسم همه الأول. وقد بقي مخلصاً للرسم لليوم. لم يتزوج ولم يتعلم الموسيقى، رغم أنه ابتاع بيانو روسي، قضى نصف حياته يجلس ويعزف عليه، أي شيء، دون نوته. ولا أظنه عزف مرة لحناً معروفاً أو حتى ذات اللحن! وفي معرضنا المشترك الأول والأخير في صالة الكلية، تعرفت على مأمون صقال وسعد يكن، ولأني سريع الخيانة هجرت بسام ولحقت بهما. رغم أنه حذرني بقوله: (انتبه يا منذر .. إنهما يرسمان الناس يرتدون ثياباً، إما نحن فنرسمه عارياً.. على حقيقته) قلت له وقتها: (بسام.. ما أريد رسمه هو الواقعي، العابر، الفاني، وليس الحقيقي الثابت الأبدي). من مأمون تعلمت أن يكون خطي قوياً وواضحاً.. أثر ذلك بالتأكيد على مفهومي للغة في شعري.
بقيت أرسم دون انقطاع تقريباً وأقيم معارض فردية في دمشق وحلب وحمص ومدينتي اللاذقية، كان أخرها معرضي الثامن عام 1983... بعدها مضيت صافياً، لا ليس صافياً، بل عكراً إلى الشعر.. لأني كنت غالباً ما أعود وأوصي نجاراً بإطارات خشبية بقياسات متنوعة، واشد عليها قماشاً كتانياً، وأطليها بخليط من الغراء والدهان الأبيضين مناصفة، ثم أركنها جانباً، حتى أهب في ليلة ليلاء وأقوم برسم سلاسل لا تتنهي من طيور ليلية 1993-1994 ثم رجل يدير ظهره وعلى كتفه ينسدل شعر امرأة أو شعر قصيدة! 1994- 1996 ثم سلسلة ( ساقا الشهوة ) بالأقلام الخشبية والباستيل 1997 إحداها غلاف مجموعتي ( مزهرية على هيئة قبضة يد) ثم 2001-2002 سلسلة( زجاجات، لا أحد غير الله يعلم ماذا تحتوي ) وأخيراً في عام 2004 عدت للرسم بالألوان الزيتية وبدأت سلسلة لوحات لا أستظهر فيها أي مقدرة بالرسم أو التلوين، فقط مربعات صفراء غالباً ضمن فراغات أسود غالباً!!
ولأني، ليس كسواي أبداً، أقصد أولئك الشعراء الذين يرسمون، وغالباً ما يرسمون سيئاً، ولا الرسامين الذين كنت أصدق أنهم غالباً يكتبون جيداً، ولكن تبين لي أن هذا ليس صحيحاَ أيضاً، قمت بحل تلفيقي لمشكلة أني معروف كشاعر أكثر بكثير مني كرسام، رغم أني كرسام أفضل مني بكثير كشاعر! أو مشكلة ذاتها بتعبير آخر، هو أن أصدقائي الشعراء، ومنهم الراحل محمد سيدة، يعتبرونني رساماً عظيماً ولكني أفسدت ذلك بكتابة الشعر، وأصدقائي الرسامون يعتبرونني شاعراً هاماً ولكني أضيع وقتي في الرسم. بأن أجمع الرسم والشعر معاً عندما اضطر لأن أقدم أمسية شعرية أو أشارك في مهرجانات ثقافية، كما حصل في ربيع الشعراء مرتين في دمشق واللاذقية، وفي السمبوزيم الشعري في "كافالا" في اليونان 2002 والدائرة المستديرة حول سوريا في اليونسكو في باريس 2003 ومهرجان جرش 2004 وغيرها.. أي أني أقوم بإطفاء الضوء كلياً في الصالة وأقوم بعرض رسومي بواسطة عارض أقراص ليزرية على أكبر شاشة متوفرة، خلفي. وأنا أقرأ قصائدي، إما من أوراق أمامي على المنبر، وإما أن تكون مكتوبة أو مرسومة على اللوحات المعروضة نفسها. قال لي أمجد ناصر بعد أحد وصلاتي الشعرية: (هذه أول مرة أرى شاعراً يقرأ أشعاره وهو يدير للجمهور ظهره) أما صبحي حديدي فمرة أطلق صيحة: ( منذر مصري، تشكيل وشعر!؟ اهربوا ) ثم صرت أعرف بهذه الطريقة رغم اعتراض كثيرون عليها، ورغم شعوري أن بها قدراً غير قليل من الافتعال، ولكن.. أ ليس الفن كله افتعالاَ، على نحو ما.
الآن لدي في مرسمي، الذي نسيت أن أذكر لكم شيئاً عنه، إطارات عديدة تنتظر أن أشد عليها قماشاً وأرسم .. أرسم أي شيء، أي شيء، وأظن أني سأعود لفعل ما أفعله بأفضل وجه، أي لرسم ما أرسمه بأفضل وجه، سأرسم أناساً، أناساً نصف عراة ونصف يرتدون ثياباً، أي أناساً بثياب داخلية.. لماذا لا؟ بذلك ربما أكون قد وجدت تصالحاً بين بسام جبيلي من جهة، وبين سعد يكن ومأمون صقال من جهة أخرى، بين الجوهري والأبدي الذي هو الله، وبين العابر والمؤقت والفاني الذي هو... البشر... نحن.
***
 بدءاً لابد أن أشير إلى أنني "في بغداد" كنتُ درستُ المسرحَ سنتين والسينما ست سنوات. وبالتالي فإن كلامي عن الفن المصاحب للأدب في حياتي سيكون كلاماً عن محترف مّا في ذلك الفن"المسرحي والسينمائي" حتى إن لم أكن مارسته عملياً.
بدءاً لابد أن أشير إلى أنني "في بغداد" كنتُ درستُ المسرحَ سنتين والسينما ست سنوات. وبالتالي فإن كلامي عن الفن المصاحب للأدب في حياتي سيكون كلاماً عن محترف مّا في ذلك الفن"المسرحي والسينمائي" حتى إن لم أكن مارسته عملياً.
تعوَّدَ الأديب عندنا أن يدرس الأدب. أقراني كانوا يفكرون في الدراسة في كلية الآداب. لكنني كنت أقول إذا كنت أنا أديباً بدون كلية آداب فلماذا عليَّ أن أدرس فيها ما يمكن أن أعرفه بدونها؟ لماذا لا أدرس الفن؟ والمسرح كان انشغالاً شعرياً في ذهني أكثر من غيره. كنت قارئ مسرح أيضاً..نصوصه ونظرياته. وحين تم لي هذا تحولت بعد سنتين من دراسته إلى فرع الإخراج السينمائي وفي التخرج كان لا بد لي أن أقدم أطروحةً سينمائية للتخرج: فيلماً قصيراً. فقدمت تجربة أكبر من إمكاناتي السينمائية الحقيقية وأكبر من إمكانات السينما في المعهد الذي درست فيه..لقد قدمت فيلماً شعرياً.قصيدة لي اشتغلتها فيلماً.
تحويل القصيدة الى فيلم أمر صعب على أية إمكانات. السينما فن واقعي والشعر لا يُفسَّر.لكنني غامرت مغامرة "طريفة" في عمر الشباب ذاك.
وواصلت دراستي السينمائية بعد ذلك الفيلم سنتين أخريين في أكاديمية أعلى ثم فصلت منها لأساق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية ولأهرب بعدها من العراق ولأدرس في مدريد في كلية الفلسفة والآداب.
هل طلقت الدراسة السينمائية؟
لا.
لكنَّ هدف الدراسة الفيلولوجية للغة أجنبية أخرى في مدريد كان أقوى من أية رغبة أخرى.
حين كنت قررت الذهاب إلى الدراسة الفنية في بغداد فبقرار حازم في عدم ممارسة الفن ممارسة عملية خوفاً على الشعر. لم أمارس الفن في عمل أو في وظيفة قط.
كنت أريد من دراستي الفنَّ أن تكون لي عوناً في الشعر وربما على الشعر أيضاً. ماذا تعلمت من المسرح والسينما من أجل الشعر؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُسأَلَ دائماً.
الإجابة صعبة إن كانت أكاديميةً أو شخصية.
لكن. ولن أكرر ما قاله إخوة نقاد وشعراء في كتابتهم عن شعري ووضوح المسرح والسينما فيه فإنني أقول ما كان لتجربتي الشعرية كلها أن تكون في ما هي عليه الآن لولا المسرح والسينما.
الأول بإمكاناته البدائية المتخيلة دائماً بلا بذخ في العرض والثانية بإمكاناتها القطعية "من المونتاج" والتصويرية بعين العدسة الصغيرة لرسم المشهد الداخلي والخارجي -ليلاً أم نهاراً- لمصائرنا.
الأول بالحوار المكثف والمختزلِ زوائدَ كلاميةً لا ضرورة لها في الحكي والثانية بالصمت وتحويل الوصف الممتع أصلاً للطبيعة والأشخاص في أية رواية إلى واقع شاخص وحقيقي في فعل يشبه السحر القديم.
الأول بالمحاكاة الأرسطوطاليسية لكي نتطهر جميعاً والثانية في شدك للمصير التراجيدي المصور بحياة تنسيك إنما هي تشبه الحياة لا الحياة نفسها.
الأول والثانية بشرف امتلاك بوح التراجيديا لجمهور غير مصادق على براءته الفعلية وبالغور الفعلي عميقاً في تقديم الأبعاد النفسية والاجتماعية والطبيعية للشخصيات..إلخ
وهذا كله وغيره من التفاصيل التقنية مهما كان صغرها يفيد الشاعر في بحثه الشعري الدائم.
قد لا أتمتع "ببراءة المشاهد العادي" للمسرح والسينما. فأنا إن ذهبت إلى مسرح فلن أكفَّ عن التدقيق في تفاصيل تخص الديكور والإنارة والأزياء وحركة الممثل وصوته وإن شاهدت فيلماً فالتوازن في تكوين الصورة، وصرامة ضرورته في تكوين الصورة لا يفارقانني البتة..إضافة إلى تفاصيل تخص العمل السينمائي كله إخراجاً وتمثيلاً وتصويراً..إلخ
لكن هذا الفعل..عدم استمتاعي في مشاهدة مسرحية أو فيلم هو بحثي في الجمال من خلال المسرح والسينما وسينعكس حتماً على بحثي الشعري في الكتابة الشعرية وهو ما أسعى إليه وأتمناه محقَّقاً.
في الكاميرا القديمة 16 ميلم التي كانت ترافقنا في الدروس الأولى تعلمت المزج بين مشهدين.كان أمراً بدائياً في التقنية أن يدخل مشهد قادم جديد على نهاية مشهد سابق في الكاميرا ذاتها.لكنني كنت أفكر فيه مثلما كنت أفكر في التداعي عند جويس وعند المتأثر به، في ما بعد، الخلاّقِ فوكنر.إنها إمكانات تقنية سأستفيد منها لاحقاً في عملي الشعري. وهذا مثل واحد.
في شعري كله "وتتضح أكثر" في قصائدي الطويلة غير الموزونة، شخوص ومشاهد مصوَّرة.شيء خافت من الدراما الأولى في المسرح وشيء خافت من السيناريو ومن التصوير السينمائي ومن المونتاج.والأخير..يا للأخير في الشغل الفني والأدبي كله.
في شعري ملوك قدماء وقادة جيوش وطباخون ومؤرخون وسعاة بريد وعلماء كيمياء وأئمة وخلفاء وأنبياء وفقهاء وعبدة أديان وسحرة ومستكشفون وحكماء وقضاة وشرطة ومحققون وسجناء وجنود وشعراء جوالون ومهرجون وحُدْب وسكارى وأصحاب حانات وملكات وزوجات قادة وراقصات وممرضات وعاشقات شعراء وأمهات وعجائز وعاهرات وساحرات وقبائل وفرسان وجيوش وقراصنة وعرب وأكراد وأتراك وفرس وشعوب أخرى ومسلمون ومسيحيون ويهود ووثنيون وفراعنة ومجوس وآلهة..إلخ
وهذا كله يتطلب إدارة مّا في الشعر. وأظن أنّ المسرح والسينما يعينانني فعلياً في تلك الإدارة حتى في إخفاء ظهورهما أو استفادتي الفعلية منهما داخل القصيدة.
***
 الموسيقى: بكل أنواعها وخاصة موس.قى الشعبية للشعوب والموسيقى الكلاسيكية الغربية. أنني مستمع جيد وقارئ جيد أيضا عن الموسيقى. وكثيرا ما اكتب وأنا استمع إلى الموسيقى. وكم يحزنني أنني لا أستطيع قراءة النوتة الموسيقية رغم محاولاتي المتكررة للقيام بذلك.
الموسيقى: بكل أنواعها وخاصة موس.قى الشعبية للشعوب والموسيقى الكلاسيكية الغربية. أنني مستمع جيد وقارئ جيد أيضا عن الموسيقى. وكثيرا ما اكتب وأنا استمع إلى الموسيقى. وكم يحزنني أنني لا أستطيع قراءة النوتة الموسيقية رغم محاولاتي المتكررة للقيام بذلك.
الرسم: كذلك يستهويني لأنه يتعامل بلغة بصرية لها جماليات فائقة، كما أنها لها إمكانية الكتابة الذي يتعامل معها كل الناس والتي حدودها لا تنتهي.
الآثار: فهي أيضا لها كتابتها الخاصة و مليئة بالمعرفة فلاشيء معلق في الهواء وهي تعطينا معرف الماضي.
الحكاية الشعبية: هذا التراث العظيم الذي أنتجته العقلية الجماعية للشعوب.
***
 لن أتثاقف وأتفلسف وأظهر انني تأثرت بموسيقى باخ وبيتهوفن وتشايكوفسكي وموزارت، أو أدعي أن الفن التشكيلي هو الذي لعب أكثر من غيره في تكويني الثقافي كما يقول السؤال؛ فلا أعرف بالتحديد، صحيح أنني أحب اللون وتأثرت جدا بلوحة التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور الشهيرة (جمل المحامل)، وكنت أتلهف كثيرا وأنا أشاهد والدتي وشقيقاتي يطرزن التطريز الفلسطيني أو حينما كانت الوالدة رحمها الله تقوم بعملية صباغة خيوط الغزل ونسيج النول والبساط وبقيت حتى اليوم وحينما أزور مدينة جديدة أذهب لمتاحف الفن والرسم فيها، فقد زرت اللوفر وشاهدت لوحة الموناليزا مطوقة بالشرطة، ورسوم رامبرانت، وذهبت لمتحف الفن الحديث هناك، وأدهشني عمل جبار لفنان فرنسي صنع رجالا ونساء من الخيش لكنه صنع الجزء الأمامي منهم وترك ظهورهم فارغة، وظل ذلك العمل عالقا في ذهني حتى اليوم، ورأيت أعمالا ولوحات جنسية رائعة، وأحببت ولليوم أعمال ماتيس جدا وتسحرني أعمال بيكاسو وكاندنيسكي ودالي وسيزان وكثيرين جدا غيرهم، وقد ذهبت لهولندا وأقمت عند صديقي الفنان التشكيلي الفلسطيني جمال اخميس والذي اصطحبني لعدة غاليريهات هولندية ولمتحف فان كوخ في أمستردام، ووجدت نفسي اكتب مرة مقطعا شعريا يشير لقيامه بقطع أذنه (إلى فان كوخ: أذني من خطيئة وأذناك من طين) وأحب أعمال العديد من الفنانين العرب مثل فيصل اللعيبي وستار كاووش وعصام طنطاوي وضياء العزاوي وغيرهم.
لن أتثاقف وأتفلسف وأظهر انني تأثرت بموسيقى باخ وبيتهوفن وتشايكوفسكي وموزارت، أو أدعي أن الفن التشكيلي هو الذي لعب أكثر من غيره في تكويني الثقافي كما يقول السؤال؛ فلا أعرف بالتحديد، صحيح أنني أحب اللون وتأثرت جدا بلوحة التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور الشهيرة (جمل المحامل)، وكنت أتلهف كثيرا وأنا أشاهد والدتي وشقيقاتي يطرزن التطريز الفلسطيني أو حينما كانت الوالدة رحمها الله تقوم بعملية صباغة خيوط الغزل ونسيج النول والبساط وبقيت حتى اليوم وحينما أزور مدينة جديدة أذهب لمتاحف الفن والرسم فيها، فقد زرت اللوفر وشاهدت لوحة الموناليزا مطوقة بالشرطة، ورسوم رامبرانت، وذهبت لمتحف الفن الحديث هناك، وأدهشني عمل جبار لفنان فرنسي صنع رجالا ونساء من الخيش لكنه صنع الجزء الأمامي منهم وترك ظهورهم فارغة، وظل ذلك العمل عالقا في ذهني حتى اليوم، ورأيت أعمالا ولوحات جنسية رائعة، وأحببت ولليوم أعمال ماتيس جدا وتسحرني أعمال بيكاسو وكاندنيسكي ودالي وسيزان وكثيرين جدا غيرهم، وقد ذهبت لهولندا وأقمت عند صديقي الفنان التشكيلي الفلسطيني جمال اخميس والذي اصطحبني لعدة غاليريهات هولندية ولمتحف فان كوخ في أمستردام، ووجدت نفسي اكتب مرة مقطعا شعريا يشير لقيامه بقطع أذنه (إلى فان كوخ: أذني من خطيئة وأذناك من طين) وأحب أعمال العديد من الفنانين العرب مثل فيصل اللعيبي وستار كاووش وعصام طنطاوي وضياء العزاوي وغيرهم.
وأذهب لمشاهدة المعارض التشكيلية وتأسرني اللوحات والنحت وكل أعمال التشكيل، وتمنيت لو كنت رساما لأرسم جسد ووجه المرأة التي أحب لكنني استعضت عن ذلك بالكلمات، ولم أفكر للحظة بتعلم مزج الألوان ومسك الفرشاة، لكنني لا أميز فنا معينا أثر بي تأثيرا مباشرا، دون غيره، هل أنسى السينما أو المسرح؟ لكنني بصراحة كنت اذهب للسينما بحثا عن اللذة أكثر من سعيي للاستمتاع بقصة الفلم او مشاهدة بطلاته وأبطاله من ناحية فنية رغم أنني تعرضت مرة لموقف كاد يقدمني نجما سينمائيا حين قرر المرحوم حسان أبو غنيمة السينمائي الأردني تحويل قصيدة لي إلى فيلم قصير وقد مثلت فيه دور البطل وقمنا بتصوير أكثر من تسعين مشهدا سينمائيا على كاميرات 35ملم.
ومثلت على خشبة المسرح مذ كنت في المدرسة وحتى بعد تخرجي من الجامعة لكني لم أجد فنا معينا استلبني مثل الكتابة، قد أكون ارتكزت عليها كلها لكن ما زلت هشا ضعيفا حينما أسمع عزف الناي والشبابة والغناء الفولكلوري وربما يكون هذا التراث البعيد الجذور والذي تتلاقى فيه المواويل والكلمات والألحان مع ردات الفعل وتهيج النشوة أثر أكثر من غيره علي، فما زال غناء الفلاحين في قريتنا يشدني أكثر من حفلة باليه او عزف بيانو وربما كنت وما زلت صريع الموسيقى حتى اليوم.
وباختصار فقد عصفت بي كل الفنون وأسرتني لكن الشعر كان أكثر ديكتاتورية في السيطرة علي وعلى تكويني بكامله.
***
 السينما قطعا هي الفن الأول الذي أدين له بالشاعرية وقدح شرارة اكتشاف العالم. ربما لأنها ارتبطت بنزوع التمرد الأول الذي يصاحبنا في أولات العمر.
السينما قطعا هي الفن الأول الذي أدين له بالشاعرية وقدح شرارة اكتشاف العالم. ربما لأنها ارتبطت بنزوع التمرد الأول الذي يصاحبنا في أولات العمر.
دور السينما في مجتمع محافظ كان ينظر لها باعتبارها بابا للرذيلة أو أقلها "قلة أدب"، بالنسبة لي كانت تلك الصالة المعتمة المضاءة من نافذة خلفية، بحرا يحملني إلى السماء الأولى. كنت أهرب من المدرسة وقوانين البيت الصارمة لألتقط أفراحي في شاشة فضية على الجدار. الحجومات الكبيرة للممثلين، أصواتهم التي تخترق القلب كانت وعدا آخر للحرية.
في السنوات المبكرة الأولى ستكون الفرجة ومتابعة الحدث هي غاية المتعة. لاحقا حين يرجّني الكلام والشعر والتعبير سألتفت للسينما باعتبارها فنا متكاملا يمكنها أن تعيد ترتيب الذائقة واستقبال العالم على نحو "عياني" مختلف.
السينما بوصفها "نص" هي إبداع متكامل، الصوت والصورة والألوان والقلب والأحلام، المعقول واللامعقول. كل تلك أدوات ستجعلك تنظر إلى العالم بوصفه حركة متداخلة، متنافرة تماما، لكنها متناغمة أيضا.
التحدي الذي فرضته السينما على نصوصي، جعلني مغرما بالمشهدية بوصفها إطارا للتجول في نفسي وفي العالم. الكلام يصبح ناقصا إذا لم تتحرك صور المعاني الشعرية كما تتحرك الصور السينمائية.
الجانب الأهم في تأثير السينما أيضا أنها ذات مبنى تعددي : أصوات وألوان ومستويات عدة للرؤيا. وهو أمر يجعلها "ديمقراطية" من حيث الأساس، لينتقل تأثيرها من نص يكتبه شاعر إلى طريقة تفكير تنير طريق الإنسان.
حين نجلس جميعا أمام الشاشة الطقسية تلك، فأي آلاف من المشاعر والأفكار والانطباعات المختلفة والمتباينة التي سيخرج بها كل واحد منا. تخيلوا!
***
 أستطيع أن أشير يا صديقي، دون تردد، إجابة ًعلى سؤالك الى الهوى "المعرفي، الجمالي" الأول: السينما
أستطيع أن أشير يا صديقي، دون تردد، إجابة ًعلى سؤالك الى الهوى "المعرفي، الجمالي" الأول: السينما
فقبل ان أمسّ الكتاب أو أعرف عالمه عرفتُ السينما. واذا كانت متابعة السينما، في مرحلة الفتوّة، نوعاً من اللهو وتزجية لهواية لم تتبلور ملامحها غير انها في ما بعد أضحت مصدراً حيوياً من مصادر اطلاع وفضول جمالي وثقافة بصرية لا محيد عنها، ففي السينما نجد كل شيء أو بمعنىً أدق يمكن القول انّ لها أنْ تختزل كل شيء من شعر وسرد وصوت ولون.. لم يتبق إذن إلا العطر والرائحة وقد قرأت منذ سنوات عن محاولات لتنفيذ أو استخدام "المؤثرات العطرية" في الفيلم، سعياً الى الإكتمال.. هي حياة، بمعناها الجمالي، بموازاة الحياة الفعلية وتحضرني، هنا، عبارة الكاتب الإيطالي"إيتالو كالفينو"، الجميلة البليغة التي تختصر الكثير: " كان إحساسي ان ما أشاهده على الشاشة فقط, هو الذي يمتلك الميزات المطلوبة من العالم, الامتلاء, الضرورة, الانسجام". "كالفينو"هو صاحب التعريف الذكي للسينما والذي استعرته عنواناً لهذه الإجابة: السينما كـ "مراوغة".
ان "سينماي" التي أعنيها هي التي تستعين بـ "الحلول الشعرية" في مواجهة الواقع فـ"هناك بعض المظاهر من الحياة الإنسانية لا يمكن تمثلها بأمانة إلاّ من خلال الشعر" حسب "تاركوفسكي".
والشغف بالسينما يعني لي أيضاً نوعاً من التمرد على منطق الكتابة الصارم فثمة دائماً رغبة لدي في صناعة صور حرة تكتفي بجماليتها وسحريتها ولا تخضع لأنساق متعسفة وهذا ما لا تتيحه الكتابة بطبيعتها.
أتحدث عن السينما كنص بصري خالص دون الحاجة الى لغة تذكر، معتمدة ً عبقرية َ الإيماء والإيحاء والأداء. هو شغفي ذاته بما يُعرف بمسرح الصورة، الذي أحببته لدى مجنون المسرح والشعر، المسرحي العراقي "صلاح القصب" فقد كان الشعر دافعاً وملهماً له في أعماله دون أن يكتم ذلك.
بهذا المعنى لا منجاة من أن تكون السينما أحد مصادري الكتابية بالمعنى الظِلالي، الإيحائي، طبعاً لا المباشر.
***
 أكثر الفنون التي أميل إليها هو الرقص. ولو أن الصدفة كانت أكثر وفاء لي، لصرت راقصة باليه، أو أسست فرقة للرقص التعبيري، أجول معها العالم بأجساد مجنونة، لأجعل من الرقص الجهة الخامسة. وبيقين مطلق أعود بالفضل إليه لفكرة الحرية التي جعلتني أقف مع نصي ببياض خالص من تراكم طبقات الزيف فوق الحقيقة، التي كان علي أن أدركها منذ وجودي فوق هذا العالم المغبون والممسوس بفكرة القتل والموت والخطيئة. جعلني انتمائي لرقص الجسد وعلاقته بالموسيقا أكثر إخلاصا لمتعة الكتابة عندما اكتشفت اللحظة التي توحد هذين الفعلين، لحظة رقص الجسد البدائي المنعتق من فكرة البذاءة والخطيئة التي أتت بها الديانات التوحيدية، تشبه لحظة تربع خالق مخلوق من نفسه حي، ميت، مقتول، قاتل في تشكيلاته على عرش السماء، وهي نفس اللحظة التي أعيشها ككاتبة مع نصي وأستمد منها قوتي. الجسد الذي يتمدد إلى ما لانهائية ليثبت أنه الحقيقة المطلقة الوفية لتحولاتها. تماماً كما تفعل أصابعي، وهي ترقص بطريقتها لتروي نهمي من فكرة اللانهائية نفسها.
أكثر الفنون التي أميل إليها هو الرقص. ولو أن الصدفة كانت أكثر وفاء لي، لصرت راقصة باليه، أو أسست فرقة للرقص التعبيري، أجول معها العالم بأجساد مجنونة، لأجعل من الرقص الجهة الخامسة. وبيقين مطلق أعود بالفضل إليه لفكرة الحرية التي جعلتني أقف مع نصي ببياض خالص من تراكم طبقات الزيف فوق الحقيقة، التي كان علي أن أدركها منذ وجودي فوق هذا العالم المغبون والممسوس بفكرة القتل والموت والخطيئة. جعلني انتمائي لرقص الجسد وعلاقته بالموسيقا أكثر إخلاصا لمتعة الكتابة عندما اكتشفت اللحظة التي توحد هذين الفعلين، لحظة رقص الجسد البدائي المنعتق من فكرة البذاءة والخطيئة التي أتت بها الديانات التوحيدية، تشبه لحظة تربع خالق مخلوق من نفسه حي، ميت، مقتول، قاتل في تشكيلاته على عرش السماء، وهي نفس اللحظة التي أعيشها ككاتبة مع نصي وأستمد منها قوتي. الجسد الذي يتمدد إلى ما لانهائية ليثبت أنه الحقيقة المطلقة الوفية لتحولاتها. تماماً كما تفعل أصابعي، وهي ترقص بطريقتها لتروي نهمي من فكرة اللانهائية نفسها.
إنها ترقص أيضاً في أحشائي تلك الأفكار، دغدغة المجاز في اللغة وحيوات الشخصيات، تتمدد ولا تنتهي، إلا على الورق الأبيض، لتمارس رقصاً أخر في أحشاء قارئي...
***
 كنت ذاهبا إلى الرسم وكان الطريق طويلا كنت احمل بيدي المشعثتين المشتعلتين علب ألوان وفرشاة وألواح خشبية عريضة، فجأة شعرت بتعب، فقعدت تحت شجرة كثيفة الظلال بحثا عن راحة جسد وهدوء روح، فوجدت نفسي بعدها انهض واذهب باتجاه طريق آخر هو الكتابة، في لحظة ما انتبهت اني تركت الألوان والفرشاة والألواح تحت الشجرة، ولا ادري كيف ارتدت أصابعي أوراق بيضاء وقلم سائل، واصلت الطريق الجديد معتقدا انها نفس الطريق الأولى ومتوهما أنها نفس الأحاسيس ونفس الرؤية، لكني عرفت لاحقا انه لم يكن مجرد وهم، كان حقيقة طويلة القامة ومشعة العينين، ووقحة أحيانا، أنا رسام كاتب او كاتب رسام، لم يعد هناك تخوم تفصل بين طريق الكتابة وطريق الرسم هل هذا يكفي لأبرر خيانتي للون والظلال، كان الرسم كان البرق الأول او الطريق الأولى التي أبحرت في سفينتها المتشردة المجنونة باتجاه الاقويانوس البعيد بحثا عن سمك الروح الذهبي، ألاحظ ان قلمي يتخذ غالبا شكل فرشاة فأصف تفاصيل الكائنات والأمكنة والأشياء وكأني ارسمها، اللون في قصصي دائما حاضر بشكل يوحي باني احن بحزن ووفاء إلى جذوري وسلالتي التي خنتها وهربت الى القلم، الأزرق الداكن يحتل وجوه شخوصي وأرواحهم بل ويشرق منها، أهيم برقصاته وأمواجه المتقلبة ويهيم هو بلغتي، اسكر بفضائه ويذوب بشهقات نسائي العنيدات المطلات من سطوح البيوت على قوافل الحواس المارة يغزارة، من طريق تكره المطر وتمتهن طرد الريح.
كنت ذاهبا إلى الرسم وكان الطريق طويلا كنت احمل بيدي المشعثتين المشتعلتين علب ألوان وفرشاة وألواح خشبية عريضة، فجأة شعرت بتعب، فقعدت تحت شجرة كثيفة الظلال بحثا عن راحة جسد وهدوء روح، فوجدت نفسي بعدها انهض واذهب باتجاه طريق آخر هو الكتابة، في لحظة ما انتبهت اني تركت الألوان والفرشاة والألواح تحت الشجرة، ولا ادري كيف ارتدت أصابعي أوراق بيضاء وقلم سائل، واصلت الطريق الجديد معتقدا انها نفس الطريق الأولى ومتوهما أنها نفس الأحاسيس ونفس الرؤية، لكني عرفت لاحقا انه لم يكن مجرد وهم، كان حقيقة طويلة القامة ومشعة العينين، ووقحة أحيانا، أنا رسام كاتب او كاتب رسام، لم يعد هناك تخوم تفصل بين طريق الكتابة وطريق الرسم هل هذا يكفي لأبرر خيانتي للون والظلال، كان الرسم كان البرق الأول او الطريق الأولى التي أبحرت في سفينتها المتشردة المجنونة باتجاه الاقويانوس البعيد بحثا عن سمك الروح الذهبي، ألاحظ ان قلمي يتخذ غالبا شكل فرشاة فأصف تفاصيل الكائنات والأمكنة والأشياء وكأني ارسمها، اللون في قصصي دائما حاضر بشكل يوحي باني احن بحزن ووفاء إلى جذوري وسلالتي التي خنتها وهربت الى القلم، الأزرق الداكن يحتل وجوه شخوصي وأرواحهم بل ويشرق منها، أهيم برقصاته وأمواجه المتقلبة ويهيم هو بلغتي، اسكر بفضائه ويذوب بشهقات نسائي العنيدات المطلات من سطوح البيوت على قوافل الحواس المارة يغزارة، من طريق تكره المطر وتمتهن طرد الريح.
حبيبتي المتزوجة تشبه اللون الأزرق فهي عميقة مثله وهاربة دوما ممن يود أسرها في قصة قصيرة عابرة، لهجتها تميل الى الزرقة المبلولة والمفرطة في طلاتها على حاسة السمع الداكنة، واسمها يحيل الى مغامرة حب قديمة خلدها التاريخ العربي بأحرف سميكة وزرقاء، وسع انتمائي الأصيل الى اللون والظلال من أفق نصي، وأمده بإمكانات تأويلية تسعدني وتفرح قلبي، حين يتقاتل اثنان حول حقيقة إحساس بطلي أو نهاية نص ما، أو مصير امرأة مركبة الأفعال وغامقة التفاصيل، في الصف الثامن اعبر عن وفائي لسلالتي وانحيازي لنوع دمي بان اطلب من طلابي ان يرسموا نصا، يرسموه كما يحسوه هم بعيدا عما أحس به أنا، أقول لهم تكفيرا عن خذلي لطريقي الأول: اللون كان البداية فامتطوه الآن حصانا حرونا رائعا، واجعلوه يمتطي مخيلاتكم، فيشرع طلابي أقلامهم ويرسمون اللغة والكلمات، والأحداث، بينما أتنفس أنا الصعداء وأعود طفلا مرتبكا نقيا إلى الشجرة، إلى الواني الضائعة، وخيانتي الجميلة الأولى.
***
 فن النحت...هو الذي طبع حياتي بأثر حاسم لا يهدأ ولا يزول مطلقا، فقد كان أخي الأكبر نحاتا وعمي كان نحاتا أيضا، ومنذ كنت صغيرا وأنا أنظر إلى بهمة الحجر وهي تتحول إلى نطق.. وهي تتحول إلى كلام، كنت انظر مأخوذا إلى القوة السافرة التي تضرب بعنف على الصلابة التي لا تنضب ومن ثم تشكلها، كنت أنظر إلى الطين عبر دفع جذاب بالأيدي التي تلوكه يتحول إلى لغة تصرخ...والنحات عامل... بأيد ملؤها العضل وبوجه حاد التقاطيع وصامت يجعل من غرابة الحجر الذي لا يقول شيئا البتة، كلاما عميقا، ويجعل من اللامسموع مسموعا، ويصنع من الطين البارد بصورة مذهلة شيئا حميميا وقريبا، يحول الحديد والألمنيوم الذي هو دون سر تقريبا إلى كلام سري وجذاب. وأنا أفكر إلى اليوم كيف يمكنني أن أنحت اللغة الباردة التي نسمعها ليلا ونهارا، وأن صنع منها تمثالا يصرخ. هذه الرتابة الصامتة التي تهشم بقوة وتبدد، الكلام الميت، والمنطوق، كيف يتم عجنه مرة أخرى بشغف، كيف يمكن تشكيله لتخليصه من وحدته الكتومة، ومن نطقه الباطل، هذا التبت الخالي من الأسرار مثل الطين والحجر، كيف يمكن تخليصه من ثخانته الصامتة، ومن إقامته الغنية بالسكوت، وبعمل متصلب، وتحويله إلى لغة حية ثرية بالأسرار.
فن النحت...هو الذي طبع حياتي بأثر حاسم لا يهدأ ولا يزول مطلقا، فقد كان أخي الأكبر نحاتا وعمي كان نحاتا أيضا، ومنذ كنت صغيرا وأنا أنظر إلى بهمة الحجر وهي تتحول إلى نطق.. وهي تتحول إلى كلام، كنت انظر مأخوذا إلى القوة السافرة التي تضرب بعنف على الصلابة التي لا تنضب ومن ثم تشكلها، كنت أنظر إلى الطين عبر دفع جذاب بالأيدي التي تلوكه يتحول إلى لغة تصرخ...والنحات عامل... بأيد ملؤها العضل وبوجه حاد التقاطيع وصامت يجعل من غرابة الحجر الذي لا يقول شيئا البتة، كلاما عميقا، ويجعل من اللامسموع مسموعا، ويصنع من الطين البارد بصورة مذهلة شيئا حميميا وقريبا، يحول الحديد والألمنيوم الذي هو دون سر تقريبا إلى كلام سري وجذاب. وأنا أفكر إلى اليوم كيف يمكنني أن أنحت اللغة الباردة التي نسمعها ليلا ونهارا، وأن صنع منها تمثالا يصرخ. هذه الرتابة الصامتة التي تهشم بقوة وتبدد، الكلام الميت، والمنطوق، كيف يتم عجنه مرة أخرى بشغف، كيف يمكن تشكيله لتخليصه من وحدته الكتومة، ومن نطقه الباطل، هذا التبت الخالي من الأسرار مثل الطين والحجر، كيف يمكن تخليصه من ثخانته الصامتة، ومن إقامته الغنية بالسكوت، وبعمل متصلب، وتحويله إلى لغة حية ثرية بالأسرار.
***
وراء كل قصيدة سينما
محمود عبد الغني
(المغرب)
 قد تصبح السينما ركاما بئيسا من الصور. مثلما قد تصبح الروية ركاما بائسا من التفاصيل، و السيرة الذاتية ركاما بائسا من الأسرار. وقد تكون السينما بلا نظير إذا ماكان وراءها عقلا عظيما، محيرا. هذا هو الضرب من الفن الذي ألهمني كثيرا، وساعدني في العيش و التخيل و العبث وبناء الشخصية. السينما فعلا فن بلا نظير يقودني دائما أثناء كتابة القصائد. وراء كل قصيدة سينما. حتى أنني عندما أتلقى بيتا شعريا من السماء أذهب لمشاهدة السينما كي أكمل القصيدة. والحالة الذهنية التي في الفيلم (وهي أيضا موجودة في الرواية) هي في الحقيقة سلوك هذا الفيلم عندما يشاهده الجمهور. الفيلم يعمل بشكل جيد أثناء المشاهدة فقط. فيمكن أن نقول الفيلم يعمل. مثلما نقول " القصيدة تعمل" عندما تكون تحت عيني القارئ.
قد تصبح السينما ركاما بئيسا من الصور. مثلما قد تصبح الروية ركاما بائسا من التفاصيل، و السيرة الذاتية ركاما بائسا من الأسرار. وقد تكون السينما بلا نظير إذا ماكان وراءها عقلا عظيما، محيرا. هذا هو الضرب من الفن الذي ألهمني كثيرا، وساعدني في العيش و التخيل و العبث وبناء الشخصية. السينما فعلا فن بلا نظير يقودني دائما أثناء كتابة القصائد. وراء كل قصيدة سينما. حتى أنني عندما أتلقى بيتا شعريا من السماء أذهب لمشاهدة السينما كي أكمل القصيدة. والحالة الذهنية التي في الفيلم (وهي أيضا موجودة في الرواية) هي في الحقيقة سلوك هذا الفيلم عندما يشاهده الجمهور. الفيلم يعمل بشكل جيد أثناء المشاهدة فقط. فيمكن أن نقول الفيلم يعمل. مثلما نقول " القصيدة تعمل" عندما تكون تحت عيني القارئ.
عندما نريد أن نقارن الحالة الذهنية للفيلم علينا أن نقارنه بباقي الفنون و الآداب. إذاك نجد ان مايقوم به الفيلم يعجز عنه غيره. هذا أمر يدخل في إطار الملاحظات الميدانية. لذلك فالسينما تؤثر كثير في سلوك الإنسان. أقول بكل صراحة: عندما أكتب قصيدة لا أطلقها في فضاء القراء فقط بل أضعها إلى جانب الأفلام. وأرى كيف تعمل، كيف تعيش، وكيف تحدد مظاهر سلوكها.
***
 يبدو لي أن الموسيقى أخذت حيزا مهما في حياتي إذْ لم تكن هي التي أخذتني للشعر.
يبدو لي أن الموسيقى أخذت حيزا مهما في حياتي إذْ لم تكن هي التي أخذتني للشعر.
يعتقد البعض أن نصوصي خالية من الموسيقى، فيما أعتقد أنا أنني أقوم عبر الكلمات بالتأليف الموسيقي. وبشكل أوضح أعتبر نفسي مؤلفاً موسيقيا بالسرد. يبدو لي بأنني لا أكتب الشعر حسب التوصيف المتعارف عليه، بل أكتب الموسيقى بالسرد. فالأنا الشعرية هي بالنسبة إلي أنا سردية. وضمير المتكلم في النص لست أنا هو بل شخصية روائية. والموسيقى عندي ليست هي الموسيقى الخليلية العربية المتعارف عليها. إنها موسيقى مبتكرة ترجع إلى ينابيع موسيقية شتى شرقية وغربية. فكما أن مصدر الحداثة الشعرية ليس واحدا، كذلك فإن الموسيقى لها آثار أوردية وصينية ويابانية وإفريقية وغربية. لا أدري كيف يمكنني رصد هذا الأثر، مع هذا أعتقد بوجوده. وهو حال الكتابات السردية التي هي ليست بالضرورة روائية، بل يمكن أن تكون كتابات تاريخية كتبت بطريقة سردية فنية.
***
 تلقفت السؤال وأنا أردد لن أكتب عن الرسم... لن أكتب عن الرسم... ونظرت إلى المرأة المائلة في آخر جريمة لونية ارتكبتها ورددت... لن أكتب عن الرسم. وتذكرت قطتي السوداء التي كانت تتقمصها روح رامبرنت حين كانت تبدي رأيها بآخر خط أفق رسمته بل وتحاول تصحيحه بقوائمها الأربع إذا اقتضى الأمر .. ورددتُ لن أكتب عن الرسم ... ولكن ...
تلقفت السؤال وأنا أردد لن أكتب عن الرسم... لن أكتب عن الرسم... ونظرت إلى المرأة المائلة في آخر جريمة لونية ارتكبتها ورددت... لن أكتب عن الرسم. وتذكرت قطتي السوداء التي كانت تتقمصها روح رامبرنت حين كانت تبدي رأيها بآخر خط أفق رسمته بل وتحاول تصحيحه بقوائمها الأربع إذا اقتضى الأمر .. ورددتُ لن أكتب عن الرسم ... ولكن ...
تلك الخزامى التي تستعر في أنابيب اللون توحي بأحقية الحياة لكائن يتجسد أمامك زبدا أو كاحلا أو وردة أو زجاج نافذة مكسور على حساب ثلاث نقط في أول السطر أو آخر الفردوس ..
لطالما أرقني أني لا أعيش في لوحة ..
ما بين الشعر و الرسم ثأر وليس ألفة حسبما يُشاع.. الشعر سلطان.. الرسم صعلوك ..
أشبه بتلك العشيقة السرية التي تطأ جنونها بحذائك البالي و غبار رأسك وصقيع شمعة ذابت على معصم الآلهة بانتظار أن تغفو ربة الشعر..فجأة الكائن الوديع الحالم الذي يؤمن بالعذاب كفلسفة للتقية والنقاء.. يستحيل مجنونا.. وينكأ خاصرة الريشة حتى تهوي توتة بشممها إلى مداركه.. فيباشر الرؤيا..
فن الرسم فن متوحش الالتفات.. يسود اللون و الظل و نتف الأرواح التي تتنامى كنخلة تلهب معادلة رصف الوجود بالحجارة التي يرجمون بها بعد إخضاعها لمبدأ الحنين و اللين .. والفنان في محاولة الرسم هش كالطبشور يحاول أن لا يغفر لنفسه أنه ليس حافيا كالذي يرسمه و ليس أزرقا ككوّة ابتسامة بحرية ..
نداء زيت الكتان يُنذر بطواغيت شبق مترامي الأطراف حتى نهاية الغواية ..
كي أكتب قصيدة عليّ أن أموت..
كي أرسم لوحة عليّ أن أحيا و أحيا وأحيا ..
هناك تضيئ اللغة صخب الوريد الأكبر و الأصغر و المسام الصغيرة لغيمة عبرت فلم تمطر.. و هنا انفجاري الكبير وحده يفسر نشأة الكون الأولى ويغريني بالتصوف و التوحد بضربة ريح متنكرة بالفرشاة لتضيف بريقا على بؤبؤ يفيض بالموج ..
تجربة الرسم معصية اختمرت لترضى عني ملائكة الكتفين و الأصابع العشر..
أدينُ حتى بجلبة القصيدة لها .. قد يغفر لي الشعر هذا النزق حين أرشو مفاتيحه بإحدى تدرجات الأزرق و هي تتلمس الطريق اليه ..
تلك الراء التي ينتهي بها الشعر و يبدأ بها الرسم ليست حرفا غير منقط اعتباطيا.. هناك تفاصيل مؤجلة تشفع دائما لبقعة ضوء مشاغبة تضمر للحرف مايشتهيه ليتكئ عليه ..
هو الفن الذي يغامر برصيد الفراشة من الاحتراق غير آبه أو نادم ..همّه أن تضيئ للحظة حين تغرب الشمس.. وكفى ..
كم يتقن ذاك الكائن الغير منقط كاسمي.. لعبة الخلود..
***
 هما فنّان لا واحد؛ الموسيقى والفن التشكيلي معاً.. كلاهما شدّا حواسي قبل السباحة في دواة الحبر، كأن شيئاً غريزياً كان يؤسس لاستنهاض الموهبة الشعرية تزهيراً من بين الركامات في حديقة الحطب بعد صيفٍ جافٍّ ابتلع كل النداوة بجرعة واحدة..
هما فنّان لا واحد؛ الموسيقى والفن التشكيلي معاً.. كلاهما شدّا حواسي قبل السباحة في دواة الحبر، كأن شيئاً غريزياً كان يؤسس لاستنهاض الموهبة الشعرية تزهيراً من بين الركامات في حديقة الحطب بعد صيفٍ جافٍّ ابتلع كل النداوة بجرعة واحدة..
لذا كنتني لا أمرُّ (ببراءة ما قبل الشعر) عابراً دون قراءة اللحن والكلمة وعلاقتهما معاً، بحثاً عن تماهٍ تتداخل فيه الكلمات والألحان الموسيقية المنبعثة من آلات مصاغة من موادّ قد لا تعني شيئاً وحدها دون العدوان الإيجابيّ عليها.. مثل هذا المقطع الفيروزي: "وتكيت غصون الورد عا كتف السياج".. ما زلت أذكرني كيف رقصت صرختي، في داخلي وخارجي، صرخة عارمةً حدّ أن الآخرين استهجنوا حركتي المسرحية.. ولم لا؟! غصون ورد (بنعومتها الأنثوية) تتكئ على كتف (لم يكن بشرياً) بل على (إبرية) سياج.. ولم أزل أمارس هذه (العادة) اللذيذة في قراءة الموسيقى الغناء وحتى اليوم، وما لم يكن يحمل هذا المعنى التصويري، المليء بشاعرية الحواس، ليس، باعتقادي قابلاً لقابلتي/ ذائقتي الخاصة..
أما بخصوص الفن التشكيلي، فقد ساقني إلى هذا إنسان الكهف؛ ذلك أنني أعتقد أن إنسان الكهف هو أول من كتب الشعر بلغة الفن التشكيلي على جدران كهفه، فقد كان ينتصر لفشله في الصيد برسم ما لم يستطع صيده على جدار الكهف، ثم يبدأ برمي السهام والرماح عليه، تعبيراً عفوياً (ويحمل قصدية غير مكتشفة بعد) عن قدرته الأخرى في امتلاك الآخر نصاً لا جسداً (كما العشاق مثلاً).. ولم يكن يدري هذا الإنسان أنه يطور موهبةً فنية ويزداد تدريباً لجولة أخرى من الصيد والفن..
وبما أن الشعر، في النفس الشاعرة، يتحول إلى كلمات مرسومة بخلاصٍ كيميائي، وبإيقاعات الكلمات نفسها، أي رسم بالكلمات، فقد تفحّصت منذ بدايات حبوي الشعري هذه المعادلات اللغوية اتحاداً وافتراقاً في آن، وكيف أنها ساهمت في صياغة نصي الشعري بفطرة أدركتني وأخذتني إلى فضاءاتها، لذا لم أهتف ذات يوم بلغة مباشرة (تشتعل مثل عود كبريت لمرة واحدة)، ولم أكن بيانياً/ خطابياً (حسب مفهوم لغة القصيدة المقاومة)، بل كلما بدأ رنين مطلع القصيدة، انفتحت ذاكرتي نافذةً على (حديقة فيروز: غصون تتكئ على سياج) وتبدأ المخيلة باجتياحي ومحاصرتي وإثارتي حتى الانتهاء منها..
***
 لا اعرف فنا نازع حبى للشعر مثل حبي لفن السينما.وربما سبق وعي لحبى لفن الكتابة فسه. ربما جرني لهذا الحب حينما كنت طفلة جيراننا الأقباط الذين كانوا يسكنون معنا في حي شبرا وكانوا يطلبون من أبي أن يأخذوني معهم إلى السينما.
لا اعرف فنا نازع حبى للشعر مثل حبي لفن السينما.وربما سبق وعي لحبى لفن الكتابة فسه. ربما جرني لهذا الحب حينما كنت طفلة جيراننا الأقباط الذين كانوا يسكنون معنا في حي شبرا وكانوا يطلبون من أبي أن يأخذوني معهم إلى السينما.
وأظن ان الفنان الجميل احمد زكي أيضا كان مسؤولا بأدائه العبقري الصادق عن فتنتى بحال السينما حتى أنني اذكر المرة الوحيدة التي خرجت فيها على طاعة أبي وأنا طفلة حين حرضت أخي الذي يكبرني بأعوام وبعض الأطفال الذين يسكنون معي في نفس الحي على الهروب من المدرسة لمشاهدة احد أفلام احمد زكي الجديدة.
أذكر أيضا أنهم عوقبوا جميعا فيما عداي. ربما لأنني كنت البنت الوحيدة لأبي وكنت أصغرهم جميعا...
ربما تعلمت من فن السينما أشياء كثيرة ساهمت في تكويني ووعي بالحياة والفن. وتكوين الحس الجمالي بالأشياء وربما كانت سببا فيما أظن في اختياري لقصيدة النثر فيما بعد.تعلمت منها أيضا كيف تكتشف شعرية الأشياء, إذا اعتبرنا الشعر في احد تجليات هو كل ما يثير الحاسة الجمالية.
ولا أبالغ إذا قلت إنني تعلمت من أداء احمد زكي وأفلام العبقري صلاح أبو سيف القادر على ان يجعل اللقطة السينمائية سحرا خاصا. والتي اعتقد أنني استفدت منها في كتابة قصيدة النثر التي تتكئ فيما أظن على اللقطة السينمائية التي حلت فيما اعتقد مكان المجاز اللغوي في القصيدة القديمة. فعن طريقها يعاد تركيب العلاقات بين الدال والمدلول داخل النص. تعلمت أيضا تقنية المونتاج من السينما الذي يجعلك قادرا على إعادة إنتاج العالم من حولك من جديد وإعطائه أكثر من قراءة.
***
 لعلي تأثرت - وما زلت أتأثر- بجميع الفنون التي تُشَغلُ الحواس جميعا، إلا أني حين أتفكر في سؤالك وأحاول أن أكتشف الفن الأكثر تأثيرا فيَ، والذي كان له الدور الأبرز والأهم في تدريب حواسي على الالتقاط والانتباه إلى الأشياء وتفاصيلها ومَصَائرهَا ، وَخلَقَ وشَكَلَ مخيالي الشعري، أجد فنين اثنين: الرسوم المتحركة في مرحلة الطفولة الأولى، والسينما في مرحلة لاحقة.
لعلي تأثرت - وما زلت أتأثر- بجميع الفنون التي تُشَغلُ الحواس جميعا، إلا أني حين أتفكر في سؤالك وأحاول أن أكتشف الفن الأكثر تأثيرا فيَ، والذي كان له الدور الأبرز والأهم في تدريب حواسي على الالتقاط والانتباه إلى الأشياء وتفاصيلها ومَصَائرهَا ، وَخلَقَ وشَكَلَ مخيالي الشعري، أجد فنين اثنين: الرسوم المتحركة في مرحلة الطفولة الأولى، والسينما في مرحلة لاحقة.
***
 تأمل الحياة ذاتها فن يساهم في صياغة التكوين الثقافي للكاتب
تأمل الحياة ذاتها فن يساهم في صياغة التكوين الثقافي للكاتب
مازلت أتأمل خيباتي المريرة وخياناتي اللانهائية لأحلامي السرية
هنا في اليمن.. ثمة سيناريوهات سرية للحلم في رأس كل كاتب لا يجرؤ على البوح بها بفعل كوابح اجتماعية متأصلة.. يظل تأمل الفشل الشخصي على أكثر من صعيد محفزا للكتابة.
سأذكر حلما سريا واحدا من أحلامي وهو أن أمتلك آلة العود وان أتعلم العزف لأغني لنفسي.. هذا يعني أن فن الغناء والعزف على العود ظل هاجسا شخصيا.
لا أستطيع أن أقول لك بأن سيمفونيات بيتهوفن أو الفن التشكيلي العالمي ساهما في تكويني الثقافي.. سأكون كاذبا لو ادعيت ذلك.
أنا من بيئة فلاحية تضج بأغاني الفلاحين المتعلقة بالمواسم الزراعية ولطالما حلمت بتحويل تلك الأصوات إلى موسيقى وأغان عصرية.
أحببت كل ألوان الغناء الشعبي في اليمن، وحفظت الكثير منها. أستغرب حينما اسمع أي مثقف يمني نشأ في الريف الفلاحي وهو يدعي انه يفضل أغاني محمد عبد الوهاب على (المهاجل الزراعية) وانه لا يتفهم روح الأغنية الشعبية التي انطلقت بأصوات الفنانين في السبعينات.. رغم أنها بقيت مقتصرة على آلة العود فقط..
من الأغاني الشعبية في الأعراس والمواسم الزراعية أحببت موسيقى الشعر واستوعبتها، وبدأت بكتابة قصيدة التفعيلة قبل أن اكتب النثر.
هنا في اليمن تجد في أغاني المرأة الريفية شجنا بكائيا وهي ترثي لحالها ومعاناتها المستمرة إلى اليوم.
كانت أغاني الجدة والأم ونساء الدار هي سيمفونياتي الأليفة إلى النفس.. وهن يجلبن الماء من العيون البعيدة عن القرية.. وهن يطحن الحبوب في المطاحن الحجرية أسفل الدار، وهن يجلبن الحطب أو العلف من رؤوس الجبال المحيطة بالقرية.
كل ما له صلة بالأغنية الشعبية اليمنية المعجونة بدم الحياة وتعبها والمختلطة بعرق الفلاحين في الأراضي الزراعية التي خلقها الإنسان اليمني بنفسه وهو يغني ويبني المدرجات ويحافظ عليها بعناء وغناء إلى اليوم.
***
 أميل أكثر إلى المسرح. درست التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي بالرباط، لكنني اكتشفت بسرعة أنّني ممثل فاشل. بعد التخرّج، جرّبت الإخراج ضمن فرقة محترفة، ولم أتجرّأ على التأليف أبدا. مازلت أشتغل في مجال المسرح. لكنني كلما انغمست فيه، أجدني في الشعر. وكلما غرقت في الشعر، يعيدني إلى لمسرح. يخيل إليّ، أحيانا، أنني أضيّع طاقة هائلة بين الاثنين. لست في القصيدة ولست على الخشبة: بينهما.
أميل أكثر إلى المسرح. درست التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي بالرباط، لكنني اكتشفت بسرعة أنّني ممثل فاشل. بعد التخرّج، جرّبت الإخراج ضمن فرقة محترفة، ولم أتجرّأ على التأليف أبدا. مازلت أشتغل في مجال المسرح. لكنني كلما انغمست فيه، أجدني في الشعر. وكلما غرقت في الشعر، يعيدني إلى لمسرح. يخيل إليّ، أحيانا، أنني أضيّع طاقة هائلة بين الاثنين. لست في القصيدة ولست على الخشبة: بينهما.
أول وآخر مسرحية أخرجت في العام 1999، تحت عنوان "انبعاث، ذكرى سفر"، كانت عبارة عن عرض مستلهم من قصائد شعراء مغاربة، بينهم أحمد المجاطي ومحمد خير الدين. وخلال دراساتي العليا في شعبة فنون العرض بباريس الثامنة، اشتغلت على الشعر أيضا. أمّا ديواني الذي سيصدر هذا الشهر فيحمل عنوان: "نظّارات بيكيت"!
أعتقد أن المسرح غيّر نظرتي إلى اللغة. بسببه، لم أعد مقتنعا بأن الشعر مجرّد "وظيفة لغوية". بل أكثر. أصبحت أطارد الشعر خارج الكلمات. في الجسد وفي الضوء وفي الصوت وفي الصمت وفي الحركة. أحلم بأن تخرج قصيدتي من الكلمات لتتوسع في الفضاء: أفكّر في قصيدة-بيرفيرمونس. poème-performance) (
من جهة أخرى، اكتشفت أن فشلي في لعب أدوار مقنعة على الخشبة، جعلني أتجه تلقائيا إلى تقمّص شخصيات أثناء الكتابة بضمير المتكلم، على سبيل التعويض. أنا دائما آخر. عندما كتبت، قبل سنة، نصّا بلسان مريض بالسرطان (تحت عنوان "تذكرة ذهاب") نبّهتني ردود فعل الأصدقاء القلقة أنني لم أكتب، بل تقمّصت دورا. تكرّر الأمر ذاته مع كتاب "كيف تصبح فرنسيا، في خمسة أيام ومن دون معلّم"، الذي نشر في الصحافة المغربية على حلقات، كثيرون ممن قرأوه باتوا ينادونني "جيرار لولاش"، على اسم الشخصية التي تقمّصت، تماما كما يحدث مع أصدقائي الممثلين!
***
 العتمة التي ندخلها فرحين كأطفال يتهيؤون لدهشة قادمة، غامضة، تفتح لنا عالماً أوسع من معرفة، وأعمق في التكوين. أنها السينما يا صديقي المختصرة بساعة ونصف عـوالم محتشدة من الألوان والأصوات والحيوات والأحاسيس التي نصدق أنها حقيقية، بعدما تجتاز مخيلتنا الطيبة بياض الشاشة، وتـذهب معها هناك، متواطئة هي والعتمة في إقناعنا على معايشة عالم عمره فيلم. فيلم فقط.
العتمة التي ندخلها فرحين كأطفال يتهيؤون لدهشة قادمة، غامضة، تفتح لنا عالماً أوسع من معرفة، وأعمق في التكوين. أنها السينما يا صديقي المختصرة بساعة ونصف عـوالم محتشدة من الألوان والأصوات والحيوات والأحاسيس التي نصدق أنها حقيقية، بعدما تجتاز مخيلتنا الطيبة بياض الشاشة، وتـذهب معها هناك، متواطئة هي والعتمة في إقناعنا على معايشة عالم عمره فيلم. فيلم فقط.
إذن، بإمكاني أن أقول كعاشق واثق بالحلم السينمائي، أنها السينما، عتمة صالتها غلاف، ودهشتها كتابة، وحدثها قصيدة.
ثـم، ألا ترى معي أن "رقصاً سينمائياً مع الذئاب" يحياه كيفين كوستنر في الخضرة البرية، أو شوكولاتة جولييت بينوشيه التي هذّبت أطباع قريتها الصغيرة تعادل عشرين رفاً من الكتب الأدبية الخامدة في مكتبة "أنطوان" أو أي مكتبة عامة؟!
الأغنية الحلوة التي تستنفر جميع حواسنا، ونذهب معها مأخوذين تترك أثـرها في تكويننا، وقد ترسم ملامحها الملائكية غير الواضحة في ما نكتب، دون أن ننتبه.
فيروز تكتبنا، وشادي الضائع في طفولته والنداءات عليه تكتبنا، والمواويل الشعبية أيضاً.
لا يشترط أن نجد المتعة المخدرة في الأغاني الفخمة فقط، قد نجدها في بحة محمد فؤاد في "الحب الحقيقي"، وفي إضاءات أميمة خليل وهي تخترقنا كأنها قادمة من مجرة بعيدة عامرة بالصوت والموسيقى.
السينما، والأغنية إذن، تشكّل كتاباتنا لكن من يثق ويطمئن لإجابته الناقصة؟!
هناك ما نجهله يشارك بخفاء في تكويننا الكتابي، هناك الكثير الغائب والمنسي والمهمل. من يقول إن اللوحة لا تأخذ نصيبها منا ؟! من يقول إن: المقهى، فوضى الشارع، وقوفنا بطابور مزدحم أمام مخبز شعبي، زيارتنا لمريض يرقد في مستشفى، صالة مطار ما وموسيقاه التي تشكل Backgroundلأفراحنا الصغيرة قبيل الطيران، نشرات الأخبار، مشهد عابر ونحن نطل من نافذة قطار يقطع جنوباً أخضر، انتظاراتنا لموعد حبيبة لا تجيء، بيوت رملية نسيناها في طفولتنا، و... و... كل هذا وأكثر ... ألا يشكّلنا؟!
يا صديقي، وبلا فذلكة، زياراتي لك في الصيف الماضي في مقر عملك، فنجان قهوتك، من يقول إنها لم تترك رائحة ما في جسد الكتابة، أو مادة ما مؤجلة قد تأخذ شكلاً آخراً، أجهله ؟!
***
 أمواج عاتية تقترب... تلمس وجهك الذي أصابه الذعر وربما البلل، وبحركة لا إرادية تنحني للوراء.. ترتجف... تضغط بيدك على يد من يجلس بجانبك... تحبس أنفاسك.. هل نحن على وشك النهاية؟؟!
أمواج عاتية تقترب... تلمس وجهك الذي أصابه الذعر وربما البلل، وبحركة لا إرادية تنحني للوراء.. ترتجف... تضغط بيدك على يد من يجلس بجانبك... تحبس أنفاسك.. هل نحن على وشك النهاية؟؟!
لحظات مرعبة تمر وتنسى أنك أمام مشهد سينمائي رائع.
بعيدا عن التشويق والحركة... ومتعة وشمولية هذا الفن الذي يختزل بداخله كل الفنون الأخرى هناك تفاصيل عميقة أكثر تحقق المعادلة الصعبة والجميلة بين حلمك الفردي الدائم الذي لا يشبه أحدا.. وبين حبك وهوسك المجنون لأن تكون مع المجموعة... تضحك معها... تبكي معها.. ويخفق قلبك وقلبها في آن... جمهور السينما كله في لحظة ما صديق حميم.
السينما فن يخفف قليلا من عنجهية الفنون ونخبويتها، ويقدمها للإنسان العادي لتكون أكثر التصاقا به وأكثر سهولة، أنا أعشق السينما
***
 لن أجد فنا لعب دورا فى مخيلتي أكثر من السينما. تقريبا كنت فى السادسة عندما دخلت السينما لأول مرة مع أخي الكبير، كان يعرض فيلم مليون سنة قبل الميلاد، في دار سينما أمير بالإسكندرية. فوجئت بالشاشة الكبيرة وهذه الحياة التي تتحرك عليها، لم احتاج الى تفسير عن الكيفية ولكنى استسلمت لهذا الدفق من الصور والخيالات. واعتقد ان هذه اللحظة اختزنت داخلي كعقد استسلام لهذا العالم الآخر. هذا العالم الذي تطرحه السينما كعالم متكامل تحاول ان تنوب عن كل أبطاله حتى فى الحزن والموت. لايمكن ان نحب الموت او الحزن او الفشل الا اذا كان هناك خلل ما فينا، نعم في وجود السينما وكثافتها واكتمالها كحكاية داخل زمن، كنا نفرح بهذا الخلل الجمالي.
لن أجد فنا لعب دورا فى مخيلتي أكثر من السينما. تقريبا كنت فى السادسة عندما دخلت السينما لأول مرة مع أخي الكبير، كان يعرض فيلم مليون سنة قبل الميلاد، في دار سينما أمير بالإسكندرية. فوجئت بالشاشة الكبيرة وهذه الحياة التي تتحرك عليها، لم احتاج الى تفسير عن الكيفية ولكنى استسلمت لهذا الدفق من الصور والخيالات. واعتقد ان هذه اللحظة اختزنت داخلي كعقد استسلام لهذا العالم الآخر. هذا العالم الذي تطرحه السينما كعالم متكامل تحاول ان تنوب عن كل أبطاله حتى فى الحزن والموت. لايمكن ان نحب الموت او الحزن او الفشل الا اذا كان هناك خلل ما فينا، نعم في وجود السينما وكثافتها واكتمالها كحكاية داخل زمن، كنا نفرح بهذا الخلل الجمالي.
السينما وما تحمله من حس جماعي لعبت دورا تعويضيا فى حياتنا، الجميع يشاهد ويعيش لحظة واحدة وفى مكان واحد. إذا كانت هناك ثورية يمكن ان تعاين فى موضع آخر غير الثورة فاعتقد ان السينما هي الجديرة بهذا الدور، ولكنها ثورة تخيلية، تعمل على الخيال. وفى نفس الوقت هي ثورية صادمة او محبطة فبمجرد خروجك من السينما مشحونا بما رأيت تعود محبطا لحياتك العادية والمملة والتي لا تنتظم فى نسق جمالي. ولكن رغم هذا فلم تولد طاقة حوارية وحنونة بيني وبين أصدقائي الا وكان فيلم ما هو القاسم المشترك. الأفلام كانت تسمح بحوار جماعي وليس فرديا فلا مكان للمنافسة بيننا فى الفهم فما نتشارك فيه هو بناء ذاكرة جماعية. وأتذكر انه لم تلمع عيوننا وحماسنا الا ونحن نتمثل الأبطال والأفكار المتوارية وراءهم او نتمثل شعرية اللقطة. وهنا أتوقف أمام الشعرية فربما هذه الكثافة الشعرية هي التي قاربت بين السينما وبدائية تكويننا فاستسلمنا لها.
وأحيانا كنت اخرج محبطا من السينما لان الواقع لايتغير سواء فى حزنه او فرحه، ولكن هذا الإحباط ايضا كان له وجه ايجابي فلن نبنى عالمنا الخاص من الأمل فقط. ومن يصنع هذا الفيلم له ايضا حلم قوى وابهاري وحلم تجارى، ولا يمكن ان أرى ان أي نوع من الفن تربوي أو يدفع فقط للأمام اوليست به عيوب: انه مثل أي علم مر بكثير من الأخطاء ولازال. المهم اننا نختار لنا موقعا داخله ونعيشه كتجربة متكاملة كتجربة الحياة. كتجربة ناقصة وبدون تصديق كامل لها / انها لعبة مثل كل الألعاب .
***
السينما بالطبع
إيمان حميدان يونس
(لبنان)
 السينما بالطبع. اكتشافي الخاص والمستقل وأنا ما زلت طالبة في صفي التكميلي الأول عندما كنت تلميذة في الجامعة الوطنية في عاليه. ساعات الهرب من صفوف بعد الظهر بحجة "مرض نسائي" يصيبنا كل شهر، أو في سنوات لاحقة خلال أوقات التدريب العسكري للشباب. نأخذ الطريق نحو سوق عاليه حيث صالات السينما الصغيرة والضيقة. أذواقنا نحن فتيات الصف كانت تختلف وكنا نرضي بعضنا بأن نختار الفيلم بالقرعة. سينما صبح أكثر الصالات حداثة تعرض أفلاما جديدة. صالة طانيوس متخصصة بأفلام جريئة حينها وميامي، ونصر التي تحب عرض الأفلام الهندية، وايدن التي لم يطل عمرها كثيرا فأقفلت قبل أن نعتاد عليها. ندخل ونترك العالم خلفنا. هناك نتفرج على حيوات أخرى لم نكن قد ذقناها بعد وان كنا بدأنا نحلم بها. صالات وأفلام، مساحات حلم ورغبة، جزء من تاريخي الشخصي، امتزجت تفاصيلها مع أول مظاهرة شاركت بها وأول حب وأول كتابة.
السينما بالطبع. اكتشافي الخاص والمستقل وأنا ما زلت طالبة في صفي التكميلي الأول عندما كنت تلميذة في الجامعة الوطنية في عاليه. ساعات الهرب من صفوف بعد الظهر بحجة "مرض نسائي" يصيبنا كل شهر، أو في سنوات لاحقة خلال أوقات التدريب العسكري للشباب. نأخذ الطريق نحو سوق عاليه حيث صالات السينما الصغيرة والضيقة. أذواقنا نحن فتيات الصف كانت تختلف وكنا نرضي بعضنا بأن نختار الفيلم بالقرعة. سينما صبح أكثر الصالات حداثة تعرض أفلاما جديدة. صالة طانيوس متخصصة بأفلام جريئة حينها وميامي، ونصر التي تحب عرض الأفلام الهندية، وايدن التي لم يطل عمرها كثيرا فأقفلت قبل أن نعتاد عليها. ندخل ونترك العالم خلفنا. هناك نتفرج على حيوات أخرى لم نكن قد ذقناها بعد وان كنا بدأنا نحلم بها. صالات وأفلام، مساحات حلم ورغبة، جزء من تاريخي الشخصي، امتزجت تفاصيلها مع أول مظاهرة شاركت بها وأول حب وأول كتابة.
"آخر تانغو في باريس" ربما كان آخر فيلم شاهدته في "عاليه". لم أعد أذكر. خفّت زياراتي إلى صالات تلك المدينة بعد أن تعرفت على صالات السينما في بيروت. من وسط البلد مرورا بمنطقة الفنادق وصولا إلى شارع الحمراء.
قبل أن أبدا رحلتي الفردية مع السينما، شاهدت بمعية العائلة فيلم "لحن السعادة". كانت المرة الأولى التي أتعرف فيها إلى شارع الحمراء. مَن منا لم يشاهد هذا الفيلم أكثر من مرة؟
أخذني عالم الفن السابع منذ أن بدأت أعي وجودي. القاعة الأولى التي دخلت، ألوانها الخريفية المائلة إلى النبيذي، الظلمة التي تولد الموسيقى، الصوت وأناس يجلسون بقربي من دون أن أدري هويتهم. هم أقرباء لي بل أصدقاء بمعنى مختلف وجديد. نتشارك فعل رغبة قوية نعبر عنها بالصمت والانتظار. رغبة في شيء آخر فيه من السحر والحياة بحيث يتجاوز الحياة نفسها.
الألوان، سحرها الممتد على مساحة الشاشة، الرقة المنبعثة من وجوه تعشق وتتألم، الرفض لكل ما هو لا إنساني، إمكانية تحقيق الحلم، فرصة الرغبات غير المكتملة أن تجد طريقها، البحث عما هو أعمق من الصورة والكلمة، الفقدان الذي يوجع ولا يقتل، حق الناس العاديين بالحياة، هشاشة الحياة وزيف الكلام الكبير، السعادة التي لا تتطلب أفكارا ضخمة بل هي ربما في تلك الهشاشة، اكتشاف ان الموت والحياة وجهان لسيرورة واحدة لا تكتمل إلا باكتمالها. هذا بعض مما أعطته لي السينما في عمر مبكر.
*******