(ملف)
تحية إلى عصام محفوظ
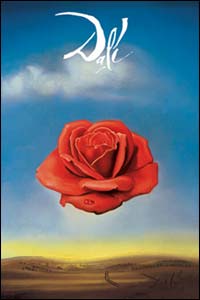 عندما أغلق يوسف الخال مجلة (شعر) للمرة الأولى، نشر قصيدة بعنوان الرفاق. كتب عن حزمة من العصي، وعن الاصطدام بجدار اللغة. لا ادري يومها لماذا تذكرت عصام محفوظ.
عندما أغلق يوسف الخال مجلة (شعر) للمرة الأولى، نشر قصيدة بعنوان الرفاق. كتب عن حزمة من العصي، وعن الاصطدام بجدار اللغة. لا ادري يومها لماذا تذكرت عصام محفوظ.
تعبير الرفاق أحالني على اليساري في وسط المجموعة التي جعلت من شارل مالك إمامها الفكري. وأخذني جدار اللغة إلى شاعر الموت الأول، الذي تخلى عن الشعر من اجل ان يكتب بيانه المسرحي معلنا فيه ولادة اللهجة اللبنانية كإحدى لغات العرب المحدثين التي تكتب بها أجمل نصوص المسرح.
صاحب الزنزلخت و الديكتاتور، الذي ذهب مع فرج الله الحلو إلى ستيريو68 ، نجح في مصالحة موجة الحداثة العاتية التي أطلقتها مجلة شعر مع فكرة يسارية علمانية منفتحة، كان فيها نسيج وحده. تصالح مع التراث العربي القديم معيدا اكتشاف مارقيه وملحديه، وذهب في الحداثة الأدبية الغربية إلى أقصى الأماكن، من اجل ان يجد لإنسانه اللبناني والعربي مكانا تحت شمس العالم الرصاصية التي لم ترحم العرب.
صديقي عصام، هل استطيع ان أتكلم عن صداقة صنعتها الكلمات؟!
لم أشارك عصام محفوظ مائدة المقهى إلا نادرا، ومع ذلك جذبني هذا الغريب الدائم بقدرته العجيبة على جمع المتناقضات وصوغ عوالمه من الشعر والمسرح والنقد الأدبي والحوارات الحقيقية والمتخيلة.
التقيته أولا على صفحات شعر ثم صارت جريدة النهار بصفحتها الأدبية منبره إلى عوالم القارئ. كنا ننتظره كي نكتشف الجديد في الأدب العالمي، وننتظره كي نتعرف إلى الطليعي في الأدب العربي.
نتفق معه او نختلف، لا يهم، فالرجل كان يصنع لنفسه زادا روحيا لا ينضب. وحين تكون الكتابة حوارا مع أسئلة العقل والروح، فإنها تأسرك في حالتَي الاتفاق والاختلاف لأنها تتحداك دائما.
صديقي عصام وحيد في المستشفى، يقاوم الجلطة الدماغية مثلما قاوم الطغيان والقمع والبلادة في بلاده المنكوبة.
انه في الوحدة التي لا نستطيع اختراقها كي نصل إليه ونقول له كم نخاف عليه، وكم نريده ان يبقى بيننا.
نحن في حاجة إلى عصام محفوظ وأمثاله.
كيف نستطيع مواجهة هذا المنعطف المخيف الذي يهدد لبنان وبلاد العرب بكوابيس الانحطاط من دونكم؟
الكلمة قد لا تداوي جرحا، وقد لا تشفي مريضا، لكنها قادرة على ان تبلسم جروح الروح.
أرواحنا مجروحة أيها الرفاق، ولا نملك سوى الكلمات.
النهار الثقافي
***
أسلّم عليك وقصدي أن أعترف بأفضالكَ العامة والشخصية.
لم يكن يجمع بيننا، كشخصين، الشيء الكثير لفارق الأعمار والظروف. فأنتَ من جيل هو إلى حدّ ما جيل "الآباء"، وأنا من جيل "الأبناء" طبعاً.
لم يكن يجمع بيننا الشيء الكثير. الأدب فقط وبعض أهله وأبناء عمومته من حرية ومسرح ونقد وترجمات. وهذا في رأيي كان كافياً جداً لكي أكون قارئكَ وعارفكَ ووازن فاعليتكَ ومندهشاً بقدرتكَ على أداء الأدوار الجميلة في هذه كلها.
أريد لكَ العافية الموفورة أيها العزيز.
وأريد لكَ القلم والورقة والسيكارة ودخانها العابث واستعادة الجلوس في المقهى. فهذه تليق بكَ، وأنت تليق بها.
يشقّ على شخص مثلي أن لا يجد سبيلاً إلى الإعتراف بالأفضال، بأفضالكَ، سوى الكتابة إليكَ.
أهل الكتابة مسؤولون عن فكرة التضامن معكَ والالتفاف حولكَ ورفع الصوت العالي كي ينتشلكَ الطبّ والجمهورية المسؤولة من الهوة التي أنتَ فيها.
الإنسان الفرد الذي كتبتَ من أجله طويلاً، والمجتمع مجتمِعاً، فضلاً عن المثقفين، ولبنان الثقافي، من واجباتهم كلهم أن يقفوا إلى جانبكَ في امتحان العافية الذي تعيش بعضاً من أصعب اختباراته.
الدولة الحكيمة والديمقراطية والعلمانية التي دعوتَ إلى قيامها منذ أكثر منذ أربعين عاماً، من مسؤولياتها البديهية الأولى أن تسأل خاطركَ وتهبّ إلى نجدتكَ وتشيل عن مزاج الجسد والدماغ ما ألمّ بهما من تعكّر.
عيب عليها، وعلينا جميعاً، أن تكون وحيداً في هذه المحنة.
كتبكَ، القصائد والمسرحيات والنصوص وأعمال النقد والترجمة، ومقالاتكَ، ومواقفكَ، وأفكاركَ، فضلها علينا كبير، وفضلها على لبنان الثقافي أكبر وأكبر. فليس كثيراً ان تصعد الدولة إليكَ، وإن تكن مقيماً الآن في هوة المزاج، كي تفيكَ بعض أفضالكَ وكي تكشح عن صحتكَ الغمامة الثقيلة.
الجميع يعرف انكَ أعزل. دائماً كنتَ هكذا، أما الآن فأكثر.
ولهذا السبب بالذات، نحن مسؤولون عنكَ، كمواطنين اولاً وككتّاب أولاً وأخيراً.
وللأسباب كلها، فإن الدولة مسؤولة. كل المسؤولية تقع عليها وعلى وزاراتها في إنهاضك مما أنتَ فيه، لجعلكَ في الموضع والمقام والمزاج والأحوال التي تليق بالكاتب مطلقاً. فكيف إذا كان هذا الكاتب، مثلكَ، من صنّاع النهضة الثقافية اللبنانية والعربية.
أريد أن أسلّم عليكَ وأسأل خاطركَ.
بل أنا أطلب إليكَ - بمَونة الصديق الأصغر سناً وباعترافه - ان تقوم من السرير ومن مزاج الجسد والدماغ المتعكر، لتعود إلى الحبر والمقهى والى الضحكة العالية.
من مسؤولياتك، يا عصام محفوظ، بل من واجباتكَ حيالنا وحيال بلدكَ، وحيال القلم، أن تنهض إلى شمس الصيف التي تطالبكَ بالوقوف.
الحبر ينتظركَ، المقهى ينتظركَ، وضحكتكَ المجلجلة التي تركتَها هناك، لا تزال في انتظاركَ.
وفضلكَ علينا ينتظر، واعترافنا.
والسلام لكَ والسلام عليكَ.
النهار الثقافي
الأحد 17 تموز 2005
*****
بعيداً عن لغة العواطف والأحاسيس المنكوءة وعن شكرنا للمستشفى ووزير الصحة بالذات.. الخ، الخ.. هكذا ببساطة : عصام محفوظ، الصديق (الوديع المستلقي في صمت)، يفجّر بقسوة ما بعدها نقمة، من (غرفة عناية فائقة)، كل مأساة الأدباء والفنانين البسلاء والبسطاء دفعة واحدة على رؤوسنا ومؤسساتنا (الإبداعية) واتحاداتنا الفولكلورية النافقة، وعلى ثقافتنا ومسؤوليها... وعلى (الضمان) الاجتماعي والشيخوخي في حياتنا وآخرتنا...
وتقول الرسالة بلسان عصام. قلمي؟
شكرا، لقد عرفنا أخيراً (آخرتنا الممتازة) : غرفة كانت (علّية طفولة وشباب) تحت قرميد تحت سماء زرقاء. وأصبحت، أو صيّرها الوطن وسكّانه، سجناً يكبر معنا، غربة ووحدة وشقاء، ما لم نقل قبراً يصغر علينا كلما كبرنا.
شكراً ل(آخرة) ممتازة : غرفة وسكون ودماغ مفتون... وعناية خارقة. شكراً. فما يجمع الأدباء والفنانين عندنا في النهاية هو غرفة انعزال عالية العناية بانتظارهم بالواسطة وافداً معززاً تلو الآخر. وأي (عناية) بعد طول كتابة وسهر و(جوع) وبهدلة؟ بل أي (فائقة) بعد طول كدح ونضال بالقلم الثائر والفكرة الحرة والروح المتمردة (بعيداً عن أي مزاجيات تبقى للقلم قيمته وللعمل مكافأته في البلدان التي تحترم (عداءها) لكتّابها).
وتجاوزاً للتذكير ب(الكوارث) التي حدثت طيلة سنوات ماضية مع كتّاب شرفاء حقاً (مثل محمد عيتاني وعبد اللطيف شرارة وفضل الأمين وصولاً إلى ميشال سليمان وسلام الراسي...) ومع فنانين أزود من شرفاء (بدءاً بشوشو ونهاية بإبراهيم مرعشلي مروراً بمن قبلهما ومن (سيكافأ) بعدهما على الحبل الجرار)، وتجاوزاً بالتالي لشكرنا لاندفاعة وزير الصحة المشكورة، لا بد عبر الحرقة والغضب واليأس المحبط من تسجيل المفارقات المعروفة والمسكوت عنها :
- خارج غرفة عصام الفائقة، ما من جهة رسمية ترعى الكتّاب والفنانين بالفعل وبالتحسس، حيث لا وزارة ثقافة تعاني معهم وتلتفت إلى واجباتها تجاههم، فأقصى تقديماتها مساعدة زهيدة شكلية كرقعة من هنا، والتفاتة مادية استعراضية سخيفة روتينية كترقيع من هناك... رغم تبريرات (قلة اليسرة) التي لا تصيب سوى وزارة الثقافة التي تستكين لهذه التبريرات غالباً وتنافح عنها.
- لا وزارة عمل أو شؤون اجتماعية تتابع بالفعل وتلاحق مشاريع أو مجرد مطالب الكتّاب في الضمان (المقرّ من سنوات) الصحي والاجتماعي. فكيف بما يعود إلى حقوق الكاتب والشيخوخة ! 3 لا اتحاد أو نقابة أو... مؤسسة تعمل بالفعل اليومي على سد الحاجات الطارئة والمطالب المزمنة، حيث بالعكس تهمل التحركات أو تنسى وتُقبر المطالبات الحقة بالحكي والانتخاء بالتقصير...
صديقي الطيب عصام. لمن نقدّم الشكوى ورفع الظلامة؟ لوزارة الثقافة أم لوزارة (الضمان) و(الإنتاج الأدبي والفني؟) ومن نحاسب؟ وزارة الزراعة مثلا؟ أم وزارة الاتصالات (التي تجلدنا بأسعار البريد الباهظة جدا). أم وزارة البيئة والدفاع. الأدباء والفنانون مغتربون في الأوطان والمذاهب والطوائف ومهجّرون من لغة التخاطب والبث والاستقبال السياسي وستدافع عنهم وزارة للمغتربين... والمهجرين. شكراً...
أخيراً، على كل عامل في الأدب والثقافة عموما والفن أن يتساءل كيف يتم (اختراع) وزير للثقافة عندنا، كما كنت تتساءل في وحدتك المزمنة يا صديقي عصام بانتظار الضحية التالية.
نعم، يتم اختراعه واكتشافه (سياسياً) لا ثقافياً. أي بالسياسة، (لا ثقافياً ولا فنياً إبداعياً). هل السياسي بهذا الاختراع يعاني حاجات المثقفين ويحس بهم وبخصوصياتهم؟ حتى الاستثناءات لا تشجع (كم وكم سمعنا بمكافأة شهرية أو براتب للأدباء والفنانين بعد الخمسين مثلا أو بطاقة طوارئ لدخول المتشفيات)...
فرغم ما تعانيه يا صديقي عصام في هذه اللحظات في غرفة عنايتك الفائقة ! وما تتوجع له نفسياً وجسدياً، أتجرأ على نفسي وأعلن رهبة الجميع ورعبهم من مصيرك، وأعني بلسانك الصامت أو المصمت الآن مصيرنا الذي نشاهده بكارثية المبكي الساخر على مسرحك العظيم، من خلالك بل من خلالنا فيك، رغم مأساتك/ مأساتنا المزمنة التي ننساها أو نتناساها أفراداً (عندما نكون في صحتنا) ونتذكرها نصاً مخيباً في حمالة مصابين بحب الأوطان وسيارة إسعاف وطني في طريق (غرفة عناية مكثفة) بعد فوات الإنسان. ولعلي لا أزعجك، خصوصاً بعدما تركتك تشد أصابع كفيّ بيسراك (لا بيمناك التي كافأنا نضالها بإخراسها) وخرجت. أقول، مع (الديكتاتور) و(كارت بلانش) ومن أعلى (الزنزلخت) بلسانك دون مراعاة أو حيطة خجل : رغم ما أنت فيه ونحن، وما تعانيه وحدك يا صديقي الطيب، أقول : (نيّالك) في سرير هذه الغرفة الاصطناعي عبر نباريشها التي تشبه شبكة علاقاتنا، بعيداً عن الوزارات والادارات و... الاتحادات وشركات الطوايف والمذاهب والأحزاب والأحزان الوطنية الأخرى. نيالك مبعداً، مهجراً، (مكرماً) لكي لا تمارس معنا هذه الليلة الأخيرة، الطويلة جداً، في مصنع التوابيت.
ابتسم بعُبّك صديقي الطيب كما فعلتها لحظة وداعي حين قلت لك : ستعود أقوى. أقول ابتسم ساخراً في بداية المسرحية الوقحة هذه أو في نهايتها. عندما أتجرأ كما تريد وأقول أخيراً بلسانك إنني أعني قصيدتك الأولى : (الليلة الأخيرة في مصنع التوابيت). وستخرج مثلك (دائماً) منتصراً على كل الليالي الأخيرة. واعتقادي أنك رغم الشدة ستنزل عائداً إلينا مع كل ما كتبته شعراً ومسرحاً ونقداً وترجمة ونضالات. وكلنا ننتظرك، بلسانك أُبلّغ...
Jeudi، 14 juillet 2005
***
عصام محفوظ في حالة صحية حرجة. هذا الخبر يهزّنا ويستنفرنا، وإن كان الأمل في الشفاء كبيراً، وعودة الكاتب إلى عطائه رجاءَ كل المهتمين بالشأن الثقافي، وكل الذين يعرفون أهمية الرجل ومساهمته في صناعة ربيع الثقافة اللبنانية في مواسمها الخصبة، وإصراره على المعاندة أيام تراجعت الثقافة أمام المد المليشياوي.
إذا كان عصام محفوظ ينام هادئاً اليوم في سريره بمستشفى الساحل، فهو صاحب تاريخ من التمرد على السائد في المسرح والشعر والنقد، وتاريخ من المشاغبة والمشاكسة والرفض، من أجل تكريس منطق التغيير والتحديث ومجاراة العصر.
كان علينا ألا ننتظر مناسبة مرض عصام محفوظ لنبري أقلامنا وننبري لتكريمه والكلام على دوره الحاضر بقوة في الثقافة اللبنانية والعربية. فقامة هذا الكاتب تستوجب أن يتنبه لها المهتمون بالشأن الثقافي وشؤون المثقفين.
لا يمكن أن يمر خبر مرض واحد من المؤسسين لموجة الحداثة التي عمت لبنان خلال نهايات الخمسينيات وبدايات الستينيات ثم السبعينيات، مروراً عابراً، فإذا تذكرنا مجلة (شعر)، نتذكر أن محفوظ كان واحداً من أركانها، وبالتالي من أركان مشروع الحداثة الذي حملته، ليس فقط على مستوى الشعر، وإنما على مستوى الإبداع الأدبي عموماً والنقد.
لا يمكن أن يمر الخبر، من دون أن نتذكر حضور ذلك الصحافي المثقف الذي كانت كتابته، على صفحات (النهار)، تختزن معرفة موسوعية، لا تقف عند حدود الأدب والنقد، وإنما تتعدى ذلك إلى الفلسفة والفكر والعلم والسياسة والفنون.
لا بأس أن نعيد شريط المؤلفات التي أتحفنا بها محفوظ، ذلك الشريط الذي نحصي فيه أكثر من خمسة وعشرين كتاباً، تأليفاً وترجمة، نتذكر مسرحياته (الزنزلخت) والدكتاتور) و(التعري) و(ستيريو 70) و(من قتل فرج الله الحلو)، إلى حواراته مع كبار الشعراء والروائيين العالميين، وابتداع حوارات مع متمردي التراث ورواد النهضة العربية، في محاولة لإعادة اكتشاف أولئك الذين أثّروا في بناء ثقافتنا، إلى مؤلفاته في المسرح العالمي والعربي، وثقافة القرن العشرين عموماً، مفرداً كتاباً عن جورج شحادة، وآخر عن رامبو.
لا نريد هنا أن نقدم إحصاء لما قدمته قريحة عصام محفوظ، بقدر ما نريد أن نشير إلى أهمية ما قدم للمكتبة العربية من مؤلفات جديرة بالقراءة، بل أهمية ذلك الرجل القابع في المستشفى والذي لا يملك من الثروة غير تلك التي أعطاها للثقافة.
دخول عصام محفوظ إلى المستشفى، ومرض أي من المثقفين، العاملين أو المتقاعدين، يذكّرنا بأزمة دائمة تجعل المثقف مهموماً، إلى جانب الهم الثقافي الذي يقلقه دائماً، بهم المعيشة والحصول على العلاج، وسبل الحفاظ على حياته، بغياب كل أنواع الضمانات الصحية والاجتماعية والمعيشية.
إلى متى تبقى الحكومات المتوالية عموماً، ووزارات الثقافة خصوصاً، غافلة عن واجبها في احتضان الثقافة والمثقفين، واعتبار الكتاب والفنانين جزءاً منها ومن بنائها البشري، بل واجهة من واجهات لبنان الحضارية.
الكلام كثير في مناسبة مرض عصام محفوظ، إلا أن ما نتمناه أن يعود إلى حبره يرسم به ما تبقى من خرائط الثقافة.
Mardi، 12 juillet 2005
***************
في مستشفى الساحل يرقد عصام محفوظ صريع الجلطة الدماغية والشلل النصفي.
العاصفة والرعب والدوي في كل مكان، ووحده عصام محفوظ في غرفته المنعزلة يصارع هوله الخاص.
مع ان العاصفة في كل مكان إلا ان معركة عصام محفوظ الصامتة ليست شيئا لا يمكن سماعه. أنها ملحمة أيضا، الروح تتخبط وحدها في الماء الأسود. القلب ينفجر وسيُسمع على بعد أميال. سيسمع عبر كتب يتيمة لم تكتب وعبر كلمات تنتظر ان تثمر ويحين قطافها وعبر بذور تتململ
في هجعتها. سيسمع عبر أشعار فاجأتنا في يوم قبل ان يقرر الشاعر ان يكتفي بالمفاجأة وان يترك لآخرين غيره ان يستثمروها ويؤتوا أكلها. سيسمع عبر مسرحيات فريدة ورائدة آثر معلمها ان يتركها أيضا لمن يواصل المسيرة، وعبر كتب وكتب كثيرة كان عصام محفوظ في كل منها معلما وشيقا ومفيدا.
العاصفة تثور ووحده عصام محفوظ في غرفته المنعزلة العالية في داخله المنعزل العالي يصارع عاصفته الخاصة. لا نعرف ماذا سيواجه تماما لكننا نعرف انه يواجه هولا باسم وبغير اسم. انه يواجه عصره وزمانه، يواجه عصرا استنفد كل مغامرة وبات يستبق المغامرات، يواجه زمانا باسم الحرية وصل إلى مجتمع رقمي. يواجه بلدا يتدهور في بئر لا قرار لها، بئر لا قرار لها كتلك التي يسعى عصام محفوظ الآن إلى الخروج منها.
عصام محفوظ الذي كان في البدء فتى حركة سعى دائما ليكون مختلفا وقبلته مختلفا لان شبابه ونضارته سحرتاها. كان يساريا وسط جماعة تربت على اليمين، وكان واقعيا على طريقته وسط سيرياليين، وكان منهجيا أكثر من وسطه، وباحثا وعارفا أكثر، وبالنهاية فإن عصام محفوظ حين تفرق الجمع ذهب بعيدا بعيدا عن الجميع، وبعيدا عن الآخرين.
كانت الخيبة الكبرى، خيبة مشروع وخيبة ثقافة وخيبة حركة، وأصر عصام محفوظ على ان يبتلعها كلها. انه من الذين لا يحيدون عن الحجر الساقط، من الذين يعانقون الكارثة، من الذين يتوحدون مع التراجيديا. ألم يكن رائدا في المسرح، رائدا في الشعر، فلم لا يكون رائدا في الحياة.
العاصفة تثور وعصام محفوظ في غرفته المنعزلة، في داخله العالي. الموهبة الأكيدة التي تعرف أيضا ان لا تنحني. الموهبة التي تعرف ان لا ثمن للموهبة وان من يستطيع النهوض عن المائدة في وسطها هو الذي يستحق مصيره. عصام محفوظ شاعرنا ومسرحينا وباحثنا،
وصديقنا أيا كان مكانه،
ورائدنا بلا ريب،
في غرفته المنعزلة يصارع هوله الخاص.
لم يدعُنا في أي يوم لنحبه،
لكننا الآن نملك الجرأة لنقول ذلك.
******
"تلك التي أحبّ
تجسّد رغبتي في الحياة
الحياة التي أعيشها الآن هي أبداً الآن.
ولأنه ليس ثمة حياة أخرى فإنها حياة رائعة"
بول ايلوار
زلزلني مقال عباس بيضون في "السفير" قبل أيام: عصام محفوظ، نزيل مستشفى الساحل، نصف مشلول. كيف يُشلُّ من روحه طيران دائم؟ وكيف يُشلُّ الشاعر، والمسرحي، والناقد، والمترجم، والثوري، الذي هو عصام محفوظ؟
قرأت المقال مرة، مرتين، وثلاثاً، وكان الوقت فجراً، فهربت من غرفتي، وانتهبت الدرب الضيق الذي يفصل حديقة المحلة عن المسجد الكبير، كما حدث ذلك في واقعتين: الأولى يوم قصفوا بغداد للمرة الأولى، والثانية يوم احتلوا بغداد.
كنت أسرع إلى بيروت، إلى البحر، بجوار الروشة، حيث المقهى القديمة، بعيد منتصف الليل بقليل، وكان العام عام، 1970 عام الهجرة الأول، والنزول في بيروت للمرة الأولى، ولقاء بعض الناس الذين كنا نقرأ لهم، ونعرف عنهم أشياء كثيرة، إلا مجالستهم إلى طاولة في مقهى.
عصام كان الأكثر دفئاً، والأكثر اعتداداً، والأكثر ثقة، والأكثر ثورية، بجوار غسان كنفاني. وما هي إلا سويعات حتى كنت أصارحه بكل شيء: محدّداً من كفراني بالأحزاب الشمولية، وليس انتهاء بالآمال الناقصة في الثورة الفلسطينية.
وسرعان ما أمسك عصام محفوظ بكتفي، ونحن نواجه بحر بيروت في الليل، ولم أدر هل كنت أرى شمساً أم بدراً، أم أن عصاماً هو الشمس والبدر في ذلك الفجر، حين كان يحدثني بطريقته، غير المألوفة لدينا نحن العراقيين، عن ايلوار، واكسوبري، ومجلة "شعر"، والتجديد، والمغامرة غير المتوقفة عند الشكل.
وتوقف كثيراً عند "غيوم ابو لينير".
تعرفت على "ابو لينير" من سارتر. لكن عصاماً جعله بين يدي، كما أنا بين يديه. كانت تلك هي الرفقة التي دفعتني إلى أن أتحدث إليه عن مشروعات أدبية، ربما يرى فيها غيره، ضرباً من جنون، بيد أنه كان ينفخ في طينتي، كما لو أنه يريدني اكتشافه الخاص. وذاك ما قد حصل.
وكنت سعيداً بتلك الرفقة. وكانت سعادتي كثيرة، عندما كتب في "النهار" حيث كان يشرف على "القسم الثقافي" فيها، مقالاً عن "جمعة اللامي الأول ليس بين كتاب القصة العرب، بل بين كتاب القصة في كل مكان، كتب القصة بهذا الأسلوب". وكان يشير بذلك إلى قصائد "ابولينير" التشكيلية.
هنا، العام ،1970 أطلق عصام محفوظ، النار على مؤامرة الحزب الشمولي، وأعاد الحياة إلى "حكمة الشامي". فكيف يُشلُّ من روحه طيران دائم؟
جريدة الخليج
يرقد عصام محفوظ، منذ أكثر من أسبوع، على سرير غرفة العناية الفائقة في مستشفى الساحل.
لطفت به عناية ذلك الذي كان عصام على شبه قطيعة معلنة معه وفي قلبه أكثر من مودة تقارب الإيمان، وفي عقله أكثر من سؤال وجودي.
تجاوب مستشفى الساحل لاحتضانه، وهو الغريق بلا طوق نجاة، يحمل كالكبار قليل المال في جعبة جسد نحيل ناء تحت ثقل الإبداع وتاه وحيدا في ديار العرب. واستجاب وزير الصحة العامة الدكتور خليفة بشهامة العارف لإنقاذ طاقة متوثّبة خرجت من لياقات المجتمع السياسي إلى رحاب الحلم بالثورة/النهضة/ الحداثة باسم المعذبين في الأرض، مزيجا هجينا غير مألوف تاق إلى عصارة تعاليم ماركس وسعادة، ومدارس فانون والمعتزلة، عبد الناصر والأفغاني.
جنوبيّ هو بالتأكيد. ريفي هام في المدائن، لا طائفي ينشد "حزب الله" على أنغام مسيحيته بالهوية والافتراض، شاعر بدون شعر، يدوّن الكلمات في سجل المقاومة، ويصارع العنصرية والصهيونية كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
يا "رجل"، أو يا أخا الديانة كما يحلو لك أن تقول، ما الذي أقعدك في ذاكرة الناس وغرفة المريض، وكيف لك ذلك يا صعب المراس؟
اخترت غريماً بالانفراد اسمه جورج بوش، ولم تكن لترضى بأقلّ منه خصماً تهزأ من تهوّره، وتقارن عثرات هجمته وضيق أفقه بخصوبة عمالقة الأدب وصناعة الحرف في بلاده بالذات.
أين صوتك الصارخ، أين رنين جرس مطالعاتك، وقنابل حجّتك وسنابل قطافك؟
أين كبار القوم من زوّارك ما حاجتهم بك وما حاجتك بهم كما كنت على الدوام؟
انهض أيها المشاغب، لا نريدك حيث أنت. قم، عد، قاتل، صارع، عش بجسدك وقلبك وفكرك وقلمك.
وإذا ارتضيت فنحن لن نرضى. اعتقنا من انتظارك في حقل المنازعة والصراخ.
يا مسافراً في الوطن بلا حقيبة وباسم المسرح، أنت متّهم بالهروب من الحياة، فلا تفعل، ولا تطل المشوار.
***
منذ مساء الخميس والشاعر والكاتب المسرحي عصام محفوظ يصارع من اجل الحياة.
كان وقع الخبر تلمسا للقديسين ليرأفوا به ويأخذوا بيده ليخرج من المحنة معافى.
غريبة هي الحياة. نتعارف، نكبر كل على طريقته في عالم الفن او الأدب. نقرأ او نشاهد، او نعجب بما ننجزه.
كل مرة وأحيانا كل يوم نلتقي، ونتناقش، ونتشاور، ثم نختفي... وفجأة نتذكر بعضنا بعضا.
قبل يومين ونحن في كافيتيريا "النهار" تذكرنا عصام، وتحدثنا عن أيام كنا نعمل في مكتب واحد: نزيه خاطر، سمير نصري، مي منسى، عصام محفوظ وأنا. كان شوقي ابو شقرا "السنجاب الأبيض" راعيا لقسم الثقافة. وكنا "نزحنا" غالبيتنا من الفرنسية إلى العربية، وكان عصام بالعربية متفوقا علينا.
كان يكتب بعفوية وسرعة، ويتفاعل ويرق ويغضب ثم يهدأ. لكنه لم يستسلم مرة للسأم.
لماذا؟ لأننا كنا وقتها لا نترك الزمن يباغتنا، ولا ندع تجاربنا تفقدنا مؤهلاتنا للتثقف والمعرفة والسفر والتمتع بمباهج الحياة.
كانت الفرص مفتوحة أمامنا، وكنا نكبر دون خوف.
اليوم أصبحنا مفرّقين: رحل سمير نصري قبل ان يترك عصام "النهار" وتوقفه عن الكتابة المنتظمة في الصحافة اليومية.
اذكره وهو يروح ويجيء، عصبيا ومحتارا وخائفا، في الكواليس ننتظر ردة فعل الجمهور في أول عرض لمسرحية "الديكتاتور" التي ألفها واختار انطوان كرباج، زوجي، والراحل والممثل والصديق ميشال نبعة، لإخراجها وتمثيلها. كان ذلك عام 1973.
كان كلما احتاج إلى مال أسرع إلى تأليف نص للتلفزيون، او وضع دراسة لمجلة متخصصة، او حتى مسرحية.
فكيف يتقبل الآن إلا تحمل يده قلما ليرقّصه فوق الورقة البيضاء التي تنتظر خواطره؟
منذ مساء أول أمس ونحن نأمل ان تعفو الشدة عنه، ويعود إلى أصدقائه ومحبيه وقرائه. وجميعنا، حتى وإن فرقتنا اهتماماتنا، نبقى متحدين في ذكرياتنا وشبابنا وماضينا.
يلا يا عصام، انهض، فنحن نصلي من اجل شفائك. والله يستجيب أدعية انقياء النفوس وأصفياء القلوب.
***
خرج الشاعر والصديق عصام محفوظ من الغيبوبة التي كان قد دخل فيها الخميس الماضي وأصبح ممكنا التحدث معه ولكن خلال ساعات محددة من النهار. ومن الطبيعي ان يترك يستعيد عافيته قبل ان يسمح له الفريق الطبي، المشرف على علاجه، بالاتكال على نفسه والتنفس طبيعيا. يقولون ان حالته تتحسن لكنه يحتاج إلى المراقبة والمتابعة في العناية الفائقة.
قد نزوره اليوم. انه على طريق العودة السالمة إلى الحياة الطبيعية.
نشكر العناية الإلهية التي رأفت به وأعادته ألينا والى الأصدقاء.
*************
لن تشهد المرحلة المقبلة صراعاً
بين الحداثة وما بعدها،
بل بين الثقافة وما بعدها".
ادوار بوند
هل يجدي الكلام عن ماضي المسيرة الثقافية العربية، بعد الانقلاب التاريخي الذي طاول كل المفاهيم، بما في ذلك المفهوم الثقافي؟
هذا السؤال طرحته على نفسي عندما طُلب منّي إجراء حوار عن المسيرة الثقافية اللبنانية، وتالياً العربية، من خلال مساهمتي الشخصية فيها. وهي فكرة كان يمكن ان تكون مغرية في زمن الاستقرار، وليس في زمن الاستنفار، الذي يعيشه العالم عموماً، وعالمنا خصوصاً، حيث لم يعد الكلام في ماضي الثقافة مجدياً إلا من زاوية ما يتمخّض عنه المستقبل.
لكن، لأن من حق القارئ، الذي قد يخالفني الرأي، ان يستوضحني وجهة النظر هذه، استعضت عن الحديث بانطباعات عامة قد يتوافق معي في شأنها كثيرون ممن كانوا فاعلين مثلي في المسيرة الثقافية العربية، حتى نهاية "الحرب اللبنانية"، التي تزامنت مع نهاية "الحرب الباردة"، وتالياً مع "نهاية التاريخ"، التي أعلنها المفكر الأميركي فوكو ياما، بعد حسم الصراع الإيديولوجي العالمي. وكان محقاً، لأن التاريخ هو سجل الصراع، وفي غياب الصراع يغيب التاريخ، لكنه أخطأ في الكلام عن نهاية التاريخ وليس عن نهاية مرحلة في التاريخ، فالصراع لا يتوقف إلا مع توقف الحياة، فهو يتجدد مع تجدد التناقضات في كل مرحلة جديدة من التاريخ.
والثقافة، موقفاً وإبداعاً، هي الخط البياني للمسيرة التاريخية التي لا تتقدم دوماً إلى الأمام، فقد تنحرف يميناً او يساراً، او قد تتراجع إلى الوراء. وليس التقدم العلمي هو المقياس، فقد يتقدم العلم وتتخلف الحقوق الإنسانية. وهذا ما كان أشار اكبر عقل علمي في القرن العشرين، ألبرت أينشتين: لأن ذكاء النخبة، الأعلى مستوى من ذكاء الجماهير، قد يستغل العلم للمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة.
ولعل النخبة هنا هي غير التي يحمل لواءها الياس عطا لله، منظّر "اليسار الديموقراطي" في لبنان.
فماذا عن النخبة التي تقود العالم اليوم؟
***
إذا ثمة صورة كاريكاتورية، فهي مطالبة احد رجال المال والأعمال، دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الاميركي، بخلق مراكز "لصنع الأفكار"، على غرار تصنيع الأسلحة كالتي باع بعضها للرئيس العراقي السابق.
أما الصورة الجدّية فهي التي توقّعها دافيد روتكوف، المستشار السابق لوزير الخارجية الاميركي الأسبق هنري كيسنجر، وسماها "الامبريالية الثقافية الجديدة"، التي تتناسب مع "المشروع الاميركي" الذي: "قليلة هي المناطق في العالم التي تتمتع أيضا بالاستقلال عن ثقافته"، كما جاء في كتاب هربرت شيلر "المتلاعبون بالعقول"، واصفاً المشروع الاميركي بأن له "ميزة مخاطبة غرائز النزعة الفردية، تعززها الصورة الباهرة التي يقدم فيها المشروع الاميركي مبتكرات التكنولوجيا ومباهج الاستهلاك".
ولقد طال هذا الانبهار بعض المثقفين اليساريين، في عالم المركز، كما في عالم الأطراف ("العالم الثالث" سابقاً)، حتى ان احدهم، الكاتب المسرحي سعدالله ونوس، تساءل، في الكلمة التي كلفته بها منظمة "الأونيسكو" لمناسبة "اليوم العالمي للمسرح"، وهي المرة الأولى التي يكلف بها مسرحي عربي، تساءل، مستغرباً وجود أزمة ثقافية: "على رغم الثروات الهائلة من المعلومات والمعارف، وإمكانات التسويق والاتصال..." كما جاء في كلمته، التي لم يختلف تعليقي عليها آنذاك عما سيقوله لاحقاً خبيران بالثورة "المعلوماتية"، هما جيمس كاري وجون كيرك، في كتاب ملفت العنوان: "تاريخ المستقبل"، وفيه: "إن سادة العولمة يسمحون حقاً بأن يقاسمهم الآخرون المعلومات والمعارف، لكنهم في الحقيقة لا يسمحون إلا بما يرغبون، لأنهم يحتكرون أسلوب التفكير المقرر سلفاً".
هذا الأسلوب هو الذي جعل "المجتمع الغني بالمعلومات" ممسوكاً بالقبضة التجارية التي جاهد ليتحرر منها "المجتمع الفقير بالمعلومات".
وقبل ثلاثة آلاف عام أدرك الكاتب المسرحي الإغريقي سوفوكليس: "ان قيمة المعرفة ليست في ذاتها، بل في أسلوب استخدامها".
***
لا أريد للقارئ ان يفهم من كلامي إنني أدافع عن النظام الاشتراكي المهزوم ضد النظام الليبرالي المنتصر. فلم تكن الممارسات، في أي من النظامين اللذين تنافسا على العالم، تُغري بالانتصار لأحدهما. لكن الصراع السابق كان مفتوحاً على احتمال قيام نظام عالمي جديد يوحّد الحرية الفردية، عماد الليبرالية، والعدالة الاجتماعية، عماد الاشتراكية: "بعد تنازع البقاء العظيم بين أفكار كينز وماركس"، كما جاء حرفياً في بياني المسرحي الأول الذي قدمت به أولى مسرحياتي، في الستينات من القرن الفائت.
ولا اعتقد ان النظام العالمي الراهن هو النظام الذي حَلُم بعضنا به، وسعى إليه، فالشعور بالخيبة كان مشتركاً بين غالبية المبدعين، في الشرق كما في الغرب، ففي حديث إلى مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، يقول المخرج المسرحي السوفياتي (سابقاً) أناتولي فاسيلييف: "ان إحدى النتائج المؤسفة ل"البيريسترويكا"، التي دافعت عنها ضلالاً او انتهازية، أكثر مما بدافع القناعة، هي أننا فقدنا العمل في بلادنا، من دون ان نكسب الحرية التي وعدنا بها أنفسنا".
وفي المقلب الآخر من العالم كان الكاتب المسرحي الأميركي، ادوار ألبي، صاحب "من يخاف فرجينيا وولف"، يقول لمناسبة "اليوم العالمي للمسرح"، العام 1994: ان الديمقراطية البديلة عن الأنظمة الشمولية، هي ديموقراطية وهمية". فإلى أي حد هي وهمية هذه الديمقراطية التي تفرضها الإمبراطورية الكونية.
يقول مؤسسو هذا الشكل من الحكم في العالم ان الديمقراطية والإمبراطورية نقيضان. كان ذلك عندما تحولت أثينا إلى مركز إمبراطوري، بعد تزعمها "الحلف الديموقراطي" في المدن الإغريقية، ضد الحلف الاستبدادي الذي تزعمته إسبرطة. وفوجئ الأثينيون بممارسات قادتهم غير الديموقراطية، فكان رد كليون، الزعيم الديموقراطي المتطرف: "ان الديموقراطية لا تصلح لتصريف شؤون إمبراطورية". ولم يكن جواب بركليس قبله أقل صراحة: "أعرف ان إمبراطوريتكم تحولت إلى ديكتاتورية، وهذا ليس بالأمر العادل، لكنه يصعب التنازل عنه بسهولة".
فهل ان قادة أميركا أفضل من قادة أثينا، فيتنازلون بسهولة عن الديكتاتورية، ضريبة الإمبراطورية، وبخاصة بعد ان صارت الإمبراطورية الأميركية، إمبراطورية كونية؟
لعل معاناة الديموقراطية في النظام العالمي السابق كانت أخف وطأة، لأن المعارضين في احد المعسكرين المتنافسين كانوا، عند الضرورة، يحتمون بمظلة المعسكر الآخر، سواء كان المعارض فرداً او حزباً او دولة. فأين المظلة التي تحمي من ديكتاتورية الإمبراطورية الكونية؟
***
في زمن هجرتنا الصحافية إلى أوروبا، التقيت، صدفة، بالروائي الراحل عبد الرحمن منيف، في احد مقاهي باريس، أواخر السبعينات، وخرجت من اللقاء متأثراً بكلامه عن العالم العربي، هو الذي خبره جيداً ، وعمل في مختلف أقطاره، فكتبت مقالاً عنه توّجته بعبارة منه: كل شيء في عالمنا يضيق إلا السجن فيتّسع".
وفي أواخر التسعينات، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، كرّر عبد الرحمن منيف عبارته عن السجن، لكنه نسبها إلى.
ولأن الحديث كان مباشراً، على الهواء، كدت أطلبه لأصحح له الخطأ، لكنني تراجعت خشية ان يكون تقصّد ان يتبرأ من العبارة، تفادياً لاستغلالها في غير محلها، بعد عودته إلى العالم العربي. وعندما استوضحته لاحقاً قال إنني ألاحق منه بهذه العبارة بعد وصفي العالم كله بأنه صار سجناً، فلم يعد العالم العربي سوى زنزانة في هذا السجن الواسع.
فهل كنا نبالغ، هو عن العالم العربي، وأنا عن العالم؟
***
يقول الروائي غارسيا ماركيز انه طالما فوجئ بأحداث كان كتب عنها في بعض قصصه قبل وقوعها. ويعلل ذلك بأن حدس الفنان أصدق من حدث المحلل السياسي، وأكثر واقعية.
تأكدت من صحة كلامه عندما جاء إلى لبنان المبعوث الاميركي، السيد مورفي، متوسطاً في الأزمة الرئاسية للعام 1988، فقال عبارته التهديدية الشهيرة: "فلان... أو الفوضى".
وقبل سنوات من ذلك التصريح كنت وضعت على لسان المبعوث الأميركي "كارت بلانش" وهو أيضاً اسم المسرحية التي كتبتها عن أزمة رئاسية متخيلة في لبنان، العبارة التهديدية نفسها: "فلان... أو الفوضى"، التي سيقولها مورفي لاحقاً فتتصدر الصفحات الأولى في الصحف اللبنانية.
لذلك لم أستغرب ان تتحقق العام 2001 نبوءتي عن ديكتاتورية الإمبراطورية الكونية منذ ولادتها في مسرحية قصيرة بعنوان "1992".
أما لماذا تأخرت الديكتاتورية عشر سنوات، فلأن شعار الديموقراطية كان يحول دون إعلان "البلاغ رقم واحد" من دون ذريعة مناسبة تأخرت كواليس الإمبراطورية في تدبيرها حتى الحادي عشر من أيلول من العام 2001، حين صار بإمكان القيادة الإمبراطورية ان تعلن: "من ليس معنا فهو ضدنا"، واضعة العالم أمام خيارين: الطاعة او العقاب.
***
يقول المنظر الاميركي أيرفنغ كريستول، لتبرير قيام الإمبراطورية الكونية: "ان ما حصل هو ما أراده العالم".
وفي اعتقادي ان أي استفتاء، على مستوى الشعوب، خارج الشعب الاميركي طبعاً، ستكون نتيجته معاكسة للتنظير السابق، لأن ما حصل لم يكن نتيجة إرادة شعبية بقدر ما كان انقلاباً تمّ التخطيط له طويلاً، ولا تكفي صفة "العولمة"، التي ارتبطت بهذا الانقلاب، لإخفاء حقيقة وهوية هذا الانقلاب. وكأي بلد يحصل فيه انقلاب يظن الناظر إليه انه موحد بسبب الصورة التي تنقلها عنه وسائل الإعلام التي يهيمن عليها أصحاب الانقلاب، وليس من فارق سوى ان هذا الانقلاب كان على مستوى العالم.
هذا لا يعني ان شعوب العالم ضد "العولمة". لكن أي عولمة؟
كانت العولمة مطلب شعوب العالم عندما كان لها في زمننا اسم آخر هو "العالمية"، كسعي إلى مجتمع مدني عالمي، أول من بشّر به الشاعر فيكتور هوغو، بعد "ثورة المواصلات" في القرن التاسع عشر، التي كان لها الوقع نفسه ل"ثورة الاتصالات" اليوم، متنبئاً بقرب تحقق ما سماه "الولايات المتحدة العالمية"، "العالمية" وليس الأميركية.
كانت العالمية ترافق شعوراً أممياً يهدف إلى تضامن الشعوب ضد المستغلين، وليس، كما العولمة اليوم، تضامن المستغلين ضد الشعوب. لذلك فإن تهمة "التخلّف" التي يُطلقها مناصرو العولمة، المستفيدون منها، على المناهضين لها، وأنا منهم، هي تهمة في غير محلها. ولعلني كنت استبقت مصطلح "القرية الكونية" بمصطلح "العالم الصغير"، الذي "صار فيه المزارع الفنزويلي يستطيع أن يُنصت إلى سُعال حمّال في أقاصي سيبيريا"، كما جاء في بياني المسرحي الأول في الستينات، انطلاقاً من وعي عام آنذاك بالخطر النووي الذي وحّد العالم، عندما كانت السفن السوفياتية تتقدم في اتجاه كوبا، حاملة الصواريخ النووية، على رغم الإنذار الأميركي الحاسم.
وليس الخطر الذي يواجه العالم اليوم أقل من خطر القنبلة الذرية، بل هو أشد. انه خطر قتل الأمل بمجتمع عادل، طالما داعب مخيلة البشر منذ فجر الحضارة. وكان مجرد السعي في اتجاهه يزيد من صعوبة عودة البشر إلى "شرعة الغاب"، حتى بداية النظام العالمي الجديد، حيث بدا ان العالم يتجه نحو "شرعة غاب حضارية".
انه انطباع يزداد ترسخاً بقدر الشعور الطاغي بأنه لم يعد ثمة بديل عما يجري. ولعل انتشار الحديث في العالم عن قرب نهاية العالم، و"عودة المسيح"، والانتقال إلى "الجنة السماوية"، هو رد فعل على التيئيس من إمكان تحقيق "جنة أرضية"، كانت محور كل مشاريع "اليوتوبيات" في التاريخ، التي استُبدلت بالأسواق الحرّة.
***
فهل كان يبالغ الكاتب المسرحي الألماني (الشرقي سابقاً) هاينر مولر، الذي كان معروفاً بمناهضته للنظام الشيوعي، عندما قال، بعد انهيار الجدار: "كنا نظن أننا نقتحم باب الحرية، فإذا بنا سلعة في السوق".
فأين حصة الثقافة في هذه السوق؟
***
لم تكن الثقافة في يوم ما ثقافة واحدة، بل كانت دوماً ثقافتين: ثقافة التيسير وثقافة التغيير. وليس من نتاج ثقافي فاعل، نظري أو إبداعي، خارج الصراع بين هذين المفهومين اللذين يتبادلان الغلبة بين مرحلة وأخرى. فتغلب ثقافة التيسير في بداية كل مرحلة جديدة وتنغلب في نهايتها.
وثقافة التغيير ليست واحدة بل قد تذهب في اتجاهين، يشدّ أحدهما إلى الأفق الفردي، ويشد الآخر إلى الأفق الجماعي، وهو الذي يتراكم عبر التاريخ تحت اسم "الثقافة الإنسانية".
وإذ تتراجع الثقافة الإنسانية لمصلحة ثقافة التيسير، أو ثقافة الاستهلاك، فلأن الثقافة وسيلتها الإعلام "الذي يصنع الرأي العام والذوق العام"، بحسب ريجيس دوبريه في كتابه "الميديولوجيا". والإعلام الأقدر على الوصول هو إعلام الرأسمال الأكبر، ما جعل الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتران، يتساءل، منذ العام 1993: "هل إن ما لم تستطع الأنظمة الشمولية تحقيقه، من فرض الرأي الواحد والرؤية الواحدة، يحققه تحالف المال والتكنولوجيا؟"
***
ان خطورة هذا التحالف، غير الرسمي، بين المصالح الحكومية والعسكرية والتجارية، انه يشمل صناعات الإعلام والإعلان والمعلوماتية.
أما لماذا صناعات الإعلام والإعلان والمعلوماتية، فالجواب عند هربرت شيلر: "لأن هذه الصناعات تمنح "التحالف" سلطة ثقافية، هي مفتاح كل سلطة".
ولكن أي سلطة؟
***
منذ أن استعانت جماهير الثورة الفرنسية الكبرى، أم الثورات الإيديولوجية، بفئة من خارجها، هي فئة المثقفين والعلماء، لدعم ثورتها، ترسخت هذه العلاقة الجدلية بين السلطة والمثقفين، وبلغت ذروتها في زمن الأنظمة الشيوعية، باعتبار ان هذه الفئة تملك أدوات المعرفة، والوعي التاريخي، وكل ما تفتقر إليه "البروليتاريا" لتحرير نفسها قبل "تحرير العالم".
لكن، منذ البداية، توقع المفكر النمسوي الماركسي كلوزوفيتز، الذي اشتهرت عنه عبارة "إن السياسة هي استمرار الحرب بطرق أخرى"، توقّع ان هذه الفئة، لدى أول تناقض بين مصالحها ومصالح الجماهير، ستغلِّب مصالحها على المصلحة العامة. وهذا ما سيؤكده لاحقاً جان - بول سارتر، ولم يكن مخطئاً، لأن أبرز المنظّرين لدعم النظام العالمي الجديد، سواء في بلدان المعسكر الشيوعي سابقاً، أو في البلدان الرأسمالية، إنما جاؤوا من اليسار، وأحياناً من اليسار المتطرف، كما في أميركا، لخدمة إيديولوجيا تتناقض مع التي كانوا يعملون لها.
وفي غياب الصراع السياسي المتكافئ، الذي ميّز النظام العالمي السابق، وفي ظل هيمنة إيديولوجية وحيدة لا رادع لها، حتى إشعار آخر، يحق للمبدعين الأصيلين، تمييزاً عن المزيفين، أن يتخوفوا من التنظير الثقافي الجديد، المتماهي مع النظام العالمي الجديد ويحق للكاتب المسرحي الانكليزي ادوار بوند أن يقول: "ان المرحلة المقبلة لن تشهد صراعاً بين الحداثة ما بعدها، بل بين الثقافة وما بعدها، لأن الثقافة ستصبح سلعة يعتاش منها المثقف، من دون أن يعيش بها المجتمع".
وهو كلام لا يصدر عن ماركسي مُحبط، بل عن مبدع محسوب على الحداثة. فإذا هذا هو الحال في عالم لمركز، فماذا عن عالم الأطراف؟
***
لم تكن ثقافة عالم الأطراف، منذ بداية عصر النهضة، سوى صدى لثقافة عالم المركز، بكل أشكالها.
ومن الطبيعي أن تكون النكسة التي أصابت الثقافة الثورية في عالم المركز قد شملت الثقافة الثورية في عالم الأطراف، وبخاصة في العالم العربي، حيث النكسة مضاعفة، بسبب تحالف "التوحش الليبرالي" مع "التوحش العنصري" عندما استغل أصحاب المشروع الصهيوني الظرف الدولي الجديد للتحرر نهائياً من القرارات الدولية السابقة التي كانت تحفظ بعض الحق للشعب الفلسطيني، وبعض ماء الوجه للنظام العربي المتعاطف معه.
وعلى رغم الحصار المزدوج، وانهيار المشروع القومي للتحرير، ظلّت الثقافة الثورية مدعومة غالباً من الرأي العام، المغلوب على أمره، حتى بعد تقاعس المقاومة الوطنية، وتولّي الحركات الإسلامية زمام المبادرة، فكان على كواليس الإمبراطورية الكونية، ذات المصالح المتوافقة مع مصالح حليفتها الإقليمية، خلق ممارسات إرهابية، سواء بالتواطؤ أو بالاستفزاز، وهي قادرة على ذلك في الحالين، لقطع الطريق على هذا التعاطف، عبر خلط مقصود بين المقاومة والإرهاب، لضرب المفهوم الليبرالي بالمفهوم الديني، ما يسمح للمواقف الليبرالية العربية بالتقاطع مع المواقف الليبرالية الغربية، في اتهام المقاومة بالتخلّف، والأنظمة الداعمة لها بالديكتاتورية. وهو اتهام قد يكون في محله لو أن البديل عنه، كما صار واضحاً، ليس أسوأ منه، منذ أن تنكّرت الإمبراطورية الأميركية، المهيمنة على السياسة الدولية، لشعار "السلام العادل والشامل"، ما جعلني أكتب، منذ نهاية العام 1992: "إذا وصل التخطيط الأميركي - الصهيوني إلى غايته، سنترحم على التخلّف العربي، والديكتاتوريات العربية، وكل أشكال القمع التاريخية".
لم يكن موقفي انحيازاً إلى التخلّف والديكتاتورية، فأنا متهم، في شبه إجماع، بأنني خالق لغة المسرح "الحديث" في لبنان، كما ان مسرحيتي "الديكتاتور"، العام 1969، كانت أول صيحة مسرحية عربية ضد الديكتاتورية. لكنني، بدفاعي عن آخر المواقف المتصدِّية للاستخضاع، كنت آمل، ولا أزال، أن تتيح هذه المواقف المتصدّية، مع التمييز بين المقاومة والإرهاب، وقتاً قد يتعدل فيه التوجّه الدولي الراهن، الذي اتبعت فيه الإمبراطورية الأميركية، في النظام العالمي الجديد، سياسة الحسم، في إطار "الحق للقوة"، بدلاً من سياسة التسوية، التي ميّزت النظام العالمي السابق الذي كان يسعى لتطبيق مبدأ "القوة للحق".
***
لذلك فإن الأصوات المعارضة لهذا التوجه كانت تبدو نشازاً، أو في أحسن حال كان يوصف أصحابها بأنهم يتحدثون لغة قديمة، وكأن المطالبة بالعدالة موضة لم تعد تتناسب مع التوجه الليبرالي الغالب، المساير للإدعاءات الأميركية في مسألة "الحرب على الإرهاب" التي هي، حتى الآن، أهم استثمار سياسي أميركي، لا ينغصّه سوى الذين يعملون على فضح دور الكواليس الأميركية في صناعته. لذلك لم أستغرب، كما ذكرت في رد سابق في "الحياة"، ان كاتباً مثلي، يتعارض توجهه مع توجه المنبر الليبرالي الذي يعمل فيه، وألا يظل له محل في أي منبر ليبرالي، حتى إشعار آخر، إلا كضيف ربما وليس كمسؤول، فالمنابر الليبرالية العربية أكثر تأثراً، من مثيلاتها الغربية، بالضغوط السياسية، والأمنية، بشقّيها العلني والخفي، وفي الأخص بالضغوط المالية التي، وقد لا يكون انتبه أحد إلى ذلك، حالت دون استمرار إي صحيفة يومية حزبية في لبنان، بلد الحريات الإعلامية، فصارت البيانات والتصريحات الحزبية محكومة بالمنابر الليبرالية تُبرز منها أو تغفل ما يتناسب وتوجّه كل منبر.
في كتابه "مغامرات الحرية" يقول المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي: "لقد تغلّب التطرّف الليبرالي، في غياب الرادع الاشتراكي، على الديموقراطية، فلم تعد الليبرالية تتحمّل من الديموقراطية سوى اسمها".
وقد لا نستغرب اذا علمنا بأن الليبراليين الكلاسيكيين، المتمسكين بالقيم الديموقراطية الحقيقية، هم أنفسهم، بعد اقل من عقد على تهليلهم لانتصار الليبرالية، الذين وصفوا الليبرالية الجديدة بأنها "الليبرالية المتوحشة"، متذكّرين بخوف شعاراً لماركس طالما سخروا منه: "الاشتراكية او البربرية".
***
لقد بلغ التنظير الليبرالي من الوقاحة الحد الذي لم يتورع فيه المفكر الفرنسي آلان مينك عن القول: "ان الديموقراطية محكومة بالفشل، لأنها ليست من طبيعة الإنسان مثل الرأسمالية".
***
ان هذه الصورة القاتمة عن مستقبل البشرية ستزداد قتامة اذا استمر هذا النهج الرأسمالي في ظل ديكتاتورية الإمبراطورية الكونية. ولا شيء يشير إلى إمكانية ضبطه، على رغم الأصوات المحتجة من قلب هذا النهج، خوفاً عليه أكثر مما خوفاً منه، كما المفكر الاقتصادي ايتان كابشتاين الذي، منذ العام 1996، عندما كان مديراً لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، يقول: "ان العالم يتجه دون هوادة نحو الكارثة التي سيقف حيالها المؤرخون في المستقبل حيارى يتساءلون عن السبب في عدم اتخاذ إجراءات كان يمكن ان تحول دون هذا التدهور الذي أفرزه التطور الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي".
في إحدى تراجيديات سوفوكليس، يقول العرّاف تريزياس: "وإذ يصبح الإنسان مالكاً لمعرفة لا ينضب معينها، يستطيع بعدها ان يختار طريق الخير او الشر".
إن الأكثر تراجيدية هنا ان النخبة التي تقود العالم اليوم لها من القدرة على التضليل ما يجعل مفهوم الشر والخير مبلباً لدى الرأي العام، الذي يصنعه إعلام يزداد ضعفاً إزاء "منطق القوة"، بعكس ما كانت عليه الحال في ماضي الأيام. فماذا يفعل المستضعفون الذين بلا حول ولا قوة؟
***
في العام 1973، في "اللقاء الشعري العربي الأول" في بيروت، قلت: "ان الشعراء اليوم هم الشهداء". كلمة صدمت الشعراء، بقدر ما تجاوب معها جمهور الشعر.
كنت استوحيت كلمتي هذه، من أم سرحان سرحان، التي فوجئت بجواب ابنها على القاضي الأميركي الذي سأله: "لماذا قتلت السيناتور روبرت كينيدي؟" فرد الشاب الفلسطيني: "إنما هو الذي قتلني، يا حضرة القاضي"، وانطلق يحكي عن الخير والشر بطلاقة، هو الذي كان نادراً ما يتكلم، ما جعل أمه (كما اخبرني محاميه، اللبناني الأصل، عابدين جبارة، الذي جاء إلى بيروت العام 1971 لحضور عرض مسرحيتي "لماذا رفض سرحان سرحان") تقول: "لقد أصبح ابني شاعراً".
في وسط هذا الإحباط المتزايد في عالمنا، هل سيتكاثر أمثال هؤلاء "الشعراء"، أم ان المستقبل سيشهد لغة ثورية جديدة، قادرة على قلب المعادلات الفوقية، دون الوقوع في ما وقعت فيه سابقاً الأيديولوجيا الثورية؟
الحياة
2004/11/29