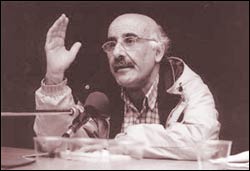 اكتشف أن العودة ثانية إلى برلين لا تجعلني أرسخ فيها. فها أنا افقد طريقي بين شارعين. ومذ فقدته بدأت أدور في مثلث محصور خوف أن ازداد بعدا وتغدو عودتي أصعب. المتاهة أيضا تبدأ بخطوة وكل خطوة تضاعف من التيه، حسابات لم تعد ممكنة بعد أن بدأ الرذاذ يلح علي وتتشربه ثيابي. لم يكن الرذاذ نفسه الذي بدأ من دقائق. لقد أصبح بالتأكيد أكثر ماوية، لكن هذا يتم ببطء شديد غير ملحوظ. ميزان نتوهم انه ثابت لكن نفخة باردة تجعل الهواء أكثر حركة وبردا يغزر بعده الرذاذ فيستحيل مطرا. بل هو مطر حقيقي يقطر من الأشجار ومن حافات السقائف ومن الجو كله الذي تناسجه كما يقول امرؤ القيس. مطر صامت زخاخ. الأرجح أن حالا كهذه لا تمت إلى خلو بال السياحة وصفتها. فالوقوف تحت السقيفة ومماحكة مطر لا يهدأ والخروج من تحت السقيفة لإيقاف تاكسي لا يقف رغم فراغه إذ قلما تقف التاكسيات هنا لراكب. ولا تأتي إلا بتلفون أو إذا قصدتها في محطات مخصوصة. المطر والاحتباس تحت السقيفة التي قلما تحمي والخروج تحت المطر كلما مرت تاكسي، ومناداة المارة سؤالا عن محطة تاكسي لا يحظى إلا بتقليب الشفتين وانعكاس إمارات الوجوه في شكل استفهامي، كل هذا يعني أني حبيس هذه الخطوة الشاردة، هذه القطرة التي تسقط عليّ. هذا المكان المعدوم الإشارات، وضع أسلم بأنه ورطة. أسلم في النهاية بأنه سخيف وغير لائق، إذ أن ابتلال المرء وظهوره وقد تبقع بالمطر أمر شبه مهين، لكن المطر مستمر والتيه مستمر ولا منجى لي إلا بأن اجمع نفسي وأصعد إلى المقهى الذي الطى تحته فأقول للمرأة الوحيدة في المكان المظلم الخالي كلمتين اثنتين <<تليفون، تاكسي>> ويفاجئني أن المرأة تسارع إلى التليفون ثم أجدها ملأت فنجانا من القهوة ووضعته أمامي، حتى إذا حضرت التاكسي رفضت أن تأخذ ثمنه.
اكتشف أن العودة ثانية إلى برلين لا تجعلني أرسخ فيها. فها أنا افقد طريقي بين شارعين. ومذ فقدته بدأت أدور في مثلث محصور خوف أن ازداد بعدا وتغدو عودتي أصعب. المتاهة أيضا تبدأ بخطوة وكل خطوة تضاعف من التيه، حسابات لم تعد ممكنة بعد أن بدأ الرذاذ يلح علي وتتشربه ثيابي. لم يكن الرذاذ نفسه الذي بدأ من دقائق. لقد أصبح بالتأكيد أكثر ماوية، لكن هذا يتم ببطء شديد غير ملحوظ. ميزان نتوهم انه ثابت لكن نفخة باردة تجعل الهواء أكثر حركة وبردا يغزر بعده الرذاذ فيستحيل مطرا. بل هو مطر حقيقي يقطر من الأشجار ومن حافات السقائف ومن الجو كله الذي تناسجه كما يقول امرؤ القيس. مطر صامت زخاخ. الأرجح أن حالا كهذه لا تمت إلى خلو بال السياحة وصفتها. فالوقوف تحت السقيفة ومماحكة مطر لا يهدأ والخروج من تحت السقيفة لإيقاف تاكسي لا يقف رغم فراغه إذ قلما تقف التاكسيات هنا لراكب. ولا تأتي إلا بتلفون أو إذا قصدتها في محطات مخصوصة. المطر والاحتباس تحت السقيفة التي قلما تحمي والخروج تحت المطر كلما مرت تاكسي، ومناداة المارة سؤالا عن محطة تاكسي لا يحظى إلا بتقليب الشفتين وانعكاس إمارات الوجوه في شكل استفهامي، كل هذا يعني أني حبيس هذه الخطوة الشاردة، هذه القطرة التي تسقط عليّ. هذا المكان المعدوم الإشارات، وضع أسلم بأنه ورطة. أسلم في النهاية بأنه سخيف وغير لائق، إذ أن ابتلال المرء وظهوره وقد تبقع بالمطر أمر شبه مهين، لكن المطر مستمر والتيه مستمر ولا منجى لي إلا بأن اجمع نفسي وأصعد إلى المقهى الذي الطى تحته فأقول للمرأة الوحيدة في المكان المظلم الخالي كلمتين اثنتين <<تليفون، تاكسي>> ويفاجئني أن المرأة تسارع إلى التليفون ثم أجدها ملأت فنجانا من القهوة ووضعته أمامي، حتى إذا حضرت التاكسي رفضت أن تأخذ ثمنه.
لا أعرف ماذا دعاني إلى أن ابدأ من هذه القصة وهي ليست طريفة ولا فريدة. الأغلب أن ليس في أسفاري شيء أكثر تواترا منها. المتاهة تبدأ بخطوة، خطوة لا ينفعني حرصي في تفاديها، وهذه المرة مثل كل مرة كان علي أن أدوخ فترة، ثم أجد طريقي وأنسى. لكني أجد المطر مدخلا جيدا لأسبوع انقضى في برلين تحت سماء غائمة. هذا بالتأكيد في نظر كل من يصادفه حظ سيء والجميع يبدأون كلامهم بالقول أن الأمر لم يكن هكذا قبل يومين. كأنهم بهذا يعتذرون عن الطقس أو أنها تعويذة لاستعادة الصحو. إذا لم تدرك أن في الأمر سوءا تكفل محدثك بإبلاغك ذلك، ثم أن الامتحان الأكبر الذي لا مفر لك منه هو أن هؤلاء الذين لا يزالون منذ تسعة اشهر يتبعون الرسالة بالرسالة عن مهرجان بوتسدام الشعري في برلين يعلقون كل شيء في اليوم الموعود على الطقس. لا لأن الطقس يزن في كل مناسبة فحسب، بل لأن المهرجان الصيفي ينعقد منذ ثلاث سنوات في الهواء الطلق وتحت السماء، وبديهي أن الطقس يتحكم في نجاحه وعدد روّاده. كان كل شيء يوحي أننا سنصل في الموعد مع المطر والريح والبرد، وهذا بالتأكيد حظ سيء للمهرجان ولي وللمنظمين، ولا بأس من أن أتحمل قسطا من المسؤولية وأن اشعر في قرارتي بأني لم أحمل معي طقسا جيدا.

(ميشائيل كليبيرغ تحت النصب الروسي) |
لا تمطر كل يوم، بالطبع لكني لا احتاج إلى مطر لأشعر أنني متسكع مهما تعددت زياراتي ومهما طالت. متسكع لأن هذه الشوارع الطويلة للغاية هي تقريبا مكاني هنا ولأن المشي على غير هدى هو ما افعله، يبدو الجلوس فوق في الغرفة وترك المدينة وحدها تعج بالحياة قتلا للوقت وتخليا عن الرحلة. ما زلت أظن أن كل مهرجان أو مؤتمر في مدينة هو حجة لزيارة المدينة. وأن المهم أن نوجد هنا أكثر مما نستطيع في الشوارع التي لا نعرف إلى أين تفضي ومتى نتوقف فيها. انه هدر ثمين للوقت إذا أننا نعرف هذه المرة أن ليس علينا إلا أن ندور هنا وأن نرى وأن نتوقف أمام الواجهات ونتردد مئة مرة قبل أن نتعب من أنفسنا ونقرر أن نجلس في مطعم أو مقهى، التسكع هو كل ما تعطيه لنا مدينة أخرى. انه طابع وجودنا فيها، ليس طابع غربتنا فيها فقط ولكن أيضا انضواءنا معا في لحظة عابرة ليس لها ماض ولا مستقبل. لحظة بدون قصد ولا غرض ولا عمق. إنها فقط الحاضر الخفيف الذي يتبخر قليلا قليلا في شمس النهار. شبكات الطرق وأنفاق القطارات ومسارات الباصات، إنها موجودة هنا لتتلقى وجودنا الصغير المار. لتحمله بدون ثقل، وتدفعه في مدارات صامتة، لنلتف عليه أو نأخذه إليها، لكنها أيضا حركة تبقيك في الطريق، من حيث جئت، ومن حيث ستعود كأنك دائما في انتقال.
لا لأنك لا تعرف اللغة فحسب بل لأن المدن التي نزورها، المدن وحدها، يمكن أن تكون مضيعة كاملة والأرجح أننا لا نحسن تفادي ذلك عن قصد. وأن للتيه والدوران والمشي على غير هدى متعة غير مشكورة. بل لعلنا نتآمر على أنفسنا ونحن ننزلق هنا خارج الخط ونتوغل في ذلك خطوة على خطوة. الأرجح أن هذه تقريبا رواية السفر، وبدونها لن نجد ما نرويه، إننا نخرج في النهاية من كمائن الطرق ونعود بمعجزة صغيرة ما إلى الجادة.
كان يوم المهرجان ماطرا كما توقع الجميع. أقيم مع ذلك في الشارع وتحت السماء سرادق طويل ونصبت أمامه منصة بيضاء احتضنها تجويف ابيض يشبه العش. وأمامه درج معدني كدرج الطائرات. لا اعرف من رسم المنصة. لكن بياضها بدا في الطقس الماطر البارد جنائزيا إلى حد. والأرجح أن زهرته الناصعة كانت قابلة لاتساخ شبه مهين. سبق القراءة حفل استقبال من شركة مرسيدس راعية المهرجان. كنا في الأعلى بين الكؤوس وصحون الفاكهة وشراذم الواقفين ثم نزلنا من حالق تقريبا إلى عراء الشارع والجو المهلهل والمقبض. كان المكان وسط بنايات زجاجية ومقاه محيطة والحق انه امتلأ وفاض. لقد جاء الناس بالمئات ككل عام، ربما حضروا بالآلاف في طقس أفضل. الهواء البارد والزخات المفاجئة بدت من دون تأثير. كان بإمكان الشعر أن يسمع وأن يصل بلا اكتراث لشيء. انه أيضا صبر المدن. الصبر الذي قد يكون في حقيقته ابن الطقس المخادع دائما.
عندما أخذتني ماري كلود سعيد إلى ساحة بوتسدام قالت لي أن هناك جدلا ألمانيا حولها. ولم يفتها أن تقول انه شبيه بالجدل الذي لا يزال يدور هنا حول وسط بيروت. لم يكن ميشائيل كليبرغ الذي لم يعش في حياته مرحلة يسارية بحاجة إلى ماض كهذا ليبدي اعتراضه على الساحة. الأرجح أن هناك نوازع يسارية وألمانية وربما فنية وأخلاقية تدعو كثيرين إلى احتجاج مماثل. اذكر أن سائقا أوصلني إلى هناك صادف انه يعرف الفرنسية قال (إنها حداثة بلا قلب)، لكن الحداثة وما بعدها لا يملكان علم القلوب هذا. ولا نعرف بسهولة كيف تحضر القلوب في معمار أو ساحة أو سوق.
أما الساحة نفسها فأشبه ما يكون ماضيها ماض بوسط بيروت. إنها في الوسط بين البرلينين حين كانت هناك برلينان. أي أنها عاقبة تلك الحرب المعلنة من دون أن تقوم بين الألمانيتين. أنها خطوط الهدنة كما تسمّى أو المنطقة المعزولة من السلاح. تركت الساحة مهجورة بورا. ثم لما انتهت الحرب والانقسام سارعت شركة سوني إلى استغلالها، وقيل أنها تسلمتها بثمن بخس نسبيا، إذ أن سياسة الحكومة كانت دائما قبل الوحدة وبعدها تشجيع إعمار برلين والاستثمار والسكن فيها، وقدمت في سبيل ذلك تسهيلات ومساعدات وإعفاءات من الخدمة العسكرية ومن ضرائب كثيرة وحتى قيل أن برلين عاشت على الإعانات والمساعدات وهي الآن لا تتحمل إلغاءها. ليست برلين إلى الآن مدينة صناعية ولا هي مدينة أعمال، وإذا رحبت الدولة باستثمار سوني اليابانية للساحة فضمن خطة رامية إلى إعادة تأهيل المدينة بعد الوحدة. لم تنجح الخطة ولا تزال معظم المشاريع فنادق ومطاعم وحوانيت وسوبر ماركات وتظاهرات ثقافية. انتهت الحرب وانتهت التجزئة ولم يعد لبرلين خصوصية وطنية ولم تعد امتيازاتها مقبولة من المدن الألمانية الأخرى التي لا تمانع في أن تنظر بإشفاق وربما بشيء من النكاية للعاصمة التي هي أفقر مدن ألمانيا والكبرى ولا تستطيع أن تسير في سويتها.
ماذا فعلت سوني سنتر. أدخلت تظاهرة عمرانية ما بعد حديثة إلى الساحة المهجورة. ليس هذا بالطبع أول بناء من الزجاج والمعدن في برلين، لكننا أمام مستعمرة عمرانية من هذا النوع. المباني الزجاجية تنهض شاهقة رقيقة منحنية ومائلة في نوع من لعبة توازن مستمرة لكنها أيضاً متعامدة مصطفة فيما يشبه دائرة تقوم فوقها مظلة هائلة قصديرية تسقط منها على نحو مائل مرساة ضخمة. لسنا أمام مبنى بل أمام تشكيلة بل أمام وكر ما بعد حداثي نشعر حياله أننا في ما يشبه الاستديو السينمائي لواحد من أفلام الخيال العلمي المحبوكة حول اختراق الزمن. الأرجح أننا داخل هذه الساحة الصغيرة تحت المظلة في واحد من محطات المستقبل، المستقبل الخالص المقطوع عن كل زمن، الخالي من أي ذاكرة، المستقبل الشبيه بمستعمرة فضائية في مكان وزمان مجهولين.
ليست هذه كل ساحة بوتسدام. خارج هذا الوكر الصناعي تقوم مبان مدهشة. ثمة هذا البناء القرميدي الذي هو في مكعباته غير المنتظمة وأعاليه غير المتساوية فتنة للقرميد الأحمر قلما نجد لها مثيلاً. هناك البناء الزجاجي الرقيق الشفاف الذي ينتهي بما يشبه حد السيف وهذا البناء الذي يتفتح كزهرة نيلوفر. إذ أن استفزاز ما بعد الحداثة ليس وحده هنا، هناك أيضاً شعريتها وجمالياتها، هناك شفافية الزجاج وتخطيطية المعدن، وهناك النور والخفة والمشاقة، والجسور الرقيقة. يمكننا هنا أن نتحدث بحق عن رقة وأناقة. بل إن هذه الأناقة التي لا تتوفر إلا قليلاً في فنون ما بعد الحداثة تثير الريب في ما نراه، وفي ماهيته ما بعد الحداثية، بل تشعرنا أحياناً بقلق تجاه هذه الهارمونيا والتناسب. إذ لا يبعد أننا أمام خداع بصري، أو أمام لعبة جمال فارغة. فالإغراء الأكيد هنا مريب. ونادراً ما لا نخاف من فتنة كهذه لا يبعد أن (مصالحة) خفية قامت وربما ردة غير منظورة والمهم أن جماليات هذا الفن تأسرنا لدرجة تزعجنا من أنفسنا.
يقال في ساحة بوتسدام ما قد يقال مثله في وسط بيروت، أنها قبل كل شيء جرح في الذاكرة، إذا سأل رهيف فياض عن سوق أياس ومعالم كثيرة أزيلت من وسط المدينة لأسباب سياحية فإن ساحة بوتسدام تملك هي الأخرى ذاكرة ما قبل الانقسام. ما فعلته شركة سوني هو أنها نقلت إلى هنا زمنها الخاص الافتراضي، زمن الخيال المستقبلي. لا أعرف أي قلب افتقده السائق الذي نقلني إلى ساحة بوتسدام. هو قلب ألماني برليني وجد في ما فعلته سوني عن غير وعي جناية يابانية. لم يتكلم أحد بلغة كهذه، فالألمان حذرون للغاية من الاقتراب من حدود مثلها. لكن صديقاً ألمانيا واحداً على الأقل أشار من بعيد (للثمن البخس). هناك في الغالب من أقحموا أنفسهم في مسألة ألمانية ولعبوا، بهذا المعنى، بالذاكرة الألمانية. ربما لا نجد رضا لأن يحمل قلب برليني شعاراً يابانياً. ربما لأن شكل المستعمرة المنقطعة في وسط المدينة يستفز. يقال في ساحة بوتسدام ما يقال في وسط بيروت. لقد تحول وسط المدينة إلى منطقة سياحية، غدا هامشاً متأنقاً معنوياً لكن ليس أكثر من مدينة ملاهي. ليست ألمانيا بلداً متصالحاً مع ذاكرته لكن الألمان لم يرحبوا كثيراً بهذا التطهر التاريخي المستقبلي، الأرجح أنهم انتظروا في المكان الذي هو ساحة الانقسام رمزاً آخر.
كتبت أثناء إقامتي في برلين (يوميات برلينية) التي هي مذكرات سفرية إذا جاز
التعبير ومن جملتها واحدة عن ساحة بوتسدام، ومن هذه القصيدة:
الأبطال لا يولدون من أمهاتهم في ساحة بوتسدام
والجريمة بلا أسنان في ساحة بوتسدام
سيكون المستقبل بلا ذنب ولا آلهة ولا موتى في ساحة بوتسدام.
نتألم بدون أحساس في ساحة بوتسدام
نتكلم بلا لغة في ساحة بوتسدام
السعادة بائع في ساحة بوتسدام
الكراهية بلا شوكة في ساحة بوتسدام
والحب لا يؤذي في ساحة بوتسدام
الأشياء لا تترك بقايا في ساحة بوتسدام
كلاب الجحيم لا تعوي في ساحة بوتسدام
الأبطال لا يولدون من أمهاتهم في ساحة بوتسدام
الرعب ملاك في ساحة بوتسدام
في هذه الأبيات (هل يصح أن نسميها أبياتاً) رؤيا مستقبلية بكل رعبها وانفصالها.
لكن لجنة المهرجان قررت أن تنحي القصيدة بعد ترجمتها إلى الألمانية. لم يحسن أحد أعضاء اللجنة وهو شاعر في أن يفسر لي سبب ذلك. ولم تكن المترجمة الفرنسية أوسع فهماً مني لما قاله، قال إن القصيدة باختصار تحك في موضع سيء وتبعث أموراً راقدة لم أدرِ إذا كانت في الماضي النازي أو في الحاضر والسجال الراهن حول الساحة. كل ما فهمته أن اللجنة استحسنت أن (تبعد الشر) وأن لا تعرض المهرجان لمساءلة مزعجة. مع من، لا أدري؟.
كان حضور غونزالو روخاس حدث المهرجان، فروخاس رفيق نيرودا وزميله في المنفى والشاعر الذي أدرك برتون وتزارا هو اكبر شاعر تشيلي حي وواحد من كبار شعراء العالم. اعتذر روخاس عن دعوات سابقة إلى ألمانيا لذا كان مفاجئا أن يحمل أعوامه الستة والثمانين إلى ساحة بوتسدام. كم أشبه روخاس زميله نيرودا وهو يصعد إلى المنصة البيضاء مسنوداً إلى ذراع احدهم وعلى رأسه كاسكيت نيرودا الشهيرة، أشبهه بالهيئة والحجم والطلعة وأشبهه حين استقر على المنبر بالإنشاد القوي والمعبّر والهازل أحيانا. كنا نراه يقرأ شعور بأننا إحدى القامات الأسطورية لشاعر. أو أن هذا هو (الشاعر) هنري شوبان الفرنسي مولود 1922، في الواحدة والثمانين وتعب العمر بل وبؤسه على ملامحه وجسده الذي ينتقل على كرسي بعجلات، نحيل مبري الجسد والوجه والشفتين. عينان غائرتان لامعتان وخدان معظمان والوجه بالخلاصة ذابل وممصوص، حمل شوبان الذي لا اعرف له اسما من قبل في محفة إلى المنصة واجلس على كرسي قبالة المنبر ثم اتبع بآلة نصبت قبالته على المنبر ولم يفعل شوبان سوى أن أدار الجهاز وصعد منه فورا أصوات من كل نوع، أصوات بلا كلمات لكنها بتعابير ومعان تكاد تفصح وتبين، وشوبان على كرسيه يتابع الأصوات بوجهه وملامحه يمنحها بتعابيره وإماراته معانيها الخفية تلك. الأصوات ليست بشرية فحسب ولكنها مجموعة من الطبيعة أيضا وهي أحيانا مصحوبة بموسيقى. وجه شوبان الذابل الممصوص تحول فجأة حيا ناطقا عارما بالأمارات والصور والإيماءات والإشارات. لنقل أن الرجل الذي ولد 1922 لا بد من أن يكون رائداً في هذا الضرب من القصيدة الصوتية كما تسمى، ولا بد انه توصل إلى ما وصله بتأن وتدريب طويل وموهبة.
اجتذب عرض شوبان، لنسمه عرضا، الجمهور بالتأكيد فهذه قطعة مسرحية محكمة وبين لعبة الأصوات وأداء الوجه تناسب وتناغم ملحوظان، وعرض شوبان للسمع والبصر في آن معا فهو فرجة بحق. ليس مهما أن نسميه شعرا أو لا نسميه فإثبات شيء في الشعر أصعب من نفيه منه، وتحديد الشعر وتعريفه ورطة. في كل مهرجان شعري اليوم واحد كشوبان. واحد فحسب ولا حاجة إلى أكثر، انه لتطرية المهرجان وتنويعه وغالبا ما ينجح في ذلك لكن المهرجان لا يتسع لاثنين من صنفه فهو نوع من فاصل مسرحي يشبه الفواصل الموسيقية التي تحضر للسبب نفسه، أي انه تسلية المهرجان وربما جاز أن نقول مهرجه. في هذا ظلم لعمل لو حضر في أبانه لوجد لنفسه مكانا أكيدا. انه دائما ومهما كان أثره هامش في المهرجان. مع ذلك فهو يكسف الشعر الذي لا قوة له على منافسته، الشعر فن قصير المهجة ولا يسلي إلا في حدود صعبة وقلما تبلغ، الأرجح أن لعب شوبان يحشر الشعر ويحرجه ويطلب منه قدرا من الابتذال والمباشرة، يطلب منه أن يكون عرضا ككل عرض وإذا جاز ذلك غدت قوته في تصريحه وأدائه وتبخر سره وخصوصيته. لنقل أن هذا محرج جدا ويطرح سؤالا عن فائدة المهرجانات الشعرية التي قامت أساسا لإنعاش الشعر. أفلا يبدو هذا (تحديدا) للشعر وقسرا له على التبسيط والعلنية، فيخسر نفسه من حيث يحب أن يربح حياة ثانية أو يعود إلى الحياة. ما فائدة المهرجانات إذا اقترعت في النهاية لشعر ميسور وحجرت على مستويات أخرى من الشعر. إنها تضع الشعر أمام أزمته لكن بثمن قد يكون باهظا، وقد يكون الأمر في جملته عبثيا بلا جدوى.
إسماعيل كاداره وحق الحياة
(إسماعيل كاداره)
لم يكن إسماعيل كاداره بجسده، الصغير ونظارتيه المدورتين وجاكيتته التي بلون القش سوى رجل صغير آخر، مع ذلك ضاع في المطار وهتفت لي اوديل إنها لا تقدر على حضور ندوتي (الشاعر والنبي) لأنها تبحث عنه، لم يلبث كاداره أن ظهر على الطائرة التالية القادمة من باريس وحضرت اوديل متأخرة، رافقت كاداره إلى ندوته في السيارة وكان مهتما أكثر بالاستدلال على المعالم التي نصادفها في طريقنا من الحديث عن اللغة الألبانية. على المنصة ظهر أن صوت كاداره القوي وتوفزه العصبي أكثر مما يلوح على الرجل الصغير. كانت المرة الأولى التي اعرف فيها كاداره الشاعر وكنت أظن أن الشعر هامش في نتاجه الروائي أساسا لكن فهمت من الألباني الذي ناقشه انه معروف بين ابرز الشعراء الألبان وانه بدأ شاعرا وتأخر حتى باشر الرواية، وان بين شعره وروايته حبلا ممدودا. بل علمت أن بعض روايته (قصر الأحلام) مثلا تحول عن قصائد. حضرت البانيات جميلات ندوة أديب الألبان الأول الذي كان حضوره فيما يبدو عيدا صغيرا للجالية. ناقشه الباني قادر حاضر وقد ظهر عليه أنه يلعب بالألبانية والألمانية على قدر سواء، وأجاب كاداره بقوة وفهم وعصبية وغضب مغلول أحيانا. قال أن تحول من الشعر إلى الرواية لأنه فطن إلى أن هذا هو عصر الرواية، لقد نجحت الرواية في امتصاص كل عناصر التراجيديا وستعيش 2000 سنة مثلها. قال انه بدأ شاعرا وهو شاعر في الأصل ولم يكن ليكتب روايات لولا أنها مسبوقة بالشعر. بعض رواياته قصائد متحولة، بعض قصائده غدت روايات، لا حدود بين شعره ورواياته، انه يكتبها جميعا بالطاقة نفسها.
السؤال الأبرز على كاداره كان لا بد أن يأتي. كاداره معجزة في أمر لم يسبق إليه. لقد عاش في ظل نظام أنور خوجا الستاليني واستطاع أن يساير النظام، بل كان في بعض الأحيان شيوعيا في الحزب وأحسب أنه اختير عرضا ولفترة سريعة للجنة المركزية، كانت بينه وبين أنور خوجا صلة خاصة حمته في الغالب ويسرت له أن يكتب تحت وطأة النظام الحديدي أدبا حرا ناضجا، وغير مرهون بغايات دعائية أو تحريضية، بل إن في رواياته التي كتبها في ظل حكم خوجا رؤى ساخرة ونقدية للتاريخ والسياسة خفيت على الرقابة الثقافية بل حظيت بتأويل آخر. كان إسماعيل كاداره محظوظا في ذلك كله، لقد استطاع أن يكتب ما يريده تقريبا. طبعا بقدر من الاحتياط والحرص، لكنه مع ذلك كتب أدبا قويا احتفظ بكل زهرته بل وبكل التباسه وتعدده، من دون أن يقدم تنازلات باهظة ومن دون وهذا الغريب أن يتعرض هو لعسف النظام وقسوته. أما الركن الثالث في معجزة إسماعيل كاداره فهو أن هذا الأدب لأديب غير منشق وبلغة أوروبية ثانوية وصل إلى القراء الغربيين وغدا إسم كاداره وهو في ألبانيا خوجا معروفا في الغرب والعالم. لا يعلم كاداره أنه مترجم من 30 عاما تقريبا إلى العربية، لكن وصلته في يوم رزمة من ترجمات بالعربية بلا رسالة مرفقة ولم يعلم أي رواياته المترجم فيها، لنقل أنه لم يسأل أيضا.
السؤال المطروح دائما على أنور خوجا يتعلق بهذه المعجزة التي يحسبها كثيرون صفقة قد تكون مريبة أو ملغومة. لماذا ساير النظام لماذا لم يكن منشقا؟. يسأله كثيرون ذلك وفي بالهم أرتال المنشقين من أدباء الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية. جواب كاداره حاسم، يقول في البدء... الجواب سهل وكأنه بذلك يقلب الطاولة على الذين يحسبون أنهم يحرجونه. الجواب سهل، لم يكن في عهد النظام الستاليني السوفياتي منشقون، إذ لم يكن ستالين يعطي معارضيه فسحة لينشقوا، المعارضون حين يشتبه أمرهم يعدمون فورا، القتل هو الذي ينتظر المعارض لا السجن. نظام خوجا لم يكن مجرد نظام شيوعي في أوروبا. إنه نظام ستاليني والمعارض فيه لا ينتظر أكثر من 3 دقائق ليغدو في القبر، لم يكن هناك أي خيار آخر ممكن. بالطبع لم تكن الكتابة المعارضة خيارا ممكنا، لربما كان الخيار الوحيد هو الانتحار. إلق بنفسك من النافذة. هذه حريتك الوحيدة، ولا حظ لك في أن تفعل شيئا آخر ضد النظام. سؤال لماذا لم تكن منشقا هو أشبه بسؤال لماذا لم تمت، لم يتكلم أحد علنا ضد النظام فالمعارض الحقيقي في وقت كهذا كان المعارض الميت.
يتكلمون عن الحرية. وكأن من غير الممكن أن يكتب أدب كبير بدونها. ليس الرهان هنا، إنه في أن تكتب أدبا جيدا وطبيعيا تحت الاستبداد، لماذا لا ننسى أن كل المؤلفات الكبرى كتبت في ظل الاستبداد. لماذا تبقى هذه إذا كان الاستبداد لا يمكن من الخلق، لماذا نرى أن أفضل الأدب الألباني كتب تحت الاستبداد ولماذا نستمر في قراءته، لماذا نواصل نشره اليوم. لأنه جميل وطبيعي، لأنها كتب جميلة وطبيعية كتبت تحت نظم غير طبيعية. المقاومة الوحيدة ضد استبداد كهذا هو أن تبقى طبيعيا، لم أكن منشقا وأقولها بملء الفم، لم أكن منشقا، لكني اجتهدت في أن أكتب أدبا طبيعيا وهذا هو الأهم، كانت الأسئلة تتفرع من السؤال الأول والجواب يتواصل، علينا أن نكتب أدبا طبيعيا، أدبا طبيعيا. كان الجو فظيعا تلك الآونة، هناك الرعب والتهديد لكن ما كان في وسع النظام أن يجبر أحدا على كتابة أدب رديء. كان في وسعه أن يبتز من الكتاب بعض القصائد الرديئة، هذا صحيح لكن لا تنسى أن الحزب الشيوعي الألباني كان ألبانياً ووطنيا، هذه النزعة كان يمكن أن تساعد في حماية الأدب. في الخارج كانوا يفسرون كل شيء بالقرار الحزبي، لكن الأدب يهرب من هذا التأويل الوحيد، ثمة كتب كانت تمنع، منع (قصر الأحلام) والمنع كان بحد ذاته حدثا لا يحلم به كاتب، انه أمر أشبه بهزة أرضية، فالكتاب الذي يمنع يطلب من الجميع، ويجري الكلام عنه في كل مكان، يقرأ في السر أكثر بكثير مما تقرأ الكتب في العلن، المهم أن تصنع أدبا جيدا.
استطرادا وربما من الجهة المعاكسة يتابع كاداره كلامه. الأدب يتطور ويتابع سيره لكن لا تبعا لحسابات البعض. ظن كثيرون أن تغيير النظام سينعش الأدب، الأدب لا يطور هكذا، فهو ليس حصيلة تطورات سياسية فحسب، لا أظن أن الأديب ينبغي أن يعامل دائما كسفير لبلده وثمة خطر في أن يعتبر الأدب بديلا عن التاريخ والسياسة في بعض الظروف، مع ذلك فإن ثمة أوقاتا ينحني فيها الأديب للظرف ويكتب تحت إلحاح ما. ماركيز كتب قصة واقعية لينقل رسالة بلده ومن الممكن أن نكتب أحيانا لننقل رسالة مماثلة. أدباء كوسوفو شطوا كثيرا، لجأ إلى صيغ متحذلقة ومفرطة في ما بعد حداثيتها، أنا نددت بذلك، لكنهم الآن في وضع أفضل ويفهمون الأمر أحسن من ذي قبل.
حين صعد كاداره إلى المنصة، ألقى بقوة وبحدة، ألقى باحتراف، ولم يبد عليه ضيق بجلسته أو بقراءته، بعد المهرجان التقى أكثرنا على عشاء، كان كاداره في مواجهتي وجنبي في مقابله تماما صبية ثلاثينية جميلة. كاداره يكلمها بالألبانية وهي تحاول بصعوبة أن تعبر بالفرنسية، قال كاداره إنها زوجة سابقة لدبلوماسي وكتبت رواية وحيدة تصف فيها العالم الايروسي للدبلوماسيين. كلمت كاداره عن رواياته التي أعرفها، قلت له أن قصر الأحلام نص علني ضد التوتاليتارية وان حتى في طبول المطر التي تبدو رواية وطنية تهكما صريحا من السلطة ومثقفي السلطة. استمع وأظن أن شيئا ما راقه في هذا الكلام. أعتذر لأن الوقت لم يتسع لحديث صحفي كنا اتفقنا عليه. خرج كاداره مع الصبية وفي الصباح حين صعدت إلى الطابق الثامن للإفطار رأيتهما يدخلان معا ويتوجهان إلى طاولة من طاولات المطعم.
لا أدري كيف احتجبت هذه الحديقة الهائلة وغارت في عمق برلين الشرقية، ولا أحسب أن في الامكان مواراة شيء بهذا المدى إلا في مدينة برلين. لم نصل بسهولة وظل ميشائيل يحك ذاكرته ويسأل، انتقلنا مرتين في أطراف خالية نسبيا قبل أن نصل إلى الحديقة التي رفع فيها في الأربعينيات النصب التذكاري للجيش الروسي الغازي في برلين. كانت هذه فكرة ميشائيل، لم ير النصب من قبل ويريدني أن أراه معه، إنها نظرة بعيدة إلى الخلف، إلى الضواحي المنسية للتاريخ. فما نبحث عنه أثر لا يزال يحمل توقيع جوزف ستالين الذي سقط قبل أن تسقط الشيوعية، اثر عرف نفيا مزدوجا وطرد على دفعتين. ربما لذلك لم نستغرب أن يغدو شبه مجهول في مكانه ومدينته. لقد ابتعد أكثر مما تصل ذاكرتنا الحالية، لا شك أن كثيرين شهدوا دخول الجيش الروسي وهذه اللحظة مفصلية بالنسبة لقاطني ألمانيا الشرقية، لكنها أيضا مطمورة تحت تراكماتها. لم يفاجئنا أن لا نعثر على الحديقة والنصب وأن يبدو للحظة أنهما اختفيا، فهذه زيارة إلى التاريخ ولا عجب أن تختفي فيه معالم ومواقع. كنا نبحث عن مكان لم يعد لأحد، ولا أعرف ماذا كنا ننتظر؟ ننتظر على الأقل أن نجد أثرا حيا لمرور الزمن، أن نجد مكانا شائخا على الأقل، أن نراه مهجورا أو متآكلا أو ركيكا. حين أشرفنا من على عاملين مشغولين في ارض الحديقة راودني إحساس من يشاهد حراس المقبرة. لم ينظرا إلينا ولم نحسب لهما حسابا وكأنهما أيضا من الذاكرة، رأينا شبكا ممدودا فخلنا أن المكان مسدود لكننا وجدنا فيها فسحة دخلنا منها، سرنا أمام اللوحات المنقوشة التي تروي حكاية الجندي الروسي بحرفية عالية تباري الفكرة الساذجة والشعبية. الجندي يخرج من لدن أهله الماثلين لوداعه، الجندي في المعركة منتصبا مشدودا، الجندي شهيدا وجثمانه مديد يملأ أسفل اللوحة. تقدمنا في الساحة المديدة المستطيلة المغطاة بالعشب وبدأ النصب العظيم يتراءى أقرب لنا، كان شاهقا منصوبا فوق قاعدة تتدرج السلالم الحجرية إلى قمتها. صعدت بقدر من رهبة، صفا من الدرجات، ثم صفا آخر، وجدتني تحت النصب مباشرة وكان علي أن أبتعد قليلا لأراه. كان جنديا هائلا يحمل، لا أدري لماذا، سيفا، نعم سيفا يغرسه في شكل ملتو تميزنا فيه صليبا نازيا معقوفا تحت قدميه، كان هذا متحولا عن أصل معروف. صورة مار جرجس التقليدية وهو يطعن التنين، تحويل بسيط وحرفي للأسطورة الدينية. تحت النصب ما يشبه الكهف الذي أضيئت في جنباته جدارية عملاقة تمثل الشعوب الروسية. كان مار جرجس الشيوعي لا يزال يطعن في الصليب النازي ولم تستطع هيبة التمثال أن تغطي على شعورنا بركاكة الفكرة، بدت الضخامة كاريكاتورية إلى حد. في الجهة المقابلة رأينا أيضا لوحات، ذات نقوش كلامية والتوقيع بارز واضح هذه المرة: جوزف ستالين، جوزف ستالين منتصرا بعد الحرب العالمية الثانية. كان أمامي أثر ستاليني لم يزل سليما متكاملا لم يتعرض له أحد، لا زالوا يسقون العشب في أرض الحديقة ويقصونه، لا يزال كل شيء نديا لماعا. تبدو الأشجار حوالي الفسحات المستطيلة هائلة ضخمة غابية.. وجليلة. الحديقة التذكارية صممت من دون شك بمخيلة احتفالية. ومن الصعب أن نجد حديقة هي أيضا فكرة مجسدة عن النظام وعن الجلال، بل هي إلى حد ما صورة للنصر وللمعركة الصامتة وللجيش الغازي. كان هذا أثرا ستالينيا وسليما متكاملا حيا لا يزال في شبابه. بدد جلال الحديقة الأثر الركيك للنصب، كان علينا أن نسمع جوزف ستالين يتكلم في أدغال الذاكرة الألمانية.
السفير- 2003/07/18