 منذ وقت لم يطل. كان آخر حديث تليفوني لخيري شلبي مع إبراهيم أصلان. بعد هذا الحديث وصل إلى إبراهيم أصلان خبر خيري فذهب وأغرق جسد خيري بدموعه. ليت الدموع تسعفنا بعد أن وصل إلينا خبر إبراهيم. ليت الدموع تتحنن علينا. إذا كان للوداعة واللطف والأريحية اسم آخر سيكون إبراهيم أصلان، كلما ذكرنا مصر ذكرناه معها. كان مهدداً منذ وقت لكننا حسبنا أن الموت نسيه وأن غفلته عنه ربما تطول. لم يكترث الموت للعبتنا وغفلتنا وجاء قبل أوانه. قبل أوانه بالتأكيد فإبراهيم أصلان كان بكلمة واحدة حيا حتى آخر نفس فيه، صوته وسيجارته وحركات يديه زاخرة بالحياة، لم يكتب كثيراً إبراهيم أصلان، أمضى حياته كما قال وهو مرعوب من الكتابة. لكنه كان مثل قصة دائمة. لكم أشبه أدبه، الدقة والطرافة والشاعرية والصدق كانت تجمعه به. كان يعرف الأدب لدرجة ان يندمج فيه، كان يعرفه إلى حد أن يكونه. تسمعه يتكلم فتظن انك أمام قطعة من كتابته. لم يكتب كثيراً مع ذلك، لقد كتب بأنفاسه ونبضه وفنائه في الكتابة ومن هو كذلك لا يهتم بالكمية بل لا يعيرها التفاتاً، لم يكتب كثيراً مع ذلك فإن كثيرين، كثيرين جداً يرونه أكبر كتاب جيله، كثيرين مثله لم يعطوا اعتباراً للكمية، من كتب «مالك الحزين» و«عصافير النيل» و«وردية ليل» لا يحتاج إلى أكثر. كان إبراهيم أصلان، ربما، الكاتب المحبوب أكثر في الوسط الأدبي كله، المحبوب أكثر بالتأكيد، يعود ذلك إلى احترام عميق لتجربته قلما حظي بها كاتب، كما يعود أيضاً إلى أخلاقه، إلى ترفعه وأنفته وبعده عن المشاحنات الأدبية، بعده عن المنافسات العقيمة واحترامه الكبير لكلمته وأريحيته وقلبه الكبير العامر بالحب، كان محبوباً أكثر لقدرته الهائلة على ان يحب. يصعب ان نجد في الوسط الأدبي شخصاً بهذا الخلق. شخصاً احترم الأدب والكلمة لدرجة أن لا يبتذلهما، ان لا يتناتشهما، ان لا ينازع عليهما، كان مع ذلك ذا أصابع ذهبية. يكتب خبراً فتراه يتألق في مكانه. يكتب يوميات فتشع، يكتب أي شيء فتعرف انك أمام تحفة صغيرة. مع خيري شلبي وإبراهيم أصلان اللذين لحقا بعضهما إلى الغياب يتزعزع جيل الستينيات، نشعر أن تجربة كبيرة بدأت تطوى.
منذ وقت لم يطل. كان آخر حديث تليفوني لخيري شلبي مع إبراهيم أصلان. بعد هذا الحديث وصل إلى إبراهيم أصلان خبر خيري فذهب وأغرق جسد خيري بدموعه. ليت الدموع تسعفنا بعد أن وصل إلينا خبر إبراهيم. ليت الدموع تتحنن علينا. إذا كان للوداعة واللطف والأريحية اسم آخر سيكون إبراهيم أصلان، كلما ذكرنا مصر ذكرناه معها. كان مهدداً منذ وقت لكننا حسبنا أن الموت نسيه وأن غفلته عنه ربما تطول. لم يكترث الموت للعبتنا وغفلتنا وجاء قبل أوانه. قبل أوانه بالتأكيد فإبراهيم أصلان كان بكلمة واحدة حيا حتى آخر نفس فيه، صوته وسيجارته وحركات يديه زاخرة بالحياة، لم يكتب كثيراً إبراهيم أصلان، أمضى حياته كما قال وهو مرعوب من الكتابة. لكنه كان مثل قصة دائمة. لكم أشبه أدبه، الدقة والطرافة والشاعرية والصدق كانت تجمعه به. كان يعرف الأدب لدرجة ان يندمج فيه، كان يعرفه إلى حد أن يكونه. تسمعه يتكلم فتظن انك أمام قطعة من كتابته. لم يكتب كثيراً مع ذلك، لقد كتب بأنفاسه ونبضه وفنائه في الكتابة ومن هو كذلك لا يهتم بالكمية بل لا يعيرها التفاتاً، لم يكتب كثيراً مع ذلك فإن كثيرين، كثيرين جداً يرونه أكبر كتاب جيله، كثيرين مثله لم يعطوا اعتباراً للكمية، من كتب «مالك الحزين» و«عصافير النيل» و«وردية ليل» لا يحتاج إلى أكثر. كان إبراهيم أصلان، ربما، الكاتب المحبوب أكثر في الوسط الأدبي كله، المحبوب أكثر بالتأكيد، يعود ذلك إلى احترام عميق لتجربته قلما حظي بها كاتب، كما يعود أيضاً إلى أخلاقه، إلى ترفعه وأنفته وبعده عن المشاحنات الأدبية، بعده عن المنافسات العقيمة واحترامه الكبير لكلمته وأريحيته وقلبه الكبير العامر بالحب، كان محبوباً أكثر لقدرته الهائلة على ان يحب. يصعب ان نجد في الوسط الأدبي شخصاً بهذا الخلق. شخصاً احترم الأدب والكلمة لدرجة أن لا يبتذلهما، ان لا يتناتشهما، ان لا ينازع عليهما، كان مع ذلك ذا أصابع ذهبية. يكتب خبراً فتراه يتألق في مكانه. يكتب يوميات فتشع، يكتب أي شيء فتعرف انك أمام تحفة صغيرة. مع خيري شلبي وإبراهيم أصلان اللذين لحقا بعضهما إلى الغياب يتزعزع جيل الستينيات، نشعر أن تجربة كبيرة بدأت تطوى.
هكذا نجد أنفسنا أمام التاريخ الأدبي، أمام صفحة رائعة بدأت تدخل في التاريخ. ربما يحرّض هذا مؤرخي الأدب والنقاد على أن يبذلوا جهداً أكبر، على أن يجدوا أنفسهم أمام مهمة ملحة. مع ذلك فإننا نخسر إبراهيم لا كاتباً فحسب ولكن إنسانا وصديقاً. بل نخسره مثالاً، أخلاقياً وإنسانياً، ليت الدموع تسعفنا، ليتها تتحنن علينا، ستكون القاهرة العظيمة التي سر إبراهيم أن العمر سمح له بأن يلحق ثورتها، ستكون القاهرة بدون إبراهيم أصلان شاحبة شيئاً ما، ستكون «أمبابه» مكسوفة في قراراتنا وذاكرتنا. عم إبراهيم لن يلعلع بصوته ولن تفرقع ضحكته بعد. عم إبراهيم لن يكتب قصة اخرى.
في معنى أصلان
قبل أكثر من 14 عاماً وأثناء دراستي الجامعية، نشر لي إبراهيم أصلان قصة قصيرة دونما سابق معرفة. عرفت بأمر النشر بالصدفة وبعدها بأسابيع، فذهبت إليه في مكتب جريدة الحياة، حيث كان يعمل للحصول على نسخة من العدد المنشورة فيه قصتي. لا أتذكر الكثير عن تفاصيل هذا اللقاء، لكن ما لن يزول من ذاكرتي هو هذا الانبهار به كحكّاء شفاهي لا يقلّ مهارة عن الكاتب المبدع الذي كانه.
وقتذاك، كان الجميع يتكلم عنه ويعامله كأيقونة لا يجوز المساس بها. في سنتنا الجامعية الأولى، وبينما نجلس على سلم كلية الإعلام ننصت لزميل وهو يقرأ قصة جديدة له، صاح زميل آخر معترضاً: ما هذه المباشرة؟ ألم تقرأ أصلان؟!
نظر إليه صاحب القصة مستفهماً فواصل هو اعتراضه: أصلان لا يكتب أن البطل متوتر، إنما ينقل لك إحساسه بالتوتر من حركة جسده وطريقة سيره والتفاصيل المحيطة به.. إذا أردت الكتابة عليك بقراءته أولاً!
بعدها بأقلّ من عام، نصحني أحد أساتذتي في الجامعة بأن أتدرب يومياً على الكتابة. بعد التأكيد على أنه لا يقدم هذه النصيحة إلا لمن يراهن على موهبتهم، قال: «أصلان نفسه يفعل هذا»!
على هذا النحو، كان أصلان ولا يزال يحظى بتقدير قل أن يناله كاتب مصري حيّ، ربما لهذا فوجئت، في لقائي الأول به، ببساطته وتواضعه وذلك الدفء المغّلّف كل تصرفاته. لم أتكلم معه عن أعماله التي كنت قرأتها كلها، فقط استمعت له وهو يحكي عن طفولته فتتحوّل كلماته على الفور إلى مشاهد وكلمات متحركة أمامي.
في لقائي الأخير به، قبل شهرين تقريباً، كان أصلان بحضوره الآسر نفسه، ولياقته الذهنية وسخريته الدافئة نفسيهما.
قلت له إن جيل الستينيات خسر كاتباً كبيراً. كنت أقصد إبراهيم عبد العاطي الذي قرأت له في «غاليري 68» قصتين قصيرتين تنمان عن موهبة لافتة. ما أن سمع أصلان الاسم حتى لمعت عيناه بفرح حقيقي، وبدأ يحكي عن رفيقهم القديم الموهوب الذي توقف عن الكتابة في بداية مشواره. يتشعب الحديث إلى موضوعات أخرى، لكن أصلان يعود من وقت لآخر لإضافة معلومة عن عبد العاطي مبتهجاً لأن هناك من يتذكره. الابتهاج نفسه الذي يكسو ملامحه حين يحكي عن يحيى حقي أو عبد الحكيم قاسم أو عبد الفتاح الجمل فيبدو كذواقة يقدر الكتابة الجيدة ويحتفي بموهبة الآخرين أكثر منهم.
حين مات خيري شلبي، كان أصلان شديد التأثر، بدا كأنما يرثي نفسه وزمنه. شعرت في ثنايا كلماته أنه أصبح يعيش بإحساس المغادر لا المقيم، ومع هذا كانت الصدمة شديدة حين وصلني خبر موته. أصلان أيضاً يموت؟! كان أول ما خطر ببالي. ذلك أن إبراهيم أصلان من الأشخاص الذين يصلحون كمرادف لكلمة الحياة ومعنى من معانيها. وجوده في مكان ما من العالم يمنح إحساساً بالطمأنينة حتى لو لم نتقابل إلا على فترات متباعدة. أعمال أصلان ستبقى بيننا، ونبرته الخافتة في الكتابة ستظل على ألقها وتأثيرها، لكن الخسارة الفادحة هي في خسارة إنسان نادر وبالغ العذوبة والرقة.
(كاتبة مصرية)
أيقــونــة الصفــاء
في 14 ديسمبر من العام الماضي تُوفي الممثل العجوز أحمد سامي عبد الله، وكان أشهر أدواره هو العم مجاهد بائع الفول في حارة الشيخ حسني، من فيلم الكيت كات، إخراج داود عبد السيد، والمُستلهم بتوسع عن رواية مالك الحزين لإبراهيم أصلان. ولم يُثر موت الرجل الطاعن في السن أكثر من الدهشة الممزوجة بالابتسام إذ كنا قد اعتدنا موته، منذ أن جرّه الشيخ حسني جثةً هامدة، على عربة الفول، في أولى ساعات الصباح في الحارة الصغيرة التي بناها مهندس الديكور أنسي أبو سيف لتأسر أبصارنا في فيلم الكيت كات. مشهد موت العم مجاهد من أشهر مشاهد الفيلم وربما السينما المصرية، لم يقتصر فيه داود عبد السيد على الرمزية البسيطة والمعهودة لموت القيمة، بل حوّله إلى حالة إنسانية فريدة تتجاوز الرمز وتعانقه معاً.
إذا كان العم مجاهد تحوّل إلى أيقونة للموت، فإن وجه إبراهيم أصلان، واسمه نفسه وابتسامته وبالطبع كلامه ونصوصه، قد تحوّل إلى أيقونة أخرى للحياة. لم نلتفت كثيراً لعمليات القلب التي أجراها، فبعض الأيقونات كأنها غير قابلة للموت. هكذا كان رد الفعل مختلفاً عند إعلان موت العم أصلان، الوجوم كلمة والمفاجأة كلمة أخرى، لكن متى كانت الكلمات تحمل العزاء أو تنقل الداخل؟
أيقونة العم أصلان كانت ومازالت - تشعّ في أعين الشباب بدرس البساطة، واختبار الحياة اليومية في أدق وأصغر تجلياتها، والاتكاء على الناس الغلابة في خبراتهم وحواراتهم دون أي نزوع للاتجار بهم وبمواجعهم، بل السخرية أحياناً من تلك الهموم والأشجان. أيقونة العم أصلان تشيح عن القضايا الكبرى وترفض الاستسلام للمقولات الضخمة، مفضلةً عليها التفاصيل الإنسانية الرهيفة والموجعة، من أولى قصصه وحتى آخر مقالاته. بوسع أي متأمل لأيقونة أصلان الأدبية أن يستشف روح الإنسان المتواري وراء تلك السطور، الإنسان البسيط ناصع الرؤية ثاقب النظرة، الذي يعرف كيف يصفي ركام التجربة اليومية ويغربله ويقطره حتى يصل إلى الماسات الصغيرة الجارحة. وتتوطد ثقتك بهذا الإنسان حين تسمع آراءه في الفن والكتابة، وتقرأ مقالاته عن مواقف مرّ بها أو أشخاص عرفهم. كل سطوره تؤكد هذا الحضور الخاص والهادئ، الذي يُضجره الضجيج والضوء. من بين أبناء جيله كان أكثرهم قدرة على استقراء جماليات السينما، دون أن تكون اللغة عنده أداة نفعية للمشاهد والحوار، ودون أن يؤطرها كذلك في صيغ أقرب للقداسة.
في متتالية قصصية قديمة لي، كتبت: «وكان يريد أن يقول لها إنه لا يفهم أصلان، رغم حبه لشغله، لا يعرف هو فؤاد التائه أبداً على هذه الطرقات كيف يُنقي أصلان الناس والشوارع، كيف يعمل جاهداً على تصفية اللوحة من كل الشوائب، مختاراً بعناية تفاصيل مرهفة». ومازلتُ متحيّراً، ليس فقط لأنني أحاول أن أكون ابناً باراً للفوضى والعشوائية والارتباك الكبير الذي نعيشه، بل لأنني أدرك الآن فقط أن صفاء كتابات أصلان ليس سوى ثمرة لصفاء النفس والرؤية. أُدرك الآن فقط أن هذا الصفاء قد يكون المُنجز الحقيقي لأي واحد منا، وسط بهلوانيات السيرك الذي نعيشه يومياً. مات العم أصلان قبل يومين، كما سبقه العم مجاهد في الفيلم وفي الواقع، غير أن أيقونة هذا الصفاء النادر باقية تناوشنا بطموحٍ يكاد يكون مستحيلاً.
(كاتب مصري)
* * *
الكتابـة المراوغـة والعصيـة
كتابة شديدة الخصوصية، تشبه ملامح وجهه، تلك التي لا تشبه أحدا، وتستطيع أن تتعرف اليها بسهولة شديدة، بسماتها المميزة. لم يكن العم إبراهيم أصلان كاتبا عاديا، فهو الذي حمل عبء القصة القصيرة وتجديدها بعد رحيل يوسف إدريس ويحيى حقي، الكاتبين الشهيرين للقصة، وبقي الأمل معقودا، في ازدهار هذا الفن على ثلاثة من جيل الستينيات: إبراهيم أصلان ويحيى الطاهر عبد الله ومحمد حافظ رجب، وهم الذين منجزهم الأكبر في السرد القصصي، كل بطريقته الخاصة، وبأسلوبه المتفرد، لكن يحيى مات ورجب انزوى واحتجب، وظل أصلان وحيدا منفردا كعمود الخيمة الذي يأبى السقوط أو الابتعاد عن فنه الأثير، ظل قائما عليه، يطوره ويجدد فيه، ظل يحدو عليه كالأم التي تهتم برضيعها حتى يكبر ويشتد عوده. نعم كتب أصلان الرواية، وأنجز ثلاث روايات، لكنه يظل كاتب قصة بالأساس، فرواياته تشعر كأنها قصص قصيرة تتجاور لتشكل لوحة كبرى، وهل ننسى أعجوبته «وردية ليل» التي لا تعرف كيف تصنفها إلى أي نوع، كان الرجل بمهارته الفائقة كأنه يضرب كرسيا في «كلوب» الفرح، الفرح النقدي بالمصطلحات والتصنيفات التقليدية، ووضع النصوص في خانات محفوظة وثابتة، وهو الأمر نفسه الذي فعله بعد ذلك في «خلوة الغلبان» و«شيء من هذا القبيل» التي ما زالت فكرة تصنيف هذين العملين مهمة غير مأمونة العواقب، كونها تتأبى على القولبة.
العم أصلان أغوته الكتابة المراوغة، العصية، اللعوب، التي لا تستقر على شاطئ، وتهوى السباحة على سطح النظريات الجامدة. أغوته هذه الكتابة وأغوانا بها، فأصابتنا فتنتها وسحرها، وصرنا أسرى لجمالها الخلاب، الذي تحبه، لكنك لا تعرف سر جماله وأين يكمن ومن أين ينبع؟ إنه الجمال الذي عليك أن تسلم به وبسحره دون محاولة النبش في خلفياته، فيأخذك إلى عوالم مخملية تشبه الحلم، الذي تعيشه وقت قراءة قصة من قصصه، لكن الحلم الذي تمنحنا إياه قصص أصلان لا ينتهي مع نهاية عملية القراءة، بل يظل موجودا وكامنا في الركن الأعمق من اللاوعي، ويقفز إلى الذاكرة من آن لآخر، هكذا بلا استئذان، تضبط نفسك متلبسا باجترار شخصية من شخصياته، أو مشهدا ما من قصصه، وتعيش معها كأنها تحدث هنا والآن، وكأنك فرغت من قراءتها توًا.
لم تكن نصوصه، أبدا، جامدة، أو ذات بعد واحد، فقد كان الرجل، بمهارة استثنائية، يمزج السرد بالشعر، والشعر بالموسيقى، والموسيقى بالرسم، والرسم بالسينما، فتخرج من بين دفتي كتابه بشحنة جمالية وشعورية لا توصف، كأنك كنت بين يدي ساحر، وأصابك بسحره، تخرج مفعما بالجمال والحب والحياة، تخرج وقد أخذت نصيبك من الفنون كلها، وقد أعطاك حقك غير منقوص، لأنه إبراهيم أصلان الذي لم يهتم أبدا بالكم، ولم ينشغل بعدد الكتب، بقدر انشغاله بحذف ما يزيد على الحاجة، وأتخيله لم يكن يكتب قصصا، بل كانت قصصه مولودة معه، ويخفيها في مكان ما من رأسه، وفي اللحظة التي نسميها نحن لحظة الكتابة والإبداع يخرجها، لا ليكتبها، بل ليحذف منها ويصفيها، وينفخ فيها من روحه، تلك الروح الوثابة الحالمة السمحة، التي غافلتنا وصعدت إلى حيث يليق بها أن تكون.
(ناقد مصري)
* * *
بوابـة الستينيـات
عندما تفتحت أعيننا نحن الجيل الذى جاء بعد هزيمة 67 مباشرة، كان كتاب الستينيات يزحمون المشهد بقوة، وكنت ألتقي يحيى الطاهر عبدالله وأمل دنقل ومحمد البساطي وكبيرهم عبد الفتاح الجمل وحكيمهم إبراهيم منصور ومعلمهم ابراهيم فتحي ومنشدهم محمد حمام ورائدهم سليمان فياض وغيرهم، وكنت أرى رجلا ذا شارب كثيف يضحك أحيانا بحساب، ويتحدث باقتصاد ، قالوا لى إنه إبراهيم أصلان. كان هذا من زمن بعيد. وكانوا يتوزعون فى القاهرة بأشكال مختلفة، ورغم أنني اعتقدت أنهم تنظيم سياسي وأدبي لم أعرف كيف أصنف إبراهيم أصلان وأين أضعه بين كل هؤلاء، خاصة أنه لم يدع صفة لنفسه، كان أحيانا يجلس على مقهى إيزافيتش أو استرا وفي ما بعد زهرة البستان، وطبعا في جلسة نجيب محفوظ على مقهى ريش، وكان محفوظ يقدره بشكل خاص جدا، وكنت ألحظ هذا التدليل الذي كان يتعامل به محفوظ مع أصلان.
عندما تصادقنا إبراهيم وأنا وجدت نفسي أمام أحد أبطال السير الشعبية، هؤلاء الذين يملكون عفة النفس ونبل التوجه، بعيدا عن أي انحناءات للسلطة كانت تتواتر أمامنا دون احصاء أو عد، وكان يقول لي في هدوء: لا يوجد كاتب نبيل لا ينطوي على نفس عظيمة ولن يولد الابداع إلا من هذه النفوس. كنت دوما أحرص على استدعاء هذه الجملة الدالة عندما أتأمل ما يكتبه في الصحف السيارة، وكان هو قلقا وكنا نشتبك تقريبا بشكل شبه يومي عندما كان يضجر مما يكتب ويتساءل مستنكرا: (هو اللي أنا باكتبه ده يا شِعب مش هرتلة)؟ كنت أطمئنه على ما يكتب خاصة انه كان يقرأ لي بعضه فى التلفون قبل النشر، لكن المقال الأخير المنشور في الأهرام أقلقني وشعرت بأنه فقد الزمام وفقد قدرة التحكم في بناء المقال ولذلك لم يكتب بعده، أظنه شعر وأدرك أنه لا يستطيع المداومة الآن، وأبلغني أنه سينتظر قليلا حتى يستعيد لياقته الذهنية. إبراهيم أصلان هو العنوان الرئيسي لجيل الستينيات وهو البوابة الكبرى، للدخول لتفاصيل هذا التنظيم الأدبي المترامي.
(شاعر وناقد مصري)
* * *
عـن وعـد لـم يتـم
التقيته لأول مرة في تونس، صيف عام 1992. كنتُ قد قرأتُ له «مالك الحزين»، وكتباً أخرى، ولكن لم أكن أعرفه شخصياً.
كان يجلس وحيداً في إحدى زوايا المقهى المجاور لمطعم الفندق. نحيلاً، شارداً كأنه يعانقُ عالمه الداخلي ويأنسُ إليه. لكنه بادر إليَّ مرحباً عندما رآني مقبلة عليه.
أهلاً يمنى.
كان وجهه يطفح بالنقاوة، وعيناه تمتلئان بعالم سري.
كنت راغبة في الحديث معه. أود أن أحاور صمته الذي انطوى عليه عالم عشته في طفولتي. كأنما وددت بذلك أن أتعرَّف الى قرين لا أفصح عنه.
ما زلتُ أذكر جلستنا في حديقة ذاك الفندق التونسي. فوق الأرض على حافة فاصل ترابي. كنت تعبِّر عن ارتياحك لهذه البساطة بعيداً عن ضجيج الحوار الثقافي في القاعات المغلقة. بدوت مرتاحاً لهذا القرب من التراب الذي داعبته بأصابع يدك وقتذاك، التراب الذي يحتضنك الآن.
في ذلك اللقاء الثقافي أهديتني روايتك «وردية ليل» الصادرة بداية العام نفسه (1992)، ومعها محبتك.
أفتقدُ حضورك اليوم، وإن كنتُ لم ألتق بك سوى في تلك المناسبة، وفي مناسبة ثانية في القاهرة وكانت عابرة. لكني كنت أواظبُ على قراءتك وأتابعُ ما تصدره من أعمال.
دائماً كنتُ أودُّ أن أكتب عن تجربتك المميزة. وتأخرت لأني كنتُ أبحثُ عن موضعها في النظري الذي يميزها. عنيت علاقتها بالمعيش الذي تروي عنه. عنيتُ رداً تنطوي عليه أعمالك الروائية، رداً على القول السائد بأن الرواية العربية كُتِبت وتُكتبُ، فنياً، بالعلاقة مع الرواية الغربية. عنيتُ أصالتك، وتميزك، أي ما لم أشأ أن تكون كتابتي عنه في إبداعك، مجرد توصيف. وكنت، من أجل ذلك، أعمل على إنضاج فكرتي.
في العام 2010 كتبتُ عن روايتك «وردية ليل». عن ذلك المهمش فيها، الموظف في مصلحة البريد. كتبتُ ورحت أنتظر فرصة أخرى للقائك، للحوار معك.
لكن كان الزمن يمضي، وكانت الفرص تفوتني.
ها أنا أكتب إليك اليوم مخاطبة روحك الجميلة، الحاضرة أبداً بيننا وأهديك محبتي.
راحـة المحـارب
إبراهيم أصلان... كان حاضراً حتى عندما أطفئت كل أنوار الأمل.
آن للمحارب أن يرتاح قليلا. مثلما جاء الدنيا على رؤوس أصابعه، وفي صفاء كلي انسحب منها بصمت عن عمر توقف على حواف 77 سنة كانت كلها نضالاً وسعادات صغيرة، ومرتبكة أحياناً. لم يستسلم إبراهيم حتى في أقسى الظروف وأصعبها، إذ كانت رهاناته الكبيرة في حياة أفضل، هي حقيقته الكبرى. وكان الأدب وسيطه الحقيقي وصديقه الأعظم الذي لا يخون. كان إبراهيم أصلان الذي على الرغم من المرض الذي كان ينهكه من الداخل، من أوائل الذين رأوا في كفاية فرصة لتوقيف الفساد السياسي، والحدّ من تدهور وضع كان ينشأ في الخفاء، يلغي كل التراث السياسي الديموقراطي لمصر بعد أن عوضه مبارك بجملكية صغيرة سيدها الفساد والتوريث والعمالة. لكن ثمن هذا الانخراط كان غالياً.
التقينا أول مرة في القاهرة في أحد مؤتمرات الرواية، ثم تأكدت هذه العلاقة عندما طلب مني أن أسلمه حق نشر رواية سيدة المقام في سلسلة آفاق عربية التي كان يرئس تحريرها، والتي انتهت بمصادرة وليمة لأعشاب البحر التي نشرت في السلسلة ومنع تسويقها وقتها وتسويق رواية سيدة المقام التي كنا اتفقنا على نشرها في السلسلة. كان حــــزيناً لانهيار مشـــروع أحبه، ولكــنه لم يتنازل عن موقفه وظل يدافع عن حق الكاتب والفنان في التعبير عن رأيه.
كلما رأيت إبراهيم في القاهرة، الرباط أو الدار البيضاء، أو بيروت، أو دبي أو غيرها، داعبته صادقاً: كيف حبيبي دون كيشوت اليوم. يرد ضاحكاً: على حصانه وفي قمة جنونه. وتغيب ضحكته تحت شاربين كثين يقربانه من شخصيات عميقة لا تنتمي إلى هذا العصر الذي ابتذل فيه تقريباً كل شيء. لقد حمل إبراهيم أصلان بالفعل نبل دون كيشوت وشجاعته وسخاءه، وقوته وشجاعته ويأسه أيضاً. فقد عاش في زمن انتهت فيه الفروسية، أو قلت حتى أصبحت نادرة ومتخفية وراء كتل الانتهازية والسهولة. ولكنه ظل حالماً وحاملاً سيفه، يحارب ليس فقط طواحين الهواء القلقة ولكن عصراً بُني على الرياء والكذب والاغتيال.
لكن معركته التي بدت خاسرة في ظلم قاس، سرعان ما تجسدت في سقوط الطغاة، لكن قلق الكاتب لم ينته أبداً فقد ظل إبراهيم يحمله معه بقوة. وما كان يحدث في مصر بعد الثورة لم يكن دائماً شيئاً مريحاً. فقد رفض مقابلة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في سبتمبر 2010، عندما دعا هذا الأخير مجموعة من المثقفين للقاء في القصر الرئاسي، فكان أصلان من القلة القليلة وربما الأوحد الذي رفض هذا التكريم الغريب من نوعه لأنه كان يعرف مسبقاً أن ما يتخفى من وراء ذلك سوى ابتذال ما كان يعتمل في عمق المجتمع المصري من ثورات ورفض وانكسارات خفية. وكان أكبر تكريم له هو انتصار الثورة في لحظتها الأولى. ويبدو أن الموت كان أسرع من فكرة ترشيحه للأكاديمية المصرية للفنون له للفوز بجائزة النيل التي انطفأ قبل أن ينالها. وكأن القدر شاء له أن يظل كبيراً خارج الغوايات الصغيرة وإن كان قد تحصل على جوائز مصرية وعربية ودولية كثيرة.
لم تفقده الحياة عفوية الشاب الذي عاش في حي إمبابة والكيت كات، بالخصوص، والوراق والمقطم، التي شكلت مرجعه المكاني في الكثير من نصوصه القصصية والروائية التي فرضته كصوت كبير أمام قرائه. لينقل عامل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من المهني إلى الكاتب الذي لم يفقد علاقته بمرجعه الاجتماعي الذي ظل يشكل مادته الأساسية التي جعلت من نصوصه تندرج ضمن الأدب الذي يشتغل من خلال أدواته الفنية الداخلية على مجتمع آخر، غير مرئي، كان ينمو في الخفاء. أصدر إبراهيم أصلان في وقت مبكر، في نهايات الستينيات أول نصوصه وكان لمجلة الطليعة الدور الأساسي في إظهار موهبته الخلاقة التي أثارت انتباه الكثير من النقاد وقتها بالخصوص مع العدد الخاص: جاليري 68، الذي أصدرته مجلة الطليعة قبل أن يفرض وجوده الأدبي في الفترة نفسها كحالة متفردة بصدور أولى مجموعاته القصصية بحيرة المساء، والتي بينت العلامات الأولى لعالم ساحر كان يرتسم في الأفق. قبل أن يستقر الكاتب نهائيا في الذاكرة الجمعية المصرية والعربية بمالك الحزين التي حولت إلى فيلم: الكيت كات، وحولته نهائياً من الهواية إلى الاحترافية التي وضعت جهده في المكان الذي يليق به. كل النصوص التي جاءت فيما بعد لم تعمل إلا على تأكيد هذه الموهبة الخلاقة التي شكلت علامة مضيئة في الثقافة العربية بصدقها واستمرار نضالها حتى عندما تطفأ كل أضواء الأمل أو يبدو لنا ذلك.
(روائي جزائري)
* * *
خـارج السـرب
لقد خسرت الثقافة العربية أحد أعمدتها الكبار، وكاتباً كبيراً وإنساناً عظيماً. فهو كان أسس في الأدب العربي الحديث، لتيار خاص في الرواية والسرد.
إبراهيم أصلان قلم يعشق الحياة، مسحور ومفتون بها لتقربها من الكتابة ولتكون قريبة منها.
ففي الوقت الذي كان فيه أكثر أبناء جيله من الكتاب وأهل السرد يؤدلجون الأدب ويضعونه في خدمة الأفكار والقضايا الكبيرة، كان أصلان يغرد خارج الأسراب، يغمس أدبه بالحياة وهواجسه مشغولة بالإنسان البسيط وعاديات وتفاصيل الحياة اليومية والفن أولاً.
ينطبق عليه حقاً قول ماركيز «إن الفرق بين الأدب والحياة هو مجرد خطأ بسيط في الشكل». يسحرني إبراهيم أصلان بكتاباته وشخصيته وحيث لا انفصال بينهما. هو ساخر وبسيط وكثيف ووحيد ومنتمٍ للإنسان والفن أولاً.
لم ينتم لشللية ولم يخضع قلمه لخدمة سلطة أو جماعة، هو حرّ، وحرّ كثيراً كما الكاتب الحقيقي. مرجعيته بالكتابة موهبته وصدقه وليست الثقافة والمعرفة المكتسبتين والزائفتين والاستعراضيتين.
لغته أهم ما فيها اقتصادها وبساطتها وغناها ولا يثرثر ولا يضيف ما لا لزوم له. وقادر على التصوير بدقة وكثافة في الوقت عينه.
باختصار، أهميته في هذا الصدق الهائل بالكتابة وهذه القدرة على السخرية والانتماء في الوقت عينه. وهو كشخصية غير منفصلة، من البراءة والعفوية والدم الخفيف، وهذه بارزة في كتاباته.
ربما كان أصلان أكثر من يعرف نفسه عندما قال يوماً: «أنا مثل طائر يغني في وحشته» والقراء يعرفون هذا جيداً ويفهمون عليه.
* * *
كاتـب للإنسانيـة
إبراهيم أصلان من الكتاب النادرين الذين كانت مواقفهم المعلنة لا تتناقض مع كتابتهم، ولا أظن أنه أخطأ مرة واحدة في مواقفه وخياراته. وكان محترماً ومقدراً ومحل ثقة في كل ما تولاه من مناصب. الأهم أنه كاتب متميز، لا أحب استخدام وصف «كاتب عالمي»، لذا أقول إن إبراهيم أصلان كان كاتباً للإنسانية. «بحيرة المساء» كل قصة فيها إنجاز كبير على مستوى فن القصة القصيرة.
هو أحد الذين شاركوا في نقلة نوعية كبرى للرواية بعد نجيب محفوظ. لا يجب أن نحزن لوفاة أصلان لأنه رأى الثورة، ونزل إلى التحرير للاحتفال يوم 11 فبراير وسهر هناك للصباح وكان في غاية السعادة. كان محباً للحياة، وترك أعمالاً خالدة، ومن كان مثله لا يموت.
أعرف أصلان منذ عام 68 وكنت جاراً له لمدة عشر سنوات، وأذكر أني قرأت معظم الأدب المترجم من مكتبته. كان صديقاً رائعاً محباً لأصدقائه وكريماً معهم.
(كاتب مصري)
* * *
وردية مـوت
فور انتشار الخبر، قيل إن إبراهيم أصلان مات وهو يتحدث في الهاتف، لم تكن هذه هي الرواية الوحيدة لملابسات لحظات أنفاسه الأخيرة، لكن تمريرها وتقبلها بديا متسقين تماماً مع الميتات التي تعوَّد أصلان أن يحكيها، ذلك أنها تحاكي ميتات شخوص قصصه، وتلائم تصوره «الفني» عن الموت. أكثر ما كان يدهشني في أصلان، تعامله مع الموت في الكتابة بخفة عجيبة، لينزع وقاره، يخففه من ثقله، من استثنائيته وملحميته.. وبحيث يصبح الرحيل دائماً مفارقة عابرة، مزحة كبيرة مؤلمة، يستدعي الناس ما فيها من مفارقات مضحكة في لحظات العزاء بالذات.. تماماً مثلما تسمع المرأة في (حجرتان وصالة)، آخر كتبه، صوت الهاتف المنبعث من «الفيلم العربي» المعروض في التليفزيون، فتصيح «حد يرد على التليفون» وتموت.. بينما يضحك الزوج الذي وصله نداءها، عندما يرى الممثل على شاشة التليفزيون ينهض ليرفع السماعة، وكأنه يطيع أمر زوجته.. وعندما يدخل ليخبرها أن الرنين قادم من شاشة التليفزيون وليس من هاتف الشقة، يرى عينيها المتحجرتين. في العزاء، تصير واقعة الموت ملتبسة بالمفارقة، لا تستطيع الشخصية «الأصلانية» مقاومة حكيها، مستغربةً، للمتجهمين، وكأن المثير، القابل لأن يُحكى، هو المفارقة البسيطة وليس واقعة الموت ذاتها.. هذا النمط من الموت، كان دائماً النمط الذي يغوي أصلان ويأسره.. وهو متكرر باختلاف الحكايات في كل أعماله تقريباً.
حتى في حكيه عن أصدقائه ممن رحلوا، كان أصلان يلتفت للمفارقات والتفاصيل التائهة، التي ربما يراها البعض غير لازمة في لحظات النهاية.. أدهشني مثلاً تأكيده على سؤال «خيري شلبي» له في مكالمته الأخيرة معه، عن اسم الجزء الثالث من الكوميديا الإلهية.. وتكراره لهذه التفصيلة في كل كلامه الشفاهه والمكتوب عنه فيما بعد، وكأنها مفتاح موت صديقه، رغم أنه كان يمكنه حذفها ببساطة.
أعتقد أن بعض الناس يموتون بالطريقة التي يريدونها.. «أصلان» لم يمت في المستشفى الذي دخله قبل أيام، لم يتألم كثيراً في احتضاره، ولم يغب في أوقات حرجة سابقه كان رحيله فيها متوقعاً، لكنه مات «على أهون سبب».. بالضبط، مثلما كان يميت شخصياته!
(كاتب مصري)
السفير- 9-1-2012
******************
ابراهيم أصلان... بعيداً عـن «الكيت كات»
خلوة الغلبان
أتخيّل أحياناً أن إبراهيم أصلان ساعي بريد، تتدلّى على جنبه حقيبة فيها برقيّات ورسائل. أراه يتنقّل بالبدلة الكاكي والقبعة، بين الأزقّة التي عاش فيها وكتبها. يدقّ على الأبواب ويمدّ المظروف الأسمر، ثم يعرّج على أحد تلك المقاهي التي أكلت من عمره، وصارت مسرحاً لأدبه. لم أجرؤ يوماً على مفاتحته بهذه الصورة. كان دائماً يسارعنا بجمل مقتضبة، ساخرة ورقيقة، مؤطّرة بتلك الابتسامة التي تبدو على علاقة ما بشاربيه الكثيفين. كان حرَفيّاً بامتياز، تلغرافيّاً ومقلّاً، يأخذ وقته في النحت والصقل والتشذيب.
كتب ببساطة وعفويّة تقولان تعقيدات وأحزان واحتجاجات وصراعات. وقام نصّه على التقشّف اللفظي، واللغة العارية، والنكهة المحليّة. على المكان الذي يمثّل منبع السرد ومصبّه. على «اللقطة المكثّفة الموحية»، كما كان يسمّيها غالي شكري، وتقنيّة «المفارقة» الكامنة تحت السطح. هذا الكاتب الهامس «يرق ويخفت حتّى لا يكاد يبين، ويبتعد حتّى يبدو محايداً كل الحياد»، كما وصفه مرّة فاروق عبد القادر قبل أن يستدرك: «لكن قصصه تشي بوجهه الحقيقي». العمّ أصلان غلبان بين الغلابى. أما «خلوة الغلبان»، فهي بلدة ذلك «اليهودي المصري» الذي التقاه بشكل عابر في باريس، وبقي الاسم مقترناً لديه بعقدة ذنب، حتّى قرأ نبأ موته، وعرف أنّه عالم النفس والكاتب جاك حسّون. طعم الندم نفسه سيحضر بعد الآن، كلّما تذكّرنا إبراهيم أصلان.
* * *
كتب كالأسطى وبقي هاوياً إلى النهاية
له مخطوطان يصدران قريباً في القاهرة
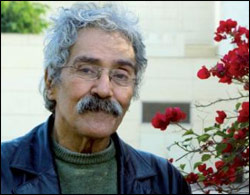 وقف على حدة بين أبناء جيله من «كتّاب الستينيات»، ومضى ببساطة مدهشة كما عاش وكتب. ابن أمبابة المقلّ الذي تعلّم الاختصار في مصلحة البريد، أخذ كل وقته في مراقبة العالم، ونقل مكانه الحميم وناسه في أعمال خاصة، تراوحت بين القصة والمقالة الأدبيّة والرواية. أبرز المثقفين المصريين كانوا في وداعه أمس في القاهرة
وقف على حدة بين أبناء جيله من «كتّاب الستينيات»، ومضى ببساطة مدهشة كما عاش وكتب. ابن أمبابة المقلّ الذي تعلّم الاختصار في مصلحة البريد، أخذ كل وقته في مراقبة العالم، ونقل مكانه الحميم وناسه في أعمال خاصة، تراوحت بين القصة والمقالة الأدبيّة والرواية. أبرز المثقفين المصريين كانوا في وداعه أمس في القاهرة
محمد شعير
القاهرة | إبراهيم أصلان (1935 - 2012) لم يطل عذابه مع المرض. لم يمدّ يده إلى سلطة أو اتحاد كتّاب هزلي طلباً للعلاج. لم تلوّثه السياسة بألاعيبها. شهد الثورة التي حلم بها طويلاً. كان الفنّ الخالص لعبته، وملعبه، وعشقه. صاحب المشروع الروائي الذي ألهم أجيالاً، أسلم الروح أوّل من أمس وهو جالس على كرسيّه الهزاز بعد رحلة قصيرة مع المرض.
رحلة إبراهيم أصلان مع الفنّ والحياة لا يمكن تلخيصها بسهولة.
سنجد أنفسنا أمام صيّادٍ ماهر للحظات المستعصية على الكتابة. في مقتبل حياته، عمل في هيئة البريد لفترة طويلة، ومن هناك تعلّم الاختصار. الصيد والإيجاز أبرز سمتين في عوالمه الإبداعية. بدأ صاحب «مالك الحزين» (1983) الكتابة كسائر الكتاب، بالخواطر، ثم نشر مسرحية قصيرة في مجلة «الثقافة». وتجمّعت لديه عشر قصص قصيرة نشرها في الصحف، من بينها «عصفور على أسلاك الترولي»، وهي القصة التي تحوّلت إلى مدخل لرواية «عصافير النيل» (1999) لاحقاً. لكنّه كان يشعر أنّ هذه القصص تشبه قصص «الآخرين»، ولا تشبهه. لهذا، قرّر أن يمزّقها وعاد إلى القراءة، وتحديداً إلى كتّاب ثلاثة، هم هنري جايمس، وإرنست همنغواي، ومارك تواين. كتب عن هؤلاء في مجلة «الثقافة الجديدة»، ومطلع عام 1965، بدأ كتابة قصص «بحيرة المساء» التي أصدرها عام 1971 بعدما شعر أنّه وجد صوته. قبل أن يصدر أعماله، حدَّد أصلان موقفه من الكتابة: هناك كتابة «طليعية»، وأخرى «رديئة». برأيه ليس هناك حلول وسط، فإما أن يكون هناك فنّ أو لا يكون. وبالتالي، تصير أعمال أبناء جيله يحيى الطاهر عبد الله، ومحمد البساطي، وحافظ رجب، وصنع الله إبراهيم، كتابات طليعية... أما كتابات عبد الحليم عبد الله، ويوسف السباعي، والآخرين، فرديئة.
منذ الطفولة، كان الصيد هواية أصلان. تعلّم منه الصبر والقدرة على «معرفة الغمزة الملائمة لجذب السنارة»، وهي أمور تحتاج إليها الكتابة أيضاً. أما عمله في مصلحة البريد، فعلّمه أنّ كل حرف ينبغي أن يكون له مقابل مادي، ليخلص إلى كتابة كل ما هو مفيد وضروري فقط. كان يهرب من الكتابة بتمزيق ما يكتب. وعندما تعلم استخدام الكمبيوتر، اكتشف ما يتيحه من قدرة في «الحذف»، فسهّل مهمة المسح والإلغاء، لكن ليس مهمة الكتابة. هذا الأمر ميّز نصّه منذ البداية. كان يؤمن بأن كل ما يمكن استبعاده يجب أن يستبعد. فأهمية المكتوب تكمن في قدرته على التعبير عن كل الأوجاع غير المكتوبة، لأنّ ما هو حقيقي يكون عصيّاً على الكتابة في الغالب.
قلة الإنتاج هي «التهمة» التي كان النقاّد يواجهون بها أصلان. يكاد يكون أقل كتّاب الستينيات إنتاجاً. أصدر ثلاث روايات هي «مالك الحزين» التي تحولت إلى فيلم داود عبد السيد الشهير «الكيت كات»، وأدّى بطولته محمود عبد العزيز وشريف منير، و«وردية ليل» (1991)، و«عصافير النيل» (1999) التي تحولت أيضاً إلى فيلم للمخرج مجدي أحمد علي بالعنوان نفسه (2009). هذا إضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية هي «بحيرة المساء» (1971)، و«يوسف والرداء» (1983) و«حكايات من فضل الله عثمان» (2003)... فضلاً عن كتابين نثريين هما: «خلوة الغلبان» (2003) و«شيء من هذا القبيل» (2007). أما آخر أعماله المنشورة، فـ«حجرتان وصالة» (2009) الذي سمّاه «متتالية منزلية». ومعظم أعماله صادرة عن «الهيئة المصريّة العامة للكتاب» و«دار الشروق» في القاهرة، و«دار الآداب» في بيروت، كذلك ترجمت إلى لغات عدّة منها الإسبانيّة والفرنسيّة والألمانيّة والصربيّة والإنكليزيّة. كان يقول دوماً: «أعتبر نفسي عاشقاً للكتابة وهاوياً لها. ولست كاتباً محترفاً مفروضاً عليه أن يكتب. ولديّ يقين بأنّه إذا لم يكن ما أكتبه يلبّي احتياجاً داخلياً لا يمكن تفاديه، فإنه من الصعب أن يلبّي احتياجاً لدى القارئ». كان أصلان يكتب إذاً كأسطى، يعشق عمله الذي يكتبه، وهو ما يتطلب منه «حالة مزاجية» عالية. لذا يريحه دوماً وصف الأديب الراحل يحيى حقي لهذا النوع من الكتّاب بـ«المنتسبون إلى الكتابة لا محترفوها». في أيامه الأخيرة، كان مبتهجاً بالثورة، يتابع تفاصيلها وتأثيرها. قال: «مهما كانت نتائج ما يحدث حالياً، فأنا ممتلئ فرحاً لأنني لم أرحل قبل أن أشهد أبناء مصر وهم يقدّمون للعالم بطاقة تعريف جديدة لهذا الوطن». رحل تاركاً لنا إرثاً متميّزاً وكتابين تحت الطبع سينشران قريباً.
***
جوائز
نال إبراهيم أصلان جوائز أدبيّة عديدة، منها «جائزة طه حسين» من جامعة المنيا عن رواية «مالك الحزين» عام 1989. كذلك حاز «جائزة الدولة التقديرية في الآداب» عن دورة عام 2003، و«جائزة كفافيس الدولية» (2005)، و«جائزة مؤسسة ساويرس للأدب المصري» (2006) عن «حكايات من فضل الله عثمان».
* * *
تلك الحكايات الصغيرة هي ما يجمع بيننا: راقب العالم كأنّ لديه الزمن كله
تسعة كتب مشغولة بالتفاصيل الصغيرة هي رصيد صاحب «ورديّة ليل» الذي وضع عدسته على الأرض، ليرى ملحها وينقل دهشة لا تنقطع
القاهرة | من المعروف بداهة أنّ أمثال إبراهيم أصلان حينما يموتون فإنهم لا يموتون فعلاً. لذا، فالحزن العادي على الموت قد لا يكون في محله هنا، بل هو حزن صمت الموسيقي في نهاية الحفل، واعتزال اليد عن هوايتها في نحت الكلام، وانتهاء الوعد بتلقّي المزيد من النصوص الأصلانية المتأنية، المتباعدة، الفريدة. ولأنه ليس موتاً حقيقياً، فلا عزاء يفلح فيه سوى أنّ العم أصلان لم يحفل كثيراً بالزمن منذ «بحيرة المساء» إلى «حجرتان وصالة».
عندما أصدر مجموعته الأولى «بحيرة المساء» عام 1971، كان في منتصف الثلاثينيات، وهي سن يصلها كتّاب اليوم وفي حوزتهم ثلاثة كتب أو أربعة. لكن أصلان لم يكن يعاني أزمة نشر، بل يعتنق تمهلا نادراً في الكتابة اتضح في روايته «مالك الحزين» الذي أورد في نهايتها أنّها كتبت من ك1 (ديسمبر) 1972 إلى نيسان (أبريل) 1981. هذا التأني لا يعنى سوى أنّ صاحبه لا يحفل بما يتقاتل عليه الآخرون من «مجد» و«عالمية». وها هو يغادرنا وليس في جعبته سوى 9 كتب تتنوع، لا كما تتنوع الأخرى بين رواية وقصة، بل بين نصوص يمكن أن نصنّفها، وأخرى لم يسمّها سواه، «متتالية منزلية» هو الاسم الذي أطلقه على كتابه الأخير «حجرتان وصالة». وفي «خلوة الغلبان» و«شيء من هذا القبيل»، ثمة إيحاء مخادع بأننا إزاء مقالات لا نلبث أن نكتشفها كحالات عصية على التصنيف، لكنها ليست عصية على القلب. وفي إحداها، يقول إنّه اختار اسم «بحيرة المساء» من نصف شطر بيت لعبد الوهاب البياتي. وبعد سنوات، يلتقي الشاعر العراقي فينصحه الأخير بأن «على الواحد أن يعيش ويراقب ما شاء، شرط أن يحرص على بقاء مسافة بينه وبين الواقع، مسافة يأمن معها ألا ينكسر قلبه»، لكن أصلان يعترف بأنّ القلب انكسر فعلاً. ومع ذلك، يبدو أنّ نصيحة الشاعر وجدت موقعاً مألوفاً في كيانه، فراقب العالم كأنّ لديه الزمن كله. ولهذا ربما لم ينشغل بالمعارك الصغيرة بل بالتفاصيل الصغيرة، ورسمت فرشاته العالم عبر جزئياته الدقيقة ولحظاته الغافلة وكلماته العابرة. وفي جميع نصوصه، تكاد الصفحات تضيء من فرط البياض لقلة الكلمات. ويبدو السرد الفعلي أحياناً ليس في الأحرف والعبارات، بل في المساحات الخالية بينها، ويكاد يستحيل اقتباس شيء من النصوص. الدهشة ليست في سطر بعينه، بل في ما يظهر وما لا يظهر معاً. يصعب الاجتزاء والاقتباس. ولهذا، فعندما اقتبس داود عبد السيد «مالك الحزين» في فيلمه «الكيت الكات»، استقى روح النص وصنع منه لغته السينمائية الخاصة. هكذا احتل «الكيت كات» مكانه في قائمة أهم الأفلام، واحتلت «مالك الحزين» مكانها بين أهم الروايات.
ربما كان ثمة سبب آخر لقلة أعماله أنّه لم يكتب سوى عمن يعرف. عندما عمل في إدارة البريد، كان شاباً. فتحت له مرة الباب مراهقة جميلة تسأله فجأة «إنت بتشتغل كده ليه؟ كنت في الثامنة عشرة من عمري، وهي لاحظت حرجي وصمتي، وقالت مستنكرة: إنت شكلك حلو سيب الشغل ده واشتغل شغل تاني. وأخذَت الخطاب وأغلقت الباب»، لكنه لا يحكي تلك الحكاية في كتابه «وردية ليل» الذي يدور في عالم موظفي البريد. بل انتظر ليحكيها في «خلوة الغلبان». انتظار هو نوع خاص من تقطير التجربة وتقطير الكلام، ومن يعلم فربما دفعته تلك البنت حقاً في ذلك الزمن البعيد كي «يشتغل شغل تاني». لكن نصيحة كاتب عجوز مغمور لم تكن تقل إدهاشاً، عندما نصح الشاب إبراهيم «لازم تكتب، الكتابة هي الشيء المهم». ويسكت الشاب متأملاً سوء حال الرجل، فإذا بالعجوز يصيح فيه غاضباً «أنا مش مقياس. فاهم؟». وسواء كان السبب صرخة الرجل أو سؤال البنت أو نداءه الذاتي، وجد الشاب نفسه في طريق كتابة لا تتعجل نفسها. وبين مصلحة البريد وحواري إمبابة وشوارع الكيت كات، وجد الناس الذين عَبَر من خلالهم إلى أسئلة الوجود. وعندما ترك كل ذلك إلى المقطم، البعيدة عن الزحام، كتب الحزن المنزلي في «حجرتان وصالة»، حيث التلصّص على الكفاح الذاهل لكهل ترحل زوجته، وتتركه في متاهة الأدوات المنزلية وعلب الدواء، ثم ينتقل أصلان نفسه في أيامه الأخيرة من بيته إلى بيت آخر. وفي عموده الأخير في «الأهرام» يسأل نفسه: «هل يليق أن يكون البلد هكذا؟ وتروح أنت تحدث القارئ عن الكتب والانتقال من مسكن إلى آخر، هل هذا كلام؟» ثم يجيب: «تلك الحكايات الصغيرة العابرة التي نتبادلها طيلة الوقت، في كل مكان، هي ما يجمع بيننا، وما يبقينا على قيد الحياة».
* * *
كتابة التقطير: متتاليات حياتيّة
 ليس من قبيل المصادفة أن يلجأ إبراهيم أصلان إلى كتابة «الشيفرة» وتقطير الكتابة إلى الحدود القصوى. عامل التلغراف القديم أتى ببلاغة «البرقية» إلى الكتابة، ولم يحد عن الاختزال والكثافة، منذ تجاربه المبكرة، فباتت نصوصه علامة مسجّلة تخصُّ صاحبها وحده.
ليس من قبيل المصادفة أن يلجأ إبراهيم أصلان إلى كتابة «الشيفرة» وتقطير الكتابة إلى الحدود القصوى. عامل التلغراف القديم أتى ببلاغة «البرقية» إلى الكتابة، ولم يحد عن الاختزال والكثافة، منذ تجاربه المبكرة، فباتت نصوصه علامة مسجّلة تخصُّ صاحبها وحده.
يس الاقتصاد اللغوي فقط ما يميّز كتابات صاحب «وردية ليل»، بل الالتقاطة الصارمة للمشهد الذي يعبره الآخرون دونما اهتمام. كان يلتقط كنوزاً ممّا يراه سواه «نفايات الحياة اليومية»، أو مشهديات ما قبل الكتابة. هكذا يقلّب المادة الأولية بموشور متعدّد الأطياف، عبر الكتابة والمحو، إلى أن يجد جهة البريق، وإذا بنا إزاء شخصيات، وأمكنة، ومواقف، يصعب تخيّل ثرائها الحياتي، قبل أن يصطادها صاحب «مالك الحزين» بكمينه المحكم. على الأرجح، فإنّ أصلان كان يدرك بإمعان معنى عبارة «العالم يبدأ من عتبة بيتي». وجد في إمبابة، الحي القاهري الشعبي الذي نشأ فيه وأهداه أروع شخصياته القصصية والروائية، فضاءً سردياً لا ينضب، في تناوبٍ آسر بين هامشية حضور هذه الشخصيات وفاعليتها من جهةٍ، وقدرتها على صناعة الحلم من جهةٍ ثانية.
هذا النحت المتواصل للعبارة، لجهة الدقّة في الوصف، ونبش داخليات شخصياته، واختزال المسافة بين المحكي والمكتوب، وضع صاحب «عصافير النيل» في منطقة الدهشة والفانتازيا والابتكار، في تقنيات الكتابة نفسها. سنلحظ تحولاً تقنياً متواتراً في أعماله. هو بدأ قاصّاً، ثم روائياً، وانتهى إلى ما سمّاه «نصوصاً سردية»، كما في «خلوة الغلبان»، و«شيء من هذا القبيل»، وأخيراً «حجرتان وصالة» التي عنونها بـ«متتالية منزلية».
نتقاله إلى العيش من حي إمبابة الصاخب إلى شقة في المقطّم، انعكس على حجم فتحة العدسة، فانكبّ على اكتشاف جمالية المكان الضيّق. شخصيّات لا تغادر أمكنتها المغلقة، إلا نادراً، وهي حين تغادر لطارئ ما، تجد حياة موازية على سلّم البناية، أو في زقاق معتم. أبواب مغلقة، وأخرى مفتوحة، نحو مشفى، أو عيادة للطب النفسي، أو صيدلية. حيوات تضيق بأرواح أصحابها، في لحظة ما قبل الاختناق، ونفاد الهواء..
* * *
مثقفو مصر شيّعوه إلى «باب النصر»

محمد هاشم ويوسف القعيد خلال التشييع
القاهرة | أمس، وصل إبراهيم عبد المجيد باكراً الى بيت إبراهيم أصلان في المقطم لتوديع جثمانه، فوجد سعيد الكفراوي ينتظره فتعانقا طويلاً ثم انخرطا في بكاء طويل. انتبه الكفراوي الى أنّه هو الذي ورّط أصلان في المجيء الى المقطم وترك امبابة. حكاية قطعها دخول الموسيقي العراقي نصير شمّة الى المشهد، ومعه الشاعر السوري محيي الدين اللاذقاني ليودعا «مالك الحزين». دقائق ثقيلة مرت قبل أن يتحول الشارع الى سرداق مفتوح ضم رفاق أصلان في سنواته الطويلة، التي لم تكن كلها قاسية، لأنّ بهجته منحت عمره المزاج الذي يليق بصاحب «خلوة الغبان».
هذا هو العنوان الذي اختاره لأحد أجمل كتبه، وبدا صوفياً أكثر مما تحتمل الكتابة، «لكن الحياة تحتمل طالما عشتها خالية من الآلام المنافسة وأحقادها»: هكذا قال مرةً وهو يسير في شوارع «غاردن سيتي» بحثاً عن سيارته الـ «فولس فاغن» القديمة التي رفض التخلي عنها، ثمّ تركها لابنه هشام، الذي فأجاه باحتراف الكتابة وهو يعبر سنواته الثلاثين.
جاء السينمائي مجدي أحمد علي الذي حوّل رواية «عصافير النيل» الى فيلم شجي. وكان قد بدأ العمل على تحويل عمله الأخير «حجرتان وصالة» الى مشروع سينمائي جديد، مع محمد الرفاعي. قاوم مجدي رغبته في البكاء ثم أمسك يد الروائي محمود الورداني، والناشر محمد هاشم، وظهر في اللقطة محمد المخزنجي، الذي يندر أن تراه في مشاهد مزدحمة مماثلة. فالكاتب الهامس رأى دوماً في أصلان ملاذاً وركناً لا يمكن تفاديه في أركان السرد المصري. قبل أن تخرج جنازة العم إبراهيم، ويوارى جسده في الثرى، أطلّ ناشر أعماله إبراهيم المعلم (الشروق)، ووقف الى جانب وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي، الذي بكى طويلاً وهو يصلي على الجثمان. وقبل أن ينطلق المشيّعون الى مقابر الأسرة في باب النصر، الى جوار سور القاهرة الشمالي، وقريباً من حي الحسينية وباب الفتوح، نبّهنا عماد أبو غازي الى أنّ المقابر ذاتها ضمت رفات المؤرخ المصري المقريزي، قبل أن تنقل المحافظة الرفات الى وجهة مجهولة. وتبادل الجميع حكايات عن الراحل بدت كلّها كأنها «تمارين على الابتسام»، وإذا بالجميع يعودون إلى كتبه المؤجلة. قبل وفاته، كان يعمل على إعداد كتاب بهذا العنوان يضم المقالات التي كان يكتبها لصحيفة «الأهرام». كتب صاحب «وردية ليل» في «الأهرام» طوال ثماني سنوات، ناجحاً في إعادة الاعتبار إلى فن المقال الأدبي. هذا النوع تعرّض لإهمال متعمد، من وجهة نظره، بعد غياب يحيى حقي، الذي نظر إليه أصلان دوماً كـ «جبل شاهق» من جبال الكتابة.
عاش إبراهيم أصلان ومات مثل صياد ماهر لأكثر اللحظات الحميمية التي تستعصي على الكتابة، لكنها تلين بين يديه لتتحول إلى «حياة من لحم ودم». فالبشر هم السر الحقيقي في كل ما أنجزه أصلان، ودرسه الأهم والأكبر هو ألا نبتعد عن الحياة
* * *
جلس على كرسيّه الهزاز... ومضى
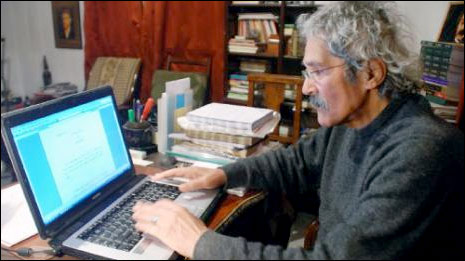
منذ أسبوعين، أنهى إبراهيم أصلان اجتماع «اللجنة العليا لمكتبة الأسرة» التي يرأسها. توجّه إلى وسط القاهرة، وسار في شوارع وسط القاهرة قبل أن يصل إلى مقهى «زهرة البستان». هناك، احتسى الشاي، ثم غادر إلى مقهى «الجريون» الشهير. في تلك الليلة التي بدا فيها كأنه يودّع أماكنه الثقافية التي شهدت الكثير من معاركه، حدثنا عن أمه «السيدة التي لم تكن تنام إلا بعد أن تطمئن على عودته وتناول عشائه. ثم تدخل لتنام بهدوء». ذات مرة، نسيت ما إذا كانت قد تركت لإبراهيم نصيبه من اللحم أو لا، فظلت مستيقظة بجوار سريره حتى استيقظ عند الظهيرة، فسألته: «هل تركت لك نصيبك؟» أجابها بنعم، ثم انسلت لتنام. كان صاحب «يوسف والرداء» يتحدث بعذوبة عن والدته، وعن صديقه الروائي الراحل خيري شلبي. كان الجميع يضحك من حكايات «المقالب» بين الاثنين. يقول إبراهيم: «كان يصرّ على أنّني لست كاتباً لأنني مقلّ، والأديب الحقيقي ينبغي أن يصدر عشرات الأعمال. وأنا من جانبي، أصرّ على أنه ليس كاتباً لأنه يكتب كثيراً. وأنا أحاول أن أقنعه بأنّ الكاتب الكبير ليس بعدد الأعمال. ذات مرة، اتصل بي يسألني عمّا إذا قرأت روايته الجديدة. أجبته: لا يا خيري. قال لي: والنبي اقراها مش حتصدق إني أنا اللي كاتبها».
ضحكنا وهو يتحدث عن العم خيري صديق عمره، وكدنا نبكي وهو يتحدث عن مكالمتهما الأخيرة التي سبقت رحيل خيري بلحظات. تحدث يومها أصلان عن الموسيقى والعمر الذي لن يكفي ليستمع إلى ما يحبّ، وعن مدرسة التلاوة المصرية، وعن الثورة التي كان يرى أنه فرح جداً بها، مهما كانت نتائجها. كان يقول: «لم أرحل قبل أن أشهد أبناء مصر وهم يقدمون للعالم بطاقة تعريف جديدة لهذا الوطن». وأول من أمس، خرج أصلان من المستشفى بعدما قضى أربعة أيام في إجراء التحاليل والفحوص وعلاج عضلة القلب المجهدة. خرج والتقى الأصدقاء. لم يكن سعيداً وهو يتحدث عن ترشيحه لجائزة «النيل»، لكنه أبدى رغبته في مشاهدة فيلم «منتصف الليل في باريس» الذي يتحدث عن همنغواي أستاذه الحميم. وعده سعيد الكفراوي بأن يحضره له في اليوم التالي. لم ينتظر أصلان أن يشاهد الفيلم. جلس على كرسيه الهزاز الذي لطالما كتب عن حبّه له... ومضى!
الاخبار 9-1-2012
* * *
يا ابراهيم مالك حزين
رحيل الروائي المصري إبراهيم أصلان «كاتب الكاميرا»
 غيّب الموت أمس الكاتب المصري، الزميل في «الحياة»، إبراهيم أصلان عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد فترة مرض قصيرة قضاها بين مستشفى قصر العيني ومنزله الجديد بالمقطم. ومع شيوع خبر وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبّر الكتاب المصريون عن عميق حزنهم لوفاة القاص والروائي الذي كان قريباً من قلوب الجميع بفضل حسه الإنساني الساخر ودعمه اللامحدود للمواهب الشابة. ومن المقرر تشييع جنازته اليوم، ونعاه وزير الثقافة المصري شاكر عبدالحميد بوصفه «أحد أعمدة السرد في مصر».
غيّب الموت أمس الكاتب المصري، الزميل في «الحياة»، إبراهيم أصلان عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد فترة مرض قصيرة قضاها بين مستشفى قصر العيني ومنزله الجديد بالمقطم. ومع شيوع خبر وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبّر الكتاب المصريون عن عميق حزنهم لوفاة القاص والروائي الذي كان قريباً من قلوب الجميع بفضل حسه الإنساني الساخر ودعمه اللامحدود للمواهب الشابة. ومن المقرر تشييع جنازته اليوم، ونعاه وزير الثقافة المصري شاكر عبدالحميد بوصفه «أحد أعمدة السرد في مصر».
وتعطي حياة أصلان الذي كان يقول «انا مثل طائر يغني في وحشته» نموذجاً فريداً للكاتب العصامي الذي لم يستند الا إلى موهبة استثنائية تقوم على تحويل العادي أو «نثار الحياة» كما كان يسمي تفاصيله اليومية الى مادة خصبة لكتابة كان يخاف منها ويرى أنها «مرعبة».
بنى أصلان حضوره الفني على تأملاته بين عالم طفولته في أحدى قرى محافظة الغربية (غرب الدلتا) وبين عالم المهمشين في أحياء القاهرة الكبرى، وبالذات منطقة «الكيت كات» في «إمبابة» التي تشكل فضاء جغرافياً مميزاً لأعماله.
ويعتقد كثر من النقاد أن أصلان كاتب مكان بامتياز، كما تكشف عن ذلك روايته الفريدة «مالك الحزين» التي كانت من بين أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين بحسب ترشيحات النقاد، وكذلك في روايتيه «حكايات فضل الله عثمان» و «عصافير النيل»، فضلاً عن مجموعتيه القصصيتين «يوسف والرداء» و «بحيرة المساء».
وتلفت النظر في كتاباته قدرته على خلق عوالم لها سمات غرائبية تنهض فيها اللغة بالعبء الأكبر، والتي استمدت شاعريتها من كفاءتها في الالتقاط والتصوير الفني فهو كاتب «الكاميرا» كما كان يسمي نفسه.
وجد أصلان دعماً مبكراً من نجيب محفوظ الذي كان أول من زكاه للحصول على منحة للتفرغ مكنته من ترك مهنته كساعي بريد العام 1971، واحتفظ أصلان برسالة التزكية التي وجهها صاحب نوبل لمسؤولي وزارة الثقافة مشيراً فيها الى أصلان «فنان نابه، موهبته فذة، له مستقبل فريد»، ودعا محفوظ مسؤولي الثقافة لأن ينال أصلان حقه « وأن يكرم بما هو أهل له».
واللافت في مسيرة صاحب «مالك الحزين» ان أعماله التي نقل بعضها الى لغات أجنبية، اتسمت بـ «أناقة أسلوبية ملحوظة. نالت تكريماً استثنائياً من كتاب جيله الذين خصوه بعدد خاص من مجلتهم الطليعية «غاليري 68».
في كتاباته وحواراته كشف أصلان عن تأملات عميقة في شأن العلاقة بين الأدب والسينما واستفادته من الفن التشكيلي كمصدر لتخصيب كتاباته الإبداعية التي كان أخرها كتاب «حجرتان وصالة»، وهو متتالية قصصية ترصد حياة يعيشان في خريف العمر.
وفي سنواته الأخيرة أعطى أصلان وقته الأكبر لكتابة مقالات النثر التي كشف فيها سخرية ذات حضور ذكي ولا تخلو من ادراك للتناقضات الاجتماعية. كما لم تخل كتابات أصلان من انحيازات واضحة للفقراء، ومناهضة الاستبداد السياسي والديني.
وتوج إبراهيم أصلان مسيرته الأدبية بجوائز، منها: جائزة طه حسين من جامعة المنيا عن رواية «مالك الحزين» العام 1989، جائزة الدولة التقديرية في الآداب العام 2003 – 2004، جائزة كفافيس الدولية العام 2005، جائزة ساويرس في الرواية عن «حكايات من فضل الله عثمان» العام 2006، ورشح قبل أيام لنيل جائزة النيل وهي أرفع الجوائز المصرية التي تمنحها أكاديمية الفنون.
الأحد, 08 يناير 2012
******
روائيون مصريون يودعون صاحب «مالك الحزين»
جمعت الشهادات: سلوى عبدالحليم
الإثنين, 09 يناير 2012
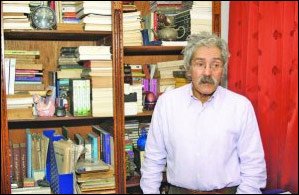 بهاء طاهر
بهاء طاهر
أشعر وكأني أنا الذي مات، لذلك يصعب عليّ أن أسترسل في الكلام، كل ما يمكنني قوله الآن عن إبراهيم أصلان ما كنت دائماً أقوله له هو شخصياً كلما جمعنا لقاء: إنني أعتبره شاعر القصة القصيرة في مصر، والذي لا يُبارَى.
وأظن أن كل من لديه حس أدبي، وتذوق للنثر العربي، وقرأ أعمالاً لإبراهيم أصلان مثل: «بحيرة المساء»، و»يوسف والرداء»، و»حكايات فضل الله عثمان»، حتى تلك الصور القلمية التي كان يكتبها أخيراً في جريدة الأهرام، يستطيع أن يشعر أن ما قدَّمه أصلان نثر فريد من نوعه، والمتلقي لهذا النثر يجب أن يكون على درجة عالية من التذوق، لكي يعرف الفرق بين النثر الذي قدَّمه أصلان وغيره من النثر الذي لا يضيف إلى القارئ شيئاً من المتعة الأدبية والفنية والفكرية.
صنع الله إبراهيم
كان صاحب لغة متميزة وحداثية، ووفاته خسارة جسيمة.
رضوى عاشور
«رحيل زميلنا وصديقنا الكاتب الكبير والجميل إبراهيم أصلان، واحد من أبرز كتاب الرواية والقصة القصيرة في الستينات خسارة كبيرة.
ما قدَّمه أصلان، سواء في قصصه القصيرة أو رواياته الثلاث «مالك الحزين»، و«عصافير النيل»، و«حكايات فضل الله عثمان» كان وساماً وإضافة حقيقية في أسلوب كتابة النثر العربي الفصيح المشبع بإيقاعات العصر والممزوج بالأسى والضحك.
كانت جمل إبراهيم أصلان قصيرة، وكلماته محسوبة، كأنما يتوجس مما قد تحمله من أوجه أذى؛ فروايته الفريدة «مالك الحزين»، وكنموذج على نصوص وكتابات أصلان، هي صوت منفرد لعزف على آلة الكمان، يشي بمنمنمات لعمر يغتاله الفقر والقمع والهزائم، وفي الوقت نفسه عمر يتأمل الحياة منعكساً على جدول غاض ماؤه، فاستولى عليه الأسى، وظل موزعاً بين الصمت والقول الخافت الحزين. هذا ماقلته عن إبراهيم أصلان في دراسة مقارنة مكتوبة ومنشورة قبل أكثر من عشرين عاماً.
إبراهيم عبدالمجيد
إبراهيم أصلان كان من المجددين الكبار، سواء على مستوى القصة القصيرة أو الرواية، ورغم أنه كان كاتباً مُقلاً، لكنه كان مبدعاً من طراز نادر وفريد، صاحب معمل خاص في الكتابة الأدبية، دائم البحث عن لغة خاصة، تحمل معاني جديدة وعميقة في آن، هذه اللغة تصبح وبمرور الوقت لصيقة بعمله الأدبي، وقد تجلى هذا الأمر في معظم أعماله، ومنها على سبيل المثال مجموعته القصصية «بحيرة المساء».
رحيل أصلان خسارة كبيرة للحياة الأدبية والثقافية، هو من واحد من أبرز المبدعين الذين أثروا الكتابة الأدبية، والذين تأثر بهم الكثير من الأدباء؛ لدرجة أننا نجد ظله في كثير من الكتابات التي جاءت بعده.
محمد البساطي
«الحديث عن إبراهيم أصلان من الأمور الصعبة على نفسي الآن، وكل ما يمكنني قوله، إنه كان صديق عمر، وكاتباً لا مثيل له».
عماد أبو غازي
إبراهيم أصلان قدَّم للثقافة المصرية وللإبداع العربي القصصي والروائي إسهاماً مميزاً وإضافة مهمة وفريدة.
رحيل جسد أصلان عنا لا يعني غيابه، لأنه باق بكل إسهاماته وإبداعاته ودوره في الثقافة المصرية، على مدى يقرب من نصف قرن...كل ما يمكني قوله وفي جملة واحدة إن إبراهيم أصلان باق بيننا لم ولن يرحل عنا.
محمد سلماوي
رحيل إبراهيم أصلان خسارة فادحة؛ لأنه من الأعمدة الأساسية في الأدب المصري المعاصر، بعد أن تداعت أعمدة عدة بدءاً من يوسف أبو رية مروراً بمحمد عفيفي مطر وخيري شلبي ... هذا الجيل من الكتاب يتداعى، وهو جيل مهم في الأدب المصري. هذا الجيل الذي تفتحت موهبته فترة السبعينات الرافض لحركة التراجع المصري التي بدأت منذ هذه الفترة حتى قيام ثورة 25 يناير مطلع العام الفائت. أصلان كان ينتمي إلى هذا الجيل الرافض، والذي عبَّر عنه الشاعر أمل دنقل في قصيدته «لا تصالح» وعبَّر عنه أصلان في روايته «مالك الحزين»
هناك أدباء أعمالهم تظل خالدة، وتكتسب حياة خاصة بها لا تزول بزوال صاحبها، ولا علاقة لها بكون الأديب موجوداً على قيد الحياة أم لا، أصلان من هؤلاء الكتاب فأعماله علامات، وقصصه القصيرة عبّرت عن الإنسان المصري وهمومه وأوجاعه ببساطة وتلقائية شديدة ودون افتعال أو إقحام لأيدولوجيات سياسية لدرجة أنها قد توهم القارئ أن كاتبها لم يبذل مجهوداً في الكتابة، لكنه السهل الممتنع.
أعمال أصلان ستظل خالدة، لكن ما سنفتقده حقيقة هو شخصه النبيل بمعنى الكلمة كان إنساناً صاحب خلق عظيم، لا أذكر أنه اغتاب أحداً أو تحدث عن زميل له في شكل جارح ولو مرة واحدة طوال حياته.
كان أصلان مثالاً نادراً في الحياة الثقافية حيث نجد انفصالاً كاملاً بين الأديب بوصفه إنساناً مرهف الحس والمشاعر وبين تصرفاته في حياته اليومية والتي قد تكون على عكس ذلك تماماً.
أديب على خلق له من النبل والشهامة ما نفتقده الآن في الحياة الثقافية. كانت إنسانيته جياشة في هدوء ودون افتعال، كان مثل نهر النيل يمضي في ثبات وعمق إلى مقصده دون ضجيج أو إزعاج.
يوسف القعيد
إبراهيم أصلان يُلخَّص بالنسبة إليَّ مقولة «إن الكاتب هو الأسلوب» فهو لم يكن من أصحاب الكلمات أو الأساليب الرنانة أو من كتاب البلاغة العربية القديمة، لكن الأسلوب بمعنى طريقة انتقائه كلماته ووضعها بجوار بعضها والتي تجسد شخصيته ورؤيته إلى الحياة.
كان أصلان يلتقط لحظات عادية جداً من الحياة نمر بها ولا نلتفت إليها، ولا نتصور أبداً أن بداخلها إمكانات درامية صالحة لكي تكتب أو تدون أو يتم التوقف أمامها. من هذه اللحظات العابرة جداً صنع أصلان عالمه وأسلوبه وطريقته الخاصة جداً في الكتابة الأدبية.
أصلان أيضاً من الكتاب القلائل الذين لم يكتبوا حرفاً واحداً إلا عما يعرفـــونه جيداً وعاشوه جيداً بمعنى أنه لم يكن يقرأ لكي يكتب، ولم يكن يتعمد أن يعـــيش حيوات لكي يعكسها في إبداعاته، ولم يكن يتثقف لكي يعكس ثقافته في كتاباته، وكان يفصل دائماً بين القراءة والكتابة على الرغم من كونه قارئاً جيداً وكاتباً جيداً أيضاً.
يجب أن يقام لإبراهيم أصلان تمثال في مدخل حي أمبابة؛ لأنه خلَّد هذا المكان في كتاباته، ولولا أصلان ما كانت الدنيا قد عرفت هذا الكيان الذي كنا ننظر إليه دائماً بوصفه مبعثاً للمشاكل وللفتنة الطائفية ومنطقة للعشوائيات، لكن أصلان نظر إليه نظرة إنسانية وفنية وأخذ أجمل ما فيه.
أصلان دخل أمبابة ولم يبرحها أبداً على الرغم من أنه انتقل إلى العيش في حي المقطم، لكن روحه ووجدانه وكيانه كله ظل هناك معلقاً في هذا المكان الذي جعل منه إمبراطورية خاصة به، شأنه في ذلك شأن الكتاب العظام. كانت أمبابة بالنسبة إلى أصلان مثل «بطرسبرغ «بالنسبة إلى ديستوفسكي، و«موسكو» بالنسبة إلى تولستوي، و«ريف فرنسا» بالنسبة إلى فلوبير.
***
كفى موتاً يا عمّ
الإثنين, 09 يناير 2012
 للتو، أي منذ ساعات، وربما منذ أيام، وقع ما يأتي:
للتو، أي منذ ساعات، وربما منذ أيام، وقع ما يأتي:
في مساء رطب ومنعش لواحد من أيام معرض الشارقة للكتاب، وفي بهجة اللقاء بمن فاتني لقاؤه أو لقاؤها منذ سنة أو منذ عشر، أطلّ إبراهيم أصلان وجمال الغيطاني. وسرعان ما تحلقوا وتحلّقن حولهما، ولكن بعد أن ظفرت بعناق لا يبرد الشوق. وسرعان - أيضاً - ما تصدر إبراهيم المنصّة، فعاودني ما يراودني كلما رأيته في مثل هذا الموقع والموقف: أمتلئ إشفاقاً عليه، أكاد أنده: ارحموا هذا الطير. العمّ إبراهيم ليس رجل منصّة، العم إبراهيم مثله مثل بوعلي ياسين، دعوهما للجلسة غير الرسمية في مقهى، في بيت، بلا أضواء وبلا مكبر للصوت. لكن إبراهيم كذّب وساوسي كما فعل في كل مرة شاهدته فيها يتصدر منصّة.
بلا رسميات وبلا كلفة يحدث القاعة، صوته أقرب إلى الهمس، وعلى رغم ذلك لا يخفي ما أورثه التدخين من شروخ. عينان تناديانك إلى الغور، لتتوه بين المكر والبراءة والذكاء والسذاجة والطيبة والدهاء، وقد كان جلُّ ذلك مما أشعر به لأول مرّة، كما في كل مرة، فالعم إبراهيم من أولئك البشر الذين لا تفتأ تتعرف إليهم، ليس لغموض فيهم وحسب، بل لما يكنزون في دواخلهم.
حين طُلِبَ مني التعقيب على ما أنعم به إبراهيم أصلان على القاعة الصغيرة المحتشدة، تلعثمت كما تتلعثم يدي كلما حاولت أن أكتب أو أتحدث عن كتابته أو عنه، فأكتفي بالقول: إبراهيم أصلان يقطّر الرواية التي لا تُقطّر، ويقطّر القصة التي لا تُقطّر، كما لعله يُقطّر الحياة.
***
للتو أيضاً، أي منذ رفّة جفن، وقع ما يأتي:
في مساء بارد ومقلق لواحد من أيام (18 و19 يناير) اصطحبني محمد زاهد زنابيلي الذي أسس دار التنوير، إلى الصين الشعبية، أي إلى حي إمبابة، وبالضبط إلى وكر - لا إلى بيت ولا إلى غرفة - هو وكر إبراهيم أصلان، حيث حشرتنا الكتب والكراسي التي ليست بكراسي، والترابيزة التي ليست ترابيزة. وعلى وقع قرقرة الشيشة والصوت المشروخ وضحكة الأعماق وذيول منع التجول ليلاً وأصداء ثورة 18 و 19 يناير... على ذلك الوقع سكن العم إبراهيم روحي، إنساناً ومبدعاً، وما همّ من بعد أن تُباعد أحياناً سنواتٌ بين لقاء ولقاء، ففي غيابه هي ذي (وردية ليل) أو (يوسف والرداء) أو (بحيرة المساء)، هي ذي قصة ليست كالقصص، أو رواية ليست كالروايات، أي قصة - حكاية أو رواية - حكايات، بل هي ذي (مالك الحزين) أو (شيء من هذا القبيل) أو (خلوة الغلبان) أو (عصافير النيل)، هي ذي (حكايات من فضل الله عثمان) فما معنى اللقاء أو الفراق يا عمّ إبراهيم؟
***
بين لقاء إمبابة ولقاء الشارقة أربع وثلاثون سنة. وبين لقاء الشارقة وما يســـمى موت إبراهيم أصلان أو غيابه أو رحيله أربعون يوماً، تخــللها هاتف وحيد بيـــننا. وهكذا هو الزمن مع العم إبراهيم. وما دام لا حول لي ولا طول في ذلك، فسأنصرف عن الحزن وما شـــابهه إلى غواية إبراهيم أصلان الكبرى: غواية الإبداع المقطّر، أي: عالم من النكرات، من الألســـنة، من الشفوي، من اليومي، من الهامـــش، من مصلحة البريد، من الكيت كات، من الصاعق الذي يفجّر قصّة أو رواية أو حكاية، من اللقطة الأليفة المدهــشة في آن، من هذا الذي يســـمونه بفخامة: الاقتصاد اللغوي... ولكل ما تقدم دعوني أهمس في أذن العم إبراهيم: قوم بقى وكفاية موت
***
ابراهيم أصلان الروائي المصري الراحل شرّع أبواب السرد على ثقافة الحياة
الإثنين, 09 يناير 2012
 الصائغ الذي لم أتعلم منه
الصائغ الذي لم أتعلم منه
> يكفي نطق اسمه لتقفز ملامحه إلى مخيلتك بشاربه الكثيف وعينيه المبحرتين في العمق وتقاطيع وسامة ملامحه وعفوية حديثه، وتعلق يده بسجارته المغروسة في فمه على الدوام. رحل هذا العملاق مسجلاً اسمه كأول الراحلين لهذا العام، وكأن العام لا يريد المضي في أيامه قبل أن يلتهم سادناً من سدنة الحرف البهي، رحل بعد أن رأى ولادة مصر التي يحبها ويعرف تفاصيلها الليلية تماماً، وحين أقول الليلية كونه كائناً ليلياً كما يصف نفسه. فأصلان يرى أن القاهرة لا تنام ولكل وقت من أوقاتها كائناتها، ولأنه عاشق لليل تجده يفتش في شوارع القاهرة عن شخصياته الليلية.
كنت مبهوراً به من خلال روايته «المالك الحزين» التي تحولت في ما بعد إلى فيلم سينمائي حمل اسم «الكيت كات»، وهو الحي الذي عاش فيه أصلان وسط مجاميع من البشر كل منهم له حكاية تلصص عليها أصلان بحرفية الفنان، كي يخرجها من واقعها إلى الواقع الفني. تكررت لقاءاتي بأصلان في القاهرة وفي مؤتمرات عدة تباعدت زمنياً، وفي كل لقاء يكون حال إبراهيم كما تركته آخر مرة، نتبادل الأحضان وكأننا لم نغب عن بعضنا إلا ليلة، فالرجل بقي على دماثة خلقه من غير أن يمسسها تحريف أو كبر. في يوم سألته عن مقدرته على اقتصاد الكلمات في أعماله الروائية والقصصية، فأجابني بأن ما تحذفه لا يستحق أن تندم عليه، فلو كان مهماً لما رضيت روح الفنان بحذفه. منه تعلمت اقتصاديات الأدب ومع ذلك لم أطبق ما تعلمت منه. رحل إبراهيم الآن وبقي متناثراً في كل شخصياته التي كتبها بحرفية صائغ الذهب.
عبده خال
القبض على المشهد السردي لحظة حدوثه
> قصة أو رواية الأديب المبدع والراحل العظيم إبراهيم أصلان، تجدد الرغبة في أن نعيش حياة أفضل بوعي أوسع، كما يكرر دائماً، هذه فلسفتها بكل بساطة وهذه رؤيتها النقدية العفوية. قدمها أصلان في كتبه السردية بكل عفوية وهدوء وجمال وعمق. هذا الفنان المبدع فعلاً، الذي تحولت القصة الإيحائية العميقة التي يكتبها، فجأة، إلى رواية، رحل، فجأة أيضاً، بعد أن ترك لنا «خلوة الغلبان» و «شيء من هذا القبيل» و«حكايات من فضل الله عثمان»، وهي كتبه الفنية الأدبية السردية العظيمة غير المصنفة التي سارت خطواتها في كل حارات القاهرة على مدى نصف قرن من الإبداع، إضافة إلى رواياته وكتبه القصصية المعروفة.
جميع كتابات إبراهيم أصلان في المقالة والقصة والرواية وحتى حكاياته الشفهية العذبة التي أمتعتنا كثيراً، كانت في المنطقة الوسطى، ما بين الرواية والقصة، أو ما بين السرد والشعر الإيحائي، أو ما بين اليقظة والحلم، دائماً إيحاءات في المنطقة الوسطى، لكنها ليست محايدة وليست مباشرة... إذ صاغ بأسلوب مختلف وعميق من المشاهد اليومية ومتاعبها ومباهجها القليلة، لحظات سردية غاية في البساطة وغاية في العمق أيضاً، ذلك حين يقوم هذا الكاتب الفنان بالقبض على المشهد السردي لحظة حدوثه فعلاً، حتى لو كانت هذه اللحظة في عمر إبراهيم أصلان، إنها محاولة القبض على الزمن، أو محاولة إيقافه ربما.
فهد العتيق
صوت متفرد
> هذا رجل معجون بطينة أرض مصر، ومية نيل مصر الزلال الطيبة، وهواء مصر، وشجرها وعصافيرها وطيبة أهلها ونخوتهم. هذا رجل مصري خالص حتى النخاع، بصدقه ونبله وصوته وابتسامته وكلمته وكرامته وإخلاصه وترفعه وقهره وثقافته وإبداعه.
إبراهيم أصلان، صوت متفرد على الساحة الإبداعية العربية في القصة والرواية، وتفرده بشخصه ومسلكه الإنساني، في هذا الزمن الفقير والملتبس، يضيف الى تفرده الإبداعي الكثير الكثير، ويجعل من فقده حادثاً مؤلماً، يمضّ في القلب. «تعلمت تكثيف اللغة في حضن الناس الغلابة». هكذا أسرني إبراهيم مرة، وأخبرني أن عمله كموظف في قسم البرقيات البريدية، وحبه لمساعدة الناس الفقراء، أبناء جلدته، جعله يطلب منهم الاختصار في كلمات البرقية، كي لا يحملهم فوق طاقتهم. وتبتسم عيناه لي، يضيف قائلاً: «اللغة تحيا بين الناس، وعلينا أن نتعلم منهم الأجمل». لأن إبراهيم أصلان ينطوي على روح كريمة، وهدف غالٍ نبيل، فلقد عاش كالنسمة، لكنه في الوقت نفسه كان يمتلك من خبرة الحياة وعمق الثقافة وسعة الاطلاع ما يجعل الحديث معه متعة، وقراءة كتبه فائدة كبيرة، وتتبع عوالمه إضافة مهمة لحياة القارئ.
طالب الرفاعي
علامة مهمة
> بالطبع أنا في غاية الحزن، وأعتقد أن وفاة الصديق الروائي الرائع إبراهيم أصلان، إحدى الخسارات الكبرى، للكتابة ولغير الكتابة، فقد كان من الشخصيات التي صنعت مجداً، وعاشت في هدوء بعيداً من الزخرفة التي تصنعها الشهرة، أعتقد أن إبراهيم كان من أكثر الناس موهبة، من نوع تلك المواهب التي يمكن قراءتها في العيون، ومنذ بداياته في «مالك الحزين» و «يوسف والرداء»، إلى كتاباته اللاحقة، مثل «وردية ليل»، و «عصافير النيل»، لم يتنازل أصلان عن ضخ الجمال في كل ما يكتب، الفكرة قد تبدو عادية، لكن قراءتها قصة لأصلان، تمنحها اللاعادية حد الإبهار. ذكاء كبير، ودرجة عالية من الثقافة، أعتبرها مثالية. أتذكر حين أهديته روايتي الأولى «كرمكول» عام ١٩٨٨، لم يحتف بي فقط، لكنه اشترى منها نسخاً عدة وزعها على قراء كثيرين، تماماً مثلما فعل محمد مستجاب. منذ شهر التقيت أصلان في الشارقة، كان جميلاً كعادته، جلسنا على شرفة فندق «ميلينيوم» لساعات، وكان عادياً في وجهه وتنفسه، لم ألحظ عليه شبهة غياب سيحدث. وكان أيضاً يمارس السخرية كما يمارسها دائماً، وأبدى انزعاجاً من مصور لإحدى المجلات التقط له عشرات الصور.
أمير تاج السر
الأرستقراطي الجميل
> هناك أشخاص يحتلّون قلوبَنا من دون أعمارهم، يدخلونها متخفّفين من كل ما يجمعهم بالآخرين، فإذا بهم حين يغادرون يباغتوننا، ولا يعزّينا قطّ أن نكتشف أنهم لم يرحلوا عنّا مبكرين.
كان إبراهيم أصلان استثنائياً، أديباً وإنساناً. هكذا كنت أنا أراه. كالخارج من كتابٍ أو من عملٍ مسرحيّ، منفرداً، دانياً ونائياً، مثلما تكون الشخصيات التي هي مزيج من الأهل ومن أبطال الحكايات. وكان من القلائل الذين يجعلون أهلَ مصر في مخيّلتي، سكّانَ عالمٍ على حدة، وناسَ معرفة وسعة وسخاء.
لم أعرف صامتاً بقدره ومتواصلاً بقدره، مُقِلاً بقدره وصائباً كريماً بقدره، سلس الابتسامة، لطيف الحزن، سمحاً وودوداً.
كأنه الأخير. لا بل هو حتماً الأخير.
وداعاً أيها الارستقراطي الجميل.
نجوى بركات
***
لا... يا شيخ؟!
الإثنين, 09 يناير 2012
 يشـــاركني أصــدقاء إبراهيم أصلان بأنه يملأ حياتهم بهجة، حين يصمت سامعاً وحين يعلّق موجزاً أو يستطرد ناسجاً مشـــهداً من كلام الجـــلسة. رجل حكاية بلا حدود، بسرد محدود يكتفي بالإشارة ويترك المجال للقراء.
يشـــاركني أصــدقاء إبراهيم أصلان بأنه يملأ حياتهم بهجة، حين يصمت سامعاً وحين يعلّق موجزاً أو يستطرد ناسجاً مشـــهداً من كلام الجـــلسة. رجل حكاية بلا حدود، بسرد محدود يكتفي بالإشارة ويترك المجال للقراء.
حين أحدثه وجهاً لوجه أو عبر الهاتف كانت لازمة كلامه: «لا يا شيخ»، مستغرباً في ما يشبه السؤال.
رجل الدهشة أمام المشاهد والأحداث والأفكار، تتخيل معه أن كائنات العالم وأشياءه جديدة كأنها خلقت للتوّ، وأنها تصلح في أي وقت لنستلهم منها الحكايات التي تدهش.
هل يفتح عينيه حيث هو الآن قائلاً: لا يا شيخ؟
إبراهيم أصلان ابن القاهرة الألفية كان يجددها في عينيه فلا يبقى شيء قديماً، من جامع السلطان حسن إلى الأهرامات. كل ما نراه جديد حين نفتح عيوننا جيداً ونصيخ السمع لأصوات الناس وحكاياتهم السائلة مثل نهر النيل، بل يمكننا أن نسمع صوت الحجر ومنحنيات الشوارع القديمة إذا أحسنّا توجيه آذاننا إلى مصادر الأصوات.
لم يكتب كل ما رأى وكل ما سمع، كان يتخير الأكثر تلاؤماً مع عاطفته وشاعريته، بل الأكثر انسجاماً مع فكره المنحاز إلى الفقراء. كان المشهد التعبيري لبيئاتهم أكثر إيحاء لديه من بيئة الأغنياء التي تشبه صوراً في مجلة أجنبية تحتاج إلى مترجم.
بذلك يبدو أصلان معلماً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة رجوعاً إلى ما قبل السيد المسيح. ومصر التي يستهلكها السائح في أيام وحتى في أشهر، تعجز أعمار البشر في أحقابهم المتلاحقة عن استهلاكها إذا شاهدوها بعيون مثل عيني إبراهيم أصلان.
«لا... يا شيخ!؟»، تكفي الدهشة لتتفجر ينابيع الأشياء أمامنا ونكتب أقل مما يتوفر لنا أن نكتب.
وعن إبراهيم أصلان الكثير. رؤيته هو البوسطجي لبشر فارس، رائد الرمزية في الشعر العربي، وهو يتلقى الرسالة من باب بيته الموارب في حي غاردن سيتي، حيث يرى أصلان مكتبة عامرة تمتد حتى آخر الرواق. ورؤيته لرفعت الجمال (الجاسوس المصري في إسرائيل الذي سمّي في الرواية والمسلسل التلفزيوني رأفت الهجان) عند باب محله حيث يبيع راديوات وأدوات كهربائية، كان الجاسوس قبل إرساله إلى إسرائيل أنيقاً، لكن إبراهيم أصلان يفك طلسم تلك الأناقة، فالبزة وربطة العنق من قماش رخيص. إنها أناقة الفقراء.
كتب إبراهيم أصلان ما يكفي لذكره في الأدب المصري والأدب العربي، على رغم القول إنه مقل، لكن مشافهاته للأصدقاء كثيرة وتحتاج من يجمعها في كتاب. أين أنت يا شعبان يوسف يا صاحب المروءة، ودليلك المرشد الأمين عمدة القاهرة الأدبي سعيد الكفراوي؟
الحياة- 8-1-2012
**************************
"أماكن أصلان" سكنت فى قلبه بعد أن سكنها
الأحد، 8 يناير 2012
 تميز الكاتب الراحل إبراهيم أصلان فى كتاباته "بالمكان" فهو بالنسبة إليه كان هو البيت والمستقر والحياة، لذلك وجدنا كل أماكنه التى عاش وتربى فيها مستقرة فى قلبه، تطل علينا من نافذة كتابته بتفاصيل مدهشة، فنرى من خلاله نفس المكان الذى نمر عليه يوميا لكن بتفاصيل مختلفة ومدهشة لا يراها سواه، لا لأنه عاش فى هذا المكان، بل لأن هذا المكان هو من عاش بداخل أصلان واستقر فى قلبه.
تميز الكاتب الراحل إبراهيم أصلان فى كتاباته "بالمكان" فهو بالنسبة إليه كان هو البيت والمستقر والحياة، لذلك وجدنا كل أماكنه التى عاش وتربى فيها مستقرة فى قلبه، تطل علينا من نافذة كتابته بتفاصيل مدهشة، فنرى من خلاله نفس المكان الذى نمر عليه يوميا لكن بتفاصيل مختلفة ومدهشة لا يراها سواه، لا لأنه عاش فى هذا المكان، بل لأن هذا المكان هو من عاش بداخل أصلان واستقر فى قلبه.
هنا نمر على "إمبابة والكيت كات والوراق" يوميا، إلا أن أصلان كان يكشف لنا شيئاً فشيئاً عن قدرته فى كشف تفاصيلهما وكشف علاقتنا – نحن- بهما، لنكتشف أننا عبرنا خفافاً لكنه أقام معهما وفيهما، حاورهما فكشّفتا له عن أسرارها وأسرارنا، ربما تتغير الأماكن وحتما تغير من ساكنيها ولكن من يصنع لها ذاكرتها يظل مقيماً بداخلها، فالأحياء بالنسبة إليه ليست مجرد فضاءً شكل فيه أصلان عالمه الخاص فحسب بل أستطاع أن يشارك شخوصه رؤيتهم وأن يتفاعل معهم، أستطاع أن يلمس انعكاسات الأفكار والقضايا الكبرى على سلوكيات الإنسان الذى يتشكل فى رحم هذا المكان.
الكاتب فى وجهة نظر "أصلان" هو ذلك الشاهد الأمين الذى يراقب الإنسان ويتأمله وليس هو ذاك الذى يطلق أحكاما عليه بل لابد له أن يتفاعل معه، وهكذا كانت قراءة المكان ركنا أساسياً وطقساً من طقوس كتابته للإنسان وخطوة فى اتجاهه، فلم يكتب بدون تصور عن جغرافيا المكان الذى تدور فيه الأحداث لأنه كان يسعى دائما لتجسيد حالة، متكئاً على المكان كتجربة حية تتيح للكاتب أن ينمو وتنمو شخوصه معها .
وفى حوار سابق له قال أصلان: إنه لو كان هناك بيت قديم حتى ولو مهجور فهو بالتأكيد يختزن أرواح من كانوا يعيشون فيه ،سوف نجد أثار أقدامهم فى كل مكان، سوف نجد الكثير والكثير، مجرد علبة قديمة تختزن زمن وتخزن جمالية معينة وقيمة معينة، ويضيف: أنا مثلا أعتمد على عينى فى الكتابة، الأشياء والأمكنة أساسية بالنسبة لى فى علاقتى بالزمن، مثلا اعرف أننى تقدمت فى العمر من خلال تطلعى فى وجوه الأصدقاء من مرورى بالحوارى القديمة التى تربيت فيها أيضا لأننى لا أعتمد على حدوتة فيبقى إحساسى بجغرافية النص الذى أكتبه أساسى فى إحكام عملية البناء لأن الحدوتة تقوم بعملية كساء الهيكل العظمي، ولابد أن يكون لدىّ جغرافيا النص الذى أعمله حتى ولو لم أكتبها ولكن لابد من أن تكون واضحة جدا داخلي، هذا على المستوى الفني.
والمكان عند "أصلان" شعبياً بامتياز هو لا يعبر عن حالة الشريحة الواسعة من الشعب المصرى فحسب بل أنه يقرأها ويعيد أنتاج العلاقات التى تفرضها تلك الأماكن على ساكنيها "الكيت كات أو إمبابة" حيث تتداخل بنايات المساكن وتستند بعضها على البعض الأخر فى مواجهة الشقاء والطموح، تلك التى تفرض على السكان ضرورة التعايش، وتؤكد على حتمية المشاركة فى التفاصيل اليومية، لقد أمكننا أن نعرف دقائق التفاصيل لشخصيات "مالك الحزين" حينما بعثرها الشيخ حسنى الكفيف فى الهواء، كما أننا ظللنا طوال شارع فضل الله عثمان الذى ظهر فى معظم أعمال أصلان نبحث عن شيء ما ولكننا دائما ما نكتشف الدهشة طازجة ونعيد ترتيب علاقاتنا الإنسانية وعلاقاتنا مع الأماكن ونعيد اكتشاف ذاكرتنا الخاصة بها
اليوم السابع -7-1-2012
********
"مالك الحزين" بلا أب (1935 - 2012)
وداعـا يا عـم إبرهيـم أصـلان
2012-01-08
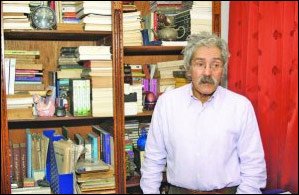 غاب أمس الكاتب المصري الكبير ابرهيم أصلان عن سبعة وسبعين عاماً، تاركاً وراءه "مالك الحزين"، و"بحيرة المساء"، و"عصافير النيل"، و"حكايات فضل الله عثمان"، و"خلوة الغلبان"، و"وردية ليل"، وسواها، يتيمة الأب.
غاب أمس الكاتب المصري الكبير ابرهيم أصلان عن سبعة وسبعين عاماً، تاركاً وراءه "مالك الحزين"، و"بحيرة المساء"، و"عصافير النيل"، و"حكايات فضل الله عثمان"، و"خلوة الغلبان"، و"وردية ليل"، وسواها، يتيمة الأب.
فور تخرجي في جامعة القاهرة عام 1992 التحقت بالعمل متدرباً في مجلة "أدب ونقد"، من طريق صديقي الشاعر حلمي سالم، الذي كان مديرا لتحريرها في ذلك الوقت. في الأشهر القليلة التي مكثتها هناك كلفني حلمي إعداد بعض الملفات، منها ملف عن إبرهيم أصلان، قمت بالعمل فيه مع زميلة لي. لا أذكر المناسبة تحديداً، وأظن أن الملف كان "يا ورد مين يشتريك"، أو شيئاً من هذا القبيل، على علاقة بالورد. كان هذا أول لقاء موسع لي بعالم أصلان. في الجامعة كنت قد قرأت "بحيرة المساء" و"مالك الحزين" مدفوعاً بإيعاز من صديقي الشاعر والروائي ياسر عبد اللطيف في ما أذكر. التقيت بعض الكتّاب كي أتحصل منهم على شهادات عن أصلان وكان من بينهم سعيد الكفراوي الذي كتب شهادة مؤثرة ومليئة بالحب عن صديقه، هي التي بقيت عالقة في ذاكرتي من يومها، ذكر في إحدى فقراتها الثلاث موقفاً رآه رأي العين في بغداد، حيث كانوا جالسين في بهو الفندق ودخل عليهم رجل يرتدي جلباباً وعمّة سودانية ويصيح بصوت عال: "أين إبرهيم أصلان؟"، وعندما أشاروا إلى موضعه ذهب إليه الرجل واحتضنه عميقاً ومدحه بكلمات كثيرة. لم يكن ذلك الرجل سوى الروائي السوداني الطيب صالح.
في العام 1993 التحقتُ بالعمل مع صديقي الفنان عادل السيوي في مجلة "عين" للفنون البصرية بعدما رشحني صديقي هشام قشطة للعمل هناك وقدّمني الى السيوي. هناك كنت على موعد آخر مع أصلان، ولكن هذه المرة التقيتُ به شخصيا. كان هناك ملف كبير في المجلة يتناول علاقة الكتّاب بالفن التشكيلي، وكان عليّ أن ألتقي الكتّاب والشعراء كي أستطلع آراءهم. ذهبت إلى إبرهيم أصلان في مكتب جريدة "الحياة" في القاهرة، حيث يعمل، وعرضت عليه الأمر، ولعلّي ذهبت إليه متأخراً، فقد كان على وشك الخروج، ومن ثم رافقته إلى وسط المدينة القريب وقد هالني تواضعه الشديد وحماسته في الحديث عن الشعر وتوقفه مرات عدة في الطريق وهو يتكلم. كتب في علاقته بالفنون التشكيلية كلمات قليلة أحبّ أن أستعيدها هنا لأنها تكشف عن فهمه للأدب والكتابة، وقد قال فيها متحدثا عن المثّال الشهير جاكوميتي: "ولقد أحسست أن هذا المثّال يقدم حلا لما أراه في الأدب لأنه قائم على مبدأ الاستبعاد، فهو يستبعد ما يمكن استبعاده والباقي قادر على جلب المستبعد، فالمستبعد أكثر حضورا من الباقي، وهذا مبدأ أساسي في عملي فأنا أكتب القليل الذي يحمل وراءه الكثير من غير أن أقوله لكنه حاضر أيضا في هذا القليل، ومعنى هذا أنني أتصور أن الفنان لا يعبّر عن تجربته ولكن يعبّر بتجربته".
المرة الأخيرة التي التقينا فيها كانت في معرض القاهرة للكتاب عام 2005 وكان أصلان يمضي بصحبة عادل السيوي وكنت جالسا مع صديقي الشاعر كاظم جهاد والتقينا جميعا وأمضينا وقتا طيباً للغاية. يومذاك أخبرته أن مقالاته في "الأهرام" يوم الثلثاء هي زادي الأسبوعي في إسبانيا وأنني في غاية الإعجاب بها ولا أفوّت واحدة منها. المفاجأة أنه خجل تماماً وقام بتغيير الموضوع وسألني عن المستعربة ميلاغروس نوين مترجمة "مالك الحزين" إلى الإسبانية، ثم دخّن سيجارة واحدة ومضى بعدها وحده، فيما بقينا نحن جالسين. أذكر أن عادل السيوي قال ساعتها: إن وجود أصلان في ذاته يشيع البهجة وإنه من الأناس القلائل يجعلونك تحب الحياة".
تبادلت إيميلاً واحداً مع الراحل الكبير، وكانوا قد قاموا بإجراء عملية له في القلب، كتب بعدها في "الأهرام" عن كميات باقات الورود التي كانت تصله في المستشفى وحديث الناس عن الرجل "المهم" الذي تأتيه كل هذه الورود من دون أن يعرفوا أنه هو. أرسلت له إيميلاً واحداً فقط متمنياً له سرعة الشفاء ومعبّرا له عن محبتي. لم أنتظر رداً في الحقيقة ولكن جاءني ردّه بعدها بفترة شاكراً ومحييا.
أخبرني الصديق الشاعر محمد بدوي عضو لجنة مكتبة الأسرة برئاسة إبرهيم أصلان أن اللجنة اختارت ديواني الأخير لينشر في الدفعة الأولى من الإصدارات الجديدة للمكتبة وكان الصديق الشاعر منتصر عبد الموجود هو أول من أبلغني بالخبر بعد قراءته له في "أخبار الأدب". كان الخبر رائعا بالنسبة إليَّ، فأن يكون أصلان رئيسا للجنة مكتبة الأسرة وأن تكون الأولى بعد الثورة، وحيث لن نجد صورة لزوجة المخلوع على الغلف الخلفية، فهذا يعني الكثير والكثير. لكن القدر لم يمهل أصلان رؤية الإصدارات الأولى مطبوعة.
الكلمات الأخيرة التي كتبها، في "الأهرام"، عن صديق عمره خيري شلبي الذي رحل هو الآخر منذ شهور قليلة، كأنه كتبها من أجل نفسه أيضا: "الآن، وقد مرت من الأيام بعضها، بدأ يخايلني متأنقا على مهل، ووجدتني، ويا للعجب، أستقبله مبتسما، وأستعيد به أوقاتا لا تنقضي من البهجة".
نبذة
ولد ابرهيم أصلان في طنطا في محافظة الغربية عام 1935. انتقلت أسرته للعيش في حي امبابة الشهير في القاهرة، الذي ألهمه روايتيه الشهيرتين "مالك الحزين" و"عصافير النيل". بعد الدراسة عمل بوسطجياً في هيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو العمل الذي ألهمه روايته الشهيرة "وردية ليل". بدأ الكتابة والنشر عام 1965.
في عام 1987 عمل نائباً لرئيس تحرير سلسلة "مختارات فصول"، وفي عام 1997 رئيساً لتحرير سلسلة "آفاق الكتابة"، ثم استقال منها عام 1999 بعد الأزمة التي أثارها نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدر التي اتهمت بأنها تتضمن استفزازاً للدين الإسلامي. عمل أصلان في القسم الأدبي في جريدة "الحياة" منذ بداية التسعينات حتى رحيله.
تميز أدبه بوفائه للحياة، وعرف عنه إخلاصه لوصية الكاتب الأميركي ارنست همنغواي في الكتابة عما يعيشه ويعرفه، وعما ينشغل به من تفاصيل صغيرة عبر "الكتابة بالمحو"، في لغة مختزلة بعيدة عن الحشو والتصنع.
بدأ أصلان تجربته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، وأولاها "بحيرة المساء" التي لفتت انتباه الكاتب الكبير يحيى حقي. ثم لقيت باكورته الروائية، "مالك الحزين" صدى واسعاً في أوساط المثقفين المصريين والعرب، واختيرت واحدة من أهم مئة رواية عربية، وقد استوحى منها المخرج داوود عبد السيد فيلمه "الكيت كات"، الذي اختير هو الآخر من بين أهم مئة فيلم أنتجتها السينما المصرية منذ انطلاقتها قبل أكثر من 112 عاماً. كتب في القصة: "بحيرة المساء"، يوسف والرداء"، و"وردية ليل". وفي الرواية: "مالك الحزين"، و"عصافير الليل"، و"خلوة الغلبان"، و"حكايات من فضل الله عثمان"، و"شيء من هذا القبيل".
حاز جوائز عدة بينها جائزة الدولة التقديرية في مصر وجائزة كافافيس الدولية.
النهار-2012