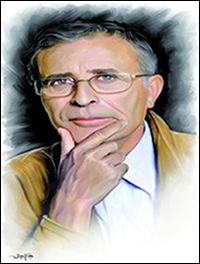
المتفرّد – المتعدّد، هو التوصيف المزدوج، البكر، لحالة عبد الكبير الخطيبي الإبداعية ذات الاستثناء المضاعف.
هذا الممتهن لقياس المساحات كما يحبّذ أن ينعت نفسه، علامة فكرية لا مألوفة، منفلتة وخارجة عن خطية منظومة الإنتاج المعرفي والأدبي والفكري، المغربي والعربي في آن، علامة ذات قيمة سامقة، حظيت بتقدير خاص ضمن الثقافة الفرنسية بشكل خاص، والغربية بشكل عام. يكفي أن نلمح لذلك بما كتبه عنه رولان بارث وجاك دريدا على سبيل المثال لا الحصر، يقول رولان بارث في شهادته الموسومة بـ «ما أدين به لعبد الكبير الخطيبي»: (إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصور، الأدلة، الآثار الحروف، العلامات. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديدا، يخلخل معرفتي، لأنه يغير مكان كل هذه الأشياء، يأخذني بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحس كأني في الطرف الأقصى من نفسي).
ويقول جاك دريدا: (مثلي مثل الكثيرين، أعتبر الخطيبي أحد الكتاب والشعراء والمفكرين المعاصرين العمالقة في اللغة الفرنسية، وأتأسف لكونه لا يُدرَّس بالشكل الذي يستحقه في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية).
هي حفاوة غربية أثمرت نيله لجوائز ذات صيت عالمي، كجائزة لازيو الإيطالية عن مجمل أعماله الأدبية، وجائزة الأكاديمية الفرنسية وجائزة أهل الأدب.
فيما لم ينتبه الشرق إلى هذه العلامة النادرة، ولم يكتشف قوة وعمق وخطورة فسيفسائها الإبداعي والجمالي، كما لم يقرأها النقد بعد ويوليها الاهتمام الذكي اللائق بها.
البناء الفسيفسائي العجيب لعبد الكبير الخطيبي يرتهن إلى مغامرة مسكونة بنداء الحدود القصوى، أو مخاطرة تدمن الترحال فيما وراء هذه الحدود بالأحرى، فيصعب القبض على اسمه المتعدد والمتشعب ضمن تصنيف أحادي أو تكثيفه واختزاله ضمن تحديد أجناسي ثابت ومستقر، فهو:
- أولاً، مفكر سوسيولوجي وأنثروبولوجي، يمكن أن يندرج عمله الفكري الجسور في حقل الفلسفة بجدارة، بحسب مؤلفاته: (دموع سارتر/ القيء الأبيض: الصهيونية والضمير الشقي/ النقد المزدوج/ المغرب المتعدّد/ المفارقة الصهيونية/ السياسة والتسامح/ المغرب العربي وقضايا الحداثة).
- ثانياً، مفكك رموز ومهووس علامات، يمكن أن يندرج عمله النقدي في حقل السيميولوجيا (الاسم العربي الجريح/ فن الخط العربي...).
- ثالثاً، ناقد للرواية والسرد يمكن أن يندرج عمله في حقل النقد الأدبي والفني (أنطولوجيا أدب شمال أفريقيا الناطق بالفرنسية/ الرواية المغاربية/ الكُتّاب المغاربة من عهد الحماية إلى 1965/ تجليات الأجنبي في الأدب الفرنسي/ الفرنكوفونية واللغات الأدبية/ الجسد الشرقي «ألبوم صور»).
- رابعاً، روائي أصدر أكثر من عنوان سردي: (الذاكرة الموشومة/ كتاب الدّم/ ألف ليلة وثلاث ليال/ حب مزدوج اللغة/ صيف في استوكهولم/ ثلاثية الرباط).
- خامساً، شاعر صدره له: (المناضل الطبقي على الطريقة التاوية/ إهداء إلى السنة المقبلة/ من فوق الكتف/ ظلال يابانية).
- سادساً، مسرحي صدر له: (موت الفنانين/ النبي المقنّع).
فضلاً عن اهتمامات ثقافية أخرى، ساهم في إثراء أجناسها برؤى استثنائية وملاحظات مربكة ومستقبلية ومساءلات مخلخلة للأنساق، كأطروحته أو نظريته في اللغة والهوية والتقنية والميتافيزيقا... الخ.
وإيمانا منا بضرورة قراءة واكتشاف مشروع عبد الكبير الخطيبي الفكري والأدبي والنقدي، يفرد «الاتحاد الثقافي» ملفاً خاصاً، يضيء تخومية وخرائطية عمل هذا الكاتب الأريب، من خلال الوقوف عند الوجوه المتعددة لإبداعيته: فكراً وفلسفة ونقداً وسرداً وشعراً.
***

ربما يتعذر الحديث عن عبد الكبير الخطيبي و«القبض» عليه. فهو من الكتاب الذين يصعب تصنيفهم. وربما لا يرجع ذلك فحسب لتعدد اهتماماته، وإنما بالأولى للتعدد الذي يطبع كل اهتمام من اهتماماته. فهو يتموقع دائماً «بين ــ بين». وهذه البيْنية تكاد تطبع جميع أعماله. وقد عبر عنها ربما أحسن تعبير في المحاضرة التي كان ألقاها سنة 1978 بكلية الآداب في الرباط، والتي نشرت في مجلة أقلام المغربية، حيث قال: «حقا، يكون المحاضر غربياً وشرقياً في مسألة المغرب. لماذا؟ لأن وجود المغرب هو بين الغرب والشرق، بين المغرب والمشرق، بين التاريخ وما قبل التاريخ، بين الميتافيزيقا وما يناقضها، بين العرب والبربر، بين الدين والسحر، بين القبيلة والإقطاعية من جهة، والرأسمالية من جهة أخرى، بين ــ بين..».
من هنا تلك الدعوة الملحاحة إلى «نقد مزدوج» يضع نفسه بين عدة «تخصصات»، وينهج طرقاً متعددة تجد التعبير عنها في كتابة متنوعة الواجهات تتردد بين النقد السوسيولوجي والبحث السيميولوجي والكتابة الأدبية.
ولعل الوصف الذي يطلقه الخطيبي على الاستراتيجية التي تتبعها أبحاثه خير معبر عن ذلك. فهو يدعو، كما نعلم، إلى «نقد مزدوج» يقوض أسس السيادة ويعيد النظر في أصوله وأسسه. لا تعني الازدواجية هنا أن النقد ينصب على الميتافيزيقا الغربية ثم على نظيرتها الإسلامية. إنه، على العكس من ذلك يتخذ طريقه بين - بين، بين هذه وتلك، وهو، كما يقول «مجابهة بين الميتافيزيقا الغربية والميتافيزيقا الإسلامية». يريد الخطيبي، على غرار جاك دريدا، أن يعيد النظر «في جميع الأزواج التي أقامتها الفلسفة، وتتغذى منها خطاباتنا، لا لكي يرى فيها قضاء على التقابل، وإنما علامة على ضرورة، بحيث يظهر كل طرف من أطراف الزوج كمخالف للآخر، ويبدو على أنه الآخر ذاته في إرجائه»..
فبما نحن عالم ثالث ليس علينا أن نسلك إلا مسلكاً ثالثاً ليس هو مسلك العقل ولا مسلك اللاعقل كما فكر فيهما الغرب، وإنما خلخلة مزدوجة تقول «بفكر متعدد لا يختزل الآخرين، أفراداً وجماعات، ولا يضمهم إلى دائرة اكتفائه الذاتي. إذ إن على الفكر أن يتجنب هذا الاختزال، إذا هو أراد ألا ينظر إلى مجاله الخاص على أنه الكون في مجموعه، ذلك الكون الذي ينخره التباعد، وتتوزعه الهوامش والأسئلة الصامتة». فالمعرفة العربية لا تستطيع أن تتنصل من أسسها اللاهوتية والتيوقراطية إلا بفضل قطيعة لن تكون كذلك ما لم تكن مزدوجة «لتقابل المنظومة المعرفية الغربية بخارجها اللامُفَكَّر فيه، وتعمل، في الوقت ذاته، على تجذير الهامش، ليس فقط عن طريق فكر يستعمل اللغة العربية أداة، وإنما بالاتجاه نحو فكر مغاير، يتكلم عدة لغات، ويصغي لأيّ كلام أنّى كان مصدره». إنه إذن فكر يتسلل إلى الكيانات من فجواتها، ويتخذ «موقعه» على هامشها. من غير أن تعني الازدواجية أن النقد ينصبّ على كل طرف على حدة، إذ إنه يتخذ طريقه، على العكس من ذلك، بين هذه وتلك، إنه مجابهة بين الميتافيزيقتين.
لا ينبغي أن نفهم من هذا «البرنامج» كتابة جديدة لتارخ الفلسفة الغربية ونظيرتها الإسلامية. فالخطيبي لا ينشغل بإعادة النظر في تواريخ الفلسفة، وإنما يرمي إلى تقويض تاريخ الميتافيزيقا بالمعنى الهايدغري للكلمة، أي تاريخ الوجود. وهو تقويض لا يتم من منبر كرسيّ الفلسفة داخل مؤسسة جامعية ووفق القواعد الأكاديمية، وإنما عن طريق عقد «حوار مع أكثر أنواع الفكر والتمرّدات جذرية، تلك الأنواع التي هزّت الغرب وما زالت تهزّه»، وبفضل قراءة سيميولوجية للخط العربي والفن الإسلامي والوشم، ونهج كتابة أدبية تطرق مسألة الشر والحب والتصوّف، واللغة والموت، وصراع الأضداد: هنا يلتقي الخطيبي بالميتافيزيقا وليس في النصوص الكلاسيكية، إنه يلتقي بكل بالموضوعات التي غلفتها الميتافيزيقا بغلافها وقيدتها بقيودها: يلتقي بالمقدس، ليس كموضوع متعال، وإنما كحضور في الفن: «فكثير من الأسئلة المتصلة بالمطلق تتكرر من خلال العلامة الخطية التي تتلألأ فيها تغيرات المقدس عبر تلك الزخارف المتغنية بنشوتها»، يلتقي بمسألة الاختلاف الجنسي حيث تتخذ المرأة موقعها بين الإلهي والبشري، ضمن تدرج المرئي واللامرئي، فهي «مرئي لا مرئي وتحطيم للنظام اللاهوتي»، يلتقي بالتصوف حيث «ينبجس اللامرئي في المرئي ذاته»، يلتقي باللغة، ليس كهوية متوحشة، وإنما في تجربة ازدواجية كمجال لفعل الاختلاف، حيث تتفاعل اللغات ولا ينضاف بعضها إلى بعض، وإنما يحيل إليه ويستدعيه، ويُبقي عليه كخارج»، يلتقي بالمتخيل الإسلامي، لا ليسجنه داخل دائرة العقل، وإنما ليرصد منطقه الخاص، والقوانين المتحكمة فيه، ويلتقي أخيراً بالثقافة الشعبية ليهدم الحاجز بين المكتوب والشفوي، بين الصورة المرسومة والنص، بين الاجتماعي والذهني، فيحرر الجسد من بطانته اللاهوتية، ويعيد النظر فيما رسخته المقاربات الإثنولوجية.
لن ندرك مغزى هذه الاستراتيجية البينية إن نحن بقينا متشبثين بالمفهوم الذي رسخته الميتافيزيقا عن الثنائي وحدة/تعدد. فليست علاقة الوحدة بالتعدد في نظر الخطيبي كعلاقة الكل بالأجزاء، وإنما هي كعلاقة الهوية بالاختلاف. آنئذ لن يعود الاختيار مطروحا بين الهوية ونفيها، وإنما بين هوية مفتوحة على إمكانات متعددة، وأخرى محددة تحديدا أزليا. ستغدو الهوية هنا جمعا يقال على المفرد. إنها، على حد قول دولوز، تركيب جغرافي، وليست نشأة تاريخية. نقرأ في «المغرب أفقاً للفكر»: «لنأخذ الإنسان العربي، وعلى وجه الخصوص الإنسان المغربي، فإننا نلاحظ أنه يحمل في أعماقه كل ماضيه قبل الإسلامي والإسلامي والبربري والعربي والغربي. أهم شيء إذن هو ألا نغفل هذه الهوية المتعددة التي تكوّن هذا الكائن. ومن ناحية أخرى، يجب أن نفكر في الوحدة الممكنة بين هذه العناصر جميعاً. إلا أنها وحدة غير لاهوتية تترك لكل عنصر نصيبه من التميّز، وتتيح بالنسبة للمجموع حرية الحركة». غير أن هذا التعدد، كما قلنا، لا يعطى بسهولة، إذ سرعان ما تغلفه الأيديولوجية لتخفي تناقضاته وتملأ فراغاته، وتجعل منه وحدة متطابقة يذوب فيها الاختلاف: «إن اسم «العرب» هو، من جهة، اسم حضارة اكتملت في عنصرها الميتافيزيقي، غير أن هذا «الاكتمال» لا يعني أن هذه الحضارة ماتت وانقضت، بل هي فحسب عاجزة أن تنهض كفكر». لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذا الاسم هو من جهة أخرى حرب تسميات وأيديولوجيات توضح التعدد الخلاق للعالم العربي، وهو تعدد من شأن الوحدة اللاهوتية أن تغيّبه، فتحجب الوحدة التعددية التي لا تضم هوامشها الخاصة، وإنما تشمل كذلك تقسيم البلدان العربية، ومنها المغرب، إلى شعوب وطبقات.
فالمغرب اسم بصيغة الجمع: «المغرب هنا اسم هذا التباعد، وهذه اللاعودة نحو نموذج لاهوتي، هذا اللارجوع الذي قد يهز أسس المجتمعات المغربية في أسس تكوينها». المغرب إذن هو هذا الفضاء الذي يترك لكل عنصر نصيبه من التميّز، ويسمح للتفرّدات بنصيبها في الوجود. ها هنا تكون الوحدة من الحيوية بحيث تستطيع أن تستوعب التعدّد، ويصبح التعدّد مفهوما باطنيا «يصدّع الوحدة ويضم أطرافها»، فيغدو إنسان التعددية ليس ذاك الذي يحمل عدة جوازات، ويتكلم عدة لغات، وإنما ذلك الكائن السندبادي الذي لا يوجد إلا «بين - بين».
ما أدين به للخطيبي
إنني والخطيبي، نهتم بأشياء واحدة، بالصور، الأدلة، الآثار، الحروف، العلامات. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديداً، يخلخل معرفتي، لأنه يغير مكان هذه الأشكال، كما أراها يأخذني بعيداً عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحس كأني في الطرف الأقصى من نفسي.
إن الخطيبي معاصر، يساهم في هذه التجلية التي تنمو بدخيلتي، وشيئاً فشيئاً أدرك كيف أن المشروع الدلائلي، الذي ساهمت فيه وما أزال، ظل حبيس مقولات الكلّي التي تقعد كل مناهج الغرب منذ أرسطو. كنت أفترض ببراءة، وأنا أسائل بنية الأدلة، أن هذه البنية تبرهن على عمومية ما، تؤكد هوية لم تكن، في العمق، وبسبب المتن، الذي اشتملت عليه، إلا هوية الإنسان «الثقافي» لموطني. والخطيبي يقوم بمعنى ما بالشيء نفسه لحسابه الخاص، إنه يسائل الأدلة التي ستجلي له هوية شعبه. ولكن ليس الشعب واحداً. إن شعبي أنا لم يعد «شعباً فصورة هويته - التي نسميها تقاليده - لم تعد إلا مادة متحفية في متحف التقاليد الشعبية الكائن جنب بوادو بولوني، غير بعيد عن حديقة قديمة للحيوان.
رولان بارت
تطهير
لقد كانت الفلسفة العربية تعرف بطريقتها الخاصة ما نتعلمه الآن من الغرب. فنحن نسينا ألف باء مسألة الوجود والموجود، مسألة الوحدة والاختلاف. وعلى رغم ذلك، فما زلنا نثرثر، دونما خجل، حول استعادة الذات، وحول البعث العربي. فأية استعادة نعني؟ إن انبعاث الفكر هو مصير الأشباح والأموات الذين يخاطبوننا.
إن ما ينبغي علينا أن نقوم به هو أن نتجاوز الصورة المشوهة التي لدينا عن أنفسنا وعن الآخرين، وأن نوسّع من معارفنا ونجعلها متعددة الجوانب الاستراتيجية. علينا أن نطهّر الخطاب التاريخي من المطلقات التي تقيّد الشعب فتجمد الزمان الذي يحياه، والمكان الذي يعيش فيه، والجسد الذي يحيا به.
مركزية غربية
بالتأكيد أن لمساءلة الذات أهمية قصوى لكن مساءلة الذات في مواجهة الآخر تكتسي نفس الأهمية. من هنا بروز مفهوم التمركز حول الذات العرقية ومركزة الخطاب حول الذات، وهو ما ترجمناه عن: ethnocentrisme وlogocentrisme. فالغرب الذي أنتج خطابا، انطلاقاً من نفسه، وبوأه مرتبة العالمية والكونية ينسى أن هذا الخطاب محلي مركزي يكاد يكون قبلياً، إثنياً. من هنا وجب تفكيكه والتحقق من مزالقه، رغم عقلانيته، والحفاظ على اليقظة الدائمة لأنه يتسلل كالأفعى لكل الخطابات المستكينة.
نقد الآخر ونقد الذات
يجب أن ننخرط في نقد جذري للتراث الغربي وبنفس الحدة لتراثنا الوطني. من هنا النقد المزدوج: نقد الآخر ونقد الذات. إعادة النظر في الميتافيزيقا الغربية التي مثلت الأرضية الأساسية للفكر الاستعماري ونقد اللاهوت العربي الإسلامي، الذي طمس الاختلافات وأسكت اللغات المتعددة وهيأ بذلك الطريق للاستعمار. نقد مزدوج يتوجه لهذين الحليفين الاستراتيجيين، وإن بدون شعور منهما، حتى يعري الآليات التي تحرك كليهما. يجب أن نعري الاختلافات ونهتم بالهوامش (الأكراد، الأمازيغ، الأقباط، خصوصاً هامش الهوامش، المرأة).
هذه الميادين هي نفسها التي اهتم بها فلاسفة التفكيكية الذين اعتبروا أن الحداثة بتركيزها على كل ما هو واعٍ وعقلي نسيت أن الإنسان ليس عقلاً فقط وأن له من الممارسات التي قد تخرج على هذا النطاق، لذا وجب الاهتمام بها والبحث عنها في الجسد، في الفن.
***

من المنصف ابتداء الإشارة إلى أن المساحة النقدية مدعوة للإقرار بمحدودية قدرتها على استيعاب قامة الخطيبي ومنجزه المختلف هذا الاختلاف العميق الذي دفع الخطيبي ثمنه نكراناً وتجاهلاً في رحيله الصامت الذي شكل إدانة كبيرة لثقافة النكوص.
يكتب المفكر الخطيبي ونتذكر معه كلام الشاعر الفلسطيني الراحل مصطفى مراد الذي قال:
«أن تكون إنساناً.. يعني أن تولد كل يوم.. لأنهم سيقتلونك كل يوم». فقد صار حلما أن تحمي حدود إنسانيتك وتحصن المواطن فيك من مس السياسة الملتبسة ومن قصف اليومي الذي يحرمك بطريقة مبتكرة من أن تكون علاقتك سوية بالحياة، صار حلما أن تصاحب الضوء دون أن تخشى خيانة في الدرب، أو شهوة غدر في مفترق أسئلة.
حفريّات
يؤسس الخطيبي حفرياته في اتجاهات مختلفة لكنها محكومة بنسقية ناظمة تكسب منجزه أهمية بالغة وقد اخترت أن أجعلها خمسة أصابع تشكل حركة يد راحتها السوسيولوجيا وأصابعها ترفد من السيميولوجيا والأنتربولوجيا جوهر اشتغالها.
ينهض نقد الخطيبي على عملية ذكية تهدف إلى بناء المعنى الذي استنزفته إرادات القوة التي حكمت تداوله مبتغيا من ذلك عمليتين متجاورتين: عملية إفراغ عبر سيرورة هدم وعملية إعادة بناء من خلال قراءة مختلفة للمرجعيات. ذلك أن جزءا كبيرا من أزمة الخطاب كامنة في استعمال كثير من المعاني ببراءة منقطعة النظير متجاهلة بقصدية ماكرة روائح المرجعيات وطعوم التنسيب.
وكمثال على هذه القراءة الذكية للعلامة نقدم كلمة شعب حيث تتجاور في القراءة مسافتان، مسافة شعور اللغة ومسافة لا شعورها حيث يمارس الخطيبي تمرينا لسانيا، وهو ينتبه ابتداء لكون دلالة كلمة شعب تحيل على المتفرق والمقسم، الشعب تفريق تراتبية اختلاف عوض وحدة وكلية. هذه القراءة التي تفطن لمكر اللغة وللخفي منها والمعلن هي التي مكنت الخطيبي من بناء حفريات دلالية وازنة فهو يستخلص من ذلك أن الشعب هو تاريخ قمع وعدم إمكانية اختزال، قمع عبر ثقافة عربية كلاسيكية أرستقراطية أنزلت الشعب في حقل السحر والخرافة والوثنية المتنكرة وعدم إمكانية الاختزال لفائدة خطاب لاهوتي. غير أن ما يميز الشعب المغربي حسب الخطيبي هو قدرة ثقافته (الشعبية) على تغذية الدلالات المنذورة للنسيان بتهريبها عبر سفينة الجسد من خلال الكتابة (الوشم) وهو ما سنشرحه لاحقا. وقبل ذلك يهمنا أن نعرض لمسارين مترابطين مسار نقده المزدوج ومسار قراءة الهوية.
يروم النقد المزدوج في مداه الاستراتيجي تفكيك كل تيولوجيا الأصل وهو مزدوج من حيث صدوره عن لغتين وأرضيتين تاريخيتين وأفقين ميتافيزيقيين مختلفين وبينهما يبحث الخطيبي عن إمكانية تجديد هواء الأسئلة المطلوبة من خلال التشكيك في أصالة النحن وفي مدى وضوح الآخر.
الهوية والاختلاف
سؤال الهوية والاختلاف الذي امتد من جيل ما قبل سقراط، ذلك الجيل الذي كان محط إعجاب الخطيبي وحتى مارتن هايدغر وجماعة التفكيكيين الشباب ومروراً بالميتافيزيقا الغربية كان دائما محط سؤال وموضع حيرة.
يسترفد الخطيبي من فرانز فانون نداءه الشهير: «أيها الرفاق لقد ولى عهد اللعبة الأوربية فلنبحث عن بديل ليطرح سؤال الاختلاف المتوحش»، ذلك أنه «إذا لم يعد الغرب مجرد ذلك الوهم المتولد عن فزعنا فيتبقى علينا أن نعيد النظر في كل شيء مهما كلفنا ذلك»، ليعتبر ذلك الانفصال الزائف الذي يرمي بالآخر في خارج المطلق اختلافا متوحشا، اختلافاً يضيع في متاهات الهويات الحمقاء تلك الهويات التي سيسميها أمين معلوف الهويات القاتلة، يطرح الخطيبي إذن سؤال الهوية في سياق هدم غايته تغيير زوايا النظر، ذلك أن الأحادية الواثقة من نفسها هي التي أضاعت مفتاح إمكانية الوجود، الوجود الذي لا يحتاج للتحيز لكي يكون. تحت السماء الروحية المسماة ميتافيزيقا كبر التراث وشكلت صورته أزمة للهوية استضماراً لذلك يصح أن نعتبر الخطيبي أحد مؤسسي صورة الهوية التي تمشي، الهوية التي لا تتوقف وفي حركتها تنبجس الأسئلة التي تحتاجها الذات كي لا تتعفن ولن يتحقق ذلك إلا في المسافة بين نحن ملغومة بوهمها وغير مشكوك فيها وبين آخر تشكل في وعينا بصورة مفصولة عنا حتى صار الشرق غربا صعب المعالجة.
يقول مطاع صفدي في حديثه عن الانبناء للمجهول والانبناء للمغيوب: «دعوة الزوال كانت أيديولوجيا السياسة والثقافة والسلوك، فكان نداء الرحيل عن العالم عقلا ووعيا وسلوكا، يسبق رحيل الجسد». تحت السماء الروحية المسماة ميتافيزيقا كان التراث يتنفس وكانت صورته تمارس عنفا على الهوية فكان المطلوب عند الخطيبي هو الدعوة إلى تشييع جنازة الميتافيزيقا كما عبر عن ذلك في كتابه نحو فكر مغاير لقد اختلطت علينا الأمور بفعل التباس هذه العلاقة مع التراث فنحن «تراثيون لأننا نسينا التراث، ونحن أصحاب مذاهب وعقائد لأننا نسينا التفكير في الوجود، ونحن عشاق التقنية لأننا مستعبدون» هكذا نصل إلى ما عبر عنه مطاع صفدي كما يلي: «التدين يقضي على الدين، كما الاسم يمنع فعل التسمية، كما القانون يعرقل التشريع، فكل هذه الصيغ تتضمن حدا يمنع الحد الآخر».
على أن أهم منجز يحسب للخطيبي هو انتصاره الكبير لما يمكن تسميته عقيدة بقاء الرمز كأننا أمام داروينية يتحايل فيها الرمز باستماتة للبقاء. فالمغرب العتيق «هذا الذي لم يعرف الكتابة، مازال حلا في جسد الشعب تتجلى مظاهره على الرغم من الأدب الرسمي وهي مظاهر تتخذ في بعض الأحيان شكلا رائعا يتجلى في الأدب الشعبي وآداب الصوفية وفي الوشم والرسم التشكيلي الذي يستعمله الحرفيون وفي روعة الغناء والرقص، إنها صور تكشف عن نشوة مغرب تميل وثبته المنتشاة نحو المحيط».
المفاهيم المتعالية
إغراء آخر يرتاده عبدالكبير الخطيبي ضمن أفق المنهج الدلالي الذي ارتسم عبر علامات فارقة لرولان بارت مثلها كتاب ميثولوجيا 1957 وعناصر علم الدلالة مما سيمهد لتفجير العقلانية كأيديولوجيا للطبقة المسيطرة على التقنية، على أن فرادة المنجز الخطيبي يمثلها كتابه/العلامة: الاسم العربي الجريح الذي راود ما سماه محمد بنيس في تقديمه للكتاب: المفاهيم المتعالية التي تفصل بين الإنسان وجسمه، الإنسان ومستقبله مستفيدا من تفكيك الأرضية اللاهوتية المغيبة للجسم وهو ما يشبه فهم العمر كنمو للموت بتعبير صاحب استراتيجية التسمية.
ما ينبغي الاهتمام به في هذا السياق هو التأكيد على أن قراءة الخطيبي للجسد هي قراءة للغة هذا الجسد ولمكره الرمزي كي يعبر ويتسلل خارج الحدود وكي يهرب مكامنه الدلائلية وحمولاته الرمزية.
البحث عن العابر في فضاء الجسم، عن الكتابة والنصوص التي تراوغ في علاقتها بالأصل وتراوغ في صلتها بالسياق، السياق الذي تآكل بفعل قدرة الرمز على المحو لتدعيم سلطته في التعبير، والخطيبي كان ذكيا في قراءة الوشم الذي يدخل ضمن التخصيص والوشم الذي يمكن اعتباره وشماً مستعرضاً، بمعنى أنه حاضر ويخترق عدة أنظمة دلائلية؛ ففي التخصيص مثلاً عند المغاربة يخضع اقتصاد القراءة البصرية لقانون مشابه لقانون الفلاحة، الكتابة كما الحرث. يصبح الوشم لباسا مكتوبا يقول الخطيبي: «الجسد الموشوم هو كتابة تخلخل مفهوم الامتلاك، إنه الكتابة التي تلح على أن تكون، مقروءة، محبوبة، ومشتهاة، ضمن حركتها الأكثر إثارة وغموضا».
قراءة هذا الكم من الدلائل الوشمية وتعالقاتها المختلفة مع الثقافة الشعبية ومع الخلفيات الأنتروبولوجية والميتافيزيقية يكشف عن جدارة التقدير الذي كان بارت مدينا به لعبدالكبير الخطيبي.
تضيق هذه القاربة في منعرجاتها المختلفة عن استيعاب الجهد الدلائلي العميق الذي نهض به الخطيبي ولا تمثل بحال عمق فرادة اشتغاله على المعنى وعلى ازدواجية رؤيته النقدية وروافده لكن الساحة المعرفية مدينة باعتذار كبير لقامة فكرية كبيرة لم تجد حظها من الضوء في ثقافة نكوصية تمجد العتمة.
..................................................................
1- مطاع صفدي، الانبناء للمجهول، الانبناء للمغيوب مجلة الفكر العربي المعاصر العددان: 164/165.
2-CHEMINS DE TRAVERSEessais de sociologie Abdekébir Khatibi. textes réunie et revue par Said nejjar Editions Okad rabat،Novembre2002.
3- عبدالكبير الخطيبي، نحو فكر مغاير، منشورات مجلة الدوحة، مايو 2013.
4- عبدالكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، المركز الثقافي العربي.
كتابات كثيرة تتأثر خط موتها، كتابات ليس بوسعها أن تتجاوز زمنها أو معناها، إنها تلك الكتابات التي لا تملك إلا أن تتسيّد لحظتها الراهنة فحسب، وخلافاً لهذا التصور الذي يرفع نخب الموت تخط كتابات الخطيبي لنفسها مساراً مختلفاً وتجترح منزعا مفارقا، وهي ترصد هذا العارض الذي ظهر على أنقاض الميتافيزيقا، وحمل توصيف الإنسان، رصد يستشف الكيمياء الاجتماعية ويتعقب بذكاء دلالي لافت خطاب الغيرية في أكثر مساراته حدة. الخطيبي يهتم بفلسفة الفرد لمقاربة اللامفكر فيه على مستوى كتاباته، فالمعارف بالنسبة له هي مكونات للكتابة ومصدر للإلهام. يعترف الخطيبي بأن الكتابة تنسى مصادر إلهامها، تمحوها، تخفيها وتذيبها في إيقاع النشوة.
ديْنُهُ علينا!
الساحة المعرفية مدينة باعتذار كبير لقامة فكرية كبيرة لم تجد حظها من الضوء في ثقافة نكوصية تمجد العتمة
***

تكاد وضعيّة عبد الكبير الخطيبي في الثّقافة العربيّة تكون مطابقة تماماً للوضعيّة الثانية، أي وضعية ما لا يقبل التّصنيف. وهي الوضعيّة التي تجعل منه (تماماً مثل بنيامين وكافكا) حالة فكرية وأدبيّة أكثر منه أديباً ومفكّراً. وبالفعل كانت مشكلة الثّقافة العربية مع الخطيبي دوماً مشكلة مَوقَعة: أين علينا أن نصنّف هذا الرّجل الذي يعلن عن نفسه ضدّ كلّ تصنيف؟ لقد جاء الخطيبي في فترة كان فيها الفضاء الثقافي يطالب بتقديم أوراق الانتماء، ولم يكن للخطيبي أوراق ثبوتية ليقدّمها. اللهم نصوصه التي تخترقها سيرته ورؤيته لذاته في غير ما موضع. ولعلّ على رأس تلك النّصوص نصّ «المناضل الطّبقي على الطّريقة التاوية» الذي لم يتم الالتفات إليه بما يكفي للأسف، على الرّغم من أهميّته البالغة في فهم متن المفكّر المغربي في كليّته.
يضيق حيّز هذا المقال عن عرض إشكالية تجنيس هذا العمل، فالنّاشر الفرنسي كان قد وضع على غلاف الكتاب مفردة قصيدة، وبيّن الشّاعر العراقي كاظم جهاد الذي نعتمد هنا المقاطع بترجمته، أنّه فضّل تجنيس الكتاب بمسمّى شعر، مع تأكيد عدم اعترافه لا هو ولا الخطيبي بالحدود المفروضة بشكل تعسّفيّ على الأجناس. وأحسب أنّ إشكالية تجنيس هذا العمل ليست إشكالية خارجية، بل تمسّ جوهر موضوع النّص نفسه، لأنّ النظر إلى النّص في علاقته بمشكل التّلقي يعيدنا إلى سؤال التّصنيف الذي طرحناه أعلاه، وهو سؤال واجه كلّ نصوص الخطيبي تقريباً، فقلّما تمّ الانتباه إلى وجوب دراسة كلّ نصّ في فرادته دون السّعي إلى إلباسه لبوس الأطر الضّيقّة التي يفرضها التّجنيس الأدبي. فالمشكل نفسه الذي كان يواجه الخطيبي (هل هو سوسيولوجي، أم شاعر، أم فيلسوف، أم ناقد، أم مفكّر، أم أديب...؟) هو نفسه الإشكال، الذي يواجهه كلّ نصّ من نصوصه، بما فيه النّص موضوع حديثنا. أفضّل هنا اعتبار النّص بياناً شعرياً، بياناً يعالج عبره الخطيبي (وهنا تكمن أهميّته) جانباً من الإشكالات السّابقة.
كيف رسم الخطيبي بورتريهاً ذاتيا لنفسه في هذا الدّيوان؟ وما ملامح المناضل الطّبقي على الطّريقة التاوية؟
المناضل الماركسي
لا ريب في أنّ المقولات والمفاهيم المهيمنة على الديوان هي مقولات ومفاهيم ماركسية. ولا ينكر الخطيبي انتماءه الماركسي، بيد أنّه نوع من الانتماء الطوباوي (والطوباوية أيضاً تتطلّب مع الخطيبي فهماً خاصاً جداً) إنّه كالانتساب الصّوفي الثّوري إلى دينٍ من الأديان. فهو لم يكن ماركسيَ العقيدة، لكن من جهة أخرى يمكن اعتباره الأكثر ماركسيّة من بين أبناء جيله، إذ يكاد يكون الوحيد الذي أفاد من الماركسية في الاتّجاهين معاً: الاشتغال بمقولاتها ومفاهيمها المنتِجة، ومن المنهج الجدليّ والماديّ، ومن جهة أخرى إغناء هذا الفكر نفسه بمساءلته من الدّاخل، وجعله يكشف عن إمكاناته، بل وحتّى تلقيحه بما قد يبدو بعيداً تماماً وغريباً كلّ الغرابة عنه من قبيل فكر لاو تسو.
يحدّد الخطيبي منذ الأسطر الأولى للعمل موقفه من نوع خاص من الماركسيين، أولئك الذين يأخذون بالكلمة بدل الأثر، فالماركسية عندهم تستحيل إلى مجرّد كلمات ومقولات (التّاريخ، الإيديولوجية، اللاشعور)، وكأنّما تلك المفاهيم أنسوخات (بتعبير جيل دولوز) يمكن أن نجعلها أطراً ثابتة ونسقطها على أيّ إشكالية دون أن نأخذ بعين الاعتبار الاختلاف والفرادة التي ينطوي عليها كلّ مظهر من مظاهر هذا العالم الشّديد التنوّع:
التاريخ كلمة
الإيديولوجية كلمة
اللاّشعور كلمة
في أفواه الجهلة ترفرف الكلمات (ص 9)
بيد أنّ ما يهمّ مع الماركسي الفعلي هو التّغيير، وكلّ تغيير ينطوي على الصراع والنّضال. من هنا فإنّ كلّ مقاربة ماركسية ينبغي أن تحدّد موقفها من فكرة الصراع والنضال.
المناضل الطّبقي
لا ينفصل الوعي الماركسي كما أسلفنا عن الوعي بفكرة النّضال الطّبقي، لا بل إنّ النضال الطبقي هو الممارسة حيث يتجسّد الوعي الماركسي. بيد أنّ الفهم التّقليدي للنضال الطّبقي يختزل الأمر برمّته في صراع طبقي، في صراع بين الطّبقات. من هنا فإنّ النضال الطبقي بحسب الفهم السائد للماركسية هو توحّد جهود الطّبقة المستغَلّة لمجابهة الطبقة المستغِلَّة. يتجاوز النضال الطبقي عند الخطيبي هذا المفهوم الضيّق نحو نضال أوسع، نضال مزدوج، نضال ضدّ العدو الطبقي، ولكن أيضاً نضال ضدّ الذّات نفسها:
لذا فالمناضل الطبقيّ
لا يقفزُ مثل جرادةٍ قَلُوب
يجرح بفرحٍ طبقتَه نفسَها (ص 21)
إنّ المناضل الطّبقي يناضل داخل الطبقة نفسها. يقوم بعمل من الدّاخل. عمل خلويّ. عمل لا يلغي السلسلة (ما دام الوعي بالعدو الطبقيّ يظلّ حاضراً)، لكنّه يعطي أهمّية كبرى للعمل من داخل الحلقات، وبخاصة الحلقة التي يلفي نفسه داخلها. ولعلّ تلك هي الممارسة المتيقّظة:
حين يقرأ ثوريّ ماركس
يمارسه بيقظة (ص 13)
إنّها ممارسة تفرض النّظرَ المزدوج إلى الدّاخل والخارج، تفرض الانقلاب على الذّات في كلّ مرة، ومواجهة الهوية والانتماء بالقدر نفسه الذي نجابه به العدوّ الطبقيّ. باختصار ارتضاء اليتم والانتساب إليه.
المناضل اليتيم
يتيم هو المناضل الطبقي (ص 10) بيد أنّه في الآن نفسه سيّد في يُتْمه (ص 10).
اليتم هو الانتساب إلى العالم. وينبغي أن نميّز هنا تمييزاً واضحاً ما بين مفهومي الانتماء والانتساب، فالانتساب نتيجة طبيعية لنفي الانتماء. ينفي المناضل الطّبقي كلّ انتماء مسبق، يرفض الأطر الجاهزة (الأسرة، الطبقة الاجتماعية المقيِّدة، الحزب، الولاء الأيديولوجي)، يختار اليتم طوعاً، أن لا يُنسب إلى أحدٍ، وإنّما أن ينتسب إلى العالم في كليّته. العالم في تناقضه وحركته. ليس اليتم قيمة سلبية، فانتفاء الأبوّة هو البداية الفعلية للتحرّر.
على أنّ اليتم ليس حالة جامدة، فهو ليس يتماً تجاه مكوّن محدّد. اليتيم فاقد الوالدين هو يتيم قياساً إلى والديه، إلى افتقادهما، وبالتالي فهو يكاد يعيش وضعاً جامداً مستقراً، وضعاً محدّداً. أما اليتيم الطبقي فهو اليتيم متجدّداً، اليتيم الذي يكون كلّ مرّة يتيماً قياساً إلى مكوّن جديد، يتيم قياساً إلى هويّته نفسها ما دام قادراً في كلّ مرّة على تدمير ذاته. لا ينتمي اليتيم حتّى إلى نفسه، وهذا بالضّبط ما يجعله في موقف قوّة إزاء العدو الطبقيّ:
لذا فأنا يتيمٌ بلا انتهاءٍ
لأنّني قادرٌ على تدميريَ
أهزمُ العدوّ الطبقيّ.
إنّ وضعية اليتيم قياساً إلى العدوّ الطبقيّ، تناظر شيئاً مّا وضعية الفصامي عند جيل دولوز قياساً إلى النظام الرأسمالي، فمشكلة الرّأسمالية مع الفصامي كما يقول دلوز هي عدم إمكانية اتّخاذه لا حليفاً ولا خصماً لأنّه ينفلت من كلّ تصنيف ممكن، وبالتالي تعجز عن استدماجه في بنياتها التي تستدمج الجميع، حلفاءَ وخصوماً.
حكيم الاختلاف
لا ينكر الخطيبي في عمله الشعري رهانه، لا يخفي أنّه يعلّم شيئاً. لكن ما هو هذا الشيء الذي يعلمّه ويبشّر به؟ إنّه الاختلاف الذي لا رجوع منه (30). اختلاف المناضل الطبقي على الطريقة التاوية.
لمَ اختار الخطيبي التاو أفقاً لفكر المناضل؟ لأنّ التّاو أولاً فكر الجمع بين المتناقضات، وفكر تمجيد اللّيونة والأنوثة والفراغ. بيد أنّه لا ينبغي أن نفهم من التّمجيد هنا التغليب. يقوم التّاو في الواقع على إعطاء الأهمية لما لم يهتم به في العلاقات، ليس على اعتبار أنّه هو العنصر الأفضل وإنّما فقط باعتبار أنّه الجانب المغيّب الذي ينبغي أن يتمّ إبراز دوره أيضاً، وعليه قد يصنع الإنسانُ بحسب التاو نافذةً من أجمل الإطارات وأنفسها بيد أنّه لولا الفراغ لما أمكن تسميتها نافذة. فالأمر لا يتعلّق إذن بتغليب عنصر على عنصر آخر، وإنّما إبراز فكرة التكامل التي لا يستقيم دونها الوجود.
ثمّة أيضاً، مسألة النظر إلى المهمّش والثانويّ بوصفه يحوز نفس قيمة البارز والرئيسي (وهو ما مارسه الخطيبي نفسه على الثقافة المغربية)، إذ يستوي بوذا في عرض الماء مثلما يستوي في جذع خيزرانة (بحسب التّاو). ثم هنالك، ولعلّ هذا هو الأهمّ، مبدأ التعلّم القائم على التقفّي الذي ينشد الاختلاف.
بتقليدك إيّاي تعرف اختلافك (35)
وضع الحافر على الحافر قد يكون أيضاً طريقة في الاختلاف، والمهم بحسب التّاو أنّ الوصول ما هو إلا البداية، «إذا وجدتَ البوذا أقتل البوذا»، لا ينشد تلميذُ التّاو الخلاص في الوصول إلى مرتبة أستاذه. والمناضل اليتيم أيضاً لا يطلب من تلميذه الوقوف عنده:
ألقى بك البحرُ نحوي أيُّها المسافرُ المجهول
فاترُك حُطامكَ وواصل السّيرَ
لا أسألكَ شيئاً الحمدُ لله
وداعاً! (ص 53)
هو نفسه أي الخطيبي قتل البوذا ما إن وجد البوذا وعانق الاختلاف الذي يدفع به في نهاية النّص إلى أن يتخلّى عن اسمه وتوقيعه وأن يحمل (مؤقّتاً فقط) اسم حكيم يتيم (ص 53).
***

تختلف استراتيجيات تمثل الأدلة وتأويلها في كتاب «الاسم العربي الجريح»، حيث لا يحضر، سواء في المقدمة أو في العرض، تعيينٌ لخلفية القراءة، أو تحديدٌ لغايتها. ويتبدى ذلك واضحا في تفاوت عمق ومجال الأنساق المستدعاة من قبل التحليل. كما يتبدى في تنوع مداخل المقاربة. بيد أن التفاوت والتنوع ليسا نتيجة سيرورة تدلالية تلقائية، بل نتيجة تفكر نسقي يمكر بالأدلة المباشرة ويحولها إلى مؤشرات على سياقات مختلفة، ثم وبشكل سلس يجري توجيه سياق ما، فيصبح من ثم مناط الحديث، ومرتكز التأمل. وهو صنيع مماثل في بعض الجوانب لتحليلات دريدا وكيليطو، وبخاصة في خلق التحليل لمتعة الغرابة المبررة من قبل النسق المتعالي المستحضر من أجل الإقناع، وأيضا في استراتيجية القارئ الضمني المتصور، والذي يتصف بامتلاك معرفة بآليات التأويل وبخلفيات التفكيك.
وتتمثل هذه الاستراتيجية في الاستناد إلى المنهج الافتراضي الاستكشافي (Abduction)، والذي هو نوع مخصوص من الاستنتاج المنطقي القائم أساسا على تشييد المعرفة انطلاقا من مماثلات حدسية مدعمة بحدود مؤسسة على تناظرات مقبولة، ومنها ربطه بين معنى الأحجية بحبات المسبحة: «فنص الأحجية، وهو لعبة بين قرابتين أو أكثر، يربط انغلاقه (انغلاق النص) بهدفه الأولي، وبتعسف نهايته، ويناظر فضاء النص الملغز، بصيغة استعارية، مسبحة، حيث كل حبة لا تدفع الحبة الأخرى إلا من أجل أخذ مكانها»، وذلك بناء على اعتبار أخذ الواحدة مكان الأخرى، وربطه الوشم بالإبر بليلة الزفاف بناء على التناظر بين الوخز والافتضاض وعلى صورة الدم والألم المصاحب لهما.. أو ربطه للأشكال الراسخة من قبل الوشم بالعدد خمسة أو علاقة الوشم بلعب الأوراق.
ومن البين أنه، من خلال استعماله لهذه التناظرات التي يصعب تمثلها أو الاقتناع بصوابيّتها من دون خلفيات معرفية بالغة العمق، يعامل الأدلة بعيدا عن تحققاتها الواقعية، سواء أكانت مجردة (معنى المثل المعياري كما هو في القاموس أو في التمثل الشعبي العام غير المقيد بحادث معين) أم محيّنة واقعيا (استعمال المثل واقعيا ليدل على توصيف حالة مخصوصة).
تأويل المثل الشعبي
انطلق الخطيبي في تحليله لمجموعة من الأمثال الشعبية المغربية من علاقتها بالجسم محاولا مفصلة القول بين الجسم الحمدلي والجسم المثلي، بين الجسم المفهومي والجسم الحقيقي. ولعل هذا المنطلق هو الذي جعله يتغاضى عن تمثل المثل في مستوى كونه مؤشرا على معنى مقصود لحظة الاستعمال، أي إنه لم يعامل الأمثال بِعَدِّهَا أدلة وجودية تجسد معنى مجردا عاما وتحيّنه في لحظة تلفظها من أجل تأويل دليل حادثٍ في تلك اللحظة. الشيء الذي يعني عدم مراعاة المثل في مستوى كونه دليلا قانونيا، يتألف بالضرورة من مورد ومضرَب، حيث لا يمكن صياغة دلالته إلا بفضل تمثلِ الموْرِد الأول للمثل، إذا كان بناء ينتجه الذهن المفكر ليختزل من خلاله سيرورة من التًّفكُّرٍ التي تتغيّا إنتاج حقيقة بخصوص حالة أشياء ما أو حالة وعي ما، أو تمثلِ المصدر إذا كان اختزالا، وفق تكثيف مخصوص، لمغزى حادثة أو حكاية؛ وصولا إلى تحوله إلى مثل سائر متعدد الحالات وأزمنة المضارب، وحيث يكون المعنى العام والمجرد المتعالي واشما لمعنى الورودات الفعلية.
إن هذا التغاضي هو الذي يجعل تحليله غارقا في التجريدية، وضاربا نحو التفسير الثقافي المؤسس على التأثير الديني في تمثل وظائف وأعضاء الجسد، وليس المبني انطلاقا من تراكم التجربة الثقافية عبر التاريخ، أو انطلاقا من خبرة اجتماعية. ومن الأمثلة على ذلك ربطه لمجموعة من الأمثال التي تستعمل كلاما نابيا أو خادشا للحياء العام بتدمير القدسية.
إن الرغبة في إهمال الكلام الاجتماعي جعلته، إذن، يستبدل الدلالة المجردة وأيضا الدلالة الفعلية لكل ورود تواصلي حادث ووجودي، بدلالة مجردة من نوع آخر لا تستمد معناها من المورد أو المضرب، بل من فضاء وسطي متعالي يحاول رصد خلفيات التعالقات بين الرمزي والحقيقي.. ولذلك اكتفى بتوصيف شكل حضور المعنى الاجتماعي للأمثال دون تفكيكها وفق جهات التصور والاستعمال. ويتمثل ذلك بجلاء في قوله: «وما دام المدلول مفترض الفهم من طرف المتحادثين، فإن العادة تمنح في التحادث، عن طريق المثل، نظاما مملوءا، أي زمنا تكراريا، وفضاء مفتوحا، ومعرفة حشوية.»
إن الخطيبي بهذا الصنيع يصر على تحويل المثل من دليل عرفي قانوني، ثابت الدلالة في المستوى المجرد ومستوى التحيين الوجودي، إلى دليل مفرد مطور عن أدلة نوعية، أي أنه يحاول أن يؤسس تحليله على تهميش القوة التأشيرية ( بوصفها تعيينا واضحا للقصد) بمقابل توجيه القوة المؤشرية (بوصفها تقبل تعدد المعاني)، الشيء الذي يحيل المثل إلى نص إبداعي. ومن ثمة يتيح تفكيكه بناء على تهديمه إلى ممكناته. وهو الصنيع الذي جعل تحليلاته متعددة وافتراضية.
تأويل الوشم
لا تختلف استراتيجية تأويل الخطيبي للمثل عن تأويل الدليل (الوشم) كثيرا، فكلتاهما تقومان على الفرض الاستكشافي.
إن الوشم الذي يسميه، أيضا، كتابة بالخط لجعله متعارضا مع الكتابة الأصلية الربانية، هو لباس رمزي لا ينكشف إلا بانكشاف عري الجسد الذي وحده ( أي العري) يعلن عن وجود هذا اللباس الثانوي والذي يدثر الكتابة الأصل أي الكتابة الالهية. إن مدار تحليلات الخطيبي للوشم بأشكاله المختلفة تتبأر حول هذا اللباس الثانوي الذي يشبه الستار الهاتك للمستور، والذي يتمثل في شفافية ماحقة. يبدو أن التموقع في هذا المستوى من الإدراك هو الذي جعل تأويلاته حافلة بالأيقونات ( أي الأدلة الخفية التي لا تستنتج إلا انطلاقا من تمثل أنساق دينامية ذات تعالقات ما مع الدليل المُدْرَكِ) والاستعارات العصية على الإدراك العادي. مثل علاقة الوشم بلعبة الأوراق وعلاقة أشكاله باليد والعدد واسم الجلالة والحركات البذيئة والشرج والفرج وغير ذلك.
كما يتمظهر ذلك في تحليلاته القليلة لبعض الأمثال مثل ربطه للدليل (يندم) بالسواد، أو ربطه لتعفن الجثة تحت الشاهد الحامل لاسم الجلالة بالمثل «منخرو في الجيفة وهو كيكول أخ». وغير ذلك من أشكال التفكيك الذي يصعب قبوله من جهة العلاقات المنطقية، لأن التحليل مستند إلى القوة الأيقونية وحسب.
خلاصة
من البين أن تحليلات الخطيبي متوقعة في خانات المؤولات المنتمية إلى مقولتي الممكن والوجود، وأنها لم تلتجئ، في أي وقت من تشكلها، إلى المؤولات التي تنتمي إلى مقولة الضرورة، الشيء الذي يفسر تغاضيه عن الالتجاء إلى السياقات المناسبة لمكونات الدليل (المورد والمضرب بالنسبة للمثل الشعبي، والتصورات الشعبية لعلاقات المناسبات بالوشم وابدالاته مثل الحناء)، والتي تؤشر على سياقات مسجلة في الموسوعة الفعلية، سواء أتعلق الأمر بالسياق التاريخي أو الاجتماعي أو المتعاليات الفنية..
إن كل ذلك يوضح رغبة خفية في المكر بالسياقات الفعلية التي تؤشر عليها الأدلة الشعبية، بمقابل الرغبة في خلق سياقات بديلة متأتية من متعاليات مخالفة. ومع ذلك تتجنب القراءة بذكاء باهر إمكانية عدها ضمن القراءات التي تسعى إلى تهديم الأدلة من مستوى الوجود إلى مستوى الممكن، بهدف إنكار وجود حقيقة ما في مقابل تشييد إمكانات لحقيقة ما مفترضة.. لذلك فلابد لكل قراءة في تأويلات الخطيبي السابقة أن تراعي العمق الشفاف الذي يسم تحليلاته، التي لا يمكن أن تسبر إلا بفضل تعرف خلفياته الفلسفية، وضبطها نظريا، ثم تأكيد محايثتها للتظهير النقدي انطلاقا من تحليل نصوصه.
من المؤكد أن المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي، المعروف بتحليلاته العميقة والشائقة ذات النفس الإبداعي، قد أبدع، من خلال مسيرته الفكرية، في مجالات متعددة؛ ومن ثمة يصعب الزعم بكون مقاربة نص من نصوصه هو بالضرورة اقتراب من آليات تفكره، ولذلك، فإن قراءتنا الحالية لا تُعد تجسيداً لتصور عام لكيفية تفكيره في الأدلة بإطلاق، بل هي مجرد تشخيص لشكل تَفَكُّرِهِ في الوشم والمثل الشعبي المغربي.
***

يحدد عبد الكبير الخطيبي نفسه مقومات التفكيكية ومصادرها في كتابه المغرب المتعدد، الصادر بالفرنسية سنة 1982 بشكل متزامن بباريس والرباط. ويعني المفكر بالمغرب، المغرب العربي الكبير، لأنه استعمل مدلول Maghreb. ففي هامش بالصفحة 47 يتوقف ليحدد ما المقصود لديه بهذا المفهوم. وكانت الإشكالية التي استدعت اللجوء إلى هذا المفهوم هي تحرير السوسيولوجيا من الفكر الاستعماري. وبما أن مفهوم التحرير كما تستعمله الفرنسية التي كتب بها الكتاب هو Dé-colonisation فإن الخطيبي حاول أن يجد أساساً فلسفياً في الجهاز المفاهيمي ما بعد- حداثي في الفلسفة الفرنسية التي كان ينتمي إليها روحياً.
إسهام مفاهيمي
إذا كان مفهوم التفكيكية قد استعمل في بداية الأمر عند الفلاسفة، فإن الخطيبي، وهو عالم اجتماع أولا ثم أنثروبولوجي لاحقا، قد استعمله، أو حوره لضرورات منهجية. فالمفهوم في حد ذاته، وإن لم يكن ظهر إلا عند مجموعة من الفلاسفة الفرنسيين كجاك ديريدا، وبشكل عملي منهجي قبل ذلك عند البعض الآخر كميشيل فوكو، فإن إعماله كمنهج عرف قبل ذلك عند الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر. إن الإشارة التي يحدد فيها الخطيبي مصادر استلهامه لهذا المفهوم تقول:«إنني أقتبس هذا المفهوم من جاك ديريدا بالنظر إلى أن فكره هو أيضا حوار مع «مجاوزة ميتافيزيقا»، كفكر نقدي تأكيدي، يبني، خطوة خطوة، فكر اختلاف ما بين الفلسفة والعلم والكتابة، وأن التفكيكية، بما هي تدمير للميتافيزيقا الغربية، وكما يمارسها ديريدا، بطريقته الخاصة جدا، نشأت ورافقت تصفية الاستعمار كحدث تاريخي. سوف نؤكد هنا بعض ملامح الالتقاء التي ليست بالمرة مساراً اعتباطياً. لقاء بين تصفية الاستعمار والتفكيكية. (المغرب المتعدد، ص 47 و48، من النسخة الفرنسية).
من هنا يظهر أن الحاجة إلى مفهوم يزعزع بنيان فكر، يتعلق الأمر هنا بالفكر السوسيولوجي الاستعماري، متكامل مقتنع بنفسه ومتمركز حول ذاته وإثنيته، كانت ضرورية. ولم يجد الخطيبي أحسن من التفكيكية لسببين:
عقده العزم على مساءلة الفكر الغربي، في جذوره الفلسفية العرقية، الذي نما وتكون بموازاة مع الإمبريالية، وفي أحضانها.
مساءلة الفكر الذي كونته المجتمعات العربية عن نفسها في حقب مختلفة من التاريخ.
هذا المنحى والذي سماه الخطيبي نقدا مزدوجا هو الذي تطلب اللجوء إلى استراتيجية نقدية سماها النقد الفكري العربي فيما بعد بالتفكيكية، مترجما بذلك المفهوم الفرنسي Dé-construction. ليس من الخطأ أن يترجم المفهوم هكذا، ولكن ليس من السهل أن تؤدي هذه الكلمة كل المعنى.
مساءلة الفكر الغربي
يرجع أصل التفكيكية إلى الفينومينولوجيا، ممثلة في مارتن هايدغر وطريقته في تعرية أصول المفاهيم وإعادتها إلى أصولها إما الميتافيزيقية أو اللاهوتية أو حتى الاعتباطية المتعجرفة. وللوصول إلى هذا الهدف كان هايدغر يعمد إلى مساءلة الأصول التاريخية، الدينية، اللاهوتية، الميتافيزيقية، الفيلولوجية.. للمفاهيم مرجعاً إياها إلى زمن انبجاسها ورابطاً علاقتها مع الحقول التي سمحت بإنتاجها. بهذه الطريقة كان هايدغر يطمح إلى أن يضع نفسه خارج كل الأنساق الفكرية والفلسفية وخارج السياج الميتافيزيقي الغربي الذي كان الكل يعتبر أنه أقفل بصفة نهائية مع فلسفة هيغل المطلقة.
هذا التوجه نحو مساءلة الفكر الغربي برمته وإعادة النظر في منطلقاته، هو الذي سوف ينهجه فلاسفة كثر، ومنهم ميشيل فوكو الذي انكب على نقد الأنساق المؤسساتية الأوروبية: مؤسسات العزل، السجن ومعازل المجانين، مؤسسات الخطاب، مؤسسات الجنس.. هذه المساءلة لم تكن في نظر ديريدا كافية، لأن مساءلة الفكر عن جذوره وشروط تكونه كانت تنقصها مساءلة أخرى تتعلق بعلاقة هذا الفكر مع الأنساق الفكرية غير الغربية.
من هنا اتجه معول التهديم من أجل إعادة البناء إلى ميادين متعددة. يجدر بنا هنا أن نؤكد أن المعنى القريب من الصواب لمفهوم التفكيكية هو: «الهدم من أجل إعادة البناء«، وإذا صح فهمه هكذا فإننا لن نكون بعيدين جدا عن كل الاجتهادات الإبستمولوجية، التي أسس لها جاستون باشلار، الذي هو بالمناسبة من أكبر أساتذة هذا الجيل. إذ أنه كان أستاذاً بالسوربون عندما كان كل هؤلاء طلبة. ولقد كان ديريدا في كتابه De la grammatologie، الصادر عن دار مينوي بباريس سنة 1967، قد حدد هذه الميادين: مفهوم الكتابة، تاريخ الميتافيزيقا ومفهوم العلم. واعتبر أن الأرضية التي تأسست عليها هذه الحقول أرضية إثنية، المقصود هنا إثنية أوروبا، ولهذا وجب تفكيك ذاك الخطاب الذي أنتجته حول نفسها.
هذا هو التوجه النقدي الذي سوف يتخده الخطيبي والذي سوف يلتقي، كما قال، بشكل لا مجال للاعتباط فيه بمشروع جاك ديريدا. سوف يتوجه إلى ميادين الصراع مع الفكر الاستعماري الذي بقي، رغم رحيل المستعمر، يسيطر على أذهان مثقفي الأمة العربية أو على الأقل بعضهم، معتبراً أن عش هذا الفكر هو العلوم الإنسانية، علم الاجتماع الاستعماري والاستشراق. كما سوف يشمل نقده ميادين ظلت في نظره مكبوتة من طرف الفكر العربي نفسه ألا وهي ازدواجية اللغة، الجنس والفن.
اللعب.. القاتل
في سنة 1977، أصدر الخطيبي مع مجموعة من المفكرين عددا خاصا من ، الأزمنة الحديثة، عن المغرب العربي. كان نص الخطيبي في الأصل محاضرات ألقاها باللغة العربية أمام طلبة علم الاجتماع بجامعة الرباط في نفس السنة. انطلق السؤال الإشكالي لهذا البحث من مقولة تحريضية لفرانز فانون، أحد أقطاب الثورة الجزائرية، تقول: «هيا يا رفاق، لقد انتهى اللعب الأوروبي إلى غير رجعة، يجب الآن البحث عن شيء آخر». في هذا المفصل بالذات يتدخل الخطيبي ليتساءل عما هو هذا الشيء الجديد وإن كان بالإمكان التخلص من اللعب الأوروبي بهذه السهولة. ألا تسكن أوروبا حميمية وجودنا؟ أمن الممكن أن نجد هذا الجديد انطلاقا من تراثنا؟
يجب لكي نصل إلى هذا أن ننخرط في نقد جذري للتراث الغربي وبنفس الحدة لتراثنا الوطني. من هنا النقد المزدوج: نقد الآخر ونقد الذات. إعادة النظر في الميتافيزيقا الغربية التي مثلت الأرضية الأساسية للفكر الاستعماري ونقد اللاهوت العربي الإسلامي، الذي طمس الاختلافات وأسكت اللغات المتعددة وهيأ بذلك الطريق للاستعمار.
هذا الشيء الآخر الذي ينادي به فرانز فانون يبلوره الخطيبي بطريقة أخرى. إنه فكر مختلف واستراتيجية مغايرة. إن على المغرب، ومعه العالم العربي وحتى العالم الثالث، أن لا ينقاد للفكرة التي تقول أن نهاية العالم توجد بين يدي ذلك النظام التقني والعلمي، الذي خطط العالم بإخضاعه لإرادته واقتناعه بنفسه. فالخلاص يوجد على هامش هذا الفكر، على هامش الميتافيزيقا الغربية المؤسسة له وعلى هامش اللاهوت الإسلامي. الفكر المختلف، الذي يدعو الخطيبي إلى تبنيه، يوجد في هذا الهامش، ويجب أن يبقى فيه متيقظاً. الفكر المختلف يعتبر هذا الهامش حظا لا نظير له.
نقد الذات
من هذا الهامش إذن سوف يراقب الخطيبي المغرب العربي ويتوقف عند تحولاته. لا يحلل عبد الكبير الخطيبي هنا المجتمع من وجهة نظر سوسيولوجية بل يتعرض للأفكار السياسية والأيديولوجية، التي أنتجت بصدد العالمين المغاربي والعربي. سوف يحلل هذه البنيات إذن، واضعا نصب عينيه بعض الأسماء الفكرية العربية، مصرحا ببعضها أحيانا ومضمرا بعضها أحيانا أخرى. سوف يرصد ثلاث مستويات: التقليدانية، السلفية والعقلانية. وهنا عندما يتعرض للتقليدانية والسلفية بالنقد نفهم، وخصوصا من إحالاته، أنه يتوجه لكل الفكر التقليداني والفكر السلفي العربيين، لكن عندما يتحدث عن العقلانية فإنه يقصر نقده على مؤلف عبد الله العروي، (الأيديولوجيا العربية المعاصرة، في نسختها الفرنسية الصادرة بباريس سنة 1967). وبعني بالتقليدانية، الميتافيزيقا مختزلة في اللاهوت، ذلك العلم المستحيل المختص في الله وأصل العالم. أما السلفية، فيعني بها الميتافيزيقا التي تحولت إلى عقيدة، أخلاق لتصرف سياسي وبيداغوجيا اجتماعية تطمح إلى مصالحة العلم مع الدين والتقنية مع اللاهوت. وأما العقلانية (سياسية، ثقافوية، تاريخانية، اجتماعوية...)، فيعني بها الميتافيزيقا، التي تحولت إلى تقنية. تنظيم للعالم بطريقة وفق إرادة للقوة، غير مسبوقة، تستمد قوتها من التطور العلمي.
هذه الرؤى الثلاث تجعل من المغربي والعربي على السواء، تقليديا بنسيانه للتقاليد، عقدي بنسيانه لفكر الوجود وداعية للتقنية بالتبعية.(تجدر الإشارة هنا إلى أن عبد الله العروي قام بنفس التحديد: الشيخ، السياسي، داعية التقنية، انظر الأيديولوجية العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1999).
فالتقليدانية لا يمكنها أن تتجلى وتستمر إلا في عالم مهزوم معرض للوعي الشقي والتمزق الدائم. إن التقليداني يقتات من حقد وكراهية الحياة. إنه ينهك نفسه باستمرار لينقلب إلى الوحشية والجنون. أما السلفية فإنها يدعي أنها مجاوزة للتقليدانية. إنها تريد أن تصلح انحطاط وفساد العالم. لكن السلفية والتقليدانية على السواء لن تستطيعا ذلك. إنهما تائهتان في العالم المعاصر. ليس باستطاعتهما الثورة على أسسهما التيوقراطية ولا القفز للسكن داخل فكر الحوار مع الخارج أي الشر المطلق الذي ينخرهما من الداخل. إن السلفية تدعي قدرتها على إخضاع التقنية الغربية إلى اللاهوت الإسلامي دون أضرار أخلاقية على المستوى الإنساني. إفراغ التقنية من القيم المؤسسة لها.
في مقابل كل هذا نجد العقلانية في نسختها التاريخانية، التي تلح على الاستمرارية التاريخية. تتبنى هذه التاريخانية نظرية العصور الطويلة حتى يتأتى لها إدماج الحالة الاستعمارية و«تخلفنا الثقافي». إنها تنتفض ضد التقليدانية والسلفية اللتين تلحان على سجن التاريخ العربي في ماض نوستالجي، هذا شيء محمود، ولكنها بتبنيها الاستمرار والاتصال في فهم التاريخ، تنسى أشياء أساسية: اللا اتصال، التقطعات، الانحرافات، الفوضى، التشتت، اللا توازنات.. وهذه مجتمعة يمكن أن تؤسس جزءاً من تاريخنا. لسنا ملزمين، نحن العرب، باتباع نفس الحقب التاريخية التي مر منها الغرب. يجب الانطلاق مما هو موجود الآن وهنا، موجود كسؤال، كقضية، كتحد للفكر.
هذه التفكيكية لم تتوقف عند الأيديولوجيات الكبرى. سوف يتحول عبد الكبير الخطيبي لاحقاً ومعه نقده المزدوج إلى ميادين الفكر والإنتاج الروحي: الفن، الثقافة الشعبية والكتابة. سوف يحلل الثراث الشفهي منه والمكتوب: الخط العربي، الوشم على الأجساد، ألف ليلة وليلة، ازدواجية اللغة.. إلى غير ذلك من الميادين المنسية والمهمشة من طرف اللاهوت الإسلامي والسلطة الذكورية الممركزة.
لا يتوقف عبد الكبير الخطيبي إذن عند الطرح المدرسي للمفاهيم وإنما يعملها في ميادين تجلي الجسد والفكر.
نقد البُنى الأيديولوجية
يحلل الخطيبي بُنيات الأفكار السياسية والأيديولوجية التي أنتجت بصدد العالمين المغاربي والعربي من خلال ثلاثة مستويات: التقليدانية، السلفية والعقلانية. عندما يتعرض للتقليدانية والسلفية بالنقد نفهم، خصوصاً من إحالاته، أنه يتوجه لكل الفكر التقليداني والفكر السلفي العربيين، لكن عندما يتحدث عن العقلانية فإنه يقصر نقده على مؤلف عبد الله العروي.
***

تكفي إطلالة سريعة على الحضور القوي لمعالجة سؤال الفن عند الفلاسفة المعاصرين لتؤكد الحقيقة السابقة، إذ إن ما كتبه هيدجر حول «أصول العمل الفني»، ودراسته لأعمال فان جوخ، وما تناوله جاك دريدا في كتابيه: «يوميات أعمى»، الذي خص به موضوعة العمى في التشكيل، وكتاب «فن الصباغة والحقيقة»، وما لاحظه ميرلوبونتي في كتابه «العين الحية» الذي خص أعمال الفنان سيزان، وما كتبه مشيل فوكو حول «مونيه»، وتودوروف في كتابيه «مديح اليومي»، و«مديح الفرد» حيث تناول في الأول التشكيل الهولندي والاحتفاء بالحياة اليومية. كل هذه الأعمال تعكس الانْهمام بالفن لعمقه في تناول الوجود والفرد واكتشاف الأشياء وإعادة تشكيل الهويات. في هذا السياق – بالتحديد- سأعالج المجهود النوعي الذي قام به المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي.
فكر مغاير
طرح صاحب «المغرب المتعدد»، و«النقد المزدوج» و«الاسم العربي الجريح» وكتاب الدم «في الأفق المغربي أسئلة عميقة وجوهرية وجذرية، اتسمت بجرأة المفكر الحر، الذي اتخذ من الفلسفة استراتيجية وبرنامجا وقد تجلى ذلك في تشككه السقراطي اليقظ، وحذره الشديد من أن ينجر إلى الخطابات الأيديولوجية والتحليلات التاريخية المبسطة، كما يتضح في معاملته الحذرة مع المذاهب الفلسفية، حتى أكثرها ثورية، وفي نهجه استراتيجية تعتمد أساسا اقتراح قراءات مفتوحة، أكثر ميلاً إلى إثارة الأسئلة وفحص القناعات» (انظر: عبدالكبير الخطيبي، نحو فكر مغاير، بنعبد العالي، كتاب الدولة. (ص 9).
لقد حاور بندية فكر الاختلاف الغربي واستفاد من استراتيجيته ليخلص إلى استراتيجية متعددة الأبعاد ينصهر فيها الابستمولوجي بالسيميائي بفكر الاختلاف، طارحا وراء ظهره كل أحادية منهجية، ومتحررا من كل دوغمائية.
بالفعل لقد دشن لفكر مغاير، جعله ينتبه مبكرا لخصوصية الفن العربي الإسلامي، وأن يلتقي بالمقدس، ليس باعتباره موضوعا متعاليا، وإنما باعتباره حضورا في الفن.
هذه اليقظة، وهذا الانتباه المبكر للاهتمام بخصوصية العلامات المشكلة للهوية، دفعت برولان بارت إلى تدبيج اعتراف عز نظيره بين المثقفين تحت عنوان «ما أدين به للخطيبي»، ورد فيه «إنني والخطيبي نهتم بالأشياء نفسها، بالصور، والآثار، والحروف والعلامات، وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي شيئا جديدا، يخلخل معرفتي لأنه يغير مكان هذه الأشكال، كما أراها، يأخذني بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحسني في الطرف الأقصى من نفسي.. إن الخطيبي معاصر، يسهم في هذه التجلية التي بدخيلتي وشيئا فشيئا أدرك كيف أن المشروع السيميائي الذي أسهمت فيه ولا أزال، ظل حبيس مقولات الكلي التي تقعد كل مناهج الغرب منذ أرسطو. كنت أفترض ببراءة، وأنا أسائل بنية العلامات أن هذه البنية تبرهن على عمومية ما. تؤكد على هوية لم تكن، في العمق، وبسبب المتن الذي اشتغلت عليه، إلا هوية الإنسان الثقافي لموطني، والخطيبي يقوم بمعنى ما بالشيء نفسه لحسابه الخاص، إنه يسائل العلامات التي ستجلي له هوية شعبه... وهنا يمكن لغربي (مثلي) أن يتعلم شيئا من الخطيبي، إننا لا نستطيع أن نفعل ما يفعله فليس أساسنا اللغوي واحدا، ومع ذلك يمكن مثلا أن نأخذ عنه درسا في الاستقلال (ce que je doit a Khattibi).
فالخطيبي كما قدمه بارت، يخلخل معرفة الآخر، ويجره إلى أرضه، كاشفا عن خصوصية شعبه، وعن طبيعة ثقافته، فدرس الخطيبي نحتاج إليه دائما لتعميق البحث في نسق العلامات التي تشكل هوية حضارتنا، هذه الخصوصية هي ما سنحاول إبرازه من خلال تناول الخطيبي للفن العربي في سياق التنصيص على خصوصية حضارة العلامة.
طبائع الحضارات.. تمايزها
يستعير الخطيبي تمييزا دقيقا لطبائع الحضارات من أحد العرفاء، يقول فيه: «هناك ثلاثة نماذج كبرى للحضارات: حضارات الصورة (الحضارة الأوروبية وامتداداتها في أمريكا الشمالية والجنوبية)، وحضارات العلامة (الحضارة الهندية والصينية والإسلامية التي تقيم قوتها
الرمزية في القرآن باعتباره معبد الكتاب)، وحضارات الإيقاع (كالحضارة الإفريقية)».
ويؤكد الخطيبي أن مفهوم الفن المعاصر الذي انبثق في الخمسينيات باعتباره نظرة جديدة على «عالم منهار ويعاني من التقلبات» هو مفهوم متمركز حول التجربة الأوروبية والأميركية الشمالية»لا يقدم نظرة مكتملة عن ابتكار الحداثة والمستقبل في دوائر حضارية أخرى«(ص3) ولذلك يجب التفكير في المقارنة بالتمييز، وإبراز القيمة المتبادلة للحضارات الفاعلة في مسألة الفن.
فما يميز الفن العربي الإسلامي، الذي راكم مسارات وموروثا، حسب الخطيبي، هو أنه موسوم بالمزيات الآتية: «استقلال اللون، وصفاء الأشكال، وهندسة مطلقة، وقوة الزخرفة سواء في العمارة أو التوريق أو الزواقة أو المنمنمات (4) والخط والفنون والحرف بتنوع موادها، من حجر ومعادن ونحاس وجلد وورق وحرير. فهناك وفرة في العلامة لا ينقصها الجمال ولا تخلو من قوة غامضة مميزة، ومن تم فإن الفن العربي الكلاسيكي ظل يخترق الحداثة التشكيلية المعاصرة. إذ «قيمة الفن ذي الأشكال الثابتة الذي يخضع للرغبة في الخلود، لم يكف عن بصم نظرة التشكيليين وذاكرتهم البصرية». (5) والتجريدية التي هي خصيصة الفن العربي الإسلامي هي «تجريدية نابعة من حضارة العلامة» (6)، ليس لها «التاريخ نفسه ولا التأليف الجمالي ذاته الذي يميز الفن التجريدي الغربي». وبحسب الخطيبي فهذا الفرق الأساس بين التجريديتين راجع إلى أن «النظر إلى العالم بعيون الكتاب والتوريق يفترض فكرا متوحدا مع كل رغبة في الخلود». وقد أوضح الخطيبي هذا الفرق الدقيق باستشهاده بقولة لبول فاليري حول الفن العربي الإسلامي اتسمت باستبصار لروح حضارة العلامة، يقول فاليري: «إن المخيلة الاستنباطية الأكثر تحررا، والتي واءمت بشكل باهر بين الصرامة الجبرية ومبادئ الإسلام التي تحرم دينيا كل بحث عن محاكاة الكائنات في النظام التشكيلي هي التي ابتكرت التوريق، وأنا أحب هذا التحريم، فهو يجرد الفن من عبادة الأصنام، ومن الخيالات الزائفة والحكي والاعتقاد الساذج ومحاكاة الطبيعة والحياة. أي من كل ما لا يكون خصبا بذاته، بحيث إنه يطور مصادره الباطنية ويكتشف بذاته حدوده الخالصة، ساعيا إلى بناء نسق من الأشكال يكون مستنبطا فقط بالضرورة والحرية الواقعتين التي يقوم بإعمالهما» (7).
إن هناك اختلافا حضاريا يحمل في طياته الإمكانات الإبداعية الخلاقة، فرجوع المنتظم للفن الإسلامي القديم من قبل التشكيليين العرب وغير العرب ليس تعبيرا عن حنين انطوائي وتقديس للأطلال. «ربما كان ذلك الرجوع يخفي السر التشكيلي لكل حضارة تستمر في موروثها البصري، في الحجب الدائم للحياة والموت بفن الأوهام» (8)
فما يميز الفن الكلاسيكي العربي الإسلامي كما بين ذلك الخطيبي في هندسة البيوت والقصور والجوامع هو صفاء الأشكال، وعراء الجدران الذي تزينها زخرفة خفيفة. وفي الخط يتبدى ذلك في الصفحة التي نجد فيها كتابة من درجة ثانية تمنح للنص تموجات بين فن الخط واللون والإنشاد الصامت.
لقد أبرز الخطيبي في دراسته الرائدة الدقيقة ما للفن العربي الإسلامي من إمكانات هائلة في رفد الفن التشكيلي الحديث من مقومات ومن جماليات ما زالت تبهر وما زالت تحتفظ بديمومتها.
..........................................................................................
هامش:
* الاقتباسات الواردة بين العلامتين «» من كتاب الفن العربي المعاصر، الخطيبي، ت: فريد الزاهي.
***

يرى بنعبد العالي أن ثلة مائزة من الكتاب والمفكرين لم يسلخوا ما سلخوا من حيواتهم وأعمارهم، ولم يُحبِّروا ما حبَّروا من جُماع أفكارهم وأنظارهم إلا في مقامات العبور، ولم يضطلعوا بهذه المقامات كأحوال عارضة وعابرة، بل دأبوا أن «يقيموا في العبور» وأن يَحلُّوا في برزخ اللغات، وفي الحدود الواصلة الفاصلة بين الأرومات والهويات والثقافات.
والخطيبي، في تقديرنا، واحد من بين أفراد ذلك اللفيف الفكري المائز الذي يضم صفوة من الكتاب العابرين بين اللغات والثقافات، ولا نحسبه في هذه المنقبة أقل منزلة من هولدرلين أو بيكت أو سواهما، لسبب بسيط هو أنه خبر بدوره المقام في إقامات العبور وفي خطوط اللَّيْمَس الهاربة، بل نظَّر له ضمن ما نظَّر ودبَّج فيه صفحات شائقات فائقات. يقول عبدالكبير الخطيبي في كتابه «عشق بلسانين»: «إنني كينونة تتوسط بين لسانين»، ويقرُّ أنه لم يشعر أبدا بمنزع يشدُّه إلى لغة مخصوصة أو ينزله في سرادق لغوي بعينه. ولئن كان هايدغر يرى أن اللغة هي مسكن الكائن ومقْدِسُه القدسي، فإن صاحب «الذاكرة الموشومة» كان بخلاف ذلك يرى أنه لا يتنزل في لغة معينة ولا ينتسب إلى أفق ثقافي مخصوص.
لقد وجد عبدالكبير الخطيبي نفسه شأنه في ذلك شأن جُماع من الكتاب الذين درجوا بين لسانيين أو أكثر، متراوحاً بين أفقين أنطولوجيين متباينين. ولم يكن يرى في ذلك معْيباً أو معْطباً بل قوة غاذية ترفد عالم الكتابة بمرجعيات رمزية وتخييلية فائقة. إن الكتابة في برزخ الألسن وفي حدودها اللزقة تشكل حسب الخطيبي «لجة فردية وطاقة للنسيان»، نسيان الهويات المغلقة وشرنقاتها، والسلفيات الرمادية وانغلاقها.
فكل كاتب فرانكوفوني (أو كتاب بلغة موليير) يعي أكثر من غيره الانشطار الإيجابي والفعال بين جغرافيات بوليفونية شديدة الميوعة والاندلاق. لأن الجغرافية الثقافية الفرانكوفونية هي جغرافية «مزدوجة بل متعددة الألسن، وفي كل منحى من مناحيها نجد آثارا للامتزاج والرطانة Pidgination ولمراتب ومدارج اللغات»، والكاتب العربي الفرانكوفوني يتشظى بين اللسانين العربي والفرنسي ويهيم بهما كلفا وعشقا من غير أن يعقد القران على أحدهما. وحينما يختار الكتابة باللغة الفرنسية لا يلفي فيها لغة أبوية ولا تطالعه بما هي اللغة الأم، لأنها بالنسبة إليه لسان غفل من كل ملمح شخصي. «وهذا الملمح اللاشخصي، يقول عبدالكبير الخطيبي، هو العالم الطوباوي للكاتب». بل إن مشروعية الكتابة في تصوره لا تتحقق ولا تتأسس إلا حين يعانق الكاتب الكتابة بلسان يغدو منفاه وذريعة انسلاخه وانمحائه، ولئن كانت اللغة تعتبر بالجملة أمة nation الكاتب الفرانكوفوني فإن الفرنسية تبدو بالنسبة إليه عابرة لحدود الأمة une trans-nation، لأنها ليست لغة مركزية ولا تعتبر لسان حال دولة بعينها. لقد انتهى كما يقول الخطيبي «وهم وجود مركز، أو إثنية مركزية مولدة للحضارة الفرنسية ومندمجة في مجال ترابي تحت ظل دولة أو إيديولوجية بعينها». إن اللغة الفرنسية تتبدى لمستعمليها من الكتاب غير الفرنسيين ومن الكتاب الذين أنسوا بالازدواجية اللغوية لغة مضيفة أو لغة ضيافة، ليس فيها محاباة ولا مواربة.
وفي هذه اللغة المضيفة لا يستكين إلى ميتافيرقا الهوية والحضور والتطابق، بل لا ينفك عن التلبس بأرومات وهويات أخرى هلامية وشديدة الانمحاء. لأن اللغة الفرنسية وهي تستضيف الكتاب الفرانكوفونيين إلى سرادقها العامر لا تخلع عليهم ميسما واحدا ولا تسبغ عليهم هوية مشتركة أو ترتهنهم في أفق أنثربولوجي بعينه. فالهوية صيرورة وموروث حركي من الآثار والعلامات، وليست جوهرا قائما أو ماهية معطاة. يقول عبدالكبير الخطيبي: «إن الهوية لا تتحدد من خلال بنية أبدية بل تنتظمها علاقات غير متوازية بين الزمان والمكان والثقافة».
الغريب المحترف
يصف عبدالكبير الخطيبي نفسه في كتاب «صيف بستوكهولم» بالغريب المحترف، ويصفه ريو فاتانبي Ryô watanbe «بمفكر اليتم الذي يرفض كل أمل ويشتبه في ثالوث العرق ـ اللغة ـ الأمة». ويلتقي التوصيفان معا في التأكيد على أن صاحب «الحمى البيضاء» vomito Blanco عاش غريبا ومات غريبا، واضطلع بغربته كقدر أنطولوجي تاريخي وكسيرة إستيطيقية. والغربة التي اضطلع بها طبعت فكره واصطبغت بها كتاباته الأدبية والفنية والفلسفية، وكابدها في جرح الاسم وازدواجية اللسان وتشظي الهوية وتعدد المظان وتناسل الذاكرات وتضايف التواريخ المحلية والكونية. خبر الخطيبي الغربة واحترفها، ولم يعانقها خارج حدود الذات وخارج مداراتها الإثنولوجية، بل أنس بها كطقس أنطولوجي يومي في أفق تدشين فكر للاختلاف والمغايرة: أفق مغاير يستوي فيه على حد تعبير ريو فاتانبي «كشخص غريب لا يعنيه أن يظل مغربي الأرومة ولا أن يتشبه بما يتحدر من فرنسا أو ما يمت إليها». فهو يشعر بالغرابة والاغتراب في «لغة قومه وحدود بلده وفي جغرافيته المادية والروحية»، كما يستشعرهما في لغات وثقافات وجغرافيات أخرى. والكتابة العارية، المتشظية والمتحللة من كل أصل ومن كل أرومة ومن كل ذاكرة إثنية، هذه الكتابة المتغربة هي الضمانة الوحيدة ضد التصور الماهوي للهوية وضد المقترب الميتافيزيقي للتراث. الكتابة المتغربة العارية لا تنتسب إلى الهويات المخملية الرضية ولا تتمسح بالتراث كما يتمسح السدنة بقدس الأقداس.
ماذا يقول لنا التراث؟ إنه لا يشي بما يرج الكتابة رجّاً أو يسوقها في مساقات التجريب والتقويض والتغريب. إن التراث، بحكم بنيته الأنطو ـ تيولوجية الراسخة، لا يستطيع أن يتخلص من إسار الميتافيزيقا. كما «أن الميتافيزيقا، يقول الخطيبي، هي بنحو من الأنحاء السماء الروحية للتراث». إنها العود الأبدي للموتى الذين يخاطبون الأحياء من مقام شامخ وبعقيرة عالية متفيشة وصلفة، على نحو لا تغدو معه أصوات الأحياء غير رجع حيي خافت وكأنها وقع أجراس في مدينة غارقة.
لا يضطلع الكاتب بتجربة الغرابة إلا بوصفها خلخلة لميتافيزيقا الهوية والوحدة والحضور: خلخلة تجهز على السرائر والضمائر قبل أن ترجَّ الأفكار والأنساق والذِّهنيات والبِنيات والقيم. يقول عبدالكبير الخطيبي: «الغرابة هي أولاً ملمح يتمثل في تخارج ما هو جواني» وتشظي ما هو جواهراني. إنها ما يجعلنا نباشر «تجربة المستحيل» بما هي تجربة حدودية قُصوى، تجربة ما لا ينقال وما لا تطاله الإرادات.
إن الكتابة تقتلع صاحبها من تضخمه النرجسي، ومن تطابقه ووحدته، وتُحرِّره من التاريخ والجغرافية ومن لغته الأم. لذلك ترى الكاتب ينوس بين سجلات لغوية مختلفة» ويتخلق داخل لغة غريبة عن أصله وينشأ بين ثناياها بوصفه أحد ذريتها أو أعقابها، بل يترحل من لسان إلى لسان داخل نفس اللسان، لأن كل لغة من اللغات الطبيعية هي لغة تعددية بوليفونية تتناسل فيها سجلات لغوية وقواميس تداولية مختلفة، وتتشابك داخل بنيتها المعجمية والدلالية مستويات مختلفة شفوية ومدونة، واقعية ومعيارية، سائدة وبائدة، كما تضطلع بوظائف متباينة مرجعية ميتالغوية، شعرية وفاتية. واللغة بقواميسها وإسناداتها وسجلاتها ومرجعياتها تستولي على الكاتب وتزيحه عن مركزيته الانثربولوجية، كما تزيح قارءه عن مسبقاته. إن اللغة، يقول الخطيبي، هي الأفق الجوهري للكاتب. وعن طريقها ينفذ إلى معرفة العالم والإنسان، لكن اللغة وهي ترسم المدارات وتحدد الخطوط العامة التي يهتدي بها الكاتب تشرعه، في الوقت نفسه على التيه والغرابة والتشظي والانشطار. ولأن اللغة لا تكف عن الخروج عن تطابقها ونسيان وحدتها أو صفائها المفترض، فإن الهوية تغدو هوية دينامية تستدمج ما هو مغاير وتتقوم به، وتنفتح على الغريب «وستغرقه وتتملكه» على حد تعبير الشاعر والأديب الألماني الكبير غوته. إن اللغة التي تستحق فعلا أن تكون لغة الكتابة والأدب هي لغة غريبة عن ذاتها وعن قومها، لغة تسكنها لغات أخرى ويشكل التعدد اللغوي مقومها الجوهري»، وليس محض مرض يصيبها أو عرض يلحقها». إنها تستضيف في معجمها وفي عالمها الدلالي المختلف والمغاير والحوشي والغريب، وتتجابه داخلها لغات ولهجات مختلفة ويتضارب في تضاعيفها الأصلي والدخيل والمعياري والمولد، لأنها، يقول الأستاذ بنعبد العالي، «عُشُّ الاختلاف بلا منازع وهي تعيش حروبا (لغوية) لا تنفك ولا تنقضي».
كتاب الدم
لم يلتفت كثير من العارفين بمتن الخطيبي الأدبي إلى أحد أجمل نصوصه وأكثرها وهجا ورواء، أقصد «كتاب الدم». فهذا نص إبداعي جسور يدشن لكتابة مغايرة تشرع القارئ على أسئلة لافحة تتصل بالموت والحياة والغياب والحضور والهوية والاختلاف. ولعل أخص خصيصة تطبع «كتاب الدم» وتميزه عن سواه من كتابات الخطيبي هي أنه نص يراهن بكثير من الألق على الممتنع والأورفي والمفارق، ويؤسس ترتيبا على ذلك لكتابة رائدة ينعتها مارك غونتار بكتابة الغلو أو بالكتابة المفرطة Hyperécriture أو ما يمكن أن نجوز لأنفسنا أن نسميه من جهتنا ببلاغة النزيف. ونتكئ في هذه الدعوى على عبارة لماحة من جماع فرائد الخطيبي التي لا يسع القارئ إلا أن يتمتم بها بملء فيه وأن يرددها عاليا بضرب من الرنح وبنحو من الشطح غريب، تقول هذه العبارة الواردة في «كتاب الدم»: «أنا أنزف وأغرق في أغوار ذاتي وأطمر نفسي على مهل: فأنا أكتب». وهذا النزيف اللجي الذي يحايث فعل الكتابة ويشكل ملمحها الفارق ووازعها الماهوي يكاد يطالع القارئ في أغلب عناوين نصوص الخطيبي الشهيرة: ألا يطالعنا في «الذاكرة الموشومة»؟ أليس الوشم هو وخز الجسم وتغريزه بالإبر، ورش لجروحه بمادة النيلج كي تستحيل أشكالا وتخطيطات ورسوما تسبغ على هيولى الجسد كيمياء عضوية جديدة؟ ثم ألا يطالعنا نثار النزيف في كتاب «جرح الإسم الخاص» أو في ما عرف في الترجمة العربية» بالاسم العربي الجريح»، وفي «كتاب الدم» وفي نصوص وكتابات غيرها يمثل التمزق عنوانها المائز ومقومها البنيوي. فالجسد المتشظي، المنثلم والنازف على الحدود القصية والمتحلل من وحدته وتطابقه وتجوهره يعد تيمة أثيرة تسكن متن الخطيبي بتنوع مآخذه النظرية والسردية والشعرية. الكتابة نزيف والكتاب نثار الدم وبقعه الممتدة التي لا تخضب الصحائف فحسب، بل تستغرق الكاتب في لجة جارفةلا تبقي ولا تذر. يؤكد الخطيبي في سياقات مختلفة على مصادرة أساسية مؤداها أن الكتابة تتخرم الكاتب وتستنزف قواه وتجعل الدم الخصيب «يسقط كما يقول الخطيبي نقطة نقطة على كل كلمة من كلمات وتجعله يمزق أوصاله ويقطع أوردته». وما دامت الكتابة، بهذا المعنى، لا تباشر بالحبر بل تتفتق ثلوما وكلوما، وتجري دما وتسوق الكاتب إلى ذروة النزيف، فهي ترتيبا على ذلك تجربة قصوى على شفير الموت وعلى حدوده الماحقة. بل قل إنها احتفاء أورفي بالموت. ليس لأنها كتابة تشتغل من مقام تراجيدي على موضوعة الموت بإشكالاته الأنطولوجية وأبعاده القيامية والإسكاتولوجية، بل إن ظلال الموت ترين عليها وتنتظم سيروراتها الخلاقة، فتصيرها كتابة يتيمة، جريحة الإسم بلا أب ولا منظومة إسناد، ولا تحيل إلى مرجع في العالم كما لا تستوطن أية لغة بعينها، إن هذه الكتابة اليتيمة لا تعترف بالأرومات والأبوات ولا تعنى بالهويات والجنيالوجيات، إنها ترفض الإقرار بأبوة الكاتب وسيادته على نصه أو بملكيته لحقيقته. كما ترفض التأكيد على العالم كمعيار مرجعي لإثبات تلك الحقيقة أو على اللغة كوساطة تواصلية لمحاكاة العالم وتمثل معطياته. إنها تشرع الكاتب على الغربة وعلى «متاه مستديم» يعانق فيه الموت في جدله السالب الحياة في توثبها الحيوي واندلاقها وغناها. يقول الخطيبي: «أنت، أيها الشاعر المأخوذ بحالة الشطح لا تبحث عن وطنك في مقام آخر غير مقام الموتى، والموت الذي أتحدث عنه هنا هو موت أورفي، يقع في ذروة حياتك المسحورة». الشاعر اليتيم هو كائن أورفي لا يحيا إلا في «المواجهة مع الموت» في مفازات الكتابة. إنه يمشي، يقول الخطيبي، بين خرائب العالم، حاملا نعشه على كاهله. ولا يبقى منها على ظهر الكتاب غير «توقيع يتيم». «فيا أيها القارئ لا تغلق دفتي الكتاب على عجل فهو يضم بين صحائفه جثمان صاحبه».
***

الشعر والفكر، في هذا النص، يتواشجان في نشيد لا يروم تمجيدا للذات أو اختلاق ملحمة ذات نزوع مأساوي خالص، إنهما يتطابقان في جدال وحوار أشبه ما يكون بموسيقى فاغنرية: «هات حكاية جميلة وإلا قتلتك. هذا المبدأ الحصري على الإطلاق المعتمد في ألف ليلة وليلة من شأنه، عندي، أن يؤدي بكل راو حيث يتجلى: صورة لحد مشع منه – قد – ينبعث نشيد الشعر والفكر» (ص7).
يزحزح الخطيبي جرحه القدري تحت ضوء كاشف، ويتقلّب تهويمات أشكاله وعنف مفارقاته، عبر تقاطعات الغيرية الصادمة، صدمة تاريخية وجمالية وفكرية، قبل أن تكون لغوية وذاتية.
هويّات ملتبسة
عن زخم الهويات المارقة، الملتبسة والمتعددة، ولو على سبيل الازدواجية، تلوح المدن في «الذاكرة الموشومة» كمجرات تستأثر بالغواية والمسخ والتحول، كمرايا شيطانيّة، يدخلها الخطيبي فيؤول إلى ذوات منشطرة، لا سبيل إلى لملمة شظاياها المنزاحة، بدءا بمدينة الجديدة وصنْوتها الصويرة، ومراكش مدينة مراهقته، ثم باريس ولندن وستوكهولم...
يفرد الخطيبي حيزا مركزيا لباريس في ذاكرته الموشومة، على غرار باريس خوليو كورتاثار وجورج أورويل وهمنجواي وهنري ميللر.. إلخ
يسافر الخطيبي إلى باريس كطالب لعلم الاجتماع في السوربون، ولا يخفي لقاءه بالغرب في «رحلة الهوية والغيرية المتوحشة»، يعلن السفر بلا رجعة كما لو كان قد عقد العزم على التلاشي في غواية الضفاف الأخرى، محملاً بأعطابه وجروحه النرجسية.
باريس السريّة
تبدو باريس شأنها شأن اللغة الفرنسية «غريبة جميلة شريرة»، منشطرة إلى صور، الصورة الأولية هي صورة باريس الأيروتيكية، التي يكتشف زمنها السري عبر غواية الجنس، وكان دليله إلى أبجدية «وزير النساء»، صديق مغربي له جدية الأب وخبث الخال.
هناك صورة ثلاثية، لباريس سديمية، يجلو ملامحها تعاقب ثلاثة وجوه لأصدقاء غيْريّين، هم شريف الخلاسي (هوية إيرانية بولونية) شبيه ببهلوان في علاقاته النسائية، وجاك المولع بموسيقى الجاز، صاحب الجمال الخيالي، الذي يثير الاضطراب عند المراهقات، وبطرس الريفي المولع بالرسم. هكذا تتمزق أو تتلاشى صورة باريس البكر عند الخطيبي التي ارتبطت في مخيلته بسارتر، وصارت تتأرجح بين موسيقى الجاز وبريق أجساد النساء وهذر النظريات حول الثقافات الأخرى.
باريس الموسيقية
باريس الموسيقية، ستتضاعف مع حبّ الخطيبي للنّغمة الأشد تعقيداً، شأن صوت بيلي هوليداي وجون كولتران، الذي يحفزه قلقه على الكتابة: «جسدي ينصت فأنا كاتب» (ص 90).
تتعمق العلاقة الموسيقية بباريس من خلال تعرفه على فتاة فاغنرية تعزف البيانو: «ذئبة يهيجها الهوى، أتت مرتعشة الجسد، دوارا عند الفتحات الفاغنرية، فقد تعبدت لهذا الموسيقي، تتحوط بالأسطوانات وتعزف على البيانو، جنونية، مشبوهة، مأساوية حتى التشنج» (ص 101).
وعبر التسكع معها في نوادي الموسيقى يكتشف الخطيبي الحدود القصوى للذة والمعنى، الحدود القصوى للفراغ المفزع أيضاً.
باريس الأدبية
ثمة صورة أخرى لباريس الأدبية والثقافية، المتعلقة بتردّده على الحلقات الشعرية في المقاهي السرية، والجماعات في الحي اللاتيني الذي يصفه بمزبلته، أو قصره الرّملي «فيه أدفن مراهقتي فيما المبتزون ينامون في نهر السين مسدلي الجفون» (ص 91).
في صلب ذلك الزخم الهادر كتب الخطيبي أشعارا وقصصا ونصوصا نقدية، مدركا لفخ باريس الشبيهة بمؤامرة، وفي معترك هذه التخوم، نسج صداقات مع كتاب كآلان روب جرييه، الذي ينعته بالمهووس المنهجي،: «نظام معتوه من العادات المضحكة السخيفة» (ص 92).
أما باريس السينمائية، فصورة مزدوجة لها صلة بارتياده قاعات السينما بتلك المرحلة البكر، التي كانت تعرض أفلام شابلن مع أخرى ذات علاقة هشة بالواقع من جهة، ومن جهة ثانية لها صلة بصداقته مع المخرج جودار، الذي جمعتهما نقاشات حول أفلامه وفق هذيان الثقافات حسب توصيفه.
هناك صورة لباريس اليسارية والراديكالية، ذات الارتباط بحرب الجزائر، إذ يعلن الخطيبي نفسه إلى جانب ماركس، كمناضل منقسم على نفسه (يختار الالتزام العملي حين يحلو له، ويختفي حين يمسي مأساة سخيفة) ص 95.
يعود الخطيبي لباريس الرسم والفن التشكيلي، ليقرّ بأن الفنان شاجال كان هو الدليل العملي إلى المعرفة الفنية وتذوق اللوحات، إضافة إلى الرسام المغربي الشرقاوي الذي فتح باب الكلي في وعيه الجمالي، فيما يتعلق بنظرية الألوان. ثمة شعور يسجله الخطيبي غداة دخوله لمعرض ووقوفه أمام لوحة، إنه يشعر بوحدة تجعله يفكر في الهرب، وتكفيه لوحة واحدة لمدة أسبوع كي يستمتع باهتزاز إيقاعها البصري ورعب اللون. أما المعارض فيشبّه نضارتها (بنضارة المقابر: الغرب يعرف جيدا هذا المذاق الأخروي الذي ثمنه ألم الرسامين الكبير) ص: 96.
ثمة صورة أخرى لباريس المسرحية، لا يتعلق الأمر بمشاهداته لمسرحيات في مسارح بعينها، بل يتعلق بنصوص مسرحية كتبها هو نفسه، وأُخرجتْ ومُثّلتْ، بعضها كان فاشلا وبعضها ظفر بنجاح خاص.. ابتدع الخطيبي مسرحاً جديداً: «لم يعد للمؤلف ولا للمخرج ولا للشخصيات أية فائدة. تقنية عجيبة لتدمير الحياة وخلقها من جديد» (ص 98).
فضلا عن صورة ضمنية لباريس بورجوازية، تكشّفتْ له من خلال علاقته بصديق جزائري، كان يتقصى نساء القرى المجاورة المترفة، ويغنم لحظات جنسية مع زوجات الأثرياء، يأتي بهن فرادى ومثنى وثلاثا، فتواطأ الخطيبي معه في اللعبة، معريا عن وجه سافر للمدينة، عبر مطبخ زوجات الأثرياء.. باريس الخيانة الموشومة والعلاقات الإنسانية المزيفة والانتهازية..
تلك هي صور باريس الموشومة، المتاهيّة في المجمل، صاخبة وناهبة، حالمة ومجنونة، فردوسية وجحيمية، أليفة وغريبة، عابرة وراسخة، مضيئة وعاتمة، سديمية وملتبسة، واحدة ومتعددة، متناغمة وانشطارية.. إنها باريس الذاكرة الموشومة، التي ينعتها الخطيبي في علامة مكثفة وموجزة، بمرتع غيريته: «الغيرية امرأة، والغيرية المتوحشة غواية خفية» (ص 104).
.......................................
* عبد الكبير الخطيبي، الذاكرة الموشومة، ت: بطرس الحلاق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1984.
مدينة كل شيء
تتبدى باريس في نص الخطيبي: صاخبة وناهبة، حالمة ومجنونة، فردوسية وجحيمية، أليفة وغريبة، عابرة وراسخة، مضيئة وعاتمة، سديمية وملتبسة، واحدة ومتعددة، متناغمة وانشطارية.
***
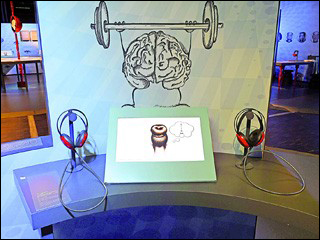
اسمحوا لي أن أذكر أنه سبق لي أن قدمت- في إطار آخر- اقتراحات واضحة حول دور المثقف في المجتمع، فسواء أكان محافظاً أو مجدداً أو مبتكراً فإنه يقوم بعدة وظائف متفاوتة منها: وظيفة بيداغوجية، تقنية: إذ يُمرس غيره على قضايا الفكر والفن، بحيث يعطي المثال بنفسه. وظيفة اجتماعية: فسواء أكان ملاحظاً أو عنصراً فعالاً أو مجرد ناشر للمعرفة، فإن المثقف يقوم بدور تنبيه الفكر لذكاء وحساسية عصره. لقد كان المثقف دائماً، وفي جميع المجتمعات، يلعب دور الوسيط بين الحاكمين والمحكومين، وسبق له أن تعاطى السياسة، لكنه نادراً ما استمر في ممارستها، لأن عمله الأصلي هو تحريك الفكر، وتحليل المجتمع، لا إدارته. وظيفة أخلاقية: فسواء أكان مناصراً للعقل المطلق أو للحكمة في خدمة الإنسان، أو كان مناصراً لقضية أو لمثل أعلى، فهو مطالب بأن يتكيف باستمرار مع المبادئ والقيم التي يدافع عنها، وبالتالي فهو مرغم على سلوك موجّه لذاته.
لكن استبطان قانون الفكر يعني الاستقلال والملاحظة، ملاحظة النفس كحامل لحرية تفكير مستمرة، إذ بدونها كيف سيصبح المثقف عنصراً فعالاً في المجتمع المدني. فالمراس والتكيف وإرغام النفس هي مهام المثقف، مهامه في المدينة، حتى ولو كان متجاوزاً لعصره.
إذن، كل مثقف ينتمي إلى عصره، إلا أن عصرنا يعرف في نهاية هذا القرن تغييراً حاسماً، أي تقسيماً جديداً للعالم إلى مناطق نفوذ، حسب تكتل جهوي لمجموعات كبيرة قائمة، أو في طور التكوين.
ويؤدي هذا التكتل إلى تراتب بين مجموعات البلدان الحضارية، حيث تشكل «الليبرالية الديموقراطية» رأس رمح الأيديولوجية السائدة، باعتبارها أسمى قيمة للإنسانية العالمية، و«لنظام العالمي الجديد»، فمن جهة تشكل هذه القيمة نموذجاً مرجعياً لحقوق الإنسان وللمجتمع المدني، ومن جهة أخرى تبريراً لكل بنية تقنية (صناعية وعسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية).
ثقافات عابرة للموقع
هذا وبسرعة تقنية وعلمية تُحدث ظاهرة جديدة لا يمكننا تخمين كافة عواقبها الآن. ألا وهي «لا تموقع» الثقافات التي تَقْلب المعالم والتي يرجع إليها هذا المجتمع أو ذاك. ويوجد من بين هذه المعالم ما يسمى بالتراث في جميع أشكاله: المكتوبة والشفوية والصوتية والحركية والبصرية. كل هذه الآثار تشكل ذاكرة ثقافة، أو حضارة نقلت إلينا وهي من بين أنفس ممتلكاتنا. بيد أن هذا التراث يخضع لقانون تصنيع الذاكرة وسوقها.
وقبل أن أتحدث عن هذه النقطة، أود أن أقدم نفسي من جديد:
وإذا تقدمت إليكم من جديد على أنني باحث مغربي، فإني أفترض إما أن تنحصر إنسانيتي في مغربيتي (التي تصبح بالنسبة لي علامة هوية)، وإما أن تعتبر مغربيتي كمفهوم وكتعبير عن العالمية، الشيء الذي يجعلني قريباً من أي إنسان، حي أو ميت، في كل زمان ومكان، وإما أن أحمل مغربيتي بصفتها تصوراً دقيقاً نسبياً، أو صورة لما هو مفروض أن أكونه كأحد أعضاء المجموعة التي أنتمي إليها.
لنتابع، وإذا تقدمت إليكم أولاً بكوني مسلماً، يمكن أن يكون ذلك بصفتي وحدة دينية أو وارثاً لرسالة عالمية. آنذاك سيتأرجح تحليل هويتي الدينية بين اتجاه وآخر.
لو كنا نتوفر على وقت كاف، لتابعت هذا الحديث في شكل حوار من صميم الديموقراطية ومعرفة الآخر. ذلك أنه يجب في الحوار، أن نبتدئ بالإقرار أن محاورنا مصيب شيئاً ما فيما يعبر عنه. وهكذا، فإن العقل يغتني ويغني المتحاورين إذ يوجد بينهم مجال للحوار والمعرفة وممارسة الفكر والتسامح، التسامح مع النفس ومع الآخر، في حدود القانون والأخلاق يتعدى مسألة «لا تموقع» الثقافات إذ المكان ليس إحالة على بلد معين وإنما هو أيضاً إحالة على ثقافته وتاريخه وتراثه ومرجعياته، وباختصار على معالم هويته.
إن «اللا تموقع» الذي أحدثته التقنيات والنظام الجديد للسوق وعولمتهما المزعومة لا يمكن أن يدرك من قبل أولئك الذين يعارضون بين الحضارة والتقنية، لقد فهم العرب القدامى ذلك بما فيه المجال الفني إذ كانوا يقولون مثلاً: بأن الشعر صناعة والموسيقى صناعة.
ومواكبة للحضارة الصناعية وضعت التقنية نسقاً كونياً للمعلومات، في حين أن الثورة الرقمية تعيش مسلسل ابتكارات تقنية لا تحصى، إنها تؤثر في سياساتنا واقتصادياتنا وثقافتنا وعاداتنا بل حتى في حساسيتنا وجسدنا، إذ يتعين على المثقف أن يسجل هذا المسلسل، ذلك أن المعرفة في ميدان العلوم الإنسانية مثلاً تغير وسيطات تحليلها. فهي تتجه بقوة متزايدة، نحو عالم جديد، هو عالم التقنَعِلمية. فقد حلّ محل الحوار القديم القائم بين الفلسفة والعلوم الإنسانية حتماً حوار آخر، حوار أصبحت فيه التقنَعِلمية تفرض، بسرعة اختراعاتها وسيطرتها (من المعلوميات إلى الجراحة الوراثية مروراً بجميع المعارف العلمية الجديدة). لقد أصبح مفهوم العلوم الإنسانية يتغير اليوم.
هناك اشتكى باحث مؤخراً من قلة المراسلات بالجامعة المغربية. ولكن التطور المتوازي للإنسان والآلة، يضعنا أمام أشكال وأنماط أخرى للاتصال اللا مادي. لقد أشرت في مذكرتي التقديمية إلى أن المفكر يواجه اليوم التطور السريع للمعرفة وللمهارة التقنية وللعولمة. هذا التطور الذي يحدث منافسة بين الثقافات وحواراً بينها على أساس معطيات جديدة في حالة إسهامنا في ذلك الحوار.
سياسة الذاكرة
هل يخضع هذا الحوار الذي يشكل مهمة ما يسمى بمجموعة المثقفين، إن على المستوى الوطني أو الدولي لوسيطات جديدة؟ ما هي؟ ما معنى مجموعة المثقفين الدولية اليوم؟ في عالم تخضع فيه الثقافة أكثر فأكثر لاقتصاد ضاغط في الانتاج والتدبير والتوزيع. ما هي البلدان القادرة اليوم على نقل ثقافتها وبيعها على الصعيد الدولي؟ خصوصاً وأن التراث الحضاري متعدد المراكز من جهة، ومن جهة أخرى يشكل وجيهة من تصنيع الذاكرة الذي يندرج ضمنه تراث الشعوب الوارثة له.
هكذا، يجد المثقف نفسه أمام معلومات غير محدودة، بسبب ذلك التصنيع للذاكرة، وللمعلومات نفسها قدرة كبيرة على إنتاج الثقافات الحالية، وهكذا توجه المعلومات التفكير وتؤثر في الرأي العام وتندرج ضمن ما يمكن أن نصطلح علي تسميته «بسياسة الذاكرة».
لنأخذ مثلاً طفلاً ينتمي إلى بلد ما وينجذب يومياً، ولو لساعة واحدة إلى الرسوم المتحركة الأميركية، دون أن يشعر بتحول في خياله. فقد قيل لي في شهر نوفمبر الماضي، وأنا بأطلانطا في استديوهات «س. ن. ن» أثناء زيارة استطلاعية، إن هذه القناة والقنوات التابعة لها تصل إلى 220 مليون بيت عبر العالم. وذلك يدل على مدى أهمية تحديد الهوية الثقافية والرمزية للمشاهدين من خلال هذه العمليات التجارية الضخمة للصورة.
كما يدل على أن مفاهيم الوراثة والنقل التي تعزز الهوية الثقافية تمر عبر طرق أخرى، فإذا كانت الصورة تنتج حياة حلم للترفيه عن الفكر وعن الجسد، فيجب أن نتساءل من خلال حياة الحلم هاته، كيف ينتصب توزيع جديد للعالم، أي قوى حديثة سياسية واقتصادية وإعلامية، كما يجب تحديد ما يتهدد التنوع الحقيقي للحضارات ولتراثها الذي يوجد كوجيهة بين المعلومات ووسائل الإعلام والسياحة وقنواتها الدولية.
الترجمة عابرة الحدود
كان الدور التقليدي لعابر الحدود بين الثقافات يكمن وما يزال في الترجمة، فالمترجم هو رجل الحوار بين الحضارات من خلال اللغة. والترجمة مهمة حتمية لتحيين المعرفة والتعرف على الآخر.
وهكذا يجب أن نترجم المؤلفات القديمة والحديثة للبشرية التي تطبع عصرنا ولو للاطلاع على ما تنتجه مجموعة المثقفين الدولية.
أعتقد أن الترجمة أي معرفة حضارات أخرى تقي البشرية من هيمنة «الفكر الوحيد». إنها تعدد الحوار بين الحضارات ونضال سياسي على واجهات مختلفة، وحين نعلم أن الكتاب الذي ينتجه مثقفون عرب لا يستطيع أن يتجاوز الحدود العربية فمن حقنا أن نقْلق على عدم انتشار الحضارة العربية في العالم، وعلى مكانة مثقفينا في المجموعة الثقافية والعلمية الدولية، يتعين إذن احتلال هذه المكانة وهي غير شاغرة.
فالمثقفون المهاجرون العرب يشكلون حيزاً بين الثقافة والعولمة، ويحظون بنفس أهمية المترجمين، وذلك يعني أن العربي هو الذي يدّعي أنه كذلك حيثما وُجد. وقد أصبح هذا المثقف أجنبياً احترافياً قادراً على إدراك الظاهرة الدولية للاتموقع. إن تجربة المنفى ليست فقط حالة تمزق وحنين، بل هي كذلك درس مفيد للحياة وللفكر. إن التداخل الثقافي يعلمه يومياً ممارسة التشابه والاختلاف بين البشر والثقافات والمجتمعات. فهو كمواطن عالمي يشعر بمسألة التسامح وعدمه. إن الإسهام العلمي والثقافي لهؤلاء العرب ملك نفيس للجميع، بما في ذلك الحضارة العربية. فحيث ما جُلت عبر العالم إلا ووجدت علماء وفنانين ومثقفين عرباً رفيعي المستوى، هم بكيفية ما سفراء حضارتهم الخاصة.
استراتيجية مزدوجة
لنعد إلى المثقف العربي الذي يعيش في بلده. لقد تحدثت إلى حد الآن وكأني لم أميزْ بين المثقف والمفكر، فالمفكر مختص في ميدان معين، إذ نرجع إليه باعتباره خبيراً أو مسؤولاً عن الدراسات غير أنه حين يتوجه إلى الرأي العام الوطني أو الدولي، فإنه يلعب دوراً ثانياً هو دور المثقف في المجتمع.
إننا نعرف أن الرأي العام الدولي يتأثر أكثر فأكثر بتقنيات الاتصال وبوسائل الإعلام. ودون أن ينمحي؛ فالمثقف الملتزم من أمثال طه حسين وجون بول سارتر يُعوّض بظهور شخوص آخرين من مثقفين صحافيين أو إعلاميين أو خبراء أو مدبرين أو صانعي الرأي العام وثقافة الفرجة. هناك إذن تحول في دور المثقف وليس انمحاء. ومن الملح أن نحدد مهمته إزاء الرأي العام الدولي، وبالتالي إزاء حوار الثقافات في هذا المعطى الجديد.
إنه يحتاج في نظري إلى استراتيجية مزدوجة، فمن جهة يتعين عليه أن يحافظ على استقلالية فكره ليشكل هوية جديدة تتلاءم مع مسلسل العولمة واللا تموقع. ومن جهة أخرى يتعين عليه أن يتحاور مع المختصين في الفكر والباحثين والمبتكرين والخبراء الذين يصنعون الرأي العام الدولي.
ففي ما يخص الجانب الأول تشكل الجامعات والمعاهد المصدر الأول لمعلوماته، إلا أن الجامعة نفسها تعرف تحولات كبيرة بفعل المعلوماتيات وشبكاتها المختلفة. فمثلاً بالنسبة للتعليم عن بعد وللجامعات «المحتملة»، فمن مصلحة المثقف أن يعمل جنباً إلى جنب مع خبراء التقنيات والاختراعات الجديدة، وأن يظل ملتزماً بالدفاع عن إنسيّة متفتحة تروم تعدد مراكز الحضارات وخصوصياتها واختلافاتها، وتروم من خلالها الدفاع عن الشعوب المهمشة.
فلا أنسى قط أنه توجد بين الثقافات منافسة إن لم أقل حرباً مستمرة. وبما أن العنف مندمج في الحياة، يجب ألا ننكره بل أن نخلصه من اللا معقول.
إذ يظل الفن الحليف الطبيعي للدفاع عن الإنسان في مواجهة ذاته وضد عنفه الذاتي. علاوة على كونه ترفيهاً عن النفس فإن الفن تجل للحياة. إذ لا يجعلنا نحلم فقط وإنما ينقل قوة حياة نحتاجها جميعاً لمواجهة حركية العالم. لكل حضارة معالمها وتاريخها وأصالتها. لذا يتعين التعريف بالحضارة العربية وجعلُها أكثر تنافسية في إطار العولمة.
.........................................................
نشر هذا المقال في كتاب: السياسة والتسامح، ترجمة عز الدين الكتاني الإدريسي، الرباط 1999، منشورات عكاظ ص (7- 18)
 بين مؤلفات عبد الكبير الخطيبي التي لا تحصى، في مجالات نظريّة وإبداعيّة شتّى، هناك كتاب يبقى إلى اليوم أقرب إلى اللغز. نصّ طلسمي، أو رسالة مشفّرة إلى معاصريه، تحمل لنا جديداً مع كلّ زيارة. إنّه «المناضل الطبقي على الطريقة الطاويّة» (صدر بالفرنسيّة في عام 1976، وعرّبه الشاعر والمترجم والباحث العراقي/ الباريسي كاظم جهاد، وصدر في عام 1986 عن «دار توبقال» المغربيّة). دار جدال حاد حول مدى جواز تصنيفه في خانة الشعر، لكنّه كذلك في العمق. ربّما جاز اعتباره نصّاً فكرياً أو حكمياً، لا يبتعد عن سيوران كثيراً، ولو أن كتاب لاوتسو يبقى مرجعه الظاهر. وماذا لو نظرنا إليه بصفته الكتاب الحميم، القادر على اختصار صاحبه الذي يترك لنا منجزاً متعدد الروافد والوجوه: النقد أساساً، علم الاجتماع والفلسفة كمادة مرجعيّة، اللغة والكتابة ومنظومة الإشارات، الرواية والشعر والنصّ الإبداعي...؟ وذلك القاسم المشترك، «التأليفي»، لمثقف عربي مغاربي تجاوز شروط الجغرافيا، وبنى منهجه على فكرة النقد (المزدوج) في قلب الأزمة، ومكانة الإنسان في قلب الحاضرة (أو المدينة)، ضمن علاقة جدليّة بين الإحساس والفكرة والكتابة (أو الشكل الإبداعي). هذا المثقف الملتزم (بالمعنى السارتري الأصفى)، «القلق»، «الشاهد»، المنشغل بتفكيك البنى ونقد المجتمع، باستقراء العلامات والرموز وتحريك الفكر، يزاوج هنا بين الماركسيّة والطاويّة، بين التغيير والتأمّل. إنّه «عناد» الكتابة، تجليات فكر يقترن بالواقع خارجاً على الأنساق الفوقيّة الجاهزة. نلتقيه هنا في لحظة ترف جمالي، وتيه لا يوفّره إلا الشعر. والشاعر رأى كلّ شيء: «وها أنا أغادر الحكمة المنظومة/ مواصلاً سيري في هذه الرحلة/ قاربي الصغير ينزلق/ والموجة ترشق الزبد الراقص».
بين مؤلفات عبد الكبير الخطيبي التي لا تحصى، في مجالات نظريّة وإبداعيّة شتّى، هناك كتاب يبقى إلى اليوم أقرب إلى اللغز. نصّ طلسمي، أو رسالة مشفّرة إلى معاصريه، تحمل لنا جديداً مع كلّ زيارة. إنّه «المناضل الطبقي على الطريقة الطاويّة» (صدر بالفرنسيّة في عام 1976، وعرّبه الشاعر والمترجم والباحث العراقي/ الباريسي كاظم جهاد، وصدر في عام 1986 عن «دار توبقال» المغربيّة). دار جدال حاد حول مدى جواز تصنيفه في خانة الشعر، لكنّه كذلك في العمق. ربّما جاز اعتباره نصّاً فكرياً أو حكمياً، لا يبتعد عن سيوران كثيراً، ولو أن كتاب لاوتسو يبقى مرجعه الظاهر. وماذا لو نظرنا إليه بصفته الكتاب الحميم، القادر على اختصار صاحبه الذي يترك لنا منجزاً متعدد الروافد والوجوه: النقد أساساً، علم الاجتماع والفلسفة كمادة مرجعيّة، اللغة والكتابة ومنظومة الإشارات، الرواية والشعر والنصّ الإبداعي...؟ وذلك القاسم المشترك، «التأليفي»، لمثقف عربي مغاربي تجاوز شروط الجغرافيا، وبنى منهجه على فكرة النقد (المزدوج) في قلب الأزمة، ومكانة الإنسان في قلب الحاضرة (أو المدينة)، ضمن علاقة جدليّة بين الإحساس والفكرة والكتابة (أو الشكل الإبداعي). هذا المثقف الملتزم (بالمعنى السارتري الأصفى)، «القلق»، «الشاهد»، المنشغل بتفكيك البنى ونقد المجتمع، باستقراء العلامات والرموز وتحريك الفكر، يزاوج هنا بين الماركسيّة والطاويّة، بين التغيير والتأمّل. إنّه «عناد» الكتابة، تجليات فكر يقترن بالواقع خارجاً على الأنساق الفوقيّة الجاهزة. نلتقيه هنا في لحظة ترف جمالي، وتيه لا يوفّره إلا الشعر. والشاعر رأى كلّ شيء: «وها أنا أغادر الحكمة المنظومة/ مواصلاً سيري في هذه الرحلة/ قاربي الصغير ينزلق/ والموجة ترشق الزبد الراقص».
***
عبد الكبير الخطيبي: الغريب المحترف ال - ذي امتهن قياس المساحات
راهن على «القوة الهادئة»، وعمل بعيداً عن الأضواء، وأحدثت مؤلفاته النظريّة والإبداعيّة نقلة جذريّة في وعي معاصريه. الكاتب وعالم الاجتماع المغربي (1938 - 2009) الذي كان يتمتّع بحفاوة أكاديميّة، أغمض عينيه أمس، واضعاً نقطة نهائيّة في مسيرة خصبة شملت الرواية والشعر والنقد والبحث. إنّه المثقف العربي الوحيد الذي نال جائزة «أهل الأدب» الفرنسيّة العريقة
غيّب الموت المفكّر والأديب المغربي الكبير عبد الكبير الخطيبي، عن 71 عاماً، إثر ذبحةٍ قلبية حادّة، فاجأته صباح أمس، بعدما كان قد تماثل إلى الشفاء من ذبحة أولى أدخلته العناية الفائقة في مسجد زايد في الرباط منتصف الشهر الماضي. على رغم إسهاماته البارزة التي بلغت 25 مؤلفاً في الرواية والشعر والنقد والبحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي والاحترام النقدي والحفاوة الأكاديمية اللذين حظي بهما، أوروبياً وعربياً، إلا أنّ الخطيبي ظل دوماً ذلك «الغريب المحترف»، كما كان يحلو له أن يقول... بتلك النبرة المحبّبة من التواضع الشخصي والمعرفي التي لم تفارقه حتى اللحظة الأخيرة، حين أدلى بحوار أخير لوكالة الأنباء المغربية، وهو على فراش المرض، الشهر الماضي. يومها، طلب ألا يُشار، إن أمكن، إلى أنّه المثقف العربي الوحيد الذي نال جائزة «أهل الأدب» Les gens des lettres الفرنسية المرموقة التي تأسّست عام 1838، على أيدي عمالقة من مصاف بالزاك وفيكتور هوغو وألكسندر دوما.
رفض عبد الكبير الخطيبي دوماً أن يكون له أتباع أو مريدون. وضحك ساخراً ممن حاولوا التنظير لمذهب فكري أو بحثي خاص به، قائلاً في مقالة شهيرة نشرها في مجلة «الكرمل» الفلسطينية، عام 1984، بعنوان «الباحث الناقد: «يريد الآخرون أن يؤطّروني في خانة ما، والحال أني ممتهن لقياس المساحات!»
تكفي نظرة سريعة على أعمال الخطيبي التي أعيد إصدارها أخيراً عن منشورات La Différence الباريسية، في ثلاثة مجلدات بعنوان «الأعمال الكاملة للخطيبي» للتأكد من أنّه كان بالفعل مثقّفاً مستعصياً على أي تأطير. ظل دوماً مثل مهندس الطوبوغرافيا، مولعاً بقياس (وامتحان) المسافات بين مختلف الأصناف الإبداعية والفكرية، وشغوفاً بمساءلة الأشياء والأحداث والمفاهيم، في محاولة دائمة لفكّ علاماتها ورموزها وإشاراتها.
منذ تخرّج من «السوربون» خريف 1966، بأطروحة دكتوراه سوسيولوجية عن الرواية المغاربية، كان كلّ مؤلف جديد يصدره الخطيبي - إبداعيّاً كان أم بحثياً - بمثابة ضربة «بازل» هادئة، لكنّها دؤوبة ومنتظمة وطويلة النفس، على صخرة السائد والمألوف في الساحة الأدبية والسياسية والفكرية. لذا، مَن ينظر اليوم، بأثر رجعي، إلى تلك الأعمال، يدرك حجم النقلة التثويرية التي أحدثتها أعمال الخطيبي، بفضل «القوة الهادئة» التي راهن عليها، بعيداً عن أضواء النجومية وادعاءات فكرية أو فلسفية. حتى إنّه رفض بشدة أن يوصَف بـ«الفيلسوف»، لأنّه مفكّر من مصاف أولئك الذين يحسّون بالنفور من اقتحام باب الشروح والتعليقات والتأويلات التي تتطلبها كل متابعة لتاريخ الفلسفة. وهو نفور نابع من رفض مفهوم «الأستاذية»، كما يقول الباحث المغربي عبد السلام بنعبد العالي في فصل «الخطيبي والتراث الفلسفي» ضمن كتابه المشوّق «التراث والهوية، دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب» (منشورات «توبقال»، الدار البيضاء - 1987).
وتتضح هذه الروح التثويرية الهادئة التي اتسم بها الخطيبي جلّياً، من خلال ثلاث محطات مفصلية في مساره الإبداعي والفكري: أطروحته الجامعية عن «الرواية المغاربية» (منشورات «ماسبيرو»، باريس - 1968) التي ترجمها إلى العربية («المركز الجامعي للبحث العلمي»، الرباط - 1971) الناقد والكاتب محمد برادة (راجع زاوية أشخاص، ص 40)، وديوانه الشعري «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» (منشورات «سندباد»، باريس - 1976) الذي عرّبه الشاعر كاظم جهاد (منشورات «توبقال»، الدار البيضاء - 1986)، وبحثه الأنثروبولوجي «جرح الاسم العلم» La blessure du nom propre (منشورات «دونويل»، باريس - 1974) أو «الاسم العربي الجريح» وفقاً لعنوان الترجمة العربية التي حملت توقيع الشاعر المغربي الكبير محمد بنيس («دار العودة»، بيروت - 1980).
في أطروحته عن الرواية المغاربية، كان الخطيبي أول من قام بمسعى بحثي جاد لتقريب الهوّة بين شقّي الرواية المغاربية: العربي والفرنكوفوني. إذ برهن بأنّ تلك الروايات، بغضّ النظر عن لغة الكتابة، تنطلق من متخيّل ثقافي واحد. أما ديوانه «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية»، فقد أحدث صدمةً أثّرت في وعي أجيال كاملة من الأدباء والمثقفين. إذ إنّ الخطيبي لم يتردّد في رشق الفكر اليساري الذي كان غالباً آنذاك، بحصى النقد والتجديد، رافضاً مفهوم «المثقف الوظيفي»، قائلاً: «المثقّف، سواء كان مناصراً للعقل المطلق أو للحكمة في خدمة الإنسان، أو كان مناصراً لقضية أو مثل أعلى، فهو مطالب بأن يتكيّف باستمرار مع المبادئ والقيم التي يدافع عنها، وبالتالي فهو مرغم على سلوك موجّه إلى ذاته، لأنّ وظيفته هي تحريك الفكر وتحليل المجتمع لا إدارته».
أمّا بحثه الأنثروبولوجي «الاسم العربي الجريح»، فقد انصبّ في نقد المفهوم اللاهوتي للجسم العربي، ونقد المقاربات الإثنولوجية التي تتعامل مع الثقافة الشعبية تعاملاً خارجياً، وفقاً لما كانت عليه تلك الثقافة في مرحلة تاريخية لم تخرج عن نطاق «تقديس المتعاليات». عبر تلك المقاربة النقدية المزدوجة، استطاع الخطيبي إبراز الحاجة الماسة إلى الفصل بين «الجسم المفهومي» و«الجسم الحقيقي المعاش والملموس»، موضحاً أنّ سبيل الخلاص يكمن في «تجاوز قراءة الجسم قراءة لاهوتية، عن طريق التركيز على الهامشي في الثقافة، والذي يعتبر محرّماً مثل: حديث الأمثال، الشم، وكتاب «الروض العاطر» للشيخ النفزاوي، وقصة الطائر الناطق، رغم أن هذه المجالات غريبة عن الثقافة العربية المكتوبة».
وقد كتب المفكر الفرنسي رولان بارت، الذي كان - إلى جانب موريس نادوا وجاك دريدا - من أوائل الذين اكتشفوا الخطيبي وتبنّوا كتاباته ونشروا له في فرنسا، أواخر الستينيات، كتب مقدّمةً خاصة لكتاب «الاسم العربي الجريح» حملت عنوان «ما أدين به للخطيبي». وقد جاء فيها: «إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصور، الأدلة، الآثار، الحروف، العلامات. وفي الوقت نفسه، يعلّمني الخطيبي جديداً يخلخل معرفتي، لأنه يغيّر مكان هذه الأشكال، كما أراها، فيأخذني بعيداً عن ذاتي، إلى أرضه هو، حتى إني أحس كأنني في الطرف الأقصى من نفسي»!
أما بخصوص الإنجاز المعرفي الكبير الذي حقّقه «الاسم العربي الجريح» بخصوص إشكالية فهم «الجسد الشرقي» ونقده - وقد باتت اليوم، بعد أكثر من ثلث قرن على صدور البحث، راهنةً أكثر من أي وقت مضى، في زمن الردّة والمدّ الأصولي - فقد كتب رولان بارت في مقدّمته: «الخطيبي ينطلق من فرضية مهمة مفادها أنّ التحرر العربي يتطلّب تحرّر الجسم هو الآخر. وهو ما يجعل هذه القراءة تقترن بالإسلام، بوصفه مفهوماً مسبقاً ومتعالياً للذات وللعالم، كما أنّها تعرض لمسائل الهوية والأصالة المزعومتين، وأيضاً للاحتفال بشهوة الجسم ومتعته».
***
سيرة
في ربيع السنة الماضية، نال عبد الكبير الخطيبي جائزة «لازيو» الإيطالية عن مجمل أعماله الأدبية، وخصوصاً روايته «صيف في استوكهولم» («فلاماريون»، باريس - 1990) التي نالت رواجاً خاصاً في ترجمتها الإيطالية، كون بطلها مخرجاً إيطالياً يدعى ألبرتو يصوّر في السويد شريطاً عن العلاقة التي ربطت بين مؤسس الفلسفة العقلانية الفرنسية ديكارت والملكة كريستين، ملكة السويد. قبل ذلك، كان الخطيبي قد نال «جائزة الأكاديمية الفرنسية» (1994) وجائزة «أهل الأدب» (2008)، ما يدلّ على الحفاوة النقدية التي حظيت بها أعماله الأدبية التي تضم ستّ روايات نشرها على مدى ربع قرن، وغلب عليها المنحى النقدي - التاريخي. كانت أولاها روايته البيوغرافية «الذاكرة الموشومة» («دونويل»، باريس - 1971)، ثم تلاها «كتاب الدّم» (الناشر نفسه - 1979)، ثم «ألف ليلة وثلاث ليال» («فتى مرجانة»، مونبولييه - 1980)، و«حب مزدوج اللغة» (الناشر نفسه - 1983)، ثم «صيف في استوكهولم» وأخيراً «ثلاثية الرباط» («بلاندن»، باريس - 1993).
نشر الخطيبي أيضا أربعة دواوين شعرية، وهي «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» («سندباد»، باريس - 1976)، «إهداء إلى السنة المقبلة» («فتى مرجانة» - 1986)، «من فوق الكتف» («أوبييه»، باريس - 1988)، و«ظلال يابانية» («فتى مرجانة» - 1989). كما ألّف نصين مسرحيين، هما «موت الفنانين» («دونويل»، 1964) و«النبي المقنّع» («لارماتان»، باريس - 1979). وفي النقد الأدبي أصدر خمسة أبحاث، وهي «أنطولوجيا أدب شمال أفريقيا الناطق بالفرنسية» («بريزانس أفريكان»، باريس - 1965)، «الرواية المغاربية» («ماسبيرو»، باريس - 1968)، «الكُتّاب المغاربة من عهد الحماية إلى 1965» («سندباد»، باريس - 1974)، «تجليات الأجنبي في الأدب الفرنسي» («دونويل»، 1987)، «الفرنكوفونية واللغات الأدبية» («الكلام»، الرباط - 1989).
إلى جانب أعماله الأدبية المذكورة آنفاً، أصدر الخطيبي ستّة مؤلفات أكاديمية وبحثية بارزة، توزعت بين الفكر السياسي والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، تم تأليفها بالفرنسية، وتُرجمت إلى العربية ولغات عالمية عدة، كالإنكليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية: بينها «الاسم العربي الجريح» («دونويل»، 1974)، «القيء الأبيض: الصهيونية والضمير الشقي» («10/ 18»، باريس - 1974)، «فن الخط العربي» («شين»، باريس - 1976)، «مغرب متعدّد» («دونويل»، 1983)، «المفارقة الصهيونية» («الكلام»، 1990)، «الجسد الشرقي» (ألبوم صور - منشورات «حازان»، باريس - 2002).
****
عبد الكبير الخطيبي: الغريب المحترف ال - ذي امتهن قياس المساحات
راهن على «القوة الهادئة»، وعمل بعيداً عن الأضواء، وأحدثت مؤلفاته النظريّة والإبداعيّة نقلة جذريّة في وعي معاصريه. الكاتب وعالم الاجتماع المغربي (1938 - 2009) الذي كان يتمتّع بحفاوة أكاديميّة، أغمض عينيه أمس، واضعاً نقطة نهائيّة في مسيرة خصبة شملت الرواية والشعر والنقد والبحث. إنّه المثقف العربي الوحيد الذي نال جائزة «أهل الأدب» الفرنسيّة العريقة
غيّب الموت المفكّر والأديب المغربي الكبير عبد الكبير الخطيبي، عن 71 عاماً، إثر ذبحةٍ قلبية حادّة، فاجأته صباح أمس، بعدما كان قد تماثل إلى الشفاء من ذبحة أولى أدخلته العناية الفائقة في مسجد زايد في الرباط منتصف الشهر الماضي. على رغم إسهاماته البارزة التي بلغت 25 مؤلفاً في الرواية والشعر والنقد والبحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي والاحترام النقدي والحفاوة الأكاديمية اللذين حظي بهما، أوروبياً وعربياً، إلا أنّ الخطيبي ظل دوماً ذلك «الغريب المحترف»، كما كان يحلو له أن يقول... بتلك النبرة المحبّبة من التواضع الشخصي والمعرفي التي لم تفارقه حتى اللحظة الأخيرة، حين أدلى بحوار أخير لوكالة الأنباء المغربية، وهو على فراش المرض، الشهر الماضي. يومها، طلب ألا يُشار، إن أمكن، إلى أنّه المثقف العربي الوحيد الذي نال جائزة «أهل الأدب» Les gens des lettres الفرنسية المرموقة التي تأسّست عام 1838، على أيدي عمالقة من مصاف بالزاك وفيكتور هوغو وألكسندر دوما.
رفض عبد الكبير الخطيبي دوماً أن يكون له أتباع أو مريدون. وضحك ساخراً ممن حاولوا التنظير لمذهب فكري أو بحثي خاص به، قائلاً في مقالة شهيرة نشرها في مجلة «الكرمل» الفلسطينية، عام 1984، بعنوان «الباحث الناقد: «يريد الآخرون أن يؤطّروني في خانة ما، والحال أني ممتهن لقياس المساحات!»
تكفي نظرة سريعة على أعمال الخطيبي التي أعيد إصدارها أخيراً عن منشورات La Différence الباريسية، في ثلاثة مجلدات بعنوان «الأعمال الكاملة للخطيبي» للتأكد من أنّه كان بالفعل مثقّفاً مستعصياً على أي تأطير. ظل دوماً مثل مهندس الطوبوغرافيا، مولعاً بقياس (وامتحان) المسافات بين مختلف الأصناف الإبداعية والفكرية، وشغوفاً بمساءلة الأشياء والأحداث والمفاهيم، في محاولة دائمة لفكّ علاماتها ورموزها وإشاراتها.
منذ تخرّج من «السوربون» خريف 1966، بأطروحة دكتوراه سوسيولوجية عن الرواية المغاربية، كان كلّ مؤلف جديد يصدره الخطيبي - إبداعيّاً كان أم بحثياً - بمثابة ضربة «بازل» هادئة، لكنّها دؤوبة ومنتظمة وطويلة النفس، على صخرة السائد والمألوف في الساحة الأدبية والسياسية والفكرية. لذا، مَن ينظر اليوم، بأثر رجعي، إلى تلك الأعمال، يدرك حجم النقلة التثويرية التي أحدثتها أعمال الخطيبي، بفضل «القوة الهادئة» التي راهن عليها، بعيداً عن أضواء النجومية وادعاءات فكرية أو فلسفية. حتى إنّه رفض بشدة أن يوصَف بـ«الفيلسوف»، لأنّه مفكّر من مصاف أولئك الذين يحسّون بالنفور من اقتحام باب الشروح والتعليقات والتأويلات التي تتطلبها كل متابعة لتاريخ الفلسفة. وهو نفور نابع من رفض مفهوم «الأستاذية»، كما يقول الباحث المغربي عبد السلام بنعبد العالي في فصل «الخطيبي والتراث الفلسفي» ضمن كتابه المشوّق «التراث والهوية، دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب» (منشورات «توبقال»، الدار البيضاء - 1987).
وتتضح هذه الروح التثويرية الهادئة التي اتسم بها الخطيبي جلّياً، من خلال ثلاث محطات مفصلية في مساره الإبداعي والفكري: أطروحته الجامعية عن «الرواية المغاربية» (منشورات «ماسبيرو»، باريس - 1968) التي ترجمها إلى العربية («المركز الجامعي للبحث العلمي»، الرباط - 1971) الناقد والكاتب محمد برادة (راجع زاوية أشخاص، ص 40)، وديوانه الشعري «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» (منشورات «سندباد»، باريس - 1976) الذي عرّبه الشاعر كاظم جهاد (منشورات «توبقال»، الدار البيضاء - 1986)، وبحثه الأنثروبولوجي «جرح الاسم العلم» La blessure du nom propre (منشورات «دونويل»، باريس - 1974) أو «الاسم العربي الجريح» وفقاً لعنوان الترجمة العربية التي حملت توقيع الشاعر المغربي الكبير محمد بنيس («دار العودة»، بيروت - 1980).
في أطروحته عن الرواية المغاربية، كان الخطيبي أول من قام بمسعى بحثي جاد لتقريب الهوّة بين شقّي الرواية المغاربية: العربي والفرنكوفوني. إذ برهن بأنّ تلك الروايات، بغضّ النظر عن لغة الكتابة، تنطلق من متخيّل ثقافي واحد. أما ديوانه «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية»، فقد أحدث صدمةً أثّرت في وعي أجيال كاملة من الأدباء والمثقفين. إذ إنّ الخطيبي لم يتردّد في رشق الفكر اليساري الذي كان غالباً آنذاك، بحصى النقد والتجديد، رافضاً مفهوم «المثقف الوظيفي»، قائلاً: «المثقّف، سواء كان مناصراً للعقل المطلق أو للحكمة في خدمة الإنسان، أو كان مناصراً لقضية أو مثل أعلى، فهو مطالب بأن يتكيّف باستمرار مع المبادئ والقيم التي يدافع عنها، وبالتالي فهو مرغم على سلوك موجّه إلى ذاته، لأنّ وظيفته هي تحريك الفكر وتحليل المجتمع لا إدارته».
أمّا بحثه الأنثروبولوجي «الاسم العربي الجريح»، فقد انصبّ في نقد المفهوم اللاهوتي للجسم العربي، ونقد المقاربات الإثنولوجية التي تتعامل مع الثقافة الشعبية تعاملاً خارجياً، وفقاً لما كانت عليه تلك الثقافة في مرحلة تاريخية لم تخرج عن نطاق «تقديس المتعاليات». عبر تلك المقاربة النقدية المزدوجة، استطاع الخطيبي إبراز الحاجة الماسة إلى الفصل بين «الجسم المفهومي» و«الجسم الحقيقي المعاش والملموس»، موضحاً أنّ سبيل الخلاص يكمن في «تجاوز قراءة الجسم قراءة لاهوتية، عن طريق التركيز على الهامشي في الثقافة، والذي يعتبر محرّماً مثل: حديث الأمثال، الشم، وكتاب «الروض العاطر» للشيخ النفزاوي، وقصة الطائر الناطق، رغم أن هذه المجالات غريبة عن الثقافة العربية المكتوبة».
وقد كتب المفكر الفرنسي رولان بارت، الذي كان - إلى جانب موريس نادوا وجاك دريدا - من أوائل الذين اكتشفوا الخطيبي وتبنّوا كتاباته ونشروا له في فرنسا، أواخر الستينيات، كتب مقدّمةً خاصة لكتاب «الاسم العربي الجريح» حملت عنوان «ما أدين به للخطيبي». وقد جاء فيها: «إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصور، الأدلة، الآثار، الحروف، العلامات. وفي الوقت نفسه، يعلّمني الخطيبي جديداً يخلخل معرفتي، لأنه يغيّر مكان هذه الأشكال، كما أراها، فيأخذني بعيداً عن ذاتي، إلى أرضه هو، حتى إني أحس كأنني في الطرف الأقصى من نفسي»!
أما بخصوص الإنجاز المعرفي الكبير الذي حقّقه «الاسم العربي الجريح» بخصوص إشكالية فهم «الجسد الشرقي» ونقده - وقد باتت اليوم، بعد أكثر من ثلث قرن على صدور البحث، راهنةً أكثر من أي وقت مضى، في زمن الردّة والمدّ الأصولي - فقد كتب رولان بارت في مقدّمته: «الخطيبي ينطلق من فرضية مهمة مفادها أنّ التحرر العربي يتطلّب تحرّر الجسم هو الآخر. وهو ما يجعل هذه القراءة تقترن بالإسلام، بوصفه مفهوماً مسبقاً ومتعالياً للذات وللعالم، كما أنّها تعرض لمسائل الهوية والأصالة المزعومتين، وأيضاً للاحتفال بشهوة الجسم ومتعته».
سيرة
في ربيع السنة الماضية، نال عبد الكبير الخطيبي جائزة «لازيو» الإيطالية عن مجمل أعماله الأدبية، وخصوصاً روايته «صيف في استوكهولم» («فلاماريون»، باريس - 1990) التي نالت رواجاً خاصاً في ترجمتها الإيطالية، كون بطلها مخرجاً إيطالياً يدعى ألبرتو يصوّر في السويد شريطاً عن العلاقة التي ربطت بين مؤسس الفلسفة العقلانية الفرنسية ديكارت والملكة كريستين، ملكة السويد. قبل ذلك، كان الخطيبي قد نال «جائزة الأكاديمية الفرنسية» (1994) وجائزة «أهل الأدب» (2008)، ما يدلّ على الحفاوة النقدية التي حظيت بها أعماله الأدبية التي تضم ستّ روايات نشرها على مدى ربع قرن، وغلب عليها المنحى النقدي - التاريخي. كانت أولاها روايته البيوغرافية «الذاكرة الموشومة» («دونويل»، باريس - 1971)، ثم تلاها «كتاب الدّم» (الناشر نفسه - 1979)، ثم «ألف ليلة وثلاث ليال» («فتى مرجانة»، مونبولييه - 1980)، و«حب مزدوج اللغة» (الناشر نفسه - 1983)، ثم «صيف في استوكهولم» وأخيراً «ثلاثية الرباط» («بلاندن»، باريس - 1993).
نشر الخطيبي أيضا أربعة دواوين شعرية، وهي «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» («سندباد»، باريس - 1976)، «إهداء إلى السنة المقبلة» («فتى مرجانة» - 1986)، «من فوق الكتف» («أوبييه»، باريس - 1988)، و«ظلال يابانية» («فتى مرجانة» - 1989). كما ألّف نصين مسرحيين، هما «موت الفنانين» («دونويل»، 1964) و«النبي المقنّع» («لارماتان»، باريس - 1979). وفي النقد الأدبي أصدر خمسة أبحاث، وهي «أنطولوجيا أدب شمال أفريقيا الناطق بالفرنسية» («بريزانس أفريكان»، باريس - 1965)، «الرواية المغاربية» («ماسبيرو»، باريس - 1968)، «الكُتّاب المغاربة من عهد الحماية إلى 1965» («سندباد»، باريس - 1974)، «تجليات الأجنبي في الأدب الفرنسي» («دونويل»، 1987)، «الفرنكوفونية واللغات الأدبية» («الكلام»، الرباط - 1989).
إلى جانب أعماله الأدبية المذكورة آنفاً، أصدر الخطيبي ستّة مؤلفات أكاديمية وبحثية بارزة، توزعت بين الفكر السياسي والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، تم تأليفها بالفرنسية، وتُرجمت إلى العربية ولغات عالمية عدة، كالإنكليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية: بينها «الاسم العربي الجريح» («دونويل»، 1974)، «القيء الأبيض: الصهيونية والضمير الشقي» («10/ 18»، باريس - 1974)، «فن الخط العربي» («شين»، باريس - 1976)، «مغرب متعدّد» («دونويل»، 1983)، «المفارقة الصهيونية» («الكلام»، 1990)، «الجسد الشرقي» (ألبوم صور - منشورات «حازان»، باريس - 2002).
***
عن «الروحانية العلمانية» في أعمال الخطيبي
 عزيزي بختي بن عودة،
عزيزي بختي بن عودة،
تذكرتكَ هذا الصباح، وافتقدتكَ، يا صديقي، كما لم أفتقدكَ طيلة السنوات الـ14 الماضية. لا تستعجل، كعادتك، دعني أشرح لك ما حدث. كنت ما أزال نائماً، حيث تلقيتُ رسالة قصيرة على الخليوي. آخ، كدتُ أنسى أن تلك الرصاصات الغادرة التي خطفتكَ، في تلك الظهيرة اللعينة من مايو 1995، غيّبتكَ مبكراً، فلم تعرف ما الـSMS! لولا تلك الرصاصات الغادرة، لكنتَ أنت، بالتأكيد، أول من يتصل بي لينعى إليّ صديقك و«أستاذك» عبد الكبير الخطيبي. هل تذكر ذلك اللقاء الذي جمعنا في سلا؟ كان ذلك في 1989 (أو ربّما 1990؟). وهل تذكر أنكَ، حين تعارفنا، لأول مرة في وهران، أواخر 1987، أصررتَ على أن تهديني نسخةً من مجموعته «المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية»؟ وحين ترددتُ، لأنها كانت تحمل توقيعاً خاصاً لك من المؤلف، قلتَ ضاحكاً: «معليش، سأضيف إليه توقيعاً آخر لك، بالنيابة عن المؤلف!»... ذلك أنك كنت تحسّ دوماً بأن أعمال الخطيبي وبارت ودريدا وجوليا كريستيفيا هي جزء حميم من ذاتك...
هل أخبرتكَ أن كتاباتكَ عن الخطيبي أُصدرت، بعد رحيلك، في كتاب «الخطيبي ناقداً»؟ وأن أشعارك جُمعت في ديوان «رنين الحداثة»؟ لا تبتسم ساخراً، كعادتك! اطرح جانباً الطابع التراجي - كوميدي في ثقافة بلد لم يسمح لقامة فكرية من مصافك بأن تُصدر، وهي على قيد الحياة، أي عمل فكري. دعني أزف إليك خبراً سيفرحك: بلغني أن الخطيبي كان سعيداً جداً، وبكى متأثراً عندما تلقى نسخة من كتابكَ عنه.
وبعدُ، يا صديقي، هل يجب أن اعتذر منكَ، لأنّني تأخرتُ كل هذه السنين في الكتابة عنك أو إليك. ليس تقصيراً، يا عزيزي. فقط لأن الكتابة عنكَ بصيغة الماضي استعصت عليّ. ثم إنني كنت دوماً على قناعة بأنني سأؤلمكم، لو ضممتُ صوتي إلى جوقة المؤبّنين المحترفين!
لماذا أكتبُ إليك اليوم؟ هل تذكر تلك الجلسة الصاخبة الأخيرة التي جمعتنا في أحد بارات «مونمارتر»، في تلك الأمسية الماطرة من ديسمبر 1993؟ لا تتظاهر بالنسيان، كعادتك! أنا متيقن بأنك تذكر جيّداً حديثك المستفيض، وقد قطعنا أشواطا في الشرب، عن «الروحانية العلمانية» في أعمال الخطيبي؟ لقد أبصرتُ الابتسامة الساخرة على طرف شفتيك، فلا تحاول أن تداريها، كعادتك، بالتظاهر بمداعبة شاربك! تلك «الروحانية العلمانية» هي التي دفعت بي اليوم، أنا الملحد، إلى الكتابة إليكَ، متيقّنا أن روحك تستمع إليّ من «فضاء ما»..
سلاماً، يا صديقي. مع المحبة الدائمة
عثمان...
****
مفكر عربي كبير لم نقرأهُ بعد
 كثيرون لم يعرفوا أمس لِمن يوجّهوا تعازيهم بعدما شاع نبأ رحيل عبد الكبير الخطيبي. هذا «الغريب المحترف» لم يكن ينتمي إلى عائلة فكرية أو أدبية. عاش مثل ماءٍ نزق يسيل بين الصخور، ظل يتنقّل بين «نقط العبور الفاصلة بين اللغات والبلدان والحضارات». علماء الاجتماع المغاربة يؤكدون أنّ الرجل قطب من أقطابهم، ودليلهم أبحاثه المتعددة وإشرافه على إدارة معهد السوسيولوجيا التابع لجامعة محمد الخامس في الرباط منذ 1966 حتى إغلاق المعهد بقرار سياسي عام1970. لكنّ الخطيبي عرف دائماً كيف يفتح شرفات السوسيولوجيا على رياح الأدب. ظل يدعو إلى مراجعة شمولية للسوسيولوجيا حتى يصير بالإمكان تحويل القضايا الميتافيزيقية التي تقضّ مضاجعنا إلى حقل المعالجة السوسيولوجية.
كثيرون لم يعرفوا أمس لِمن يوجّهوا تعازيهم بعدما شاع نبأ رحيل عبد الكبير الخطيبي. هذا «الغريب المحترف» لم يكن ينتمي إلى عائلة فكرية أو أدبية. عاش مثل ماءٍ نزق يسيل بين الصخور، ظل يتنقّل بين «نقط العبور الفاصلة بين اللغات والبلدان والحضارات». علماء الاجتماع المغاربة يؤكدون أنّ الرجل قطب من أقطابهم، ودليلهم أبحاثه المتعددة وإشرافه على إدارة معهد السوسيولوجيا التابع لجامعة محمد الخامس في الرباط منذ 1966 حتى إغلاق المعهد بقرار سياسي عام1970. لكنّ الخطيبي عرف دائماً كيف يفتح شرفات السوسيولوجيا على رياح الأدب. ظل يدعو إلى مراجعة شمولية للسوسيولوجيا حتى يصير بالإمكان تحويل القضايا الميتافيزيقية التي تقضّ مضاجعنا إلى حقل المعالجة السوسيولوجية.
سوسيولوجيا الخطيبي ظلت مفتوحةً على الأدب والتأمل الفلسفي وعلم الجمال. كان يمارس الفلسفة ويتحرّج كثيراً من لقب الفيلسوف. لهذا، ربما، راهن بقوة على الأدب. كتب الرواية من دون أن يعتبر نفسه روائياً: «الذاكرة الموشومة»، «صيف في استوكهولم»...
طبعاً كانت «الذاكرة الموشومة» سيرة ذاتية لابن مدينة الجديدة الذي كان ينظم الشعر بالعربية في سنّ الـ12، ويرسل قصائده باسم مستعار إلى الإذاعة الوطنية. أما أعماله الأخرى فجاءت على هيئة سرديات من صميم الحياة، أكثر مما كانت روايات بالمعنى التخييلي للكلمة. لكنّ الخطيبي لم يكن يهتم لتصنيف النقاد. أما الشعر فشأن شخصي. «مناضلنا الطبقي على الطريقة الطاوية» كان يكتب حكماً وتأملات ومونولوغات وجد الفرنسيون صعوبةً في اعتبارها شعراً، فيما بدت للقراء العرب بعيدةً عن روح الشعر العربي. أما هو فكان يهمس من داخل قصيدته بنبرة الحُكماء: «جئت لأعلمكم الاختلاف الذي لا رجوع منه»، «أنا أعلِّمُ المعرفة اليتيمة»، قبل أن يضيف: «ولكنّ حكمتي تقول: الثورة العظيمة ليس لها أبطال».
هل كان شاعراً؟ سيكون صعباً عليه قبول هذه التهمة، هو الذي حرص على تصنيف قصائده كالتالي «هذا ليس شعراً». والحقيقة أنّ ديوان الخطيبي كان تفكيراً في المحبة وتأملاً في قيم العيش المشترك بين الأجناس والأفكار والديانات والثقافات المختلفة.
كانت الكتابة له تدخّلاً وجودياً عنيفاً في شؤون الحاضر، واستفزازاً عنيداً للفلسفة والفن والعلم والدين. لهذا، لم يؤمن بحدود فاصلة بين الحقول المعرفية والأجناس الأدبية. والذي يقرأ أبحاثه العلمية بنظرة أكاديمية تقليدية، لن يفهم الخطيبي. أما مَن يقرأ نصوصه الإبداعية بنظرة تذوّقية جمالية، فلن تكشف له قصيدة الخطيبي عن أسرارها. بل حتى النقد حينما مارسه، قسى عليه. فقد طالب النقد بأن يبدأ بذاته. لا يكفي أن يتوجه النقد إلى الواقع أو إلى هذا الموضوع أو ذاك، بل عليه أن يبدأ بنفسه وبتأزيم ذاته. ومن هنا، صاغ نظريته الشهيرة عن «النقد المزدوج».
مع ذلك، ظل دائماً على الهامش. يكتب على هامش الفلسفة والعلم معاً. ومعالجته لأسئلة الهوية والغيرية والحب والحداثة والنقد والتراث اتخذت أساليب غير مألوفة. لكنَّ اهتمامه بالحرف والخط والوشم وشغفه بالرموز والصور سيكرِّسُه مرجعاً في هذا المجال. ورولان بارت نفسه لم يُخفِ تأثّره بالخطيبي. أمّا جاك دريدا فيؤكد في شهادة له: «مثلي مثل الكثيرين، أعتبر الخطيبي أحد الكتاب والشعراء والمفكرين المعاصرين العمالقة في اللغة الفرنسية، وأتأسف لكونه لا يُدرَّس بالشكل الذي يستحقه في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية».
مرة في سهرة أقيمت على هامش «مهرجان مراكش الدولي للفيلم»، كنا نتجاذب مع الخطيبي أطراف الحديث عن المثقف المغربي والسياسة، حينما تسلل الرجل خارج حلقتنا فجأة من دون سابق إشعار. بعد قليل لمحناه وسط غابة الأجساد الشابة يرقص مثل طفل. في اليوم التالي، انتقدت صحف مغربية رقصة الفيلسوف. أما أنا فعدت إلى نصوصه كي أفهم. يقول الخطيبي: «الجسم الراقص يكتب الكلام ويحطمه. يجعل الفضاء هندسة دقيقة ومتعددة الأصوات. إنه زوبعة القوانين، انعكاس الضوء ومحو الأثر الذي بواسطته ينطق الأصل: أي الجسد». هذا هو الخطيبي لا حياة له خارج كتابته. ولعل رحيله أمس يذكّرنا به وبحاجتنا إلى قراءته. الخطيبي مفكر عربي كبير لم نقرأهُ بعد.
الاخبار
عدد الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٠٩