ترجمة: فهيمة جعفر
 الموتُ كموضوعٍ للحديث ؟! أليسَ الموتُ أنموذج الموضوع الذي لا حديثَ فيه؟ مهما تحدّثنا بمرحٍ عنِ الحبِّ، فالقليلُ يقالُ حولَ الموت. قيلَ لنا كان الموتُ مختلفاً في العصورِ السالفة. كانَ طَلِق اللسانِ عذبَ المعشر، جُزءاً من المجتمع وَالعائلة. لم يتفادوا مواجهته. إن لم يكُن صديقاً مقرّباً، فقد كانت علاقتهُ بالبشريةِ جيدةً على الأقل. طرأ تغيرٌ جذريٌّ خلال القرنين الماضيين، صمتَ الموتُ وَأمرنا أن نلتزمَ الصمت.. وَكنّا سعداء بالإذعانِ لأمره؛ كُنّا في واقعِ الأمرِ نصونُ صمتاً مميتاً. لا لأننا نجهل كلَّ شيءٍ حوله – هذا ليسَ سبباً ليطبق الشخص فمَه كما هو معروف – لا، بل لأنّهُ روحُ السلبِ السرمديِّ، مُفسدُ المتع وَهادمُ اللذات بما تعنيه الكلمةُ من معنىً، وَلا حيلة لنا معَ شخصياتٍ كهذه في زمننا الحاضر.
الموتُ كموضوعٍ للحديث ؟! أليسَ الموتُ أنموذج الموضوع الذي لا حديثَ فيه؟ مهما تحدّثنا بمرحٍ عنِ الحبِّ، فالقليلُ يقالُ حولَ الموت. قيلَ لنا كان الموتُ مختلفاً في العصورِ السالفة. كانَ طَلِق اللسانِ عذبَ المعشر، جُزءاً من المجتمع وَالعائلة. لم يتفادوا مواجهته. إن لم يكُن صديقاً مقرّباً، فقد كانت علاقتهُ بالبشريةِ جيدةً على الأقل. طرأ تغيرٌ جذريٌّ خلال القرنين الماضيين، صمتَ الموتُ وَأمرنا أن نلتزمَ الصمت.. وَكنّا سعداء بالإذعانِ لأمره؛ كُنّا في واقعِ الأمرِ نصونُ صمتاً مميتاً. لا لأننا نجهل كلَّ شيءٍ حوله – هذا ليسَ سبباً ليطبق الشخص فمَه كما هو معروف – لا، بل لأنّهُ روحُ السلبِ السرمديِّ، مُفسدُ المتع وَهادمُ اللذات بما تعنيه الكلمةُ من معنىً، وَلا حيلة لنا معَ شخصياتٍ كهذه في زمننا الحاضر.
إذن كيفَ يمكننا ربطَ هذا المتحفِّظ البغيض ب “إيروس [1]” الشهواني المَرِح، ليسَ كنقيضهِ –وَهو ربطٌ يبدو متسقاً أكثر- بل كرفيقه ؟ وَكيفُ يمكن أن تصدرَ المبادرةُ لنيلِ رفقةٍ كهذه لا عن “ثانوتاس [2]” (هذا المخلوق الفظُّ أشدُّ كسلاً وَاكتفاءً بذاتِه من أن يبادرَ بذلك)، بل عن إيروس نفسه، هذا المثيرُ، الفاتنُ، وَالمصدرُ الظاهريُّ لكُلِّ اندفاعٍ خلاّق ؟
في قصّةِ أوسكار وايلد، تقعُ الأميرةُ الجميلةُ سالومي في غرامِ متعصّبٍ دينيٍّ أجبنُ من أن ينظرَ لها حتّى. لكنّهُ أعمىً وَشجاعٌ بما فيه الكفاية ليدفعَ حياته ثمناً لرفضه لها. وَبعدَ أن يُقطعَ رأسُهُ بأمرٍ منها، تُقبِّلُ بغبطةٍ شفتيه الميتتين وَهما تقطران دماً، وَتخبرُنا أن لغزَ الحبِّ أعظمُ من لغزِ الموت. قد نعترضُ قائلين: “وَمن تكونُ سالومي هذه؟ مجرّدُ صبيةٍ مدللةٍ في الثانيةِ أو الرابعةِ عشر من عمرها، لا تعرفُ سوى القليل عن الحب، وَلا شيء إطلاقاً عنِ الموت.” بيدَ أن توماس مان نفسه ، الذي كان فائق الذكاء، وَضليعاً في الأمرين، يربطُ بينَ الحُبِّ وَالموت ليسَ في أعمالهِ فقط، بل في سيرةِ حياته أيضاً. في غمرةِ افتتانِه بنادلٍ شابٍّ يلتقيه وهو عجوزٌ في الخامسةِ وَالسبعين من عمره، خلالَ إجازةٍ يقضيها في زيورِخ، يقولُ إنه “يكادُ يتمنّى موتَه.” وَيكتبُ في مذكراته: “وداعاً إلى الأبدِ أيها الفتى الساحر! سأعيشُ قليلاً،وَأنجزُ قليلاً، ثمَّ أموت. أنتَ أيضاً ستنضجُ في حياتكَ التي تمضيها، وَتموتُ يوماً ما! يا لكِ من حياةٍ عصيةٍ على الفهم، تثبتُ ذاتها في الحُب”. لكنَّ “ثانوتاس” و”إيروس” لا يلتقيان فقط في لحظةِ الفِراق والهجران، حيثُ التياع الحب. في رأي ستاندال – الذي ينبغي وصفهُ كخبيرٍ في الأمرِ- الحُبُّ بشكلٍ عام مصاحبٌ مزمنٌ للموتِ. وَيكتبُ: “يجعلُ الحُبُّ الحقيقيُّ من فكرةِ الموتِ اعتياديةً، سهلةً، وَغير مرعبة. يصبحُ مادَّةً بسيطةً للمقايضة؛ الثمنَ الذي يكون الواحدُ مستعداً لدفعه لقاءَ الكثير.”
نتفهّم كلا الموقفين: الموقفَ الذي يلتمسُ في الموتِ خلاصاً من ألمِ الحُبِّ المضني، وَالآخرَ الشهم الذي يتقبّلُ الموتَ كمجازفةٍ لا مفرَّ منها في سعيهِ إثرَ فريسته الإيروسية، لا سيّما في الأزمان وَالمجتمعات التي تُسَلُّ السيوف وتُشهَرُ المسدساتُ فيها بسرعة . لا يمكنُ اعتبارُ أيٍّ من الموقفين نموذجيّاً وَجديراً بالمحاكاة، بل الأحرى أن يُعزى لطبيعتهِ المجنونةِ وَالمرضيّة واقعاً، واعتباره اضطراباً مؤسِفاً ذا باعثٍ إيروسيّ. غيرَ أنَّ بوسعنا تفهم أمرٍ كهذا، أي يمكننا وضع أنفسنا مكان أولئك الأشخاص الذين يموتون أو يقتلون أنفسهم لأجلِ الحُب. لو لم يكُن ذلكَ بالوسع، كيفَ استطعنا إذن قراءةَ “أحزان الشابِّ فرثر” أو”آنا كارنينا” أو”مدام بوفاري” أو”ايفي بريست” [3] دونَ أن تحرِّكَ مشاعرنا؟ لكنَّ النقطة التي ينتهي عندها التعاطف وَالتفهّم وَيتضاءل الاهتمام هي حينَ يرمي “إيروس” نفسه بقوّةٍ بين ذراعي “ثانوتاس” – في تناقضٍ تامّ – كما لو كان سيتّحدُ به، النقطة التي يلتمس فيها الحُبُّ شكلَه الأرقى وَالأنقى – أي كمالَهُ- في الموت.
تبدأُ هذه العلاقة المشؤومة مبكّراً منذُ أوائل القرنِ السادس عشر – كما يخبرنا بذلك فيليب آرييه في كتابه “ساعةُ موتنا” -، في ذاكَ الوقت حوَّلت الفنون البصريَّةُ رقصةَ الموتِ القروسطيَّة المظلمةَ لكنِ المحتشمة، إلى رقصةٍ إيروسيّةٍ داعرة. لاحقاً تتخذُ هذه الظاهرة ملامحَ “نيكروفيليّة necrophiliac “، متبوعةً بمظاهرَ ساديّة قبلَ ظهور دي ساد نفسه، فشقَّت طريقها إلى الأدب. تمَّ اختلاق خرافةِ انتصابِ الرجل المشنوق، وَهي سخفٌ محض. أدخلت اللغة الفرنسية المصطلحَ (la petite mort ) كمرادفٍ لهزّةِ الجماع، وهو تعبيرٌ يبدو عندَ النظرةِ الأولى صادِماً وَحسناً (وَلرُبَّما أريدَ له في الأصلِ أن يبدو متناقضاً) لكنّهُ عندَ النظرةِ الثانية يبدو غيرَ ملائمٍ إطلاقاً. وَأخيراً تفرطُ هذه الظاهرة في النضجِ في القرنِ التاسع عشر، حبُّ الموتِ وَالموتُ حبّاً يبلغُ أوجَ نشوتهِ: ما “أناشيدُ لليل” ل نوفاليس إلا قصائدُ حبٍّ طَرِبَةٌ تخاطبُ الموت، وفي نهاية الفترة الرومانتيكية تظهر “أزهار الشر” ل بودلير التي تمزجُ الواقعيَّ بالغرائبي، باعثةً رائحةَ العفنِ الحادّةَ السامَّة. عنهُ كتبَ أناتول فرانس: “ينتشي برائحةِ الجثث كما لو كانت عِطراً مثيراً”.
رسائلُ “هنريك فون كليست Heinrich von Kleist” الأخيرة كانت مفعمةً بمرحِ الحياةِ وَالحماسةِ الإيروسيّة، بعدَ أن اعتادَ فكرةَ الانتحار. ظلَّ أشهراً يبحثُ عن امرأةٍ مستعدةٍ للموتِ معه، وَأخيراً وجدَ ضالته في امرأةٍ مريضةٍ وَكئيبةٍ وحمقاء بما فيه الكفاية لتتحمَّس لتأديةِ الدور؛ زوجةٍ لموظفٍ مدني – يفكّرُ المرء كم كانت حياتها عاديةً، كئيبةً، فاترةً، وَمليئةً بالشكوك الدينية إن كانت تنشدُ ذروةَ متعتها في القتلِ بالرصاص! كتبتْ له ملاحظاتٍ متَيَّمةٍ بحبّه، وَكتب لها رسائل حُبٍّ لا نظيرَ لجمالها في اللغةِ الألمانية. كانَ يركعُ صباحاً ومساءً “شاكراً الربَّ على حياةٍ ملؤها العذاب” أكثر من أي حياةٍ أمضاها شخصٌ آخر، لأنّهُ “كافأني بأسمى ميتةٍ وأكثرها شهوانية.”
يكتبُ لابنةِ عمه – التي ظلّت مؤتمنة أسراره حتى ذاك الحين- ما هو شبيه برسالةِ اعتذارٍ قبلَ أسبوعٍ من موتِه المدبَّر، يطلبُ منها أن تتفهَّم أنه وجدَ امرأةً أخرى – زوجةَ الموظفِ المدني – وَهو يحبُّها أكثر: “هل يواسيكِ قولي إنّي ما كنتُ لأؤثِر إطلاقاً تيك الصديقةَ عليكِ لو أنّها أرادت فقط العيشَ معي؟ ” لكنَّ ابنة عمّهِ للأسف رفضت مراراً اقتراحهُ بأن يموتا معاً، في حينِ أن تلك “الصديقة المؤلَّهة ” وافقت في الحال، وَ”لا أستطيع أن أصفَ لكِ القوةَ العظيمةَ التي تجذبني بها موافقتُها إلى صدرِها”. فيضٌ من الغبطةِ – لم يعرف له من قبل مثيلاً- يغمره، كما يقول. وَينتهي إلى القول: “وَليس بوسعي الإنكارُ أنَّ قبرها أحبُّ إليَّ من فراشِ إمبراطوراتِ العالمِ كافّة”. وَلا يغفل عن إضافةِ تحيةٍ قصيرةٍ يخبرُ فيها “صديقته العزيزة” –يعني بذلكَ ابنة عمّه- أنهُ يتمنى من اللهِ أن يقبضَ روحها عاجلاً “إلى ذلكَ العالمِ الأفضل، حيثُ يمكننا جميعاً ضمَّ قلوبِ بعضنا البعض بحُبِّ الملائكة- وداعاً! ”
انتُقِدَ غوته عندَ قوله عن كليست – وَهو بالمناسبةِ يعترفُ بعبقريته – أنْ لطالما غمرَهُ “بمشاعرِ الرُعبِ وَالنفور”. قد يتفقُ معه المرء “ماذا غيرُ ذلك؟ ” وَيضيفُ أنَّ المعنى الأصلي لمفردةِ “نفور” لا تنطوي على ازدراءٍ، بل تعني جفولاً غريزياً، “نَفْضَةً”، للإبقاءِ على شئٍ في منأىً عن طبيعةِ الشخص – وَهو موقفٌ معقولٌ خاصةً إذا كانت طبيعةُ هذا الشخص غيرَ محصَّنةٍ تماماً ضدَّ المُرعبِ وَالمنفر.
يندرجُ انتحار “فرثر” تحتَ صنفٍ مختلفٍ عن انتحارِ كليست بالطبع. قَتَل فرثر نفسه أو “ضحّى بحياته” لأجلِ محبوبته كما يقول، لأنَّهُ حُرِمَ الحياة مع “لوته Lotte” – كما يعتقدُ هو على الأقل. كليست – من جهته – كان مفتوناً طيلة حياته بالانتحار، ناظِراً لمواثيق الانتحار كتعبيرٍ أقصى للمودَّةِ وَالإخلاص المتبادل. وَينتحر آخر الأمر برفقةِ شخصٍ آخر لأنه يأملُ أن تهبه هذه التجربة ما يمكننا وصفه ب النشوةِ الإيروسيةِ القصوى. غيرَ أن هناكَ أوجه شبهٍ بين رسائل الوداع “المتخيّلة” التي كتبها فرثر ل لوته، وَبين رسائل كليست الأخيرة لابنة عمه وأخته، وَهي ليست مجرَّد صيغةِ تواصلٍ نثرية بل عملاً أدبياً راقياً. بالمثلِ أيضاً، لفعلِ الانتحارِ بناءٌ متقنٌ لدرجةٍ مرعبة – في تخطيطه وَتنفيذه المتكامل، وَفي توثيقه الأدبي وَأثره المحسوب على العامَّة، وَيمكن وصفه واقعاً – وَعذراً لاستخدامِ هذا التعبير- ب تحفةِ كليست الأدبية.
يقرُّ فرثر بأن الفكرة المهتاجة بقتلِ ألبرت، زوجِ لوته، أو قتلِ لوته نفسها، قد تسللت إلى رأسه، بدلاًً من الانتحار، إذ أنَّ “على واحدٍ منا نحن الثلاثة أن يغادر”. لم يقترح أن يموتا – لوته وهو- معاً، بل ماتَ مدّعياً أنَّ ذلك سيجعلها ملكه للأبد. سيسبقها فقط إلى عالمٍ آخر وَينتظرها هناكَ حتّى تأتي. وَعندئذٍ ” سأطيرُ إليك، أمسكُ بكِ، وَسنغرقُ في عناقٍ أبدي على مرأىً من السرمدية” كما يكتبُ لها. حديثهُ هذا لا يذهبُ بعيداً عن انتحارِ كليست الإيروسي.
بعد أن نضجَ غوته ما عاد يحبّذُ تذكيره بأمورٍ كهذه. على الرغمِ من كونِ “آلامِ فرثر الشاب” أساسَ شهرته، صرَّح بأنَّ هذا العمل ماضٍ تجاوزَه، وَنعتَ المتحمسين الذينَ آذوا أنفسهم احتذاءً ب فرثر، مغفلين وَذوي طبائع هشة وَيستحقونَ ميتةً حمقاءَ كهذه. لا عجبَ إذن أن يسبب له كليست –الذي كانَ هشّاً – الاضطراب، وثمَّة أمرٌ مريبٌ في طريقةِ نبذهِ ليسَ للرجلِ فقط، بل لعملهِ أيضاً ناعتاً إيّاهُ بالسخفِ البربريّ. ذلكَ أنَّ الإغراءات التي تعرَّض لها كليست فاستسلمَ لها دون مقاومة لم تكن غريبةً عن غوته.
بعدَ العديد من السنوات – ومضيِّ وقتٍ طويل على وفاةِ كليست- يكتبُ غوته قصائدَه الأشهر، نُشِرت أوّل الأمرِ في مجلةٍ نسائيةٍ تحت عنوان (Vollendung كمال) ثُمَّ تالياً بعنوان (Selige Sehnsucht اشتياقٌ بهيج ) في West-Eastern Divan : في خمسِ رُباعيّاتٍ بتقفيةٍ متقاطعة؛ يبيّنُ البيت الافتتاحي بإيجازٍ أن التالي لا يخاطب أي شخصٍ، بل قلةً من العقلاءِ فقط:
أَنْبئ العقلاءَ فقط،
فالعامّةُ ستزدري فكرةً كهذه.
ثُمَّ يباشرُ فكرته بقرعِ طبلٍ أجوف:
أبجّلُ تلك الأرواح الحيَّة
التي تتوقُ لموتٍ محموم.
ثُمَّ يصنعُ مجازاً من الصورةِ التي فتنته طيلةَ حياته، صورةِ الفراشةِ وَهي تندفعُ نحو موتها.. منجذبةً دونَ مقاومةٍ للشعلةِ الملتهبة. يضعُ هذا المجاز مقابل خلفيةٍ معتمةٍ معتادة؛ رسْمٍ بقرائنَ شديدة الإيروسية:
في هدأةِ ليالي العشق
المتناسلة كما تتناسلُ أنت،
شعورٌ غريبٌ يحلُّ عليكَ
مؤتلِقاً، تحتَ لهبِ شمعة.
خَللَ الظلالِ، ما عدتَ تحتملُ
الترقٌّبَ في سكونِها المعتم.
مثقلٌ أنتَ باشتهاءاتٍ أشدّ
لرفقةٍ أسمى.
عاجزةٌ المسافةُ عن لجمِ تحليقك،
مترعاً بالحُبِّ على أجنحةٍ رشيقةٍ،
قدِمتَ أخيراً، تشتهي النورَ،
كفراشةٍ تقتحمُ اللهب.
حتّى ينتهي إلى القولِ في البيتِ الأخير، الذي باتَ مشهوراً وكَثُرَ الاستشهادُ بهِ رغمَ تحذيرِ المؤلفِ في استهلاله:
حتّى يحين الموتُ الأخير،
ذاكَ التجلي، يضمّك إلى صدرِه،
ما أنتَ سوى عابرٍ كئيبٍ على هذه الأرضِ المعتمة
متريّثاً، يصعّدُ أنفاسَه هنا.
كان غوته شديدَ التحفّظِ حيالَ نشرِ قصائدَ معينة، آثرَ أن يغلقَ عليها الدرجَ ككنزٍ خاص، وَلا يخرجها إلا لقلةٍ مجتباة. من الجديرِ بالملاحظة أنَّ العديد من سونتاته الفينيسيّة، وَمراثيه الرومانية، وَقصيدة “المذكرات” وَقصائد إيروتيكية مشابهة ظلَّت حبيسةَ الأدراجِ، في حينِ سنح للقصيدة التي اقتبستُ منها للتوِّ أن تُنشَر في مطبوعةٍ رصينة. فهيَ الأكثرُ جرأةً من بينِ هذه الأعمال، ومؤلفّها ليسَ بأقلَّ تطرّفاً من كليست الذي وصفهُ بالبربريّ.
صحيحٌ أنَّ كليست يتناولُُ عِرْقَهُ المتأصّلَ دونَ إبهامٍ، وَلا يحيدُ أبداً عن صراطه، بينما يمكنُ القول عن غوته – بمحاولته تخفيفَ حِدَّةِ الموضوع- أنّهُ يتركُ ثغراتٍ لتأويلاتٍ محتملة: دينيةٍ، وَميتا-صرفيّة، وَإبستمولوجيّة “معرفيّة”. وفي حينِ نجدُ نبرةَ كليست حادَّةً، وَمتفاقمةً، وَمهتاجة، يُهَدْهِدُنا غوته بترفِ نغمهِ اللفظي وَنَفَسِ حكمةِ الشيخوخةِ المطْمَئنة. وَبذلكَ يُلهينا عن الافتتانِ المُرعبِ الذي يحتلُّ تفكيره كما يحتلُّ تفكيرَ كليست: هذا التوق الإيروسيِّ للموت.
كانَ ريشارد فاغنر [4] أقلَّ حرجاً حيالَ الأمر. لا الغِنى الموسيقيّ وَلا الحوار وَالحَدَث تمكّنا من حجبِ التنافر الرهيب في “تريستان وَإيسولد” . يحلُّ الغروب حتى في الجزء الأولِ من الافتتاحية. في الفصل الأوَّل يُقدَّمُ سمٌّ زعاف ثُمَّ يتضحُ أنه ترياقٌ للحب؛ وَفي الفصلِ الثاني تنقلبُ أمسية الحبِّ إلى ساعةٍ مسخّرةٍ “للتوقِ موتاً في الحب” – ال “ليبستود [5]” – لكن ليسَ بتكتمٍ كما هو “شعور غوته الغريب” تحتَ ضوء شمعة، بل بابتهاجٍ وَمرحٍ وظفر- مقتربةً بذلكَ من روحِ كليست لكن في لغةٍ أبسط –كما يليق بأوبرا- . وَفي الفصل الأخير كلُ شئٍ على المحك: عندَ عودةِ إيسولد إلى تريستان –الذي يرغبُ بها بشدة- لتتمكّنَ من مداواته وَالعيش معه، يمزّقُ الضمادات التي تلفُّ جرحه ليندفعَ نحوها، نازفاً حتى الموتِ وَمحتضراً بين ذراعيها. تنزعجُ لفترةٍ قصيرة لفشلهِ في الالتفاتِ للتوقيتِ المناسب بحيث يصل مبكّراً، ثُمَّ “تحدّقُ في جسدِ تريستان في نشوةٍ متتأججة” لتطلقَ الأورغازم الأطول في تاريخِ الموسيقى (سبع دقائق ونصف تقريباً) قبلَ أن تسقطَ بدورها ميتةً بينَ ذراعيه.
استغرقَ كليست وقتاً أقصر في الواحد والعشرين من شهرِ نوفمبر 1811، على مرتفعٍ عندَ ضفّةِ بحيرةِ وانسي الصغرى بالقربِ من “بوتسدَم”. أخبرت نادلةٌ تعملُ في نُزُلٍ قريب الشرطةَ التي استجوبتها أنها قطعت “خمسين خطوةً” بعدَ سماعِ الطلقةِ الأولى، وَكانت ما تزالُ تفكِّرُ “يا لهؤلاء الغرباء! يتسكعون ببنادقهم! ” حينَ سمعتْ الطلقةَ الثانية. ذلكَ يعني أنَّ المدّةَ الفاصلة بينهما أقل من دقيقة. احتاجَ كليست لهذه الدقيقة كي يستوثقَ من كونِ رفيقته –يتردد المرءُ عندَ قولِ “حبيبته” – ميتةً بالفعل بعدَ أن أطلق النار على قلبها، الرصاصةُ اخترقت الأضلاعَ تحتَ ثديها الأيسر؛ بعدئذٍ مَدّد جسدها ربّما (وُجِدَتْ مستلقيةً على ظهرها وابتسامة رضىً تعلو محيّاها) ، ألقى بالبندقيةِ التي أطلق منها والتقطَ أخرى شُحِنتْ تواً (جلبَ ثلاث بنادقَ معه احترازاً)، انحنى عندَ قدميّ المرأةِ وَأطلق الرصاصةَ لتخترقَ فمهُ حتّى دماغه.
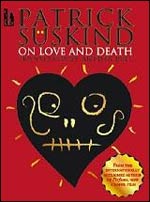 يتصدّر أورفيوس [6] تاريخِ أولئكَ الذينَ –لأجلِ الحُبِّ- استنكفوا الموت. ثمَّة آخرون جازفوا خلال حياتهم باختلاس نظرةٍ لعالمِ “هيدز [7]” المعتم، أو خَطَوا خطوةً داخله، لكن ما من أحدٍ ولجَ عالمَ الأمواتِ لإعادةِ محبوبتهِ إلى الحياة، كما فعلَ أورفيوس. يستحضرُ اسم أورفيوس رتلاً من إنجازاتٍ وَأفعالٍ مذهلةٍ أخرى، إلى جانبِ هذا الأداءِ غيرِ الناجحِ تماماً. هو مؤسسُ الأهازيجِ، وَفنِّ اللفظِ وَالموسيقى، كان غناؤه ساحراً لدرجةِ استئثارهِ ليسَ بالإنسانِ فقط، بل الحيوانِ وَالنباتِ وَحتى العناصر وَالطبيعة الجامدة. نجحَ –جزئياً- بقوِّةِ الفن وحده في تحضيرِ عالمٍ عشوائيٍ وَمتوحشٍ وَعنيف. محوِّلا ًإياه إلى عالمٍ مقنن وَمبهج. كما يُعَدُّ واليَ الزواجِ وَحُبِّ الفتيانِ وَمبتدعَ السحر.
يتصدّر أورفيوس [6] تاريخِ أولئكَ الذينَ –لأجلِ الحُبِّ- استنكفوا الموت. ثمَّة آخرون جازفوا خلال حياتهم باختلاس نظرةٍ لعالمِ “هيدز [7]” المعتم، أو خَطَوا خطوةً داخله، لكن ما من أحدٍ ولجَ عالمَ الأمواتِ لإعادةِ محبوبتهِ إلى الحياة، كما فعلَ أورفيوس. يستحضرُ اسم أورفيوس رتلاً من إنجازاتٍ وَأفعالٍ مذهلةٍ أخرى، إلى جانبِ هذا الأداءِ غيرِ الناجحِ تماماً. هو مؤسسُ الأهازيجِ، وَفنِّ اللفظِ وَالموسيقى، كان غناؤه ساحراً لدرجةِ استئثارهِ ليسَ بالإنسانِ فقط، بل الحيوانِ وَالنباتِ وَحتى العناصر وَالطبيعة الجامدة. نجحَ –جزئياً- بقوِّةِ الفن وحده في تحضيرِ عالمٍ عشوائيٍ وَمتوحشٍ وَعنيف. محوِّلا ًإياه إلى عالمٍ مقنن وَمبهج. كما يُعَدُّ واليَ الزواجِ وَحُبِّ الفتيانِ وَمبتدعَ السحر.
انتشرت عقيدته من ثريس”Thrace” ممتدةً عبرَ العالمَ اليوناني ثُمَّ الروماني. حتّى نهايةِ العصر الكلاسيكيِّ وَإبان العصور الوسطى، كانت شهرة أورفيوس على درجةٍ من العظمة لدرجةِ أنه لم يكن أمام مبشّري المسيحيةِ السابقين من خيارٍ إلا استغلال شهرته وَتبني شيءٍ من عقيدتهِ في دينهم، رابطين إياها بيسوع (تبجيل الراعي الصالح مثالاً) . معَ التشديدِ على كونِ عقيدةِ أورفيوس وثنيةً بدائية، وَأن يسوع فاقَ أورفيوس في كلِ مجالٍ، حّتى كمغنٍّ يطردُ بغنائهِ الشياطين وَالآلهة الشيطانيةَ وَالثانويّة للأبد، كما روّضَ أشرسَ الحيوانات، وَحتى الإنسانَ ذاته، دالاً إياه ثانيةً إلى طريقِ الجنّة.
وَادّعوا أنه ، إضافةً لذلكَ، لم يكتفِ بتحدّي الموت بل تغلّبَ عليهِ أيضاً باسمهِ واسمِ الإنسانيةِ جمعاء –وَليس بثمنٍ أبخس- هذا عدا نفخهِ الحياةَ في الموتى بنجاحٍ (على العكسِ من أورفيوس). سأسمح لنفسي بالقولِ إن حوداث الإحياءِ الثلاث، لا سيّما إحياءِ إليعازر، التي اجترحها يسوع الناصريّ كما يوردُ الكتاب المقدّس، سواءً نجحت أم لم تنجح، ليس بوسعها مضاهاة فشلِ أورفيوس الذريع، سواءً في جرأتهِ أو في قوّتهِ الشعريّة وَالميثولوجية.
بعد عودتهِ من العالم السفليّ وَخسارته الثانية والنهائية لمحبوبته، غرِق أورفيوس في كآبةٍ شديدةٍ وَزهدَ ملذّاتِ الحياة؛ أي حُبَّ النساء. يعبّرُ عن ذلك فيرجيل بقوله: “وحيداً يجوبُ الشمالَ الجليديَّ، نهرَ تانياس المثلِج، وَالحقولَ الممتدة حتى صقيع ريفايين، نادِباً ضياعَ يوريدايس.” أثارَ ذلك غضبَ النساءِ الثراسيّات (نسبةً إلى ثريس) المسكوناتِ بالشهوةِ الديونيسيّة وَالتائقاتِ لأن يُشتهينَ. وإذ طفح الكيل بغناء الشابِّ، حجّرنهُ حتّى الموت، مزّقنه إرباً، بعثرن عظامه، وَألقينَ برأسه مُسَمَّراً إلى قيثارتهِ في أقربِ نهر، حيثُ واصلَ ندائه وَهو ينجرفُ بعيداً “بلسانٍ ميْتٍ بارد، بأنفاسٍ تتفلت، آهٍ يوريدايس، يا يوريدايس التعِسة! “يوريداس” رددت الضِفافُ الصَدى على امتدادِ المَجرى” .
لم تنتهِ حياةُ أورفيوس بعبارةِ “انتهى كل شيءٍ” مسلّمةٍ للقضاءِ الحكيم، ممثلةً اللحظة الخاتمة لخطةٍ عظيمةٍ لتخليصِ العالم، بل بنحيبٍ بسيطٍ على المرأةِ الوحيدةِ التي أحب، وَقد بدأت حياته بذاتِ النحيب. في حينِ تمَّ التنبؤ مسبقاً بأن يصبح يسوعُ المسيحَ، فَوُلِدَ وَنشأ كمسيحٍ طيلةَ حياته، ولجَ أورفيوس التاريخَ وَالأسطورةَ كرجلٍ يخوض الحِداد. فقدَ زوجته الشابّة إذ لسعتها أفعىً سامّة. كان شديد التفجّع لفقدها لدرجةِ ارتكابِ عملٍ قد يبدو جنونياً بنظرنا، لكن يسهل علينا فهمه: أرادَ إعادة محبوبته الميتة إلى الحياة. لم يُشكك في سلطةِ الموتِ ذاته أو في حقيقةِ أن له الكلمة الأخيرة، وَلم يكن يعبأ بمقاومةِ الموتِ باسمِ الإنسانيةِ أو تحقيق الخلود. جلّ ما أراده إعادةُ هذه المرأة فقط إلى الحياة، محبوبته يوريدايس، وَلم يرِدها خالدةً للأبد، بل بالقدرِ الذي يمضيان فيه حياةً بشريّةً عاديةً، ليسعدَ معها على وجهِ الأرض.
لذا لا يمكنُ اعتبارُ مجازفة أورفيوس بولوجه العالم السفليّ عملاً انتحارياً- فليسَ ب فرثر، وَلا كليست، وَعلى وجه التأكيد ليسَ تريستان – بل مغامراً شجاعاً يأملُ في الحياةِ وَيقاتلُ واقع الأمر بيأسٍ لحيازتها. وَيلومه أفلاطون عَرَضاً في “المجادلة”. يهزأُ فيدروس Phaidros بِ”العازفِ الضعيفِ” أورفيوس الذي يفتقرُ إلى الأريحيةِ لقتلِ نفسهِ باسم الحب، وَيُؤْثرُ التوجهَ حيّاً إلى العالمِ السفلي، كما لو كانَ لهوَ أطفال. فعلى خلافِ يسوع، لا يستطيعُ أورفيوس التعويل على المعونةِ الإلهية في اختراقه الجريء، رغم تمتعه بصلاتٍ قويةٍ بجبلِ الأوليمب إذ كانَ ابن أبولو – كما يقول البعض-. على النقيضِ من ذلك، فقد انتهكَ في تمامِ وعيهِ ورغبته الأمرَ الإلهي بولوجه عالمَ الموتى.
لكن دونَ رغبةٍ – كما يقول – في التشكيك بالسلطةِ المطلقةِ لحكّام الأرواحِ الميتة، بتطفّله دونَ دعوةٍ على ساحةِ الظلال وَطلبهِ إياهم تحرير يوريدايس. يقولُ أورفيوس: “سطوتك هيَ الأقوى على الجنسِ البشري” . علاوةً على ذلك، لم يهبطِ إلى العالمِ السفلي بحسابٍ مسبّقٍ أو بدافعِ فضولٍ أو نوايا خبيثة، لكن لغايةِ الحُبِّ محضة. الحُبُّ قوةٌ لا يسعُ الإنسان التملّص منها ، يقولُ ذلك أورفيوس، كما يؤمنُ أنَّ نور الحُبِّ يمكن أحياناً أن يشقَّ سبيلاً حتى عبرَ ظلماتِ العالم السفلي. ألم تجمع قوةُ الحُبِّ بين حكامه ذاتَ مرة؟ إن صحّت الحكايا، ألم يجلِب “هيدز” ذاته في شبابهِ “بيرسفون” من روضةٍ مزهرةٍ إلى “أوركوس”، مدفوعاً بشغفٍ جارِفٍ وَمتجاهلاً ترتيباتٍ مع رفاقه الآلهة؟ يتوسّلُ أورفيوس الآلهةَ أن يتذكروا شبابهم وَتجاربهم معَ الحُبِّ، وَلتسبق رحمتُهم عدلَهم لأجلِ الحُب وليحرروا يوريدايس. وَإن لم يستجيبوا لطلبه، فلن يعودََ أورفيوس إلى عالمِ الأحياء بل سيمكثُ هنا بين الموتى.
قالَ كلَّ ما قال في أغنية. وَظفرَ –يا للعجبِ- بما أراد. أعاد له حكّام عالم الموتى محبوبته، لكن تحتَ الشرطِ المعروف بألا يلتفتَ وَينظر للخلفِ خلال متابعتها إياه في طريقهما للعودةِ إلى العالم ِالعلوي.
والآن يرتكبُ خطأً. سعيدٌ هوَ، وَمن يلومه؟ مبتهجٌ بانتصاره. فقد قامَ بما لم يسبقه إليه أحد: أعادَ محبوبته من عالمِ الموتى إلى الحياة. مُراده أنجِز، وَظفره اكتمل، كما يظن. وَفي غمرةِ فرحهِ يأخذ بالغناء ثانية، ليسَ عويلاً بالطبع، بل أنشودةً جذِلةً عن الحياةِ، للحُبِّ، ليوريدايس. يبتهجُ بجمالِ غنائه لدرجةٍ ينتقصُ فيها من الخطر الذي ما زال يحدق بمغامَرته، لربما ما عادَ يشعرُ به- فذاكَ الخَطَر كان ينبعثُ من داخله.
علينا التذكّرُ أن أورفيوس فنان. وَككلِّ الفنانين لا يخلو من غرورٍ، أو لنقل من زهوٍ بفنّه. لا يمكنُ لمغنّي أوبرا أن يُقدِّم عرضه مولياً ظهره للجمهور فترةً طويلة.. لا يمكنه ذلك، فهذا منافٍ لطبيعته. لقد تماسكَ أورفيوس طويلاً جداً، وَهو يعاني من عذابٍ مضاعفٍ لعدمِ قدرته على الالتفاتِ وَللفكرةِ التي مؤداها أنه ربّما خُدِع منذ البداية. يكتبُ فيرجيل أنه كان “عندَ طرفِ الضوءِ”، على أرضٍ آمنةٍ، عائداً إلى هذا العالم، حينَ تهاوت سيطرته على نفسه. لربّما عاشَ احتيالاً إلهياً، لربّما نشدَ ملجأً في خواطرِ الثأرِ وَالانتقام. لكنّهُ إذ يلتفتُ الآن يلفي زوجته –وَيالمفاجأته وَرعبه – بالفعلِ هناك، ليسَ على بعدِ خطوتين منه، بل ما تزال على الجانب الخطأ من الحدود، وَقد خسرها بخطأٍ منه. نظرت إليهِ، مرتعبةً بالقدرِ ذاته، في كمدٍ لا حدَّ له وَدونَ لومٍ، وَبالكادِ همست كلمة وداعٍ مسموعة، لتهوي في العالمِ السفلي إلى الأبد.
تقودنا قصةُ أورفيوس إلى عصرنا الحاضر لأنها قصةُ فشل. فشلت آخر الأمر تلكَ المحاولة الرائعة لمصالحةِ قوتيّ الوجود الإنساني الغامضتين البدائيتين: الحب وَالموت، وَدفعِ أشدهما ضراوة لبذل تسويةٍ صغيرةٍ على الأقل. أمَّا قصةُ يسوع فكانت ظفراً منذ بدئها حتى منتهاها الأليم في مواجهته الموت. لم يبدِ ضعفاً إنسانياً سوى مرتين: في جثسيمانيGethsemane حيثُ شكك قليلاً بمهمته (”يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ” ) ، وَفي تجلٍّ متصدّعٍ على الصليب، بآخر كلماته غير المتوقعةِ بتاتاً “ربّاهُ، يا ربّاه، لمَ تخليت عني؟ ” التي لم تكن جزءاً من الخطة.
على كلٍ، لم يُدوَّن نداءُ اليأسِ هذا إلا في السفرين الأولين. في أناجيلِ لوقا ويوحنّا، التي دُوِّنت لاحقاً، استبدل هذا النداء بعبارةٍ واثِقة “يا أبتاه، في يديك أستودع روحي”، أو كالاقتباسِ السابق من يوحنا: “انتهى كل شيء.”
وَماذا عن الحُب؟ إيروس الشهواني المتطلّب الملح الذي تحدثنا عنه؟ لم يُمنحَ أي فرصة. لم يعنِ شيئاً ليسوع. وَكان الشيطان على علمٍ بذلكَ حين أغواه. لم تكن الفتيات الجميلات ولا الغلمان إغراءً يمكنه اجتذاب ذاك النجّار الفتي. ما كان يهمّه هو السلطة. ولذلك عرض عليه الشيطان سلطةً على “كل ممالكِ العالم وَأمجادها” إن سقطَ وعَبَدَه- لكن دونَ جدوى، كما نعلم، ففي حينِ لم يكن لدى يسوع أي نيةٍ في التخلي عن السلطة، كانَ معتمداً كليّاً على الطرفِ الآخر الأقوى في هذا النزاع لتمكينه منها.
هذا الجانب الحذِر من شخصيته، تماسكه المطّرد، حصانته ضد سعار إيروس، كل هذا ينفح شخصَ يسوع الناصري بشيءٍ من صَرْد، حسٍّ بنأيٍ ولا إنسانية. لكن ربّما نطلب الكثير منه. ربما لم يكن غيرَ إلهٍ بالفعل. لذا نجدُ أورفيوس أقرب إلينا. على الرغمِ من غلوّه العاطفي وَعناده، هو أقربُ إلينا في شجاعته المباشِرة، موقفهِ المتحضِّر، حذقهِ وذكائه العفويّ تماماً، وَكل هذا ناتجٌ عن وَمتناقضٌ معَ فشله.
Patrick Süskind * من كتاب ” في الحُبِّ وَالموت” باريس - دار "فايار"
عن موقع دروب