إعداد وترجمة: صبحي حديدي
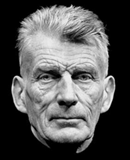 مقدّمة
مقدّمة
يحتفل العالم، وليس إرلندا وإنكلترا وفرنسا وحدها، بالذكرى المئوية لولادة الشاعر والمسرحيّ والروائي الإرلندي الكبير صمويل بيكيت (1906 ـ 1989)، ليس دون إجماع مذهل حول عبقريته الفذّة وأدبه الرفيع وإنسانيته الفريدة غير المألوفة عند كتّاب الطليعة والحداثة والعبث، وليس دون اختلاف واسع النطاق ـ ولهذا فهو صحيّ تماماً ـ حول هذا أو ذاك من خطوط تأويل رموزه وتفكيك موضوعاته وتحليل الأساليب والأشكال والخيارات الفنّية التي جعلته أحد كبار روّاد التجريب على امتداد القرن العشرين بأسره.
وعلى سبيل المثال، تنطلق برامج الاحتفاء الواسعة التي بدأتها "حلقة أبحاث صمويل بيكيت" في اليابان من فلسفة متكاملة ومدهشة بعض الشيء: أنّ في أدب بيكيت الكثير من عناصر المأساة والملهاة والألم والأمل التي لا تمثّل الإنسانية جمعاء فحسب، بل تمسّ الوجدان الياباني في الصميم، أو تمثّل روح اليابان بالمعنى الوثيق الدقيق! وهم يرون، كما يرى معظم عشّاق فنّ بيكيت ودارسيه، أنّ عمله يتجاوز أيّ وكلّ حدود تقيمها المفاهيم المسبقة، القارّة الراسخة خصوصاً، حول "الشرق" و"الغرب" بادئ ذي بدء، ثمّ في تسعة أعشار القضايا التي تخصّ الفنّ والأدب والرواية والمسرح والفلسفة ولغة الكتابة والمقاومة والحياة والموت. ليس غريباً، بالتالي، أن يطلقوا على احتفالات المئوية اسم "بيكيت بلا حدود" من جهة أولى؛ وأن يتعمدوا، من جهة ثانية، دعوة باحثين من آسيا والشرق عموماً، أكثر من أوروبا والغرب؛ وأن يكرّسوا محوراً أساسياً بعنوان "بيكيت وآسيا"، يتلمّس حقلاً بحثياً جديداً تماماً، وبالغ الخصوبة والجدوى والأهمية.
ولعلّ معظم الأسباب التي تجعل بيكيت كونياً هكذا إنما تنبثق من استراتيجية أساسية كبرى حكمت معظم نتاجه، أو لعلّها الروحية العظمى في ذلك النتاج: أنّ معطيات دائرة العبث المطلق التي تتحرّك فيها شخوصه، ونتحرّك معها بدورنا، أكثر اتساعاً وتعقيداً وإيغالاً في النفس البشرية من أن تُدرج الثنائيات التقليدية بين خير وشرّ، وشرق وغرب، ورجل وامرأة، أو أن تقبل احتكار "الروايات الكبرى" التي تمنح هذه الثقافة أو تلك تفوّقاً من أي نوع في تمثيل الهواجس الإنسانية. والشخصيات حاملة هذه الاستراتيجية لا تهبط مرّة واحدة عن مستوى التمثيل التراجيدي الأقصى لمعضلات هذا العالم، الذي ينتظر غودو عبثاً، ولكنه لا يكفّ عن الانتظار؛ والذي يأخذ هيئة جمجمة مجوّفة هائلة فيها يواصل الكائن البشري خضوعه لشرط وجود ناقص: لابثاً في حاوية قمامة، مسمّراً على كرسيّ هزّاز، جامداً كلوح من الخشب أمام نافذة مظلمة، مدفوناً حتى عتقه في الرمال، أو مقلوباً على وجهه في حمأة من الطين...
من جانب آخر، كانت الأسئلة الكبرى التي أثارتها أعمال بيكيت قد تجاوزت حدود تراجيديا البشر بما تنطوي عليه من عزلة ويأس ومهانة وعبث، لتبلغ مأزق التعبير ذاته، في المعنى واللغة والشكل والرسالة. ولقد قاد الرواية، مثلاً، إلى منعطف مغلق (وبالتالي فإنه، لهذا تحديداً، جعلها مفتوحة الاحتمالات)؛ وجرّد المسرح من بعض أهمّ عناصره، حين جمّد الشخصية في المكان وألغى حركتها على الخشبة؛ وكاد أن يذهب بالتمثيلية الإذاعية إلى حافة "الصوت الصامت"، أو الصوت غير اللغوي؛ وقارب فنّ السينما لكي يوقّع بياناً شجاعاً ضدّ فحشاء الصوت والمؤثرات وألعاب السيناريو، لصالح المعطى البصري دون سواه.
وفي رائعته "أيام هانئة" رسم واحداً من أصعب الأدوار النسائية في تاريخ المسرح، إذْ كيف يمكن لممثلة مهما بلغت براعتها أن تسترعي انتباه المشاهد إليها (بوصفها الشخصية الوحيدة) وهي مدفونة في كثيب رملي حتى ثدييها في الفصل الأوّل، وحتى عنقها في الفصل الثاني والأخير؟ وكيف يمكن لها ذلك وقد سُلّطت عليها، أو على فمها تحديداً، بقعة ضوء ساطع يخطف الأبصار ولا يبارح خشبة المسرح حتى إنزال الستارة؟ ورغم ذلك، فإنّ نجمات المسرح الغربي تسابقن لأداء الدور، وبينهنّ روث وايت، بريندا بروس، ماري كين، مادلين رينو، إيفا كاتارينا شولتز، بيغي أشكروفت، إرين وورد، وبيللي وايتلو.
وفي سياقات كلّ هذا التجريب المتعدد كان بيكيت قد وضع اللغة ذاتها موضع مساءلة عنيفة قاسية. ولم يكن مستغرباً أن يكتب أعظم أعماله، الثلاثية الروائية ومسرحيته الأشهر "في انتظار غودو"، باللغة الفرنسية وليس الإنكليزية. إذْ بمعزل عن فلسفته الشخصية التي تكمن وراء هذا الخيار، أي رغبته في التخلّص ما أمكن من ضغط وإغواء وسطوة البلاغة الفطرية في اللغة الأمّ، ثمة تلك العلاقة الوطيدة التي جمعته مع اللغة الفرنسية، أو مع فرنسا عموماً في الواقع. وكان قد جاء إلى باريس سنة 1928 لإكمال دراسته الجامعية، وناقش أطروحة متميّزة عن الروائي مارسيل بروست، وانضمّ إلى حلقة مواطنه الروائي الكبير جيمس جويس (ولم يكن سكرتيره الخاصّ، كما يتردد في بعض المراجع)، ثمّ أخذ يكتب بالفرنسية أو يترجم إليها. ولكي يبرهن أنّ روحه الكونية ليست مقتصرة على النصّ وحده، انضمّ بيكيت إلى حركة المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال النازي، واضطرّ إلى التخفّي والعيش في الحياة السرّية حين اكتشف النازيون أمر الخلية التي كان منضوياً فيها، فغادر باريس إلى الجنوب ليشارك في مختلف أعمال المقاومة، رغم أنّه يحمل جنسية بلد محايد في الحرب وكان من حقّه أن يقيم في باريس بلا منغصات.
كذلك كان بيكيت فناناً شديد الأصالة وبالغ الانهماك في المعضلات الجمالية للنصّ الأدبي أسوة بالمعضلات الكبرى للوجود الإنساني. ولقد رفض بثبات تقديم أيّ تنازل لجمهوره، وكلما اتسعت شهرته ازداد خجلاً وانكماشاً وتوارياً عن الأنظار والعدسات. وحكايته مع جائزة نوبل للآداب، التي نالها سنة 1969، لم تكن طريفة عجيبة فحسب، بل كانت مجرّد تفصيل مألوف عادي في سلوكه العامّ اليوميّ، أياً كان الحدث وأياً كانت العاقبة. وفي سيرته التي تحمل عنوان "محكوم بالشهرة"، وهي الأفضل بين جميع السِيَر التي تناولت حياته، يروي جيمس نولسون عشرات التفاصيل التي تبرّر اختيار هذا العنوان لسرد حياة بيكيت، وبينها واقعة نوبل تلك.
كان بيكيت وزوجته سوزان ديشفو ـ دومنيل يقضيان أواخر الخريف في بلدة تونسية صغيرة اسمها نبول، تقع على مبعدة 40 ميلاً جنوب العاصمة، وكانا ينزلان في فندق صغير يدعى "الرياض". وفي يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1969، وصلت من جيروم لاندون، صديق بيكيت وناشره، البرقية التالية: "العزيزان سام وسوزان. رغم كلّ شيء، لقد منحوك جائزة نوبل. أنصحكما أن تتخفيا. قبلاتي". ولم تنجح كلّ الجهود في كشف مكانه، ثمّ حين توصّل الصحفيون إلى مكان الفندق وتقاطروا إليه بالعشرات، لم يفلحوا حتى بالتقاط صورة، بما في ذلك فريق التلفزة السويدي الذي عاد خائباً.
وتبقى كلمة حول صمويل بيكيت الشاعر، الذي اخترنا له عدداً من القصائد في هذا الملفّ، لسببين. الأوّل أنه غير معروف كشاعر، في اللغة العربية على الأقلّ، ولعلّ هذه المختارات تفلح بعض الشيء في تمثيل نمط الشعر الذي كان يكتبه، والذي كان رفيعاً وجسوراً وناضجاً في قناعتي. السبب الثاني أنّ بيكيت بدأ شاعراً، ويتفق اثنان من كبار نقاد النصف الثاني من القرن العشرين، مارتن إسلين وهيو كينر، على أنّ الشعر لم يغادره قطّ، وتواصل في رواياته ومسرحياته، واتخذ من الأشكال والتعبيرات ما يتجاوز الحسّ الشعري أو الشاعرية التلقائية أو شَعْرَنة السرد والحوار. ويضرب كينر قصيدة "النسر" مثالاً على براعة بيكيت في التحايل على حجم القصيدة والزمن الذي تستغرقه قراءتها، بحيث يجعل محمولها الشعوري أشدّ كثافة من معمارها المجازي والصوتي.
ولا يتردد اسم بيكيت إلا وتعود إليّ، شخصياً، تلك العبارة الصاعقة الصادقة التي أطلقها مسرحيّ كبير آخر هو البريطاني هارولد بنتر: "لا أريد منه [بيكيت] الفلسفات، والمنشورات، والدوغما، والعقائد، والمخارج، والحقائق، والإجابات... يكفيني أنه الكاتب الأكثر شجاعة، وكلّما سحق أنفي في البراز أكثر، ازداد امتناني له أكثر وأكثر"!
صبحي حديدي
ـ يُنشر هذا الملفّ بالاتفاق مع فصلية "الكرمل" الفلسطينية، العدد 87، ربيع 2006.
قصائد
***
عظام صدى
النسر
جَرّ جوعَه على امتداد السماء
التي تنبسط في قوقعةٍ، جمجمة السماء والأرض
انحنى أمام منكبٍّ على وجهه سرعان
ما سيأخذّ حياته ويمشي
عرضة لسخرية نسيج قد لا ينفع
حتى يصبح الجوع والأرض والسماء نفايات (1)
ترنيمة تروبادور II
عالَمٌ عالم عالم عالم
والوجه قاتم
غيمة قبالة المساء
لا تذكر الأموات إلا بالخير (2)
الوجه يتقوّض خَجِلاً
فات الأوان لكي تسودّ السماء
متورّداً ماضياً نحو المساء
مرتعداً ماضية مثل زلّة
يا فيرونيكا العالم
فيرونيكا عالمنا
أعطنا مسحة على حُبّ يسوع (3)
يتصبب عرقاً مثل يهوذا
متعَب من الموت
متعب من العسس
القدم في المرملاد
يفرز العرق
والقلب في المرملاد
مزيد من الفاكهة المدخنة
والقلب الشيخ القلب الشيخ
يتشظى خارج الحشد
مستلقياً، الصدق أقول
على جسر أوكونيل
محملقاً في زهور توليب المساء
التوليب الأخضر
وهّاجاً حول الزاوية مثل جمرة
وهّاجاً على مراكب غينيس
وجهٌ وَقْعُ الصوت
فات الأوان لكي تلتمع السماء
الحقّ الحقّ أقول لكم
ألبا
ستكون هنا قبل الصباح
معك دانتي والـ "عقل" (4) والأطوار والأسرار المستغلقة
والقمر الموسوم
خلف سهوب الموسيقى البيضاء
التي ستبسطها هاهنا قبل الصباح
وقورٌ دمثٌ طروبٌ حريرٌ
طأطأة أمام قبّة سوداء من الأشجار النخلية
مطرٌ على زهر الخيزران من دخان زقاق القصب
ومَنْ رغم طأطأةٍ بأصابع الرحمة
بغية اعتناق الغبار
سيستنكف عن الإسهام في سخائك
مَن الذي سيكون جمالُه صفحةً قبالتي
قولاً من ذاته مسحوباً على امتداد عاصفة الرموز
بحيث لا شمس ولا انكشاف حجاب
ولا مضيف
سواي أنا والصفحة
والكتلة ميّتة (5)
دورتموندر
في السحريّ شَفَقِ هوميروس
عبر العسلوج الأحمر في الحَرَم
أنا العديم وهي الفخمة المَلَكية
نحثّ الخطى نحو مصباح البنفسج نحو العلامة الرفيعة في موسيقى سيّدة الماخور.
تشخص أمامي في الدكة اللامعة
مهدهدة شظايا حجر اليشب
والزهد الملتئم في الصفاء الساكن
والعينان العينان سوداوان حتى تفلح اللازمة الشرقية
في فكّ عبارة الليل الطويلة.
وعندها، مثل لفافة، تُطوى،
ويتّسع مجد انحلالها
في داخلي أنا، حبقوق، كبير الخطاة أجمعين.
شوبنهاور مات، وسيّدة الماخور
تُبعد عنها قيثارتها. (6)
مالاكودا
ثلاثاً جاء
رَجُلُ الحانوتي
بليد الحسّ خلف قبعته السوداء المستديرة
لكي يقيس
ألا يُدفع له كي يقيس
هذا الجاثم في الدهليز غير قابل للفساد
هذا الكاردينال التوفيقي الغارق في الليلك حتى ركبتيه
مالاكودا الغارق في الليلك حتى ركبتيه
مالاكودا من أجل رَوْع الخبير كلّه
يكسو باللباد شرجه ويٌخرس إيماءته
متنهداً نافخاً عَبْر الهواء الثقيل
لا مناص لا مناص لا مناص
إبحثْ عن الطحالب إغرسْها في الحديقة
إصغِ إليها لعلّها ترى أنها ليست بحاجة
أنْ تكفّن
بمساعدة الثدييات ذوات الحوافر
إبحثْ عن الطحالب إجذب انتباهها
إصغِ إليها لعلّها ترى أنها ليست بحاجة
أنْ تغطي
أن تتأكد أن تغطي الكلّ تغطي الكلّ
غرضك هذا يجعلني أحبس ماء الكبريت فيك
قَدّسْ حصاد الزجاج نَظّفْ شوائبه
إمكث يا سكارميليون إمكثْ إمكثْ
وضع هويسام هذا على الصندوق
إنتبهْ إلى أنه هو الصورة
وعليها أن تصغي أن تصغي أن تصغي
الكلّ على متن السفينة كلّ الأرواح
السارية منكسة نعم نعم
لا (7)
عظام صدى
ملاذٌ تحت مداسي طيلة هذا النهار
صوتهم المخنوق يعربد واللحم يسّاقط
منكسراً بلا خوف ولا ريح مواتية
قفّاز المعاني والترهات
إذْ تأخذها اليرقات بصفاتها تلك (8)
سبيلي
سبيلي هناك في الرمل الذي يتدفق
بين الموضع كثير الحصى والكثيب
مطر الصيف يمطر على حياتي
وعليّ حياتي التي تسوقني تتبعني
إلى بدئها إلى منتهاها
سلامي هناك في الغبش المتقهقر
ساعة أتوقف عن وطء هذه العتبات الطويلة المتحرّكة
وأعيش فضاء باب واحد
ينفتح وينغلق
ماذا سأفعل
ماذا سأفعل من دون هذا العالم الذي بلا وجه، غافل غير مبالٍ
حيث ثمة نهائيات ولكن ثمة برهة حيث كلّ برهة
تُراق في الفراغ في جهالة أن تكون
بلا هذه الموجة حيث في نهاية المطاف
ينحشر الجسد والظلّ معاً
ماذا سأفعل من دون هذا الصمت حيث تموت التمتمات
اللهثات نوبات السعار صوب المأوى صوب الحبّ
دون هذه السماء التي تحوّم
فوق غبارها الطافح حصى
ماذا سأفعل ماذا فعلتُ البارحة والنهار الذي قبل أمس
أحملق من المنور باحثاً عن آخَرٍ
يتجوّل مثلي دوّامةً بعيداً عن كلّ الأحياء
في فضاء متشنّج
وسط أصوات بلا أصوات
تحتشد في غَوْر خفائي
يطيب لي
يطيب لي أن تموت حبيبتي
يطيب لي أن يمطر المطر على القبر
وعليّ أنا إذْ أذرع الشوارع
حداداً عليها التي ظنّت أنها أحبّتني (9)
*****
إنّ مزج مخيّلة جبارة مع منطق في حال من العبث سوف يعطي واحدة من نتيجتين: إمّا المفارقة، أو الإرلنديّ. فإذا كانت النتيجة هي الثانية، فإنك ستضع المفارقة في مقايضة. وجائزة نوبل للأدب، نفسها، يمكن أن تنقسم هكذا. والمفارقة أنّ أمراً كهذا وقع سنة 1969، حين مُنحت جائزة واحدة إلى رجل واحد، وإلى لغتين وأمّة ثالثة، هي نفسها منقسمة.
ولد صمويل بيكيت قرب دبلن سنة 1906. ولم يدخل العالم كاسم أدبي مرموق إلا بعد نصف قرن في باريس، حين صدرت له ـ خلال ثلاث سنوات فقط ـ خمسة أعمال نقلته على الفور إلى مركز الاهتمام: "موللوي"Molloy الرواية، 1951؛ تكملتها "مالون يموت"Malone Meurt ، السنة ذاتها؛ مسرحية "في انتظار غودو"En Attendant Godot ، 1952؛ وفي السنة التالية صدرت روايتان: "اللامسمّى"L’Innommable التي اختتمت الثلاثية مع "موللوي" و"مالون"، وأخيراً "وات" Watt.
هذه التواريخ تسجّل ظهوراً مباغتاً ببساطة. فالأعمال الخمسة لم تكن جديدة زمن صدورها، كما أنها لم تُكتب ضمن الترتيب الذي ظهرت به. إنّ خلفيتها تنتمي إلى الوضع الراهن، وإلى التطوّر السابق في عمل بيكيت. إنّ الطبيعة الحقيقية لرواية "مورفي"، التي تعود إلى عام 1938، والدراستين عن عن [جيمس] جويس (1929) و[مارسيل] بروست (1931)، والتي تسلط الضوء على موقعه الإبتدائي، يمكن أن تُرى بوضوح أكثر في ضوء نتاج بيكيت اللاحق. إذْ بينما كان رائداً في طُرُز جديدة من التعبير في القصة وعلى المسرح، ظلّ بيكيت في الآن ذاته حليفاً للتراث، شديد الارتباط ليس مع جويس وبروست وحدهما، بل مع كافكا أيضاً؛ والأعمال الدرامية لبداياته تضرب بجذورها في أعمال فرنسية تعود إلى تسعينيات القرن التاسع عشر وإلى مسرحية الفريد جاري "أوبو ملكاً".
وضمن اعتبارات عديدة تسجّل رواية "وات" نقلة مرحلية في هذا المبتدأ اللامع. لقد كُتبت خلال 1942 ـ 1944 في جنوب فرنسا ـ حيث فرّ بيكيت من النازيين، بعد إقامة لفترة طويل في باريس ـ وسوف تكون آخر أعماله باللغة الإنكليزية إلى زمن مديد، لأنّ شهرته ذاعت عبر اللغة االفرنسية، ولن يعود إلى لغته الأمّ طيلة 15 سنة. وكان العالم من حول بيكيت قد تغيّر حين عاد إلى الكتابة بعد "وات". وكانت جميع الأعمال التي صنعت اسمه قد كُتبت خلال 1945 ـ 1949، وكانت الحرب العالمية الثانية ركيزتها، وبعدها فقط بلغت شهرته درجة رفيعة في النضج وفي الرسالة. لكنّ هذه الأعمال لا تتناول الحرب ذاتها، ولا الحياة على الجبهة، ولا حركة المقاومة الفرنسية (التي شارت فيها بيكيت بنشاط)، بل ما حدث بعدئذن حين حلّ السلام ورُفعت الستارة عن المدنّس في أشدّ المدنسات لتكشف المشهد المريع عن المدى الذي يمكن للآدميّ أن يذهب إليه في الانحطاط الإنساني، سواء نفّذه بنفسه أو سيق إليه، وكم يستطيع الآدميّ أن ينتشل من ذلك الإنحطاط. وبهذا المعنى فإنّ انحطاط الإنسانية موضوع متكرر في عمل بيكيت، خصوصاً وأنّ فلسفته ـ التي تؤكدها ببساطة عناصر المضحك المبكي والمهزلة السوداء ـ يمكن وصفها بالنزعة السلبية التي تأبى، مع ذلك، الامتناع عن النزول إلى الأعماق. وإلى الأعماق ينبغي أن تتوغل، إذْ هناك فقط يمكن للفكر وللشعر المتشائمين أن يجترحا المعجزات. فما الذي يناله المرء حين يُنشر السلبيّ؟ ينال الإيجابيّ، والإيضاح، والأسود وقد برهن أنه ضياء النهار، والأجزاء في أعمق الظلال بوصفها هي التي تعكس منبع الضوء. وهنالك سوابق من تراكم القبائح في التراجيديا الإغريقية دفعت أرسطو إلى نظرية تطهير العواطف، أي التطهّر من خلال الألم. والإنسانية استمدّت من بئر شوبنهاور المريرة قوّة أكبر ممّا استمدت من ينابيع شيللينغ المباركة، وقد جرحها شكّ باسكال المعذّب أكثر ممّا فعلت ثقة ليبنتز العقلانية العمياء في خير ثمار الإنسانية جمعاء. وفي ميدان الأدب الإرلندي، الذي غذّى كتابة بيكيت أيضاً، نالت الإنسانية من رعويات أوليفر غولد سميث الكنسية البيضاء المغسولة حصاداً أقلّ ممّا أعطاه دين سويفت في تسويد الشديد لسمعة الإنسانية قاطبة.(1)
ويمكن العثور على جزء من نظرة بيكيت هنا: في الفارق بين التشاؤم سهل المنال القائم على محتوى من الشكّ لا يتزعزع، وتشاؤم عسير المنال يتوغل في أقصى بؤس الإنسانية. الأوّل يبدأ وينتهي من مفهوم يقول إنّه لا شيء يستحقّ القيمة، والثاني يرتكز على نظرة معاكسة تماماً. ذلك لأنّ ما لا قيمة له، ليس قابلاً للانحطاط. وإجراك الانحطاط الإنسانيّ ـ الذي لعلّنا شهدناه بدرجات اشدّ من أيّ جيل سابق ـ ليس ممكناً إذا جرى إنكار القِيَم الإنسانية. لكنّ التجربة تصبح أكثر إيلاماً كلّما تعمّق الإقرار بالكرامة الإنسانية. هذا هو مصدر التطهير الداخلي، أو قوّة الحياة بالأحرى، في تشاؤم بيكيت. إنه يشتمل على حبّ للإنسانية يتنامي وسط التفهّم وهو يغوص في أعماق الاشمئزاز، وذلك يأس يتوجب أن يبلغ أقصى حدود المعاناة لاكتشاف أنّ التراحم ليس له حدود. ومن ذلك الموقع، في باطن عوالم الإفناء، تنهض كتابة صمويل بيكيت من مزمور الإنسانية الجمعاء، وصوتها المخنوق يعزف نغم التحرير للمقهور، والسلوى للذين بحاجة ماسّة إليها.
ويبدو هذا بارزاً تماماً في تحفتيه، "في انتظار غودو" و"أيام هانئة"، اللتان تطوّران على نحو ما نصّاً من الكتاب المقدّس، كلٌّ على طريقته. ففي حالة غودو، لدينا "أنت هو الآتي أم ننتظر آخر" (2). الشريدان يواجهان لامعنى الوجود في اشدّ تجلياته وحشية. قد يأخذ هيئة إنسانية؛ لا قوانين اشدّ قسوة من قوانين الخلق، وموقع الإنسان الفريد في الخلق أنه المخلوق الوحيد الذي يطبّق هذه القوانين بنيّة شريرة عن سابق قصد. ولكننا لو تخيّلنا عناية إلهية ـ حتى إذا كانت مصدراً لعذاب لا حدّ له ينزل بالبشرية ـ أيّ نوع من الجبروت الإلهي سوف نصادف، مثل الشريدين، ذات مكان، ذات يوم؟ إجابة بيكيت تتألف من عنوان المسرحية. فيعد انتهاء العرض، بعد انتهاء عرضنا نحن، لا نعرف شيئاً عن هذا الـ غودو. وحين تنزل الستارة الأخيرة، لا نستجمع أيّ إلماح إلى القوّة التي شهدنا تقدّمها. ولكننا نعرف شيئاً واحداً، لن تستطيع كلّ فظائع هذه التجربة أن تفقدنا إياه: أننا ننتظر. هذه هي محنة الإنسان الميتافيزيقية، حول التوقّع المستديم غير المؤكد، ملتقَطاً ببساطة شعرية حقّة. في انتظار غودو...
نصّ "أيام هانئة" ـ "صوت صارخ في البرّية" (3) ـ أكثر اهتماماً بمحنة الإنسان على الأرض، وبالعلاقة بين بعضنا البعض. ففي هذا المعرض لدى بيكيت الكثير الذي يقوله حول قدرتنا على رعاية أوهام غير قابلة للزعزعة في برّية من فراغ الأمل. لكن هذا ليس هو الموضوع. فالفعل ببساطة يخصّ العزلة وكيف أنّ الرمل يعلو ويعلو حتى يغرق الفرد كليّاً في عزلته. ومن خارج الصمت الخانق يظلّ الرأس يصعدن مع ذلك، وهو يصرخ في البرّية، عن حاجة الإنسان التي لا تُقهر إلى البحث عن أخيه الإنسان حتى نهاية النهايات، والتحادث مع الخلاّن للعثور على العزاء في الصحبة. (4)
*****
بطل الالتباس
تيري إيغلتون
كان صمويل بيكيت فناناً ذا رؤيا هادفة تماماً حول الوجود الإنساني، لدرجة أنه لم يولد يوم الجمعة 13 فحسب، بل في يوم تصادف أنه "الجمعة الطيبة". ولسوف يلمح، فيما بعد، إلى نهار موت المسيح هذا في عبارة ساخرة خالدة في مسرحيته "في انتظار غودو": "واحد من لصوص سلاح الفرسان تمّ إنقاذه. إنها نسبة مئوية معقولة".
وبرامج هذه السنة للاحتفال بمئوية بيكيت حاشدة بالأحداث الأدبية التي تحتفي بحياة متشائم العصر الحديث الأكثر استئثاراً بمحبّة الناس، ولعلّ معظم تلك الاحتفالات سوف تحفل بالحديث عن الشرط الإنساني اللازمني الذي تصوّره أعماله.
لا شيء يمكن أن يكون بعيداً عن الحقيقة مثل هذا. وبيكيت لجأ إلى أسلوب تفضيح إرلندي نمطي في التعامل مع هذه التأويلات المثقلة بالاحتمالات، فذكّر النقّاد بما يلي: "لا رمز حيث لا يكون الرمز مقصوداً". ومن جانب آخر، لم يكن الرجل روحاً لازمنية، بل كان بروتستانتياً إرلندياً جنوبياً، وجزءاً من الأقلية المحاصَرة المؤلفة من غرباء واقعين في أسر "دولة كاثوليكية حرّة" انتصارية. وحين أضرم الجمهوريون النيران في البيوت الكبيرة الأنغلو ـ إرلندية خلال حرب الاستقلال، فرّ الكثير من البروتستانت إلى المقاطعات الداخلية. وإنّ الخوف الدائم، والإحساس المزمن بانعدام الأمن، والهامشية عن سابق وعي ذاتي، هي العناصر التي تضفي على عمل بيكيت الكثير من المعنى في ضوء ذلك كلّه. الحال ذاتها تنطبق على ما يسود في عمله من سمة التعرية وحسّ الانسلاخ، مع ما يقترن بهما من ميل بروتستانتي إلى الإبهار والإفراط. وإذا كان قد تخلى سريعاً عن إرلندا لصالح باريس، فإنّ بعض السبب يعود إلى أنّ المرء يمكن أن يكون شريداً في بلده كما في الخارج. وكما جرى مع صديقه جيمس جويس، وهو بدويّ أدبيّ إرلندي آخر، سرعان ما تحوّل المنفى الداخلي إلى هجرة أدبية. واغتراب الفنان الإرلندي يمكن ترجمته بسهولة كافية إلى قلق حداثي أوروبي.
وكان بيكيت أبعد ما يكون عن الإحساس بالعار لأنه إرلندي. ومعروف ردّه الثأري على صحافي فرنسي سأله ببراءة عمّا إذا كان إنكليزياً، فقال بالفرنسية: على العكس Au contraire. وسخريته السوداء وطرافته الهجائية ذات جذور ثقافية فضلاً عن كونها سمات شخصية. ولكنه لم يتمكن من العثور على موطئ قدم في دولة منطوية على ذاتها الغاليّة Gaelic، وتقشّف الحدّ الأدنى في عمله كان، بين أمور أخرى، نقداً للبلاغة القوموية المنتفخة. ثمة، مع ذلك، صفة إرلندية مميزة في تفريغ بيكيت للمنمّق والمزركش، تماماً كما الصفة الإرلندية المميزة في تلك المشهديات الراكدة الخاوية حيث ـ على حال ضحايا الاستعمار ـ لا يفعل المرء شيئاً سوى انتظار الحرّية.
وبذلك فإنه ليس مفاجئاً عند هذا المايسترو الأستاذ في فنّ المقتلَعين من أرضهم أن يجد نفسه سنة 1941 وهو يقاتل مع المقاومة الفرنسية. كان يعيش في باريس الخاضعة للاحتلال الألماني، فالتحق بخليّة كانت جزءاً من "العمليات الخاصة البريطانية"، وحوّل مهاراته الأدبية إلى طبع وترجمة المعلومات السرّية. وحين انكشف أمر الخلية، جرى ترحيل الكثير من رفاقه إلى معسكرات الاعتقال، ولم يفصل بيكيت وزوجته سوزان عن الاعتقال إلا 10 دقائق أو نحوها.
ولقد جدا ملاذاً في قرية صغيرة قرب باريس، فعمل بيكيت في الحقول، ثمّ التحق مجدداً بالمقاومة. مهمّته هذه المرّة انطوت أيضاً على نصب الشراك للألمان، وجمع التموين الذي كان السلاح الجويّ الملكي يلقيه بالمظلات. وفي باريس ما بعد الحرب، عاش هو وسوزان في برد وجوع مثل غالبية أهل المدينة، وكانت أصابعه تزرقّ من البرد وهو يواصل الإمساك بالقلم. ولقد نال، فيما بعد، وسام "صليب الحرب" تكريماً لنشاطاته السرّية ضدّ الاحتلال.
وعلى نقيض المألوف في صفوف الفنانين الحداثيين، كان هذا الرجل ـ الذي يُفترض أنه مَسّاح النزعة العدمية ـ مناضلاً يسارياً وليس يمينياً. إنه بطل الالتباس واللامحدَّد، ولكنّ فنّه القائم على التشظي والشرط المؤقت كان مناهضاً للشمولية أوّلاً وأساساً. تلك كتابة رجل أدرك أنّ الواقعية المتيقظة ذات الأعين البصيرة الباردة أفضل خدمة للتحرّر الإنساني من تلك اليوتوبيا ذات الأعين المرصعة بالنجوم.(1)
*****
"سام الرجل" مادّة لا تنتهي من الأسطورة، والتنقيب، والإشاعة، والتبجيل، والإبهام، والأقاصيص المضخّمة. وسوف لن يكون من غير المعقول القول إنه الآن معروف حتى على سطح القمر، المنطقة التي اعتبر ذات يوم أنها من مخصصات ألبير كامو. أناس عديدون التقوا بيكيت وتناولوا معه شراباً بالضرورة. صحيح أنه كان يشرب كثيراً، ومن المؤكد أكثر أنه احتاج إلى الشراب، سواء لكي يُحيي روحاً لم يكن عندها "إلا القليل فقط من موهبة السعادة"، أو لكي يخفف وابل أنخاب الأصحاب. أعماله كلّها ضاجّة بأشخاص لا يكفّون عن الكلام، وإثارة الأسئلة. وقد يبدو تهوّراً أن نأتي على ذكر الشراب في ما يخصّ رجلاً متطلباً مثله، غير أنّ الأعمدة الثلاثة للعبقرية الإرلندية، جويس وبيكيت وفلان أوبريان، عُرفوا كروّاد حانات، ممّن ثابروا على حسن الاستفادة من حلّهم وترحالهم.
وإرلندا، هذه "االتائهة خراباً بين الدرب والخندق"(1)، كانت على الدوام قالباً، مثلما كانت وسيطاً، في عمل بيكيت. وإنّ مناحاته، وتناغماته، وتوبيخاته، ولعناته... كلّها بدت لي إرلندية حقّة. وما اعتبرَ أنه ضارّ ببلده الأمّ كان التعصّب والقوّة الخانقة للكهنوت الكاثوليكي، وهؤلاء في المقابل اعتبروه "مجدّفاً". وفي تأبين قصير ومتألق للرسّام جاك ييتس، قال بيكيت إنّ الفنان الذي يضع حياته على المحكّ ليس له شقيق وليس له محتد. التصريحات ليست كلّ الحكاية، مع ذلك. ففي كتاب جمع موّاده أيون أوبريان على شرف الذكرى الثمانين لولادة بيكيت، نقرأ ونرى "الدروب الخلفية العزيزة"، والخنادق، وزهر الأقحوان، والقطيع، والخراف، والمشيمة كما تخيّلها في المشاوير الجبلية صحبة والده، ومطرقة الحجّار ذات الصوت الفضّي كما سمعها في البعيد. والمشهد الطبيعي البرّي، الفطري، الذي كتب عنه [جون مللنغتون] سينج، بجذل فريد، كان كذلك عالم بيكيت الذي أقرّ بدَيْن مدى الحياة لروح سنج الشفيفة. الدَين الآخر الأكثر التفافاً حول عنقه كان تجاه جويس، الرجل الذي أقسم بيكيت (عبثاً) أن يتجاوزه.
ولقد قيل الكثير في علاقته مع جويس وما إذا كان قد عمل سكرتيراً له، الأمر الذي يبدو غير ممكن، بالنظر إلى طبائعه في الخمول والصعلكة في باريس تلك الأيام، وكان عمره 22 سنة، حين قابل جويس للمرّة الأولى. وكان أحد المارشالات الـ 12 (أو الحواريين) الذين استدعاهم جويس، وساندهم ووجّه كلماتهم، لكي يردّوا البيّنة على هجمات ربيكا ويست، وندهام لويس، شون أوفولين، وسواهم ممّن تعرّضوا لـ "عمل قيد الإعداد" Work in Progress، الذي كان قد نُشر في مجلة Transition. والمقالات تلك، التي كانت متعالمة وقاصمة وقاتمة، كُتبت لإبراز تصميم جويس على إبقاء الأساتذة في حيرة من أمرهم، وإشغال النقّاد 300 سنة.
وكان جميل بيكيت قد طوّق جويس في أكثر من سبيل، وساعد في ترجمة "أنّا ليفيا" Anna Livia إلى الفرنسية، غير أنّ زوجة جويس، نورا بارناكل، تقول إنّه لو نزل الربّ نفسه من عليائه، فإنّ زوجها سيجد له عملاً ما. وحين طُعن بيكيت، جرّاء حادث مؤسف مع قوّاد، في الساعات الأولى من شهر كانون الثاني 1938، وبالكاد أخطأت السكين قلبه، كان جويس في زيارته على الفور. واللقاء وصفه نينو فرانك، الذي اصطحب جويس شبه الكفيف، بأنه جرى بين إرلنديَين اثنين يتباريان في الصمت المطبق. كان اسم القوّاد "مسيو برودان"، أي "الحَذِر"، والدعابة لاحقت المؤلّفَين معاً. وكتب جويس، الذي يكره كسر عولته، أنّ شقته باتت "اشبه بالبورصة الأمريكية" بسبب المتعاطفين المتصلين السائلين عن حال الرجل المطعون.
ولم يكن ثمة مهرب من تأثير جويس عليه، وعلى سواه. وذات يوم، حين قدّم عملاً مبكراً هو Sedendo et Quiescendo إلى شارلز برينتس، المحرّر المعجب به في دار النشر Chatto & Windus، أقرّ بيكيت أنّ العمل "تفوح منه رائحة جويس"، وأقسم أن يتجاوز تأثيره. ومن الصحيح أنّ معظم أعماله المبكرة تعكس خصائص جويس في اللغة المكشوفة والتدنيس والمواربة والمناظرة الفيثاغورية. وبعد سنوات، في مقابلة نشرتها "نيويورك تايمز"، قال بيكيت إنّ جويس كتب من موقع "كليّ العلم" و"كليّ القدرة"، أو على نحو ربّانيّ، في حين أنه [بيكيت] كتب من موقع الجهل والعجز. ولأنه يشتغل من ميدان "المجاهيل"، فقد زعم أنه "ليس لديه ما يعبّر عنه بواسطة أو من داخل أو نحو أيّ غرض، ما عدا الالتزام بأن يعبّر". ولكن كيف كان هذا النتاج الهائل من النفائس سيرى النور، لو لم يكن لديه ما يعبّر عنه. غير أنّ محاذاة اللاشيء، مثل محاذاة الجنون، هي التي تشكّل ديناميكية وزخم الفنّ العظيم. الشظايا. الحشوات. الدقائق. الرجال المتخففون من الأسطورة، أشباه الشخوص التوراتية، ممّن يندبون عبور الجلجلة بكثير من السخرية، ويزيحون أوجاعهم عن طريق سرد الحكايات الصغيرة لأنفسهم (ولنا أيضاً). ما كان ذكياً ومَتَاهياً جرت تنحيته جانباً، من أجل المضيّ أعمق، إلى مناطق الوجود الأكثر إرهاباً؛ وفي هذا بدا لي قريباً من كافكا، الكاتب الذي كان له عليه بعض التحفظات.
وفي ما يخصّ المرأة، كان بيكيت أكثر تطوّراً من جويس. لا أعياد الغطاس من أجلها، ولا ابتهالات أو أناشيد تسبيح من أجل عينها الشبيهة بالحجر الكريم. حيزبونات، شمطاوات، نفايات في براميل قمامة يتشاجرن كالقطط، طافحات بالشهوة الجنسية، منخرطات في ثرثرة لا تنتهي، كما السيدة روني في "كلّ ما يتداعى"، والسيدة ويني في "أيام هانئة": مكرورات، مصبوغات، لكنهنّ، مع ذلك آسرات في تمسكهنّ بالحياة عبر طرائق تهريجية وحكيمة غالباً. وحين تصرّح السيدة روني أنّ لزوم البيت انتحار، ولكنّ مغادرته فناء عاصف، فإنها لا شكّ تؤكّد مشاعر بيكيت نفسه.
لقد بحث [و. ب.] ييتس عن ربّة الإلهام التي لا سبيل إليها، وبحث جويس عن ربّة الجسد، وأمّا بيكيت فقد استقرّ على الربّة المضادة.
وفي سنّ الـ 22 وقع بيكيت في غرام بيغي سنكلير بنت خالته، وسط قلق أمّه الرقيبة عليه، فكتب قصيدة حافلة بالأشواق وتنقل أحلام الفتى في أن "يندمج بالسخونة البيضاء لجوهرها الحزين اللامتناهي". وحين باتت السخونة البيضاء أكثر بدانة، ثمّ طفح دفق رسائلها العاطفية المشبوبة، راودته أفكار أخرى فلجأ إلى ما هو أكثر وفاء للنسق الذي سيهيمن على حياته: فرّ بعيداً! وبيغي سنكلير هي، جزئياً، الطراز البدئي لشخصية سمير الدينا ريما في عمله المبكر "حلم بنساء منصفات معتدلات". وجسد بطلتنا هذه متنافر تماماً، وفوق الموشور الدلفيني يجثم حجر كريم صغير جميل شاحب للوجه الذي لم يسبق للبطل بيلاكوا (في إرجاع إلى واحد من خَطّائي دانتي غير التوّابين) أن وقعت عيناه اللاهبتان على مثيله. كان توهجها غير الدنيوي قد شجّعه على الرسوّ عند خثارات ثديها الساكنة، لكي يكتشف بعد معرفة وثيقة أنها حسنة المظهر بدءاً من الزنّار فالأعلى فحسب، وأنّ ذهنه ظلّ ناقداً بصرامة رغم أنّ روحه جاشت من مفاصلها. وكانت تلك واحدة أخرى من نسائه الثرثارات، تلحّ دائماً على أنها محقة وهو مخطئ، وهلمّ جرّاً إلى ما لا نهاية.
وفي "حبّ أوّل"، العمل الذي لم يسمح بنشره إلا بعد 30 سنة من تأليفه، يُظهر نفسه بأقصى العري والدعارة. السارد، المتشرّد، ليس لديه مكان يذهب إليه بعد أن طُرد من غرفته إثر وفاة والده. يجلس على دكة، وهناك تلاحقه لولو، التي يفلح معها في تدبّر صحبة غريبة مضحكة. وبعد وقت قصير تنقلب لولو إلى أنّا، المرأة الواحدة التي، إذا جاز القول، هي استمرار للأخرى ولكلّ تبديل في المرأة الأولى. وتنجح لولو ـ أنّا في جعله أليف البيت، رغم أنه رجل يفضّل النوم على القشّ. ورغم ضآلتها فإنّ متطلباته كانت طغيانية، وكان سلوكه متعجرفاً. يصرّ على غرفة تجعل المطبخ فاصلاً بينهما، ويطلب مبولة داخل الغرفة ثمّ يتنازل فيقبل قِدراً "ليس بالقدر الحقيقي"، ويعلن بعتوّ توقه إلى زهرة ياقوتية في أصيص. وتتدبر أنّا طريقها إلى غرفته عبر المطبخ، وحين يستيقظ فيجدها عارية، تأخذه الرعدة من إجهاداتها. حبّه لها يسير إلى محاق على الأقلّ، وهذا وحده المهمّ. وفي اليوم الذي تعلن فيه أنها حامل وترفع الرداء بفخار لتكشف امتلاء جسدها، فإنه يكون عندها قد انسلّ لتوّه عائداً إلى داخل ذهنه، مرتداً إلى الجبل، مصغياً إلى طيور الكروان والفضة النائية لمطارق الحجّار، في مكان ما. وهو لا يغادر على الفور، بالنظر إلى مزاجه الخامل. ولكن عند الصرخة الأولى للمرأة في المخاض، ثمّ الصرخة الأولى للوليد، ينهض من الفراش، يتناول معطفاً، ثمّ معطفاً أثقل وقبعة، ويربط حذاءه الطويل، ويمضي. ولكن، كما يقول لنا، لا تتوقف الصرختان كلاهما، لأنّ "الذكريات تقتل". هكذا كانت هجمات هواجسه، والقلب الذي خشي أنه يوشك على الانفجار "فيلقي في نفسه فزع الموت ليلاً".
وهنالك العديد من الكتّاب (جويس وهمنغواي بشكل أشدّ صخباً) يفزعون من التحليل النفسي ويشجبونه، مؤمنين أنّ التنقيب في اللاوعي سوف يطرد العبقرية. لم يكن بيكيت من هذا الرأي. ولقد قرّر أنّه جوهري لأسباب متنوعة، بينها عزلته، ونرجسيته القانطة، واستخفافه الصقيعيّ بالآخرين. ولقد خضع لتشخيص نفسي في مصحّ تافيستوم في لندن، طيلة سنتين، فانغمس فيه كليّاً وأقصى بعيداً كلّ ما عداه. قرأ فرويد ويونغ وأوتو رانك وأدلر، منخرطاً في عقائدهم المتنوعة، وحضر محاضرات ألقاها يونغ، وأحبّ معالجه النفسي الدكتور بيون إلى حدّ مخالطته اجتماعياً. واستخلص من هذا ما كان بحاجة إليه، وطرح ما كان مفتعلاً.
والدكتور بيون، الرجل الصموت الذي كانت طريقته تروق لبيكيت، لم يكن قد أماط اللثام عن سرّ "الجزّة الذهبية" حين قال إنّ الأمّ هي المفتاح إلى أزمات مريضه. كانت ماي بيكيت امرأة رائعة صلبة قوية الشكيمة، ذات مزاج ناري، وتأثيرها عليه كان مديداً. أحبّته، كما قال في رسالة إليها، "محبّة متوحشة" جابهها بالعصيان، فتذبذبت حياته بين الشفقة والسخط، وبين الحضور والانفلات. كانت تقرأ التوراة له ولأخيه فرانك، كلّ يوم، وأصرّت أن يحضرا معها صلاوات الآحاد في الكنيسة البروتستانتية المحلية، فكانت تجرّهما في محبس مربوط إلى حمار، وتغرس فيهما ضرورة الإيمان(...)
والكتابة، ليس على نقيض من حزن باسانيو (2)، تنبع من لامكان وهي غالباً غامضة على المؤلف أسوة القارىء. وبيكيت، مثل بطله كراب (3)، راوده وحي، سُمّي رؤيا في حالة كراب: رؤيا الرصيف البحري في دون لاوير (4)، والزيد يتعالى، والريح تصطفق، وكراب يقرّ بأنّ رباطه الأشدّ وثوقاً هو مع الظلام. ومن المألوف أن يتحدث بيكيت عن الظلمة، وما جعله يرتجف أمام لوحات كاسبار دافيد فردريش وجاك ييتس (5) كان الاستنارة المنبثقة من الظلمة والفراغ. رؤياه الخاصة، كما سردها على ريشارد إلمان، وقعت وهو في بيت أمّه صيف 1945. وما أبصره يظلّ خافياً، ما خلا قوله إنه وضع جانباً حماقته السابقة واستقرّ على كتابة الأشياء التي أحسّ بها. وكانت العاقبة فيضاً هائلاً من التأليف في أقلّ من ثلاث سنوات: الروايات القصيرة "موللوي"، "مالون يموت"، و"اللامسمّى"؛ بالإضافة إلى "في انتظار غودو"، وكلها بالفرنسية. وإنه لأمر جذري أن يبدأ المرء الكتابة بلغة أخرى، خصوصاً بالنسبة إلى مؤلف رفيع السيطرة على لغته الأمّ. الفرنسية أتاحت له، كما قال، تخفيف الأسلوب. ولعلها كذلك أتاحت التخفف من تأثير جويس، والامّ إرلندا، والنزاعات الناشبة عن الأتون العائلي. والأمّ تتكرر مرّة بعد أخرى في عمله، مذمومة، مؤنَّبة، مشَهّراً بها، مشوّهة الخَلْق، ولكنها مع ذلك مدعاة حداد وأسى. مقالة ج. د. أوهيرا في "دليل دراسات جويس" تساجل بأنّ موللوي لم يكن يبحث عن الأمّ الشخصية بل الأمّ في الداخل، بوصفها "تنويعاً على الأنيما" (6) الخاصة به. لكنّ الأمّ الروائية لها سلف في الأمّ الفعلية، كما خَبِر هذا جويس، واضطرّا في أعمالهما القصصية إلى الإقرار بأنّ قتلها غير ممكن.
موللوي يأتي إلى بيت أمّه ليلقي عليها الوداع، و"ليفرغ من الموت"، والذي نفترض أنه يعني الموت الفعلي في نهاية المطاف. ومع ذلك فإنه بعيد كلّ البعد عن الموت، فكيف وهو يذمّ ويشتم. الأمّ في البدء تُسمّى Mag حيث أضيف حرف الـ g لإلغاء التشديد في Ma والبصق عليه، كما يقول. وفي موقع آخر تُعطى التسمية الإشكالية "كونتيسة كاكا". موللوي يعثر عليها تهذر وتبربر فيتفاهم معها عن طريق النقر على الجمجمة لإيصال معنى نعم، ولا، ولا أعرف. لم يأت بغرض الحصول على النقود، لأنه أساساً يعرف أين أخفت النقود؛ بل يأتي، وهو الجرو الفتيّ، ليعرّضها إلى نوبة إضافية من التنكيل. وهو يؤمن أنّ أسوأ ما أنزلت به من مصائب كان إنجابها له، و"إفسادها الفترة الوحيدة المحتمَلة من تاريخه الوجيز". جاء بوصفه جرواً، وجنيناً، وشاعراً لاذعاً. لكنّ بيكيت هو بيكيت، والتقاطه الأمّ أو الأب أو منحدر الجبل ليس كامل الحكاية أبداً.
كانت نهاية الحرب فترة مجيدة مبدعة، لكنّ الظروف المادية كانت مريعة. كان ورفيقته سوزان ديشفو ـ دومنيل بحاجة ماسة إلى النقود، وعاشا بتقشف ولم يكن يعينهما إلا علاوة بسيطة من أسرته، لم تكن تتحوّل إلى فرنكات فرنسية كافية. ولقد انغمس تماماً في متاهة الكلمات تلك، صحبة الآلة الكاتبة، ومجلدات التوراة الأربعة، وحبيبه دانتي، ومجموعة موحدة من المعاجم. سوزان، من جانبها، عكفت على آلة الخياطة، ترقّع وتصلح ثيابهما، وتكسب بعض النقود من الخياطة ودروس البيانو، حيث كانت كبرياؤها تمنعها من طلب العون. كانت، حسب روايات عديدة، امرأة حادّة تشبه أمّه في بعض الجوانب، وكانت كذلك وفية بشراسة وتصميم.
وحين اكتملت الثلاثية كانت هي التي دارت بها على مختلف الناشرين، دون أن تحقق نجاحاً فورياً، في حين أنه ظلّ يقتل الوقت جالساً في المقهى. وجاء الخلاص على يد جيروم لاندون، وهو محرّر شاب في مطلع عشرينياته يعمل مع الناشر فيركور، والذي وصف حال الاستغراق التي عاشها وهو يقرأ "موللوي" في المترو، ولا يفلح في كتم ضحكاته.
عانى بيكيت من الندم بعد وفاتها، وأخبر كاتب سيرته جيمس نولسون أنه يدين بكلّ شيء إلى سوزان. لكنه كان رجلاً مركباً وزوجاً آبقاً؛ وكان يحبّ الشراب مع أصحابه الذكور، فتعترض هي على هذا، مثل اعتراضها على غرامياته، التي يقول نولسون إنها كانت تتمّ "بمنتهى السرّية". ليس الاحتشام هو السائد في مسرحيته القصيرة اللاذعة "مسرحية"، حيث المصيدة تطبق على امرأتين ورجل، وحيث ثمة جحيم للجميع، يدفع الجميع لتبادل المظالم، فيهتف الزوج في نبرة متقرحة: "أيها الزناة، حاذروا، ولا تعترفوا أبداً".
"نهاية اللعبة" هو عمله الأصعب. وها نحن من جديد أمام وليمة السيد/ العبد، حيث هام الضرير حبيس الكرسي، وكلوف غير القادر على الإخلاد إلى سكون، وعلاقتهما اللاهبة، واستحالة الانفكاك، والعذاب وعقم العذاب، كلّ هذا انضغط في 90 دقيقة صاعقة. ركود ظاهر وصلب، على نحو ما أسماه هيو كينر "دراما لا نستطيع إزاءها إلا إسقاط أكثر من مغزى رهيب". كُتب العمل سنة 1956، بالفرنسية، أثناء عزلته في أوسّي، في الكوخ الذي أسماه "طين المارن". ورغم أنّ "في انتظار غودو" شكلت نجاحاً ملحوظاً، فإنّ "نهاية اللعبة" قوبلت بالرفض من مدراء مسارح عديدة. ومن المبهج أنّ بيكيت كان يثور بعنف ضدّ كلّ مَن يحاول إعاقته أو رفض عمله. وهكذا جرى عرض أوّل للمسرحية في فرنسا، وتقديم في الـ"رويال كورت" في لندن، كان باهتاً حتى قال عنه إنه أشبه "بالتمثيل أمام خشب الماهوغاني". وكانت ترجمة العمل إلى الإنكليزية عبئاً وإثارة في آن، فقد آمن أنّ النصّ لم يكن قابلاً للسكب من وعاء إلى وعاء، وأنّ معظم حدّته وإيقاعاته فُقد. عداء النقّاد الإنكليز كان عنيفاً، إذ شاع الظنّ بأنّ المسرحية باعثة على اليأس، مَرَضية، مشاكسة، عصابية، وكومة كلمات بلا دراما، ومؤلفها مازوشي أسكرته عدميته الذاتية. وكان هارولد هوبسون هو صوت الإعجاب الوحيد. ومن جانبه رأى بيكيت أنّ العمل "امتلك قوّة الخَمْش بالمخلب". وبعد سنوات عديدة، في كتابه "الأقنوم الغربي"، اعتبر هارولد بلوم أنها "آخر المواقف ضدّ الأدب" في القرن العشرين(...)
وهنالك عملان أعود إلى قراءتهما مراراً، هما مسرحيته الإذاعية "جذوات" و"اللامسمّى". ففي "جذوات" يكون هنري، الذي انتحر والده عن طريق إغراق نفسه، مسكوناً بعدد من الأصوات: صوت الأمواج، وصوت الحوافر على دروب وعرة. إنه، كذلك، يصاب بالجنون فيحادث نفسه لكي يدفع الجنون، ويقوم شبح زوجته آدا بزيارته للثرثرة، فتُستعاد ذكريات ولدهما آدي، الذي لا يُطاق. كما يحكي لنفسه حكاية، على غير شائع ما يفعله العديد من شخصيات بيكيت. الحكاية تحكي عن رجلين، بولتون وهولواي. هوللواي، نزولاً عند رجاء بولتون، يسافر عبر عالم مكسوّ بالثلج إلى دار بولتون، ويسفر الأمر عن لقاء باهت، بين رجلين يعانيان من متاعب، يحملقان في جذوات الموقد الأسود.
وثمة الكثير الذي يُقال عن حال اليأس التي عاشها بيكيت، وروحه الديكارتية المسمّرة على صليبها الديكارتي. لكنه ليس كاتباً موهناً للعزائم، ليس على غرار هنري دو مونترلان أو توماس بيرنهارد، لأنّ أكثر كلماته قتامة تُقال، كما عند شكسبير، بالجمال والإدهاش؛ وحدّته الجيّاشة هي الشاهد الأفضل على الشكوى الإنسانية، واشمئزازه طافح بالانتعاش. لقد كان مهووساً تدبّر مهارات شديدة البراعة كي يحوّل ذلك الهوس إلى شعر خالد.
في "اللامسمّى" يستعيد الراوي حياته، مناسبات الفزع والعار، وهو يوشك على الغرق في الظلمة والصمت. لكن الصفحات الأخيرة سيل متدفق من الكلمات، والإعادة، وإعادة الإعادة، متشنجة لكنها جلية على نحو عجيب، تبلغ ذروتها في تلك الصرخة المسحورة المتطهرة من الغضب والتأكيد القائم على المفارقة: "لا تستطيع أن تذهب، لا أستطيع أن أذهب، أنا سأذهب".
الشهرة، كما قال ريلكه، هي خلاصة كلّ الأخطاء التي تتراكم حول اسمٍ ما. قبل إنّ جويس كان يستحمّ في نهر السين كلّ صباح، وكان يكتب عن الفراش أساساً؛ وأنّ بيكيت كان ممرِّضاً في مصحّ عقلي، كما تقول في امتداحه عبارة طُبعت على ثنية غلاف روايته المبكرة "مورفي". لكنه تحاشى الشهرة، ونادراً ما تحدّث عن عمله، حتى ذهب إلى القول إنه كان يفقد الرغبة في الكتابة إذا ما جفّ الحبر. لكنه لم يكن ناسكاً، حسب الأسطورة السائدة، بل كان حارّاً، ودوداً، شريفاً، كريماً، ذا جاذبية مغناطيسية عميقة ومنضبطة. لقد التقيت به مرّات عديدة في لندن وباريس(...) ولقاؤنا الأخير جرى في فندق بولمان في باريس سنة 1989، وهو مكان مزدحم بدا فيه، هو الطويل النحيل، مثل قامة منحوتة قادمة من حضارة سالفة، غير مكترث بما يحيط به. سألني إذا كنت أتفق معه أنّ الهواء في الحيّ الذي يقطنه عليل ونقيّ، فلم أستطع منازعته حقاً. وقادنا الحديث إلى الدنيا الآخرة،. قلت له إنني عثرت على موقع بديع للقبر في جزيرة منعزلة في منطقة شانون. وبعد صمت قصير، بدا واضحاً أنّ رفاته لن تُدفن في تلك الأرض الباردة المجللة. وأخبرني كيف أنّ دونالد ماكويني (7) اتصل به هاتفياً من فراش احتضاره، طامعاً في كلمة تحمل حكمة ما.
ـ "ماذا قلتَ له":
ـ القليل فقط"، كانت الإجابة العاثرة.
كان رجلاً تشعّ منه عذوبة فريدة، ولم يكن مدهشاً أن يلتفت إليه ماكويني في تلك اللحظة. كاتبا سيرته البارزان، أنتوني كرونين ونولسون، يشهدان على توقه للصداقة، ويتذكران كيف قطف بضعة بنفسجات من حديقة بيته في أوسّي ليرسلها إلى حبيبة سابقة، إثنا مكارتي، كانت تحتضر آنذاك، وكانت على الدوام مصدر إلهام لشعره: "غارقة في جزازات من القرمزي والبشروش".
"الكلمات كانت حبّي الوحيد، وليس عندي منها الكثير"، كتب ذات يوم. كانت في الواقع كثيرة، وكانت نيزكية. (8)