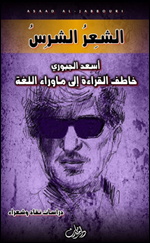 منذ بداياته ..حاول أن يكون شاعراُ آخر. خرج من جسد الشعر،ليكون في حواس اللغة العميقة،فصار بمرور الوقت عامل خرق يتدرب على تطهير النص من الغبار والفضلات ،ليثبت إنه قوة شعرية لا تستمد حيويتها من الظلال والمرجعيات،ربما لأنه أدرك مبكراً بأن الآخرين _ بما فيهم شعراء ما يسمى بالحداثة_ ليسوا أكثر من خزائن للتقاليد الشعرية النمطية وللتراث ولمفردات المدارس الأدبية التي عادة ما لا تنم إلا عن تلك الحبال الصوتية المتهرئة من التكرار ووظائف النقل والاستنساخ المتبادل ما بين مختلف الأجيال على الرغم من الفوارق الزمنية بينهم.لأن شعراء اليوم ممتلئين بشعرية القرون السحيقة ،فالجاهلية ما تزال قائمة في حداثة اللحظة المعاصرة بشكل قاطع.
منذ بداياته ..حاول أن يكون شاعراُ آخر. خرج من جسد الشعر،ليكون في حواس اللغة العميقة،فصار بمرور الوقت عامل خرق يتدرب على تطهير النص من الغبار والفضلات ،ليثبت إنه قوة شعرية لا تستمد حيويتها من الظلال والمرجعيات،ربما لأنه أدرك مبكراً بأن الآخرين _ بما فيهم شعراء ما يسمى بالحداثة_ ليسوا أكثر من خزائن للتقاليد الشعرية النمطية وللتراث ولمفردات المدارس الأدبية التي عادة ما لا تنم إلا عن تلك الحبال الصوتية المتهرئة من التكرار ووظائف النقل والاستنساخ المتبادل ما بين مختلف الأجيال على الرغم من الفوارق الزمنية بينهم.لأن شعراء اليوم ممتلئين بشعرية القرون السحيقة ،فالجاهلية ما تزال قائمة في حداثة اللحظة المعاصرة بشكل قاطع.
هذه الكلمات التي نقدم فيها أسعد الجبوري شاعر المخيلة الأول عربياً وعالمياً وفقاً لوقائع النصوص التي تؤكد صورها عدم تفوق أحد من شعراء الغرب أو الشرق لمنجز هذا الشاعر العظيم بترسانة خياله ككاسر لظهر اللغة وكمفجر لجينات الكلمات
،لا تعني القوي الذي عادة ما يضمه النقاد إلى نادي الرموز ،أو تكرسه الأحزاب أو الطوائف من ضمن سلسلة المشاهير.
قيل إن الشعر سحر.أو هو تأليف روحاني أحمرٌ بمرارته.أو قيل إنه بطولة شيطان عادة ما يكسرُ ظهر الواقع،تاركاً روحه في كامل غوايات نار ،عادة ما ترتقي سلالم العقل وتعبث بالذات ،رفضاً للعودة إلى المربع الأول في اللغة.
ما من تجربة في عالم الشعر،ولا تريد قول شيء عن جوهرها.أي أن هاجس كل شاعر هو في أن يكشف للقارئ كل أو بعض ما في جعبته من هموم وسحب وأسرار. عدا قلة،ممن يساهمون بتجهيل طرق أو طرائق الوصول إليهم،كي يبقى نقل نصوصهم إلى الآخرين عن طريق العدوى،بعد ما أصبحت مكونات الشعرية عندهم أشبه بالبكتريا القابلة للتحولات ،بحيث يصعب القبض عليها أو احتوائها في نهاية المطاف .
يقول الناقد د.عقيل مهدي يوسف:
((يطور العقل أفكاره المتعالية ، من خلال الوصول الى ماوراء الخبرة الممكنة ، فيطورها
الى حدّ لايعود فيه الحسّ الحدسي محققا للهدف ، إذ يقوم التخيل ، بتحرير نفسه من الترابط المنطقي للأفكار ، ليحوّل الخبرة الى شيء جديد، وذلك بخلق طبيعة أخرى ، يصنعها من المادة التي زودته به ، الطبيعة الحقيقية وهكذا تتخلق الأفكار الجمالية. فيقوم التخيل بمعاينة السلوك الذي يقوم به العقـل.
فالشاعر - مثلاً - يقوم بإدراك المفهومات العقلانية المجردة على جعلها مصطلحات حسيّة وهو يدرك مفهومات مثل الجنة والنار والأبدية .
إن حالات التمثيل الذي يقوم به التخيل بربط أفكار عظيمة أو بتركيزها ، مثل النسر والطاووس ، لكي يثير أفكاراً كبيرة للتعبير عن مفهوم تحدده الكلمات ، وهكذا تصبح أقوى مما يقوى المرء على فهمه خلافاً للطرق العادية العقيمة . الفن في فلسفة كانط يستقل عن الرغبة ، والأخلاق وعن المعرفة ، مثلما أظهر استقلال الفهم في نشاطه القبلي عن الحسّ ، واستقلال المبدأ الأخلاقي عن المنفعية. ويؤكد كانط على إن جمال الطبيعة علامة على الصحة الروحيـة )).
لم أسأل نفسي كيف يمكن التوغل في عالم شاعر يجننُ اللغةَ أو يضطهدها ببراعة فائقة.ولم أضع في خاطري فكرة القيام بمخطط نقدي لتعلم الطيران استعداداً للإقلاع مع نصوص شعرية خلقت منذ ولادتها وهي في فضاءات سحيقة بعيدة،لأن عدم إتقان مهنة الطيران قد يتسبب بتحطيم عظامي وبالتالي فقدان متعة المرافقة مع شعر صاروخي أمتهن الصعود دون التفات إلى هاوية أومحاكاة لعالم سفلي.
إنه أسعد الجبوري..شاعر الشعر الشرس الذي لا يترك للقارئ فراغاً في القراءة، دون أن يملؤه صوراً ما أنزل الدهر الشعري بها من شيطان ليتخيل ويتأول ويكشف سقف العقل،ويجعلنا رهائن شعرية عربية،لم تأتِ حتى في أبلغ ما جاء في كتبنا تراثاً ومعاصرة،لأن الصور التي تنزل من جبال أسعد الدماغية،مستحيلة التوقع ونادرة في بلاغتها .
قارئ اسعد.قارئ أبلسنة شعرية تبدأ بالتيه ثم المحو ثم التوثيق لكاتولوج من الحوادث البصرية لا الصور كما هو موروث، ولا تنتهي إلا بهما.فهو يقدم شعراً يجرف ما نام في الذاكرة من شعر كلاسيكي أو محدث قريب العهد بالحر أو بقصيدة النثر،وكذلك فهو يكتب شعراً ماحياً كل ما حاول أنسي الحاج وأدونيس وسركون بولص وشوقي أبي شقرا ووديع سعادة وصلاح فائق تأسيسه في كتب أو بيانات أو إعلام أو مقاهٍ ،غالباً ما اعتبرها النقاد شعراً حداثوياً وعلى قدر كبير من الأهمية والعمق.
فعلى الرغم من تكاثر الشعر ونمو الشعراء في العالم العربي ،إلا أن هذه الهبة الإلهية ما تزال في كينونتها الوجودية ومكوناتها اللغوية فرصة نادرة.فرصة لا تتعلق بالموهبة والمديات التي تأخذها التجارب الشعرية،بقدر ما إن الشعر جوهر عاق، هو بالضرورة لا يتشكل إلا من الزلازل في أبسط الحالات وأعقد التحولات..
الشعر في العالم العربي مخازن وتجارب ومواهب وقرابين وعجلات وأصوات ومقاعد ،لكننا من النادر الوصول إلى شاعر يزعج اللغة ويخلخل قواعد سلوكها في الاستعارة والرمز والمجاز وبقية الصفات التي عادة ما يعلقها النقاد في رقبة اللغة كأجراس إنذار تشير إلى مستويات الشعرية لدى هذا الشاعر أو ذاك،فتوجز الموهبة نجاحاً أو فشلاً عند نقطة ما.
وإذا كان الشعر في العالم العربي يعيش مستويات متفاوتة وطقوساً باردة ونزاعات خافتة أو غير موجودة بفعل غياب التنافس ما بين شعراء الأمة التي غاب أغلبهم عن الساحة بفعل الموت أو شعراء الصحافة ممن يهبون على ورق الجرائد كرياح رملية لا تجلب غير اللعنة والبعد اليبابي القاسي،نصل إلى شعرية عربية نادرة تتمثل بالشاعر أسعد الجبوري الذي يتجاوز الهوية العراقية والعربية ،ليشكل بعداً أكثر امتداداً من الحجرة الجغرافية وأبعد من السجل التاريخي الذي عادة ما تحشر ضمن أقواسه الأجيال التي تنتظم ضمن سياق الزمن.
الشاعر أسعد الجبوري المجهول نقدياً بحساب الصحافة الأدبية للقائمة على العلاقات الشخصية.. المُغيب عن ملفات الشعر ومهرجاناته وانطولوجياته،هو في حقيقة الأمر جوهرة الشعر المعاصر منذ الثمانينات ،أي بعد ظهور مجموعته الشعرية الثالثة ((أولمبياد اللغة المؤجلة)) الصادرة في مارس 1980 في دمشق.
فقد كانت تلك المجموعة انقلاباً داخل الشعر العربي، أو جرأة لا مثيل لها عند ذلك الجيل بكامله،بعدما حمل كتابه الشعري المذكور ،ما هو أبعد من التمرد ،وأشد من التجاوز ،لأنه خلخل اللغة بمفاتيحه الخاصة،ليقيم على سطوحها احتفالاته الواسعة،فكان كتابه بمثابة دعوة قدمها إلى اللغة من أجل أن تحرر نفسها من نفسها،وأن تكون كل مفردة من جملها ، كلمة مقاومة للصحراء ومضادة لمرجعيات الظلام الشعري المستبد بالسطر ،على الرغم من التباهي بأزياء حداثة، أصبحت هي ذاتها مرضاً فضفاضاً وهلامياً يلبس مختلف الشعراء .
من هنا ..تقدم دار ((مديات )) أسعد الجبوري الشاعر الشرس في بلاغته لقراء العربية،مثالاً وأنموذجاً للشعراء الذين تفيض بهم اللغات وتتجدد بعيداً عن الرمل والظلام ،وخلافاً لكل ما هو متوقع.
(الناشر)
منذ بداياته ..حاول أن يكون شاعراُ آخر. خرج من جسد الشعر،ليكون في حواس اللغة العميقة،فصار بمرور الوقت عامل خرق يتدرب على تطهير النص من الغبار والفضلات ،ليثبت إنه قوة شعرية لا تستمد حيويتها من الظلال والمرجعيات،ربما لأنه أدرك مبكراً بأن الآخرين _ بما فيهم شعراء ما يسمى بالحداثة_ ليسوا أكثر من خزائن للتقاليد الشعرية النمطية وللتراث ولمفردات المدارس الأدبية التي عادة ما لا تنم إلا عن تلك الحبال الصوتية المتهرئة من التكرار ووظائف النقل والاستنساخ المتبادل ما بين مختلف الأجيال على الرغم من الفوارق الزمنية بينهم.لأن شعراء اليوم ممتلئين بشعرية القرون السحيقة ،فالجاهلية ما تزال قائمة في حداثة اللحظة المعاصرة بشكل قاطع.
هذه الكلمات التي نقدم فيها أسعد الجبوري شاعر المخيلة الأول عربياً وعالمياً وفقاً لوقائع النصوص التي تؤكد صورها عدم تفوق أحد من شعراء الغرب أو الشرق لمنجز هذا الشاعر العظيم بترسانة خياله ككاسر لظهر اللغة وكمفجر لجينات الكلمات
،لا تعني القوي الذي عادة ما يضمه النقاد إلى نادي الرموز ،أو تكرسه الأحزاب أو الطوائف من ضمن سلسلة المشاهير.
قيل إن الشعر سحر.أو هو تأليف روحاني أحمرٌ بمرارته.أو قيل إنه بطولة شيطان عادة ما يكسرُ ظهر الواقع،تاركاً روحه في كامل غوايات نار ،عادة ما ترتقي سلالم العقل وتعبث بالذات ،رفضاً للعودة إلى المربع الأول في اللغة.
ما من تجربة في عالم الشعر،ولا تريد قول شيء عن جوهرها.أي أن هاجس كل شاعر هو في أن يكشف للقارئ كل أو بعض ما في جعبته من هموم وسحب وأسرار. عدا قلة،ممن يساهمون بتجهيل طرق أو طرائق الوصول إليهم،كي يبقى نقل نصوصهم إلى الآخرين عن طريق العدوى،بعد ما أصبحت مكونات الشعرية عندهم أشبه بالبكتريا القابلة للتحولات ،بحيث يصعب القبض عليها أو احتوائها في نهاية المطاف .
يقول الناقد د.عقيل مهدي يوسف:
((يطور العقل أفكاره المتعالية ، من خلال الوصول الى ماوراء الخبرة الممكنة ، فيطورها
الى حدّ لايعود فيه الحسّ الحدسي محققا للهدف ، إذ يقوم التخيل ، بتحرير نفسه من الترابط المنطقي للأفكار ، ليحوّل الخبرة الى شيء جديد، وذلك بخلق طبيعة أخرى ، يصنعها من المادة التي زودته به ، الطبيعة الحقيقية وهكذا تتخلق الأفكار الجمالية. فيقوم التخيل بمعاينة السلوك الذي يقوم به العقـل.
فالشاعر - مثلاً - يقوم بإدراك المفهومات العقلانية المجردة على جعلها مصطلحات حسيّة وهو يدرك مفهومات مثل الجنة والنار والأبدية .
إن حالات التمثيل الذي يقوم به التخيل بربط أفكار عظيمة أو بتركيزها ، مثل النسر والطاووس ، لكي يثير أفكاراً كبيرة للتعبير عن مفهوم تحدده الكلمات ، وهكذا تصبح أقوى مما يقوى المرء على فهمه خلافاً للطرق العادية العقيمة . الفن في فلسفة كانط يستقل عن الرغبة ، والأخلاق وعن المعرفة ، مثلما أظهر استقلال الفهم في نشاطه القبلي عن الحسّ ، واستقلال المبدأ الأخلاقي عن المنفعية. ويؤكد كانط على إن جمال الطبيعة علامة على الصحة الروحيـة )).
لم أسأل نفسي كيف يمكن التوغل في عالم شاعر يجننُ اللغةَ أو يضطهدها ببراعة فائقة.ولم أضع في خاطري فكرة القيام بمخطط نقدي لتعلم الطيران استعداداً للإقلاع مع نصوص شعرية خلقت منذ ولادتها وهي في فضاءات سحيقة بعيدة،لأن عدم إتقان مهنة الطيران قد يتسبب بتحطيم عظامي وبالتالي فقدان متعة المرافقة مع شعر صاروخي أمتهن الصعود دون التفات إلى هاوية أومحاكاة لعالم سفلي.
إنه أسعد الجبوري..شاعر الشعر الشرس الذي لا يترك للقارئ فراغاً في القراءة، دون أن يملؤه صوراً ما أنزل الدهر الشعري بها من شيطان ليتخيل ويتأول ويكشف سقف العقل،ويجعلنا رهائن شعرية عربية،لم تأتِ حتى في أبلغ ما جاء في كتبنا تراثاً ومعاصرة،لأن الصور التي تنزل من جبال أسعد الدماغية،مستحيلة التوقع ونادرة في بلاغتها .
قارئ اسعد.قارئ أبلسنة شعرية تبدأ بالتيه ثم المحو ثم التوثيق لكاتولوج من الحوادث البصرية لا الصور كما هو موروث، ولا تنتهي إلا بهما.فهو يقدم شعراً يجرف ما نام في الذاكرة من شعر كلاسيكي أو محدث قريب العهد بالحر أو بقصيدة النثر،وكذلك فهو يكتب شعراً ماحياً كل ما حاول أنسي الحاج وأدونيس وسركون بولص وشوقي أبي شقرا ووديع سعادة وصلاح فائق تأسيسه في كتب أو بيانات أو إعلام أو مقاهٍ ،غالباً ما اعتبرها النقاد شعراً حداثوياً وعلى قدر كبير من الأهمية والعمق.
فعلى الرغم من تكاثر الشعر ونمو الشعراء في العالم العربي ،إلا أن هذه الهبة الإلهية ما تزال في كينونتها الوجودية ومكوناتها اللغوية فرصة نادرة.فرصة لا تتعلق بالموهبة والمديات التي تأخذها التجارب الشعرية،بقدر ما إن الشعر جوهر عاق، هو بالضرورة لا يتشكل إلا من الزلازل في أبسط الحالات وأعقد التحولات..
الشعر في العالم العربي مخازن وتجارب ومواهب وقرابين وعجلات وأصوات ومقاعد ،لكننا من النادر الوصول إلى شاعر يزعج اللغة ويخلخل قواعد سلوكها في الاستعارة والرمز والمجاز وبقية الصفات التي عادة ما يعلقها النقاد في رقبة اللغة كأجراس إنذار تشير إلى مستويات الشعرية لدى هذا الشاعر أو ذاك،فتوجز الموهبة نجاحاً أو فشلاً عند نقطة ما.
وإذا كان الشعر في العالم العربي يعيش مستويات متفاوتة وطقوساً باردة ونزاعات خافتة أو غير موجودة بفعل غياب التنافس ما بين شعراء الأمة التي غاب أغلبهم عن الساحة بفعل الموت أو شعراء الصحافة ممن يهبون على ورق الجرائد كرياح رملية لا تجلب غير اللعنة والبعد اليبابي القاسي،نصل إلى شعرية عربية نادرة تتمثل بالشاعر أسعد الجبوري الذي يتجاوز الهوية العراقية والعربية ،ليشكل بعداً أكثر امتداداً من الحجرة الجغرافية وأبعد من السجل التاريخي الذي عادة ما تحشر ضمن أقواسه الأجيال التي تنتظم ضمن سياق الزمن.
الشاعر أسعد الجبوري المجهول نقدياً بحساب الصحافة الأدبية للقائمة على العلاقات الشخصية.. المُغيب عن ملفات الشعر ومهرجاناته وانطولوجياته،هو في حقيقة الأمر جوهرة الشعر المعاصر منذ الثمانينات ،أي بعد ظهور مجموعته الشعرية الثالثة ((أولمبياد اللغة المؤجلة)) الصادرة في مارس 1980 في دمشق.
فقد كانت تلك المجموعة انقلاباً داخل الشعر العربي، أو جرأة لا مثيل لها عند ذلك الجيل بكامله،بعدما حمل كتابه الشعري المذكور ،ما هو أبعد من التمرد ،وأشد من التجاوز ،لأنه خلخل اللغة بمفاتيحه الخاصة،ليقيم على سطوحها احتفالاته الواسعة،فكان كتابه بمثابة دعوة قدمها إلى اللغة من أجل أن تحرر نفسها من نفسها،وأن تكون كل مفردة من جملها ، كلمة مقاومة للصحراء ومضادة لمرجعيات الظلام الشعري المستبد بالسطر ،على الرغم من التباهي بأزياء حداثة، أصبحت هي ذاتها مرضاً فضفاضاً وهلامياً يلبس مختلف الشعراء .
من هنا ..تقدم دار ((مديات )) أسعد الجبوري الشاعر الشرس في بلاغته لقراء العربية،مثالاً وأنموذجاً للشعراء الذين تفيض بهم اللغات وتتجدد بعيداً عن الرمل والظلام ،وخلافاً لكل ما هو متوقع.
((الناشر))
في منزله الدمشقيّ ، بين الفقراء ، في مساكن برْزة ، كان أسعد الجبوريّ يُقيمُ مائدتَه :
أشتاتاً
وأضغاثاً
وتهاويلَ بين الحـُلم و الكابوس .
أحياناً تتهاوى المائدةُ لتتطاير في الهواء الدمشقيّ الكثيف.
وعلى فادية الخشن أن تتدبّر الأمور.
*
ثمّتَ واقعية في شعر أسعد الجبوريّ ؛ لكنها الواقعُ ، ملتبساً ، غيرَ مقروء ، نائياً ، ومُلِحّاً في آن .
أهي الواقعية المرتجاة ؟
ربما ...
في قصيدته ، الأثيرة لديّ ، " نيويورك ، نيويورك " ...
ليس من نيويورك.
النصّ ، على مداه ، استغراقٌ سورياليّ ، اشتغالٌ على أمرٍ أعمّ ،
أمرٍ هو الوهمُ ...
وقد يكون أهمّ من نيويورك.
أنا أقمتُ في نيويورك فترةً ليست بالقصيرة . أقمتُ هناك متخفّياً ، لأعرف المدينة : التفّاحة الكبيرة كما تدْعى.
كتبتُ : قصائد نيويورك .
لكنّ مأثرة أسعد الجبوري أهمّ :
لقد صعّدَ وهماً.
منحَ الوهمَ لحماً وعظماً .
وقال: هكذا نيويورك . هكذا العالَم !
*
أعتقدُ أن العراق السورياليّ حظيَ بشاعرٍ سورياليّ .
لندن 26.04.2012
كيف يمكننا التعامل مع هذا المقطع الأول من قصيدة الشاعر أسعد الجبوري:
" الرأسُ بطاريةٌ
والشاعرُ ممتليء بالحليب والتراب والطائرات
يصعد نفسه مزمجراً بمرافقة الخوف
كما الساسكفون
وخلفه النبال والإشعاعات والنساءُ بفرائهنّ
المنزوع من شدة الاحتكاك"
مثل هذا المقطع هناك المئات مما هو أقسى خيالاً وعنفاً صوريّاٍ لا يلين.
ولا شك أن أفضل طريقةٍ هو أن لا نقيس هذا الشعر بغيره فنحنُ أمام عالم خاص لا يجرؤ أحدٌ سوى أسعد الجبوري على كتابته.
هذا الشعرُ الشرس من أجل أن يستفيق الكائن الرصين المهذّب ليفتح، بعدها، نافذته ويجد الكارثة قريبة منه وكان عليه أن لايطمئن إلى رصانته وكياسته هذه فالحياة أقرب إلى الطبيعة الكاؤسية (العماء والفوضى ) منها الى الطبيعة الكوسموسية (الكون والنظام ) .
تندفعُ الصور والأفكار في غريب الكلمات والجمل الحديثة التي سرعان ما يدجّنها الشاعر ويمضي مؤسساً عالمه، صورٌ حادة المزاج ومدببةُ النهايات ولا تخلو من القسوة والألم.
هل الشاعر يبكي؟
هل هو ينبّه؟
هل يحرِّضُ على مشاهدة كارثة الإنسان بقسوتها البالغة وتراجيديتها المخزية؟
نعم.. هو كذلك يفعل ما لا نريد أن نفهمه نحن .
ولذلك لا نرى أسعد برفقة العادات الشعرية المستهلكة وغير مهادن للقاموس المنتقى للشعر ولا يتصالح مع تيارات الشعر الحديثة في رتابة مشيها الوئيد.
كذلك جرأته التي تظهر في استخدامه الشعرَ معبراً عن رؤاه الفكرية والروحية.. وهي أيضاً حادة مثل صوره الشعرية فهو (يرسم بطبشور من أحمر الشفاه، ومن ثم يتأرجح على خط الإستواء بيضةً اكتملت دورتها في قصيدةٍ. أجسادٌ وراء أجساد) لا يتوانى عن التقاط ما يجده من أحجار ليرجم بها الكليشهات الثابتة وليخلخل ما استقر فهو يرى أن (الأرواح بطارياتٌ مشغولةٌ بنبيذ الجوف والبطارخ المضادة لكنوز أفلاطون . كأننا مع بعض لوتس دراماتيكي، ندخل التيه الحداثوي وعلى أكتافنا أثقال المجهول المفترس عند باب كلّ مغيب).
تسبحُ في شعره المفردات والمصطلحات العلمية من كلّ الحقول دون أن تلتفت لاحتجاجنا ويدربّها أسعد على أن تكون أسماكاً ماهرةً للغوص في مياه الشعر، هذا إنجازٌ لوحده حين يرى أن الأرواح هي (بواخر هائمة بالشغف وبالحرير وباللحم المدخّن بالبخار الكهرومغناطيسي لرفع كفاءة الطوفان).
لا يتوانى عن وصف أحداثٍ علمية بلغةٍ شعرية شرسةٍ هي الأخرى ضارباً عرض الحائط تلك الرصانة المفتعلة في التوصيل الشعري ليفتح لنا توصيلاً شعرياً آخر يليقُ بتحديه، فهو حين يتحدث، في قصيدة، عن غزو الفضاء يقول (تسحبُ –ناسا- رأسها من الغيوم لتضعَ في بريد الفضاء بيضةً تسمى ديسكفوري ، الآلات تشق طريقها بتقنيات عاليةٍ والملائكة في ارتباك عظيم. لا نعرفُ ما الذي يمكن فعله. حتى أن مفاتيح السماوات تكاد تذوب بين أصابعهم المبلّلة بالنار. يحدث ذلك سريعاً لتواصل الحيوانات المعدنية صعودها على سلالم من ألياف الكربون فيما يتخلصُ الخيال من الهواء الجيولوجيّ القديم).
ما يخافُ منه شعراء الحداثة يلجُهُ أسعد الجبوري بقوةٍ وتحدٍ فهو لا يرى أن هناك مفردات شعرية وأخرى غير شعرية ولذلك يستعمل كلّ هذه المفردات دون أدنى انحياز لبعضها ليجعلنا أمام مشاهد متتابعةٍ حيّةٍ، وكلما توغلنا في شعره أدركنا أنه لا يفتعل انتخاب المفردات العلمية والحديثة على القاموس العربي ليصدمنا أو ليلفت انتباهنا بل هو يسترسلُ في ذلك دائماً وأبداً حتى أصبحت هذه من بديهيات شعره، وبذلك يكون قد كسرَ تابو المعجم الشعري الحديث وأغناه بمفردات وصور كثيرة لا عهد لنا بها.
جملهُ تتراسلُ مع الأضداد في وقت واحد (الشياطين والملائكة، الأعلى والأسفل، اليمين واليسار، السماء والأرض...إلخ) ويجبرنا على استلام هذه الجمل في منطقة تتناسب مع راداراته التي تبثُّ في كل الاتجاهات ما لا يمكن تصنيفه أو وضعه في وصفٍ ثابت.
يشكِّل الجنسُ جوهر شعره الشرس فهو يكمن هناك قصيّاً خلف كلّ صورةٍ أو استعارة أو جملة محتدمةٍ، وبذلك يتحول الجنس من فعل جسدي إلى فعل لغويّ، ويأخذ مسالكاً وعرةً جداً في تجربة أسعد فهو يكمن خفيّاً موارباً في كلّ انتباهاته الخاصة لكنه، أحياناً، ينكشف بعريه على مصراعيه، وكأن شعره باطنٌ جنسيّ لغوي في أغلبه وظاهر جنسيّ جسديّ في بعضه. ومن هنا يمكننا، أيضاً، تفسير الحدة والقسوة في شعره انطلاقاً من فهمه الخاص للعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة.
عندما نحاولُ إرجاع أسعد الجبوري إلى أي مرجع شعريٍّ عربيٍّ معاصر فإننا نفشل تماماً، فهو كيان قائمٌ بذاته يفترس ما يريد من شهوات الحداثة دون قوانين أو ضوابط موصوفة سلفاً.
نلمحُ في شعره سوريالية سرعان ما تحيلنا إلى خارجها وإلى نوعٍ من التجريد الحسيّ الذي ينفرد بصناعته، وأحياناً يتلاقى مع الشعر الإيماجي الأميركي المهووس بالصورة.
في تعريفاته الشعرية، وهي قصائد أسماها (غبار الساعات) يعمل على إعادة تعريفات الأشياء والظواهر بطريقة شعرية، نلمحُ اختزالاً مدهشاً ولسعاً حاداً وغرابةً آسرة.. فهي تمنحنا نوافذ تكسر المألوف وتوسّع العالم وتشحن اللغة بطاقة جديدة. وهي تجربةٌ تستحقُ الوقوف والتأمل، ففيها لونٌ جديدٌ من ألوان الشعر يعبر على النوع المألوف ويتجاوزه .
ومثل هذه تجربة الرسائل الشعرية القصيرة (sms) في (قاموس العاشقين) والتي تأخذ منحىً آخر.
وإذا ما أضفنا لكل هذا وذاك رواياته الخاصة والنادرة المضامين فسنكون أمام مبدعٍ حقيقي استطاع أن يؤسس بيته الإبداعي بصدق رؤيته هو ومشاعره هو بعيداً عن ما ظل يسود الأدب العربي من اتجاهات، وربما يصحب هذا أن أسعد الجبوري صعبٌ على التجييل (في الأدب العراقي مثلاً) فرغم ظهوره الإبداعي في حقبة السبعينات إلاّ أنه خارجٌ على الأنماط السبعينية الشعرية والروائية فنياً، فهو نسيجٌ قائم بذاته يستجيب بإخلاصٍ لنشاطه الروحي واللغوي ويجد في مخيلته المرجع الأول له.. أما عكازات الآخرين فمرميةٌ على طريقه هنا وهناك لا يبالي بها.
أزمة الدلالة في نص "موقف الطابع العاري"
من مجموعة "الملاك الشهواني"
غرابة المفردة الشعرية عند أسعد الجبوري حتى لتنكر ذاتها، أو تنتحر
سامح كعوش
(شاعر وناقد أدبي فلسطيني)
من بين الأصوات الشعرية العربية التي يصح وصفها بالجديدة لسنوات أدبية ضوئية. يجلس في هامشه الحر ويكتب منتظراً قارئاً واحداً يأتي متأخراً، لكنه موجود ويأتي. هذه طبيعة الشاعر عندما يكون صديق مخيلته بالدرجة الأولى. أحببتُ هذا الصوت الجامح لرغبته الصريحة في عدم الإيمان بأشكال غيره كدروس ناجحة. ليس سهلا قراءة أسعد الجبوري بدون التمسك بشهوة الاكتشاف خارج الغابة. وهذا هو شرط القارئ في نص الجبوري. أن يكون القارئ شاعراً، أو بالضبط صادرا عن المخيلة فقط، وأن لا يسعى للمعنى مطروحا على قارعة الطريق. هذه طبيعة تستدعيها قراءة اللذة الخالصة، فيما المعاني والمعارف والفلسفات تأتي لاحقا وعفو الخاطر وبمعزل عن شعارات القول.
لا أحب حبس كتابة اسعد الجبوري في تجربة "السريالية"، ففي هذا التوصيف شيء من كسل الدلالة وامتهان الخصوصية. سأحب أن تقرأ التجارب الجديدة بقوانينها الجديدة، دون اللجوء إلى رَكْمِها على رصيف جاهزياتٍ تمسخ الذات في موضوعيات تائهة. فمثلما تجتهد موهبة المبدع يتوجب أن تقوى موهبة القارئ على ذلك.
لن ادعي وأنا اكتب عن تجربة الشاعر اسعد الجبوري بأنني سأكتب عن ذلك كناقدة ،بل كقارئة متذوقة للشعر أولاً ،وكشاعرة ومترجمة عشت في غمرة الشعر الإنكليزي والعربي منذ الصغر ،بحكم نشأتي بانكلترة واحتكاكي المباشر والمبكر بالأدب الانكليزي والعربي.
وحينما قرأت ولأول مرة نصوص الشاعر اسعد الجبوري ، شعرت بأنني أمام شاعر يغامر بالمفردات ويتعامل معها بعيداً عن المألوف المتكرر والاستهلاك الشعري الذي يغص به المشهد الشعري العربي بصورة عامة والعراقي بشكل خاص هذه الأيام.
أن نصوص اسعد الجبوري مغرية ومراوغة، تجر القارئ بذكاء، وتجعل منه شريكاً في المتعة والكشف في طبقات النص المتعددة والتي تتميز بالتركيز والتكثيف، حيث يتجلى ذلك في بعضها أكثر من البعض الآخر . والمتفحص لنصوص الجبوري يجد بأن العديد منها، يجمع بين الفلسفة الشعرية والشعر الفلسفي من دون أي إهمال للجانب الجمالي الإنساني والعاطفي، فتبدو نصوص الجبوري وكأنها هي المعنية بقول الشاعر صامويل تايلر كولريدج: " لا يمكن أن يكون الشاعر شاعرا عظيما إلا حينما يكون فيلسوفاً في نفس الوقت لأن الشعر هو عطر وبراعم المعرفة الإنسانية والفكرية والعاطفية واللغوية"
إن نصوص الشاعر تحتاج إلى قراءة متأنية والى قارئ ملم بالأبعاد الثقافية العربية والأجنبية إضافة الى الإلمام الميثولجي المتنوع والموروث الديني، كما تحتاج الى قاريء جريء، لا يتردد في الولوج في التجارب الجديدة، وفتح أبواب النصوص ، وتفكيك مغزاها بذهنية متفتحة لسبر أغوارها وكياناتها الثرة المتجددة، ولغتها الغنية الموصلة للفكرة المبتغاة ، هذا على الرغم من أن البعض من نصوصه تغلب عليها التعابير السريالية وتحيلها أحيانا الى أحجية تشغل المتلقي بمهمة تفكيكها بدلا من الاسترخاء التلقائي في غمار المتعة الشعرية المتمناة.
تمثل نصوص الجبوري محاولات جادة وناجحة لكسر الجمود الشعري، وتقديم نصوص تقوم على اختراق المألوف بنسجه للنص نسيجا أسطوريا يجمع ما بين الواقع والهلوسات العميقة في المعنى والتلغيز والأسلوب، جاعلا من القارئ شريك فاعل في الكشف المعرفي والجمالي ،كما يجعل منه المعادل الأخر للشاعر حيث يتحول المتلقي الى متأمل وباحث ومتذوق ومشارك حتمي في الاستنتاجات التي يتركها تفاعله الشحصي والثقافي والفكري مع النص ، علماً بأن كل ذلك يتوقف على استيعاب المتلقي الشخصي للنصوص وإمكانيته في تفكيك بنيتها اللغوية :
أيها الشر وحدكَ تسدُ رمق العارف هنا..
ولا بأس للرواد بكأس من روم المريخ
مع بطل اليوغا المندمج تأملاً
في حركات السعي لطرد الشياطين
من مدارس النار أو فراديس الإيروس.
ولا بأس أيضاً بكأس عرقٍ مع فستق من حلب
لشاعرٍ ملتهبٍ بمداعبةِ المكوكِ العائم بخيالهِ.
الأحلام المضغوطة بأكياسٍ تنفلتُ.
ويمكن الإصغاء إلى تسرب الصور من خزان
وقود الهيدروجين إلى الرأس.
ولأكثر من امرأة غائمة الجمال،
يمكن للنص أن يقف على منصة الإطلاق
"بين ثياب الأساطير, اسعد الجبوري "
وأخيراً يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو من أين يستمد اسعد الجبوري دفقه الشعري المتميز يا ترى؟
هل يستمده من ردفه أو شيطانه كما كان يعتقد العرب والإغريق القدماء بأن الشعر هو الهام من قوى غير منظورة وبأن لكل شاعر ردفه أو شيطانه*
ومهما يكن المصدر الذي يستقي منه اسعد الجبوري فلا بد من الثناء عليه وعلى ذلك الردف أو الشيطان الذي أجاد مهمته حقا..
كتاب الشعراء نقاداً للناقد الدكتور عبد الجبار المطلبي*
أشعر بتسرب القصيدة كالزئبق، فالكلمات ترتطم ببعضها ناثرة رذاذا سحريا يشعل الشغف في الروح الظمأى لكتابة مغايرة. كاتب من نوع أخر وشاعر جن بالقصيدة وهامت به، فلمس رقة خدها ومزق ورودها تارة، وقبلها بحرارة تارة أخرى بينما يقشر عنها مفرداتها الكلمة تلو الكلمة، صعب جدا الكتاب عن المبدع أسعد الجبوري، لأن مغناطيس كلماته يجذبنا نحوه ثم يدفعنا بعيدا، فلا نحن فهمنا ولا نحن قرأنا انما عشنا ومتنا وسمعنا وصراخا وهمسا ونشيجا ماطرا، ثم فاجأنا ضوء ساطع وفقدنا القدرة على التنفس ثم وجدنا أنفسنا تحت الماء غرقى وسعيدين.. فرحين بمراراة، هكذا تتركني قصيدة الشاعر، والحقيقة إنها لم تتركني أبدا، بل سكنت جيوبي وتنفست رئتي وأكلت معي خبزي وشربت كل قهوتي.
يكتب الشاعر أسعد الجبوري وكأنه يموت بعد الكتابة، وكأن الكلمات كفنه، والحروف الياسمين الذي يسقفه، يكتب حتى يخرج من السكون للديمومة. يبدو البحث عن القصيدة المميزة الأصيلة عبثا مع هجوم النت بمواقعه المختلفة ونزول الجميع للمشاركة بسباق الكتابة، فمجانية الشعر جعلنه مشاعا للسذج والهامشيين مشرعا دون كرامة أو ملامح، فالسرقات منتشرة والنهب الإبداعي متاح،
فما بالك إيجاد تلك الملامح الخاصة بالقصيدة التي تعصف بها رياح التغريب فتزيدها متانة، وتتشكل بتربة التجريب والتجريد فتصبح أكثر نضجا ومغناطيسية في جذب انتباه القارئ وسحبه لعوالمها السحرية، هكذا هي قصائد الشاعر أسعد وهكذا هي لغته
حين تصبح الأوهام الكبيرة أرضا لمسيرة الذات، تتعامد أجنحة الروح مع خطوات الأنفاس المحترقة، لتظلل المساحات الداخلية بأفياء أجوبةٍ ملتبسة وظلال طمأنينة عابرة، تعتلي متن السكرات الخرافية مبشرة بميلاد نبي مهشم، يوطد حواريه هدنة البرزخ الرمادية.. هذا النبي المهشم يكسيه الشاعر العراقي "أسعد الجبوري" بترانيمه الجامحة وعنفوانه المتعدد، ويمنحه اسم فيلمون، ليحرث من خلاله تاريخ الطوارئ، في رواية تحمل اسم"اغتيال نوبل".
في الرواية /القصيدة يخلق "الجبوري"عالما مسرحيا متكاملا، يحتضن دوامات فيلمون الفكرية، ويوجهها صوب عتبات العقول المخدرة، لأخذها في رحلة نحو تخوم الأسئلة المصيرية للإنسان، المكبل بقيود الحضارتين الشرقية والغربية. أي أن فيلمون، سيهز عرش المتوقع المألوف، المتجذر في جمودية الفلسفات الميتة، متحديا تاريخ الطوارئ، مسطرا بتمرده وصولاته الجنسية كتابات المساحات المُنتظِرة، مكسبا الرواية طابعا سرياليا بنكهة الكوميديا السوداء.
كي يحقق "الجبوري" غاية الحوار الوجودي، يضاعف طبقات الأبطال، حواريه المخلصين، ابتداء بالعشيقة المهجورة جوانكا، التي يحملها مهمة حراسة مستودع الإرث الواقعي، ويوسع المواجهة نحو الثورة، لاستثمار المجهول وتقويض الواقع تمهيدا لنسفه. ثم يعرف أبعاد شخصية البروفيسور فيلمون، الذي انساق وراء العمل على طبيعة الأجساد وغرائزها، كمادة تصلح لمعالجة تحولات الحياة، وعرف كيف يكون نارا تصطلي بها الفراشات. ربما لأنه متورط بأفكار محيرة، مقلقلة، تتجاوز كليا أنقاض الثقافة القديمة، والشروط الاستهلاكية التي تتحكم بمصائر
البشر ووجودهم على الأرض. مما يسمه عاشقا مثاليا تتلألأ روحه من وراء جداره الإنساني.
وكتحريك للواقع الإنساني الذي يراه "الجبوري" مستنقعا لا تنبت في قاعه إلا السيوف، يستحضر روح العالم المادي، ومدخنة العصر الغباري، ممثلا في شخص الصحفي الأميركي واشنطن. ويحاول عبر المواجهة بين الاثنين تحدي الاستهلاك الإنساني في طواحين الموت، وبث الحماسة في أطوار الإبداعات والخطط للخروج من جهنميات العادي الجاهز المألوف القاتل. ولعل إحداها خطط واشنطن حول جينات عملاقة مسلحة تطير فوق جميع القارات، لتفرض تراث سلالة "البوكس". ويتضمن التطبيق في هذه الحالة تحويل عشيقة فيلمون الصغيرة لورا، إلى حاضن لجينات واشنطن. وتدشين المفاوضات على سطح الماء في بار عائم، قبل رواده بدورهم المهشم في التاريخ، بعدما هجروا اليابسة ووقائعها المتفجرة المؤلمة، مفضلين الإقامة داخل ذلك المكان المفتوح دائما على زمن الأعاصير...
الشد والجذب في لعبة الحوار، يضاعف أبعاد شخصية فيلمون، باعتبارها حياة تستجيب استجابة كاملة للنمو خارج القفص، ليغدو مجموعة ذوات تتصارع، لتجعل الحياة محيطا يتسع ولا يضيق..هذا التحرر من الزمن يصير التاريخ علبة صغيرة ضيقة في نظره، ويحيل واشنطن إلى تحفة الزمان وخردته! وبعد مواراة لورا في السجن يطل واشنطن بصورته التقليدية من أرشيف ذاكرة فيلمون، بسيوفه التي تحرث في التاريخ قصصا. ليكون واشنطن الذي اجتمعت في داخله كل نفايات العالم..واشنطن مخترع الضحايا ومخلصهم الجمركي من العقاب.
يهجر فيلمون التدريس ويعتكف في منزل ريفي، ليجري جرة حساب صغيرة، يفلسف فيها خيانته للورا وتخليه عنها، مموها الخديعة بإسقاطات الحفرة المليئة بالجثث والدساتير الوهمية واللاعدل وقوانين الإبادة والمحو والقهر. التي تشكل امتداد ملحميا لمأساة المهاجر الشرقي، المنفي واللاجئ، الواقع تحت نطع نظريات الاستيعاب وإعادة التحويل. التي يرى فيها فيلمون حصان طروادة المكرس لتمجيد العبودية والسلطة المطلقة للمضيف، حريته، رفاهيته، انتصاره. فلا يجد فيلمون المتمرد أمامه سوى تهديد أساطيرهم بعزلته؛ فليست العزلة هزيمة في عالم يترنح في مسلخ يفور بالدم، بل هي انتصار! مما يجعل تنظيف التاريخ من الحطام السافل مقترنا بالإهمال والازدراء..
مع شخصية كونتل، يلج فيلمون مرحلة جديدة من حياته، ويفتح ثقبا يسمح باكتشاف فضاءات أخرى، تظلل مدنا محشوة بمخلوقات مستنسخة عن جدب وخراب وذنوب. وأفواه تتكسر فيها العبارات. وأعماق تشع بالأنين. وجماجم ترن بالثرثرات. وتتقطر خلاصة التهويمات أثناء السهرة الخرافية، في لمعة أخيرة لنجم الجنرال توكالمو الآفل، الذي ملأته الحرب فأصبح أرشيفا ضخما لها، فغدا مكملا لفيلمون باعتبارهما من جيل المفقودات. الجيل الذي مات حيا وعاش ميتا. وترك ليمشي على الخط الفاصل ما بين الحياة والموت في شبه غيبوبة مستمرة، بين مقام اليأس وضريح العدم. لكن الطفل المعتق بضباب الغرب وبوحشيته، سرعان ما ينفض اضطرابه داخل الخوف، ويعلن أن ميلاد القيامة يكون من معبد الداخل، قيامة اللذة. الحلم. التاريخ. التأليف. النهار والليل. الطفولة. العبقريات. وبذلك يهيأ الفرصة كي يحيي تاريخ التشرد ويستلهمه شجاعة خوض التبدلات المصيرية الحاسمة.
يتفق ذهن "الجبوري" عن حل درامي مبتكر يؤجج قضية الحوار الأساسية في الرواية، عبر عقار تجريبي يدعى "أندو"، واظب أعوان واشنطن على دسه سرا في طعام فيلمون وشرابه، بغية إحداث سلسلة من الانقلابات في مزاجه الشخصي. وبنية العقار التركيبية تعتمد تنمية خصائص بيولوجية معينة، تستعمر المخلوق البشري بطريقة ذاتية، وتجهله قابلا للخنوع، مما يترجم فعليا بإحداث تحول كبير في أساليب السيطرة على الإنسان من خلال الجينات. لكن الفكرة بحد ذاتها تستثمر إيجابيا في صيغة علاقة عاطفية جديدة بين فيلمون وفيب، تؤذن بتكريس مفهوم "النبي المهشم": فيلمون الذي يحمل تواريخ طويلة من سلالات وأجناس وأساطير وخرافات وعادات وثقافات تراكمية، الرجل المهووس بحياة يخترعها هو، لا تلك التي تخترع له.
مع صعود شخصية الظل "شوكتر"، ابن واشنطن المستنبت داخل رحم لورا، وتعاظم قدرته على التدمير، يتخذ صراع الحضارات مكانه الأبرز على الساحة الروائية. فيعلن "الجبوري" على لسان فيلمون أنه لا بقاء لعالم بلا تبدلات. فثمة مخلوقات بشرية طارئة على الإنسانية، وأخرى شيدتها التجارب لتكون خلاصة معارف لثقافات متعددة. والتعددية هنا توازي الانفتاح والتجدد. فالثقافة الواحدة خنق، مهما كانت خلاقة وانتفاضية وبارعة. وتقع الديانات في الإطار ذاته، لأنها مستخلصة من رموز عليا تشير إلى منابع النور في العالم، ولا تشير إلى القمع والاستلاب وهدم المخلوق البشري ودفنه تحت الأنقاض.
نقطة الحسم في الرواية تبدأ مع استحضار روح ألفريد نوبل، لإنتاج تاريخ جديد. فمؤلف الموت الانفجاري الصاعق، وصاحب معادلة الفصل الجذري ما بين القوي الضعيف، أنتج بفلزاته مادة
عزل تاريخي بين الشعوب، فأهدى للبعض موتا زؤاما، وللبعض الآخر أهدى حياة مليئة بالترف والتفوق والنشوة. لذلك كان مصيره الجلوس على عرش من الديناميت في المنطقة العازلة بين الجنة والنار، كقاطع طريق يحول دون وصول البشر إلى كل من الجنة والنار..
حاول فيلمون أن يتخلص من العيون التي تكدست فيها الأنقاض والأحجار والتراب الأسود للتاريخ، فاخترع القنبلة السوداء التي تنشر الظلام الاصطناعي وتعيد توازنات القوة بين الفقراء والأغنياء. ثم توجه بها إلى نيويورك لتحقيق هدف تاريخي قد يكون حلما بشريا لمواجهة طغيان القطب الواحد، أو الفك المفترس الواحد. واضعا بذلك نقطة الختام لحياة استنزفت تركيبها العاطفي، فبقيت رهينة كيمياء الخوف فقط. لكن محاولته تنتهي أمام عرش نوبل الملغوم، كي يحاكم على تحديه للغطرسة الغربية الأميركية. وقبل صدور الحكم، يتحقق حلمه برؤية الرجل الأسطوري جلجامش، الذي يؤكد له على آلية تدوير العذاب في الطبيعة. فكل شيء يطرد عذاباته من داخله نحو الخارج، بما في ذلك الإنسان، إذ يصدر هذه المادة للغير ولكن بفارق واحد: إنه يستخدم التعذيب كفن، لأنه من الأمور الحيوية التي يعتقد بصوابها! أي أننا جميعا نشترك بزرع الأوهام وابتلاعها بالتقسيط!
حاول "الجبوري" من خلال شخصية بطله فيلمون، تعويض الأحلام المفقودة باختراع أسى رومانسي الحجم. حشد الشهوات ونظمها في ثورة التمرد المحركة لطاقة الإبداع الخلاق لإنتاج عوالم انبثاقية متمايزة. دون أن يكون هناك تصدير لليأس والألم ولا تسويق تبشيري للأمل، بل صخب هادر متفجر، يفسح المجال أمام بوح سري خافت بالوحدة المضنية وعزلة الأسوار العنصرية. إسقاطات كثيرة تعرب التناقضات وتحرث الركود الفكري، ليبق الأهم: الحساسية العالية، التي تنعي خراب الزمن وبؤس الإنسان المخلوق للحب، المنذور للكشف المعرفي وسط أنقاض الهياكل والدعامات..
تأجج احتكاك الشاعر أسعد الجبوري مع ثقافة المنفى حضورا عقليا متفجرا، اختزل ضراوة الدفاع عن النفس، وسط الاجواء المغلقة المعادية، بأبعادها التصريفية القاسية. فاستكانت فتوحاته تحت راية البحث عن خصوبة تثري الارث الإنساني، ليتحقق اكتمال وجوده في قلب الاغتراب، وليستطيل المخزون السومري القديم مرنا مطواعا ومحركا خفيا للقاء الحضارات. فتتلون لقاءات الشرق والغرب، بنكهة ابداعية جميلة ترتسم عنوانا حقيقيا في قلب شعارات "الحياة هي في مكان آخر" .
تبدأ القصيدة بقول الشاعر (أرمي جسدي في الماء) وهو سطر موزون عروضيًّا، ويتفق في وزنه مع العنوان نفسه، ويمتد نفس الوزن في السطر التالي (فأراهُ سفينة) وبعدها يتغير الإيقاع. غير أن هذا الإيقاع يعود في نفس السطر في عبارات مثل (تسعى بين منازل)، (اللؤلؤ والبترول)، (والهامور)، وكذلك في السطر الرابع (جسدي يحملني)، ومثل هذه الأمثلة كثيرة في النص من قبيل: (يتمدد في الطول)، (أعرف كيف يغرد)، (يملؤها الله)، (أنا في جسدي ماءٌ)، (بغزاةٍ مرُّوا)، (خلفي شجرٌ)، وما إلى ذلك من أمثلة كثيرة لا تقيم وزنا خالصًا، ولكن تنثر موسيقى خاصة بالقصيدة تتولد فيها ولا تتقيد بما هو آتٍ من خارجها. هذه المراوغة في الإيقاع التي تلت المراوغة في المعنى كما رأينا في العنوان تظهر لنا أن الشاعر مشاكسٌ للقارئ، ولا ينتظر من القارئ أن يتلقي قوالب جاهزة دون جهد منه في صياغتها، وما فعلُ القراءةِ سوى إعادة صياغة للنص. وهنا يتعين على القارئ الذي تدربت أذنه على الإيقاع أن يستمع إلى ما تهمس به موسيقى النص حتى وإن حاول الشاعر إخفاءها وطمس معالمها. ويتعين على القارئ أيضًا أن يتعدى حدود المعنى النمطيِّ في ذاكرته ليتساءل ويكتشف، بل ويتعدى ما يرمي إليه الشاعر أحيانًا. مثل هذه المراوغة في المعنى قول الشاعر "وسأرحل للصيد في أعالي الكلمات" والتي تذكرنا بتركيبة "أعالي البحار"، وليس على الشاعر إثمٌ شعريٌّ إن هو استخدمها في قالبها النمطيِّ وقال "وسأرحل للصيد في أعالي البحار"، والتي سيتقبلها القارئ ولا يقف عندها، لأنها توافق ما استقر في ذهنه من تركيبة لغوية. غير أن الشاعر لا يرضى إلا بمفاجأة القارئ وتعدي حاجز النمطية لديه، بل وكسره، فهو يذكره بأنه شاعرٌ، والإبحار والصيد لديه لا يكون إلا في اللغة وفي الكلمات.
إنَّ الشاعر، وهو شديد الحرص على تجديد لغته ومعانيه، لا يستنكف أن يلجأ لتراثه الإسلامي وللغته القرآنية الإعجازية في قوله (دون خوف ولا هم يحزنون) في اقتباس صريح من الآية القرآنية (ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون). هو اقتباسٌ نراه ملائمًا لمعرض حديث الشاعر عن هؤلاء الذين قضوا نحبهم غرقى وهم يجمعون المحار من أعماق البحار، فكأنهم ينزلون بلا رهبةٍ سلالمَ تأخذهم للموت المنتظر لهم، أو كما عبَّر عن هذا الشاعر بقوله: (يزرعون في المحار أرواحهم وينزلون سلالم الموت / دون خوفٍ ولا هم يحزنون). هذا التناص مع الآية القرآنية يكشف لنا شيئين: أولاً أنَّ الشاعر حريصٌ على التزوُّد من تراثه والاقتراب منه قدر حرصه على مخالفته والابتعاد عنه. ثانيًا أنَّ الشاعر فخورٌ بأجداده الذين قضوا حياتهم في صيد المحار حتى أنْ أسبغ عليهم هالة قرآنية أضافت مسحة ربَّانية على موتهم غرقى، حيث أن الآية القرآنية، والتي تكررت بعدة صيغ فمرة (فلا خوفٌ)، ومرة (ألَّا خوفٌ) وغيرها من الصيغ البلاغية القرآنية، تتحدث مرة عن الشهداء، ومرة عن الصدِّيقين، ومرة عن الصالحين والأولياء. هذه الإشارة القرآنية تظهر مدى تبجيل الشاعر لأجداده والذي يبلغ ذروته في قوله (أنا حفيدُ مملكة الجبور في البحرين). المفارقة هنا هي أنه حفيد الأمير مقرن بن زامل وليس حفيد المملكة نفسها. هذا خروجٌ لغويٌّ آخر يفجأ القارئ ويكشف له أنَّ جد الشاعر ومملكته، بالنسبة للشاعر، شيءٌ واحد، فهو تبجيل للجد وفخر من الشاعر به، أو هكذا يبدو.
القصيدة رحلة يقوم بها الشاعر عائدًا إلى أصوله وتاريخه منقبًا عن آثار أجداده وما تركوه، وكيف عاشوا، وكيف كانت نهاية رحلتهم. هي رحلة يستحضر فيها الشاعر روح جده الأمير، يبدأها بأن يلقي جسده في الماء فيتحول الجسد إلى سفينة من تراب الذي هو مادة الجسد. تصير الروح رُبَّانًا لهذه السفينة، تسكن أعاليها، وتبصر الزبد الأبيض للموج قصائد تتراءى للشاعر في رحلته. يقول الشاعر في أول قصيدته: (أرمي جسدي في الماء. / فأراهُ سفينةَ ترابٍ، تسعى بين منازل اللؤلؤ والبترول والهامور / وقصائد السراب الأبيض من خلايا الموج. / جسدي يحملني. / وما زلتُ أغوص فيه، / لأكون أنا والماء من كهرباء الظنون. / هو العمودُ / يتمددُ في الطول وفي الارتفاع. / وأنا لمبةُ الذروة). نقف عند "كهرباء الظنون" التي تصعق القارئ بفجائيتها كما تصعق ظنون الشاعر نفسه. روح الشاعر في أعلى الساري سراجٌ، ثم تصير عند الطوفان موجة (وكيف تكون النفس موجةً / يملؤها الله بالليل وبالكؤوس على مائدة التخوم). يقول الشاعر في مقطع آخر: (أقف في مرآة الخليج / لأقرأ بحر الظلمات كتاباً في داخلي. / وأرى عذاباً قديماً لم تستطع الزلازلُ محو نقاطه / من العيون والدفاتر وجدران البحر). يستوقفنا قول الشاعر أنه يقف (في) المرآة وليس أمامها، وهو تعبيرٌ يأخذنا إلى داخل هذه المرآة مع الشاعر لندرك أنها ليست إلا الخليج، فالشاعر يبحر فيه ويقرأ ما يسطره البحر في نفس الشاعر عن عذاب قديم عاناه أجداده. هذه المعاناة التي ما زال البحر يحملها وتبدو ماثلة على جدرانه! وهل للبحر جدران سوى الموج الذي يعلو كأنه جدار؟ هي صورة تذكرنا بقول امرئ القيس: (وليلٍ كموج البحر أرخى سدولهُ / عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي). هي لمحة أخرى من لمحات تأثر الشاعر بتراثه، لا الإسلاميِّ بل العربيِّ هذه المرة. يكمل الشاعر متسائلاً: (لمَ كلما لمستُ مياهاً ، / أصبحتُ باخرةً تغوص بين أرجل الموج. / وكأني منقذٌ لاستخراج تواريخ غرقى أعرفهم / أو بعضهم أو أحمل عطر واحد منهم يذكرني / بغزاةٍ مروا بنا سحبَ موت وهلاك / ليس عندي غير شبكة الريح. / وسأرحلُ للصيد في أعالي الكلمات. / خلفي شجرٌ وأسلاكٌ وألغامٌ وآلهةٌ يتصدرون موائد الأساطير. / ومعي مطرقتي لكسر الحدود في الموج / وفي التاريخ وفي البصريات .. / أنا حفيدُ مملكة الجبور في البحرين. / أشقُ الآن غرفَ الماء بصوتي مستذكراً غرقى / يزرعون في المحار أرواحهم وينزلون سلالم الموت / دون خوف ولاهم يحزنون . / تلك صورهم في جوف المياه . / خيوط سيراميك مُعشق بالأحلام. / عظامهم مراكبهم تغوصُ وتطفو. / والملحُ آخرُ ما في كؤوسهم من ثمالة الوجود). صورٌ تترى للشاعر بمجرد أن يلامس مياه البحر، إذ يتحول لا لغواصةٍ بل لباخرة تغوص! وكأن الشاعر يسافر في الزمن بمجرد أن تطأ قدماه البحر فيبحر على باخرة كما كان يسافر القدماء في القرن السادس عشر. غير أنها باخرة يمكنها الغوص بالشاعر في الأعماق بحثًا عن أجداده الغرقى، حاملاً معه مطرقته محطمًا بها غرف الموج ليرى ما تحوي من غرقى. هو يرى صورهم وعظامهم تغوص وتطفو ولا شيء في كؤوسهم سوى الملح، آخر ما لهم من ثمالة الوجود! صور متواترة لا يملك معها القارئ سوى أن يتذوق ملح الثمالة في حلقه! هذه العودة في الزمن استلزمها عودة في اللغة، فلا نجد في هذا المقطع كلمة حداثية أو عصرية باستثناء كلمة "سيراميك" والتي من الممكن جدًّا
أنها كانت مستخدمة في القرن السادس عشر جنبًا إلى جنب مع كلمة "خزف"، على الأقل بين البحارة في خطابهم اليومي، حيث أنَّ أصولها يونانية من كلمة "كيراميكوس"، إلا أنه من المؤكد أنها كمادة كانت مستخدمة منذ آلاف السنين.
انتقال الشاعر إلى عصره وارتداده من رحلته التي عادت به إلى القرن السادس عشر استلزم معها تغيرٌ في اللغة، فنجد في نهاية القصيدة في المقاطع المعنونة "هامش" مفردات مثل "زمكنة"، "البلاجات"، "الشيطلائكة"، "باطون" وكلها مفردات تعكس زمنًا غير الذي جاء منه. كما يتحول الشاعر ليصف الخليج في عصرنا هذا والذي يرى فيه: (أطلالاً ومنازلَ باطون مسلحٍ ترتفعُ ما بين النفس والكتب / الآن أرى وراقين يؤلفون الخيبةَ بأحمر الشفاه، وعمال هنود وأجانب من مختلف الأعراق يحاولون ترميمنا على الشواطئ. اللغةُ مكسورةٌ، ونحن بقاع الليل نشتعلُ على حطبٍ من الموسيقى القديمة). هذه النقلة اللغوية تتوافق مع النقلة الزمنية وتبرزها، فكأنَّ القارئ يصحب الشاعر في انتقاله بين زمنين. غير أننا نستشعر أن الشاعر لم يفقْ بعدُ من صدمة العودة من القرن السادس عشر إلى القرن الحادي والعشرين ليرى ما رأى. نلمس هذا في بعض مفرداته التي ما زالت معجونة بأنفاس الماضي مثل "أطلال"، وهي مفردة تعود للقرن السادس الميلادي، و "ورَّاقين"، وهي مفردة كانت تطلق في القرون الوسطى على الكتبة وبائعي الكتب وطابعيها، وكان السوق الذي يباع فيه الكتب يسمى "سوق الورَّاقين". هذا التزاوج بين ألفاظ عتيقة وأخرى حداثية تعكس لنا روح الشاعر المغموسة في تراث عتيق، الكائنة في عصر حديث صبغها بصبغته، فجاءت مفردات الشاعر معبرة عن رحلته للماضي وأصالته، وعودته للحاضر العولمي الحداثي، وصدمته في الارتداد من هذا إلى ذاك. هذه الصدمة يكرِّسُها تعبير الشاعر بأنه وجد أنَّ "اللغة مكسورة"، فهي ليست اللغة التي ألفها في زمنٍ سابقٍ عاد منه لتوه! ولأنه عاد لتوِّه من الخليج، وهنا المزاوجة بين استحضار الزمان والمكان، والذي عبره عنه الشاعر بكلمة "الزمكنة"، فهو يرى نفسه وقومه في هذا الزمن العولمي الحداثي قابعين في "قاع" الليل، فالليل عند الشاعر قد تحول لبحرٍ. تحويل الزمانِ لمكانٍ اختصره الشاعر في كلمة "زمكنة"، وهي إحالة ثانية لنفس بيت "امرئ القيس" الذي أشرنا إليه سابقًا والذي حوَّلَ فيه الليل (الزمان) إلى بحر (المكان).
بعد أن ينعي الشاعر حال الخليج الآن، يستحضر مجدَّدًا روح جده مخاطبًا إياه: (أيها الأمير المرصع بماء الياقوت الأحمر .. / يا من غرفتَ البحر بملعقةٍ وشربت الموتَ. / ها أنذا أستحضر تاجكَ في شعوبٍ لا تنتهي. / أستحضركَ من منازل السحاب المتحركة. من الريح العابرة في بريد الله. أستحضرك من تربة اللغة ومن تراب النظر المتطاير فوق غلاف التاريخ. أيها الأميرُ النائم ُ تحت المطر لا تحت الشاهدة الصخرية. ذراعك لن تنخفض). هذا المقطع الصافي في لغته، المدهش في صوره وتركيبته اللغوية والإيقاعية مثل (يا من غرفت البحر بملعقةٍ وشربتَ الموتَ) وهي تركيبة ذات نغمة موسيقية عالية تحيلنا للإيقاع الذي بدأت به القصيدة. هي تركيبة شعرية رائعة لا نملك إزاءها سوى تذكر قول ت س إليوت (I have measured out my life with coffee spoons; / لقد قست حياتي
بملاعق القهوة)، فكلا من الأمير مقرن بن زامل و"ج ألفريد بروفروك" متشابهان في كيفية انتظارهما للموت. الأول يغرف من البحر بملعقة ويشرب الموت على مهلٍ في انتظار قدومه الكامل، والثاني يقيس حياته بملعقةٍ في انتظار الموت، على مهلٍ أيضًا! إمعاناً في الفخر بجده، يؤكد الشاعر لجده الأمير النائم في البحر، لا تحت الأرض، أن ذراعه، برغم الموت، لن ينخفض.
لن يمكننا الوقوف عند كل سطر في القصيدة لقراءته قراءة انطباعية توضح معناه، فهذا ليس مقصدنا من هذا المقال، إنما مقصدنا، كما ذكرنا، هو تحليل النص لنرى كيف تماوجت لغة الشاعر ومفرداته ما بين المعاصرة والاقتباس من التراث الإسلامي، وكيف تراوحت صوره بين التماهي مع الشعر العربي القديم والشعر الغربي الحديث، وكيف تمازجت موسيقاه بين همساتٍ عروضيةٍ حينًا، ونثريةٍ لغويةٍ غالبةٍ على القصيدة تعمد إلى التحرر من رتابة الإيقاع، وكيف وظفَ الشاعرُ لغته لتعبِّرَ عن زمنين مختلفين، وأثر الصدمة الواقعة عليه إثر انتقاله بينهما، وكيف استحضر جده في رحلته للبحث عن ذاته وأصوله، وكيف رأى أجداده وهم يكتسبون قوتهم بجمع المحار، ورأى معاناتهم، ورأى موتهم في تحدٍّ سافرٍ للموت في غير خوفٍ منهم ولا عليهم. وما هذه القراءة المتواضعة إلا رحلة مع الشاعر، نحلل فيها ما كتبه، لا لكي نزعم أنَّ هذا ما قصده الشاعر تحديدًا، بل لمجرد المتعة المكتسبة من الرحلة فحسب.
1
كتابة المعنى الشعري ..
تمارس الكتابة الشعرية المغايرة علاقة اختلاف مع اللغة، وباللغة يختلف المعنى والمبنى، والأختلاف هنا ليس مجرد مغايرة عابرة أو لعب لغوي يسقطنا مجدداً في دائرة التكرار بل هو محاولة للتماهي مع الشكل الجمالي للنص الشعري المكتوب . في وضع كهذا أو في فهم كهذا للعلاقة بين الجمالي والشعري تتحدد معه العلاقة هذه كعلاقة مغايرة شعرية واختلاف جمالي وليس كعلاقة معنى ومبنى فقط .
ليس لنا أن نفهم علاقة الاختلاف في نصوص الشاعر أسعد الجبوري على أساس من هذا الزخم اللغوي، بل لا بد لنا من أن نفهمها على أساس نقدي معرفي به تقوم علاقة الكتابة الشعرية مع أي شكل فني بعلاقة نقدية تمارس الكتابة الشعرية، خلالها، حريتها اللغوية وضمانتها الجمالية بأن تكون قولها على حدّ نقدي يفهم الأختلاف بين النص والشاعر، بمعنى آخر فاللغة وحدها ليست مقياساً مطلقاً لفهم النصوص الشعرية والتوفيق أو التطابق العابر بين المعاني المتناثرة هنا وهناك، اللغة تحتاج إلى حدس أو حس نقدي وهو عمل الناقد وأسلوبه في القراءة مثلما هو عمل الشاعر وطريقته في كتابة المعنى الشعري، لنطلع على هذه المقاطع التي تمثل لغتها الشعرية المغايرة مستوى المعنى الكامن في ثنايا النص: (ليس من مكان نذهب إليه ولا أنا، قالت له اللغة وهي تسحبه من خصره نحو التلال في منتهى الليل) (ما من كورال إلا وتسرقه عذوبتك للغناء حيث تجتمع البلاغة في قصيدة تأخذ العقل) (إزاء هذا الخبل أريد لغة تثقل عنق العراق) (ألف طويل وموسيقى تعصر ثوبها في حدقة) .
الكتابة الشعرية لدى الشاعر أسعد إذ تمارس نشاطها اللغوي في علاقة لها من الجمالي مختلفة، إنما تمارسه كذلك في علاقة لها أخرى، مع المغايرة الفنية والمغامرة اللغوية، هي أيضاً نقدية فالمغامرة أو المغايرة هي الشكل المختلف الذي لم يستو بعد في صياغة شعرية نهائية، إنه النص المقروء أو المحسوس في
الكتابة وفي فضاءه المفتوح ضمن تشكيلة من العلاقات اللغوية والفنية والذهنية التي تكون الطابع النقدي وبدور هذا الأخير تبدو الكتابة الشعرية متمثلة بموقع هو منطقها الذي به تمارس نشاطها اللغوي صياغة وقولاً وأعني نطقاً فنياً، لنتأمل هذه العبارات الشعرية: (فم فائض ومطمئن، أنت ضعت في ضبابه) (للمرة الأخيرة تؤثث الغرائز منازلها تحت رافعة النهدين) (بعدما أتّم الهواء بنائي تجمدت الأجراس في العيون) .
قد نخلص إلى القول: إن الكتابة الشعرية لدى الشاعر أسعد لا تتحدد، إذ تمارس نشاطها اللغوي، بالشكل الفني وحسب وأن هذا الشكل هو شكل أختلافتها وإنتاجيتها المبدعة، ولا تتحدد أيضاً بمجرد اللغة الصارمة، إن على مستوى علاقتها بالمعنى أو بالمبنى، بالجمالي أو الفني .
نختار نصوصاً شعرية، العناوين فقط، وإذ نختار عنوان هذا النص أو ذاك لأن العنوان، نفسه، يقدم نموذجاً مصحوباً بتماسك بنيته اللفظية، ولأن اللعبة الفنية فيه تمكنت، مع حفاظها على هذا التماسك اللفظي، من الإيهام الجمالي فداخلت بين المعنى المنشود وتركيبة الجملة الشعرية، ونحن إذ نتناول هذه العناوين إنما نتناولها ليس كمثال عابر وحسب بل كنص مكتوب على مستويين: مستوى المعنى ومستوى الجملة الشعرية وهنا أريد أن أشير إلى أن العنوان ليس موجز النص المكتوب وليس هو بالتالي المعنى المنشود وحسب بل هو ما نصل إليه، أثناء القراءة، بعد تفكيك اللفظة الشعرية وتجريدها، لنتأمل بعض من عناوين نصوص الشاعر أسعد الجبوري: (عندما تفكر الدموع/قاموس العاشقين/الأناركيزم والأكمه/الوداع باب بصرير/تمارين عظمى للمخيلة/لم يبق من الجحيم إلا دانتي/الهايكو كحيوان ياباني/البكتريا الايروسية/نسخة الذهب الأولى/مخلوقات الألبوم الشيطلائكي/البحر في حقيبةٍ وغريق يطفو على الكيبورد) . غير ان اللافت هو أن زوايا النظر في القراءة النقدية، على شكل اختلافها، ظلت في غالبيتها تحوم حول إشارت، تتعلق بالعنوان، ذات مدلول معرفي جمالي فحدّدت، بالتالي، حقل المعنى الشعري وأفق تطوره اللغوي، والعنوان هنا، أيضاً، هو الأداة المعرفية بامتياز والتي تنعكس على طبيعة الكتابة الشعرية المختلفة المحملة بدلالات تقع داخل النص .
2
الشكل الفني ..
لعلّي أقول: إن الشاعر أسعد الجبوري شاعر مغاير، حتى على صعيد الشكل الفني لنصوصه، فالشكل الفني هو جمالٌ بالأساس أو هو في وجهٍ أساس من وجوهه، شكل من أشكال الممارسة الذهنية أيضاً وليس انسياقاً مع عفوية الكتابة الشعرية الخاضعة للصدفة عند البعض أو الواقعة في ظل الالتباس النقدي والتداخل الشعري وعدم التحديد في كثير من النصوص الشعرية والدواوين الصادرة هنا وهناك، وإذا تأملنا نصوص الشاعر نلمس تلك التشكيلات اللغوية المختلفة أو التجليات المتنوعة لمفردات شعرية غير محددة تنطلق من رؤية فنية صارمة، لا توهمنا بالبذخ اللغوي ولا تخون الخيال، ومن تصورات فكرية لطبائع الأشياء وتفاصيلها ثم من مفهومه للشعر، كما أرى، الذي يرى الحياة الحقيقية وصولاً إلى الحلم، وهذا ما أشار إليه في هذه الالتقاطات الشعرية المعنونة "بنك الخيال": (الحلم فاكهة صغيرة السن) (وأما الجسد فباصٌ لركاب يتساقطون تباعاً) (البكاء مجرى الأنفس وأما الدمعة فوحدة قياس عند العاشقين) .
تتعيّن شعرية أسعد بتصور معرفي جديد للعالم، قبل أن تتجلى في أغلب نصوصه الشعرية التي يرتكن خلالها إلى العبارة الذهنية ومجانبة الوضوح، يُعَلّم قارئه، كما يبدو لي، طريقة التأمل بالنص بشكل موارب قبل أن يرسل إليه، من خلال المعنى، بعض الإشارات المحملة، أحياناً، بالالتباس وهو يتقاطع من نصوصه تارة ويلامس لغته المسكونة بالمتغّير تارة أخرى ولا يخفي، في ذات الوقت، الافصاح عن تصوره المعرفي بالعالم الذي يستنبت المعاني المشاكسة أو الدلالات المشحونة بالسحر والتاويل والمقاربة .
لا يفصل الشاعر، في مجمل نصوصه الشعرية، بين اللغة والخيال ويعتقد أن الكتابة الشعرية، وبالمعنى الدقيق للكلمة، هي عبارة عن تصورات باطنية لا يقدر على ردها إلا بالاستعانة على المخيلة وفنية اللغة، بمعنى آخر: إذا كان الشاعر قادراً على تلقين المعنى الشعري ما شاء من الكلمات والمواقف والصور فإن منتج النص الشعري سيُعير الشاعر كل الاهتمام الجمالي الفني ولا يكترث بمعادلات اللغة، أحياناً، الغارقة بالبذخ وبسبب هذه المفارقة النقدية، في القراءة، فإن نصه يحاور الخيال/اللغة من دون اغتراب ويأخذ بزمن شعري مشخّص يطرد زمن الكتابة العفوية، كما أشرت سلفاً، ذلك أن كتابة النص لدى أسعد لا
تستحضر الزمن القريب ألا لتنفيه لأن الزمن البعيد الذي يكتب فيه يستلهم روح الماضي ويعرض عن الحاضر الذي يريد تجميد الحياة في لحظة ما، وهذا ما أشار إليه في النص المعنون (سركون الأكدي) كما لو كان يقول أن على القديم والمتقادم أن يخرج من كهفه، وأن البقاء في الكهوف دعوة إلى الجمود والموت وعلى نص الشاعر أن ينطلق إلى حياة منسوجة من نبض اللغة وأوجاع المعنى، إذن، هذه هي الأهمية المعرفية التي يحتلها النص الشعري جمالياً ونقدياً . من هنا يمكن أن نتلمس ما ذهبنا إليه في هذا الجزء، أعني الشكل الفني، خلال قراءتنا لهذه المقتطفات: (كم تمنى السرير أن لا يفيق وأنت نائمة) (الألم أن تكون وحيداَ في مضائق الألفاظ) (ومن الصخب تخرج علينا أميرات الحبر على دراجات من حرير) (قدم البيانو تنزف أناناساً) (وكلما لمست طرفاً منك أسمع بيانو يتأوه خارج النوتات) .
3
ذاتية مفرطة الاناقة ..
ما يشغل الشاعر في الكتابة الشعرية يقع في صدق النص (ذاتياً) وفي حدة الاناقة (شعرياً ولغوياً) وهذا ما يجيزه الشاعر في أن يجعل جزءاً من ذاته مادة شعرية غير محجوبة، وهي إجازة لا تتقيد بما هو متاح ومقبول أو واضح عن الذات في نظر القارئ طالما أنها تعين القارئ النقدي للخروج بسر المعنى الشعري إلى العلن، وهكذا تقترن الكتابة بالذات أو بخلوة الشاعر، بأنواع مختلفة من المسرّات والغياب والآلام التي تكون عالماّ ذاتياً خاصاً بالشاعر، وبهذا، أيضاً، تتحقق علاقة الذات بالنص الشعري ولعلنا نجد في هذه العلاقة تعويضاً عن هذا الوجع الذاتي أو تصويراً لحالة الفقدان طالما أن الشاعر أقام علاقة إيصال وأتصال بين الحياة والشعر تقوم على تخييل أو تصوير لما هو موجود في نثر الحياة نفسها وأقتصر جهده، ذاتياً، على لعبة أفصاح لما هو واقع في الحياة والشعر واللغة والمخيلة، ولقد بدا لنا، من خلال بعض النصوص، أن الشاعر غارقاً في الذات من حيث يعلم أو لايعلم وانه ينتهي إلى الإفصاح حين يريد أو يحجم عن ذلك وأن النص واقع في مساحة قول المعنى، وإنني أرى أن هناك ضرورة نقدية، عند قراءة أي نص أدبي، للتفريق بين الذات وسلوكها وبين ما يريده الكاتب منها وإن هناك وظيفة للذات في العمل الأدبي ووظيفة أخرى للنص الذي يحتوي عليها،
إذن هذه هي الذاتية في فلسفتها الشعرية الجمالية، ذاك أن الذات صورة كبيرة تنفتح على فكرة لا تشير إلى المعنى بيسر بل بقراءة نقدية صارمة أو بمماطلة وفي هذا الموقف نورد قول أبو إسحاق الصائبي: (وأفخر الشِعْر ما غمض فَلَمْ يُعطك غرضه إلاّ بعد مماطلة منه) . نخلص من كلامنا هذا إلى القول بأن الذاتية التي نحن بصددها ليست ظاهرة شعرية عابرة بقدر ما هي ظاهرة فلسفية، تتعلق بوجهة نظر الشاعر من الكون، ولا لكي ننفي عنها الطابع الشعري الذاتي بل لكي نؤكد أن الفلسفي فيها هو الأساس وأن ما عداه، شعرياً أو ذاتياً، يحتل الأهمية النقدية المضافة في تعريف هوية النص والشاعر معاً، ألم يقل كانط: (أن الفلسفة هي معرفة الأنا في علاقنها مع اللا أنا) لنقرأ هذه المقاطع الصغيرة من نصوص أسعد الجبوري: (ما من راو واضح لحبكة النفس) (يعرفكم بنفسه امهر السباحين وأطولهم غطساً، إنه الغريق) (كلما غطى حلمهُ تخرج القدم من اللحاف) (التأمل في السعادة يثني العصفور عن الذهاب إلى دار الأوبرا) .
4
تقنيات النص التخيّلي ..
كيف تجعل، الكتابة الشعرية المختلفة، القارئ يخرج من غيبوبة اليومي؟ حين تبتعد عن التكرار أو بتقديم الحدث اليومي بصورة مستهلكة ولا تركز على الجانب الدرامي التقليدي الذي يبث الرعب في الحياة، فالكتابة المختلفة ترتكز على المفارقات التي يتوارى خلفها معنى النص أو موقف الشاعر مثلما تعتمد على الدراما الكامنة بين تدفق وتوهّج القارئ/الإنسان في لحظة وبين انطفائه وسكونه في اللحظة اللاحقة، بين التأسيس والهدم أو بين الوجود والعدم وتلاصقهما وكأنهما واجهتان لشيء واحد، في هذا تكمن تقنيات النص التخيّلي في نصوص أسعد وكأننا نعيش مع اللغة ونتماهى مع الخيال وكأن اللغة والخيال توأم لا يفصل بينهما إلا لحظة تأملية تُؤنْسِن الشعري ولا ترفع عن الشاعر إنسانيته وتجعل، في الوقت ذاته، من النص كائناً حميمياً بملامح إنسانية مغلفة بلغة رصينة خالية من الترهل والاورام، أليس هو القائل: (الضعف اللغوي يعد منشأ كل مرض يصاب به كاتب النص الشعري، النصوص الرديئة عادة ما تحمل في اجسادها الفيروسات القاتلة) وبهذا أيضاً يعي الشاعر فكرته الشعرية ويدرك تماماً
قابلية المعنى الإنساني/الشعري على التأسطر لذا يبدأ من ذاته، كإنسان، ليكون، بالتالي، معياراً لعالم ممكن .
تُرجع نصوص الشاعر للمفردة الشعرية جمالها وللمعنى بداهته الأولى وتنلقنا من التكثيف اللغوي إلى الإيجاز الذي يضفي للنص تقنيته الخاصة الخالية من الرتابة والجمود ويمكن قراءة نصوصه على الصعيد المجازي فملامح المعنى توازي ملامح الخيال ويمكن أن يُقرأ المعنى بوصفه سياقاً عاماً للصورة الشعرية، إذ السياق يستدعي معنى النص ويختلط به وقد توحي هذه الحالة، أثناء القراءة، باشكال لغوي غير أن القراءة النقدية الصارمة تقوم على إمحاء المسافة/الاشكالية بين المعنى والنص الذي يلغي، بدوره، مثل هكذا احتمال .
النص التخيّلي يأخذ حيزه المحدّد في المكان والزمان مثلما يطرح موضوعة المعنى لا كعبارة غائمة تقبل إحالات متعددة، فالموضوعة هنا معنى النص والقراءة النقدية له، هي بداية التفكيك التي تشكل امتداداً لمعنى النص الذي تبدو من خلاله الدلالات والرموز والإشارات ناطقة بلغة شعرية لا تقبل الالتباس، لغة خارجة عن صورتها المتكرّرة في الكتابة الشعرية السائدة المستهلكة، لغة شهوة ومتعة جمالية . لنتأمل في هذه المقاطع المختارة من نصوص الشاعر: (الورد سريع النسيان أن هرول بين يديك أو في الحقل) (العين أرض الزلازل والحب جندي احتياط) (وما كنت أعطي يدي لحزن من غير سلالة الباطن الضوئي، هكذا أجرّ حصاني لتتبعني الريح) (هل السؤال يهرب من نسيجه ويقذفنا من الطابق الأخير للرسائل) .
5
الإطاحة بالخمول الذهني ..
العبارة الشعرية المعرفية المكثفة بالمعنى تلازم عند أسعد الجبوري لغة النص مع رهان على قدرة المخيلة على التحليق وعلى الإطاحة بالخمول الذهني الذي يغلف الكثير من النصوص الشعرية السائدة، فقد قدم الشاعر تبررين للتثبت من ضرورة قدرة المعرفة الشعرية: أولهما جمالي، قوامه الفكرة واللغة التأملية الخاصة بفلسفته الجمالية . وثانيهما فلسفي، وبمقتضاه تكون لغة النص قد صنعت الفكرة الفلسفية التي تتطابق مع المعنى المغلف بمسحة صوفية، سعى إليها الشاعر في
بعض نصوصه، تستحضر، في لحظة ما، زمن النص، ذاته، وهو يجسد الحياة أو الكون إذ الزمان منطوٍ في الشاعر والنص على مذهب المتصوفة وهكذا يختزل أسعد هذه اللعبة الشعرية المعرفية وكيفية ارتباطها بالوجود عبر هذا الشطر الذي اسماه "موقف الشفرات" (هذا النهار حيوان شعبي، هنا رمزه يذوب في نهاية المفكرة ويلعب الصبية بطينه دون اكتراث) وفي هذا الجزء المسمى "موقف النوم" (ليس من نائم بين هضاب الموت سوى السرير) وفي هذه الجملة الشعرية التي لا تخلو من التهكم أو الفكاهة الشعرية الموضوعة تحت عنوان "موقف قصيدة النثر" (قصيدة النثر بالشورت على بلاج اللغة/لكنها ليست آخر تفاحة للخطيئة) أو (النصوص هوائيات لنزهة الشيطلائكة وثمة نساء في محميات الذهن عادة ما يُطلن التحلم بصقور تأتي من وراء التلال لتندفع في لحومهن نبالاً من لذائذ غير اكاديمية) .
لقد أجاد أسعد في تفسير هذا التطابق، الجمالي والفلسفي، المشار إليه أعلاه عندما فسّر كيف ينكشف واقع علاقات المعنى للنص الشعري في حين تبقى اللغة الرصينة متحررة من الخمول الذهني وغير أسيّرة تصورها المستَلَب للقارئ الخامل أيضاً، إذن، هذا هو الانطباع الذي أجاده وأوجده الشاعر للتمييز بين المعاني والنصوص، لذا فإني أقدّم، من خلال هذه القراءة، بعض الانطباعات مما سبق من نقد للكتابة الشعرية المختلفة واشتراطاتها الفنية واللغوية، لعلها تشكل نقطة بداية في جدال شعري أعمق ونقد رصين وقارئ مغاير، وأخيراً لا بد من التأمل في عبارات الشاعر المحملة بمدلولات عدة: (القصيدة في النهار مكشوفة الظهر، هكذا ينتابني شعور ما، عادة ما يكون مجهول المصدر، ليؤكد لي صحة تلك الفكرة مما يتطلب الاحتراس من اللغة أو الخوف من مخلوقاتها اللاعبة على حبال الغسيل أو تلك المرمية على الأرصفة والوجوه والمقاهي دون غطاء لغوي يحمي المعاني من الانكشاف السريع كما يفرض على النص هيبة الغامض المجهول مما يمنع انقياد النصوص إلى القراء كالدوّاب) .
القراءة مسؤولية نقدية وأخلاقية والشاعر مسؤول عن صياغة الحياة والجمال والفكر والعالم الممكن، لذا يجب أن نبحث عن النص المحمل برؤية جديدة أو بفكر محض تحدثه الكتابة الشعرية المختلفة، وإن طريقة الوصول إلى النصوص المغايرة هو الإدراك المعرفي والنقدي والجمالي والذهني لمعطيات لا يمكن رؤيتها فحسب بل لمسها وتذوقها .
إذا كانت التجارب الشِعرية تنقسم إلى نمطين لا ثالثَ لهما:
- التجربة الأفقية: وفيها يَنْكَتِبُ النصّ بالوتيرةِ نفسها، وفي درجةِ حرارة إبداعيةٍ معينة، ودونَ حصولِ تطوّرٍ يذكرُ.
- التجربة العمودية: وفيها - تماماً كاللبلابِ - تعلو القصائدُ وتزهرُ، وتطوّرها يكونُ بشكلٍ تصاعديٍّ بحت.
فإنّ تجربة أسعد الجبوري تنتمي بلا شك إلى النمط الثاني، فمن كتاب إلى آخر لا نلحظ أي تكرار لمفردة بعينها، أو الدوران في فلك صورة أو جملة شِعرية محددة.
قاموسه يتحدّث ويتجدد تلقائياً، وهو "لا يكتب نصاً بقدر ما يتأمل ويراقص التعبير"، ونصه ليس مجرد جمل وصفيّة بقدر ما تكون أشبه بملهى الكلمات، فكل كلمة لها نكهتها ورقصتها التي لا تشبه سوى نفسها.
نصّهُ جديدٌ ومبتكرٌ، وبنكهةٍ غير مألوفةٍ لدى القارئ، ينتمي ولا لينتمي - في آنٍ واحد- إلى موروث النص الشِعري العالمي الجديد.
بخطى حثيثة يمضي الشاعرُ، يتنقل كما النحلِ، بين أزهار الكلماتِ ولا يتقن سوى الإصغاء إلى أزيز قلبهِ، أو يملّ من ابتكار المزيد من الصور الشبيهة للحظة حدوث القبلة/ العذبة أبداً.
في النفق المظلم، وحدهُ الشاعر يحمل قنديل كلماته، خفيفاً.. خفيفاً.. ليضيء دربنا، هذا النفق الذي حياتنا.
(هل كان الابطال على الدوام موضع شبهات ، ولا يتحرّرون من اللعنات التي تلاحقهم إلا بالتضحية الشاملة ؟
هذا ما فعله الكثيرون . وكأن لا جواب مقنعا لنفي تلك التهم والافتراءات عنهم ، إلا بتدمير أنفسهم ، والإنتقال بها من عدم الحياة إلى بطولة العدم ! )
# (الكائن البشري ليس غير موظف يعمل في خدمة ذكرياته على الدوام )
# (إن مجموعات بشرية تحب العزلة، وتفضل معاشرة الكلاب على الإختلاط بالشعوب الأخرى ، حريّ بها هذا المجد : تعيش في غابات نباح . فالحضارة مثل المخلوق الحي ، متى ما شعر بتخمة الإستعلاء ، يكون قد أجهز على نفسه بمصير مغلق أو غامض )
# (أجل يا آدم. فالعنصرية تراث من طراز معقّد. وهي ضربة قاضية لماهية الإنسان.
الشرق الذي هربت من عبودياته المختلفة، لتلتجيء للغرب الديموقراطي المفتوح، سيستعيدك ذات يوم، مادمت ترفض عبودية الغرب لك. لذلك ترى الإثنين – الغرب والشرق أقصد – يدفعان بك إلى الحفرة. فحيث ترفض استعبادية الغرب، يضغط عليك الفرنجة، لتعود إلى مواقعك الأولى عبداً لأنظمة ما تزال مُستعبدة من قبلهم. وتاليا لتكون منضبطا داخل السرب. إنها ينابيع الاستبداد القديمة. ولكن تذكر أن من يبتسم لك في هذه البلاد، إنما يشتم سلالتك في أفضل تقدير أو احتمال).
تمهيـــد :
إن الموضوعة التي يعالجها الشاعر والروائي العراقي “أسعد الجبوري” في روايته الأخيرة “ديسكولاند” هي موضوعة متفرّدة لا أعتقد – وبقدر متابعتي للإنتاج السردي العراقي والعربي – أن كاتبا آخر غيره قد عالجها بهذه السعة والدقة والشمول. فقد تصدى اسعد لمعضلة هائلة، لعل أول علامات صعوبتها المضنية، هي أنها أقرب للأطروحات الفلسفية والفكرية منها إلى الأطروحات الاجتماعية والنفسية، التي تكون أكثر يسرا على الروائي عند التعاطي معها سرديا ، فالفن ليس من مسؤوليته التنظير الفكري والتأطير الفلسفي للمعضلات الوجودية، بالرغم من أنه يغوص في أعماقها، وقد يستبق المختصين في كشف إرهاصاتها والتقاط نواها الأولية ؛ واجب الفن هو أن يلتفت جماليا إلى أوجه الشقاء البشري – وهو أكثر بكثير من نعيمه وأولى منه – لـ “يصوّره” بأكثر الصور نفاذا مؤلما وقاسيا في النفس البشرية، وليهز عن هذا الطريق أسس التفكير ومقومات العقل . فدستويفسكي – مثلا – لم يطرح في روايته الجريمة والعقاب على سبيل المثال افتراضات نظرية تمهيدية حول العدالة وصراع الخير والشر، ثم يأتي بحادثة قتل بطلها راسكولينيكوف للمرابية اليهودية من أجل تحقيق “مشروعه” في تخليص سونيا – كأنموذج فردي واحد مسحوق – من مهانتها وفقرها بعد امتلاك المال ، بل طرح الحادثة الجرمية الدامية وضمنها المعطيات الفكرية المريرة والشائكة التي يؤمن بها، والتي شوّشت ذهنه وأربكت حياته هو أولا قبل المتلقي . وقد حاول أسعد الجبوري جاهدا في روايته “ديسكولاند” هذه، أن يمرّر رؤاه الفكرية حول محنة عالمية مريرة لم تأخذ حظّها الوافي من البحث العلمي والإستقصاء النفسي والتناول السردي عالميا بشكل عام، وفي الحياة الغربية، وهي المعنية بها أساسا بشكل خاص . وحين يمضي القاريء مع وقائع الرواية الكثيرة المتراكبة ذات الإيقاع اللاهث، فإنه قد يشعر بأن المعضلة بعيدة نوعا ما عن الهموم والإنشغالات اليومية الوجودية والنفسية والاجتماعية، وحتى السياسية، التي يتقلب على جمرها منذ مئات السنين. فقد يتصور هذا القاريء ذو النوايا البريئة أن محنة “العنصرية – racism ” قد انطوت صفحتها بدرجة كبيرة جدا في القرن الحادي والعشرين، الذي دخلنا بخطوات قلقة ومرعوبة عقده الثاني. وفي الغرب – وعلى مستوى المرجعيات السياسية والبحثية المؤدلجة بشكل خاص– يبدو أن العقل يعيش حالة من “الإنكار – denial” و”المقاومة – resistance”، وهما آليتان دفاعيتان نفسيتان يلجأ إليهما الإنسان لاشعوريا لتخفيف حدة الشعور بالقلق المرتبط بالإحساس بالإثم في المواقف الفكرية والسلوكية التي تثيرهما. إن العقل الغربي يعيش في ما أسماه المفكر العراقي الراحل “علي الوردي” بـ “القوقعة البشرية”، وهو مصطلح اجترحه كمرادف لمصطلح (الإطار الفكري)، الذي يحيط بعقل الفرد ووجوده، ويحدد مسارات إدراكه وأحكامه. وهذه القوقعة تكون في أوج قوتها في سنوات الطفولة المبكرة. وكلما كبر الإنسان وزادت تجاربه ضعفت فيه هذه (النظرة القوقعية) ولكنها لا تموت أبدا. ويصعب على الإنسان التخلص من قوقعته مهما حاول، فهي تكتنفه بصورة لاشعورية، وتخلق نوعا من (الغربال اللاشعوري) يغربل الأقوال التي تُقال عن شخص فلا يدعها تصل إليه على حقيقتها. ويتساوى في هذه القوقعة في النوع العامة والمثقفون ورجال الدين وقادة السياسة والزعماء والفلاسفة ولكنهم يختلفون من ناحية درجتها. فـ (الظاهر أن الفلاسفة لا يختلفون عن العامة في هذا. مزية الفلاسفة أنهم يتكلمون فلا يرد أحد عليهم مخافة أن يتهمه الناس بالغباوة أو الغفلة أو الجهل. ولهذا ملأ الفلاسفة القدماء كتبهم بالسخافات وصدق بها الناس. ولو جمعنا الفلاسفة في صعيد واحد، وقلنا لهم اتفقوا على رأي صحيح نصلح به الناس ، لتجادلوا وتخاصموا .. ولظن كل منهم أنه أتى بالرأي الصواب) (2).
ومن الواضح أن هذه القوقعة المحيطة بالعقل الغربي جمعيا وفرديا، تتصلب طبقاتها، وتتشابك أذرعها الأخطبوطية يوما بعد يوم إلى الحد الذي تشوّش فيه النظرة العلمية، بل تعمي البصيرة قبل البصر في التعامل مع المعضلات، التي تحاصر المصير البشري في المجتمع الإنساني. وقد أوصلت هذه القوقعة الغرب، حكومات ومجتمعات، إلى انتقائية مرضيّة عجيبة. تصوّر أن الغرب قد اعترض على الحكومة العراقية لأنها رسمت صورة السفاح (جورج بوش الأب)، قاتل الأطفال حسب وصف الجواهري الكبير في قصيدته المعروفة، على مدخل فندق الرشيد بحيث يدوسه من يدخل إلى الفندق، وعدّوا هذه الخطوة مضادة للديموقراطية ولحقوق الإنسان (قتل هذا المجرم 400 طفل عراقي في محرقة العامرية)، في حين أنهم يعدّون رسم صورة النبي محمد (ص) على هيئة خنزير من قبل رسام دانماركي من باب الحرية الشخصية، وشجبوا ردود فعل المسلمين الساخطة التي كانت “غذائية”، لم تتجاوز مقاطعة الجبنة الدنماركية!!
وقد حاول أسعد الجبوري، بجرأة ومهارة فنية عالية، وعزم سردي لا يلين، وعبر (356) صفحة من الوقائع المريرة المتلاحقة الصاخبة ، تمزيق البراقع عن “قوقعة” العنصرية التي باتت تخنق المجتمعات الغربية، وترسم سلوكياتها بتعسف، وبما يلحق أفدح الأضرار بالمجتمعات الأخرى، برغم أن الجميع هناك لا يقوى على الإعتراف بها.
وحيداً في صقيع الديسكولاند :
تبدأ الرواية بعرض الحال الموجع لـ “مالك” المهاجر من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصقيع الإسكندنافي، والمستقر حاليا في بلاد “الديسكولاند” عاملا في حوض بناء السفن لعشرة أيام كان من المنتظر – وكنتيجة متوقعة – أن يتكيّف مع متطلبات المجتمع الجديد مقاوما جفاف الإغتراب وموجات الموت المبكر كما يقول، إلا أنه لم يستطع تحقيق ذلك . لقد عاش نهبا لمشاعر الإغتراب عن ذاته وعن محيطه ، وعالقا في مصيدة دوامة اجترار الأفكار والذكريات السود التي تنبثق من جوف الإحساس بالعزلة الخانقة :
(… ذلك ما حدث معي طوال سنوات الإغتراب ، فقد بت أشعر بأن وجودي الشخصي ليس إلا كومة عظام معلقة على ظلام متحجر، مما دفعني لخوض المعارك تلو المعارك مع رأسي لمحو تلك الصورة ، خاصة في اللحظات التي أرفع فيها صفائح الحديد لوضعها على سطوح الرافعات الضخمة. كانت فكرة تحوّل المرء إلى مخلوق من مواد صلبة ، هو ما كان يفتتني ويرعبني في آن واحد – ص 10 ) .
في الوقت الذي رفض فيه وجوده الكلي ، روحا وعقلا، تقبّل المكان الجديد وكأنه جرثومة مميتة، فإنه لم يستطع خلع ذكريات المكان القديم. وهذا الصراع هو الطريق المستقيمة نحو الكارثة بالنسبة لأي مهاجر. وإذ استولى هذا الصراع على عقل مالك ووجوده بأكمله، فإن النتاج الطبيعي هو الغرق في خضم ذكريات وتأملات متلاطمة يكون تمظهرها الاساسي هو “الشرود” الدائم والثابت، الذي لفت إليه أنظار المشرفين على العمل برغم نشاطه وطموحه. ولهذا السبب استدعاه الآن مدير حوض بناء السفن (السيّد فرانك) إلى مكتبه. وفي محاولة لتخليصه من “مرض” الشرود هذا، طلب منه المدير أن يتحدث إليه عن طفولته، فهي مصدر تيار الذكريات والأفكار التي تتضارب في ذهنه وتمنعه من التركيز على المتغيرات المحيطة به. وفي استدعائه لطفولته يستذكر مالك الكيفية التي نُفخت فيها طقوس ولادته، لتمنحه وجودا اصطناعيا متنفجا، مخلوعا من حضن أمه الحاني، ومرميا في أحضان ذكورية خشنة وقاسية، حيث تُمنع عليه الرضاعة من ثدي أمه المنعم وتُفرض عليه الرضاعة من النوق مباشرة ليصبح أكثر جلدا على الآلام وأكثر تحملا لمشاق الحياة. وبدلا من أن توزع الحلوى على الناس فرحا بولادته، وزعت البنادق والأعتدة لتشتعل سماء المدينة بأضواء الرصاص. وعوضا عن نحر الخراف، قُطعت رقاب الأعداء من أسرى القبائل وسجنائها ممن كانوا محتجزين في قلعة جدّه (ص 15). لقد خُلع من حضن الأمومة (الأنوثة المسالمة والعادلة والمتصالحة مع ذاتها ومع الطبيعة- humanbeing among nature) الفردوسي وألقي في حضن جدّه (الذكورة المعادية والمنحازة والمتصارعة ضد ذاتها وضد الطبيعة- humanbeing against nature ) في محاولة مستميتة لنفخ ذاته بمقومات ذكورة اصطناعية افتقدت أهم ركائزها متمثلة في النمو الطبيعي الراكز في فردوس الأمومة أولا. والطفل الذي لا تدرّبه يد الأمومة (الأم هي المعلم الأول وجوديا وفلسفيا) أولا على الحب، لن يصبح قادرا على محبة نفسه، ولا على التناغم مع مشاعر الآخرين. ولهذا عاش مالك، وهو يشعر بعزلة قاتلة، وهو وسط أهله وقومه وعلى تربة وطنه، حالما – بفعل الحرمان – بالبحر كرمز مكافيء للرحم الأمومي المفقود ومنذ سنوات طفولته الأولى، عابرا إليه – لأن بيئته صحراوية جرداء – من زرقة، والزرقة لون الأمومة، عالم إرهاصاته الداخلية ، عالم مائي يذكّر بالرحم الأمومي الحاني :
(شعرت بالوحدة. أجل يا سيّد فرانك، لم أحس بتعاطف مخلوق واحد مع طفولتي. لكن، وعلى الرغم من أن جدّي لا يملك من البحار بحرا، وهو ما كان ينقصه بالفعل، إلا أنني استطعت تخيّل البحر للمرة الأولى… لا أعرف كيف قفز ذلك المشهد الأزرق الشاسع لدماغي آنذاك. فقد تخيّلت السفن بيوتا مشيّدة تمشي على سطح المياه.. قد يكون السراب الصحراوي هو الذي أوحى لي بتلك الصورة – ص 15) .
هنا تتقطع أنفاس المدير ويسقط منهارابرغم أنه لم يسمع سوى جزء بسيط من طفولة مالك المفقودة، وتنقله سيارة إسعاف إلى المشفى. ومن هنا- وعلى امتداد مسار الرواية الطويل- قد يقع القاريء في مصيدة تصوّر سطحي ومباشر مفاده أن حادثة انهيار المدير واحتباس أنفاسه هي حركة ساخرة مبالغ فيها من أجل إضفاء روح فكهة على مناخ الرواية. لكن ما سنراه يشي بخلاف ذلك. وسيثبت التحليل أن ما سنحيا في خضمّه هو ليس من نوع الكوميديا السوداء إلا بالقدر الذي توقعنا في شباكه مقاوماتنا ونزوع عقلنا التبريري (الإنسان ليس كائنا منطقيا بل تبريريا- not rational but rationalized humanbeing ). نحن نقف مع أسعد على عتبة (أقصى الواقع) والتي سنواجه بعدها (الجنون) ممنطقا ومعقلنا كما سنكشف ذلك.
يهرب مالك من مكتب المدير وهو مغيّب الوعي بفعل الخمرة، والخمرة واحدة من سبل ترميم الواقع النفسي الممزق للمهاجر غير المتكيّف. ومالك في حالة هجرة (دائمة) منذ أن اكتوى بنيران الهجرة المريرة الأولى من حضن الأمومة (الأنوثة) إلى حضن الذكورة. وضمن “مرض” السفر الدائم في الزمان أو المكان أو كليهما، والذي يترتب على صدمة الإنخلاع من الحضن الأمومي، تأتي دوامة “السفر” في “بحر” الذاكرة العارم والخطير. لا تمر لحظة على مالك دون أن “يسافر” تائها في محيط ذاكرته الهائج ، فمن تصوّر نفسه كلوح سومري أصابه الإضطراب في لحظة غامضة من الزمن، فجاء محمولا إلى حوض بناء السفن الإسكندنافي الصقيعي، إلى التفكير بتشييء ذاته إلى كمنجة أو آلة تنطق.. فتصوّر نفسه صاحب جيش جرار منهك.. وغيرها من الهواجس والصور المتلاطمة التي تعبر عن القلق من اهتزاز صورة الذات وعدم ثباتها؛ هذا القلق الذي جسّدته الصورة التي رسمها وعيه المشوش ببلاغة عبر التساؤل:
(كيف لنطفة شرقية مثلي أن تغادر رحمها الطبيعي، فتصبح قشّة في هذا التيه المخيف الموحش؟ – ص 6) .
ولم يكن بحثه عن فردوس رحمي جديد- بحريّ هذه المرة- معوضا بكفاية عن حرمانات حياته القاسية الماضية، فقد جاء صقيعيا ليمثل الطرف القصي من المتصل – continuum البيئي، صقيع مقابل صحراء؛ صقيع يجمد أوصال الروح قبل أطراف الجسد؛ صقيع حتى العمال من المواطنين الأصليين يرفضون العمل فيه في حين يُنسب العمال المهاجرون- ومالك منهم- للعمل فيه كخطوة أولى في التمييز في العالم الجديد. عالم لم يكن له فيه من خلٍّ غير المصطبة الحجرية في وحدة مروّعة لم يخدشها سوى حضور رجل ضخم جاء ليجلس إلى جواره على المصطبة. كان مالك يتوقع أن هذا الرجل سوف يخفف وحشته القاتمة، لكنه مد يده لمداعبة عضوه التناسلي!! (وسنرى أهمية هذه الإشارة الجنسية التي تبدو مُقحمة لاحقا).
هكذا تتراكم الخيبات الواحدة فوق الأخرى، وعبر عشر سنوات متلاحقات من رحلات “السفر” الدائم المضنية في المكان. ومن هذه الرحلات الفعلية- وليست المتخيلة في أكثرها- هي رحلته مع “جينفرس” التي التقاها مصادفة فقادته في رحلة إلى أقصى الصقيع حيث تعارف جسداهما، هو القادم من الصحراء وهي الراكزة في الصقيع، لتكون نتيجة هذا التعارف، الحامي جنسيا، والمتناشز معرفيا كما تدل على ذلك تفصيلات الحوار بينه وبينها، وهما يستعدان لممارسة الجنس، طفلا خديجا أسماه أبوه “المثنى” تيمنا بثنائية فصيلتين من الجينات التي اتحدت ذات يوم تحت تأثير طغيان من الشهوات المشتركة (ص 31)، كما كان مالك يرى، لكن عاصفة الحب بين الأبوين مالك وجينفرس سرعان ما همدت لتنتهي العلاقة بالإنفصال، وليحيى المثنى وحيدا، ليس بسبب اتفصال والديه عن بعضهما ثم موت أبيه، وهو في السادسة عشر من عمره حسب، بل لأنه واجه مقتا اجتماعيا متصاعدا من السكان الأصليين أوصله إلى عزلة بايولوجية ونفسية مؤلمة. كان الآخرون يسمونه “الخنزير الأسود” ويحملون أمّه وزر تلويث الدم الصافي في اختلاط غير شرعي مع فصيلة دم الشخص الطارىء الغريب (أي مالك). ولم تفلح كل محاولاته الهروبية في تخفيف هجمة العنصرية التي حاصرته من كل جانب. ومن الغريب أن حاله ينطبق على حالة أبيه التي وصفناها سابقا، حتى في التعبيرات اللغوية التي تصور آلام عزلته فقد (تحولت منازل الغرباء إلى ما يشبه أكوام قش تطفو على أسطح مياه لوّثها الطمي الإجتماعي والإنهيارات الكبرى لأحقاد بلغت ذروتها بطوفان العنصرية – ص 32).
إن وجوده، هو نفسه، وجود القشّة التي تتلاعب بها أمواج بحر التيه المتلاطمة. بل يصل التطابق حتى المماهاة – identification الكاملة في الإنفعالات النفسية حيث عاد الإبن إلى المعاناة من رحلة “السفر” المزمنة في المكان! مثلما عانى منها الأب الذي أوصى إبنه بخلاصة تجربته الإغترابية بقوله :
(لو بحثت عن العدالة الشاملة على الارض يا مثنى، فلن تجدها إلا نسخة مستهلكة لعالم أحرق صورتك حتى قبل أن تولد أو يرى ملامحك من قبل. فالأرض التي تحت قدميك الآن، يا بني، ستكون مستنقعا آسنا، تتصاعد منه رائحة العزلة. فالإندماج، وعندما يصبح قبرا مثاليا، فما عليك إلا مغادرة المناطق المشيّدة على أساس محو الآخرين. تذكّر ذلك يا ولدي، ولا يأخذك هوس الإرتباط بتيه جديد – ص 33).
وبالرغم من أن كل الشواهد المحيطة بالمثنى تؤكد صحة وصيّة أبيه، وآخرها طرده من قسم الإلكترون في كلية العلوم التي تخصص فيها، بسبب محاصرة الآخرين له من أساتذة وطلاب، كانوا يتهمونه صراحة، بأنه يريد إتقان هذا العلم، ليس لخدمة الديسكولاند التي يعيش على أرضها، ولكن لنقل هذه الخبرات إلى بلاده التي ينتمي إليها بروحه وبدمه:
(شرقكم ضدّنا دائما – ص 34)
… إلا أن المثنى كان في رحلة “سفر” متذبذبة تؤرجحه بين قناعتين متضادتين ..
# وقفة : إنه واقع وليس استشرافا :
ما وضعه اسعد الجبوري على لسان بطله مالك، وعلى لسان الراوي المستتر، من أن طوفان العنصرية سيكتسح، أو انه اكتسح فعليا، ارض الديسكولاند التي تؤمن بالديموقراطية والحرية والمساواة، ليست فذلكة سردية أو تخييلا حكائيا، ولا هو استشراف قد يضعه البعض في موضع “النبوءة”. إنه نتاج قراءة حقيقية لمتغيرات واقع “الديسكولاند” التي عايشها الكاتب فعليا، كما أن التحليل الدقيق للفلسفة المادية، التي حكمت العقل الأوربي وحركة مجتمعاته منذ عصر التنوير حتى يومنا هذا، تشير بما لا يقبل اللبس إلى أن الخاتمة الطبيعية للفلسفة الغربية هذه في مرحلتيها الحداثية وما بعد الحداثية ليست العنصرية حسب بل الإبادة (إبادة الآخر) أيضا. وصحيح أن الكاتب قد اختار زمناً مستقبليا يمتد من يوم الأربعاء من سبتمبر من عام 2021 إلى صيف عام 2056 لوقائع وأحداث “سوف تجري” على أرض الديسكولاند، لكن كل المعطيات التاريخية والفلسفية والاجتماعية القديمة والراهنة تشير إلى أن هذه الوقائع قد “جرت” منذ قرون وعقود. (وقد بيّن كاتب مدخل العنصريّة في دائرة المعارف البريطانية أنه ليس من المصادفة أن العنصريّة ازدهرت في وقت حدوث الموجة الثانية الكبيرة من التوسّع الاستعماري الأوروبي والزحف على أفريقية (حوالي 1870 م)- وهو وقت ظهور الصهيونية وبداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين.
وقد بيّن المفكر النازي ألفرد روزنبرج- في أثناء محاكمته في نورمبرج- أن العنصرية جزء أصيل من الحضارة الغربية الحديثة، وأكّد لقضاته أن هناك علاقة عضوية بين العنصرية والاستعمار. وقد أشار إلى أنه عثر على لفظة سوبرمان في كتاب عن حياة اللورد كتشنر، وهو الرجل الذي قهر العالم، كما أكد أنه صادف عبارة العنصر السيّد في مؤلفات عالم الأجناس الأميركي ماديسون جرانت والعلّامة الفرنسي جورج دي لابوج، وأضاف قائلا: (إن هذا النوع من الأنثروبولوجيا العنصرية ليس سوى اكتشاف بيولوجي جاء في ختام الأبحاث التي دامت 400 عام) أي منذ عصر النهضة في الغرب وبداية مشروع التحديث. ومعنى هذا أن العنصرية ليست مرتبطة بالإستعمار وإنما بالرؤية المعرفية العلمانية والإمبريالية وبمشروع الإنسان الغربي التحديثي. وقد كان روزنبرج محقا في أقواله، فالمركزية التي منحها الإنسان الغربي لنفسه منذ عصر نهضته باعتباره كائنا ماديا متفوقا على الآخرين، وكيف تصاعد هذا الإتجاه حتى وصل الذروة في القرن التاسع عشر حين أصبحت العنصرية أحد الأطر المرجعية الرئيسية للإنسان الغربي. وظهر علماء مثل جورج دي لابوج الذي أشار إليه روزنبرج، الذي انطلق من نظرية المجتمع ككيان عضوي، وأكد أن الجنس الإنساني لا يختلف عن الجنس الحيواني، أي أن كليهما ينتمي إلى عالم الطبيعة. ولذا دعا إلى أخلاقيات جديدة مبنية على الإنتخاب الطبيعي وعلى الصراع الدائم والبقاء للأصلح بدلا من الأخلاق المسيحية. وانطلاقا من كل هذه المفاهيم المحورية في الحضارة العلمانية، فهذه هي فلسفة داروين ونيتشه ووليام جيمس، طرح دي لابورج تصوره لتفوق الجنس الآري باعتباره الجنس الأرقى الأقدر على الصراع وذبح الآخرين. ولم يكن دي لابورج وحده ضالعا في مثل هذه الأفكار، إذ كان يشاركه فيها جو بينو وهيبوليت تين وجوستاف لوبون وإدموند درومون. وقد روج لهذه الأفكار في ألمانيا أوتو أمون وأرنست هايكل وإدموند فينيننجر (المفكر الألماني اليهودي الذي تأثر به هتلر) وهوستون تشامبرلين (الإنجليزي الأصل). أما في إنجلترا فقد كان هناك و.ف. إدواردز وتوماس أرنولد (والد الشاعر والمفكر المشهور ماثيو أرنولد) وجيمس هنت مؤسس جمعية لندن الأنثروبولوجية الذي ذهب إلى أن الطريقة الوحيدة لجعل علم الأنثروبولوجيا أكثر حيادية هو تحريره من القيم الأخلاقية الإنسانية مثل نظرية الحقوق الداعية إلى تساوي البشر. وكان من أهم المفكرين روبرت نوكس الذي أثرت أفكاره في داروين صاحب نظرية التطور الذي كان من اليسير على دعاة العنصرية أن يتبنوا منظورها اللاأخلاقي كما فعل نيتشه – ص 184 و185 و186 ) (3).
# عودة : قيامة ديناصورات العنصرية :
وهاتان القناعتان المتضادتان اللتان يتأرجح بينهما “المثنى” بألم، تستأثران بالكثير من المحفزات؛ منها ما هو داخلي تؤججه ذكريات ورسائل أمه لأبيه مالك، ومنها ما هو خارجي كالذي مثلته الإمرأة التي جلست بجواره في الباص وزرعت في ذهنه عبارات “رسولية” منصفة :
(أصبحنا أشبه بالمصابيح العمياء. فلا تعط لذلك اهتماما. التاريخ ذات يوم، سيضحك منا كثيرا. هل تعرف بأن أوروبا مليئة بفرنجة يحسون بالغربة في بلادهم أكثر من الأجانب. وبفرنجة ملحدون ودمويون وعرقيون، وبفرنجة فلاسفة لا يودون رؤية التعفن وهو يلتهم هذه الأرض التي نسكن عليها، والتي باتت شبه مستهلكة بالتمام – ص 36 ).
لكن عبارات الإمرأة الملاك هذه ما هي إلا قطرة بيضاء وسط لجّة طوفان اسود كان يتمطى لاكتساح البلاد بأكملها. فقد تصاعد نشاط الجماعات اليمينية المناهضة لوجود الأجانب في البلاد، وفي مقدمتها اليد المسلحة الضاربة، “عصابة الثيران الفولاذية”، التي قامت بقتل عشرة أطفال في إحدى رياض الأطفال كلهم من الديسكولانديين، فألبت الرأي العام ضد الأجانب، وأشعلت فتيل برميل البارود، لتبدأ قوانين الفصل العنصري، مترافقة مع حملات قتل الأجانب، الذين امتلأت المستشفيات بجرحاهم وقتلاهم، ومنهم المثنى الذي هاجمه مجهولان برش نوع من الغاز على عينيه. لقد قامت “قيامة ديناصورات العنصرية”- لاحظ أن عنوان الرواية التي سيكلف بكتابتها “السومري” لاحقا هو “قيامة الديناصور”!- كما وصفها المثنى، الذي تجمع الجرحى في غرفته الآن بصفته مدير “نادي الأجانب” الذي كان يدعو إلى التعقّل والتسامح وامتصاص العدوان وعدم إعطاء الديسكولانديين العنصريين الفرصة لمزيد من العدوان، في حين كانت أغلبية من تحلقوا حول سريره تطالب بالرد العنيف المقابل (ما ينقصنا هي المواجهة وليس الغفران – ص 42)، وتستعرض العديد من حوادث التقتيل والإغتصاب.
يتصاعد النقاش في غرفة المثنى لإيجاد حلول منها، مثلا، عودة المهاجرين إلى بلدانهم، فيرد واحد بالقول أن الكثير من المهاجرين لا يستطيعون العودة بسبب الظروف السياسية القمعية في بلدانهم الأصلية. ويكمل آخر برأي أكثر نضجا، وهو أن المهاجرين يؤدون في الواقع واجبا إنسانيا هنا بمواجهة العنصريين الديسكولانديين لأن رياح العنصرية إن انتصرت هنا، فإنها ستجتاح كل شيء، وكل مكان . يعلق المثنى على هذا الرأي قائلا:
(لا أعتقد بأن لدى الأوروبيين فائضا بشريا، ليكون ثمنا لهلوسات عصابات دموية مسعورة مازال هتلر يقودها من قبره. لقد شن النازي الأول حروبه القديمة بأسلحة تقليدية. أما هؤلاء، وإذا ما سيطروا على بلد أوروبي صغير المساحة وقليل السكان مثل ديسكولاند مثلا، فسيسيطرون على أسلحة متطورة وحديثة، يكون ثقلها التدميري شاملا، أسلحة لم تكن معروفة لدى هتلر أو السوفيت أو الإنكليز سابقا.
ولا ننسى استعداد دولة عظمى لدعم هؤلاء، بهدف زعزعة استقرار أوروبا. فهي تريد لبلد ما من بلدان أوروبا بأن يكون سكينا في الخاصرة الأوروبية. لذلك فقد تمكن هذه العصابات من لعب مثل ذلك الدور التأديبي مستقبلا – ص 44 ) .
ومن المهم التوقف على ما يبثه الكاتب على لسان شخوصه من إشارات صريحة إلى العصابات النازية وشيوع مفهومي العنصرية والنازية (مرتبطة بهتلر تأريخيا بطبيعة الحال) في الديسكولاند خصوصا، وفي العالم الغربي عموما. فقد يتصور المتلقي، أن هذه الإشارات متحاملة، أو أنها لا تمتلك مبرراتها على صعيد الحياة الواقعية التي نرقبها في العالم الغربي، والتي تعيشها المجتمعات الغربية في حركتها الراهنة التي تحكمها مفاهيم الديموقراطية والحريات الشخصية. ومن المهم إحالة ذهن القاريء إلى حقيقة مغيّبة وخطيرة تتمثل في أن ما رسخه الغرب في أذهاننا، هو أن النازية هي نتاج “ألماني” نهض به هتلر قبل وبعد تسلمه للسلطة، وأشعل حربا عالمية مدمرة لتمرير أفكاره المركزية المتمثلة في النقاء العنصري والبقاء للأصلح وعبء الإنسان الأبيض وضرورة تعقيم واجتثاث الأعراق “المنحطة” و”الملوثة” و”المتخلفة” كاليهود والزنوج والعرب والغجر .. إلخ. يجب التنبه إلى أن النازية هي نتاج طبيعي للفلسفة المادية التي حكمت العقل الغربي منذ عصر الأنوار والتي بدأت بتمجيد مركزية الإنسان، لتمر وتتصاعد بإعلان موت الإله، ولتنتهي الآن بإعلان موت الإنسان.
يذهب المثنى إلى شقة عشيقته السابقة “فيبيكا” لاستعمال الهاتف بعد أن عُطّلت جميع هواتف الأجانب تحت حالة الطواريء التي فُرضت على البلاد بعد اغتيال ملكها بتدبير من الحركات والعصابات النازية والعنصرية التي سرعان ما ألصقت التهمة بالأجانب. وبدأت الحملة الدموية “الوطنية” المسلحة لاجتثاث الأجانب من البلاد. وفي شقة فيبيكا يحاول المثنى سبر نوايا صديقته في هذا الظرف العصيب. يحاول امتحان التاريخ والجغرافيا في مساحة غرفة، وفي سرعة تشبه سرعة البرق (ص 54)، حسب التعبير الموفق للكاتب، الذي يورد هذا الحوار البليغ بينهما:
(فيبيكا: أنتم مجموعة تواريخ نختصرها بعبارة واحدة : الجثة التي لابدّ لرائحتها من الإختفاء. قد لا يليق بي أن أتلفظ بهذه النفاية .. ولكن ماذا نفعل ؟ أصبحت أفواهنا أشبه بالبراميل التي لا يتكدس فيها غير الهراء المتعفن الذي سيخنقنا ذات يوم قادم ؟
المثنى: نحن لا نخاف من هذه الإندفاعات ولا نريد حلا مؤقتا لنزع الفتيل، لأن الضرورة تقتضي من الطرفين حلا حضاريا. بعد ذلك، يمكن التوجه نحو المقبرة للمشاركة في مراسم دفن الصراع. الآن نرى العكس، فهنا من يسعى إلى النفخ في جثّة الديناصور العنصري العرقي الفاشي النازي، بهدف تحريك الدم في عروقه وإعادته للعمل على الأرض.
…………….
المثنى: مازال جنوب العالم يلملم شظايا أطراف جسده المبعثرة. ويعجز عن الدفاع عن كيانه. أنتم تحاولون وضعه خارج الخندق. تريدونه مكشوفا في العراء، علما بأنه ليس بذلك المارد الأسطوري الذي يحمل على ظهره كل ما استطاعت التكنولوجيا أن تنتجه من أسلحة وتقنيات. إنه لا يملك شيئا من ذاك القبيل. فعلام تهويل ذلك بحق السماء؟
فيبيكا: ما نخشاه نحن ليس ماردا من مردة التسليح التكنولوجي، بل من المارد الديني المضاد الذي بدأ يتشكل في الرحم الأوروبي ويتمدد في مختلف الخلايا.
نحن خرجنا على الكنيسة. تركناها متاحف وأطلالا مهجورة كما ترى. لقد قتلنا الربّ واسترحنا، بعبارة أدق: ضيّعناه منذ زمن بعيد، ولا نمتلك الرغبة بعودته من جديد. أنتم تصرّون على أن نعيده مرة أخرى إلى دياره، ونحن نرفض ونحاول المقاومة.
- هذا ليس هو الجوهر. الغرب استبدل الله بأسلحة القوة، ويحاول انتزاع الجنوب من جذوره القديمة، أي بجعلهما خاضعين لترسانة شرائعه المُنتجة من الحديد والمظالم. فالله الذي مات لديكم، صيّرتموه جنرالا مسلّحا للقرصنة والسيطرة وللإخافة. لذلك يا عزيزتي، فكل الصراع يتعلق بمن يحكم العالم. صورتنا الراهنة، صورة عبيد جديرين بالطاعة وحسب، هذا إذا كنتم تحتاجونها فعلا. فالطاعة المتناهية إلى حدود محو الكيان، تثير القرف في أنفسكم، لأنها تمنع الحاكم من التلذذ بالهلع الذي ينتاب المحكوم بالموت.
- أراكَ متأكدا من هذا .
- منذ زمن بعيد. فالإنسان الشرقي هو االتلميذ الفارغ. التلميذ الذي لا ينجو من عقوبات الأساتذة الفرنجة على تخلفه ودونيته التي يريدون منه أن يحملها إلى قبره. هذه هي أغلب مدارس الغرب وأفكارها. إنها الطعام الصحي الوحيد للعقل الشرقي، أو لبقية عقول مجمعات التخلف في العالم الثالث. أليست هذه حقيقة يا فيبيكا ؟- ص 57).
وقفة :
(وقد أشار المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا “فاكيلاف هافل” – الذي رحل هذا الأسبوع – إلى ما أسماه “إسكاتولوجيا اللاشخصي”، وهو اتجاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكم من خلال آليات ضخمة مثل المشروعات الضخمة والحكومات التي لا وجه لها، والتي تفلت من التحكم الإنساني، وتشكل تهديدا كبيرا لعالمنا الحديث. ويبيّن هافل أنه لا يوجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثل شل وآي. بي. إم والشركات الإشتراكية الكبرى، فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب البعد الإنساني منها. ولذلك تصبح مسألة طابع الملكية هنا، أي ما إذا كانت فردية أم جماعية، رأسمالية أم اشتراكية، إشكالية غير ذات موضوع.
وحينما سئل هافل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع أجاب قائلا:
(هذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ البشري. فلم يعد الناس يحترمون القيم الميتافيزيقية العليا، والتي تمثل شيئا أعلى مرتبة منهم، شيئا مفعما بالأسرار. وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي، إذ إنني أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز. هذه الإعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة للناس وأفقا لهم، ولكنها فُقدت الآن. وتكمن المفارقة، أننا بفقداننا إياها نفقد قبضتنا على المدنية، التي أصبحت تسير بلا أي تحكّم من جانبنا. فحينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأ العالم يفقد بعده الإنساني- ص 150 ) (4).
# عودة : العنصرية تشتعل.. تساؤلات سردية :
بعد عملية اغتيال ملك الديسكولاند من قبل عصابات “الثيران الفولاذية” العنصرية الديسكولاندية، استولى زعيمها “جو كريس” على الحكم، فعاث في الأرض فسادا، حيث شملت إجراءاته العنفية القمعية الجميع بلا استثناء، مهاجرين ومواطنين أصليين، بالرغم من أنها كانت موجهة أصلا ضد الأجانب. وهذه سمة مركزية في الديكتاتوريات العنيفة التي لا توفّر في عنفها أحدا. وهذا ينطبق على الأنظمة والأيديولوجيات العنصرية التي تبدأ بفرز الأعراق والإثنيات “الملوّثة” وتعمل على تخليص الجسد الوطني النقي منها، لتنتهي بتمزيق هذا الجسد الوطني نفسه. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هي النازية- وأكرر أن النازية هي النتاج الطبيعي للفلسفة الغربية المادية* – التي وصلت إلى سدة الحكم في ألمانيا وضمن شعاراتها تطهير الجسد الألماني من “الشوائب” الإثنية التي علقت به كاليهود والغجر .. لكن الديسكولانديين المخلصين أفرادا وجماعات ومنهم منظمة “الأرض للجميع” التي أسسها العم “هنترسين” وذراعها المسلّح الذي تزعّمه “طوروس” وهو مهاجر أجنبي من أصدقاء المثنى عُرف عنه التهوّر والميل الشديد للمغامرة المنفلتة والعنف الجامح. وبمساعدة (لوزانا)؛ زوجة الحاكم العسكري الجنرال (جو كريس) وعشيقة طوروس، يتم اغتيال الحاكم العسكري، وتتحرك الأحزاب والمنظمات الوطنية وبعض المنظمات العنصرية المنشقة مثل منظمة “HR” النازية برئاسة “وليم فير” الذي قتل في خضم الأحداث الأخيرة.
في النهاية، استطاع طوروس إنقاذ العائلة المالكة التي خطفتها الجماعات العنصرية المسلحة، والإستيلاء على مقاليد الحكم، لتبدأ مرحلة ديكتاتورية عنصرية مظلمة في أرض الديسكولاند؛ مرحلة كانت نواها تتململ وتنمو في تربة الديسكولاند نفسها، تحت طبقة كثيفة من الممارسات الديموقراطية، التي لم تكن قادرة على منع التيارات العنصرية من أن تنمو “ديموقراطيا”، وتقوى ويشتد عضدها حتى أنها قفزت إلى سدة السلطة، واستولت على مقاديرها. ولكن- هنا أيضا، وعند هذا الموضع من الرواية- تثور معضلة فكرية وسردية. فعلى امتداد المسار المقبل من الرواية وهو طويل سيكون مثال الطغيان والعنصرية والديكتاتورية باقسى صورها الدموية البشعة هو “طوروس”، المهاجر الأجنبي سابقا، والمواطن الديسكولاندي كما يُفترض حاليا.
فما الذي يبغيه الروائي من اختيار هذا الأنموذج؟
كان من المفروض، واتساقا مع سياق وقائع الرواية، أن يخيّم على البلاد شبح عنصرية وطغيان يمثله “جو كريس” (عصابة الثيران الفولاذية)، أو “وليم فير” (عصابة HR النازية) كنتاج طبيعي للتربية العنصرية المستترة والمعلنة، التي كان المواطن الديسكولاندي يترعرع على إفرازاتها السامة منذ نعومة أظافره. ولكن الروائي اختار مهاجرا أجنبيا، وصل أرض الديسكولاند، ومنح جنسيتها، ولكنها لم تستطع معاونته- كما كان يتوقع- على التكيف مع مقومات الحياة فيها، والذوبان في بُوتقتها الإجتماعية. لقد جاء إلى أرض الديسكولاند هاربا من جحيم بلاده، متصوّرا أنه سيظفر بمحطة الفردوس النهائية، حيث قانون الأمومة المفقود الذي لا يفرق بين الأبناء الذين سينعمون بالهناءة والأمن والسعادة. ولكن “الأخوة” المهاجرين الذين نبذهم الرحم الأمومي من مواطنهم الأصلية، قد يجدون عذرا لهذا النبذ على المستويين الشعوري واللاشعوري. فعلى المستوى الشعوري الظاهر، عانى هؤلاء “الأخوة” من القمع والإضطهاد من جانب، مثلما عانوا من شظف العيش في بلدان بعضها يطفو على بحيرات من الثروات في مفارقة عجيبة- بعضها أسطوري تعرض للسلب والنهب الغربي المباشر وغير المباشر- من جانب آخر. وعندما وصلوا “الأرض الموعودة” كانوا ينظرون إليه كرحم بديل. لكن ما صدموا به هو أنموذج مواز للنبذ والتمييز ومجافاة الأهداف المعلنة والمغوية التي اجتذبتهم. لقد أسهموا بفاعلية وحماسة- بالرغم من أنهم يؤمّنون في الوقت نفسه سبل عيشهم- في ديمومة عجلة الحياة في هذا البلد الذي هاجروا إليه وحملوا جنسيته. لم يعيشوا ككائنات طفيلية على جسد “الوطن” الجديد، تمتص دمه وخيراته. إن من حق أبناء أي وطن أن يشعروا بمنافسة “أوديبية” من “الأبناء” الوافدين الدخلاء، وأن يتحسبوا من أن يستولي االأبناء الدخلاء على فردوس الرحم الأمومي ويصادروا نعمه وظلاله الحامية والحانية ويستأثروا بها. لكنهم كانوا يرفعون شعارات ديموقراطية برّاقة تصوّر وطنهم/ الرحم الأمومي المنعم الذي ينعمون بأمانه، وكأنه جنة / ملاذ آمن تجذب الأبناء المهددين في مواضع أخرى وتغويهم باللوذ بها. ولكن ما حصل هو العكس، فقد واجه الأبناء “الدخلاء” قسوة أبوية ممزوجة برفض أمومي صادم، زرع في أعماق نفوسهم الخيبة والخذلان، وجعلهم يصابون بإحباط مضاعف. فإذا كانت الهجرة من الوطن/ الرحم الأمومي الاًصلي مبرّرة من بعض الوجوه، بفعل شراسة القمع الأبوي ودمويته (الأسباب السياسية)، أو بفعل ضياع فرص العمل وغلق أبواب المستقبل في وجه الشباب خصوصا (اسباب معيشية)، أو أن نزوعا شديدا نحو آفاق ومديات أكثر سعة وتألقا في المسيرة المهنية (أسباب مهنية وعلمية)، تسوق الفرد للهجرة، فإن الرفض الذي يواجه الابناء المهاجرين من قبل “الوطن”/ الرحم الأمومي الجديد غير مبرّر، خصوصا وأنه يرفل بشعارات جذب عن العدالة والنمو والرفاه والتسامح، تقف على النقيض من محددات الواقع السابق الذي هجروه. وهذا الرفض لم يكن في الديسكولاند حالة فردية عابرة أو موقفا شخصيا طارئا. كان موقفا جمعيا تقريبا عبّر عن روحه الروائي في فقرة (غبار النص)، التي طرح فيها الكيفية التي عرض فيها تلفزيون الديسكولاند لقاء أجراه مذيع محرّض مع ثلاث عجائز:
الأولى : لقد أكلوا طعامنا وأنهكوا أعصابنا بوجوههم المظلمة..
الثانية : يريدون تحويلنا إلى أفارقة .. تصوّري أنك لا تجدين قالب كاتو ولا شموعا ولا شمبانيا ولا هدايا في عيد ميلادك التسعين.
الثالثة : هل تقبلين أن يمشي وراء جنازتك أي خنزير من تلك الخنازير الأجنبية الوسخة؟
الأولى : لقد منعت أحدهم من تنظيف طيزي ، كيلا يلوثه بيديه – ص 51) .
كما أن مديات العنف المتصاعدة، لم يكن لها أن تتأجج بهذه الصورة المسعورة قبيل وبعد الإنقلاب العسكري، لو لم تكن هناك حاضنة اجتماعية ونفسية ترعرع في كنفها ووفرت له شروط النمو:
(لم تستطع قوى البوليس الضغط على رجال العصابات وإيقاف جنونهم وتوحشهم وانتشارهم المكثف في مختلف المدن. فقد توسّعت حلقات العنف بعد أن تورط الكثير من الديسكولانديين في الصراع. فيما تخندق الأجانب العزل في بيوتهم أو هربوا نحو الريف أو لجأوا لدوائر البوليس طلبا للحماية من هوس الإنتقام المجاني الأعمى الذي راح يستشري بجنون في البلاد – ص 51 ).
صحيح أن “الحشد – crowd “، يوفّر المظلة السيكولوجية الجمعية لتحقيق التماهي العام، ولتخفيف الشعور بالذنب بحيث تتفجّر اشد الحفزات عدوانية ودموية في النفس البشرية بيسر وانسعار. في ظل الحشد يمكن أن تحصل أفعال سادية لا يمكن تصوّرها من قتل وسحل وتمثيل (أسقط الباريسيون حجارة الباستيل بأظافرهم وقتل العراقيون العائلة المالكة ومثلوا بجثثها ببشاعة) كما حصل في الديسكولاند- على سبيل المثال – من حرق بشع لجثث الأجانب الذين احتجزتهم عصابة الثيران الفولاذية في الطاحونة. ولكن التأثير النفسي هذا، للحشد، يتاسس عادة على ركائز أولية مترسخة في البنية النفسية البشرية من جانب، وعلى “استعداد” للمجتمع المعني من جانب آخر. هذا “الإستعداد” الذي أثارت غيلانه المجموعات العنصرية. وبالرغم من ذلك لم تستطع هذه الموجة العارمة أن تكتسح كل منابع الإنسانية في النفوس، متمثلة بصورة رئيسية في جماعة الأرض للجميع وبقية القوى التي لم تستطع الإطاحة بقادة الإنقلاب العسكري العنصريين، إلا باللجوء إلى استخدام القوة (إرفع البندقية لنزع البندقية وتحقيق السلام كما قال “ماو”) التي برع في إدارتها “طوروس” المهاجر، الذي استولى على الحكم، وأصبح ملكا، بعد أن تزوج من “شيريهان” – المصرية (أجنبية شرقية ايضا!!) – أرملة الملك السابق “روبن شيفر” الذي تم اغتياله.
ومن جديد، ما الذي يبغيه الروائي من تصميم حبكة وفق هذه الصورة، التي يصبح فيها الأنموذج العملي الأول للعنصرية والطغيان في الغرب، مهاجرا شرقيا، يستولي على الحكم بصورة تقفز على الحيثيات الموضوعية والظروف المنطقية التي تحيط بمجتمع الديسكولاند البحر شمالي كجزء من المجتمع الغربي ؟.
وقبل أن نمضي في تساؤلاتنا يجب أن نضع في أذهاننا أن الواقع السردي يختلف عن الواقع الموضوعي، وقد يفارقه بدرجة كبيرة جدا في بعض الأحيان. هل يريد الروائي تصميم حالة فنّية توضح للديسكولانديين، بشكل صارخ، الكيفية التي ستدمّر فيها العنصرية حياتهم، فيما لو تسيّد على السلطة تيار عنصري في بلادهم ؟ ولكن – ومن جديد- لماذا مهاجر شرقي ؟ هل لأن الشرقيين مهيئين أصلا، وبحكم التجربة التاريخية، للنزعات العنصرية والسلوك الطغياني الدموي؟
قد يكون واحدا من الحلول التي يجترحها النقد، هو أن نبقى مع الروائي في إطار الحقيقة السردية؛ في إطار الواقع الفني المغاير وأحيانا المناقض للواقع الموضوعي “المادي” المباشر. ولكن التأني القرائي، والصبر التحليلي سوف يكشف الرؤيا الفريدة التي صممها الروائي لحكايته الشائكة.
# طوروس الطاغية “منقذاً” :
بعد استيلاء طوروس على الحكم، تشهد البلاد أحلك مرحلة في حياتها، من قهر واضطهاد وهدر لكرامة الإنسان. فخلال ساعات عصفت المخاوف بالديسكولانديين ، وبلغت ذروتها القصوى حين شعر الرجال، الذين شاركوا في الحرب ضد العنصرية، بأن الثأر يهرول نحوهم هرولة، كي يقتص منهم، ويسحقهم باعتبارهم مذنبين قطعوا شوطا لا بأس فيه بتعذيب وقتل وإهانة الغرباء (ص 83). وهنا بدأت أوسع هجرة في تاريخ الديسكولاند إلى الخارج عبر البحر بصورة رئيسية.
ومن هذه اللحظة السردية، وقدما، نستطيع ملاحقة المستلزمات والاشتراطات الفكرية والإجرائية (سياسيا واجتماعيا ونفسيا)، لإشادة معمار الديكتاتورية المتقن والكريه، وللكيفية التي يُصنع فيها الديكتاتور الطاغية. وهذا امتياز مُضاف لأسعد.
فأولا على الطاغية أن يصور نفسه كمنقذ منتظر/ مخلّص. ولاحظ أن كل التغييرات الكبرى- والسلبي منها بشكل خاص، نصحو عليه بعد حين عادة بسبب التغييب النفسي للبصيرة البشرية الذي تحدثه اسطورة المنقذ- تقوم على تصوير الطاغية كمخلّص، بدءا من الإسكندر، ومرورا بنابليون وهتلر، وليس انتهاء ببوش الإبن. الطاغية، هو المخلص الوحيد والأوحد، وأي محاولة لمنافسته في ذلك، ستشوه صورته الإنقاذية هذه، لأن التشارك معه في أي صفة يعني أنه “بشري” عادي. أما استئثاره بها، فهو يقربه من صورة الإله، إن لم يجعله إلها فعلا . لذلك كانت أول خطوة قمعية ملحة، قام بها طوروس، هي إعدام رئيسي تحرير الصحيفتين، اللتين نشرتا منشيتات تصوّر “لوزانا”، بطلة وطنية، استطاعت بخبرتها الماكرة ودوافعها الوطنية، أن تسحق رأس الأفعى العنصرية؛ زوجها “جو كريس”.
أما الشرط الثاني، فهو نزع، وحتى سحق القداسات القديمة، وتأسيس قداسات “مدنّسة”، سيعتاد عليها الجمهور الواسع لتصبح “مقدسات” خالصة جديدة. وفي مقدمة ذلك الإستئثار بـ “الأم” أو رموزها ومكافئاتها. من هذا القبيل قيام طوروس بالزواج من الملكة شيريهان أرملة الملك السابق (الأم السابقة). الآن أصبح طوروس أبا رمزيا حتى لو كان مكروها. وبالمناسبة فإن شحنات كره الأب هي الوجه المستتر للعملة الأوديبية في الموقف من الأب.
ثم أن عهد المنقذ يجب أن يتعمد بأضحية ذات مضامين وإيحاءات أسطورية – يتساوى في ذلك، ويا لغرابة النفس البشرية، دور المنقذ في وجهيه الإيجابي والسلبي !- .. يتعمد بدم .. ولا أخطر من مهابة الدم والقلق الذي يثيره في نفوس الأبناء. وإذا كانت ثورة الأبناء المباركة الأولى ضد الأب – وحسب أطروحة معلم فيينا- قد تعمدت بدم الأخير الأمر، الذي خلق شعورا مستديما بالذنب في نفوسهم حتى يومنا هذا، فإن تصدّي الإبن لدور الأب الطاغية، الذي سيثير حسد الأبناء/ الأخوة الآخرين، لابدّ أن يتعمد بدم بعض الأخوة/ الأبناء، لردع أكثرية الأبناءالباقية. وهذا من الإجراءات الدموية الأولى التي قام بها طوروس، حيث جعل وسائل الإعلام، تعلن أن الملكة قد أعادت العمل بعقوبة الإعدام، وأن أول حكم سيُنفّذ، هو إعدام الشابين الأجنبيين اللذين قاما بقتل سبعة من المواطنين الديسكولانديين الأصليين ابتهاجا بالعرس الملكي. إن من المهم جدا أن يُثبت الأب الطاغية، أن عدوانه وشراسته، لن توفر أحدا؛ لا مواطنا أصليا ممن أذلّوه كمهاجر، ولا مواطنا أجنبيا من أخوته المهاجرين. هكذا سيكون الجميع تحت مطرقة الرعب، كمشروع متوقع للتصفية والموت. لابدّ أن يكون المخلّص في وجهيه قرينا للموت لا للحياة. فكونه قرينا للحياة سيشوش صورته وتجعلها ذات مضمون أمومي (أنثوي خصبي)، في حين أن اقتران حضوره بالموت سيحدّد صورته كتمظهر أبوي (ذكوري خاصي).
ولعل من أخطر الإجراءات التي يقوم بها الطاغية، هي أن يعرض “عقاب” الأخوة / الأبناء السابقين على الابناء الآخرين .. على عموم الشعب كما يُسمى . (لم تنم عين واحدة في البلد. كان المواطنون يتطلعون إلى الساعة التي يشهدون فيها قامات أولئك الجناة من الأجانب، وهي تخر أرضا كالشمع الملتهب. لم تر الناس عملية إعدام واحدة في البلاد على مدار سنوات تاريخهم، لذا جاءت العائلات بأطفالها لرؤية ذلك الفيلم الخرافي الأكثر متعة من أفلام كارتون توم وجيري أو أفلام الأكشن. تدفقت الحشود البشرية وكأنها تريد رؤية يوم القيامة – ص 87 ).
حصل هذا مثلا في المدرج الروماني القديم .. وفي عهد روبسبير في فرنسا الثورة التي كن قادتها يفتخرون بأن إصدار حكم الإعدام وتنفيذه لم يكن يستغرق أكثر من خمس دقائق.. وفي إعدامات الرفاق في المرحلة الستالينية.. وفي إعدام القيادات البعثية في عام 1979.. ومع الخمير روج .. إلخ. إن عرض العقاب أمام أعين “الأبناء”، ليس لكي يشهدوا بأنفسهم، على جزاء من يحاول خرق محددات السلطة الأبوية، ولكن لكي يروا بأم أعينهم جزاءهم هم أنفسهم، فيما لو سوّلت لهم أنفسهم خرق المحظور الأبوي القامع مستقبلا. ولهذا كان النظام العراقي السابق، مثلا، يكلف “الرفاق” بتنفيذ إعدام “الرفاق”، رفاقهم، بأنفسهم وبأسلحتهم الشخصية التي سيحتفظون بها في بيوتهم علامة تذكير وحضور لبطش الطاغية، وكرمز لتهييج الشعور بالذنب، الذي سيستولي على ضمائرهم بهذا القدر أو ذاك. ناهيك عن عملية تفريغ ضغوط غريزة العدوان اللائبة عادة، عميقا في النفوس في منسرب “تأديبي”، بدلا من تفجّرها في ممارسات، قد تمس مويجاتها الصغيرة جرف السلطة الأبوية. في العراق تدافعت العائلات لمشاهدة إعدامات أعضاء شبكات التجسس ومعها قدور الدولمة والرز والحلويات !!.
وكانت هذه المناسبة، فرصة لإظهار سمة مهمة من سمات الأخ الأكبر – يذكّرنا هذا الوصف بـ “الأخ الأكبر” في رواية جورج أورويل النبوئية “1984″ – الأب الطاغية المقبل، وتتمثل في قدرته، التي لا تردد فيها، على تنفيذ العقاب بنفسه، وكأن يد الأب لابدّ أن تكون “حمراء” ابتداء، وأن تكون يد “الإثم” الاستباقي. ولعل هذا ما حدا بطوروس، إلى أن لا ينتظر إنزال القصاص بالشابين بصورة قانونية، كما هو متوقع، بل استل مسدسه الشخصي – وهو مكافيء لقضيبه رمزيّا – وأردى به أحدهما أمام أنظار الجمهور. ثم طلب من الملكة أن تطلق النار على المتهم الثاني..
نسيان (1) :
أخبرنا الكاتب على الصفحة 85 ، بأن اثنين من الأجانب، قتلا خمسة شباب وفتاتين من سكان البلاد في لحظة ثمل شديد .. ثم أكد ذلك على الصفحة 87 بأن عقوبة الإعدام أعيدت وأن محكمة ميدانية شكلت لمقاضاة مرتكبي الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة سبعة من السكان الأصليين (وهما رجلان أجنبيان كما قال).. ولكن على الصفحة 88، قال بأن طوروس أطلق النار على أحد المتهمين وأمر زوجته الملكة بإطلاق النار على شخص آخر. فيما تمت حفلة عقاب الآخرين بأيدي الرماة الآخرين !!) .
سياسة التأثيم العام :
… إن توريط الملكة والآخرين بتنفيذ عمليات الإعدام، ومشاهدتها بأنفسهم، له وجه آخر، فهو جزء من عملية “التأثيم” العام الذي يجعل الجميع مذنبين، تأثيم يحيل الأبناء – المشارك كمنفذ للعدوان، والمتفرج، بل حتى الصامت احتجاجا – كلهم في حالة دائمة وقلقة من الشعور بالذنب الذي يتطلب التكفير والتخفف الذي يدفع – ويا لعجب آليات النفس البشرية – إن لم تتوفر منافذه المناسبة، إلى المزيد من الإيغال في العدوان، الذي يتبعه تضاعف الإحساس بالإثم، الذي يتطلب بدوره التكفير .. وهكذا تدخل شعوب كاملة في حلقة مفرغة لا نهاية لها، قد تستمر عقودا طويلة ، تشهد مسيرة لا تنتهي من العذابات والخسائر والتصفيات. إن نزوع الطاغية إلى إشاعة روح الوجدان الآثم، وتلويث ضمائر الجميع، عبّر عنه طوروس في ردّه على الملكة، بعد أن أمرها بقتل المتهم الثاني، فاعترضت بأن هذا مخطط لتوريطها وزجّها داخل الشرك، حيث قال:
(بالضبط . كي لا تكون هناك يد نظيفة مقابل يد قذرة – ص 88 ).
الطاغية والقدرة الكلية الطفلية :
وفي كل فعل يجد عقل الطاغية – وهذه من مميزات العقل البشري المتأصلة – مبررا “منطقيا” لما يقوم به من أفعال وحشية. كان طوروس يتكيء على مخزون عميق لا ينضب من المبررات والأمثلة التي قدمتها له التجربة الديسكولاندية نفسها. فالتحيّز والتمييز والقهر، الذي عامل به مجتمع الديسكولاند، المهاجرين الغرباء، صار دليلا لتمرير الثأر والشعور بالحيف الذي قُمع طويلا في النفوس. لقد كان الغرب – وبـ “عمى نفسي- psychological blindness” سببته القوة المنفلتة والشعور بـ “القدرة الكلّية أو المطلقة – omnipotence”، وهي في حقيقتها من ميزات التفكير الطفلي، والتي في ديمومتها في الحياة الراشدة، تعكس اضطرابا عقليا ذهانيا – راجع تحليلنا لشخصية الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن- سنتوقف عنده لاحقا استنادا إلى أطروحات الروائي الدقيقة ومفهومه الفريد عن “الجنون”
السور العظيم :
وضمن آليات تعويض الشعور بالنقص الضاربة جذوره في الأعماق الطفلية الهشّة، يعمد الطاغية إلى “البناء” .. بناء يأتي في العادة في هيأة شواهد “ضخمة” و “طويلة” و”مدببة” و”مركبة”. ومن المؤكد أن واحدا من أهداف حملات البناء هذه، هو إشغال الجمهور الواسع إلى الحد الذي لا تتوفر لديه أي فرصة لالتقاط أنفاسه. ومثل ذلك يُقال أيضا عن المناسبات والأعياد الوطنية التي تتضاعف في عهود الطغيان. ولم يترك طوروس حدثا شخصيا إلا وخصص له يوما احتفاليا في حياة شعب الديسكولاند. حتى العملية الانتحارية الفاشلة، التي نفذها ضده مصلّح العجلات “فرانك جون” الذي كان زملاؤه من الراقدين في مشفى المجانين يشكون في كونه يعمل لصالح مخابرات الدولة، جعل لها يوما وطنيا، هو “يوم العملية الانتحارية” الذي جاء ضمن ضمن سلسلة أيام وأعياد وطنية لا تنتهي. وقد يكون إصرار الطغاة على تكثير الأعياد والمناسبات، والإحتفاء بها بضجيج الأبواق والطبول هو للتأكد من أنهم “أحياء”، فالطغاة هم كائنات الموت، كائنات “نيكروفيلية – necrophilic” تهتم بالحديد والأسمنت والحجر أكثر من الإنسان بكثير. ولهذا كانت أعظم الشواهد المعمارية عبر التاريخ مرتبطة بأسماء الطغاة ومن منجزاتهم الفريدة. وهذا ما تمثل أيضا في إصرار طوروس على بناء السور العظيم، الذي يعزل الديسكولاند عن البلدان المحيطة بها. ليمنع عنها الأوبئة والضوضاء، ويحميها من تسلل الغرباء واللصوص، كما كانت دعاية الدولة تشيع عن أهداف بنائه. لكن بناء هذا السور العظيم الذي يشبه سور الصين قد جُنّد له الشعب بأكمله في عمل مرهق ومتواصل جعل بعضهم يفقد عقله ويُصاب بالجنون كما هو حال المواطن “هاري” الذي لم يكن يمارس الجنس مع زوجته “تاستا” ليلة الأحد كي يدّخر قواه من أجل بناء الوطن. لقد جُنّد الجميع بلا استثناء في حملات “سخرة” دائمة، ولم يستثن من ذلك حتى المعاقين الذين بدأت أرواحهم تزهق وأخذت أعدادهم بالزوال (ص 167)، الأمر الذي يذكرنا بالإجراءات التي اتبعها النازيون للقضاء على المعاقين في ألمانيا (تمّ قتل سبعين ألف معاق) لأنهم يأكلون ولا ينتجون. ولم يذكر لنا التاريخ السياسي نظاما طغيانيا واحدا لم يقم بعزل شعبه عن الحياة وعن الشعوب الأخرى، ويضرب ستارا حديديا حوله، ويحجزه في قفص حديدي أو في “علبة حديدية” آمنة لا تستطيع الجراثيم الخارجية النفاذ إليها، و”ربّ حضارة تصنعها الكلاب خير من أجانب لا يصلحون حتى للعواء” كما يقول أسعد. إن الشعوب التي تخضع لقبضة الطغاة الديكتاتوريين المتطاولة، تُصاب بوباء “هذائي” من الناحية النفسية؛ وباء يجعل الجميع يشك في الجميع. ويسري سرطان التشكيك ليس بين الناس الذين لا تجمعهم سوى الروابط المهنية أو الجغرافية ولكن حتى بين أبناء العائلة الواحدة. فقد (أصدر الملك أوامر سرّية لتشديد هيمنة قبضة الأجهزة المخابراتية على البلاد. فمنع انتقال المواطنين بين المدن بدون إذن حكومي مسبق. كما حرّم على المواطن أن يستضيف مواطنا آخر دون إبلاغ دوائر البوليس. هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة بتوزيع استمارات خاصة على السكان، لتسجيل أسماء أبنائهم أوأقاربهم من الفارين والهاربين إلى الخارج. بل وأصبح على المواطن أن يقدم تقريرا اسبوعيا عن ظروف وتحركات ونشاطات جاره الآخر. وكذلك فرض تطبيق تلك الإجراءات لتشمل طلاب المدارس والجامعات تحت شعار صريح وواضح: “إذا لم تكن شرطيا للدولة، فأنت جندي في صفوف الأعداء”- ص 185 ).
.. ويمتد هذا الإنهواس الهذائي الشكوكي ليشمل الطاغية نفسه. وفي الحقيقة هو يبدأ منه أولا، بفعل تركيبته النفسية وسلوكه الخياني. ولا يوفّر الطاغية أقرب الناس إليه. كان طوروس يشك في زوجاته، وهن كثيرات قتل ثماني عشر منهن، وفي مقدمتهن “شيرين” أرملة الملك السابق. لقد اتهمها فورا بالتآمر عليه وأنها قتلت طفلها (ولي عهده). كما قام بقتل ولديه من زوجته “سورين كلار” الأميرين “تراكس” و “بلاتو”. ودائما يطيح الطاغية بأقرب مساعديه بصورة متكررة بسبب شعوره بالتهديد الدائم .. وتشيع مصطلحات التآمر والإنقلاب والطابور الخامس والخيانة .. إلخ في خطابات وأحاديث الطاغية .. ثم تمتد العدوى لتشمل هواجس وأحاديث أفراد قيادته وحتى زوجاته.
كلّما صار الغرب أكثر حداثة صار أكثر عنفاً :
أقول كان الغرب بسياساته الإذلالية للشعوب، يقوم من حيث يدري أو لا يدري بعملية “تدريب” لقطاعات واسعة من هذه الشعوب، على سياسات القهر والعدوان والثارات بصورة مباشرة وغير مباشرة. إن “الحداثة” التي رافقت عملية الإستعمار ومرحلة الإمبريالية، دشّنت مرحلة القهر في العلاقات البشرية معتمدة على التأويلات “العقلية” العنصرية حول مركزية الرجل الأبيض، التي حلّت محل مركزية الإله، الذي أعلنت الفلسفة الغربية موته، كان ضحيتها إنسان الهامش : إنسان الجنوب أو الشرق. أما “ما بعد الحداثة” التي رافقت النظام العالمي الجديد والتي أعلنت مركزية المادة/ الطبيعة، التي حلت محل الإنسان، الذي أعلنت الفسفة الغربية موته أيضا، فقد كان ضحيتها الآن، ومن جديد، إنسان هذا الهامش : جنوبيا أو شرقيا أو مهاجرا. والفرق هو أن الاساليب صارت أكثر علمية وتطورا، وبالتالي اكثر تدميرا وإشاعة للخراب. فالظاهرة الملفتة لانتباه الفلاسفة والباحثين هي أن الغرب يصبح اكثر وحشية وعنفا كلما صار أكثر حداثة وتطورا. تصوّر أن الدولة الأعظم والأكثر رقيا ماديا في التاريخ، وهي الولايات المتحدة، هي الدولة الأولى في التاريخ التي أدينت كدولة إرهابية – بهذا المصطلح المحدّد – في التاريخ السياسي، وبقرار من الأمم المتحدة. لنستمع إلى شاهد من أهلها كما يُقال ؛ شاهد ثقة شهادته غير مجرّحة هو المؤرخ والمفكر الأميركي “نعوم تشومسكي”. يقول تشومسكي :
( وبما أن الولايات المتحدة في هذه الحالة، كانت تهاجم بلدا [= نيكاراغوا]، وليس شعب ذلك البلد فحسب [ كما كان في السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس]، كان ذلك البلد قادرا على إتباع وسائل الاستعانة المتاحة للدول. فكان رد فعلها بالطريقة التي من المفروض أن تتبعها أية دولة ملتزمة بالقانون في الرد على الإرهاب الدولي الجماعي: أي اللجوء إلى المؤسسات الدولية. فأول ما فعلته نيكارغوا، هو الذهاب إلى المحكمة الدولية التي أدانت الولايات المتحدة بالإرهاب الدولي (بسبب استخدامها اللاشرعي للقوة)، ولانتهاكها المعاهدات. فأمرت الولايات المتحدة أن تنهي الجرائم وتدفع تعويضات كبيرة – ص 63 ) (5) . فماذا كان ردّ فعل الولايات المتحدة، أم الديمقراطية في العالم، والمدافعة عن حقوق الإنسان؟ هل انصاعت لقرار المحكمة الدولية كما يُفترض بأي دولة متحضرة؟ الجواب هو: كلا . والأنكى من ذلك هو أنها اندفعت بطريقة حيوانية هوجاء إلى تصعيد الحرب، ولكن على من؟ على الأهداف المدنية .. الموت .. الموت .. القتل .. القتل .. الدم .. الدم .. الدم .. هذا هو شعار الولايات المتحدة الدائم وعبر تاريخها المشؤوم، فانظر ماذا قامت به هذه الدولة الشيطانية كما فعلت لاحقا مع العراق عام 1991، وحسب تشومسكي أيضا: ( وكان ردّ فعل الولايات المتحدة تصعيد الحرب ( بتأييد من الحزبين !! ) فأعطت لأول مرة أوامر رسمية بمهاجمة ما يُسمى بـ “الأهداف اللينة” – مثل المستوصفات الصحية ، والتعاونيات الزراعية ، وما إلى ذلك . وتابعت الهجوم إلى أن صوّت الشعب في النهاية لمرشح الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا للبلاد، فتوقف الرعب في العام 1990 – ص 63 ) (6).
طوروس العنصري نتاج عنصرية الديسكولاند :
لقد وفّرت تجربة طوروس المريرة في الديسكولاند، والمعاناة التي عاشها الأنموذج العنصري والطغياني، الذي يقيس عليه، ويمدّه بالقرائن التي لا توفّر له التخريجات المنطقية في وجه منتقديه حسب، بل تحقق غاية أكبر، تتمثل في تخفيف الشعور بالذنب الذي تخلقه سلوكياته الدموية عادة، من خلال كونها سلوكيات سابقة ومقتفاة الآن. إن كون فعلا مدانا ما، قد قام به فرد أو مجموعة سابقة لك، يخفف كثيرا من إحساسك بأن زمام المبادرة جاء منك بلا سابقة، لأن كل فعل جديد يثير قدرا من القلق يتناسب مع طبيعته، فكيف إذا كان فعلا دمويا مميتا؟!. لقد اعترضت الملكة بعد عودتها من “حفل” إعدام المتهمين على تصرّف طوروس بكونه يشكل خرقا للقانون وأنه سيلحق اذى بامبراطورية الغرب الديمقراطي، فكان ردّ طوروس حاضرا:
(وهل ترغبين أن نتحوّل إلى هنود حمر في أوروبا؟ – ص 89)
فلو استمرت هجمة مواطني الديسكولاند الأصليين على الغرباء، لأعاد التأريخ الذي هو عبارة عن ذيل طويل لأي خدعة في الزمان، رسم صورة تلك المجزرة التي صارت فتحا وتحضّرا.. وأقصد بها ذكرى إبادة الهنود الحمر في أميركا الشمالية. وحسب تشومسكي أيضا فإن الروّاد “الأميركان” الأوائل قد أبادوا أكثر من (100) مليون هندي أحمر (وأكرّر ليس آلافاً بل – وحسب تشومسكي أيضا – مئة مليون هندي أحمر) من مواطني أميركا الأصليين. أمّا عندما تقول الملكة شيريهان لطوروس، في ختام حديثها معه في العربة الملكية إنه لعنة عظيمة؛ لعنة لا تريد أن تكون صدى لأنينها، فإن الأخير يستل الجواب المفحم من مخزون ذاكرته التاريخية الجريحة قائلا :
(وهل ثمة أنين أبلغ مما تزخر به أساطير القراصنة يا جلالة الملكة؟ – ص 89)
وقفة :
لقد كان الفعل الاستعماري هو شكل من اشكال القرصنة الفعلية .. قرصنة مدججة بأسلحة حديثة وبمبررات عنصرية وشعارات تطهيرية “متحضرة” عن الأراضي العذراء والأراضي التي بلا شعب والشعب الذي بلا أرض، وأرض صهيون الجديدة. الفارق الوحيد هو شدة الشراسة، وعلمية المكر والإبادة ، وكون سفينة القرصان لم تعد تعترض سفينة أخرى، وتسلبها، بل تحتل أوطانا كاملة وتسلب ثرواتها وتبيد شعوبها. فتلك الشعارات كانت تعني في واقع الأمر (إبادة السكان الأصليين حتى يمكن للمستوطنين البيض الإستقرار في الأرض الخالية الجديدة. وقد تم إنجاز هذا من خلال القتل المباشر، أو نقل الأمراض المختلفة، كأن تُترك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود الحمر فينتشر الوباء بينهم ويتم إبادتهم تماما. وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي قرينة على قتله. واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال أمريكا، بل تصاعدت بعد عام 1830 م حين أصدر الرئيس جاكسون قانون ترحيل الهنود، والذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفا من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) في أثناء فصل الشتاء سيرا على الأقدام إلى معسكر اعتقال في أوكلاهوما. وقد مات أغلبهم في الطريق … وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أميركا الشمالية عمليات نقل ملايين الأفارقة السود للأمريكيتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة؟ وقد تم نقل عشرة ملايين تقريبا، ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من خلال أسباب “طبيعية” بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال الصحية أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض.
وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقية ذاتها لا تقل قسوة. ففي كتابه رحلة إلى الكونغو (1927 م) يبيّن “أندريه جيد” كيف أن بناء السكة الحديد بين البرازيل والبزانت السوداء (مسافة طولها 140 كيلومترا) احتاجت إلى سبع عشرة ألف جثة. ويمكن أن نتذكر أيضا حفر قناة السويس بالطريقة نفسها وتحت الظروف نفسها وبالتكلفة نفسها – ص 214-216 ) (7).
# عنصرية الغرب لا تموت، وقفة على محاسن الإستعمار! :
(هذا ما كتبته قبل عدة أشهر)
ظاهرة غريبة هذه أن يتم الاحتجاج على فيلم عربي قبل عرضه. يدينه وزير الثقافة الفرنسي (فلادريك ميتران) وتسير المظاهرات الاحتجاجية ضده قبل أن يعرض على شاشات السينما ويراه المحتجون. هذا الموقف يعبر عن التعبئة المسبقة والتعصب الاستباقي ضد المواقف التي تمس القضايا العربية. هذا ما حصل مع فيلم “خارج القانون” الجزائري للمخرج “رشيد بوشارب” الذي تقرر أن يعرض في مهرجان كان تحت حماية مشددة!! الفيلم يتحدث عن مجازر المستعمرين الفرنسيين في مدينة “سطيف” الجزائرية من خلال قصة ثلاثة أخوة جزائريين يعيشون في فرنسا وعندما تندلع الثورة الجزائرية يقررون عمل أي شيء لمساندة ودعم ثورة شعبهم المقهور. حتى وزير الخارجية الفرنسي (برنارد كوشنير)- والمؤسف أنه شاعر- أدلى بدلوه في إدانة الفيلم وهو لم يشاهده وقرأ نتفا من السيناريو نشرت في الصحف الفرنسية. علق أحد النقاد المغاربة على هذا الموقف بالقول إن فرنسا ما كانت ستعترض لو أن الفيلم يتناول المحرقة اليهودية أو مجازر الأرمن على أيدي الأتراك ولحصل على جائزة فكل شيء مسخر للسياسة ولا مكان لألعاب حرية الفكر والمعتقد. وأنا أريد توسيع الأمر وأقول إن الديمقراطية الغربية حقيقة بالنسبة للغربيين وخدعة وأكذوبة بالنسبة لنا.. مع الغربيين تحرص الديمقراطية الغربية على حقوق الكلب “إبن الكلب” الذي يتمتع بكل الحقوق في الولايات المتحدة عدا حق الانتخاب والترشيح.. ومعنا تكشر الديمقراطية الغربية عن أنيابها وتكسر عظامنا وتبارك الأسلحة النووية لاسرائيل وتحاصر العرب حتى الموت.
هل تريدون دليلا هائلا وعجيبا ويدوّخ العقل؟.. إذن خذوه.. هل تعلمون أن البرلمان الفرنسي أقر بالأغلبية في (23 / شباط / 2005) قانونا اسمه (محاسن الاستعمار أو حفظ الذاكرة) اعتبر فيه الاستعمار الفرنسي للجزائر وغيرها وما قام به من مجازر نعمة للشعوب المحتلة؟؟ كانوا يحرقون الجزائريين احياء.. يقتلون الأطفال ويغتصبون النساء.. وفي باريس مدينة الحرية وحقوق الإنسان تم إلقاء أكثر من ألف مواطن جزائري في نهر السين وهم أحياء مربوطي الأيدي ليموتوا غرقا وبطريقة ديمقراطية لأنهم احتجوا على الاستعمار الفرنسي في الثلاثينات؟؟!!.. وعلى الرغم من كل ذلك، يأتي البرلمان الفرنسي ليشرّع قانونا يقره بالأغلبية يشرح فيه محاسن الإستعمار !!
عودة : مكر الروائي الخلّاق :
.. الآن – وهنا سيتضح جانب كبير من “مكر” أسعد المبيّت – سيكتوي شعب الديسكولاند، الذي كان يستخف بمعاناة الغرباء المهاجرين بل يضاعفها، بنيران محنة هؤلاء الغرباء نفسها التي أجبرتهم على الفرار من أوطانهم. الآن سيذوق شعب الديسكولاند – وهذا ما صمّمه الجبوري من خلال طوروس كما يبدو لي – علقم الهجرة حيث صار شعار الحياة في هذه البلاد (من يعبر البحر ، يعبر الموت فينجو).
تلك جملة ملحمية، التصقت بعقول العامة من شعب ديسكولاند. جملة نُحتت في أعماق الناس من شدّة الإرهاب على وجه الدقة. فالعبور من الظلام إلى النور، بات يمر عبر برزخ أزرق هو البحر. وهكذا تحوّلت الهجرة إلى ثورة شعبية عارمة، تحت تأثير فكرة الهجرة، لمغادرة البلاد وتركها بالسرعة القصوى. الهجرة التي أصبحت هاجسا يوميا يضغط على النفوس إلى حد الإختناق. فلول المخابرات السرية لطوروس، بدأت تنفذ مشروعها لتهجير السكان وترويعهم، بالإضافة إلى ما يحدث من مصادمات بين سكان البلاد الأصليين والأجانب. لذلك كلّه تكونت شبكات التهريب البشري في المدن والأرياف، وبخاصة في المدن الساحلية المطلة على دول الجوار – ص 91).
تراجيديا لعنة الهجرة تطول شعب الديسكولاند :
ومن الملاحظات الحاسمة على الفن السردي المحكم، هو أن الروائي ينبغي أن لا يطرح أفكار ورؤى وتجارب شخوصه بصورة كلامية وحوارية إلا في أضيق الحدود، لأن هذا السلوك السردي سوفي يصبح تعليميا وأحيانا وعظيا، ويصير فذلكات نظرية بالرغم من عمقها وأهميتها. لم ينج من هذه المصيدة أعظم كتاب الرواية وفي أكثر أعمالهم شهرة كما حصل – على سبيل المثال – لدستويفسكي في الجريمة والعقاب والأخوة كرامازوف، وستندال في الأحمر والأسود. مثلما لم ينج منها اسعد كذلك. ولكنه ، وبدءا من هذا القسم الثالث عشر (تراجيديا الهجرة)، صار لزاما عليه، أن (يشخصن) فكرة جديدة تمثل نقلة في مسار الرواية، حيث تحوّل مواطنو ديسكولاند الأصليين إلى “غرباء”، بدأ طوروس يذيقهم عذاب التقتيل والفتك بكل السبل، وصاروا “اجانب” في أوطان أخرى استغلتهم ابشع استغلال، حيث أصبحوا مادة لا تنضب لتجارة الرقيق (هل يريد الجبوري خلق أنموذج غربي متخيّل أو مستشرف لما عاناه غرباء الديسكولاند الحقيقيون من عذابات في الماضي ؟ هل يقوم بإعادة كتابة التاريخ ؟). كما استُغلوا أيضا من الناحية المالية في عمليات التهريب، خصوصا بعد أن غير طوروس العملة من الكرونه المعروفة إلى عملة جديدة اسمها “الشبح” فأسهم في إهارة اقتصاد البلاد.
لقد (قفزت أرقام الفارين من البلاد في زمن طوروس إلى أرقام مرعبة. فيما تراوحت الإحصاءات عن أعداد الموتى إلى مائة وخمسين ألف مواطن بسبب حوادث بناء السور العملاق. أما المحاكم العسكرية، فقد نفذت أحكام الإعدام بما يقارب الأربعين ألفا من السكان بعد أن شملتهم مختلف التهم.
هذا بالإضافة إلى أن أعداد المعتقلين قد بلغت أكثر من مائة وسبع وعشرين ألف مواطن من المحكومين بعقوبات تتراوح فتراتها من السنتين إلى العشرين سنة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. حيث يتم إرسال المحكومين للتنقيب والبحث تحت جبال الجليد عن مجموعات من سفن الفايكنغ الضائعة منذ قرون في تلك الجزر القطبية- ص 215).
وقد كانت موجة الهجرة عاتية وطوفانية. وصار مواطنوا ديسكولاند في فزع لا يصدّق، أججه طوروس بنفسه، وفي أول ظهور علني له على شاشات التلقاز الوطني، وهو يرتدي بزة عسكرية مزينة بالنجوم والأوسمة والسيوف، مع أنه لم يكن عسكريا من قبل أبدا.
الطاغية .. القويّ :
ولاحظ أن كل الطغاة يتجهون نحو منافسة العسكريين المحترفين على اختصاصهم .. وإزاحتهم من مواقعهم بل التصدي لقيادتهم وتصفيتهم. والخطوة الأولى في ذلك هو ارتداء الطاغية الزي العسكري حتى لو لم يكن عسكريا. إنهم يحاولون مستميتين الإمساك بكل مصادر القوة في المجتمع. ولا نستغرب إذا قلنا إن الطاغية نفسه يعاني من قلق شديد وشعور بعدم الكفاية والنقص يقض مضجعه، ويجعله يحاول التعويض أو تشكيل ضعفه عكسيّا – reaction formation، في صورة قوة مطلقة في الظاهر، حتى في المناسبات التي لا تستدعي ذلك، أو تتطلب ممارسات مسالمة مناقضة تشيع الإطمئنان في نفوس الناس. لقد ألقى طوروس خطابا موجزا عن دوره في إسقاط الإنقلاب العسكري وإنقاذ البلاد من نيران الحرب الأهلية التي حاولت العصابات العنصرية إشعالها. وختم حديثه بالدعوة إلى التعايش بين السكان ، وضمان السلام الاجتماعي الذي سيدفع بالشعب نحو التقدم الإجتماعي الذي يريده له أولا. ولكن الحادثة التي أعقبت الخطاب قلبت التأثير النفسي لهذا الخطاب رأسا على عقب، فقد قلب طوروس الطاولة التي أمامه، ثم سحب مسدسه الشخصي، وأطلق الرصاص في الأستوديو ابتهاجا بالنصر، فأصابت بعض الطلقات المخرج في حين فرّ الآخرون فزعين. إن هذه السلوكيات مخططة وينتهجها الطغاة كافة، لإثارة نوع من “التضاد الوجداني – emotional ambivalence” في نفوس الناس، تضاد بين المشاعر السلبية والإيجابية تسببها سلوكيات الطاغية المتناقضة موقفيا وفي الآن نفسه. ففي الوقت الذي يتحدث فيه الطاغية عن قيم الخير يمزق كل قيمة خيرة ويشيع نقيضها، قيم الشر. وفي اللحظة التي يتحدث فيها عن الوفاء ينقلب على رفاقه . وفي الوقت الذي يرفع شعارات السلام نظريا، يشن الحروب ويروج للعنف عمليا. إن هذا السلوك الذي سيطبع سلوك الطاغية طوروس مدروس، وليس عفويا. فهو يضع المواطن في حالة صراع نفسي شديد بين السلب والإيجاب، ينتهي بلجم إرادته في أغلب الأحوال. وقد لا يصدّق القاريء الغير مسلّح بالثقافة النفسية العميقة، أن المآل النهائي لهذا الصراع هو أن المواطن المقهور يبدا بإقناع ذاته بقناعات القهر والطغيان. وقد تحدث “ونستون سمث” بطل رواية جورج أورويل “1984″ عن هذه الحالة والتمزقات النفسية التي تصاحبها والصراع العقلي الممض ومضاعفاته الخطيرة :
(أنزل ونستون ذراعيه إلى جانبيه، وأعاد ملء رئتيه، ببطء، بالهواء، فيما انزلق ذهنه بعيدا في العالم المتناهي لـ “الإيمان المتناقض” . فأن تعلم ولا تعلم في الوقت ذاته، وأن تكون مدركا للمصداقية التامة فيما تعلن أكاذيبا منظمة بدقة. أن تحتفظ، في آن واحد ، باعتقادين باطلين، وتؤمن بهما معا مع علمك بأنهما متناقضان. أن تستعمل المنطق ضد المنطق، وأن تتبرأ من الفضيلة فيما تدّعي لنفسك حق المطالبة بها، أن تعتقد أن الديمقراطية مستحيلة، وأن الحزب هو حامي الديمقراطية، أن تنسى كل ما يكون نسيانه ضروريا ثم تسترجعه ثانية إلى الذاكرة في اللحظة التي تحتاجه فيها لتنساه مرة أخرى من دون إبطاء. وقبل كل شيء أن تطبق نفس العملية على العملية نفسها.
إن ذلك هو حدّة الذهن القصوى: أن تُحدث عدم الإدراك بشكل واع، ثم تصبح غير مدرك، من جديد، لفعل التنويم المغناطيسي الذي قمت به منذ لحظات .. وهكذا ، فحتى إدراك كلمة “الإيمان المتناقض” يستلزم ، بحد ذاته، استعمالا للإيمان المتناقض – ص 41 و42) (8) .
رعب هجرة الديسكولانديين يتفاقم :
وقد فاقمت هذه السياسات المتضادة من قلق المواطنين ورعبهم، ودفعتهم إلى المزيد من موجات الهجرة (وهي في الحقيقة فرار مذعور) عبر البحر. وكان من بين من فروا (سوني) وصديقتها (لونا) اللتين ارتبطتا بعلاقة مساحقة شاذة بالنسبة لقيمنا. لقد سرقت سوني ربع مليون دولار من البنك الذي كانت تعمل فيه وتركت رسالة لزوجها “لانكسن” بأن يأخذ طفلتهما “مونو” ويلحقها إلى بيت صديقتها لونا. لكنه تأخر عن الموعد المحدد ففرت الصديقتان وحدهما.
إن سيناريو الهجرة (أو الفرار)، العراقي أو المغربي أو المصري أو التركي، يعيد نفسه الآن بتفصيلات المعاناة التي كان الديسكولانديين يستخفون بها والتي صاروا هم [= الديسكولانديين] ضحيتها الآن. فالفرار عبر البحر في الليالي المدلهمة الباردة .. وما يتبعه من تمزّقات عائلية.. والإستغلال كرقيق أو مادة جنسية.. ومخاطر الرحلات.. ورفض بلدان اللجوء.. غرق السفن بمن فيها (إحدى سفن اللاجئين العراقيين غرقت وعلى متنها 800 عراقي قرب سواحل استراليا المتحضرة والتي أسهمت في غرق سفينة أخرى والفرجة على غرق الأطفال والنساء وفي انتحار مهاجر عراقي محتجز .. إلخ.. وفي عام 2006 قامت الشرطة اليونانية برمي مهاجرين عرب في البحر المتوسط مكتوفي الأيدي وتفرجت على موتهم غرقا!!).. والتشرد والنوم في العراء أو على المصاطب. وبذكاء جعل اسعد الصراع أوروبيا داخليا هذه المرّة حيث تعاني البلدان الأوروبية من هجرات وفرار مواطني دولة أوروبية أخرى :
(تدفّق اللاجئين أصبح قضية بالنسبة للألمان الذين يحاولون منع تدفق الأجانب إلى أراضيهم. وكانت أولى محاولات كبح جماح المتسللين عبر البحر، أن قامت قواتهم البحرية باعتراض ومطاردة عشرات من قوارب تهريب اللاجئين عبر البحر، مما تسبب في غرق قاربين ووفاة أكثر من ثمانين شخصا في المياه الأقليمية. كانت الأخبار عن الهجرة واللجوء هي العناوين الكبرى التي تتصدر الصفحات الأولى لصحف ومجلات أوروبا، بعدما انتشرت المخاوف من محاولات طوروس التدخل لدى دول الجوار بعدم فتح أبواب اللجوء أو السماح للديسكولانديين بالإقامة على أراضيها. وهو ما اعتبرته الكثير من الدول بمثابة إنذار لها، وإلا تصبح من الدول المعادية للحكم – ص 96).
العنصرية تلتهم نفسها :
يحيلنا الروائي بين وقت وآخر، إلى مواقف يعلن فيها صراحة أن البلدان المحيطة ببلاد الديسكولاند، والتي من المفترض أنها متحضرة وديموقراطية مثلها، قد بدأت باستغلال محنة سكان الديسكولاند الفارين أبشع استغلال، حتى أنها حوّلت قسما منهم إلى مادة لتجارة الرقيق. وأعتقد أن في هذه المواقف إحالة إلى حقيقة أن العنصرية يمكن أن تأكل نفسها بنفسها ايضا. فالنازية التي كانت لحظة أنموذجية قصوى لتجلي الخلاصة العملية الإبادية لجوهر الفلسفة المادية الغربية العنصرية، قامت بأكل الجسد الأوروبي الذي أنتجها. يتجلى ذلك في الموقف الثأري المميت للدول الغربية في علاقتها ليس مع النظام النازي الألماني بل مع الإنسان الألماني عسكريا كان أو مدنيا. فقد كانت كل جهود الحلفاء خلال وبعد الحرب العالمية الثانية تهدف ليس إلى تدمير الإنسان الألماني واجتثاثه حسب بل القضاء على الأمة الألمانية ومسحها من الوجود!!. والسبب الأساسي في هذا الموقف التدميري المتقابل هو أن الحلفاء يشربون من معين الفلسفة المادية نفسه الذي شرب منه النازيون وكان النازيون (يدركون تمام الإدراك أن نظامهم النازي وممارساته الإبادية إنما هي ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الغربي الحديث. ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة، تضرب بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة، أنها لم تكن مقصورة على النازيين وإنما تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء، أعداء النازيين الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب. فإرنست همنجواي ، الكاتب الأميركي ، كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على العنصر الألماني. وفي عام 1940م قال تشرشل إنه ينوي تجويع ألمانيا وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق الغابات الألمانية. وقد عبر “كليفتون فاديمان” محرر مجلة النيويوركر، وهي من أهم المجلات الأميركية إبان الحرب، عن حملة كراهية ضارية ضد الألمان، تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر: (إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب، وإنما ضد الألمان ككل، فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما نقول هو قتلهم.. فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة.. وإنما هو التعبير النهائي عن أعمق غرائز الشعب الألماني. فهتلر هو تجسّد لقوى أكبر منه، والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها 2000 عام – ص 216 و217) (9).
(لقد قضى 793239 جندي ألماني نحبهم في معسكرات الإعتقال الأميركية عام 1945 م ، كما قضى 167 ألف منهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة، وفي الوقت نفسه كان يوجد 5و13 مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمر ، تعمّدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها عليهم لغرض إبادتهم.
وفي اليابان ، وقبل اختراع القنبلة الذرية ، كان الجنرال الأميركي كورتس لي ماي يقوم بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له مثيل في التاريخ . فخلال عشرة أيام في مارس 1945 م ، قامت الطائرات الأميركية بطلعات جوية بلغ عددها 11600، تم خلالها إغراق 32 ميلا مربعا من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل، وهو ما أدى إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 000و150 ألأف إنسان. أما الغارات على طوكيو يوم 25 مايو 1945 م ، فتسببت في إندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحروق وهم على ارتقاع آلاف الأقدام. أدّت هذه الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون شخص على الاقل- ص 219 و220) (10) .
العنصريات المختلفة تتظافر :
.. ولكن هناك حالة مقابلة مضادة وتتمثل في أن الجسد العنصري تغذي أعضاؤه بعضها بعضا، حيث نلاحظ تظافرا مستترا بين الأنظمة والفلسفات العنصرية الغربية والشرقية، على الرغم من أنها قد تظهر خلافات أيديولوجية شكلية؛ تظافر يجري بصورة غير معلنة، لأنه يتحقق من خلال السلوك “الصامت”، والذي يوصل في النهاية إلى مسخ إنسانية الإنسان الشرقي، وتحويله إلى عبد “منضبط” إلى الأبد. فالإنسان الشرقي المقهور يعاني من اشكال شتى من التمييز العنصري، ليس شرطا أن تقوم على اللون، على الرغم من أن هذا الشكل من التمييز موجود حيث – مثلا – يسمّي المواطنون العرب إخوانهم السودانيين بـ “العبيد”، اشتقاقا من العبودية بطبيعة الحال. لكن التمييزات الأخطر والأوسع تقوم على المستويات القومية والإثنية والاقتصادية والسياسية والدينية. وهي عنصرية فجّة إذا جاز الوصف. لكنه حينما يفر من جحيمها، ويلجأ إلى بلاد الديسكولاند، معتقدا أنه سيجد الملاذ الآمن، الذي يستطيع أن يتنفس هواء الحرية في فضاءاته، ويستعيد فيه شيئا من كرامته المهدورة، تواجهه عنصرية متحضّرة إذا جاز الوصف أيضا، عنصرية مفلسفة ومؤدلجة ومعلمنة. وهي لا تفح في وجهه ولا تنفث سمومها بصورة مباشرة، ولكنها تتمظهر في السلوك الصامت الماكر الذي يزرع في أعماق اللاجيء قناعة بوجود مخالب باشطة تحت القفازين الناعمين. (فعادة ما تأتي المخلوقات الغريبة القادمة من الأصقاع المختلفة، بنصف عقل مرهق تسبب فيه القمع على أراضيها، لتفقد النصف الثاني من عقلها بعدما تستوطن المنافي الجديدة – ص 339).
وقد يكون هذا واحدا من عوامل الحنين المستديم، الذي يشعر به اللاجيء نحو مسقط رأسه الأم الجحيمي، بالرغم من استقراره في الفردوس الجديد لعقود. لقد فرّ الإنسان الشرقي من أرضه القديمة بسبب النبذ الفاضح القاسي، واستقبله النبذ المستتر والمتشفي، ليعيده راضيا مذعنا بالعبودية القديمة، في ظل أنظمة هي نفسها عبدة للأنظمة الغربية. هذا ما كشفه بوضوح وزير الحواس لآدم السومري في جلسة التمهيد لكتابة رواية طوروس:
(أجل يا آدم. فالعنصرية تراث من طراز معقّد. وهي ضربة قاضية لماهية الإنسان.
الشرق الذي هربت من عبودياته المختلفة، لتلتجيء للغرب الديموقراطي المفتوح، سيستعيدك ذات يوم، مادمت ترفض عبودية الغرب لك. لذلك ترى الإثنين – الغرب والشرق أقصد – يدفعان بك إلى الحفرة. فحيث ترفض استعبادية الغرب، يضغط عليك الفرنجة، لتعود إلى مواقعك الأولى عبداً لأنظمة ما تزال مُستعبدة من قبلهم. وتاليا لتكون منضبطا داخل السرب. إنها ينابيع الاستبداد القديمة. ولكن تذكر أن من يبتسم لك في هذه البلاد، إنما يشتم سلالتك في أفضل تقدير أو احتمال – ص 315).
وهذا التناغم المربك في عمل أواليات البنيتين العنصريتين تحيلنا إلى ظاهرة أخرى في غاية الخطورة وتتعلق بسلوك المهاجرين واللاجئين إلى أرض الديسكولاند عندما يعودون ليحتلوا مواقع قيادية في بلدانهم السابقة بعد إسقاط أنظمتها الديكتاتورية بطريقة أو بأخرى. فهو سلوك ينضح بالمرارة الفائضة ضد جريمة النبذ السابقة التي لا يستطيع المنفي غفرانها. تظهر في صورة استعادة دائمة ومتكررة لتلك الجريمة التي اقترفتها البلاد (الأم) أولا، تصفية للرموز الأبوية – كبنى مادية ومعنوية – (معاقبة الأب وحتى قتله) ثانيا، الإذلال المقابل للأخوة (الابناء) الذين ظلوا مستئثرين و”متنعمين” بالحضن الأمومي ثالثا، والسعي المحموم لبناء الفردوس المتخيّل والمنتظر طويلا والذي يأتي “هجينا” مشوّها ويهدر إمكانات البلاد وثرواتها رابعا. والمنفي العائد إنما يحاول أن يرسم مسارات “رواية عائلية” جديدة على المستوى النفسي الأوديبي. فلو لم يكن ابنا لعائلة أخرى ما نبذه الأبوان “الأصليان”، وهو في عودته إنما يأتي “منقذا” ليسهم في إيقاظ الأخوة/ الأبناء “الضالّين” على حقيقة المسارات الخفية الفعلية لروايتهم العائلية. واحد من القيادين المنفيين العائدين إلى بغداد “مدينته الأم” بعد احتلالها يتحدث عن “العراقيين” بصيغة الغائب دائما.. ويذكّرهم بـ “عار” المرحلة السابقة بصورة مستمرة، ووقف –ثالثا – ضد واحدة من أهم الإجراءات التنموية والرفاهية في الحياة العراقية بالرغم من أنه أشرف على صرف أكثر من عشرين مليارا من الدولارات على هذا الحقل التنموي، وهو مبلغ يعادل ميزانية ثلاث دول معروفة في الشرق الأوسط. وأعتقد أن العامل الحاسم في هذا السلوك هو مضاعفة مرارات النبذ الشرقي بمرارات النبذ الديسكولاندي المستتر.
الطاغية … العارف :
وفي الكثير من الأحيان، يحاول الطاغية أن يعوّض بإفراط القلق النابع من كونه إبنا مارقا خرج من صفوف الابناء، وذلك بلعب دور الأب بصورة شديدة الإنتفاخ تترتب عليها تبعات مضنية ترهق مفاصل الحياة بأعبائها. فالطاغية – والكثير من الطغاة يرزحون تحت سياط التهديد بالإنخصاء المتاصل منذ الطفولة المبكرة كما أشرنا – سيسعى لإثبات قدرته الكلية “الأبوية” – وهي موروث طفلي في الجوهر كما قلنا أيضا – فتراه يتدخل في أنشطة الحياة كافة، من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية ودينية وإبداعية وغيرها الكثير. كان ستالين مثلا يتدخل حتى في تقييم الأفلام السينمائية الروسية في قاعة قريبة من الكرملين مخصصة لهذا الغرض، ناهيك عن تدخلاته في الاقتصاد وشؤون المجتمع والجيش والتعليم والصحة والرسم والصناعة والموسيقى والأوبرا ,..و..و .. وجميع قطاعات الحياة. إنه الأب الذي وسع كل شيء علما، والذي يفهم مصالح إبنائه أكثر منهم، ومن المختصين من بينهم في تلك المجالات. وها هو طوروس يحضر حفلا لدار الأوبرا، ينتهي بقيامه بقتل المايسترو بطلقة من مسدسه الشخصي، وتعليق العازفين من أرجلهم. فهل هذه كوميديا سوداء؟
إنها واقع.. ليست كوميديا سوداء :
فقد زار خروتشوف معرضا تشكيليا لفنان روسي، يشتغل ضمن إطار المدرسة التجريدية فقال قولته الشهيرة : هذه اللوحات رُسمت بذيل حمار !! ومثل هذا التصريح، هو بمثابة طلقة، اصاب بها قلب ذاك الفنان التشكيلي المسكين وقتله.
عودة :
لكن الأهم هو دور الإعلام عموما، والصحافة خصوصا، في تزيين صورة الطاغية، وهو دور في غاية الخطورة. فقد خرجت صحف اليوم التالي لتحيّي في مانشيتاتها هذا السلوك الفريد لطوروس (قتل المايسترو وتعليق العازفين)، وتعدّه سلوكا “إنقاذيا” في مجال تنمية الذائقة الموسيقية وهبة لإعادة الكرامة الموسيقية المهدورة !!.
# رئيس صحيفة “اكس كيو” :
ولعل من الأمثلة المهمة على دور الصحافة خصوصا في “أسطرة” أنموذج الطاغية هو ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “X . Q ” :
(لقد بدأنا نتنفس الحرية منذ اللحظة التي تخطت بها قدما الملك المعظّم طوروس الحدود المترهلة القديمة. فجاءنا الملاك حاملا بشارة الفتح وشعاعا نقمع به ظلامنا الذي استبد بأرواحنا طوال قرون…. فالملك طوروس ليس إلا هدية عظيمة ، خصّ بها الربّ هذه البلاد وحدها دون سائر العالم – ص 123).
# وهذه ليست كوميديا سوداء ايضا :
فـ (قد حكم ستالين بنظرية الحاكم الإله نفسها، وليس أدل على ذلك مما جاء في “البرافدا” عام 1936م:
“آه يا ستالين العظيم، آه يا زعيم الشعب، أنت الذي خلقت الإنسان، أنت الذي وزعت وخلقت البشر في الأرض، أنت الذي أعدت للقرون شبابها، أنت يا من جعل الربيع يزهر- ص 153) (11) .
ومن المهم القول إن هذه القطعة المدحية لو قُطعت شعريا فسنجدها مطابقة شكلا ومضمونا – والغريب إلى حدّ التفاصيل – القصائد السومرية القديمة التي تتغنى بمديح الآلهة (أنليل ، مردوخ … وغيرهما) (راجع مثلا ديوان الأساطير لقاسم الشواف).
(وتتجاوز الأدبيات الشيوعية ذلك فتصف حضور ستالين في الكرملين عام 1946م بالقول : “ها هو ستالين معنا هنا في الكرملين. إن حضوره يلامسنا في كل خطوة يخطوها. إننا نمشي فوق حجارة ربما يكون قد وطئها أخيرا. فلنركع على ركبنا ونقبّل هذه الآثار المقدسة- ص 153) (12) .
في الشرق ملاذ آمن للديسكولانديين المهاجرين :
ولأن الروائي قد صمم وقائع روايته ومساراتها بقصدية عالية، فقد جعل أبواب الدول الأوروبية المجاورة تُقفل أبوابها الحدودية في وجوه الديسكولانديين الهاربين من طغيان طوروس، فلم يجدوا من ملاذ آمن غير الشرق . وصلت سوني ولونا إلى مدينة شرقية هي “مراكش”. وهناك استوعبهم المجتمع القائم ببساطة وبلا تعقيدات أو تحاملات مثل تلك التي كان مجتمعهما الديسكولاندي يصبها على المهاجرين الذين يلجأون إليه. لقد اندفعت سوني ولونا في حياة صاخبة في مخيم الغجر الذين يخافون من أوبئة الأمكنة الثابتة، ولا يريدون الإنتماء إلا إلى تاريخ الرحيل الأبدي فهي فلسفتهم كما يبدو (ص 127) كما كان يقول المغربي (سلامة العارف) صاحب الفندق الذي سكنت فيه الإمرأتان الديسكولانديتان في ردّه على سوني، وهو يكشف لها تعلقه بالغجرية “هديلو”، التي سترتبط بها لونا لاحقا في علاقة جنسية مثلية، بعد أن تنتقل سوني إلى بيروت للعيش هناك.
.. ولم يكن هناك شيء يكدر ساعات سوني المترعة بالرقص والغناء والجنس في مخيم الغجر سوى تفكيرها بمصير صغيرتها “مونو”. كان الحزن يقطع قلبها برغم أنها لا تعلم بالمصير الأسود الذي واجهته ابنتها التي فقدها أبوها بعد فرار زوجته، وسط هيجان جموع الديسكولانديين الفارين من بطش طوروس. لقد طردها مسؤول المركب فلجأت إلى عائلة ديسكولاندية هي عائلة “هولم”، التي فرّت ايضا بها مع طفلها “سكوت”. لكن غيرة الأم “ميتا” من عناية الأب بمونو جعلها تتركها في إحدى الأسواق المزدحمة. وعبر سلسلة من التنقلات والاختطافات تستقر مونو أخيرا في احضان قبيلة غجرية !! ماذا يفعل الروائي إذا كان يجد لزاما عليه أن يوصل البنت المسكينة إلى أمها، غير أن يجعلها تُختطف من قبل امرأة غجرية تعتني بها وتنشئها في كنف الغجر؟؟!!. لكن الأم سوني انتقلت إلى بيروت الآن، فما هو الحل؟ لا يوجد من منفذ للروائي سوى أن يجعل الغجر الذين اختطفوا الإبنة مونو يصلون المغرب ومراكش تحديدا، ليشاركوا هناك في “أسبوع كرنفال الزهور” السنوي الخاص بالغجر عند منابع الواحات – لم أجد ما يشير إلى مثل هذا الأسبوع في طقوس الغجر لكن الواقع السردي يختلف عن الواقع الموضوعي كما قلت- حيث تجتمع الفرق الغجرية من مختلف البلدان المجاورة والبعيدة. ولأن لونا بقيت مرافقة لحبيبتها الغجرية “هديلو” كظلها، فقد رافقتها إلى الكرنفال، وهناك ستلتقي بمونو .. والله يحب الروائيين الذين يجمعون شمل العوائل المهاجرة المفككة.
# نسيان (2) :
على الصفحة 91 أشار الروائي الى أن عمر الطفلة مونو، يوم هربت أمها سوني، هو سبع سنوات. وعلى الصفحة 192 وصف نشأتها بين الغجر بالقول : (بدأت اللغة الثانية بالتشكل والنمو السريع . فدماغ مونو أرض بيضاء .. فعلت ذلك بإرادتها خلال عامين من المنفى مما سهل عليها، بعد بلوغ التاسعة من العمر، أن تنظر إلى حياتها الجديدة بشيء من المتعة) . ولكن على الصفحة 210 يعلق الروائي على لقاء لونا بمونو فيقول: (أدركت لونا إن الأبوين [= أبوي مونو] لا يعرفان شيئا عن قصّة غيابها منذ أكثر من عام) . وفي هذا مغالطة.
# و.. ثغرة فنية :
كانت آخر مرة ورد فيها ذكر اسم (المثنى) من قبل الكاتب هي على الصفحة 72 وهو يتحدث إلى العم هنترسين في بيت الأخير، الذي وصله بعد أن تم إنقاذه من محرقة المطحنة. ولكن على الصفحة 203 يصور لنا الكاتب فيبيكا، عشيقة المثنى السابقة، وهي تلبد مع صديقها الكاتب الصيني “شاي لين” تحت أطنان من شباك الصيد القنبية، كي يهربا خارج البلاد، يقول الأخير لفيبيكا : (لم أر وجهك هكذا من قبل. حتى موت “المثنى” لم يترك عليه شيئا مما أراه من الحزن العميق) .. فنفاجأ بموت المثنى من دون أي مقدمات. كما أن موته يأتي بعد غياب عن مسرح الرواية دام (31) صفحة !!.
وفي وصفه لاختباء فيبيكا ولين، يقول إنهما لبدا تحت أطنان من شباك الصيد. وهذه مبالغة كبيرة، لأن هذا الثقل سيقتلهما. والأكثر طرافة هو أنه يجعلهما يمارسان الجنس بمتعة وحيوية تحت هذه الأطنان!. تحصل مشكلات فنية كثيرة حين يتحمس المبدع لعمله وينفعل بشخوصه، وتنسرب حفزاته الغريزية خلف استار تلك الحماسة. طبعا هذا الإعتراض يجب أن لا يمنعنا من التذكير بان اشتعال الرغبة الجنسية والمواقعة في ظل ظروف القلق والتوتر هي مسألة مقرة علميا.
و.. مشهد مستهلك :
وفي محاولة تخلّص الملكة من طغيان زوجها “الملك” طوروس، ذهبت إلى المستشفى لرؤية طفلها الميت، وهناك و (ما إن وصلت المستشفى حتى أمرت مرافقيها بالإنتظار في الممر الداخلي، لتستقل المصعد بنفسها وحيدة. وهي فكرة أرادت منها مناورة المرافقين، لتغيير مسار المصعد، كي يفضي بها إلى باب الحديقة من الجانب الآخر من المبنى. ذلك ما حصل فعلا. فقد عبثت الملكة بشكلها، بعد أن غطّت شعرها بشال أسود، وعينيها بنظارة سوداء، لتهبط من طرفه الآخر المطل على الحديقة. وتكون امرأة أخرى خارج المستشفى- ص 214 و215)
.. وهذه من المشاهد الشائعة في الأفلام المصرية، وبشكل نمطي، وكان من الممكن أن تصمم لنا قريحة أسعد مشهدا أكثر جدة وفرادة.
# ذات المرأة الديسكولاندية تتفتح في الشرق :
لقد بدأت سوني تفهم ذاتها جسدا ونفسا، وفق اضواء جديدة وفّرتها البيئة الاجتماعية المغايرة لبيئتها القديمة. البيئة الجديدة جعلتها تتصالح مع نفسها وجسدها، بعد أن كانت تعيش اغترابا حقيقيا عنهما في مجتمعها السابق. لقد “تشيّأت” العلاقات الإنسانية مثل كل مكونات الحياة الأخرى في الديسكولاند. وهذا التشيؤ هو نتاج طبيعي للفلسفة المادية الحاكمة ومنهجها في “التسوية”؛ تسوية الإنسان بالأشياء واعتباره جزءا “طبيعيا” من الطبيعة. لقد عاشت سوني العملية المروعة التي سُحب الإنسان في مجتمعها من ذاته، ليوضع في عالم الأشياء/الطبيعة في الوقت الذي وجدت فيه أن الإنسان في المجتمعات “الجديدة” التي هاجرت إليها، وبرغم كل المساويء التي تحيط به، يُنظر إليه كـ “ثغرة” في نظام الطبيعة:
(أدركت سوني بأن الحياة التي بدأتها في “المغرب” آخذة بالإتساع بفعل ما تخلفه من آثار إيجابية لتكوين شخصية جديدة لها، تختلف كثيرا عما مضى. سحرتها الطقوس بعوالمها، بدءا من الطبيعة وانتهاء بالتشكيلات الاجتماعية والثقافية والفولكلورية في تلك البلاد. فبعد شهور ستة من إقامتها في تلك البلاد، كونت سوني لنفسها فكرة واضحة لمعنى وجودها البيولوجي. حسمت الوضع لصالح نفسها. كأن تكون امرأة أخرى تنفض الغبار عن ذاتها المحكمة، لتنهض بها فتخرج من القمقم القديم نحو المنابع التي وجدت فيها الخيال ممزوجا بالوقائع اليومية – ص 144).
لم ينبذها أحد في المجتمعات الشرقية التي لجأت إليها .. لم يستغلها رب عمل .. لم يعدها الآخرون طفيلية تريد استنزاف ثروات بلدهم أو تمزيق النسيج الاجتماعي لمجتمعهم كما فعل الديسكولانديون مع الغرباء الذين لجأوا إليهم من ضيم وبطش ولاعدالة أنظمة الجنوب.
وقد امتدت يد التغيير التراكمية في البيئة الجديدة لتشمل أفكار لونا – حبيبة سوني السابقة – أيضا، وطبيعة نظرتها إلى الحياة ومتغيراتها. ويتجلى هذا التغيير لدى الصديقتين الديسكولانديتين في الرسالتين اللتين تبادلتاهما من مكانيهما – وطني اللجوء الجديدين -: تلك (لونا) في المغرب، وهذه (سوني) في المشرق (لبنان). وكل منهما خلق (منظورا) متفرّدا في النظر إلى الحياة الجديدة وعواملها الإنسانية الفاعلة في تجربته وبنيته الإنسانية التي شكلها المجتمع السابق فكرا وسلوكا. تقول لونا في رسالتها بعد أن تؤكد رسوخ ميولها المثلية، وعشقها الملتهب لهديلو الغجرية:
(عزيزتي سوني..
….. أعرف بأن الشرق ليس قفصا جنسيا حسب، بقدر ما هو عوالم متعددة الأقفاص، كل من يغرق بمعرفته أو باكتشافه، لا يتخلص من طقوسه بسهولة. لقد أدركت أنني ابتعدت عن الموت بضع خطوات. أقصد الموت البطيء الذي كنا نمارسه في بلادنا العظيمة تلك من قبل. فالغرب هو الآخر، يا سوني، ليس ثلجا وتكنولوجيا فقط، بل للأسف، هو شيخوخة مبكرة للمشاعر والحب والمال والشهرة والروح والرفاه. لقد أدركت أن الفقراء والمعدمين هنا أكثر معرفة منا بدواخلهم وبالحياة. فعلى سبيل الافتراض، لو عشنا نحن في الغرب ظروفا مشابهة لظروفهم القاسية هنا ، بالقليل من المال والقليل من الجنس وبالقليل من الحريات وبالقليل من الطعام، لحدث الطلاق بيننا وبين الحياة منذ زمن بعيد مبكر. ألا تعتقدين بأننا أنتجنا لهم جزءا مهما من ذلك الحرمان؟
على ما يبدو يا عزيزتي سوني ، لسنا نحن إلا مسودة لتاريخ الموت المبكر. ومع ذلك، مانزال نحمل كبرياء ذلك التاريخ، ونواجه الشرق بالاحتقار والدونية وقلة الأدب، معلنين براءتنا التامة عن تحمل الجزء الأعظم من خرابه.
تذكري بأننا وصلنا إلى هنا بشكل متأخر، وهذا ما يجعلني أكثر حرصا بعدم تضييع الوقت. الشوق لبلادي يتفجر في داخلي. ولكن ليس في كل الأوقات. تذكري بأن استبداد الملك طوروس، ربما هو النقطة البيضاء الوحيدة في تاريخه الأسود. فقد هبط ذلك الديكتاتور على بلادنا كملاك يحاول اجتثاثنا من العزلة التي كنا فيها – ص 253 و254).
وفي رسالة سوني الجوابية لصديقتها لونا، يظهر منظور مغاير، يتمثل أولا في المدخل اللاجنسي الذي لا يرى أية “مركزية” من أي نوع في صالح الحياة البشرية .. لا الغرب ولا الشرق مركز مقدس تتوفر فيه كل سمات الأنموذج اليوتوبي. ولا أحد منهما خال من الفساد والعقم والانحطاط والخوف من الآخر – على الأقل هذا ما كشفته مناقشاتها مع حبيبها الجديد (بيرم) اللبناني، وخفايا علاقات ثلته (الوزير قيصر فريد وزوجته هالة قيس وعيسى المعشوق وسهاد فواز وسعيد وجدي والدكتور ممتاز الشرقي وصولانج الجوزي .. إلخ.. من تجار وإعلاميين وفنانين وفنانات ). والحل يكمن في أن يتقاسم الشرق والغرب رسم لوحة الحياة الإنسانية، وفي جمالية الحوار ما بين العناصر التي تقوم بتشكيل اللوحة من كلا الطرفين في نهاية المطاف (ص 255).
لقد أتاح المنظور الجديد لسوني، مقتربا جديدا للتعاطي مع حاجاتها الجسدية، بنزعات طبيعية مغايرة لجنسها، وبعيدا عن مصيدة الاتجاهات المثلية، التي أصرّت عليها لونا :
(لقد وجدت في بيروت ما كنت أفتقده في حياتي تماما… كل شيء في الشرق يملك حماسه الخاص. بما في ذلك الفقر واليأس والحب والطقس والعشب. فأنتِ لو قابلتِ رجلا، لأدركت بأنك تقابلين جبلا من العواطف. فالعواطف هنا تتقدم وجوه الجميع . بعبارة أوضح أنها واجهات الناس. والإنسان قليل العواطف، يكون فارسا بلا جواد أو سيف. لا تظني بأن العواطف وحدها على هذه الأرض، فهناك عقول تدرك عالمنا إدراكا خلاقا وكاملا. هنا أسمع أنين الشرق ينبعث كالحجر المطحون. لكل رجل حشرجته. وفي الكثير من الأحايين أرى آلام الناس تمشي كظلال لهم – ص 255).
لقد اتسعت نافذة الرؤية لتتجاوز الإطار الجسدي الشهواني الذي العابر والضيق الذي كانت تعيشه سابقا، وتشمل المعاني العميقة للوجود البشري من آلام وتساؤلات مؤرقة. ويظهر هذا التغيّر أيضا في حوار سوني مع قرينها النفسي الذي ظهر لها في جو الغرفة من العدم وبدأ ياستجوابها :
(-أنا شبيهك يا سوني، وأريد محاورتك عن فانتازيا الخيبة والذنوب. فما رأيك؟
-رأيي؟! ها .. تقتحم علي خلوتي وتسألني عن رأيي؟
-أأنت حيّة أيتها المرأة؟ أم أصبحت تمثال شمع جميل، تخافين الاقتراب من النار، كي لا يتبدد هيكلك؟
-النار أولى أفعال التغيير للتعبير.
-مازلت قاصرا عن معرفة التغيير. هكذا الواضح.
-لا أعرف ما يدور في خلدي. بالأمس كنت قاصرا عن معرفة أوروبا. واليوم أقع في النسق الإنشائي للتذمر، فلا صمود عندك أمام إغراء الشرق وثرثرته عن نفسه. أسمعهم يقولون “إن الله خص الشرق بقابلية الإشراق الدائم على ظلمات الآخرين”! لا أريد أن أشغل نفسي بالردود. إنها توجع الرأس. ولكن هل ثمة جناية فيما لو تركنا الشرق يخصب نفسه بقوة ما، قد لا نؤمن نحن بها؟ لنترك الأمر للحب . فهو ملقط يجمع ما بين السماء والأرض.
-أنت تحاولين أن تؤلفي من هروبك أخلاقا. لقد أعطيت ظهرك لوطنك، ودخلت مشافي الشرق طواعية، وكأن هذا المكان فردوس مقدس. ألا تجدين الغثيان يملأ نفسك من جراء هذا الوهم الراقي؟ – راجع تكملة الحوار المهم على الصفحات 257 و258و259 ).
# نسيان (3) :
في رسالتها إلى سوني، قالت لونا بوضوح، وفي استهلال الرسالة، بأنها مازالت مصرة على توجهاتها المثلية برغم خذلان سوني لها :
(عزيزتي سوني ..
لا تخرج الكلمات الدافئة إلا من الجسد الدافىء. هذا ما عهدته فيك منذ اليوم الأول الذي وقعت فيه في هواك. لكن حذلانك كان النتيجة المذلة المريرة. لقد أطلقت عليّ رصاصة الرحمة وهربت لعالم الرجال…. إن نظرة من (هديلو) تضخ في أعماقي بئرا من البترول. كأن كل ملامسة منها لجسدي، تُشعل تلك البئر ليستمر الحريق دون نهاية – ص 253) .
ولكن الغريب، وأمام هذا الإعتراف الصارخ، هو أن الكاتب جعل سوني تسأل لونا في ختام رسالتها :
(أسألك الآن: هل مازلت غارقة في بئر ساحرتك الغجرية “هديلو” في تلك الصحارى ؟ – ص 256 ).
المرأة الديسكولاندية لم تُستغل في الشرق جنسياً :
.. في أثناء المدّة التي أمضتها سوني مهاجرة في مراكش .. وفي خيام الغجر .. لم تتعرض لأي استغلال أو تحرّش جنسي، بل كانت تُعامل كأنثى باحترام من قبل الرجال المحيطين بها، وكانت تختار نمط الحياة الجنسية الشخصية التي تعيشها من دون اي حواجز أو مخاوف أو “عبودية جنسية”. وكان هذا حالها أيضا في بيروت التي سافرت إليها بعد ذلك، وأمضت فيها سنوات طويلة. قارن هذا بالاستغلال الجنسي المأساوي الذي تعرض له الرجل الزنجي البائس “كورنيك”، الذي جلبته من الكاميرون عجوز ديسكولاندية اسمها “بيهين”، ابتاعته بمئة دولار فقط، لإشباع هوسها الجنسي. ولكن الحال لم يستمر أكثر من عامين، فقد فرّ الأفريقي المسكين من “نزل الموت” كما كان يسمّيه كي يتفادى الهلاك جنسيا كما قال في المحكمة. لكن المشكلة أن هذه المرأة شكلت حزبا سياسيا بين ليلة وضحاها، يرفع شعارات عنصرية ويدعو إلى رحيل الأجانب من البلاد. ثم أقامت دعوى قضائية على الرجل، ولكن المحكمة برأته، ليس لرفض هذا السلوك اللاإنساني الإستغلالي، ولكن خوفا من تدويخ المحكمة بقضايا أخرى مماثلة ترفعها النساء الديسكولانديات لمقاضاة الرجال الأجانب الذين يُجلبون من أجل غايات جنسية (ص 266-268).
# استطرادات فائضة :
في كتابه “عشر روايات خالدة” يرى سومرست موم أن قيمة بعض الأعمال الروائية، تتمثل في بعض الأحيان بعدد الصفحات التي يطويها القاريء منها، للوصول إلى ما يثير اهتمامه، أو يعيد إثارته من خلال الإرتباط بحلقات الوقائع السردية السابقة. وفي رواية اسعد الجبوري هذه، هناك – من وجهة نظري الغير متواضعة – وخصوصا في نصفها الثاني، الكثير من الصفحات، التي من الممكن أن يطويها القاريء، من دون أن يلحق تسلسل الأحداث الأصلي أو حبكة الرواية المركزية أي خلل. من ذلك القسم المعنون بـ “المطاردة الساخنة”، والذي امتد لعشر صفحات (بين الصفحتين 153 و163)، وتحدث فيه الكاتب عن الشاعر البدوي “ورد الكعبي” المتيم بلونا المثلية التي ترضعه الرضاب، وهو مدفون في التراب، وتمارس معه الجنس والحرس وقائدهم ينظرون من النافذة ويستمنون.. إلخ من تفصيلات لا تحمل ضرورات فنية أو فكرية. ثم ما هو مصيره؟ لقد هرب واختفى من الرواية إلى الأبد!! وحتى لو كان الروائي يبغي رصد تحولا حدث في حياة لونا في نظرتها إلى الحياة ودور الجنس ومعنى الحياة .. فهذه الحادثة مستفيضة وزائدة.
ومن ذلك أيضا : حكاية ابنة عم السارد “إخلاص” (ص 244-246) ، وحكايته مع ابنة عمه الثانية التي قصها آدم السومري على مدير شعبة النطق ( من ص 300 إلى ص 306)، والتي ملّ منها حتى المدير. ومنها مناقشات طوروس مع زوجاته في مواضع مختلفة.
# مقاربات مع رواية “1984″ لجورج أورويل :
لقد كان للروائي النبوئي جورج أورويل في روايته الشهيرة “1984″، الريادة في معالجة موضوعة الطغيان القائم على القمع الفائق بالأساليب العلمية المدروسة الموصلة إلى اشد درجات “الحرمان الحسّي – sensory deprivation”، الغير محسوسة، والتي تتراكم تاثيراتها الغاسلة للدماغ ومحتويات الذاكرة والمربكة لسلسلة العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. هو طغيان يقوم على اساس التدخل التفصيلي المرعب في أدق جوانب حياة الإنسان اليومية. ومن المحتم أن يكون أي طغيان عنصريا، وهو ما يوصل إليه السلوك الديكتاتوري الشمولي لـ “الأخ الأكبر” الذي يحكم دولة “أوقيانيا”. ولأن رواية أسعد الجبوري تعالج بين ما تعالج موضوعة الطغيان والسلوك الديكتاتوري الشمولي، ولأن “الأسد عبارة عن مجموعة من الخراف المهضومة” حسب مقولة الأخ “بول فاليري”، بالرغم من أنني لا أوافق على هذه الأطروحة، التي لو كانت صحيحة لكان من المنطقي أن يكون الأسد خروفا ضخما !!، فإن من المتوقع أن تحصل مقاربات بين العملين – السبق فيها لأورويل طبعا – بسبب السياق من جانب، وبفعل المخزون المعرفي للكاتب أسعد الجبوري من جانب آخر :
- هناك وزارة الحقيقة لدى أورويل ، وهنا وزارة نقل الكلام ووزارة الحواس لدى اسعد.
- هناك فودكا يلتسين وهنا جن الإنتصار.
-هناك أوقيانيا مفترضة ومتخيلة معززة بواقعية بتاريخ لندن ، وهنا ديسكولاند مفترضة ومتخيلة معززة بحاضر واقعية بحر الشمال وألمانيا والمغرب .. إلخ.
- هناك يكتب ونستون سمث يومياته/ روايته، وهنا يكتب آدم السومري رواية الطاغية طوروس/ “قيامة الديناصور”
- هناك الأخ الأكبر وهنا أخ أكبر هو طوروس
- هناك ونستون سمث الذي يُغسل دماغه في السجن وهنا آدم السومري الذي “يُدرّب على الكتابة” في “الغرفة الشاقولية”.
- هناك وهنا حفلات إعدام عامة
- هناك “مباديء الكلام الحديث” وهنا “اللغة الشرسة”
- هناك حفلات شنق الأسرى وهنا حفلات إعدام المتهمين
- هناك “أَخَويّة” .. وهنا “أَخَويّة” ..
- لهجة وطبيعة الخطاب التهديدي لـ “اوبرين” ضد “ونستون سمث”، مطابقة تقريبا للهجة الخطاب الذي وجهه وزير الحواس إلى “آدم السومري”
- هناك الغرفة (101) المخيفة وهنا الهول ديزني وكلتاهما مخصتان للتعذيب
- هناك وزارة الصدق ووزارة الحب .. وهنا وزارة الكلام ووزارة الحواس.. وغيرها الكثير.
لكن أسعد الجبوري يجترح آلية مراقبة جديدة قد تحمل سمة استشرافية/ نبوئية (!!)، وتشير كل تأملاتنا لما يجري من منجزات علمية – أميركية خصوصا – مخصصة للرقابة والإتصالات، وملاحقة ما ينتجه الفن الهوليودي الباهر الذي يسبق العلم عادة في تخيّل أبشع طرق ووسائل الرقابة والقمع وغسل الدماغ وقتله وتنظيف الذاكرة ليلحقه العلم في “التنفيذ”، أن اختراع النظام الآلي الرقابي الذي تخيّله أسعد ليس أمرا مستحيلا ، بل ليس بعيدا عن التحقق زمنيا. إنها “المسلّة الالكترونية” التي صُمّمت على شكل قيثار سومري، وقد دارت الشائعات حول الهدف منها. ولكنها لم تكن أكثر من تصميم افتراضي يغطي جهازا إلكترونيا آخر، يقوم بقراءة ما في رؤوس المواطنين، وأخذ صورة عنها على غرار بصمات الأصابع، والهدف منها معرفة مشاعر المخلوقات الآدمية، وتحليلها وتخزينها على اسطوانات ممغنطة موصولة بأجهزة خاصة لتحليل ما تدّخره رؤوس العابرين من أفكا رونوايا ومشاريع. وعلى المواطن أن يزور المسلة (يُفحص في الواقع) يوم الأحد الأخير من كل شهر (ص 254).
وفي عام 1994 نشرت صحيفة العرب اللندنية تحقيقا، يشير إلى سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى اختراع وسيلة جديدة لغسل ذاكرة الأسرى، وإعادة تشكيل عقولهم، وذلك عن طريق “قنبلة صوتية”، تُفجر على الأسير في زنزانة مغلقة وخلال جلسة واحدة. وفي القاعة الشاقولية التي يلقى فيها آدم السومري لغرض “غسل دماغه السردي” تبدأ ما سمّيها اسعد بـ “تمارين الكتابة”. وكان التمرين الأول يُسمّى بـ “نزهة البراءة” حيث (المطر الأسود يتساقط، وما أن يتوقف، حتى تُلقى على المؤلف من الفتحة العليا كتل صغيرة من الإسفنج المشتعل، تعقبها قنبلة صوتية تنفجر لإطفاء ذلك الإشتعال- ص 280).
حيادية المصطلحات و “براءتها” :
.. تستخدم آلة الطغيان والإبادة فلسفة لغوية تقوم على أساس تحييد المصطلحات، واستخدام تعابير بريئة وأحيانا مناقضة لطبيعة العمليات البشعة التي تُستخدم في تطويع إرادة الإنسان وسحق شخصيته .. وأخيرا قتله. فالمصطلحات – وبتأثير الفلسفة المادية التي تحيّد العلم وتفصله عن أي قيمة مهما كانت – يجب أن تكون محايدة لا تحمل أي معنى إنساني أو عاطفة بشرية أو بعد اجتماعي أو نفسي. هذا ما حصل في اللحظة النازية التي أنتجتها الفلسفة الغربية، حيث كان النازيون يستعملون مصطلحات “باردة” ومحايدة، فهم يسمون عمليات الإبادة “الإخلاء” و”النقل” و”إعادة التوطين” و”الحل النهائي” و”التطهير”. وكانت المؤسسات التي تُشرف على الإبادة وتنفذها لها أسماء محايدة أو إيجابية مثل “جمعية نقل المرضى” و”المؤسسة الخيرية للعناية المؤسسية”. وليس عجيباً أن تستخدم الولايات المتحدة – أبشع أراضي الديسكولاند عنصرية – تسميات مثل “إعادة الأمل” و”توفير الراحة” على عمليات عسكرية هدفها تمزيق البلدان وتحطيمها. ومن المجالات التي استعيرت منها بعض التسميات هو الفن الأميركي (موسيقى وأفلام). فعملية اللكمة الجانبية (Side Winder) مأخوذة من اسم فرقة موسيقية أميركية اشتهرت بألبوم عنوانه انتقم سبع مرات. وكذلك عملية ثندر كات (Thunder Cat) وهو اسم مسلسل كرتوني أميركي، ونفس الشيء بالنسبة للعملية أوكي كورال (O.K. Corral)، فالعبارة اسم لفيلم أميركي أنتج سنة 1957. وعملية ميفيلد الثالث (Mayfield III) مأخوذة من اسم مؤلف أسطوانات أميركي من أصل أفريقي (13) .
والشيء الذي يجب أن ننبه عليه هو أن لا يظنن أحد أن اختيار هذه التسميات هو شيء عشوائي، فهناك لجنة متخصصة في البنتاغون من كبار المختصين تقوم بهذا، ولديها تقويم بالمناسبات الوطنية والدينية للشعوب، تحدد وفقها مواعيد الهجمات. هذا ما ذكره عالم النفس “بيتر واطسون” في كتابه الخطير “حرب على العقل – war on the mind “، وهو غير مترجم إلى العربية.
وفي أرض الديسكولاند، وبعد استيلاء طوروس على الحكم انتشرت التسميات المحايدة التي تربك الاستلام الدلالي لدى الفرد فهي محايدة أو حتى جميلة شكلا، ولاإنسانية بشعة مضموزناً. فتسمية “مكبس الحرير” يطلق على “تمرين كتابي” خلاصته انضغاط المواطن (آدم السومري هنا) بين بين أرضية الموقع وكتلة ساخنة من السقف حتى يصبح أشبه بالحرير الساخن.. أما “همس الملائكة” فهو “التدريب” الذي تقوم فيه (سماعات صغيرة في جدران الغرفة الشاقولية، ببث ألف ياء اللغة الشرسة، بمختلف اصوات الحيوانات، يجمع بينها إيقاع مرعب – ص 280).
# مفهوم جديد للجنون : هل العنصرية جنون؟!:
بعد أن أحرق “لانكسن” – زوج سوني – بيته في لحظة “جنونية” سببها الإحباط الشديد الناجم عن فرار زوجته وضياع طفلته مونو، اقتيد إلى مشفى المجانين. وهناك وجد العديد من المعارضين وقد ألقى بهم طوروس في المشفى باعتبارهم مجانين أو ليجهز على قواهم العقلية بالعقاقير أو الصدمات الاختلاجية الكهربائية. ومن الشائع والموثق تاريخيا أن الكثير من الطغاة، كانوا يقومون بحجز قسم من معارضيهم في مستشفيات الأمراض العقلية، بزعم إصابتهم بالجنون. ويتساوى في ذلك طغاة الشرق والغرب. وقد تكون هذه التهمة – في احتمال غير مُفكر فيه – ناجمة عن أوالية “إسقاط – projection ” يقوم فيها الطاغية بإبعاد شبح جنونه الشخصي عن ذاته و (شخصنته) في الخارج عبر أفراد غرباء عنه. إذ ما الداعي لإلقاء هؤلاء المعارضين في مشفى للمجانين – الطب النفسي الحديث يرفض، طبعا، هذه المفردة “الجنون” لأنها وصمة ويستخدم بدلا منها مصطلح الذهان – psychosis - مادام قادرا على إفنائهم بشتى الطرق؟. إن من بين معاني فعله هو أنه أشبه برقية سحرية ذات مضمون عقلي طفلي، فطالما بقي هؤلاء “المجانين” محتجزين “بعيدا” عنه، فإنه سيكون بمنجى من لعنة الجنون. لكن الروائي يستثمر اجتماع المعارضين “المجانين” ليمرّر معضلة نفسية وفلسفية كبرى تتمثل في “معنى” الجنون ذاته. فهو يهز أركان التعريف التقليدي لهذا المصطلح الطبنفسي الراسخ منذ عقود طويلة. فوسط تندرهم المأساوي على حالهم المزري وحال بلدهم الذي آلت مقاليد السلطة فيه إلى يد طوروس الطاغية يقول “روبرت ستين” لصديقته “روني بينك” إنه لا يشك لحظة واحدة في أن طوروس قد تخرج من هذا المشفى. فترد عليه بأن الملك سوف يأتي إلى هذا المكان يوما ما ليختار مستشاريه، ولذلك فهي تهيء نفسها من أجل تلك اللحظة (ص 139). إنها طرفة (وشر البلية ما يضحك) لكنها ذات مغاز معرفية عميقة جدا. ويكمل أسعد المعضلة/التساؤل من خلال استمرار الحوار بين المعارضين “المجانين” :
(-كلا . فإذا جاء الملك إلينا ، سنقنعه برفع رتبته إلى مقام آخر، ننصبه امبراطورا علينا. أليس ذلك ما يليق به؟
سأل الكاتب “هيس ثروب” الضيف الجديد “لانكسن” وهو يتأمل في وجهه فاحصا.
-الملك طوروس يحتاج إلى قارة كي يتوسع ويتنفس بالقدر الكافي.
أجابه لانكسن مكفهرا
-لا تكن تافها. فما دمت من سكان هذه المستشفى. عليك توخي الحذر من السخرية، أفهمت ؟
ردّ عليه مصلّح العجلات “فرانك جون” وهو شبه ثائر.
-خذ حذرك يا لانكسن من هذا الوغد – وأشار إلى فرانك- فهو يعمل في سلك القذارة؛ المخابرات.
صاح به القبطان “بيرن سكوت” وهو ينهض رافعا قبضته المليئة بقنينة البيرة الفارغة، استعدادا منه لتهشيم رأس فرانك.
-على مهلك يا بيرن. فقد يسكن نصف الشعب هنا في غضون سنة من الزمن. فليس أسهل من أن يكون المرء مجنونا أو معاقا في هذه الأيام. ولكن قل لي بحق السماء: هل تقل العنصرية كمرض عن الجنون في أوروبا الحديثة ؟ – ص 139 و140 ).
إن العقل الإنساني يقف حائرا أمام أفعال طوروس العجيبة الغريبة التي تنافي كل منطق وكل عرف. لقد أصدر قوانين وقام بإجراءات لا يمكن أن تصدر إلا عن عقل “جنوني”! . وهذه المحاكمة لا تصح إلا إذا وسّعنا مفهوم الجنون ليتعدى الأطر التقليدية المستقرة. إذ كيف “نعقلن” إجراء يقضي بتخصيص كلب لكل مواطن ؟ ما معنى أن يشن جلاد حملة إيمانية (أمر طوروس “المسلم” بمنع الخمور والعودة إلى منابع المسيحية!!)؟ ما معنى أن يلقي حاكم بشخص عاقل في مشفى للمجانين كعقاب له على عقله الانتقادي؟ ما معنى أن يقوم حاكم بقتل أشخاص يمنعهم من الهروب ويدين الدول التي تؤويهم؟ ما معنى أن يقود شخص كل نواحي الحياة في بلد ما، هل كون الشخص قائدا يعني أنه يفهم في كل الاختصاصات؟ ثم ما معنى أن تعتبر عرقك أهم الأعراق، وتحتقر ونصفي الأعراق الأخرى؟
إن الحضارة الحديثة – وحسب عالم النفس الشهير ” إريك فروم ” هي حضارة ” الجنون السويّ ” حيث يقول :
سيكون من دواعي دهشتي ألّا يقدَّم إنسان علم التحكم أحاديّ التفكير صورة لسير فصام الحد الأدنى المزمن ؛ “الشكيزوفرينيا – schizophrenia ” – باستخدام المصطلح من أجل التبسيط . فهو يعيش في جوّ لا يقل إلّا كمّياً عمّا يجري في الأسر الفصامية ( المُحدثة للفصام ) .
وأعتقد أن من المعقول ان نتحدث عن ” المجتمع غير السوي ” ومشكلة ما يحدث للإنسان السوي في مثل هذا المجتمع . فإذا أنتج مجتمع من المجتمعات أكثرية تعاني من الفصام الشديد ، فإن ذلك سوف يضعضع وجوده . والشخص مكتمل الفصام يتصف بأنه قد قطع كل العلاقات بالعالم الخارجي ، إنه منسحب إلى عالمه الخاص ، وأهم سبب يجعله يُعدّ مريضا بشدة هو سبب اجتماعي ؛ فهو لا يؤدي وظيفته اجتماعياً ، ولا يستطيع أن يُعنى بنفسه كما ينبغي ، ويحتاج إلى مساعدة الآخرين بطريقة أو بأخرى …. والمجتمع ، إذا لم نتحدث عن مجتمع ضخم ومعقد ، لا يمكن أن يديره أشخاص فصاميون . ومع ذلك يمكن أن يديره على ما يُرام أشخاص يعانون من فصام الحدّ الأدنى ، وهم أشخاص قادرون تماماً على إدارة الأمور التي تُدار إذا كان المجتمع يؤدي وظيفته . وهؤلاء الناس لم يفقدوا القدرة على النظر إلى العالم ” واقعياً ” ، شريطة أن نعني بذلك تصوّر الأمور عقلياً كما هم بحاجة إلى أن يتصورهم الآخرون ليتعاملوا معهم عاطيا . وقد لا يكونون قد فقدوا كليّاً قدرتهم على خبرة الأشياء شخصيا ، أي ذاتيا ، ومن قلوبهم . ويمكن للشخص مكتمل النمو أن يرى وردة ، مثلا ، ويَخْبرُها على أنها ناشرة للدفء أو ملتهبة ( وإذا صاغ هذه الخبرة في كلمات فقد ندعوه شاعراً ) ، ولكنه يعلم كذلك أن الوردة – في مجال الواقع الفيزيائي – لا تُدفىء كما تُدفىء النار . والإنسان الحديث لا يخبُر العالم إلّا من حيث غاياته العملية . ولكن نقصه ليس أقل من نقص من يسمّى الشخص المريض الذي لا يستطيع أن يخبُر العالم ” موضوعياً ” ، ولكنه احتفظ بالمقدرة الإنسانية الأخرى عن الخبرة الشخصية ، الذاتية ، الرمزية .
وأعتقد أن ” سبينوزا ” في كتابه ” فلسفة الأخلاق ” أول من عبر عن مفهوم ” الجنون الطبيعي ” :
تستحوذ على الكثيرين من الناس العاطفة نفسها باتساق شديد . فتكون حواسّه كلّها شديدة التأثر بشيء إلى حدّ أنه يعتقد أن الشيء موجود ولو لم يكن موجودا . وإذا حدث هذا الأمر عندما يكون الشخص مستيقظاً ، يُعتقد أن الشخص مجنون .. ولكن إذا لم يفكر الشخص الجشع إلّا في المال والممتلكات ، ولم يفكر الطامح إلا في الشهرة ، فلايعتقد المرء أنهما مجنونان ، ويكون لدى المرء احتقار لهما عموما . ولكن الجشع والطموح وما إلى ذلك ؛ هي بالفعل من أشكال الجنون ، على الرغم من أن المرء لا يعتقد في العادة أنه ” مرض ” .
ويغدو التحوّل من القرن السابع عشر إلى عصرنا واضحاً في أن الموقف الذي يقول سبينوزا إنه ” يكون لدى المرء احتقار … [ له ] عموماً ، لا يُعدّ اليوم محتقراً بل جديراً بالثناء .
وعلينا ن نتخذ خطوة أخرى ، إن ” أمراض الحالة السويّة ” نادراً ما تتدهور إلى الأشكال الخطيرة من المرض الذهني لأن المجتمع يُنتج الترياق المضاد لهذا التدهور . وعندما تُصبح السيرورات المرضية محتذاة اجتماعيا ، تفقد خصيصتها الفردية . بل على العكس ، فإن الفرد المريض يجد نفسه في بيته مع كل الأفراد الآخرين المُصابين بأمراض تشبه مرضه . والثقافة الكلية مرتصفة مع هذا النوع من الأحوال المرضية وتدبّر الوسائل لتقديم الإشباعات التي تلائم الأحوال المرضيّة . والنتيجة أن الفرد العادي لا يعيش تجربة الإنفصال والإنعزال التي يشعر بها الشخص الفصامي تماما . وهو يستأنس بالذين يقاسون من التشوّه ذاته ؛ وفي الواقع ، فإن الشخص السوي تماما هو الذي يشعر بالعزلة في المجتمع غير السوي – وقد يعاني كثيراً من العجز عن التواصل بحيث هو الذي قد يصبح ذهانيا – ص 130 و131 ) (14).
# الموقف من الكلب.. جنون أم عصاب؟ :
وقد يتصوّر القارىء العراقي والعربي أن الإشارات المتكررة التي نثرها اسعد في مواضع كثيرة من روايته، والتي تشير إلى الأهمية الإستثنائية لتعلق مواطني الديسكولاند بالكلاب ومنحها – كما هو الحال فعليا في الولايات المتحدة مثلا – كل حقوق الإنسان عدا حقي الإنتخاب والترشيح، هي إشارات هدفها إثراء المسار الدرامي للرواية وتصعيد وتائر وقائعها. لكن هذه الإشارات، وبعضها شديد الدلالات المضمونية، منسجمة تماما مع الإطار الفكري للرواية ومع رؤيا الكاتب . فقد كان واحد من أهم اسباب قيام “لوزانا” عشيقة “طوروس” بقتل زوجها “جو كريس” رئيس منظمة “عصابة الثيران الفولاذية” ثم الحاكم العسكري لاحقا – بالإضافة إلى إهماله وسوء معاملته وخيانته لها، وعدم إشباعه لحاجاتها الجسدية – هو قيامه بطرد كلابها المحببة إلى خارج البيت في الليل. وهناك الحوار المعبر بين سائق السيارة الذي كان مفترضا به أن ينقل عائلة هولم إلى المطار، والذي غيّر السعر المتفق عليه، بعد أن شاهد طفلة زائدة هي “مونو”، التي لجأت إلى عائلة الأخير بعد ضياعها :
هولم : أنت تحاول خداعي أيها الخبيث ، لتتركني عرضة لنهش الكلاب.
السائق : وهل أصبحت تكره الكلاب؟ لقد كانت تلك الحيوانات لديكم بالأمس أهم من الأرواح الآدمية. أقصد أهم من الأجانب الغرباء. فلم َ تنقلبون على مبادئكم بشكل فوري أيها السيّد ؟
- ولستم أفضل حالا منا. فأنتم تنامون مع الكلاب، وتهدرون عليها الكثير من الأموال .
- الأموال . الضرائب . ألا تنطق ألسنتكم غير هذه الكلمات المملة ؟
- إنها أحدث وسائل التذكير بالإذلال ليس إلا . والآن ماذا عن سعر نقل الطفلة ؟ – ص 115 ) .
ولعل أهم المواقف المعبّرة عن رؤيا الكاتب هو “قانون الكلاب” الذي أصدره طوروس بعد استيلائه على الحكم في ديسكولاند، والذي يقضي بأن (يقتني كل مواطن كلبا في منزله، حيث تتكفل الدولة بدفع نفقة شهرية تُقدر بخمسمائة (شبح) للكلب الواحد. ولم يعف القانون من أحكامه إلا الأجانب، كونهم لا يفقهون لغة الكلاب، ولا يعرفون سبل التعايش معها. بل لأن الكلاب ترتاب منهم أصلا ، ولا تطيق روائحهم، كما كان سكان البلاد يقولون عنهم فيما مضى – ص 134 ) .
وقد أتبع طوروس هذا القانون بقانون آخر يفرض على المواطنين استخدام حفاظات خاصة لكلابهم. والأدهى هو قانونه الذي يأمر بجمع فضلات الكلاب في البيوت وتسليمها إلى “شرطة الكلاب” يوم الأربعاء من كل أسبوع للإستفادة منها لدعم الإقتصاد الوطني (ص 138 ) .
وصحيح أن الكاتب بفعل معرفيّته العالية يضع على لسان الملك طوروس استنتاجا يرتبط بنتائج هذا النزوع “الكلبي” في تلك الحضارة؛ حضارة الديسكولاند، وهو نزوع يعبر عن خواء مفزع في الروح البشرية: (إن مجموعات بشرية تحب العزلة، وتفضل معاشرة الكلاب على الإختلاط بالشعوب الأخرى ، حريّ بها هذا المجد : تعيش في غابات نباح . فالحضارة مثل المخلوق الحي ، متى ما شعر بتخمة الإستعلاء ، يكون قد أجهز على نفسه بمصير مغلق أو غامض – ص 135)، إلا أن ما ينبغي علينا الإحالة إليه ، وهي إحالة متسقة مع افتراضنا الأساسي الذي يرى أن هذا التعلق النفسي المفرط بالكلاب خصوصا والحيوانات عموما ما هو إلا جزء من معطيات الفلسفة المادية الحاكمة التي سيطرت على الفكر الغربي والتي قدّمت تأويلات خطيرة لأهمية مساواة الإنسان بالحيوان ووضع لائحة بحقوق الأخير مشابهة للائحة حقوق الإنسان؛ إنه نتاج حضارة وفلسفة خاصة هي الفلسفة المادية العلمانية الغربية، والتي من أهم مرتكزاتها “التسوية” ، وإلغاء أي مرجعية ثنائية. تسوية الإنسان بالطبيعة وبالتالي بالحيوان، لإلغاء أي خصوصة له . (وتظهر هذه العنصرية الجديدة المعادية للإنسان، والتي تقوم بتسويته بالكائنات الأخرى وتصفّي كل الثنائيات وتنكر كل تجاوز (تجاوز بالمعنى الفلسفي طبعا) في أفكار العالم البريطاني ريتشارد دوكنز (أستاذ علم الأحياء في جامعة أكسفورد) الذي يبدأ منظومته بالقول بأن الإيمان بإله متجاوز للنظام الطبيعي إن هو إلا خلل في العقل يشبه القيروس الذي يصيب الكومبيوتر ، أي أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة/ المادة التي تشبه الكومبيوتر المبرمج بدقة. وقد بدأ هذا الأستاذ حركة سياسية لمنح القرود (باعتبارهم أقلية مضطهدة) حقوقا متساوية مع البشر، على أساس الأطروحة الداروينية التي تذهب إلى أن الإنسان والقردة متساوون من الناحية الجوهرية.. وظهر ما يُسمى بمشروع القرد الأعظم الذي أصدر إعلان القردة العليا على غرار إعلان حقوق الإنسان ، ويبدأ الإعلان بما يلي: (نحن نطالب بتأسيس جماعة من القردة العليا من الأعضاء المتساوين في الحقوق تضم ما يلي: البشر والشمبانزي والغوريلا والأورنج تانج). وقد عرّفت عالمة الأنثروبولوجيا الهولندية بربارة نوسكي هدف هذا الإعلان بأنه “فك التمركز حول الإنسان” .. ) (15) .
إن إشاعة العناية بالكلاب إلى درجة مساواتها بالإنسان هو نتاج فلسفة عميقة تحكم الحياة الأوروبية عموما والأميركية خصوصا. وهي نتاج السعي لفك التمركز حول الإنسان ورفض الثنائيات وإلغاء المرجعيات ومفهوم التجاوز . وبفك التمركز حول الإنسان يصبح كل شيء مساوٍ لأي شيء (وهذا هو محور الفلسفة التي تقود العولمة). ويصبح أي مواطن في أي مكان مساوٍ لأي مواطن في أي مكان آخر ليس من ناحية حقوق الإنسان أبدا، ولكن من ناحية تسطيحه كسلعة وإلغاء مركزيته التي تتأسس في عائلة ووطن وأمة.
وقبل مدّة قام أحد القضاة الأميركيين بمعاقبة زوجين، بغرامة قدرها خمسمئة دولار، لأنهما تركا “قطة” تموء وحيدة وجائعة في البيت لعدة ساعات، في حين أن جزّاري ملجأ العامرية – وهم الكلاب الفعليون، بل هم أدنى من الكلاب – والذين أحرقوا أكثر من أربع مائة طفل وامرأة، وهم أحياء، لم يُحاسبوا حتى الآن، بل بالعكس فإن سفّاحهم “شوارزكوف” قد مُنح أوسمة ونياشين التكريم !!
# نظرية “الفاتحة” الإنسانية، مقابل نظرية العولمة العنصرية :
قد يبدو غريبا – على القاريء العام خصوصا – أن نقول أن “الحداثة” الغربية، قد أنجبت للعالم الإستعمار الكولونيالي، بكل المآسي الدموية والعذابات الهائلة والخسارات الجسيمة التي سببّها للشعوب المتخلفة المسحوقة، التي نظر إليها كشعوب لا تستحق الحياة، وتنبغي إبادتها أو اجتثاثها بحدود معينة بما يخدم مصالح شعوب الرجل الأبيض الذي حمل عبء “الرسالة” التي طفحت بالمقت والتحامل والروح العنصرية التي سمّمت نفوس أبناء الشعوب المفتوحة. أما مرحلة “ما بعد الحداثة”، فإنها أنجبت لنا العولمة والنظام العالمي الجديد، الذي يقوم على مبدأ “القتل عن بعد” بعد أن تسلّح بأعظم مخترعات الموت العلمية. وليس غريبا على مفكر لامع ومشهور مثل “هيدجر”، بنزعته النيتشويه المعروفة، أن ينحاز إلى هتلر وإلى الحركة النازية، بعد أن رأى فيهما تجسيداً للنوى الأولية لأفكار مابعد الحداثة، فأيّدهما بلا تحفظ، وصار النازيون يعدونه فيلسوفهم.
وليس غريبا أيضا أن يأتي الإعلان عن “نهاية التاريخ” على لسان فوكوياما، وبمباركة من القيادات المرجعية الغربية مع تصاعد انطلاقة حركة العولمة، فهذا الإعلان هو في حقيقته دعوة عنصرية تعني ضمنا إنهاء “الآخر”، الذي لم يعد له أي تاريخ و هوية ولا مستقبل، إلا بالإنصهار في التصوّر الكوني الجديد، الذي يقوم على الفلسفة المادية الغربية التي تسحق كل الهويات والمرجعيات الأخرى. والغريب أن نهضة العولمة ودعوتها إلى عالم بلا حدود ونظام دولي جديد، جاءت “مسلّحة” بصورة أفظع من كل المراحل السابقة، بالرغم من أنها تعدّ الديمقراطية وحرية حركة الأفكار من مبادئها الأساسية. حالها، في هذا التناقض، حال أرض الديسكولاند الموعودة التي كانت ترفع شعارات الحرية والديموقراطية والمساواة في نفس الوقت الذي كانت تذيق فيه اللاجئين إليها مرارات التمييز والقمع والإستغلال. وقد عبّر الروائي بدقة، عن الموقف الرافض للآخر والساحق له، الذي وسم حركة العولمة، من خلال ما قاله “مدير شعبة النطق” وبطريقة منذرة لآدم السومري :
(سأقول لك كلاما قد يقنعك أيها السومري..لنفترض بأنك أنتجت أيديولوجية جديدة لحسابك الخاص، وأطلقت عليها اسم “الفاتحة” وكلها تتلخص بالفتح الإبجابي لا بفتوحات القوة أو الغزو أو استعمال السلاح، فماذا سينتج عن ذلك كلّه؟
سيكون لسانك مفقودا أو ثقيلا بالحديد أو مغطى بكثبان من الرمل… جوابي سيقضي على على مجمل ما تعاني منه بعد خروجك من غرفتك الشاقولية.
أجل يا آدم. فنظرية “الفاتحة” تريد من سكان العالم أجمع، ودون استثناء، أن يكونوا منفتحين على بعضهمليبس إلا؛ أن يأكلوا من صحن واحد. أن يعملوا في ورشات مشتركة. أن يتنفسوا هواء واحدا بمختلف الرئات. ستقول : وهل تتساوى الشعوب المنتجة مع الشعوب الكسولة؟ وهنا لابد من جواب يخرج عليك من فم تمساح، ليصرخ بوجهك مع بصقة بحجم كوكب المشتري (هنا تتدخل حفزات الكاتب لتضخم الشتيمة إلى حجم مفرط لا داعي له- الناقد) : لا توجد شعوب منتجة وشعوب كسولة على الأرض، هناك شعوب منهوبة فقط، ومجموعات بشرية مكرّسة لن تكون كسولة بهدف توسيع حلقات استهلاك ما تنتجه لهم الشعوب النشيطة المنتجة النظيفة الغنية- ص 296 و297).
وتحيلنا الإشارة الرمزية إلى “الفاتحة” إلى ما تستدعيه الذاكرة من مخزونها عن المفتتح القرآني التقليدي في إشارة ذكية وغير مباشرة إلى المشروع الإسلامي الروحي المساواتي الذي يتوقع مدير مشروع النطق الديسكولاندي أن آدم السومري يحمل تصوّره الجوهري في ذهنه. وهنا لا يمكن إلا أن نستعيد أيضا وبصورة شبه شرطية موقف الحضارة والفسلفة الغربية من الإسلام، ممثلة بمشروع “هنتنغتون” العنصري والدموي الداعي إلى صدام الحضارات والذي جعل الإسلام – ومعه الكونفوشيوسية – عدوّا للنهضة البشرية الحضارية الختامية ممثلة بحركة العولمة. ترى أليست هذه نظرية إرهابية ؟
(والنظام العالمي الجديد بهذا المعنى، نظام معاد للإنسان ومعاد للتأريخ، وهو عداء نابع من العداء الذي يحس به ذوو الاتجاه الطبيعي المادي نحو كل الظواهر المركبة بكل ما تحوي من قداسة أو أسرار، وهو أيضا نابع من رغبتهم العارمة في تسوية الإنسان بما حوله، حتى يذوب في الطبيعة/ المادة ويختفي ككيان مركب مستقل. ولابد من التصدي لهذه النزعات المعادية للإنسان وللتاريخ، ولا يمكن أن يتم هذا إلا عن طريق الجهاد ضد عمليات الترشيد المادي والمكدلة والكوكلة macdonalization & cocalization.
إن هذه الحضارة الغربية تشيع صورة للإنسان باعتباره كائنا طبيعيا جسمانياً، وتشيع نمطا استهلاكيا لا اساس له في الواقع المادي أو التاريخي. ولذا فالصور التي تشيعها هي أكبر دعوة للإرهاب، فمن يبيع صورة مستحيلة يدعو بشكل صريح للصراع والتقاتل والإرهاب.
والإسلام كرؤية للكون يرفض هذه الرؤية المادية ابروميثية الفاوستية، فهو يدعو للتوازن بين الإنسان والكون، وينمي في الإنسان إحساسه بذاته الإنسانية وبمنظوماته الأخلاقية التي تخلق مسافة بينه وبين الطبيعة والمادة وتزوده برؤية تمكنه من رفض هذه الاستهلاكية التافهة الشرسة. ولاتزال الشعوب الفقيرة في عالم السلام تجاهد ضد هذا النظام العالمي الجديد القديم.
وهذا هو سر عداء هذا النظام للإسلام. فلو أن الإسلام يدور حول بعض الشعائر ويركز اهتمامه على ختان الإناث (كما يدّعي البعض) لقام النظام العالمي الجديد بتشجيعه وتمويله. والعالم الغربي على أتم الاستعداد للتصالح والتعاون مع حكومات شمولية قاتلة ترفع لواء الشريعة الإسلامية علانية ولكنها تتبنى، بشكل واع أو غير واع، رؤية للإنسان باعتباره غاية داروينية مادية. ولكن النظام العالمي الجديد يعلم تمام العلم أن ثمة رؤية اسلامية إنسانية شاملة، اساسها الإيمان بالعدل، وأن هناك خطابا إسلاميا جديدا مركبا إلى أقصى حد يؤكد ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، وبين أعضاء الأغلبية والأقلية، ويطرح رؤية مركبة للعدل الاجتماعي وللعلاقات الدولية، ويجند جماهيره ضد الاستهلاكية اللعينة.
يقول “سيرج لاتوش” في كتابه “تغريب العالم”: إن الغرب لم يعد بقعة جغرافية ولا حتى لحظة تاريخية وإنما أصبح كالآلة التي تدور وتدوس الجميع بما في ذلك صاحبها والقائمين عليها. والجهاد الأعظم هو محاولة الخروج من القفص الحديدي ومن هيمنة الآلة البسيطة التي تشبه في دورانها ورتابتها حالة الطبيعة، إلى عالم مركب مدهش، يقف فيه الإنسان كائنا نبيلا كريما، متعدّد الأبعاد، يحمل عبء وعيه التاريخي ومنظوماته الأخلاقية والمعرفية- ص 174 و175و176)(16).
وفي لمسات سريعة موحية يقدّم الروائي مقارنات ثرة في دائرة الفوارق العميقة بين هذين الموقفين الحضاريين : العنصري الديسكولاندي، والإنساني الشرقي الإسلامي. ويجب الإنتباه إلى أن اسعد قدّم التسميات الفعلية لمدن الشرق العربية والإسلامية: مراكش، وبيروت مثلا، ولم يضع لها مسميات رمزيّة، في حين أنه وضع للعالم الغربي تسمية رمزية هي الديسكولاند وهو موقف بالغ الدلالة. ومن تلك اللمسات السريعة والموحية هو الحوار الموجز الذي دار بين سوني، وقد استقرت لاجئة في بيروت، وعشيقها اللبناني بيرم، حيث سألته عن أخبار عيسى المعشوق – عضو ثلتهم التي يسهرون معها كل ليلة – .. فيلعنه بيرم، ولكنها تعاتبه محتجة :
(-ولمَ تلعنه؟ أنت مسيحي وهو مسيحي.
-لا .. صديقي عيسى المعشوق مسلم.
-وهل يسمّي المسلمون أولادهم بأسماء مسيحية ؟
-نعم. هم يسمون بأسماء موسى وعيسى وعمران ويونس … ألا يحدث لديكم في الغرب شيء من هذا القبيل، أن تُطلقوا إسم محمد أو فاطمة أو عمر أو علي على طفل من مواليدكم ؟
-لم تكن لدينا الشجاعة لنفعل ذلك بعد.
-الشجاعة فقط .. أم الـــ .. ؟
-العنصرية تقصد ؟ – ص 201 و202).
# طوروس نتاج تظافر عنصريتين :
يقول المؤلف الأول “ستيفاني بروكسن” مؤلف رواية “ديسكولاند” والذي قتله الوزير بجرعة من الثاليوم في العصير الذي قدمه له وهو يشكره على جهوده، – ما علاقته باسعد؟- وهو يعلن ارتياحه في القبر الذي يعده فردوسه الأرضي بأنه كان شاهدا على “زمن العنصرية” في بلاده .. وما فعله بالغرباء المهاجرين الذي جاءوا أرض الديسكولاند هاربين من بطش سلطات الشرق التي (فعلت بهم ما نفعله نحن بالخنازير – ص 230) كما يقول.
وقفة : الضمير يصحو متأخرا عادة :
.. ومشكلة الضمير البشري هو أنه يصحو دائما بصورة متأخرة أو على حافة بعد فوات الأوان إذا جاز الوصف حيث تكفي دفعة صغيرة لحدث اجتماعي بسيط جدا لأن يسقط في هاوية الخراب الماحق. وقد قدم الروائي هذه الصحوة المتأخرة في مواضع كثيرة كانت تجري على صورة حوارات تأنيبية وتكفيرية، ومراجعات تقرّع الذات بين شخوص الرواية من المواطنين الديسكولانديين الأصليين، خصوصا من الفارين منهم من جحيم طوروس إلى المنافي. لكن واحدة من بين أهم هذه المراجعات هي التي تمظهر فيها قرين نفسي يمثل الضمير للديسكولاندي (هولم)، رب الأسرة التي آوت (مونو)، وذلك في حلم قصير غرق فيه وهو في طريقه للفرار من وطنه بعد أن انقلب سحر العنصرية على الساحر إذا ساغ التعبير:
(لقد ضغطتم ضغطا هائلا على من تسمونهم بالأجانب، مما أخرج الرصاص من صدورهم، فولّد الإنفجار المروع ليطيح بكل ما كان جميلا لديكم دفعة واحدة. ساقتكم بعض رموزكم السياسية المعقدة إلى الجحيم بهدوء…. أفعالكم أدت لانقسام في المجتمع وفي الجيش وفي الفكر وفي النفس البشرية. لقد فتح الإنقلابيون الطريق أمام طوروس. عبّدو له الطريق بالحرير، فالتف على عصاباتكم وخرج منتصرا.
شيء يبعث على القرف والقذارة: الأجانب عاطلون ، الأجانب يعملون، الأجانب لا يتعلمون، الأجانب يملأون المدارس، الأجانب ينكحون بنات البلد، الأجانب يتوالدون كالأرانب… الأجانب الأجانب الأجانب، وكأن بلادكم فردوس خال من المشاكل إلا من مشكلة وجود بضعة ألوف من اللاجئين والغرباء. كيف يكون المرء معرفيا وحضاريا وهو يحاول العيش داخل علبة من السردين ؟ أليست الشعوب التي تنتمي إلى نفسها تبقى شعوبا متحجرة، لأنها تمنع روحها عن التلاقح مع ثقافات الآخرين وحضاراتهم؟ كل حضارة في هذا الكون تحمل أجوبتها الخاصة. وقد لا تجد شيئا من تلك الأجوبة إلا عند الحضارات الأخرى – ص 116 و117) .
عودة : رواية العصاب العنصري :
إن هذه العنصرية هي طبقة حديثة من طبقات العصاب “الجنوني” الذي خلخل بنية طوروس النفسية الداخلية وشوّه شخصيته. إنها طبقة تراكمت فوق طبقات مرضيّة أخرى جاء طوروس محمّلا بها أصلا من بلاده الشرقية؛ طبقات مرضيّة كانت تربة طفولته (طفولة تذكرنا بطفولة مالك ولكن من مقترب آخر)، المكان الملائم الذي استقبل بذور الإستعداد للحقد والعدوان والنقمة، التي كمنت طويلا ثم أنعشتها وأنهضتها زخات من أمطار عنصرية الديسكولاند السود. وهذه النظرة الثاقبة لأهمية التاريخ الشخصي في نشأة ونمو وترعرع الإستعداد لتقبل الأفكار والمواقف العنصرية، هي ما إستهل بها آدم السومري، روايته من خلال تقييم طفولة طوروس، كعامل حاسم في توفير نوى الشخصية الطغيانية، التي هي تشكيل عكسي ضخم لانمساخات وإحباطات طفولة معذّبة ومعادية (أعلن طوروس يوم قتله كلبا اسود وهو طفل عيدا وطنيا في الديسكولاند):
(ستعجز الأنثروبولوجيا عن تفسير طوروس، وما يمتليء به جسده من أشياء ميتة أو حيّة على حدّ سواء. لقد رضع الرجل من الغرب حليبا مازال يتسبب بعسر هضم الشقاء الإنساني والكراهية التعبيرية. لقد غسل الظلام وجه طوروس مبكرا. تصحّرت ذاته ؛ فأشبعت طفولته بآثار الخيبة وخيالاتها الإنتقامية منذ الزمن الأول. فأشدّ انتقام يواجه المرء، أن يتشبع بالخيال القمعي منذ صغره. آنذاك، لا يجد ذلك المخلوق فرصة لتطهير ذاته المكونة من طبقات قهر قديم، بل يمضي بالإتجاه المعاكس. يُغرق نفسه بالظلام ويتشكل في نسيجه. يبتكر عبقرية ظلامية، تشع بجنون جاد، بحيث لا يعود يعرف رأفة ولا يركن إلى سكون – ص 312) .
ولكن من الضروري التنبيه على أن تلك الطبقات فيها ما هو مرتبط بالطبقة الأخيرة الحديثة التي شكّلها النبذ والإحتقار الديسكولاندي له؛ إنها الطبقات التي صنعها التسيّد العنصري الإستعماري الذي مُرّر تحت غطاء رسالة الرجل الابيض، وكانت مغوية ايضا، لكنها عنصرية المضمون، وأذاقت شعوب طوروس علقم العبودية والمهانة والإذلال لقرون طويلة. فقد امتص الإستعمار الغربي (الذي كان عنصريا بطبيعته، وبطبيعة الفلسفة التي أنتجته) دمّ شعب طوروس، الذي جاء الآن ليعيش المأساة “الإستعمارية” من جديد، ولكن في ديسكولاند الديمقراطية حيث يُستغل في العمل بقسوة، ويُذل بالمعاملة العتصرية بلا رجمة. لقد تعلّم طوروس الدرس العنصري الأول، ولقرون على الأيدي الآثمة للمعلم العنصري الأكبر: الإستعمار. ثم جاء إلى الديسكولاند بحثا عن الخلاص من بطش بلاده في الشرق، ليواجه خدعة ممزوجة بالاستغلال وكأنه قد استُدرج إلى مصيدة السطو الاستعمارية العتصرية القديمة ولكن تحت غطاء ديموقراطي هذه المرّة.
إن التشخيص الذي يقدمه “بروكسن” لسلوك طوروس الطغياني وأفعاله الديكتاتورية دقيق جدا، فطوروس تعاون على تشكيله مرضيّا الشرق والغرب على حدّ سواء:
(كل تفكيك لقطعة من جسد طوروس، يعني تفكيكا للبنيان الفكري الذي تشكل منه ذلك الوحش. ويعني أيضا، توطينا للغات السياط والسجون والملاجيء والكراهية والإحتقار. حيث يلتقي الغرب بالشرق في مركز الزلزال، أي على نقطة واحدة تُسمّى: طوروس.
لا يمكن النظر إلى طوروس كمتقمص لنزعة التدمير والإنتقام في مواجهة خصومه التاريخيين. بل لأن تكوينه العنيف، هو نتاج تراكم تاريخي طويل من تأليف الإحتقار له ولجذوره، والتي من أقلها: الإستعباد الفظيع الذي مارسه المستعمرون القدامى، ممن يحاولون اليوم تكييف سلطاتهم بأنماط جديدة من الهيمنة.
فالإرهاب الطوروسي بكل ما يحمل من فانتازيا وخرافات ورعب مضادة للوعي الإنساني، امتد ليُطبق على شبكية التشكيل الروائي للنص، ليصبح الإنتقام المزمن إعلانا عن فتح الهاوية أمام الجميع – ص 330 و331).
وتعاون الغرب والشرق هذا في خلق حكاية طوروس المأساوية التي فاقت بشرورها نتائج العنصرية الغربية لأنها نتاج مضاعف من اجتماع ثقافتين دمويتين، خلق أسعد له “تعاونا” سرديا مقابلا في مسارات العملية السردية الداخلية – كتابة “رواية” طوروس- بصورة موازية من خلال تعاون “السارد” الغربي “ستيفاني بروكسن” مع “السارد” الشرقي “آدم السومري”، لإكمال رواية واحدة عن طاغية عنصري هو نتاج ثقافتين متعارضتين في الظاهر ومتفقتين في الباطن على تدمير إنسانية الإنسان، ومحق حضوره المرجعي في الكون والطبيعة. لم يستطع بروكسن الديسكولاندي أن “يكتب” رواية طوروس بالصورة الشافية التي تعكس هذه التركيبة ذات الطبقات المعصوبة إنسانيا وعنصريا التي تحدّث عنها ، بالرغم من أنه كان يعتقد بأنه قد أنجز العمل بصورة كافية، وبالرغم من أن طوروس نفسه قد أوصاه بأن يكون أكثر قذارة في تدوين حياته وأفعاله. لقد كانت اللوحة/ بورتريت الواقع النفسي المرضي لطوروس غير مكتملة الملامح فهو نتاج ثقافتين استطاع بروكسن الإلمام بالإفرازات السمّية للأولى، لكنه لم يكن قادرا على الغور عميقا في تربة تلك الطبقات التأسيسية التي شكلت القوائم الراكزة التي أشادت عليها العنصرية الديسكولاندية مراراتها الخانقة. وقد كانت هذه مهمة المؤلف الثاني “آدم السومري” الذي شهد “المراقبون الثلاثة” بقدرته الهائلة – خصوصا بعد أن انتهت مرحلة رفضه بمعالجته بـ “الغرفة الشاقولية” – على قدرته الهائلة على أن يسحب من أعمق أعماق طبقات التاريخ الآليات والوقائع التي شكّلت ديناصورا اسمه طوروس :
(فاجأنا آدم حقا، حينما بعث في الرواية ديناصورا مسخا ، كان يختبيء تحت طبقات الأرض. سحبه من كهوف الظلام السحيقة، وقدّمه لنا على طبق من ذهب. وبسبب ضخامة الحدث وثقله، أوصلنا إلى بلاغة فاسدة مرجوّة، فرض طوروس رائحتها على مناطق الرواية وأوردتها وثقوبها – ص 337).
وإذا كان بروكسن قد كوفيء بجرعة ثاليوم مميتة في كأس العصير التي قدمها إليه “غلاوسين” وزير الحواس، فقد كوفيء آدم السومري أيضا بقتل عقله من خلال رميه في مستشفى المجانين. وفوق ذلك فقد سلبه الوزير هذا حقه باستيلائه على جهد الروائي المرهق ووضع اسمه على غلافها كمؤلف لها، الأمر الذي اثار سخط طوروس الذي طلب منه إحضار المؤلفين حيين أمامه ، وبخلافه فإنه سيُلقى في “الهول ديزني” المعتقل السري الرهيب، الذي يعد من أساطير الجحيم، والمخصص لتعذيب القادة الذين يشك طوروس في ولائهم.
لكن أسعد الجبوري – وهذا امتياز مضاعف له – هو “السارد العليم” – طبعا ليس وفق المصطلح السردي المعروف – . هو المؤلف الخالق الذي صمم شخصيتي المؤلف الأول والمؤلف الثاني، كما صمّم – وهذا هو الأهم – شخصية طوروس التي مرّر من خلاله رؤاه المركزية التي اعتصر خلاصتها في المشهد الختامي حيث يشاهد آدم السومري/ المؤلف الثاني، ويكون شاهدا على عبثية محاولات الخلاص من خلال الفعل الإرادي العملي المتمثل بفتح ثقب في السور العظيم (سور العزلة والموت) ومحاولة الفرار من الديسكولاند حيث يُقبض عليه مع الرجل الذي حاول تكسير الحجارة ، لوضعهما أمام المسلة الإلكترونية/ المقصلة قارئة النوايا، وكان هدف آدم و “رؤية البحر” فقط للتطهر والخلاص . وبذلك نعود إلأى حلم مالك الطفل المُجهض في رؤية البحر وهو في أحضان جده/ أحضان الذكورة الخاصية التي أنجبت طوروس، أو – وهذه محاولة الخلاص الثانية – بتسجيل حكاية طوروس لتكون الحكاية الدرس التي يتسلح بها الناس في الديسكولاند لبناءعالم إنساني حرّ كريم ومتوازن.. فحتى للشيطان – بتحوير مقولة كافكا المعروفة – هناك أمل ، أما للإنسان .. فلا .. خصوصا إنسان الديسكولاند الذي سيسحق بفعل قيامة الديناصور العنصري المركّب :
(.. بعد ذلك وجدت نفسي على ظهر اليخت الملكي، أمام طوروس الذي كان مستلقيا كالديناصور في بانيو محاط بأجساد شبه عارية لمجموعة من المدلكات الفاتنات، وهو يتابع عبر الشاشة عمل المقصلة الأوتوماتيكية، فيما كان حرّاسه مشغولين برمي نُسخ روايتي إلى البحر – ص 356).
.. يبتلع البحر حكاية المؤلف الثاني .. لكنه لن يستطيع ابتلاع حكاية المؤلف الخالق الشاهد .. أسعد الجبوري الذي دق، بشجاعة وكفاية سردية عالية – رغم الهنات والعثرات – ناقوس الخطر المنذر من بحر العنصرية الهائج في الديسكولاند، والذي سيصبح طوفانا، يبتلع أول ما يبتلع، الديسكولاند نفسها… فتحية له ..
هوامش :
(1) ديسكولاند – أسعد الجبوري – رواية – دار فضاءات- عمان – 2010
(2) مهزلة العقل البشري – د. علي الوردي –
(3) و(4) و(7) و(9) و(10) و(15) و(16)الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان – الدكتور عبد الوهاب المسيري – دار الفكر – دمشق – الطبعة الرابعة – 2010.
(5)و(6) القوة والإرهاب جذورهما في عمق الثقافة الأمير كية – نعوم تشومسكي – ترجمة – إبراهيم يحيى الشهابي – دار الفكر – دمشق – 2003 .
(8)1984 – جورج أورويل – ترجمة أحمد عجيل – رواية – المكتبة العالمية – بغداد – 1990 .
(11) و(12) أيديولوجيا الإسلام السياسي والشيوعية – د. سامح محمد اسماعيل – دار الساقي بالإشتراك مع مؤسسة الدراسات الفكرية – بيروت – الطبعة الأولى – 2010
(13) مقالة بعنوان: فعل التسمية بين العمليات العسكرية ومقاصد السياسة للدكتور والباحث التونسي عبد السلام المسدي من خلال الرابط: http ://www w.afkaronline.org/arabic/archives/Juill-aout2006/mseddi.html
(14) تشريح التدميرية البشرية – إريك فروم – ترجمة د. محمود منقذ الهاشمي – الجزء الأول – منشورات وزارة الثقافة السورية – دمشق – 2010.
مع نهاية كل أسبوع نقرأ ممحاة شعرية جديدة للشاعر أسعد الجبوري، فيها يُمهد للانقلاب على النسق شكلاً ومضموناً لخلق شعرية مختلفة تستند على رؤية مغايرة لشعرٍ جديد من خلال اشتغاله على اكتشاف الذات والتأسيس لما يُشبه نهضة رؤيوية قادرة على ابتكار ما يُطيل أمدها بشحن أسباب وجودها كي نصل معه إلى ثَمالة شعرية حقيقية. ثمة شعر لا يكتفي بالتحليق العادي، وثمة شعر يُسكِر بلمسات خاطفة، وفي زحمة هذا وذاك لا أحد يُنكر قوة النثر في خلق حالة تفيض شعراً، وهكذا يأتي المقال مُلْقياً بظلاله على غموض يشفّ عن تمرين للمعاني على استيعاب تقنية خاصة في اختيار تراكيب مُذهلة ومُربكة في آنٍ معاً، حيث يجتمع في كل ممحاة أسبوعية، كلاً من المقالة والشعر وبنك الخيال، وحوار يدور بين سانشو ودون كيخوت؛ لإكمال فكرة تنشعب ومن ثم تلتئم، لتنتهي شعراً أو سطراً صادماً من بنك الخيال. من ممحاة "سبيرتو" :
الأجسادُ الأهراماتُ.. تنهضُ في فضة الحقول الدونجوانية. والطائرُ النفسي مخضبٌ باللقاح. فيما الحبّ يمضي متعمقاً في آخر النقاط. يحدث ذلك بجرأة مرآة، تحفظُ بصماتَ العابرين بين ثيابها المرتوية بالبصر.
ووحدها لا تتألم.. تلك الثيابُ الملقاة على الرمال في اللوحة.
يُركز الجبوري على ضرورة إبراز ما يُسميه بطقوس الإغواء ما بين روح القارئ والأرواح المقيمة في النصوص، إذن لا بد من مسالك سحرية تصهرها ليتطاير الشذى فيما بعد. كما يُشير إلى قرابين تُقدّم طواعية بغية الوصول إلى هكذا حالة صحية من شعر مُستَلِب ولكن دونما الوقوع في حالة من التبجيل المَرضي للنص، مع أن القارئ في توق دائم إلى النص
/الشرَك ليقع في أسره. يعتبر الجبوري أن الأحلام " قطعان حيوانات ضالة في صحارى الرأس"، ونحن معه في أن هذه الأحلام تحتاج إلى شاعر يثور على أية حالة ساكنة، بل وعليه أن يحرّض على الالتهابات السامية التي يعتبرها من أهم المصادر الشعرية المثيرة للنيران..نيران الخلق والوجود. إذاً الغاية، هي البحث عن ألق متصاعد يُغذي القصيدة ويضخ المزيد من التوتر كي نلامس حدود الشعر في نص جارف لكل فخاخ التسمية عبر اكتشاف مسار خاص له. لن نختلف على أننا نعاني من ضيق شعري، وأننا لن نتعافى منه إلا بامتلاك أدوات الخيال الوثّاب دون أن يجرحنا شوكه النابت في صور نافرة. ليس الهدف تحقيق الأمان لصور شعرية بل فضح الشعر الكسول. برأيه أن الملائكة لا توحي بالشعر وليس هناك ما يمنع النزول عن العرش، طالما نستطيع أن نحقق فتنة رائقة وقلق فني محبّب في صدمات صغيرة موحية، تؤسس لحالة روحية متمرّدة، ولكنها ذات أسلوب داخلي ومنضبط حتى ولو بدت ساخطة إلى أبعد الحدود.
"نحن الهديل الذابل في النوتة" "الشعراء الذين ينتظرون جوائز القراء، فلن يحصلوا إلا على المرارة"
يُبرّر الجبوري ويُشرّعن افتراس العقل من قبل كائنات الحداثة...كونها طوق نجاة..الطوق الذي يصنعه المهرة من الشعراء المعجونين بماء الذهب؛ المالكين لعين شيطانٍ تمكنهم من الاغتسال من النصوص الرديئة، وهذا حتماً سيحوّلهم إلى شعراء خصومة بسبب دعوتهم إلى التحرر من الهياكل القديمة، وتقوية مناعة العقل قبل تحوّل الكائنات البشرية إلى شاشات. فعلاً، غياب القارئ مهّد لصنع القتلة. "صار الإنسان حطباً تُنتزَع طاقته لقتله". ولا ينسى الجبوري أن يلفت النظر إلى ديكتاتورية الأقسام الثقافية، وتلويثهم للحبر وتخريب الذاكرة، بتكريسهم لنمط قهري لا يتبدّل وفكر سديمي يقود إلى ما نشهده من إعاقات روحية بعيداً عن مطاحن البصيرة. أيضاً يُشير إلى طقوس النشر وما تفرضه من مناخ مستبد يتبدّى في استياء الشعر وشعرائه من ناهبيه. كما يدعو الجبوري إلى تفكيك الآلهة بعد تراجع درجة حرارة الأساطير والحاجة إلى إيجاد أبعاد أسطورية أخرى.
" لابأس في أن تأكلنا النمور حتى يتطاير غبار ريش الأساطير" و"كل تفكيك لأسطورة هو تفكيك لإله، وهو يعني كسراً لنظام العبودية".
هذا يستدعي محاربة الظلام اللغوي بلغة النور. حقاً، قد آن الأوان لتنظيف العقل واللغة.
يسعى الجبوري في كل ممحاة إلى خلق ميثولوجيته الشخصية المتماسكة والدّالّة عليه بغرائبيتها المُبهرة؛ شعر يُحفِّزك على تحرير ذاتك بإغناء الوعي وضرب الإيقاع، وبدون حتى أن يفرض إرادته عليك، مع أنه أحياناً يسير بنا إلى سخرية شعرية ولكن واعية، بإدخال كلمات فجّة تُقلق أمان الصورة التي اعتدناها.
"الأمل كلب سلوقي" لا يقصد الجبوري من خلال انهماكه اللغوي أي تشويش، بل الإخلاص لفضاءات شعرية تحملُ في طبقاتها ما يُغني القارئ ويبدد ما حوله من سواد، حتى لا تفنى النصوص قهراً من استسلامها لتراكم لغوي مكرور ومستهلك. حتى أنه يُشير في بعض قصائده إلى تصاعد الدخان من مخلوقاته الهائمة في النصوص على شكل سحب، وهنا تكمن براعة إنضاج العملية الشعرية بتحقيق حالة من البهاء والدهشة.
السؤال الأهم الذي يتبادر للذهن بعد إتمام قراءة رواية "ديسكولاند" لأسعد الجبوري هو: من المسؤول عن طوروس وعهده الأسود وسلطته المطلقة وجبروته العاتي؟!
هل طوروس نتاج غرب عنصري، أم نتاج شرق متخلف، أم هو مزيج من هذا وذاك؟
كثيرة هي القضايا الإشكالية والموضوعات التي تثيرها الرواية، وتستحق الوقوف عندها بتأنٍ وتعمق. وستقتصر هذه المقالة على عناوين ثلاثة فقط:
محاضن العنصرية
العنصرية هي موضوع الرواية الرئيس، وقضيتها الأولى. وقد تناولت الرواية هذا الموضوع بصورة بشعة وصارخة تهدف إلى التحذير من آثارها وعواقبها المستقبلية إنْ لم تُعالج من الآن، وتوضع لها حلول فكرية واجتماعية جذرية، تمنع تمددها وتغولها.
وقد نجح الكاتب في إثارة الرعب والخوف من المستقبل، ليس على صعيد ديسكولاند فحسب، بل على صعيد عالمي واسع، فما يمكن أنْ يحدث في ديسكولاند –وهي هنا رمز- يمكن أنْ يحدث في أي دولة من العالم، فالعنصرية داء وبيل، إنْ أُصيب به قوم، انتقلت عدواه إلى غيرهم بسرعة عاصفة، وهكذا كل شرء وسوء.
وعندما ينجح الكاتب في أن يجعلنا نعيش أحداث الرواية كأنها واقع لا تخيل، يكون قد وُفِقَّ في توصيل رسالته، وتبليغ أمانته، وأداء مهمته. وهذا النجاح لا يتيسر لكل من كتب، فهناك فرق أن تكتب من أجل الكتابة، وبين أن تكتب عن معاناة ونار أكتويت بجمرها!
وعوداً على بدء: هل طوروس نتاج غرب عنصري، أم نتاج شرق متخلف، أم هو مزيج من هذا وذاك؟ من المسؤول عن شخصية طوروس التي أبدعت في مجال الإجرام والتسلط إلى حد مرعب؟ وكيف تشكلت عقليته بهذا الشكل المعقد الشاذ؟ وهل هو نسيج وحده؟ وهل هو متفرد في إجرامه أم هي فرصة سنحت له ولم تتوفر لغيره؟
أسئلة كثيرة تتناسل منها أسئلة أكثر وأكثر، ولكن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ليست ممكنة بسهولة طرحها، وكل محاولة للإجابة تبقى مجرد اجتهادات لا أكثر.
إنَّ العنصرية ابتداءً هي داءٌ متأصل في النفس البشرية، ولا يمكن استئصالها مطلقاً، ولكن بالإمكان تهذيبها والتخفيف منها، وتوجيهها لتكون عامل بناء ورقي، ودافعاً للتميز والعطاء ، وهذا ما نادت به الأديان قاطبة، والفكر البشري السوي على مرِّ العصور. وعندما تختل المعادلات وتحدث الانتكاسة وترتكس البشرية إلى حمأة الجهل والتخلف والهمجية وإن رافقها علم وتطور مادي وعلمي، يثور بركان العنصرية من جديد بأشكال ولبوس مختلفة، ومسميات برَّاقة، وتبريرات خدَّاعة. وما استعمار الغرب للشرق وإعادة احتلاله والسيطرة عليه مرات ومرات، إلا إحدى هذه الأشكال البشعة التي أحدثت زلزالاً عنيفاً ما زالت افرازاته وتموجاته تتردد حتى اليوم، ولم ينجُ أحد من أضرارها وتأثيراتها المدمرة.
إنَّ الغرب المستعلي المستكبر هو المسؤول الأول عن تشكيل شخصية طوروس وأمثاله ممن لم تسنح لهم الفرصة للظهور وتفريغ شحنات القهر والغضب والانتقام التي تمور داخلهم. فالغرب زرع البذرة القذرة، وترك لأتباعه وعبيده مهمة تعهدها والعناية بها، فأنبتت نبتاً شيطانياً، وثماراً سامة.
وعندما تيقن الغرب أنَّ خطته تسير كما رسمها بدقة، انسل من الشرق، وترك خلفه أزلامه ومسوخه ليزيدوا من التشوه وتعميق الفجوة بين الغرب والشرق عبر التبعية في كل شيء للغرب بل والعبودية المذلة، حتى لا يشعر الشرقي إلا أنه لا شيء بدون الغرب، وأن لا حياة نموذج إلا حياة الغربي.
هذه النظرة ولدت شعوراً بالدونية والنقص، وبالتالي الكراهية المبطنة للغرب، والرغبة في الانتقام منه، وأن يشرب من الكأس التي أترعها للآخرين، وهذا ما أنجزته شخصية طوروس التي كانت مفاجأة الرواية، فلم يكن أحد يتوقع منه أن يكون كما ظهر في الرواية، شخصية مرعبة قادرة على الإبداع الإجرامي دون حدود. وهذا مؤشر أن شخصية طوروس ليست وحيدة في تشكلها، بل يبدو أن كثيراً من البشر قد يكونون نماذج مرشحة لأن تكون مثل طوروس وربما أفظع إن توفرت لهم الظروف "كل واحد منا نسخة خاملة من الملك المتوحش. نسخة لم يحن وقت نهوضها بعد."(286)
أضف إلى ذلك، أنَّ الشرقي عندما يهاجر إلى الغرب، يأخذ معه كل شرقيته وأمراضه ومشكلاته، أي أنه ينقل نسخة مشوهة من مجتمعه الشرقي معه. وهذا يسبب التخوف من قبل المجتمعات الغربية، وخشيتها من الغزو الاجتماعي والفكري الأجنبي الذي يهدد وجودها، وخاصة بعد طنطنة الإرهاب بعد تفجيرات 2001. ولذا على الشرقي أن يراعي قواعد وأصول مجتمعه الجديد لا أن يفرض رؤيته وعاداته عليه. ولكن الذي يحدث هو العكس تماماً، بل ويزيد الطين بلة، نقله لأمراض الشرق وعلله، مما يحدث ردة فعل عنيفة عند الغربيين، تتمظهر في الرفض والرغبة في التحوصل لحماية مكتسباتهم التي لم ينالوها إلا بشق الأنفس بعد قرون من الصراع وأنهار من الدم.
يتحمل كل من الشرق والغرب المسؤولية الكاملة عن ترعرع العنصرية وتفشيها هنا وهناك، والغرب يتحمل القسط الأكبر، لأنَّه من أساء وأجرم أولاً، ولأنَّه يمتلك القوة بكافة أشكالها. أما الشرق فلديه تراث روحي وديني يفترض أن يكون صمام أمان وجداراً شاهقاً في وجه كل عنصرية، أو تعدٍ على الإنسان وحقوقه!
لقد لامس الجبوري معظم هذه الإشاكلات والقضايا في ثنايا روايته وإن بين السطور أحياناً، فالرواية أولاً وأخيراً ليست تأريخاً أو محاكمة لمرحلة، وإنَّما هي نذير وتحذير من مستقبل قد يأتي ولا يأتي، وإن كانت النذر تشير إليه، وتكاد تضع يدها على قرن الشيطان!
الخيال الجامح
أخطر ما في الرواية هذا الكم الهائل من الإبداع الإجرامي الأسود الذي اجترحه طوروس، وقدرته الفذة على إصدار قوانين وتعليمات وأنظمة قمعية وتسلطية تشكل حياة البشر كما يريد، حتى أوشك أن يحولهم أحجار شطرنج يحركها كيف يشاء، دون أن تقوى على مجرد الاعتراض ناهيك عن المقاومة. لقد حول الديسكولانديين إلى شعب آلي يتحرك وفق مشيئته، وأصبح هو إلهاً يحكم ويرسم ويشرِّع. لقد سخَّر الشعب كله في بناء سور حول ديسكولاند لمزيد من التقوقع ولمنع أي رياح دخيلة، وألزم كل مواطن أن يقتني كلباً، تجسيداً للنظرية العنصرية "الكلاب أفضل من الأجانب"، ومنع التزاوج بين المواطنين الأصليين والأجانب، وغير ذلك من القوانين التي تكرس عنصريتهم ونقاء عرقهم، كما كانوا ينادون قبل عهد طوروس، لكأنه يحقق لهم أمنياتهم، ولكن بطريقته، ليعذبهم بها وينتقم منهم بطريقة جهنمية لا تخطر على شيطان!
ويتوالى إبداع طوروس فيُعيِّن برلماناً معظمه من شذاذ الآفاق والسكارى والمجرمين، لا عمل له إلا اللهو واللعب والتسبيح بحمده. والأعياد التي اخترعها طوروس لا غاية من ورائها إلا مزيداً من الإذلال للمواطنين، وكانت درة إبداعاته المسلة العجيبة التي تكشف عن مشاعر المواطنين تجاه طوروس، وتصنفهم، وذلك كل يوم أحد، وتقضي بالقصل على كل من يحمل مشاعر الكراهية والبغض له.
وقمة السخرية التي أبدع فيها طوروس هي طلبه أن تؤلف عنه رواية تظهر بشاعته وبطشه وجبروته، رواية "رعب عن عصر طوروس الجهنمي العظيم. رواية عندما يفتحها القارئ تهب في وجهه نتانة إرهاب أقذر عصور الإنحطاط والظلم والموت في التاريخ. رواية تؤرخ هول ما جرى ويجري من قتل وذبح واضطهاد وتدمير للمخ ومسخ للذاكرة وإتلاف للكيان الآدمي."(371). هذه الرواية التي كُلِّف بكتابتها أحد كتاب المعارضة –آدم السومري- بعد ترويضه وتدريبه وشحنه، فخرجت كما يريد ويشتهي طوروس، لكأنه يشمت بالكتاب وما يكتبون، وأن لا أثر لكل ترهاتهم وأكاذيبهم، وأنَّها مجرد أوهام يحشون بها العقول :"وجدت نفسي على ظهر اليخت الملكي، أمام طوروس الذي كان مستلقياً كالديناصور في بانيو محاط بأجساد شبه عارية لمجموعة من المدلكات الفاتنات، وهو يتابع عبر الشاشة عمل المقصلة الأتوماتيكية. فيما كان حراسه مشغولين برمي نسخ روايتي إلى البحر."(356)
لكأن الجبوري يُعرِّضُ ببعض الكتاب الذين يظنون أنَّ لهم أثراً أو دوراً في صنع الأحداث وتوجيهها، وما هم إلا مجرد ألعوية في يد السلطة، تشتريهم لتسكتهم، أو تتخذهم أدوات لخداع الشعب وتزوير وعيه.
لقد أبدع طوروس أيضاً في قلب السحر على الساحر، وتبليع السم لصانعه، فأذاق الديسكولانديين ما أذاقوه للأجانب، فهاجروا، وتدافعوا، وغرقوا في البحار، وناموا على الأرصفة، وتكدسوا في الشوارع، وعلى أرضية السفن، وتشردت أسرهم وتمزقت، ولجأوا إلى دور الجوار، وكان الانتقام الساخر منهم هجرتهم إلى دول الشرق لتكون لهم ملاذاً ومأمناً، والتي كانت من قبل، ميدان جبروتهم وبطشهم، بل ووجدوا فيها الراحة والسكينة، وحياة أخرى أجمل وأرحب، وبصيص نور وأمل.
كما أبدع الجبوري في اختراع مسميات جديدة أو توظيفها بشكل رائع ومنها: عش الثلج، اللعنة الحمراء، وزارة الحواس، وزارة نقل الكلام، شعبة الصم البكم النطق، نزهة البراءة، مكبس الحرير، همس الملائكة، إلى غير ذلك تؤكد طول باعه وبراعته في الابتكار واستيلاد كل جديد.
ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأنَّ إبداع طوروس المخيف، وراءه مؤلف مبدع، له قدرة عجيبة على اختراع فنون القتل والتدمير والتسلط والقهر. والسؤال: من أين جاء الجبوري بكل هذا؟ وأي قدرة عجيبة يمتلك؟ وماذا تراه يصنع لو امتلك سلطة كطوروس؟!!
اللغة الشعرية
لغة الرواية مبهرة وفاتنة وموحية بشتى الصور والتشبيهات والانفعالات، وما تبطنه أكثر مما تظهره، وهي لغة شعرية بامتياز، تُحلِّق بنا بعيداً في آفاقها وفضائها الرحب، لكأنها تنطق، وهذا لا يُستغرب من شاعر متمرس، أتقن أدواته الشعرية، ولمَّا ضاق به الشعر بما رحب، عرَّج إلى الرواية؛ علَّها تشبع نهمه، وتسعفه في نشر أفكاره، والتعبير عما يمور في أعماقه، واصطحب معه لغته الشعرية الثرية، فأكسبت الرواية رونقاً وبهاء، لكأننا نقرأ في بعض ثناياها شعراً لا نثراً!
اقرأ هذا النص مثلاً: "استشرت رائحة الحداد وصوره في كل مدن البلاد ومنازلها. كان الصمت سيد الموقف. ناس بوجوه متبلة بالظلام، فيما الأدمغة المحمولة في الرؤوس الآدمية، مراكب غارقة من ثقل أفكار تطحن أفكاراً، في عالم تسيطر عليه طواحين الإرهاب التي تدور دون توقف."(227)
وأيضاً: "لقد عشت زمن صعود العنصرية وما زرعته في تراب العقل وعطر الروح وأرض البشر. لم أر خرابها كأي خراب. فما فعله العنصريون بالغرباء بالأجانب بالملونين، لا ترتقي إلى مستوى أفعال موجات الجراد في الحقول المزدهرة. كنا نقوض الأجانب برياحنا الضارية، وكانت أجساد الغرباء أشبه بجدران كارتون ترتجف. جاءوا مهزومي العقول هزيلي القامات، بعدما فعلت بهم سلطات الشرق ما نفعله نحن بالخنازير."(330)
وقد أبدع الجبوري في صوغ عبارات وجمل وتراكيب دالة وربما جديدة من مثل: طوفان الليل، رائحة الهجرة، جفاف الاغتراب، موجات الموت، ظلام متحجر، حضارة البرد، سرير الماضي، نيران الكراهية، ثكنة المهمشين، بودرة الكراهية، بخار العواطف، البعوض العنصري، بطولة العدم، ثور تأليف، جيولوجية الرعب، تكرش الذهن، تبليط الشعوب، الكراهية التعبيرية، تراب العقل، كهربائيات الآلام،.... وغير ذلك من الأمثلة التي تمتع القارئ وتفتنه، ولولا الرعب الذي تثيره الرواية لجعلت البعض يرقص طرباً ونشوة!
وبعد، فإنَّ رواية "ديسكولاند" لأسعد الجبوري هي صرخة مدوية، وجرس إنذار من خطر يحدق بالعالم، ليس خطر العنصرية فحسب بل وخطر الطائفية وخطر الإقليمية، فكلها أوبئة تصدر عن بؤرة واحدة قذرة، ليس لها وقاية إلا بالوعي بالقيمة المطلقة للإنسان باعتباره إنساناً أولاً وأخيراً، له حق الحياة والعيش والتكريم، ولا اعتبار لأية اختلافات أخرى إلا بقدرها وحدودها التي لا تؤثر على الحقوق الأساسية للإنسان، فقد خلقنا الله مُكرَّمين من نفس واحدة، ولم يختر أحد فينا أصله أو فصله أو دينه أو عرقه أو بلده، فليحاسب الإنسان أخاه الإنسان على اختياراته، وغير ذلك فهو افتئات وظلم وتطاول على الخالق سبحانه.
لقد أبدع الجبوري في "ديسكولاند" وأرعبنا، وجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً ورهباً، ولكن كل ذلك يُحسب له، فقد حذرنا من مستقبل مخيف قد يحدث، وهو ليس منا ببعيد، إن لم يتداركه الحكماء والعقلاء، وإن لم يفعلوا، فقد ينتظرنا مستقبل شيطاني مظلم، يكون طوروس بالنسبة له ملاكاً!
((من الجسد الطويلِ ، الشهواتُ الطويلةُ. وما بينهما مشرحةُ الأمطار والنيران والروايات .
وقال لي صاحبي في الوراثة: قد يصبح الورق ميكرفون الرعد بعد مرور العاصفة . وكل امرأة لا يمسسها برقٌ ،تكون طيناً سلفياً ،لفخار التوحش في التخوت المليئة بالمستحثات . الربّ يعلمُ كم من المرافئ في فم الغريق ، وهو من سيثبطُ نمور الكلمات الهائجة ، كي تخلدَ الجنةُ في الحاوية التقريبية للروح.نحن أكاليلُ شعراء، يتأرجحون بسجونهم تارةً .. وليومٍ آخر في زهرة الأوكسجين ، لا تتلوث صفاتهم بحطب الكؤوس. هم أيضاً هناك مع بقايانا العُزل.. يهدمون تماثيلَ الجسدِ . تهيئةً للصيد في الآبار السحيقة ، حيث تطفو الأعيرةُ النارية فوق المخيلة دون تهميش لفتنةٍ أو سحقٍ لصور الملائكة . هل سنقفُ لمحاكاة اللغة. هل مدفأةٌ واحدةٌ تكفي ، لاستخراج الحليب من سرير الفاتنة. الآن الاعتقاد بأنفلونزا الفصول، شهواتٌ بلا حدود. عيدانُ الكبريت متوترة. الظلام غير برئ. وكل الكؤوس غارقة بدم الأوبرا)).
ماذا يوحى لنا ونحن نمر بهذا المقطع من كتاب((على وشك الإسبرين)) للشاعر العربي العراقي الدنمركي أسعد الجبوري الذي صدر مؤخراُ عن دار الينابيع في دمشق؟
قد لا يستطيع أحد منا التحكم بهول التداعيات التي تخلفها القراءة الأولى للنص.فالكتاب قنابل موقوتة دون نهاية.والشاعر يجرب.يلعب باللغة كدمية من المطاط.يمطها كما يشاء تخيلاً ،ويشكلها أشكالاً بما فوق السريالية التي تربت الذاكرة العربية عليها ردحاً طويلاً من الزمن.أي منذ ظهور السريالية الأولى على يد بريتون وشياطين حركته الشعرية.
وكان يعتقد القاموس ربّةً
لا ترث غير الجمال .
آخرٌ يراهُ ربّاً فقط،
لتسقيف الرأس بعظام الخرافات.
وقضبان الأسماء النّكرة.
المؤلفُ البرّي لا يسالُ،
انه بلا قراء بلا مطابع بلا شاشات
للتنقيب والبحث .
عادةً ما يستخرجُ من نفسه ديناميتاً،
لقتل ثعابينه دون نجاح.
لذا يبحث في نصوص الانتظار عن قطعانه التائهة فيما وراء النفس.يتعطر منها ماضياً في فكرته.المراوحُ تثرثر .. هناك سيناريو الصحراء . هناك خيولٌ تنتحبُ.. لا فراش للنوم . لا مهدئات للقرون الغابرة ، وهي تهربُ من بين شقوق ملابسنا المغسولة بخافض الحرارة.
كتاب ((على وشك الإسبرين))الشعري ،يُعد بالدرجة الأولى ،فيضاً لغوياً صاخباً ،لا بالمعنى المجازي المتعلق بحركة الإشارات النابعة من احتكاك المفردات في متاهات النصوص، بل لأنه كتابٌ كاشفٌ لأسرار البواطن وكائناتها الشعرية،بحجم بلاغي فلسفي هدّام لنصوص الأسلاف ،وذلك عندما تحضر لغةٌ بروح أكثر من معاصرة وأعمق بعداً مما نجد لدى الشعراء الأحياء.فأسعد معلم الانقلابات.وهو اللا مدرس واللا مدرسة بحد ذاته.هو شاعر اختار عدم الاستقرار لا تحت سقف سريالية جديدة ولا قديمة،كأنه تحرر من الأنظمة المدرسية ،وراح يشتغل ضمن خصوصيته التي لم يجرؤ عليها أحد ممن يؤلفون في عالم الشعر. فأسعد الجبوري ينحت صوره الكونية بوعي مباغت فتفور به الكلمات طيراناً لتستقر ما وراء الكتابات المعمول بأنظمتها عمودية كانت أو حرة ،ووصولاً لقصيدة النثر التي أسس لها الجبوري عوالم تنحى صوب الفرادة والاختلاف الجذري عما يكتب فيها الآخرون .فهو صاحب جملة لعوب قل نظيرها عن الماغوط أو إنسي الحاج أو أدونيس أو سركون بولص أو الجيل الجديد الذي أعقب جيل الرواد ،سواء في الفضاء المغاربي أو الشرق أوسطي أو العربي عموماً.فالجملة عند اسعد قد تبلغ مديات من العمق والتشيؤ وعدم السكون تحت تأثير النقاط.ولقد بلغت الجرأة بالشاعر في كتاب ((على وشك الإسبرين)) أن يدخل نصوصه في سيناريوهات تستكشف بأسئلتها كل ما يشتبك في الداخل الإنساني من حوادث وارتطامات سيكولوجية،ومن دون أن يمنح القارئ غير إجابات تهكمية تغوص في أبعاد فلسفية .
_س/من أنتَ أيها الغصنُ الهادئ على المنضدة؟
_ج/أنا الهايكو . وأعمل في صالون حلاقة الطبيعة.
_س/متلبسٌ بالبرد. أليست؟
_ج/لقد باعت الذئابُ ثيابي للغات . ولذتُ ساكتاً.
_س/هل أنت حيوانٌ ذكرٌ؟
_ج/أنا قربانٌ مشوشٌ ليس إلا . وفقط.
_س/يا لك من مخلوق مُكتمل بدمه الأخضر !
_ج/لذلك يشربني حكمائي بغطرسة دون خوف.
_س/وشعوبكَ الآن أين ؟
_ج/في مقاطعات بوذا الثمل بشرائح سوني
وميتسوبيشي وأخواتها الإليكترونيات.
س/هايكو. كم أنتَ فأرة؟
ج/ولكنني لم أكل يدَ أحدٍ!!
لقد افترق أسعد الجبوري كشاعر عراقي عن مجمل جيوش شعراء بلاده أو عن سواهم من الشعراء العرب،بقي متحصناً في قلاعه التخيلية دون نكوص أو معاناة أو ندم.كيف لا ..وهو الشاعر الذي لا مدرس تجمعه بأحد ولا يؤسس لنص إلا ليهدمه في اللحظة التالية، تجاوزاُ وخلقاً لنص آخر سرعان ما يجد القارئ نفسه فيه أشبه بنبتة تعاني من ألم الريح في عراء كوني !
لنأخذ مثالاً :
((الرأسُ المترو.
العقلُ المكسورُ.
والكلماتُ تركبُ الأشباحَ ،
بانتظار حبرها الخارج من الحانة
بمعية فتيات الأرجوان .
هكذا المرأةُ التاريخية قالت،
وهي تعبر جسدها الضليعَ في قناة
الموبقات.
وكانت معها غرفتها تضحكُ باللمسّ،
رفضاً للتجمد في غير الفتنة.
الشيء ذاته حدث في النفس .
عندما ذبلت المنارةُ في زاوية التقويم.
وكنتُ أنا في النعاس منادياً :
الهجرة يا ناسُ راديو العارف.
راديو صوته يرى.
يتلمسُ ويتناكحُ.
يتقدمُ في الشجرة من الجذر
حتى النخاع.
وكان أحدهم مثله ينادي على الأقوام
في شرائح الكومبيوتر:
سيكون الأملُ فاكهةً صغيرة السنّ ،
تعرفُ مغادرةَ تختها في الجينات.
مرة أخرى:
هل الكلماتُ مقاعدٌ..
ومنها العاصفة على سطح العقل ،
لتجريف المؤرخِ العميقِ للأساطير ؟
ونفعل ..
ماذا ..
نحن ..
سوى عشاق.
وستذهب بهم السيرُ الذاتيةُ للتجدد
في النيران .))
عند الشاعر الجبوري ..تحدث مختلف الصدمات والمصادمات،تارة ما بين العقل وأدواته الداخلية ضمن شبكات المخ نفسه، وتارة أخرى ما بين اللغة ومخلوقاتها المنتجة للوعي على تراب متاهة عارمة ،عادة ما تجعل النص في بؤرة السحر.
((
أحدٌ ما . سرق ساعتي ، تاركاً زمني مع جنيّات الليل دون مأوى . وزمزمُ من أعالي الربّ .ترمي الأساطيلَ على الوجه ، مُلوحةً لي بباقة طوفان ، لا تكن أرضاً يا بنيّ . إياك من المحاريث والعجلات والأحذية والأفاعي. هكذا كانت تقول بحرص. وتتركُ أصابعها تندفعُ ، لاستنشاق الانفجارات في فراغي. كم لأمي من الأرواح في بيضة الرخِ الفوارّة بالنحيب . في نقطة الدمع حينما لا تقبل التنقيح . في الصفصاف ، وهو يخرجُ من الجسد لملاقاة البرق على القارعة . في القرآن ، حينما يكون بارجة ، في البحار عندما نراها في الصحون على هامش الكون. في الأفران الملتهبة ، عندما يتكسر الأبناءُ كالأيام اليابسة تباعاً . في محاكم التفتيش ، حين تحاكي المشانقُ الحرياتَ داخل الأرحام الشبيه بالفنادق. يا إلهي . أحدٌ ما سرق أمي ، مستبدلاً إياها بأدوات القلق الثري)).
كل مفردة في كتابات الشاعر أسعد الجبوري تبني خصوصياتها بدقة متناهية.فهو شاعر لا يستسلم لإرادة اللغة ولا إلى منابعها الأولى.ربما لأنه يؤمن بشيء من إعادة تكوين لغة خاصة به ،وتتمرد على لغات الجوار نفسياً وبلاغياً وفقهياً وجمالياً.أسعد الشاعر ،هو أسعد البناء اللغوي الذي يمكنه السيطرة على أوسع المساحات اللغوية المبهرة في الشعر.
لننظر بدقة إلى هذه الجمل من كتاب ((على وشك الإسبرين)) ونراقب مصادر المخيلة المهيمنة على الجمل وكيف تتكون تربتها في وعي المتلقي:
سنأخذ جملاً متفرقةً لا على التعيين لنبرز قوة التخيل الشعري عند أسعد:
1- كانت الشموسُ مستلقية معنا في المنامة
1- أتذكر نهديها . مضختين على أوتوستراد الربيع
2-
3- العالمُ كله يكتبُ الآن مسّودةَ نصرنا في الهباء الإلهي.
4- وكان يمكن التسوّل على باب الأفخاذ برفقة الكمنجة أيضاً.
5-الوقتُ تفاحةٌ ..كأنها متفحمةٌ على طاولة التاريخ الغرامي
6- ما معنى أن يكون المرءُ قطاراً راديكالياً ؟
7- ما الذي ستفعله بلحيتك الزرقاء أيها النيل الحزين؟
8- التاريخُ بملابسه المستعملة
9- كانت الرسائل أبواباً .. وكان العشاقُ فاكهةً دون هوامش
10-الأرواحُ أسرةٌ بلا نوم
لا نصل إلى بعد واحد في كل جملة من شعر اسعد الجبوري.الشاعر يتشظى ويطيرُ دون أن يستقر في معنى واحد محدد بعينه،لأنه يفتح بوابات اللغة كاملة،ويهيمُ مع نيرانه دون تردد أو خشية من فخ أو هاوية أو فشل .فاستعمالات أسعد للغة وبهذه الطرائق والأساليب الصاخبة المفتوحة على كل الاحتمالات ،جعلتها في مصافي اللغات القادرة على تحمل أعباء الخيال،وبقدرات نادرة.ومن هنا يمكن القول :بأن تفجير اللغة العربية بمخيلة مثل مخيلة اسعد الجبوري ،وسعت من مساحات اللغة العربية ذاتها جمالياً ،وكثفت قدرتها على النمو وبإشراق أكثر فاعلية ،بعيداً عن حالات الموات والنظرات الضيقة التي تتعامل مع اللغة كحيوان على وشك الانقراض ،سواء من خلال الدافع الإيديولوجي- البيولوجي المشترك أو عبر الهاجس القبلي الموسوم بذرائع حماية اللغة من التغريب والاستغراب بمنشار الحداثة!!
قراءة في مجموعة" قاموس العاشقين" لأسعد الجبوري
لعل الكاتب والشاعر العراقي أسعد الجبوري، أراد من مجموعته الشعرية( قاموس العاشقين- دار الينابيع، دمشق/2006)، أن تكون شاهدة، على مكانة العشق لديه إنما في الصورة المتحركة تلك التي تنمُّ عن تحولات العالم من حوله وداخله.
في ( قاموس العاشقين) نكون إزاء سياقات عشقية، إرهاصات قلب عاشق، منمنماته تلك التي تتجاوب وطابعها الموبايلي، وما يتصف به الموبايل" هذا الجهاز الخدمي والذي أدخل ثورة في عالم الاتصالات في العالم وبين بني البشر" من قدرة على تقريب المسافات بين الناس، بين شخص وآخر، وما ينطوي عليه من ميزة يتفرد بها في تمثُّل أدوار في الصوت والصورة، وحتى ما يمثُّله من غموض، يجعله أقرب إلى التأويل منه إلى التفسير، ولهذا، وكما يبدو، فإن الجبوري في عمله الشعري هذا، رغِب أن يكون كل الوارد فيه متجاوباً مع فكرة الموبايل، بدءاً من حجم الديوان، وهو بشكله المستطيل والصغير، والصورة الرمزية التي تتصدر واجهته، والإشارة التي تواجه الناظر أو القارئ بجوار العنوان، أي من جهة الإحالة إلى ما هو موبايلي(1000SMS )، حيث المودع في المجموعة 1000 مقطعاً شعرياً، أشبه برسائل موبايلية، وكأنّي به استساغ لعبة الموبايل، إنما في خدمة ما هو عشقي. لم لا، أليس الشعر هو تمثل تاريخه ليكون تأريخ التاريخ؟
لا بأس في الحالة هذه من التوقف عند هذا الديوان، أي القيام بممارسة تنقيبية وتأويلية لهذا العاشق المتواري وراء الكلمات أو في فضاء متخيَّل الشاعر، وهو مأخوذ بشبقيات الموبايل، إن جاز التعبير، إنما بغية استشراف مكانة الموبايل في عالمه الشعري، وموقع العشق فيه، من خلال تلك التمثلات المختلفة لما هو موبايلي بالاسم أو بالترميز، انطلاقاً من فكرة تمتلك بعضاً جلياً من وجاهة الطرح والمساءلة والمقاربة معاً، وهي طزاجة مفهوم الموبايل في تجلياته الشعرية عشقياً، وذلك عندما يكون العشق ذاته بوابة كبرى لخاصية الشعريّ، وتحفيزاً للشعر في أن يتعدد وجوهاً وأصداء معان ٍ، وإعلاماً بأن ثمة دائماً ما ينتظرنا ويغبطنا، أعني سعادة الروح بشعر هو خميرة ممرَّرة موبايلياً، أو هو موبايل يؤاخي بين الجهات.
فكرة القاموس: قاموس الفكرة
أن يرِد المتعلق بالعشق، من خلال اسم علم جمعي: العاشقين، كما هو المتداول اليومي وحتى العامي أحياناً، استجابة للروح الحية والمعاشة في وسطنا الاجتماعي، في حيثيات" قاموس"، فإن في ذلك نوعاً من رد الاعتبار للكلمة، من خلال ارتباطها بما هو لغوي عام، وما يقبل التصنيف والتراتبية بالمقابل، وحتى ما يفيض عن مفهومها، كون العشق أكبر مما هو قاموسي، بقدر ما هو أكثر استنارة منه، إنما يلتقيه فيما يستمر به إشكالاً متجدداً، حيث إن القاموس لا يأتي إلا في أعقاب سيرة حياة لغة في تاريخ مرسوم، ومجتمع مسمَّى، كما لو أن القاموس يحيل قارئه إلى المتفرق أو المشتت، أو المتداخل، أو ما يحتاج إلى لائحة اعتبارات جمالية وذوقية في تسلسل كلماته ومنهجه في الكتابة، دون أن يغلق الباب، لأن القاموس ليس محك ما يحتويه، إنما هو إجراء تقويمي أو ترتيبي لكلمات بحسب أهميتها أو دلالتها أو مكانتها، انطلاقاً من ثقافة صاحبه، حسب القاموسي أن ينجو من النقد، كما هو معروف، وحسب العاشق في إهابه الشعري، أن يقول شيئاً، ويثبته وأن يلقى أسماعاً، ليكون الشعر شعر شاعر واحد، والعشق منظور إليه في عمومه، ولكنه يحمل بصمته، وكأني بالشاعر فيما يتمثله عشقياً، داخل في رهان التحدي مع ذاته العاشقة، والعاشق الآخر، وما يلقى لديه من أذن مماثلة.
إن ما أعرفه، أو ما أعتقده معروفاً لدي، هو أن ثمة تجاذباً ضدياً بين كل من الشاعر وعشقه، في اللحظة التي يحاول فيها تحويل هذا المخبَّأ أو المبثوث داخله إلى كلمات ذات معنى، بما أن العشق في أعمق مشاهده عصي على التمثل اللغوي، لأن العشق حالة ما قبل اللغة التي تستهدف النيل من اللامحدد أو السرّي، حتى بلغت درجة عالية من التفنن والمكرية في استدراج مشهديات العشق في الداخل، لتتمكن من الإحاطة به، وتدوينه كما لو أن حقيقة العشق هي في المسطور.
أكثر من ذلك حين يحاول الشاعر، وكونه شاعراً أن يمارس لعبته الفنية في جعل المنطوق ميتاعادياً، لغة أكثر كونها لغة من خلال طابعها الجمالي أو الفني، وأن يتقدم بذاته الشعرية باعتبارها تؤدّي مهمة معتبرة فائقة الوصف وهي أنها لا تتوقف عند حدود ذاتيتها إنما تروم ما هو عام، وما من أجله يشعر كل شاعر أن المرسوم باللغة يعنيه ويعني غيره.
في ضوء هذا الاعتبار لا يبدو على الشاعر أنه يستنفد فرص التعبير ومعاودة ذات المفهوم، وكذلك السعي المستمر ولو بطرق متنوعة، للالتفاف على موضوعه، مدخِلاً المكر المجاز في ذلك، ليكون في مقدوره تحقيق المبتغى أكثر فأكثر.
وفي حديث المكر الأدائي ضرب من ضروب المغامرة الشعرية الغاوية، لنصرة عاشق مدنف أو من تملَّكه العشق، وهو يحاول التخفيف من "مصابه" العشقي، أو رؤية طريقه ليستعيد عافيته مع محبوبه، ويكون أكثر وضوحاً وصفاء.
وفي ( قاموس العاشقين) نجد التفافات ومناورات واستراتيجيا التمثل الدلالي لصور وأطياف ورموز لذات المقصد: أي العشق، رغبة في إنجاح مسعاه الرغبي: أن يزداد قرباً من عاشقه أو معشوقه، أو تتقلص المسافة بينهما، دونما هوادة، ودون طائل بالمقابل، حيث إن الشاعر ليس من وظيفته أن يضع مخططاً لعاشقه أو لعاشقيه، وإلا فإنه سوف يصبح رجل مشاريع عشقية أو تعهداتياً، ليبوء عمله الفني بالفشل الذريع، كون الشعر لا يؤمّن دواء لداء يبتلي به أحدهم في سياق الأدب أو الفن أو الشعر تحديداً، إنما يمعن النظر في ذات الداء، ليتخذه موضوعاً يبرع في تبين مأسويته ونفاذ فعله في الإنسان، عدا عن أن الشاعر هنا لا يؤدي دور الطبيب إنما الوصَّاف الذي يشجّع على" معاقرة" العشق كداء نبيل.
وربما ما قاله رولان بارت في كتابه( شذرات من خطاب في العشق- ترجمة: د. إلهام سليم حطيط- حبيب حطيط، الكويت/2000)، حول العاشق وما يميّزه، يفيدنا هنا( يتساءل العاشق، ليس عما يحب قوله للحبيب( ليست صورة الاعتراف) بل كيف يمكنه تخبئة" اضطرابات"( مطبّات) عشقه: رغباته وضيقه، أي باختصار اندفاعاته.ص48).
والشاعر عاشق بامتياز، أو عليه أن يكون عاشقاً فوق العادة، وإلا لبطُل أن يكون شاعراً، وخصوصاً حين يتناول موضوعاً عشقياً، وخصوصاً أكثر حين ينهمُّ بوضع قاموس تذوقي للعاشقين عموماً وليس لعاشقين محددين، وبالتالي فإن عشق الشاعر هو شعره هذا الذي يتجاوزه، ويصيبه بالحيرة وبالجذب ليكون أكثر مكاشفة لهذا الأثر الحرّيف للعشق.
يتداخل المجسَّد موبايلياً، مع الطريقة التي يؤدي الموبايل وظائفه المركَّبة: من أداء دور الهاتف، إلى خزن معلومات معيَّنة، إلى تقديم معلومات ذات صلة بالأحداث، تبعاً لنوعية التصميم والجدة له، وما في ذلك من مفاجآت، بما أن الموبايل يمتلك القدرة على المباغتة باستمرار، وما يناظره في الجانب الآخر: الشعري، كما لو أن الشعر يعرّف بنفسه شعرياً، من خلال الاختزال أو التوميض في المرسَل الشعري، أو ما يخص مفهوم" الميسِج"، وخاصية الميسج في التعبير عن أمور مختلفة بأقل قدر ممكن من المفردات، إنما في المرتقى الفني، وما يعنيه التكثيف هذا من معاينة للموضوع، وبالتوازي مع الحدث التخيلي، وإبلاغ الآخر: المتلقي بأن ثمة شيئاً مغايراً للمقروء، يمارس طابعه الإيحائي والدلالي روحياً، وفي الوقت الذي يميط المرسَل اللثام عما هو مستجد، وحتى مستفز إيجابياً، باعتبار ذلك ترجمان أحوال حيوات في الأفق المنظور.
إن الشعر هنا ينسّب نفسه إلى المستقبل، بسوية لافتة، بقدر ما يكون الراهن تحدياً له، وعلى طريقة نهرية في سريان فعل مؤثرته الجمالية، وكأني بالشاعر فيما يأتي به يمارس لعبة مستحدثة، تماشياً مع الطارئ والمختلف وتوقاً إلى الأجمل.
أليس الموبايل معبراً إلى التخومات القصوى، وإشعاراً بأن الموعود به شعرياً، لا يمكن نفاده، إنما يتعزز الارتحال إليه؟
إلا أن السؤال الذي نعتبره ضرورياً، ومن حق القارئ هو: هل المهمة التي تكفَّل بها الشاعر ذاتياً، أو كلّف بها نفسه كان مؤدياً للهدف المنشود؟ إن الجواب، والذي نعتقده مرتبطاً بمغزى المجموعة الشعرية، وبعمل الجبوري، هو أنه غير معني بسؤال كهذا، بما أنه شاعر أساساً، وأن ليس لدى الشاعر سؤال يشغله بدايةً ونهاية، ربما كونه سؤالاً معيارياً، وأن الذي تحقَّق لديه هو أبعد من حدود المعيارية، إنه منجَز فنّي بجلاء، ولهذا فإن السؤال الذي يستحق الطرح هو: إلى أي درجة يمكن لقارئه أن يشعر أن ثمة حضوراً لعشق سابر، عشق يصله بما هو موبايلي، وأنه تمكَّن في أن يموبل" من الموبايل" صوره الشعرية الخاطفة أو الوامضة، وأن يأخذ بقارئه إلى فضاء المتخيل الشعري، ومعايشة متعة المدوَّن لغوياً.
في هذا السياق، يكون العدد المتعلق بذات المقاطع الشعرية من جهته قابلاً للمساءلة، وهو: لماذا ألْف، وليس أقل أو أكثر؟
إذ إننا نجد أنفسنا إزاء عدد مركَّب وزوجي، عدد يفصل ما بين ما قبله وهو مكوَّن من مرتبتين، وآخر، يضاف إلى هذا المتوقف عنده، أي ألف، بأصفاره الثلاثة! هل لأن الذي ضمَّنه المتخيَّل هو الجانب الزوجي وما فيه من مفارقة الجنسانية، إذ يُستدعى كل من الذكر والأنثى، أو الرجل والمرأة، أم إن ذلك متروك للبواعث الحسية والتذوقية للقارئ؟
ثمة في الذاكرة الجمعية مفهوم ( ألف ليلة وليلة)، وهو المفهوم الذي يعايش لحظة التوقف عند( ألف مقطع)، كما لو أن الشاعر أراد أن يقوم بعمل آخر يعنيه، مع ملاحظة اعتبارية وهي أنه على علم بحقيقة الواحد على جهتَيّ الصفرين، أعني بذلك ( 1001)، وإحداث تأثير مغاير في الذاكرة الجمالية، ليس أكثر من رغبة الشاعر في الاختلاف بحضور أنثاه.
ولعل الناظر في موبايلياته، أو مقاطعه الموبايلية، يلاحظ أن ثمة نحو خمسين مقطعاً موبايلياً، إلى جانب مقاطع أخرى تقابله، منها ما يتعلق بالهاتف( أكثر من عشرة)، دون نسيان خاصية الموبايل أكثر من خلال المقاطع الأخرى التي تضمنت مفردات من نوع( الشاشة)، و( البطارية)، و( الصوت)، و( الخليوي)، و( المحمول)... الخ، فهل كان المقصد هو إمكان التقابل أم التحويل أم التنويع في وسيلة الاتصال، مع فارق المأثور التذوقي في كل حالة؟
إن كل ما تقدَّم يُبقي الموبايل" سيد الموقف" في واجهة الحدث الشعري التخيلي وفبركة الصورة الشعرية، وهي المقاطع التي تتباعد وتتقارب فيما بينها، كما جاءت مرقمة، كما في الشعور الحادث لحظة النظر في هذه المقاطع والمسافة الفاصلة فيما بينها( 3-4-9-21-92-114-162-163-168-171-173-175-180-181-187-192-197-282-297- 345-349-465...الخ)، حيث إن المقاطع التي رتَّبتها تبعاً لورودها في الديوان، تضمنت مفردة الموبايل بصياغات مختلفة، ولكنها، أي المقاطع، جاءت لتنمُّ عن ذائقة شعرية يصعب اكتناهها، أو البت في حِكمة ورودها بالصياغة التسلسلية هذه، ولماذا جاءت موزعة هكذا، أم كان ثمة مخطط لدى الشاعر ليتصرف مع موبايله وصدمة الموبايلية الشعرية؟
هذه أيضاً إشكالية المكاشفة الدلالية، وشهادة الموبايل المصاغة شعرياً، ونوع الباث فيها، وصلتها بحالته النفسية، أو أي وضعية نفسية كان عليها لحظة كتابة كل مقطع، سواء في جملة واحدة أو اثنتين أو أكثر، كما سنرى، وتحديداً عندما ننتقل إلى نهاية الديوان، وذلك الحضور المكثف للكلمة إذ التتابع قائم فيها(972-977-982-983-988-997-988-999)، ليكون المقطع الأخير ذاته مجنَّساً موبايلياً بقوله( أينما ذهبت يا حبي- فأنت محمول في هاتفي المشفَّر)، لأنه يعنيه وحده، بقدر ما تكون الحالة الشعرية مسمّية إياه لا سواه، وليكون الاسم المشفَّر لأنه خاصية الحبيب، مقابلاً للصورة العائدة إليه في المفتتح القاموسي رقم"1"( ما أن تملأ صورتك الشاشة- حتى يبدأ قلبي بالتبخر)، وبين الصورة التي تستشرف جلاء أمر الحبيب: العاشق، والصورة التي تلغي صورته وتتحفظ حتى على الاسم، لأنه من ذاتياته، تكون ثمة لعبة شعرية.
إن الموبايل ليس مجرد جهاز الكتروني أو تقني فقط، إنما يصطبغ بأهواء وميول ومزاجيات الشاعر في صفحات الديوان، باعتباره عاشقاً لا يهدأ، أو كون العشق لا يستقر على حالة معينة لحظة النظر في الموبايل وقد اتخذ هيئات ومجازات واستعارات، وأُخرِج من قيافته المادية، وأُلبِس أكثر من معنى تلويني أو تشكيلي، كما هو مقتضى المغامرة الشعرية.
في المقطع الثالث نقرأ( لا تغلقي الهواء بوجهي- دعيني أطاردك ِ في حدائق الموبايل- وأحلم بالعنادل)، لنقرأ ثمئذ في الرابع( ما لون هواك في الموبايل- ليتلطخ قلبي بكل ذلك الطلاء الأرجواني.).
بين المشهدين الواردين في مقطعين متسلسلين، ثمة الفارق بين حالة رغَبية موجهة، جهة مخاطبة العاشق، لحظة اتخاذ الهواء عامل ربط، وتفاعل، وكون الهواء متنفساً أو لصيقاً بالتنفس، إزاء الضرب الآخر من المقرَّر وهو المتمثل في الرغبة بأن تفسح تلك لعاشقها ما هو مشتهى لديه، وهو دائماً الفاعل والمقرّر ومدوّن الخبر، وجامع مفردات العاشقين كذكور طبعاً، أي أن تكون هناك فسحة لافتة وغنّاء، حيث حدائق الموبايل، وما تستحضره هذه من طير كالعنادل، وصفة العندلة في الموضوع على صعيد التمثل الصوتي والطيران، وما في ذلك من محاولة تشكيل المختلف واللذيذ في العلاقة، خلاف التالي، أي حين يكون إزاء سؤال دون السؤال، لعله استفسار، حيث غابت إشارة الاستفهام، عبر مكاشفة اللون للهوى، وهو غير ممكن، ولكنه الممكن الشعري وحده، ويكون الطلاء الأرجواني ومزجيته التعبير عما هو متألق ومفعم بالحركة أو الحيوية، وحكمة المكاشفة، وما في ذلك من مسعى تخديمي، ليكون القلب في مقام اللون المقدَّم، معرَّفاً به.
كأني بالرسالة الموبايلية تؤدي أدواراً تمارس المزيد من المجازات وحتى خوض غمار المغامرة الشعرية في لعبة مفتوحة، وهي لا تصل، أو لا أظنها تصل، ولن تصل، لأن عليها ألا تصل طبعاً، كونها غير موضوعة في خدمة مواطن ما باسمه، وغير عاهدة إياه بذلك،بما أن العاشق هنا في حالة غفل عن الاسم، وتلك تيمة العشق لدى الشاعر، كونه لا يسمّي عاشقه الذي في مقدوره أن يشير إلى أي عاشق دون أن يبتَّ في أمره، سوى أنه يضعه في مواجهة مصير ذاتي، أي ما يعتبره عشقه، ومن يكون موضوع عشقه، لأن لا توجيه مسبقاً، أو محدَّداً لخط سير الرسالة أو عنونة العاشق، حتى بالنسبة لقاموس العاشقين، يكون المبتغى هو أن يتفاعل القارئ مع مناخات عشقية، أن يضطلع على أحوال عاشق ما، غير محدد زماناً ومكاناً، إلا من خلال المحال عليه موبايلياً أو تحت رعاية وموبايلية، لأن البحث عن الاسم والعنوان والمرسل أو المرسل يكون من شأن مؤسساتي أو إعلامي، والشاعر يوسّع في حدود العلاقة، ليبقى العشق شغّالاً للمعني به .
ذلك ما يحاول الشاعر إرساء قاعدة متحركة له، أو رسم حدود غير مستقرة، على قارئه أن يعاينها بدرجة عشقية ما، هي التي تقيم فاصلاً مأخوذاً به بينه وبين آخر، وفي هذا التنوع يحضر العشق، ويكون القاموس أكثر من صنعة أثر قائم!
إن الموبايل هو بناء عالم في قلب عالم، بل ربما أمكن القول أنه محاولة التحرك صوب عالم موبايلي، لعله صنو المدينة الفاضلة بمعايير العاشقين ليس إلا، وخصوصاً حين يُتَّخذ الموبايل وسيلة أو إشارة مرور وعتبة لرؤية هذا العالم المختلف، وكونه قابلاً لأن يستجيب لأكثر من تمثُّل رغبة، وفي تشكيل المشاهد الحسية على قاعدة موبايلية، كما في قول الشاعر
(كصحراء نيفادا- هكذا موبايلي يكون بعد نفاذ البطارية- مقطع171)، حيث إن البطارية بمثابة القلب للجهاز الخليوي، وأنه في نشاطه العملي يشابه ذات القلب، بقدر ما يوفّر غطاء آمناً لصاحبه في أن يستمر " ينبض" في نسج خيالاته.
وهذا ما نتلمسه في المقطع"982"، والمرتجى من الموبايل، تبعاً لحالته المؤنسنة( ما إن يصاب موبايلي بالحمّى- حتى أعرف أنك في غير عالمي)، لأن أي خلل يتعرض له الجهاز، يقلل من إمكانية الاتصال بالآخر: المحبوب أو المنشود، ولأن الحرص عليه هو دوام التفكير بنجاح وغبطة بالآخر ذاك، لا بل إن سلامة الجهاز هي التي تضمن سلامة حامله: العاشق أو الداخل في حوار عشقي مع الآخر: منتظره أو مشاركه في الخاصية الموبايلية، وهو الهاجس الذي يتوافر في أكثر من مقطع، كما في المقطع"978"( أشحن قلبي بلمستك ِ- ولا حاجة للبطارية بعد اليوم)، وهو الذي يمثل حالة نكوص عما تقدَّم، أو إلغاء لعقد وخيانة ما له، لأن القلب النشط لا يمكنه أن يؤدي مهاماً موبايلية، إلا إذا أعطيَ دوراً مجازياً أو تمثَّل الموبايلية في التخاطر عن بعد ومعايشة الآخر وجدانية، ويتكرر ذلك في المقطع" 995"، إنما هذه المرة عبر الإشارة إلى قلب المحبوب أو العاشق، وما في ذلك من تسمية أدوار، أعني من تمرير رغبات موبايلياً في الواقع، وما يجعل الواقع رهن إشارته الشعرية طبعاً( ما حاجتي للبطارية بعد الآن- وقلبك معي).
في الحالات كافة، سواء جرى التنويه إلى قلبه أو قلبها، أو أي قلب آخر، فإن ذلك عائد إلى مناقبية ماثلة للعيان وهي التي تسمّي الموبايل، وفنون الموبايل، ليكون هذا النشط خيالياً بمحفّز موبايلي، لولاه لما كان المختلف في( قاموس العاشقين).
إن هذا الولع الموبايلي، استهدافيٌّ واستكشافي في آن، لأنه يروم عبر الموبايل ما يمكّن صاحبه من التحليق عالياً في فضاء المشتهى، كما لو أن الموبايل قبعة الإخفاء في الانتقال من مكان إلى آخر، أو بساط الريح في التحرك عبر مسافات طويلة، لأن الرغبة التي يسمّيها الشاعر غير مدينة ومنسوبة سوى إلى ذاتها، وأن القيمة الجمالية وحدها تجلو فاعليتها الفنية.
إن الصور المتداخلة هي أوراق الشاعر في عالم تخيلاته، بينما يكون الموبايل المفتاح ليكون انتقاله أو تحوله إلى الجهة التي يريد أو يرغب، وما رحابة عالم أدواته ومشهّياته إلا ذائقاته الشعرية وفتوحاته الدلالية الفائضة على القاموس.
في المقطع" 180" حين يقول( الموبايل كرسي ملوكي- ووحدها صورتك على العرش تمضي)، لا أظنه معنياً بالسؤال الزمكاني لقارئه، إنما ثمة مرجعية وحيدة تعينه في بث مؤثراته على صعيد المفردة الشعرية وتضميناتها الرمزية:
عند ربط الموبايل بالكرسي الملوكي وتكريس سلطة نافذة، وعند ربط صورتها بالعرش وهي تتحرك، كما لو أن الصورة تلك هي دمغة، أو إمضاءة الشاعر، وأن الذي يثيره هو ما يعلِمه وينثره جمالياً في إهاب التقابلات أو التناظرات.
ذلك ما نتلمسه في المقطع التالي" 181"( يطالب العاشق بحضانة صوتك- قبل أن يشيخ خارج الموبايل):
أن يكون العاشق في موقع الحاضن، والصوت في موقع الطفل الطري العود، فإن ثمة تبنياً له، وهو التحديد الزمني أو عين المهلة الزمنية لهذا الموعز إليه، قبل فوات الأوان، من خلال مفهوم الشيخوخة، وطالما أن الموبايل يعلِم بذلك.
تلك هي اللفتة الشعرية الكريمة لعاشق كريم بأعطياته القلبية، لمحبوب مكرَّم بفيض مشاعر العاشق، لجهاز كريم بدوره لا يتوانى عن تلبية نداءات العاشق، لحظة الاستعداد لطلبه، والآخر يكون على الانتظار مهما بعدت المسافة، لنكون في مجتمع موبايلي، أو يكون لدينا كائن موبالي حديث العهد، أو ما يصح اعتباره حول أننا شخصيات مسنَّنة موبايلياً.
وإن تحدثنا بنوع من التوسع والتروّي أكثر، أمكن التشديد على خاصية لافتة، هي مدى قدرته على تحويرنا وجعلنا على نموذجه الذي يغطي كوناً، وما في الطرح الموبايلي أو سليل الموبايل هذا من نزوع فيتيشي أيضاً، جهة التعلق به، على صعيد تأصيل رغبات تترى ووسمها بما هو موبايلي، ولكنها الفيتيشية الجاذبة والخادمة في ضوء المعرَّف به خليوياً، كما لو أن هذا العشق الذي تفرعت حدوده، وتنامت مقاماته القلبية، إنما يتفيأ فضيلة الموبايل، ويؤنسن عالمه الضيافي ويجمّله، وما الشاعر إلا ناظر في أمر الموبايل، لكنه يخرجه على مقاس رؤيته الشعرية، لجعل قاموسه ملتقى دلالات مؤمثلة.
وهذا النظر يتوخى إمكان تحقيق الحد الأقصى من الكشف الشعري، كما هو دأب الشاعر الكاتب أو الكاتب الشاعر، يقيناً منه أن الكتابة ذاتها هي هواية المغامرة، أما الشعر فلعله مغامرة في قلب المغامرة، وحتى بالنسبة للذي اعتمده في طريقة تصنيفه لمكونات موقعه الالكتروني" الامبراطور" وما يعنيه الامبراطور من دلالة، وقد تمت فلترة الاسم، ليكون الاسم الرحب معفىً من ضريبة المكاشفة الأخلاقية، كونه الامبراطور على صعيد الممارسة الثقافية وتعميقاً للمختلف ثقافياً.
في ( قاموس العاشقين)، حيث سؤال الحداثة الشعرية وما بعدها يطرح نفسه، ليس من جواب منتظَر، بقدر ما تكون لدينا حزَم إجابات مفتوحة على اللاتناهي، كرمى الشعر وطابعه المتعدي للحدود، وفي البنية الحداثية القائمة في الديوان، ثمة شافية تجلو خاصية الشعر، والرغبة في الإتيان بالجديد، أو البحث عن المختلف، كما هو شأن الموبايل ومرادفاته.
الموبايل موضوع شعري، وليس الشعر نفسه، وهو ممثَّل بقائمة طويلة من المعطيات التذوقية والمقدَّمة للآخر، وليس من تحديد أو تأطير لهذه المعطيات، كما في العلاقات المفعَّلة بين عناصر المقطع الواحد، أو كما في المناخ الهذياني الخاص الذي يسيطر على عموم مقاطع( قاموس العاشقين)، وهو الهذيان الذي يتقدم صُعُداً أو في أي اتجاه دون النظر خلفاً، كما لو أن مجرد النظر على طريقة" أورفيوس" يجلب الكارثة لصاحبه، ووفق هذا التصور، يكون لدينا هذا الدفق اللافت من المقاطع" الألف" وهو مرقَّم، بغية التوقف عند كل مقطع، ولكن دون إمكان البت في الطريقة التي تعامل بها الشاعر مع مقاطعه المختلفة هذه. ما إذا كانت كتابة هذه المقاطع جاءت دون ترتيب، ثم رتَّبها، أم اشتغل عليها في زمن غير معلوم بالدقة، من خلال الفاصل العددي بين مقطع وآخر، وما كان يُرجى في قول أو كتابة هذا المقطع أو ذاك.
ما يهم، بالنسبة للناظر فيها، هو ما جاءت به في طريقة التسلسل، وهي الطريقة التي تشرّع له في أن يتعرض لها بالبحث أو المساءلة أو المقاربة النقدية: السيميائية أو التأويلية أو الجمالية أو التذوقية...الخ، وهبَات الموبايل للشاعر.
إن الالتفاف أو الاصطفاف حول الموبايل يبرّره الوضع الانتاجي له، إن جاز استخدام هذا التعبير الاقتصادي، بما أن ثمة مقاطع كثيرة، بالاسم أو بالإحالة أو عبر الترميز، ترتد أو تنتسب إلى عالم الموبايل، ليكون هذا القاموس الاستثنائي في جلاء أمره معزّزاً بأثريات الموبايل، وما المقاطع التي وردت في صيغة رسائل نصية قصيرة، إلا إخلاصاً لهذا الكائن المؤنسن ووفاء له، بالطريقة التي تخيَّلها الشاعر، وفي السياقات التي أطلق العنان لخياله في أن يستشعر موبايلياً.
في لائحة من الأوصاف، يمكن معاينة جانب الاجتهاد في عامل الخيال الشعري لديه ومغامرة التوصيف، حيث المحقَّق على مستوى المبلَّغ عنه شعرياً هو الجدير بالتثبيت، كما في المقطع"282"( الموبايل مستشفى في اليد- الموبايل أرض اليكترونية تحررت بفعل نساء من غير فئة الحريم).
بين تعيين مكان إقامة لمعالجة أولئك الذين يحتاجون إليها، إنما هؤلاء لا يكونون في هيئة بشر مشخصين، بل في وضعية مشاعر وأحاسيس وانفعالات، والذين ينشغلون بأخبارهم أو تسقط أخبارهم هذه، من موقع تفاعلي طبعاً، وأداتية اليد في المصافحة وترجمة العلاقة حركياً، تكون اليد الفاعلة في ذلك، كونها تحمل الموبايل وباسمها أو طريقها يكون الاتصال بالذي يهمنا أمره، كما لو أن اليد هي التي تديرأمورنا موبايلياً، أو أن مواهب الموبايل تكتشَف عبر الأصابع وقبضة اليد، وفي الطرف الآخر وهو غير منفصل عن الأول ثمة عناصر أخرى يجري تأميم أنشطتها، وجعلها مناط العشق، عن طريق النساء اللواتي يستحققن شرف الاسم ومباركته، وليس الحريم هؤلاء اللواتي سلبن خاصية الذات المستقلة بأنوثتها، وما في الأثر من جانب تحريري وتوعية صحية أو حتى من تحريض على المجاهدة ومقاومة العالم الضيق سابقاً.
ذلك ما يمكن تلمسه في مغامرة موبايلية أخرى في المقطع"334"، حيث الطبيعة تمدنا بقوى كامنة وراعشة( صورتك في براري الموبايل- هي صورة من يؤرخ لليل والخيل- وصالون الجوكندا).
إذ إن الإحالة إلى البراري إحالة إلى العالم مطلق السراح مما هو كابوسي أو محمياتي في الداخل، هي التشديد على وضع إنشائي لعالم محرَّر من الضغوط والولاءات، بالترافق مع الجاري ضبطه أو تدوينه عبر تقصّي الليلي، وما يرتَكب فيه من جنَح أو آثام، ربما باسم الذكورة ضداً على المرأة، وما يستحضره إجراء كهذا من نشدان للحرية ومتعة الفن، حيث الحديث المقتضب جداً عن الجوكندا" رائعة دافنشي" حديث عن الفتح الجمالي متعدد الطيات والمسارات والأهواء.
وللأسباب الموجبة والوجاهية أصولاً، يكون هذا الإقدام على ما هو مشرَّع له، حين يكون التيمم صوب الجهات التي تدخل في عهدة الموبايل على صعيد الذبذبات، والموعود به دائماً، عندما يصرّح الشاعر لمن يحب ما يريد أن يكونه، أنَّى كانت هي، تجاوباً مع اللامحدود في أعطيات الموبايل في المقطع"564"( أنا عباد شمسك في الموبايل- في اللغة- وفي الفناء).
إنه الإعلان المباشر والصريح عن لحظة الولادة الشعرية، كما هو الإعلان عن لحظة نعي أو ساعة الوفاة، حيث الموت حبَّاً، طالما أن هذا الموبايل لديه كل هذه المواصفات، ويحقّق للعاشق ما كان يحلم به في أمكنة مختلفة ولحظة يشاء طبعاً.
الشاعر رهين الموبايل في الوقت نفسه، ولكنه واع ٍ لما هو عليه، وهو يحفظ وداً لموبايله، حتى في حالة صمته، ربما لأن صمته يعادل صمت النص الخصب، والذي ينطوي على الكثير من الموعود به، إذ إن صمت الموبايل ليس باعثاً على أي نوع من أنواع القلق أو مثيراً للسخط، ليجري انتقام ما منه، كون الذي يدَّخره في داخله لا يمكن الاستغناء عنه، كما ورد ذلك في المقطع"683"( لن أقتلك على صمتك أيها الموبايل- ففيك من الأرواح ما يحول دون ذلك).
كما لو مجرد المس بالموبايل يعني إلحاق الأذى بالذات في الحال، وما يصل هذه بأسماء أو أرقام من يهمه أمرهم داخل الموبايل، وذلك ما نجد له شرحاً آخر وتوضيحاً في المقطع"887"، وكيفية إضفاء بعد قداسي على المشهد المركَّب شعرياً، ولو في حالة مغايرة( موبايلي مثل نخلة مريم- أهزه وما من رطب لحبي- يتساقط!!).
هذا الأفق المفتوح لحسابات الموبايل وما لا يمكن حصره من الأوصاف، يعادل متعة الارتحال إلى اللغة وهي في أكثر حالاتها انفتاحاً على العالم، عبر تمثيلات لا تنتهي، والرغبة في منح المشروعية للموبايل لأن يحتفى به بالتالي.
إنه نوع من التأسيس لقدرات الموبايل، ولكنه التأسيس الذي لا يتوقف عند نقطة معينة، بقدر ما يكون العمل لصالح سلطة مخيال الشعر وليس سوى الشعر في عالم، كثيراً ما نشهد فيه تراجعاً لما هو شعري، أو انزياحات مأسوية له، كما لو أن هذا المعمول به، يمثّل بياناً عالي المستوى عن مآلات العالم الكارثية، حيث اختفاء الشعر هو اختفاء الكائن الجميل: القلب الذي يعمل ليل نهار، والقلب الذي ينبض على مدار الساعة، ولكنه يمنح الجسد عافيته أو القدرة على التحرك هنا وهناك.
ثمة الحديث عن قدرات الموبايل، عما يظهر به جهة التمثيل أو التحول، والشاعر ينوع في كشف حساب قدراته، كما في المقطع" 465"( أسهر تحت أشجار الذكرى- ومعي كآبة الموبايل تعوي في العظام)، حيث يجري الربط بين الذكرى التي تنمو أو تتفرع وما فيها من ظاهر وباطن، وما تستحضره الذكرى من كآبة، أو تسببه من ألم، لأن ثمة ما لا يأتي أو لا يتحقق، كما لو أن الموبايل يشاطر صاحبه ألمه أو يكون المدَّخر داخله نظير الذاكرة المعذَّبة بما هو مناط بها.
أو حين الانتقال يكون إلى مشهد آخر، في إجراء تقابل بين من يحب واللواتي يحاولن النيل منها، وكأني بالموبايل فيما يتعرض له آلياً، يفصح عن مكنون العاشق( كلما حاولت الحمقاوات محو صوركِ- من موبايلي- يغرقن في بحر الشاشة).
لكأن الشاشة ببياضها هي العودة إلى الوضع السديمي، هي طمس لكل أثر وتغييبه، حيث بياض الشاشة يعني إطلاق تحذير إلى أن الذي رؤيَ على الشاشة يعني ضرورة التوقف، وكأن القائم وراء البياض لا يعود في مقدور أحد الوصول إليه، كون الصور مودعة في نقاط، أو حيوزات مؤمَّن عليها، وهي لعبة شعرية أو مباراة شعرية يفوز فيها العاشق.
ذلك ما نتلمسه في المقطع"967"( الموبايل محارةٌ- وطالما أتلذذ بوقع صوتك اللؤلؤي- هناك).
دائماً يكون لدينا السفر أو الارتحال إلى الأعماق أو إلى الخفاء، أو إلى آفاق بعيدة، وأظن ذلك من خصوصيات الموبايل أو من بين مهامه الأكثر براعة، حيث الحجم الصغير والفعل الكبير، وحيث المصمَّم في الداخل في مفهومه الرياضي، يعدُ بما لا يحاط به مقارنة بقدرات الإنسان العادية في تقليص المسافات، وليكون لدينا هذا المشهد الكنزي في الأعماق لسان حال الملموس في الموبايل، وما يشكّله كل ذلك من حوافز تغبط الشاعر بقدر ما توسّع في حدود قدراته بالذات.
لكن ذلك يبقي الموبايل في منعطف طرق، قرين احتمالات، مجسّد مصائد، ومشخص مفاجآت، ليكون الحد الذي تلتقي المناقب والمثالب، وحيث يكون الفتنة التي لا راد لسحرها بالمقابل، كما هو المنظور إليه في المقطع"998"( اللعنة على الموبايل- صانع الخطايا وقائدها على طريق الأحلام.)
هل يمثّل ذلك دعوة إلى إعلان القطيعة معه، أم ضرورة التحكم بقدراته، أو الحد من سلطاته الهائلة والرهيبة؟
ليس من درس معطى لتغيير مسار سلوك، أو إحداث تأثير فيه، إنما هي مغامرة الجمال عبر الشعر وتيهه الأثير.
هل من عناء ملموس لدى الشاعر فيما استهل به قاموسه وتوقف عنده؟ هل من مقايضة لدى الشاعر لموبايله، أم من حُكم أخلاقي في مقطع ما دون آخر؟ هل أفصحت مغامرة الشاعر عما يستبطنه بالكامل تجاه الموبايل في قاموسه؟
إنها أسئلة تعمل على أكثر من " جبهة" معرفية وذوقية، جبهة يكون الخاسر الوحيد فيها، كما أعتقد، ذاك الذي يتوقف عند معنى وحيد مكتفياً به أو يستوقفه مشهد حسي في مقطع دون آخر، وربما لا يعود قادراً على المتابعة وما في ذلك من إساءة إلى روح الديوان لأنه يراعى في مجموعه، بينما الرابح هو الذي يضيف من عنده ما هو منتظر منه، أي ما يجعله أكثر قرباً من الشاعر وهو يسائله عما سكت عنه، وما استبقاه لديه لأن القاموس الموضوع ليس خلاصة قواميس العاشقين سوى أن الذي قام به الشاعر كان يمثُّل رؤيا شعرية، أو جملة بثيات أو برقيات، كما هي لمعة الشعور في الداخل.
حسبه أنه قدَّم ديواناً يحمل اسماً معيناً، وأنه لما يزل يحتفظ بموقعه لأن الانشغال بالموبايل في اضطراد بالتأكيد.
ولعل التنويع الذي حفل به ديوانه يترجم هذا الجانب المثابر في ذات الشاعر، بقدر ما يلقي الضوء على مسيرته الأدبية، وليس الشعرية وحدها، وهي التي تكاد تتلخص في عبارة واحدة، سلفت سابقاً، وهي: المغامرة!
لكنها المغامرة التي تحفظ للشعر حقوقه قدر استطاعته، أي من خلال إثارة قارئه وإعلامه ضمنياً أن ثمة ما ينبغي التنبه له والإصغاء إليه، أن ثمة ما يجدر التوقف عنده، أن ثمة ما يجب تبين فعل تشكيله الجمالي في الناظر أو القارئ، رغم وجود صعوبته أحياناً أو عجز أولي في التواصل مع هذا المختلف، وتحديداً إذا كان العمل المختلف ضداً على التقليد.
إذ بالنسبة للجبوري كشاعر عراقي مغترب، هو يكتب منذ عقود زمنية عدَّة، وما يعنيه هذا الفاصل الزمني من تجلي استحقاق الشاعر أو الكاتب عموماً في أن يُهتمَّ بأمره، والتفكير خارج زوايا النظر المعتادة في السرد القولي وسياسة الكتابة، حيث له مع كل كتابة جديدة مسعى جديد للإتيان بجديد، والهدف هو كيفية تنويع المقام الشعري، وجعله في ذمة اللامعهود، ليكون اللامتوقعُ أو العجيب أو الصادم والباعث على اليقظة الروحية هذا الذي يتشكل مشهداً شعرياً أو غيره.
سواء تحدثنا عن شعره في تعدد دواوينه، كما في ( ذبحت الوردة... هل ذبحت الحلم؟)، أو( أولمبياد اللغة المؤجلة)، أو( الامبراطور)، أو ( العطر يقطع المخطوط)، أو( الملاك الشهواني)..الخ، أو بالنسبة لأعماله الروائية( التأليف بين طبقات الليل- الحمّى المسلحة- قيامة الديناصور...الخ)، إذ إن في وسع متابعه القارئ أو الناقد أن يتلمس جنون الاختلاف والشغف بالتنويع لديه، وما هذا الديوان الشعري الذي اتخذناه نموذجاً بحثياً، رغم مرور سنوات ست على صدوره، إلا الدليل على نوعية الشغف المتبصر بحيوية المختلف، وبدقة أكثر: بفاعلية المتنوع، واستمرارية أثره جمالياً وذوقياً حتى الآن.
إن الكتابة في ( قاموس العاشقين)، تنسّب الشاعر إلى عالم المعاصرة بكل تقلباتها ومستجداتها وحكاياتها الكبرى، بقدر ما توفّر أمثلة حيّة، ومن الداخل طبعاً، على مدى رحابة مفهوم العشق واستطالاته الأرضية وملامسة جنون العاشقين.
لعل صرح المعنى الشعري يسهل النظر فيه من خلال مقاطع مختلفة تتناثر في مرمى النظر داخل الديوان، حيث الحديث لا ينفك يتعلق بما هو اتصالي، والتشديد على الاتصال في عالم يشهد اختناقات كثيرة، ومضايقات للروح بالذات، كما لو أن المرعيَّ في الموبايل هو إمكان تأصيل المؤتى فيه أو منه على أرض مجتمعية تشهد على تصحر أرواح، وأن هذا المتنفس الحداثي يقبل التأهيل والتعويل عليه لجعل الكلمة أكثر نضارة أو تكون ممثلة إشراقة أمل لاحقاً.
إذ الهاتف نفسه موضوع في الخدمة لتخفيف الضغط، ضغط العزلة على المعذبين هؤلاء الذين يشكلون سكان أو أهل القاموس ( قاموس العاشقين)، مع فارق الإمكانات والقدرات، باعتباره منزلياً، والآخر نقالاً أو محمولاً ويخص قبل كل شيء، المسافات البعيدة، وليكون يقين الشاعر بما يصف إيمانه بالمودع فيه في أهليّته ونجاعته، كما في المقطع"68" حيث الإيحاء إلى المفارقات والمعانقات في المشاهد المتخيلة، بدءاً من الحب وما يكونه حقيقةً، وعرائية التمثيل للمعنى المضاف إلى القول المركَّب والتخيلي( الحب نظرة بلا ثياب- وهو أيضاً رحلة تعذيب طويلة- على خطوط الهاتف الوهمية).
لكن الذي يمكن قوله هو أن ثمة تبادل مواقع جمَّة جهة التعبير عن كل من الهاتف والموبايل، إذ يتراءى لي أن الموبايل هو الهاتف مع إضافة بعض اللمسات أو الميّزات من خلال التعامل معه، وأن الهاتف هو الموبايل من خلال طريقة تقديمه، كما في المقطع"885"( صار هاتفك النقال نقالاً كبساط الريح- فحذار أن تسقط بك الحمولة في الوادي العميق)، وما يقوله أكثر في المقطع"960"( حينما تظهر على الشاشة صورتك- حزينة- أطلب لهاتفي سيارة الإسعاف)، أو ما يقوله في المقطع " 990"( ما أن يصبح صوتك كطريق مغلق- حتى يبدأ هاتفي بالأنين كجندي- عائد من الحرب.).
رغم أن الاختلاف قائم بين الهاتف المنزلي والثابت في مكانه، والهاتف النقال داخل البيت، أو المتعلق بقاعدته ويستطيع العمل على مسافة معينة، والموبايل الذي يعتمد على بطارية تنشحن، ومن خلالها يكون المؤشر الدال على عمل الموبايل.
أهو العشق الذي تلبَّس الشاعر وهو يتمثله، ليجد في وسيلة الاتصال ذات التعبير أحياناً؟ إذ المهم هو وجود جهازين بين شخصين متحابين، أو عاشقين، وهو رهانهم، ووسيلتهما في التفاعل مع بعضهما بعضاً، كما لو أن الخفي في الموبايل هو الذي يجلو الخفي في العشق، أعني أن حضور الموبايل هو الذي يملي قواعده على العاشق في اختيار كلماته وضبطها، كما في المقطع" 253"( الحب راديو يهذي بموجات الكوبرا- والعاشق ثملٌ على كرسي الغروب).
في جدل الحضور والغياب، الصمت والكلام، الصوت والصورة، يكون الانشغال الدائم بالآخر، نفياً لزمن ضاغط هنا.
أو حين يظهر الموبايل راسماً الخلفية الحية للموبايل، أعني ما يأتي على صورة الموبايل، كما في المقطع"788"( ما من عاشق- ولا يدَّخر نفسه ضحية في بنك الحب).
في مجمل الحالات أو الأوقات التي تصعد المشاعر والأحاسيس مستنفرة تلبية لنداء الأقاصي حيث القلب يكون رحالة أو متنقلاً بين أمكنة المحبوب، يكون الانشغال بالموبايل على مدار الساعة تعبيراً عن هذا الامتلاء الوجدي بالمقابل.
إنها اللحظات التي تأتي مرنَّمة أو مموسقة، كما لو أن المعبَّر عنه موسيقياً، يناشد العفوية ويلتزم بإيقاعها المتصادي في الجهات كافة، كما في تمثل الكمنجة أكثر من مرة، كما في المقطع"71" صحبة البيانو( صوتك بيانو في النهار- وهو في سريري كمنجة مبللة- بالكحول)، حيث البيانو المركَّب بمكوناته الموسيقية، يصدح في النهار، بينما الكمنجة باعتبارها الجهاز العزفي المعروف، فيحيل على ما هو رومانسي أو حتى ليلي، بين الصحو والنشوة المذهبة بالعقل.
أو ما يأتي تحت رعاية موبايلية، حيث التشابك بين الصوت النابع من الكمنجة والصورة الظاهرة على الشاشة، في المقطع"958"( الكمنجات في الأرواح- تذبل- ووحدك على شاشتي غابة أحلام- بلا حدود).
إنها جملة من الإحالات الشعرية إلى ما هو موبايلي، ولكنها إحالات تحتفظ بنقلاتها الموسيقية، كما هو الجامع الجذبي بين الصوت والصورة، بين الصمت الباعث على النشاط التخيلي، وانتظار لحظة سماع الصوت أو ظهور الصورة ضمناً، وما يعنيه الانتظار من قيمة اعتبارية وانهمام كل عاشق بنظيره أو بمقابله.
بالطريقة هذه، أو كما يعتقَد، يمارس الشاعر أسعد الجبوري في زمن الاستخفاف بالحب، وحتى من خلال الاستخفاف بهذا الجهاز الموبايلي دونما نظر في مهامه الجليلة، يمارس كتابة المفرد بلغة المثنّى، حيث يكون لدينا عاشقان، أو يكون العاشق الذي يصاغ في هيئات شعرية، في سيرة المقاطع الألف، وحيوية المثار وجدانياً من خلالها.
وربما، ومن خلال ما تقدم، يستثير أحدهم جرَّاء هذا الكم اللافت من المقاطع، ويستوقفه هذا التعبير النقّال أو المتحول من مقطع لآخر، ولكن ما لا يمكن غض النظر عنه، هو وجود قاموس يسمَّى ( قاموس العاشقين)، وما فيه من ابتداع لغة خاصة قد لا يوافَق على بعض شكلياتها، لكن لا مناص من الموافقة على غواية المبثوث عشقياً وجمالياً فيها.
ولعلي فيما أثرته من خلال قاموسه، بعد مضيّ سنوات ست، أعبّر عن سيرورة القيمة الجمالية لشعرية الموبايل العشقية!
عبر قراءة العشرات من قصائد الشاعر أسعد الجبوري وترجمة مجموعة منها إلى اللغة الكرديّة ؛ تيقنت من إبداع شعريّته الخاصّة بإنجازه قصائدَ خارج إطار التسييس والأدلجة؛ فهي قصائد حرّة بمعنى الإصطلاح و زاخرة بصور تستحضر الأحاسيس والأفكار بنزعة سوررياليّة، لكنها غير مستسلمة لإنفلات الألعاب البهلوانيّة اللغويّة و شططها، وإنما ثمّة منطق شعري خاص يتحكّم ببنية كلّ قصيدة مبنىً ومعنىً ، وهو طبعاً ليس المنطق العقلاني المتعارف عليه في المقال مثلاً. ولعلّ لهذه القصائد الأسعديّة أخوات أخرى ، لكنهنّ قليلات في مشهد الشعر العربي المعاصر لدى شعراء مبدعين أمثال: سركَون بولص ، صلاح فائق ، نصيّف الناصري (في قصائده القديمة) واحمد الدمناتي.
برغم (بلبلة الألسنة) منذ غابر الأزمنة ، ظلّت الترجمة تتحدّى البلبلة بتجسير الحوار بين اللغات المختلفة بخصوصيّاتها المعجميّة واللفظيّة(الجَرْسيّة)والقواعديّة، حتى اللغات من ذوات الأرومة الواحدة؛ وهذا ممّا يجعل نقل المتن الشعري من لغة المصدر(الإرسال) إلى إلى لغة الهدف (الإستلام) نقلاً أميناً تامّاً في حكم المحال ، مهما كان المترجم ضليعاً في اللغتين ومتعمّقاً في ثقافتيهما، بل حتى لو كان مثلي شاعراً في اللغتين.
ولأنني بصدد ترجمة قصائد الجبوري من العربيّة إلى الكرديّة ؛ فهذا يعني الترجمة بين لغتين مختلفتيّ الأرومة، لكن الجيرة الثقافيّة تربطهما منذ بدايات انتشار الديانة الإسلاميّة ، وهذه الجيرة تخفف من وطأة الغرابة والإختلاف بينهما إلى حدّ ما، وممّا يزيد التخفيف أيضاً هو ثراء اللغة الكرديّة قاموسيّاً، بل و كونها لغةً إلصاقيّة واشتقاقيّة في آن واحد ، وهي حالة إستثنائيّة نادرة بين اللغات ، قد لايدركها إلاّ الملمّ بلهجاتها الخمس الرئيسة!
أجل ؛ فهذا الثراء القاموسي يتيح للمترجم المتمرّس القدير إنجاز ترجمة توفّق بين حرفيّة المتن وروحيّته بأقصى شعريّة ممكنة ، عبر انتقاء المفردات الكرديّة البديلة لمفردات المتن العربي بمعانيها ودلالاتها وموسيقى ألفاظها، مع عدم اللجوء إلى الحذف أو الإضافة إلاّ في الحالات الضروريّة القصوى، لكنّما الإلتزام التام بنقل التركيب النحوي للجمل الشعريّة و صيغ المفرد والجمع والتنكير والتعريف والأزمنة، ناهيكم عن الكنايات والمجازات والجناسات ؛ فهو عسير للغاية في بعض الأحيان ؛ لإختلاف اللغتين في بناهما القواعديّة، خصوصاً في بنية الجملة(تسلسل الفعل والفاعل والمفعول به أو التكملة..والصفة والموصوف) فلاتوجد صيغ الحال المنصوب والمفعول المطلق والمنصوب وجوباً والكافة والمكفوفة غيرالعاملة في اللغة الكرديّة على سبيل المثال ، لا الحصر، بل من الصعوبة ترجمة الجمل المركّبة الطويلة الحاوية على صيغ المضاف والمضاف إليه و الصفات والضمائر المتصلة إلى الكرديّة، وهنا من الضرورة إيراد تشخيص الشاعر صلاح ستيتيه لمعضلة ترجمة النظام اللغوي: "... فمن السهل الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى ذات أصول ساميَة ، تتقارب في تكويناتها اللغويّة والشكليّة ، والصعوبة تكمن في الإنتقال من تكوين كامل للغة معيّنة إلى تكوين آخر. ماذا ننقل من لغة إلى أخرى؟ ننقل الهيكل فقط ، ويبقى عصيّاً إنتقال الذوق ، الطعم ، النكهة ؛ فإختلاف امرأة عن إمرأة أخرى يكمن في نكهتها، لون عينيها، تكوين جسدها، تقاطيع وجهها، وهذا مايفصل امرأة عن أخرى ! (...) إن الترجمة هي نقل الهيكل العظمي وليس النور الشفاف للجسد، والصعوبة الجوهريّة في ميدان الترجمة في نقل الهيكل والجسد في آن واحد"
وهنا لابدّ من التأكيد على ضرورة رفقة الشاعر للمترجم ؛ بغية توضيح مايستغلق على فهم المترجم حتى بعضها البسيط مثل المفردات ثنائيّة أو ثلاثيّة المعنى مثل (العرق) كما في قصيدة(يا أبي) : " لقد غرقت المراكب في العرق" فلكون المفردة غير مشكّلة (محرّكة) تسبّب مشكلة في الترجمة ؛ حيث يضطرّ المترجم إلى تقليبها لاقتناص الإحتمال الصحيح : (عَرَق =
من التعرّق) ،(عَرَق= خمر)و(عِرْق) وقد أهملت إحتمال (عِرْق) بعد التمعّن في السياق ، لكنني لم أستطع حسم الإختيار بين (العرق الإعتيادي) و(العرق = الخمر) ومن حسن الصدف أن مفردة (ئاره ق) الكرديّة تعني كلا المعنيين ؛ وعليه استطعت حسم هذه المشكلة. وقد جابهتني المشكلة نفسها في عنوان قصيدة (ثلج و مقعد)؛ لأن مفردة (مقعد) غير مشكّلة، بل لاترد في نص القصيدة ؛ لتساعد على حسم الإختيار بين (مَقْعَد) و(مُقْعَد)؛ فاضطررت إلى حذفها في الترجمة، واستبقيت العنوان هكذا(ثلج و...) ولقد جابهتني أيضاً مشكلة أخرى أعقد تتعلّق بخصوصيّة كلمتيّ (الحرب) و(حرّ) في جملة " الحرب مجرّد حرّ فقدَ الباءَ عنوةً" في قصيدة(الموظف) وكدت أن أتخلّى عن ترجمة القصيدة بسببها، وإذا بومضة تهديني إلى حلّ المعضلة عبر الجناس المقلوب في مفردتيّ (جه نك= حرب = jang) و(كَه نج= كنز= شاب= ganj) فاستقامت الترجمة الكردية إلى حدّ لابأس به، بعدما صارت الجملة" جه نك هه ر كَه نجه به توبز هه لكَه راوه" حيث تعني " الحرب مجرّد كنز مقلوب عنوةً"
وهكذا وجدت نفسي أهمل ترجماتي لأربع قصائد بعد إنجازها؛ بسبب مثل هذه المشكلات ، التي كان معظمها سيتذلّل ؛ لو كان الشاعر نفسه يؤازرني بتوضيحاته.
لقد تبيّن لي عبر عمليّة الترجمة كم كانت هذه القصائد مطواعة في الإنتقال إلى اللغة الكرديّة، ومترعة بالموسيقى الداخليّة والإيقاع ، بل حتى التقفية أحياناً بعفويّة وتلقائيّة دونما قسريّة، ولاغرو في ذلك ؛ فهي من عيون الشعر الحقيقي ، سواء أكانت قصائد قصيرة ومضويّة ، أو متوسّطة الطول ، حيث استقبلتها اللغة الكرديّة بثرائها القاموسي وشعريّة موسيقاها الباذخة بكلّ أريحيّة.
أعتقد أن أفضل وأعمق قراءة للشعر هو الترجمة التي تنطوي على عمليّتيّ التفكيك والتركيب اللتين تكشفان عن معدنه الحقيقي ، وقد صارت هذه القصائد نماذج على محكّ الترجمة ؛ من أجل إصدار حكم أوّلي على شعر أسعد الجبوري المبدع ، لايدّعي صاحبها الإحاطة بمجموعاته الإثنتي عشرة جمعاء ، والتي تشكّل إحدى التجارب البارزة في مشهد الشعر العربي المعاصر، تمتدّ قرابة أربعة عقود، متسمة بالتنوّع والرحابة والعمق ، وهذا يعني أن الجبوري شاعر طليعي مغامر متفرّد في عطائه الشعري المتواصل الذي يستحق المزيد من الدراسة والترجمة إلى اللغات الأخرى.
(ج.ز): شاعر، مترجم وباحث كُردي
.نص ماجن أقل حقيقيّةً إلى درجة الحلم , يتربّع تحت صنبور اليقظة , حيث يمكن للمتتبع أن يقتفي سيرورة لغةٍ تبني هدما خارج أبعاد الوجود الاعتيادية , في اتجاهٍ لا معاكس و لا موازٍ .. إذ تجذب لغة أسعد الجبوري إطلاق المنثور و تكدّسه في شعريّة مغايرة وصادمة .
فتجربة الخوض في لغة /على وشك الأسبرين/ تشبه تجربة السقوط الحر حيث لا مرتكزات إلا من تداعٍ مبهم للمفردات و الاستعارات الغريبة منتجةً نصاً عدمياً في القشرة .. قبّاضاً على جوهر الوجود المتوهم في الصميم ..
/ أهو فعل لضرب كل ساكن من أدوات الكتابة؟؟/ص 233
من السهل رصد التناصات في تاريخ تجربة الكتابة الأدبية إنسانياً كتخاطرات لا واعية و جمعية في آن .. و من جهةٍ أخرى كتراكمات للقراءات و توليد الأفكار و الاستعارات من فكرة جوهرية أو استعارة تتعدد وجوهها حسب زمن الشاعر و نقطة مراقبته الثقافية بكل مكنوناتها المتداخلة و هذا ما أطلق عليه رولان بارت تناسل النصوص في كتابه "لذة النص" ..
و هذا التوصيف ينطبق على جمل كتاب / على وشك الأسبرين/ فالتجربة موضوع التعبير على اختلاف الأزمنة والشعراء لا تعدو كونها عجينة تسويّها أكفّ الشاعر اللغويةً كتابةً متمايزةً في كل مرة على صعيد التشكيل ،بيد أن مادة بنائها جمعية بامتياز ..
عندها يحضر في الأذهان أن كل تجربة شعريّة أصيلة، لم تختر مدرستها الأسلوبية بمحض إرادتها ،إلا أن ذلك قدَرٌ يدخل في دهاليز علم الاحتمالات ..
إلى ذلك يُردُّ انتهاج الجبوري لهذا الأسلوب .. بل تلويح هذا الأسلوب التعبيري لبشرة الجبوري اللغويّة والشعريّة ..فاللامعقول في نصوصه كان ولا يزال هروباً لاواعياً من جهة .. و عبثيّةً اختياريةً من أخرى .. بغية تجنّب مواجهة جبل الحقيقة المهيب و المرعب .. حيث مرَّ الجبوري في تجربةٍ إنسانيّة مريرة و صادمة حدَّ توهمها حلماً و إنتاجها نصاً لامعقولاً .. فقد تم اعتقاله مع شقيقه في وطنه العراق في زمنٍ قاتمٍ و سحيق .. و في لحظة تنفيذ الإعدام بشقيقة أمام عينيه رمياً بالرصاص
كان دوي الطلقة الذي أيقظه من الوعي ليصحوَ في حلمٍ لغويّ لا ينتهي .. يدخل في باب النكران كبهلوانٍ يحمل عصا لضمان توازن هو أصعب من كل احتمالات الوقوع
/*هكذا يخلق الطغاة صورهم في المسلخ ..
_ولكن أين مسقط رأسك ؟؟ *
لم أعثر على جثتي بعد فأكون ممثلاً إيمائياً للموت/ص 239
من هذه البوتقة الزمنيّة يغادر الشاعر مداعبات الشواطىء ليغوص .. فالغريق لا يخشى البلل وتنطبق على حالة الجبوري نبوءة ت.س أليوت: (ليس الشعر تعبيراً عن الشخصية بقدر ماهو هروب منها )
فالجبوري الإنسان و الشاعر يعاني عقدة النجاة بوصفها ذنباً غريباً اقترفه بأيدٍ من قدر .. فالدموع تنذرف من أحداق اللاوعي ميّتةً /لا عظام للضلالة لتصبح هيكلك إلى مائدة النار/ص103 .. و المرح في السلوك اليومي لا أكثر من رد فعل متوهّم و آنيّ !!
لكن الخسائر الكبرى تقف بالإنسان على إشارة الجوهر الوجوديّ فنبلغ في لحظة إشراقٍ حدسيّةٍ رشدنا المعرفيِّ
/لا نوم للبويضة بعد سن الرشد/ص233
بويضة الوجود إذ يلقّحها العدم لينخلق جنين الشعر الذي يسبح في رحم مظلم وعصيّ على التحديد ..ففي جانبٍ ما يكون الخيال الفلكيّ تعبيراً عن العجز تماماً كما وصّفه وردزورث ( الخيال .. تلك الملكة هي خضوع للعجز المحزن في التعبير الإنساني .. تلك التي انبثقت من هوّة العقل المظلم و سيطرت عليه ) بمعنى انها رفض طفليّ للركون لأيّ عقل
/ *هل قلتَ طردتُ العقل من الأرشيف؟؟
_ نعم , و شعوبي تقيم مع الحيوانات والبراثن !!/ص85
إنّ الفوضى السرياليّة التي تسبح في كموناتها لغة الجبوري نابعة من تماس مباشر مع النقطة الحساسة التي تربط الواقع بالحلم و المنطقيّ باللامعقول .. ولا علاقة لها بتصريحات أندريه بروتون عرّاب السوريالية: ( إن السوريالية التي أخصها بهذه الدراسة قد انصبت على إعادة الحقيقة المطلقة إلى الحوار و ذلك بتخليص المتخاطبين من واجبات اللباقة. ) و إن انطبقت عليها ..و ذلك يتضح في رؤية الجبوري المفارقة لما طرحه بروتون في كتاب "الأواني المستطرقة" : ( السرير رمز مشترك للحياة وللموت) .. فالموت في تجربة الجبوري الشعريّة/ الطفليّة العميقة غير مرتبط بالسرير فالإنسان يموت واقفاً و فجأةً يتبخر في العدم ..
/لا ثابت له في لغة و لا عنده سرير مرتفع في مرآة
هكذا تراه الأعين العامّة ذابلةً
على طبقات من جبهته
فيما هو يشقُّ البلاغة بقطعان أعمدة الكهرباء
و ماضياً سباحةً في العاصفة
غير محتمٍ بما قلَّ من آلهةٍ في بواطن الأفلاك
غالباً ما لا يكون مزدحماً بالبشر
مع ذلك يرسم أساطيل لنزهات الزجاج العتيق
بصور لراحلين يتذكّرهم .
بداية أود الإشارة إلى أن الكاتب والشاعر الكبير أسعد الجبوري
يصعب تناوله عبر أقلام غير متخصصة في النقد والتحليل ..فهو يكتب من اجل أن :
يخلق
يؤسس
ويبني
من اجل أن يمدّ جسرا زمنيا بين موروث يرفضه ولا يتخلى عنه
وبين جديد يقبله ولا يذوب فيه
فهو إذا بحاجة الى اكادميين متخصصين لدراسة منجزه الإبداعي الغزير والثر الجميل
لكنّي هنا بكلّ تواضعي وبساطتي سأحاول أن أضع إصبعي على بعض مواطن
الجمال التي أجدها مثيرة للاهتمام ومثيرة فعلا للدراسة والتحليل...
( أسقطُ في حضنهِ ثمرةً مُعَدلةً وراثياً
ويسقطُ في أغوار طاحونتي نهراً
كأنه في غيبوبة الابد.)
لمحات شعرية تدور في فضاء الممكن والمقبول تشير كثيراً ولا يُشار إليها إلّا قليلاً
فمهما تحركت الألفاظ وتغيّرت أماكنها , ومهما طالت أو قصرت انكشفت أو تغلّفت
تبقى في النهاية ضمن إطارها العام وهي اللغة التي تبقى بدورها هي الأداة
الأوحد في إيصال المعنى والفهم من اجل تحقيق التفاعل بين طرفين :
المتكلم- السامع
الكاتب- القارئ
(الحكمةُ –
أن ترى البحرَ كأساً في عميق النفس
الحكمة –
أن تجعل الطيرَ من منازلك
الحكمة –
أن تكون بين النهدين حطباً ,
لا بئر غاز)
بداية سأشير إلى العتبة الأساسية ألا وهي العنوان الذي من خلاله يمكن تأطير كل
اللمحات الشعرية الداخلة فيه والخارجة منه ..
لماذا بنك؟ لماذا خيال؟
اعتقد إنها لا تحتاج الى عناء طويل من الشرح للوصول الى التفسير,ببساطة شديدة
البنك هو لفظ معّرب جمع بنوك تعني المحل الذي توضع فيه الأموال لأعمال
مخصوصة تحت إدارة مخصوصة وعربيتها المصرف وهي مفردة جامدة أقرب الى
الذهن من الحس , عكس الخيال مفردة أصيلة حسب ما جاء في المعجم جمع
أَخْيِلة اي الظنّ والوهم والخَيالة جمع خيالات اي ما تشبّه لك من الصور في المنام
والكلام المخيل اي المشكّل اما المخيلة والخيالة فهي القوة التي تخيِّل وتمثّل
الأشياء ولها قدرة هائلة على الخروج من وظيفتها التاريخية بسهولة والدخول في
معايير مختلفة وأماكن متغيرة ومعانٍ جديدة بهذا يمكن القول ان مفردة بنك هي
مفردة مادية إما مفردة الخيال فهي مفردة معنوية وبتشكيلهما في وحدة جامعه
يمكن ان تخلق علاقة تضادية تفرز طاقة من المعنى ترسم صورة حسية وذهنية
أي :
( الحس ) + ( الذهن ) = ( صور شعرية )
(صور خيالية) في (حاضنة واقعية)
(خيال) بتصريف (واقعي).
( تضيق سيارة الإسعاف بالأرض المريضة
وما من قشة بين أمواج الدمار لأحد.)
يطرح الشاعر أسعد الجبوري في بنك الخيال لمحات شعرية عالية الكثافة, شديدة
الصرامة متماسكة البنيان , بخيلة في استعمالها العطف والربط , صور حسية وذهنية
خيالية يقبلها العقل ويقودها المنطق , واقعية يراودها الخيال لكنها مثيرة لأسئلة
الألم والسعادة دافعة نحوا لكفر والإيمان, صادمة , مدهشة ,احياناً خاطفة كسهم
سريع يصيب فريسة فيجعلها منذهلة من حقيقة وقعت على نقيضين من الألم واللذة
فيتركها حائرةً.. أميتة أم حيّة ؟ واضحة أم غامضة ؟ هذه الحيرة هي لحظة اللذة
الحقيقية بين ..
الاندفاع + التردد
الجوع + التخمة
الصدق + الكذب
الجمال + القبح
القبول + الرفض
الشعر + اعراضه
( ما أشدّه في حبكِ الشاسع
كأن ينهمك في خندقك العميق دبابةً
نزل الخبلُ بها حتى ذوَبان الحديد.)
بنك الخيال يطمح ليحقق الجمال بقيمه العليا بلغة متفردة, بصيغة خاصة جداً
لخلق جملة شعرية غريبة بطرازها فهي أحيانا منشطرة الى نصفين متساويين
بالقوة والمقدار ..
فحين يبدأ نصفها الأول بواقعية حادة فلا بد ان ينتهي نصفها الثاني بالخيال الحاد
والعكس صحيح طبعا ان كان نصفها الأول خيالا بعيدا فنصفها الثاني سيكون واقعا
قريبا لا محال وأحيانا تبدأ الجملة الشعرية بسيطة لا تخرج عن إطار الكلمة ومعناها
لكنها تنتهي معقدة حمالة لاوجة عدة , ألفاظها منزاحة عن مواقعها التاريخية
والثقافية يصعب الامساك بها وبين هذا وذاك تتحقق مساحات هائلة من الجمال
والقيم الإنسانية العليا ..
( ليست مجرد بريد لغط واستعراض ) = ( الرسائل بوصلات تستهدي بها الأرواح ).
أو
( القلبُ خمّارة في نهاية المطاف) = ( وما كلّ مفرطٍ في شرابٍ بسكران ).
أو
( الشاعرُ ساعي بريد الأرض) = ( الصندوق الأسود لطائرةٍ تسمى السموات).
اضافة الى ذلك هناك مواطن كثيرة تعتمد مبدأ التناقض والتضاد والتعارض ما بين
الدوال لتحقيق التجانس والتناغم لخلق المعنى والوصول به الى ابعد مراتب الاقناع
بانزياحاتٍ مولِّدة لطاقةٍ جديدة, تلك الطاقة القادرة على توليد صورا حسية وذهنية
معا يصعب تحديدها في اطار الفهم السائد او السطحي البسيط انما تغوص عميقا
لتشكلَ أسئلة صعبةً بالمٍ قديم تؤدي بالنتيجة الى فهم منطقي قادر على التكيّف
في أقصى درجات الممكن والمقبول ..
( ما أجمل الكاف)
(سفينةُ)
(تُحاك في بطونِها أساطير)
(الهلاك الجميل)
أسعد الجبوري شاعر فذّ غزير الانتاج سريع التحول دائم البحث عن دلالات ورموز
له طرازه الخاص ونكهته الخاصة ولغته العصية الواعية انّه ندّ عنيد للغةٍ تفيض
بالمعاني وتستفز المتلقي , تجعله يفكر بالبدائل او بعملياتٍ قيصرية لإعادة صياغتها
وتشكيلها فيتورط في الشعر ,ليتحولَ الى عنصر فعّال ضمن حدود مملكة الشاعر
(هلمّ )
(ترنّم)
(بحبك
دون جدران)
(أهتف)
(لنمو شهوتك)
(في غير الصلصال)
إذا هو له مساحاته الشاسعة التي يشتغل عليها من اجل الخلق والابتكار
وله طريقه الشاق الى المتلقي بكل مستوياته والذي يجرّه الى مناطق التأمل
والسؤال بعيدا عن السطحية والمجانية حيث ان قصائد بنك الخيال القصيرة
لا تحتمل اسقاط اية مفردة منها ولا اضافة ايّ حرف لانها محبكة بعناية فائقة
من أجل تحقيق غايتها والوصول بها الى جمال أسمى .
( ربّما الرغيف الأسود تاجٌ في نهاية المطاف
وربما ستفتح الأرضُ البيت الأبيض,
وتستريح الجذور قليلا ).
رجل يظهر في الطريق، تطلب منه الجلوس على كرسي في مكان مُظلم تماما؛ تمهيدا لالتقاط صورة فوتوغرافية له، تضبط إعدادات الكاميرا.. وتستعد، وقبل أن تضغط على زر التصوير، يندلع ضوء/ فلاش في وجهك، يقوم الرجل من مكانه، يضع في يدك صورة (سينيّة) لعظامك، ويختفي... هذا هو أسعد الجبوري!
كولاج*
"كان يمكنه الضجر من الحياة قبل أن تداهمه الشياطين في محطة بنزين. يُلقي الدّلوَ في الدمعِ ليستخرج منه الخيالَ والكبريت والنهود. ومثلما نفعل أثناء طمر جثة الحزن في الثلاجة/ نُطارد الخوف بالكلاب، الضوءُ في نهاية النفق خفّاشٌ بثياب ريبة/ والرصاصُ يندفع لاستكمال رومانسيته في الجثة... يا لمتعة الخَرَفِ في الوحدة: النوافذُ تقع من الوجوهِ/ والزجاجُ يختلط بالأحلام بين شقوق النوم/ السماءُ ورقةٌ ستسقط ذات يوم/ والقتيلُ في كل مكانٍ يحاول سحب جثته من النسيان؛ ليُشير بإصبعه نحو الريش المتساقط من القمر. يستحقُّ النباحُ أن يدوّنَ كحنفيّةٍ ساخطة في وجه الرمل/ وإذا ما تساقطت الأرواحُ كالثلج بعيدا عن منازلها/ كسرَ في صدره السلالم ليذهب غريقا في الموسيقى. العاشقُ: ثيرانٌ تتمرّن، سمكةٌ في تجريب الذّوبان.. كانت وحدته في جسده/ تجلسُ خاملةً إلى طاولةٍ مرسومة بالفحم/ والكأسُ رصاصة يُطلقها على روحه/ ليرقد نائما كَـ باصٍ تعطّل ما بين الغيوم. ينظرُ النومُ إلى صورته البالية في المرآة/ الزجاج لا يعكسُ نفسَه/ يأكل المنومات فقط/ تاركًا قناني الأحلام تثرثر على السرير دون هوادة. الوقتُ: قنّينةٌ فارغة في نهاية قبر، وردٌ يتشرّد بعيدا عن ذكرياته في مدافن الجليد، والموتُ ليس غير زورق يمشي بطاقة السحاب. أنظرُ إلى: حصاني الميت تحت زجاج ساعتي، الفأسِ التي تنزل عميقا في كعكة الميلاد. يتعذَّرُ أن تتنفسَ الحريةُ برئة فأس/ غير أن تهيم كالزرافات في مجرى الحطام المُلتقَطِ من ساعة اليد، يحدثُ ذلك بجرأةِ مرآةٍ تحفظ بصمات العابرين؛ فقد أكلتْ حكمتي الثعالبُ في الدّجاج!. كحبّات زيتون سوداء/ تساقطت منه دموعه في مُنتهى العُزلة/ أرهقَ نفسَه طويلا/ ثم أكلَ الرسّامُ الزهورَ في اللوحة"
* مادة الكولاج الإبداعية مُقتطفات من ديوان الشاعر أسعد الجبوري- الأخير (على وشك الأسبرين).
تأصيل نظري
الكتابة الايروسية مأخوذة من الإله الإغريقي ( أيروس) وهو اله الرغبة والحب والخصوبة . أما اللفظة الانكليزية المشتقة من ( أيروس ) فهي ايروتك وتعني المثير للشهوة . ثمة فارق بين كلمتي ايروسية وايروتيكية ’ فالايروسية هي التعمق في إظهار المشاعر من دون التطرق إلى العملية الجنسية ’ أما حين يتطرق الكاتب إلى العملية الجنسية فأن كتابته تعد كتابة ايروتيكية . وحين يندفع الكاتب إلى ابعد من ذلك ’ أي إلى المستوى الاباحي فتعد كتابته كتابة بورنوغرافية . وكلمة ( بورنوغرافيا ) متكونة من شقين هما : بورن ومعناها البغي وغرافيا ومعناها الكتابة . ولعل الأدباء العرب لم يخوضوا هذا الميدان بسبب من العادات والتقاليد التي تحكمهم وتمنعهم من التصدي لهكذا موضوعات إلا إن البعض قد خاض غمار التجربة دون الالتفات إلى حسابات الربح أو الخسارة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الروائية السورية سلوى النعيمي في روايتها ( برهان العسل ) والشاعرة اللبنانية جمانة حداد التي أصدرت مجلة جسد والشاعر العراقي حسين مردان . إذن الاشتغال على ثيمة الجسد الأنثوي ليست جديدة على الأدب العربي بوجه خاص والعالمي بوجه عام إلا إن الجدة هي في مسلك التناول وطريقة التعامل مع جسد المرأة .
الدخول الى القصائد
في قصائده العشر استطاع اسعد الجبوري أن يحشر جسد المرأة داخل معصرة الوعي لتكون منتجاته مرتدية حلة جديدة في مضامينها . ولم يمنع هذا كله الشاعر من معانقة ذلك الجسد بنحو جمالي ’ إذ إنه لم يدع ذاته تتمركز تمركزا لا مفر منه بل حاول أن يستنطق ذلك الجسد بتوصيفات لا تخلو من الدلالة الجسدية ’ بمعنى انه يجتهد في دفع الجسد للكلام نيابة عنه’ أي إن يكون الكاشف أو على حد قول (جيل دولوز ) الجسد هو ( الكاشف الذي يختفي فيما يكتشفه ) ’ هذا البعد التركيبي المتداخل يستفز الآخر لهذا يحاول الآخر ألذكوري أن يدخل من بوابة الجسد ’ وحين تستقر به الأمور يلعب لعبته لكي يستفز تضاريس ذلك الجسد بواسطة مجساته وما تراكم لديه من الخبرة . إذن عملية تعرية الجسد في داخل النص ما هي ( إلا تعرية الآخر ) بكل محمولاته . يقدم لنا المقطع الأول بعدا غريزيا بيد أنه مقموع ومنفصل عن الجسد ’ إنه يبحث عن فريسته وهو على دارية إن هذه الفريسة ليست سهلة المنال ’ لهذا يقدم مجموعة من القرابين إمامها قبل أن يصل غاياته لترويض جسد الذات قبل جسد الآخر . إن هذه الرؤية الباطنية لما يعتلج في الذات من تراكمات عاطفية أدى إلى طاقة تراكمية لا يمكن حبسها فهي كالنار في الهشيم . الذات الناطقة – هنا - محروقة لأن الاشتهاء متحقق قبل حصوله بمعنى إن الجسد غائب هنا والعاطفة الشهوانية تلعب على الجسد بالغواية
حيواني يا غرامي
ستأكل نارا قبل جسدي
إن زمن الجسد مضمحل في ذلك الوله الحارق الذي يحاول الانفلات من سلطة الشعور إلى سلطة اللاشعور المملوء بغواية الرغبة الجائعة التي تحاول التهام كل شيء . في القصيدة الثانية يصور الشاعر ذلك الاستيحاش الحاصل بسبب البعد ما بين الجسدين ’ جسد الأنا الهائجة والجسد المشتهى عبر مجموعة من الأشياء الحسية التي تؤطر مشهد الالتحام إذ إن الجسد يمثل الحاضنة المادية للذات . ونلاحظ أيضا تسخير الشاعر للبعد السينمي بواسطة كاميرته ( العين ) المستندة في إخراج المشهد عبر تقنية متكونة من : كاميرا \العين + ذكريات \فلاش باك ’ انه يداخل الشعر مع الفنون الأخرى التي تصور الجسد وتجسد كل طوية فيه . فعملية البعد عن الآخر هي القشة التي تقصم ظهر البعير لأنها تؤجج تلك النيران الزرقاء المستعرة في الداخل . في القصيدة الثالثة يكون الجسد في حالة مشهدية \طقسية ينفضح فيها المستور ’ إنها لحظة الانفلات بواسطة التعري الكاشف عما هو مستور ’ ولعل كشف ذلك المستور يشيع في الآخر اطمأنا وهجوعا فـ ( الوضع الأكثر ايروسية في جسد ما ’ هو حيث ينفرج اللباس ) بحسب بارث . هنا نلاحظ إن كشف المستور هو الوسيلة الوحيدة للتحكم في ردود الأفعال وكأن الجسد العاري هو الفردوس المشتهى لتحقق الوحي الضائع من دونه لا يحصل شيء
ما دمنا من العراة
أيها الثمل
سأتلو عليك قصائدي حتى تذوب البومة
أو يمحي كتابي
إذن الجسد هنا ليس مشروعا فيزياويا بل هو الملهم الوحيد وهو الذي يمنح الآخر \ المغاير إيحاءات ناضجة وطرية . في القصيدة الرابعة يمارس الجسد لعبة التفكيك ’ انه يترك أمكنته الأثيرة ليحلق بعيدا خارج رؤيته ورؤاه حيال جسد الآخر الذي يمنحه فردوسا حسيا بواسطة اللذة المتحققة في مكتنزاته
الليلة قنص بين طبقات اللحم
العاصفة
انه يكور كونه الشعري بما يتخيله من اللحم المكتنز ’ يضع زمنه داخل زمن جسد الأنثى وهذا الزمن لا يتحقق إلا بواسطة الغواية المرعية من مجموعة من الاكتظاظات الهائجة القوية \ الحراس \ الموانع غير المصرح بها والمقموعة بوعي إلا إنها متحركة بإرادة محرضة
أنا على ظهرك يا حبي
بأجنتي وأجنحتي وطاقم
الحراس
هذه هي الجهات الساندة في عملية الهجوم التي يسخرها السارد في تحصيل مبتغاه . يلعب التشفير الدلالي لعبة ذكية إذ انه يمحو المسافات بين المتخيل والمحسوس , بمعنى إن الدلالات ذات إزاحة أفقية ’ فهي تتبعثر لتلتحم ثانية في البؤرة الرئيسة . النصوص العشرة مروية عن طريق راو عليم ’ يعلم ما يقول ويفعل وان بدت الأشياء محلقة في عالم الخيال بيد إنها متاخمة للحدث ومخالفة آلية الزمن ’ فهي تحاول تجسيد أو استنطاق الجسد ومكوناته عبر عملية إضمار الطقس ليتشكل الحلم من الوجود الواعي الذي تعكسه مآلات الآخر كحالة عامة وليست خاصة ’ بمعنى إن العملية عملية معالجة وردم هوة واستحقاق أنساني . إن هذا القرار تمرد على الموروث \ صندوق العادات اليومية \ الذي يكبل فعل المرأة باتجاه التمدد على مساحة أوسع من الفعل الإنساني ’ لهذا يتخذ السارد من الفضاءات المفتوحة مكانا له \ الطير , السماوات \ . ويلعب الفضاء الدلالي دوره في هذه القصائد بواسطة الجملتين الأخيرتين \ حضن الزئير \ مع السيف نلعب \ وهما منتجان حسيان ’ فالزئير يمثل القوة والعنف وما يوازيه هو عملية اللعب مع السيف الذي بحدوده قد تنتهي الحياة . هذه القسوة متأتية من عملية الخلاص التي تمارسها الأنثى في أحضان الرجل الذي ينظر إليها بمنظار الوجود الأصعب الذي لا يمكن السيطرة عليه بالوسائل الاعتيادية لجسد الأنثى المشتهى لا يتحصل بالطقوس المستهلكة فهي بحاجة إلى مفترس قادر على تحطيم الجسد قبل تحطيم التابوات . انه نوع خاص من الإخصاب الروحي الذي يتجاوز احتمالاتها المتداولة إلى مناف سحيقة زاخرة بما هو حيوي لكنها متهالكة في صياغة عالمها بنحو غرائبي بواسطة مجموعة من الاستحواذات المستوعبة لرغبات الرجل عندما تذوب المسافات ويتحول الجسدان إلى مجموعة تشكلات آدمية تبحث عما يطفئ ظمأها الأبدي . في القصيدة السابعة يتصاعد الفعل الأنثوي باتجاه موازنة المعادلة ’ فالسارد يخرج من دائرة المد ألذكوري ليضفي على الأنوثة شراستها وبحثها عن شبق يطفئ تلك النيران الزرقاء المشتعلة في شرايينها
تريده من الضواري
لا من سلالة القناع
إنها ماسوشية المكبوت الذي يبحث عن اللذة بنحو غير سوي ’ انه كشف لجوانية الشعور المكبوت الباحث عمن يمزقه ’ هذا البحث الشره هو – في حقيقته – محاولة إسكات الشعور الداخلي الذي يطاول عنان السماء والذي يحرق كل ما هو اخضر من اجل أن يستكين وهذا لا يتحقق إلا من خلال قوة ضارية تمزق كل ما هو أمامها . هذه اللغة الانفعالية ترفض – في الوقت نفسه أن تبقى الأنثى في المكان الدوني أو المقام الثاني ’ إنها تبحث عن منازلة شريفة تملؤها الرفعة في مقارعة الآخر ’ بمعنى بحثها عن المنازلة أكثر مما تبحث عن الممارسة . في المقطع الثامن تتغير اللغة باتجاه إحلال البدائل والدخول إلى منطقة الطراوة والرقة الأنثوية
كأنها الريم في تيه
وخلفها شمس لملامسة
أثير يتشكل من مرايا اللحوم
إن الطاقة التصويرية المبنية على البعد التشكيلي عالية جدا ’ فالسطور آنفا عبارة عن لوحة مرسومة بريشة فنان مبدع ’ هي لغة أخرى داخل اللغة . فتوصيف الأنثى بالريم يشير إلى الاحتراس الشديد لهذا الحيوان في كل سكناته وحركاته والشمس أية الكشف عن المخبوء والمستور وان تشكل من تلك القطع المتراصة التي تكوَن ذلك الجسد المكتنز الذي يثير حفيظة الأخر المتلهف للوقوع في الخطيئة من اجل اكتشاف المعرفة ’ معرفة ما يخبئ الجسد بين طياته . في المقطوعة الأخيرة يشرأب سؤال المريد عن جوهر القضية المتوزع بين العرش الذي يمثل السلطة والتسلط وبين السفينة \ الحاضنة المبحرة في عباب بحر متلاطم من العادات والتقاليد . إن هذين العنصرين بينهما طقوس متخالفة لكنهما يكرسان الوقت والأسلحة المستعملة من اجل سلطة متحركة وغير متوقفة عند حدود ’ إنها – هنا – السلطة التي تتكسر عند بوابتها كل خداعات الرجل وهي أيضا المنقذ من الأوحال العالقة في مياه الآخر والتي تعيق أو تحاول أن توقف هذا الإبحار الروحي الذي تتكسر عنده موجات الانتظار في داخل الرجل من اجل الوصول إلى المبتغى . لقد استطاع الجبوري اسعد أن يحفر مجراه بخطاب ينكشف على جوانيات الطقوس السرية وأوهام النفس في صحوها وأحلامها بلغة تشكيلية وفائض رؤية حيال اخطر واعقد مشكلة تواجهها البشرية منذ الخطيئة الأولى التي ما زال ناقوسها يرن في النفوس من اجل احتياج أنساني أو اجتياح شهواني.
1
أهو عرشٌ أم سفينة تحاولُ الإقلاع
بجسدٍ من مخاطبات الوردِ
فيما المنشغلُ بالتأمل يزدادُ شغفاً
بأنين البئر
2
كأنها الريم ُ في تيهٍ
وخلفها شمسٌ لملامسةِ
أثيرٍ يتشكلُ من مرايا اللحوم
3
الثمرةُ محمولةٌ
ونمرٌ يحاولُ سدّ فراغِ سيدهِ
في رحمٍ
مَهجورٍ في كتابِ الأساطير
4
تريدهُ من الضواري
لا من سلالة القناع
هي المنغمسةُ بالرسم تشريحاً
لآلامٍ تلتهبُ في الأعماق
5
يبحثُ جلجامشُ عن خلودٍ لها في الغابةِ
الزرقاء
فيما هي في حضنِ الزئير
مع السيف تلعبُ
6
تحاولُ الفرارَ من سجنها
فيأتيها الطيرُ بالأكسجين هائماً
وهنا السمواتُ فنادقٌ لأسلحة
الجمال
7
أنا على ظهركَ يا حبّي
بأجنتي وأجنحتي وطاقمِ
الحُراس
فالليلة قَنْصٌ بين طبقاتِ اللُحومِ
العاصفة
8
وما دمنا من العراة
أيها الثملُ
سأتلو عليكَ قصائدي حتى تذوبَ البومةُ
أو يُمحى كتابي
9
كلما ابتعدتَ عني خطوةً
رأيتني على وسادتي
أو في كأسٍ تملؤهُ العينُ
بنبيذٍ مُستخلصٍ من الذكريات
اعتقد بصعوبة الكتابة النقدية حول أي عمل أدبي من خلال مقالة ذات مشهدية لا تتجاوز صفحاتها الأربع أو الخمس، خاصة حول مسائل الأدب الحديث.
وتتفاقم تلك الصعوبة ،حين يكون الهدف الذي تتجه النية للحفر والتقصي في بناءات نصوصه، قصة كانت أم شعرا أو غيرهما .
مبدع مثل اسعد الجبوري يحلق في فضاء الخلق بجناحي الشعر أو الرواية، وربما جاوز ذلك المنحى، لكي يجعل من الكتابة عموما مدونة خالصة لوجه الإبداع ،تنأى عن خصاصة التجنيس وتنشد الخلاص من قيود التوصيف، وهذا مشغل ثالث يستخدمه الجبوري ،لتأكيد التصاقه بخصائص الديناميك وتبنيه لمذاهب الحداثة على اختلاف مشاربها .
لنأخذ عينة من تلك الاختراقات الإبداعية التي لا تنتمي لغير الكتابة مهادا وموطنا، والتي لا يقبلها النص الشعري وحدة إبداعية شعرية خالصة في معمار بنيانه الفني ،غير أن فيها من الشعر ما يغري المصنف والدارس لضمها إلى هذا الضرب من الفنون، ولا أجناس الرواية أو القص أو النقد الأدبي تضيفها في فراديسها النمطية ،بينما هي قابلة للتطوير، لتشتبك مع تلك الأجناس الأدبية الراسخة بجدارة، لكي تتبلور لو أراد لها الجبوري ذلك المذهب، لتتحول إلى ما يشاء من أطياف المدونات .
والعينة التي مر ذكرها في غير هذا المكان .
فالانطولوجيا التي نشرها موقع جهة الشعر لأسعد الجبوري، وهي عينة وقع الاختيار عليها كونها تجمع شتات الفنون الإبداعية الأدبية تحت سماء الكتابة / المدونة، كما إنها تشكل وسطا رخوا يسمح لتلك الأجناس المتناظرة بالتزاور والتنافذ والتماهي، لتتوالد عنها صورة بديعة من صور الجمال الذي انسل من إيقونة الشعر وترعرع في متون السرد وتهذب في أكاديميات النقد الصارمة ،وهذا الأمر لا يتم إلا لذوي مكنة في سبل المعرفة والثقافة والخبرة.
ولندخل إلى مدونة الجبوري التي تفيد بما يأتي:
(( يوم الشعر هو يوم القيامة .......... هنا.. لا نقصد القيامة الأخرى، بقدر ما نعني قيامة الكلمات في المعاني. قيامة البصري في المخيلة على مدار ساعات اليوم الواحد. فنحن نعتبر اليوم مكاناً لقيامة ))
جاءت العتبة الأولى للنموذج المختار هكذا ( يوم الشعر ، هو يوم القيامة )
من هنا يشعل الناص الجبوري اسعد فتيل التساؤل فينا منذ البداية الأولى لثريا النص ويثير لدى متلقيه غريزة الفضول وقلق الاستفهام، فالعنونة تشتبك مع النقدي والشعري والسردي وهي (حــمـّـالة أوجه ) تقدم لنا زمنا مجردا محدودا ( يوم ) لكنه يوم استثنائي يشط ُّ عن محدوديته لأنه يرتبط بالشعر أولا ،وهو قيمة جمالية عمادها المخيال البشري الخلاق اللامحدود ( يوم الشعر ) .وهذا زمن غير مألوف فقد يكون لحظة وضعية نستطيع مسائلتها وحصرها بظهور الشمس وزوالها، وربما يكون توقيتا لغويا كونيا يتعالق مع نوايا الناص المتجهة لخلخلة الفضاء النصي الذي يرتكز على محصلتي الزمان والمكان المستقرتين أبدا ، وهي محاولة جديرة بالبحث والمتابعة والتحليل ، وتكشف لنا خبرية الجملة اللاحقة ( هو يوم القيامة ) إن الزمن الذي أسس له الجبوري زمن ما ورائي مفتوح ينبثق عن هيبة الأسطوري المقدس ( يوم القيامة ) وهذا الإجراء تبجيل وتوقير لمكانة الشعر ويومه الزمني الذي اختاره له ،حين وضعه محاذيا لمنزلة قيامة الكائن .ويتكرر فيما يلي السطر الشعري الأول تكرارا يفيد الإيقاع والتوكيد لغرض أن تحتفظ المدونة بمناخها الملحمي على غرار التكرارات في قصة الخليقة وملحمة كلكامش والكتاب المقدس.
ولكي لا ينفرط عقدها وتهبط الى سياقات الإنشاء والشروحات الفجة ولنستأنف القراءة:
(( هنا.. لا نقصد القيامة الأخرى، بقدر ما نعني قيامة الكلمات في المعاني. قيامة البصري في المخيلة على مدار ساعات اليوم الواحد. فنحن نعتبر اليوم مكاناً لقيامة الأحياء في أبدية زمنٍ، ما زال محمولاً على متون شعراء الضوء، ممن
تلخصهم صور أعمدة الكهرباء على طول الفضاء وعرض الأفق. شعراء يضخون التنوير في عروق الأرض، لتشتعل مخلوقاتها بحمى التحديث، من أجل التجمل بالطيران هدفاً لبلاغة الارتفاع. ومنعاً للابتذال فيما يخص الإقامة الجبرية في كهوف الواقع الاستعماري للتعبير المُستَبد. ))
نلحظ هنا تداخل السرد الذي يتواضع عن مكانته كجنس أدبي راسخ ليخدم المساحة الشعرية التي تتخفى تحت ظلال السرود ..
فلا سيادة لجنس أدبي على آخر إلا من خلال هندسة المدونة وما تسمح به المخيلة الخلاقة من تفضيل جنس على آخر ، أحيانا خدمة لمقصديات تلك المدونة وخصائصها الفنية والجمالية دون السماح لآفــة الاستطراد بالغلو والاستشراء، والتي غالبا ما تؤثر سلبا على بنيه العمل الإبداعي.
ويقدم لنا الجبوري من خلال ما مر ذكره صورة بديعة من صور ( الكتابة ) في المقطع الثامن ينفتح الخطاب المتعارف عليه في الانطلوجيات قليلا ويتخلى الناص عن تطرفه في تجيير النص لصالح المدونة إلى بيان رأيه بطائفة من النصوص والشعراء وتظهر للعيان ملامح الخطاب النقدي المقنع باللغة الشعرية والانزياحات العالية مع احتفاظه بالخطاب النخبوي ( التدويني ) الذي يسعى الى ترسيخه والعبور به الى مثابات بعيدة (عابرة للقارات ) وهو ما جاء في معرض النص ، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه غير مرة من أن الجبوري غالبا ما ينزع الى جمع الأجناس الأدبية في مختبره الإبداعي ليخلص الى فضاء جديد من فضاءات التجريب والتجديد الهادفة الى خدمة العملية الإبداعية وتلك خصيصة امتازت بها الكثير من أعماله، ومنذ وقت ليس بالقصير، وان كانت ضمن خريطة فطرته الجينية غير المقصودة في ستراتيجيات مشروعه الكبير، لكنها تبقى إيقونات واخزة في الحدائق الخلفية لمخيلة الجبوري.
ورب معترض على زعمنا هذا يلقي علينا حجته بان هذا السبيل لهو من السبل التي خاطر بها الكثير من أهل الأدب والإبداع، فنقول نعم هناك الكثير من فرسان التجديد،غير أن لكل زمان ظواهره وطرائقه للبحث والتقصي عن الصورة الأكثر دهشة والتي تتناغم مع ذائقة ذلك العصر ، ولنذهب الى المقطعين الثامن والتاسع من انطولوجيا الجبوري ،ونتابع نبض كتابته ، المقطع الثامن:
( في هذا النص الكوني.. تتابع المخيلات ألعابها النارية على سطح الكون. في فضاء السموّ لا الكهف. فتتداخل الأسماء بعضها في البعض الآخر، من خلال مياه المجرى ونوره وبخار كآبته. قدرات خلاقة تتجانس في كتابة نص عابر للقارات يؤلفه 111 كائناً شيطلائيكياً من شعراء العالم.ويمكن أن نكون بهذا العمل قد قمنا بضرب المعادلة الشعرية القائمة، ما بين الشرق والغرب. ما بين الأبطال التاريخيين من رموز الشعر العالمي وما بين ما يسمى بالكومبارس. )
ونأتي الى المقطع التاسع :
( في هذا النص الطويل الذي عملنا على تحرير منتخباته بطريقة صهر المقاطع عبر رائحة الكلمات، تتضح صورة الشاعر العربي وقيمته الكبرى، لتثبت في الكثير من الأحايين أنها أفضل من النص الغربي بالشكل وبالمضمون. وهذا النص الإمبراطوري الذي ضم 125 من شعراء العالم، هو برهان نثبته اليوم بالدليل القاطع . الكل هنا شريك بالإشراق والتجلي. بالقضاء على مخلفات بكتريا السلف القائم على تقديس الصنم وتطوير أمكنته ) إن الشعر هو المعالجة التي تقترب من حافات المثال لإشكالية الموت والحياة وانتصار الجمال على القبح ( كلكامش مثالا ) أما السرد فهو العوالم والأزمان والأمكنة المنتظمة التي توفر فسحة تأملية لتمثيل جرعة الشعر في حياتنا المتوترة ( مئة عام من العزلة لماركيز ورواية مأتم لطه الشبيب نموذجين للمعاينة ) في الوقت الذي تنشغل فيه حساسية النقد في استشراف تينك الإيقونتين وتحليل الشفرات والبؤر العاملة ومستويات السرد وغيرها من شروط النص الأدبي.
أما الكتابة / المدونة فهي الجنس الشمولي الذي يجيب على تلك التقاطعات والتابوات الوهمية التي تخندقت ورائها تلك الأجناس الأدبية المتزمتة ولعل انطولوجيا الجبوري التي مر ذكرها آنفا واحدة من الإجابات الحيوية التي تجسر تصلب الحاضر أمام حاجة المستقبل.
هامش :
تناول الشاعر علي الاسكندري المقدمة التي كتبها الشاعر أسعد الجبوري لقصيدة الإمبراطور التي اشترك بكتابتها شعراء من العالم.هنا نص المقدمة:
قصيدة الإمبراطور
هنا.. لا نقصد القيامة الأخرى، بقدر ما نعني قيامة الكلمات في المعاني. قيامة البصري في المخيلة
على مدار ساعات اليوم الواحد. فنحن نعتبر اليوم مكاناً لقيامة الأحياء في
أبدية زمنٍ، ما زال محمولاً على متون شعراء الضوء، ممن تلخصهم صور أعمدة
الكهرباء على طول الفضاء وعرض الأفق. شعراء يضخون التنوير في عروق الأرض،
لتشتعل مخلوقاتها بحمى التحديث، من أجل التجمل بالطيران هدفاً لبلاغة
الارتفاع. ومنعاً للابتذال فيما يخص الإقامة الجبرية في كهوف الواقع
الاستعماري للتعبير المُستَبد.
(2)
وإذ نعتقد بأن الشعر يوم طويل بمسافة التاريخ، وعميق بأبعاد أساطيره،
ومبتكر لتقنيات العالم التكنولوجية في أعقد صورها،ودون نهاية عند خط، فإن
الشعرية، هي الدرس الأول لاستنشاق سحر الليبيدية وانقلاباتها الكثيرة ضد
الأوثان.
فالشاعر ليس إلا لقطة مشحونة على الدوام بطاقة العاطفي الحيوي التناغمي،
في مشروع سد الثغرات الفاضحة في جسد اللغة التي عادة ما يتم مصادرتها
لحساب الإقطاعيات السلفية بالقوة وبالتكفير وبالإقصاء.
(3)
الحداثة في شعر اليوم، لا تقل عن أي عمل جراحي في أصغر غرف المخ. وما من
شاعر معني بالحداثة، إلا ويستبدل الحبر بأشعة الليزر من أجل خلخلة عوالم
الكتابة واستخلاق الجوهر من سحرها الغامض. ذلك لأن الوضوح ضحالة تربك النص،
إن لم تقضي عليه أو تعدم وعيه بمنظومة كاميرات الحواس.
(4)
ليس في الشعر أهم من الكآبة.إنها بمثابة عقرب الساعة الذي يصور لنا
جزئيات عمل طاحونة الوقت الداخلي. وقتنا الذي على توقيته تنتشر الأحلام
وتتصادم الأرواح وتتماجن الشهوات كما الأرانب في البرّ الأحمر.
(5)
وعدا عن أهمية إزاحة العقل عن تربة النص الشعري وإن بنسب مبالغ فيها،
فإن أرواح الشيطلائكة تحتاج إلى الفانتازيا كتمرين يُحسن من سلوك الكلمات
ويضفي عليها الماكياج الضروري من التأويل الذي يجعل انشطار القصيدة رغبة
عنيفة تجرف الشاعر إلى أعمق نقاط الغرق في التخيل الجمالي المتوحش.
(6)
أن رؤية جيل جديد من الشعراء والشاعرات العرب، بعد انقطاع الدورة عن
الغالبية العظمى من الديناصورات الشعرية، ممن استبدوا بالشعر ودور النشر
والمكريفون والشاشة على امتداد عقود تجاوزت نصف القرن من الزمن، أصبحت
واضحة الآن، وتسيطر على المنتوج الشعري عربياً، من خلال قصيدة النثر التي
باتت تتمتع بشيزوفرينا بلاغية قادرة على تفكيك الوعي وجعل أنظمة الداخل
السرّي أكثر اضطراباً أمام العواصف المحمولة من الخارج، سواء أكان ذلك في
بناء الجملة الشعرية أو تشريح اللقطات البصرية في عمليات تكثيف الدلالات
داخل النص البحري المتلاطم.
(7)
للبرهنة على جدارة عصر من الشعر النبيذي، التكتمي، الجواني، القائم على
هلع الابتكار، أقدم اليوم القصيدة الإمبراطورية التي اشترك في كتابتها
شعراء من كل بلدان العالم. رجالاً ونساءً. شعراء قمت بإطلاق حشودهم في مجرى
واحد: مجرى المخيلة الشجاعة.
(8)
في هذا النص الكوني.. تتابع المخيلات ألعابها النارية على سطح الكون. في
فضاء السموّ لا الكهف. فتتداخل الأسماء بعضها في البعض الآخر، من خلال
مياه المجرى ونوره وبخار كآبته. قدرات خلاقة تتجانس في كتابة نص عابر
للقارات يؤلفه 111 كائناً شيطلائيكياً من شعراء العالم.ويمكن أن نكون بهذا
العمل قد قمنا بضرب المعادلة الشعرية القائمة، ما بين الشرق والغرب. ما بين
الأبطال التاريخيين من رموز الشعر العالمي وما بين ما يسمى بالكومبارس.
(9)
في هذا النص الطويل الذي عملنا على تحرير منتخباته بطريقة صهر المقاطع
عبر رائحة الكلمات، تتضح صورة الشاعر العربي وقيمته الكبرى، لتثبت في
الكثير من الأحايين أنها أفضل من النص الغربي بالشكل وبالمضمون. وهذا النص
الإمبراطوري الذي ضم 125 من شعراء العالم، هو برهان نثبته اليوم بالدليل
القاطع.
الكل هنا شريك بالإشراق والتجلي. بالقضاء على مخلفات بكتريا السلف
القائم على تقديس الصنم وتطوير أمكنته.
(10)
سيكون النشيدُ لأرضٍ أخرى.
عطرها
نهرٌ بلا غلاف.
نحن سكارى
المخطوطات
وبأجنحةٍ
تنتشرُ السيوفُ بين خطواتها.
1. تجربة قلقة:
منذ أن تعرّفتُ على نصوص أسعد الجبوري (1951- )، قبل نحو عقْدٍ من الزمن، وأنا أدرك حجم المغامرة التي ينصرف إليها، بلا طمأنينة، هذا الشاعر العراقي. إنّهُ يقيم هناك، في التُّخوم، بلا سببٍ وجيه يُذْكر سوى وَسْم زمنيّته الخاصة بأسلوبه هو؛ لكن، في عمل مخيِّلته ولواحقها، لا هُويّة محدّدة لكتابته التي تقف على طرف نقيض من تلك الكتابات التي تعيّشت على مضمار التأثيرات السياسية والاجتماعية المباشرة كما حصل لجيلين من شعراء بلده، في مجرى طواحين الحرب وأزيزها الذي روّع الشعراء، وجعل ما يقولونه من شعرٍ ونحوه عصفاً مأكولاً على مائدة آلام العراق. وهو إذ يسعى بكتابته، إنّما كان يسعى إلى العمل على أن يُنْهض طاقات تعبير جديدة في لغة الشعر، وأن يعالج شعراً متحرراً من نسق الذهنية، ومن لغة الذعر بلغة لا مرجع لها، أو من الغبار الإيديولوجي كما يُؤْثر أن يسمّيه. يقول أسعد: "وإذا كان لا بُدّ من الحديث عن تجربتي الشخصية التي قد تكون غائمة لدى البعض، فهي تبدأ من نقطة واحدة هي أنني مررتُ بمنازل الشعراء وأكملتُ هروبي من الجميع دون التفكير بالسكن في دار، أو الاستقرار داخل أية علبة من غرفهم". بمعنى إنّه يرفض أن يرهن شعره بمدرسة فنية يُقيم فيها، أو يُحيله على مرجعية شعرية تُصيِّره مادة للاستهلاك السريع. تاريخٌ من رفْضٍ لتسمية ما، ومن جوعٍ إلى ما لا يَنْقال في الشِّعر وعبره. نقرأ هذا التاريخ ابتداءً من أواسط السبعينيّات، أي منذ أن خرج الشاعر من العراق ووجد نفسه في غمار الحركة الشعرية العربية الجديدة بآفاقها المختلفة في دمشق وبيروت، متعرِّفاً على شعراء الحداثة من رموز قصيدة النثر. وهو إذ يريد أن يسم توقيعه الخاصّ ويبذره في مجرى الشعر كما يتطلّع إليه، فإنّه اكتشف في قصيدة النثر آنذاك مغناطيسية خاصة رأى فيها حريّته المفقودة، فجذبت حواسّه إليها، وحرّكت في لاوعيه ماء أعماق عمره السحيقة، وقدحت في مخيّلته "بنكاً" من الصور والأخيلة الطائرة لا ينضب في أفق المستقبل. وهكذا ارتضى تلك القصيدة خياراً فنّياً وأسلوبيّاً عكسته كتبه الشعرية الأولى بغرابة عناوينها، التي خيّبت أفق الانتظار النقدي واستُقبلت بخليط من الدهشة والاستغراب والرفض، ابتداءً من "ذبحت الوردة. . هل ذبحت الحلم"، الصادر عام 1977م، و"صخب طيور مشاكسة" عام 1978، ومروراً بـ "نسخة الذهب الأولى" 1988، و"الإمبراطور" 1995، و"العطر يقطع المخطوط" 2003، و"قاموس العاشقين: 1000 رسالة SMS " 2006، وانتهاءً ب"على وشك الأسبرين" 2011.
وكأيّ تجربة شعرية قلقة، نشعر بأنفسنا في خضمّ عالم لجيٍّ من الحيرة تجاه كتابةٍ أكثر حيرة ولا تعرف ما تصنع بنا، إلّا أننا نشغف بها بقدر ما أنّها تعنينا بحساسيّتها وملفوظاتها الخبيئة، حتى وهي في شتاء مهجرها الإسكندنافي، لأنّها تتمتع بقدر هائل من الحيرة العربية، ومن بلاغة الموهبة العربية التي لا تخلو من عفو الخاطر وافتتان اللحظة والحيدة حيناً، ومن الكدر والهذيان والجموح حيناً آخر.
2. سورياليٌّ قبل أوانه:
في العصر الذي ظهر فيه الشاعر أسعد الجبوري من سبعينيّات القرن الفائت، لم تكن الذائقة الفنّية وروح العصر نفسه يرحّبان بمثل كتابته، فقد ضاعت صورٌ وحيواتٌ وكشوفاتٌ في الهامش، ولم تلْقَ حظوة النقد الأكاديمي الذي كان بيانيّاً ومتصلّباً وغير متسامح في أكثره مع الجديد والطليعي، ولا حتى مع الحديث نفسه: جورج حنين، جويس منصور، علي الناصر، عبد القادر الجنابي، عبدالله زريقة وسواهم؛ أي مع من اعتُبروا سورياليّين تحديداً. بدا أسعد الجبوري، من خلال عناوين كتبه وعفويّة جمله وملفوظاته الصادمة وانفراط صوره وشكل تمثُّلاته للعالم وطبائع مخلوقاته النافرة، سورياليّاً قبل أوانه، غير منصرف إلّا إلى حريّته وذاته بوصفها يوتوبيا، يحفزه خياله الثرّ على ارتياد مناطق غير معهودة في خارطة الشعر العربي. يقول أسعد ثانية: "أنا كسوريالي أو غير سوريالي معنيٌّ بالمدى الذي توفره لي اللغة لأصنع منها طيراً خارج القفص، أو سمكة بعيدة عن الاكواريوم وذكرياته السوداء. السوريالية الغربية سهمُ في هواء النص، وهي في النص العربي عربة بعجلات ما تزال مربعة أو مثلثة".
إنّ السوريالية ـ كما فهمها الشاعر نفسه ـ ليست مدرسة انتهت بزوال أسبابها وموت روّادها وانطفاء بياناتها المدوّية، بل هي استراتيجية داخل الكتابة التي تحرّره من الالتزام بمعناه النمطي، وتبدو كما لو أنّها بدون سقف، وهو ما يجعل إقامته في قصيدة النثر كخيارٍ جماليٍّ وفكريٍّ إقامةً على حوافّ الخطر؛ وهل لشاعر وجده نفسه في الشتات الشعري داخل قصيدة النثر مخفوراً بمخلوقاته الغريبة والحيويّة، وبلا برامج معهودة، ألّا أن يلوذ بالرّيح في مهبّ أسئلة لم تحتمل تلك الصيغ التي طُرِحت بها، ولا المقولات التي سيقَتْ بها.
3. الإقامة الخطرة:
بين قصيدة النثر كخيارٍ فنّي، والسوريالية كإستراتيجية في الكتابة يُقيم مشروع أسعد الجبوري ليس في تحديث الشعر العربي فحسب، بل في الرقيّ بذائقته الجمالية، وتحرير معناه ومخيِّلته من "الدوكسا"؛ وهو المشروع الذي نجده يختطُّ مجراه في ثباتٍ ووعيٍ بمنأى عن "ماكينة" التشويش التي تُواجَه بها مثل هذه المشاريع التي يبدعها العقل العربي في فضاءات الكتابة شعرها ونثرها. وإذا كان أغلب شعرائنا ممّن كتبوا قصيدة النثر، فإنّما تعاطوا مع أدواتها في اللغة والبناء والتصوُّر بذهنيّات قديمة، مطمئنّة ومتردّدة، فيما يقترح أسعد الجبوري في إقامته داخل قصيدة النثر معماريّةً خاصّةً به، ومُفارقة لغيره بمعانٍ شتَّى. وهكذا، بدلاً من أن نضع قصيدة أسعد بجوار القصائد الأخرى كـ"مومياءات" في المتحف الذي لم يعد يرتاده أحد ولا ورثة له، يجدر أن نحتفي بها، لأنّها تريد أن تكون نفسها بلا إجماع كاذب، وأن تختطّ مسارها الغرائبي الذي يشبهنا في عصر لم يكن لنا، ولا وافقته روحنا. من هنا، وبسبب من تهمة "الغموض وعسر الهضم" التي تُرفع في وجهها، نحاول أن نُقدّم بعض الآليّات، من ضمن أخرى، نراها متداخلة ومترتّبة على بعضها الآخر وممكنةً لتلقّي الكتابة عند أسعد الجبوري، وقد استفَدْناها من البيانات التي يُطلقها الشاعر في كلّ مفترق طرق. أهمّ هذه الآليات لتلقّي شعر أسعد، في نظري، هي:
أ ـ الرؤية إلى العمل الشعري ليس باعتباره نظاماً، بقدر ما هو فعل كيميائي يتأتّى من "شراكة أبدية" ما بين كائنات الخارج بأبعادها الأنطولوجية وبين الباطن الضاجّ بودائع وأيقونات وتعاويذ في تاريخٍ مُوغلٍ ومهموم؛ وداخل هذا العمل تشعر بذات الشاعر ليس كفاعلٍ للخطاب فحسب، بل هي أشبه بعرّافة خارجة للتوّ من أتون السحر والخرافة، ولكنّها لا تدّعي نبوءة. عبر هذا البعد الكيميائي تكون للشّعر روائحه ووظيفته الغائية في اللغة التي تنقل الملفوظ الشعري من الذهنيّة إلى المحسوسيّة، وهو ما يفسح للتجربة المعيش واليومي مجالاً حيويّاً ( الإيروتيكا، تحديداً) لتطلق الكلمات في فضاء الرؤية وأسرار لعبة الخلق.
ب ـ الانزياح عن نسق البلاغة التقليدية بما يفيد تدمير الصيغ والعلاقات وهدم القوالب الشعرية المتداولة، وإحلال بلاغة توليديّة تنشأ من صيرورة العمل الدلالي، ممّا يجعل لغة الكتابة تلوذ ببلاغة شائكة وعصية على الفهم، إلّا أنها الرئة التي تتنفس بها الكلمات، فتقدر على إنتاج المعنى عبر علاقات حركته الداخلية التي تختطّ مسار إنتاجها في غفلةٍ عن ذات الشاعر نفسه، وصولاً إلى اللذّة التي تُجسِّدها عملية التأليف.
ج ـ رجّ الذائقة الفنية للشعر من داخل اللغة نفسها، مواجِهاً لبنية استقبال لقارئ الذي لا يزال يتعايش مع ذهنيّة التلقي السائد ومأخوذاً بتمثيلات اللغة النفسية ومُقدّسها ومحدودية مجازها، وهو ما يوقظ في ذهن القارئ ووجدانه بمدى حاجزية اللغة ويشكّكه بها ويحرّضه على الوعي بها من جديد، بلا متعاليات.
د. بعث المخيِّلة لا بوصفها خزيناً لتكرير المشترك أو مجرّد استعارات مسكوكة تتسلّى مع النظام، بل بوصفها تمريناً لغوياً ـ تصويريّاً يبثّ الحمية في طاقات اللغة ويُطلق أطراف شهوتها عبر الفضاءات المختلفة، بما يستهدف وعي الشاعر والقارئ في آن، ويخلق رؤية بديلة للأشياء والكائنات والمفردات التي لم يبق منها في حياتنا غير القليل. ذلك ما يُحرّر أوهام النفس ويُقوّي الأداء التخيُّلي لديها. ولقد فهم أسعد الشعر باعتباره "خلاصة لروح الابتكار. خلاصة اللعبة اللغوية الكبرى التي تنتجها المُخيِّلة".
هـ ـ اختلاق طاقة شعرية تعبيرية ـ رؤيويّة بديلة تمتح من الصورة والصوت، قادرة على تحويل الأصوات والرموز والإشارات إلى حقول بصريّة ممكنة وشاسعة، وذلك بموازاة مع رقمنة العمل الشعري بتصييره نصّاً رقميّاً يأخذ طريقه إلى التحول الأتوماتيكي الذي يُجنِّح مخلوقات اللغة نحو حقولها المجهولة على الدوام، بقدرما يجسر العلاقة المفقودة إلى اليوم ما بين الشاشة الشعرية وبين المشاهد المحفوز على أن يُبْصر بحواسّه أكثر ممّا يقرأ.
لمّا سُئِل الشاعر أسعد الجبوري عمّا لم يكتبه إلى الآن، بعد أكثر من عشر كتب شعريّة كانت دائماً مثار جدل، قال: "هو الشعر بذاته.. فكلما كتب الشاعر نصّاً، خرج من غيبوبة ليدخل أخرى دون أن يُدرك ما الذي يحدث له بالضبط.. لذا أحسّ بأن الشاعر القوي هو الشاعر الذي يكتب في الريح". أعتقد بأنّ مثل التوصيف، مع محاذيره، مهمٌّ للولوج إلى تجربة قلقة في الشعر عامّة، ومختبر قصيدة النثر تحديداً، يتحرّج النقاد من مقاربتها والدنوّ، وإلّا في ما تُفيدنا مثل تلك الشذرات التي يُطلقها شعراء سومر وأيتامها من بلادٍ كانت دائماً على حوافّ الخطر، مثلها مثل إقامتهم على حوافّ الشعر وآماله الخطرة التي "يسهر الخلق جرّاها ويختصم"، ولعلّ أقدمها وأصفاها في آن، شذرة المتنبي: "على قلقٍ كأنّ الريح تحتي!"
تعلمنا " أن التمسك بالوطن وخياراته ميزة كل كاتب مؤثر" كما لدي الأديب والشاعر والروائي العراقي اسعد الجبوري، المقيم في الدنمارك، المحمل بهموم الوطن والإنسان على الأرض .
نتلمس درجات إيقاعه الذي يخضع لمحولاته الثقافية، المتناسبة مع لغته الشعرية، وحواسه المنتهي برجفة الجسد وما يذهب بينهما من رؤى واستلهام .
انه شاعر من طراز فيكتور هوجو، المتفوق في أعماله الشعرية والمسرحية والروائية والخطابية .... كما استطاع الشاعر اسعد الحبوري، كباحث وكاتب، وشاعر، ومترجماً، وقارئا، أن ينجز أعمالاً إبداعية متنوعة، تكشف للمتلقي عن كينونة رؤيته الخاصة بمستقبل الإنسانية، والتي ساعدت الشاعر على صياغة الحركة الشعرية المحملة بصورة الإنسان، باعتباره قادراً على التحكم في أعمال العقل وما بداخل الفرد والجنس البشري، الذي غزاه قلم الشاعر المتحدث عن أهمية الشقاء الإنساني، وعزلة الفرد الراقي. بموهبة شاعرنا التأملية، حيث نقل للمتلقي والمتخيل والمجرد، وسائله التي تقوم على معالجة مواضيع كينونات الفرد في المجتمعات العربية والغربية، في قدسية الكلم، ليتوحد جدل الفرد بالإدراك الفلسفي المعبر عن اتجاهه الواقعي... وليبقى أدبه في طليعة الصفوف، حيث قدم للقارئ أعماله المصورة من حياة الشعوب التي مر بها، وما اتسمت به الطبيعة من خلال اطلاعه على الحقائق التاريخية، من مختلف نواحي الحياة، وتتبعه العلاقات القائمة في تاريخ الشرق والغرب، ونزعتهم المتطابقة مع الأدب العربي الحديث، مع الحفاظ على النقاط المشرقية التي أرادنا الاطلاع على تلك التواصل الأدبي، واستخدمه مجمل أدبه المهجن، القائم على وقائع الحياة، والحقائق التاريخية، من خلال معرفته للتاريخ، وتتبعه طبائع البشر وتصويره الساخر للمجتمع العربي... وحساسيته المفرطة إزاء العالم المضطرب والمبرمج .
لذا نرى من الضرورة التقرب من ثقافة هذا الشاعر، والتعرف على مخزون تجربته المكتظة بالمعرفة الشعرية، الوجودية المتوغلة في الذات، والموضوعات التي تشكل أبرز السمات الأساسية في مشهد الشعر العالمي والعربي الحديث، في إبداعات مزاجه المفروش على مائدة اللغة، ورموزه المعبرة عن موقفه من الحياة التي يرى فيها صور الإنسان المعكوسة، وكأن الشاعر يمشي على قاعدة الأديب والفيلسوف الشاعر بابلوا نيرودا، في الالتزام الاجتماعي، والدفاع عن قضايا العدل والحرية، كاشف عن الحقائق والمظالم التي تواجه الإنسانية .... في ما يشاء كلمه، المحمل بوجدانية ترصد عالم التناقضات والهزائم الاجتماعية في العالم، كشاعر متجول في القارات، يجمع من نكهتها الإبداعية، نبرته التي تترك للمبدع والقارئ إمكانية التفاعل الذاتي مع تجربته الشعرية المثيرة للاهتمام... ولعل التعرف عليها يمد المتلقي بماء الوضوء، للكشف عن مكامن النفس المعبرة عن كل المشاعر التي يعيشها الفرد .
لننظر من جديد إلى بنية أعماله المغناطيسية، ومنظوماته الأدبية المحتكة بثقافة الغرب الموصولة برنات شاعرية الشاعر الملموسة على فم قصائده المتأثرة بفلسفة "هيجل و تيوفيل وجوتيه"، اللذين كشفوا عن أبواب إحساس الفرد وعلاقته بالجمال الروحي، والقيمة النفسية، والوجودية المطلقة، وعلاقته بالزمكان وتحولاته، كما في تجربة اسعد الجبوري، ومؤثراته الثقافية اللافتة في تميز نصوصه الهلالية، وأسلوب لغته في سرد الحدث، كبؤرة مركزية منفردة في أعماله الشاملة لجميع النواحي الإبداعية والفكرية، على صعيد الوطن العربي والعالمي معاً، لثقافته المعرفية الهامة في تجربته الإبداعية المحملة بآفاق إنـسانـية واسعة، وشاعرية منصهرة في مـنظوماته "الأنثروبولوجية" وفلسفته المعمقة نسيج العربي الحضاري في أعمال الجبوري، المتميز بالصدق ودقة الوصف، وحسن الطرح، وبراعة تحليل نفسية الشخصيات في سرده الشعر وقصصه التصويري، مما جعله يصل إلى عظام شعراء الغرب قديماً وحديثاً, أمثال: الشاعر البلجيكي رودنباخ، والروسي وفرها يرن وداريو، وأخيراً في نقده الذي يشبه سخرية "مونتسكيو"، من المجتمع في رسائله الفارسية، المشيرة إلى أسطورة بمثلها الشاعر في لحظة التفاعل ....،
يبقى الخيار للكلم الذي شكل أرضيته التي انطلق منها إلى عالم الإبداع في العالمين، الذين حولوا تأثيرات عوامله الداخلية والذاتية، وظروفه الطارئة إلى مكتسبات البيئة المحيطة به، وسـط غربة مترامية الأجنحة، رغم بحثه المكثف عن كينونة مكانته اللائقة التي يستحقها الأديب والشاعر العراقي اسعد الجبوري، في أعماله الأدبية، المجابهة العقل بالقلم الذي يقوده إلى مواقف لا تغيب عن معاناة الإنسان وخارجه الميتافيزيقي، المتمثل بأعمال الشاعر "الاسكتلندي آدمس روبت"، "وجون باربر"، اللذان عالجوا قضايا الإنسان وظروفه الموضوعية، والموضوعات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، بلغة هموم المجتمع الذي ينادي بحلول المسائل الوجودية، والأخلاقية، والإنسانية، لتقترب ذاته المتعبة من ذات الأخر المنفصلة عنه، مع المحافظة على أصالته العربية، والميزات التي نلمسها في تجربته الإبداعية، وتواجده مع معظم شعراء العالم العربي والغربي، على صعيد التجربة الحياتية وانجذابه نحو الخلود ، لنرى تلك المشاعر الاستكانية الهارمونية،في نبرة الشاعر العميقة، واندفاعه العفوي في أعماله الإبداعية، إضافة إلى طلاقاته في الكوميديا الإنسانية، بما أنها أفضل الطرق لبوح الحقيقة .... في مثل هذا الإبداع الذي لا يستهان في ترسيخ ثقافته الشعرية المتمثلة في جسد مستقبل الجيل الرابع، برسائله المفتوحة على أعالمه ونضاله في عالم الشاعر المتعدد المناهج .
بين الشعر والخيال وبين الجمال وتزوقه نتعرف على مسالك تجربة الشاعر وإشاراته ورموزه وانفعالات عواطفه، ومحبته وعنفه ودماثته، لمشاركته تجربته الخارقة التي حولت موضوع الشعر إلى رمز لكل الأشياء في محاوراته المتمثلة بالسرد العربي قديما وحديثاً من جهة الفكر العربي والعالمي الذي ن جمع من خلالهم جوانبه الفلسفية وتأويلها، وآثارها في الفكر والمعرفة التي ترفع من شأنه في مجمل أعماله.
لذا نجد معظم أعمال اسعد الجبوري، تمثل فلسفة جان جاك روسو، ودينيس، وديدرو، وفولتير ... وهم من أشهر رجال الأدب في العصر الحديث، المحلق بأجنحة الإنسان في ظل ثقافة إنسانية تستطيع أن توحد التعددية الثقافة، والعقائدية، وطبائعها ...
إذا يحمل شاعرنا مشروع فكري عربي مستقل في تجربته التي أتت في سياق تطور الفكر العرب، كما صرح في قصيدة " مقاطع من مياه الكائنات المضطربة" .
10
حيواني يا غرامي
ستأكلُ ناراً قبل جسدي
فأنا لَيْلتُكَ بالليل
دون بردٍ بشهوةٍ أو دمٍ ينامُ
على سَبورةٍ