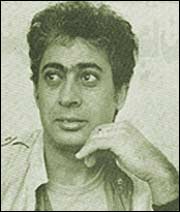 يقاربُ الشاعر السوري سليم بركات مفاهيمَ مجرّدة من مثل الموت والأبد, الخير والشر, الفردوس والجحيم, وغيرها من الثنائيات, مقاربةَ شاعرٍ رومنطيقي للطبيعة بصفتها انعكاساً طيفياً لعالم المُثُل الأفلاطوني, مقوّضاً الفروقات بين المرئي واللامرئي, المجرّد والمحسوس, الأزلي والزائل. في ديوانه الجديد "المعجم" الصادر عن (دار المدى - دمشق - 2005), يقدم الشاعر قصيدة ملحمية طويلة تدور, ظاهرياً, حول جدلية الخير والشرّ كما تتجلى في عالم المرئيات, بنباته وطيره ومياهه وحجره وهوائه. لكننا سرعان ما نرى أن هذه الجدلية, ومن منظور آخر للقراءة, تتعرّض للتقويض في كل لحظة, عبر سعي الشاعر إلى إقامة حرب ضروس بين الاستعارات الدالة عليها. فالشاعر لا يدع اللغة تهدأ, أو تستقرّ على حال, وما المعنى الذي يسعى إليه سوى ومض خاطف سرعان ما يتلاشى, ليتلوهُ ومضٌ آخر, فآخر. فالشرّ, الذي يفتتحُ القصيدةَ - "لأعضّنّ رسغكَ إذ تتقي فميَ - فمَ الكيدِ العذبِ في انبثاقي من المهجورِ جائعاً, أيها الشرّ" (ص 5) - هو الرمزُ المهيمن بإطلاق على أفق القصيدة, يتداخل عضوياً في نسيج النصّ, ساحباً معه نقائضَه وأشباهَه, ليختفي تارةً, ويظهرَ أخرى, من دون أمل بالعثور على خيط سردي يقود القارئ إلى برّ الحكاية. فالحبكة المقترحة في القصيدة لا يسندها شيء سوى كنايات الشاعر التي تتعاقبُ موشوريةً كضربات موسيقية لا تتقيدُ, البتة, بسلّمها الموسيقي. بل يمكن القول إن الديوان - المعجم نفسه مؤلف من فيض هائل من الحبكات الصغيرة المتداخلة, تتناغمُ حيناً وتتصارع أحياناً أخرى, يؤلّف بينها رمزٌ محوري مشعّ, هو "الشرّ", يؤنسنه الشاعر ويضفي عليه صفات الكائن الحي, ليصبح المحرك الأساس للقول الشعري, مثلما يُصبح, أي الشرّ, محرّكاً لناموس الكون في رؤيا القصيدة. وهذا يعيد إلى الذاكرة الجدل الذي أثاره ولا يزال, الشاعر الإنكليزي المتمرّد جون ميلتون, إبان صدور ملحمته الشعرية "الفردوس مفقوداً", عام 1674, والمؤسسة, أصلاً, على جدلية الخير والشر (الله والشيطان) كما ترويها الحكاية التوراتية, حين أعاد ميلتون الاعتبار, شعرياً, الى شخصية الشيطان, عبر تحالفِهِ البلاغي معه, وجعلِهِ ينطق بأجمل الأبيات وأقواها في القصيدة. وهذا ما قسم النقد الإنكليزي, عندئذ, إلى مدرستين متناقضتين: شيطانية وملائكية.
يقاربُ الشاعر السوري سليم بركات مفاهيمَ مجرّدة من مثل الموت والأبد, الخير والشر, الفردوس والجحيم, وغيرها من الثنائيات, مقاربةَ شاعرٍ رومنطيقي للطبيعة بصفتها انعكاساً طيفياً لعالم المُثُل الأفلاطوني, مقوّضاً الفروقات بين المرئي واللامرئي, المجرّد والمحسوس, الأزلي والزائل. في ديوانه الجديد "المعجم" الصادر عن (دار المدى - دمشق - 2005), يقدم الشاعر قصيدة ملحمية طويلة تدور, ظاهرياً, حول جدلية الخير والشرّ كما تتجلى في عالم المرئيات, بنباته وطيره ومياهه وحجره وهوائه. لكننا سرعان ما نرى أن هذه الجدلية, ومن منظور آخر للقراءة, تتعرّض للتقويض في كل لحظة, عبر سعي الشاعر إلى إقامة حرب ضروس بين الاستعارات الدالة عليها. فالشاعر لا يدع اللغة تهدأ, أو تستقرّ على حال, وما المعنى الذي يسعى إليه سوى ومض خاطف سرعان ما يتلاشى, ليتلوهُ ومضٌ آخر, فآخر. فالشرّ, الذي يفتتحُ القصيدةَ - "لأعضّنّ رسغكَ إذ تتقي فميَ - فمَ الكيدِ العذبِ في انبثاقي من المهجورِ جائعاً, أيها الشرّ" (ص 5) - هو الرمزُ المهيمن بإطلاق على أفق القصيدة, يتداخل عضوياً في نسيج النصّ, ساحباً معه نقائضَه وأشباهَه, ليختفي تارةً, ويظهرَ أخرى, من دون أمل بالعثور على خيط سردي يقود القارئ إلى برّ الحكاية. فالحبكة المقترحة في القصيدة لا يسندها شيء سوى كنايات الشاعر التي تتعاقبُ موشوريةً كضربات موسيقية لا تتقيدُ, البتة, بسلّمها الموسيقي. بل يمكن القول إن الديوان - المعجم نفسه مؤلف من فيض هائل من الحبكات الصغيرة المتداخلة, تتناغمُ حيناً وتتصارع أحياناً أخرى, يؤلّف بينها رمزٌ محوري مشعّ, هو "الشرّ", يؤنسنه الشاعر ويضفي عليه صفات الكائن الحي, ليصبح المحرك الأساس للقول الشعري, مثلما يُصبح, أي الشرّ, محرّكاً لناموس الكون في رؤيا القصيدة. وهذا يعيد إلى الذاكرة الجدل الذي أثاره ولا يزال, الشاعر الإنكليزي المتمرّد جون ميلتون, إبان صدور ملحمته الشعرية "الفردوس مفقوداً", عام 1674, والمؤسسة, أصلاً, على جدلية الخير والشر (الله والشيطان) كما ترويها الحكاية التوراتية, حين أعاد ميلتون الاعتبار, شعرياً, الى شخصية الشيطان, عبر تحالفِهِ البلاغي معه, وجعلِهِ ينطق بأجمل الأبيات وأقواها في القصيدة. وهذا ما قسم النقد الإنكليزي, عندئذ, إلى مدرستين متناقضتين: شيطانية وملائكية.
هذا التحالف مع الشرّ, أو الافتتان به, يؤسس لبلاغة المعجم لدى سليم بركات أيضاً. فالشرّ, كما يتجلى في قصيدته, كائن لغوي محض, قوامه الاستعارات والرموز, ينقضّ على تاريخ البلاغة نفسها, مخلخلاً مفهومنا للعبارة الشعرية ووظيفتها. كما أنه يطيح كل معرفة يقينية مسبقة, ناشراً الضلال حوله, في سلسلة انزياحات متشرّدة, لا برّ لها: "شرّدهم أيها الشرّ/ شرّد/ جيرانَ/ الكتابِ/ المهملِ/ على/رفّ/ الشفقِ/ الثالثِ. شرّد الكتابَ سطراً سطراً./ شرّدِ الشفقَ./ شرّد الغدَ, الذي يتمرّغُ في قشّ العدسِ بدواجنه - دواجنِ المديحِ./ اقرأ عليه سيرتَه. اخذلهُ أن يتتبعَ سيرتَه" (ص 61). وكأن سليم بركات يتعمّد نسف الحبكة, أو السيرة المدوّنة, باحثاً عن شفق ثالث, أو جنس أدبي هجين, يقومُ جوهرياً على شهوة افتراس الكلمات, وزجّها في علاقات دلالية جديدة, قلّما نجد لها مثيلاً في شعرنا العربي الحديث. والصراع جلي واضح هنا, فالمفردة تريد الانعتاق من ذاكراتها المعجمية, عبر إطلاق شهوتها الدلالية الكامنة: "كل شهوةٍ يتهدّجُ صوتُها امتناناً أنّكَ تتنفّسُ الصعداءَ, أبداً, إذ تتنفّسُ الشهواتُ الصعداءَ في خيالِكَ, أيها الشرّ" (ص 27). وهي شهوةُ الكلام المتخيّل, خارج سطوة المعجم, بل عبر تقطيع جسد المعجم, وإعادة ترتيب متنه وهوامشه. وليس غريباً أن يختتم الشاعرُ القصيدة باستغاثة العارف باستحالة المحاولة, مستنجداً بتلك الشهوة - الشرّ, التي ستدلّ الخيرَ النقيضَ على مكمن السرّ, عبر الكشف عن الأحجية, أملاً بالعثور على النقش المفقود: "أرهِ/ النقشَ/ المفقودَ/ أيها الشرّ: ذبحٌ من العدم إلى العدم./ ذبحٌ في الكلمات مذ تسلّمتَها هكذا من الله,/ وأعدتها متخبّطةً في الدمِ إليهِ" (ص 70).
وإذا صح قول الناقد الأميركي هارولد بلوم بأنّ في داخل كل مبدع قوي سلفاً قوياً يتأثّرُ به, عبر التكتّم عليه, سعياً للانحراف عنه, وتجاوزه, وبالتالي الإتيان ببلاغة تضادية تعيد النظر جذرياً بصورة هذا السلف, فإن سليم بركات لن يرضى بأقل من اللغة العربية نداً له, معنىً ومبنىً, يقيم صراعه الأوديبي الخفي معها, في سبيل ابتكار لغة داخل اللغة, تنحرف بزاوية حادة عن تاريخ بلاغتها, فيما تؤكّد في كل جملة, جوهرها البلاغي. وما "المعجم", اسماً ومسمىً, سوى تجسيد شعري هائل لهذه المفارقةparadox التي تقيم على حدّ الاختلافdifferance أو التأجيل. يخاطب الشاعر رمزه المحوري في القصيدة, الشرّ, قائلاً: "جاورني, جاورِ الجلالَ الأعمى يتلمّس بعصا النسيانِ كنوزَه المنتثرةَ في دهليزِ الجوهرِ - لذائذِ الشكل الأثيرِ بلا نهايةٍ. قشّر الكواكبَ هناك في النهايةِ المقشّرةِ بمديةِ الفراغِ الطّاهي" (ص42). نلاحظ هنا, أنه على رغم براءة الانسياب, والغنائية الأثيرة المتأتية من النبرة الخطابية, وعلى رغم وضوح القصد المجازي, لكنّ الكلمات أُخرجت من سياقها المألوف, وباتت مفرداتٌ من مثل "الشر", "الجلال", "النسيان", "الجوهر" و"الفراغ", كمائن بلاغية لا غير. وهذا ما يجعل قصيدة بركات عصية على القراءة, تماماً بسبب كمائنها البلاغية تلك, كما يجعلها بعيدة, نائية, منقطعة عن شرطها التاريخي الوجودي, حيث الدوال لا تطيقُ القرانَ بمدلولاتها, وفي كل سطر تقريباً. حقاً, قد يكون عصياً الركون إلى فحوىً ثابت أمام هذا السيل من الاستعارات, العالية الصقل, الشديدة الفصاحة, لكن لا أحد يمكن أن يغفل الطاقة الشعرية الكامنة في الانزياح نفسه, والتي تميّز عادةً الكتابات الهرمسية "المقدسة" التي تتحدث عن الطبيعة النورانية للكون, القائمة في جوهرها على التلميح, أو الترميز المخاتل. ثمة ما يجعل البلاغة هنا محاطة بهالة من السّحر, أو ما يمكن أن يسمّيه البلاغيّ والفيلسوفُ اليوناني لونجينوس "الرفعةَ" أو "السموّ"the sublime . وهذه, من دون شكّ, سمة الأسلوب لدى سليم بركات الذي عُرف به منذ ديوانه الأول: "كلّ داخلٍ سيهتفُ لأجلي, وكلّ خارجٍ أيضاً" الصادر عام 1972. إنها الرفعة التعبيرية التي تعيدنا إلى بلاغة المخطوطات اللاهوتية في القرون الوسطى, إسلامية ومسيحية, بمجازاتها الحلزونية الملتفة, وتراكيبها البديعة.
وسليم بركات يوظّف مهاراته الأسلوبية جميعاً, لخلق هذا التكثيف التشكيلي الثري, هو الروائي المفتون بالوصف, الناظر إلى المرئيات بعين سينمائية فذّة, إذ نراهُ يلوّن ويبدّل وينوّع ويحذف ويقدّم ويؤخّر, من دون كلل. لكنه أيضاً واقعي بقدر ما هو سوريالي, وفلسفي بقدر ما هو لاهوتي. ولا يعلم القارئ إن كانت الذاكرة (اللغوية), أم المخيلة (اللغوية) ما يبثّ الروح في هذه القصيدة - المعجم. أهي ذاكرة الطفل سليم بركات, ملتصقاً التصاق العشب بأرض الشمال السوري, أم المخيلة التي تريد الهروب من ماضيها النازف, عبر ابتكار بيئة مثالية خارقة. أم هو النداء السحيق الذي يشدّ الكائن إلى الكون في صيغته الكلية, حيث عناصر الطبيعة متآلفة, متناغمة مع حقائقها الروحانية العليا. غير أن نقيض هذا الكلام صحيح أيضاً, فالشاعر يفكك أي وهم بالوحدة, وينهال على المفاهيم المستقرة طعناً, مخلخلاً علاقة الدال بالمدلول, كما أسلفنا. فالعقل, رمز الوحدة, منقسمٌ على نفسه أيضاً, يخفي تحت جليدهِ صراعاً خفياً ترمز إليه "زُحافة الجليد" في هذا المقطع: "كلبٌ واحدٌ, أيها الشرّ" كلبٌ واحدٌ يجرّ زُحافةَ الجليدِ من العقل إلى العقل" (ص 11). ليُرمى بنا, نحن القراء, في متاهة جديدة, نتأمل غموضها بالكثير من الدهشة, والقليل من الطمأنينة. والحق أن الشاعر يعي محنة المعنى ومأسويته, هو القنّاصُ الباحث عن طرائده اللغوية خارج سطوة المتن اللغوي" المفتون بالمعنى النازف, القلق, المرتحل" ذاك "المعقول" الذي تُرِكَ "ينزفُ كسلوقيّ أصابهُ القنّاصون إذ أخطأوا الطريدةَ" (ص 15).
ولكن لماذا المعجم؟ وأي معجم هذا الذي يسعى الشاعر دائماً إلى تقويض دلالاته؟ أليس الشعر صراعاً لا هوادة فيه ضد المعجمية؟ إن سليم بركات من أقوى الشعراء وفاءً للتسمية القاموسية. فديوانه, وشعره عموماً, يزخر بأسماء يصعبُ حصرها للنبات والحيوان والطيور والأمكنة, بعضها يحتاج حقاً إلى معجم لتأويله, كما في هذا المقطع: "البقلةُ والتوتُ مسحوقينِ في التّوبال. حشيشةُ العقربِ النابتةُ في مقابرِ الغرقى. عنبُ الثعلبِ, والكراويا. الماميران الشّبِقُ. أسدُ العدس. الجَنطيانُ الجبلي المختمرُ في هواءِ السهولِ. الخشخاشُ الرزين... إلخ" (ص 41). لكنه أيضاً من أقوى الشعراء انزياحاً عن التسمية, من خلال فهمه الفريد والمتفوق لوظيفة الاستعارة, وما تقوم به من تكسير دلالي. كأن لا غاية للشاعر سوى الرقص بالكلمات, واللعب بالمفاهيم, كاسراً جهامتها, ضاحكاً من رصانة القاموس, ومن يده التي تخطّ الحروف. يضع يقيناً هنا لينسفَه على الفور, ويسرد حكايةً هناك ليطلق النارَ على شخوصها. ولأنّ الشرّ فتنةُ التناقض وخيرهُ الوحيد, يتمرّد الشاعر على المقدّس اللغوي, موغلاً أبعد وأبعد في جنونِ الكنايات وخَبلِها, مؤسساً لمعجمٍ لا تُصرّف فيه المفردات كمفردات, ولا تدوّن فيه المعاني كمعانٍ: "لن أدوّنَ شيئاً. سأبري الأقلامَ, ثانيةً, بمبراتي. سأقضمُها بأسنانِ السطورِ المنصرفة, بعد التدوين, إلى شؤونِها. لن أُبقي قلماً. حتى يختبلَ الرصاصُ في غلافهِ الخشبيّ, ويتهتّكَ" (ص 51).
سليم بركات شاعرٌ بلاغي كبير, يقتحمُ معترك التجريب الشعري بلغةٍ تتمرّدُ على نفسها, فاتحاً, بمخيلته الرفيعة, بابَ الغواية على مصراعيه, ناسجاً على منوال سلفه الفذّ ميلتون في تحالف هذا الأخير مع الشرّ - الشعر. لمفرداتِ معجمه أسنانٌ قاضمةٌ, تتركُ المعاني مثقوبةً تنزفُ على بياضِ الصفحة, وتتركنا, نحن قراؤه, نهباً للمتاهة, باحثين عن النقش المفقود في فخامة التدوين وجنونه.
الحياة
2004/12/28