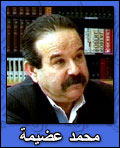 تستمرّ مغامرة الشاعر السوري محمد عضيمة في تقديم سلسلة مختاراته من التجارب الشعرية العربية الجديدة مع ظهور كتابه (ديوان الشعر العربي الجديد ـ بلاد المغرب العربي) عن دار التكوين، في دمشق (2007)، وهو الخامس له، ويضم مختارات لأكثر من مئتي شاعر وشاعرة من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، ممن ينتمون إلى أجيال شعرية مختلفة. وقد سبق للشاعر عضيمة، الذي يقيم في اليابان منذ أكثر من عقد، أن أصدر مختارات منفصلة عن الشعر العراقي واللبناني والسوري والخليجي، مستخدماً المنهج ذاته، القائم على اجتزاء مقطع واحد من قصيدة كاملة، واعتباره الجزء الذي يختزن لبّ القصيدة أو روحها، وهو الجزء الذي يستحقّ البقاء وحده، بمعزل عن سياق القصيدة. وقد أثارت تلك الطريقة جدلاً بين النقاد والشعراء، الذين شكّكوا بجدوى هذه الاستراتيجية، خاصة أن الانتقائية في الاختيار تميل إلى طمس كل نقاط الاختلاف بين تجربة شعرية وأخرى.
تستمرّ مغامرة الشاعر السوري محمد عضيمة في تقديم سلسلة مختاراته من التجارب الشعرية العربية الجديدة مع ظهور كتابه (ديوان الشعر العربي الجديد ـ بلاد المغرب العربي) عن دار التكوين، في دمشق (2007)، وهو الخامس له، ويضم مختارات لأكثر من مئتي شاعر وشاعرة من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، ممن ينتمون إلى أجيال شعرية مختلفة. وقد سبق للشاعر عضيمة، الذي يقيم في اليابان منذ أكثر من عقد، أن أصدر مختارات منفصلة عن الشعر العراقي واللبناني والسوري والخليجي، مستخدماً المنهج ذاته، القائم على اجتزاء مقطع واحد من قصيدة كاملة، واعتباره الجزء الذي يختزن لبّ القصيدة أو روحها، وهو الجزء الذي يستحقّ البقاء وحده، بمعزل عن سياق القصيدة. وقد أثارت تلك الطريقة جدلاً بين النقاد والشعراء، الذين شكّكوا بجدوى هذه الاستراتيجية، خاصة أن الانتقائية في الاختيار تميل إلى طمس كل نقاط الاختلاف بين تجربة شعرية وأخرى.
ويشير عضيمة في مقدمته النقدية الطويلة التي افتتحت كتابه إلى أنه أراد من خلال تلك المختارات أن يقبض على ما يسمّيه النقد العربي القديم "بيت القصيد"، وهو بمثابة الذروة الشعرية في كل قصيدة، التي يجب أن تتحلّى بدفق دلالي حاسم، منفلت من المخزون التراثي، وقادر على الإبهار والدهشة. ولا يتردّد عضيمة في أن يهمل البقية الباقية من القصيدة، ونعني حطامها، بحجة أنها مجرد فائض لغوي لا طائل منه. هذه الذروة يجب أن تأخذ القارئ على حين غرة، وتبهره بجدتها وأصالتها، فهي تشبه اللغم على حد تعبيره: "كنت أمضي إلى حيث يوجد لغم ولا أتردّد في تفجيره والتمتّع بإيقاعه وصوته، ثم أجلس مكان الانفجار، وقد أعطيته اسماً أو عنواناً". ولا ينسى عضيمة في المقدمة أن يشن هجوماً قاسياً على اللغة التراثية التي تتصف بالحذلقة المنبرية، الغارقة في كآبة مستديمة، والتي تعيد تكرار رؤيا لاهوتية قديمة، تنبذ الراهن، وتصادر الآني والفاني. من هنا دعوته إلى شعرية الفرح، وضرورة إحداث طلاق معرفي وجمالي مع إرث الولولة والرثاء، والكف عن الركض خلف المجاز، الذي لا يقل وطأة عن الرؤيا الدينية التي تفكرّ دوماً بالموت، على حساب بهجة التجربة الحياتية، الطارئة والعابرة. ويجد عضيمة أن أي ابتعاد عن حواس الجسد، وحياة الكائن في الزمان والمكان، يعني السقوط في فخ الميتافيزيقيا، وبراثن الوقفة الرثائية للخطاب الصوفي، المنحاز للأفكار الكبرى، التي ما تزال تهيمن على مخيلة الشاعر العربي حتى يومنا هذا. ولا يرى عضيمة كبير جدوى في تصنيف الشعر وتنميطه، رغم إعلانه الانحياز إلى قصيدة النثر، التي يجب أن تتحرر من هرطقة المعنى الناجز، والمجاز الناجز، وإلا لن تكون سوى قصيدة نثر عمودية، متصلّبة وكئيبة، خاصة أن الوزن لم يكن في يوم من الأيام عنصراً جوهرياً في حسم شعرية النص، فاللغة العربية، في قواعدها ونحوها وصرفها، "موزونة"، وبالتالي فإنّ اللجوء إلى الوزن لن يكون سوى مجرد زخرف براني يزيد الشكل تشابكاً وتعقيداً.
وإذا كان عضيمة ينبذ الوزن، ويرى في موسيقى التفعيلة امتداداً لبحور الخليل، فإن الشيء الذي لا يمكن فهمه هو ربطه النظرة الدينية الميتافيزيقية بالإيقاع، رغم أن موسيقى الوزن لا تخاطب العقل بل الحواس، وتطلبُ حاسة السّمع مستقراً لها. كما لا يُفهم ربطه الإيقاع بالهذيان حين يقول إن "قصيدة النثر هي قصيدة وعي وصحو، أما قصيدة الإيقاع فهي قصيدة سكر ودوخة"، فموسيقى التفعيلة تتطلب ذاكرة رياضية يقظة دوماً، ونقيضها جدلاً هو النثر الحرّ. ونذكّر في هذا السياق أن قصيدة الوعي تناقض جوهرياً رؤيا أحد أكبر شعراء الحداثة في القرن التاسع عشر، ونعني به الفرنسي رامبو، صاحب "المركب السكران" و"فصل في الجحيم"، الذي أطلق ثورة حداثية كبرى، بدعوته إلى "تشويش الحواس"، وتخطي "صحو" الجسد، والذهاب بعيداً في طريق التجلّي والكشف الداخلي، وهذا ما فات الشاعر عضيمة.
لكن عضيمة يصرّ على أن مختاراته ليست سوى "أقوال شعرية"، منفلتة من سياقها العام، وهي حرة، بريئة، وصافية، وجدت ضالتها في ميثولوجيا بيضاء، سعيدة دائماً، مبتسمة دائماً، لا يشوبها عبوس أو حزن، وخالية من كل شعور بالإثم، ومن كل صراع، لأن آدم وحواء هنا لا يعرفان طعم السقوط، وهما كائنان مصنوعان من لذة أبدية. وقد انعكست هذه النظرة الأيديولوجية المتزمتة على معظم المقاطع المختارة، حيث يتعمّد عضيمة اختيار الطريف، والخفيف، والمضحك، ويستبعد كلّ ما له علاقة بالكآبة واليأس والقلق. لكن المتتبع لهذه الومضات يعثر على تناقض رهيب بين مقطع وآخر من حيث التألق الجمالي ونضارة الصوغ، ونصطدم مراراً بمقاطع عادية، باهتة، لا توتر فيها ولا دفق، ما يعمّق الفجوة بين ما يطرحه عضيمة نظرياً في المقدمة، وبين النماذج التي يقدّمها في المتن. ولا يُخفى سقوطه في شرك رؤيا نمطية تقليدية، عبر تمسّكه بفهم سكوني لماهية القصيدة ـ المقطع، ودعوته الحفاظ على وحدة الومضة بدلاً من وحدة البيت. وهنا نرى خطورة التماثل بين شعراء المختارات، على كثرتهم واختلافهم، وهم يبدون شاعراً واحداً، يحمل، على الأرجح، بصمات عضيمة، وتحكمهم نظرة أحادية، تمليها بنية قصيدة الهايكو، التي يبدو أن الشاعر لا يعرف نمطاً شعرياً أكثر جدّةً منه، بالرغم من تقليديته وقدمه. وليس غريباً أن يقع التشابه بين المقاطع إذا كان عضيمة يعطي لنفسه الحق، ليس فقط بابتداع عنوان منفصل لكل مقطع، بل بتغيير بعض الجمل والمفردات، بحيث يجعلها تتطابق وتتناغم مع مسطرته الجمالية. بمعنى آخر، ليس مفاجئاً أن يتشابه شاعر من الجزائر مع آخر من المغرب، أو من ليبيا أو تونس، بسبب هذا النسق المتراص، الصارم، الذي يلغي خصوصية كل صوت شعري، ويحيل الجميع إلى جوقة تردّد نشيداً واحداً، بالرغم من الدعوة الملحة إلى قصيدة تحمل نبض صاحبها، وتدل عليه وحده، وتتخلى عن ذاكرتها المجازية والبلاغية المنجزة، وتسمّي الأشياء بأسمائها، وتكتفي، إن أمكن، بهيكلها العظمي فحسب.
ورغم النبرة التبشيرية التي يستخدمها عضيمة في مقدمته، والتي تناقض دعوته إلى نبذ التبشيرية أصلاً، فإنه لا ينحرف معرفياً وجمالياً عن تمرّد جيل الرواد، ونراه يسير على خطاهم في البحث عن شعرية مضادة، تكمن دائماً في الوجه الآخر للمرآة، وهو لا يفعل أكثر من تقديم نموذج ضدّي لمختارات أدونيس الشهيرة، في (ديوان الشعر العربي)، المتنوعة والغنية، عبر طرحه نمطاً واحداً وحيداً تجسّده، كما أسلفنا، قصيدة الهايكو، وبالتالي ليس مفاجئاً أن يأتي مقطع للشاعر محمد بنيس مثلاً مشابهاً لمقطع للشاعر خالد مطاوع، أو مقطع لعياش يحياوي مشابهاً لمقطع ليوسف زروقة، رغم الاختلاف الكبير بين هؤلاء في الحساسية والأسلوب والرؤيا. وينطبق هذا بالطبع على أغلب شعراء المختارات، ومنهم، على سبيل التمثيل لا الحصر، سالم العوكلي، وصالح قادربوه، وفوزية شلابي، وحكيم ميلود، ومباركة بنت البراء، وصلاح بوسريف، ومنصف المزغني، وياسين عدنان، ومحمد علي اليوسفي، وغباري الهواري، وعبد الإله الصالحي، وأحمد القاطي، وغيرهم. في هذا الصدد، لا بأس أن نستعير تحذير عضيمة نفسه من ضرورة تجنب الوقوع في التماثل والتشابه، ونسقطه على شعراء مختاراته، ونقول معه: "انظروا إلى نصوصكم يا أصدقاء كيف تتشابه، تتقاطع، وتتطابق. انظروا إلى صوركم الشعرية كيف يخرج بعضها من بعض، كيف تتراكم مثل الكتل الطينية، فلا تكاد تتنفس حتى تخنقها واحدة أخرى مشابهة".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن فكرة القصيدة ـ الومضة تعود في أصولها الحديثة، الأنكلو ـ ساكسونية، إلى بدايات القرن المنصرم في أميركا، حين فكّر عزرا باوند وهيلدا دو ليتل وكارلوس ويليامز وآمي لويل، بتنظيف القصيدة من رواسب الخطاب الرومانسي البائد، والتركيز على نضارة الصورة، وقوة التكثيف، وشفافية الجملة. وهي حركة دعت إلى ضرورة تخطي تقليد الشعر الغنائي، الذاتي، والبحث عن جملة شعرية أكثر "موضوعية". وقد انبثقت عن تلك الحساسية حركة "النقد الجديد" (New Criticism) في أوائل الثلاثينات، التي دعت إلى عزل القصيدة عن سياقها التاريخي والثقافي والفكري، والتركيز على بنيتها اللغوية والدلالية بصفتها نصاً أدبياً صرفاً. وجاء هذا التطور، في جزء كبير منه، نتيجة تأثر الشعر الأميركي بقصيدة الهايكو، التي تتصف بالاختزال والشفافية، وما انبهار باوند بنماذجها الرفيعة، في عمله الضخم "الكانتوات" (Cantos) سوى دليل على حضورها القوي آنذاك.
هكذا، ورغم نضارة الرؤيا المتضمنة في التمهيد النقدي المسهب، والجهد الكبير المبذول في إنجاز هذه المختارات، إلا أن محمد عضيمة لا يأتي بجديد سوى تكرار منهج مختاراته الشعرية السابقة (العراقية واللبنانية والسورية والخليجية)، واستخدام أسماء شعرية إضافية، قادمة هذه المرة من المغرب العربي. ورغم صوابية هجومه على التراث، ماضياً وحاضراً، وتفنيده لتلك الذهنية المتزمتة التي تجعل الشعر خطاباً لاهوتياً جديداً يتصف بالغموض والتجريدية، إلا أن مختاراته، كمثل سابقاتها، لم تنج نفسها من الوقوع في فخّ المألوف والسائد، إلا في أمثلة قليلة، ولم تنحرف كثيراً عن دائرة البلاغة التقليدية، القائمة، في جوهرها، على المجاز والتهويم.
المستقبل
الاحد 1 تموز 2007