فصليّة، تعنى بنقد الشعر، تصدر لدى "دار النهضة العربية"
ناشرها الالكتروني "جهة الشعر"
العدد الثالث، تموز (يوليو) 2007
رئيسا التحرير
زينب عسّاف/ ماهر شرف الدين
لمراسلة المجلة
Nakd2007@hotmail.com
أمّا بعد
دراسات
طبيعة غير صامتة في الشعر العربي، بقلم: عهد فاضل
كتابة السيرة الذاتيّة للقصيدة، بقلم: حسن نجمي
من العنوان إلى النصّ (قراءة في قصيدة "يطير الحمام")، بقلم: خالد حسين حسين
الترجمة الشعريّة للآخر، بقلم: إبراهيم محمود
التقديم والتأخير والتوازي... شكل القول، بقلم: سعد كمّوني
المكان... قاب جرح أو أدنى، بقلم: عمر شبلي
محمود درويش في عيون الشعراء العرب الشباب - "الشاعر أم المنقذ؟" لغسان جواد (لبنان)
"ذاكرة تشبه كمائن ليلكيّة" لعبد الوهاب عزّاوي (سوريا)
"في حضرة الدراما" لوائل السمري (مصر)
"ذهنه أم نصّه!" لعبد الله ثابت (السعودية)
"الصوت اللاحق" لعزّ الدين جوهري (الجزائر)
"أسمعه في مدرّج، أقرأه في كتاب" لنشمي مهنّا (الكويت)
"قراءة الألم" لمازن معروف (فلسطين)
"حرارته الشعريّة شفعت لتجربته" لباسم الأنصار (العراق)
"بين سرديّة النثر وإيقاعيّة الشعر" لأديب حسن محمد (سوريا)
"شاعر الجيتار المتجوّل" لرنا التونسي (مصر)
"هذا فراق بيننا" لعبد الرحمن جاسم (فلسطين)
"قتل الأب" لمحمد ديبو (سوريا)
"الحبو والكلام" لنسرين أبو خاص (الأردن)
منتخبات
منتخب "أوراق الزيتون" 1964
منتخب "عاشق من فلسطين" 1966
منتخب "آخر الليل" 1967
منتخب "العصافير تموت في الجليل" 1969
منتخب "حبيبتي تنهض من نومها" 1970
منتخب "أحبّك أو لا أحبّك" 1972
منتخب "محاولة رقم 7" 1973
منتخب "تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق" 1975
منتخب "أعراس" 1977
منتخب "مديح الظلّ العالي" 1983
منتخب "حصار لمدائح البحر" 1984
منتخب "هي أغنية، هي أغنية" 1986
منتخب "ورد أقلّ" 1986
منتخب "أرى ما أريد" 1990
منتخب "أحد عشر كوكباً" 1992
منتخب "لماذا تركت الحصان وحيداً" 1995
منتخب "سرير الغريبة" 1995
منتخب "جداريّة" 2000
منتخب "حالة حصار" 2002
منتخب "لا تعتذر عمّا فعلت" 2004
منتخب "كزهر اللوز أو أبعد" 2005
منتخب "في حضرة الغياب" 2007
أحوال الشعر
إضاءة: التجانيّ يوسف بشير (1912 - 1937)، جمال محمد إبراهيم
حوار: الشاعر الدانماركي نيلس هاو، محمد سعيد ريحاني
متابعة: مؤتمر "خليل حاوي وتطوّر الشعر العربي الحديث"
مكتبة الشباب:
"شعرائيل" للسوري تمام تلاّوي
"تمائم" للسعودي أحمد الواصل
"كما يخسر الأنبياء" للأردني حسين جلعاد
"أنا شاعر كبير" للبناني رامي الأمين
"ينتظرونكَ" لليبيّة خلود الفلاح
بعدما تناولت في عددها الفائت تجربة الراحل صلاح عبد الصبور "المظلوم" بسبب إقصائه عن دائرة التكريس، تختار نقد تجربة محمود درويش "المظلوم"، لكن بسبب إقامته في هذه الدائرة تحديداً.
ففي تجربة درويش تمّ إنصاف الشاعر على حساب شعره، تمّ تقديم الشخص على القصيدة. على الدوام كان الانتصار لدرويش الفلسطينيّ على درويش الشاعر. على الدوام كانت القضيّة هي الطريق الإجباريّ لامتداح الشعريّة. تقريباً، درويش لم يُقرأ، بل تُرجم... وضمن اللغة الواحدة!
كان ثمة "خيانة" (والإيطاليون يقولون: "الترجمة خيانة") في سلوك القصائد مجاريَ كسفتْ الجانب الفنّي فيها. كان ثمة بخسٌ "كرنفاليّ" للفنّ في سبيل الأيديولوجيا. لكن درويش لم تنطلِ عليه هذه "الخدعة" الموقّتة، بالرغم من ثنائيّة البنفسج - القذيفة التي ملأت قصائده، وبالرغم من حيرة بعض نصوصه بين مطلع غنائيّ بديع وختام مباشر وتكراريّ.
شعريّة محمود درويش ذات المزاج التقريريّ في أعماله الأولى، استطاعت الإشراق بأجمل مطالع الشعر العربي الحديث ("سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا"، "عودة الأسير"، "الرمادي"، "كان ما سوف يكون"، "شتاء ريتّا"...)، مثلما استطاعت اختراع قاموس تركيبيّ اغتذت منه الأجيال اللاحقة. بالطبع، استفاد درويش من تقنيّة السرد القرآنيّ (راجع مطلع قصيدة "سنخرج" مثلاً)، وتقنيّات الأغنية الشعبيّة (الأهزوجة تحديداً)، و"نشيد الأناشيد"... لكن قدرة هذا الشاعر على إجراء كلّ شيء في فلك غنائيّته الاستثنائيّة، جعل من ذلك تفاصيل. لذا، يكون تحديد تقنيّاتٍ في شعر درويش كالقول: لعبه الأثير بالضمائر (أنا، أنتَ، هو)، أو تذويبه التساؤل الفلسفيّ في البنية الشعريّة ("هل كان أوّلُ قاتلٍ - قابيلُ - يعرف أن نوم أخيه موت؟")، أو حرصه على قيام توازن سيكولوجيّ في الموسيقى (على سبيل المثال، قصيدة "الكمنجات" في "أحد عشر كوكباً" التي تُبرز التجانس الموسيقيّ بين "فاعلن" وصوت عزف الكمنجا)، أو "الغموض البليغ"... نقول إن تحديد تقنيّات هذا الشاعر بواحد واثنين وثلاثة لا يخدم الباحث كثيراً في القبض على "سرّ المصلحة" في شعره.
بالشعر، استطاع درويش تحويل قصّة النزوح من فلسطين إلى قصّة شبيهة بقصّة الطرد من الجنّة: فلسطين هي الجنّة، والفلسطينيّ هو آدم، والزيتون هو التفّاح.
بامتزاج الألم باللذّة، والحزن بالسحر، بات للمأساة مردودها الجماليّ الخالص (هنا يمكن جيلنا الشاب أن يستذكر تلك الشائعة التي طالما تداولناها عن "عمالة" ريتّا وارتباطها بجهاز الموساد الإسرائيليّ!).
في شعر درويش ثمة سمة ضوئيّة، أو فلنقل ثمة صباح: نهوض دائم من النوم، قهوة الأمّ، والقهوة مع الحليب... إضافة إلى صفاء لغويّ لا يقلّ استعلاءً عن قولنا: صفاء عرقيّ. وفي حين يأخذ الجسد في قصائد الآخرين منبر الكلام في الجنس، يقوم الجسد الدرويشيّ بالإصغاء. الجنس في قصائد درويش فعل إصغاء لا مرافعة.
لقد جعل درويش من الشعر وسيلته الفضلى لقول كلّ شيء: الغضب، الخيبة، الحبّ، التحيّات... حتى النقد: "كيف أنجو من مهارات اللغة؟". أكثر من ذلك، نستطيع، من خلال قصائد درويش، تقديم رسم بياني لبدء تحوّله، الذي أخذ طابع الحيرة الفلسفيّة، إلى كتابة قصيدة النثر.
بعد "كزهر اللوز أو أبعد" (2005) بات انتقال محمود درويش إلى كتابة قصيدة النثر أكثر سلاسة، وربما أكثر حتميّة. لقد أظهر درويش في هذا الديوان قدرة (رغبة؟) كبيرة على "تمويت" الوزن وإدخاله في غيبوبة. لقد بدا جليّاً أن ثمة حاجة ملحّة لتنويمه مغناطيسيّاً (نثريّاً)؛ محوه والإبقاء عليه في آن واحد. استفادة قصوى من تقنيات قصيدة النثر وموارد تعبيرها، وطغيان لليوميّ، مع تصميم لا يُراجَع لردّ الاعتبار النثريّ للأشياء من خلال تعريفات كرّستها، تقليداً، قصيدة النثر... بالطبع، ذلك كلّه مسبوقاً باستهلال غير بريء مقتبَس من كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيّان التوحيديّ: "أحسن الكلام ما... قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم" (الديوان ينتهي باقتباس آخر، لكن للشاعر نفسه من قصيدة "طباق"، يبدو غير بريء أيضاً: "وداعاً، وداعاً لشعر الألم").
في هذا الديوان كان ثمة تأتأة نثريّة. كان ثمة احتباس نثريّ واعٍ. كتابة محمود درويش قصيدة النثر، بعد 21 ديواناً، ليست فعل "تصابٍ" قطعاً، بل دليل قدرة، إن لم نقل يقظة نقديّة لا تشرد. والحقّ أن هذا الشاعر كان أحسن نقّاد تجربته، وليست غاراته التنقيحيّة على شعره القديم سوى دليل على ذلك.
امتحان "في حضرة الغياب" كان امتحانَ إيقاع، هذا المسمّى الذي طالما اعتبره درويش مقياساً أساسيّاً لحساب منسوب الشعريّة في النصّ، ناهيك بأن هذا الشاعر هو أكثر الشعراء العرب استخداماً لهذه المفردة (الإيقاع) في شعره حيث ترد عشرات المرّات. والصحيح أن قدرة الإيقاع، كمصطلح نقديّ، على التملّص والإفلات من تعريف أكاديميّ صارم يرسم له حدوداً للقياس، جعله يتقمّص هيئات عدّة في شعر درويش بين اختلاطه بالغنائيّة حيناً، وانبجاسه في "إباحيّة" عروضيّة حيناً آخر، أو حواريّات لم تكن تنويعاً يوماً في قصيدة درويش (وإذا كانت كذلك فهي تنويعات بنيويّة)، ناهيك بالتدوير المباغت ولعبة الصدى وجماليّة اللاوصول الدائم... في هذا الديوان الأخير، والذي تمّ ترويسه بلفظة "نصّ"، ثمة "مصالحة" تمّت، أو ثمة لقاء أُنجز. فلا يخفى على من يقرأ دواوين درويش، قراءةً كرونولوجيّةً، بروز ثنائيّتَين اجتهدتا على التصاعد كتاباً بعد آخر: ثنائيّة الحضور والغياب (حتى أن الغياب استطاع بلوغ مرحلة الوجود الفيزيقي: أشياء الغياب، مشاغل الغياب، ركض الغياب، رمّانة الغياب، فرس الغياب، شجر الغياب، رخام الغياب، زجاج الغياب، آثار الغياب...)، وثنائيّة النثر والشعر. في هذا الديوان كان ثمة استعادة نثريّة لـ"جداريّة" التي بلغت ذروتها في طرح الثنائيّة الأولى (الحضور والغياب)، مثلما بلغت ذروتها في استنفاد طاقة الأوزان في حمل (قول؟) كلّ شيء. "في حضرة الغياب" صالحَ النثر بالشعر، مطبّقاً مقولاتٍ كان درويش قالها في دواوين سابقة: "ستعثر الأنثى على الذكر الملائم/ في جنوح الشعر نحو النثر"، "أحبّ من الشعر عفويّة النثر"، "لعلّ السهل نثرٌ/ لعلّ القمح شعرٌ"، "]إلى الشعر والنثر:[ طيرا معاً/ كجناحَيْ سنونوّة تحملان الربيع المبارك"... وليست "زلاّت" التبرير للنثر في هذا الديوان سوى ترجيع لـ"زلاّت" العروض في النثر (وهنا لا نقصد المقاطع الموزونة التي تضمّنها الكتاب، لكن بعض الجمل الموزونة التي تسلّلت إلى المقاطع النثريّة).
قبل ذلك، كان لدرويش في ديوان "أحبّك أو لا أحبّك" 1972 محاولة لكتابة قصيدة النثر، وذلك في قصيدة "مزامير" التي تألّفت من 12 مقطعاً (5 مقاطع موزونة، 6 مقاطع غير موزونة، ومقطع مقفّى من دون وزن) في هيأتها النهائيّة، حيث كان الشاعر قد أعاد النظر في هيأتها الأولى (راجع قسم "منتخبات" في هذا العدد ص 163). بعد صدور "في حضرة الغياب" في وسعنا القول إن تلك القصيدة كانت محاولة قصيدة نثر في أصلها، حتّى ولو قال الشاعر إن لها مرجعيّة تاريخيّة هي نصوص المزامير.
قناعة درويش أخيراً بأن الشعر ما هو إلا "نثر مصفّى"، والتي كلّفته ديوان "في حضرة الغياب"، ستكلّف "الأيديولوجيين" عناء انتظار الديوان "الثاني" أو الثالث والعشرين. فثمة اعتقاد لاشعوريّ، جمعيّ، بأن التخلّي عن القصيدة الموزونة هو نوع من التخلّي عن مبدأ أو قضيّة أو مسيرة نضال. لا قضيّة تُخاض بقصيدة نثر، قصيدة النثر منقوصة الوجاهة... بالطبع، مثل هذه الدفوعات الرجعيّة لا يصمد طويلاً أمام تاريخيّة النقد التي لا يمكن أن تخضع لمنطق ابتزازيّ.
إذاً، في نيّة هذا العدد من نقد (ولو أن بعضاً من النقّاد العرب ممن وعدوا بالمساهمة فيه تخلّفوا لظروف قاهرة) أن يكون قراءةً ضدّ الترجمة، أن يكون قراءة الشعر بلا شوائب الأيديولوجيا والقضايا الكبرى... قراءة درويش المصفّى، درويش النقيّ.
رئيسا التحرير
****
أحدث محمود درويش "مشكلة" في الوعي الشعري الجديد الذي صاحب ما يشبه الثورة أو الانقلاب الجذري على الأصول. فقلد دأب أغلب مجايليه ومَن سبقوه، بفترة قليلة وغنيّة ومحدّدة، على تعامل أعلى مع حساسياتهم الشعرية، بحيث تعكس التجربةُ الشعرية قلقاً مولَّداً من نظرية المعرفة. و"الرجل القوي"، هنا، هو أدونيس الذي أكثَر من احتمال أن تكون نظرية الشعر امتداداً لنظرية المعرفة، لا بل في قصيدة "أحلم وأطيع آية الشمس" جعل نظرية المعرفة جزءاً من القلق الشعري.
المشكلة التي رماها محمود درويش بوجه سابقيه ومجايليه، قبل قرّائه، تمثّلت بصانع نصوص "حدَّث" في متنه الشعري إنما احتوى، وبلا منازع، مقدرة الشعر الجديد على تقبّل الصوت أو الملفوظ. ربما لا يعرف القرّاء الجدد، وكتّابهم، إلى أي حدّ يمثّل الصوت مشكلة للقصيدة الجديدة، بالنسبة إلى أصحاب المشكل طبعاً. إن احتواء محمود درويش للصوت داخل تركيبه الشعري مثّل نقضاً غير متعمّد لمن سبق ولمن جايل، وتقريباً لمن تلا.
الصوت الذي يتأمّن على يد اللفظ والإيقاع، هو بمثابة آلة نسخ لموروث شعري كامل عَمِلَ أصحاب "شعر" اللبنانية ومريدوها على تجاوزه باعتباره شريكاً في "جريمة" التقليد الشعري. وتمّ التعامل معه كآخر حصن من حصون الموروث بصفته مولِّدا للإيقاع والتفعيلة والألفاظ. وفعلاً، تمّ الاتفاق غير المدوَّن بين شعراء يجمعهم هذا النوع من التجاوز وذهبوا باتجاه تقليل الاعتماد على أي شكل من أشكال التصويت أو اللفظ. لم ينجح الجميع، القليل منهم نجح. إنما لم يستطيعوا إغواء واحد كمحمود درويش الذي أعاد السؤال إلى أحضانهم جميعاً: كم سيخسر الشعر العربي بلا صوت؟!
كان أبو نواس محقّاً، مرّة، عندما دافع عن نفسه في معرض انتقاد وُجِّه إلى رخاوة في ألفاظه لحال التمدّن وأن ثمة من يسبقه بسبب ذلك، فقال: "لو كان كلُّ شعري يملأ الفم لما تقدَّم عليَّ أحدٌ". لقد أصاب أبو نواس في بنية تسيطر على الذائقة العربية، وطبيعة أحكام اللغة العربية، ما منحها بطاقة تعريف، في الصوت وفي اللفظ، والإيقاع تالياً. هذا ما فعله محمود درويش: سباحة بعكس عقارب التجديد والعودة إلى الصوت. لقد نجح هذا الرجل بشكل منقطع النظير مما أوقع "خصومه" في إرباكٍ ثان: كيف يمكن الجمع بين الشعرية والجمهور؟ من الصوت، وصولاً إلى شعبية القصيدة. كيف فعل درويش هذا كلّه؟!
في الواقع، ساهم محمود درويش بإحداث نوعٍ من التوازن في نظام التفكير الشعري بعدما أثبت، وبما لا يدع مجالاً للشك، بأن تحميل الصوت واللفظ كلَّ آثام المرحلة الكولونيالية القديمة، لا يمتّ بصلة إلى الموضوع أساساً. فالمرحلة التي تلت سقوط بغداد عام 1258 م، وصولاً إلى محمود سامي البارودي (1838 - 1904)، كانت تعكس سؤالاً خفياً لمّا تجرؤ الحداثة على طرحه علناً وهو علاقة الشعر بالقوة، أو بالمصطلح الفرويدي: علاقة مبدأ اللذة بمبدأ الواقع. وإلا كيف يمكن فهم اضمحلال الشعر العربي مع زوال الدولة؟! إلى أي حدّ ثمة تصادفٌ وإلى أي حد ثمة علاقةٌ؟ لقد أدرك محمود درويش بموهبته المفرطة أن نوعية التصويت العربي والملفوظ فيه يمتّان بصلة غير مدرَكة إلى الإحساس بالتفوّق، ذلك النموذج الذي كان المتنبي الناطق الرسمي به، والأخير. لقد كانت شعريّة المتنبي نوعاً من الكمال الذي لا يتأسس إلا بدمج المادي بالروحي معبِّرَين عن شكليهما في التاريخ والفن، وذلك بقوله الشهير: "وما الجمع بين الماء والنار في يدي/ بأصعب من أن أجمع الجدَّ والفهما".
مع هذا الاختزال اختُصِرَت طبيعةٌ صامتةٌ في الشعر العربي الكلاسيكي. وكَمَنَت أكثر من ستة قرون وراء ظاهرة موت الشعر العربي من نهايات القرن الثالث عشر الميلادي حتى بداية القرن الثامن عشر. والعجيب أنه بسبب سيطرة المنهج الأخلاقي على الإحيائيين والرومنطيقيين ومن ثم الروّاد، لم يجرؤ واحدٌ منهم على ربط الشعرية بالتفوّق. والأغرب أنهم أفادوا من الإحساس بالتفوّق إنما من دون تحويله مبدأ في الفكر الشعري(!) والدليلُ يعرفه الجميع بالثقافة التي سيطرت على "شعر" فترة غير قليلة. كما أن الشعر العربي المعاصر قام بأكمله على دعوات الإحياء، وإنْ برؤية متضخّمة للذات، ومن دون قراءته في النسق، بل في الظاهرة الشعرية.
محمود درويش ربما فعل مثلهم، أي لم يعطِ الإحساس بالتفوّق مبدأ للفكر الشعري، إنما عمل من داخل، في التكوين، واستعاد الصوت عبر اللفظ والإيقاع وجلس ينظر إلى الوفود التي تؤم بيته الشعري الكبير. دامجاً مبدأ اللذة بمبدأ الواقع.
إذاً، من الصوت، إلى نموذج التفوّق (الذي أفاد منه من خلال معنى القضية الفلسطينيّة) إلى النص. على العكس من سابقيه الذين تعاملوا بمديونيّة مع علم الاجتماع ورأوا أن نقص المعرفة العربية بعلم الاجتماع، وتحديداً منها المصطلح، وبقية أزمات المجتمع العربي، ينبغي أن يَعْبَأَ النص بحالته بها، فحوّلوا نصوصهم إلى مساحات حوار لا تخلو من الشعر أحياناً، في الوقت الذي ظنّوا فيه أن الشعر وحده هو الموجود. بينما عمل درويش في النص نفسه وأنتج القصيدة كتلاحم ضروري بين الصوت ونموذج التفوّق، وهذا هو سرّ خلو نصّ درويش من تلوينات نظرية المعرفة، كذلك هذا سرّ غياب الاضطراب في مفرداته، فعادة ما تتكامل فيها الأدوات مع الموضوع على نحو غير مسبوق، بسبب سرعته في التخلص من أثر المتكلمين، ذلك أن دور الصوت والنموذج هو الوحدة، تماماً، مثلما أعلن المتنبي في "الجمع" بين همّته وفهمه: طَرَفَي المثال المتفوّق الذي يجعل من أرسطو والنبي موسى مفْتُوْلَي العضلات، في الوقت الذي تسيطر عليهما، في الوقت نفسه، العَرافة الفلسفية الحادة. لقد مات نيتشه وهو يحلم باستعادة أوروبا التي تتفلسف وتُصارع، في آن واحد معاً. وهو مسعى هيدجر بإرجاع الفلسفة إلى بيتها اليوناني. هل من مفارقة بأن الحرب كانت على الأبواب بعيد كلّ هذا التكامل الفاتن والمدمّر، الخلاّق والدموي؟ سيختصر محمود درويش بإجابة غير ناقصة: "لا تعتذر عمّا فعلت"...
من الصوت، إلى نموذج التفوّق، وصولاً إلى النصّ. قام درويش بكل ما يريد القيام به، عادت الماء إلى عُوْد الشعر اليابس. بينه ونزار قبّاني شراكة مدمّرة، الأول يقوم بواحدة من تكتيكات درويش، الصوت. أما نموذج التفوّق فلم يكن عند قبّاني سوى المكان الأكثر قابلية للتحطم، ولقد تجلّى هذا في الأيام الأخيرة بعدما تساءل عن الوقت الذي سيعلنون فيه وفاة العرب، موت النموذج الذي كان مجرّد استعادة عند قبّاني، حلم، ارستقراطية شاعر شاميّ. بينما لم يكن الأمر كذلك عند درويش، كان نموذج التفوّق وعياً بالأنا ومن ثم التكامل عبر الصوت: سرّ الأسرار في الشعر العربي. وهو أمرٌ دوّخ خالدة سعيد في أول إشاراتها عن محمود درويش في دراستها الشهيرة عندما اعتبرت أن درويش يمثّل "حماسة جديدة في الشعر العربي". ذكاء خالدة قادها إلى مفردة ذكية "حماسة"، وهو اختصار اقترب من قيمة درويش الفنيّة إنما قد بخسه أشياءه. إن هذه الحماسة تعبيرٌ فضفاض لقوّة الملفوظيّة لديه، هذا الأمويُّ في شكل لغة عرف أن مغارة في اللاشعور العربي لا يفتحها سوى اللفظ، والنطق. الصوت هو المطلق، وهو غاية القول الشعري، وإلا فاستدارةٌ إلى نظرية المعرفة. لا يوجد حلّ لهذا المعضلة التي لا تحتاج حلاً في الأساس. عمل كثيرٌ من الشعراء على التسلل بين نقاط اللفظ والصوت، ولم يستطيعوا النجاة. المحظوظ فيهم، كأدونيس، خرج بقصيدة فذّة أراد فيها منافحة درويش بقوة الصوت واللفظ، فكتب قصيدة "إسماعيل" وهي تمثّل أثر التوازن الذي فرضه درويش على بقية الشعراء: إياكم ونظرية المعرفة. كانت "إسماعيل" أدونيس تحدّياً لـ"أحمد العربي". قصيدة بقصيدة، صوت بصوت، اسمٌ باسم. وأحمد بـ... اسماعيل. نجح درويش في جذب أعتى خصومه وأصعبهم على الإطلاق إلى هذه المنطقة التي بدت كما لو أن الحداثة قد طهّرتها، ثم ظهر زيف الحقيقة تلك. وسرّ قبول أدونيس لهذه المواجهة هو أنه، في الأساس، احتفظ لنفسه بعلاقة خاصة غير معلنة بالصوت واللفظ اللذين ظهرا بأكمل صورهما في "أغاني مهيار الدمشقي".
قيمة محمود درويش مثل شاعريته(!) لقد أحدث التوازن بين المكتوب والمنطوق، وأعاد مثال التفوّق ليكون في المنتصف. سيمرّ وقتٌ طويل لمعرفة القيمة التطبيقيّة لأسلوبيّة درويش باستلهام ما يختزنه اللفظ والصوت من موروث جمالي صامت. إنه مدهشٌ يسرح بمحبّي الشعر دون أن يقدّم لهم طبقاً مجانياً. رائجٌ وصعبٌ وملغزٌ. كثيرٌ من سابقيه نجحوا بالصعوبة والإلغاز، إنما أحدث درويش فتنَته عبر الرواج من دون أدنى تنازل، لقد خدعهم بعسل اللفظ ومرَّر بين الحروف ألعابه كلّها. من هنا يبدو أن الحلّ الذي قدّمه محمود درويش لمعضلة التحديث والرواج، هو الحلّ الأمثل. ذلك يُفْهَم عند نزار قباني الأكثر رواجاً والأقلّ تضميناً. وكذلك تفهم كلّ الأساليب التي تلت وجايلت. هل يمكن اعتبار محمود درويش، بهذا المعنى، النموذج الأكثر قابلية للتأثير، من قبل، وحتى زمن مقبل بعيد؟!
****
"قلنا: إن الشعر هو الشاعر. وكان علينا أن نصدّق الشعر ونكذّب الشاعر"
في حضرة الغياب (ص. 169)
1
ما الشعر الذي تنكتب سيرته الذاتية في ديوان "في حضرة الغياب" لمحمود درويش؟ وكيف يتأمّل (نفسه)، خصوصيته، صوته الخاص ضمن الأصوات الأخرى والأساليب الشعرية السائدة في الجغرافيا الشعرية العربية الراهنة؟ وأي علاقة ينسجها هذا الشعر مع شاعره؟ ومن يكتب من (ما)؟ وإلى أي حدّ تصل مغامرة الكتابة الشعرية عبر شكل مختلف، أي في انزياحها الجديد من نصّ تفعيلي إلى نصّ شعري موازٍ يتخذ له هذه المرّة شكلَ محكيٍّ شعريٍّ بلوريٍّ؟
مرّة أخرى، نجد أنفسنا أمام القوة نفسها في اللغة واللعب بالكلمات وبالمجاز والاستعارة والتشبيه (وإن شهدت سيرورة الاستعارة لدى محمود درويش الكثير من التحوّل والتطوّر)، وأمام نصّ له نَفَس أقرب إلى نَفَس القصيدة الدرويشية بكل ما فيها من ذكاء ومكر وتجربة إنسانية طازجة وحسّ فجائعي ورؤية إشكالية.
ظاهرياً، نحن أمام الشاعر الفلسطيني الذي نعرفه ونعرف مساره الشعري والإنساني، لكننا أيضاً أمام الشاعر الذي يذهب عميقاً في تحرير وافتكاك نصه الشخصي من النص العمومي. يكسر أفق الانتظار الشائع فلسطينياً وعربياً، ويكتب عن نومه (اليقظة المغمى عليها)، وعن حلمه وكوابيسه، وعن مرضه وهشاشته، وعن خوفه وحيرته، وعن حبّه، وعن أشجاره وفواكهه، وعن حياته وموته...، موته الذي مضى إليه وصافحه بقلب "مفتوح" قبل أن يعود موفور العافية، شغوفاً بالحياة كما يليق بإنسان حقيقي وبشاعر كبير، صانع للحياة والجمال أساساً. يكثّف محمود درويش ذاكرته في هذه السيرة الذاتية المتقللة من التفاصيل، ومن كثير من الظلال والأحداث والأسماء. وهو لا يكتب سيرته الذاتية بالمعنى العميق للمفهوم، بل يكتب - إن شئنا الدقة - السيرة الذاتية لقصيدته. وذلك من حيث انه يقوم بتجميع، بإعادة تمثّل، وإعادة بناء الاستثناءات والمفارقات التي ميّزت هذه السيرة، سيرة انبثاق وتشكّل المادة الأوليّة (الخام) لكتابة الشعر، ولميلاد القصيدة (علينا هنا أن نفكر في قصيدة "جداريّة" تحديداً، كموديل شعري تنكتب سيرته في هذا الكتاب مثلما ينجز الرسّام اللوحة انطلاقاً من الموديل الجسدي العاري أمامه).
إذاً، فالشاعر في هذا النصّ العميق المركّب، يتوسّل جنساً أدبياً بات معروفاً اليوم في النظرية الأدبية الحديثة، هو "المحكي الشعري". وشعريّة المحكي في نصّ "في حضرة الغياب"، تأتي لتنبّهنا إلى ما لم يتسنَّ لنا الانتباه إليه، أو تعيد تركيب الاستثناءات التي لم تُوصف من قبل كما كان ينبغي أن تُوصف. والأساس الذي يتعلّمه المرء من "المحكي الشعري"(Le récit poétique)، كما نجد ذلك لدى الفرنسي جان إيف تاديي في كتاب نظريّ له بهذا العنوان، هو هذا الهدم الجمالي الخلاّق لهوّة التعارضات الحادّة القائمة (التي ظلّت قائمة لزمن طويل) بين الأجناس الأدبية، وبالخصوص بين الشعر والنثر، مع أن الأمر يتعلّق باختلافات ترجع في جوهرها، كما يرى إيف تاديي نفسه، إلى توزيعات متغيّرة لوظائف أدق من وظائف اللغة، في أغلبها، مؤكداً من ثمّ أن كل رواية هي قصيدة، وإنْ في القليل الممكن منها، وأن كلّ قصيدة هي محكي، في مستوى معيّن. وسنجد أن عدداً من خصائص المحكي الشعري تتلبّس نصّ محمود درويش. ثمة هيمنة واضحة لوظيفة الفضاء كوظيفة رئيسيّة رغم أن الإحساس بالموت يثير دائماً وعادة وظيفة الزمن (لكنه هنا موت لم يكتمل لحسن الحظ). وثمة إيثار للحظة على حساب الديمومة، وينعكس ذلك بجلاء حتى على مستوى التكثيف الحكائي وانقطاعات الخطيّة السرديّة. وثمة أيضاً، حضور للتاريخ من خلال استحضار بعض الوقائع، لكنه استحضار يتمّ في الآن نفسه الذي تحضر فيه اللازمنية. ومن ثمّ، الذهاب إلى غموض المعنى الشعري، حتى ولو أن الأمر يتعلّق - كما يفترض - بكتابة نثريّة تتقصّد "الوضوح". وكما نجد لدى إيف تاديي، فإن الإيقاع كخاصّيّة أخرى للمحكي الشعري، يحضر في نصّ محمود درويش عبر آلية التكرار الجمالي في الكلمات، في الجمل الأساسية (الجمل - المفاتيح)، في تكرار بعض الصور والأحداث... إلخ، ما يجعل السرد التفافياً يتخذ صورة الدائرة (الولادة والموت، الخروج والعودة، الوطن والمنفى والوطن). كما أن أهم خاصّيّة في المحكي الشعري تحضر هنا أيضاً، وهي أن التجربة التي يعيد هذا المحكي كتابتها (رَسْمَهَا) هي تجربة واحدة، وإن تعدّدت تجلّياتها وتنوّعت؛ وتتطلّب "بنية لها وحدة القصيدة وانسجامها وغموضها، أكثر مما يكون لها تنافر الرواية واختلاطها" (إيف تاديي - المدخل).
2
الشاعر غير معني بتعميم خبر سردي عن حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وحتى عن حياته الشعريّة (وإن كان يلامسها قليلاً). وإنما هو يكتب هذا النص - هذا الكتاب، ليقدّم لنا السيرة الذاتية لقصيدته، كما أشرت، بالنَّفَس ذاته الذي يكتب به قصيدته ذاتها. ولذلك، قَلَّت شهيته للتفاصيل العمومية، وهي وافرة وغزيرة لديه - لو أراد، أو لو كانت تهمّ استراتيجية كتابته أساساً في هذا العمل - وإنما كان منشغلاً بإنجاز نصّ نثري شفيف أصبح في جلّ مستوياته قصيدة نثر حقيقيّة.
ويخطئ من يطالب نصّ "في حضرة الغياب" بوظيفة نفعيّة. إنه محكي شعري يشتغل على عناصر واقعية، معيشة، معلومة، تنتسب إلى الفضاء السيرذاتي للشاعر. وبدلاً من أن يكتب الشاعر هذه العناصر بتقنيّة التأريخ أو التوثيق والتدوين الذي يميّز في العادة كتابة المذكرات واليوميات، فإنه فضّل نهج أسلوب المحكي الشعري مستثمراً جماليات هذا الجنس وبعض تقنياته، متيحاً لنفسه قدراً من التخيّل الذاتي (Autofiction)، على الأقلّ في تأطير البناء السردي للنصّ من خلال تقنيّة مضاعفة الذات المتكلّمة في النصّ (شخصان في شخص واحد؛ "تصير إلى اثنين: واحد يقول نعم، وواحد يقول كلا"، "في حضرة الغياب" ص. 141). وبالتالي، فإن ما نقرأه في هذا العمل الجميل، الودود، الناعم والقاسي، هو نصّ محمود درويش (الشاعر العربي الفلسطيني الكبير) ونصّ الشاعر الافتراضي أو المتكلّم المضاعف (المركّب من شخصين، ومن صوتين يكثّفهما في الغالب صوت مهيمن). في معنى أننا أمام نصّ يستثمر خطاب الواقع الملموس وخطاب الواقع المتخيّل (الحلميّ، الاستيهاميّ، الكابوسيّ). ولنقل أيضاً، إن هذا العمل يلعب بإمكانيتين نصيّتين: بالخطاب الفعلي الملقى... وبالخطاب المختلَق، الكاذب، الماكر، الفاتن، الذي ليس في جوهره إلا خطاب الشعر. ومن ثمّ صدق السارد (الذات المتكلّمة في النصّ) عندما قال بأن "ليس على الشاعر من حرج إن كذب. وهو لا يكذب إلا في الحبّ..." (في حضرة الغياب، ص. 10).
يُبَئِّر الشاعر خطابه الحكائي الشعري تبئيراً مخادعاً. إنه يحكي عن نفسه فيما يحكي عن "الآخر" الذي يتذرّع به، وليس ثمة من آخر غير الشاعر نفسه. وثمة سردية داخلية يقوم بها الشاعر - السارد عبر موضوعه الموصوف، بينما يراهن على أن يستكملها القارئ، المؤهّل شعرياً وسردياً وجمالياً، بما يعرفه عن مسار حياة الشاعر، وعن أهم علامات تجربته الإنسانيّة التي سبق للشاعر أن امتصّها في شعره، وفي نصوصه الموازية. البناء السردي الذي يتخذ له هنا فضاء المحكي الشعري ولغة قصيدة النثر عموماً، لا يقول أي شيء ولا يقول كلّ شيء. وهو ليس سرداً تقليدياً خطياً تتخلله وقفات وصفيّة، وإنما هو سرد قائم على نوع من الذهاب والإياب، بل يكاد يكون مجمل الإطار الحكائي في الكتاب قد تمّ داخل لحظة واحدة ممتدّة ومسترسلة، يحرّكها التأمّل الوجودي أو التعليق السريع الساخر أو السؤال أو الاستطراد الفني. وذلك ما يتحكّم في وتيرة السرد ويكسبها جمالية وشاعرية وقوّة. وهو ينوّع الخطاب من خطاب حكائي إلى خطاب تأمّلي، إلى خطاب شعري (نثري أو تفعيلي)، إلى خطاب يوميات...، كي لا تتعطّل حكاية النصّ، الحَيِيَّة، ذات الصوت الخفيض، التي ليست في العمق إلا حكاية قصيدة، أو بالأحرى حكاية حياة فرديّة في أقصى لحظات عزلتها وهشاشتها وصمتها... تتحوّل لتصبح حكاية قصيدة أولاً وأساساً، وليس لتصبح حكاية شخص يريد للحظة ألمه و"موته" أن تتحوّل إلى بطولة للادّعاء أو التمجيد أو جلال التقديس.
لذلك، ينبغي أن نتوقع سوء فهم لهذا النصّ الذي يراوغ أفق الانتظار النمطي التقليدي. والمراد أن ترتقي القراءة إلى مستوى الخطاب الشعري الرفيع المكثّف في هذه التجربة الإبداعية التي يخوضها محمود درويش بجسارة. صحيح أن عدداً من المعطيات الإحالية في النص معروفة ومتداولة، لكن الشاعر بإعادتها أو استعادتها يكاد يقول لنا بأن المهم ليس أن تعرفوا ما تعرفونه عني (وسبق أن قلته أو كتبته)، وإنما المهم أن تتعرّفوا إلى طريقة مغايرة في التمثّل والنظر إلى ماتعرفونه عني. ونحن نعرف مسبقاً (نظرياً على الأقل) أن المحكي النثري استثمر دائماً موارد التغيّر الداخلي، وإن كان استثماراً أكثر احتشاماً مما نجده في تعبيرات فنيّة أخرى (جيرار جونيت، عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد المعتصم، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء 2000، ص 31). وليس من شك في أن الخطاب الشعري ككل، ومنه المحكي الشعري، هو المؤهّل أكثر لاستثمار هذه الموارد الذاتية التي توفّرها السيرورة الباطنية للشاعر، لوعيه الشعري، لحساسيته اللغويّة والمعجميّة والجماليّة والفنيّة، ولأفق قصيدته.
وليس التبئير وحده الذي جاء ماكراً في بناء هذا النصّ، وإنما نجد أيضاً أن السيرورة الزمنية - بما هي سيرورة زمنية لمحكيّ شعريّ - قامت على زمنية مخادعة. إنها تقفز على الكثير من اللحظات، فيما يبدو للوهلة الأولى أنها تمرّ بمجموع اللحظات التي عاشها الشاعر خلال حياته (في فلسطين النكبة وهو طفل، وفي لبنان، وبعد الخروج من فلسطين المحتلة: في القاهرة، بيروت، دمشق، تونس، باريس... وفي مختلف العواصم والمطارات والمنافي الصديقة والشقيقة). إن المحكي ينتقل من لحظة في الماضي إلى لحظة في المستقبل، ومن لحظة في الحاضر إلى أخرى في الماضي، ومن لحظة الواقع إلى لحظة الحلم أو الكابوس. وذلك كلّه اعتماداً على ذاكرة انتقائيّة، تصطفي وترتّب عناصر التجربة الإنسانيّة التي تشكّل المادّة الخام للقصيدة. كما يعتمد الشاعر كذلك كثافة المحكي، عبر تكثيف وتسريع الخطاب الذي يحكي، مقابل الامتداد الزمني للواقع المعيش الذي يتمثّله المحكي الشعري. وبعملية بسيطة، نجد أن أربعاً وستين سنة، هي التي تفصل ما بين تاريخ ميلاد الشاعر (1942) وتاريخ صدور النص (2006)، يتمّ تكثيفها في 181 صفحة من القطع المتوسط. لنقل إننا إن قسمنا 23.360 يوماً على عدد صفحات الكتاب نحصل على معدل 129.06 يوماً لكل صفحة واحدة. طبعاً، ما من رهان كبير على "دلالة كبيرة"، بتعبير جيرار جونيت، في هذه المقارنة الطريفة، لكننا نريد القول إن الأمر لا يتعلّق بسيرة ذاتية للشاعر، وثمة تضحية واضحة بالكثير من تفاصيل الحياة التي عاشها محمود درويش فعليّاً. وبالتالي، فنحن أمام كتابة تعتصر حياة الشاعر لتحتفظ لنفسها بما يتيح للغة الشعريّة الكثافة والوجازة والاقتصاد الخلاّق الموحي.
3
إذاً، في هذا الكتاب ثمة ملفوظ شعريّ، وثمة تحليل شعريّ لهذا الملفوظ في الآن نفسه. ثمة خطاب شعريّ (أدبيّ) مضاعف، خطاب يقول نفسه فيما هو يحلل ويتأمّل نفسه أيضاً. وهو خطاب مضاعف، بهذا المعنى، يتحدّث بصوت مضاعف، الصوت الذي يقول النصّ ويتكلّم فيه، ويقدّم عن نفسه "صورة ذاتيّة" (أوتوبورتريه) تتداخل مع السيرة الذاتيّة للقصيدة. وإذا أدركنا أن النصّ المكتوب يمنح للقراءة حيزاً من الكلام، حيّز شخص يتكلّم بداخله عن شخص آخر لا يتكلّم (وإن كان حاضراً، ولو في حضرة الغياب)، نجد أنفسنا أمام مكوّنات "خطابٍ عاشقٍ"، بالتحديد الذي أعطاه رولان بارت لهذا المفهوم.
الشاعر الذي أصبح أيضاً سارداً في هذا المحكي الشعري يتيح لنفسه حريّة أكبر مما قد يتيحها له، عادةً، النصّ الشعريّ المخصوص (النصّ الشعريّ التفعيليّ تحديداً)، فـ"يجري داخل رأسه"، والعبارة لبارت، أي داخل المساحات الممتدّة للذاكرة ليداعب مدّخراته النفسيّة والأدبيّة والسوسيوثقافيّة والسياسيّة، بل والجسديّة أيضاً (للجسد ذاكرته، للحواس بالطبع). وهو، وإن كان لا يقول جديداً عن حياته، لكنه يقول ما نعرفه عنه بطريقة جديدة، وببنية إيقاعيّة جديدة. ومثل كلّ خطاب عاشق، فإننا كلّما قرأناه بدا لنا أننا نعرف هذا المحكي أو هذا القول، "نتعرّف إلى هذا المشهد اللغوي" (بارت) الذي نعرفه بالطبع لأنه مشهد ذاكرة مشتركة بين الشاعر والقارئ داخل النصّ وخارجه. مشهد شيّدته مشاعر وأحاسيس الشغف المشترك بين الكتابة والقراءة. وهو مشهد يعيد تكوينه هنا المتخيّل الشعري والرغبة الجماليّة وجسارة البوح بالشخصي والخصوصي والحميمي.
ومرّة أخرى، كي نلامس خصائص المحكي الشعري، فإن هذا النصّ لا يبتغي "إسماع كلّ ضجيج الأرض"، بتعبير جان إيف تاديي، وإنما يتوسّل لغة متكتّمة، سرّيّة تحتاج - كي تُفهَم - إلى إحساس مختلف بها وترجيعها عبر الذات القارئة. وإن محمود درويش، الشاعر الماكر الذي يعرف معنى وضعه الاعتباري في الساحة الفلسطينية والعربية، ساحة القراءة النمطيّة عموماً وساحة الصراع والاحتراب والواجب والوظيفة، ينأى بنفسه قليلاً ليكتب نصّه الشخصيّ - "سطره الخاص" (في حضرة الغياب، ص. 99) وليقوله بكثير من الصمت، وبتقاطع واضح مع ظلال القول. لذلك، نخطئ إن قرأنا "في حضرة الغياب" على ضوء ما نعرفه عن الإحالات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة لوضع الشاعر في مجتمعه وسياقه العمومي، بل ينبغي أن نقرأه على ضوء ما يقوله النصّ ذاته. وهو في هذا المعنى، ليس إلا أثراً لخطوات الشاعر وليس تقريراً تفصيليّاً عن الخطوات التي خطاها. وهو صورة عن الطريق التي تسلكها القصيدة الدرويشيّة كي تخرج من بين ثنايا الروح وجروح الجسد ومتاعبه، وليست الطريق الفعليّة التي مشاها الشاعر. والنصّ، إن شئنا، هو رحمٌ لنصٍّ تفصيلي لم ينكتب بعدُ بالكامل، وإن كانت تجلّيات منه قد ظهرت في العديد من نصوص الشاعر الموازية (كتب سابقة، قصائد، شهادات وكلمات، حوارات، رسائل منشورة، افتتاحيات بعض المجلاّت الثقافيّة والفكريّة، خاصة "الكرمل"، أفلام وتسجيلات صوتيّة... إلخ).
4
لقد اختار درويش الشكل الأفضل لاستيعاب تجربته الشخصيّة القاسية، تلك التي مرّ خلالها بأقصى وأقسى سفر يمكن أن يسافره المرء في حياته، سفره إلى المستحيل الإنساني، أثناء خضوعه لعمليّة جراحيّة على القلب الواهن، وفي اللحظة التي كان لاواعياً، وكان "لاوعيه يقاوم الموت". وهي لحظة عسيرة قارَبَها شعريّاً في قصيدته المدهشة "جداريّة"، ويعود في هذا النص ليقاربها "نثرياً" من داخل تجربة المحكي الشعري. شخصياً، لم أقرأ هذه اللحظة فقط باعتبارها لحظة محنة جسديّة لشاعر صديق، وإنما كلحظة كانت لها أرجاعها وتأثيرها على القصيدة وعلى المشروع الشعري ككلّ لمحمود درويش. وهو نفسه لم يكتبها من باب توثيق الألم، وإنما لإضاءة نص شعري كتَبَه... وربّما نص شعري آخر لم يكتبه!
ولم ينحرف وعي الشاعر بالموت إلى الفكرة الخاطئة عن الموت. كما أنه لم يفلسف "موته"، وإنما عامله باحترام كشاعر له حصانة اللغة والصورة والإيقاع، وكإنسان هش... تهمّه الراحة ولا يتمناها راحة أبدية. جميل أن ننظر إلى موتنا. هكذا، العين في العين. نصافحه ونعيد معه الجدولة (مثل بنك نعيد معه جدولة الديون!). وحين نُسأل عنه، عند عودتنا الطارئة إلى الحياة بعد سفرنا الطارئ إلى الموت، نقول كما قال الشاعر في نصّه: "أن ترى كما لم ترَ من قبل. أن ترى الضوء أبيض والغيم أبيض والهواء أبيض. أن تخرج من جسدك. ولا تتذكر متى خرجت من جسدك لأنك لا تتذكّر أنك كنت في جسد. أن تعود إلى أوَّلِكَ فيما أنت ذاهب إلى آخِرك. أن تنام ولا تعلم أنك نائم. أن تخرج من الزمان ومن الشكل" (ص. 112). ولذلك، يقال للشاعر - وقد عاد ناجياً من حادثة الموت إلى حادثة الحياة - "أصرخ يا صاحبي، لأعرف أنك حي"، وكأننا بصدد صرخة الميلاد، تلك التي يصرخها الوليد وهو يلتحق لأول مرّة بضجيج الأرض: "... وعلمت فيما بعد أن صرخة الألم كانت دليل عودتك إلى الحياة التي تبدأ وتنتهي بصرخة. وسألت: أين كنت إذاً؟ فقيل لك إن الموت قد اختطفك لمدة دقيقة ونصف الدقيقة، وأن صدمة كهربائية قد أعادتك إلى الحياة" (ص. 113).
هكذا نفهم أن "في حضرة الغياب" محكيٌّ شعري عن لحظة مضاعفة كان الشاعر خلالها في الحياة وفي غيبته في الآن نفسه. إنها القصيدة هنا هي التي تكتب سيرتها كأن "الموديل" ينوب هنا عن الرسام فيرسم نفسه في اللوحة! كتابة درويش في هذا العمل تحقق مستوى نموذجياً لمحكي شعري في النثر (كما سبق لدرويش أن حقق المحكي الشعري النموذجي في الشعر). وهو في هذا "الموديل" النثري، مثلما في كلّ محكي شعري نثري ناجح، يحقق "شكلاً من أشكال المحكي يستعير من القصيدة وسائلها في الفعل ويحدث آثارها" كما يؤكد جان إيف تاديي (كي أستأنس مرّة أخرى بمختصّ). ودرويش في هذا النصّ، ينأى عن توسل "التخيّل" لأن الواقع الذي عاشه وفّر له (ولكتابته) أقصى إمكانات التخيّل التي لا تحتاج معرفة بلاغيّة لتحقيقها، بل يكفي أن "يموت" الشاعر قليلاً (لمدة دقيقة ونصف دقيقة) ليعثر على تخيّلات تتخلق في جسده وفي هاوية ألمه. ومن ثمّ لم يكن الشاعر في حاجة إلى استثمار عنصر التخيّل الذي تنهض عليه الكتابة الروائيّة، وإنما اكتفى بطرائق السرد التي توفرها القصيدة، وتحديداً قصيدة النثر، وتمكّن من أن يعثر على الإيقاع الملائم كي يجنّب كتابته تلك المواجهة المفترضة في كلّ محكي شعري، بين الوظيفة المرجعيّة (الإحاليّة) بما قد توفره من إمكانات الاستعادة والتشخيص، والوظيفة الشعريّة بإمكاناتها الذاتيّة على مستوى اللغة والصورة والإيقاع... وما إلى ذلك. بل يمضي درويش بعيداً في تمسّكه بما توفره شعريّة القصيدة لشعريّة النثر، عبر الاشتغال بنظام كامل من التعارضات والتناظرات والاسترجاعات والتصاديات، بل واستثمار بعض التوازيات الدلاليّة والتقابلات بين وحدات المعنى (أمكنة وعواصم وروائح وأحداث ووجوه وأفكار... إلخ). وأكثر من ذلك، وصل بمحكيّه الشعري إلى حدّه الأقصى في مقاطع تفعيليّة ختم بها بعض فصول الكتاب، ناهيك عمّا يمكننا العثور عليه من وفرة في الصور والجمل الموسيقية والمصوتات، في سرده النثري، مع أنها عناصر من مقوّمات القصيدة كما نعلم.
5
إلى جانب الأهمية التي يكتسيها شكل البناء في هذا النصّ القائم على تركيب الشعري والنثري، واعتماد المحكي الشعري على مستوى التجنيس، فإن لثيمة الغياب هيمنة دلاليّة وجماليّة تخترق النصّ في كلّيته، وفي سيرورته الحكائيّة، وكذا على مستوى سرديته التي حكمتها تقنيّة الصوت المضاعف من البداية إلى النهاية.
والغياب في هذا النصّ هو اختبار للفقدان الشخصي أساساً، بالرغم من أنه غياب يستحضر كلّ أنواع الغياب الأخرى للشاعر، فثمة غياب المكان الأثير، غياب اللحظة المثلى، غياب الآخر المنشود، لكن أقصى (أقسى) غياب في النصّ هو غياب الذات: أن تكون هذه الذات هنا فيما هي ليست هنا. أن تكون في الحياة فيما هي في الموت أيضاً. وأن تكون في الموت (لمدّة دقيقة ونصف الدقيقة) فيما هي كانت ما تزال ذاتاً محسوبة على الحياة وتنتسب إليها.
من هذه الفكرة، فكرة الشاعر الأصليّة التي لم يعثر عليها في مرجع قرأه أو لدى شخص آخر حدّثه، من هذه البذرة الملتهبة التي استخرجها الشاعر من حمأة اللحظة الجسديّة العنيفة التي عبرها، انبثقت آليّة التضعيف الصوتيّ التي قلنا إنها حكمت كليّة هذا النصّ الاستثنائي الفاتن. يفتتح محمود درويش محكيه، بالكشف منذ انطلاق النص عن أوراقه: "سطراً سطراً أنثرك أمامي بكفاءة لم أُوتَها إلا في المطالع/ وكما أوصيتني، أقف الآن باسمك كي أشكر مشَيِّعيك إلى هذا السفر الأخير، وأدعوهم إلى اختصار الوداع، والانصراف إلى عشاء احتفالي يليق بذكراك/ فلتأذن لي بأن أراك، وقد خرجت مني وخرجت منك سالماً كالنثر المصفّى على حجر يخضرّ أو يصفرّ في غيابك" (في حضرة الغياب، ص 9).
هكذا يقتسم الشاعر مع ذاته (مع صوته الآخر) الحصص والمسافة والأشياء (صوته الآخر إلى حياة أخرى وعدته بها اللغة، وهو إلى موت كان قد وعده بكأس نبيذ في إحدى قصائده) وهو يحضر حضوراً مضاعفاً (حضورين اثنين)، يحضر في الحياة ويحضر في غيابها. والغياب، أن تخلص للغياب أيضاً، ألا تغدر به (فلا شيء يهين الموت كالغدر، ص 10). الغياب هو الموت، هنا في هذا الكتاب، حيث يكون الشاعر حيّاً ويكون أيضاً مسجّى في الكلام.
إنه غياب لا يشبه أي غياب آخر، وبالخصوص لا يشبه كلّ أنواع الغياب التي اعتدناها تملأ القصائد وتضجّ بها الأغاني وأناشيد الحبّ، وحتى أناشيد الموت (المراثي والتعازي). فلا هو غياب شخص قد يعود، ولا هو موت شخص جدير بالرثاء، وإنما هو خطاب عن شخص فقد نفسه، أو بالأحرى هو تأمّل رجُل حيّ في جسده المسجّى أمامه! في هذا الغياب القاسي، الغياب التراجيدي، لا أحد يغادر ليبقى آخر في انتظاره (كما في قصص الحب وقصائده!). إنها قصّة أو قصيدة ذاتٍ تخرج من ذاتها، فلا تبقى ولا ترحل. وإنما هي هنا وليست هنا في آن واحد. لذلك، يراوغ الشاعر غيابه محوّلاً التفاوت القائم بين "ذهابه" من الذات و"إيابه" إليها، فينتج إيقاعاً آخر "فاتحاً مشهد اللغة" ليستولد اللغة من الغياب (بارت، شذرات من خطاب عاشق). وبالتالي، يصبح الغياب منتجاً للمعنى، بؤرة نشيطة يتمركز حولها الانشغال الأساس للنصّ. ذلك الانشغال الذي يشغل عن أي شيء آخر، أي أن ثمة، بالمعنى البارتي، إبداعاً لخيال متعدّد الوظائف يستدعي كلّ الارتيابات والرغبات والاكتئابات في شكل إخراج لغوي mise en scène langagière عادة ما يبعد الموت عن الآخر (الغائب) في أنواع الغياب الأخرى السائد. وهو في هذا النصّ تحديداً يبعد الموت عن الذات، ومن ثمّ فمراوغة الغياب (استعماله) هي أن تمنح امتداداً للحظة الغياب التي لم تستغرق أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة في الواقع، لتجعلها أكثر رحابة كي تستوعب حياة كاملة ومكثّفة. والغياب في "حضرة الغياب" يتجلّى لنا في وصفه غياباً "لا مرجع له". فهو غياب يتحقق من دون أن يتغيب أحد عن أحد كي يكون ثمة أيضاً مرجع للخطاب حول الغياب. ولذلك، فهو غياب في ذاته، كما يمكن أن يكون الشعر في ذاته، أي أن وظيفة الغياب في هذا النصّ هي بامتياز وظيفة شعرية.
في هذا الكتاب الجميل، نحن في حضرة غياب لا يقول إلا ذاته. ومعناه، أننا في صدد شعرية أعمق وأكبر من بؤس بعض القراءات النمطيّة. شعريّة ليست في حاجة إلى من يحاسبها أو يحاكمها بمعايير النثر أو الشعر أو الوزن العروضي أو الوطن أو المقاومة أو البندقية (وذلك كلّه، لا يحتاج فيه محمود درويش لا إلى دروس ولا إلى شهادة من أحد)، وإنما هي شعريّة جسورة تحتاج فقط إلى شعريّة قراءة عاشقة، شغوفة بالجمال، منتصرة للإنسان وللحياة.
إن هذا الكتاب يفتح أفقاً جديداً أمام شعريّة محمود درويش، ويمنحه إمكانات أخرى لإبداع خطاب شعري ينتصر باستمرار على نفسه.
****
"العنوان يعلو النصّ ويمنحه النور اللازم لتتبُّعه"
جاك دريدا
عتبة القراءة
تنبثق أهمية "العنوان" - سليل العنونة - من حيث هو مؤشّر تعريفيّ وتحديديّ، ينقذ "النصّ" من الغفلة، لكونه، أي العنوان، الحدّ الفاصل بين العدم والوجود، الفناء والامتلاء. فأن يمتلك النصّ اسماً (عنواناً)، هو أن يحوز كينونةً، والاسم (العنوان)، في هذه الحال، هو علامة هذه الكينونة: "يموت الكائن، ويبقى اسمه". من هنا، المشقّة التي ترمي بثقلها على المسمّي أو المعنون، وهو يقف إزاء النصّ - الغفل بقصد عنونته وتسميته، فيستبدل العنوان إثر الآخر، كما لو أن العناوين مفاتيح لباب النصّ الموصد، إلى أن يرتضي النصّ عنوانه، ويفلت من العماء، ويستكين إلى ألفة الوجود، ويحوز هوّيته.
هذه الخطورة الأنطولوجيّة الجسيمة التي يتمتّع بها "العنوان"، هي التي لفتت انتباه الباحث، وفرضته موضوعاً للدراسة الراهنة، من حيث إن "العنوان" يعدّ أخطر البؤر النصّيّة التي تحيط بالنصّ، إذ يمثّل العتبة التي تشهد عادةً مفاوضات القبول والرفض بين القارئ والنصّ، فإما عشقٌ ينبجس فتقع لذّة القراءة، وإمّا نكوصٌ ليتسيّد الجفاء مشهدية العلاقة. فالعنوان هو الذي يتيح أولاً الولوج إلى عالم النصّ والتموقع في ردهاته ودهاليزه، لاستكناه أسرار العملية الإبداعيّة وألغازها. هكذا يعرّف "العنوان" النصّ، بتسميته وتحديد تخومه، ومجاله، ثمّ يقتنص قارئاً له، ليدقّ، من ثمّ، نواقيس القراءة، فتشرع عوالم النصّ بالتكشّف والتقوّض في فعل القراءة.
تفرض قصيدة "يطير الحمام" لمحمود درويش اختيارها على الباحث من ضمن النصوص الحداثية العربية المتميّزة، لتكون مثالاً ساطعاً على استراتيجية العنوان في الكتابة الشعريّة وعلاقته بالنصّ من حيث إنّها، وتبعاً لمنظور القراءة، تمثّل نموذجاً للقصيدة الطويلة نسبياً من جهة، ونموذجاً للعنوان الفعلي من جهة أخرى، وإلى جانب هذا وذاك تتمتّع القصيدة بلغة شعريّة عالية، لتغدو "بنيةً منزاحةً" ليس فحسب عن اللغة الاستعماليّة، وإنّما عن اللغة الشعريّة السّائدة، فضلاً عن انبنائها وفق تقنيات متنوّعة: التّفاعل التّناصي مع "نشيد الإنشاد" بصورة رئيسة، الصورة البلاغيّة المربكة للقراءة، بتأسيسها لفجوات ومراوغات ليس من السهولة ملؤها وتصيّدها في الفعل التّأويلي، وكذلك إدخال البعد البوليفوني الذي أتاح للنصّ أن يزخر بأصوات متعدّدة: الكورس، العاشق، العاشقة، الراوي. تشابك هذه الأبعاد يضع المتلقّي إزاء نصّ شعريّ خطير ينذر قارئه بلذّة على وشك الانفجار.
1 ـ مستوى البنية:
ما يلفت الانتباه في هذا العنوان ("يطير الحمام") انبناؤه وفق صيغة فعليّة، أي ابتداؤه بـ"فعل"، وليس ثمة من غرابة مقلقة في الأمر إذا تصفّحنا ديوان محمود درويش إذ تطفح عتبات العناوين بالصيغ الفعليّة. فعلى سبيل المثال، وضمن خرائطيّة فهارس مجموعاته الشعريّة، تتدفّق على المتلقّي العناوين الفعليّة الآتية:
"سنخرج، نزل على البحر، يكتب الراوي: يموت، أسمّيك نرجسةً حول قلبي، سأقطع هذا الطريق، تضيق بنا الأرض، نسير إلى بلد، نسافر كالناس، أقول كلاماً كثيراً، يحقّ لنا أن نحبّ الخريف، يعانق قاتله، سيأتي برابرة آخرون... إلخ"، وإذ نستحضر هذه الصيغ الفعليّة للعنوان لدى محمود درويش - ومثلها الكثير من العناوين الحداثيّة وما بعد الحداثيّة في الشعر العربي - إنما لتتمّ الإشارة إلى أن للعنونة الأحقّيّة في استيلاد عناوين من خلال الصيغ الفعليّة، مثلها مثل الصيغ الاسمية، بل إنها في حضورها تؤدّي وظيفةً مزدوجةً في اشتغالها كعتبة للنصّ: وظيفة التسمية، من حيث أنها تعنون النص، أي تمارس التعيين والتحديد، فترسم خطوط كينونة النصّ وفضاءه، أي أنها تتقمّص "الاسميّة" عنواناً للنصّ، وفي الوظيفة الأخرى تسعى "الصيغة الفعليّة" إلى تحطيم هيمنة الصيغة"الاسميّة" ، في احتكارها للعنونة وسيطرتها الأبديّة على أبنية العناوين، وبهذا الشكل يدشّن "العنوان" اختلافه عن "الاسم العلم" في تبنّيه الصيغة الفعليّة.
وإذا كان الأمر كذلك، فلنمضِ باتجاه أسرار بنية العنوان: "يطير الحمام":
على المستوى التّركيبي يتمظهر "العنوان" في مركّب فعليّ، أي تلك "الهيئة التّركيبيّة المبدوءة في الأصل بفعل تام" ، مشكّلاً بذلك مركّباً إسنادياً في شكل "جملة بسيطة" من حيث أداؤها لفكرة مستقلّة، مكتفيةً بذاتها: طيران الحمام. غير أنّ ميزة العنوان ("يطير الحمام") هنا، قائمة على اشتغاله بصيغة الفعل المضارع: "يطير = يفعل"، وبذلك يدشّن حدث "الطيران" في الزمن الحاضر المستمرّ، بما تدلّ عليه صيغة "يفعل" صرفيّاً وسياقيّاً، وهكذا بتعاضد ذلك مع دلالة الجمع التي يختلقها فاعل الجملة من خلال اسم الجنس الجمعي، يستحوذ العنوان بقوّة على متلقّيه، بإدخاله في مشهد بصريّ حيّ، ليستنطق المشهد بأسئلة من مثيل: إلى أين يطير الحمام؟ لماذا يطير؟... إلخ، وهنا تتحقّق وظيفة العنوان في كونه المنجم الذي لا ينفكّ عن إنتاج الأسئلة، ليدفع بالمتلقي وراء الأجوبة، فيلج متاهة النصّ، ليكون "الطعم" الذي يرميه "الشاعر"، ويغوي القارئ تمهيداً لاصطياده.
أما على المستوى المعجميّ، فينتظم العنوان في حقل دلاليّ وفق علاقة الاشتمال ما بين مفردتَي "الحمام" و"يطير"، حيث "الطيران" سمة دلاليّة من سمات "الحمام". غير أن المعنى الدّلالي لا يتميّز إلا بمقابله التضادي في معنى أن الفعل "يطير" يستدعي على الفور فعلاً مضاداً لـه "يحطّ"، وهكذا ينبني الحقل الدلالي - فضلاً عن علاقة الاشتمال بتضمّن مفردة "الحمام" للفعلين "يطير، يحطّ" - على علاقة التّضادّ الناشبة بين الفعلين "يطير، يحطّ"، وهو تضادّ اتجاهي Directional opposition تتضح معالمه من خلال المربّع السيميائي :
| يطير | تضادّ | يحطّ |
| |
| لا يطير | تحت التضادّ | لا يحطّ |
وهكذا يدخل الفعل "يطير" دلاليّاً في جملة علاقات يتحدّد بها معناه:
- علاقة تضادّ: يطير - يحطّ.
- علاقة تناقض: يطير - لا يطير.
- علاقة تداخل: يطير - لا يحطّ.
- علاقة ما تحت التضاد: لا يحط - لا يطير.
بناءً على ما تقدّم من علاقات، يتبنّى العنوان العلاقة التضادّية التي تسمطق حركة "الحمام"، بجعلها حركةً ذات مغزى ودلالة نتيجةً لما ينجم عنها من تناسل ثنائيات تضادّية، يترتّب بعضها عن بعض: السماء  الأرض، الصعود
الأرض، الصعود  الهبوط، الأعلى
الهبوط، الأعلى  الأسفل، وكلّها ثنائيات مشحونة بالقيمة والتفاضل تسم الثقافة التي أنتج فيها النصّ، فالكيانات المتصارعة محمّلة بأبعاد ثقافيّة ودينيّة ونفسيّة سوف تتجلّى في الانعطافات اللاحقة لفعل القراءة.
الأسفل، وكلّها ثنائيات مشحونة بالقيمة والتفاضل تسم الثقافة التي أنتج فيها النصّ، فالكيانات المتصارعة محمّلة بأبعاد ثقافيّة ودينيّة ونفسيّة سوف تتجلّى في الانعطافات اللاحقة لفعل القراءة.
إذا كان هذا حال المستوى المعجمي للعنوان بعلاقاته الدلاليّة فكيف يتجلّى مجازياً؟ وفي معنى آخر، كيف يتحرّك العنوان ("يطير الحمام") من التدليل على حدث يوميّ إلى كونه بنيةً سيميوطيقيةً لا تتقن سوى التشظّي، والشطب والاختلاف؟
وسوف ننظر إلى العنوان في مستواه المجازي من خلال مفهومَي "الاستعارة" و"الرمز"، ولنبدأ بالعنوان في وصفه بنيةً استعاريةً. إلى ذلك، وفي قراءة للاستعارة، يقول بول ريكور: "إن الاستعارة ليست تزويقاً لفظياً للخطاب. بل لها أكثر من قيمة انفعاليّة، لأنها تعطينا معلومات جديدة. وبوجيز العبارة، تخبرنا الاستعارة شيئاً جديداً عن الواقع"، فما الشيء الجديد الذي تبوح به استعاريّة العنوان؟ تستند القراءة في تأويلها للبنية البلاغيّة للعنوان على الكائنات النصيّة الحاضرة والغائبة بالتكافؤ المعجمي بينها عبر المشابهة. وهذه العناصر هي:
ـ الحمام  عاشق وعاشقة.
عاشق وعاشقة.
ـ [ يطير  يحطّ
يحطّ  ] فعل الحب.
] فعل الحب.
لكن كيف يمكن تسويغ هذا التأويل؟
استناداً إلى هذه التكافؤات المعجميّة، يستبدّ العنوان بعنصريه موقع "المشبّه به"، والعناصر المكافئة لها موقع "المشبّه"، وبذلك يندرج العنوان استعاريّاً في ما يسمّى بـ"الاستعارة التصريحيّة"، حيث يصرّح بـ"المشبّه به" وتغييب "المشبّه" الذي يتقمص كينونة "المشبّه به"، يقول الجرجاني: "فالاستعارة: أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبّه به، فتعيره المشبّه، وتجريه عليه"، ولكون الأمر كذلك، يتلبّس اللغز الاستعارة، وهنا تنهض القرائن السياقيّة في تفكيك لغزية الاستعارة. غير أن العنوان "يطير الحمام" يفتقد إلى هذه القرائن، ومن هنا نلجأ إلى السياق العام أقصد السياق الثقافي، وما يقدّمه من مؤشرات تدعم الزعم الذي نطرحه هنا. وفي هذا الإطار تقدّم لنا كتابات الجاحظ تماثلات بين "الحمام" و"الناس"، فمن أولى بروتوكولات العلاقة بين الإنسان والحمام: الحب "ومن مناقب الحمام حبّه للناس، وأنس الناس به"، وفي موقع آخر: "ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوق. وذلك يدلّ على ثبات العهد، وحفظ ما ينبغي أن يحفظ، وصون ما ينبغي أن يصان..."، كما يشير الجاحظ إلى تقاطعهما (الحمام والناس) في الشهوة: "وفي الإنسان ضروبٌ من القوى: أحدها فضل الشهوة، والأخرى دوام الشهوة في جميع الدهر، والأخرى قوّة التصنع، وأنت إذا جمعت خصاله كلها كانت دون قوّة الحمام عند فراغه من حاجته وهذه فضيلة لا ينكرها أحد، ومزية لا يجحدها أحد!"، لكن المشابهة تبلغ الذروة في ما يورده الجاحظ من حديث أحد أئمة الحمام: "لم أرَ شيئاً قطّ في رجل وامرأة إلا وقد رأيت مثله في الذكر والأنثى في الحمام" . هذه البيانات كمؤشّرات قرائيّة تقودنا إلى القول: إن العنوان ("يطير الحمام") يفيض عن معناه الحرفي إلى معناه المجازي، بالانتقال من المشهد البصري الاعتيادي لطيور الحمام إلى مشهد يخصّ كائنات إنسانيّة بامتياز، وبذلك تنسف الاستعارة العلاقة العرفيّة بين الدالّ = يطير الحمام، و المدلول = المشهد البصري لطيران الحمام، ليغدو الدالّ عاشقين والمدلول مجامعةً جنسيةً، فالاستعارة تفتح فجوةً بين الدّال ومدلوله العرفي و"كأنها طعنةٌ انتقاميةٌ خاطفةٌ" للتداول العرفي للعلامة اللغويّة.
لكن ما الذي يطرأ على العنوان ("يطير الحمام") بانتقاله من مجال الاستعارة إلى مجال الرمز؟
المجال الرّمزي هو الذي يتضاعف فيه "العنوان" دلاليّاً ويتعدّد، وتشطب فيه الدلالة السابقة لحساب الدلالة الراهنة، والأخيرة لمصلحة دلالة قادمة برسم الانبثاق، وبذلك ينفلت "الرمز" من سطوة السياق النصيّ وقرائنه - على عكس الاستعارة - لتغدو "العلامة - الرّمز" كائناً هائماً على وجهه، تراوغه المدلولات، وليس لـه عندئذ سوى ممارسة لذّة الانزلاق ومتعته. وحتّى تحيط القراءة بهذه الدلالات المرتقبة دون محاصرتها، يمكن تقديم الترسيمة الآتية:
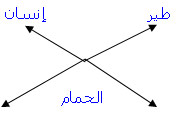
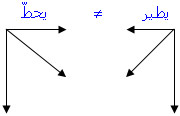
 | مشهد جنسي |  |
| السماء | الأرض |
| الصعود | الهبوط |
| الأعلى | الأسفل |
| | |
رمزياً، وفي مستوى أوّل، ينذر العنوان ("يطير الحمام") بخطر داهم، وبذلك يتقمّص العنوان لافتة إنذار، فالطيران - وبخاصة بالنسبة إلى طائر أليف مثل الحمام - لا يحدث إلاّ باضطراب يقع في موطنه، وفي هذا الإطار يستقطب الفعل "يطير" ما يعضد هذه الدلالة من حيث مراكمته لدلالات: الفزع والخوف (طار قلبه)، والاضطراب (طارت نفسه) وما يرتبط بذلك من بلبلة وشرّ وتشاؤم: التطاير: "التفرّق والذهاب، (...) والطائر: ما تيمّنت به أو تشاءمت وأصله في ذي الجناح. (...)، والطائر الحظّ من الخير والشر" ، وبذلك يكون "طيران الحمام" مؤشراً على فأل سيء، ومن هنا المماثلة بين الشؤم والطير في الثقافة العربية: "وقيل للشؤم طائرٌ وطيرٌ وطيرةٌ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها، والتطيّر ببارحها ونعيق غرابها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها، فسمّوا الشّؤم طيراً وطائراً وطيرةً لتشاؤمهم بها" . وفي مستوى ثانٍ، وإذا أخذنا بالحسبان الدلالة الاستعاريّة للعنوان، يرمز العنوان إلى الخفّة والطيش، أليس العشق موصوفاً بهاتين الصفتين؟ نظراً لارتباطه بنوازع الكائن وأهوائه: "وفي فلان طيرةٌ وطير وطيرورةٌ أي خفّةٌ وطيشٌ، (...). وفي الحديث إيّاك وطيرات الشباب، أي زلاّتهم وعثراتهم" ، وما العشق وما يترتّب عليه إلاّ هذه الزلات التي يتصف بها الكائن في أوجه، وهكذا يختلق "العنوان" في رمزيّته الثقافيّة دلالات القلق والتفرّق، وما يرتبط به من تشاؤم، والطيش وما يتركه من متعة وسعادة في نفس الطائش.
وتمعن "العلامة - الحمام" في ارتكاب دلالات أخرى، إذ ترمز "الحمامة" إلى السلام "حمامة بيكاسو" ، وما تفترضه هذه الدلالة من علاقات الوئام بين الشعوب بعيداً عن ضجيج الحروب والقتل. غير أن "الحمامة" ترتبط في الثقافة الشرقية بـ"البشارة"، وذلك في زمن سحيق من تاريخ البشريّة. يحدّثنا "العهد القديم" الحكاية الآتية: "وحدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب. فخرج متردّداً حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلّت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقرّاً لرجلها. فرجعت إليه إلى الفلك. لأن مياهاً كانت على وجه كلّ الأرض. فمدّ يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضاً سبعة أيّام أخر وعاد وأرسل الحمامة من الفلك. فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذ ورقة زيتون خضراء في فمها" . يؤسّس الخطاب الديني لتضاد دلاليّ (وبضدّها تتمايز الأشياء) بين الحمامة والغراب من جهة، وائتلاف دلاليّ بين كلّ من "الحمامة والحياة ( = ورقة زيتون خضراء) "، و"الحمامة والبشارة"، بعودة الكينونة إلى الفضاء الأرضيّ.
ويمكن هذه الرمزيّة الثقافيّة أن تغتني وتثرى بالبعد النفسي لرمزيّة العنوان. فهل يمكن قراءة العنوان ("يطير الحمام") على أنه بنية حلميّة؟ وهنا يتخذ العنوان مستويات من التفسير والتأويل، نظراً لتقاطع الرمز والاستعارة في بنية الحلم: يطير الحمام، حيث يتقمّص "الحالم" صورة طير "الحمام"، ويغدو "الطيران" الفعل الذي يؤدّيه في فضاء الحلم، وبذلك يغدو "الحالم" نهباً لصراعات نفسيّة عميقة تتحدّد بالحركة (الطيران) بين السماء - الأرض، الصعود - الهبوط، الأعلى - الأسفل، في هذا المفصل يغدو النسق الأوّل: السماء، الصعود، الأعلى موضوع الرغبة، أي موضوعاً للاتصال، في حين يصبح النسق الآخر والمضادّ: الأرض، الهبوط، الأسفل موضوعاً للانفصال. وهكذا يحيلنا فعل "الطيران" على دلالات متنوّعة، فعلى صعيد علاقة "الطيران" بثنائية: السماء الأرض - والأمر يستغرق الثنائيتين الأخريين - يمثّل الحدّ الأوّل: الحرّيّة، حيث "الرغبة في الحرية قد يكون لها أكثر من طريقة للتعبير، فقد يشير الطيران إلى الرغبة في الاتجاه القدسي، والتشوّق إلى الخلود" ، فالأعلى قرين المقدّس والخلود والحياة المفارقة للفناء، في حين تمثّل الأرض القسوة والتعسّف، فيقتنص "الطيران" دلالة "الرغبة في الهروب من ارتباط المرء بالأرض، من الوجود العادي المملّ بكلّ مسؤولياته الرئيسية، وبالتالي الطيران لممالك أحلام اليقظة والخيالات" . هكذا تنبثق ثنائيّة إضافيّة من ثنايا الثنائيات المذكورة، وأقصد تدليل "الطيران" من خلال النسق الأوّل على "الخلود"، وبعكسه الفناء متمثّلاً بالنسق الثاني. كذلك يكتسب "الطيران" في انزلاقاته المثيرة دلالات التفوّق والسيطرة، لأنه يتخذ من "الأعلى" فضاءً لـه، فقد "يشير الطيران على المستوى العملي إلى رغبة الحالم في تجاوز وتخطّي الصعاب، برفع نفسه فوق تعقيدات الروتين ومشاكل الحياة اليومية، أو يرفع نفسه ويرقّيها فوق الآخرين من أجل التفوّق والسيطرة أو محاولة لتعويض شعوره بالنقص" . والفضاء العالي يتلاءم مع فكرة التفوّق والسيطرة، وما القصور، والأبنية إلا دلائل غير لغويّة على محاولات السيطرة والهيمنة والتفوّق على الآخرين.
هذه هي فعاليّة "الرمز" حيث الاختراق وهتك الحدود والقيود والاعتماد على تداعيات حرّة في التدليل. والآن ماذا يمكن للقراءة أن تسجّل بخصوص هذا الانفجار الدلاليّ الناجم عن تفكيك العنوان عبر تشظّيه إلى دلالات تنبثق وتختفي في فعاليّة القراءة، إذ لا يمكن الرهان على معنىً مستقرّ، وحيد، ومركزي، بقدر ما يتعلّق الأمر بممارسة "العنوان" - في وصفه نصّاً - للعبة إرجاء الدلالات وتأجيلها، فهو في كلّ حركة يرتكب دلالةً ثم يتنكر لها في لعبة مثيرة من إخلافه لهويّة المعنى، ناسفاً حضوره وتمركزه، وبدلاً من تأسيسه لدكتاتورية الحضور - حضور معنىً محدّد وثابت - يسعى "العنوان" إلى تفتيت هويّة المعنى وتماثلها مع نفسها، وبالتالي إحداث الاختلاف في مساره الدلاليّ، وعليه لا يمكن بحال تثبيت العنوان ("يطير الحمام") على حدث يوميّ أو مشهد شهوي أو اضطراب أو طيش... إلخ، بقدر ما يكونها جميعاً أو لا يكون أيّاً منها في الوقت نفسه، مندفعاً بغواية التأجيل الأبديّ، محمّلاً بآثار الدلالات السابقة والراهنة واللاحقة.
2- مستوى التجاذب: معانقات العنوان والنصّ:
تكمن أهمية العناوين في أنها بوّابات غير محروسة بإحكام، ينسلّ منها القراء إلى النصوص، لانتهاك عفّتها وفضّ بكارتها، وهي بذلك مفاتيح يختلسها هؤلاء - في خلسة من الحرّاس - للبحث عن متعة غافية، فالقبض عليها قبضٌ على كلمة "السرّ" التي تقود القرّاء - القراصنة إلى مواقع "الكنز - هل قلنا المتعة؟"، ولهذا تبرز استراتيجيّة العناوين ليس في كونها نصوصاً جماليّةً فحسب، بقدر ما تؤشّر إلى كينونة محتجبة خلفها برسم الاستيقاظ، والكشف عن الأخيرة كشفٌ عن تجربة ورؤيا، تمدّنا بأساليب جديدة في معرفة "العال"، ولذلك كان العنوان "بالنسبة إلى نصّه اللاحق يوجد في وضعيّة مفارقة حسب ليوهوك Léo.H.Hoek إذ عليه أن يخبر وأن يبقى محدود الإخبار في الوقت نفسه" . وهذه السمة هي ما تتوافر في العنوان "يطير الحمام" على نحو كبير، من حيث إنه يمارس التلميح والتأشير والإحالة على ما يجري من أحداث نصّيّة متوارية خلفه، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يؤدّي العنوان مهمّاته الاستراتيجيّة في الكشف عن الكنوز المطمورة؟
لنحدّد، بدايةً، محورَي القراءة بين العنوان والنصّ والنصّ والعنوان:
- الحضور الصيغيّ.
- الحضور الدلاليّ.
ولننطلق من المحور الأوّل:
أ- الحضور الصيغي:
كتب أحد النقّاد: "وقد يكون العنوان بكامله جملةً أو كلمةً من القصيدة ينتقيها الشاعر دون غيره لكونه يراها بؤرةً أو مرتكزاً يشدّ إليه بقيّة الكلمات المسهمة في النسيج اللغوي للنص" ، وهذا ما ينطبق بدقّة على العنوان قيد القراءة، حيث اقتطع من النص، ليكون النواة التي يتكشّف فيها النص، ويرتدّ إليها. وفي الواقع يشكّل العنوان بصيغته ("يطير الحمام") جملةً من جملتين فعليّتين تمثّلان لازمة تكراريّة، تتصدّر كلّ مقطع نصيّ من المقاطع التسعة المكوّنة للنص الشعريّ:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام".
والسؤال الذي يطرح نفسه، وقبل الخوض في الحضور الصيغي للعنوان، لماذا لم تحضر اللازمة التكراريّة في نصّ العنوان بالكامل، وإنما اكتفى الشاعر بجملة منها دون الأخرى؟ ترى القراءة أن الأمر يتعلّق بقضايا تخصّ وظيفة العنوان ذاته، من حيث عليه التقيّد بأقصى اقتصاد لغويّ من جهة، وبالتالي محدوديّته على الإخبار، وبمعنى آخر، فالعنوان نصّ، لكنه نصّ ناقص يتضمّن فجوات وفراغات في بنيته، التي تفجّر الأسئلة في لقاء العنوان بالمتلقّي، وأيّ عنوان يدفع للمتلقّي على نحو مكتمل، سوف يكون بديلاً للنص، وهنا ينحدر العنوان والنص معاً نحو الموت، ولذلك "على العنوان أن يكون مثيراً، مختصراً، ومركّزاً يحمل مجموعة معلومات في شكل مورفولوجي صغير، غير مكتمل، يدفع القارئ إلى طلب زيادة مجموعة معلومات" . ومن جهة أخرى أظهرت القراءة في بنية العنوان أنه بذاته يفترض ضمناً الحدث الدلاليّ المضادّ لـه متمثّلاً بـ"يحطّ الحمام"، فلم يجد الشاعر فائدةً من إثبات اللازمة كاملةً في العنوان بإفساح المجال للمتلقّي بملء الفراغ وإيجاد الضديد الدلاليّ للعنوان.
والسؤال كيف يحضر العنوان في النصّ؟ وما هي أشكال هذا الحضور؟ وما هي مهامّها البنائيّة والدلاليّة في النصّ؟ بدايةً، لنقدّم ترسيمةً بمستويات حضور العنوان في النصّ:
مستويات حضور العنوان في النصّ
| تكرار تضادي | تكرار تطابقي
صيغة المضارع | تكرار تطابقي
صيغة الماضي | تكرار إفرادي | تكرار وزني في مختلف مقاطع النص |
يطير الحمام
يحطّ الحمام
عدد التكرارات تسع مرّات | يطير الحمام
يطير الحمام
عدد التكرارت مرّة واحدة في نهاية المقطع
التاسع | وطار الحمام
وطار الحمام
تكرّرت هذه الصيغة في المقطع التاسع على نحو متقطّع | يطير | الحمام | الرخام
الغمام
الختام
السلام
الكلام
الحمام
وشام
حرام
الكلام
الكلام
الرخام
المنام
مقام
الظلام |
أطير
تكرّرت مرّة واحدة في المقطع الثالث | الحمام
تكرّرت مرّة واحدة في المقطع الثالث |
|
|
يتّخذ حضور العنوان صيغيّاً تقنيّة "التكرار" Repetition بأشكال مختلفة، كما هو مبيّن في التّرسيمة، وما يلفت الانتباه فيها أوّلاً: التكرار التضادّي للعنوان "يطير الحمام" مع ضديده الدلالي "يحطّ الحمام" في عتبة كلّ مقطع من المقاطع التسعة للنصّ، لتغدو هذه اللازمة ("يطير الحمام - يحطّ الحمام") عنواناً فرعياً لكلّ مقطع نصيّ. ومن اللافت للانتباه، أيضاً، أن هذه اللازمة التكرارية - وفق ما يظهره الشكل الطباعي للنص، وبدءاً من المقطع الثاني - تؤدّي دور "نهاية" المقطع السّابق، و"بداية" المقطع اللاحق، وهي بذلك تحقّق معادلةً طارئةً: "نهاية - بداية" أو "بداية - نهاية"، وبذلك يمكن وسمها بـ"لا نهاية - لا بداية"، إنها تتّخذ وضعيّة عنصر بنائيّ غير محسوم.
من جهة أخرى إذا تمعنّا في النص، تظهر المواقع المكانيّة لهذه اللازمة في هندسة النصّ الطباعية فراغات من البياض تفصل بين اللازمة والمقطع النصّيّ، الأمر الذي يدعو إلى الشكّ في تبعيّتها للمقطع النصّيّ، ولهذا لن تكون اللازمة سوى استهلال نصيّ أو دور تمثيليّ لصوت آخر يفتح المشهد الشعري، ليبدأ "العاشق" أو "العاشقة" الحوار على غرار "نشيد الإنشاد" المصدر النصّيّ الذي يتصارع معه درويش بنيةً ودلالةً وتقنيّةً، فهو يستند إلى الطابع الدرامي في البنية النصّيّة، حيث يتيح للكورس (الجوقة) المشاركة بين دوري "الحبيب والحبيبة" في المشاهد الحواريّة بينهما، وعليه ليست اللازمة ("يطير الحمام - يحطّ الحمام") إلا صوت الكورس المنحدر من "نشيد الأناشيد" إلى قصيدة "يطير الحمام".
لكن، ماذا بشأن الدورين البنائيّ والدلاليّ الذي يمارسه التكرار التضادّيّ في مساحة النصّ؟ على الصعيد البنائيّ، وبانبثاق صوت الكورس، تمسرح "اللازمة" الحدث الشعريّ، أي تمنحه بعداً دراميّاً، فيمضي "النصّ" إلى الاشتغال وفق تعدّد صوتي (بوليفوني)، ويتحرّر من سلطة الثنائيّة الصوتيّة التي تسم النصّ تقنيّاً، كما أن قيام اللازمة بدورَي "البداية (النهاية) - النهاية (البداية)" تضمن ربطاً بنيويّاً بين مقاطع النصّ باستمرار الحدث الشعريّ بين المتحاورين من جهة أولى، وبين العنوان ومقاطع النصّ من جهة ثانية، وبين مقاطع النصّ والخاتمة من جهة ثالثة، وأخيراً بين العنوان والخاتمة وفق ما يظهره الشكل الآتي:
يطير الحمام
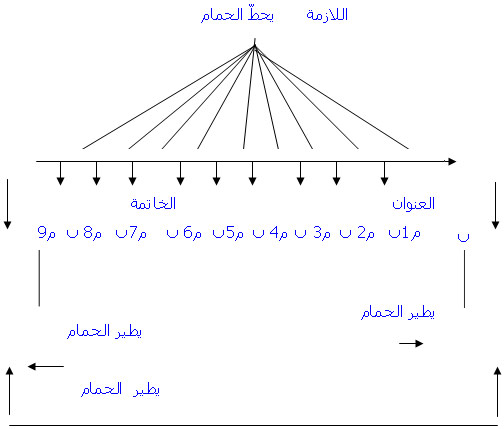
فالشكل الهندسي يوضح قوة التماسك البنائيّ بين مكوّنات النصّ: العنوان، جسد النص، الخاتمة. فالعنوان يرتبط ببداية النصّ من طريق تكراره في اللازمة، والمقاطع ترتبط في ما بينها من طريق "اللازمة" كونها بداية للمقطع السابق ونهاية له، وبداية للمقطع اللاحق، فيما ترتبط الخاتمة بالنصّ من طريق تكرار الحدّ الأوّل من اللازمة ("يطير الحمام") على نحو مزدوج، لترتبط بذلك الخاتمة بكلّ من النّصّ والعنوان، وهكذا تنفتح مكوّنات النص على بعضها: العنوان يحضر في النصّ والخاتمة، وكلاهما في العنوان، فيغدو النصّ دون بداية، دون خاتمة، دون جسد، فكلّ مكوّن يؤدّي دور المكوّن الآخر، الأمر الذي يؤكّد خطورة "العنوان" واستراتيجيّته في البناء والتدليل. وبقدر ما ينتشر العنوان في النصّ والخاتمة بقدر ما يتكثّف الأخيران فيه.
أما الشكل الثاني من حضور العنوان في النصّ فيتمثّل بـ"تكرار تطابقيّ"، وذلك في الخاتمة بتكرار العنوان بصيغته المعهودة على نحو تتابعيّ: "يطير الحمام، يطير الحمام"، وبصيغة الماضي في المقطع التاسع: "وطار الحمام، وطار الحمام"، بفاصل بين التركيبين. فما الذي أدّى إلى هذا التغيير الصيغيّ من المضارع إلى الماضي من جهة، وأخرى مجيء الخاتمة في صيغة تخلو من التضادّ كما في المقاطع النصّيّة السابقة؟ تقتضي الإجابة إيراد المقطع التاسع لإدراك طبيعة التحوّلات والصيرورات في حضور العنوان في النصّ:
"يطير الحمام
يطير الحمام
رأيت على الجسر أندلس الحبّ والحاسة السّادسه
على وردة يابسه
أعاد لها قلبها
وقال: يكلّفني الحبّ ما لا أحبّ
يكلّفني حبّها
ونام القمر
على خاتم ينكسر
وطار الحمام
رأيت على الجسر أندلس الحبّ والحاسّة السادسه
على دمعة يائسه
أعادت لـه قلبه
وقالت: يكلّفني الحبّ ما لا أحبّ
يكلفني حبّه
ونام القمر
على خاتم ينكسر
وطار الحمام
وحطّ على الجسر والعاشقين الظلام
يطير الحمام
يطير الحمام".
يتقدّم المقطع الشعري ليقلب الأدوار رأساً على عقب، إذ شهدت المقاطع الثمانية السابقة عليه تبادلاً للعاشق والعاشقة في مشاهد حواريّة تتفجّر بالرغبة والعشق والوصال، حيث تغدو العاشقة موضوعاً للعاشق، للاتصال به، وبالعكس، غير أن المشهد التاسع يشهد انفصال كلّ فاعل من الفاعلين عن موضوعه، ليتحرّك النصّ من الملهاة إلى المأساة، فكيف يتمّ تأويل ذلك من خلال العنوان؟ التغيير الذي يطرأ على المشهد يتمثّل بتموقع صوت جديد، صوت راوٍ يروي النهاية التراجيدية للعشق بين العاشقين، وذلك باستخدام صيغة الماضي "رأيت" الذي يدلّ على أن الحدث الشعري المتمظهر من خلال صيغة المضارع "يطير الحمام  يحطّ الحمام" جرى في الماضي، وترهينه كان بقصد إدماج المتلقّي في الحدث الشعريّ، لما تدلّ عليه صيغة المضارع من حال واستقبال، ما يجعل الحدث الشعريّ مكتنفاً بالتحوّلات في مسار النصّ، على عكس صيغة الماضي التي يكون الحدث فيها قد أنجز وتحقّق.
يحطّ الحمام" جرى في الماضي، وترهينه كان بقصد إدماج المتلقّي في الحدث الشعريّ، لما تدلّ عليه صيغة المضارع من حال واستقبال، ما يجعل الحدث الشعريّ مكتنفاً بالتحوّلات في مسار النصّ، على عكس صيغة الماضي التي يكون الحدث فيها قد أنجز وتحقّق.
في هذا المشهد، الذي يتفرّع بدوره إلى مشهدين وصفيين، الأوّل يخصّ العاشق والآخر العاشقة، تحدث مأساة الانفصال بين العاشقين ويتمظهر ذلك نصّيّاً من خلال المعجم النصّيّ: "وردة يابسة، نام القمر، خاتم ينكسر، دمعة يائسة"، فالأسماء والأفعال هنا تومئ على التوالي إلى الموت، وحلول العتمة، والانفصال. هذه الدلالات تتساوق مع دلالة الحدّ الثاني من اللازمة أو ضديد العنوان: "يحطّ الحمام"، فالفعل "يحطّ" يفيد دلالات الهمود، والسكون، والفتور، وتبلغ هذه الدلالات ذروة التجلّي في السطرين الأخيرين من المشهد التاسع:
"وطار الحمام
وحطّ على الجسر والعاشقين الظلام".
هكذا تنبثق دلالة جديدة، تدعم التأويل الأخير لضديد العنوان، حيث يتلاءم الفعل "حطّ" مع الفاعل (الظلام) دلالياً، فالظلام يتضمن دلالات الموت والانطفاء والخوف... إلخ، بما يوحي بالانفصال بين العاشقين، ولهذا سوف تأخذ اللازمة الصورة الآتية:
"وطار الحمام
وحطّ (...) الظلام".
وبذلك يشير الحدّ الأوّل إلى التفرّق والذهاب، في حين يشير الحدّ الثاني إلى الهمود والسكون، ليحدث الانفصال والفراق من خلال صيغة الماضي (طار، حطّ) بما لا يتفق مع ثيمة الحبّ التي تتضمن حركة انفعاليّة وجسديّة متشخصة في صيغة المضارع:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام".
وبناءً على ما تقدّم من السهولة بمكان تفسير الخاتمة:
"يطير الحمام
يطير الحمام".
فمن وظائف التكرار التوكيد، كما يشير ابن الأثير: "واعلم أن المفيد من التكرار يأتي في الكلام تأكيداً لـه وتشييداً في أمره، وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي كرّرت فيه كلامك"، وتأتي الخاتمة للإمعان في حال الانفصال بين العاشقين وتأكيده، بإزاحة الضديد "يحطّ الحمام"، وتكرار الحدّ الأوّل "يطير الحمام"، الأمر الذي يؤكّد، في الوقت نفسه، الضديد في صورته الثانية "وحطّ الظلام"، فالتكرار التطابقي: تكرار هشّ لا يشير إلى التطابق بقدر ما يشير إلى الاختلاف، بمعنى آخر، فالخاتمة تسند التأويل الآتي:
"يطير الحمام
يحطّ الظلام".
ثمة شكل آخر من حضور العنوان في النصّ، وهو في الواقع حضور مجموعة من المفردات التي تتعالق مع مفردة "الحمام" في الصيغة وفونيم "الميم": الرخام، الغمام، الختام، السلام، الكلام، الحمام، وشام، حرام... حرام، الكلام، الكلام، الرخام، المنام، مقام، الظلام، وتكمن أهمية هذا النوع من حضور العنوان في مقاطع النصّ في مسارين: الأوّل إيقاعي، فكل مفردة من هذه المفردات، وفي سياقها النصّيّ، تؤسّس تفعيلة: فعولن، وهذا ما يكثّف من بؤر الإيقاع الموسيقي بتضافر البحر المتقارب مع هذه المفردات المنتهية بفونيم "الميم"، وبذلك ترتبط هذه المفردات مع عنصر العنوان "الحمام" في الصيغة والوحدة العروضيّة، ما يدلّ على امتداد العنوان دلاليّاً وإيقاعيّاً في تشكيل جسد النصّ. ويتجسّد المسار الثاني في البعد الدلالي لهذه الكلمات من حيث إنها تتماثل مع أحد عنصرَي العنوان "الحمام" في الصيغة الصرفيّة (فعال) والوزنيّة (فعولن أو فعول)، وتختلف عنه دلاليّاً، وهذا الاختلاف يسهم إلى حدّ كبير بإكساب النصّ تراكمات دلاليّةً وغنىً معجميّاً.
حضور العنوان وانتشاره في النصّ عبر تقنية التكرار بمستويات مختلفة، يظهران طابعاً مميّزاً للغة الشعرية لدى محمود درويش الذي يتكئ في بنينة نصوصه الشعرية على التوازي التركيبيّ القائم على التماثل النحويّ والاختلاف الدلاليّ، كما هي الحال في اللازمة - فالتكرار لا يني منتجاً للاختلاف على الصعيد الدلاليّ، فإذا كان ذلك بيّناً في التكرار التضادّيّ والوزنيّ، فإنه يستمتع بـ"الاختلاف" حتى في إطار التكرار التطابقيّ، كما في قراءتنا للخاتمة "يطير الحمام، يطير الحمام"، وبالتالي "ليس ثمة من "تكرار" حقيقي إلا وهو في خدمة "التمايز" أو هو في مصلحة "اختلاف" يندغم فيه ليفلت به عن حيّز التكرار"، فالتكرار لا يكون إلا بكونه اختلافاً، فما أن يولد حتى يحمل في رحمه بذرة الاختلاف. وإذ نؤكّد إنتاجية التكرار للاختلاف؛ فلأن العلامة اللغويّة المكرّرة لا تنزع إلى "التماثل الدلالي" مع ذاتها، بل "إن قابلية التكرار بما هي تكرار إشارة أو معاودتها تفضي إلى تفتّت الهوية الدلاليّة لهذه الإشارة"، وبمعنى آخر، فالتكرار لا يثبت هوية الكلمة، ويمنحها الاستقرار الدلالي باقتطاع معنىً لها، بقدر ما يفكّك هذا "المعنى"، ويفتح العلامة على الاختلاف، لتختلف مع ذاتها وتتباين على المستوى الدلاليّ.
ب- الحضور الدلاليّ:
إذا كان الحضور الصيغي للعنوان وانتشاره قد كشف أسرار البنية النصّيّة جزئيّاً، فإنه من المدعاة بمكان الكشف عن انتشار العنوان في النصّ، للقبض على اشتغالات العنوان وتحوّلاته دلاليّاً، وبالتالي المعرفة بأسرار البنيّة وغوامضها على صعيد النصّ. وتشرع مجازفة القراءة بالعمل بزعم مفاده أن العنوان مع ضديده يمثّل نواةً نوويّةً تنشطر في المقطع النصّي، فيتمفصل إلى حقلين دلاليّين، تدور كائنات الأوّل حول نواة الحدّ الأوّل: يطير الحمام، وكائنات الحقل الثّاني حول نواة الحدّ الثّاني: يحطّ الحمام، فكيف يمكن القراءة إدراك تشظّيات العنوان في مقاطع النصّ:
ـ المقطع الأول:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
- أعدّي لي الأرض كي أستريح
فإني أحّبك حتى التعب...
صباحك فاكهةٌ للأغاني
وهذا المساء ذهب
ونحن لنا حين يدخل ظلّ إلى ظلّه في الرخام
وأشبه نفسي حين أعلّق نفسي
على عنق لا تعانق غير الغمام
وأنت الهواء الذي يتعرّى أمامي كدمع العنب
وأنت بداية الموج حين تشبّث بالبرّ
حين اغترب
وإني أحبّك، أنت بداية روحي، وأنت الختام".
حين نتأمّل المشهد النصّيّ، وبتعالقه مع اللازمة، يشرع الحقلان الدلاليّان بعمليات جذب الشظايا النصّيّة وأغبرتها إلى مركز الحقل من ناحية، والتجاذب بينهما من ناحية أخرى. في هذا الإطار تستبدّ النواة الدلاليّة "يطير الحمام" بالمعجميّة الآتية: صباحك، الغمام، الهواء، حين اغترب، في حين تجتذب النواة الأخرى "يحطّ الحمام" إليها المعجميّة الآتية: الأرض، المساء، تشبّث بالبر، ومما له دلالته، التساوق الدلالي بين النواة والعناصر الدائرة في مدارها، فالصباح مؤشّر زمنيّ على طلوع الشمس، والغمام يتحرّك نحو الأعالي، في حين أن الفعل "اغترب" يومئ إلى الحركة، فالعناصر الثلاثة تشترك مع النواة في سمة (+ حركة). وبالمثل توحي العناصر الثلاثة الأخرى في الحقل الثاني بالثبات والهمود، وعليه فهي تشترك في سمة (حركة). لكننا حين ننظر إلى النواتين في تجاذبهما، أي في ما توحي به اللازمة من حركة مستمرّة بين الصعود والهبوط دون انقطاع، يغدو المشهد النصّيّ توسيعاً دلاليّاً لهذه البنية التفاعليّة، وإيجازاً لذلك نقدّم ممارسةً قرائيّة لإحدى هذه الموجات الدلاليّة:
"أعدّي لي الأرض كي أستريح
فإني أحبّك حتى التعب...".
تمتدّ هذه الموجة اللغويّة بين المخاطب (العاشق) والمخاطب (العاشقة)، وتؤسّس كينونتها ضمن ما يسمّى "بإنشاء طلب بتحقيق فعل على وجه الاستعلاء" ، ويكشف الخطاب عن طبيعة علاقة المخاطب بالمخاطبة من خلال الجملة الأمريّة، وذلك بخلوّها من التكلّف بين الطرفين، ولذلك اتخذت الجملة صيغة الأمر: أعدّي، لكن ماذا عليها أن تعدّ؟ هنا تنهض طيةٌ دلالية من خلال مفردة "الأرض" المستخدمة - في وصفها مفعولاً به - للفعل أعدّي، حيث تشرع مفردة "الأرض" بالانتقال من مدلول حرفيّ إلى مدلول حاف به، لتومئ إلى "سرير الحب"، فما التقاطع المشترك بين "الأرض" و"السرير"؟، تتخذ مفردة الأرض السمات الآتية: مادة + ممتدّة + غير ممهّدة + سرير واسع، في حين يمتاز السرير بـ: + مادة + ممتدّ + أرض صغيرة، فالعناصر المشتركة بين المفردتين تسمح بدخول "الأرض" في فضاء الاستعارة من حيث يكون "للفظ أصلٌ في الوضع اللغويّ معروفاً تدلّ الشواهد على أنّه اختصّ به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم". وما يخفف من وطأة الطية الدلاليّة ويجعل الاستعارة في متناول التأويل تلك المؤشرات السياقيّة "كي استريح" و"أحبّك"، فهي عناصر كافية لتخفيف التوتر الاستعاريّ في مفردة الأرض. من جهة أخرى تفترض "الأرض" ضديدها الدلاليّ: "السماء"، ليكون المتلقي إزاء ثنائية: السماء  الأرض كصورة دلاليّة أخرى عن "يطير الحمام
الأرض كصورة دلاليّة أخرى عن "يطير الحمام  يحطّ الحمام" أو:
يحطّ الحمام" أو:
"يطير العاشقان
يحطّ العاشقان".
- المقطع الثّاني:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
أنا وحبيبي صوتان في شفة واحده
أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده
وندخل في الحلم، لكنّه يتباطأ كي لا نراه
وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي
وأختار أيامنا بيديّ
كما أختار لي وردة المائده
فنم يا حبيبي
ليصعد صوت البحار إلى ركبتيّ
ونم يا حبيبي
لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسده
ونم يا حبيبي
عليك ضفائر شعري، عليك السلام".
يقدّم لنا المشهد الثاني صورة أخرى من انتشار النواتين الدلاليّتين في المشهد، ويمكن النواة الأولى أن تشرف على المفردات الآتية: "النجمة الشاردة، أصحو، ليصعد صوت البحار"، وبالمقابل تستغرق النواة الثانية "ينام حبيبي، الليالي، فنم يا حبيبي، لأهبط فيك"، وليس بخافٍ العلاقة بين "الطيران" والنجمة وصعود الصوت، من حيث تقاطعها في سمة (+ ارتفاع)، في حين تتقاطع مفردات الحقل الثاني مع النواة الدلاليّة "يحطّ الحمام" في سمة (+ هبوط)، ففي النوم تتغيّر وضعيّة الكائن من وضع عمودي إلى وضع أفقي، وكذلك في الليالي تهبط العتمة، والدلالة الجنسية واضحة في مفردة التركيب الأخير. إذا كان هذا حال "اللازمة"، فكيف تتجلّى على نحو تفاعليّ في النصّ؟ يشكّل المشهد الثاني موجةً دلاليّةً أخرى في إثر الأولى. ويمكن لنا التأمّل في الصورة الآتية:
"أنا وحبيبي صوتان في شفة واحده
أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده".
يعكس السطر الأوّل تفاعلاً التحاميّاً بين العاشقين (الحمام) من خلال آليّة التشبيه البليغ أو المضمر، كما يسمّيه ابن الأثير: أنا وحبيبي = صوتان في شفة واحدة، إذ تمّ الدمج بين المشبّه والمشبّه به دون "توسط أداة ولا وجه شبه، وإذا المشبّه به خبر أو في حكم الخبر عن المشبّه. وغياب هذين الركنين يفتح الباب أمام الذهن يتطلع إلى جميع وجوه اللقاء الممكنة بين الطرفين فإذا هما واحد أو كالواحد في التصوّر"، وهكذا يغدو الصعود هبوطاً، والهبوط صعوداً، والعاشق عاشقةً والعاشقة عاشقاً في الفعل الجسدي، وتختفي الخطوط بين الطيران والهبوط. غير أن الصورة الثانية سرعان ما تكمن للصورة الأولى، وتفقدها لذّة الالتحام ليكفّ التفاعل، وينفرد كلّ حدّ من حدّي اللازمة بدلالة منفصلة، وتنزاح "اللازمة" عن تدليلها على الفعل الجسدي، لتبوح بإرهاصات المأساة، وفيما تؤكّد العاشقة على توحّدها بالحبيب "أنا لحبيبي أنا"، تستقطب انتباه العاشق أنثى أخرى (النجمة الشاردة) واهتمامه. وبذلك بقدر ما تؤدّي "اللازمة" معنىً دالاً على التوحّد الجسدي، بقدر ما تؤسّس لمعنى الانفصال والافتراق، وهذه من عادات العلامة اللغويّة في الإحاطة بهويّتها والانزلاق بها نحو الاختلاف معها.
ـ المقطع الثالث:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
- رأيت على البحر إبريل
قلت: نسيت انتباه يديك
نسيت التراتيل فوق جروحي
فكم مرّةً تستطيعين أن تولدي في منامي
وكم مرّةً تستطيعين أن تقتليني لأصرخ: إني أحبّك
كي تستريحي؟
أناديك قبل الكلام
أطير بخصرك قبل وصولي إليك
فكم مرّةً تستطيعين أن تضعي في مناقير هذا الحمام
عناوين روحي
وأن تختفي كالمدى في السفوح
لأدرك أنك بابل، مصر، وشام".
تنتشر شظايا العنوان مع ضديده في هذا المشهد الشعريّ من خلال نسقين معجميين، الأوّل: رأيت، انتباه، التراتيل، أن تولدي، أناديك، أطير، والثاني: نسيت، تقتليني، كي تستريحي، قبل الكلام، المدى، السفوح، بابل، مصر، وشام، ومما لـه دلالته أن النسق الأوّل تجمع كائناته سمة ( + حركة)، فالرؤية ناجمة عن حركة العين، والانتباه عن يقظة الشعور، ومثلها الأفعال: تولدي، أناديك، أطير، إذ تتحرك نحو الخارج عبر حركة المولود والصوت واندفاع الجسد. هكذا يبلور المشهد موجةً دلاليّة تنطوي على ( + حركة)، بمواجهة هذا المدّ الدلاليّ تسهم النواة "يحطّ الحمام" بانتشارها في المشهد الشعري باختلاق فضاء دلاليّ دالّ على السكون والصمت، فالنسيان فقدان آليّة التذاكر، والقتل يقود إلى الموت، والاستراحة ضدّ الحركة، وقبل الكلام ثمة صمتٌ، أمّا العلامات الأخرى فتشكّل فضاءً مكانياً، يوحي بالسكون، غير أن العنوان مع ضديده الدلاليّ يتجسّد في النصّ على نحو تفاعليّ، فالصعود والهبوط المتواتر يؤدّيه فاعلٌ واحدٌ متمثّلاً بالحمام (العاشقين):
"أناديك قبل الكلام
أطير بخصرك قبل وصولي إليك".
يتأسّس الحراك الدلاليّ للصورة الشعريّة على تضادّ دلاليّ: حركة  ثبات، ويتجلّى في السطر الأوّل بـ"نداء
ثبات، ويتجلّى في السطر الأوّل بـ"نداء  صمت" وفي السطر الثاني بـ"أعلى (أطير)
صمت" وفي السطر الثاني بـ"أعلى (أطير)  أسفل (خصرك)"، هذه الصورة تشاكس المنطق، وتبدو، وكأنها غير قابلة للبتّ فيها لكونها تفسح للانزياح حيّزاً كبيراً في بنيتها. فمن الصعوبة بمكان اقصار الفعلين "أناديك وأطير" على دلالة محدّدة، فالسياق الشعري، هنا، يبدّد الدلالة القاموسية للفعلين المذكورين، ويحمّلهما بحمولة سيميائيّة تناقض الدلالة العرفيّة لهما، فالفعل "أناديك" يتشظّى ويتبعثر دلالياً، فتفقد اللغة بذلك وظيفتها التّواصلية لتؤسّس الوظيفة الشعرية، وذلك لأن الفعل "أناديك" يتأرجح وينوس بين الدلالة القاموسيّة والسياقيّة، فهو نداءٌ، وصمتٌ في الوقت نفسه، ومثله الفعل "أطير" فهو طيران وثبات، وهكذا يتحكّم التناقض المنطقي بالبنية الدلاليّة للثنائيتين: نداء - لا نداء، طيران - لا طيران، فالاشتغال اللامنطقي أو ضدّ المنطق السائد في اللغة من شؤون اللغة الشعريّة التي تجمع بين المتناقضات، وتحرّر العلامات من سطوة العرف والعادة، لتفتح العلامة على أقصى تشظّيات التدليل.
أسفل (خصرك)"، هذه الصورة تشاكس المنطق، وتبدو، وكأنها غير قابلة للبتّ فيها لكونها تفسح للانزياح حيّزاً كبيراً في بنيتها. فمن الصعوبة بمكان اقصار الفعلين "أناديك وأطير" على دلالة محدّدة، فالسياق الشعري، هنا، يبدّد الدلالة القاموسية للفعلين المذكورين، ويحمّلهما بحمولة سيميائيّة تناقض الدلالة العرفيّة لهما، فالفعل "أناديك" يتشظّى ويتبعثر دلالياً، فتفقد اللغة بذلك وظيفتها التّواصلية لتؤسّس الوظيفة الشعرية، وذلك لأن الفعل "أناديك" يتأرجح وينوس بين الدلالة القاموسيّة والسياقيّة، فهو نداءٌ، وصمتٌ في الوقت نفسه، ومثله الفعل "أطير" فهو طيران وثبات، وهكذا يتحكّم التناقض المنطقي بالبنية الدلاليّة للثنائيتين: نداء - لا نداء، طيران - لا طيران، فالاشتغال اللامنطقي أو ضدّ المنطق السائد في اللغة من شؤون اللغة الشعريّة التي تجمع بين المتناقضات، وتحرّر العلامات من سطوة العرف والعادة، لتفتح العلامة على أقصى تشظّيات التدليل.
إن الشاعر، هنا، يقرأ الصمت، لهفة العاشق في الوصال، وبذلك يؤسّس لـ"جماليات الصمت"، الصمت في وصفه كلاماً ملغّماً، ورغبةً على حافّة الانفجار "قبل الكلام - قبل وصولي". واللافت للانتباه الدور البنائيّ والدلاليّ الذي يؤدّيه الظرف "قبل" الذي يغيّر من دلالات الفعلين "أناديك، أطير"، فيتحرّران من المعنى القاموسي، وفجأة نكتشف انبثاق مرجعيات إحاليّة غير موجودة: النداء قبل الكلام، والطيران بخصر الحبيبة قبل الوصول، وهذه المرجعيات لا تمارس كينونتها إلا في الخطاب الشّعري فـ"المدلول الشّعري - كما تقول جوليا كرستيفا - يحيل ولا يحيل معاً، على مرجع معيّن، إنه موجود وغير موجود، فهو في الآن نفسه كائن ولا كائن". إنها اللغة الشعرية تقرّب البعيد وتبعد القريب، مندفعةً بنشوة جذلى في تحطيم الائتلاف، لتحيا في الاختلاف.
ـ المقطع الرابع:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
إلى أين تأخذني يا حبيبي من والديّ
ومن شجري، من سريري الصغير ومن ضجري،
من مراياي من قمري، من خزانة عمري ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟
إلى أين تأخذني يا حبيبي إلى أين
تشعل في أذنيّ البراري، تحمّلني موجتين
وتكسر ضلعين، تشربني ثم توقدني، ثم
تتركني في طريق الهواء إليك
حرامٌ... حرام".
ينبني المشهد على توتّر دلاليّ بين الحركة والثبات، بين الرغبة الجارفة من العاشق (إلى أين تأخذني) وبين الرغبة والخوف من عادات المكان وأعرافه لدى العاشقة (والديّ، من شجري، سريري، ضجري، مراياي، قمري، خزانة عمري، سهري، ثيابي، خفري)، وكلّها علامات دالّة على العرف الذي إن هو إلا استقرار وثبات في مواجهة المضي مع الحبيب (إلى أين تأخذني)، فالخوف من المصير الذي ستؤول إليه العاشقة يقودها إلى التأكيد الاستفهامي: "إلى أين تأخذني يا حبيبي إلى أين؟"، وهنا يبثّ المشهد الشعري موجةً دلاليّة تعضد مفهوم الحركة (تأخذني) من خلال صيغ الفعل المضارع "تشعل، تحمّلني، تشربني، توقدني، تتركني" التي تقتنص معنى الحركة من خلال دلالات التعدية والصيرورة، والاتصال واستمرار الحركة في تساوق مثير في ذلك المعنى المتولّد من اللازمة: "يطير الحمام  يحطّ الحمام"، في وصفها حركةً مستمرّةً من الصعود والهبوط بين العاشقين.
يحطّ الحمام"، في وصفها حركةً مستمرّةً من الصعود والهبوط بين العاشقين.
- المقطع الخامس:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
- لأني أحبك، خاصرتي نازفه
وأركض من وجعي في ليال يوسّعها الخوف مما أخاف
تعالي كثيراً، وغيبي قليلاً
تعالي قليلاً، وغيبي كثيراً
تعالي تعالي ولا تقفي، آه من خطوة واقفه
أحبّك إذ أشتهيك. أحبّك إذ أشتهيك
وأحفن هذا الشعاع المطوّق بالنحل والوردة الخاطفه
أحبّك يا لعنة العاطفه
أخاف على القلب منك، أخاف على شهوتي أن تصل
أحبّك إذ أشتهيك
أحبّك يا جسداً يخلق الذكريات ويقتلها قبل أن تكتمل
أحبّك إذ أشتهيك
أطوّع روحي على هيئة القدمين - على هيئة الجنّتين
أحكّ جروحي بأطراف صمتك... والعاصفه
أموت، ليجلس فوق يديك الكلام".
تتنكّر النواتان "يطير" و"يحطّ" في أشكال دلاليّة مختلفة بالكاد يمكن الاستدلال على علاقاتها بالنواتين الدلاليّتين، كما في معجميّة هذا المشهد الشعري، وليس من الضرورة أن نلحظ التفاعل الجدلي بينهما، بالتدليل على الفعل الجنسي وذلك بتوحّد العاشقين، إذ كثيراً ما تمارس كلّ واحدة منهما عداءً دلاليّاً تجاه الأخرى، ومن هنا، فليس ثمة وعود راسخة للدليل الأدبي مع "الهويّة" لكونه يسحر بـ"الإخلاف"، ماضياً نحو الاختلاف.
تشبك النواة الأولى مفردات: خاصرتي نازفة، أركض، أشتهيك، النحل، الوردة الخاطفة، شهوتي، يخلق، جروحي... إلخ، إذ تتقاسم هذه الكائنات اللغويّة والنواة سمة (+ حركة)، فالنزف سيلان الدم، والركض ممثّل الإرادة والعزم في الاندفاع، في حين يمثّل الاشتهاء الرغبة الشديدة في الأنثى، وكذلك النحل بما يتميز به من حركة في الفضاء، والوردة بتفتّحها. فهذه الكائنات تندفع بحركتها نحو الخارج، مع ما يحقّق لها الاتصال بالعالم. ومن جهة أخرى، لا يقف الضديد رهين العزلة، وإنما يمتدّ بدوره في النصّ ليسجّل حضوره عبر مفردات: ليال، غيبي، خطوة واقفة، يقتل... إلخ، والتأمّل في هذه المفردات يقودنا إلى أنها تكرّس "الغياب" على نحو عامّ، وتومئ إلى الامتناع عن التفاعل والتداخل مع الطرف "الآخر". من جهة ثالثة، ثمة محاولة من العاشق في تفعيل العلاقة مع العاشقة:
"أحكّ جروحي بأطراف صمتك... والعاصفه
أموت، ليجلس فوق يديك الكلام".
كما أشرت؛ فالمشهد الخامس يدعم التضادّ السلبيّ بين العاشقين، ولهذا يلجأ العاشق إلى محاولة التواصل من خلال الفعل "أحكّ"، ثمّ التضحية بـ"الذات" في سبيل التواصل (أموت). غير أن الصورة تبوح بدلالاتها على نحو آخر: إذ تنبني "الصورة" على ثلاث استعارات جزئيّة تتفاعل في ما بينها، لتشكّل الصورة بنية انزياحيّة بامتياز، فالاستعارة الأولى (أحكّ جروحي)، تنجز مهامّها من خلال الفعل "أحكّ" عبر تشبيه الجرح بمادّة محسوسة، ولتكن الحجر، فما مساحات التقاطع بين الملفوظين؟ سوى أن "الجرح" ينتج عن فعل "الحجر"، أي أنهما يتقاطعان بالاقتضاء بينهما، وما عدا ذلك تتسع الهوة بينهما، الأمر الذي يعزّز قدرة التركيب الاستعاريّ على إنتاج الاختلاف على صعيد الدلالة. وترتبط الاستعارة الثانية بالأولى بحرف الجرّ "الباء"، حيث يتخذ "الصمت" هيئة شيء له "أطراف" فيتجسّد، ويتشيّأ وفق قانون اللغة الشّعرية: تجسيد المجرّد وتجريد المجسّد.
يرتكب الشعر منطقاً خاصّاً به، لكن ما علاقة "العاصفة" هنا، بالتركيب الاستعاريّ؟ وإذا أردنا الدّقة، ما العلاقة الدلالية التي تربط بين "صمتك" و"العاصفة"؟ فالكاف يحيلنا على "العاشقة"، و"الصمت" مؤشّر على امتناع العاشقة عن "التواصل"، و"العاصفة" معطوفة على "الصمت"، لتكون مكافئاً معجميّاً له: أحكّ جروحي بأطراف العاصفة، ويمكن لنا أن نؤوّل التركيب على نحو آخر عبر إحداث تكافؤ معجميّ بين الضمير "ك" العائد إلى العاشقة و"العاصفة"، ليتخذ التركيب صورةً أخرى: "أحكّ جروحي بأطراف صمتـ (ك  العاصفة". التركيب بهذا الشكل يحيلنا على "صمت العاصفة" المخادع، صمت الرغبة قبل الانفجار. وترتبط الاستعارة الثالثة بما تقدّم من خلال ارتباط الفعل "أموت" بما سبقه "أحكّ" من حيث استمرارية التكلّم بالضمير "أنا" في الزمن الحاضر، وتتمّ الاستعارة من خلال الفعل (ليجلس) عبر تشبيه "الكلام" بطفل صغير، غير أن التركيب "أموت، ليجلس فوق يديك الكلام" يدخل مجال اللاحسم على الصعيد الدلاليّ، فهو يتحرّك بين: تضحية العاشق بنفسه (أموت)، كي تفوز العاشقة بالحياة، أو التضحية مقابل استمرار العاشقة في التواصل. ومن هنا نجد أن العنوان مع ضديده الدلاليّ ينأيان عن التفاعل، في وصفهما حركةً التحاميةً بين العاشقين، ليدلاّ على حال انفصال بينهما، فالرغبة في التواصل صادرة عن العاشق وحده دون العاشقة. إنها جروح العشق وعذاباته بانقطاع الوصال والاتصال.
العاصفة". التركيب بهذا الشكل يحيلنا على "صمت العاصفة" المخادع، صمت الرغبة قبل الانفجار. وترتبط الاستعارة الثالثة بما تقدّم من خلال ارتباط الفعل "أموت" بما سبقه "أحكّ" من حيث استمرارية التكلّم بالضمير "أنا" في الزمن الحاضر، وتتمّ الاستعارة من خلال الفعل (ليجلس) عبر تشبيه "الكلام" بطفل صغير، غير أن التركيب "أموت، ليجلس فوق يديك الكلام" يدخل مجال اللاحسم على الصعيد الدلاليّ، فهو يتحرّك بين: تضحية العاشق بنفسه (أموت)، كي تفوز العاشقة بالحياة، أو التضحية مقابل استمرار العاشقة في التواصل. ومن هنا نجد أن العنوان مع ضديده الدلاليّ ينأيان عن التفاعل، في وصفهما حركةً التحاميةً بين العاشقين، ليدلاّ على حال انفصال بينهما، فالرغبة في التواصل صادرة عن العاشق وحده دون العاشقة. إنها جروح العشق وعذاباته بانقطاع الوصال والاتصال.
ـ المقطع السادس:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
لأني أحبّك "يجرحني الماء"
والطرقات إلى البحر تجرحني
والفراشة تجرحني
وأذان النهار على ضوء زنديك يجرحني
يا حبيبي، أناديك طيلة نومي، أخاف انتباه الكلام
أخاف انتباه الكلام إلى نحلة بين فخذيّ تبكي
لأني أحبّك يجرحني الظلّ تحت المصابيح، يجرحني
طائرٌ في السماء البعيدة، عطر البنفسج يجرحني
أوّل البحر يجرحني
آخر البحر يجرحني
ليتني لا أحبّك
يا ليتني لا أحبّ
ليشفى الرخام".
فالحبّ بؤرة المشهد، والحبّ انطلاق (طيران) الذات نحو الآخر، نحو الذات، صعودٌ وهبوطٌ، غير أن للحبّ تكاليفه، وعذاباته "لأني أحبّك يجرحني: الماء، الطرقات، الفراشة، أذان النهار، الظلّ، طائر، عطر البنفسج، أوّل البحر، آخر البحر"، المشهد هنا ردّ من العاشقة على أوهام العاشق بامتناع العاشقة عن التواصل. وبمعنى آخر إن خطاب العاشقة يعمّق من وحدة العاشقين واستمرار جدليّة الصعود والهبوط من خلال انفتاح الخطابين بعضهما على بعض، غير أن طارئاً ما يقوّض تيار الحبّ المستمرّ بين العاشقين:
"ليتني لا أحبّك/ يا ليتني لا أحبّ/ ليشفى الرخام".
شفاء الجسد (الرخام) من جراحه مرهون بـ"ليتني لا أحبّك"، أي ترجيح الانفصال، بين "يطير" و"يحطّ"، وبالتالي "ليتني أكرهك". بهذا التكافؤ التأويليّ بين العبارتين يتيسّر لنا بنينة المربّع السيميائيّ لتفسير الشذرة الأخيرة:
| ليتني أكرهك | تضادّ | ليتني أحبّك |
| |
| لا ليتني أحبّك | تحت التضادّ | لا ليتني أكرهك ّ |
وبذلك يمكن القول إن بنية "التمنّي" في خطاب العاشقة لا تقوم على التضادّ، بقدر ما تشتغل تحت التضادّ، أي: لا ليتني أحبّك - لا ليتني أكرهك، إذ الحبّ يخلّف جروحاً غائرةً، وكذلك الكراهية، وعليه شفاء الرخام "ليشفى الرخام = الجسد أو الروح" مشروط بتحقيق المابين: حدٌّ، تخمٌ عاطفيّ يسكن الحيّز البيني بين الحبّ والكراهية متمثّلاً بـ"حياد"، غير أن الحياد لا يحاذي سوى أطراف التمنّي، فلا مجال له في "يطير الحمام - يحطّ الحمام" إما كلاهما معاً (الحبّ) وإما انفصال بينهما (الكراهية). الحياد الذي تبحث عنه العاشقة في الشذرة الأخيرة، ما هو إلا مشيئة التمنّي فحسب.
- المقطع السابع:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
- أراك، فأنجو من الموت. جسمك مرفأ
بعشر زنابق بيضاء، عشر أنامل تمضي السماء
إلى أزرق ضاع منها
وأمسك هذا البهاء الرخاميّ، أمسك رائحةً للحليب المخبّأ
في خوختين على مرمر، ثم أعبد من يمنح البرّ والبحر ملجأ
على ضفّة الملح والعسل الأوّلين، سأشرب خرّوب ليلك
ثم أنام
على حنطة تكسر الحقل، تكسر حتى الشهيق فيصدأ
أراك، فأنجو من الموت. جسمك مرفأ
فكيف تشرّدني الأرض في الأرض
كيف ينام المنام".
يراكم المشهد السابع دلائل لغويّة كثيرة للتدليل على الحركة المتواترة للحمام في الصعود والهبوط، ويمكن تبئير هذا التراكم في تركيب بؤريّ: جسمك مرفأ، أو يمكن تفسير دلائل المشهد من خلال هذا التركيب الذي يبثّ دلالاته من خلال آليّة التشبيه المضمر أو البليغ: جسمك = مرفأٌ، حيث التطابق يصل إلى أقصى حدوده، بإسقاط أداة التشبيه ووجه الشبه، الأمر الذي يدع التأويل يمضي بعيداً، فالمرفأ يبوح بدلالات الاجتماع والضمّ والاتفاق: "ورفأ الثوب، (...)، يرفؤه رفأً: لأم خرقه وضمّ بعضه إلى بعض وأصلح ما دهى منه، مشتقٌّ من رفء السفينة، (...). والرفاء بالمدّ: الالتئام والاتفاق. (...) وفي الدعاء للمملك بالرفاء والبنين أي بالالتئام والاتفاق وحسن الاجتماع. (...) ورفأ السفينة يرفؤها رفأً: أدناها من الشطّ (...). ومرفأ السفينة: حيث تقرب من الشطّ" ( ). وعليه يفيدنا تشبيه جسد العاشقة بالمرفأ بالوصال والاجتماع بين العاشقين، وتغدو المفردات الأخرى تنويعاً وتمطيطاً وتوسيعاً لهذه النواة الدلاليّة وفق الترسيمة الآتية، حيث يتخذ فيها العاشق دور الفاعل القائم بالاتصال ( ) مع موضوعه (العاشقة):
) مع موضوعه (العاشقة):
| الفاعل | الاتصال | الموضوع |
| أر ا | | ك |
| أمسك | | البهاء الرخامي |
| أمسك | | رائحة للحليب المخبّأ في خوختين على مرمر |
| أعبد | | من يمنح البرّ والبحر ملجأ على ضفة الملح والعسل |
| سأشرب | | الأوّلين |
| ثمّ | | خرّوب ليلك |
| أنام | | على حنطة تكسر الحقل حتى الشهيق فيصدأ |
فالأفعال المضارعة ترتكب حدثها وزمنها في الزمن الحاضر الذي يفيد الاستمرار، أو الاستقبال (سأشرب، ثمّ أنام) كإشارة إلى وقوع الاتصال مستقبلاً. غير أن نهايات المشهد أو "الشذرة الأخيرة منه"، تنسج إرهاصات تشير إلى تفكّك الوصال بين العاشقين:
"أراك، فأنجو من الموت. جسمك مرفأ
فكيف تشرّدني الأرض في الأرض
كيف ينام المنام".
إذا كانت كينونة العاشق مرهونةً بالآخر (العاشقة) من حيث هي المكان الذي يخلد إليه العاشق، وينجو من الموت، فإن السطرين الأخيرين، ومن خلال اسم الاستفهام "كيف" الدالّ على الكيفيّة، يفرز مواقف: التحسّر، والتعجب والإنكار "تشرّدني الأرض" حيث "الأرض" تحيلنا على المشهد الأوّل "أعدّي لي الأرض كي استريح"، حيث تتشابك الاستعارة مع المجاز المرسل إذ يجري استعمال مفردة "الأرض" الدالّة على المكان مقصوداً بها ما حلّ بالمكان أي جسد العاشقة، كما أن حضور الفعل "تشرّدني" كمجرى للاستعارة، يمضي بعلامة "الأرض" إلى أن تتقمّص "العاشقة" مدلولاً لها، وهذا التأويل يحيلنا بدوره على المشهد السادس حيث الرغبة الجارفة في الفرار من تكلفة "الحبّ": ليتني لا أحبّك، وهكذا يمكن كتابة السّطر الثاني على النحو الآتي:
فكيف الأرض تشرّدني في الأرض
العاشقة العاشق العالم
وعليه، يبئّر الفعل "تشرّدني" دلالات الطرد والطريد والتفرّق حيث لا مأوى، لكن السطر الأخير يستدرك الأمر: كيف ينام المنام، والمنام هو موضع النوم، وهو المرفأ، وجسد العاشقة، ليؤكد علاقة التلازم والتفاعل بين المشرّد والمشرّدة، لكن الشذرة الأخيرة توحي بإرهاصات مأساة الحمام.
ـ المقطع الثامن:
"يطير الحمام
يحطّ الحمام
حبيبي، أخاف سكوت يديك
فحكّ دمي كي تنام الفرس
حبيبي، تطير إناث الطيور إليك
فخذني أنا زوجةً أو نفس
حبيبي، سأبقى ليكبر فستق صدري لديك
ويجتثّني من خطاك الحرس
حبيبي، سأبكي عليك عليك عليك
لأنك سطح سمائي
وجسمي أرضك في الأرض
جسمي مقام".
في هذا المشهد تتعزّز مخاوف العاشقة من طيران الحمام، ففيما هي تؤكّد على العشق ("حبيبي، سأبكي عليك عليك عليك/ لأنك سطح سمائي/ وجسمي أرضك في الأرض، جسمي مقام") تبرز إرهاصات الانفصال بالتمظهر على نحو واضح:
- حبيبي، أخاف سكوت يديك
- حبيبي، تطير إناث الطيور إليك
- ويجتثّني من خطاك الحرس.
هذه الدلائل: صمت الحبيب، استقطابه لإناث أخر، بروز العامل الاجتماعي متمثّلاً بـ"الحرس" في التفريق بين العاشقين، تأتي لتؤكّد خاتمة القصيدة: "يطير الحمام، يطير الحمام"، وعليه يغدو عنوان القصيدة في حضوره النصّيّ يمارس المراوغة، فتارةً يستدعي ضديده الدلالي للتدليل على هوية العشق، ووحدته، وتارةً أخرى يراوغ تلك الدلالة ويخاتلها ليرسم مدار الانفصال بين العاشقين.
3- مستوى التناص:
سنتوقف عند مستويين من مستويات الفعل التناصي: التناص الخارجي أي البروتوكولات الموقّعة مع النصوص الخارجيّة، والتناص الداخلي حيث التفاعل بين العنوان الراهن وخطاب الشاعر نفسه. وتبعاً لنظرية التناص، فالنصّ احتذاءٌ لنصّ آخر( )، ووقوع الحافر على الحافر، وهو - كذلك - وبالمعنى الإيجابي - نسخٌ وسلخٌ ومسخٌ( ) على ما يرى ابن الأثير الجزري في تفاعلية النصوص الشعريّة بعضها مع بعض، وبالتالي فهو أثرٌ لأثر آخر، بل أثرٌ لآثار (نصوص) أخرى، معروفة الهويّة وغير معروفة، حيث تغدو "أصالة" النصّ - تحت هذه الوطأة - مشكوكاً في أمرها، فلا أصل له، لكونه ابن الخطيئة بامتياز، لا نسب لـه، ونسبه - إن كان ثمة نسب - مفقودٌ في لجّة النصوص والاقتطافات والاقتباسات التي تجتاح كيانه دون رحمة بوعي، ومن دون وعي، فالهجانة هي التي تميّزه وتمنحه الهويّة. يكتب رولان بارت: "كلّ نص هو تناصٌّ، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة، وبأشكال ليست عصيّة على الفهم بطريقة أو بأخرى إذ نتعرّف فيها نصوص الثقافة السالفة والحالية: فكلّ نصّ ليس إلاّ نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة"( )، يغدو النصّ - وفق هذه الرؤية - ضيفاً ومضيفاً، متطفّلاً ومتطفّلاً عليه( )، يؤدّي الدورين معاً بلذّة عالية، يتغذّى على جثث النصوص السابقة عليه بنهم، وتنهشه هي الأخرى، ذلك أن الشاعر اللاحق يستبدّ به العماء، ولا يرى العالم إلا من خلال أسلافه الشعراء الذين يهبونه البصر والبصيرة. في هذا الإطار تنفتح قصيدة "يطير الحمام" عنواناً ونصّاً على كائنات نصّيّة، لا يمكن بحال الإمساك بأرواحها، وبقليل من الجرأة يمكن القراءة أن تحدّد طبوغرافية بعض النصوص الخارجيّة ذات الطابع الأنثروبولوجي التي تكشف عن التقاطع بين الكائن الإنساني وطير الحمام في سمات الألفة والأنس والشهوة... حيث تمثّل الإطار الثقافي لاتخاذ الشاعر لطيور الحمام عنواناً لقصيدته، وقد أشرنا إلى بعضها في رمزية العنوان، غير أن قصيدة "يطير الحمام" تتخذ من "نشيد الإنشاد" في العهد القديم نموذجاً للاحتذاء وإدارة الصراع معه، وفي واقع الحال يتمّ التفاعل النصّيّ مع النصّ التوراتيّ - الذي ينحدر بدوره من نصوص سومريّة غارقة في القدم - على مستويات البنية الهيكليّة: تقنية الحوار بين عاشقين، الجوقة أو الكورس كصوت تكراريّ - عدد المقاطع النصّيّة، الثيمات، فضلاً عن البنيتين المعجميّة والإيقاعيّة( ). غير أن ما يهمّ القراءة يتحدّد في كيفية التّفاعل بين عنوان القصيدة الراهنة و"نشيد الإنشاد"؟ في واقع الحال ينأى عنوان القصيدة اللاحقة "يطير الحمام" عن التفاعل المباشر مع "نشيد الإنشاد" في وصفه عنواناً، ليقتنص الشاعر ثيمة العنوان من جسد "نشيد الإنشاد" ذاته عبر تشبيه العاشقين في حوارهما المتعاقب والمدجّج بالغلمة والشهوة بـ"الحمام" نظراً، كما أسلفنا القول في رمزيّة العنوان، إلى ارتباط "الحمام" في المخيال السوسيو - ثقافي بوفرة الشهوة ووقدتها، وما "نشيد الإنشاد"، وفق القراءة الراهنة، إلاّ صرخة تنهض من قاع الأزمان السحيقة في مدائح الجسد، لكننا لو تجاوزنا هذا الأمر، لوجدنا تقاطعاً تناصياً على المستوى المعجميّ للعنوان اللاحق، ومعجميّة النصّ السابق، إذ ترد العبارات النصّيّة الآتية:
- "ها أنت جميلةٌ يا حبيبتي ها أنت جميلةٌ. عيناك حمامتان"( ).
- "ها أنت جميلةٌ يا حبيبتي ها أنت جميلةٌ. عيناك حمامتان"( ).
- "يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك..."( ).
- "حبيبي أبيض وأحمر (...). عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللّبن جالستان في وقبيهما"( ).
5- "واحدةٌ هي حمامتي كاملتي"( ).
هكذا يمثل "تشبيه العاشقين بالحمام" في النص السابق في سياق النصّ، بل إن تشبيه العينيين بالحمام، يتخذ في النصّ صورة لازمة تكراريّة - كما اللازمة "يطير الحمام، يحطّ الحمام" في القصيدة اللاحقة، وهذا الحضور الجزئي لمفردة "الحمام" في النصّ السابق يغدو حضوراً عامّاً في النصّ اللاحق، ليسمه، ويصبح مؤشراً على هويته وكينونته، وذلك بانتقال مفردة "الحمام" من موقع مكانيّ (المتن) إلى موقع مكاني آخر (واجهة النصّ) يتميّز بالخطورة، الأمر الذي تصبح بمقتضاه، ليس عنواناً للنصّ اللاحق فحسب، وإنما النواة النوويّة التي يتكثّف فيها النصّ في حركته الارتداديّة، وينتشر منها في حركته الامتداديّة. فما هو خاصّ يصبح عامّاً، وهو أحد قوانين آليّة التناص وفق ابن الأثير "الضرب التاسع من السلخ: وهو أن يكون المعنى عامّاً فيجعل خاصّاً، أو خاصّاً فيجعل عامّاً"( )، وهذا هو التنقيح الذي يتحدّث عنه هارولد بلوم في علاقة الشاعر اللاحق بالسابق، ذلك أن اللاحق وعبر عمليات التحويل والمسخ، يوزّع النصّ السابق تبعاً لحساسيات مختلفة في نصّه، لكن الأمر لا يتمرّد على الفكرة الآتية: "القصائد، بالضرورة، هي حول قصائد أخرى، القصيدة هي ردّ على قصيدة أخرى"( )، لأن العلاقة بين الشعراء، أي بين النصوص تتخذ الصراع والاقتتال، ومهما أمعن الشاعر اللاحق في عملية القتل، فإن الموتى لا يلبثون أن يعودوا مستمرّين في المقاتلة، وهذا هو شأن "يطير الحمام" مع "نشيد الإنشاد" الذي لا يني يتكلّم بصوت عنيف - وهنا ندخل في مجال التناص الذاتي - في نصوص درويش اللاحقة، يتخذ من "يطير الحمام" المعبر لينفجر في القصائد اللاحقة، وما قصيدة "شتاء ريتا" (1992) إلا إعادة كتابة لـ"يطير الحمام" أو إعادة الكتابة الثانية لـ"نشيد الإنشاد"، وفيها ("شتاء ريتا") يطرأ الوضوح على الغموض الذي اكتنف هويّة العاشقين في "يطير الحمام"، إذ يتحدّد "الحمام": العاشق (فلسطينيّ)، والعاشقة (يهوديّة)، وبذلك يفكّك محمود درويش هويّة "نشيد الإنشاد" على مستوى الفاعلين، بإدخال هويّة مختلفة ومغايرة، لينقل الصراع الأنطولوجيّ من مستوى الأرض إلى مستوى النصّ، وينتهي الحدث الشعري بالعاشقين، في "شتاء ريتّا"، إلى الانفصال أيضاً كما في "يطير الحمام"، الانفصال في وصفه إحدى الدلالات المترشحة عن العنوان "يطير الحمام". لكن كيف يتجسّد ذلك في "شتاء ريتا":
"وكسّرت خزف النهار على حديد النافذة
وضعت مسدّسها الصغير على مسوّدة القصيدة
ورمت جواربها على الكرسي، فانكسر الهديل
ومضت إلى المجهول حافيةً، وأدركني الرحيل"( ).
انكسار الهديل، انكسارٌ للانسجام والألفة والعشق، وبالتالي يغدو حلول "الرحيل" نتيجةً منطقيّة لهذا الانكسار، لهذا الصراع، وتعبيراً آخر لـ"يطير الحمام، يحطّ الظلام". إن العنوان الراهن، نواةٌ دلاليةٌ فعّالةٌ، بذرةٌ في طورَي الكون والانتشاء، لا تني، تنمو في قصائد أخرى، أنجزت بعد "يطير الحمام". وإذا كان "يطير الحمام" في تأويل آخر ليس سوى "ملهاة العشق ومأساته"، إذ يسيطر الانسجام والالتئام وحسن الاجتماع على العاشقين في المشاهد الثمانية الأولى من النصّ، في حين ينفرد التاسع بثيمة الانفصال والفراق، هذا التمفصل يسوّغ للقراءة تأويل العنوان "يطير الحمام" على أنه: "ملهاة الحمام ومأساة الحمام"، ألا يمكن عندئذ التكهّن بأن "يطير الحمام" هو البذرة المسببّة لعنوان شهير آخر - وقبل قصيدة "شتاء ريتّا" - أقصد "مأساة النرجس، ملهاة الفضة" (1990). من الاحتماليّة بمكان، المضي قدماً في تحرّي صيرورات "يطير الحمام" في نصوص درويش، غير أن الذي يمكن التأكيد عليه أن "العنوان الراهن" ذو طبيعة تفاعليّة لانهائيّة، لا يمكن بحال إمساك مرجعياته ومصادره، وقابليّته على الدخول في علاقات نصّيّة راهنة ومحتملة، فـ"العلامة" النصّيّة أثرٌ مدفوعٌ بآثار سابقة عليه، وفي الوقت نفسه، لها قابليةٌ على دفع نصوص لاحقة، ولاحقة، وليس هدفها في ذلك أن تكون الدمغة الأصليّة، وإنما بذرة، تنتثر بقوّة رياح القراءة وعواصفها، في وصفها سرقةً، ومسخاً ووقوع الحافر على الحافر أو على طرف منه. هذا هو قانون "الانتشار" والطاقة المستحيلة على الانتشاء الذي تأخذ به "العلامة"، انتشاء البذرة في أرض أخرى، لا لتؤكّد معناها، وإنما لتختلف مع ذاتها، وتربك هويّتها المزعومة.
4- تركيب:
كان للعنوان "يطير الحمام" مفاجآته على صعيد إحداث الاختلاف مع ذاته: مرّةً يرسم فضاءً للعشق، وأخرى يفكّك فضاء الانسجام ذاته، رامياً بالائتلاف عرض الحائط، داخلاً بالتذاذ في لعب حرّ من التدليل المستمرّ والمراوغة، يربط بداية القصيدة بنهايتها، لتكون النهاية هي البداية، والبداية هي النهاية، ليستملك النهاية والبداية معاً، أو لا يكون أيّاً منهما معاً، ليحقّق بذلك نصّيّته من خلال بنيته - في وصفه بنيةً نصّيّةً مستقلّةً - ثم ليرتدّ بقوّة، ويؤسّس مداراً للتعالق والتعانق مع النصّ الذي لم يكن سوى توسيع له، وفي حركة إضافية - وليؤكّد غناه واختلافه ووجوده وتطفّله - كان ينهش في النصوص السابقة عليه، ويبيح ذاته للنهش في الوقت ذاته، مؤكّداً الحكمة التفكيكيّة الأثيرة أن النصّ في كينونته لا يتقن سوى إرجاء هويّته وتأجيلها، فراراً من التماثل والتطابق.
الهوامش:
(1) - محمود درويش: الديوان، مج (2)، بيروت: دار العودة، ط1، 1994، ص 169 - 179.
(2) - المصدر نفسه، وقد اخترنا العناوين من مجموعتَيْ "هي أغنية هي أغنية" و"ورد أقلّ".
(3) - نلفت الانتباه إلى أن الشاعر إمعاناً في فعليّة العناوين الشعريّة عَنْون إحدى مجموعاته بـ"لا تعتذر عمّا فعلت"، 2003.
(4) - محمد إبراهيم عيادة: الجملة العربيّة (دراسة لغويّة نحويّة)، الإسكندريّة: منشأة المعارف، ط 1، 1984، ص 51.
(5) - ينظر بخصوص المربع السيميائي لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون - دار النهار للنشر، ط 1، 2002، ص 147 - 149.
(6) - بول ريكور: نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى)، ترجمة: سعيد الغانمي، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2003، ص 94.
(7) - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: ياسين الأيوبي، بيروت - صيدا: المكتبة العصرية، ط 1، 2002، ص 114.
(8) - الجاحظ: كتاب الحيوان، ج (1)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الجبل، د. ط، 1996، ص 147.
(9) - المرجع نفسه، ص 227.
(10) - المرجع نفسه، ص 159.
(11) - المرجع نفسه، ص 165.
(12) - بول ريكور: نظرية التأويل، مرجع مذكور، ص 91.
(13) - ابن منظور: لسان العرب، مادة "طير".
(14) - المرجع نفسه، مادة "طير".
(15) - المرجع نفسه، مادة "طير".
(16) - فيليب سيرنج: الرموز في الفن - الأديان - الحياة، ترجمة: عبد الهادي عباس، دمشق: دار دمشق، ط 1، 1993، ص 198.
(17) - الكتاب المقدّس، التكوين، الأصحاح الثامن: 6، 7، 8، 9، 10، 11/ 13.
(18) - توم شيتوانيد: معجم تفسير الأحلام في ضوء علم النفس الحديث، ترجمة: أحمد عمر شاعين، القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط1، 1996، ص 197.
(19) - المرجع نفسه، ص 197.
(20) - المرجع نفسه، ص 197.
(21) - رشيد يحياوي: الشعر العربي الحديث (دراسة في المنجز النصّيّ)، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، ط 1، 1998، ص 113.
(22) - المرجع نفسه، ص 112.
(23) - شعيب حليفي: النصّ الموازي للرواية (استراتيجية العنوان)، مجلة الكرمل، ع 46، نيقوسيا، 1992، ص 96.
(24) - ابن الأثير الجزري: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 2، تحقيق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1998، ص 138.
(25) - فيليب مانغ: جيل دولوز أو نسق المتعدّد، ترجمة: عبد العزيز عرفة، حلب: مركز الإنماء الحضاري، ط 1، 2002، ص 21.
(26) - بيير ف. زيما: التفكيكيّة (دراسة نقديّة)، ترجمة: أسامة الحاج، بيروت: المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر، ط 1، 1996، ص 78.
(27) - الأزهر الزناد: دروس في البلاغة العربية (نحو رؤية جديدة)، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط 1، 1992، ص 120.
(28) - عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق: محمد الفاضلي، بيروت - صيدا: المكتبة العصرية، د. ط، 2003، ص 27.
(29) - الأزهر الزناد: دروس في البلاغة العربية (نحو رؤية جديدة)، مرجع مذكور، ص 23، 24.
(30) - ابن الأثير الجزري: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 1، تحقيق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1998، ص 344.
(31) - جوليا كرستيفا: علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، الدار البيضاء: دار توبقال، ط 1، 1991، ص76.
(32) - حول ذلك ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ط، 1973، ص 138، 245.
(33) - ابن منظور: لسان العرب، مادة "رفأ".
(34) - بخصوص ذلك ينظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، مرجع مذكور. ويوضّح الجرجاني هذا المفهوم بالقول: "واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر، وتقديره وتمييزه، أن يبتدىء الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً - والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه - فيعمد شاعرٌ آخر إلى ذلك الأسلوب، فيجيء به في شعره، فيشبّه بمن يقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها، فيقال قد احتذى على مثاله"، ص 428.
(35) - بخصوص هذه المفهومات ينظر ابن الأثير الجزري: المثل السائر...، ج 2، مرجع مذكور، ص 302 - 361. وفي الواقع يقدّم ابن الأثير قراءةً بارعة لمفهومات التناص من نسخ وسلخ ومسخ، وما يتفرّع إليه كلّ مفهوم من المفهومات المذكورة.
(36) - رولان بارت: نظريّة النصّ، ترجمة: محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمي، ع 3، بيروت، 1988، ص 96.
(37) - عبد العزيز حمودة: الخروج من التيه (دارسة في سلطة النصّ)، سلسلة عالم المعرفة، ع 298، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2003، ص 206.
(38) - للتفصيل ينظر خالد حسين حسين: جماليات التناص والاختلاف، مجلة المدى، ع 28، دمشق، ص 17- 27، وكذلك صبحي الطعان: بنية النصّ الكبرى (نموذج قصيدة درويشيّة)، ع 19، بيروت، 1993، ص 94.
(39) - الكتاب المقدّس، نشيد الإنشاد، الأصحاح الأوّل: 1.
(40) - المصدر نفسه، الأصحاح الرابع: 1.
(41) - المصدر نفسه، الأصحاح الثاني: 14.
(42) - المصدر نفسه، الاصحاح الخامس: 2.
(43) - المصدر نفسه، الأصحاح السادس: 9.
(44) - ابن الأثير الجزري: المثل السائر ...، ج 2، مرجع مذكور، ص 332.
(45) - هارولد بلوم: خريطة للقراءة الضالّة، ترجمة: عابد إسماعيل، بيروت: دار الكنوز الأدبيّة، ط 1، 2000، ص 25.
(46) - محمود درويش: أحد عشر كوكباً، 1992: الديوان، مج 2، مصدر مذكور، ص 548.
****
"خارج الطقس،
أو داخل الغابة الواسعة
وطني.
هل تحسّ العصافيرُ أني
لها
وطنٌ... أو سفرْ؟
إنّني أنتظرْ...
في خريف الغصونِ القصيرْ
أو ربيعِ الجذور الطويل
زَمَني.
هل تحسّ الغزالةُ أني
لها
جسدٌ... أو ثمرْ ؟
إنني أنتظرْ
في المساء الذي يتنزّه بين العيون
أزرقاً، أخضراً، أو ذهب
بَدَني
هل يحسّ المحبّون أني لهم
شرفةٌ... أو قمرْ؟
إنّني أنتظرْ...
في الجفاف الذي يكسر الريح
هل يعرف الفقراء
أنني
منبع الريح؟ هل يشعرون بأني لهم
خنجرٌ... أو مطر؟
إنني أنتظرْ...
خارج الطقس،
أو داخل الغابة الواسعة
كان يهملني مَنْ أحبُّ
ولكنني
لن أودّعَ أغصانيَ الضائعة
في زحام الشجر
إنّني أنتظر..."
محمود درويش
(الأعمال الكاملة، أعراس، دار العودة، ط 2، 1978 بيروت، ص 573)
"هكذا قالت الشجرة المهملة". ماذا قالت؟ لم يقل الشاعرُ ماذا قالت! أيكون هذا لأن الشاعر لا يعنيه ماذا يقال بقدر ما يعنيه كيف يقال! ربّما. على كلٍّ نحن أمام عنوان إعلانيّ لقول سيأخذ أهميّته من فاعله، وليس من مضمونه، فالفاعل هنا هو "الشجرة"، أي من عالم لم يُعهد منه قولٌ ولا سمع. وإذا حاولنا أن نفهم ذلك؛ نجد أن فعل القول يستدعينا إلى مداه الإنسانيّ لندلف من خلاله إلى فهم الفاعل الغريب. والشاعر لا يدعنا عند الشجرة كما ينبغي، نقدّر إمكانات فاعليّتها من خلال معرفتنا بكونها النباتيّ، بل يمضي بها فاعلاً موصوفاً بالإهمال، ما يعني أن القول منها لكونها تحت تأثير الإهمال.
هكذا، من العنوان، نحن أمام عالم شعريّ جديد، له كيمياؤه الخاصّة، له مفرداته ودلالاتها، وله مقاصده ومشاعره، ولنا أن نقرأ تبعاً للصيغ الصرفيّة فيه، والتراكيب النحويّة، وللتلاؤم وعدمه، وكلّ ما يمكن أن يحمل ظاهرةً أسلوبيّةً تغري بنا، لعلّنا نبلغ الإحاطة بعالم محمود درويش في هذا النصّ القديم نسبيّاً، ومهما حاولتُ أن أسوّغ اختياري له من دون سواه، فإنني لن أوفّق في ذلك؛ لأن أيّ كلامٍ في هذا المجال سيبقى ادّعاء تعوزه الأدلّة، وستبقى علّة اختيار النصّ علّةً غامضة.
إذاً؛ العنوان قصيدة مفتوحة إلى ما هو أبعد من كميّته المعلنة، بل هو كثافة شعريّة أحدثها غليان النصّ من تحتها، أو قل إنه العنوان الذي اختاره الشاعر عقب انطفاء القصيدة. وإن كان لذلك من دلالةٍ مستعجلة، فهي حاجة الشاعر إلى استدعاء الآخرين إلى عالمه قبل أن يتفلّت من عقاله بين أصابع الكلمات، فالقصيدة غالباً، تفرّ من عرقٍ إلى عرقٍ في داخل الشاعر قبل أن يلقي القبض عليها، ويسلّمها للكلمات العلنيّة. ويعتقد الشاعر أن القارئ كان معه يلاحق القصيدة إلا أنه وحده أوغل في سراديب الشعر، ووحده استطاع أن يصل، وها هو يعرض على القارئ ما رأى، فالعنوان المكثّف محاولةٌ لضبط القصيدة بأكملها حتى لا تفرّ مرّةً أخرى، والقارئ لن يتبعها، والشاعر سينصرف لملاحقة قصيدةٍ أخرى.
نعم، استطاع الشاعر أن يستدرجنا إلى قصيدته بواسطة العنوان، وكلّنا أملٌ بأن نتعرّف إلى مقول القول، فاإغراء يبدأ من كون القائل شجرة، ومن كون الشجرة مهملة، فهل يكفي هذا لتبرير اختيارنا للنصّ؟
الشجرة، مواطنة، ووطن...
"خارج الطقس،
أو داخل الغابة الواسعة
وطني.
هل تحسّ العصافيرُ أني
لها
وطنٌ... أو سفرْ؟
إنّني أنتظرْ...".
إذا امتثلنا العنوان، فإننا في هذا النصّ على هيئة القول وليس على مقول القول، فالنصّ مشدودٌ إلى ياء المتكلم (وطني/ أني) ما يوحي بأن الكلام كلامُ المتكلّم - الشجرة، إلاّ أن الشاعر الذي اختار العنوان بكامل وعيه وحضوره، كان جدّيّاً في ما ذهب إليه، فالذي نقرأ ليس قولاً بل هو هيئة قول. إذاً، أخذت هيئة القول شكل القول، فماذا يعني هذا؟
قد يكون مضمون الكلام سلبيّاً، وقد يكون إيجابيّاً، إلا أن ذلك لا يعني حقيقة القول، وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة علينا أن ننظر في كيفيّة القول، فـ"أهلاً وسهلاً" لا تعني الترحيب على الدوام، بل تعني أحياناً استنكاراً للقدوم، والفيصل في تحديد ذلك قدرتنا على معرفة هيئة القول. فماذا يمكننا أن نلحظ في هيئة قول شجرة محمود درويش؟
يبدأ البحث العلمي عادةً بالوصف، فإذا وُفِّقنا في ذلك نبلغ مرامينا.
يبدأ المقطع بالخبر، ثمّ بالإنشاء، ثم ينتهي بالخبر. الخبر جملةٌ اسميّة هي أثبت في الدلالة من الجمل الفعليّة عادة، لأنها لا ترتبط بزمنٍ يحدّدها. ومنطوق الخبر (خارج الطقس/ أو داخل الغابةِ الواسعة/ وطني).
من الناحية البلاغيّة، يلعب التقديم والتأخير دوراً أساسيّاً في أداء الجملة، فتقديم ما حقّه التأخير يكون لضرورةٍ اقتضت ذلك، وليس عبثاً، والمقدّم هنا هو "خارج الطقس/ أو داخل الغابة الواسعة"، وإذا كانت الضرورة تدلّ على الاهتمام؛ فإن مقتضى الاهتمام يكمن في كون الشجرة مهملة، وتقديم الظرف أمر مهمّ للمهمَل، وله الأولويّة في البال، ما يعني أنه سيكون له الأولويّة في النطق، فلو أن الشجرة المهملة لم تقدّم الظرف المتعلّق بالخبر النحويّ المحذوف (كائن أو موجود)، وقالت: "وطني خارج الطقس"، لكان المعنى يحتمل أن يكون وطنُها خارج شيء آخر أيضاً، أمّا وقد تمّ تقديم الظرف فهذا يعني أن وطنها كائن خارج الطقس حصراً وبشكلٍ خاصّ. هكذا تقول العرب، وهكذا أنزل الشاعر رؤيته المنزلة التي يقتضيها علم النحو، وهكذا قالت الشجرة المهملة.
أمّا على المستوى المعجمي فإن "الطقس مصطلح شامل لكل الظواهر المتعلقة بجو كوكب... عادة ما يستخدم اللفظ بمعنى طقس كوكب الأرض "(موسوعة ويكيبيديا). وأن تضاف مفردة "خارج" إلى مفردة "الطقس"، فذلك يحيل على مناخ مأسويّ تتحيّزه الشجرةُ المهملة.
لم ينتهِ الخبر، بل أردفت الشجرة بأداة نحويّة تدلّ على الاضطراب "أو" لتضع بديلاً ممكناً للظرف الأوّل "داخل الغابة الواسعة"، ومن دون أن يعني ذلك التخيير بين الظرفين انتفاء الإباحة، فأحدهما وطني أو كلاهما، وكلاهما وطني. والغريب هنا أن يكون أحدهما يعني الآخر، وهذه رؤية في العمق حيث يتساوى أداء الظرف الزماني "خارج الطقس" مع أداء الظرف المكاني "داخل الغابة الواسعة"، ولا يغرّنّك التعارض السطحيّ بين الداخل والخارج، فخارج الطقس غير خارج، وداخل الغابة غير داخل. خارج الطقس تعني ألاّ تكون الشجرةُ مشمولةً بكلّ الظواهر المتعلّقة بجوّ كوكبها، وداخل الغابة الواسعة يعني أن تكون الشجرة بين أشجار كثيرة، فإذا كان الظرف الزمانيّ يحيل على الإهمال، فإن الظرف المكانيّ يحيلُ على الضياع، وهل ثمة من مأساة أعمّ؟!
إذاً، هكذا قالت الشجرة مأساتها.
وينتقل الكلام من الأسلوب الخبريّ إلى الأسلوب الإنشائيّ. وكأني بالشجرة لا تريد أن تستسلم لمضمون الخبر، أو أحسبها لا تقرّ بأنه ملازم لها، مع كون الشكل الذي رُكِّب به، يشي بأنه ملازم؛ فتنشئ استفهاماً بـ"هل" يدخل على مضارعٍ لتخصّصَه للاستقبال، ما يعني أن الاستفهام هنا فتح بوّابة واسعة على الرهان (هل تحسّ العصافيرُ أني/ لها/ وطنٌ... أو سفرْ)؟
إذا كان للاستفهام أن يخرج على معناه الأصليّ إلى معاني أخرى تُفهم من السياق؛ فلا يعني هذا أن المعاني الأخرى قد جرّدت الاستفهام من هويّته كلّياً، بل يعني هذا أن المعاني الأخرى لا يمكن أن تُؤدّى إلا بواسطة الإمكانات التي في هويّة الأداة الاستفهاميّة. فالاستفهام بـ"هل" هنا يؤدّي وظيفة التشكيك بالمسند الذي دخلت عليه، لكن التشكيك بواسطة الاستفهام بـ"هل" يفتح المدى أمام الجواب بـ"نعم" أو "لا" إلى ما لانهاية، وهذا ما لا يمكن أن يُؤدّى بغير هذا الأسلوب، وأنت لا تستطيع أن تؤدّي معنى واحداً بطريقتين مختلفتين كما يقول الجرجاني (دلائل الإعجاز).
فعل الإحساس الذي منحتْه أداة الاستفهام "هل" بُعداً توقّعيّاً، يأخذ أهميّته التلاؤميّة من كونه مسنداً إلى "العصافير" التي تلائم الشجرةَ تمام الملاءمة. والسؤال عن الإحساس، لا يعني أن العصافير تهمل الشجرة، بل يدلّ على أن الشجرة ينقصها الإحاطة بكنهِ الموقف الوجداني لدى العصافير، وهذا مردّه إلى إحساس الشجرة بالإهمال، فهي لا تتوقّع أن تكون موضوعَ موقف، كما أن الإحساس هنا يقع على المصدر المؤوَّل من "أنّ" وما بعدها، الأمر الذي يشير إلى انهزاز الثقة بالذات فهي تطلب جلاء موقف العصافير منها في وصفها شجرةً خارج الطقس أو داخل الغابة الواسعة.
هل تحسّ العصافير أن الشجرة المهملة وطن أو سفر؟ فالجواب مؤجّل، وطالما أن الأمر في إسار التوقّع؛ فهذا يعني أن الشجرة تعاند اليأس، وتقاوم وتقاوم، فلا تنسحب من الحضور حيث هي؛ بل تصرّح بهيئة قولها في آخر المقطع خبراً مؤكّداً بأداة واحدة في مواجهة الشكّ:
"إنني أنتظر".
وما البياض الطباعيّ بين الإنشاء وهذا التأكيد، إلا دلالة على بياض في المسافة الزمانيّة المتوقّعة، زمن الانتظار. وإذا كان البياض أقرب إلى الصفاء والنقاء وما شابه من المفردات ذات الدلالة الإيجابيّة، فهي موازية أيضاً للصمت، والغموض والحيرة و... الارتباك، أي إن الشجرة معاندة، لكنها تغامر في عنادها، وكأنما هي مجبرةٌ على ثوريّتها في مواجهة الإهمال، وما من خيار آخر غير الانتظار.
هكذا قالت الشجرة المهملة مأساتها، وهكذا قالت الشجرة المهملة مقاومتها للمأساة.
الشجرة، مظروف زماني و... ظرف
"في خريف الغصونِ القصيرْ
أو ربيع الجذور الطويل
زمني.
هل تحسّ الغزالة أني
لها
جسدٌ... أو ثمرْ ؟
إنني أنتظرْ".
يلعب التوازي بين مقاطع هذه القصيدة دوراً بارزاً في إظهار الإيقاع الوجوديّ للشجرة المهملة، ويأتي ذلك على مستوى التركيب النحويّ أحياناً، وعلى المستوى الصرفيّ أحياناً أخرى، وعلى مستوى النسق الطباعيّ أيضاً، ولا يدلّ هذا إنْ كان الشاعر يعي ما يفعل، أو لا يعي أثناء تنزّل القصيدة، فهذا ليس مهمّاً، طالما أن القصيدة موفّقة في أداء الرؤية الخاصّة بالشاعر. وتأتي العلاقة بين النصّ بمظهره الأخير الذي وصلنا، وكيمياء الانفعال الوجدانيّ الذي اقتضاه؛ علاقةَ الأداء بما يُؤدّى، فما الظواهر الأسلوبيّة إلا مظاهر الرؤية الخاصّة المختلفة، والقصيدة الفاشلة هي التي لا تكون ظواهرها الأسلوبيّة أمينةً في أداء مقتضياتها، أي تكون قصيدة مفتعلة. لذلك قلنا ليس مهمّاً أن يكون محمود درويش واعياً ما يفعل أو لا يكون واعياً، فالقصيدة حشدٌ من الظواهر الأسلوبيّة الأمينة على أداء رؤاه. وهو مكتظّ بالعلامات اللغويّة المتأهّبة بكلّ ما تحمل من إرث لتدخل في أدغال شعريّته الخاصّة، ليكون لها عمر جديد في قصيدة جديدة.
أمّا الإيقاع الصوتيّ الذي أدّاه التوازي؛ فهو مظهر اتّساق الإيقاع الحضوريّ الحلوليّ بين الشجرة المهملة والشاعر الطاغوريّ الصوفيّ محمود درويش. يرى إلى الأشياء فيسمع صمتها المدوّي، كما يدعها تمضي في مسالك الشعر عالماً من دون زوائد، تمضي كما يشاء، وهي تحسب أنها تمضي كما تشاء، طبعاً حلّت به فأخذت شكلَه، وحلّ بها فأخذ شكلها... هو هي وهي هو.
تلبّي هذه الشجرة حاجة الشاعر إلى التعبير عن تموضعه إنساناً في غابة الإنسانيّة، في ظروف زمانيّة أو مكانيّة أقلّ ما يقال فيها إنها غير مؤاتية. وهنا يستدعينا النصّ إلى تتبّع الشجرة المهملة، إذ تُعيِّنُ زمنها "في خريف الغصون القصيرْ/ أو ربيع الجذور الطويل/ زمني".
طبعاً، يأتي هذا التزمّن للشجرة، بعد تحيّزها في مكان. ويكتسب أهميّته من الإضافة والوصف، إذ تتجلّى عبرهما الغرابةُ المدهشة مع دلالاتها البعيدة والقريبة.
الخريف والربيع علامتان من علامات الزمن التقليديّ، إلا أنهما في الوجدان الجمعيّ، ينطويان على الجنى أو على وعود بالجنى، وما لا شكّ فيه إن هذه الوعود، أو المواسم، لها طقوسها الخاصّة، ولها فضاءاتها في الحبّ والكره والعلاقات العامّة والخاصّة والخاصّة جدّاً، ولها تراثها الشفوي والمكتوب، ولها ولها... "وسمّي خريفاً لأنه تُخْرَفُ فيه الثمار أَي تُجْتَنى... وخُرِفَتِ البهائم: أَصابها الخريفُ أَو أَنْبَتَ لها ما ترعاه؛ قال الطِّرمَّاح:
مِثْلَ ما كافَحْتَ مَخْرُوفةً نَصَّها ذاعِرُ رَوْعٍ مُؤام
يعني الظبيةَ التي أصابها الخَريفُ"(ديوان الطرمّاح).
والخريف الذي تعيّنه شجرة محمود درويش المهملة، خريف الغصون، فما الذي يكتسبه هذا الزمن من إضافته إلى الغصون؟ هل يحيلنا ذلك على استحضار الشجر - الغابة مرّةً أخرى؟ لمَ لا؟ فالتحيّز المكانيّ السابق لم يكن تحيّزاً راهناً، بل هي فيه تنتظر. إذاً، الخريف هذا لا مجال لتمظهره إلاّ على الغصون. أمّا كيف سيكون مظهرُه، فإنّ الشعر يفتح الأبواب على الاحتمالات كلّها. ورغم أنّ النصّ لا يكتفي بإنهاء تنكير الخريف من خلال إضافته إلى الغصون، بل يصفه أيضاً بأنه القصير، وإنْ كان هذا يعني شيئاً، فإن ما يحيل عليه سنعزف عن الكلام عليه موقّتاً حتى يكتمل المشهد، لكن الخريف في ثقافتنا التلقائيّة default position بحسب مصطلح جون سيرل (العقل واللغة والمجتمع)، يقدّم لنا الغصون وقد أعطت كلّ ما يمكن أن تعطيه، فالأوراق اخضرّت حتى آخر الخضرة، ونموّ الفروع قد بلغ الذروة، والثمر قد نضج، وكأنّ الأمر لم يعد يشي بشيء. إذاً، الخريف قد تسلّم الشجرةَ وقد بلغت غايتها الطبيعيّة، وما عليه إلا أن يزاول فعله فيها، يعرّيها، ويسقطُ المهمل من أثمارها، وهذا كلّه في زمن قصير. هذا زمن الشجرة المهملة.
لا، ليس هذا كافياً للدلالة على زمن الشجرة المهملة، فالشاعر يراها تواصل تقديم زمانها باعتماد علامة أخرى من علامات الزمان التقليديّ: إنه الربيع، لكنّه "ربيع الجذور الطويل".
مع كلّ الثقل المعنويّ الجميل الذي تبعثُه مفردة "ربيع"، لا نرانا على أبواب أيّ انفراج، فالإضافة إلى الجذور تحمل وعداً بالحياة، بل تمنح الانتظارَ قيمةَ الجدوى، لكن الجذور الدفينةَ ينكرُ فضلها السطحيّون، ولا يعرف نضالها في الأعماق أولئك الوصوليّون المستعجلون، إنها رحم الجذوع والفروع والأوراق والأزهار والثمار و... الظلال، والدفء، بل هي هذا كلّه في نوايا الأرض؛ فمن يرى؟ إذاً؛ هي العزلةُ الغنيّة، هي التضحيات النكرات. ويأتي الوصف "الطويل" ليضفي على هذا كلّه بُعداً قنوطيّاً لا فكاك منه.
يرتبط هذا المركّب الإضافيّ الوصفيّ بما سبقه بواسطة الحرف "أو" لتكون إباحة الكون الظرفيّ أمام الشجرة المهملة زمناً مختلفاً، إنه زمن الوجود في خباياه، إنه الزمن الذي يحتاج إلى أنبياء يدركون كنهَه، ويعرفون مساراته الحقيقيّة. فالشجرة مظروف هذا الزمن الخاص، إنها نبيّ فدائيّ يكتنز الوعد، ولا يبالي بأجر مباشر، بل لا يشاء أن يتّخذ على ذلك أجراً.
"هل تحسّ الغزالة أني/ لها/ جسدٌ... أو ثمرْ؟".
هكذا قالت الشجرة المهملة، تنطلق في قولها بالتوازي مع المقطع السابق، من الخبر إلى الإنشاء، لتؤكّد نضاليّتها، وعدم تراجعها عن مكانها وزمانها.
لماذا يسند الإحساسَ إلى الغزالة في إسار الاستفهام بـ"هل"؟ لماذا الغزالة؟ أيكون ذلك لأنها تمثّل الكائن الجميل الضعيف المذعور، أم لكونها الكائن النشيط عند الفجر والغروب، ويعيش في الأودية الجبليّة الهادئة، أو في الصحارى الرمليّة. ويعيش على القليل من النباتات مثل الحشائش، والأعشاب والشجيرات، وفي أوقات الجفاف يتغذّى على الشجيرات الصحراويّة الجافّة؟ ربّما، فالشجرة المهملة في زمانها، خريفاً أو ربيعاً، تشكّل جسداً للغزالة، أو ثمراً. ومن هنا أفهم الاستفهام بدلالته الخارجة على دلالة الاستفهام الحقيقيّة، فهو النفي، لكن الشاعر - الشجرة، لا يريد إغلاق الباب نهائيّاً في وجه ذلك الإحساس المفقود راهناً؛ فيدع فسحةً طباعيّةً بيضاء ويصرّح إثرها: "إنني أنتظرْ".
الخريف والربيع ظرف الشجرة، عمرها، أمّا الشجرة فهي عمر الغزالة، أي هي عمر الحيوان الجميل، وعى ذلك الحيوانُ هذا الأمر أم لم يعِ.
الشجرة، لن تستقرّ على متحرّك
"في المساء الذي يتنزّه بين العيون
أزرقاً، أخضراً، أو ذهب
بَدَني
هل يحسّ المحبّون أني لهم
شرفةٌ... أو قمرْ؟
إنّني أنتظرْ...".
هكذا قالت الشجرة المهملة، وإذا كانت المفردة (هكذا) تفيد العرضَ لهيئة القول، فإنها أيضاً تفيد تعدّد المظاهر لتلك الهيئة، وهذا ما يجعلنا لدنْ كلّ مقطع نتردّد بإزاء المدخل العلاميّ. وما ذلك في شعر محمود درويش بعامّة إلاّ لكونه لا يعلن قصيدته إلاّ بعد أن تكون قد امتلأت شعراً، أي بعد أن تكون قد تزاحمت فيها العلامات.
إذا اخترنا العلامات الزمانيّة (القصيدة برمّتها مشدودة إلى مفردة "مهملة" التي تستدعي الزمن "أنتظر" ليكون مساحة المأساة والمقاومة) فإننا لن نعثر للزمن على مزية خاصّة في كلّ مقطع لأنه المشكلة التي اقتضت القصيدة، وهو القضيّة التي لن يفلت منها الشاعر أبداً. فالزمن عند العربيّ هو الذي يهلكه ولا شيء غيره يهلك الإنسان: "وما يهلكنا إلا الدهر". وفي الأسطورة اليونانيّة: "هو كرونوس الإله الذي يأكل أبناءه". ومع ذلك نجدُنا من أوّل هذا المقطع أمام حرف ظرفيّ لصوته دلالة زمانيّة مهمّة: "في". لو أصغينا إلى التقعير الذي يمارسه "الياء" لوجدنا المساء ينبعجُ في وسطه لمصلحة التشكّل البدنيّ للشجرة المهملة، إنه المساء الحاضن للشجرة. لا يقول الشاعر: المساء بدني، بل يقول: في المساء بدني، وهذا يدلّ على أن "في" تهندسُ المساء ليلائم الشجرة.
وإذا تابعنا بغيةَ التعرّف إلى هذا المساء الخاصّ، لألفينا الوصفَ باسم الموصول "الذي"؛ من شأنه أن يخصّص المساء بفعل يدلّ على المداومة والاستمرار "يتنزّه"، ما يعني أنه فعل لا يقدّم معلومةً عن حدث، بل يقدّم معلومةً عن إمكان حدوث، وهذا ما يتلاءم والانتظار.
ويعود الحرفُ "الياء" في الظرف "بين" ليأخذ فعل المساء الوصفيّ، إلى قعر العيون، وهذا ينسجم مع فلسفة الشعر أصلاً التي لا تعترف بأن للأشياء وجوداً خارج رؤية الشاعر، فالأشياء ليس كما هي، بل كما تبدو، وإذْ يبدو المساء، فإنه على أحوالٍ تتواتر بتواتر التنزّه وتتنوّع بتنوّعه، فالمساء يتنزّه "أزرقاً، أخضراً، أو ذهب"، وقد منح النصّ هذه المفردات معاني تضمينيّةً لا يمكن أن نحيط بها ما لم نعثر على المشترك بين ثقافة الشاعر وثقافة المتلقّي. فالزرقة عندنا مرتبطة بالبحر والسماء، والخضرة مرتبطة بالحقول والغابات، والذهب مرتبط بسقوط الشمس في قبضة الصحراء. واللافت هنا أن علامات الإعراب قد أخضعها الشاعر للرخصة المعطاة له في تصريف ما لا ينصرف أصلاً (أزرق، أخضر)، وتسكين ما ينبغي تحريكُه (ذهب)، أفلا يدلّ ذلك على شيء؟
التنوين الذي اعترى "أزرق، أخضر" إنما هو لإعدام الحركة في منتهى الغاية البصريّة لدن هذين الكيانين، وكذلك تسكين "ذهب"، ولماذا إعدام الحركة؟ هل لأن الشجرة لن تستقرّ على متحرّك؟ هل لأن الحركة المفتوحة هي على الضدّ مع العيون؛ فيتمّ التدخّل ضدّ اللغة وإجبارُها على الحدّ من ضدّيّتها؟ نعم، وبهذا تخصّصَ كونُ بدَنِ الشجرة المهملة في المساء.
إذاً، هكذا قالت الشجرة المهملة معاندتها، أو هكذا قالت الشجرة المهملة مشروعَها في مواجهة الأمداء التي لا تبالي بها.
وهنا، ينتهي الخبر، ليبدأ الإنشاء بالتوازي مع المقطع السابق، "هل يحسّ المحبّون أني لهم/ شرفةٌ... أو قمرْ؟".
مرّةً أخرى يخرج الاستفهامُ بـ"هل" على معناه الحقيقيّ، لا يخرج ويغلق الباب وراءه، بل يضمّنُه النفيَ ليكون النفي غير نهائيّ، وكأني بالشاعر الخلاّق رأى لو أنه استعمل أداة نفي لكان المعنى قد انحصر بما تؤدّيه تلك الأداة (لا، مثلاً) وهذا ما لا يريده. إذاً من اللطف أن ينفي بصيغة الاستفهام، ففي ذلك تحريض لضمير المخاطب، يحرّضُه ليحاول الإجابة بـ"نعم" أو "لا". و لا ينتهي اللطف عند هذا الخروج بـ"هل" على معناها الأصيل إلى معنى مجازيّ، بل عندما يدخل الاستفهام على الفعل"يحسّ" مسنداً إلى "المحبّون"، يدَعُ المحبّين بلا مفعولٍ ليتمكّن قارئ القصيدة من تقديره، فذاك لطفٌ لكونه يصمت عن سلب الإحساس عن نوعٍ معيّن من المحبّين، بل يسلبه ويدعُ فرصةً لأيّ محبّ أن يستثني نفسه من هذا الإطلاق. وكذلك لطف ثالثٌ في هذا الأداء عندما يُنزل المحبّين - المخاطبين بهذا التعبير منزلة الغائب، وذلك التفاتٌ جميلٌ يتّكئ على سلوك اجتماعيّ قيميّ منطوقُه بين العامّة: "بحكيك يا كنّة لتسمعي يا جارة". فالكلام السلبيّ المباشر، يعمد المتكلّم إليه عندما يكون غير آبهٍ بردّ الفعل، أو يريد إحراج المخاطب، ولا يكون جادّاً في تعديل الواقع، أمّا عندما يكون جادّاً فإنه يتنخّل كلماته ويلتمس للمتلقّي فرصاً تجعله قادراً على تعديل سلوكه من دون أن تخدش كرامته... على المتلقّين أن يحسّوا أن الشجرة شرفة لهم، يطلّون عبرها على مراميهم، أو قمر لهم يرون في صفحته ما لا يراه سواهم...
إذاً؛ الشجرة المهملة خبيرة ورائدة، وهي لا تمارس نقدها، ولا تعلن همومها لإدانة الآخر؛ بل تفسح له في المجال كي يعدّل وجهة نظره بكرامة، فهل ستوفّق الشجرة في الختام؟ "إنني أنتظرْ".
الشجرة، خنجرٌ أو مطر...
"في الجفاف الذي يكسر الريح
هل يعرف الفقراء
أنني
منبع الريح؟ هل يشعرون بأني لهم
خنجرٌ... أو مطر؟
إنني أنتظرْ...".
في الجفاف، ماذا في الجفاف، أو من في الجفاف؟ كان في وسع الشجرة أن تقول: "أنا في الجفاف"، ويرضى الخليل بن أحمد، لكنّ القول هذا لم يتمّ، فهل يعني ذلك أن الشجرةَ ليست في الجفاف؟ الإباحة هي الأصل في ما لم يردْ فيه نصّ كما يقول الفقهاء.
وثمة احتمال آخر لا يقلّ قوّة عن الاحتمال السابق، وهو أن يكون الفقراء في الجفاف. إذاً، فهمنا لماذا لم يذكر النصّ المحكوم عليه بمتعلّقِ الجارّ والمجرور، فلو ذكرَ لتوقّفَ التخمين، وخسرت الشعريّةُ بعضاً من إثاراتها، فاحتمال الشجرة، يبقى قائماً، واحتمال الفقراء كذلك، واحتمال الاثنين معاً، أيضاً، وهذا هو الأرجح، وفي ذلك الأسلوب مكمنٌ من مكامن الإبداع الشعريّ. أن يستدعيك النصّ إلى الممحوّ من الكلام قبلَ أن تبدأ بالتعامل مع المثبت، فذلك من قدراتِ النصّ الغامضة، وملامحُ الممحوّ باديةٌ على وجه الكلام المثبت، فكيف لك أن تتجاهل ذلك، وأنت آليت على نفسك أن تفي النصّ حقّه من القراءة؟!
بإمكاننا أن نفاتحَ النصّ بنظرتنا إلى مفرداته الأساسيّة، ونقول له إنها في معظمها علاماتٌ على أحوال مناخيّة بدائيّة، (الجفاف/ الريح/ مطر) تستدعينا إلى بدايات النظرِ إليها، وعلينا أن نرصد فيها موقف الإنسان منها إذ يصنّف الكائناتِ المحيطةِ به أو الأحوال، بين حليف وعدوّ، فالجفافُ حالٌ معادية، على الدوام، والريح أحياناً، وكذلك المطر. وإذا كان الجفاف قد خصّه النصّ بصلةِ الموصول (يكسرُ الريح)، فذلك دلالة على شراسته وإمعانه في عداوته، ولكون الفعل يكسر فعلاً مضارعاً، فذلك لإثبات صفةِ الدوام والاستمرار له. لكن النصّ الممعن في تقديم الأزمة على أنها أزمة مواقف، يعمد إلى إثارة الفقراء وهم في قبضة الجفاف، يطالبهم بأن يعرفوا. ويأتي الطلب في صيغة الاستفهام بـ"هل" ليُدفعَ زمنُ الفعل إلى المستقبل، إذ المشهد مشهدُ مواجهةٍ بين الجفاف الذي يكسر الريح من جهة، والفقراء الذين لا يعرفون أن الشجرة منبع الريح من جهةٍ أخرى. وهذا يشكّل إشارةً إلى القرابة المفترضة بين الشجرة والفقراء، فكلاهما ضحايا الجفاف، ما يستلزم تحالفاً غير قائم في الواقع الراهن. وبحسب النصّ يتحمّل الفقراء مسؤوليةَ عدم قيامه حتّى الآن، إذاً، الشجرة منبع الريح. ما يعني أن الريحَ لها دور إيجابيّ هنا فهي التي تزجي سحاباً في مواجهة الجفاف، وإذا كانت الآن عرضة للكسر فتلك حالٌ موقّتة، ستنقضي عندما يعرف الفقراء أن الشجرة منبع الريح، فيحتفون بها ويهتمّون بجذورها وغصونها ووعودها، وتأتي مفردة "منبع" لتؤكّد إيجابيّةَ الريح، من كونها المفردة المرتبطة في أصل اللغة بالدلالة على الماء النقيض الرسميّ للجفاف. ما يعني أن إضافةَ مفردة "منبع" إلى الريح يُنزّل الريحَ منزلةَ ما ينبع، وهذه رؤيةٌ شعريّةٌ من شأنها إغراءَ الفقراء بالشجرة التي هي منبع الريح.
ويكرّر الطلب، بواسطة الاستفهام بـ"هل". وكأني بالموقف الأوّل "يعرف الفقراء"، وهو موقفٌ يستلزم نشاطاً عقليّاً، كأني به لا يكفي، فيعمد إلى تحريضٍ آخر يعزّزُ به العقل، إنه الموقف الوجدانيّ "هل يشعرون"، ما يعني أن النضالَ ضدّ العدوّ يقتضي وعياً. هذا صحيح، لكنه يقتضي حبّاً أيضاً، وإذا لم يُعزّز الموقفُ العقليّ بحبّ سيبقى ترفاً لن يصلك بأيّ أمل.
ما المأمول؟ إنّه بلا شكّ وعي الفقراء لأهمية التحالف مع الشجرة المهملة، ووعيهم أن الأمن يقتضي توفيرَ الحمايةِ في وجه الأعداء الذين يستهدفون وجودهم الماديّ؛ فالشجرة لهم خنجرٌ، ويقتضي الأمنُ أيضاً توفيرَ الحماية من الذين يستهدفونهم في لقمة عيشهم وفي كرامتهم، فالشجرة لهم مطر.
"هل يعرفون (...) هل يشعرون (...) إنني أنتظر".
إذاً، هكذا قالت الشجرة المهملة ثورتها على الجفاف، في وصفها حليفاً طبيعيّاً للفقراء، وفي وصفه عدوّاً لا يرحم. وسواء وعى الفقراء مصالحهم، أم لم يعوا، فإن الشجرة ستزاول كونها منبع الريح وخنجراً ومطراً، وستزاول مهنة الانتظار للعقل والحبّ معاً.
5- الشجرة، نفي الأوهام
"خارج الطقس،
أو داخلَ الغابةِ الواسعة
كان يهملني مَنْ أحبُّ
ولكنني
لن أودّع أغصانيَ الضائعة
في زحام الشجر
إنّني أنتظر...".
خارج - داخل، مرّةً أخرى. الطقس - الغابة الواسعة، مرّةً أخرى. هل هي دائرة تجد الشجرةُ فيها نفسَها عند نقطة البدء كلما حسبَتْها عند المنتهى؟ أم أن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن تتشابه بعض فقراته، كما يقول ابن خلدون؟
في الواقع، هكذا قالت الشجرة المهملة، قالت أداءها الحضوريّ بين الماضي والمستقبل. "كان يهملني مَنْ أُحبّ"، هذا الشكل التعبيريّ لمعاناة الشجرة خارج الطقس، أو داخل الغابة الواسعة، شكلٌ إخباريّ، يفترض أن المتلقّي خالي الذهن إزاءه، لكنّ مقتضاه يكمن في ما هو أبعد من كون الشجرة المهملة ترغب في تزويد المتلقّي بما لا يعلم، هكذا لمجرّد الإخبار، بل تشير هذه العلامة التركيبيّة إلى محمول تبريريّ، تحتاجه الشجرة وهي تؤدّي سلوكاً قد يُستغرب منها. تُرى، هل هذا وهمٌ منّا نحن القرّاء، أم هي الحقيقة؟
الفعل "يهملني" في معناه يدلّ على اضطهاد من نوع ثقيل، يستهدف الكرامة ويبخس مفعول الإهمال أشياءه التي يعتزّ بها، وفي صيغته المضارعيّة يدلّ على أن الفاعل يزاول ذلك في وصفه سلوكاً ملازماً له، كأنْْ يكون من طبعه الإهمال. ويزيد المسألةَ مرارةً أن الذي أُسند إليه فعل الإهمال هو "مَن أحبّ". إذاً، كلّ شيء في هذا التعبير، يشير إلى أن الشجرة ستسلك سلوكاً يشكّل نقيضاً ثأرياً للفعل "يهملني"، وقد يكون من حقّها، إلا أننا نرى كلّ الخونة والمنحرفين يبرّرون خياناتهم وانحرافاتهم بهذه الطريقة.
والأمر اللافت هنا، هو لو نتابع هذا النصّ، سنجد أن الشجرة تستدرك، وكأنها عرفت بما ستوسوسُ لنا النفسُ السيّئة الظنّ، فتأتي بحرف الاستدراك "لكنني" لتدفع أوهامنا كلّها، فالاستدراك بـ"لكنّ" يثبتُ ما يُتوهّم نفيُه، أو ينفي ما يُتوهَّم إثباتُه، فهي من أدوات التعارض، ومن شأنها هنا أن تعِدَ بتعبير معارضٍ لما سبقها، فإذا كنّا قد توهّمنا إخبارَها السابق لتبرير سلوكٍ ثأريّ؛ فإن التعبير بعد "لكنّ" ينفي ذلك، وهنا مكمن الإبداع الفنّيّ الذي يستغلّ إمكانات اللغة للتبشير بما ينبغي أن يكون عليه السلوك النضاليّ: "اغفرْ لهمْ يا أبتاه إنهم لا يدرون ماذا يصنعون". أوليس الشاعر فلسطينيّاً؟ إذاً لا بدّ للثقافة المسيحيّة من أن يكون لها دورُها في أداء حضوره النضاليّ ضدّ الجفاف وضدّ خذلان الأحبّة، وضدّ...
ماذا بعد "لكنّ"؟
"لن أودّع أغصانيَ الضائعة
في زحامِ الشجر".
هكذا قالت الشجرة المهملة ردّها على سلوك المحبوب، نفت عن نفسها فعلاً توهّمناه، فعلاً يؤدّي - لو كان - إلى كارثة مبدئيّة "مبرّرة". فالشجرة هنا لا تطلب من المحبوب أن يعدّل موقفه، بل تُلزم نفسها بسلوك وجدانيّ يحفظ كرامةَ الانتظار الذي كان في ختام المقاطع علامةً على العناد في زحمة الانكسارات الوجدانيّة. وحتّى نفهم الفعل المنفيّ فلنجرّب تجريده من النفي، فما الذي يحصل؟ الأغصان الضائعة ستبقى ضائعة، وزحام الشجر سيبقى على لامبالاته بما ضيّع. بينما النفي أعطى لهذا الفعل المسندِ إلى الشجرة بُعداً تحصينيّاً يعزّز الصّمود في مهبّ الضياع، بل يعطي للموقف الوجدانيّ قيمته الحقيقيّة، فتقول قد يكون بإمكانك أيها الـ... أن تحولَ بيني وبين حقّي، لكن لن يكون بإمكانك أن تحول بيني وبين الإحساس بحقّي وبأنك المغتصِب.
"إني أنتظر".
وهكذا كان لنا مع هذه القصيدة أن نمتاحَ إحساساتِنا الارتوازيّة من أعماق نفوسنا المستترة بإسمنت الذرائع، وكان لنا أن نكتشف مواطن القوّة فينا، فشكراً لك يا محمود درويش أنك أصغيت إلى الشجرة المهملة، وشكراً لك أنك نقلت إلينا ما تستند إليه في ثباتها رغم كلّ شيء. وإني معها أنتظر ولن أملّ الانتظار.
****
ربما يبدو العنوان في بدايته مألوفاً، حيث الآخر صوتٌ جلي في كتابة الذات، في الذات نفسها، وأن عملية التصدي لها، مثلما هي عملية القيام في التعبير عنها، ممارسة يوميّة، أو دائمة، صراحة أو ضمناً، وأن إظهار العلاقة هذه، تعميق لخاصّيّة الذات، هذه التي لا تعدو أن تكون من جهتها، وجهاً من وجوه الآخر بالمقابل، طالما أن كلاً منّا، هو آخر ما، حتى بالنسبة إلى ذاته، عدا عن كونه الذاتَ التي تعنيه، في ما يقول ويكتب، يفسّر ويؤول، يحسم أو يتكتّم عليه، يمانع أو يقاطع دون التخلص، أبداً، مما يعتبَر، دور الذات للذات، إزاء الحالات التي تعيشها، وبصيغ شتّى.
وفي حيّز العلاقة ذاتها، وهذه متعدّدة ومتنوّعة، تكون الترجمة، عتبة مناظرة ومغامرة قوليّة، لا تعمل على احتواء الآخر، عبر ترجمة نصّيّة، أو شفاهيّة ما، وفي مجال ما، إنما تفصح عن خاصّيّها المعينة، في مسلكيّة توعيتها الذاتيّة، في استراتيجيّة الموقف مما يحيط بها، والآخر يستشرف عتبتها القيميّة، مثلما يجلو موقعها الرمزيّ، مثلما يكون أفق رؤيا، أي أن ثمة منطقة ما، تشكّل حقلاً لصراع الرؤى، الدلالات، قيامات الرموز، متشابكة، بين صاحب الذات والآخر.
العنوان الآنف الذكر، يتحدّد بالمتضمَّن فيه (محمود درويش بين سليم بركات وإدوارد سعيد)، حيث الترتيب هذا، هو من خلال العلاقة التاريخيّة، وليس التفضيل الرمزيّ، إذ الأول شاعر وروائي كردي أصلاً، صاحب التوأم اللغوي: النثر والشعر، وأثير عند الشاعر الفلسطيني درويش، وقد عمل سكرتير تحرير مجلة "الكرمل"، تلك التي كان الأول مسؤولاً عنها، لقرابة عقدين من الزمن، ونشر فيها الكثير من نصوصه الشعريّة والنثريّة. فالعلاقة هذه، زمنيّة، مثلما هي مكانيّة، وكذلك وجدانيّة، ومن وجهة نظر معيّنة، يتكفّل الشعر بالتعبير عنها، بترجمة حراكها الدلاليّ المرصود، بينما إدوارد سعيد، فهو مفكّر وناقد فلسطيني متأمرك معروف، والصلة بينهما موطنيّة موحّدة، وفي الوقت نفسه، تكون سياسيّة ووجدانيّة، من جهة النظر في ما يجري فلسطينيّاً، وفي محيط التآخذ الفكري والأدبي العام كذلك، ودرويش هنا له علاقات كثيرة، في صفته شاعراً صيتيّاً، كما هو معروف بدوره، مع الكثير من الأشخاص ذوي المكانة السياسية والأدبية والفكرية، والعاديين أيضاً، وكتب عن هؤلاء من منظورات نفسيّة، ذاتيّة مختلفة في مآلاتها الأدبيّة، في أمكنة تتفاوت تأثيراتها، أو حضوراتها الدلاليّة أو المفهوميّة فيه.
وما كتبه عن سليم بركات وإدوارد سعيد، علائقيّ تماماً، مثلما هو وضع ترجماني لهذه العلائقية المركّبة من الداخل، حيث خصّ كلاً منهما بقصيدة لم تسمَّ باسمه، وإنما جاءت إهداء، لكنه مخاطَب من خلالها، وهو معنيّ بقوله، الأوّل، في ديوانه "لا تعتذر عما فعلت"، سنة 2004، والثاني، في ديوانه "كزهر اللوز أو أبعد"، سنة 2005. وكذلك، فإن بنية السرد في الأولى تكون أقلّ حوارية من الثانية، إنها وصفيّة، حيث الوصف يحيل الآخر على مادّة أو موضوع، يتشكّل في المصهر النفسيّ للشاعر، ويكون الآخر أقرب إلى الغياب، في سياق التتابع الجمليّ، أو مكوّنات الحدث الشعريّ، منه إلى الحضور، لأن السارد هو درويش، وهو الحاضر بخطابه، ذي الدلالة السلطويّة الرمزيّة طبعاً، ونادراً ما يخرج خطاب المتكلّم: درويش، مسلِساً القياد للآخر ليتكلّم هو، في ضرب حواريّ، طالما ناصية الكلام بيده، تعبيراً آخر، عن ترك المجال مفتوحاً أكثر، ليبرز هو، أكثر اقتداراً، قرباً من ذاته، كما هي لغة ضمير "الأنا" للشاعر العربي هنا.
أما بنية السرد في الثانية، فتتشعّب، أو تتوزّع بين ناطقة بلسان السارد، ولسان الآخر: الغائب الحاضر، أو الراحل، مظهِرة مدى توق الشاعر إلى هذا الآخر: الداخل في ذاته، ومثلما تتّخذ اللغة مظهراً من مظاهر الاتفاق أحياناً أخرى، في المزج الحواري، مع بقاء صوت الآخر جليّاً، وما يعنيه هذا الحضور البثي من قيمة دلاليّة، على صعيد أفق الرؤية والمعتقد الذاتيين، حيث تشكّل مساحة الأولى أقلّ من ثلث مساحة الثانية، من جهة عدد الصفحات (6 مقابل 18)!
ولعلّ التوقف عند هذين النصّيّن، إجراء ثقافيّ قبل كلّ شيء، وليس نقداً أدبيّاً فقط، لأن قراءة القصيدتين، تتجاوز حدود النصّين، حيث أنهما، في أساسهما، عبارة عن قراءة ما، في قراءة ما، أخرى، لكلّ منهما، لبركات وسعيد، بطريقته الخاصّة، وجاءت القراءة الشعريّة، من خلال جملة من الإحالات المكانيّة والزمانيّة، وكذلك تيمة التحويل القيميّ لذات كلّ كاتب. إنها إحالات، لا تكتفي بتقديم صورة شعريّة، وصفيّة، هي أفق جماليّ مرئيّ للشاعر، هندسيّ الأبعاد قطعاً، في الفكرة القائمة، إزاء خاصّيّة كلّ علاقة مختلفة، إنما تواجه ذات الشاعر شاعرَها، في ما تقرأه في الموسوم، مما يعنيه سلوكاً مستطرَفاً أو مستظرفاً، وفي ما يميّزه مكانة كلمةٍ، ومدىً لها.
يعني ذلك، أن قراءة القصيدتين، هي في غاية الفقر وضحالة المعنى، إن لم تمتدّ إلى بعض مميّز لكلا الكاتبين، وكيف أن القراءة هذه، في تنوّع روافدها المحيطيّة، تشكّل وضعاً ثقافيّاً لدرويش الشاعر المتفكّر على طريقته، أو المتفكّر الشاعر بطريقته إجمالاً.
والميزة اللافتة هنا، أيضاً، تتلخّص في النقاط الآتية:
كيف يمكن سبر علاقة الشعر بالشعر والرواية والفكر؟ كما لو أن الشعر يعلن عن سفارته المتحرّكة في ذات الآخر، وهي سفارة أدبيّة رحّالة، طريفة بمعماريّتها هذه المتنوّعة المقاسات، وكيف تكون واجهتها، فلتة الإكساء التعبيريّ للواجهة هذه، فتنة المنظور الجماليّ لها، والتي تكون معتقديّة، مثلما تكون فنيّة بالمقابل، كما هي سفارة فكريّة، لا تبقي درويش مجرّد شاعر، إنما متدبّر تفكير في التعبير الشعريّ، وما في الإجراء هذا، من استشراف هاوية النظر، أو مخاطر الوقع في المباشرة المفقِرة لروح الشعر الهرمزيّة.
ما الذي يثار في علاقة شاعر، له حضوره الشعري، في حيّز العلاقة المركّبة هذه؟ أي قيمة أدبيّة مشتركة، يمكن استشفافها، في العلاقة الشعريّة غير الثابتة، غير المحدّدة هذه كعادتها؟ حيث الأوّل ما زال يحيا، بينما الآخر مضى على رحيله سنوات ثلاث. أكثر مما تقدّم، أي صنافة أدبيّة، جماليّة، قيميّة، كائنيّة اعتباريّة، يمكن تشكيلها، أو بنرمتها (من البانوراما) ثقافيّاً هنا؟ حيث الأوّل، وهو بركات، كردي، كما ذكرت، ومعروف ككاتب كبير يكتب بالعربية، بينما سعيد، فقد كان متأمركاً، ولا يتوقف عن التذكير بفلسطينيّته، عدا انشغالاته بمستجدّات العالم والمنطقة، على صعد شتى، وهو معروف بالانكليزيّة طبعاً؟
أظنني، للأسباب السالفة الذكر، أردت كتابة عنوان، يتوضّح في ثالوث علائقي، هو في الأساس، ثالوث شعريّ درويشيّ، لا دخل للكاتبين فيه، إنما هو دخل المُؤتى الأدبي الرمزيّ تحديداً.
ولعلّي، في موضوعي هذا، أمارس ترجمة أخرى، علائقيّة بدورها، وأنا، أسعى جاهداً، وفي حدود المتاح، إلى مكاشفة ثقافيّة للحراك الأدبيّ، وحتى عنف المنظور، لنصَّيْ درويش.
استنطاق العنوان
لا يمكن الحديث عن القصيدتين المتتاليتين هنا، "ليس للكرديّ إلا الريح" و"طباق"، إلا باعتبارهما نصّين متجاورين، إنما هما متداخلان أيضاً، إلى درجة كبيرة، حيث قراءة أي منهما، تلقي ظلالاً على الأخرى، مع حفظ اللقب التاريخيّ للأولى، لأسبقيتها كتابة، لكن من دون نسيان فضيلة الثانية، في استنارة المعلم الأدبيّ والرمزيّ للسالفة.
أما عن إبراز وجه الصلة بين كلّ قصيدة والعنوان العام للديوان، ففيه الكثير من المماحكة، وإزاحة المعنى الممكن الإطمئنان إليه، ولو قليلاً، ولو أن شيطان المعنى الموسوس هذا، يهمس بذكر أصداء من الدلالات الحافّة، حتى إن بدت ذات نسب يوتوبي.
في "ليس للكردي إلا الريح"، ترتبط القصيدة بالديوان، بعنوانه العام "لا تعتذر عمّا فعلت"، حيث ثمة قصيدة تحمل هذا الاسم ضمناً، وتلقي ضوءاً على جانب ما، من السيرة الذاتية لدرويش نفسه، عن موقفه، عمّا يحسّ ويشعر، عمّن يتعامل ويستأثر باهتماماته... إلخ، وللمرء القارىء أن يسأل، عن صلة المفردة الواردة في قصيدة بركات عن درويش وباسمه (محمود درويش)، في ديوانه "البازيار"، أي عاشق الباز، وهي "فلتعتذر"، في السياق النصّيّ، كما سنرى، إضافة، إلى إحالات أخرى ضروريّة، ومثيرة، تبرز علاقة درويش ببركات كشاعر وكنصّ أيضاً، وأن مفردة "الريح" ذاتها، تشغل درويش، مثلما تستثير بركات كثيراً جدّاً، كما سنرى كذلك، وكيف أن اعتماد الريح يبقى مختلفاً من جهة التدوير، أو الاستقدام، لاختلاف خاصّيّة كلّ منهما. أما في "طباق"، فهي، في حقيقتها، تشكّل عنواناً للحلقة الرابعة، من عنوان شعري، أو قيّض له أن يكون شعريّاً، وهو "منفى"، وهذه مفردة أثيرة عند درويش، نظراً لمحوريّة العلاقة، مثلما أن فلسطينيّه المتأمرك، يعاني منها، وقد كتب عن المنفى كثيراً، إنما المؤثّر بالمقابل، هو أن العنوان الفرعي "طباق"، يشكّل تيمة فكريّة وثقافيّة ساخنة بمضمونها، عند سعيد، في كتابه الغنيّ عن التعريف "الثقافة والإمبرياليّة"، نوعاً من التعدّديّة، والتكامل الأعراقيّ والحضاريّ بين الشعوب، وهو ما كان يشدّد عليه، من خلال مفهوم (الهجنة hybrid)، بين الثقافات المختلفة، وقد طبّق المفهوم هذا، في دراسته للكثير من النصوص الأدبيّة والسياسيّة والفكريّة وغيرها عالميّاً. أي أن درويش عالم تماماً، بأصدائيّة المفردة، ودون أخذ العلم بوضع متلبّس كهذا، لا يمكن التعرّف إلى الهاجس الشعريّ عنده، وكيف تُستقى مفرداته التي هي صلات وصل ثقافيّة. وكذلك، فإن النصّ الفرعي، يندرج في حيّز عنوان عام، وهو "كزهر اللوز أو أبعد"، وثمة عنوان لقصيدة لها دلالتها المكانيّة والرمزيّة، هي "لوصف زهر اللوز"، لا أظنّها بعيدة كثيراً، عن المهاد السيري لدرويش، خصوصاً إذا علمنا، مدى صلة زهر اللوز بمرموزه، بالقدسيّ والعذريّ معاً، وبأبهاء المكان فلسطينيّاً تماماً، كما سيتضح ذلك لاحقاً. وما يجب التذكير به هنا، أخيراً وليس آخراً، هو ورود اسم الإهداء ترتيباً، رغم أن كلاً منهما، كانت الأخيرة ترتيباً في الديوان، دون نسيان المساحة المختلفة لكل منهما (ست صفحات ونيّف، تلك التي تخصّ بركات، وثماني عشرة صفحة ونيف، تلك التي تخصّ سعيد)، وكيف أن بنية اللغة تختلف كثافة وعمقاً، وبحسب طبيعة العلاقة بالتأكيد.
تأتي كلمة الإهداء إلى بركات، ليس بعد عنوان القصيدة، حيث خصّصت صفحة كاملة له، إنما في الصفحة التي تسلسلت القصيدة فيها، ومن جهة اليسار، والحالة الثانية مختلفة، أي في ذات الصفحة المخصصة لعنوان القصيدة الفرعي، وأظن أن لأمر الترتيب دلالته النفسيّة والموقعيّة أيضاً، حيث أن بركات يحال على ذات القصيدة، داخلاً، بقدر ما يبقى العنوان مفتوحاً للتأويل، وهو تأويل لا يحسن صنعة مقاربته الدلاليّة، إلا من اطّلع على مكانة الريح بركاتيّاً، وما يرتدّ إلى المضمر في بركات كرديّاً، وكما هو مقروء شعريّاً، من لدن درويش الشاعر هنا، فالعنوان متروك لحاله، أي إنه يشكّل عتبة نظر مفتوحة على أكثر، في أكثر من أفق معنى، خصوصاً، بالنسبة إلى من لم يحط علماً هرمنوطيقياً، بمفهوم الريح العام والخاصّ.
بينما ترد كلمة الإهداء مباشرة، إلى سعيد بعد العنوان الفرعيّ، ليكون سعيد عتبة رؤية لخاصّيّة العنوان هنا، وليس ملحقاً بالقصيدة تحديداً، من خلال حالة الوصل، وبالتالي، فإن القراءة الحجاجيّة، مثلما هي التكهنيّة، تستبق المعنى المستخلص من القصيدة، عبر الممكن تأويله داخل العنوان، هذا الذي يترذرذ في المساحة المخصّصة للقصيدة.
يغدو اسم سعيد إذاً، أشبه بعلامة فارقة، خلل العنوان، بينما، اسم بركات، فهو مارقة في مفترق القصيدة، أو في البرزخ المكاني والفراغي الفاصل بين العنوان وشروع القصيدة.
هل أبالغ هنا، إذا قلت، حتى الآن، إن بركات، يتحرّك في وعي درويش جزئيّاً، وهو مقدّر كحامل رمزيّ لمن يمثّل أجناسيّاً (باعتباره كرديّاً)، وفي ضرب من البلاغة المرتدّة إلى الوراء، تكون جغرافيّتها شائهة، بينما سعيد، فهو يتحرّك في مساحة وعي أكثر صلابة ووساعة وانهمام مغزى، وهو مقدّر بدوره، لكن كحامل رمزيّ مقدام، وهو في رحيله، وفي ضرب من القول أكثر انفتاحاً على النثر المفكّر فيه، هذه المرّة، تكون جغرافيّته فارهة، لوضع علائقي محتسب؟...
التفعيل الأدبي والثقافي
كيف قدّر لدرويش أن يكتب قصيدتيه هاتين، وفي زمانين مختلفين، وربما في مكانين مختلفين أيضاً؟ حيث يكون تداخل في الصور، مثلما هو تشابه في القيمة الممكن استخلاصها... التعبير عن المنفى، ومأزق الهويّة، ومعاناة الهويّة، ومقاضاة المكان، رغم اختلافه، وفعل التثنية اللغويّة، وبراعة التعبير باللغة الأخرى (العربيّة بركاتيّاً، والإنكليزية سعيديّاً)، والكثير من الشلال الوصفي... يكاد يربك القصيدة بالذات، يمَأزق روح الشعر ذاته، والكلمات في بعض حالاتها، وهي مؤثّرة، تنكر شاعريّتها، وخصوصيّة اللقيا الفنّيّة فيها، من خلال واجهة استعراضيّة فيها، وخصوصاً بالنسبة إلى المذكور به، عن سعيد، وكأن درويش لم يكتب "طباق"، إلا وكانت "ليس للكردي إلا الريح" ماثلة أمام ناظريه، أو مفتوحة على المنضدة أو مرئية نصّاً... لنلاحظ جيداً:
عند بركات عند سعيد
1- أنا المسافر في مجازي كان المجاز ينام على ضفة النهر
2- هويتي لغتي. أنا... وأنا. لي لغة انكليزية للكتابة،
أنا لغتي. أنا المنفي في لغتي. طيعة المفردات،
وقلبي جمرة الكردي فوق جباله الزرقاء... ولي لغة من حوار السماء مع
القدس، فضية النبر، لكنها
لا تطيع مخيلتي
3- حمل الجهات، وقال: أسكن أينما فاحمل بلادك أنَّى ذهبت...
وقعت بي الجهة الأخيرة. هكذا وكن نرجسياً إذا لزم الأمر/
اختار الفراغ ونام
4- كلماته عضلاته. عضلاته كلماته على الريح يمشي. وفي الريح
يعرف من هو. لا سقف للريح.
5- منزله نظيف مثل عين الديك... يستحم. ويختار بدلته بأناقة ديك.
6- ليس مسافراً هذا المسافر، كيفما اتفق... هنا هامش يتقدم. أو مركز يتراجع
الشمال هو الجنوب، الشرق غرب لا الشرق شرق تماماً
ولا الغرب غرب تماماً
لأن الهوية مفتوحة للتعدّد.
7- يعرف ما يريد من المعاني أنا ما أكون وما سأكون
سأصنع نفسي بنفسي.
8- بقطن نشيدك الرعوي إلى الشاعر الرعوي
9- أنت الآن حرّ، يا ابن نفسك، أنت حرّ هو الواقعي الخيالي وابن الإرادة
10- وجُرَّ سماءك الأولى ولي لغة من حوار السماء مع
إلى قاموسك السحري. القدس...
11- باللغة انتصرت على الهوية، إن الهوية بنت الولادة، لكنها
في النهاية إبداع صاحبها،...
12- والنسور كثيرة حولي نسرٌ يودّع قمته عالياً
...
ما يعنيني كباحث، وفي حيّز دراستي لتينك القصيدتين، هو هذا التفعيل الأدبي والثقافي، كيفية تجلّي شخصيّة درويش كشاعر، وهو يحاول قراءة اسمين، لهما موقعهما الاعتباري عنده، ووفق تصوّر مختلف، لاختلاف كلّ منهما، وهو اختلاف يمتدّ في أكثر من جهة.
ولعلّي أستطيع القول هنا، بداية، على أن الزخم الشعريّ في النصّ الخاص ببركات، أكثر أهليّة بالشعر، بينما هو أقلّ في الجانب الآخر، إذ تطغى اللغة النثريّة، أعني اللغة اليوميّة العاديّة جداً، في مقاطع متعدّدة، ولا يجنّبها الانجراف في العاديّة، أو الاصطفاف خارجاً، وبعيداً، عن كل ما هو شعريّ، كما هو متداوَل، إلا الوزن الذي يوليه درويش أهمّية، هي ذاتها الأهمّية التي تبقي الذاكرة الجمعيّة، مخلصة لأهبة تراثيّة، لأذن جمعيّة ما، تحافظ على شعرة معاوية، في اللحظة الأقصى من إزاحة القول، عندما يتبدّى كأي قول مشاع، وشفيعه الوزن، يؤمّن الشعريّ له.
ثمة نقطتان، عليّ توضيحهما هنا، تترتّبان على موقف درويش من النثر والشعر معاً. في العلاقة بينهما يقول: "عندما كنت أكتب نثراً كنت أشعر أن النثر يسرق مني الشعر، فالنثر جذّاب وسريع الانتشار، ويتحمّل أجناساً أدبيّة أكثر من الشعر. ويستطيع أن يهضم الشعر ويعطيه مساحة وحركة أكبر. وكنت عندما أكتب النثر أنتبه إلى أنني نسيت القصيدة، وأن عليّ أن أعود إليها. هكذا أكون بين النثر والشعر، لكنني معروف بأنني شاعر ولا أسمى ناثراً"(1). هذا الاعتراف، أظنّه، يحمل في تضاعيفه النثريّة، ما لم يُسمَّ، وهو أن الشعر، في المظنون الدرويشيّ، يهبه قيمة توكيديّة أكثر، هي ذاتها القيمة التي تفعّله جماهيريّاً، القيمة التي تبرزه الشاعرَ المرتبط بمن كانوا رموزاً ذوي صيت سابقاً، إنه الشاعر المتحرّك في متن المعنى الملتهب من روحيّة القصيد العربي، روح الشعر الذي يحرّك وجدانات المحيطين به وقوفاً، كما تقتضي لغة المكان، والظرف التاريخيّ، وتحوّلات اللحظة التاريخيّة، وموقع الشاعر، ونظرته إلى نفسه، وليس التحرّك على خط التّماس إن جاز التعبير، إذ النثر العربي، إذا كان متناً في شأن من شؤونه المستوجبة والمطلوبة، نثر القراءة، النثر الصالونيّ، والنثر الاعتباريّ الموجّه، ليبقى الشعر خارج حاضرته، فإن الشعر، رغم كلّ المهدّد له سلطويّاً، ظلّ مراح الشاعر، روحه الطلقة في التشبّث بمداه المفتوح جهويّاً، عصيانه على الهضم نثريّاً، كما هو التعبير الجسديّ، في مفهوم الهضم: الاجتياف نفسيّاً، وتبديد هيئته، وليكون الخوف من النثر، هو حرص الشاعر على ذاته المغايرة، قدرته على الذات، وهي تستقطب جماهيرها، قرّاءها أكثر، كما هو متصوّر، عبر مسعاه، في نزع فتيل العنف داخل النثر المعهود، وتأميم توهّج الشعريّ، كما يفترَض، بلعبة تصوير جماليّة، يكون الوزن مفيّزها، لتُدرَك شعراً لا نثراً.
في النقطة الثانية، حين يقول صراحة: "أحب الموسيقى في الشعر. إنني مشبع بجماليات الإيقاع في الشعر العربي. ولا أستطيع أن أعبّر عن نفسي شعرياً إلا في الكتابة الشعرية الموزونة، لكنها ليست موزونة بالمعنى التقليدي. لا... إلخ"(2).
هذا مؤكَّد!، لكنه التأكيد نفسه الذي يلفي على مسمّاه، وليس على اسمه طبعاً، عندما يكون المسمّى بؤرة توتر، ضاجّة بالمعاني، ويتلمّس الشاعر في نفسه، حركة آبائية معينة، ليس في معنى التقليد، أو المحاكاة (محاكاة خلف لسلف)، وإنما الشعور بوجود سلف ما، أب ملحوظ، هو المعيّن له، ومعِينه، فيما يستشعر، تحرّكاً نحو رؤية أكثر شفافيّة وديمومة، بالإيقاع، هذا الذي يبرز قيَّاف المسافات، محصيها رياضياً، محصّن النصّ الشعريّ، بنقاط حراسة، أو نقاط علاّم، في توافق القوافي، أو تتالي الحركات المتوازية هارمونيّاً، عدا مباغتة الجديد حداثيّاً. أوَليس هو القائل، في القسم الأعظم من ديوانه "لا تعتذر عما فعلت"، والمعنون بـ"في شهوة الإيقاع"، ومن خلال عنوان فرعي لافت أكثر "يختارني الإيقاع"، ما يؤكّد المشار إليه؟:
"يختارني الإيقاع، يشرق بي
أنا رجع الكمان، ولست عازفه
أنا في حضرة الذكرى
صدى الأشياء تنطق بي
فأنطق..."(3).
ثمة مراوغة لغويّة، إحالة الذات على الآخر، على ثقافة سابقة، يكون الإيقاع بضعاً قيّماً فيها، في كيانها المعرفيّ الاجتماعيّ الرمزيّ. يكون المصوت من الداخل، بينما هي حرفه الصوتيّ، كما هو الكمان: الثقافة، وهو انبعاث صوته، إنه اتصال بمن كانوا، حنين ما، رغم كامل أهليّة الغدق الحداثي في كتابته النثرية أيضاً ("ذاكرة للنسيان"، ومن ثمّ "في حضرة الغياب"، لاحقاً، أو حديثاً أكثر)، دخول في برلمان سلف ما، جماهيريّ، شعبيّ، كما هو تاريخه النضاليّ الأرضيّ، هو ما ليس هو، وإن كان هو الناطق، طالما أنه مأخوذ بسواه: ثقافيه، موسيقيّه، كما لو أن النثر خواف الشعر، والشعر ظنّ النثر السيء بذاته، شيطانه الرجيم، كما يمكن تسميته عطفاً على تاريخ حافل بالرموز، وفي الصدارة اعتبار الشعر ذا نسب شيطاني، لكنه لا يُسمى هنا. لكأن درويش ذاته، داخل صومعة السلف، وخارجه، كما هو اعتباره، حيث يكون الخارج بشعره، لكنه الداخل بعدّته الشعرية، مع كامل التقدير للنثر المعتمَل داخله. إنه بعد مركَّب، هجنة أخرى، في الوصل والفصل، أو هدنة مستمرّة بين توأمي اللغة، دون مناوشات ظاهرة، يمكن تلمّسها، أكثر من آخر داخل الذات، طباق من نوع مختلف هنا ثقافيّاً. إنه الآخر ليس في تعدّد مستوياته، وإنما حالاته كذلك، أو وضعياته، كما في الحياة والموت، في الدلالة والقيمة، في الحضور والغياب على صعيد المفردة الواحدة، في الجمع بين الذي ما زال يحيا، هو بركات، والذي رحل، وهو الحاضر الغائب، هو سعيد، والجامع الرمزيّ بينهما درويش، وفي هذا الثالوث، يكون كلّ منهم، حاضراً لقيمة ما، وليس الشخص ذاته، وإن كان درويش مفعّل الحدث، حيث يظلّ، في أقصى تجلّياته، وجهاً سرديّاً، سيريّاً شعريّاً أيضاً.
وربّما من هذا المعبر الحدودي - التوضيحي - يمكن إماطة اللثام أكثر، عمّا يشغلنا هنا: العلاقة المتشابكة، بين النصّين، ومن خلال الأمثلة المذكورة، تعيد الذاكرة المكانيّة، إلى المكان الذي يتحرّك درويش فيه، به، إلى الحدود المرسومة نفسها، وخطوط تقاطعاتها، وأماكن التلاقي والتقاطع بين المسموح به، والمحظور تلفُّظه عند درويش، لأنه واحد في الحالتين.
أ- درويش إزاء بركات: فسحة التلاقي
تأتي قصيدة "ليس للكردي إلا الريح"، مدماكاً شعريّاً في المعمار الأدبيّ الشعريّ الدرويشيّ، فأن تأتي مفردة "الريح" أكثر من تأكيد علامة فارقة، بعد أداة الاستثناء، ربما، كان ذلك أشبه بجرافة ثلج في يوم عاصف، لفتح طريق، لتأكيد كينونة اعتباريّة لكائن موجود، حيث الريح تتوزّع في الجهات كلها، لكنها الروح الكونيّة بدورها، الريح تمثّل النفخة الكونيّة، والكائنات الحيّة تعود إلى هذه النفخة، كما هي العلاقة بين الريح والروح والراح(4).
والريح تتوزّع في الجهات كافة، ولها تسميات وألقاب، بحسب الزمان أو الفصل أيضاً. أي أننا نجد أنفسنا، إزاء نزعة فولكلوريّة في الحديث عن الريح، وتداعيات المأثور الثقافيّ فيها. لكن السؤال الجدير بالتذكير بداية، هو: من أين استقى درويش هذا الاسم؟ هل هو من عنده، وأن مخياله مولّد المفردة، أو العنوان ذاته؟ لأن الكردي مفهومٌ نوعاً، ويمكن البحث عنه، والمساءلة حوله، بينما الريح غير محدّدة، نحسّ بها، ولا نراها، إنها ليست مكاناً، موطناً، كما هو الكرديّ المحكوم بالمكان، أو من المفترض أن يكون مشاراً إليه بمكان، محدّدة جهاته، ويعني هذا، أن الكردي منزوع الجغرافيا، إنه مقيم في اللامكان، لاجىء ما، حيث تكون الريح موجودة، وفي الوقت ذاته، إلى حيث تكون المخاطر موجودة، كون الريح، في هبوبها، تنفي الاستقرار.
ولا أدري، في ما إذا كان درويش، يريد الإفصاح عن وضع مأسويّ للكرديّ، أو إبقاء الريح قدراً يتلبّس الكرديّ حيثما كان، وحيثما يبقى، كائناً كون كيان، أو كياناً لا يحمل دمغة اسمه!
أكثر من ذلك: من أين استقى درويش كائناته التي هي مفرداته اللغويّة، والتي تشكّل في مساراتها الكبرى حكاية الكرديّ، إذ يسردها درويش؟ ألم تكن كتابات بركات مرجعاً له في ذلك؟
أشدّد هنا، على أن قراءة القصيدة هذه، لا يمكن أن تكون مفهومة، ولا بأي شكل، دون قراءة قصيدة بركات عن درويش، وجملة الإحالات المرجعية التي تهمس بما هو مفضَّل بركاتيّاً.
في الحالة الأولى، بصدد مفهوم الريح! تزخر كتابات بركات بالريح في وضعيات مختلفة. في قصيدة "مهاباد"، يقول:
"سأقدم هباتي،
فالريح وحدها، تسرق التين من راكض لم يقتطف التين"(5).
لكن الأكثر دلالة، ما يقوله في ما بعد:
"والريح؟ ما لها؟ من "مهاباد" إلى "مهاباد" أيضاً.
كأنها من " مهاباد" إلى "مهاباد"..." (دا، ص 303).
وربما، كان في الإشارة إلى درويش، في القصيدة التي تحمل اسمه، ما يفصح عن ذلك أيضاً: "فَسَم الملهاة عليه أن يرث الريح التي تتقاذف الكمال الموحش قِِلعاً قلعاً، كأنما - في الحنين الذي يتجرأ على كل شيء - لنحيل واحد، بأرز من السنابل، أن يضلل الريح" (دا، ص 312). وربما - أيضاً - كان في وسع السابر لخاصّيّة الريح البركاتيّة، أن يتحرّى سيرته، وما يقوله سائلاً ذاته، من خلال الريح: "أنت طفل، وما الذي يأسر الرياح فيك غير مدى مترع بالرياح"، والأكثر من هذا: "ونعتقد، بعد ذلك، اننا ولدنا من القشّ، وإننا سنصير إلى قشّ، وأن حدود الأرض هي حدود الرياح التي ستحملنا معها"(6)... إلخ، وأظنّ أن درويش قارىء أعمال بركات كلّها هنا.
لكن الأهم، هو أن درويش، يردّ على بركات، أعني أنه يردّ إليه جميله، وأن الكثير من المفردات المحبوكة بلغة الشعر، تكون مستلّة من القصيدة نفسها التي كتبها بركات عن درويش، سنة 1989، وهي تقع في عشر صفحات، مأخوذة بحمّى الإيقاع الداخليّ، وكثافة الصور، وعنفها كذلك، خلاف القصيدة الدرويشيّة، ذات الإيقاع الداخليّ، من جهة المعنى، والخارجي، وزناً، وهي من البحر الكامل، ربما، ليكون في وسع مساحة المتحرّك فيها، الاستجابة لشاعرها أكثر.
درويش، في مجمل قصيدته، يسخو، وهو يتحدّث عن الكردي التاريخي، الرحّالة في الزمان، المكابد لذاته وللعالم من حوله، للغة الأخرى، لصاحب الشعر، ومن يكون، مسلكاً وتمايز كتابة، وكيف يتبدّى لشاعره الآخر، هذا الذي يتحدّث عنه، منصّراً إياه بلغته المكتسبة، متحاوراً معه، ملتقياً إيّاه، خارج حدود القبيلة، إنما دون تحديد مكانه الذي يميّزه، كما سمّى مكان سعيد.
في وسعي إيراد مجموعة من المقاطع التي يمكن التوقّف عندها، بعد إيراد مقاطع أو جمل تخصّ بركات، في قصيدته عن الآخر، وأي هجنة دلاليّة، أقواميّة، شعريّة، تبرز حصيلةً.
يبدأ من الذاكرة، وهل سوى الذاكرة للكرديّ، ليعلم ما سيكون عليه غده، من خلالها؟
"يتذكّر الكردي، حين أزوره، غده...
فيبعده بمكنسة الغبار: إليك عني.
فالجبال هي الجبال. ويشرب الفودكا..." (عمّا، ص 159).
حيث الإحالة على الجبل، الذي طالما استدعاه الكرديّ، أو احتمى به، تكون رمزاً أو دلالة، كما هو الحجل مناصفة في الرمز، مع فارق المكانة. ولاحقاً نقرأ: "أنا المسافر في مجازي، والكراكي الشقيّة/ أخوتي الحمقى..."، مشيراً هنا، إلى ديوان بركات "الكراكي"، الذي صدر سنة 1982، ويقول:
"على درّاجة
حمل الجهات، وقال: أسكن أينما
وقعت بي الجهة الأخيرة...".
فنتذكّر هنا:
"جهاته جهات الزيزفون" (دا، ص 309).
نتذكّر:
"ومن كمثله سيدلّل للفكاهة حتى لكأن الجهات، درهم يتقاذفه الشحّاذون؟" (دا، ص 312).
نتذكّر (الفاصل الثاني "في ارتطام الجهات")، في "الجندب الحديديّ".
نقرأ درويشيّاً:
"[كلماته عضلاته. عضلاته كلماته]
فالحالمون يقدّسون الأمس، أو يرشون الغد الذهبي...
لا غد لي ولا أمس. الهنيهة
ساحتي البيضاء" (عمّا، ص 160).
فنتذكر بركاتيّاً:
"يا لنا، كم سنناديه في الحكاية التي تناديه وقد أثقلها العابرون برمادهم العابر. كما سنقاسمه النهب الذي يمسنا بأقراطه حينة ننحني مقبّلين فم الحياة الأبعد..." (دا، ص 311).
نقرأ درويشيّاً:
"منزله نظيف مثل عين الديك...
منسي كخيمة سيد القوم الذين تبعثروا كالريش. سجاد من الصوف
المجعد. معجم متآكل. كتب مخلدة
على عجل. مخدات مطرّزة بإبرة
خادم المقهى..." (عمّا، ص 161).
لنتذكّر بركاتيّاً:
"أعقاب لفافات تبغ قديمة نجت من مكنسة الخادم".
ومن ثم:
"طليقة رسوم السجاد، والتصاوير على الجانبين" (ص 305).
وكذلك:
"كتاباً كتاباً يفتح الجدار ذو الرفوف عينيه..." (ص 307).
نقرأ درويش في:
"يغنّي حين يدخل ظلّه شجر الأكاسيا" (عمّا، ص 162).
ونتذكّر بركات في:
"غدٌ يمضع اللبان كصبي نزق، فاتحاً أزرار قميصه الكشمير تحت شجرة الأكاسيا" (دا، ص 204).
يمكن أن نقرأ لدرويش:
"يفضّ بكارة الكلمات ثم يعيدها
بكراً إلى قاموسه، ويشوّش خيل
الأبجديّة كالخراف إلى مكيدته، ويحلق
عانة اللغة: انتقمتُ من الغياب" (عمّا، ص 162).
مثلما يمكن قراءة الكثير بالمقابل لبركات، مثل:
"في وسعه أن يتقرَّى المفاتيح الكبيرة التي تذوب في الأيدي، وأن يجر الغبار المحتشم إلى لهو محتشم..." (دا، ص 312).
يمكن أن نقرأ لدرويش:
"أنت الآن
حرّ، يا ابن نفسك، أنت حرّ" (عمّا. ص 164).
كما يمكن أن نقرأ لبركات:
"يا لحساب الفاتن للوحدة،
كأنما استثنى نفسه حين عدَّته الأرض على أصابعها التي توقظ الفروق" (دا، ص 313).
وكما يمكن أن نقرأ أخيراً، وليس آخرأ، لدرويش:
"فقال: لن أمضي إلى الصحراء
قلت: ولا أنا..." (عمّا، ص 164).
لنقرأ بالمقابل لبركات عن صاحبه الشاعر، وفيه:
"والهبوب الذي أنت فيه هبوب السنونو" (دا، ص 313)... إلخ.
الوارد من المقبوسات، أو المتقابلات، ليس في وارد الإحصاء الدقيق أو الحصريّ، بقدر ما هو محاولة الكشف الحدوديّة عن نقاط التداخل، عن التناص، وما يتجاوز التناصّ، كون محمود درويش، لا يريد تناصاً، إنما استثمار القاعدة الدلاليّة، للنصّ البركاتيّ، وتحويل المأثور عنه، إلى المأثور بالمقابل، كما لو أن مقايضة تتمّ، دون عقد مبرَم، فالعقد هنا وجدانيّ، والتعبير اللسانيّ، هو الذي يتكفّل بمهمّة إظهار ما يمكن للقارىء المعني تحرّي التفاوت، أو حالات التماثل.
بركات وجه اغترابيّ، منفاويّ، مأسويّ، مقاوم، كما هو درويش الذي برز وجهاً نضاليّاً، اغترابيّاً، منفاويّاً، مأسويّاً، ومقاوماً داخل النصّ الشعريّ، والمكان الجلي القدرة في الربط بينهما (نيقوسيا)، كما سمّى درويش هذه، ليكون الحديث عن جهات الأرض، والمعابر المقلقة، والغبار، والحنين إلى الجهة الآمنة، وحركة الرياح، والمنفى بأشكاله المختلفة... إلخ، تداعيات الذاكرة المكانيّة، مثلما هي أصول التواصل بين إنسانين، أمضيا معاً، الكثير من السنين، في مكابدة مشتركة، رغم اختلافهما جهويّاً، والمأساة هي التي وحّدت بينهما.
بينما تأتي قصيدة بركات، في تنوّع عناوينها، وطريقة الكتابة، في سياق مكاشفة ذات الآخر، تعظيماً لها، وفي الآن عينه، تجلّي ذات الشاعر بالمقابل، حيث الأمكنة أكثر، مثلما الجهات والمواقع أكثر، استجابة لروح التحدّي، ومن ثم المكانة التي يجلو فيها درويش. درويش هذا يكون (الساهر على فتوحه الممكنة. دا، ص 306)، بينما بركات، فكائن مختلف، كما قيل فيه سابقاً، وعلى لسانه (الهنيهة ساحتي البيضاء. عمّا، ص 160)، وذلك بسبب المفاجآت. وأظن أن درويش حين يقول في الكرد من خلال بركات: "الكرد يقتربون من نار الحقيقة،/ ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء" (عمّا، ص 162) فإنه يستجيب لتلك الصورة الشعريّة التي أوردها بركات في "مهاباد": "كألم تتقدّم الأجنحة/ كألم يتقدّم الكرد إلى الحقيقة" (دا، ص 303).
المكاشفة القوليّة لمجمل المفردات التي تنبني بها القصيدة في الحالتين، تحيل الشاعرين على وضع وجديّ انهماميّ بالآخر، لكن المهم هنا، هو درويش، باعتباره محور الموضوع، وكيف أنه يوطّد جسر تواصله الوجدانيّ شعريّاً مع شاعر معروف، ما زال يحيا، له معه المديد من الذكريات، وحتّى صور التآخذ الشعريّة، كما تشهد الكتابة البركاتيّة، ليس بمعنى المحاكاة، إنما تفعيل الأثر الجماليّ للقصيدة، وبارقة الصورة المثيرة لمشاعر، لها تاريخها ووقائعها.
ب- درويش إزاء سعيد: التفكير بالشعر
آثرت وضع العنوان كهذا، لأن الذي كتبه درويش عن سعيد الحاضر الغائب منذ سنوات ثلاث، كان الفكر فيه حاضراً، كما لو أنه أراد الدفع بالشعر أماماً، داخلاً في بحر الفكر.
حيث سعيد ناقد أدبي، لكنه مفكّر، حتى وهو ينتقد النصوص الأدبية، ومن النوع الموسوعي الميتاحدودي، أو جمَّاع أمثلة، وهو يتحرّك في الاتجاهات كافّة، من ناحية النصوص المنقودة.
وفق تصوّر كهذا، تكون قراءة قصيدة "طباق"، داخل الديوان المذكور، مكاشفة عتبة سرَّانية، عتبة قدسيّة، كما هو زهر اللوز "عصا هارون أزهرت وأنتجت زهور اللوز، وبدون إخصاب، الثمار المناسبة. والشروط نفسها، كان للعذراء، ثمرة، هي للطفل يسوع"(7). يأتي الطباق وفاق تصورات اثنينيّة، لكنه اختراق للسائد، كسراً للقاعدة المعتمدة، من ناحية المفكَّر فيه، كما النموذج سعيد، في ما ميَّزه نقديّاً، وكمفكر عالي الطراز بمنظومته النقديّة المتعدّدة في أصولها الفلسفيّة والمذاهبيّة والثقافيّة، تأكيداً على فتنة الهجنة، ونكهة الطباق المثلى. درويش، ما كان يعنون قصيدته بـ"طباق"، إلا لأن ثمة ما كان يردّ إلى نفسه، ما قرأه في كتاب مرثيه المذكور: "إننا في حاجة إلى منظور مقارن، أو بالأحرى طباقيّ (في معنى الطباق الموسيقي) كي نبصر علاقة بين طقوس التتويج في انكلترا وحفلات البيعة الهنديّة في أواخر القرن التاسع عشر..."، وفي مكان آخر، وللمزيد من التوضيح: "وبمعنى هام، فنحن هنا، نتعامل مع تشكّل هويّات ثقافيّة تُقهَم لا بوصفها تجوهرات (تقليصيّة اختزاليّة)... بل بوصفها مجموعات طباقيّة"(8).
ما يمكن استقراؤه في القول السعيديّ، هو الآتي: استحالة النظر في الثقافات باعتبارها تناحريّة، تضادّيّة، إنما تتكامل في ما بينها. استحالة التفريق بين الشعوب، بمعايير عرقيّة، عنصريّة فصليّة مطلقة، إنما تاريخيّة نسبيّة. استحالة النظر إلى الكائن باعتباره مجرّداً من أصول بيئيّة وثقافيّة مؤثّرة فيه، وبإطلاق، إنما قابليته للأخذ من بيئات وثقافات مختلفة، كما هو وضعه، وداخل مفهوم التنوّع.
هنا لا يكون الآخر إلا صفة لذات ما، وليس الغريب الخارج عنها، مكمّلها، وليس المعادي لها، كما كان سعيد الفلسطينيّ في أميركا، في المجتمع الأميركيّ المتنوّع في أصوله.
أما درويش، فهو يقرأ سعيد، كما لو أنه قارئه، لكنه يمارس إنتاجاً شعرياً في الأرض السعيديّة، ومن داخل البؤرة الشعوريّة الخاصة به، كون إدوارد سعيد ذا الدلالة الرمزيّة، حقل تمرير مؤثّرات، كما هو حقل تجاذبات لرؤى عابرة للحدود، للثقافة الواحدة، وكأني به (درويش)، يمارس دحضاً لكلّ طهرانيّة أجناسيّة، أو من يريد التقدّم بمناقب حكراً عليه، مثلما هو صراعه مع أيّ نقيض له.
وفي حومة النزال المعتقديّة، وباسم الشعر، تكون المكابدة النفسيّة، وعنف المواجهة، في أرض فسيحة، غير مستقرّة، عبر سعيد الشخصيّة المفهوميّة، والرمز الحدوديّ، وما يعبره دلاليّاً.
المسافة الجغرافية واسعة، تمتدّ ما بين القدس الرمز الأكثر هيبة، ونيويورك؛ حيث كان الراحل يقيم ويدرّس، ليكون التاريخ مفتوحاً، بمشاهد، تتلاقى لأداء مهمّة شعريّة أساساً:
"نيويورك/ نوفمبر/ الشارع الخامس/
الشمس صحن من المعدن المتطاير/
قلت لنفسي الغريبة في الظلّ:
هل هذه بابل أم سدوم؟"(9).
لنتذكّر التوصيف المكاني هنا، العنوان المشار إليه، التاريخ بدقة، لكن الموقف من المدينة، عالياً ودانياً، كما هو المقروء لدى كثيرين (لوركا، غوركي، أدونيس، بودريار...).
وربما كانت (باب، سدوم)، تذكيراً بمن أباح نهب نيويورك، تجريدها من كلّ أهليّة بقاء توحيشها، أي نزع صفات الأنسنة كلّها عنها، رغم أن سعيد أبدع كتابةً فكرية، وهو فيها.
أتذكّر هنا بودريار العدو اللدود لحداثة تكون نيويورك رمزاً جليّاً لها (فنيويورك هي كينغ كونغ، أو البلاك - آوت)، وكذلك: "إننا في كون شطّور، أطواف جليد رضراضة، انسياقات أفقية..."(10).
بودريار الذي أسمّيه هنا، يكون داخلاً في الإنتاج الشعريّ لدرويش، هو صوت من أصواته، إذ يرفد المعنى الميتاحدودي، مستنفِراً ذاته، والآخر الذي لا يني يتجدّد في كلّ علاقة له مع اللغة، طالما هو منذ احترافه كتابة الشعر، أو شعوره أن لديه هذا الشعور بكينونة لغة، تعنيه في ما هو فيه، في عالم يتداعى في صميم مبادئه الكبرى، الآخر هذا مستدعى باستمرار، لأنه حليفه في بعض منه، حتى وهو المرفوض من قبله، لأنه يشكّل عنصراً دامغاً في كتابته، ويبقى مختلفاً، حتى إن بدا ملحوظاً برغبة توددِ كذلك، لأنه مترجَم في وضع ما.
بودريار مقروء درويشيّ، حتى إن لم يبدُ عليه أنه قرأه، كونه يستحضر إلى الذاكرة القريبة، صداه المجلجل نيويوركيّاً، وهو التنويريّ ضدّ التنوير المعتمد، والراحل قبل فترة قريبة. أعني بذلك، أنه مكمّل طباقيّ، مثلما هي حالة شعريّة تخفّف وطأة اللغة الأكاديميّة، وحدة التنظير الفكريّة عند سعيد، حيث درويش يعود إلى ما كان، وهو مواطن الآن الذي كتب فيه نصّه.
بابل أو سدوم، تجريد للمدينة الموسومة، من كامل قيافتها المعلنة، وحتّى ممارسة لعنة لها، كون السؤال هو تعبير نافذ بمتضمَّنه الدلاليّ، أكثر من التعبير المباشر ذي الاتجاه الجلي:
"هناك على باب هاوية كهربائيّة
بعلوّ السماء التقيت بإدوارد
قبل ثلاثين عاماً،
وكان الزمان أقلّ جموحاً من الآن
قال كلانا:
إذا كان ماضيك تجربةً
فاجعل الغد معنى ورؤيا!" (ص 179).
المنجَز الحضاري التقنيّ، ينقلب إلى مشهد شؤمي، مثلما رحابة السماء، وهي داخلة في الصورة الشعريّة، أشبه بنعي لكلّ المكوّن الجمالي للمعنى الأولي، والذي يقارب المفهوم، لأن المكان شرط إقامة المفهوم المستخدَم، في التلوّن باللون نفسه الذي يحصر الحواس داخله. ويتقدّم الاسم ذاته، صاحب "تأمّلات في المنفى"، هذا الطباقيّ، بشرط قيميّ، شخصيّ، يضفي على العلاقات النصّيّة طابعاً حِداديّاً، استمراراً للصفة البابليّة أو السدوميّة وشيكة التبدّد، خلاف شاعره الذي لم يسمَّ أبداً، إنما ذُكِر في ما يسمّيه، من خلال استعارات أدبيّة وجمل تستظهره. وهذا الشعور بالآخر، بإدوارد، يجلو خاصّيّته بوضوح مباشر، كما لو أن الشعر يتودّد إلى الفكر، إلى مفكّر الشاعر، ويتغزّل به بلغته، إذ يبسّط عالمه، رغبة في حوار يمتدّ أماماً، يكون الشعر مستسلِماً لرغبة الآخر، من خلال الكلمة المقروءة (إذا كان ماضيك تجربة)، وما يليها، حيث الشعري مأخوذ بحضور الآخر، في التعبير، تأكيد مقام له.
لنلاحظ ما أبدعه درويش قبل ثلاثين عاماً، ما قاله في راشد حسين الشاعر الفلسطينيّ، ومن المكان نفسه، وكيف برز الشعر مأخوذاً بشعر الآخر، ترجمة مختلفة، لأن الاسم مختلف:
"في الشارع الخامس حيّاني. بكى. مال على السور
الزجاجي، ولا صفصاف في نيويورك.
أبكاني. أعاد الماء للنهر. شربنا قهوة. ثم افترقنا في
الثواني.
منذ عشرين سنهْ
وأنا أعرفه في الأربعين
وطويلاً كنشيد ساحليّ، وحزين
كان يأتينا كسيف من نبيذ. كان يمضي كنهايات صلاهْ
كان يرمي شِعره في مطعم "خريستو"
وعكا كلّها تصحو من النوم
وتمشي في المياه
كان أسبوعاً من الأرض، ويوماً للغزاهْ
ولأمي أن تقول الآن آه!"(11).
إن كلّ المفردات التي قد تشي ببساطة اللغة اليوميّة، أعني العاديّة، محدودة ("منذ عشرين سنة/ وأنا أعرفه في الأربعين" مثلاً)، ليس لأن الإيقاع مجنّبها وجه العادي فيها، إنما مجمل المتشكّل ببهاء الشعري، حيث الحواريّة الظاهرة تبقي النصّ في حالة حركة؛ حركة تلاقي الجهات، الأمكنة، توارد الخواطر، في التقابلات، في التغيير لما هو مكانيّ. "ولا صفصاف في نيويورك"، عبارة توصيفيّة، لكنها قيمة اعتباريّة، لا تحيل على ما هو جنائزيّ مهدّد للمكان، كما في المتحدَّد بصدد سعيد، أو إدوارد، كما يسمّيه الشاعر، لاختلاف الزمان، لكنه لاختلاف الكائن، رغم مرور ثلاثين عاماً، حيث الشعر طليق بأفقه المفتوح والشفيف.
درويش، يسرد لقارئه ما يعنيه في سعيد، في المكان، وكيف يخرج المكان هذا من مكانه، تابعاً لما هو شعريّ، إنه بعد سِيَريّ، مثلما حديث عن سعيد في بعض من أحواله وصفاته، أعني، أن محمود درويش يترجم الآخر المتداخل معه، بالطريقة التي تجعل منه كائناً شعريّاً وهو مفكّر هنا:
"نيويورك. إدوارد يصحو على كسل
الفجر. يعزف لحناً لموتسارت. يركض
في ملعب التنس الجامعي. يفكر في
هجرة الطير عبر الحدود وفوق الحواجز.
يقرأ "نيويورك تايمز". يكتب تعليقه
المتوتّر. يلعن مستشرقاً يرشد الجنرال
إلى نقطة الضعف في قلب شرقيّة.
يستحمّ. ويختار بدلته بأناقة ديك.
ويشرب قهوته بالحليب. ويصرخ
بالفجر: هيا، ولا تتلكأ"(ص 182).
هذا المقطع في كامله، يتبدّى متابعةً بصريّة وصفيّة لنشاط مفكره، كما لو أنه تقرير عادي ليس إلا، ولا يرفع من شأن العادي فيه سوى جملتين فقط، بداية ونهاية علاقة (كسل الفجر، ويصرخ بالفجر)، وما تبقّى، يظل في حدود اللغة العادية، لكن المبتدأ والمختتم، يرفعان من سويّة القيمة العادية للغة هنا.
يقرأ "الاستشراق"، و"الثقافة والإمبرياليّة"، و"تأمّلات في المنفى"... إلخ، كما تقول الصياغة الأدبيّة: الشعرية له، لمجمل عوالم سعيد، يقرأ مفكره، في ما يميزه: ألماً وأملاً، وهو يفيض كثيراً بالكلمات التي لا تخلو من تكرارات ملحوظة، ربما لأنه مأخوذ بمفكره، بحالة تجاذب وجدانيّة، وهو يعيش مكابدة الآخر: آخره الوطنيّ، المنفيّ، آخره الاعتباريّ، فلسطينيه المعتبَر. يبعث الأمل لاحقاً:
"لا غد
في الأمس، فلنتقدّم إذاً/
ولكن ثمة مخاطرة وتحذيراً:
قد يكون التقدّم جسر الرجوع
إلى البربريه..."(ص 180).
أستعيد هنا، ما قيل في الكرديّ، عنه، وهو يربط بين كلمات بركات وعضلاته، وبالعكس، بنوع من المشهديّة الاستعراضيّة أحياناً، كما هو معروف به بركات خارجيّاً، إذ يقول بعد ذلك شرحاً:
"فالحالمون يقدّسون الأمس، أو
يَرشون بوّاب الغد الذهبي...
لا غد لي ولا أمس. الهنيهة
ساحتي البيضاء..." (عمّا، ص 160).
ثمة تداخل في الحالتين، سوى الاختلاف في الاسم، من جهة التذكير به، والشاعر يقول ذاته، في موقف منها، أو لها، إذ يعاين الآخر في ذاته هذه، أو يعاين ذاته في الآخر.
وربما هي محاولة منه في الربط بين العوالم، دخول في الذات، ومضيٌّ مع اللغة وهي تنساب به، وليس معه، إذ يستسلم لذاته، كما هو المقروء هنا أو هناك، أو في أمكنة أخرى، حيث الصورة الشعرية تكون واجهاتيّة، كما لو أن درويش، لا يريدها إلا هكذا.
قصيدة "طباق" شرحيّة، تستعيد مفارقاتها، في التكرار كثيراً، وأرى أن محمود درويش، كان أقلّ شعراً في ما يخصّ مفكره، كانت مساحة الشعر، رغم وساعة المكان (أكثر من ثماني عشرة صفحة، كما ذكرت)، أقلّ اعتناء بمفردته الشعريّة، إلى درجة أن النثريّ عنده، وهو مألوف، خالف شرطاً آخر في انسيابيّة اللغة، لأن ثمة معاودة ذات الشيء، رجوعاً إلى المعنَّى، ليس لتأكيد عنف، يؤكّده التكرار، إنما هو عنف الذات في ما تتجاهله. عنف الآخر في الذات، وهي تكرّر المعنى بتغيير المفردة، فيضحل أثر الشعر، مثلما يتعثّر النثر الموزون هنا، ووساعة المساحة تضيق بكائنها:
"على الريح يمشي. وفي الريح
يعرف من هو. لا سقف للريح.
لا بيت للريح. والريح بوصلة
لشمال الغريب"(ص 182).
حسنٌ، إذاً، "ليس للفلسطيني إلا الريح" أيضاً، طالما الريح تتقدّم الفلسطينيّ، تعرّف به، وهو المنهمُّ بها، طالما الريح لها مكانتها هنا، كما الحال مع بركات، أو الكرديّ في عمومه.
درويش يسكن الريح، لكنه إذ يبدّل في المفردة، يشرح، أكثر مما يجب، إذ "لا بيت للريح"، تفي المرغوب، تستغني عن "لا سقف للريح"، لكأن تكرار مفردة "الريح" دخول أقصى في الحالة الشعريّة، وتعميق لها، لكنها نسيان للحالة الذاتية، في تداعياتها، في تكرار غير مريح هنا.
لنلاحظ:
"يقول: أنا من هناك. أنا من هنا
ولست هناك، ولست هنا
ليَ اسمان يلتقيان ويفترقان
ولي لغتان، نسيت بأيهما
كنت أحلم،..."(ص 182).
طبعاً، وبداية، يكون القائل درويش، وليس إدوارده، أو سعيد، إنه مقوّله ليس إلا. ومن ثم، ماذا يعني حضور القوائم الاسميّة والجهويّة، سوى الشرح ذاته؟ اللاجهاتيّة المحدّدة، وجود الاسمين، هما وجود اللغتين، هو الطباق، هو التعدّد:
"أنا المتعدّد. في
داخلي خارجي المتجدّد"(ص 183).
وهو شرح وتكرار، ومن ثم:
"ومنفى هو العالم الخارجي
ومنفى هو العالم الداخلي"(ص 184).
استعادة ما لما سبق، وشرح آخر له، وأيضاً:
"أنا اثنان في واحد
كجناحي سنونوة" (ص 184).
وربما يتصدّى لهذا الإجراء من يقوعده، ويبرّره، بدعوى أنه انتقال من وضع إلى آخر، وترتيب لخاصّيّات المكان والحالة، إبراز للتواصل بين الأنا والآخر، لكنني أتلمّس في المقروء خلافاً، وأنا أشهد على أن هذا اللون - الضرب من التكرار والشرح، لا يقيم للشعر قائمة جاذبة. وأن الانجذاب لـ"المتقارب": البحر المعتمد في كتابة النصّ، إذا كان يحافظ على سويّة المسافات القائمة بين الصور وهي تتتالى، فهي في الجلي فيها، مسافات ضيّقة، من جهة الرؤيا الشعريّة، لأن الذاكرة مأخوذة بلغة الآخر مأسوياً، كما لو أن فعل الشرح والتكرار، إخلاص لجرح الذات:
"هنا هامش يتقدّم. أو مركز يتراجع
لا الشرق شرق تماماً
ولا الغرب غرب تماماً
لأن الهوية مفتوحة للتعدّد
لا قلعة أو خنادق" (ص 185).
هنا نجد الآتي:
طالما أن الهامش يتقدّم هنا، فإن هذا يعني أن ثمة حركة في المركز لمصلحته، إن أحدهما شرح للآخر، في الوضع الطباقيّ.
الحديث عن لاتماميّة الشرق، كصورة شعريّة حديث عادي، وتكون العبارة الآتية استكمالاً من ناحية، لكنها لا تكون في مستوى جدّة الأولى، من ناحية أخرى. لتكون عبارة "إن الهوية مفتوحة للتعدّد"، خلاصة ما تقدّم، لكن التالي يكون تكراراً مألوفاً سابقاً، وهذا شرح من جهة أخرى أيضاً، ويعني هذا بالمقابل، أن "لا قلعة أو خنادق"، شرح إضافيّ، توضيحيّ آخر، لا لزوم له إطلاقاً، إلا لأن ذات الشاعر تعيش هاجس الآخر كثيراً. ويقيني هنا، أن الشاعر كلما لجأ إلى الماضي، إلى الطفولة، برز الشعر أكثر يفاعة ووساعة أفق، ولعلّي أستطيع القول إن حديث الشاعر عن مفكره، وهو يسائله عن بيته، عن أمسه، ربما يشكّل بؤرة التوتّر الشعريّة القصوى في التذكير بالآخر، في ترجمته شعراً استقطابيّاً، وبعد سطور أربعة:
"وحاولت أن أستعيد ولادة
نفسي، وأن أتتبّع درب الحليب
على سطح بيتي القديم، وحاولت أن
أتحسّس جلد الغياب ورائحة الصيف
من ياسمين الحديقة. لكن وحش الحقيقة
أبعدني عن حنين تلفَّت كاللص خلفي..." (ص 190).
وتأتي الخاتمة في القصيدة انفتاحاً على معهود درويشيّ في صناعة الألم الشعريّ:
"نسرٌ يودّع قمّته عالياً
عالياً،
فالإقامة فوق الأولمب
وفوق القمم
قد تثير السأم
وداعاً،
وداعاً لشعر الألم!" (ص 197).
لكنه استقبال لشعر الألم، من خلال استشراف أفق الآخر هذا. ويبقى الشعر وليد المأساة، أكثر ما هو عرّاب الملهاة، أو الناطق بلسانها، لأنه في حقيقة أمره دخول في المأسويّ بالمعنى العام. درويش يتحرّك بالألم، وإن كان يحاول في كلّ مرّة، التحرّر منه، ببذل جهد مضاعف، هو ذاته تألّم في الذات، تأكيد واقع حال الشعر، وقول الشعر، والمضي في الشعر وبه.
وفي الحالات كافّة، يبدو الشعر في أساسه نزعاً للذات، عمّا هي فيه من حضور مخادع، إذ تتوهّم رؤية الأشياء في العالم باعتبارها حقائق، تتوهّم ذاتها وقد تكاملت، تبصر حدوداً معلومة، وذلك كلّه لا يعدو أن يكون ابتعاداً عن الذات، حيث لا تكون هذه، إلا بتبصرة المزيد مما يقيم فيها، في ما لم تتبصّره داخلها، في ما يمتدّ، وعلى مستويات عدّة، خارجها، عبر مفهوم الآخر، هذا الذي يظلّ سرمديّاً في أطروحة النشأة والتكوّن وإعادة التشكّل، وفق صياغات وأسماء مختلفة، كما هو التاريخ الكونيّ الذي يظلّ عصيّاً على المكاشفة بالطريقة التي تنشدها رغباتنا من الداخل. وما حاولنا القيام به، هو وجه من وجوه الرغبة، في كيفيّة ترجمة الآخر، ومن خلال الشعر، وما تتميّز به أدوار الشعر، وعافية القول فيه، ولقيا المستلهَم من الداخل، ودور المعتقد في الرؤية.
وأحسب أن مقاربة العلاقة بالآخر، من خلال شاعر، كثيرة هي علاقاته، كما تقول نصوصه الشعريّة خصوصاً، هو محمود درويش، ومع رمزين مختلفين انتماء وطبيعة كتابة، هما من جهة الترتيب الزمني: سليم بركات وإدوارد سعيد، هي مقاربة للذات في عالمها الذي تعيشه. مثلما أحسب، أخيراً، وليس آخراً، أن ما قمتُ به، هو مكاشفة علاقة ما، تخصّني، ووفق معتقد فكريّ معين هنا، لكلّ من الشاعر والمفكّر، وأن كلّ قراءة فعليّة، هي إثراء للمتعدّد في تكويننا أساساً.
الهوامش:
1- انظر كتاب عبده وازن: محمود درويش "الغريب يقع على نفسه"، منشورات رياض الريّس، بيروت، ط1، 2006، ص 74.
2- انظر في المصدر، ص 76.
3- درويش، محمود: لا تعتذر عما فعلت، منشورات رياض الريس، بيروت، ط1، 2004، ص 15، ولاحقاً، تكون إشارة "عمّا"، محيلة على هذا الديوان، والطبعة المذكورة نفسها.
4- للمزيد من المعلومات، انظر ما أورده فيليب سيرنج، في كتابه: الرموز في الفن - الأديان - الحياة، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار الحصاد، دمشق، ط1، 1992، ص 372 - 374.
5- انظر سليم بركات: الديوان، دار التنوير، ط1، 1992، ص 298، ولاحقاً، تكون إشارة (دا) محيلة على هذا العمل، في طبعته المذكورة.
6- بركات، سليم: الجندب الحديدي، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1980، ص 8 - 35.
7- سيرنج، قيليب: في المصدر المذكور، ص 322.
8- انظر ادوارد سعيد: الثقافة والإمبريالية، نقله إلى العربية وقدّم لـه: كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1997، ص 101 - 119.
9- درويش، سعيد: كزهر اللوز أو أبعد، منشورات رياض الريس، بيروت، ط2، 2005، ص 179، لاحقاً، تكون إشارة (ك) محيلة على هذا الديوان، في طبعته المذكورة.
10- انظر ما كتبه في (الانذهال والعطالة)، في مجلة "العرب والفكر العالمي"، العدد العاشر، 1990، ص 126 - 127.
11- المقطع مأخوذ من ديوانه "أعراس"، في قصيدة "كان ما سوف يكون"، في الأعمال الأولى، المجلد الثاني، منشورات رياض الريّس، ط1، 2005، ص 245.
****
"فما أعجب هذا البلبل الذي يفتح فمه
ليأكل الشوك مع الورد، لكن أي بلبل هذا!
إنه عملاق ناري،
ومن العشق أصبح كل شيء في فمه حلو المذاق".
مولانا جلال الدين الرومي
كنت في السنة الأخيرة، قسم اللغة العربية وآدابها، في دمشق، وكنا قد انتهينا من الامتحان، أنا وصديقي الفلسطيني عبد الكريم عبد الرحيم، وكان يومذاك، وقبلها أيام الانفصال، خطيبنا هو والصديق طالب أبو عابد في المظاهرات التي تطالب بإعادة الوحدة بين سوريا ومصر. وكانت جلستنا تلك في كافتيريا الجامعة سنة 1966. بدأ عبد الكريم يقرأ لي من شعر محمود درويش، وكان يصرّ على أنه سيذهب إلى فلسطين ليرى محمود درويش، وكان يبدو وهو مأخوذ بدرويش وشعره وكأنه يقرأ أوراداً صوفيّة، وكان في حالة جذب تام.كان عاشقاً حقيقيّاً لمحمود درويش، ورحت أتساءل: هل هذا عشق المكان الذي ينتمي إليه صديقي، أم هو عشق الشعر؟ فإن كان المكان المستلَب هو الذي جذبه، فما الذي جذبني أنا؟
ونتيجة لانفعال الشباب وقتئذ، جذبتني حالة شعوريّة حادّة، متمنّياً لو كنت فلسطينياً لأنتمي أكثر إلى محمود درويش. هكذا أحسست يومها، وهكذا اشتعلت في أعماقي نار يبدو أنها كانت مغطّاة برماد كثيف. وجميع الناس الذين يعرفونني أدركوا في ما بعد إلى أين أوصلتني هذه النار التي أكلت عمري وأعمار أسرتي كلّها. ولا أزال إلى الآن مصرّاً على تلك النار المتأججة التي أطفأتها الهزائم العربية: كانت ناراً خضراء، تغري مصطليها بالموت على لهيبها.
التقيت محمود درويش لأول مرّة في بيروت، سنة 1973 في "دار العودة"، وكانت مجلة "الآداب" اللبنانية قد نشرت له مقالاً بعنوان "أنقذونا من هذا الحبّ القاسي". يومها كانت بيروت داراً لنشر الثقافة العربيّة والإنسانيّة. فجأة تذكّرت عبد الكريم عبد الرحيم، وقلت في خلَدي: ها هو محمود درويش فلأقتحمْه. كان محمود قلقاً وقتها، ورحت أسأله استجابة لتلك النار الملعونة التي لم تبرحني أبداً: أخ محمود، هل كل ما يُنشر على لسانك هو لك؟ قال لي: أعطني شيئاً ملموساً، فقلت: مقالك في مجلة "الآداب" اللبنانية "أنقذونا من هذا الحب القاسي". وكان كثيرون قد شككوا بنسبة هذا المقال إلى درويش الذي كان قد طلب فيه من النقّاد والقرّاء العرب ألا يخلطوا بين ولائهم المطلق للقضيّة الفلسطينيّة وحبّ الشعر الفلسطينيّ، وقال إن بصمات الشعراء العرب الكبار لا تزال واضحة في شعرنا، ولا يزال ينقصنا الكثير، وأذكر أنه ذكر في هذا المقال اسم أبي فراس الحمداني، كأحد الشعراء الذين تأثّر بشعرهم.
أما أنا في تلك المرحلة المتوقّدة من الشباب، فقد كنت مُصرّاً في ذاتي على أن فلسطين هي هؤلاء الشعراء، أوليست فلسطين هي الحبيبة التي تنهض من نومها؟ أوليست العصافير التي تموت في الجليل بزقزقاتها المذبوحة هي امتداد للهمّ الفلسطيني، وحبّه الكائن على حدّ السكين باستمرار؟
1
فلسطين - المكان هي محمود درويش بتجلّياته الإبداعيّة كلّها: هي الوطن والغربة، هي الحبيبة والقاتلة، هي السجن والحرية، هي الوطن والمنفى. لا بدّ من التأكيد أولاً على حضور المكان في سَفَر درويش الطويل، وكأنه الجاهليّ وهو يقف على أطلال حبيبته، تلك الأطلال التي عفَّتها الرياح وتعاقب الزمن، وما لا شكّ فيه أن العدميّة التي تهيمن على الشعر الطلليّ في أدبنا العربيّ لم تستطع أن تجعل من شعر درويش شعراً طلليّاً: ظلّ الوطن احتمالاً قائماً في وجدان الشاعر وإنتاجه، وحين يكون الوطن احتمالاً وارتحالاً يكون حضوره أكثر حدّة، ويكون نزفاً مستمرّاً. ولعلّ هذا النزف اللذيذ من وجدان درويش يجعل القضيّة الفلسطينيّة لا قضيّة سياسيّة، إنما قضيّة إنسانيّة تهزم الظلم، وتجعل الظالم أكثر ألماً من المظلوم نفسه. نفي العدمية في شعر درويش مرتبط بشكل كيانيّ بالفعل الفلسطينيّ المقاوم. ومعنى هذا أن الكلمة تسبق البندقيّة باستمرار، كي لا تكون البندقية جاهلةً الهدف الذي يجب أن تصوّب إليه. حضور اللهيب الفلسطينيّ في ضمائر أحرار العالم مرتبط بالإضاءة التي تشعّ من الكلمة الملتزمة التي تأبى الانطفاء بسبب انحيازها المطلق إلى قضية الإنسان الأولى (الحرية وحقّ الحلم وحقّ الموت على صدر الحبيبة)، لأننا أمّة تؤمن بالقيامة، وكلّنا يتمنّى أن يرى قيامته على صدر حبيبته، ولو مصلوباً لحبّ آخر، وقيامة أخرى.
2
إذا لم تكن فلسطين مكاناً عدميّاً في شعر محمود درويش، فهي رؤيا حين تنعدم الرؤية، أي أن المنفى لا يقوى على اقتلاعها، ويظلّ حضورها هو الفعل المتغذي من وعي الشاعر ووجدانه، والمغذّي لديمومته في المكان - المنفى، حيث لا يستطيع خلعها إلاّ بخلع الكينونة نفسها: "أيتها النوافذ البعيدة كالحبّ الأول/ أنا لا أقيم في بابل/ بابل هي التي تسكن تقاطيع وجهي/ أينما ذهبت.../ في قلبي نفيتُ المنفى، وذهبت".
التماهي هنا ليس انفعاليّاً لأن الشاعر ممتلئ بتفاصيل الجسد الفلسطينيّ المتحدّر من الجليل حتى آخر ذرّة رمل يهينها الاحتلال ويحاول نسخ كبريائها، وممتلئ بما نبت على ثرى فلسطين من أعشاب تجمعها أمّه لتقيته بها في النشأة الأولى، وليكتمل فتى فلسطينيّاً سحنةً، وحدةَ زعترٍ بريٍّ يحمل خصائص الإنسان والمكان، ولهذا يكون الانفصال ملغى تكوينيّاً قبل كلّ شيء، والغياب لو حصل يحذف كينونة الشاعر، إن فلسطين كبرياؤه: "يهرب منّي جبيني/ أريدك حين أقول أنا لا أريدك/ أريدك حين أقول أريدك/ يا امرأةً وضعتْ ساحل البحر الأبيض المتوسط في حضنها... وبساتين آسيا على كتفيْها... وكلّ السلاسل في قلبها... أراكِ أرى قامتي من جديد". فلسطين ليست أرضاً مواتاً في شعر درويش، بل هي تستقبل المطر، ولو كان ممزوجاً بدم أبنائها المتزاحمين على الشهادة كتزاحمهم على الحبّ.
الاستلاب لم يقدر أن ينسخ الهويّة والهوى عن سِحَن أولئك الذين حملوا فلسطين في حقائبهم وروائح ثيابهم. هذه الأرض التي ذُبحت أكثر من مرة عبر التاريخ كانت لها قدرة القيامة التي كانت تعيدها إلى خصوصيّتها باستمرار، ثم أوليست قيامة المسيح فعلاً فلسطينيّاً! وهذه القيامة صارت جزءاً من الفلسطينيّ الذي يتقن القيامة كما يتقن الشهادة، لأنه واثق من علاقته بتاريخ هذه الأرض وتجربتها الجانحة باستمرار إلى القيامة بعد كلّ موت: "هو الآن يُعدَمُ/ والآن يسكن يافا". وهذا ينفي مفهوم العدميّة عن الوجدان الفلسطينيّ، والإيمان بالقيامة هو الذي يفسّر ذلك العناد المتحفّز باستمرار في الجسد الفلسطينيّ من أجل صون هذه الكبرياء: "آه يا جرحي المكابرْ/ وطني ليس حقيبهْ/ وأنا لست مسافرْ/ إنني العاشق والأرض حبيبهْ". هذا العناد الفلسطينيّ هو الذي أعطى الديمومة للقضيّة الفلسطينيّة، وللفعل الفلسطينيّ المقاوم، ولذا "لم يتفتتْ حبنا بين السلاسلْ". يحاول محمود درويش أن يفسّر لنا سبب هذا العناد في الجسد الفلسطينيّ، وفي الفعل الفلسطينيّ. إن مجانبة الحالة تعني الضياع والاستلاب الكامل: "لكي أنسى أن لي سقفاً مفقوداً/ ينبغي أن أجلس في العراء/ ولكي أنسى نسيم بلادي النقي/ ينبغي أن أتنفّس السل/ ولكي أذكر الغزال السابح في البياض/ ينبغي أن أكون معتقلاً بالذكريات/ ولكي أنسى أن جبالي عالية/ ينبغي أن أسرِّح العاصفة من جبيني/ ولكي أحافظ على ملكية سمائي البعيدة/ يجب ألاّ أملك حتى جلدي". المسألة إذاً؛ نكون أو لا نكون. العناد هنا هويّة وانتماء، وإنجاز إنسانيّة الإنسان، لأن الإنسان حين يكون خارج وطنه عليه ألاّ ينسى نصيبه من الذلّ. المكان هنا ليس جغرافيّة الحدود والخرائط بمقدار ما هو جغرافيّة يحدّد الداخل حدودها ومفاهيمها المتجذّرة عمقاً في الذات البشريّة. الجغرافيّة هنا تراث وروح وتراب لنا فيه موتى، والمكان الذي لك فيه موتى لا يستطيع أحد أن يسلبه منك، إنه فيك حتّى ولو لم تكن فيه. إذاً، "فليكن العناد فضيلة" كما يرى شكسبير.
هذا الإيمان بحتمية مجيء طائر الرعد والبرق، وبعودة الأطفال إلى القدس، يعطي الشعر مدى ونفوذاً عاليَيْن على الشعور الجمعيّ للأمّة، وبذا يقترب معنى الشاعر من معنى النبيّ في سقاية كؤوس الأمل والبشارة للرازحين تحت الخيام الممزّقة والأكواخ المتشقّقة في كلّ صقع، لأن الشعر والدين يهدفان إلى تغيير العالم وتحويل الذات، تماماً كما يقوم القربان المقدّس بإجراء تغيير في طبيعة المؤمن: "ونغنّي القدسَ يا أطفالَ بابلْ/ يا مواليد السلاسلْ/ ستعودون إلى القدس قريباً.../ وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي/ قريباً يصبح الدمع سنابل".
في هذا المعنى تصبح القصيدة رصاصة، ولا تختلف عنها إلاّ بمقدار قتلاها. فالرصاصة قد تقتل جسداً أو جسدين، أما القصيدة فمساحتها أوسع في القتل، بل وفي الحبّ أيضاً، ولذا تحمل القصيدة، تحديداً القصيدة الفلسطينيّة، وجع الجرح ولذّة الوصال. ولعلّ درويش بتمزّقه الدائم وتجمّعه في القصيدة، استطاع أن يخدم قضيّة وطنه خدمة جعلت فلسطين حاضرةً في الوجدان الإنساني، وفي مراييل الأطفال، وعلى مقاعد الدراسة محفورةً على شكل قلب يخترقه دائماً سهمٌ، ومكتوب تحته: "ما عرفتُ الضياع/ في صرير السلاسلْ/ كان لحمي مشاعْ/ كسطوح المنازلْ/ لعدوي، ولكنْ/ ما عرفت الضياع/ في صرير السلاسلْ".
في غنائيّة عالية استطاع محمود درويش أن يجعل من فلسطين أيقونة يعلّقها الأحرار في نياط قلوبهم، وأنا أعتقد جازماً لو أن شاعراً إسرائيليّاً يملك حسّاً إنسانيّاً قرأ غنائيّات درويش لحسده على فلسطينيّته. غنائيّات درويش هي مراثٍ بمقدار ما هي أعراس فلسطينيّة تُقام على مقربة من قبور الشهداء. هي ترى النصر قاب جرح أو أدنى، حيث الغزاة رماد وأهل الأرض باقون فيها وعليها. في شعر درويش دائماً ثمة بشارة تنزف، ومستمرّة في الغناء: "يا داميَ العينين والكفّين إن الليل زائلْ/ لا غرفة التوقيف باقية، ولا زرد السلاسلْ/ نيرونُ مات ولم تمت روما بعينيها تقاتلْ/ وحبوب سنبلةٍ تجفّ ستملأ الوادي سنابلْ".
أحياناً ترقّ الأغنية حتّى تصبح واخزة كالجرح، ولعلّ شيوع شعر درويش بين الناس كافّة مرتبط بهذه الغنائيّة المذهلة المنسربة من لغته التي تحمل وجع الموّال الفلسطينيّ، وكثيراً من دموع العشق الذي هو التنّور الأول لخبز الروح التي تأبى هجرة أحزانها إلى شجر الآخرين: "في البال أغنية يا أختُ عن بلدي/ نامي سأحفرها وشماً على كبدي". العاشق يحقّ له باستمرار أن ينتظر قيامة حبيبته من نومها، ويحقّ له أن يكتب "أغنية الظلام الراحلِ".
3
مخطئ من يظنّ أن عناد القصيدة لدى محمود درويش يكون بلا وجع ونزيف، ولعلّ هذا هو سرّ روعة عناد هذا الشاعر الممزّق - المتجمّع في قصيدة. لعلّ الألم الذي يسكنه يجعل العذاب أكبر، والمكان الساكن والمقيم في وجدان درويش يحمّله همّاً جمعيّاً، فحين تكون العصافير تنقضّ على اللهيب وتموت، يصبح المرور أصعب وأشدّ إيلاماً، ولعلّ مراقبة الموت أشدّ حضوراً في النفس من الموت نفسه. الشهادة والحبّ متداخلان في شعر درويش، وهذا يلغي مفهوم العنف عن فعل الشهادة المرتكب فلسطينيّاً عشقاً للمكان - فلسطين، وفي لحظة قتال داخليّ يصرخ درويش بحبيبته القاتلة: "لماذا لا تعلنين براءتك مني/ لأكفّ عن الموت؟".
هو لا يستطيع إلاّ أن يمارس فعل الموت لأنه عاشق، وهذا ينقذ الموت من أن يكون عوماً في العدم، فما هي أسرار تلك العلاقة بين الموت والمكان؟ الواضح عند درويش أنه مفرط في حبّه للحياة، أوَلم يقل المتنبّي قبل أكثر من ألف عام: "أرى كلّنا يبغي الحياةَ لنفسهِ/ حريصاً عليها مستهاماً بها صبّا/ فحبّ الجبان النفسَ أورثه التقى/ وحبّ الشجاعِ النفسَ أورثه الحربا"؟
هذا الإفراط في حبّ الوطن هو الذي يقدّم العنق للسكّين طواعية في نسُكٍ كهنوتي يذكّرنا بالكهنوتيّ الفدائي الأوّل، وهو يخاطب أباه إبراهيم: "فلما بلغ معه السعيَ قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبتِ افعل ما تؤمَر ستجدني إن شاء الله من الصابرين".
الحبّ الرائع هو طاعة المحبّ ليظل حالة في وجدان من يحبّ، وليخفّف إسماعيل من وجع أبيه - قاتله تستمرّ لهجته محتلّةً وجدانَ أبيه، حين يقول له: "أحسِنْ مرَّ السكين على عنقي كي لا أتألم يا أبتي، واحذر أن تنظر في وجهي حتى لا تأخذك الرأفة، وإذا ما جئت أمي فاقرئها مني السلام".
الألم والعشق ينزفان من شريان واحد، وقد يتماهى الحبّ والألم إلى درجة التكامل. بودلير يقول: "لا أعرف ضرباً من الجمال ليس فيه شقاء". هذا يفسّر ارتباط الجمال بالعشق والشقاء الرائع في ندرته، وبخاصّةٍ عندما يكون شقاءً من أجل جمال الأشياء نفسها، والموت في سبيل الجمال جمال. ولذا، فالمعتدي قبيح، ومقاومة الاعتداء جمال مطلق.
يكون الموت ضرورياً كلّما ازداد ارتباط الإنسان بالمكان، كينونة وعشقاً. فإذا أردنا نفي الموت في معناه هذا فلْيُلْغَ الانتماء والعشق معاً، ولذلك فالموت من أجل الحبيبة التي تنهض من نومها يقيم علاقة جدليّة بين الشاعر والمكان بكلّ تفاصيله من الوطن - الحوض عند زهير بن أبي سلمى ("ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم") إلى الوطن - المعنى والوجدان عند ابن الرومي ("وحببَ أوطانَ الرجال إليهمُ/ مآربُ قضَّاها الشبابُ هنالكا/ إذا ذكروا أوطانهم ذكَّرتْهمُ/ عهودَ الصبا فيها فحنّوا لذلكا").
لذا يكون درويش رائياً بهذا الجسد والمعنى في أن: "حالة الاحتضار الطويلهْ/ أرجعتني إلى شارعٍ في ضواحي الطفولهْ".
العشق كان مزامير درويش فوق جلعادي، ويسطع العشق أكثر كلّما ابتعد جلعادي والكرمل، ويصبح العالم محطّة للعودة، مهما كان الانتظار في المحطّة طويلاً. وحده العشق جواز السفر الفلسطينيّ، ولا يقرّ الشاعر في مكان طالما المكان الأوّل يناديه وطالما حبّ الديار شغفنَ قلبه: "أحب البلاد التي سأحبّ/ أحبّ النساء اللواتي أحبّ/ ولكنّ غصناً من السرو في الكرمل الملتهبْ/ يعادل كل خصور النساء/ وكل العواصمْ/ أحبّ البحار التي سأحبّ/ أحبّ الحقول التي سأحبّ/ ولكن قطرة ماءٍ على ريش قبّرةٍ في حجارة حيفا/ تعادل كل البحار".
4
في شعر درويش حزن غامر يكاد يقتلع كلّ شيء لولا رؤية الجرح الفلسطينيّ الجميل. هذا الحزن بمقدار ما هو وقود لذاتٍ مشتعلة، هو سكين تؤلم وهي تغوص أكثر في لحوم الأجساد العارية إلاّ من الإصرار على الكينونة في معناها الفلسطينيّ الجميل، حيناً "يبكي في وسط كل ما هو مهزوم" كما يقول بابلو نيرودا، لكنه يعود ليؤكّد حضور المكان عبر الموتى الذين يملكونه بجدارة: "طلعتْ من الوادي وفي الوادي تموت.../ ونحن نكبر في السلاسلْ/ طلعتْ من الوادي مفاجأة/ وفي الوادي تموت على مراحلْ/ ونمرّ عنها الآن جيلاً بعد جيل/ ونبيع زيتون الجليل بلا مقابلْ/ ونبيع أحجار الجليل/ ونبيع تاريخ الجليل/ ونبيعها/ كي نشتري في صدرها شكلاً/ لمقتولٍ يقاتلْ".
المقهور هو الذي ينتصر في النهاية. نعم، قد ينزل الثائر عن صليبه، وقد يفقد الأرض والسماء في عزّ قهره وغضبه، لكن حزنه دائماً يضيء، ويدلّه إلى كيمياء الفرح، لأن نصر الأقوياء الخالي من الفرح الحقيقي لا يصمد أمام شعلة الحزن المتّقدة التي تدلّك دائماً إلى المنجم. جميل قول الشاعر بدوي الجبل في هذا الاتجاه: "لقطاف العلا شمائلُ كالناس فنصرٌ وغدٌ ونصرٌ نبيلُ". إن المقهور يحلم حتى في قيده، لأن قهره غير مقيّد، ولا يستطيع سدٌّ منع انفجاره. يافا لا تسافر، ولا تلفّ في حقيبة، وكيف يبرح درويش المكان، وقُبَل أحبابه المجفّفة لا تزال على المناديل المسافرة معه؟ وكيف تُنسخ فلسطينيّته، وهي موجودة في تفاصيله كلّها: "هذه الأرض تشبهنا حين نأتي إليها، وتشبهنا حين نذهب عنها". هذا الانشطار الذي تمارسه الغربة في الجسد يعيد الكرمل جمعه "مثلما تجمع القبلة الشفتين"، لكن الحزن لا يبرح لأنه من سمات الجواز الفلسطينيّ، ولا يخفى أن الأحلام الكبيرة تولد من الأحزان الكبيرة: "وها أنت يا كرملي كلّما/ جرّدتني الحروب من الأرض أعطيتني حلما".
الفاجعة تفتّش حنايا الشاعر، وحين تنتهي من تفتيشها، يدسّ فيها أحلاماً، لكن يوميات الموت العادي لا تترك له متّسعاً للفرح، وإذا كان الفرح انتصاراً فإن الشاعر ينتظر الانتصار، لكنه رائدٌ، والرسول محمّد يقول: "إن الرائد لا يكذِبُ أهلَه"، ومحمود درويش ليس من الصنف الذي آمن لسانه وكفر قلبه، ولذلك ينبع حزن من المشهد فيغطّيه بالحلم، وهذا دور الشاعر المبدع: "رأيت الذكريات تفرّ من شبّاك جارتنا/ وتسقط في جيوب الفاتحين... / إن الشظايا حاصرتني/ فاتسعت إلى الأمام".
الكتابة في محمود درويش هي كتابة من صنف آخر، أولاً لأن قضيته تختصر تاريخ العرب المعاصر، ولأنه هو شاعر "نسيجُ وحدِهِ"، وهو شاعرٌ متدفّق كينابيع الجليل، ولا يمكن أن تحيط هذه الصفحات بشاعريّة عظيمة كشاعريّة محمود درويش، ولا حتّى بالمكان الذي اخترناه عنواناً لهذا المقال. وننهي بالتأكيد على أهميّة محمود درويش في تجربة الإبداع شعراً وموقفاً، ونقول حسبه أنه كان يغنّي لبلاده في زمن "لم تكن الأشجار قادرة على تملّك أغصانها، ولا الطيور على تملّك أجنحتها"، على ما يقول ناظم حكمت.
****
في المرحلة الثانوية من تحصيلي العلميّ، كنت أعمل في الصيف منقذاً للسباحة في أحد مسابح الجنوب. كنت أستغلّ فترات الهدوء كي أتمدّد على الكرسي الطويل وأقرأ كتاباً ما. ذات يوم كنت أقرأ فيه "أحد عشر كوكباً" لمحمود درويش، جاء مدير المسبح وأخذ الكتاب من يدي وسألني: "إذا غرق أحد الزبائن ومات: من المسؤول أنت أم محمود درويش؟". في ظنّي اليوم أن المدير كان متسامحاً معي في هذا السؤال لجهة أنه كان فلسطينيّ الجنسيّة، وكان يعتبر محمود درويش رمزاً من رموز القضيّة الفلسطينيّة، وبالتالي استبدل العقوبة المفترضة وهي الطرد من العمل بسؤال فيه من المخيّلة ما سمح أن تبقى هذه الحادثة في ذهني حتى اليوم. ليس مدير المسبح وحده من كان ينظر إلى محمود درويش في وصفه رمزاً أو ضميراً للقضية الفلسطينيّة، أنا أيضاً قرأت درويش تحت وطأة التعاطف مع هذه القضيّة، وبتأثير من الرموز والاستخدامات التاريخيّة والفلسفيّة في جملة درويش نفسها. وكم تأجّجت مشاعري في متابعة السحر الذي يبثّه الشاعر في قصيدته كأن يقول: "سقطت ذراعك فالتقطها، وسقطتُ قربك فالتقطني واضرب عدوك بي". السحر في الانعطافة "الثورية" داخل قصيدة فيها من التحدّي والمواجهة ما يدغدغ بقوّة مشاعر شاب يساريّ (سابقاً) رغب بفتاة تشبه "ريتّا" وببندقية كالتي يحملها "أحمد العربي"، يرغبُ بقصيدة توفر كلّ انطباعاته وقناعاته حول الحبّ والمرأة والسياسة والثورة والقضايا الكبرى التي ينتمي إليها.
هذا ليس هو الجانب الوحيد من علاقتي بشعر محمود درويش، الجانب الآخر كان يتعلّق برغبتي في أن أكون شاعراً. فبعدما انتهيت في مرحلة من حياتي من قراءة نزار قباني، وبعدما كنت بدأت أعتبره شعراً للمراهقين، شرعتُ في قراءة درويش في وصفه أنضج وأكثر استجابة مع ما كان ينتابني من أفكار ومشاعر وانتماءات وقضايا... لا بأس في القول هنا إن مرسيل خليفة أيضاً لعب دوراً في السحر الذي كان يحيط بي لدى سماعي كلمات درويش محاطةً بعود مرسيل وأنغامه وصوته الرقيق.
قرأت محمود درويش لأتعلّم الكتابة، أو لأتعلّم السرقة الأدبيّة، لا فرق. جميعنا في البدايات قرأ ليتعلّم، وربما ليسرق الكلمات والحبكة والفكرة، وربما المشاعر. المشاعر نمتصّها ونتماهى معها، مع أنها ليست معاناتنا في واقع الحال. وأحسب اليوم أن لمحمود درويش حضوراً ما في مجموعتي الأولى "وأنا ظلّك". أعترف بهذا الحضور لأتخلّص منه على الأرجح. وحيث بدأت علاقتي بالشعر تختلف وذائقتي تتبدّل ومروحة قراءاتي تتسع صرت في مرحلة ما على قطيعة مع شعر محمود درويش ظناً مني أنها مرحلة انتهت وعليّ أن أنساها. حتى رأيي تجاه القضية الفلسطينيّة تبدّل، وحيث أنني في يوم ما كنت أتعامل مع هذا الشاعر في وصفه ناطقاً شعرياً باسم الثورة الفلسطينيّة، كان طبيعيّاً وواقعيّاً أن تتبدّل علاقتي به أيضاً. والحال هذه، جاءت "جداريّة"، وهي المجموعة الأولى التي كتبها درويش بعد عملية جراحيّة في القلب أجراها في فرنسا، وفي هذه المجموعة اشتغل على الحياة والموت والإنسان بينهما. فأعادت "جداريّة" وصل ما انقطع بيني كقارىء وكشاعر وبين شاعر كبير كمحمود درويش. هذه العلاقة المتجدّدة تطوّرت مع كتابه النثري "في حضرة الغياب"، وقبله مع مجموعة "كزهر اللوز أو أبعد" وغيرها من المجموعات الجديدة التي يندر أن تذكّرنا بقديم درويش الشعري وبالمرحلة الثوريّة من القصيدة الدرويشيّة.
ذات يوم التقيت محمود درويش في مقهى الـ"كافيه دو باريه"، كان بصحبة مجموعة من الأصدقاء، حين صافحته سألته: من أين أتيت بجملة "وقعتْ ريحٌ عن الفرس؟". هذا السؤال كان بمثابة تجديد الإعجاب بتجربة هذا الشاعر، والاعتقاد بأن الشعراء الذين يستطيعون إضافة جملة بهذا الحجم والقوّة في كتابهم العشرين وفي تجربتهم الطويلة هم قلّة ونادرون. أخيراً هذا ليس مقالاً، بل انطباعات شخصيّة حيال شاعر كبير كمحمود درويش، سواء غرق أحد زبائن المسبح آنذاك، أو غرقتُ أنا في الاستهلاك وفي المواقف السريعة والمرتجلة... من نزار قبّاني إلى محمود درويش.
****
لعلّ محمود درويش أبرز شاعر أثّر في الحراك الشعري العربي في العقود الأربعة الأخيرة، وبشكل خاص في صوغ اللاوعي الشعري والذائقة الجماليّة عند الشعراء الشباب بمجمل أطيافهم، حتى بات مرحلةً يمرّ فيها الجميع تقريباً، خاصة في مراحله الشعريّة المحمّلة بالرمز السياسي واللغة المركّبة عبر مجازات غنيّة بحساسية عالية وبعدٍ فلسفي يميّز شعر درويش باعتباره المعادلة الأكثر صعوبة ووعورة وجمالية ما بين الفكري والفلسفي والجمالي، وباعتبار أن تجربته الأكثر قوّة في التعامل مع الأسئلة المصيرية في الواقع العربي، وكثيراً ما كانت محمّلة بطاقة تمنحها القدرة على الصمود في وجه الزمن.
بدأت علاقتي مع شعر درويش مذ كنت طفلاً في سنواتي الأولى في بداية الثمانينيات، وأنا أحفظ بحماسة أغاني مرسيل خليفة، الذي كان له دور هائل في منح تجربة درويش فضاءاتٍ أرحب يتنفّسها الناس ضمن بقايا الحراك السياسي الاجتماعي في سوريا بشقّه اليساري والقومي الذي لم يخرج وقتها على مرحلة التعميمات والمقولات الكبرى التي تبحث عن رموزٍ تقدّسها وتدافع بها، وعنها، في الوقت ذاته، وكان محمود درويش أحد هذه الرموز، وقد تفاعلتُ مع شعره من باب المواقف السياسيّة المقرونة بالجمالي باعتبار أني ولدت في وسط يساري قومي، فأمسى درويش بالنسبة إلي، كما إلى الكثيرين، شاعر القضية الفلسطينية والأسئلة الوجودية العربية، صنماً جميلاً كبيراً بحجم قلب أضيق من أن ينبض إلا بما نشاء، فالحبّ للأرض، والمرأة رمز للوطن، والغصن رمزٌ للبندقية، والعصافير طلقات... حشد هائل يتجمّع في قاموس المجاز الدرويشيّ المؤدلج الذي وضعناه، والذي خنق شعره لفتراتٍ طويلة حتى بات أسيراً له عانى الكثير ليخرج عليه، ومررت بالكثير لأفهمه وأخرج عليه.
في تلك المرحلة بدأ اهتمامي بالأدب يأخذ أشكالاً أخرى، لكنها تخضع لتأثير قضايا شعر درويش وغنائيّته، وتطوّرت ذائقتي الجماليّة عبر التأمّل الطويل في بنية المجاز في شعره، وبشكلٍ خاص الصور القاسية والموحشة، ودون أن أدري كنت أبحث عن الحنين وقسوة الجمال في شعره، ومن ذلك أذكر مقطعاً من قصيدة "سونا" في ديوان "أوراق الزيتون" يقول فيه: "يا بائع الأزهار! اغمد في فؤادي زهرةً صفراء تنبت في الوحول". وعلى اعتبار أني بدأت مراهقتي باكراً في مدينة لا تعترف بالحبّ، أخذ شعر درويش مساحةً أخرى غامضة وساحرة وممضة في روحي، فهو أرض للحلم تُورق جدرانها بما أشاء، وقد حفظت مقاطع خاصة تنجح في التعامل مع قلوب الفتيات بعيداً عن تقليدية عدد من الشعراء كنزار قباني الذي لم أحبّ أسلوبه يوماً، وحتى الآن أذكر أني أول مرّة قرأت الأعمال الكاملة لمحمود درويش أعارتني إيّاها فتاة أحببتها، ووقتها صدمت بإنتاج درويش في التسعينيات ولم أفهم ما قرأت، وبالتحديد كانت القفزة النوعية عند مرحلة قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا"، وذلك عندما بدأت أكتشف أن أسئلة درويش أعقد بكثير مما أعرف، وتحتاج إلى مزيد من البحث. وفي هذه المرحلة بدأت تجربتي الشعرية تأخذ ملامح خاصة عبر الكتابة بنزقٍ حاد وصورٍ غريبة وقاسية مع رفض لفكرة الوزن باعتبارها كذباً مشترَكاً بين الشاعر والمتلقي الذي لا يعرف وزن التفعيلة ولا يميزه فعلاً، وكنت أبحث عن إيقاعات جديدة من خلال تجربة متواضعة مع الموسيقى، والجميل في الأمر أن والدي، وهو شاعر أيضاً، شكّل حالة مدهشة من الدعم والانفتاح دون أدنى محاولة لتسيير تجربتي، بل على العكس كان يختلف معي بحميمية ويشجعني على الدفاع عن رأيي... فوضى هائلة يمرّ بها الجميع في بداياتهم ومئات الأفكار والقضايا في الرأس، وكلها على ورقةٍ بيضاء صغيرة ستواجه العالم الصلب بلحمها الطري... هذا ما كنت عليه، واستمر ذلك فترة من الزمن حتى سافرت من مدينتي دير الزور إلى دمشق للدراسة في الجامعة، وحتى تلك اللحظة كان شاعري الأول محمود درويش وذائقتي الجمالية درويشيّة السمات، وصادف أني عشت وحدي قرابة العام فأخذت وقتاً كافياً لتشكيل علاقة أعمق مع شعر درويش، وتطوّر حسّي النقدي بشكل طفولي يغضب من بعض التفاصيل ويعشق أخرى. آنذاك كانت الصورة بكمونها الحسي والفكري محور اهتمامي باعتبار أن فهم تجربة درويش يحتاج إلى الكثير من الجهد التراكمي والإلمام بأسئلته ومواقفه الإبداعية والسياسية أيضاً، وأجمل نصّين أثّرا بي في تلك المرحلة هما "يطير الحمام" و"أحمد الزعتر"، والأخير بشكل خاص شكّل أهم مرحلة في تفاعلي مع شعر درويش.
في تلك الأيام كنت أكتب بغزارة مدهشة وأعاني من إحباطات هائلة سببها فقر وسط الجامعة الروحي في دمشق، واكتشفت أني أبحث عن زمنٍ غير زمني، ومن سوء حظي أني أدرس في كلية الطب البشري ضمن وسط قليل الاهتمام بالأدب، ومن يهتمّ فمن باب المظهرية وادعاء الثقافة لا أكثر، واكتشفت لاحقاً أن قسماً كبيراً من جمهور درويش الحاشد لا يقرأه، وأن كثيراً منهم لا يحبّ شعره أيضاً، خاصة عندما يقرأ قصيدة لدرويش مغفلة الاسم! وهنا اكتشفت الكارثة: لقد تحوّل درويش إلى صنم شعري أو مسيحٍ صغير وجميلٍ كأيقونة يرفض الآخرون نزوله عن الصليب والسير بينهم بقلبٍ حافٍ، والكارثة الشخصية هي اكتشافي أني أعيد إنتاج شعر درويش فنيّاً في نصوصي بحيث يتسرّب فيّ دون أن أدري، والميزة الأساسية التي ربحتها من ذلك أني تعلّمت كيف أتذوّقه بشكلٍ أفضل بكثير من قبل، ووصلت إلى نتيجة آنذاك مفادها أن فهم الشعر الحديث يحتاج إلى قارئ مبدع إلى حدّ ما ليعيد إنتاجه، وأحياناً يكون عمل المتلقي أجمل وأغنى من النصّ الأصلي، ومع العلم أني أعرف هذا الاكتشاف من خلال كتابات النقّاد وبعض المدارس النقدية، لكن اكتشاف الأمر بنفسك لا ينقص من متعة المغامرة أبداً، والاكتشاف الثاني، والأهمّ، هو أن الشعر كالحب، فكي تتخلّص من عشق امرأة عليك أن تحبّ سواها. هكذا بدأت بالبحث في تجارب شعرية أعلم مسبقاً أنها مهمّة، فقرأت لكثيرين من الشعراء الأحدث نسبياً: نزيه أبوعفش، سعدي يوسف، قاسم حداد، رياض صالح حسين، شوقي بزيع... لكن الأهم على الإطلاق كان محمد الماغوط الذي أعادني إلى بداياتي وأنا أكتب بنزقٍ وحشيّ في إطار ما يسمّى بالشعر الشفوي بعيداً عن تأمّلية محمود درويش وغنائيّته. وفي هذه المرحلة، ودون أن أدري، اتخذت قراراً بالابتعاد عن شعر درويش ولو لفترة أستطيع فيها أن أختبر نفسي، ولاحقاً اكتشفت لماذا كنت أستعير دواوين درويش دون أن أمتلكها، فالمشكلة لم تكن في غلاء أسعار الكتب فقط. وبالفعل كانت هذه المرحلة هي الأهم بالنسبة إلي لأني بدأت بتكوين ملامح خاصة بعد صهر عشرات الشعراء في روحي وإعادة إنتاجهم، وتدريجاً تراجعت عن مواقفي القطعية، وبدأت أكتشف أن الشعر حقل واسع للتجريب، وبشكل أدقّ هو انعكاس للحياة، فالحَلَقُ تحت حجاب صبيةٍ في الشارع قصيدة، وصوت خطواتها المرتبكة قصيدة، وكأس الشاي الوسخ في الكافتيريا، ومئات الشفاه التي لثمته بهدوء وملل وشرود... قصيدة، وتحسّنت علاقتي مع تجارب كنت أرفضها مثل: مباشرة مظفر النواب السياسية، ونخبوية أدونيس النخبوية! فكل التجارب والأساليب مهمة في لحظة ما، والاختلاف سمة تتيح تطوير الذائقة. في هذه المرحلة عدت إلى كتابة شعر التفعيلة مع استمراري في كتابة قصيدة النثر، وببساطة تعلّمت أن أترك النصّ ليحدّد نفسه حتى أني أحياناً أزاوج بينهما ما دام النسق الشعري متكاملاً وظيفيّاً وجماليّاً، وتدريجاً تعلمت أن فنّ الحذف أصعب من الكتابة ذاتها، وأفادني أني اطلعت على عشرات التجارب لشعراء شباب مدهشين بهواجسهم وأسئلتهم عبر الإنترنت، وبعد كل ديوان لدرويش من بعد "لماذا تركت الحصان وحيداً" أعود لأصطدم معه بمحبّة ونزق وذائقة أكثر تطوراً تسير نحو موقف نقدي. والأهم أن درويش شاعر متجدد وغني يستطيع أن يتدارك تكرار نفسه، لكني وحتى هذه اللحظة أحسّ أن شعره يعيش أزمةً ما بعد "حالة حصار"، وبشكلٍ أوضح في "كزهر اللوز أو أبعد"، وبعيداً عن تأليه الشعراء، وبعيداً عن الصراع المملّ بين شعراء النثر والتفعيلة، أعتقد أن هذا الديوان محاولةٌ لاقتباس حيوية السرد النثري في التفعيلة مع تخفيف الإيقاع والحفاظ على الوزن، وهو أبسط عناصر الإيقاع وأكثرها جموداً، وهذه العناصر والتي تشمل إيقاع الصورة وإيقاع الحروف، وبشكل خاص حروف العلّة، وإيقاع الأبيض والأسود وإيقاع الفكرة أو المشهد مع الكثير من العناصر الأخرى، تجعل من الإيقاع حالةً متحركة وليست جامدة كالوزن... لكن النثر أجدر بذلك ببساطة، ومن جانبٍ آخر ثمة حرفيّة عالية، لكنها غير ممتعة بالنسبة إلي كما هو الحال في قصيدة "طباق"، وبطبيعة الحال تعلّمت أن الذائقة الجمالية متطورة، ولا مكان لأحكام القيمة القطعيّة في التعامل مع تجارب غنيّة مثل تجربة محمود درويش يصقلها الزمن، أو يصقلنا في التعامل معها.
****
في زمن ليس ببعيد، انقطعتُ تماماً عن الشعر، ولم يكن حنيني الذاتي ليعيدني إليه. كنتُ أنتظر شيئاً ما خارجيّاً، أشبه بالوحي أو الأمر الإلهي. أنتظر شيئاً بلغة لا تقلّ بهاء ولا غموضاً ولا استشرافاً عن لغة الأساطير. وذات مساء، أثناء زيارتي لأحد الأصدقاء، رأيت على آخر الطاولة "جداريّة". ظلّ هذا العنوان يثير فضولي التاريخي والفني، بحكم دراستي للآثار، لكني لم أجرؤ على الإمساك بهذه الـ"جداريّة" حتى ذهب صديقي لإعداد القهوة، وبخطى حثيثة اقتربت من الطاولة وشيئاً فشيئاً تبيّن لي أن الـ"جداريّة" ديوان شعر وأنها لـ"درويش" وأن… "هذا هو اسمك/ قالت امرأة،/ وغابت في الممرّ اللولبي". رجع صديقي ليضبطني وأنا أخفي وجهي بين دفتَي الديوان مستنشقاً هواءه بعمق كما لو كان هذا هو آخر نَفَسٍ لي، وحينها عرفت أن... "لا الرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى".
محمود درويش يكتب على الجدار، مستنزفاً هاجساً أبديّاً ربط طفولة الإنسان الأول بشيخوختنا المبكرة، جاعلاً من تاريخ الإنسانية تاريخاً خاصاً به وحده، ومضفراً اسمه خلاصةً للشعور والشعر والوحي والرؤيا والدمع والدم الساخن الذي يصاحب الولادة، وقد كنت أتساءل: من يهب الحياة والخلود للآخر، الإنسان أم الجدار؟ فقال: "عد يا موت وحدك سالماً/ فأنا هنا في لا هنا"، وطار خفيفاً فوق الموت فرحاً بالحياة.
بين رؤية الموت وإغماءة الحياة تحدث مفارقة ومعانقة: مفارقة الـ"كان" والـ"كائن"، ومعانقة الـ"سيكون"، والدراما هي الأساس في هذا كلّه: محمود درويش كاتب دراميّ، ومن الخطأ اعتباره شاعراً فقط، ودراميته لا تقف عند حدّ الاستخدام في الكتابة، بل تتجاوز ذلك إلى الكتابة نفسها. ففي البداية ظهر درويش في وصفه "شاعر الأرض المحتلة"، وقد اعتُبِر إثر ذلك "صوت فلسطين" وسفيرها البهي، وكان يُطلب منه دائماً "التعليق على الأحداث" كخبير سياسيّ أو كشاهد عيان، واضطر إلى الشهادة وتقديم "القضية" كمادّة استنفار واستهلاك لنتناولها مع الفطور والشاي صباحاً... لكنه برؤيته الفنيّة أيقن أن "مشروعه الخاص" لن يتحقق بهذا الشكل الذي يتساوى فيه مع غيره ولا تظهر فيه خصوصيّته الشخصيّة والشعريّة، لذلك عمد إلى تقديم "قضية الإنسان" مراعياً التفاصيل الصغيرة والمفردات البسيطة، والعلاقات المتشابكة، وفي مرحلة لاحقة قلب المفهوم برشاقة رؤيويّة لافتة وساءل "إنسان القضية" راصداً ما به من ندوب وتعقيدات وأبعاد تاريخيّة وتراثيّة وأركيولوجيّة، وفي أعماله الأخيرة صار درويش لا يلتفت إلى "القضيّة" ولا إلى "قضيّة الإنسان" ولا "إنسان القضيّة"، وبدا جلياً أن كلّ همّه تقديم "إنسان الإنسان" في لحظات التحقّق العالية كلحظات الموت والحلم والمرض والإشراق.
حضور الدراما هنا لا تمنعه لغة مشبعة بالجماليّات، ولا غنائيّة شجيّة مثقلة بإرث طويل من المواويل والخسائر، ولا جمهور متعجّل يلهث وراء المعنى المباشر الصريح. فهذا الحضور الدرامي في مشروع الشاعر يعتمد على حيلة الشاعر نفسها في التخفّي غالباً والتجلّي أحياناً داخل القصيدة، وكأن درويش يحقق تماهياً بينه وبين الدراما محمّلاً إيّاها ما يثقله من أفكار، وما يخاف عليه من إرث، وما يخاف منه من تلاشٍ، فبعدما كان يعلّق على الأحداث، ثم يرصدها، ثم يدخل إليها كراوٍ عليم، اختار في مرحلته الأخيرة أن يدخل إلى هذه الأحداث هو وقصيدته كراوٍ مشارك: "وأرمي القصيدة/ هذي القصيدة في سلّة المهملات"، "من لم يحبّ الشعر في هذا المساء فلن يحبّ"؛ وهذا ليثبت إنسانيّته المراوغة في وجهيها (الأنا/ الآخر) فيتحقّق بها جدل الشاعر - القصيدة - القضيّة - الإنسان.
دراميّة درويش لا تقف عند حدود "المضمون"، لكنه يجنّد آليات الشعر وطرائق تشكيله وأشكاله المتمايزة؛ لتلعب معه لعبته الأثيرة، فبعد غنائه الشجي للـ"معلّقات" وتأرجحه بين المواويل يقول في النهاية إن "لا بدّ من نثر إلهي لينتصر الرسول". دراميّته تحمل المكان وتأوي به إلى جبل يعصمه، وتحمل الزمان إلى "زهر اللوز أو أبعد"، لكنها أصغر منه، كيف تحمله؟ وأكبر منه، كيف يحملها؟ لذلك اتفقا على تبادل الاختفاء كلّ منهما في الذات الأخرى؛ فيكون بطلها حيناً وتكون بطلته حيناً، كما اتفقا على أن يحمِّلاها لمن يشاهدهما في الحفل الأخير. محمود درويش يسأل: هل أؤدّي جيّداً دوري من الفصل الأخير؟ فنقول له: نعم، والمسرحية التي تسأل عنها لم تقرأها من قبل ولم تُعرض عليك ولم تُفرض عليك أيضاً، فأنت وحدك كاتبها وممثّلها ومخرجها، ووحدك ملابسها وديكورها ومؤثّراتها، ووحدك قمت بالدعاية والتجهيز الفني ورسم الحركة وإعداد الخشبة. وحدك قمت بهذا كلّه، لكنك لن تصفق وحدك.
***
بخصوص تجربة درويش وأثرها على الجيل الذي أنتمي إليه، ويفصل بينه وبين درويش جيلان أو ثلاثة على الأقل، أريد أن أتحدّث عن نقطة تخصّنا أكثر مما تخص درويش نفسه، وهي تلك القيمة التي قدّمتها لنا تجربة درويش، نحن من تفتحت أعيننا على قصيدة النثر، ودخلت إلى عالمنا كشيء يحمل مشروعيةً أكثر اتساعاً من ذي قبل، ولم نواجه تلك الصدمة في التعامل معها ولا استقبالها كما كان الأمر قبل أكثر من نصف قرن، ومهما يكن الجمهور مناوئاً لها، وغير قادر كثيراً على تعاطيها، ويعاملها أحياناً بعداونيّة، لكنه ما عاد ثمة أحد يستطيع نفيها وإسكاتها، وأن الوقت يمشي إليها، لا سيما وهي تكاد تكون اللسان الكوني المشترك في زمنٍ تهاوت فيه الكثير من الخصوصيات على مستوياتٍ أبعد من خصوصيات اللغة، أو نوعٍ من أحد أجناسها الأدبية!
وبرأيي، ما قدّمته لنا تجربة محمود درويش هو هذا الأمر تحديداً: نسف خصوصية اللغة وقدسيتها، والخروج من عبوديتها وتقويضها وإعادة صوغها من جديد. لقد قدّمت لنا تجربته هذه الذهنيّة في التعاطي مع الشعر واللغة، وإن لم نكتب التفعيلة، لكننا قبضنا بأثره، مع آخرين، على أهمية الهدم والبناء وخلق دلالات حيّة وجديدة ومتوائمة مع وقتنا على مستويي المفردات والتراكيب معاً، وبكلمة واحدة: لقد منحنا محمود درويش ذهنيته، وإن لم نكتب نصّه. هذا هو ما تركته لنا سنواته الكثيرات حتى وإن لم نمش إلى بيته، فقد قال هو مرةً إن أجمل من البيت... الطريق إلى البيت!
أما ما يخصّ نصّ درويش ذاته، فلعلّ أجمل وأسوأ ما فعله في آن واحد شعريّاً، أنه مشى بنص التفعيلة إلى مدى شاسع، ولا أريد أن أقول أنه مشى بها إلى أقصى ما يطيقه هذا النوع الشعري، حتى لا يكون في هذا جنايةً على من يحمل عبء خطوةٍ أبعد، ويحلم بمحاولات تجاوز، لكن درويش بالفعل راح بعيداً جداً في الإيقاع واللغة والدلالات والألم والجوهر إلى مدارٍ يفصل ما بينه وبين الآخرين مسافات، لا مسافة!
***
احترت بأيّ صفة أتناول محمود درويش، ولأن الكلام على الكلام صعب، كما يقول أبو حيّان التوحيدي، أردت الاكتفاء بشرح بعض التفاصيل من تلك العلاقة التي نشأت بيني وبين هذا الشاعر منذ البواكير، ولو أن بدرها لم يكتمل بعد. فأنا أعثر على محمود درويش في محطّات كثيرة بذاكرتي القديمة من خلال قصائد مغنّاة (مرسيل خليفة وماجدة الرومي وسواهما)، ومن خلال ما تناثر من قصائده في المجلاّت والجرائد زمن دراستي الجامعية. يحضر محمود درويش بكلّ ما فيه من تفاصيل الغرابة والوضوح من خلال قصائده الممزوجة بالشميمَيْن، إذ لست أدري كيف اعتبر النقد العربي أن جلّ القصائد التي كتبها غنائيّةً خالصة، وتعامى عن تلك القصائد التي كتبها مازجاً فيها الحسّي بالتجريدي ليُؤسْطر بذلك المأزق الفلسطيني. ففي الوقت الذي كانت فيه القصائد الأولى لدرويش تفصح عن فرديّة خالصة في إعادة التسميات للعالم والأشياء التي تتحرّك من حوله، فتح هذا الشاعر أُفقاً مغايراً يتجه إلى القصيدة المكتوبة بالذات التي تتحرّك في دائرة التكلّم والتحدّث والتعبير. ليس هذا الكلام بداية للدفاع عن الصوت اللاحق لمحمود درويش، حين تخلّص فيه من تعقيدات اللغة وفائضها، إنما هو تأسيس لمرحلة جديدة أدخلت شعره في الملكوت الكونيّ من خلال امتلاء قصيدته بما هو كونيّ في مسرحة القضية الفلسطينيّة وأسطرتها، حيث تتجلّى هذه المعاني في مجموعته "أحد عشر كوكباً"، الأمر الذي مكّن القصيدة الدرويشيّة من أن تكون أقلّ كثافة من ناحية اللغة، وأكثر كونيّة واتساعاً للأسطورة من ناحية الهدف، وبذلك امتلك درويش ميزةً تخرجه على دائرة ما حيك له، وما أُريد له من خلال الصفة التي ألصقها به النقد العربي في وصفها غنائيّة بلا ريب. هذا هو الانطباع الذي أزعمه من خلال قراءتي، كشاعر شاب، لمحمود درويش، لذلك أجد أن الإنصات لهذا الشاعر واستحضار نصوصه وكلماته ألذّ بكثير مما نقوله عنه بدافع النقد: إسخيلوس والهنود الحمر و"ورد أقلّ" و"أحد عشر كوكباً" و"مأساة النرجس ملهاة الفضّة" و"العصافير تموت في الجليل"... أول الأسماء والأمكنة التي داعبني بها محمود درويش، ذات أبكار وآصال من سنوات عمري. لقد مرّغني درويش في ترابه وأهداني وطنه اليسير الذي لا يتعدّى كفّين من حنين. نعم، يتسع محمود درويش وشعره - على الأقل في عقلي ووجداني - لهذا كلّه وأكثر، فهو الذي ارتقى بالنص والسرد إلى الاشتغال، وبالقصص تارة والخبر تارة أخرى استطاع غسل قصيدته، ملامساً أعلى درجات اللهيب دون أن يحترق. لقد وضع درويش يده على الجرح وبصم. هكذا يحضر هذا الشاعر في ذاكرتي بنبرته الحادة ومادّته الغنيّة بالتاريخ من خلال الواقعة والشخوص، وهكذا تحضر قصيدته ووطنه ولغته بكل توهّج واتّقاد ليكون سهلاً فتهتدي حبّة قمحه إلى ترابها المسروق.
***
بذكاء، ومنذ سنوات، نقّى محمود درويش لغته الشعرية من المفردة السياسيّة، وهمومها، وخطابها، وتخفّف من أحمالها، راجياً أهلها: "أنقذونا من هذا الحب القاسي". وتيسّر له، بمثل هذه الخفّة أن يمرّ، في ما بعد، على أبوابها مروراً مبهجاً، مروراً لا يورّط ولا يوقع في محظورات شعريّة، كأن يتمنّى أن يشتم وطنه، مثل أيّ ملاّك أرض ووطن غاضبين ومخلصين وصادقين في الحبّ (بالطبع لا حرية في الشتم إلا بعد الامتلاك).
قفزة حرّة كانت، وتخلُّصاً من مفاهيم شعريّة كانت تقيّد الوطن، وتصلب الشعر على خشبته. لكن ماذا عن الجماهير "المخلصة" التي غازلها درويش وغنّى لها وبكى معها طوال عقود؟ هل بإمكانه تكرار قفزة أخرى تنجّيه من أحضانها القاتلة، ليسلم ويسلم شعره، مثلما فعل مع قصيدته والخطاب السياسي... حينما فكر وقرّر ونقّى؟!
هذا ما يحاوله، أعتقد، بالرغم من بقايا هوى في نفسه للمدرّجات الرومانيّة، ومساحات المدن الرياضيّة الواسعة التي يتردّد في جوفها صدى أعلى من صوته، وبالرغم من غمزة مجاملة في مهرجان هنا أو هناك تضطرّه الى أن يستلّ قصيدة "عالية الصوت " قديمة، مضى زمن شحناتها وتثويرها ورفضها حتى بردت. فما معنى أن يعيد درويش قراءة "سجِّل أنا عربي" على مسامع وقلوب جماهيره سوى علة ما؟ وما معنى أن يقرأ في الأمسية نفسها قصيدة ذاتيّة سوى صحوة ما؟ وسينتصر - أخيراً - إلى الثانية؛ إلى نفسه الشاعرة. هذا ما يرصده متابعوه من الضفّة الأخرى، وما ستقوده إليه فطنته التي لن تقبل إطالة الحيرة، ولا الغزل الدائم، والمملّ، للآخرين. هؤلاء الآخرون الذين يعرف أنهم قد يساوونه بمظفّر النواب وأمل دنقل ونزار قبّاني، أو حتى مرسيل خليفة!
إذاً، انتهى، أو أنهى درويش، "السياسي" و"الجماهيري"، وتبقّت عقدة واحدة، هي هذه الصبيّة الملائكيّة، التي لا تنقاد إلى أغنية ولا وزن ولا قافية: قصيدة النثر.
... درويش درويشنا، ونحن عشّاق جديده، نعرف أنه يمرّن مخيّلته ولغته وتفاعيله للعبور إلى قصيدة النثر، وإلا ما معنى أن يقدّم مجموعته الشعريّة "كزهر اللوز أو أبعد" بعبارات أبي حيان التوحيدي: "أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم"، ويمتدح شعريّة إصداره الأخير "في حضرة الغياب".
في براءة المراهقة، كان من ينوي القفز من جسر عالٍ إلى ماء النهر، ينتظر أكبر عدد من "الجماهير" لتراقب وتندهش وتصفّق.
درويشنا هل يقف الآن عند حافّة هذه "اللحظة" أم في ارتعاشة المتردّد والمغتاظ من صحب سبقوه إلى النهر؟!
***
أشياء كثيرة نكرهها في هذا العالم لنحبّ الشعر. لكن لا بأس. المشكلة تكمن في أن تحبّ أو أن تكره شاعراً. محمود درويش ثعلب أمسك بقطعة جبن وحوّلها إلى تفاحة بين فكّيه. تصوّر ما يأتي: جذع التفاحة النحيل مربوط بخيط، طرف الخيط الآخر مربوط بأصابعك. وهكذا، كلما التهم درويش التفاحة أكثر، وهمّ بابتلاعها، جرّنا نحوه دون أن ننتبه. درويش يتلذّذ بالشعر، فيما أتلذّذ أنا، كفلسطيني، بالألم الكائن في مركّب القصيدة. أحياناً تأتي فراشة لتقف على الخيط. اعتدت أن أنتظر الفراشة تلك كلما قرأتُ قصيدة لدرويش، وأعترف، في نصوصه الأخيرة، لم تعد الفراشة تأتي. مرّة أخرى، لا بأس. ولأقلْ: قصيدة درويش قد تبعث فيك الشعور بالغثيان أحياناً. غثيان لا بدّ منه. فلننظر معاً: درويش ولد يحمل منفاخاً. الآن تصوّر ما يأتي: أنت بالون ذابل، درويش يقدّم وجبة هواء. الهواء مزيج عناصر عدّة ومركّبات، غازات تتراقص من أجل الحياة، وملوّثات. عظيم. أنت تقرأ قصيدته، تنتفخ. أكمل معي: بالهواء، الألم، المناورة. تنتفخ بأسباب وعناصر المناورة. ترتفع. أنت مصاب الآن بالغثيان أو بالخفّة. لكنك في كلتا الحالتين، تعلو إنشات قليلة فوق مساحة الكلمات - الألم. إذاً لا بدّ من حدوث الإصابة بهذا الغثيان لتقرأ ألمك أيها الفلسطيني. الألم بالنسبة إلى الفلسطيني كقطعة الجبن المتعفّن. ألقى درويش القبض عليها. قلت هذا سابقاً. البارحة مثلاً استيقظت من النوم، جرّدت نفسي من الملابس وقمت بقياس المساحة المتبقّية من جسدي، التي لم تتحوّل إلى جبن متعفّن. النمل يحبّ هذا الصنف من الأطعمة، كذلك السمكة، الدبّ القطبي أيضاً، وربما النادل والجندي والصحافي. ربما حبيبتك، وأيضاً أنت. إذاً، الفلسطيني محاط بأسباب الألم، بأسباب البقاء على قيد الحياة. لذلك، هو أيضاً محاط بأسباب الشعر. درويش فتح الباب منذ أكثر من أربعين عاماً وأدخل الفلسطينيين مجرّته "الضيّقة"، أو على الأقلّ هكذا اعتقدت، لكنه انتزع الخزانة وصنع منها غرفة إضافيّة، والتابلو وجهاز الراديو وركوة قهوته ومواء قطته التي لم تكن يوماً له. أصبحت حجرته ملآنة بالغرف الإضافية. وهكذا أجدني في شعره أقرأ ملامح أبطال الأساطير، أقرأ نوافذ الأتوبيس، وخوذة الشرطي، أنفاس عامل البريد، ولهاث المنفضة الراكضة فوق الطاولة، بالضبط كما أقرأ، ما أمكنني، هاجسه الشعري.
الآن، أكتب الشعر برئة لا تشبه رئة درويش. يفعل مثلي العشرات من الشعراء الفلسطينيين، وربما المئات. الفلسطينيون ينتشرون كنباتات صبّار على هذا الكوكب. نباتات من أصل واحد، وربما من كيلومتر مربع واحد. لكن، مَن مِن هؤلاء جميعاً لم يمرّ بلحظة تعلّق بدرويش؟ أتكلّم على الأقلّ عن نفسي. لا يمكننا إنكار اللمبة التي نكتب تحت ضوئها الشعر. ليست الورقة البيضاء وحدها ما يستدعي الحبّ، بل أيضاً الضوء. ثمّة مثلاً النظّارات الطبّيّة، وربما شجار أبيك مع الحلاّق، وربما الصرصار الذي مرّ منذ دقائق من أمامنا ونحن نكتب. الكتابة عن درويش تجعلني أصاب بالرعشة. أنا أكتب عن عدوّي الذي أحببته قديماً. الشعراء أعداء بعضهم. يتصافحون فقط في قصيدة شعر، ولا يتصافحون داخل حانة أو ممرّ مستشفى. أكرّر، من منّا لم يُصب يوماً باختناق درويشيّ؟ لا أعرف بالتحديد الإجابة عن هذا السؤال، ولست مقتنعاً بالبحث عن إجابة له قدر اقتناعي بحتميّة ذرّ هذا السؤال في فضاء كراهية مازن معروف لمحمود درويش. مهلاً، الرجل يتنفّس غليونه. نظنّه يدخّن. لكنه لا. يتنفّس وحسب. نحاول أن نتنفّس معه. لكن فتحة الغليون الضيّقة لا تليق بثغرين، بأربع شفاه، أو ثلاث وعشرين. نناور، وندخل من الفتحة الأخرى، الأوسع حجماً. لكننا سرعان ما نعلق داخل عنق الغليون الضيّق. نحن فئران القصيدة، نلتفّ إلى الوراء لنعود أدراجنا. الخروج بعدها من حيث قدمنا حتميّ. نحدّق في الرجل بعدما خرجنا أحياء. نحدّق فيه مليّاً. نُصاب بكراهيته وبحبّ رائحة غليونه. درويش الآن يحثّنا على كراهيته، على إنكاره. تلك شروط اللعبة: أن تكره أو أن تحبّ. درويش يتشبّث بورائه ليخطو نحو الأمام بطيئاً، بألف عكّاز. تغيّر جهازه العصبي الشعري. وأصدّق هذا التغيير التقني في استخدام اللغة، ربما لضرورة فنّيّة، أو سياسيّة، أو بنيويّة لموازاة ما بعد الحديث في الشعر، أو النبرة، أو تشريح الحالة الفلسطينيّة. أنا لست مهتمّاً بالسبب، لكني في دواوينه الأخيرة وجدتُني تعثّرتُ ووقعت عيناي على الأرض. أعترف. ما زلت حاملاً جهازي اللاسلكي المصنوع من البلاستيك. واقفاً كباب في شقّة مهجورة. لكن منذ كتاباته الأخيرة، لم يعد درويش يلعب معي. إنني الآن لا ألتقط أي إشارة من جهازه اللاسلكي المصنوع أيضاً من البلاستيك. ربما نسي أنه ولدٌ محتاج للعب مثلي.
***
أرى أن موضوعات النصّ الشعريّ على مرّ التأريخ انحصرت في شقّين: الشقّ الأوّل هو المختصّ بأسئلة الوجود (سؤال الحياة والموت، الحرية بمفهومها الأنطولوجي، حركة التأريخ، الزمن، الحبّ في مفهومه الصوفيّ على سبيل المثال)، والشقّ الثاني هو المختصّ بأسئلة الحياة (الحبّ في مفهومه الرومنسي الوجداني، الحرية في مفهومها السياسي، الفقر، الحروب، التخلّف... إلخ). وأرى أيضاً أن ثمة نوعاً من الشعراء يتعامل مع هذه الموضوعات معاملة حسّيّة ومباشرة، أو بالأحرى يتناول الجانب الظاهر منها أكثر من تناوله الجانب الخفي الميتافيزيقي، بينما النوع الآخر من الشعراء يتعامل معها معاملة المنقّب والباحث عن الجذور الخفيّة واللامرئيّة التي أسّستها. ومن أجل التعريف بالمنطلقات الشعريّة التي ستعينني على تناول تجربة الشاعر محمود درويش أقول إنني أميل إلى النوع الثاني من الشعراء، بل وأميل إلى تناول الموضوعات المختصّة بأسئلة الوجود الكبرى أكثر من الموضوعات الأخرى المختصّة بأسئلة الحياة المألوفة. وهنا أطرح الأسئلة الآتية بخصوص تجربة محمود درويش الشعريّة:
إلى أي نوع أو نمط من الكتابة الشعريّة ينتمي محمود درويش؟ وما هي انشغالات ومحمولات نصّه الشعريّ الأساسيّة؟ فهل انحصرت تجربته الشعريّة بالشقّ الأوّل فقط، أم بالشقّ الثاني فقط، أم بالاثنين معاً؟ وكيف يرى محمود درويش الشعر؟ هل هو يطالب الشعر بالانشغال في الجانب الفيزيقي من الموضوعات، أم يطالبه بالانشغال في الجانب الميتافيزيقي منها؟
لقد كرّس محمود درويش غالبيّة منجزه الشعريّ لتناول أسئلة الحياة أكثر من تناول أسئلة الوجود (ربما باستثناء بعض من منجزه، وبالأخصّ نصّه الطويل "جداريّة")، وهذا التكريس الشعريّ يساعد، تلقائيّاً، على التقاط مفهوم درويش للشعر ولمهمّته الجماليّة. فكما هو معروف عن تجربة درويش الشعريّة أنها تناولت القضايا السياسيّة العربيّة بشكل كبير، وبالأخصّ قضية معاناة الشعب الفلسطينيّ وقضية شرف العرب المهدور (أرجو الانتباه إلى أننا لسنا معنيين بالجانب الأخلاقيّ هنا من تجربة الشاعر التي تناولت القضيّة الفلسطينيّة، وإنما بالجانب الفنّيّ والجماليّ لها فقط)، وهذا الأمر برأيي كان واحداً من أقسى الرصاصات التي ثقبت جسد منجزه الشعريّ، وذلك لأنه كان في هذا الجانب متواضعاً وبسيطاً من الناحية الشعريّة، حاله حال أيّ شاعر عربيّ أو غربيّ تناول هذه القضايا بالطريقة الشعريّة المألوفة. فكلّ من قرأنا له من شعر في هذا الجانب نراه يقع في مطبّ المباشرة اللافنّيّة التي تبعد النصّ الشعريّ عن مفهوم الشعر بصورته الحقيقيّة. وهو مفهوم ملتبس على الغالبية العظمى من الشعراء في العالم منذ بداية تأريخ كتابته وحتى الآن، باستثناء بعض الأسماء الخالدة والمهمّة.
لكن أحد الأسئلة المهمّة يبرز هنا إلى السطح لفائدة هذا النقاش، ألا وهو: هل محمود درويش هو أحد الشعراء الذين التبس عليهم مفهوم الشعر بشكله الأصيل؟ وأنا أقول: لا ونعم في الوقت ذاته. أقول: لا، لم يكن مفهوم الشعر ملتبساً لديه، وذلك حينما نقرأ له نصّ "جداريّة" مثلاً، وهو نصّ يعبّر عن وعي شعريّ حادّ بالأشياء والوجود وهموم الإنسان الدفينة بطريقة فنيّة رائعة تجعلنا نقول إن درويش قد أمسك جمرة الشعر بقوّة. وهذا ينطبق أيضاً على العديد من مجموعاته الشعريّة الأخرى.
وأقول: نعم، حينما نقرأ له قصائده السياسيّة الكثيرة، وذلك لأنه لجأ فيها إلى المباشرة غير الفنّيّة، وإلى التعبير عن الجانب الظاهر من القضايا السياسيّة، وهو مجبر كما نرى على هذا الأمر، وذلك بسبب رغبته في إيصال موقفه الأخلاقي من تلك القضايا، وبسبب رغبته في المشاركة فيها بشكل فعّال كما يرى. لكن الشيء الذي فات درويش، وكلّ من كتب الشعر السياسيّ أو شعر المناسبات الوطنيّة، المأسويّة والمفرحة على السواء، هو أن هذه القضايا ليست من اختصاص الشعر على الإطلاق، وإنما هي من اختصاص المقالة مثلاً، وذلك لأن من أهمّ اشتراطات النصّ الشعريّ الغموض والإبهام والسرّانيّة في الطرح، بينما القضايا السياسيّة لا تحتمل هذه الاشتراطات أبداً. وإذا كان درويش مجبراً على طرح موقفه الأخلاقيّ من هذه القضايا فعليه التعبير عنه عبر المقالات واللقاءات الإعلاميّة، أو عبر الوسائل التقليديّة الخاصّة بمثل هذه الأمور. لذلك أرى أن هذا القسم الكبير من شعر درويش يجب أن يُهمَل للأسباب التي ذكرتها. ولذلك أرى أن التوجّه الشعريّ الدرويشيّ لغريزة التلقّي البسيطة وسّعت من جماهيره وقرّائه، لكنها ضيّقت من احتمالات خلود منجزه الشعريّ السياسيّ. لكن على الرغم من ذلك كلّه من الظلم أن نحيل جماهيريّة قصيدة درويش السياسيّة على هذا السبب فقط. فالحرارة الشعريّة العالية المنبثقة من نصوصه هي السبب الخفيّ وغير المعلن لعشق القرّاء هذه القصائد، أي أن الحرارة الشعريّة المنبثّة في الغالب الأعمّ من تجربة درويش الشعريّة السياسيّة، أو غير السياسيّة، هي السبب الأهمّ في استمراريّتها ورسوخها. أجل، الحرارة المستمدّة من حرارة اللحظة الشعريّة ومن حرارة الإشراق الصوفيّ في الكتابة الشعريّة ومن حرارة التفاعل الخلاّق مع الموضوعة الشعريّة. ونستطيع تلمّس هذه الحرارة وتحسّسها من خلال التوتّر الشعريّ في نصوصه، ومن خلال موسيقى لغته الشعريّة الأخّاذة. باختصار، تجربة درويش تنتمي إلى فضاء الشعر من حيث حرارتها وصدقها ولوعتها وموسيقى لغتها (ولا أقول لغتها)، ولا تنتمي إليه إلى حدّ ما من حيث طريقة تناولها للعديد من الموضوعات والقضايا، أي من حيث صياغة الصورة الشعريّة أو بناء اللغة الشعريّة الخلاّقة التي تسعى إلى خلق العلاقات الجديدة بين مفردات الجملة الواحدة، أو بين الجملة وقرينتها، أو بين الصور الشعريّة بشكل عام.
الشعر، ينتمي إلى فضاء المجهول، فضاء النرفانا، فضاء الاستمناء الروحيّ، فضاء الحكمة الصوفيّة... لذا فإن الجانب الأكبر من النصّ الشعريّ يبرز في التحليق في فضاء الميتافيزيقيا، وليس في الانغماس بالتفاصيل اليوميّة بالطريقة المعتادة أو المألوفة، والجانب الأكبر منه أيضاً يجب أن يكون ملغزاً وسرّانياً ومحمّلاً بالأسئلة الوجوديّة والحياتيّة بطريقة غير مباشرة، ومنطلقاً من جوّانيّة الإشكاليّة المتناولة، وليس من برّانيتها، وقائماً على مفهوم الانزياح النابع من الخيال الجامح دائماً وأبداً. من هذا المنطلق أرى بأن أي منجز شعريّ يبتعد عن هذه الاشتراطات وهذه الأجواء يصبح مشكوكاً به، أو لنقل إنه يصلح أن يقال عنه إنه كلام جميل مموسق فقط وليس شعراً، وهذا ما ينطبق على أكثر من نصف تجربة محمود درويش الشعريّة تقريباً!
***
في كلّ جديد لمحمود درويش أكتشف لوناً جديداً، وأتذوّق نكهة جديدة يتجاوز بها الشاعر قديمه. فتجربته سلسلة من الارتقاءات المستمرّة التي لا تستكين إلى وهج عابر، ولا تقنع بانتصارات راهنة، بل تستشرف الأبعد وتنظر إلى أفق الشعر بعينين حالمتين. يحتفظ درويش بقدرته وبراعته على اقتناص اللحظات الشعريّة من خلال لغة صافية ترتقي بالشعر في وصفها الحامل الأكبر له، واللغة هنا بعلاقتها الجديدة مع النغم أو الموسيقى التي يراد من قصيدة التفعيلة الالتزام بضوابطها، تنتقل من وظيفة توليد نسق موسيقيّ معيّن محكوم بعدد من التفعيلات المتكرّرة إلى فضاء أوسع تبدو فيه الجملة الشعريّة أبعد ما تكون عن ثقل الوزن رغم انتمائها الصريح إلى حقل التفعيلة، وهذا السرّ لا يمتلكه سوى شاعر يحلّق فوق لغته وليس العكس، فالكثير من شعراء قصيدة التفعيلة يأتمرون بأمر التفعيلات والقوافي التي تلوي أعناق أفكارهم وتحيلهم على جمل هشّة لا تريدها القصيدة، بينما نجد في حالة محمود درويش ارتفاعاً وعلواً عن مستوى التفعيلة الخليليّة ذات الوقع النافر، ويصل الأمر أحياناً أن القارئ يشكّ بانتماء قصائد المجموعة إلى حقل التفعيلة والوزن، وهذه مهارة تحسب للشاعر، كما حدث مع مجموعته ما قبل الأخيرة "كزهر اللوز أو أبعد" التي أودّ تناولها كمثال على ما أقول. ففي هذه المجموعة يبدو أن ثمة مسعى للانخراط في التفاصيل؛ في الهوامش واليوميات البسيطة مع ابتعاد عن الشموليّة وعن العموميات، وهذا في حدّ ذاته عامل أساس في التخفيف من حدّة الإيقاع وتحويل النسق الإيقاعي برمّته عن الوظيفة السمعيّة المعتادة إلى حقل أكثر اتساعاً تتمدّد فيه الموسيقى على مساحة أكبر من القول الشعريّ. وبعبارة أخرى إن انشغال القصيدة بالتفاصيل والهوامش يقلّل من دور التفعيلة في وسم القصيدة بطابعها الطاغي عادة: "فالتمسْ عذراً لمن تركتكَ في المقهى/ لأنك لم تلاحظ قَصّة الشَّعر الجديدةَ/ والفراشات التي رقصتْ على غمازتيها". المرأة الحبيبة تترك الشاعر في المقهى لأنه لم ينتبه لقصة الشعر. مشهد حياتي بسيط يتكرّر في الكثير الكثير من الأمكنة، ولا يحتاج إلى زخم وزني وإيقاعي لإقناعنا بشعريّة الحالة، ويتخذ الوصف خير حامل لميل القصيدة نحو تفعيلة على هيئة النثر. فهي كالنثر في التقاطها للحظات الحياتيّة الهاربة وفي سعيها لإبراز التفاصيل مهما صغرت، وهي تفعيليّة إذا ما قطّعناها سماعيّاً، أو إذا ما قرأناها بعين الوازن، وبين هذا وذاك تتولّد الحيرة التي ينسج منها درويش خصوصيّته، مبتعداً عن التداخل مع أصوات الآخرين: "صُحُفٌ مُبعثرةٌ. ووردُ المزهريّةِ لا يُذكّرني/ بمن قطفه لي. فاليوم عطلتنا عن الذكرى،/ وعطلة كل شيء... إنه يوم الأحدْ/ يوم نرتّب فيه مطبخنا وغرفة نومنا/ كلٌّ على حدةٍ. ونسمع نشرة الأخبار/ هادئةً، فلا حربٌ تُشَنُّ على بلدْ". فهذا المقطع يعجّ باليوميات البسيطة التي تؤلّف في ما بينها نسقاً يوازي التفعيلة التي بُنيت عليها القصيدة، نسقاً يتألف من تتالي أشياء يوميّة مألوفة ومُشاهدة ومحسوسة، لكنها غائبة عن الشعر، أو أن الشعر متعالٍ عليها. يوقظ محمود درويش أشياء المكان المُعاش بشيء من سحر الخيال الشعريّ الذي يُضفي بلمسته كينونة أخرى تحوّل الهوامش إلى طيوف تُحرّك روح القصيدة كلّ حين.
ثمة نقطة أخرى تبرّر الشعور بانزياح هذه المجموعة إلى شكل من أشكال الكتابة النثريّة، ألا وهو السرد الشعري المنتظم المتتابع بهدوئه الذي يحيله على صفة النثر، ويبعده أكثر فأكثر عن صخب التفعيلة ورقصها المحموم ومفرداتها المتوترة، والتوتر بالذات صفة ملازمة لنتوء الإيقاع، وهو ما يُجزّء القصيدة إلى وحدات تابعة للإيقاع وخاضعة له، الأمر الذي تتجنّبه قصائد محمود درويش في "كزهر اللوز..."، فالمفردات ينبعث منها هدوء غريب، هدوء الجنازات والذكريات، هدوء السنوات الستّين التي تحيل الشاعر على مخرج سينمائيّ يُقطّع شريط حياته بهدوء مريب: "فلتحتفلْ مع أصدقائكَ بانكسار الكأسِ./ في الستّين لن تجد الغد الباقي/ لتحمله على كَتِفِ النشيدِ... ويحملكْ/ قل للحياة، كما يليق بشاعر متمرّسٍ:/ سيري ببطء كالإناث الواثقاتِ بسحرهنّ/ وكيدهنَّ. لكلّ واحدة نداءٌ ما خَفيٌّ:/ هَيْتَ لكْ/ ما أجملكْ".
الاستطراد الذي هو من سمات النثر يكاد يطبع المجموعة بطابعه على حساب التكثيف والاختزال الذي هو من سمات الشعر الأساسيّة، وليس من السهل أن يجمع شاعر بين ما يبدو أنهما طرفا نقيض: الشعر والنثر. إلا أن من يخرج بالتفعيلة على حدودها ومداراتها المُتصوّرة إلى أمداء لم تطلها مجازاتها وإيقاعاتها من قبل، كما فعل محمود درويش في رائعته "جداريّة"، ليس صعباً عليه أن يُقلّم أظافر تفعيلته ويغيّر من سلوكها ويوجّهها وجهة النثر في هدوئه وتأمّلاته ومساحة الرؤيا الثاقبة لأدواته التي تنشغل باللقطة وباللحظة الهاربة أكثر من انشغالها بزخرف أو بصوتيّة أو نغمة ما تنفلت معها ما جاءت لتلتقطه ولتحيط به: "فقلتُ: نزور فتات الحياة، الحياة/ كما هي، ولنتدرَّبْ على حبّ أشياء/ كانت لنا، وعلى حبّ أشياء ليست/ لنا... ولنا إن نظرنا إليها معاً من/ علٍ كسقوط الثلوج على جبلٍ/ قد تكون الجبال على حالها/ والحقول على حالها/ والحياة بديهيّة ومشاعاً/ فهل ندخل الآن أرض الحكاية يا صاحبي؟".
إن ما يعني النثر هو بالضبط ما قاله درويش في هذا المقطع: فتات الحياة، الأشياء التي كانت وانسربت من بين أصابع أيامنا دون أن نلتفت لها، الأمر الذي أجادت مجموعة "كزهر اللوز أو أبعد" التقاطه بمهارة وبشاعريّة عالية لم تُشعرنا بدكتاتوريّة الإيقاع فيها، بل تركتنا نحلم مع أشيائها المهدورة التي التقطتها يد الذكرى وفردتها أمامنا على بساط القصيدة.
بقي أن أذكر في هذه العجالة أن تأثير محمود درويش طاول الجيل التسعيني الشعري السوري الذي جاءت كتابات شعرائه بعد انحسار تجربة الجيل السبعيني (جيل المنابر الإيديولوجيّة) وبعد ضمور ملامح الترقي الشعري لجيل الثمانينيات الذي راوح غالبية شعرائه في أسلوب أحادي لم يتجاوزه إلا في ما ندر. أيضاً، امتدّ التأثير الدرويشيّ ليشمل الكثير من قصائد النثر التسعينيّة، لا سيما أن إصدارات درويش الأخيرة يخفّ فيها الإيقاع بشكل ملحوظ، حتى ليكاد يشكّ القارئ أنه أمام شعر منثور.
***
في البداية كان كلّ شيء مختلطاً في بعضه: العطور والزهور والصباح والأنين... كانت الذاكرة بعضاً من أغاني فيروز، دقّات قلب تشبه الأفلام العربية القديمة، حبّاً للكلاسكيّات، وكلاماً يشبه الوطن. عندما بدأت قراءة محمود درويش في الصغر كانت الكتابة حلماً تظهر ضحكاته من بين طيّات الكتب. تظهر، فقط، من ملامح محمود درويش وحضوره وصوته.
وقتها كان أبي يناديني كلما ظهر هذا الشاعر على إحدى الفضائيّات، لأنه يعرف كم كنت أحبّ الاستماع إليه. كان ظهور محمود درويش احتفالاً خاصّاً أقيمه لنفسي، عرساً صغيراً أرتّب فيه الأماني. ويأتي درويش: "كان رساماً/ ولكنّ الصور/ عادة/ لا تفتح الأبواب/ لا تكسرها.../ لا تردّ الحوت عن وجه القمر" ("عازف الجيتار المتجوّل").
علّمني محمود درويش أن سندريلا لها الحقّ في أن تنتظر فارساً آخر هو الشعر، فارساً قد لا يجيء أبداً.
***
تعرّفت إلى محمود درويش وأنا لا أزال حدثاً بعدُ، فأن تكون فلسطينيّاً ولا تعرف محمود درويش معناه أنك لا تعرف شيئاً عن أرضك. فجأةً، أصبح محمود درويش أكثر من مجرّد شاعرٍ عندي، أصبح صديقاً، ورفيقاً، بل حتى رجلاً ينطق بالمقدّس. ولأنني من عائلة لادينيّة، أو علمانيّة كما يحلو للبعض تسميتها، وجدت فيه بديلي عن الكتب المقدّسة.
كنت أجلس بين يديه باستمتاع، أقرأه لأحد الأصدقاء، وإذا حدث وأغرمت بفتاة، أمطرتها بشعره. وإن كتبت شيئاً أدغمت شعراً له بين حناياه. كلّ مرحلة من حياتي تركتُ محمود درويش يعبث بها. كنت أؤمن بأن الفلسطينيين يملكون ثلاثيّاً كذاك الذي ملكه الأمويّون (الأخطل وجرير والفرزدق): محمود درويش وناجي العلي وغسان كنفاني. ولأن العلي وكنفاني كانا قد استشهدا قبل مرحلة وعيي، كان محمود درويش هو صلتي الوحيدة بذلك الحلم المستحيل.
لكن هذه العلاقة بدأت تتغيّر عندما شاهدته في معرض الكتاب ببيروت للمرّة الأولى. كان نجماً بكلّ ما للكلمة من معنى. يوقّع كتابه الجديد للمعجبات، ويكتب الجملة نفسها للجميع... صارت علاقتي به تتباعد كلما شاهدته في معرض للكتاب أو على شاشة إحدى الفضائيات. أحسست أن ثمة فرقاً كبيراً بين شعره وشخصه. باختصار، وعلى رأي واصل بن عطاء زعيم المعتزلة، حينما ودّع شيخه: "هذا فراق بيننا"، قالها ختاماً. وأنا كذلك قلتها له، لربما ليس في وجهه، لربما حتّى هو لن يعرف بها. لكن أنا - على الأقل - أعرف.
***
يعدّ محمود درويش من الشعراء العرب القلائل الذين لا يقفون عند حدّ ما، ولا يركنون لأسلوب شعري معين، أو شكل شعري ما. وأكثر ما عُرف عن قصيدة درويش هو نزوعها الدائم والمستمرّ نحو كسر الثابت والسكون الشعريين، والبحث الدائم والمستمرّ عن لغة شعريّة جديدة، وعن أرض بكر لم يطأها أحد بعد، أرض لا يكاد الشاعر يقف عليها حتى يهجرها نحو أخرى أكثر إغواء وأكثر احتفالاً بالشعر، دون أن يمنعه ذلك من العودة إلى الأرض المهجورة وقت يشاء. فالقصيدة عنده لا تركن لأسلوب شعري معيّن، إلا لتستند إليه من أجل تجاوزه إلى آخر قد يكون مكملاً له، وقد يتجاوزه وقد يتضاد معه، مولداً من صراع الأضداد لغة شعرية جديدة، فاتحاً بذلك أفق القصيدة نحو المزيد من التجريب والمغامرة والرحيل إلى حافّة الهاوية. وكأن درويش قد اتخذ من التجريب والتخريب والمغامرة عنواناً لتجربته الشعرية، وهذا العنوان بدوره لا يكون عنواناً مغلقاً مقدّساً، محدداً للقصيدة، بقدر ما يكون عنواناً مدنساً، قابلاً للتجاوز في أي لحظة، وفق ما ترتأيه رؤى الشاعر الحالمة والمنفلتة من عقال الواقع، جانحة باتجاه المطلق المستحيل.
درويش، الشاعر الذي ارتبط اسمه منذ البدايات باسم القضية الفلسطينيّة، أدرك أن القضية وحدها لا تصنع شاعراً، لذلك بدأ رحلته الكبرى نحو التحرّر من الحدث الفلسطيني وطغيانه على القصيدة، والتقليل من سيطرة التفاصيل الصغيرة واليومية الراهنة التي ترهق الشعر على حدّ تعبير الشاعر نفسه. أي أن الشاعر يجاهد ويعارك من أجل الربط بين الشعر والكلّيّات بعيداً عن ثرثرة الواقع ومهازله. لذلك بدأ الحدث اليومي والموضوعي الفلسطيني يخفت تدريجاً إلى أن كاد يختفي تماماً في دواوينه الأخيرة - باستثناء "حالة حصار" الذي كتبه تحت تأثير ظرف صعب - رغم أننا بالتدقيق بين السطور وما وراء الكلام سنعثر على ما يحيل على الحدث والمكان الفلسطينيين، فالحب في "سرير الغريبة" حبّ مأزوم لا أرض يقف عليها ولا فضاء يركن إليه. ونلاحظ تكرار كلمة المنفى ضمن قصيدة الحبّ وهو ما يحيل بدوره على المنفى الذي أضحى بديلاً للوطن الفلسطيني ولو إلى حين. يمكن القول بطريقة أخرى إن الشاعر استطاع بعد تجربته الطويلة أن "يروّض" الحدث الفلسطيني لمصلحة القصيدة، بعدما كانت الغلبة للحدث الفلسطيني على حساب القصيدة، وذلك دون أن يخسر جمهوره الشعري الذي كان البعض يقول إنه جمهور قضية لا جمهور شعر، الأمر الذي جعل من درويش واحداً من الشعراء الذين استطاعوا أن يحفظوا هيبة الشعر في زمن يعلن موت الشعر بلا حياء، ويتاجر بأرواح الشعراء وهم أحياء!
ولم يتمكن درويش من الحفاظ على جمهوره من فراغ محضّ، أو قضية اتكأ عليها كما يعلن مروّجو موت الشعر والقضايا على السواء، بل بسبب موقف فكري مضادّ للحداثة المتغرّبة التي ترى أن الشعر والجمهور قطبان متنافران، بينما هما متآلفان دون أن يتبع أحدهما الآخر، وهذا يعكس رؤية درويش التي ترى في الحداثة بعداً إنسانياً قبل أن ترى بعدها المعرفي، أي معرفة تستدلّ برائحة الإنسان، لا معرفة تستدلّ برائحة ذاتها، ولذاتها فقط.
وما يميز درويش عن غيره هو عدم القدرة على التكهّن المسبق بقصيدته، لأن هذا الشاعر يدرك جيداً أن القصيدة هي قصيدة اللامتوقع، أي التي تقدّم إلى القارئ ما لا يتوقعه ويريده في الوقت نفسه، دون أن يدري أنه كان يريده بالفعل. فقد كان من المتوقع لنا دائماً، أن يكتب درويش قصيدة عن فلسطين، ولما صار هذا متوقعاً دائماً لنا عمل على نفي هذا التوقّع من خلال دواوينه الصادرة منذ "أحد عشر كوكباً" حتى "سرير الغريبة"، وعندما صار المتوقع السابق لا متوقعاً الآن عاد ليقدّمه لنا في "حالة حصار" وبجمالية مدهشة غالباً وبسردية واقعية قليلاً تبتعد عمّا ألفناه، إلى أن يعود وينسف توقّعنا مرّة أخرى. ولأن درويش كذلك، لم نستطع نحن الشباب أن ننجو من إغواء قصيدته بسهولة، تلك القصيدة التي أسرتنا وجذبتنا إلى عالمها، فأوّل اتهام يوجّه إلى قصيدتنا في البدايات، وقصيدة أي شاعر شاب، أنها ذات معالم درويشيّة، الأمر الذي جعلنا أمام تحدّ كبير، وهو أن نقتل هذا الأب الذي لكثرة ما أحببناه حاولنا تقليده، فخسر الشعر ولم يربح الشعراء، لذلك لا بدّ من قتل آبائنا لنحيا! وقتلهم لا يكون إلا بتجاوزهم إبداعيّاً ومحاورتهم شعريّاً ونقديّاً، خصوصاً من خلال النقد الذي ضيّع أدواته وأجّر ضميره لمصلحة مافيا الشعر والعلاقات الشخصية، الأمر الذي أضرّ بالشعراء الكبار والشباب الباحثين عمّن يساعدهم على تلمّس الأخطاء في تجارب شعرائنا الكبار، كي نتمكن من تجاوزهم وفتح آفاق جديدة للقصيدة العربية، وهذا ما تسعى إليه مجلة "نقد" التي نتمنى أن تنقذنا من ركاكة النقد السائد، لمصلحة نقد جديد قوامه الحرية والإبداع وهتك المقدّسات!
***
بدأت علاقتي بشعر محمود درويش باكراً جداً، في سنّ العاشرة. كان درويش كمن يعلّم طفلاً صغيراً الحبو والكلام. لم يكن شعره بالنسبة إليّ مجرّد نصّ جميل، وفكرة غير مطروقة، وموهبة فذّة وأسلوب آسر، وإنما ثقافة قائمة بذاتها تحرّضني على البحث والتجريب. رمزيّته علّمتني كيف يمكن تحويل التاريخ، إحدى أدواته للتعبير عن الحاضر، جسراً بين الأمس واليوم.
وكان عام 1998 عام ولادة جديدة لدرويش، حيث خضع لجراحة خطيرة في القلب، أوصلته إلى حدود الموت وأعادته. الموت الكثير الذي حفل به شعره، هو نفسه الذي جعله يحفل بالأمل والحياة من جديد... صار مربّياً للأمل.
من حسن حظّي أني شهدت ولادته الثانية - بالرغم من ولاداته الكثيرة والمتعدّدة - التي دفعته إلى البحث عن صوت الإنسان، الإنسان المشاع، بكلّ ما تحمله الكلمة من معانٍ متجرّدة لا تختزن سوى أسمى الدلالات الإنسانيّة. صار يحتفل أقصى ما استطاع بالحياة، فلم يعد الموت يعني له شيئاً: "الموت لا يعني لنا شيئاً يكون فلا نكون". تجربة امتزجت فيها الموهبة الفذّة، بالجرح، وبالحمض النووي للإنسان، لتكوّن شاعراً استثنائيّاً، هو محمود درويش. الآن، أحاول جاهدة أن أختار من شعره الأقرب إلى قلبي، لكن رأسي يضجّ بالسطور... أجل، أجل، تذكّرت: "على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة".
منتخبات
منتخب "أوراق الزيتون" 1964
الموعد الأوّل
شدّت على يدي
ووشوشتني كلمتين
أعزّ ما ملكته طوال يوم:
"سنلتقي غداً"
ولفّها الطريق.
حلقت ذقني مرّتين!
مسحت نعلي مرّتين
أخذت ثوب صاحبي... وليرتين...
لأشتري حلوى لها، وقهوة مع الحليب!
وحدي على المقعد
والعاشقون يبسمون...
وخافقي يقول:
ونحن سوف نبتسم!
لعلّها قادمة على الطريق...
لعلّها سهت
لعلّها... لعلّها
ولم تزل دقيقتان!
النصف بعد الرابعهْ
النصف مرّ
وساعة... وساعتان
وامتدّت الظلال
ولم تجئ من وعدت
في النصف بعد الرابعهْ.
*****
منتخب "عاشق من فلسطين" 1966
إلى أمّي
أحنّ إلى خبز أمّي
وقهوة أمّي
ولمسة أمّي...
وتكبر فيّ الطفولةُ
يوماً على صدر يومِ
وأعشق عمري لأني
إذا متّ،
أخجل من دمع أمّي!
خذيني، إذا عدتُ يوماً
وشاحاً لهدبكْ
وغطّي عظامي بعشب
تعمّد من طهر كعبكْ
وشُدّي وثاقي...
بخصلة شَعر...
بخيط يلوّح في ذيل ثوبك...
عساني أصيرُ إلهاً
إلهاً أصير...
إذا ما لمست قرارة قلبكْ!
ضعيني، إذا ما رجعتُ
وقوداً بتنّور ناركْ...
وحبل غسيل على سطح داركْ
لأني فقدت الوقوفَ
بدون صلاة نهاركْ
هرمت، فردّي نجوم الطفولة
حتى أُشاركْ
صغار العصافيرِ
درب الرجوع...
لعشّ انتظاركْ!
***
منتخب "آخر الليل" 1967
ريتّا والبندقية
بين ريتّا وعيوني... بندقيّهْ
والذي يعرف ريتّا، ينحني
ويصلّي
لإله في العيون العسليّهْ!
... وأنا قبّلت ريتّا
عندما كانت صغيرهْ
وأنا أذكر كيف التصقتْ
بي، وغطّت ساعدي أحلى ضفيرهْ
وأنا أذكر ريتّا
مثلما يذكر عصفور غديرهْ
آه... ريتّا
بيننا مليون عصفور وصورهْ
ومواعيدُ كثيرهْ
أطلقت ناراً عليها... بندقيّهْ
إسم ريتّا كان عيداً في فمي
جسم ريتّا كان عرساً في دمي
وأنا ضعت بريتّا... سنتين
وهي نامت فوق زندي سنتين
وتعاهدنا على أجمل كأس، واحترقنا
في نبيذ الشفتين
وولدنا مرّتين!
آه... ريتّا
أيّ شيء ردّ عن عينيك عينيَّ
سوى إغفاءتين
وغيوم عسليّهْ
قبل هذي البندقيّهْ!
كان يا ما كان
يا صمت العشيّهْ
قمري هاجر في الصبح بعيداً
في العيون العسليّهْ
والمدينة
كنست كلّ المغنين، وريتّا
بين ريتّا وعيوني... بندقيّهْ
****
منتخب "العصافير تموت في الجليل" 1969
ضباب على المرآة
نعرف الآن جميع الأمكنهْ
نقتفي آثار موتانا
ولا نسمعهم.
ونزيح الأزمنة
عن سرير الليلة الأولى، وآه...
في حصار الدم والشمسِ
يصير الانتظارْ
لغة مهزومةً...
أمّي تناديني، ولا أبصرها تحت الغبار
ويموت الماءُ في الغيم، وآه...
كنت في المستقبل الضاحكِ
جنديّين،
صرتُ الآن في الماضي وحيدْ.
كلّ موت فيه وجهي
معطف فوق شهيدْ
وغطاءٌ للتوابيت، وآه...
لست جندياً
كما يُطلب مني،
فسلاحي كلمهْ
والتي تطلبها نفسي
أعارت نفسها للملحمهْ
والحروب انتشرت كالرمل والشمس، وآه...
بيتكِ اليومَ له عشر نوافذْ
وأنا أبحث عن باب
ولا باب لبيتك
والرياح ازدحمت مثل الصداقات التي
تكثر في موسم موتك
وأنا أبحث عن باب، وآه...
(...)
***
منتخب "حبيبتي تنهض من نومها" 1970
يوميّات جرح فلسطيني
(إلى فدوى طوقان)
نحن في حلٍّ من التذكار
فالكرمل فينا
وعلى أهدابنا عشب الجليلِ
لا تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليها،
لا تقولي!
نحن في لحم بلادي... وهي فينا!
(...)
صوتك الليلة،
سكينٌ وجرح وضمادُ
ونعاس جاء من صمت الضحايا
أين أهلي؟
خرجوا من خيمة المنفى، وعادوا
مرّة أخرى سبايا!
(...)
منزل الأحباب مهجور،
ويافا تُرجمت حتى النخاع
والتي تبحث عني
لم تجد مني سوى جبهتها
أتركي لي كلّ هذا الموت، يا أخت.
أتركي هذا الضياع
فأنا أضفره نجماً على نكبتها
آه يا جرحي المكابرْ
وطني ليس حقيبهْ
وأنا لست مسافرْ
إنني العاشق، والأرض حبيبهْ!
(...)
آن لي أن أبدل اللفظة بالفعل، وآنْ
ليَ أن أثبت حبّي للثرى والقبّرهْ
فالعصا تفترس القيثار في هذا الزمانْ
وأنا أصفرُّ في المرآة،
مذ لاحت ورائي شجرهْ!
***
منتخب "أحبّك أو لا أحبّك" 1972
مزامير
تركتُ وجهي على منديل أمّي
وحملت الجبال في ذاكرتي
ورحلت...
كانت المدينة تكسر أبوابها
وتتكاثر فوق سطوح السفن
كما تتكاثر الخضرة في البساتين التي تبتعد...
إنني أتّكىء على الريح
يا أيتها القامة التي لا تنكسر
لماذا أترنّح؟... وأنت جداري
وتصقلني المسافة
كما يصقل الموتُ الطازج وجوهَ العشّاق
وكلّما ازددتُ اقتراباً من المزامير
ازددتُ نحولاً...
يا أيتها الممرّات المحتشدة بالفراغ
متى أصل؟...
طوبى لمن يلتفّ بجلده!
طوبى لمن يتذكّر اسمه الأصلي بلا أخطاء!
طوبى لمن يأكل تفاحة ولا يصبح شجرة.
طوبى لمن يشرب من مياه الأنهار البعيدة
ولا يصبح غيماً!
طوبى للصخرة التي تعشق عبوديتها
ولا تختار حرية الريح!
(...)
أنا لست منكمشاً إلى هذا الحدّ
ولكن الأشجار هي العالية.
سيّداتي، آنساتي، سادتي
أنا أحبّ العصافير
وأعرف الشجر
أنا أعرف المفاجأة
لأني لم أعرف الأكذوبة.
أنا ساطع كالحقيقة والخنجر
ولهذا أسألكم:
أطلقوا النار على العصافير
لكي أصف الشجر.
أوقفوا النيل
لكي أصف القاهرة.
أوقفوا دجلة أو الفرات أو كليهما
لكي أصف بغداد.
أوقفوا بردى
لكي أصف دمشق!
وأوقفوني عن الكلام
لكي أصف نفسي...
(...)
***
منتخب "محاولة رقم 7" 1973
عودة الأسير
النيلُ ينسى
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلوا
هناك حمامتان بعيدتان
ورحلة أخرى
وموتٌ يشتهي الأسرى
وذاكرتي قويّهْ.
والآن، ألفظ قبل روحي
كلّ أرقام النخيل
وكلّ أسماء الشوارع والأزقّة سابقاً أو لاحقاً
وجميع من ماتوا بداء الحب والبلهارسيا والبندقيّهْ
ما دلني أحد عليكِ
وأنت مصرْ
قد عانقتني نخلةٌ
فتزوّجتني
شكّلتني
أنجبتني الحبّ والوطن المعذّب والهويّهْ.
ما دلّني أحد عليكِ
وجدت مقبرةً... فنمتُ
سمعت أصواتاً... فقمتُ
ورأيت حرباً... فاندفعتُ
وما عرفت الأبجديّهْ.
قالوا: اعترفْ
قلت: اعترفتْ
يا مصر! لا كسرى سباكِ ولا الفراعنةُ
اصطفوك أميرةً أو سيّدهْ!
قالوا: اعترف
قلت: اعترفت
وتوازت الكلماتُ والعضلاتُ
كانوا يقلعون أظافري
ويقشّرون أناملي
ويبعثرون مفاصلي
ويفتّشون اللحم عن أسرار مصرْ...
وتدفّقت مصر البعيدة من جراحي
فاقتربتْ
ورأيتُ مصر
وعرفتُ مصر
ما دلّني أحد، خناجرهم تفتّشني فيخرج شكلُ مصر.
يا مصر! لست خريطةً
قالوا: اعترف
قلت: اعترفت
واصلتُ يا مصر اعترافاتي
دمي غطّى وجوه الفاتحينَ
ولم يغطِّ دمي جبينكِ، واعترفتُ
وحائط الإعدام يحملني إليك إليكِ...
أنت الآن تقتربين. أنت الآن تعترفينَ
فامتشقي دمي!
والنيل ينسى
ليس من عاداته أن يرجع الغرقى
وآلاف العرائس من تقاضى أجرها؟
النيل ينسى.
والقرى رفعت مآذنها وشكواها
وأخفت صدرها في الطين...
(...)
***
منتخب "تلك صورتها وهذا انتحار العاشق" 1975
وأريد أن أتقمّص الأشجارَ:
قد كذب المساء عليه أشهد أنني غطّيته بالصمتِ
قرب البحرِ
أشهد أنني ودّعته بين الندى والانتحار.
وأريد أن أتقمّص الأسوارَ:
قد كذب النخيلُ عليه. أشهد أنه وجد الرصاصةَ.
أنه أخفى الرصاصة
أنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار.
وأريد أن أتقمّص الحرّاسَ:
قد كذب الزمان عليه. أشهد أنه ضدّ البدايةِ
أنه ضدّ النهايةِ
كانت الزنزانة الأولى صباحاً
كانت الزنزانة الأخرى مساءً
كان بينهما نهارْ.
وكأنه انتحر
السماءُ قريبة من ساقه
والنحل يمشي في الدم المتقدّمِ
الأمواجُ تمشي في الصدى
وكأنه انتحر
العصافير استراحت في المدى
وكأنه انتحرَ
احتجاجاً
أو وداعاً
أو سدى.
(...)
حين انحنتْ في الريحِ
قال: تكون قنطرةً وأعبرها إليها
وبنى أصابعه من الخشب المخبّأ في يديها.
البندقية والفضاء وآخر القتلى. سأدفن جثّتي في راحتيها.
وستضرمين النار.
قالت: أين كنتَ
ففرّ من يدها إلى اليوم المرابط خلف قامتها.
وغنّى: أيها الندم اختصرني بندقيّهْ
قالت: لتقتلني؟
فقال: لكي أعيد لي الهويّهْ
وقفت، كعادتها، فعاد من انحناءتها إلى قدميهِ
كان طريقه طرقاً وكان نزيفُه أفقاً
وكان يدور في الماضي ولا يجد اليدين وكان يحلم باكتمال الحلمِ
ما بيني وبين اسمي بلادٌ.
حين سمّيت البلاد فقدت أسمائي. وحين مررتُ باسمي
لم أجد شكل البلاد.
الحلم جاء الحلم جاء وكان يسأله:
منِ الأصلُ العيون أم البلاد؟
قال المغني للضفاف:
الفرق بين الضفّتين قصيدتي.
(...)
****
منتخب "أعراس" 1977
كان ما سوف يكون
(إلى راشد حسين)
في الشارع الخامس حيّاني. بكى. مال على السور
الزجاجي، ولا صفصاف في نيويورك.
أبكاني. أعاد الماءَ للنهر. شربنا قهوة. ثم افترقنا في
الثواني.
منذ عشرين سنهْ
وأنا أعرفه في الأربعينْ
وطويلاً كنشيد ساحليّ، وحزينْ
كان يأتينا كسيف من نبيذ. كان يمضي كنهايات
صلاهْ
كان يرمي شعره في مطعم "خريستو"
وعكّا كلّها تصحو من النومِ
وتمشي في المياه
كان أسبوعاً من الأرض، ويوماً للغزاهْ
ولأمّي أن تقول الآن: آه!
ليديه الوردُ والقيد. ولم يجرحه خلف السور إلاّ
جرحُه السيّدُ. عشاق يجيئون ويرمون المواعيدَ.
رفعنا الساحل الممتدَّ. دشّنا العناقيد. اختلطنا في
صراخ الفيجن البريّ. كسرنا الأناشيد. انكسرنا
في العيون السود. قاتلنا. قُتلنا. ثم قاتلنا. وفرسان
يجيئون ويمضونَ.
وفي كلّ فراغْ
سنرى صمت المغنّي أزرقاً حتى الغيابْ
منذ عشرين سنهْ
وهو يرمي لحمه للطير والأسماك في كلّ اتجاه
ولأمّي أن تقول الآن: آه!
إبن فلاحَيْن من ضلع فلسطينَ
جنوبيٌّ
شقيّ مثل دوريٍّ
قويّ
فاتح الصوتِ
كبير القدمين
واسع الكفّ. فقير كفراشهْ
أسمرٌ حتى التداعي
وعريض المنكبين
ويرى أبعدَ من بوّابة السجن
يرى أقرب من أطروحة الفنّ
يرى الغيمة في خوذة جنديّ
يرانا، ويرى كرت الإعاشهْ
وبسيط... في المقاهي واللغهْ
ويحبّ الناي والبيرة
لم يأخذ من الألفاظ إلا أبسط الألفاظ
سهلاً كان كالماء.
بسيطاً... كعشاء الفقراء.
كان حقلاً من بطاطا وذرهْ
لا يحبّ المدرسهْ
ويحبّ النثر والشعر
لعلّ السهل نثرٌ
ولعلّ القمح شعرٌ.
ويزور الأهل يوم السبتِ
يرتاح من الحبر الإلهي
ومن أسئلة البوليسِ.
لم ينشر سوى جزئين من أشعاره الأولى
وأعطانا البقيّهْ
شوهدت خطوتُه فوق مطار اللد من عشر سنين
واختفى...
كان ما سوف يكونُ
فضحتني السنبلهْ
ثم أهدتني السنونو
لعيون القتلهْ
(...)
****
منتخب "مديح الظلّ العالي" 1983
(...)
بيروت - لا
ظهري أمام البحر أسوار و… لا
قد أخسر الدنيا… نعم!
قد أخسر الكلمات…
لكني أقول الآن: لا.
هي آخر الطلقات - لا.
هي ما تبقّى من هواء الأرض - لا.
هي ما تبقّى من نشيج الروح - لا.
بيروت - لا.
نامي قليلاً، يا ابنتي، نامي قليلا
الطائرات تعضّني. وتعضّ ما في القلب من عسلٍ
فنامي في طريق النحل، نامي
قبل أن أصحو قتيلا.
الطائرات تطير من غرف مجاورة إلى الحمّام، فاضطجعي
على درجات هذا السلّم الحجري، وانتبهي إذا اقتربتْ
شظاياها كثيراً منك وارتجفي قليلا.
نامي قليلا.
كنّا نحبّك، يا ابنتي،
كنا نعدّ على أصابع كفّك اليسرى مسيرتنا
ونُنقصها رحيلا.
نامي قليلا.
الطائرات تطير، والأشجار تهوي،
والمباني تخبز السكانَ، فاختبئي بأغنيتي الأخيرة، أو بطلقتيَ
الأخيرة، يا ابنتي
وتوسّديني كنت فحماً أم نخيلا.
نامي قليلا.
وتفقّدي أزهار جسمكِ،
هل أصيبتْ؟
واتركي كفّي، وكأسَيْ شاينا، ودعي الغسيلا.
نامي قليلا.
لو أستطيع أعدتُ ترتيب الطبيعة:
ههنا صفصافة... وهناك قلبي
ههنا قمر التردّد
ههنا عصفورة للإنتباهِ
هناك نافذة تعلّمك الهديلَ
وشارعٌ يرجوك أن تبقي قليلا.
نامي قليلا.
كنّا نحبّك، يا ابنتي،
والآن، نعبد صمتكِ العالي
ونرفعه كنائس من بَتُولا.
هل كنتِ غاضبة علينا، دون أن ندري… وندري
آه منّا… آه ماذا لو خمشنا صُرّة الأفقِ.
قد يخمشُ الغرقى يداً تمتدُّ
كي تحمي من الغرقِ.
(…)
****
منتخب "حصار لمدائح البحر" 1984
أقبية، أندلسيّة، صحراء
(…)
إلى أين أذهب؟ في بادئ الأمر قلتُ: أعلّم حريتي المشيَ، مالت عليّ، استندتُ إليها، وأسندتها، فسقطنا على بائع البرتقال العجوز، وقمتُ، وكدّستُها فوق ظهري كما يحملون البلاد على الإبْل والشاحناتِ، وسرتُ. وفي ساحة البرتقال تعبتُ، فناديتُ: أيتها الشرطة العسكريةُ! لا أستطيع الذهاب إلى قرطبهْ.
وأحنيتُ ظهري على عَتَبهْ
وأنزلتُ حريتي مثل كيس من الفحم، ثم هربت إلى القبو؛
هل يشبه القبو أمّي وأمّك؟ صحراءُ صحراءُ
ما الساعة الآن؟
لا وقت للقبوِ
ما الساعة الآن؟
لا وقت…
في ساحة البرتقال تصدّقنا بائعاتُ السيوف القديمة، والذاهبون إلى يومهم يسمعون النشيد ولا يكذبون على الخبز، صحراءُ في القلب،
مزّق شرايينَ قلبي القديم بأغنية الغجر الذاهبين إلى الأندلسْ
وغنِّ افتراقي عن الرمل والشعراء القدامى، وعن شجر لم يكن امرأة
ولا تمتِ الآن، أرجوك! لا تنكسر كالمرايا، ولا تحتجب كالوطنْ
ولا تنتشرْ كالسطوح وكالأدويهْ
فقد يسرقونك مثلي شهيداً
وقد يعرفون العلاقة بين الحمامة والأقبيهْ
وقد يشعرون بأن الطيور امتداد الصباح على الأرض
والنهر دبّوس شعر لسيّدة تنتحرْ.
وانتظرني قليلاً قليلاً لأسمع صوتَ دمي
يقطع الشارع المنفجرْ
كنتُ أنجو
ولا تنتصرْ!
وسأمشي
إلى أين يا صاحبي؟
إلى حيث طار الحمام فصفّق قمحٌ
ليُسند هذا الفضاء بسنبلة تنتظرْ.
فلتواصل نشيدكَ باسمي
ولا تبكِ يا صاحبي وتراً ضاع في الأقبيهْ.
إنها أغنية
إنها أغنية!
****
منتخب "هي أغنية، هي أغنية" 1986
في آخر الأشياء
ثمرٌ على وشك السقوط عن الشجرْ
تلك النهاية والبداية أو كلام للسفرْ.
في آخر السرداب ينكسر الفضاء ويتّسع.
لا نستطيع البحث عن شيء وعن قولٍ يحرّر حائطاً
فينا. وتنفتح الشوارع كي نمرّ.
ظلان ينفصلان عنّا، ثم ينتشران ليلاً لا يُحَسّ ولا يُرى
من يستطيع الحبّ بعدكَ؟ من سيشفى من جراح الملح
بعدكَ؟ في زواج البحر والليل استدار القلب نحوك،
لم يجدنا، لم يجد حَجَلاً تزيّا بالحجرْ.
في آخر السرداب نبلغ حكمة القتلى، نُساوي
بين حاضرنا وماضينا لننجو من كوابيس الغدِ
أيامنا شجرٌ. وكم قمرٍ أرادكِ زوجةً للبحر،
كم ريحٍ أرادت أن تهبّ لتأخذيني من يدي.
أيامنا ورق على وشك السقوط مع المطرْ.
لم تبقَ للموتى سوى الحجج الأخيرةِ. لا مكان لنا هنا
لنطيل جلستنا أمام البحرِ. فلنفتحْ طريقاً للزهورْ
ولأرجُل الأطفالِ كي يتعلّموا المشي السريع إلى القبورْ.
كبرت تجاربنا وضاق كلامُنا
فلننطفئ
ولنختبئ
في سيرةِ الأسلاف والسفر المؤدّي للسفرْ.
(…)
****
منتخب "ورد أقلّ" 1986
أنا يوسف يا أبي
أنا يوسفٌ يا أبي. يا أبي إخوتي لا يحبّونني، لا يريدونني بينهم يا أبي. يعتدون عليّ ويرمونني بالحصى والكلامِ. يريدونني أن أموت لكي يمدحوني. وهم أوصدوا باب بيتك دوني. وهم طردوني من الحقل. همْ سمّموا عنبي يا أبي. وهم حطّموا لُعبي يا أبي. حين مرّ النسيم ولاعب شعريَ غاروا وثاروا عليّ وثاروا عليكَ، فماذا صنعتُ لهم يا أبي؟ الفراشاتُ حطّت على كتفيّ، ومالت عليّ السنابلُ، والطير حطّت على راحتيّ. فماذا فعلتُ أنا يا أبي، ولماذا أنا؟ أنت سمّيتني يوسفاً، وهمو أوقعونيَ في الجبّ، واتهموا الذئبَ؛ والذئبُ أرحم من إخوتي... أبتِ! هل جنيتُ على أحد عندما قلت إني: رأيتُ أحد عشر كوكباً، والشمس والقمر، رأيتُهم لي ساجدينْ.
****
منتخب "أرى ما أريد" 1990
(...)
… كانوا هناك يحاورون الموج كي يتشبّهوا بالعائدين من المعارك تحت قوس النصر. لم تذهب منافينا سدى أبداً، ولم نذهب إلى المنفى سدى. سيموت موتاهم بلا ندم على شيء. وللأحياء أن يَرِثوا هدوءَ الريح، أن يتعلّموا فتح النوافذ، أن يروا ما يصنع الماضي بحاضرهم، وأن يبكوا على مهلٍ على مهلٍ لئلا يسمع الأعداءُ ما فيهم من الخزف المكسّر. أيها الشهداء قد كنتم على حقّ، لأن البيت أجمل من طريق البيت، رغم خيانة الأزهار، لكنّ النوافذ لا تطلّ على سماء القلب... والمنفى هو المنفى هنا وهناك. لم نذهب إلى المنفى سدى أبداً، ولم تذهب منافينا سدىً
والأرضُ
تُورَثُ
كاللغهْ!
****
منتخب "أحد عشر كوكباً" 1992
شتاء ريتّا
ريتّا تّرتب ليل غرفتنا: قليلُ
هذا النبيذُ،
وهذه الأزهار أكبر من سريري
فافتحْ لها الشبّاك كي يتعطّر الليل الجميلُ
ضع، ههنا، قمراً على الكرسيّ. ضعْ
فوقَ، البحيرةَ حول منديلي ليرتفع النخيلُ
أعلى وأعلى،
هل لبستَ سواي؟ هل سكنتكَ إمرأةٌ
لتجهش كلّما التفّتْ على جذعي فروعكَ؟
حكّ لي قدمي، وحكّ دمي لنعرف ما
تخلّفه العواصف والسيولُ
مني ومنك...
تنام ريتّا في حديقة جسمها
توت السياج على أظافرها يضيء الملح في
جسدي. أحبّكِ. نام عصفوران تحت يديّ...
نامت موجة القمح النبيل على تنفّسها البطيء،
ووردة حمراء نامت في الممرّ،
ونام ليل لا يطولُ
والبحر نام أمام نافذتي على إيقاع ريتّا
يعلو ويهبط في أشعّة صدرها العاري، فنامي
بيني وبينك، لا تغطّي عَتْمة الذهب العميقة بيننا
نامي يداً حول الصدى،
ويداً تبعثر عزلة الغابات، نامي
بين القميص الفستقيّ ومقعد الليمون، نامي
فرساً على رايات ليلة عرسها...
هدأ الصهيلُ
هدأت خلايا النحل في دمنا، فهل كانت هنا
ريتّا، وهل كنا معا؟
... ريتّا سترحل بعد ساعات وتترك ظلّها
زنزانةً بيضاءَ. أين سنلتقي؟
سالت يديها، فالتفتّ إلى البعيد
البحر خلف الباب، والصحراء خلف البحر، قبّلني على
شفتيّ - قالت. قلتُ: يا ريتّا، أأرحل من جديد
ما دام لي عنب وذاكرة، وتتركني الفصولُ
بين الإشارة والعبارة هاجساً؟
ماذا تقولُ؟
لا شيء يا ريتّا، أقلّد فارساً في أغنيهْ
عن لعنة الحبّ المحاصر بالمرايا...
عنّي؟
وعن حلمين فوق وسادة يتقاطعان ويهربان، فواحدٌ
يستلّ سكّيناً، وآخر يودِعُ الناي الوصايا
لا أدرك المعنى، تقولُ
ولا أنا، لغتي شظايا
كغياب إمرأةٍ عن المعنى، وتنتحر الخيولُ
في آخر الميدان...
ريتّا تحتسي شاي الصباحِ
وتقشّر التفاحة الأولى بعشر زنابقٍ،
وتقول لي:
لا تقرأِ الآن الجريدة، فالطبول هي الطبولُ
والحرب ليست مهنتي. وأنا أنا. هل أنتَ أنتَ؟
أنا هو،
هو من رآك غزالةً ترمي لآلئها عليه
هو من رأى شهواته تجري وراءك كالغدير
هو من رآنا تائهين توحّدا فوق السرير
وتباعدا كتحيّة الغرباء في الميناء، يأخذنا الرحيلُ
في ريحه ورقاً ويرمينا أمام فنادق الغرباء
مثل رسائلٍ قُرئتْ على عَجَلٍ،
أتأخذني معكْ؟
فأكون خاتمَ قلبكَ الحافي، أتأخذني معكْ
فأكون ثوبكَ في بلاد أنجبتك... لتصرعكْ
وأكون تابوتاً من النعناع يحمل مصرعكْ
وتكون لي حيّاً ومَيْتاً،
ضاع يا ريتّا الدليلُ
والحبّ مثل الموت وعدٌ لا يُردُّ... ولا يزولُ
(...)
****
منتخب "لماذا تركت الحصان وحيداً" 1995
حبرُ الغراب
لَكَ خَلْوةٌ في وحشة الخرّوب، يا
جَرَسَ الغروب الداكنَ الأصوات! ماذا
يطلبون الآن منكَ؟ بحثتَ في
بُستانِ آدمَ، كي يوارِي قاتلٌ ضَجِرٌ أَخاهُ،
وانغلقت على سوادِكَ
عندما انفتَحَ القتيلُ على مَدَاهُ،
وانصرَفْتَ إلى شؤونكَ مثلما انصرف الغيابُ
إلى مشاغله الكثيرة. فلتَكُنْ
يَقِظاً. قيامتُنا سَتُرْجَأُ يا غرابُ!
لا ليلَ يكفينا لنحلُمَ مرّتين. هناك بابُ
واحدٌ لسمائنا. من أين تأتينا النهايةُ؟
نحن أحفادَ البداية. لا نرى
غير البداية، فاتّحدْ بمهبّ ليلك كاهناً
يَعِظُ الفراغ بما يخلّفُهُ الفراغُ الآدميُّ
من الصدى الأبديّ حولكَ...
أنتَ متّهم بما فينا. وهذا أوّلُ
الدمِ من سلالتنا أمامكَ، فابتعدْ
عن دار قابيلَ الجديدةِ
مثلما ابتعد السرابُ
عن حِبر ريشك يا غرابُ
ليَ خلوةٌ في ليل صوتكَ... لي غيابُ
راكضٌ بين الظلال يشدُّني
فأشدُّ قرنَ الثور. كان الغيب يدفعني وأدفعه
ويرفعني وأرفعه إلى الشبح المعلّق مثل
باذنجانةٍ نضجت. أأنت إذاً؟ فماذا
يطلبون الآن منّا بعدما سرقوا كلامي من
كلامك، ثم ناموا في منامي واقفينَ
على الرماح. ولم أكن شبحاً لكي يمشوا
خُطايَ على خُطايَ. فكُنْ أخي الثاني،
أنا هابيلُ، يُرجعني الترابُ
إليك خرّوباً لتجلس فوق غصني يا غرابُ
(...)
****
منتخب "سرير الغريبة" 1995
سوناتا [III]
أحبّ من الليل أوّلَه، عندما تأتيان معا
يداً بيد، ورويداً رويداً تضمّانني مقطعا مقطعا
تطيران بي، فوق. يا صاحبيَّ أقيما ولا تُسرعا
وناما على جانبيَّ كمثل جناحَيْ سنونوّة متعَبهْ
حريرُكما ساخنٌ. وعلى الناي أن يتأنّى قليلا
ويصقل سُوناتةً، عندما تقعان عليّ غموضاً جميلا
كمعنى على أهبة العري، لا يستطيع الوصولا
ولا الانتظارَ الطويلَ أمام الكلام، فيختارني عَتَبهْ
أحبّ من الشعر عفويّةَ النثر والصورةَ الخافيهْ
بلا قمرٍ للبلاغة: حين تسيرين حافيةً تترك القافيهْ
جِماعَ الكلام، وينكسر الوزن في ذروة التجربهْ
قليلٌ من الليل قربك يكفي لأخرج من بابلي
إلى جوهري - آخري. لا حديقةَ لي داخلي
وكلُّكِ أنتِ. وما فاض منك "أنا" الحرّةُ الطيّبهْ
****
منتخب "جداريّة" 2000
(...)
وأريد أن أحيا...
فلي عملٌ على ظهر السفينة. لا
لأنقذ طائراً من جوعنا أو من
دُوار البحر، بل لأشاهد الطوفانَ
عن كثبٍ: وماذا بعد؟ ماذا
يفعل الناجونَ بالأرض العتيقة؟
هل يُعيدونَ الحكايةَ؟ ما البدايةُ؟
ما النهايةُ؟ لم يعد أحَدٌ من
الموتى ليخبرنا الحقيقة.../
أيها الموتُ انتظرْني خارج الأرض،
انتظرْني في بلادكَ، ريثما أُنهي
حديثاً عابراً مع ما تبقّى من حياتي
قرب خيمتكَ، انتظرْني ريثما أُنهي
قراءةَ طَرْفَةَ بنِ العَبْد. يُغريني
الوجوديّون باستنزاف كلّ هنيهةٍ
حرّيّةً، وعدالةً، ونبيذَ آلهةٍ.../
فيا موتُ! انتظرْني ريثما أُنهي
تدابيرَ الجنازة في الربيع الهشّ،
حيث وُلدتُ، حيث سأمنع الخطباء
من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين
وعن صمود التين والزيتون في وجه
الزمان وجيشه. سأقول: صُبُّوني
بحرف النون، حيث تَعُبُّ روحي
سورةُ الرحمن في القرآن. وامشوا
صامتين معي على خطوات أجدادي
ووقع الناي في أزلي. ولا
تضعوا على قبري البنفسجَ، فهوَ
زهر المُحبَطين يُذكِّر الموتى بموت
الحبِّ قبل أوانه. وضعوا على
التابوت سبعَ سنابلٍ خضراءَ إنْ
وُجِدَتْ، وبعضَ شقائق النعمان إنْ
وُجِدَتْ. وإلاّ، فاتركوا وردَ
الكنائس للكنائس والعرائس/
أيها الموت انتظر! حتى أُعِدَّ
حقيبتي: فرشاةَ أسناني، وصابوني
وماكنة الحلاقة، والكولونيا، والثيابَ.
هل المناخ هناك معتدلٌ؟ وهل
تتبدّل الأحوال في الأبديّة البيضاء،
أم تبقى كما هي في الخريف وفي
الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي
لتسليتي مع اللاّ وقتِ، أم أحتاجُ
مكتبةً؟ وما لغةُ الحديث هناك،
دارجةٌ لكلّ الناس أم عربيّةٌ
فُصْحى/
... ويا موت انتظرْ، يا موتُ،
حتّى أستعيد صفاءَ ذهني في الربيع
وصحّتي، لتكون صيّاداً شريفاً لا
يصيد الظبيَ قرب النبع (...)
****
منتخب "حالة حصار" 2002
هنا، عند منحدرات التلال، أمام الغروبِ
وفوّهة الوقتِ،
قرب بساتينَ مقطوعة الظلِّ،
نفعل ما يفعل السجناءُ،
وما يفعل العاطلون عن العمل:
نُربّي الأملْ.
(...)
نُخَزِّن أحزاننا في الجِرار، لئلاّ
يراها الجنودُ فيحتفلوا بالحصار...
نخزّنها لمواسمَ أخرى،
لذكرى،
لشيء يفاجئنا في الطريق.
فحين تصير الحياةُ طبيعيّةً
سوف نحزن كالآخرين لأشياءَ شخصيّةٍ
خبّأتْها عناوينُ كبرى،
فلم ننتبه لنزيف الجروح الصغيرة فينا.
غداً حين يَشْفى المكانُ
نُحسُّ بأعراضه الجانبيّهْ
(...)
****
منتخب "لا تعتذر عمّا فعلت" 2004
لم يسألوا: ماذا وراء الموت
لم يسألوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا
يحفظون خريطةَ الفردوس أكثر من
كتاب الأرض، يشغلهم سؤال آخر:
ماذا سنفعل قبل هذا قبل هذا الموت؟ قرب
حياتنا نحيا، ولا نحيا. كأنّ حياتنا
حِصصٌ من الصحراء مختلَفٌ عليها بين
آلهة العِقار، ونحن جيران الغبار الغابرونَ.
حياتنا عبء على ليل المؤرّخ: "كلّما
أخفيتهم طلعوا عليّ من الغياب"...
حياتنا عبء على الرسّام: "أرسمهم،
فأصبح واحداً منهم، ويحجبني الضباب".
حياتنا عبء على الجنرال: "كيف يسيل
من شبحٍ دم؟" وحياتنا
هي أن نكون كما نريد. نريد أن
نحيا قليلاً، لا لشيء... بل لنحترمَ
القيامةَ بعد هذا الموت. واقتبسوا،
بلا قصدٍ كلامَ الفيلسوف: "الموت
لا يعني لنا شيئاً. نكونُ فلا يكونُ.
الموت لا يعني لنا شيئاً. يكونُ فلا
نكونُ"
ورتّبوا أحلامهم
بطريقة أخرى. وناموا واقفين!
****
منتخب "كزهر اللوز أو أبعد" 2005
هي لا تحبّك أنت
هي لا تحبّكَ أنتَ
يعجبُها مجازُكَ
أنت شاعرها
وهذا كلّ ما في الأمر/
يعجبها اندفاع النهر في الإيقاعِ
كن نهراً لتعجبها!
ويعجبها جِماع البرق والأصوات
قافيةً...
تُسيلُ لعابَ نهديها
على حرفٍ
فكن أَلِفاً... لتعجبها!
ويعجبها ارتفاع الشيء
من شيءٍ إلى ضوءٍ
ومن ضوءٍ إلى جِرْسٍ
ومن جِرْسٍ إلى حسٍّ
فكن إحدى عواطفها... لتعجبها
ويعجبها صراعُ مسائها مع صدرها:
]عذّبتني يا حبُّ
يا نهراً يصبّ مجونه الوحشيّ
خارج غرفتي...
يا حبّ! إن لم تُدْمِني شبقاً
قتلتك[
(...)
****
منتخب "في حضرة الغياب" 2007
سطراً سطراً أنثركَ أمامي بكفاءة لم أُوتَها إلاّ في المطالع/
وكما أوصيتَني، أقفُ الآن باسمكَ كي أشكر مشيّعيكَ
إلى هذا السفر الأخير، وأدعوهم إلى اختصار الوداع،
والانصراف إلى عشاء احتفاليّ يليق بذكراك/
فلتأذنْ لي بأن أراكَ، وقد خرجتَ منّي وخرجتُ منك،
سالماً كالنثر المصفّى على حجر يخضرّ أو يصفرّ في
غيابك. ولتأذن لي بأن ألُمّكَ، واسمَكَ، كما يلمّ السابلةُ
ما نسيَ قاطفو الزيتون من حبّات خبّأها الحصى. ولنذهبنَّ
معاً أنا وأنت في مسارَيْن:
أنتَ، إلى حياةٍ ثانية، وَعَدَتْكَ بها اللغة، في قارىء قد
ينجو من سقوط نيزك على الأرض.
وأنا، إلى موعد أرجأتُه أكثر من مرّة، مع موتٍ وعدتُه
بكأس نبيذٍ أحمرَ في إحدى القصائد. فليس على الشاعر
من حَرَجٍ إن كذب. وهو لا يكذب إلاّ في الحب، لأن
أقاليم القلب مفتوحة للغزو الفاتن.
أمّا الموت، فلا شيء يهينُه كالغدر: اختصاصِهِ المُجَرَّب.
فلأذهبْ إلى موعدي، فور عثوري على قبر لا ينازعني
عليه أحدٌ من غير أسلافي، بشاهدةٍ من رخام لا يعنيني إن
سقط عنها حرف من حروف اسمي، كما سقط حرف
الياء من اسم جدّي سهواً.
ولأذهبنَّ، بلا عكّاز وقافية، على طريق سلكناه، على غير
هدى، بلا رغبة في الوصول، من فرط ما قرأنا من كتب
أنذرتْنا بخلوّ الذرى مما بعدها، فآثرنا الوقوف على سفوحٍ
لا تخلو من لهفة الترقّب لما تُوحي الثنائيّاتُ من امتنانٍ
غير معلنٍ بين الضدّ والضدّ. لو عرفتُك لامتلكتُك، ولو
عرفتني لامتلكتني، فلا أكون ولا تكون
(...)
** ** ** **
بطاقة
ولد محمود درويش في قرية البروة بفلسطين عام 1941، ولجأ وهو في السابعة إلى لبنان الذي بقي فيه عاماً واحداً، قبل أن يعود متسللاً إلى فلسطين. وهناك انضمّ إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وكتب الشعر والمقالة في بعض الصحف والمجلاّت (الاتحاد، الجديد،...). اعتُقل أكثر من مرّة بسبب نشاطاته السياسيّة، وفي العام 1972 نزح إلى مصر، ومنها إلى لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة. شغل منصب رئيس رابطة الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين، وأصدر مجلة "الكرمل". وفي عام 1977 وُزِّع من كتبه أكثر مليون نسخة. عاد إلى فلسطين عام 1994، مختاراً الإقامة في رام الله. حصل على العديد من الجوائز العالميّة.
له
شعر:
"أوراق الزيتون" 1964، "عاشق من فلسطين" 1966، "آخر الليل" 1967، "العصافير تموت في الجليل" 1969، "حبيبتي تنهض من نومها" 1970، "أحبّك أو لا أحبّك" 1972، "محاولة رقم 7" 1973، "تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق" 1975، "أعراس" 1977، "مديح الظلّ العالي" 1983، "حصار لمدائح البحر" 1984، "هي أغنية، هي أغنية" 1986، "ورد أقلّ" 1986، "أرى ما أريد" 1990، "أحد عشر كوكباً" 1992، "لماذا تركت الحصان وحيداً" 1995، "سرير الغريبة" 1995، "جداريّة" 2000، "حالة حصار" 2002، "لا تعتذر عمّا فعلت" 2004، "كزهر اللوز أو أبعد" 2005، "في حضرة الغياب" 2007.
نثر:
"شيء عن الوطن" 1971، "يوميات الحزن العادي" 1973، "وداعاً أيتها الحرب، ودائماً أيها السلم" 1974، "ذاكرة للنسيان" 1983، "في وصف حالتنا" 1987، "الرسائل" 1989، "عابرون في كلام عابر" 1991.
****
التجانيّ يوسف بشير، هذا الشاعر المرهف، كم فارق نهج أضرابه من شعراء بدايات القرن العشرين، وإن اقترب كثيراً من نهج المحدثين في مصر، ومن أساليب جماعة "أبوللو" (أبي شادي وإبراهيم ناجي وأضرابهما)، وكذلك بعض شعراء المهجر من السوريين واللبنانيين، والشاعر التونسيّ أبي القاسم الشابي بوجه خاص. لكن لا أرى من بين شعراء فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، في السودان، من عبّر عن تجاريبه الشخصيّة فصوّرها شعراً شفيفاً، واستنطق دواخله المهتاجة، فصاغها مقاطع تعجّب، مثلما فعل التجانيّ. نعم، كتب في التصوّف، وتناول الذات الإلهيّة ووحدة الكون، كما كتب عمّا جاش في نفسه من رحلة عذابه القاسية، من حرّ الشكّ إلى برد اليقين. لكن التجانيّ، لم يهمل فيض قلبه العاشق، فسرى منه في بعض قصيده، مسرى لا يكاد يلحظ أثره القارىء المعجل. كنت أنا قد نظرت، بسبب من اهتمام برصد ما لحيّ "المسالمة" من أثر في الفن والشعر والغناء في "أم درمان"، في شعر التجانيّ، فوجدت أن للتجاني سهماً بارزاً، وإنْ أهمله بعض النقّاد. وهنا أدعو القارئ أن يقرأ معي بعض أبيات من قصيدته المعنونة "الله" (1):
"فتفلتّ من يدي وسبّحتَ بديئاً لأولِ ِالأشياءِ
أين مرقى سمائهِ؟ أين ملقى قدسيّ الصفاتِ والأسماءِ
قال: في رقة الصوامع أو لوعة بيضِ المساجد الغرّاءِ
لم ُتشِدْهَا يدُ الفنونِ ولا صاغت محاريبها يدُ البنّاءِ
كلمات مبثوثة في الفضاءِ الرّحبِ من ساجدٍ ومن صلاّءِ
هي لله مخلصات وكم تعقب بدعاً منازع الأهواءِ
ها هنا مسجد مغيظٌ على ذي البيّعِ الطُهرِ والمسوحِ الوضاءِ
وهنا راهبٌ من القوم ِ ثوّار لمجد الكنيسة الزّهراءِ
كلّها في الثرى دوافع خيرٍ بنت وهبٍ شقيقة العذراءِ
قلت: ما وهبٌ في الزمان وما شأن الفتاتين بالجلالِ المضاءِ
ألحواء مدخلٌ في مجاري صُوَرِ القهرِ أو مجالي السماءِ
بنت وهبٍ ماذا بها في مراحِ الغيبِ أو مغتدى عيونِ القضاءِ
ما لعذراء بالإلهِ وما للقُدسِ مِنْ آدمٍ ومن حوّاءِ
أهو الله في القلوب وفي الأنفاسِ والروحِ والدجى والضياءِِ
أمْ هو الله في الثرى عند عزرائيل وقفاً على قلوبِ النساءِ؟
قال كلتاهما من النورِ تفضي بنبيٍّ من رحمةٍ وإخاءِ
والنبيّ العظيم في الأرض إنسانُ السمواتِ إلهيّ الدماءِ
صلة الأرض بالسماءِ وصوت الحقّ فيها ومستهلّ الفضاءِ".
لقد رأى الشاعر الجريء مظاهر التوحيد، تتجلّى في تنوّع الخلق والمخلوقات وجماع الكون، فرأى بنت وهب تلازم العذراء كالشقيقة، في رؤية تشمل الكون بنظر واحد، لكنها أيضاً تستصحب رؤية متقدّمة للتسامح بين العقائد وتعايش الأديان. أورد د. أحمد عبد الله سامي، في كتابه عن الشاعر التجانيّ (2)، أن قصائد ديوان "إشراقة" هي ثمان وستون قصيدة، أربعة وعشرون منها تدور حول الشعر الذاتي، ويشكو زمانه أو يتحسّر على ما فات أو يناجي صوراً في خياله. سبع عشرة قصيدة أخرى تناولت الحبّ والجمال، ثم تسع قصائد سمّاها الكاتب شعراً صوفيّاً، وست قصائد هي عن بعض أصدقائه، وأربع في الطبيعة، وأربع أخر في الرثاء، وثلاث أخيرة في موضوعات وطنيّة. وأعجب كيف أن الكاتب عبد الله سامي، لم يفطن، وهو يعرض لقصائد الحبّ والجمال، أن بعضها حوى تعبيراً واضحاً، وفي أبيات واضحة جليّة، عن ميل الشاعر نحو امرأة بعينها، ليست من دينه، أو قد تكون مسيحيّة، أُغرم بها، وألمح إلماحاً حذراً لها، في ما بثّ عنها في قصائده. لم تغب عن يراعه الذي يخطّ عن خواطره العاشقة، إشارات للكنيسة أو للراهب أو للعذراء أو للصوامع. ترد في قصائد كثيرة، لكن أوضحها تلك التي تجرّأ الشاعر ووضع عنواناً لها، ينم عن توقه إلى التسامح يجمع المسجد والكنيسة. ذلك تراه في قصيدة سمّاها "كنائس ومساجد" (3). للتجاني نظرات في وحدة الكون كما أبنا، ولربّما فيها ما ألَّب عليه المعهديين، فرموه بما رموا من تشكيك في إيمانه، فرأوا فيه ضعفاً، بل وأسرف بعضهم في وصفه تجديفاً، وساعدهم هو بصياغات مريبة. أنظر معي كيف أورد شعراً رقيقاً، يقطر تسامحاً ومسالمة واتحاداً:
"درجَ الحسنُ في مواكبِ عيسى مدرجَ الحبِّ في مساجد أحمدْ
ونمت مريم الجمال وديعاً مشرقاً كالصباح أحوَر أغيدْ
نسلتْ موجةٌ إلى الديرِ في حين مشى فرقدٌ على إثر فرقدْ
آه لو تعلم المساجدُ كم ذا أجهدَتْ بينها الصبابةُ أمردْ
آه لو تعلم المساجد كم ذا خَفقتْ بينها جوانحُ أدرَدْ
ولقد تعلم الكنائسُ كم أنفٍ مدلّ بها، وخدّ مورّدْ
ولقد تعلم الكنائسُ كم جفنٍ مُنضى وكمْ جمالٍ مُنضدْ".
لا يخفي الشاعر تعلّقه بمن في الكنيسة، ومن غير فتاته ورديّة الخدود؟ لكن القصيدة تطفح بنظرة الشاعر إلى وحدة الوجود والكون. فهو لا يرى من اختلاف في روح الدين عند المسيحيين وعند المسلمين، ويريد في ذلك اختلاق الوشيجة التي تمنح حيثيات عشقه الأمان الذي يريح قلبه.
ثم أقرأ من قصيدة: "وحيّ المحامد" (4)، هذه الأبيات، تجد صوراً مستلهمة عند التجانيّ من واقع ماثل حوله، ويفصح تلميحاً متواتراً عن شواهد مسيحيّة، لكأنه يقصد أن يبثّ فيها رسالته للمرأة المسيحيّة التي يحبّها:
"كمْ ضرعنا إلى الذي فرض الحجَّ ليرعاكَ من صروفِ زمانِهْ
وابتهلنا إليهِ ملء أيادينا وكلّ دعاءٍ بملءِ جنانِهْ
فكأنما إذا ارتحلت دعاءٌ مرسلٌ للمسيحِ من رهبانِهْ
أو كأنّا تسبيحةٌ في فم الناسكِ تجري على مُتونِ لسانِهْ".
كان التجانيّ ينطق عن بيئة يعرفها وتعرفه. نشأ في "حي العرب" المتاخم والمتداخل مع "حيّ المسالمة"، وليس بعيداً عن السوق الكبير في "أم درمان"، حيث التجارة يدير جلّها نفرٌ جليل من الشوام، لبنانيين وسوريين، وبعض أقباط وهنود ممن استقرّوا في البلاد، شرقيّها وغربيّها، شمالها وجنوبها. كثير منهم مسيحيون بطوائفهم وأفرعها العديدة: روم أرثوذكس وأقباط أرثوذكس وكاثوليك، بكنائسهم وأبرشياتهم. حين فكّ التجانيّ الشاعر الخطّ وهو طفل، فكّه في خلوة أهله "الكتياب"، أو هي روضة الأطفال يديرها عمّه في "حيّ العرب". أما لمّا اعتلّت صحته، وهو في عشرينياته، فقد هرع به أهلوه إلى مستشفى "الإرساليّة" في "أم درمان"، على مقربة من "حيّ العرب". ذلك مستشفى يديره رهبان الكنيسة، لا سعياً لإنفاذ أجندات تنصيرٍ خفيّة، بل خدمة لأهداف إنسانيّة محضة، توجّس منها من توجّس (5). ما كانت سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي في السودان، خالية من توجّسات شبيهة، فقد شهدتْ سنوات تلتْ ذلك، سياسات المناطق المقفولة التي اتبعها الاستعمار البريطاني، وهي بذور الفتنة تُزرع في غفلة، ثم ترعاها القوة الباطشة حيناً، والترغيب الأملس أحايين أخرى. الجنوب صناعة إنكليزيّة، لكن أنظر معي: "المسالمة" تجدها صناعة سودانيّة بحتة. قبل سنوات الثورة المهديّة، وبعدها أيضاً، لم تهمل حكومة الخليفة عبد الله التعايشي، منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى نهايته، أمر "المسالمة". نما الحيّ وتعايش سكّانه مع سكّان الأحياء المجاورة في "حي العرب"، والخور الفاصل مع "حيّ العمدة" و"حيّ السوق" و"حيّ الركابية" وأطراف من "حيّ ود أرو" و"حيّ ود نوباوي" و"حي البوستة". بين الأسر المسلمة، ثمة أسر عديدة مسيحيّة: أقباط أرثوذكس، وروم أرثوذكس، وكاثوليك، من سوريا ولبنان، وأسر يهودية وهندية وأرمنية، لكنهم ظلوا سودانيين، على سودانيتهم المكتسبة أباً عن جدّ، وما نفّرهم عن البلاد الآن، إلا جنوح بعض سياسيّينا إلى فرض سياسات التأميم الاقتصادي الخرقاء، ثم سياسات التهميش المريبة من بعد، فغادر من غادر وبقي الكثير، لا يبرحون المكان الذي آواهم وأجدادهم السابقين. هنا نشأ التجانيّ في تلكم السنوات البعيدة. هنا كان يرى بأمّ عينيه التعايش بين ملل ونحل تكاد تفرّقها السحنات والعقائد أول وهلة، لكن يجمع عقدها روح الإخاء الإنساني، وروح التسامح التي تسري من فوقهم مثل غيمة تلقي بظلّ يحمي من هجير اختلاف شكليّ وتنافر جزافيّ. لو بلغ النظر مراميه العميقة لاستبان للرائي، مثلما استبانت للشاعر التجانيّ، تلك الوحدانيّة تشمل الكائنات من حوله. وليتك هنا تقرأ معي قصيد التجانيّ الشهير بعنوان "زهى الحسن" (6):
"لا تثأري من فؤادي كفى بدمعي ثارا
حسبيَ افتئاتاً تجنّيكِ نفرةً وازورارا
آمنتُ بالحُسنِ بَرْداً وبالصّبابةِ نارا
وبالكنيسةِ عقْداً منضداً من عذارى
وبالمسيح ومَنْ طافَ حولهُ واستجارا
إيمان مَنْ يعبدَ الحسنَ في عيونِ النصارى
****
لقد بلوتكَ يا حُسن كبرةً أو نفارا
وقد خبرتكَ يا ثغر بسمةً وافترارا
وقد عهدتكَ يا جفن مِنصلاً جبّارا
نشدتكَ الحبّ واللهو والدموعَ الحِرارا
ألا اطّّرحْتَ زُهى الحُسنِ وادّكرتَ الجِوارا".
لكن من تكون تلك الأنثى التي تعلّق بها الشاعر، مقيمة في الجوار؟ لا يقول لنا من أرّخ للشاعر، بل فات عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية عند التجانيّ. لم يكن يتوفر للشبّان مخالطة مع النساء، ناهيك إن كنّ من سحنات وعقائد مختلفة، وأجنبيات غريبات. كان التجانيّ يدرك أن تطلّعاته العاطفيّة مردودة، ولن تمضي به وبقلبه إلى الغايات التي يحلم بها. في ذلك المجتمع الذي لم تتسع فيه حركة التعليم، أو ينداح خلاله الانفتاح المعافى على الآخر المختلف، لن تتحقق مثل تلك الطموحات العراض، أو تتنزل على الواقع الماثل. برغم دعائم التعايش وشيوع التسامح، على أفق من الفهم المحترم للاختلافات الإثنيّة والتباينات العقائديّة، إلا أن خطط التجانيّ تبقى خططاً لا تبرح خياله، ولا تغادر خطّ يراعه. في قصيدة "طفرةُ ساحر"(7) يقول:
"يا "هذه" عمرك ِ الله هل سمعتِ بقيسِ؟
فتىً يقيمُ بجنبي بين سهم وقوسِ
رمتهُ ليلى بجنبيكِ واستعاذتْ بترسِ
وأنت يا ابنةَ لبنان تعبثينَ برأسي
كفاكِ سِحراً وحسبي ما قد لقيتُ وبسّي".
إذاً، فشاعرنا قد علق فتاة لبنانيّة، أفصح عنها بأوضح عبارة: "ابنة لبنان". ولعلّي أقرأ كلمة "بسّي" في آخر عجز البيت أعلاه: "بؤسي"، فهي أصدق تعبير عن حالة الشاعر العامّة، يحيط بها الإحباط من كلّ ناحية، لا هو حقّق مراميه في التعليم، ولا هو امتهن مهنة تعود عليه بالرزق، ولا صحته ساعدته للإقبال على الحياة بحماسة. ويورد الدكتور عبده بدوي كيف أن التجانيّ أغرم بالحسن والجمال الأجنبيّ (8)، والإشارات كثيرة مبثوثة في قصائده الوجدانية. لكن هل هي مسيحيّة، في ترائبها صليب؟ إقرأ معي قصيدة "من هنا وهناك"، كيف صاغ التجانيّ شعراً يستعجب فيه من قلبه، يتعشّق الجمال عند الغرباء (9):
"عجيبٌ أنت يا قلبي فكمْ ذا يهيب بكَ الجمالُ فتستجيبُ
يظلّ بك الهوى فرحاً وتبكي فتشرب من مدامعك القلوبُ
ترود بك الصبابةُ كلّ يومٍ مجاهلَ كلّ آهلها غريبُ
وجنّ بك الهوى فهُنا غريرٌ علقت بهِ ومن هنّا حبيبُ
وتلكَ وفي معاصمها سوارٌ وذلك في ترائبهِ "صليبُ"
يرفّ عليه من بطرٍ ونُعمى معالم كلّها أرجٌ وطيبُ".
ثم هو يصف كيف تستقبل محبوبته الملهمة، فصل الربيع، وتلك من عادات وتقاليد اللبنانيين والسوريين، فالسودانيون لا يلتفتون كثير التفات لربيع لم يألفوا علاماته، في طقسٍ لا يريهم إلا الحرّ الزؤام! لكن ذلك لا يحوجنا لإنكار هذا النظم من التجانيّ، وعينه على محبوبته الشاميّة، تحتفل بمقدم الربيع. ترى هل نعيب على شاعر سوداني مسيحيّ، مثل صالح بطرس، وقد عاش في زمن التجانيّ، قصيدة ينظمها في الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجريّة (10)؟ قال التجانيّ لمعشوقة تحتفل بمقدم الربيع:
"جئت تستقبل الربيع وتستنشي عبير الحياة من آذاره
مار من حولك الشباب وكلّ مخلّد للجمال في إكباره
عبدوا وجهك النضير وجاؤوا ينشقون الأريجَ من أزهاره
دلفوا يقرأون عذب المراسيمِ وآي الهوى على آثاره
غمروا بالحنان روحك واستنزفت قلبي إليك من أغواره".
شباب وأزاهير في شهر الربيع، وعذب المراسيم والتراتيل في كنيسة ضمّت المحبوبة بين أترابها من بنات الشآم. هذا مما جاء في قصيدة "من أغوار القلب" (11).
ثم من قصيدة "نفسي " (12) يقول التجانيّ:
"هي نفسيَ إشراقةٌ من سماء الله تحبو مع القرون وتبطي
موجة كالسماء تقلع من شطٍّ وترسي من الوجود بشطِّ
خلصت للحياة من كلّ قيدٍ ومشت للزمان في غير شرطِ
كلّما اهتاجها الحنينُ استظلّتْ بحبيبينِ من يهود وقبطِ".
لا يقف الشاعر في حبّه إذاً، على فتاة واحدة، مسيحيّة، بل ألمح إلى استظلاله بفتاة يهوديّة أيضاً. والغريب أن أسراً يهوديّة عريقة، خالطت أنسابها أسراً سودانيّة مسلمة، ومنذ سنوات بعيدة، أكثر مما يرصد من تزاوج بين مسلمين ومسيحيين في "أم درمان"، على ما شهدت المدينة من سموّ في علاقات التسامح بين سكّانها المختلفين، سحنات وعقائد.
شعر التجانيّ شهادة لـ"أم درمان"، كيف قويتْ فيها شوكة التسامح، واستطالت بنياناً شامخاً، شموخ برج بلديّة "أم درمان" العريق. لا أزال أذكر في طفولتنا ونحن نتسابق عدواً على الدرج الداخليّ للبرج، ونصل إلى السطوح، نجيل البصر مبهورين بنظرة "عين الطير"، للمدينة الحبيبة بمبانيها القصيرة، لا تسمق عاليةً تلاقي أبصارنا الغضّة، إلا مئذنة جامع "أم درمان" العتيق، وقبّة كنيسة "المسالمة"، نكاد نلمح جرسها الضخم من سطح برج البلديّة. لكم كان التجانيّ صادقاً مع ما رأى بعينه، وما رأى بقلبه الشاعر.
الهوامش:
- التجانيّ يوسف بشير: إشراقة، دار البلد، الخرطوم، 1999.
- د. أحمد عبد الله سامي: الشاعر السوداني التجانيّ يوسف بشير، دار الثقافة، بيروت، 1970.
- التجانيّ يوسف بشير، مرجع سبق ذكره، ص 57.
- التجانيّ يوسف بشير، مرجع سبق ذكره، ص 85.
- د. حسن مكي: المشروع التنصيري في السودان، المركز الإسلامي الإفريقي في الخرطوم، شعبة البحوث والنشر، إصدار رقم 11، 1991.
- التجانيّ يوسف بشير: مرجع سبق ذكره، ص 58.
- التجانيّ يوسف بشير، مرجع سبق ذكره ص 33.
- د. عبده بدوي: الشعر الحديث في السودان، ص 662.
- د. عبده بدوي: المرجع السابق.
- التجانيّ يوسف بشير، مرجع سبق ذكره، ص 55.
- التجانيّ يوسف بشير: مرجع سبق ذكره، ص 140.
- التجانيّ يوسف بشير: مرجع سبق ذكره، ص 153.
*****
حوار
الشاعر والقاص نيلس هاو أحد الأسماء البارزة في المشهد الأدبي الدانمركي، صاحب قلبٍ ساخن رغم إقامته في بلاد الصقيع... عن مشواره الأدبي وقراءاته وعلاقته بالآخر العربي كان هذا الحوار.
حين يسأل القارئ عن مضمون قصيدة أو ديوان شعري، ينصحه الشاعر بقراءته بنفسه لما في القراءة من نجاعة في فهم النص وإنتاج نصوص أخرى موازية من خلال التفكيك والتركيب، لكن حين يتعلق الأمر بالتنقيب في مسار الشاعر ذاته، آنذاك يفرك القارئ يديه استعداداً للحظوة بشرف لن يستطيع الشاعر صرفه عن الظفر به.
- هذا أسلوب طريف في تقديم سؤال افتتاحي. احتراماتي! دخلت عالم الكتابة مند سنوات ونسيت تقريباً السبب الذي من أجله بدأت الكتابة. لكن بطرحك هذا السؤال أتذكّر أول الأسباب: بدأت الكتابة لتقديم ذاتي، لأكتشف ما يجري ولأعبّر عنه بكلماتي الشخصية. ولا يزال هذا هو طموحي العميق والمقلق: أن أجد الكلمات المناسبة التي يسمّونها إلهاماً. لذلك، جوابي على سؤالك سيكون: نصوصي الشعرية والسردية هي التقديم الصادق الوحيد الذي يمكنه رسم معالم حضوري ورؤاي. ولدت ككل الناس وكان لي أب وأمّ وإخوة وأخوات. مشواري ككاتب بدأ مع مشواري كقارئ، فقد حفرت طريقي عبر بوّابة الأدب الدانمركي الكلاسيكي بحثاً عن الكلمات لمشاعر الحياة داخلي.
أصدرت ثلاث مجموعات قصصيّة وخمسة دواوين شعرية، فكيف ترى إلى الشاعر - القصّة، وكيف ترى إلى القاصّ - الشعر؟
- بالنسبة إلي، ليس ثمة تصادم بين الشخصيتين. الشعر والسرد حقلان أدبيان مختلفان والانتماء إليهما مثل الانتماء إلى عائلتين. في السرد، أنتمي إلى عائلة أنطون تشيخوف. وفي عائلتي الشعرية، لديّ أعمام وإخوة من طينة تشيسلاف ميلوز والموراي في أوستراليا وآخرون.
كيف تموقع تجربتك الشعريّة داخل الإنتاج الأدبي الدانمركي؟ وما الذي يميّز الأدب الدانمركي خصوصاً، والأدب السكندينافي عموماً، عن الآداب الأوروبية الأخرى؟
- كما تعلم، الأدب السكندينافي المكتوب هو تقليد يعود إلى الأغاني والقصص البطولية (الصاغا) المكتوبة باللغة السكندينافية القديمة (النورص). بالمقارنة مع تقاليد الكتابة في الأدب العربي، يبقى الأدب السكندينافي المكتوب تقليداً قصيراً زمنيّاً. هذا أعرفه، لكن حتى ثمانمئة أو تسعمئة سنة من الوجود هي بكل تأكيد زمن غير يسير. قبل سنوات، طلب مني أحد الناشرين أن أنجز أنطولوجيا تجمع أهمّ القصائد الشعرية الدانمركية التي كُتبت عبر تاريخ الأدب الدانمركي. الكتاب يتضمّن أكثر من 100 شاعر وشاعرة وأكثر من 350 قصيدة كُتبت على مدى 800 سنة من عمر الأدب الدانمركي المكتوب. أعتقد أن المهمّة ستفيدني كثيراً في اكتشاف جوانب الأصالة في أدبنا. الدانمرك دولة صغيرة تحيط بها المياه من أغلب جوانبها، والدانمركيون كانوا إما فلاحين وإما بحارة، ولذلك عكس شعرهم تجاربهم المقبلة من الحقول أو البحر، لكن بمعجم ديني. في الشعر الدانمركي الحديث، ثمة مدرستان على الأقلّ: الأولى أكثر ميلاً إلى اللغة الشعريّة على الطريقة الأميركيّة أو الفرنسيّة، والثانية أكثر التصاقاً بالواقع ما دامت حالة البؤس في العالم تفرض علينا التفكير سياسياً كما كتبت في هذه القصيدة: "مرّة، كتبت بريشتي قصائد تافهة/ قصائد خالصة حول لاشيء على الإطلاق/ لكن، الآن، أنا موله بهذا البعْرِ على ورقي/ سواء كان نحيباً أو شهيقاً".
يغلب على نصوصك المعجم البسيط والصور البسيطة والإيقاع البسيط والفكرة البسيطة... هل هو ميل إلى "البساطة" كمنحى تواصليّ أفقيّ، أم هو ميل إلى "التبسيط" كخلفيّة تواصليّة عموديّة؟
- أنا أعشق البساطة. البساطة فيّ هي البساطة نفسها التي فيك. نحن جميعاً نمشي على سطح الكرة الأرضيّة نفسها. لدينا نماذج من الأسئلة الوجوديّة نفسها. عموماً، لدينا اللغة، أي الكلمات البسيطة للتعبير عن أهمّ التجارب في حياتنا الإنسانيّة. في قصائدي لا أرغب في التحليق عالياً. أفضّل عوض ذلك، الالتصاق بالواقع: "مهمّتنا تتطلّب التعرّف إلى تجاربنا المشتركة/ الرعب والبؤس يترصّدان بنا/ يتشبّثان بأطراف ملابسنا ويتسللان إلى أجسادنا/ ليتحققا مما يجري/ وليقولا الحقيقة".
دارس تجربتك الشعريّة لا بدّ من أن ينتبه إلى هيمنة السخرية الوظيفيّة...
- ومن يستطيع تحمّل الحياة بلا مزاح؟ إنه لأمر محزن ومثير للسخرية أن نكون ستة مليارات نسمة على هذا الكوكب ومع ذلك نشعر بالوحدة(!). إذا ما امتلكنا الإرادة بإمكاننا أن نجعل من هذه الحياة حياةً أفضل، لكننا لحدّ الساعة لم نفعل شيئاً. نقيم الحدود بين الأمم والأديان والأعراق... عبث في عبث، لذلك فالسخرية من الذات تبقى أمراً مستحبّاً. صحيح أن الوقت ما زال مبكراً على اليأس، لكني محسوب على السذّج التائهين طلباً للمستحيل.
في زمن التقارب بين الثقافات والحضارات، هل استثمرت هذا المكسب التاريخي الذي تشهده الإنسانيّة حالياً، واطلعت على الأدب العربي، الأدب الذي أنتج "ألف ليلة وليلة"، أوّل رواية في تاريخ الأدب الإنسانيّ؟
- لدينا طبعة نرويجيّة رائعة من "ألف ليلة وليلة" في بيتنا. هذا التقليد العربي أسّس لمستوى راقٍ من السرد. أعرف نجيب محفوظ والطاهر بن جلّون وآخرين قلائل. أهمّ ما في التبادل الثقافي هو الترجمة، ونحن في حاجة إلى ترجمات. الكتّاب العرب لديهم رأسمال باهر من المعارف والإبداع لإهدائه للعالم. صديقي سليم العبدلي هو الآن في صدد ترجمة أشعار أدونيس إلى اللغة الدانمركية، ونحن على أحرّ من الجمر لقراءة هده الترجمة، ومعرفة الكثير عن الشعر العربي.
الأدب الدانمركي هو بوّابة القرّاء السكندينافيين من الناحية الجنوبيّة. هل فكّرت، كأديب دانمركي، بدعم المبادرات القليلة في الدانمرك التي تترجم أعمالاً أدبية عربية إلى اللغة الدانمركية، أم أن التباعد الجغرافي كافٍ لتبرير التباعد الثقافي؟
- أنا فرح لوجود بعض الجهود الداعمة للمزيد من الترجمات، لكن الأمر لا زال رهين إصدارات قليلة. الهجرة خلال الربع الأخير من القرن الماضي وفّرت للدول السكندينافيّة طاقات من مختلف بقاع العالم. أنا بدوري أقيم مع عائلتي في نوريبرو، وهو حيّ في العاصمة كوبنهاغن تتجمّع فيه إثنيات مختلفة. كل يوم في الشوارع والدكاكين ألتقي أناساً من أصول باكستانيّة أو صوماليّة أو عراقيّة أو هنديّة أو مغربيّة أو تركيّة... لكنهم يبقون دانمركيين، ومنهم من صار صديقاً لي، ومظاهرهم غيّرت الثقافة الدانمركية. في المستقبل القريب، سيصبح لزاماً علينا إعادة تحديد مفهوم كلمة "دانمركي". كم من الوقت نحتاج كي تصبح "البيتزا" و"الشوارما" و"الاسكندر كباب" دانمركيّة؟ مجرّد سنوات قليلة. "الفلافل" السكندينافيّة هي مزيج من ثقافات متعدّدة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأدب والفنّ الدانمركيين.
أنت تعلم أن الترجمة الأدبيّة ليست مهمّة كلّ من يجيد لغتين: لغة النصّ الأصليّة ولغة القارئ المترجم له. ذلك أن ترجمات من هذا النوع تكون في الغالب ترجمة لمعجم النصّ، بينما تبقى الترجمة التي يشرف عليها المبدع ترجمة لقوّة النصّ لجهة أن من ينجزها فاعل داخل حقل اشتغاله. هل فكّرت في اختيار مترجمي نصوصك مستقبلاً من المبدعين؟
- ديواني الأخير "نحن هنا" صدر قبل فترة وجيزة في تورونتو بكندا. هذا الديوان تُرجم من اللغة الدانمركيّة من قبل ب. ك. براسك وباتريك فريزن، وهما كاتبان ممتازان. في إسطنبول، حظيت بترجمة بعض نصوصي إلى اللغة التركيّة من قبل كمال أوزر وهو شاعر موهوب. وفي المغرب، أعمالي ستستفيد من مهارتك الترجميّة، وأنا سعيد بذلك. في ما يتعلق بالترجمة، أميل عموماً إلى النصوص المركّزة والبليغة. أعمالي تعتمد على التعبير الدقيق والكلمة المناسبة. لذلك، لا أميل لا إلى "ترجمة معجم النصّ"، ولا إلى "ترجمة قوّة النصّ". فكون القصائد والقصص هما كلّ ما أملك، يهمّني كثيراً ألا يتمّ إفسادهما باسم الترجمة. بالطبع، أنا متيقّن أنك على صواب، فالشاعر المتألّق هو دائماً الأنسب لترجمة القصيدة الشعريّة. لكن لا يجب أن ننسى أن داخل العلماء أيضاً ثمة شعراء مغمورين ينتظرون دورهم للإزهار والتفتح. أخيراً، أتمنى مستقبلاً أن تُؤسِّس هياكل جديدة للتبادل الثقافي بين بلدينا أجيالٌ جديدة ستنظر إلى عصرنا الملتبس وتبتسم. الإمبراطوريات لا تدوم سوى أوقات محددة، وحده الوعي الذي يوقظنا كلّ صباح ليحيي فينا الفرح والأمل لا يفنى ولا يُقهَر.
من شعر الحكم
قد يمضي المرء عمره كاملاً
في صحبة الكلمات
دون العثور أبداً
على الكلمة المناسبة.
مثل سمكة بئيسة
ملفوفة في أوراق جريدة هنغاريّة
فلا هي حيّة
ولا هي تفهم الهنغاريّة.
دفاعاً عن الشعراء
كيف السبيل لتخفيف الوطء على الشعراء؟
قست عليهم الحياة حتى صيّرتهم
بؤساء في ثياب السواد
زرق الجلد من ثلجيّة عواصفهم الداخليّة.
الشعر، هدا الداء المرعب،
داء شكوى الشعراء،
صراخ يلوّث الجو متسرّباً
كإشعاعات مفاعلات العصاب والجنون
الشعر مستبدّ جبّار
يحبب السهر ويفكّك أوصال الزوجيّة
ويجرّ الشعراء للاعتكاف في أكواخ الخلوة في عزّ الشتاء
حيث يتسامرون تحت الأوشحة الثقيلة وواقيات الآذان الصوفيّة.
هل بعد هذا عذاب؟
الشعر طاعون
أسوأ من كلّ داء، أسوأ من الأسوأ
ما أصعب تحمّل الذات حين يختارها الشعر، يا معشر الشعراء!
الشعراء عصبيّون كامرأة تتوقّع مولودَين توأمَين
يصرّون على أسنانهم في نومهم
يقضمون الحشائش في يقظتهم
يتسكّعون وسط الرياح المولولة طلباً للدهشة والاستعارة
أيامهم كلّها أيام مقدّسة.
قليلاً من الشفقة على الشعراء
في صممهم وعماهم
بمساعدتهم على عبور الشارع حين يشتدّ بهم الترنّح
تحت ضغط الإعاقة الخفيّة
حين يتوقّفون لينصتوا لصفارة إنذار في البعيد.
قليلاً من التقدير للشعراء.
الشعراء إخوان الأطفال المجانين
المتنكَّر لهم بدءاً من ذوي القربى
صلّوا لهم، ادعوا لهم
فمنذ لحظة ولادتهم كانوا أشقياء
رثتهم أمهاتهم
قبل إهمالهم درءاً لعدوى الجنون.
قليلاً من الرثاء للشعراء.
لا خلاص لهم
من ابتلائهم بالشعر،
أسرى عالمهم الفانتازي
غيتوهات رهيبة
تعجّ بالجنّ والشياطين.
في يوم صيفيّ صافي الشمس
قد ترى شاعراً بئيساً
خارجاً يتأرجح من بيته
تعلوه شحوبة الموت
يشوّهه التفكير
هل خطر على بالك آنئذ مساعدته؟
هل خطر على بالك آنئذ أن تربط خيوط حذائه وتقوده إلى الحديقة؟
هل خطر على بالك آنئذ مساعدته على الجلوس على كرسي تحت الشمس؟
هل خطر على بالك آنئذ أن تغنّي له قليلاً؟
هل خطر على بالك آنئذ أن تشتري له آيس كريم وتحكي له حكاية؟
هل خطر على بالك آنئذ أنه حزين للغاية،
مفلس، محبط، منهار، مهدّم، ومخرّب بالشعر؟
شعر: نيلس هاو
ترجمة: م. س. ر
****
متابعة
انعقد مؤتمر "خليل حاوي وتطوّر الشعر العربي الحديث" في الجامعة الأميركيّة ببيروت لمدّة أيام ثلاثة، بدعوة من الجامعة ومن المعهد الألماني للأبحاث الشرقيّة، وقد شكّل مناسبة لإعادة طرح الكثير من الأسئلة ولمحاولة إجلاء بعض الغموض الذي أحاط بموت حاوي، كما لإعادة قراءة هذا الشاعر وتحليل قصائده من وجهات نظر مختلفة ومتعدّدة، من خلال استضافته مجموعة كبيرة من النقّاد والباحثين من لبنان والعالم العربي وألمانيا.
تناولت يمنى العيد موضوع "حاوي والقناع"، فأشارت إلى كيفية انتزاع الشاعر للقناع من تاريخه المسرحي لاستخدامه في الشعر، موضحة أن هذا الاستخدام يندرج في حركة الحداثة العربية وهو يتمتّع بوظيفة في الصورة الشعريّة للقصيدة كما كان حاوي يعتبر. وفصّلت العيد في تناولها لقصيدة "وجود السندباد" دور القناع في تحديث القصيدة ونقلها من غنائيتها إلى بنيتها الدرامية، متحدّثة عن الحلم الذي هو حلم الانبعاث في رموزه التاريخية والأسطورية، وعن التناقض بين الزمني العابر بين زمن أنا المعيش وزمن الرؤيا أو الحلم المحيل على المطلق، ثم وصول الأنا إلى مأزق هذا المطلق الذي سيؤدي إلى نهايتها الدراميّة.
وأشار أسعد خير الله في كلمته إلى أن الرسالة النبويّة عند حاوي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ببعدين هما: الأمة الخلاّقة الناهضة والشاعر النبويّ المبدع، أي بالموازاة، أو حتى المماهاة بين الحيويّة الإبداعيّة في الشاعر وفي الأمة: "فإذا درسنا شعر حاوي وجدنا أن أكثر المواضيع تكراراً فيه ترتبط بحيويّة الأمة وطاقاتها الإبداعيّة التي تمكّنها من الانتصار في صراع البقاء. فهو في هذا نيتشويّ، جبرانيّ". واعتبر خير الله أن شعر حاوي تراوح بين جدليّة الخراب والقيامة، بين البوم والعنقاء، متحدّثاً عن البعد الطقوسيّ الذي يتيح تمثّل رسالة الشاعر وتحقيقها، بما ينطوي عليه هذا البعد من انتظار وترقّب وقلق وتضحية.
وتناول أرنيم هينمان خصائص اللغة والصورة في شعر حاوي، مشيراً إلى البعد الميثولوجيّ الواضح في هذا الشعر، كما في "السندباد في رحلته الثامنة"، أو في "العودة إلى سدوم"، ففي هذه القصائد وغيرها بدا تأثّر حاوي واضحاً بشخصيات توراتية مثل: موسى وأيوب، أو آلهة قديمة مثل: أدونيس وبعل.
وعن صورة المرأة أشارت بثينة الخالدي إلى وجوه الأنثى الخمسة في شعر حاوي، منبّهةً إلى ابتعاد الشاعر عن الصورة الأنثويّة المكرّسة في الشعر الكلاسيكي. أما صبحي البستاني فتحدّث عن "النصّ والتناصّ في شعر خليل حاوي"، معتبراً أن التداخل النصّيّ، أو التناصّ، يضفي على إنتاج حاوي "ديناميكيته النصّيّة" كلّها، ويضع بالتالي منهجيّة قراءة محدّدة تعطي القارئ دوراً طليعيّاً في تحقيق النصّ وإدراك أبعاده. وفصّل البستاني أنواع هذا التناصّ: "التناصّ الداخليّ" المتمثّل بالمقدّمات النثريّة المقتضبة، "الاقتباس الاستهلالي" الذي قد يتعدّى الثلاثة في قصيدة واحدة، "التناصّ الضمنيّ" أو غير المباشر حيث تبدو نصوص حاوي وكأنها بنيت على قواعد نصوص سابقة.
وضمن جلسة "الخطاب الفكري والثقافي"، تحدّث عدنان حيدر عن موقع الشاعر في الشعر العربي الحديث، لا سيما من خلال "بيادر الجوع"، مشيراً إلى أن التحديث في الشعر العربي تمّ بناء على مقاربتين، إحداها قامت على الاستيراد، والأخرى، التي كان حاوي من أمثلتها، قامت على منح التراث جسداً جديداً أكثر انفتاحاً وعصريةً. أما ريتّا عوض، فقد أضاءت على تجربة حاوي كناقد، حيث "تندمج في عمله العلاقات المتحوّلة ما بين الشعر والنقد، ممارسة الفن ونظريته في آن واحد". في هذا المعنى، شرحت عوض، "تكون النظرية مرتبطة بالضرورة بالتجربة الشعريّة والإبداع الشعريّ للشاعر - الناقد. لهذا فإن ظاهرة الشاعر - الناقد تبرز عند المنعطفات التي تتحوّل فيها الحساسيّة الفنّيّة ويتّجه الشعر فيها إلى التغيير والتجديد". وأشارت عوض إلى أن حاوي لم يترك كتاباً يتناول فيه تجربته الشعريّة، لكنه خلّف تراثاً نقدياً وفكرياً حول قضايا الشعر والثقافة والحضارة على شكل حوارات مع مثقفين وصحافيين، تبرز كيف كان حاوي يقول بتهافت المفاهيم النقديّة التي كانت سائدة حينها مثل الرمزيّة والسورياليّة والرومنطيقيّة، ليضع تعريفه الخاص للشعر الذي استمدّه من "بدائة الفنّ الشعريّ" كما تمثّلت في كل شعر أصيل على حدّ تعبيره. وعن "رموز شعر حاوي وشيفراته" استهلّ نبيل أيوب دراسته بتعريف الرمز ملاحظاً تقاربه مع الميثولوجيا والشعر، وطارحاً إشكالية علاقة الشعر والرمز بمنظومة القيم والأفكار المتضمّنة في الدلالة الثانية الرمزيّة.
في الجلسة الرابعة المخصصة لأعمال حاوي في سياقها التاريخيّ، رصد جورج جحا للمرحلة التي تقع بين الحقبة التي كتب فيها حاوي شعراً بالعامّيّة اللبنانيّة وأسماه "الشعر الطليق"، وصدور مجموعته الأولى بالفصحى "نهر الرماد"، فضلاً عن اتجاهه إلى كتابة مسرحيّة شعريّة أسماها "سالومي". واعتبر جحا أن قصائد حاوي غير المعروفة حملت بذور أفكار وسمات تطوّرت في وقت لاحق، حتى ليمكن وصفها بأنها وجدانية وذات طابع "فكري سياسي". وربط جحا بين مسيرة حاوي الشعريّة وإعدام أنطون سعادة، لا سيما في ظلّ القمع الذي شهدته تلك المرحلة.
وتحدّث نديم نعيمة عن خليل حاوي والمهجريين، الذين تقاطع معهم ابتداء من أواخر الخمسينيات مع صدور ديوانه الأول "نهر الرماد". فحاوي الذي كتب أطروحة الدكتوراه عن جبران خليل جبران كان قد أغرم بالأخير في صباه وتابع حركة الأدب المهجريّ. وإذا كان حاوي قد اشترك مع المهجريين في حسّ عروبيّ بدئيّ انتهى بهم إلى نظرة عربيّة إبراهيميّة للوجود، وفي مفهوم دور الشاعر، إلا أنه اختلف عنهم في كيفيّة تطبيق هذا الدور على أرض الواقع.
وقدّم محمود شريح سيرة وثائقية عن الشاعر الراحل ترصد حياته المكثّفة والشاقّة الممتدّة من مولده في 31/ 12 / 1919 في قرية الهويّة في حوران حيث كان يعمل أبوه، وصولاً إلى انضمامه في العام 1934 إلى الحزب القوميّ السوريّ الاجتماعيّ، ثم انفصاله عن هذا الحزب في العام 1951 ونشره قصيدة "الذرى البيضاء" في العام 1955، قبل صدور ديوانه الأول "نهر الرماد" في العام 1957، وحتى انتحاره قرابة الساعة العاشرة والنصف مساءً على شرفة منزله المطلّة على ساعة الجامعة الأميركية في 6/6/ 1982.
****
مكتبة الشباب
بعد "منزل مزدحم بالغائبين"، يذهب بنا الشاعر السوري تمام تلاّوي في ديوانه الثاني "شعرائيل" (منشورات وزارة الثقافة 2006) إلى مفهوم القصيدة - الكتاب، فالديوان مع أنه يتضمّن عدداً من القصائد التي تأخذ كلّ واحدة منها عنواناً مستقلاً، إلا أن ثمة بناءً متنامياً متدرّجاً من أول قصيدة حتى آخر قصيدة، فكأنما الديوان وحدةٌ شعريّة قائمة بذاتها، لها منطلق ونهاية وتشعّبات وأسفار في ما بينها. وهذه سمة من حقّنا أن نسجّلها للشاعر لأنها تدلّ بشكل ناصع على تقدّم الوعي الفنّي والجمالي للشعر لديه، كما تدلّ على أن لدى الشاعر رؤيا ورؤية يقوم من خلالهما بتقديم رسالة شعريّة محدّدة تمتزج فيها الثقافة والتراث برموزه وإحالاته التاريخيّة والميثولوجيّة واللغويّة. مما نسجّله كذلك أننا لا نرى في الديوان إمعاناً في تصيّد الغريب والموحش من الصور الشعريّة، وهذا يسمح بتواصل ممتع مع قصائده التي تنقل المحسوس إلى مجرّد مشبع بالروح، ويمزج بين المجرد واللامرئيّ وبين الحسيّ والمرئيّ. من أجواء الديوان: "كلما جئتِ انتبهتُ إلى خياناتي وجافتني المرايا،/ عارفٌ أني سأكذب، عارف أني سأحلف:/ والقرنفلِ لم تزرني بعدكِ امرأةٌ، ولم تعصر يدي كرزاً بحلمتها، ولا شفتي كسَتْها زُرقةَ القُبلِ القويَّةِ./ كيف أنسى أنّكِ الأنثى التي رَبَّتْ ملائكتي/ وأنكِ وحدك الأدرى بأخطائي/ ووحدك من يرى الملح الذي يعلو فمي/ ويشمّ رائحة الغريمةِ في سريري".
علاء الدين عبد المولى - سوريا
****
"تمائم" للسعودي أحمد الواصل
لأن "الكلمات لا تتخيّل سكونها" يكتب أحمد الواصل "تمائمـ"ـه (دار الانتشار العربي)، وهي مجموعته الرابعة، بلغة لا تملّ من ترصّد معانيها وجذبها وقنصها. لغة الواصل التي تلامس حدود التقعير أحياناً، لا تتنازل عن حرارة البرهة الشعرية وصفاء صورتها. أكثر فأكثر تصفو مياه القصائد، وأكثر فأكثر تجلو الكلمات معانيها: "يستعين السفر بوجهكَ ليترك قمراً ونورساً في أساهما".
يعرّف الواصل الضجيج بأنه نحيب الفراغ، والصمت بأنه شهادة بلا وظيفة، ناصباً فخاخ المفكَّر فيه في طريق المشعور به: "تجلس وحدك، وأنا صليب قصيدة/ تتحرّكُ أو أنكسرُ". هكذا يتحوّل العالم إلى مختبر إعادة إنتاج شعريّة، وبالتالي يصبح كلّ شيء مشروعَ إعادة تعريف وإعادة اكتشاف: "تغفر لي النار، ولا تدين الحطب".
كمال المهتار - لبنان
"كما يخسر الأنبياء" للأردني حسين جلعاد
ينقسم ديوان "كما يخسر الأنبياء" (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، وهو الثاني لحسين جلعاد، إلى قسمين: الأوّل، يتناول سيرة غيريّة للمتنبّي بعنوان "سيرة الثالث عشر"، كناية عن الغياب. والثاني، يتناول سيرة ذاتيّة للشاعر، تحت عنوان "سيرة الفتى". يُستهَلّ الديوان الأول باقتباس تاريخيّ من كتاب "المتنبي يستردّ أباه" وفيه إشارات حول حياة الشاعر المتنبي تتصل بإخفاء اسمه ونسبه، مقارباً ما تعرّض له أبناء البيت من إقصاء ومطاردة من خصومهم قديماً، رابطاً بين موت الشاعر المتنبّي وابنه محسّد، وبداية التفات الطالبيين لحقوق انتسابهم. لتقول القصيدة بعد ذلك ما سكت عنه الكلام. يلخّص جلعاد سيرة المتنبّي، بإقلاب المعنى في قصيدة "صاحب الزمان"، الخيل والليل، مستعيداً صوته، ولغزه، بتوظيف وسائل المنطق، وبراهينه ليقول: "لا الخيل/ ولا الليل/ ولا البيداء تعرفني". ويعود الشاعر إلى القصيدة التي تمثّل معنى الحقيقة مختتماً القسمين بالكيفيّة التي بدأ فيها الإشارة الأولى لتدوير المعنى الذي يشهد على خسارة العشاق، والشهداء والأنبياء: "خسرنا/ وإن/ رجعنا بسحر البيان/ ووجه الحقيقة/ ... خسرنا". في مجموعته الجديدة يضع جلعاد فكرة المعنى في مواجهة اللغة وعلاماتها، ويواجه شقاء المعرفة بالحقيقة غير التامّة، ودلالاتها ومرموزاتها، احتساباً منه أن الغياب يضارع الحضور، ويظل جزءاً من المتن الذي ما يزال يكتب حيواتنا وسيرتنا منذ الأزل.
محمد الربيقي - الأردن
"أنا شاعر كبير" للبناني رامي الأمين
لولا الكثير من التفسير الذي أوقف السرد الشعريّ عند نقاط تفتيش وهميّة، لامتنعنا عن الاعتقاد أننا أمام تجربة أولى. في "أنا شاعر كبير" (دار النهضة العربية) يفاجئنا رامي الأمين بمخيّلة سعيدة بزلّة قدمها، فخورة بكَسْر يدها أو رجلها لدى القفز خارج حدود الشعر. ثمة مكر طفوليّ في هذا الكتاب. ثمة نبذ للعفّة والتصنّع. ثمة اقتناع بأن القصيدة حرّة أكثر مما نعتقد، وأن للشعر صدراً أرحب من صدورنا جميعاً. بلغة متيقّنة من نجاتها يكتب رامي الأمين عن الآباء الذين لا يحلمون، والإله الأعمى الذي يرتطم بالكواكب، والفتاة المعجبة بأذنيه المعقوفتين كأذنَي ألبير كامو...
"أنا شاعر كبير"... هذا الفتى لا يمزح.
م. ش. د
"ينتظرونكَ" لليبيّة خلود الفلاح
"في الشتاء القادم/ سأشتهي لكِ/ صالة/ لا تتجاهلكِ مقاعُدها./ سأشتهي لكِ
حائطاً يواريك/ سأشتهي لكِ/ كعكاً، خبزاً وجبنة/ سأشتهي لكِ/ برتقالة/ تضيء". هكذا تمنحنا الشاعرة خلود الفلاح في "ينتظرونكَ" (؟؟) تقويماً لا تسقط تواريخه، وجديلة للضوء لا تنكسر خيوطها، وإن تسلقت كلّ تلك الجهات والممرّات. تعيد الفلاح رصف مدوّنة التاريخ بنور زمانها، وأحافير الذكرى تشدّها إلى طفولة حالمة سانحة لصفحات التقاويم، وإن تسلّقت ثلاثين عاماً من الرقص والعزف، فالبيانو ما زال يمنحنا تلك البهجة المختنقة وتلك المغفرة (وصكوكها المزوّرة)، وما زال الوقت ينفض عنّا غبار الخواء ويمسح تجاعيد الحزن، والقمر بدورته تكتمل خصوبة الأنثى منذ بدايات الأمومة في تدوينها للظلّ، عتمة الطين، الانتظار المبجّل للعائد: "على جدران الغرفة/ يستعيرني/ وأنام وحيدة".
استعارة مضيئة (للهوامش)، وحواف المرآة تطلّ على ثلاثين بنفسجة تدسّها الشاعرة في جيب الزمن، وإن لفظت الأمكنة بوحها، أحرفاً ومعنى، أو استباحت مجرّة نسيانها خلف ذاك الانتظار: "خلف الذكرى/ وأنا/ تؤرخ/ هوامش/ المكان". وكأنها مع نصّ ريلكه (تسمع همس كينونتها...)، أو ربما صدى الكلمات التي راوغت ألقها. وللحكاية عطشها، وإن دفنت رغائب انتباهاتها بين نسيج الصمت وحياكة المغيب: "غداً/ ترتدي/ الشمس/ سترة حزني/ وأنا/ أتهيّأُ للمغيب". وعند لحظة انحسار الشراشف عن لونها: ("ما جدوى الشعر في زمن يمتدّ نحو الهاوية" - هيدغر)، ويتواصل العزف خلف الذكرى "الغائمة" حين تلملم جرحها، طائرتها الورقية، فساتينها، ماءها...، وتنزع "الحمائم ريشها إذ يتملكها الأسى". يعلّق النسيان سقف تمدّده فوق ذكريات تتسلل في عمق التفاصيل والأمكنة سرّ التعابير، وإن أدار الزمان ظهره دونما تاريخ، دونما وقت يحين: "لأنهم أطلّوا/ من الشرفة الخطأ/ حرموا أنفسهم/ روعة المشهد".
الشاعرة إزاء ذاتها - أناها تعلن عن حضورها المقروء (نصّاً)، ينسحب للتو من صفر القول إلى درجة صفر الكتابة، وفي تفاصيل الحرف المفاجئ للنفاذ في عتمة اللغة ذاتها.
أبو القاسم المشاي - ليبيا
****
الرجاء عدم إرسال مواد سبق لها أن نُشرت، وإلا ستضطرّ "نقد" إلى وقف التعامل نهائيّاً مع أصحابها
العدد المقبل
نازك الملائكة