 بعد نحو عشرين عاماً من الانكباب على قراءة أعمال الشاعر الألماني الكبير راينر ماريا ريلكه (1875 - 1926) والعمل عليها بحثاً وترجمة، تمكّن الشاعر والأكاديمي العراقي كاظم جهاد من إنهاء تعريب الأعمال الشعرية الكاملة لهذا الشاعر الذي «قاد الشعر الألماني الى الكمال» كما قال عنه الروائي النمسوي روبرت موزيل. لم يكن إقبال جهاد على ترجمة آثار هذا الشاعر عملاً عادياً على غرار الأعمال التي تتمّ في حقل الترجمة أو التعريب، بل كان مشروعاً ذا صفة مزدوجة: مشروعٌ ريلكوي مثلما هو مشروع كاظم جهاد نفسه. ولعلّ هذه الترجمة التي افترضت هذه الأعوام الطوال وإن متقطعة، تدلّ بوضوح إلى أنها فعل إبداعي وليست مجرد نقل من لغة الى أخرى. فالأناة تبدو بيّنة وكذلك الجهد والدأب اللذان بذلهما، هذا الشاعر والمترجم المعاند، الذي انتقل من الفرنسية الى الألمانية بعد أن أصرّ على تعلمها ليكون أميناً على هذه الآثار البديعة. كان جهاد بدأ ترجمة ريلكه عن الفرنسية، متكئاً على الألمانية التي كان يلمّ بها قليل الإلمام، ونشر ترجمته لـ «مراثي دوينو» و «سوينتات الى أورفيوس» بالتعاقب في مجلة «الكرمل» في الثمانينات من القرن المنصرم، وبدت ترجمته تلك، جميلة و «مرجعية» على رغم نقله إياها عن لغة وسيطة هي الفرنسية. بل ان هذه الترجمة استطاعت أن تتجاوز بعض الترجمات التي تمت عن الألمانية مباشرة ولم تكن في حجم الشعرية الريلكوية. لكن كاظم جهاد، ذا المراس الصعب أبى أن تظل آثار ريلكه وقفاً على هذه الترجمة التي قرئت بترحاب حينذاك، فانهمك في دراسة الألمانية التي كان يجيدها قليلاً والتي تعلّمها خلال اقامته في برلين «الغربية» سابقاً.
بعد نحو عشرين عاماً من الانكباب على قراءة أعمال الشاعر الألماني الكبير راينر ماريا ريلكه (1875 - 1926) والعمل عليها بحثاً وترجمة، تمكّن الشاعر والأكاديمي العراقي كاظم جهاد من إنهاء تعريب الأعمال الشعرية الكاملة لهذا الشاعر الذي «قاد الشعر الألماني الى الكمال» كما قال عنه الروائي النمسوي روبرت موزيل. لم يكن إقبال جهاد على ترجمة آثار هذا الشاعر عملاً عادياً على غرار الأعمال التي تتمّ في حقل الترجمة أو التعريب، بل كان مشروعاً ذا صفة مزدوجة: مشروعٌ ريلكوي مثلما هو مشروع كاظم جهاد نفسه. ولعلّ هذه الترجمة التي افترضت هذه الأعوام الطوال وإن متقطعة، تدلّ بوضوح إلى أنها فعل إبداعي وليست مجرد نقل من لغة الى أخرى. فالأناة تبدو بيّنة وكذلك الجهد والدأب اللذان بذلهما، هذا الشاعر والمترجم المعاند، الذي انتقل من الفرنسية الى الألمانية بعد أن أصرّ على تعلمها ليكون أميناً على هذه الآثار البديعة. كان جهاد بدأ ترجمة ريلكه عن الفرنسية، متكئاً على الألمانية التي كان يلمّ بها قليل الإلمام، ونشر ترجمته لـ «مراثي دوينو» و «سوينتات الى أورفيوس» بالتعاقب في مجلة «الكرمل» في الثمانينات من القرن المنصرم، وبدت ترجمته تلك، جميلة و «مرجعية» على رغم نقله إياها عن لغة وسيطة هي الفرنسية. بل ان هذه الترجمة استطاعت أن تتجاوز بعض الترجمات التي تمت عن الألمانية مباشرة ولم تكن في حجم الشعرية الريلكوية. لكن كاظم جهاد، ذا المراس الصعب أبى أن تظل آثار ريلكه وقفاً على هذه الترجمة التي قرئت بترحاب حينذاك، فانهمك في دراسة الألمانية التي كان يجيدها قليلاً والتي تعلّمها خلال اقامته في برلين «الغربية» سابقاً.
بعد تلك الأعوام «المضنية» من العمل الدؤوب والترجمة والبحث والمقارنة استطاع جهاد أن يشيد بالعربية «الصرح الأساس بل الأوحد لآثار ريلكه» متمثلاً في ثلاثة أجزاء تبنّتها دار الجمل وعلى رأسها شاعر آخر هو خالد المعالي. ولعلّ صدورها هو بمثابة الحدث الكبير، سواء في حقل الشعر أو في حقل الترجمة. ومع صدور هذه الأجزاء الثلاثة يمكن القول إن الشاعر ريلكه عرّب كاملاً وأن آثاره باتت في متناول القارئ العربي الذي لا يجيد الألمانية. وهذه الترجمة تنافس بحق الترجمات الأجنبية الأخرى التي وضعت لأعمال ريلكه، ومنها على سبيل المثل الترجمات الفرنسية المتعددة. ترجم كاظم جهاد ريلكه من الألمانية مباشرة، متكئاً على الترجمة الفرنسية في صيغها الكثيرة. وهذا ما منح ترجمته الكثير من الأمانة والدقة و «الخيانة» الشعرية التي لا بدّ منها كي تقارب القصائد منابتها، إلهاماً وسبكاً. وقد أحسن شاعرنا المترجم في إبعاد بعض القصائد الضعيفة التي كتبها ريلكه في صباه ثم أنكرها ورفض إدراجها ضمن أعماله. وبرّر ريلكه لاحقاً إنكاره لأشعاره الأولى قائلاً: «إن أبياتاً كتبناها في عهد الشباب ليست بالشيء الكثير». وقال ان الشاعر تكون لديه في مطلع مسعاه «مشاعر»، لكن الأشعار بنظره «ليست مشاعر»، بل يجب أن تكون «تجارب». وكان جهاد عرّب أصلاً الأشعار التي كتبها ريلكه بالفرنسية وصدرت في مجلد عن الدار نفسها، وغدت الآن كأنها تكمّل أعمال ريلكه، فهي على رغم هامشيتها وموقعها الثانوي في مساره، تظل مرجعاً لمقاربة عالمه الرحب وشعريته الفريدة.
لعلّ أول ما يميز ترجمة كاظم جهاد، ان مترجمها واحد على خلاف الترجمات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية، التي تعاون أكثر من مترجم على إنجازها. وهذا يعني أن فن الترجمة أو صنعة الترجمة خضعت لرؤية ابداعية واحدة وتخلّلها نَفَس شعري واحد هو نَفَس المترجم الذي هو هنا شاعر يتقمّص شخصية ريلكه. تقمّص كاظم جهاد فعلاً «هوية» ريلكه الشعرية وعاش اسراره ونفذ الى عمق كينونته وعانى معاناته الوجودية. لكنه لم يكتفِ بهذه المكابدة، فلجأ أيضاً الى المعرفة النقدية بغية قراءته على ضوء العقل بعدما قرأه في ضوء الحدس الداخلي. والمراجع التي اعتمدها ليضع مقدمته والشروح الفائضة والمهمة التي أرفقها بالقصائد، تثبت حقاً مدى اضطلاعه في الحقل الريلكوي، شعراً وفكراً.
حدس المترجم
هكذا ارتكز جهاد في آن واحد الى حدسه كشاعر، والى وعيه كناقد أكاديمي والى ذائقته كقارئ، وراح يترجم القصائد وكأنه يكتبها أو يبدعها بالأحرى. ولولا الحب الكبير الذي يكنه لريلكه، الحب الذي يتخطى فعل الإعجاب، لما تمكّن من مواصلة هذا العمل، المحفوف بـ «الأخطار» والمزالق والمهاوي. انه الحبّ مضافاً اليه التماهي مع صورة هذا الشاعر الذي يصبح هو المترجَم والمترجِم. ومَن يقرأ ترجمة كاظم جهاد، هذه الترجمة الإبداعية الفريدة القائمة على «التحدي» أو «الرهان» يشعر أن القصائد كلّها خاضعة لنَفَس شعري واحد، يتقطع في تقطعها وينساب في انسيابها، يعلو ويهبط في علوّها وهبوطها. انه النَفَس الواحد الذي يجمع بين «كتاب الصور» و «كتاب الساعات» و «سونيتات الى أورفيوس» و «مراثي دوينو» وسواها من الأعمال التي تختلف بقدر ما تتناغم، وتتنافر بقدر ما تتآلف. والكيمياء الشعرية التي اعتمدها ريلكه في لغته والحيلة التي ارتآها في لعبة «القلب» (كما يسمّيها جهاد) هما الكيمياء نفسها والحيلة نفسها اللتان وقع المترجم عليهما. ولعل متعة القراءة التي تخالج قارئ هذه الأعمال في صيغتها العربية، لا تضاهيها متعة قراءة الترجمة عادة. انها متعة قراءة النص الأصل في مرآة النصّ المترجم. وقد يشعر هذا القارئ انه مشدود الى هذه الأعمال متتالية، جزءاً تلو جزء، يلتقطه هذا الإيقاع الشعري المتفجّر في النثر، وتلك السلاسة التي لا يحول دون انسراحها غموض الشعر أو إبهامه وانغلاقه «الهرمسي» في أحيان، وكذلك وعورة معانيه واستحالة تأويلها. ليست الترجمة هنا تمريناً شعرياً، انها
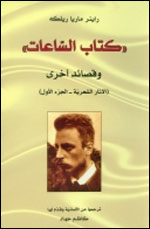 فعل عيش وتجلٍّ، انها عملٌ جاد حقاً، مهما اختلف القارئ مع المترجم على صيغة هنا أو جملة هناك أو مفردة هنالك. هذا انجاز لا يقدر على إتمامه إلا الملهمون. فالشاعر ريلكه لا يمنح مفاتيحه بسهولة، بل هو يخفي مفاتيحه قصداً، تاركاً القارئ (أو المترجم) يتدبر أمره. أما لغته، المتراوحة بين بعدين، خارجي أو وصفي، وداخلي أو ملغز، فهي بدورها لا تفتح بابها أمام أول طارقٍ، بل ان الطارق قد يحتاج الى خلع الباب والدخول اليها عنوة. ولا يمكن هنا تناسي الخزين الهائل الذي يخفيه أو يُظهره شعر ريلكه، وكأنه مصهر الثقافات والحضارات والأديان والمعارف...
فعل عيش وتجلٍّ، انها عملٌ جاد حقاً، مهما اختلف القارئ مع المترجم على صيغة هنا أو جملة هناك أو مفردة هنالك. هذا انجاز لا يقدر على إتمامه إلا الملهمون. فالشاعر ريلكه لا يمنح مفاتيحه بسهولة، بل هو يخفي مفاتيحه قصداً، تاركاً القارئ (أو المترجم) يتدبر أمره. أما لغته، المتراوحة بين بعدين، خارجي أو وصفي، وداخلي أو ملغز، فهي بدورها لا تفتح بابها أمام أول طارقٍ، بل ان الطارق قد يحتاج الى خلع الباب والدخول اليها عنوة. ولا يمكن هنا تناسي الخزين الهائل الذي يخفيه أو يُظهره شعر ريلكه، وكأنه مصهر الثقافات والحضارات والأديان والمعارف...
لم يلتزم كاظم جهاد قواعد الترجمة الحرفية والمنضبطة التي تتم عادة على حساب جمالية القصيدة أو شعريتها. فهو أعمل قلمه كشاعر وراح يضفي لمساته ويقترح صيغه أو «سبائكه»، معرّباً أكثر منه مترجماً. والأمثلة التي يمكن ايرادها عن فرادة لعبته الخطرة لا تحصى. ومَن يقارن مثلاً بين الترجمة الفرنسية والترجمة العربية يكتشف مبلغ الجهد اللغوي والشعري الذي بذله جهاد ليخرج بصيغة جميلة أو بديعة. يستهل جهاد، على سبيل المثل أيضاً، ترجمته لقصيدة ريلكه الشهيرة جداً «أغنية عشق حامل الراية كريستوف ريلكه ومصرعه»، بمطلع عربي جداً وكأنه يبغي تجذيرها عربياً على رغم غرابة جوّها.
ولئن سعى مترجم (هو كاتب هذه السطور هنا) أن يعرّب الترجمة الفرنسية التي أنجزها موريس بيتز للقصيدة نفسها، فالمطلع سيكون على هذا الشكل: «تعدو الخيول، تعدو، تعدو، نهاراً، ليلاً ونهاراً. تعدو، تعدو، تعدو. القلب متعبٌ، جدّ متعب والحنين جدّ قويّ...». أما كاظم فترجم المطلع في هذه الصيغة العربية جداً: «تخبّ جيادنا وتخبّ، خبب في النهار، خبب في الليل، خبب في النهار وفي الليل. خبب، خبب، خبب وقلوبنا أعياها التعبُ، والحنين فيها عارم...». ومع أن القصيدة هذه نثرية تماماً، استعان جهاد بوقع «الخبب» ليمنح مطلع القصيدة ايقاعاً هو ايقاع عدو الخيول الذي يمثله «الخبب» خير تمثيل.
بعيداً عن البلاغة
والملاحظ أنّ جهاد، في عمله القويّ والرصين على نقل القصائد وتعريبها تحاشى الوقوع في أسر البلاغة أو الفصاحة، ولم يسع الى جعل النصّ العربي حيّزاً لإبراز متانته في النسج والسبك، بل ظل وفياً للقصائد التي تبدو كأنها طالعة من عمق دخيلته. وتجلّى «صنيع» جهاد أقصى تجلّيه في تعريبه «المراثي» و «السونيتات» و «كتاب الصور» وسواها. فـ «المراثي» التي شغلت المترجمين الفرنسيين مثلاً، فتعدّت ترجماتها العشر، إن لم يكن أكثر، يتصدّى لها جهاد بما يلائمها من صوغ لغوي وتجلّ روحيّ وعمق رمزي وفلسفي و «ديني». وقد حافظ على غموض النص ولم يحاول تفسيره - وهو أصلاً يتحاشى الترجمة التفسيرية - وأبقى على جدليته المتراوحة بين الخارج والباطن. وقد أوجد صيغة يمكن اعتبارها بمثابة «الحل» لهذه «المراثي» لا سيما «المرثية الأولى» التي يمثل مطلعها «توطئة» ملغزة لعالمها: «مَن لو صرخت سيسمعني/ في مراتب الملائكة؟ ولو حدث يوماً/ أن يضمّني أحدهم فجأة الى قلبه/ فسأفنى بباعث من حضوره القوي. ذلك أن الجمال/ إن هو إلا بداية الرعب، ما لا نكاد نقدر أن نحتمله...». أما «سونيتات الى أورفيوس» فوجدت في العربية مبتغاها، لغوياً ورمزياً، وقد استهل جهاد ترجمته مطلع «السونيته» الأولى كما يأتي: «ها قد انبثقت شجرة. يا للتجاوز النقي/ كان أورفيوس يغني! يا لها شجرة سامقة في الأذن! ثمّ سكت كلّ شيء. لكن في ذلك السكوت/ كانت تولد بداية جديدة، علامة وتحوّل».
 قد يختلف القارئ مع كاظم جهاد حول بعض اقتراحاته - والترجمة اقتراح - والصيغ التي استخدمها أو حول «وعورة» هنا أو «حوشية» و «ضعف» في الأداء هناك، أو حول تأويل أو إلغاز وسواهما، لكنه لا يستطيع إلا أن يعجب، بل ويدهش، بهذا العمل الرصين والمتين والبديع، الذي نجح كل النجاح في ترسيخ المناخ الريلكوي عربياً وفي ربط القصائد والدواوين بعضها ببعض عبر خيط داخلي، كأنه الظلّ الذي يرقد وراء اللغة أو في قلبها. وكم يبدو صعباً بحقّ التقاط هذا الخيط الذي لا يقوم شعر ريلكه من دونه. ومثله أيضاً يبدو تجسيد المناخ الريلكوي، صعباً، شديد الصعوبة، في لغة غريبة عنه هي العربية. وقد تمكّن جهاد من انجاز هذين الفعلين، مصغياً الى صوت ريلكه، الصوت الخفي، ومتأملاً بروحه، روح ريلكه وعقله، ومستخدماً عينيه ليرى رؤيته الى العالم والحياة وما وراءهما. لقد أدرك المترجم - الشاعر ان الترجمة اصغاء قبل أن تكون عملاً كتابياً.
قد يختلف القارئ مع كاظم جهاد حول بعض اقتراحاته - والترجمة اقتراح - والصيغ التي استخدمها أو حول «وعورة» هنا أو «حوشية» و «ضعف» في الأداء هناك، أو حول تأويل أو إلغاز وسواهما، لكنه لا يستطيع إلا أن يعجب، بل ويدهش، بهذا العمل الرصين والمتين والبديع، الذي نجح كل النجاح في ترسيخ المناخ الريلكوي عربياً وفي ربط القصائد والدواوين بعضها ببعض عبر خيط داخلي، كأنه الظلّ الذي يرقد وراء اللغة أو في قلبها. وكم يبدو صعباً بحقّ التقاط هذا الخيط الذي لا يقوم شعر ريلكه من دونه. ومثله أيضاً يبدو تجسيد المناخ الريلكوي، صعباً، شديد الصعوبة، في لغة غريبة عنه هي العربية. وقد تمكّن جهاد من انجاز هذين الفعلين، مصغياً الى صوت ريلكه، الصوت الخفي، ومتأملاً بروحه، روح ريلكه وعقله، ومستخدماً عينيه ليرى رؤيته الى العالم والحياة وما وراءهما. لقد أدرك المترجم - الشاعر ان الترجمة اصغاء قبل أن تكون عملاً كتابياً.
إلا أن أهمية أعمال ريلكه الشعرية كما عرّبها كاظم جهاد، لا تكمن فقط في صيغتها المتينة وإبداعيتها وانما في بعدها النقدي أيضاً. فقد أرفق المترجم معظم القصائد بشروح وهوامش لا بدّ منها لفهم «الشعرية» الريلكوية. وبدت كتابته لهذه الشروح عملاً نقدياً يوازي فعل الترجمة. فهو اعتمد الكثير من المراجع، الألمانية والفرنسية، ليضع هذه الشروح، وعمد الى حبكها بعضها ببعض، مذكراً بما سبق من شروح، ومتكئاً على السياق العام للمسار الريلكوي أو التجربة الريلكوية، وأوضح في الشروح هذه العلاقات التي نسجها ريلكه، بين القصائد نفسها، بين القصائد والأمكنة، وبين القصائد وأبعادها التاريخية والرمزية والفنية. وقد يشعر القارئ - وهذا ما شعرت به شخصياً - أنه لا يحتاج الى العودة الى أي مرجع آخر، ما دامت الشروح تضع أمامه خلاصات ومقاربات متعددة بتعدّد القصائد نفسها. وهذا عمل أكاديمي يتطلب الكثير من الصبر والجهد نظراً الى منهجيته وصرامته.
ولم يكتف كاظم جهاد بوضع مقدّمتين للأعمال، كتبهما هو، بل استعان بمقدمة هائلة كان وضعها الباحث النمسوي غيرالد شتيغ لأعمال ريلكه الكاملة في ترجمتها الفرنسية الصادرة في سلسلة «لابلياد» الشهيرة. لكن جهاد لم يترجم المقدمة حرفياً بل لخّصها في ما يقارب المئة صفحة، وبدت أقرب الى البحث الأكاديمي العميق والشامل، الذي يلقي أضواء
ساطعة على أعمال ريلكه ودواوينه كلها، واحداً تلو الآخر. تضع هذه المقدمة أمام القارئ، عالم ريلكه، بفلسفته ورموزه وأسراره والخصائص التي وسمته، وتتابع الظروف التي كتب فيها والمعاناة التي كابدها في فعل الكتابة، والخلفيات الكامنة وراء القصائد، والأبعاد الكامنة في صميمها. وباتت هذ المقدمة الطويلة مرجعاً مهماً بالعربية لقراءة ريلكه والإحاطة بعالمه المعقد. وقد تحتاج الى قراءة خاصة مثلها مثل مقدمة جهاد الثانية التي تتناول شعرية ريلكه.
أمضى كاظم جهاد عشرين عاماً في رفقة ريلكه، باحثاً وقارئاً ومترجماً. قد تكون هذه الأعوام طويلة، لكن ريلكه يستحقها فعلاً، وقد استطاع جهاد أن ينجز خلالها عملاً إبداعياً كبيراً. لقد حلّ ريلكه أخيراً ضيفاً على العربية وكانت استضافته فعلاً خير استضافة. وبدءاً من الآن سيكون ممكناً البحث عن أثر ريلكه في الشعر العربي الراهن.
جريدة الحياة
بيروت، 24 كانون الأوّل/ديسمبر 2009
***
راينر ماريا ريلكه عربيّاً
كان صدور «الآثار الشعرية الكاملة» (دار الجمل) التي كتبها راينر ماريا ريلكه بالألمانية حدثاً بارزاً هذه السنة، ولن نجد هدية شعرية أثمن يمكن أن نقدمها إليك أيها القارئ. قد يخطر في بالك أنّ ريلكه أكثر دسامةً وتعقيداً مما تكون عليه الهدايا عادةً، ولكن هذا الإيحاء - وهو حقيقي للمناسبة - سينقشع بسرعة حين تبدأ بتصفُّح أعمال شاعر تتغذَّى مخيّلته الشعرية من هشاشته الداخلية التي قد ترى فيها هشاشتك وهشاشة الكائن الإنساني في المطلق. إذا كنت من عشاق الشعر ومتابعيه، فلن تكون هذه الترجمة الجديدة والمتكاملة التي أنجزها الشاعر العراقي كاظم جهاد غريبةً عنك. لا بدّ أنكَ قرأت سابقاً «مراثي دوينو» بترجمة فؤاد رفقة، ولا بدَّ أنّ مطلع المرثية الأولى لا يزال يتردد في ذاكرتك: «من لو صرختُ سيسمعني/ في مراتب الملائكة؟ ولو حدث يوماً/ أن يضمَّني أحدهم فجأة إلى قلبه/ فسأفنى بباعثٍ من حضوره القوي/ ذلك أن الجمال/ إنْ هو إلا بداية الرعب، ما لا نكاد نقدر أن نحتمله/ ولئن كنا نلفيه جميلاً فلأنه، ببرودٍ، يأنفُ من تحطيمنا/ مرعبٌ هو كلُّ ملاكْ». أمامك إذاً فرصة ثانية للتلذّذ والصمود في وجه «العاصفة الإلهية التي لا يحتملها أحد»، كما وصف ريلكه نفسه مراثيه التي نادراً ما نجا قارئٌ من تأثيرها كواحدة من صروح الشعر الخالدة والفريدة، حيث يتحالف الإنشاد الجنائزي مع العزلة القصوى للكائن من أجل تحويل جوهر الوجود الإنساني إلى صورٍ واستعاراتٍ آسرة.
ثمة عوالم وتأويلات وترميزات هائلة تربض تحت قصائد ريلكه التي ستبدو لكَ منسابةً ومموسقة كأنها محض لحنٍ شجيٍّ وحزين. يمكنك أن تكتفي بالمعاني التي تصلك على الفور. لكن حتى هذه القراءة العاجلة لن تُنجيك من المذاق الشعري الذي لم تجرّب مثيلاً له من قبل. أغلب الشعراء الألمان استثمروا هذه المناخات وحوَّلوها إلى ممارسة شعرية تعادل ممارسات زملائهم الفلاسفة. هناك أبديّة ما تصاحب أعمالهم إلى حدٍّ شاع فيه أن الشعر الألماني يعيش مع الفلسفة تحت سقف واحد. ألم يقل هايدغر: «كل ما كتبته في كتابي «الكينونة والزمان» موجود في شعر ريلكه»؟.
كان الموت الشغل الشاغل لقصائد ريلكه. كأن الكتابة كانت تأملاً متواصلاً في معنى الفناء. الشاعر الذي ستحلُّ ذكرى رحيله الثالثة والثمانين بعد خمسة أيام، كتب يوماً قصيدة عُدّت شاهداً على قبر: «الموت كائنٌ كبير/ ونحن أبناؤه/ بأفواهنا الضاحكة/ وعندما نحسبُنا في صميم الحياة/ يجرؤ هو على البكاء/ في داخلنا».
رغم أنك تقرأ شعراً مترجماً، إلا أنك ستسأل نفسك: لِمَ يترقرق ما أقرأه بهذه العذوبة الصافية؟ الحق معك. لقد بُذِل جهدٌ كبير من صاحب القصائد - ومن مترجمها - كي تحظى بهذا الكنز الشعري المشعّ. ستُلفتك المهنية والذكاء في تتبِّع مقاصد ريلكه، سواء في المقدِّمة الشفافة للترجمة أو في القصائد نفسها وقد انتقلتْ - محتفظةً بمعظم حمولتها الشعرية - إلى لغة الضاد.
جريدة "الأخبار"
بيروت، 24 كانون الأوّل/ديسمبر 2009
****
ريلكه وبؤس الحضارة المعاصرة
قَل أن تيسر لشاعر ألماني باستثناء غوته أن يقف على الأسرار العميقة للشعر وأن يمتلك الموهبة الغنية والمتفجرة التي امتلكها راينر ماريا ريلكه، فهذا الشاعر الذي لم يعش أكثر من نصف قرن من الزمن والذي توزعت حياته بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين يبدو من خلال تفرسه في عناصر الوجود ومعنى العالم، كما من خلال المروحة الواسعة من الموضوعات التي قاربها استثنائياً بكل المعايير ممسوساً بلهب الكتابة التي أسهم من خلالها في رفد الحداثة الشعرية العالمية بأكثر وجوهها عمقاً وفرادة واتصالاً بجوهر الشعر، ورغم أن تجربة ريلكه الأدبية قد توزعت بين ضروب عدة من التعبير، وهو الذي ترك لنا أعمالاً متميزة في الرواية والمسرح والرسائل والنقد الأدبي والتشكيلي، إلا أن فتوحاته الشعرية تظل الأبرز والأخطر والأغنى بالكشوف بين مختلف نتاجاته الإبداعية.
من هنا تكتسب البادرة الرائدة التي قام بها الشاعر العراقي كاظم جهاد في ترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لصاحب “مراثي دوينو” و”سونيتات الى اورفيوس” أهمية بالغة بالنسبة للقارئ العربي الذي لم يتيسر له حتى الآن أن يطلع بشكل كاف على شعرية ريلكه المشبعة بالمعرفة والاطلاع الواسع لا على ثقافة عصره وشعبه الألماني فحسب، بل على ثقافات العالم المتنوعة عبر الأزمنة كلها. صحيح أن ترجمات عدة لريلكه قد سبقت ترجمة كاظم جهاد ومن بينها ترجمة الشاعر اللبناني فؤاد رفقة، ولكن هذه الترجمات ظلت مجتزأة ومحصورة في مجموعات وأعمال محددة بخلاف ما فعله جهاد الذي يبدو في الآونة الأخيرة كأنه كرّس معظم حياته لهذا النوع من الترجمات التي تسد ثغرة كبيرة في المكتبة العربية بوجه عام، وفي مجال الأدب العالمي المترجم على وجه الخصوص.
في ديوانه المنقول الى العربية تحت عنوان “كتاب الصور” يقدم ريلكه نموذجاً باهراً وفريداً عن الشعر الذي لا يأبه بالعرض الجمالي والزخارف الخادعة مؤثراً أن يلتصق بالحياة في تفتحها الجوّاني ودبيبها الأعمق، وقد بدا ذلك جلياً من خلال تبرمه من الحضارة الغربية التي عملت رغم بريقها الخلّبي على إفقار الإنسان وتهميشه وسحقه بشكل تام تحت وطأة الآلة الصماء وجشع المجتمع الرأسمالي، وإذا كان الشعور بالمرارة والغربة قد واكب ريلكه في مدينته برلين فإنه قد تبلور بشكل أوضح لدى إقامته في العاصمة الفرنسية باريس التي أقام فيها لفترة من الزمن وكتب عام 1906 العديد من القصائد المكرسة للتبرم من المدينة واحتجاجه على قسوتها، ففي قصيدته المميزة “أصوات” يرسم ريلكه تسع لوحات متتالية تعكس كل منها حالة من أحوال البؤس والغربة البشريين وتؤلف مجتمعة جدارية كبيرة للمدينة التي لا يتسع صدرها لغير الأثرياء والمترفين وذوي النفوذ بينما لا يكف منبوذوها وهامشيوها عن التكاثر، وهو ما يتلمسه القارئ بوضوح في الحديث عن الأرملة والأبله واليتيمة والقزم والمجذوم والمنتحر بحيث يعكس هؤلاء جميعاً الصورة القاتمة لعالم الغرب المديني، ولا يملك الشاعر سوى أن يعلن بلسان بطله الأعمى: “أنتم تسيرون متدافعين/وتحسبون أنكم لا تحدثون ما يشبه صخب تراطم الحجارة/ولكنكم مخطئون/فأنا وحدي أحيا وأتعذب وأصخب/وفي داخلي صرخة غير متناهية/ لست أعرف من يطلقها/قلبي أم أحشائي؟".
ليس الشعر بالنسبة لريلكه كما لجميع الشعراء العظام مجرد تصريف جمالي للعواطف والمشاعر الفائضة بقدر ما هو رؤيا ومكاشفة صعبة واستنطاق للتاريخ والزمن والصيرورة، وقد يكون الشعراء الألمان بهذا المعنى هم الأقدر من سواهم على ربط الشعر بالفلسفة وإعطائه أبعاداً معرفية وميتافيزيقية وفكرية لم تكن لتنفصل بأي وجه عن الحراك المتسارع للمجتمع الألماني وعن نزوعه المتعاظم الى التفرد وإثبات الوجود. يكفي أن نذكّر في هذا السياق بكتاب غوته الشهير “فاوست”، حيث البطل يبيع نفسه للشيطان مقابل الحصول على العلم والمعرفة، أو بكتاب نيتشه “هكذا تكلم زرادشت”، حيث يتم تمجيد القوة وإعلاؤها بشكل غير مسبوق، لكي نكتشف بوضوح قدرة الأدب والفكر الألمانيين على التأثير في مجريات الأحداث في تلك الحقبة المفصلية من تاريخ أوروبا والعالم.
لقد تشارك ريلكه مع فرانس كافكا، وكل من موقعه في كشف النقاب عن استلاب الإنسان في الحضارة الحديثة وعن الرعب الذي يتهدد الجنس البشري في صراعه اليائس ضد قوى الاستغلال المهيمنة وفولاذ الآلات العمياء.
لذلك تبدو بعض قصائد ريلكه من حيث طبيعتها السوداء ورؤيتها الكارثية للعالم شبيهة ببعض أسفار التوراة وبخاصة في نبوءات أشعيا وحزقيال ومراثي إرميا، وبخاصة في قصيدته الكابوسية “مشهد من ليلة عاصفة” التي ترمز بوضوح الى ما ينتظر الإنسان المعاصر من أهوال حيث “تسري النيران في قاعة الأوبرا/وكمثل وحش تبتلع القاعة الواسعة بصفوف مقاعدها كلها، وتبتلع الحشد المتدافع فيها بالآلاف/وتروح تعلكهم رجالاً ونساء/منحشرين في الدهاليز”.
جريدة الخليج
الشارقة، 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2009