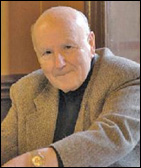 من الصعب العثور في عالمنا العربي على شاعرٍ يتمتّع بجاهزية دائمة وعالية للتحاور حول الشعر وشؤونه، مثل شاعرنا الفرنكوفوني صلاح ستيتية. ومن النادر أيضاً العثور على معادلٍ له في النشاط الكتابي الغزير التي يشهد عليه عدد اصداراته السنوية، شعراً ونقداً، أيضاً عدد المقالات والدراسات التي تتناول هذا الإنتاج الكمّي والنوعي. لمناسبة نيله «الجائزة العالمية للشعر» (بروكسل) على كامل أعماله الشعرية وصدور ديوانه الجديد «سيولة الموت» وبحثه الشعري الجديد «ليل المادة» (دار «فاتا مورغانا»)، أجرت «الحياة» معه هذا الحوار الخاطف والعفوي:
من الصعب العثور في عالمنا العربي على شاعرٍ يتمتّع بجاهزية دائمة وعالية للتحاور حول الشعر وشؤونه، مثل شاعرنا الفرنكوفوني صلاح ستيتية. ومن النادر أيضاً العثور على معادلٍ له في النشاط الكتابي الغزير التي يشهد عليه عدد اصداراته السنوية، شعراً ونقداً، أيضاً عدد المقالات والدراسات التي تتناول هذا الإنتاج الكمّي والنوعي. لمناسبة نيله «الجائزة العالمية للشعر» (بروكسل) على كامل أعماله الشعرية وصدور ديوانه الجديد «سيولة الموت» وبحثه الشعري الجديد «ليل المادة» (دار «فاتا مورغانا»)، أجرت «الحياة» معه هذا الحوار الخاطف والعفوي:
هل ما زال الشعر يحافظ على روابط مع المقدَّس والفلسفة؟
- في رأيي، لم تنقطع العلاقات إطلاقاً بين الشعر والمقدَّس، على الأقل بالطريقة التي أنظر فيها إلى كل منهما. أكثر من ذلك، في الوقت الذي يهجر المقدَّس تدريجاً حياة البشر ونشاهد، كل يوم أكثر فأكثر، استخدام اللغة ومصطلحاتها لغايات نفعية، وإن كان ذلك في إطار علمي أو تكنولوجي، يلتقط الشعر من داخل حقل الكلام بقايا المقدَّس ويحاول من خلالها إعادة تكوين وحدة الإنسان والكون، وحدة الإنسان داخل الكون. بالنسبة إلى الفلسفة، ما زلتُ على اعتقادي بأنها غير مرصودة للتعبير بطريقة شعرية، وكل مرّة سلكت فيه هذا السبيل، كان ذلك على حسابها وحساب الشعر معاً.
أين موقع «الأنا»، الغالية على قلوب الرومنطيقيين، داخل الشعر اليوم؟
- لعل الإنسان يحضر بقوة أكبر في إرادته على الامحاء (مالارمي، بونغ، دو بوشي، دوغي) من ذلك الحضور القائم على تركيز الواقع بكلّيته حول «أنا» طاغية، وأحياناً عدائية. أرى حضوراً أكبر للإنسان في الكلمة «السلبية» التي لا تريد التمسّك إلا بالعالم، من حضوره في الكلمة التي تتوجّه مباشرةً إلى قارئها انطلاقاً من حالةٍ يطغى عليها الطابع الذاتي. الرومنطيقيون الفرنسيون يظهرون اليوم لنا أقل حدّة إنسانية وأكثر تصنّعاً وفصاحة (بالمعنى السلبي) من بعض الشعراء المتعلّقين «بالشيء» أو بقضايا يفرّغون «أناهُم» لخدمتها بطريقة أفضل.
هل يمكننا أن نتحدّث عن موضوعات خاصة بالشعر؟
- أجل. ربما. كل الموضوعات المتعلقة بلغز الكينونة الأساسي (علة وجودنا في هذا العالم وغرابة وضعنا) هي من الموضوعات المفضّلة للقصيدة. لكننا نعرف أيضاً، بفضل مالارمي ورامبو وبونفوا وبونج وشعراء آخرين، أن اللغز الجوهري للشعر هو تمركزه داخل اللغة. الشعر الأكثر حداثة جعل من اللغة أحد موضوعاته الرئيسة، ما فتح الحقل الشعري على تجارب جديدة معظمها مبنية على اللغة ومفرداتها، كالتيار الحَرفي (lettrisme) والحركة الدادائية، على الأقل على صعيد نيّتها المعلنة – تدمير اللغة.
هل يجب دائماً في الشعر تقبّل الأشكال الشعرية الجامدة (كالبُحور) والإيقاعات التي كرّسها التقليد؟
- منذ الحركة السرّيالية، اكتسب الشعر الفرنسي حقاً لا يمكن التصرّف به يمنحه حرية الاختبار على المستوى الشكلي. عودة بعض الشعراء إلى أشكال جامدة هي، في نظري، حركة تراجعية بالنسبة إلى الحرية المنتزَعة، وتعكس لدى صاحبها نوعاً من الخجل أمام استخدامٍ منفتح ومبدِع للغة وللإيقاعات التي تلازمها. لكن، في حال نجح بعض الشعراء في إيصال حقيقة تجاربهم ومشاعرهم من خلال هذه الأشكال الجامدة، لم لا؟ أنا أتقبّل ذلك.
ما رأيك بالبُعد الطِباعي أو الإخراجي (توظيف البياض، التلاعب بالأسطر، القصائد التصويرية) داخل القصيدة؟
- كما أن بعض الرسّامين أدخلوا حروفاً أو علاماتٍ حسابية على لوحاتهم، يمكن أن ينفع اللجوء إلى ابتكاراتٍ جمالية داخل الشعر وأن يضاف إلى القصيدة معنى شعري. مالارمي منحنا دليلاً دامغاً على ذلك في الشكل الطِباعي الشهير لنصّه «رمية نرد». وتشكّل قصائد أبولينير التصويرية (calligrammes) جزءاً من هذه المعجزات. فطريقة ترتيبها، على بساطتها، تضيف على انفعالات القصيدة بُعداً من الدهشة لا يخلو من السحر. أما البياض في شعر دو بوشي، الذي اعتمده بعده شعراء كثر، فيُشكّل جزءاً من «صمت» قصيدته. لكن يجب أن يقف خلف استخدام فن الطباعة أو الإخراج في القصيدة شاعرٌ عليمٌ ومجرَّبٌ واثقٌ من وقع ابتكاراته الجمالية، وإلا حلّ الاعتباطي والسخيف في القصيدة وانحرفا بها عن غايتها الجوهرية.
هل لا بد من قطيعة جذرية مع التقليد الشعري؟
- القطيعة ضرورية كلّما استهلك التقليد موضوعاته وتحجّر على شكل بنياتٍ طاغية وغير مخصّبة للمعنى الذي تحمله. في كل مرة نقع فيها أمام شكلية معيّنة، يجب أن نتحلّى بشجاعةٍ كافية لتحطيمها وللتسبب في ولادة صدفةٍ جديدة. لكن في كل الأشعار المجدِّدة، من النادر أن تكون القطيعة بالجذرية التي تظهر بها في البداية، وغالباً يبقى التقليد المُستهدَف أو المُلغى مستخدماً كركيزة، داخل لاوعي اللغة، لكل التجليات التي تستهدف تدميره. بعد إفراطٍ معيّن من التجديد، يمكن التقليد أن يعود من جديد مصدراً لكثيرين في سياق البحث عن توازنٍ جديد للنص داخل فضاء اللغة الشعرية. «المخيلة هي الذاكرة» (أي التقليد أيضاً)، وفقاً لبيكاسو الذي كان يعلم عمّا يتحدّث.
ما رأيك بالشعر السمعي، أو ما يُسمّى بالأداء، الذي يحتل أكثر فأكثر الساحة الشعرية؟
- لا قاعدة مفروضة. ثمة كتابات شعرية تستدعي الشفهية والفيض السمعي أكثر من غيرها. يصعب علينا أن نتخيّل قراءةً بصوتٍ خافت «لأسطورة الأزمنة» (هوغو)، كما يصعب علينا تخيُّل قراءة مالارمي بصوتٍ عالٍ. كلوديل كان يحب أن يصغي إلى نفسه وهو يقرأ قصائده بصوتٍ عالٍ، من هنا الجوهر الشعري لمسرحه، بعكس سان جون برس الذي عرفته وكان مخاطباً فريداً. من دون شك ثمة وضعية متوسِّطة تلتقط فيها الأذن الداخلية ما تقرأه العينان. «العين تسمع»، وفقاً لكلوديل. على أي حال، يقع امتحان النص الشعري في اللحظة التي ينتقل فيها من حالة مرئية إلى حالة مسموعة. ففي هذه اللحظة مثلاً، يتجلى كل الشعر الموجود في نص (الكاتب المسرحي) راسين المرتبط في صورة حميمة بموسيقى اللغة الفرنسية.
كيف تنظر إلى الروابط بين الشعر وسائر الفنون (موسيقى، رسم، سي نما...)، وبخاصة الفنون التي تعتمد التكنولوجيات الحديثة (فيديو، الأجهزة المعلوماتية والسمعية...)؟
- في ما يتعلق بعلاقة الشعر مع فنّي الرسم والموسيقى، نعرف أن الرسامين أسقطوا خطوطهم وألوانهم على القصيدة منذ فترة طويلة، كما أسقط الموسيقيون نوتاتهم على نصوصٍ قادرة على الأخذ في الاعتبار، وبالصوت، موسيقاهم.
نظرية هذه التداخلات المبدِعة ثبّتها بطريقةٍ نهائية بودلير في قصيدته «تطابقات».
نعم، هناك «وحدة عميقة وغامضة» بين الفنون يحاول الفنانون، في مختلف أنواعهم وميادينهم، منذ قرنٍ على الأقل، التعمّق في طبيعتها ولغزها. وشارك في هذا الجهد بعض علماء الدلالة، مثل جاكوبسُن وليفي- شتراوس.
السينما أيضاً استوحت من الشعر، كما يشهد «المناخ الشعري» الذي نلاحظه في بعض الأفلام. يمكن لفيلم «العام الماضي في مارينباد» أن يشكّل مثلاً على تداخلٍ بين الصورة والعقدة والحوار والهالة الشعرية. كل فيلم كبير هو، في العمق، فيلم شعري، وكل مخرج سينمائي كبير هو شاعرٌ أيضاً. ثمة شعراء عملوا في مجال السينما، مثل بريفير الذي حقق حوارات فيلم «أطفال الجنة» الرائع.
وباستثناء السينما، لا أظن أن التكنولوجيات الحديثة نجحت، على الأقل إلى اليوم، في محاولة اتصالها بالقصيدة. لكن هذا سيحصل من دون شك.
هل تؤمن بتجمّعات كتلك التي حصلت في السابق حول دار نشرٍ أو مجلة، أو حول شخصيةٍ مغناطيسية؟
- طبعاً. كل تاريخ الشعر الحديث والمعاصر يشهد على تجمّعاتٍ على أساس التجانُس النخبوي أو الأهداف المشتركة التي يتم السعي خلفها ما وراء شخصية كل فرد. حصل ذلك في القرن التاسع عشر وفي القسم الأول من القرن العشرين في كل الفضاءات الشعرية: فرنسا، روسيا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، العالم العربي... مثلان من الفضاء الفرنسي يشهدان بقوة على ذلك: الأجيال السرّيالية الأربعة التي تجمّعت حول بروتون، شعراء مجلة «الزائل» الذي تجمّعوا حول بونفوا. في العالم العربي، لدينا التجمّع المثير حول مجلة «شعر» الذي أنجب الحداثة العربية وأظهر مدى ترابُط الشعر والشعراء ما وراء الثقافات واللغات. وغالباً، تقرّب رسامون ومسرحيون وموسيقيون من هذه المجموعات للتعبير عن تواطؤٍ معها.
هل على الشعر أن يشهد على عصره، أن يلتزم؟
- حصل ذلك خلال الحروب ومقاومة الاحتلال. نعرف في فرنسا مثلاً أهمية الشعر «المقاوِم» والملتزم مع أراغون وإيلوار وديسنوس وشار وكثيرين غيرهم. يمكن الشاعر أيضاً أن يلتزم الدفاع عن قضايا اجتماعية، كالشعر الشيوعي في العالم كله وبمختلف اللغات: ماياكوفسكي، ألكسندر بلوك، غوتفريد بن، برتولد برخت، محمد مهدي الجواهري... الشعر العربي المعاصر التزم أيضاً قضايا التحرّر من الاستعمار والقضايا الاجتماعية، ومع محمود درويش وآخرين ناضل للاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني. لكن الأهم أن القضية لا تصنع الشاعر. فهذا الأخير، حين يلتزم قضية ما، يمنح التزامه بعداً شعرياً عميقاً. في أي حال، الشاعر يلتزِم دائماً استكشاف الوضع البشري الذي، بدوره، يستدعي توتر الكائن الشعري بكلّيته بهدف توضيح، اللغز المركزي للكينونة، «تلك النواة الليلية التي يتعذّر كسرها (بروتون) بواسطة اللغة.
المقاومة، في أنحاء العالم، كان لها شعراؤها: برايتنباخ في جنوب أفريقيا، لوركا خلال صعود فرانكو في أسبانيا، وقبله والت ويتمان في الولايات المتحدة الذي صارع بصوته العاري التزمّت السائد، ثم شعراء «جيل البيت» الذين نددوا بالمجتمع الأميركي التجاري الجشع. الشاعر يتشرب عصره من مسامه ولا يمكنه عدم متابعة انعطافاته المهمة أو التشدد الظلامي للمجتمع الذي يعيش فيه. في التاريخ، إنه دائماً عامل تحرُّر: ماياكوفسكي مثلاً دعا إلى الاشتراكية بكل قواه، ولدى اكتشافها على حقيقتها بحدسه عارضها بقوة من خلال شهادته المأسوية الصامتة التي تمثّلت بانتحاره. يحدث أن يتمكّن الشعراء من الانعطاف بزمنهم وفقاً لرؤيتهم الخاصة للمستقبل، كالسرّياليين الذين كانوا وراء الجزء الأكبر من حساسية زمنهم واستطاعوا التقدّم بهذا الزمن نحو المستقبل.
أين موقع الشعر اليوم؟
- الشعر اليوم محجوبٌ ومغيَّب من السيرك الأدبي والاجتماعي. فبخلاف الدور الذي استطاع لعبه في القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن العشرين، لم يعد يتمتع بوقعٍ في غالبية القرّاء، خصوصاً في المجتمعات الغربية التي توجّهها كلياً ضرورات المردود الاقتصادي والتقدّم التقني والتكنولوجي. في المجتمعات الأقل تقدّماً على الصعيد العلمي، يبقى الشعر دعوةً رئيسة للإنسان، حيث توجد قضايا ومشاكل، ويتمتع الشاعر بموقعٍ اجتماعي مميّز.
يبقى أن الشعر في المجتمعات الغربية مستمرٌ في استكشاف العالم الداخلي للإنسان، أي ذلك الميدان الفسيح الذي يشكّله اللاوعي، مصدر الومضات الحدسية والصور، بينما يقف فن القصيدة، في ابتكاريته ودقته، حاجزاً في وجه تدهور حالة اللغة وفسادها.
هل أنت مع ترجمة الشعر؟
- أجل، بشرطَين: أولاً، أن تنتمي لغة القصيدة واللغة المُستقبلة لها إلى نفس النظام اللغوي نفسه أو إلى نظامَين عرفا خلال التاريخ قرابةً وارتشاحاً متبادلاً.
في الحالات الأخرى، الشعر المترجم ليس سوى نوع من الاقتباس. الشرط الثاني، أن يكون المترجم شاعراً ويتّقن جيداً اللغة التي ينقل إليها القصيدة.
كثير من الترجمات الموجودة حققها أشخاص يتمتّعون بمعرفة نظرية، وليس داخلية، للغة الأجنبية التي حاولوا استخراج مادة ترجمتهم منها. لهذا، مهما علت مهارتهم ودقّتهم في الترجمة، فهم غير قادرين على منحنا سوى نصٍّ معادلٍ للنص الأصلي، وليس نصاً شعرياً بذاته، نصاً لا يخلو، في الحقيقة، من القيمة لكونه يسمح لنا بتشكيل فكرة عن القصيدة.
الحياة
16/11/2007