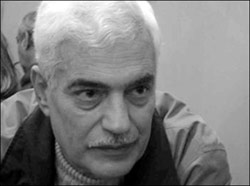 إن كان الشهيد المبدع غسان كنفاني قد كتب على غلاف ديوان الشاعر أحمد دحبور «طائر الوحدات» متنبئاً له بـ«الوعد الطليعي جداً»، فما الذي يدفع الشاعر دحبور إلى أن يتعهد بالكتابة عن كنفاني كل سنة في ذكرى استشهاده؟ وأسئلة أخرى سنتعرف الى إجاباتها في هذا الحوار الذي أجري معه في مدينة حمص الأثيرة إلى قلبه بعد حيفا، حيث اختار الشاعر أن يقيم بعد أن خرج من غزة تحت وطأة الحصار والمرض صيف العام 2008. والشاعر دحبور الذي يمكن وصفه بالمكتبة المتنقلة لموسوعيته وذاكرته الحديدية، يربك من يحاوره من أين يبدأ، لكن الشعور هذا سرعان ما يزول مع أول إجابة. معاً نقرأ:
إن كان الشهيد المبدع غسان كنفاني قد كتب على غلاف ديوان الشاعر أحمد دحبور «طائر الوحدات» متنبئاً له بـ«الوعد الطليعي جداً»، فما الذي يدفع الشاعر دحبور إلى أن يتعهد بالكتابة عن كنفاني كل سنة في ذكرى استشهاده؟ وأسئلة أخرى سنتعرف الى إجاباتها في هذا الحوار الذي أجري معه في مدينة حمص الأثيرة إلى قلبه بعد حيفا، حيث اختار الشاعر أن يقيم بعد أن خرج من غزة تحت وطأة الحصار والمرض صيف العام 2008. والشاعر دحبور الذي يمكن وصفه بالمكتبة المتنقلة لموسوعيته وذاكرته الحديدية، يربك من يحاوره من أين يبدأ، لكن الشعور هذا سرعان ما يزول مع أول إجابة. معاً نقرأ:
* منذ أكثر من سنة وأنت تهرب من سؤالي «ألا تشتاق لنشر قصيدة جديدة منذ أن غادرت غزة تحت وطأة الحصار والمرض؟»،
بالإجابة قائلاً «لست راضياً بعد عن قصائدي. ما زلت أدققها». في ضوء ذلك كيف تتعامل مع قصيدتك قبل نشرها، وما الذي تغيّر في قلقك حولها بين الماضي واليوم؟
- مبدئياً، على مستوى ذاتي، لا أؤمن ببكارة القصيدة، فقصيدتي قابلة للحذف والتعديل والشطب حتى تصدر في مجموعة. وكثيراً ما كنت أكتشف أنني كنت أغيّر في القصيدة وأنا ألقيها. ربما كان هذا عائداً إلى أن مفهوم العلاقة بين الشاعر والشعر قد تغيّر. لقد كان القدامى يستخدمون تعبير نظم الشعر. وارتبط الشعر الحديث بإصطلاح كتابة الشعر بما يعني أنني لا أشذ عن غيري في هذا الدأب على إعادة صياغة القصيدة، ولكل شيخ طريقة. أمّا الآن فلدي ما يمكن أن أدفع به إلى النشر.
* لماذا في رأيك قلّت المنابر الصحافية التي تنشر الشعر؟
ـ في رأيي السؤال الأجدى لماذا يقل الشعر؟! أذكر قبل أربعين أو خمسين سنة أن الدوريات كانت تتنافس على نشر الشعر، أمّا الآن فأنت تدوخ بحثاً عن المنبر الذي ترشّحه لتقديم صوتك. خذ مجلة «الآداب» البيروتية مثلاً، كان عنوان معركة الحداثة التي تخوضها هو ما اصطلح عليه بشعر التفعيلة. أمّا اليوم فلا تكاد ترى قصيدة التفعيلة على صفحاتها على مدار السنة!
بما أن الشعر بطبيعته «عدو الطمأنينة» بحسب تعبيرك، فما الذي تحاول أن تحاربه من استقرار في قصيدتك؟
ـ ليس هناك وصفة جاهزة للقلق. أن تكون شاعراً يعني في ما تعنيه أنك ترى العالم بعينين مختلفتين. من هنا كانت القصيدة الحديثة متوترة مثيرة للدهشة وهو ما يفسر ما بدأت به من جهة قلق الشاعر أثناء قصيدته وإعادة النظر فيها باستمرار.
* رأى الشاعر شوقي بزيع في دراسة له أنك شاعر غنائي بامتياز يعرف كيف يتصرف بالأوزان ويطوعها بما يشبه التقفية الداخلية التي تحولت إلى ميزة دائمة نسج على منوالها الكثيرون». هل يسرّك مثل هذا الكلام أن تكون صاحب تأثير أم تفضل لو أنهم شقوا لأنفسهم طريقاً خاصاً؟
ـ مبدئياً أسجل سعادتي بالصديق شوقي بزيع مع اعتراف متبادل بيننا بأن كلاً منا شهادته مطعونة في الآخر، لكن إذا كان لي أن انحاز إلى رأيه النبيل فإنني أتذكر دائماً ولعي بالعروض واللعبة الموسيقية اللغوية منذ نعومة أظفاري، ولعلي حين أعود إلى مجموعتي الأولى التي كتبتها وأنا فتىً أرى أن هناك قصيدة مكتوبة على البحر السريع، وهو من الأوزان المركبة التي لم تكن قصيدة التفعيلة تتعامل معها. فمحاولاتي التجريبية مزمنة وقديمة. وقد جوبهت بأسئلة من نوع ما إذا كان استخدامي للبحور المركبة يحمل شيئاً من الافتعال وأجيب بتلقائية بأنني وقد تدربت عمراً على هذا النوع من الكتابة لأنني أكتب بكل تلقائية وعفوية ولا أذكر أنني استخدمت مفردات لضرورة الوزن. أمّا إذا كان هناك من اتبع هذا الأسلوب فإن الحياة تتسع للجميع، ولست صانع بحور شعرية حتى أزعم أن هذا الأسلوب لي، لأن الاحتكام أولاً وأخيراً هو للشعر.
* نصوص ديوانك «كشيء لا لزوم له»، وهو يشير إلى مقدار التغيرات التي طرأت على شعرك من جهة ومقدار الأسئلة التي طرحتها قصيدة النثر على القصيدة العربية التفعيلية. ماذا تقول في المسألتين؟
- أوافق على هذا الكلام مع ملاحظة أن الشاعر عندما يذهب إلى قصيدته لا يضع خطة ولا يرسم استراتيجية. بل يأتي محتشداً بمشاعر وأفكار شتى، ومن شأن القصيدة أن تتحول لمصفاة لهذه الأفكار والمشاعر. فإذا خفت الصوت أو اعتراه نوع من الضجيج فإن هذا بمثابة إشارة إلى ما يحدث فينا من تغيرات وتحولات، ولا يمكن للفتى الذي كتب قصيدة حكاية الولد الفلسطيني العام 1969 أن يكون هو نفسه الذي يكتب قصيدة هذه الأيام مع أن هناك قواسم مشتركة في القصائد ترافق الشاعر حتى الرمق الأخير.
* إلى أي مدى تجد أن كلام بزيع ينطبق أيضاً على نتاج بعض شعراء قصيدة التفعيلة في مقدمتهم الشاعر الراحل محمود درويش، على الرغم من مهاجمة معظمهم لقصيدة النثر؟
ـ قد حسمت الحياة أمرها بشأن قصيدة النثر، وما كان محرّماً ومرجواً هو الآن حقيقة واقعة. والغريب أن الذائقة العربية كانت باستمرار تضمر قبولاً لنص غير الموزون، ونتذكر أن قريش كانت تصف النبي بأنه شاعر مع أن القرآن الكريم ليس شعراً. لكن هذه المسلمة لا تعني أن الأمر سهل فأن تذهب إلى قصيدة النثر يعني أن تواجه قدرك وصوتك، إذ لا توجد أمامك سكة حديد كما هو الأمر في الشعر الموزون، وعلى الشاعر أن يشتق إيقاعه وصوره من غير أن يعتمد على مرجعيات جاهزة في قصيدة النثر. وهذا يعني أن هذا النوع من الشعر صعب وخطير.
* ما هي تجليات موقفك من قصيدة النثر؟
ـ منذ العام 1969 كنت مفتوناً بشعر الفلسطيني توفيق صايغ الذي تقول عنه نازك الملائكة بحق إنه لم يكتب في حياته بيت شعر واحداً، وإن ما يقوله هو نثر مثل النثر. فاستوقفني هذا الشاعر مع أنني كنت موغلاً في التفعيلة وأسرارها. وحين أتأمل نفسي لا أرى في ذلك شيئاً من التناقض، فانا منحاز إلى التعدد والتنوع اهتممت بالتراث لكني اهتممت بالفلكلور أيضاً، وتوقفت طويلاً عند التجربة الإسلامية ونهلت إلى حد كبير من التراث المسيحي، وكان دائماً في الشعر مكان يتسع لمختلف الألوان. صحيح أن مزاجي العام موزون لكنني منذ العام 1969 كنت أضع قصيدة نثر واحدة في كل مجموعة لي وكنت أكتب التفعيلة.
* على الرغم مما تفضلت به قبل قليل لكننا نلاحظ عودة شعراء يكتبون التفعيلة إلى كتابة القصيدة على نظام البيت، كيف ترى المسألة؟
-هذا النكوص موجود دائماً في التراث، ولعل هناك حنيناً يشدّ الشاعر إلى الينابيع الأولى فيبدو طبيعياً أن تظهر مقاطع من نظام البيت لدى هذا الشاعر الحديث أو ذاك. أمّا عندما يوغل بعيداً في النسق القديم فإن هذه مشكلة، وساعتها من حقنا أن نشتبه بحداثة الشاعر الذي يعيد إنتاج الأسلاف بعد أن نجح في القطيعة معهم.
* كيف يمرُّ البرق إذا لم يضحك في الفجر الشهداءُ؟»، تحضر هذه الصورة من قصيدة «عتمة على سبيل الضوضاء» من آخر ديوان صدر لك في غزة «أيُّ بيت!!». تحضر مع إعجابك بالسير الشعبية الذي أفصحت عنه في مقدمة ديوانك الذي ضم مجموعاتك السبع الأولى. فهل كان سر اهتمامك بها لأنها أرضت مبكراَ نزوعات «الولد الفلسطيني» إلى وطن محرر على طريقة أبطال تلك السير، أم ثمة دوافع أخرى؟
ـ الواقع أن ولعي بالسير الشعبية شكل من أشكال إعادة إنتاج الطفولة باستمرار. وهو ما انعكس في ما بعد على الدراما في القصيدة الحديثة في نظري على الأقل. فالبطل الشعبي سرعان ما يكتشف أنه وحيد وحزين وربما كان المثال الذهبي على ذلك هو ما أشرت اليه في مقدمتي التي تتحدث عنها، أقصد «الزير سالم». فللوهلة الأولى بحسب النظرية السطحية الخارجية نعتقد أن هؤلاء الأبطال جبابرة يطيحون برؤوس ولا يهتمون بالبشر. لكن عندما تتأمل شخصية مثل شخصية الزير سالم في السيرة الشعبية ترى مستوىً ثانياً من الشخصية فيه الكثير من الحزن والشجن والعواطف والشعور بالغبن والمطالبة بالعدل مستحيلة. وهذا النوع من الأبطال في السير الشعبية لم يصادف هوىً في نفسي وحسب، بل جرّني إلى منطقة الشعر.
* منذ أكثر من ربع قرن وفي ذاكرتك بحث مقارن بين السيرة الهلالية وملحمة الإلياذة، كما قلت ذات جلسة، ما أسباب عدم كتابتك له حتى الآن؟
ـ في الواقع إن اكتشاف التقارب بين الهلالية والإلياذة كان مفاجأة مدوية في ذهني وكنت كثيراً ما أتردد في نقل هذه الأفكار الخاصة بالتشابه للآخرين، إلى أن أتيح لي في أثناء حضور محاضرتين لأستاذين كبيرين هما حسام الخطيب ولويس عوض. فطرحت هذه التصورات وتلقيت جواباً واحداً تقريباً من الأستاذ عوض والخطيب (الأول مصري كما تعرف، والثاني فلسطيني)، حيث قالا لي بما معناه «انقل هذه الأفكار إلى الورق ولك أن تنال شهادة عليا في ذلك». لكن ما أعاقني هو نوع من التهيب تجاه الموضوع أساسه البحث عن المراجع في فترة كنت فيها كثير التجوال ولا استقرار لي في مكان أكثر من سنة.
التطابق الحرفي
* هل تسرد لقارئ هذا الحوار مفاصل هذا التقارب؟
ـ أول ما يلفت النظر في العملين أن الحرب قامت من اجل امرأة، «هيلين» في الإلياذة ، و«سعدة الزيناتي» في الهلالية. وقد ترتب على هذه الحرب، حصار المدينة المسورة «طروادة» في الأولى، و«تونس» في الثانية. وكانت تركيبة المهاجمين في الإلياذة قائمة على «أغاممنون» كقائد عام، وإلى جانبه «أوليس» الذكي الداهية، و«آخيل» البطل الجبار. مقابل هؤلاء «هيكتور» المدافع عن «طروادة». وهم الذين نراهم في الهلالية في شخص «الزيناتي خليفة»، «دياب بن غانم»، و«أبو زيد الهلالي». يحدث أن «آخيل» يختلف مع «أغاممنون» الذي يعادله السلطان «حسن» في الهلالية، وبسبب خلافه معه يتوقف في الطريق ويترك الجنود يقاتلون وحدهم، وهذا ما يفعله «دياب» الذي اختلف مع السلطان حسن. ويبدأ «هيكتور» بقتل الجنود المقاتلين الفرادى، كما سيفعل الزيناتي في الهلالية. ويقترح «أوليس» في الإلياذة المصالحة مع آخيل، وفي الهلالية «أبو زيد» يقترح المصالحة مع «دياب». وحين يتردد البطل آخيل أو دياب في نجدة قومه، يرسلون شاباً قريباً إلى قلبه، «بتروكليس» لمواجهة «هيكتور»، و «عقل بن هولى» لمواجهة «الزيناتي». ويموتان بطبيعة الحال على يدي «هيكتور، والزيناتي»، ويصبح البطل البعيد «آخيل» أو «دياب» ملزماً بأخذ الثأر وهكذا يقتل «آخيل» «هيكتور»، كما سيقتل «دياب» «الزيناتي». ومن يتأمل هذين المقطعين من الهلالية والإلياذة، يدهشه التطابق الذي يكاد يكون حرفياً.
* هل لديك أي تفسيرات حول هذا التقاطع، كأن يكون من دوّن الهلالية مطلعا جيدا على الإلياذة؟
ـ لا بد من الافتراضات في أمر غير مدروس مثل هذا. واذكر أن لويس عوض اقترح نظرية التراكم الملحمي، بمعنى أن الشعوب تتناقل الملاحم والروايات الشعبية وتحصل انزياحات بهذا الشكل، أو ذاك، ثم تستقر على صيغة. لكن الغموض نشأ من اختلاف النصّين، فإلياذة هوميروس من أشهر النصوص الكلاسيكية في تاريخ البشرية. أمّا التغريبة الهلالية فهي حالة انتقال من الشفوي إلى المدوّن. وبين هؤلاء وهؤلاء كانت النزعة القبلية تتدخل فتحذف وتضيف، وقد انتقلت الخلافات إلى السرد فأنت قد ترى «أبو زيد» بطلاً في إحدى الصفحات، و «دياب» جباناً يهرب من المعركة. وفي صفحة لاحقة تجد الأمر نقيض ذلك، بما يعني أن الرواة والمدوّنين كانوا يتدخلون في مصائر شخصياتهم وإن كانوا متأثرين بما وصل إليهم شفوياً من رواسب الإلياذة. ومن المعروف أن العرب ترجموا الفلسفة اليونانية، وحاوروا اليونانيين لكنهم لم يقتربوا من الملاحم. فأدبنا العربي القديم لم يشهد ترجمة للإلياذة أو الأوديسة أو الأنيادة أو الشاهنامة، وأعتقد (وهي فكرة تحمس لها الدكتور الخطيب) أن المثقفين في بلاطات الحكام كانوا يطلعون النخب الضيقة على أخبار هذه الملاحم، بحيث انها رشحت إلى العامة بأشكال متباينة. والذاكرة الشعبية تنتخب وقائع وأحداثاً وتضفي عليها كثيراً من رغبات وانحيازات الرواة.
* ألا تخشى على ما بحت به فيقوم من يقرأ هذا التفسير والتفاصيل بإكمال المهمة المؤجلة لديك؟
- إنها مجرد تأملات منذ فجر الشباب، وأكون سعيداً إذا وقعت على من يتبناها أو يطوّرها. ليست القصة قصة براءة اكتشاف، وإنما هي مادة للتأمل والبحث، ومن حق الجميع أن يخوضوا فيها إذا ما كانت لديهم الرغبة والاقتناع والقدرة.
بعد مضي سنتين على رحيل الشاعر محمود درويش، هل تعتقد أن الناقد والقارئ العربيين التفتا أكثر إلى بقية الشعراء الفلسطينيين، قراءة ونقداً؟ أسأل وأنا أعرف انك لن تتحسس من سؤال كهذا، إذ طالما حدثتنا عن درويش الصديق والشاعر وعن شعره.
ـ ليس هذا الكلام مجاملة لذكرى هذا الشاعر الاستثنائي، لكنه كان من الخصوبة الذهنية والموهبة المتأججة بما يطرح قراءات متعددة لنتاجه الشعري. فهذا شاعر لا تستنفده قراءة سواء اكان حياً أم هو في دار الحق. بل إنني أفترض أن الكتابات الجادة المتوقعة في شعر درويش لم تظهر كلها بعد، لأن غيابه المأسوي شغل الباحثين والدارسين والمحبين، ولو إلى حين. لكن ما ليس مفهوماً أن يتم النيل من هذه القامة الباذخة من أناس كنا نتوقع أن يكونوا أكثر وفاءً. لا أقصد على المستوى الشخصي، فالحياة الشخصية ملك صاحبها، لكنني أعني بعض القراءات المفترضة التي ما كان يقولها من قالها لو كان درويش لا يزال حياً.
* قلت لي ذات جلسة انك أخذت عهداً على نفسك أن تكتب عن الشهيد غسان كنفاني كل سنة في ذكرى استشهاده، ما هي أسباب هذا العهد؟
ـ لقد تعرفت إلى غسان وأنا في مقتبل العمر، وقد سحرتني شخصيته على المستوى الإنساني سحراً لم ينافسه إلاّ الإعجاب الكبير بقدراته وموهبته، وإلاّ فلتتخيل أن ذلك الشاب ذا الاعوام الستة والثلاثين قد ترك آثاراً في الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والتمثيلية الإذاعية والنقد والمقالة السياسية والكتابة الساخرة، ما يكفي كل منها لإثارة جدل واهتمام كبيرين. وقد تكون هناك لحظة ذاتية يجب أن أعترف بها، هي أنني كنت في غاية الامتنان والسعادة عندما أدلى على الورق بشهادة طيبة تبشر بموهبة الشاب الذي كنت.
أناقة وترف
* ربطتك صلة خاصة بالشاعر السوري ابن مدينة حمص موريس قبق الذي أهديته ديوانك «هكذا»، والذي اعتزل كتابة الشعر بعد ديوانه الأول، وتبين لك أنه ترك ديواناً مخطوطاً. حدثنا عن صلتك به وعن أهميته كشاعر، وما هي دوافعك لإعادة إصدار ديوانه الأول وما تركه من أشعار؟
ـ كان الشاعر موريس رحمه الله ممسوساً بفكرة الاختلاف، حتى في كلامه اليومي، ولم يكن يكتفي باعتراف المثقفين أو الجمهور بل يتعامل مع الشعر بحد ذاته كشخصية اعتبارية وينشد منه الاعتراف. كنت أشاهده أحياناً وهو يصارع صورة فنية في ذهنه، قبل أن يسكبها على الورق. كان يصمت وأحياناً يتشنج وكثيراً ما يبدو عصبياً وإذا كان الشاعر بدوي الجبل يقول «إن وزنه ينقص بعد كل قصيدة يكتبها»، فإن هذا ينطبق تماماً على موريس قبق، وكانت نظريته في الشعر بسيطة، قصيدة الحب والمشاعر القريبة يجب أن يتوافر لها عالم من الأناقة والترف، سواء أكان ذلك بالمفردات المنحوتة أم بالصور المتميزة أم بالإيقاعات المنضبطة. أمّا القصيدة الثانية التي كان ينسبها إلى الشعر الحضاري فيسمح لنفسه فيها بحوشي الكلام والصور القاسية والفكر غير المطروق، حتى انه كثيراً ما كان يبدو لي يائساً من أن يفهمه الآخرون. ولقد بلغ موريس ذروته في العام 1964 وكان قد أصدر ديوانه الوحيد «الحب واللاهوت»، وكتب بعده عدداً من القصائد تؤكد أسلوبه الثنائي بين القصيدة الغنائية والقصيدة الحضارية بحسب تعبيره. وهي مناسبة لي حتى أعترف للصديق الشاعر ممدوح السكاف لأنه قد دوّن أهم قصائد موريس المتأخرة، فكأننا حين جمعنا أعماله كان بعضها بخط ممدوح. لقد قلت مرة إن موريس أحد ثلاثة أسهموا بصنع شخصيتي الشعرية، وأراني بعد عشرين عاماً من هذا القول اني لم أتجاوز الحقيقة، إذ لا أدري ماذا كنت سأحقق لو لم يظهر هذا المعلم النبيل في حياتي.
حمص
السفير
24 - 9 - 2010