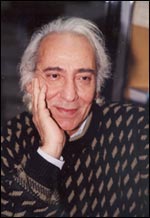 المدنُ طبقاتٌ، شأنها في ذلك شأن أي مكان يشغله الانسان في العالم. بعضنا ينظر اليها على أنها طبقاتٌ متجاورة يختفي الزمنُ حين ننظر إلى حي قديم هنا يجاور ضاحية حديثة هناك، وبعضنا يراها طبقاتٍ متراتبة يتتبعها الانسان هابطاً أو صاعداً بشيء من القدرة على التخيل، وبعضنا يراها أمكنة متعاقبة في المكان والزمان على حد سواء، يمحو بعضها بعضاً، لا يمكن أن تتعايش أو تتفاهم.
المدنُ طبقاتٌ، شأنها في ذلك شأن أي مكان يشغله الانسان في العالم. بعضنا ينظر اليها على أنها طبقاتٌ متجاورة يختفي الزمنُ حين ننظر إلى حي قديم هنا يجاور ضاحية حديثة هناك، وبعضنا يراها طبقاتٍ متراتبة يتتبعها الانسان هابطاً أو صاعداً بشيء من القدرة على التخيل، وبعضنا يراها أمكنة متعاقبة في المكان والزمان على حد سواء، يمحو بعضها بعضاً، لا يمكن أن تتعايش أو تتفاهم.
أنا أفضل المشهد الأول الذي يذكرني بوقفة طفل في بقعة تعاقب على الوقوف فيها أناس من مختلف العصور، أو مروا بها كل ذاهب لشأنه، فوجد نفسه يخالط أناسا وقفوا هنا قبل ألف عام، وأناسا وقفوا في المكان ذاته قبل مئة عام، وأناسا نظروا إلى المشهد نفسه قبل خمسين أو عشرين سنة، ثم يمضى إلى حال سبيله أو بعد أن تدعوه أمه لتناول عصيره اليومي.
مثل هذه التجربة مررتُ بها في لحظة وقوف على رصيف بالقرب من بوابة “الجهراء” المنفردة والقائمة لتذكر أن هنا كان سور طيني يحيط بالكويت من أقطارها على شكل قوس يحميها في وقت واحد ماً من غزو الغزاة وعواصف الصحراء الرملية على حد سواء. لم يكن ما حولي ينبئ بشيء من هذا، فالوجوه متنوعة تنتمي لهذا الزمن، والمباني حديثة، ولا سور هناك، بل ولا حتى ما كان قبل عشرين سنة، ولكن ذاكرتي سرعان ما بدأت تعمل.
هذه الحشود البشرية على الرصيف وفي الدوار الذي تحول إلى حديقة أكثرها من الشرق الاقصى، من الفلبين وبنغلادش، تقف في المكان نفسه الذي احتشدت فيه حشود هندية وسريلانكية قبل عشرين سنة، وهو المكان نفسه الذي تموجت فيه على الارصفة وجوه من أصدقائنا الفلسطينيين والمصريين في زمن أقدم. لم تختلف الوجوه فقط، بل وحتى البقاليات والدكاكين والمقاهي، وطريقة الارتياد، ومحتويات هذه المطاعم والدكاكين. وتعود بي الذاكرة إلى مكان أبعد حين لم يكن هنا هذا الفندق وهذا المجمع، بل بيوت متلاصقة تنفتح عن ممرات ضيقة أمام سور وبوابة ليس وراءها سوى قوافل جمال تتحرك قادمة من أعماق الجزيرة العربية. هل أعود بالذاكرة إلى ما هو أبعد؟ سيحتاج المرء إلى ما حفظته ذاكرة الكتب وذاكرة كبار السن الذين يبدو أن الزمن تحرك كثيرا وتركهم لامبالين مع صورهم. ولكنني أشعر في كلماتهم بأنهم لاينادمون أشباحاً، بل أحياء يتحركون ويتحدثون بالعنفوان نفسه الذي تحدثوا به في ماضي الايام.
مواجهة البحر
ها أنا أصل إذن إلى ذلك الكيان العضوي الذي يسمى عادة الكويت القديمة. ولن تحتاج العودة إلى كشط وحك كثيرين كما لو أننا نزيل ألوانا وخطوطاً عن سطح لوحة لنصل إلى ما ارتسم تحتها، فكل شيء قائم ومجسد وليس مجرد رسم على قماش لوحة، ففي سبعينات القرن الماضي كان يمكنني أن أتنقل في منطقة الشرق من فريج إلى آخر، وأبصر تلك البيوت الطينية بمعمارها البسيط، بعضها متآكل بفعل الامطار وبعضها متهدم الحواف بفعل القدم، واتخذ طريقي إلى البحر، فإلى مرسى السفن ذاتها التي تتحدث عنها كتب الرحالة الذين مروا بالكويت. وقد أتوقف لأشاهد الصيادين العائدين إلى الشاطئ، بعضهم مازال يصلح شباكه مثلما ظل يصلحها منذ زمن لاتعيه الذاكرة، ربما يكون ثلاثة قرون أو ستة أو أكثر، وبعضهم يدق أو يطرق خشبة أو يقف مراقبا لبحارة يهبطون إلى البر بأحمال لم أكن أعرف تحديدا ما هي.
في هذه البقعة التي يقول عنها أحد معماريي المدن أنها الأقسى مناخاً في العالم، تجد نفسك أنتَ والمدينة في مواجهة البحر، وتنسى للحظات ذلك الوجه الاخر الذي لمحته عند بوابة “الجهراء” حين اختلطت بالقادمين مع ابلهم وهم يتقدمون ويدخلون بين ظلال البيوت، ولكن هذا لايعني أن كل جزء من هذا الكيان العضوي منفصل عن الآخر. لقد تشكل جسم المدينة الداخلي استجابة لحاجات الحياة اليومية. تتقارب أعضاؤه، وتتخلله فتحات فاصلة تسمح بمرور الهواء الطلق، وتسمح بانتشار الظلال، وتسمح بالحركة بين هذا الفريج وذاك، إلا أنها تنمو استجابة للحاجات الاساسية، فتتحول إلى تحفة معمارية.
قد تتحدث أحياء هذه التحفة بخطوطها مع مشهد الشوارع الواسعة الآن والمباني الاسمنتية العالية، ولكنه سيكون حديثا أشبه بحديث غريبين التقيا مصادفة، أو سكن أحدهما في خيالي ووقف الآخر حياً وملموساً لا أستطيع أن أتجاهله وهو يضغط بثقله، أنا الذي يتحرك كأنما جزء مني في الظل والجزء الآخر تحت شمس اليوم الساطعة.
سأعود إلى الظلّ إذن، ليس لأنه أكثر عذوبة وبرودة فقط، بل ولأنه يحمل معنى.
لقد نشأت البيوت التي بناها الكويتي، وهذه دلالة مهمة، نشوءاً عضوياً أيضاً تحت ضغط حوافز وضعيته المعيشية. أي أنها تلبي أعرافه الاجتماعية وشروط المناخ، وعلى أساس ما توفر من مواد بناء محلية في الأغلب الأعم. بيوت لا يأخذها الزهو كل مأخذ، بسيطة تشعرك باعتزاز صاحبها بنفسه وقدراته، يجاور بعضها بعضا، أي يحمي بعضها بعضاً من عصف الرمال وهبات الرياح الساخنة. البيتُ بباحته كينونة تدور حولها الحياة الاجتماعية للعائلة. ولايمكن لأي عين حساسة إلا أن تنتبه لجماليات البسيط والعادي الذي يغرم به الشرقي عادة من اليابان إلى المغرب؛ سماكة الجدران وبساطتها، وجذوع الاشجار السوداء اللامعة المستخدمة في التسقيف، وحجم النوافد ومواقعها، وصقل الأبواب والنوافذ.
هذا هو ما يسمى في علم تخطيط المدن المدينة الطبيعية والمنطقية التي تنمو لتلائم حاجات السكن، بكل ما تحمله هذه الكلمة من ظلال معنى للسكينة والاستقرار والأمان. هي لاتنمو بناءً على مخطط مسبق، بل تنمو كما تفرض الحاجة الانسانية. ومع نمو هذا النمط من المدن وتوسعه، يصبح تعبيراً عن ثقافة: ثقافة الرحلات البحرية، وثقافة الامعان في الفيافي الصحراوية، والغوص على اللؤلو، والمتاجرة مع كل ما تيسر من ألوان وأجناس بشرية على امتداد سواحل المحيط الهندي شرقا وغربا، ثقافة أبوية يحكمها ويهديها المحرك الرئيس؛ الدين الاسلامي.
تناغم موسيقي
مازلتُ حتى الآن قريبا من البحر، وعلى امتداد الشاطئ أبصر منازل أيضا، وعمارات لبناء السفن، ولكن نظرة إلى الكويت من سفينة أو زورق، أو نظرة من على ظهر بعير يسعى بين الرمال، تكشف لي عن أفق تحدث فيه نغمتان نوعا من المطابقة؛ بين المنائر وسطوح البيوت المنخفضة، خطوط عمودية وأفقية. كان لابد أن يرتفع العمودي ليحد من رتابة الأفقي كما يحدث دائما في كل فن. صحيح أن صناع السفن على امتداد الواجهة البحرية وتجارها الجالسين على المصاطب، لايشاهدون هذا التناغم الموسيقي بين العمودي والأفقي، إلا أنهم يشعرون به في أعماقهم اللاواعية، لأنه يماثل تطابقات أخرى يعيشونها في حياتهم اليومية، بل ويلتقون بها في أي زاوية ومرفأ هبطوا فيه أو جاؤوا منه، أعني هذا التعدد المأخوذ كأمر مسلم به، تعدد أجناس البشر واللغات والعادات والصنائع والألوان.
كان يقال لنا دائما إن أهل المدن التجارية هم الأقل تعصبا في العالم، والأكثر تفهما للاختلاف بين الناس. في هذه الوقفة البحرية أمام الشاطئ المشغول بالاستعداد للرحيل، أشعر كم أن هذا صادق ودقيق، وأشعر أيضا كم أنه يعبر عن حقيقة من حقائق عالم الموسيقا التي تعزفها آلات عدة مختلفة صوتا وتكويناً.
الخليج
06/12/2008