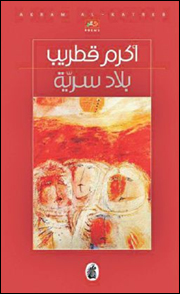 لا يستدرج الشاعر السوريّ أكرم قطريب تفاصيل صغيرة من بلده سورية، بعد رحيله عنها وإقامته منذ سنوات في الولايات المتحدة الأميركيّة، في كتابه الشعريّ الجديد «بلاد سرّية»، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر). بل يستدرج أحشاء تلك الأمكنة، أحشاءها العالقة منذ مئات، وربّما آلاف الأعوام. إنّه بذلك يرى المكان من خلال الزمن، وكأنّ الغياب عن المكان تمّ اكتشافه أخيراً، ولعله في هذا الكتاب، صار حقيقيّاً بالفعل. لكنّه لا يذهب إلى الندب أو الشكوى، بل إلى التحدّث عن المكان لمكان آخر.
لا يستدرج الشاعر السوريّ أكرم قطريب تفاصيل صغيرة من بلده سورية، بعد رحيله عنها وإقامته منذ سنوات في الولايات المتحدة الأميركيّة، في كتابه الشعريّ الجديد «بلاد سرّية»، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر). بل يستدرج أحشاء تلك الأمكنة، أحشاءها العالقة منذ مئات، وربّما آلاف الأعوام. إنّه بذلك يرى المكان من خلال الزمن، وكأنّ الغياب عن المكان تمّ اكتشافه أخيراً، ولعله في هذا الكتاب، صار حقيقيّاً بالفعل. لكنّه لا يذهب إلى الندب أو الشكوى، بل إلى التحدّث عن المكان لمكان آخر.
إنّ الكتابة هنا، أو بهذا المعنى، ليست لتعذيب النفس التي صارت بعيدة بهذا القدر. بل هي في شرح المكان للنفس الهائمة على مهل، بعد أن عاشته بسرعة قد تستدعي النسيان. إنّها كتابة لتعذيب المكان أيضاً.
«في تلك الساعة/ في ذلك المكان حيث الجراح مرتفعة عن الأرض/ والبشر ذوو أجنحة...». هذا ما أتصوّره المدخل الحقيقي للكتاب؛ إيجاد حدث في ساعة ومكان معيّنين لبشر تعاقبوا على عيش حياة يؤلّفها قطريب بهدوء يُحسد عليه.
من العناوين نفهم زمن تلك البلاد السرّية، حيث نجدها عميقة وغائرة مثل شقوق متباعدة في الوجه واليدين. كمثل هذه العناوين: عرس إسبارطي، ملاك من العصر الوسيط، مدينة إله الشمس، أوديسة، عشرة آلاف عام وأنت تتفقد طيورك، قصائد آراميّة، لم أصدّق أنّ عمر الشعر 5000 عام، الإغريقي الغامض، أصدقاء من القرن الثامن عشر...
ليس من السهل كتابة ذلك الحنين الجاري بين ضفتي نهر جفّ منذ زمن بعيد، وقد تغيّر مجراه منذ آلاف السنين. عن بلاد يُنتهك فيها كلّ شيء الآن بالحديد والنار. فقطريب يكتب عن بلده كاحتجاج على ما يجري من قتل صارخ لها. لكنّها كتابة خاصّة. كتابة خافتة واحتجاج خاص. «هذا الوجه السوريّ، كلّ ما تستطيع فعله، أن تعيده إلى رسوم سيزان المائيّة». فمثلاً هو يكتب عن الموت الطبيعيّ في نهر العاصيّ في حماه، وكأن الموت من لوازم ذلك النهر، ومن الجو الاحتفاليّ به وفيه، فهو في طريقه لمدح ذلك النهر بخيوله التي تستحم، وقطع الملابس المغسولة، وقطع الخبز والحلاوة وضحك الفتيان الذين يستحمّون فيه، لا بدّ أن يذكر بأنّه «مساء سيذهب واحد منهم محمولاً على محفة/ ولون جسده يشبه النهر». عليه إذاً أن يمدح ذلك الموت «الطبيعيّ» وكأنّ ذلك أمر مفروغ منه في طقوس ذلك النهر الأخضر. لكنّه يكتب هذا ليقول بأنّ ذلك الموت الطبيعيّ ما عاد متاحاً في بلده اليتيم.
بعد أربع مجموعات شعرية، «آكان، أحرث صوتك بناي» (1995) و»أقليّات الرغبة» (1998) و»مسمّراً إلى النوم كابن وحيد» (2003) و»قصائد أميركا» (2007)، لا بدّ أن نعثر على تلك المهارة في الحنين من دون صراخ وشكوى فارغة. أن نعثر عليه كتنهيدة. وهنا لا بدّ أنّ يتعلّق ذلك بالزمن الذي يجري منفصلاً عن زمن الكاتب ومكانه. إنّه زمن مرتبط بشخوصه وأمكنته البعيدة، وبالتالي بحنينه. «كلّ يوم يمرّ هو تنهيدة أمام بابك الموصد».
يتكرّر المشهد كثيراً في الكتاب. مشهد أسماء حقيقيّة وأماكن حقيقية وندم حقيقيّ وكبير لفقدانها أو الابتعاد عنها، أو، في مرات أخرى، مدحها «أريد أن أمشي في المدن التي نسيتُ أن أقول لها وداعاً/ في المدن التي تركتها مثلما أترك قميصاً على طرف كرسيّ..». هذه الأشياء، والأسماء والأماكن الحقيقيّة أخذت الكتابة بعيداً عن أمكنة الشعر قليلاً. في الوقت الذي كان يجب أن تتكرّر كتابة جمل ككتابة هذه الجملة «.. والشعرُ يكتب بلغة سكان الريح، وثمّة من يبني حدائقه المعلّقة وحده». أو مثلما نعثر على الشعر بغزارة في آخر قصيدتين من الكتاب، وهما قصيدتا «مثلما الهنود» و «معجم البلدان»، واللتان تؤلفان القسم الذي يحمل الكتاب عنوانه «بلاد سرّية». حيث «بلاد سرّية بأكملها تنضج في المخيّلة/ دون معونة القواميس».
« سورية التي اشتاق إليها كثيراً/ ضعي حربك الطويلة ولو في ظلّ شجرة/ أريد أن أحلم بك على مهل/ دون أذرف دمعة واحدة». هذا ما يمكن قوله عن خفوت الكتابة؛ فالشعر في بلاد سرّية لا يطارد الحرب في شوارع سورية كما يحصل الآن في هذا الوقت، وذلك لسبب بسيط هو أنّه: «كلّ هذا الدم لا أستطيع وصفه».
الحياة – 9 مارس 2014