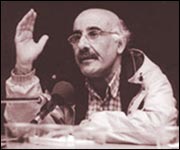 أن تكون الندوة عن الشعر الحديث. وأن تضم الحلقة الواحدة باحثا ومعقبا عليه. وأن تتم التكليفات قبل أشهر من انعقاد الندوة مما يعطي الباحث وقتا مديدا والمعقب عليه وقتا كافيا. كل هذا جهد تنظيمي مشكور أغراني بأن أشترك وبأن أتوخى خيرا. لم يكن التوفيق كبيرا في اختيار الأسماء وبالضبط في المقابلة بين الباحثين والمعقبين، إذ بدا أن الجمع بين هؤلاء وأولئك كان عشوائيا في معظم الحلقات. لقد اختيروا من دون تناسب واضح، لا أعني بالتناسب التوافق أو التطابق ولكن الاشتراك في الشاغل والمشكلية. هكذا وجدنا ان فسحة النقاش قصيرة أو وهمية أحيانا بين الجانبين. كان المعقبون يتجنبون النقاش جهدهم فيثنون على الأبحاث في غير موضع الثناء. لم يكن استثنائيا أن يبدأ المعقب بالقول ان الباحث استوفى موضوعه غاية الاستيفاء، وان له على بحثه ملاحظات هينة يتوسل بها أحيانا كثيرة لينطلق الى بحث آخر. كان انطباعي ان المعقبين يرجعون الى أدب غير مفهوم في إيثارهم المجاملة على النقد. انطباعي ان ثمة محاولة لتجنب النقاش أو حصره في أضيق نطاق. قليلا ما كان البحث والتعقيب متوازيين، حصل ذلك في حلقة محمد عبد المطلب وعبده مازن ولم يحصل في ندوة حلمي سالم ووهب رومية أو شربل داغر ونسيمة غيث على سبيل المثال، ففي الحالين كان التعقيب في واد والبحث في واد آخر. أما في ندوتي أنا ومحمد مفتاح فقد قدم مفتاح بحثا آخر أكثر منه تعقيبا. لم أفهم أين يأتي هذا الأدب الذي يؤشر اللياقة على النقد.
أن تكون الندوة عن الشعر الحديث. وأن تضم الحلقة الواحدة باحثا ومعقبا عليه. وأن تتم التكليفات قبل أشهر من انعقاد الندوة مما يعطي الباحث وقتا مديدا والمعقب عليه وقتا كافيا. كل هذا جهد تنظيمي مشكور أغراني بأن أشترك وبأن أتوخى خيرا. لم يكن التوفيق كبيرا في اختيار الأسماء وبالضبط في المقابلة بين الباحثين والمعقبين، إذ بدا أن الجمع بين هؤلاء وأولئك كان عشوائيا في معظم الحلقات. لقد اختيروا من دون تناسب واضح، لا أعني بالتناسب التوافق أو التطابق ولكن الاشتراك في الشاغل والمشكلية. هكذا وجدنا ان فسحة النقاش قصيرة أو وهمية أحيانا بين الجانبين. كان المعقبون يتجنبون النقاش جهدهم فيثنون على الأبحاث في غير موضع الثناء. لم يكن استثنائيا أن يبدأ المعقب بالقول ان الباحث استوفى موضوعه غاية الاستيفاء، وان له على بحثه ملاحظات هينة يتوسل بها أحيانا كثيرة لينطلق الى بحث آخر. كان انطباعي ان المعقبين يرجعون الى أدب غير مفهوم في إيثارهم المجاملة على النقد. انطباعي ان ثمة محاولة لتجنب النقاش أو حصره في أضيق نطاق. قليلا ما كان البحث والتعقيب متوازيين، حصل ذلك في حلقة محمد عبد المطلب وعبده مازن ولم يحصل في ندوة حلمي سالم ووهب رومية أو شربل داغر ونسيمة غيث على سبيل المثال، ففي الحالين كان التعقيب في واد والبحث في واد آخر. أما في ندوتي أنا ومحمد مفتاح فقد قدم مفتاح بحثا آخر أكثر منه تعقيبا. لم أفهم أين يأتي هذا الأدب الذي يؤشر اللياقة على النقد.
قدرت بادرة الدعوة الى ندوة عن الشعر الحديث فقد مضى على الحركة الشعرية منذ قصيدة التفعيلة الى يومنا هذا أكثر من نصف قرن وهذا كاف ليكون هذا الشعر قد ربى تاريخا وسياقا مشكليا واتجاهات ونقدا من الداخل. أما في الندوة فبدا أن التحديد الزمني للحداثة الشعرية ضائع تماما. حرنا في البداية وردها البعض الى محمود سامي البارودي وظهر أن أكثر من قرن في الميزان. هكذا لم نتميز القطع الذي شكلته قصيدة التفعيلة وما بعدها، وأدى الخلط الزمني الى تضييع المشكلية. هكذا غدت أبحاث بلا زمن تقريبا تعالج الإيقاع أو الاتجاهات من تصورات مطلقة. عاد البعض الى ابن جني وحازم القرطجي من دون حساب زمني، ووجد البعض في نزار قباني وحده مثال القصيدة الحديثة. لم تكن الخمسون سنة التي مضت من عمر الشعر الحديث لتلقى سوى زيارات خاطفة، سوى نقرات سريعة واستشهادات سريعة أيضا وكأن هذه الحركة لم تراكم ما يكفي للعودة إليه. ليس الخلط الزمني وحده السبب إذا أحسب أن عددا من الأساتذة المدعوين كانوا أكاديميين غير معنيين كثيرا بالشعر الحديث وليس هذا مجال بحثهم المفضل، فطالما ندّت أبحاثهم وتعقيباتهم عن هذا البعد. ملامساتهم السريعة والعامة وتفضيلهم التحليق في فضاء إشكالي وتاريخي أقدم ومراجعهم واستشهاداتهم تدل صراحة على ذلك.
خلط بين الباحث والأكاديمي لم يكن لولا عدم ترسخ الأدب الحديث في الدراسة الجامعية. وإذا كانت الدراسة الأكاديمية لا تميز النقد من التاريخ فقد خيم هذا على الندوة فكان صعبا حقا فرز الناقد أو الباحث من المؤرخ وقليلا ما سمعنا الشاعر الذي يتكلم من داخل تجربته وتجربة القصيدة الحديثة، هكذا بدت الندوة (على مستوى الأبحاث والتعقيبات) تقريبا خارج موضوعها. قلما بدا أن الموضوع هو الدخول في صلب تجربة عمرها نصف قرن، وقلما ظهر ان هذه التجربة لم تعد في البداية وغادرت من زمن بعيد سؤالها الأول وراكمت جدلاً داخليا ودخلت في سجال وتنازعات وأطوار واتجاهات، ولها تاريخ لكن لها يوما راهنا، ومن المهم أن نراها في لحظتها الآن. كل هذا كان إلا في القليل خارج الندوة تماما، لقد رأى الباحثون حركة الشعر الحديث كتلة واحدة ووضعوها غالبا تحت عنوان واحد وغالبا ما كانت ملامساتهم سريعة وبعيدة وهامشية. ندّ هذا بالطبع عن بعدهم وقلة اختبارهم للشعر الحديث، أما اللحظة التي كانوا فيها يظهرون عن مزاج فعلي فحين يرفعون شكوى، هي شكوى القارئ العادي، بل شكوى الأكاديمي المدرب ذوقه على قراءاته الكلاسيكية. أما هذه اللحظة فكانت غالبا لدى حديثهم عن قصيدة النثر.
هكذا رجع المؤتمر غالبا الى لحظة التأسيس الأولى، الى لحظة البداية تاركا أمامه أو وراءه تجربة خمسين عاما لم يخبرها كما ينبغي. لم نتوقف طوال المؤتمر عن سماع السؤال الأولى الأبسط عن قصيدة نثر، هل هي شعر وهل يستوي أن تكون قصيدة ونثرا. ما كان في حسبان المرء أن يبذل كل تلك المشقة ليسقط في هذا السؤال أو أن يكون لذلك مؤتمر وندوة. انه سؤال ملموم عن الطريق والأجوبة عليه جاهزة ومستنفذة. أما أن خمسين عاما شبت فيها هذه القصيدة تدفع المسألة الى موضع آخر فهذا لم يخطر لكثيرين.
****
مع ذلك لم يكن المؤتمر مضيعة للوقت. عوّض النقاش الواسع ما فات الباحثين والمعقبين، بل تحول أحيانا الى محاكمة لمنطق جامد لا يبدل شكليته ولا سؤاله ويظل دائما قبل التاريخ وقبل التجربة. تقدم النقاش على البحث وأحيانا بأطوار.
أتيح للجميع في جنبات الفندق أن يتقابلوا في لقاءات ناعمة وأتيح للبعض أن يتعرفوا على نواح أنيسة من الكويت. مع ذلك سبب لي لقاء سعدية مفرج حرجا وجوديا، فأين نحن من الشعر ومن الحداثة حين لا يكون لشاعرة كسعدية حق المواطنة وحين لا تملك جنسية ولا جواز سفر. كنا نتنقل في الماريوت الفخم ونغشى أماكن أنيقة فيما كان الواقع، واقعنا جميعا، أدنى من ذلك بكثير. ثم جاءنا خبر استشهاد جبران تويني فعلمنا ان الأمر كما قدمه باحثونا: تردد دهري على عتبة لا نجتازها ووقوف جامد أمام تأسيس لا يُنجز.
التقينا قبل الحلقة الأخيرة خمسة، وستة وطلب منا ان نقترح توصيات ولما لم نستطع ان نثني عن أمر كهذا اقترحنا بضع توصيات قدمت شخصيا جانبا كبيرا منها: كرسي للشعر الحديث في الجامعات، جائزة سنوية للشعر... (لا أدل بمشاركتي في هذه المقترحات البديهية تباهيا ولكن لأمر سيظهر فيما بعد). كانت الحلقة الأخيرة هي الوحيدة التي حملت عنوان اللحظة الراهنة، ولأنها كذلك فقد استتبعت نقاشا ثمينا، وأدارها السيد بدر الرفاعي بحكمة وحرفة ثم كان ان صعد السيد طالب الرفاعي لقراءة التوصيات فاستهلها بديباجة تضمنت فيما تضمنت، شكر المنتدين لرئيس الوزراء ووزير الإعلام وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة (السيد بدر الرفاعي نفسه) فاعترضتُ على تضمين الشكر قائلا وانقل هذا عن صحيفة القبس الكويتية التي نشرت الخبر انني لا أعارض دولة الكويت لكن لي موقفا مبدأيا هو استقلال الثقافة عن السلطة والنظام السياسي) وأنني لهذا حريص على ان لا تكون الثقافة مدينة للسلطة، أي سلطة، وان الشكر ليس من تقاليد الدول الديموقراطية فنحن نحضر مثلا مؤتمرات في فرنسا ولا نجد فيها داعيا لشكر الرئيس شيراك. قال بدر الرفاعي ان المسألة هي مسألة لياقة وشكر على ضيافة وليست تزلفا وتملقا. وتوقف النقاش هنا. خلت ان المسألة ايضا توقفت هنا، لكن مقالا للسيد بدر الرفاعي بعنوان "مرض اليسارية الطفولي" أعاد طرحها على العلن وأنا اشكر للرفاعي انه رغم حدته يتيح لي ان أوضح مسألة أكثر من شخصية وتتجاوز في دلالتها المناسبة.
ليس في الأدب العربي أكثر تواترا من موضوع صراع المثقف والسلطة. اذا كان هذا الموضوع محلا لتفتح نرجسية المثقف في صورة العقل المقتول والروح المغدورة فإن ما يعادل هذا الادعاء في سلوك الأدباء ليس سوى استخذائهم أمام أي سلطة. لا تحفل ثقافتنا بصور كثيرة للمتصدين لسلطاتهم. فالأمثلة هنا عزيزة ونادرة لكن ثمة صورا شنيعة مكبرة وجماعية للتمرغ والاستتباع. يكفي ان نتذكر ألف مثقف وقفوا في مربد صدام تحت صورته العملاقة وقال باسمهم بيان ختامي انهم يحيون صدام بطل الأمة العربية وفارسها وقائدها. الأمثلة كثيرة هنا، إذ اننا لا نجد وليمة عامرة كهذه الا ويتسابق الأدباء والمثقفون إليها. المقابل الحقيقي لذلك هو ثقافة الكليشيه التي رأينا ألوانا كثيرة منها في ندوة الشعر الحديث. وثقافة التلقين المنقطعة عن الزمان والمكان. لا اريد ان اتهم أحدا الا انني شعرت في هذه الندوة وفي كل ندوة ان في تسابق الأدباء الى شكر الجهة الداعية من على المنبر خلطا للاجتماعيات بالثقافة في أفضل التفاسير، كما ان فيه نوعا من الانحناء الطبيعي لمن لم يبلغوا أشدهم ولم ينضجوا لاستقلالهم، لا اتهم أحدا الا ان الشكر حين يعلن من على منبر أو يتضمن في بيان لا يعود لطفا فحسب وإنما يتحول، بوعي أو غير وعي، الى مشاركة في تحويل المناسبة الى أهرامات ثقافية للسلطة الداعية أو اماديح لها.
لنعد الى مقالة بدر الرفاعي وهي غريبة بالفعل. انها كمن يحرق غابة ليشعل سيجارة. لقد استعاد الأطروحة اللينينية حول مرض الشيوعية الطفولية اليساري (لم يجرؤ على تضمين كلمة الشيوعية فحذفها وغدا العنوان مرض اليسارية الطفولي) ليخلص الى ان الاحتجاج على شكر الوزراء وشكره هو عودة لفيروس هذا المرض الخطير. لا احد يعرف مناسبة هذه الى تلك الا ان لينين العصر يفترض ان شيئا خطيرا مثل التحفظ على شكر السلطة وشكره هو كأمين عام يشكل تطرفا يساريا رهيبا ينبغي التنبه له قبل ان يستفحل، ونسي عافاه الله ان اللينينية هي التي انتهت الى استتباع المثقفين والمجتمع بكامله للدولة، وان الدعوة الى استقلال الثقافة ليست بحال أمرا ثوريا من أي نوع. الثورات كلها وبجميع ألوانها تريد الثقافة سلاحا وتابعا، أما استقلال الثقافة فأقرب الى ان يكون مطلبا ليبراليا. ليس على لينين العصر ان يخشى من انبعاث اليسارية الطفولية، فان الاعتراض على ثقافة "الشكر والعرفان" كما سماها مقال نشمي مهنا النبيل والنبيه. ليس شيئا سوى الدعوة الى إرساء مثال ديموقراطي لا ينحني فيه احد لأحد ولا يستتبع فيه صاحب الأمر صاحب الرأي.
ينتهي "التداعي" اللينيني عند الرفاعي الى مسألة الشكر هذه ويسترسل الى اتهام "الشراذم اليسارية" بمداهنة اعتى الديكتاتوريات. كل هذا يتوالد من بعضه بعضا بلا مناسبة ولا منطق. لكن قارئا غير مطلع قد يتراءى له في غمرة هذا التداعي بأنني من هذه الشراذم اليسارية التي تداهن اعتى الديكتاتوريات. خشية شيئ كهذا أقول للسيد الرفاعي انني من دون جميع الذين دعاهم الى ندوته، ومنهم الكويتيون، أنا الوحيد الذي لم يحضر مرابد صدام، رغم دعوة تكررت الى كل مربد، لكي لا أقف تحت صورته ولا أشترك في بيان بتمجيده. واذا كان المنظّر اللينيني الجديد غير مطلع على مواقفي فله ان يسأل عنها فسيجد انها جميعها تشبه موقفي من مسألة الشكر هذه في الكبير والصغير.
المنظر اللينيني بعد ان كان في لحظة شيخ البلاشفة، سينقلب بسرعة الى شيخ العشيرة وسيحاضر في الضيافة "وواجب تقديم الشكر على كرم الضيافة الذي هو من شيم العرب). الضيافة يا شيخ من كرم النفس لا من كرم المائدة فحسب، وكرم النفس كما تروي قصص العرب يقتضي من المضيف ان يغفر لعدوه قاتل ابنه الذي دخل الى خيمته جاهلا أين يدخل. ولست اعلم ان المضيف يملي على الضيف شكره، كما لا أعلم انه حين لا يجد من الضيف موافقة على شكره ينهال عليه لوما وتقريعا بل وشتما، فيتهمه بالانتهازية ويصف موقفه ب"الشاذ المستهجن" الذي يفتقر الى اللباقة وحسن الأدب". ثم من يجب ان يشكر من؟ هل على الضيوف ان يشكروا أم يتلقوا الشكر للمشقة التي بذلوها وللدعوة التي لبوها وللواجب الذي التزموا به، أم ان السلطة لا تشكر بل يُرفع لها الشكر وعلى الأدباء، بثمن الليالي التي قضوها في فندق فخم والوجبات التي أكلوها والمكافآت التي تلقوها، ان يرفعوا آيات الشكر، أليس في هذا تحويل لقيم الضيافة الى كاريكاتور، اسمع أيها الشيخ المحاضر في الضيافة، أمضيتُ شهرين في ضيافة الألمان وفي صحبة خبيرين توقفوا على خدمتي بمجرد ان اطلب أي طلب كان، كتابا أم جهازا أم شانا آخر ولا لشيء سوى ان اكتب وان أفكر، كل ذلك ولم يطلبوا بالطبع جزاء ولا شكورا. هل نصحو ونتعلم من الناس والآخرين.
ثم هناك التداعي الأخير الى الكويت "التي لا تحتاج الى شهادة حسن سلوك" ولا اعرف الا انني دافعت عن الكويت يوم غزيت وكنت من القليلين الذين دافعوا، واسأل الرفاعي هل أنت الكويت ولماذا تريد ان تكسب دعواك بهذا الأسلوب. ألن تجد في الكويت من يرى في إملاء الشكر وشتم غير الشاكرين إساءة الى الكويت نفسها. ثم على من تتلو هذه المزامير، على واحد مثلي ظل شغله الشاغل نقد ثقافة بلده لبنان ومثقفيه ومحاربة أي نزعة بلدية خانقة وأي أسطورة وطنية. لقد لعبت أيها الشيخ على حبال اللينينية ثم العشيرة ثم الوطنية، كل هذا في سبيل مسألة لا تستحق كل هذا الجهد. يحيرني ان نضع لينين والقيم العشائرية والكويت في قضية صغيرة كهذه، اغلب الظن ان المطلب ليس كبيرا رغم كل هذه الضجة. قلت لي أمام أحمد حجازي انك موظف، ربما انك لا تدافع عن شيء أكبر من ذلك.
السفير- 2005/12/23