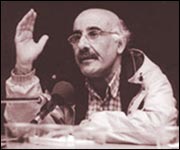 كان الافتتاح في مكان أثري قيل انه ورشة لصب السلاح. باحة صغيرة مرصوفة بالحجر في ظلال شجرة وارفة. مدخل شبيه ببيوت الريف، أما الداخل فكان قبواً مديداً. مناضد صغيرة يتحلق حولها أو لا يتحلق بضعة أشخاص. وبينما نجول بين المناضد كلمتني واحدة من النادرات اللواتي يعرفن الفرنسية، عرفتني على صاحب شولن، انه السيد شوكولا، تذكرت الرزمة التي استلمتها ما أن وصلت إلى الفندق، انها علبتا شوكولا وقبعة وعليها جميعها دائرة حمراء تحمل اسم <شولن>. شركة الشوكولا بين داعمي المهرجان، ليست وحدها لكنها لم تغب عن أي من نشاطاتها، دائما فتاتان على مدخل كل حفل مع سلتين كبيرتين من الشوكولا وثمة دائما رزم لضيوف المهرجان. لم أفهم كيف يمكن أن يوفر مهرجان شعري يحضره عشرات دعاية من أي نوع لشركة شوكولا لكني اتفقت مع الفتاة على أن الشوكولا والشعر قريبان، طعم <شولن> الذي عجلت على تذوقه في غرفة الفندق كان مصداق ذلك. داعم آخر هو البلدية التي كنت حتى هذه الساعة أظنها الداعية، انها واحدة من بلديات اسطنبول (15 مليون) الكثيرة. الرئيس ثلاثيني حاضر بشعره اللماع المسرح على جبينه والضحكة التي تطل من عينيه، يمكننا التنبؤ فوراً انه من عرق السياسيين المحترفين ونرى من الآن مستقبله الزاهر، أناقته وديبلوماسيته واستعداده الطبيعي لفرض نفسه أمارات ظاهرة. انه يتكلم عربية جيدة تعلمها، كما فهمت بعد ذلك، في تونس. اهتم بالطبع بأدونيس والتأمنا حول الاثنين أمام الكاميرا فوق ذلك السطح الزجاجي الذي غطى فجوة بليغة في ارض المصنع، لا أدري لماذا جعلت في وسطه، لكن الشق المضاء كان يوحي بأن نور القبو يصعد من باطنه، البلدية ورئيسها الآن إسلاميان، لم انتبه حينها إلى مفارقة العرق والنبيذ لكن حين دعتنا البلدية إلى عشاء كان هذا سؤال الجميع. جلس الرئيس في الوسط وجنبه ادونيس، وفيما كان الاثنان يتحادثان كنا ننتظر إذا كانوا سيسألوننا عن المشروبات. قدر بمعظمنا أن العشاء سينقضي بدونه، لكن الغارسون جاء وفي يده ورقة وسجل لكل واحد مشروبه. الرئيس لم يشرب بالطبع بل لم يأكل سوى طبق كبير من الفواكه. قال انه فهم أن لدينا أسئلة. أجوبته التخريجية لم تقل شيئاً. بعضها كان أشبه بعظة مسجد لكننا شربنا وتحادثنا تاركين المترجم يرسل بقية أجوبته في الهواء.
كان الافتتاح في مكان أثري قيل انه ورشة لصب السلاح. باحة صغيرة مرصوفة بالحجر في ظلال شجرة وارفة. مدخل شبيه ببيوت الريف، أما الداخل فكان قبواً مديداً. مناضد صغيرة يتحلق حولها أو لا يتحلق بضعة أشخاص. وبينما نجول بين المناضد كلمتني واحدة من النادرات اللواتي يعرفن الفرنسية، عرفتني على صاحب شولن، انه السيد شوكولا، تذكرت الرزمة التي استلمتها ما أن وصلت إلى الفندق، انها علبتا شوكولا وقبعة وعليها جميعها دائرة حمراء تحمل اسم <شولن>. شركة الشوكولا بين داعمي المهرجان، ليست وحدها لكنها لم تغب عن أي من نشاطاتها، دائما فتاتان على مدخل كل حفل مع سلتين كبيرتين من الشوكولا وثمة دائما رزم لضيوف المهرجان. لم أفهم كيف يمكن أن يوفر مهرجان شعري يحضره عشرات دعاية من أي نوع لشركة شوكولا لكني اتفقت مع الفتاة على أن الشوكولا والشعر قريبان، طعم <شولن> الذي عجلت على تذوقه في غرفة الفندق كان مصداق ذلك. داعم آخر هو البلدية التي كنت حتى هذه الساعة أظنها الداعية، انها واحدة من بلديات اسطنبول (15 مليون) الكثيرة. الرئيس ثلاثيني حاضر بشعره اللماع المسرح على جبينه والضحكة التي تطل من عينيه، يمكننا التنبؤ فوراً انه من عرق السياسيين المحترفين ونرى من الآن مستقبله الزاهر، أناقته وديبلوماسيته واستعداده الطبيعي لفرض نفسه أمارات ظاهرة. انه يتكلم عربية جيدة تعلمها، كما فهمت بعد ذلك، في تونس. اهتم بالطبع بأدونيس والتأمنا حول الاثنين أمام الكاميرا فوق ذلك السطح الزجاجي الذي غطى فجوة بليغة في ارض المصنع، لا أدري لماذا جعلت في وسطه، لكن الشق المضاء كان يوحي بأن نور القبو يصعد من باطنه، البلدية ورئيسها الآن إسلاميان، لم انتبه حينها إلى مفارقة العرق والنبيذ لكن حين دعتنا البلدية إلى عشاء كان هذا سؤال الجميع. جلس الرئيس في الوسط وجنبه ادونيس، وفيما كان الاثنان يتحادثان كنا ننتظر إذا كانوا سيسألوننا عن المشروبات. قدر بمعظمنا أن العشاء سينقضي بدونه، لكن الغارسون جاء وفي يده ورقة وسجل لكل واحد مشروبه. الرئيس لم يشرب بالطبع بل لم يأكل سوى طبق كبير من الفواكه. قال انه فهم أن لدينا أسئلة. أجوبته التخريجية لم تقل شيئاً. بعضها كان أشبه بعظة مسجد لكننا شربنا وتحادثنا تاركين المترجم يرسل بقية أجوبته في الهواء.
كنا بحاجة إلى يومين لنعرف من هي الجهة الداعية، مع انها طوال الوقت كانت أمام أعيننا. ليست صورة ناظم حكمت وحدها ولكن ترديد أحدهم لاسم جورج حبش وحديث يوسف عن حرب الغوار والاحتفاء الاستثنائي بالعرب. كانت مجموعة شيوعيين سابقين يلتف حولهم شبان شيوعيون حاليون. قلت لعبد المنعم رمضان مازحاً <وقعنا في وكر شيوعي>، لم يكن عندي ولا عند عبد المنعم مانع. استعدنا هكذا بدون حرج ولا تبعات فصلاً من شبابيْنا: التفاني والقربى والدوران المحموم داخل مجتمع شبه مغلق، تلك ميزات نعرفها نحن الاثنين للشيع الثورية. أحببنا هؤلاء الفتيان وهم لم يصدقونا ونحن نقول إننا مرتدون، لم يصدقوني حين استفزيتهم بالقول إنني تحريفي وغير لينيني. كنا عندهم <رفاقاً> بعلمنا أو بغير علمنا. ما المهم في حديث تركي عن إزالة إسرائيل، ما من مقابل من أي نوع لهذا الكلام، إنه إعلان فارق داخلي، إعلان انتماء إلى عالم دُفع بعيداً عنه، انتماء إلى فلسطين وإلى الشرق الأوسط والى المنطقة التي أزيحت تركيا منها لتلتحق كلها بطرفها الأوروبي. في الكتاب الأسود لأورخان باموك يتحدث عن نحات <أو صانع دمى> صاغ كل الحياة التركية ما قبل الأتاتوركية في دمى خزنها في مكان تحت الأرض. الدلالة واضحة، لقد تم كبت حياة كاملة لكن ذلك لا يكفي لإزالتها، إنها في كمون وسيأتي وقت تعود فيه بطريقة أو بأخرى. لا يحب أحد باموك هنا، لا الوطنيون ولا الإسلاميون ولا اليساريون، يجدونه جميعاً مخالفاً أو غريباً. باموك في نقد الاتاتوركية لا يذهب في أي من الوجهات النظرية، مع ذلك فإن الإنتماء إلى فلسطين يعني عودة لهذا المكبوت الكامن.
كنا في <المركب السكران> على سطح البوسفور والمركب السكران، الذي تهادى بين الضفة الأوروبية والضفة الآسيوية، كان، كما قدرت، مليئا بالشيوعيين. في المركب كان هناك، عدا الأناشيد الثورية ومنها النشيد الأممي التركي، كثيرون لم نر لهم وجهاً في كل قراءات المهرجان. أحدهم من النادرين الذين يتحدثون الفرنسية قال إنه عاد فتعلم العثمانية ويريد أن يتعلم العربية، لم يكن ذلك شغفاً لغوياً بقدر ما هو موقف أيديولوجي. إنه ماركسي ولا يعارض العلمنة بالطبع لكن له موقفاً من الثمن الذي دُفع لقاءها أو الأسس التي قامت عليها. لم تتصل العلمنة بالديموقراطية في تركيا قامت بفرض وخدمت نظاماً صارماً وفردياً. اتصلت العلمنة بالقومية، جاءت من الحلم بتركيا حديثة وأوروبية، تركيا منقطعة عن نظام الخلافة العثماني بمراجعه الأيديولوجية وخليطه القومي. تركيا متحررة من انتمائها إلى الشرق الإسلامي وركيزته العربية، إذ اتُهم هذا الانتماء بأنه وراء التخلف والظلامية ولا بد من خلعه ورميه جانباً. من الواضح أن احتقار العرب واتهامهم يمكن أن يدخلا في ثقافة قومية لأكثر من شعب إسلامي، احتقار التأثير العربي واتهامه بأنه من علائم التخلف والقصور. سواء في تركيا أو في إيران فإن الخجل بالتأثير العربي أساس في الايدولوجيا القومية. الغريب والمضحك أن الخجل بالتأثير التركي هو أيضا عنصر أساسي في ايديولوجاتنا القومية العربية، بالطبع لا تجد مبرراً لهذا الخجل وأنت تشاهد اسطنبول التي يعدونها واحدة من أجمل مدن العالم، ستجد بالعكس ولو في الظاهر أن السجال الغربي/الشرقي والأوروبي/ الآسيوي لا يبدو فاعلاً ومنتجاً بقدر ما يبدو هنا. لا يستطيع المرء أن يخجل باسطنبول بالطبع لكنك وبدون تعمق تفهم أن خلع الطربوش والحجاب لا يصنعان أوروبياً، إذ تذكرك اسطنبول طول الوقت ببيروت، الخليط اللطيف من محجبات وسافرات، بل بين محجبات أنيقات وسائرات بظهور وبطون مكشوفة. تشبهها بأسراب المتخاصرين والمنزوين في وقفات غرامية. نفسي تقول لي إن ثمة هناك الكثير من الشبه لكنك لا تسمح لمجرد حدس أو ملاحظة غير أكيدة أن يثبتا شيئاً. شبه بيروت بل أن بيروت من هنا تغدو أكثر <طبيعية>، إذ لا يستطيع الواحد أن يرد شيئا في اسطنبول إلى سنوبية أو تقليد سطحي أو كاريكاتور، ما اعتدنا أن نرد الكثير في بيروت إليه. لا بد أن في الأمر شيئاً طبيعياً. اذكر إن زميلا ألمانياً كان يتعجب من رؤية محجبة تأكل سندويش فلافل في الطريق، لم افهم في ندوة <زوايا> التي أحيتها هنريش بول ما كان يقصده الزميل الألماني، وأي مفارقة رأى بين الحجاب وأكل سندويش الفلافل، لا بد أنه افترض أن المحجبات لا يأكلن واقفات ولا يأكلن على الملأ حيث يمكن مشاهدة أفواههن سافرة تطحن وتتحرك بشفاه وأسنان. لا ألوم الزميل الألماني لأنه يفترض في الحجاب نظاماً متكاملاً مغلقاً أو نسق حياة تام لا فجوة فيه. هذه بالطبع خرافة، ليس عندنا في أي مكان مثل هذه البنى الصلبة، الأرجح أن ليس هناك سوى بنى منخورة مليئة بالثقوب. ماذا كان الزميل الألماني قال لو رأى محجبة تخاصر صديقها علانية، وهذا المشهد ليس نادراً على كورنيش المنارة. ماذا كان قال لو رأى ما تسنى لي رؤيته البارحة، امرأة متجلببة بالسواد من الرأس إلى القدم، خمسينية وجنبها صبية تسير بظهر مكشوف تماماً. احسب أن هذا التجاور يشهد أكثر بحداثة طبيعية.
نتبادل نحن والأتراك هذا الخجل ببعضنا البعض، والذي هو في الأرجح إسقاط لخجلنا بأنفسنا. بناء ايديولوجينا قومية على هذا الخجل الضمني نقطة ضعف كبيرة فيها، لكن بعض الأتراك الذين كل مساجدهم التاريخية العظيمة مزينة بالخط العربي، يجدون من العبث أن يكون العجز عن قراءتها التزاماً قومياً.
ليلتي الأخيرة أمضيتها حول مائدة في حديقة منزل لم اعرف حينها أهله من زواره. لكن الحديث دار بين التركية والفرنسية والإنكليزية، يتكلم زكي كوماك رئيس معهد التاريخ والاجتماع بالتركية التي لا يتقن سواها فينقلها روائي تركي إلى الانكليزية التي تنقلها شاعرة ساو توما إلى الفرنسية التي أجيب بها أنا، تحمل ليما الجواب بالانكليزية إلى الروائي التركي الذي يرده بالتركية إلى زكي، لم تكن اللعبة التي تذكر بتمريرات الفوتبول منهكة، تكفل جو المائدة الأنيس وكؤوس العرق التي كانت تتنقل بالسرعة نفسها بجعل هذه اللعبة محتملة. زكي شيوعي قديم، قال إنه أمضى وقتاً في السجن وأكثر منه مختفياً. إنه رئيس معهد التاريخ والاجتماع الذي ليس سوى لقدامى الشيوعيين ورئاسته تدلل على موقعه في هذه الرابطة. لكن علينا أيضا أن لا نؤخذ بالألقاب فعدنان اوزر الشاعر الشيوعي كان واضحاً انه لولب المهرجان ومديره الظاهر. المهم في كلام زكي انه مراجعة شيوعي قديم (ونحن نعلم إلى أي قدر تكون ثقافتنا في اكبر جوانبها مراجعات شيوعيين قدامى أو خارجين من الشيوعية) للمسألة الاتاتوركية. لا نتعجب إذا عاد الشيوعي القديم إلى الحقبة العثمانية، إلى قصر توبكابي الذي شيده محمد الفاتح وكالعادة على خرائب بيزنطية، هذا القصر الذي تعادل مساحته ضعفي مساحة الفاتيكان هو البلاط الإمبراطوري ومن داخله سيسَت الدولة والبلاد من نهايات القرن الخامس عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر، فقصر توبكابي كناية عن الإمبراطورية. ليست ردة قومية هي التي أعادت زكي إلى الماضي العثماني، إنها بالعكس التقليد العثماني الذي كان يعد رجال الدولة من الشعوب العديدة التي تكوّن الإمبراطورية وليس قبل قطعهم عن أصولهم وإعادة تربيتهم داخل الدولة نفسها. توبكابي، إذن كان هذه الدولة التي لا تخص قوماً دون غيرهم من أقوام الإمبراطورية. لم تعد تركيا إمبراطورية لكنها لا تزال تضم شعوباً عدة: أكراداً وعرباً وأرمن وشركس وأتراكاً سنة وأتراكاً علويين. لكن دولتها تقوم على الأتراك السنة، فيما لا يملك الآخرون حقوقاً خاصة وإلى عهد قريب كانت أسماؤهم ولغاتهم وثقافاتهم محرمة.
الحنين العثماني
الحنين العثماني يغدو أيضا شيوعياً. لا عجب إذن إذا عرفنا أن نسبة كبيرة من الذين يحيطون بنا هم من العرب والأكراد والعلويين، ميليس الجميلة التي جاءت لمرافقتنا أنا وعبد المنعم ورمضان، لكن الوقت الذي تأخرته كان كافياً لنضيع عن بعضنا البعض نحن الذين لسنا بالنسبة لبعضنا سوى أسماء. ميليس قالت إنها كردية. وحين ذكرت لها أنني كنت في كردستان العراق ظهر عليها حرج فعلي ولم تشأ أن تسير معي إلى هذا الحد، شعرت في الغالب أمام خبر بسيط كهذا بأن تركيتها مشبوهة. لكن زميلتها التي تعيش في فرنسا وسبق أن درست في ألمانيا قالت إنها غادرت تركيا بسبب الضغط السياسي لكنها الآن ذات جنسية أوروبية. (أرتْني جوازاً من الاتحاد الأوروبي) ولا تخافهم. قالت إن الأمور تغيرت في الظاهر لكن النوايا لا تزال هي هي. إنهم يتنازلون للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتغيروا حقاً. ليس يوسف من الذين يغصون بكرديتهم، أما مافي فلا يمنعها عن كرديتها انها متزوجة من رفيق تركي، لم أعرف هوية سيبل ويسون المتفانيتين، هل هما تركيتان. محمد الإنطاكي الذي رعى كل علاقاتنا بالمهرجان يقول إن ابنتيه لا يتكلمان العربية، فيما يسلمنا إنطاكي آخر لا لبس في لهجته العربية ديوانه، المطبوع على حسابه، بالتركية. هؤلاء كانوا حولنا طوال الوقت، تركوا في الغالب أعمالهم وأعطونا أوقاتهم بلا حساب، فعلوا ذلك بحب وتفان وصبر ماراتوني. لم يضيقوا بطلب وكل طلب منا لُبي بسرعة وكرم فائقين، كان يكفي القول إننا نريد زيارة مكان لنجد شخصين وأكثر جاهزين ليقتلا يومهما كله معنا. كان واضحاً أن ثمة شبكة اتصالات حاضرة رقعتها أوسع من المهرجان ولا نعرف إذا كانت الجو أو الحزب، لكن يكفي أن تطلب رفقة إلى مكان لتجد على باب الفندق، فتاتين وأكثر نراهما لأول مرة أو نشعر بهما لأول مرة، تأتيان متأخرتين إذ يبدو أن لا حرج في التأخر هنا. ثمة مفهوم شرقي للوقت، تتأخران لكنهما تأتيان مستعدتين للكدح معنا ساعات وساعات وحتى نسقط نحن إعياءً. ميليس لم تعد رغم انها وعدت بالعودة في اليوم بعد التالي، ربما لأننا لم نكلم في الأمر منظمي المهرجان. سيبل أخذتنا إلى السوق ثم إلى قصر ضولمه باتشي وأخيرا إلى المركب، بيسون لم تصحبنا إلى الغران بازار لكن أرسلت فتاتين التحقت بهما أخت الثانية، شركسيه وكرديتان. <مافي> أحداهما كلمتني عن نزار قباني. بعد أن زال عجبي فهمت انها قرأت شيئا لقباني عن بيروت. استوحت منها قصة بعنوان <بيروت، ثلج، بيروت>، لم أقل لها إنها لا تثلج في بيروت، لكنها أهدتني الكتاب. لا تتكلم مافي سوى التركية إنها صيدلية وقصاصة. كدحنا أنا وأسامة إسبر والفتيات الثلاث إلى الغران بازار على الأقدام، رأينا على الطريق نقوشاً عثمانية بالحرف العربي وبرج غلاطه الهائل. وفي الغران بازار تحملوا جميعا ترددي في الشراء والوقت الذي يتبخر مع سأمٍ موازٍ في انتظار أن أحسم. عدنا لأن موعد سفر ليما حان لكن ليما، وليس أنا، أخطأت في تحديد موعد سفرها. عادت من المطار بعد أن دفعت 50 دولاراً كعقوبة. باتت بلا مأوى بعد أن غادرت الفندق لكنها ستبيت عند الفتيات. ودعنا أسامة إسبر عند الباص الذي سيحمله مع حقيبته إلى المطار، وذهبنا إلى بيت الفتيات حيث تعشينا ومارسنا لعبة النقاش بتمريرات لغات ثلاث. قبل عودتي إلى الفندق حظيت من الفتيات الثلاث اللواتي لم اعرفهن إلا منذ الصباح، ومن الحاضرين الذين لم اعرف معظمهم إلا من 3 ساعات، بعناق وداعي لا مثيل لحرارته. حظينا بوداع حميم وفائق الصداقة من كل الذين فارقناهم. كانت الصداقات تنشأ بسرعة خيالية، تنمو كالشجر الأفريقي منذ اللقاء الأول وتغدو باسقة وظليلة في ساعات النهار، لا يعيقها فقدان اللغة، ولا الفوارق الأخرى، تغدو في الليل خيمة حقيقية، لنفترق في النهاية، وربما إلى الأبد، وقبل أن نحفظ أسماء بعضنا البعض، بصداقة ملتاعة.
أيام الشعر
لا يفترق الشعر عن السياسة في مناسبات كهذه. خمسة شعراء عرب من 12 مدعواً، غير تركي، لهذا بالطبع دلالته، أما في بقية المدعوين فيرجح الجوار والموقف السياسي. مقدونيان (احدهما ألباني)، يوناني وبلغاري، وفنزويلي شافيزي أما ساو توما واسبانيا فلم اعرف سر دعوتهما. كان ادونيس عميد المهرجان ويليه المقدوني ماتيا ماتفسكي، أما الأتراك فتجد بينهم سجيناً سابقاً ويساريين دائمين. إنهم يعتذرون لأنها المرة الأولى التي ينظمون فيها مهرجاناً <عالمياً>. لكنهم فخورون لأنهم استطاعوا، واستطاعوا دوناً عن غيرهم الذين جربوا ولم يقدروا. قالوا إن هذا أغاظ الكثيرين. لكن النية في مقاطعة المهرجان من بقية الصحف لم تفلح، حين صار المهرجان أمراً واقعاً أجبروا على الاهتمام به. وعدونا بملف صحفي لم يصل إلى الآن. يسبقونك إلى الكلام عن طراوة عودهم في هذا النوع من الأشياء، يعتذرون هكذا عما وقع وما لم يقع. لا شك أن أمورا فاتتهم لكنها ليست فادحة، كان التطوع والتفاني والتأهب التام أموراً كفيلة بتعويض أي نقص، ثم هناك، لماذا لا، هذه الروح الرفاقية التي تصل إلى الآتين من الخارج. لا أعرف من جراء ماذا لم نجد أحداً في انتظارنا في إحدى الجامعات التي لا يسمح بدخولها إلا ببطاقة ممغنطة، انتظرنا وقتاً حتى أحضرت لنا. من أين سيأتي الجمهور مع تدابير كهذه. لا بأس، لقد حظينا هنا بجلسة رائعة مطلة على مضيق الخليج. هكذا تغدو الأخطاء حسنات مؤكدة. لا اعرف إذا كان هناك تقصير في الدعوة، جانب من الحضور كان ينتقل مع الشعراء ومن جلسة إلى جلسة، إنهم المنظمون الكثر والمتطوعون الكثر وفوق ما يحتاجه مهرجان شعري، لكننا لا نستطيع الكلام عن جمهور حاشد. ثم أن الجلسات كانت طويلة غالباً ولو لم يختصر أكثر الشعراء نظراً لطول القائمة لكان من المستحيل إنهاء الجلسات في ساعتين أو ساعة ونصف كما هو مقرر. كانت الجلسات في مطارح عدة، وجزء من الجمهور ينتقل من مكان إلى مكان. كان علينا أن ننتظر طويلا في أحد المسارح حتى يخلو المكان، في باحة المسرح وجدنا معرضا للكتب الشعرية، ناظم حكمت، أحمد عارف وأيضا ريلكه وريتسوس و.. ادونيس، مجلدان يحملان صورته. وقف ادونيس يحدثنا لكن واحدة حملت إليه احد مجلديه ليوقعه ثم جاء آخرون. وقع أدونيس بضع مجلدات، لم تكن المرة الوحيدة، في كل جلسة يحضرها كان يجد من يطلب أو تطلب توقيعه، ناهيك بالطبع عن التواقيع على كراس المهرجان. كلٌ جنب صورته وفوق ترجمته التركية. هذه اشتركنا فيها جميعا.
انتظرنا إلى أن يخلو المكان ووقف عدنان اوزر على كرسي حاملا كتاباً بيده، كان يتكلم ووجهه ويداه وجسده في دوامة تعبير. يتكلم عدنان بعينيه وملامحه وبطاقة جسدية وانفعالية عارمتين. إنه مشهد لا يمنعك جهل اللغة من المثول له. في هذا الرجل حيوية مدهشة لا تتجلى في وقفته للكلام فحسب بل حين يقفز إلى حلبة الرقص. إنه يقف الآن ليشجع على قراءة كتاب صدر حديثا لشاعر تركي مشارك في المهرجان. يلوح بالكتاب ويتكلم عدنان اوزر شاعر شيوعي بالطبع لكن شاعر أولا، مع ذلك لا يقول أحد إنه مؤثر جدا كشاعر. إنه محرك المهرجان ولاعبه الاول.
ربما يجمعنا مع الأتراك هذا التقدير للشعر الذي لا يزيله ضعف الشعر الآن وانفضاض الناس عنه. حين قلت لزكي كوماك لماذا لا تفكرون بمهرجان للرواية، لم يستحسن الفكرة. قال شيئاً غريباً لا يقوله إلا عربي، أن الشعر هو الذي يحمل تاريخ الشعب. لم نحظَ ولا مرة بجمهور كبير لكن زكي لا يزال يفكر أن الشعر وحده حامل التاريخ.
كنا لا نزال ننتظر إلى أن يخلو المسرح <كم ينبغي أن أعيد ذلك> إلى أن بدأ يخرج أطفال ومعهم أمهات محجبات. محجبات ولم نفهم لماذا. حسبت أن الحفل لا يقبل سافرة لكنني رأيت أكثر من واحدة بلا حجاب. مع ذلك لا نجد في أي مكان آخر هذه النسبة من لابسات الحجاب. سألت عن السبب ولم احظَ بجواب. لكن فهمت أن للبلدية التي يحتلها إسلاميون دخلاً في ذلك. كنأ نقرأ قليلا مراعاة للوقت، لكن البعض لم يأبه. البلغاري بايف كان يحضر معه مترجمه ويزجي فيما يبدو كثيراً من التحيات والتشكرات التي يحتاج قولها وترجمتها إلى وقت. الشاعر نفسه منن جمهوره بأنه كتب ومن اجله قصيدة عن اسطنبول. كانت هذه لعبة ميديا في غير موضعها.
مع ذلك لم يكن الجمهور غريباً عن الشعراء، كان يعرف أدونيس ومايتفسكى الذي ولد في اسطنبول ووضعت لافتة بذلك على البيت الذي ولد فيه في احتفال صغير تكلم فيه عدنان. كان الجمهور بدأ يعرف آخرين الفنزويلي الشافيزي ميغيل ماركيز والبلغاري دايف، ويمكن القول إنه أحب الشعراء العرب. أحب إيقاع لغتهم وإلقاءاتهم المدربة الجامعة بين الغناء والخطابة والأداء المسرحي، لعل هذه اللغة التي طردت من لغته أعادته إلى نوع من الحنين التاريخي. لعله وجد في إيقاع هذه اللغة نبرة الأمر الثوري.
كان الافتتاح في جامعة خاصة. تكلموا عن ليبراليتها لكن تواضع المبنى وبساطته كانا يشيان بنوع من جامعة شعبية. لا اعرف ماذا كانت الجامعة التي دخلنا اليها ببطاقة ممغنطة والتي لم أفهم لماذا نفذنا منها إلى مقهى جميل ورصيف واسع مطل على الخليج وقف عليه كما هي العادة عشرات بقصبات الصيد. كان هناك المسرح الذي عدنا إليه مراراً. ولم أفهم للآن لماذا تعود إلى المسرح نفسه مراراً ما دمنا لسنا في عرض، لكن اليوم الأخير من المهرجان حفل بجديد. كانت القراءة هذه المرة في زقاق (أزقة اسطنبول في روعة أزقة باريس) أمام مقهى، ملأ الحاضرون كراسي المقهى ووقف من وقف من بعيد أو قريب. امتلأ الزقاق تقريباً. كانت القراءة على شرفة محل وبلا ميكرفون، وقف الشاعر التركي الذي قضى وقتاً في السجن وقال إن صوته لا يساعده وقرأ بصوت مسموع ما أمكن. شاعر تركي آخر بدأ يؤدي فصلاً على الشرفة، لم يقرأ شعراً بل ألقى خطاباً مليئاً بالتداعيات. كان يشير بيديه ويبتسم. فهمت انه بدأ بالكلام عن عابر المحيط الطيار الأميركي روزنبرغ الذي اعدم وزوجته بعد أن اتهما بالتجسس، كانت هذه مناسبة للكلام عن أميركا. سال خطاب الشاعر وبدا انه فلت منه ولم يعد بمستطاعه إيقافه وكلما بدا انه وصل إلى نهاية عاد فأقلع من جديد. كان الحضور في الأغلب يصغى بانتباه لكن الطول ما لبث أن ألقى ماء على حماسه. الشاعر المعروف الذي كنت التقيته في لوديف ويتكلم الفرنسية كان متأسفاً لما يسمعه، وجد فيه تهريجاً فحسب، لكن تجربة الإلقاء في شارع كانت جميلة، بحيث لم ننتبه إلا بعد وقت إلى انها انتهت، ولم نفهم لماذا علينا بسبب ذلك أن نخرج من المقهى، ربما لنبحث عن مقهى آخر.
في مكان سفلي ذي تاريخ عريق، كان خزانا لمياه اسطنبول وبني كالعادة على اثر بيزنطي انعقدت الأمسية الأكثر إثارة. هبطنا إلى ما يشبه قاعة أعمدة كانت سقسقة المياه تصل إلى أسماعنا، فيما الضوء، الخافت العامر بالظلال يلتف على الأعمدة ويقتم في الزوايا ويرفرف في الهواء. اطلينا على برك ضحلة انحلت فيها العتمة الشفافة فيما كانت تفرفر اسماك كبيرة وغريبة، لا يتناسب حجمها مع رقة الماء وضآلته الظاهرة، كأنها نبعت من مكان لا يحتاج إلى أكثر من الذكرى. كان المنبر جزيرة صغيرة منقطعة وسط المياه مدوا اليها جسراً، جلس الناس صفوفاً طويلة للغاية في هذا الممر الضيق الذي كان أيضا أشبه بلسان بحري. الماء كان يترك ذكراه الكبيرة وربما شفافيته في المكان كله، وحين بدأ الشعر بدأ وكأنه يرتسم ويتبدد عليه، لم يكن هناك أي خطر ليقولوا ما يشاؤون.
السفير
30 يونيو 2006
إقرأ أيضاً: