"علينا أن نكون لكي يُتاح لنا، في نهاية الأمر، أن نصير"
يوسف الخال
كيف نقرأ مجلة «شعر» بعد نصف قرن على صدورها؟
 كف نقرأ مجلة «شعر» في الذكرى الخمسين لصدور عددها الأول شتاء العام 1957؟ هل نقرأها كمجلة ما زالت حاضرة في مناخها الحداثي الذي رسخته وعبر القضايا الرئيسية التي أثارتها بجرأة وعمق؟ أم نقرأها كتجربة فريدة باتت تنتمي الى ماضي الحداثة وكحركة جماعية أضحت جزءاً أساسياً من ذاكرة الشعر الحديث؟ اللافت أن مجلة «شعر» لم تغب حتى عن المعترك الشعري الراهن، وما برح الشعراء والنقاد يعودون اليها والى شعرائها والى بياناتها والنظريات التي تبنتها. فالمجلة التي اعادت النظر في الشعر العربي والثقافة العربية لم تكن مجرد منبر شعري التأم حوله شعراء معاصرون، يختلف واحدهم عن الآخر، بل كانت حركة بذاتها، حركة هدم وبناء، حركة تمرد وتأسيس.
كف نقرأ مجلة «شعر» في الذكرى الخمسين لصدور عددها الأول شتاء العام 1957؟ هل نقرأها كمجلة ما زالت حاضرة في مناخها الحداثي الذي رسخته وعبر القضايا الرئيسية التي أثارتها بجرأة وعمق؟ أم نقرأها كتجربة فريدة باتت تنتمي الى ماضي الحداثة وكحركة جماعية أضحت جزءاً أساسياً من ذاكرة الشعر الحديث؟ اللافت أن مجلة «شعر» لم تغب حتى عن المعترك الشعري الراهن، وما برح الشعراء والنقاد يعودون اليها والى شعرائها والى بياناتها والنظريات التي تبنتها. فالمجلة التي اعادت النظر في الشعر العربي والثقافة العربية لم تكن مجرد منبر شعري التأم حوله شعراء معاصرون، يختلف واحدهم عن الآخر، بل كانت حركة بذاتها، حركة هدم وبناء، حركة تمرد وتأسيس.
ولم تكن «شعر» مجلة يوسف الخال الشاعر بل كانت مجلة الشعراء الذين انتموا اليها وشاركوا في معاركها. وإن كان يوسف الخال هو الذي أسسها ووجه حركتها وكتب معظم افتتاحياتها فهو لم يستأثر بها ولم يفرض ظله عليها كما يفعل المؤسسون عادة. ولم تصدر ثلاثة أعداد من المجلة حتى حمل العدد الرابع اسم الشاعر ادونيس سكرتيراً للتحرير. ثم توالت أسماء شوقي أبي شقرا وأنسي الحاج وفؤاد رفقه وسواهم في هيئة التحرير.
عندما باشر يوسف الخال في اصدار العدد الأول من مجلته في شتاء العام 1957 لم يعمد الى كتابة افتتاحية يعلن فيها اهداف مشروعه، لكنه اختار مقالة للشاعر الأميركي المعاصر ارشيبولد ماكليش (توفي العام 1982) وجعلها بمثابة الافتتاحية الأولى. ولم يتضح سبب اختيار اسم هذا الشاعر الأميركي خصوصاً أن المجلة لم تقدم لاحقاً أي ترجمات من شعره ولم تكتب عنه أسوة ببعض الشعراء الأميركيين مثل روبرت فروست وولت ويتمان وسواهما. ربما اختار الخال مقالة ماكليش مقدمة للعدد الأول ليتبنى نظرته الى الشعر كأداة وحيدة للمعرفة، وكذلك موقفه السلبي من «الشعر السياسي».
الافتتاحية الأولى في مجلة «شعر» لم تظهر إلا بدءاً من العدد الرابع الذي كرس انتماء ادونيس الى المجلة. وكانت الافتتاحية هذه هي البيان الشعري «الرسمي» الأول الذي رسخ الخال فيه منطلقات مشروعه قبل أن تصبح المجلة مجلة جماعية بعيد انضمام بقية الشعراء الى اسرة التحرير. وأصر الخال في افتتاحيته الأولى على منطلقاته التي كان أعلنها في محاضرته سابقاً والتي أصبحت «ثوابت» شبه نهائية يرددها الشاعر كلما تطرق الى مشروعه التحديثي، وينطلق منها في معاركه ومواجهاته. فالشعر كما فهمه الخال هو «تجربة شخصية كيانية فريدة» والتعبير عنها ينبغي أن يتحرر من أسر القوالب التقليدية الموروثة. التجربة هي الأصل وليس الشكل الا فرعاً، و «التجربة الجديدة تفرض التعبير الحي الجديد» والتعبير الحي هو التفاعل مع روح العصر والبحث عن لغة متطورة.
كانت مجلة «شعر» بمثابة الصدمة الأولى في تاريخ الشعر العربي. ولم تكن مواجهة شعرائها الحاسمة للشعر التقليدي والثقافة التقليدية الا انفصالاً عن التاريخ بغية قراءته قراءة نقدية. وأدركت المجلة أهمية المرحلة التي انطلقت خلالها وهي مرحلة الستينات التي سميت مرحلة «التحرر» الشامل. فأعلنت ثورتها ضد كل ما ورثته كحركة من ثوابت ومسلمات جامدة ومتحجرة. وبدت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاسئلة والقضايا التي شغلت العصر وخضت العالم العربي، ووجدت في تلك الاسئلة والقضايا حافزاً على التخطي والتجاوز وعلى الانطلاق نحو أفق كياني أعمق وأشمل.
لكن مجلة «شعر» لم تسلم من الحملات العدائية التي شنها عليها المثقفون «العروبيون» و «الملتزمون» و «دعاة الوحدة العربية والواقعية الاشتراكية تؤازرهم مجلة «الآداب» التي كانت تمثل التيار العروبي الناصري ومجلة «الثقافة الوطنية» التابعة للحزب الشيوعي اللبناني. وكان لا بد من أن تثير المواقف الثورية التي تبناها يوسف الخال ورفاقه حفيظة هؤلاء المثقفين العروبيين الذين وجدوا في مشروع المجلة حركة مناقضة للمشروع العربي والديموقراطي والوطني الذي نادوا به.
تبنت مجلة «شعر» اذاً بعض الثوابت النظرية وانطلقت منها ودأب يوسف ال خال على التذكير بها من حين الى آخر في افتتاحياته التي كانت أشبه بالبيانات الشعرية في أحيان. ولئن تبنى بعض شعراء المجلة هذه الثوابت وبخاصة ادونيس وفؤاد رفقه وسواهما من الذين التزموا النظام التفعيلي الجديد فإن شاعراً كأنسي الحاج لم يلتزمها بل بدا غير معني بها بعدما مضى في خوض تجربته الخاصة في حقل قصيدة النثر. وبدا محمد الماغوط كذلك بعيداً كل البعد عن بعض ثوابت المجلة إذ راح يكتب قصيدته من غير أن يلجأ الى أي نظرية شعرية أو نقدية. وخرج شوقي أبي شقرا بدوره عن نظام التفاعيل ليباشر في كتابة قصائده المشبعة بالرواء اللبناني والشميم القروي والفكاهة والطرافة. ولن يتأخر ادونيس كثيراً عن اعتماد النثر وقصيدته من غير ان يتخلى عن قصيدة التفعيلة التي ما برح يواظب عليها. وهو كان واحداً من أبرز الذين نظروا للحداثة بحسب ما فهمها ورأى اليها، اضافة الى عمله على التراث الشعري وانتخاب مختارات منه نشرها تباعاً في «شعر».
احدثت مجلة «شعر» صدمة في الحياة الشعرية بعدما اختارت طريق الثورة والتمرد والشك والرفض وراحت تبحث عن قصيدة مختلفة في رؤيتها ورؤياها وفي موضوعاتها وأساليبها، وأعادت قراءة التراث على ضوء المعاصرة، وكرست الحياة جوهراً للعمل الشعري. غير أن مبادئها سرعان ما أصبحت ثوابت شبه جامدة وشبه مطلقة، بل أصبحت أقرب الى المقاييس النظرية القائمة بذاتها، خصوصاً بعدما راح شعراؤها خلال السنوات اللاحقة يتباعدون بعضهم عن بعض، وراحت تجاربهم تختلف بعضها عن بعض. وفيما أمعن ادونيس في التنظير للحداثة قبل أن ينسحب من المجلة في العام 1963 كان شعراء وكتاب ونقاد يمهدون الطريق نقدياً ونظرياً للثورة الشعرية الحديثة، فاذا ماجد فخري يتحدث عن «الشعر الانساني الوجودي» ورينيه حبشي عن «الميتافيزياء كحالة من حالات الشعر الأصفى» وأدونيس عن «الكائن الميتافيزيقي الذي يغوص الى عمق الاعماق» وفؤاد رفقه عن «الفكرة الغيبية الكبرى» للقصيدة الحديثة ونديم نعيمة عن «الحياة» التي هي بحسبه «ألف الشعر وياؤه، قالبه ووزنه وقافيته». أما بدر شاكر السياب فتمثل الشاعر الحديث في صورة القديس يوحنا وقد افترست عينيه رؤياه وهو يبصر الخطايا السبع تطبق على العالم. إلا أن انسحاب ادونيس من المجلة في عامها السابع لم يؤثر في حركتها ونشاطها، فهي استمرت بعده مثلما انطلقت. ولم يكن لانسحاب ادونيس خلفية سياسية أو ابداعية، كان بدأ يحس ان ظاهرته ما عادت قابلة للخضوع للغطاء الجماعي، ولم يلبث أن اصدر بعد سنوات قليلة مجلة «مواقف» لتكون منبراً أدونيسياً بامتياز ولكن مفتوحاً أمام التجارب الجديدة والشابة. وقبيل انسحاب ادونيس كان بدأ جو من التململ يهيمن على المجلة. فالشعراء الذين خاضوا المعركة وانتصروا فيها شعروا بأن مهمتهم شارفت نهايتها لا كأفراد وإنما كجماعة. وها هو أنسي الحاج يعرب في افتتاحية العدد 27 (صيف 1963) عن «الحماسة التي خفتت» بعدما «ازداد الوعي». فالحركة الشعرية انتقلت برأيه بعد شحنتها الاولى الى مهمة التعميق وباتت انضج واشد مسؤولية. ويسأل الحاج في الافتتاحية اللافتة: «أصحيح أن ما ظنناه الكثير هو أقل من القليل وأن بيننا من فسدوا وفي وقت قصير وفي عز المعركة وصاروا اصناماً؟. وينفي الحاج التهمة الذاتية تهمة الأمان والطمأنينة» مصراً على أن شعراء المجلة ما برحوا يسكنون في «احشاء الفاجع». وكان جريئاً في نقض مقولة العمل الجماعي وكسر هالة الجماعة التي وصمت المجلة ومما قال: نحن لسنا حركة، في معنى اننا لسنا حزباً. وما ندعوه «شعراء» مجلة «شعر» هو من باب التبسيط ولا معنى شعرياً جدياً له». وكان على هذا الموقف الجريء والصريح أن يؤذن ببدء افتراق الجماعة التي اصبحت مجموعة شعراء، وهي ربما هكذا كانت منذ انطلاقتها.
ولم تمض أشهر حتى راحت تلوح في أفق المجلة ملامح أزمة ما. وبعد افتتاحية انسي الحاج (صيف 1963) العاصفة كتب عصام محفوظ افتتاحية أخرى عن «الأزمة الشعرية العابرة» مستبقاً توقف المجلة عن الصدور بعد اشهر. وأدرك محفوظ جوهر الأزمة بدوره قائلاً: «لم نكن مدرسة ولا هيئة تبشير ولا مجموعة نزوات ولا عصبة أدب. كنا ضرورة وحقيقة». وصدر العدد الأخير من مجلة «شعر» (صيف وخريف 1964 – السنة الثامنة) حاملاً «البيان الختامي» وقصيدة وداعية كتبها يوسف الخال في عنوان «الرفاق». وفي البيان الختامي الشهير أعلن الخال اصطدام الحركة والمجلة بما سماه «جدار اللغة». وكان على المجلة اما ان تخترق الجدار وإما أن تقع صريعة أمامه. اما جدار اللغة فتمثل في نظر الخال في كونها لغة «تكتب ولا تحكى». وهذا ما جعل الأدب اكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة. وفي بيانه اعرب الخال عن خيبته من اللغة الفصحى وعن عجزها عن مواصلة الثورة التي كان بدأ بها. وانطلاقاً من البيان باشر الخال تجربته اللغوية الجديدة أو «الولادة الثانية» كما أفاد عنوان كتابه الذي كان فاتحة عهده الجديد، عهد اللغة العربية الحديثة. الا ان شعراء المجلة لم يسلكوا مسلك الخال اللغوي بل أصروا على اللغة الفصحى غير عابئين بأزمة ذلك «الجدار». وبعضهم واصل خطه الابداعي مضيفاً الى قديمه جديداً ساطعاً ومتجلياً. وبدا واضحاً أن الازمة كانت أزمة يوسف الخال نفسه، يوسف الخال الشاعر الدائم التجدد والدائم التمرد.
ولكن لم تلبث مجلة «شعر» ان عادت بعد قرابة ثلاث سنوات من الاحتجاب (شتاء/ربيع 1967) ولكن في صيغة جديدة. فلا رئيس تحرير لها وانما هيئة تحرير فقط ومن ضمنها: يوسف الخال، فؤاد رفقه، انسي الحاج، شوقي أبي شقرا، عصام محفوظ، رياض نجيب الريس... وتبعاً لصدورها عن «دار النهار» اتسمت المجلة بما يشبه الطابع الصحافي في انفتاحها على احداث المرحلة، وفي اعتمادها بعض المقالات والمراسلات. لكنها لم تتخل لحظة عن الهم الابداعي والنقدي بل شرّعت صفحاتها للقصة والرواية والنصوص المسرحية. ولم تدم المجلة في صيغتها الثانية أكثر من ثلاث سنوات فتوقفت في خريف العام 1970 وحمل عددها الأخير الرقم الرابع والاربعين. وفي العام 1983 جمع يوسف الخال بعض شعراء مجلة «شعر» في دارته في بلدة غزير (شرق بيروت) ساعياً الى اصدار المجلة اصداراً ثالثاً، فاتحاً المجال أمام الشعراء الشباب ليساهموا فيها، لكن المحاولة لم تنجح لأسباب عدة، شعرية و «جيلية» وفكرية...
كيف نقرأ مجلة «شعر» في الذكرى الخمسين لصدور عددها الأول؟ لا شك في أن المجلة ما زالت حاضرة وكأن السنوات التي مرت على انطلاقتها لم تزدها إلا وهجاً على رغم انضمامها الى تراث الحداثة. فآثارها ما برحت واضحة في نتاج الشعراء الذين خلفوها. وثورتها ما زالت مستمرة في التجارب الابداعية الشابة التي تتجدد باستمرار. ولئن شاخ الكثير من ثوابتها ومنطلقاتها النظرية وبعض تجاربها الابداعية فإن روحها كحركة ومناخ لا تزال تخيم فوق خريطة الشعر العربي الراهن. والعودة الى اعدادها تظل مثيرة نظراً الى ما تضم هذه الاعداد من قصائد ومقالات وترجمات ما زالت مهمة حتى اليوم على رغم «خريفها». ويكفي أن هذه المجلة تمكنت فعلاً من ترسيخ صورة حية للحركة الشعرية العالمية في الستينات، التي لا تزال آثارها بينة في الشعر العالمي الراهن.
كنتُ من شعرائها البعيدين
 أعتقد بأنّ لي الحقّ في أن أحتفل في صورة شخصيّة بذكرى مرور نصف قرن على تأسيس مجلة «شعر» والسبب – أكرّر – شخصيّ جداً. فالعدد الأوّل من المجلّة تضمّن قصيدة لي كنت أرسلتها إلى يوسف الخال وكنت حينذاك، أي في العام 1957، شاعراً مجهولاً. نشر الخال القصيدة من غير أن يعرف أيّ أمر عنّي. ومن هنا أحترم هذا الشاعر وفطنته التي كشفت شعراء كثيرين، وقيل لاحقاً إنه هو الذي أصرّ على نشر قصيدتي في العدد الأوّل على رغم اعتراض بعض الشعراء. وقد منع العدد في العراق بسبب قصيدتي.
أعتقد بأنّ لي الحقّ في أن أحتفل في صورة شخصيّة بذكرى مرور نصف قرن على تأسيس مجلة «شعر» والسبب – أكرّر – شخصيّ جداً. فالعدد الأوّل من المجلّة تضمّن قصيدة لي كنت أرسلتها إلى يوسف الخال وكنت حينذاك، أي في العام 1957، شاعراً مجهولاً. نشر الخال القصيدة من غير أن يعرف أيّ أمر عنّي. ومن هنا أحترم هذا الشاعر وفطنته التي كشفت شعراء كثيرين، وقيل لاحقاً إنه هو الذي أصرّ على نشر قصيدتي في العدد الأوّل على رغم اعتراض بعض الشعراء. وقد منع العدد في العراق بسبب قصيدتي.
واصلت النشر في مجلّة «شعر» طوال سنوات وكان الخال يرحّب بقصائدي دائماً ولم تكن بيننا أيّ علاقة شخصيّة، واللافت أنني لم ألتقِ به أبداً خلال حياتي. حتى أيام كنت في بيروت خلال الحرب الأهليّة، لم أستطع أن ألتقي به. كانت الظروف صعبة وكان الخال يسكن بعيداً من بيروت. وعندما توفي الخال شعرت بحزن شديد وألم ولم أستطع أن أشارك في جنازته.
أدّت مجلّة «شعر» ويوسف الخال على رأسها، دوراً تحديثياً كبيراً في الشعر العربي وكانت مجلّة طليعية في كلّ ما تعني الطليعيّة من معان. وإن كنت بعيداً عن «مطبخ» المجلّة وعن لقاءاتها ومعتركها فإنني أعدّ نفسي من شعرائها ولو من بعيد.
ولا أنسى لحظة كيف أخرجتني مجلّة «شعر» من عزلتي الخانقة في العراق في تلك الحقبة.
مدرسة في الكتابة الجديدة
على كثرة ما قيل ويقال عن «مجلة شعر» سلباً وإيجاباً قدحاً ومديحاً، فإنها في حقيقة موقفها وتأثيرها لم تكن مجلة فحسب وإنما مدرسة في الكتابة الشعرية، ولا ريب في ان خمسين عاماً منذ صدورها حتى الآن تبدو كافية لتقويم دورها الإبداعي الذي نقل الشعر من عصر الى عصر وأشاع مناخاً من الكتابات الحديثة، بل جعل من الحداثة الأدبية شأناً مهماً يتوازن مع محاولات التحديث في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية، إذ ينبغي ألا ننسى ان مجلة شعر ظهرت في عنفوان المد القومي العربي وفي سنوات الحراك السياسي اليساري بأسمائه وشعاراته المختلفة.
واللافت انه حتى بعدما قضت هذه المجلة نحبها، فقد استمر تأثيرها في الأجيال اللاحقة ولم يذهب صوتها كما ذهبت أصوات تحديثية كثيرة أدراج الرياح، ولا تزال أعدادها القليلة نسبياً اذا ما قيست بأعداد مجلات عربية مشابهة، لا تزال مثار جدل ونقاش ودراسات علمية ليس آخرها رسالة ماجستير في صنعاء.
صحيح ان اجيالاً جديدة من الشعراء تجاوزت هذه المدرسة ووصلت بالقضية الى درجة اكثر سعة وعمقاً مما كانت تدعو إليه أو بالأصح تبشر به مجلة شعر، إلا ان الفضل للمتقدم كما يقال وهي من دون ادنى شك صاحبة هذا الفضل المتقدم. وأن دور الأنوار التحديثي في مجال الشعر الذي أدته هذه المجلة – على رغم ما قوبلت به من تهجمات واتهامات – لا ينكر ولا يجوز ان يتجاهله الدارسون فقد تجاوزت بدورها الإرهاصات التي بدأت مع الرواد الأوائل في الوطن العربي والمهجر، وحرّكت المياه الآسنة في اقل وقت من الزمن، وذلك في حد ذاته جهد لا يُنسى ويستحق التذكير والتقدير والتكريم.
لذا نرى ان توقف المجلة كان مؤثراً في توقف حركة التحديث الشعري ذاتها وتأجيلاً لمشروع الحداثة العربية وهي في أوج اندفاعتها التجديدية التي لامست – خلاف الموجات الأخرى – لغة الشعر وإيقاعه وموضوعاته ومكانته في الحياة.
من «كشكول» الى حالة خاصة
في الذكرى الخمسين لولادة مجلة «شعر»، أهم ما استذكره، ذلك الشغف القديم بالشعر، اقصد شغف الشعراء والناس، والهامشيين والحالمين، كفعل وجود، وفعل تغيير، وفعل حياة. ومجلة «شعر» صُنعت من هذا الشغف، لا سيما شغف مؤسسها يوسف الخال، الأجمل والأنبل والأوفى والأكرم... والأكثر شغفاً. وبهذا الشغف الحي، المجاني، انتقلت من كشكول يجمع ما كان سائداً أو سابقاً (وبلا نظرية مسبقة). لا سيما في أعدادها الأولى، من شعر تفعيلة وعمودي، الى موقع آخر. بدأت بنصوص عمومية لأحداث كبيرة وغير كبيرة: من جورج غانم، الى بدوي الجبل، الى جورج صيدح وخليل حاوي، وفؤاد رفقة، وأدونيس، وفدوى طوقان وبدر شاكر السياب... وكلهم ينتمي إما الى تجربة الشعر الحر أو العمودي (سعيد عقل لم ينشر فيها) أو الى التفعيلة... من دون أي قصيدة نثر واحدة في اعدادها الأُوَل. أو أي نظرية «مغايرة» او أي دعوة الى «التمرد» و «الفوضى» وكسر السائد... الى آخر هذه المقولات التي سادت أوروبا وأميركا منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين.
بيروت في نهاية الخمسينات كانت سبقت الجميع الى احتضان الرهانات الجديدة، والثورية، كان المجتمع كله (في لبنان) في طور الخروج من التاريخي والتقليدي والمحافظ والجامد الى ما هو جديد، ومتغير، ومتحرك... ومجهول. وكلنا يذكر ذلك الغليان الثقافي والفكري والسياسي والنقابي والطالبي في تلك المرحلة المؤسسة لثقافة جديدة متعددة في ظل ديموقراطية ناشئة (وإن نسبية). وكان على مجلة «شعر» ان تلتحق بهذا الغليان الذي يحيط بها، ليكون لها الحيز الذي يليق بها، ويليق ببيروت، وكان عليها ان تتدارك كونها مجرد مرآة للثقافة الى ان تكون نافذة بل ونوافذ وآفاقاً. وكان على بعض الأصوات الهامشية ان تنبثق لتحاول إعطاء الوجه البيروتي – التجاوزي للمجلة كمحمد الماغوط، وأنسي الحاج، وأدونيس، وشوقي ابي شقرا، وبشر فارس، وفؤاد رفقة... وعصام محفوظ. وكان على المجلة، ان تكون بذلك ابنة المكان الذي شحنها بطاقاته المدينية (معظم شعرائها من الأرياف)، أي ابنة التحولات التي كانت تتمخض بها بيروت، إزاء التحولات التي كانت تجسدها مجلات كـ «الآداب» ابنة الفكرة العربية المتفتحة، من قومية عربية وعروبة والتزام.
إذاً، بيروت الشغوفة اصابت بعدواها (والشغف عدوى) كل شيء. بل كأن كل شيء كان شغوفاً كبيروت، وشعراء مجلة «شعر» لم ينجوا من هذه العدوى. كانوا شغوفي الحلم، والاختلاف، والجديد، والتمرد، والحرية.
هكذا كانت بيروت، وهكذا كان الشعراء من «شعر» وسواها. ولكن اين هم اليوم، شغوفو الأمس؟ اتراهم شفوا من العدوى، لتصيبهم اخرى، وتنقلهم الى المقالب الأخرى من عبادة الذات، والسعي الى التكريس، وفقدان الهامش والانضمام الى... سلامة الهامش.
زحزحة الأحجار الصنمية
لم تكن «شعر» مجرد مجلة بقدر ما كانت حالة ثقافية متحركة ومتطورة باستمرار تحت وطأة التجريب النظري والإبداعي معاً وفي شكل متواز.
وباعتبارها تمثل «الحداثة الثانية» في تاريخ الشعرية العربية المعاصرة بعد حداثة نازك الملائكة وبدر شاكر السياب المترددة والمرتبكة، فإن «شعر» بدت منذ عددها الأول قادرة على إحداث الصدمة المطلوبة لزحزحة الأحجار الصنمية، وقد نجحت في ذلك فعلاً، وربما كان إنجازها الاكبر ما اثارته من جدل يسمو أحياناً الى مرتبة الحوار، وينحدر احياناً الى مرتبة اللغط. وبين المرتبتين تحددت مكانة المجلة، في تاريخ الشعرية العربية... ليس توازياً مع زمن صدورها فحسب بل استلحاقاً بهذا الزمن.
ولعل في المناسبة، اكثر من دليل على ما أثارته هذه المجلة من حيوية في الشعر والشعرية والشعراء أيضاً، وما بثته من روح نقدية سرت في أعضاء «المقدسات» الشعرية العربية.
ولعل هذا تحديداً ما عرض المجلة كحركة وكتجربة وكممثلين لهذه التجربة الى ما يمكن اعتباره «مؤامرة» حقيقية تتكئ على نظرية «المؤامرة» الموهومة في سبيل تجريدها من هويتها التغييرية واعتبارها مجرد أداة لهدم التراث بصفته العقائدية. ولم تدع «شعر» عكس ذلك، ولكنها، وكما بدا مما نشرته من بيانات ومقالات وتطبيقات ابداعية لأهلها الأوائل أكملت وظيفة الأداة بأنها للهدم وللبناء معاً وفي الوقت ذاته، أي انها تجريب قائم على إعادة الخلق، والبحث الدائم عن مستحيل الشعر.
وإذا كان اكبر الأثر تركته «شعر» لدى مجايلي زمن صدورها، فإن لها من الأثر ما بقي إرثاً لدى من لم يعش ذلك الزمن، فقد ساهمت هذه المجلة، أحياناً من حيث لا يدري ولا يقصد مؤسسوها وكتابها وراسمو سياستها، في انتاج شعرية عربية قادرة على التجاوز حد القطيعة المعرفية مع التراث العربي، وعلى اعادة انتاج هذا التراث بما يتلاءم والفهم الجديد لوظيفة الشعر (ان كانت له وظيفة أصلاً)، وفقاً للانطلاقات الفكرية وحجم الموهبة لدى كل من هؤلاء المؤسسين. فما كتبه أدونيس كمساهمة في تكوين كيان «شعر» لا يتوافق، في هذه النقطة المحددة، مع ما كتبه أنسي الحاج من المنطلق ذاته، وما تساهل فيه فؤاد رفقة في تعاطيه مع التراث العربي الشعري تحديداً لا يتلاءم والاصطدام بجدار اللغة الذي عانى منه يوسف الخال... وهكذا.
علامة في ثقافة التحديث
مثلما هو معروف، أن جديد اليوم هو قديم الغد وقديم اليوم هو جديد الأمس، فإنّ الواقع يقول بأن مجلة «شعر» كانت إبان صدورها لافتة ومحل أخذ وردّ في الأوساط الثقافيّة في خمسينات القرن الماضي وحتى توقفها ومن قبل انقطاعها في الستينات، فعمرها على رغم قصره إلا أنّها كانت ذات تأثير تحوّلي في الذائقة العربيّة النزّاعة إلى الحداثة والتجديد وقد قامت بدورها المطلوب في وقت وجودها المتمثّل في الصدور، وعندما توقفت أصبحت في محل من الذاكرة لدى البعض وأمحت عند الكثيرين، لقد فتحت الأفق ومهّدت للتغيير السائد الآن بتفوّق على ما كانت تأمله المجلة في ذلك الوقت.
هي «شعر» في الحقيقة تعتبر علامة ومنعطفاً بارزاً في ثقافة التجديد والتحديث ذلك الوقت، أمّا اليوم فهي في نظري مثل المجلاّت التي سبقتها في الصدور ثم اختفت بعد أن قامت بالدور الذي صدرت من أجله مثل «ابولو» و «الرسالة» و «الأديب» أو التي صدرت معها «حوار» و «ادب» وغيرها من المجلاّت العربيّة التي عنيت بالأدب الحديث واستقطبت الأجيال الجديدة.
فمجلة «شعر» هي اليوم تخضع للدراسات والتكثيف مثلها مثل سابقاتها. لقد أدّت دورها في وقتها، ولو أُعيد نشر النصوص التي كانت تحملها صفحات المجلة اليوم مع ما ينشر اليوم من نصوص «قصيدة النثر» لاتّضح الفرق وتبيّن أنّ الزمن عجلة دوارة فما كان بالأمس لن يكون اليوم وقد قيل (إنك لن تسبح في النهر ذاته مرّتين). فـ «شعر» كانت بالأمس أما اليوم فهي تذكار فلننظر إلى منشطات الحداثة الموجودة اليوم خير من نبش الماضي وسنظل نتذكّر: رسالة أحمد حسن الزيات مع ابولو أحمد زكي أبو شادي. وشعر يوسف الخال وكذلك الأديب وألبير أديب، وحوار توفيق صايغ، وأدب كلافتات بارزة خطت بوضوح وبخط جميل، غير أنّ اللوحات الالكترونية الحديثة طمست تلك.
نافذة بيروت
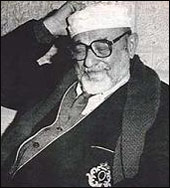 تصادف، ولعلها من مصادفات الضرورة، ان تكون نوافذي المطلة على حقول النور من نـوع النوافذ المفتوحة المقابلة بطبيعتها للاتساع، والتي سعى البعض عامدين الى تضييقها. كانت قاهرة عقود ما قبل سنة 1952 تمثل النافذة التي يمكن ان تسمح لي برؤية المتعدد يحتضن النسبي، برؤية الشك يزرع اليقين، برؤية قيام المدينة المدينة محل المدينة القرية أو المدينة الصحراء. ورؤية طه حسين والمازني وجورج حنين ورفاقهم يسعون من دون كلل في اتجاه قيامة الإنسان.
تصادف، ولعلها من مصادفات الضرورة، ان تكون نوافذي المطلة على حقول النور من نـوع النوافذ المفتوحة المقابلة بطبيعتها للاتساع، والتي سعى البعض عامدين الى تضييقها. كانت قاهرة عقود ما قبل سنة 1952 تمثل النافذة التي يمكن ان تسمح لي برؤية المتعدد يحتضن النسبي، برؤية الشك يزرع اليقين، برؤية قيام المدينة المدينة محل المدينة القرية أو المدينة الصحراء. ورؤية طه حسين والمازني وجورج حنين ورفاقهم يسعون من دون كلل في اتجاه قيامة الإنسان.
هذه القاهرة قمعتها أقدام الخراتيت اصحاب القرن الواحد، اقدام الفرقة الناجية التي ظلت تلبس ملابس العسكر، وتعتلي رؤوس الناس، وبينها رؤوس الشعراء والكتّاب، وتجعلها على هيئة الأحذية الجلدية اللماعة، إلا الذين بادوا أو أُخرجوا من ديارهم أو سُجنوا، وخرجوا من السجون عشاقاً للعزلة أو ظلالاً لأنفسهم. لذا اصبحت القاهرة هي ما نراه الآن، إما ارضاً بلا سماء، أو سماء بلا أرض.
وكانت بيروت اواسط الخمسينات وما بعد تمثل النافذة التي يمكن ان تسمح برؤية آفاق الخلاص، برؤية الشعر في النثر، والحرية في الثورة، والنظام في الدولة، ورؤية شعراء شعر المرشوقين بالتهم، العملاء والخونة وأعداء الشعب، والمنذورين للخراب، ورؤية القاموس الخفي لخصومهم قاموس الخوف من الحرية، كان شعراء شعر يسعون من دون كلل في اتجاه ميدان القيامة، قيامة انسان جديد، مشمول بضعفه وقوته، بهزائمه وكبريائه. هذه البيروت قمعتها في ما بعد اقدام العودة الى تمجيد البطل، العودة الى علم ظن أصحابه انه يفوق المعرفة، ويفوق المتعة، وإيديولوجيا ظنوا انها تفوق الشك، وإيمان ظنوا انه قسري، وشعر قدسه صانعوه بما انه منتوج للاستعمال مرة واحدة فقط.
النافذتان كانتا تطلان على شارعين يتقابلان عند ميدان، كان واسعاً في ما مضى، لكنه اصبح الآن مسكوناً بالقوميين وشعراء النضال، وأساتذة وطني حبيبي وطني الأكبر، وشعراء قصيدة النثر كعقيدة حداثية واجبة، وهم غير شعراء قصيدة النثر كآلة رؤيا، والعساكر، وملوك الطوائف، وميليشيات من تلامذة طه حسين، يمجدونه ويشنقون أفكاره، وميليشيات من تلامذة شعر، يمجدون ويشنقون ايضاً. لذا يمكنك ان ترى طه حسين وهو البصير جداً يصطدم بجدار المعنى، وأن ترى المازني ينام في قبره، ويوسف الخال يصطدم بجدار اللغة، وشوقي أبا شقرا يلوذ بجمال الحلوة، يمكنك ان ترى نجوماً آخرين ولدوا من سرة اليقين، وجعلوه يشبه الشك، ستراهم يضعون اقراص الشمس تحت آباطهم وعيون القمر في حقائبهم هكذا هكذا، ويسحبون الجماهير خلفهم من بلد ضائع الى بلد ضائع، ويرصونهم باقتدار داخل استادات معدة خصيصاً لصيد أسراب البشر وترويضها، ثم يقفون على منصات عالية ليقرأوا قصائد الانتصار، الانتصار على الماضي، وعلى الحاضر، وعلى المستقبل.
من اجل هذه الأعراس أعلن انني أحب آبائي القريبين طه حسين والمازني وجورج حنين ورفاقهم، وأعلن انني ما زلت اعمل قصاص أثر اخوتي الذين سبقوني، أنقب في حديقة القديسة بحثاً عن طزاجة شوقي ابي شقرا، أهتف مع انسي الحاج «نعم الشعراء ينهزمون في الختام» امشي في الطرقات مع ادونيس وأصافح الأولياء، وأتخيل انني امشي مع الخال وفؤاد رفقة في طرقات لا نعرفها، ولا أزعم مع الزاعمين انهم اخوتنا الأعداء، لأنهم، وهم بالتحديد، لا يمكن ان يقبلوا ان يكون الحد من حريتنا ثمناً لاحترامهم، هم بالتحديد، لا يمكن ان يقبلوا ان يكونوا الذرية الأخيرة للشعر والشعراء، هم بالتحديد يحبون المتنبي أو لا يحبونه، ولكنهم يكرهون فيه بحثه الدائم عن سيف الدولة، وعن ذهب سيف الدولة، وعن طغيان سيف الدولة، وعن العظام الباقية من جثة سيف الدولة.
منعطف شعري عربي
لفرط ما تحدث شعراء قصيدة النثر العربية عن مجلة «شعر» يظن المرء ان المجلة كرست نفسها لهذه الدعاوى، رافضة الأشكال الشعرية القائمة في قلب اللحظة العربية، والحال، ان الأمر ليس كذلك، إذ إن أبرز القائمين على تحريرها يوسف الخال وأدونيس ظلا وفيين، الى حد بعيد، لشكل التفعيلة الذي لم يكن، لحظتها، شكلاً تقليدياً ولا قديم العهد. الاستثناء الوحيد في إطار الهيئة التحريرية للمجلة كان أنسي الحاج الذي لم يأت من العمودي ولا من «التفعيلة» بل من قصيدة جديدة ستفتح لها المجلة أبوابها وستنظّر لها تحت تسمية «قصيدة النثر». لكن التباساً سيطاول هذه التسمية عندما ستصنف قصائد الماغوط التي قدمها «خميس شعر» ونشرتها المجلة بصفتها قصائد نثر.
لم تكن قصائد الماغوط، بحسب وعينا الراهن لقصيدة النثر في اصلها الغربي، قصائد نثر، بل على الغالب قصائد من الشعر الحر (بمفهومه الغربي، تقريباً)، على رغم ان أدونيس وأنسي الحاج نظّرا لقصيدة النثر انطلاقاً، كما نعرف، من كتاب الباحثة الفرنسية الصادر في ذلك الوقت، والذي يرسم إطاراً شكلياً ومضمونياً صارماً لتلك القصيدة. لكن حتى أنسي الحاج نفسه لم يلتزم، طويلاً، بشكل قصائد ديوانه الأول «لن»، الذي هو أول عمل شعري عربي في قصيدة النثر، بمعناها الغربي، وحمل أول بيان من نوعه يقدم به شاعر عربي ديوانه، إذ إن كثيراً من قصائد كتبه الشعرية اللاحقة نوّع بين شكل قصيدة النثر والقصيدة الحرة، بل بلغ مرحلة الإنشاد في «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع».
وعلى رغم هذا الالتباس الذي لا تزال تعاني منه القصيدة العربية حتى الآن، الا ان «شعر»، مع ذلك، كانت حاضناً أساسياً، ان لم يكن وحيداً، لفكرة حرية الكتابة الشعرية باعتبارها ممارسة فردية تمليها التجربة والعيش، قد تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف التجارب، وليست (أي الكتابة الشعرية) انخراطاً في نسق أسلوبي أو مضموني محدد سلفاً. هناك اكثر من جانب يمكن أن نحيي عليه هذه المجلة ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لصدور أول عدد منها ولكن أبرزها، في ظني، هو تشديدها على هذه الفكرة: حرية الكتابة، حرية القصيدة.
وأخيراً يخطر لي أن صورة الشعر العربي اليوم لم يكن ممكناً أن تكون كما هي عليه اليوم لو لم توجد مجلة «شعر»، وهي، بهذا المعنى، شكلت منعطفاً في تاريخ الشعرية العربية المعاصرة.
معركة «المتن» الاصلي
كانت الطلقة الأولى في المعركة، المقبلة بعد سنوات ليست قليلة. شارةٌ على طريق أو اختيار آخر، أو اكتشاف قبل الأوان.
لم تكن معركة قصيدة «التفعيلة» قد حُسمت نهائيًّا، بل لعلها كانت لا تزال في ذروة احتدامها، ونيرانها المتبادلة؛ والحرس القديم ما يزال متمسكاً بمواقعه لا يريد إفلاتها، ويستخدم أفدح أسلحته «المحرمة ثقافيًّا»: الاتهام بالإلحاد، والعمالة، وهدم التراث ولغة القرآن، واستعداء أجهزة الدولة؛ ويستخدم مواقعه البيروقراطية في أنظمة «التحرر الوطني» الجديدة لإصدار فرمانات المنع والتحريم والتجريم•
وقبل أن تُحسَم المعركة - بعد ذلك بسنوات - إذا بمجلة «شعر» تقفز على ساحة المعركة المشتعلة - بكل صخبها وعنفها - إلى المستقبل، كأن الراهن - آنذاك - أصبح ماضياً، والمعركة الدائرة واقعةً تاريخيةً منقضية، والساحة تبحث عن فرسان جدد وقصيدة جديدة، أخرى، مغايرة لما يتعارك عليه الطرفان.
هي «قصيدة النثر». آنذاك، هي قفزة في الفراغ، خارج السياق والتاريخ، وطلقةٌ في معركة غير قائمة. لكنها - في الوقت نفسه - نبوءةٌ، أو علامة إشارية على ما سيكون، على ما سيجيء.
وسيكون للأعداد القليلة النادرة، التي تسربت من لبنان إلى بعض العواصم العربية، أن تكون مصدر إلهام عميق لأجيال تالية من المتمردين على النسق الشعري السائد، الباحثين عن صياغةٍ ما لتمردهم، أو أفق مغاير. وسيكون لي في أواخر الثمانينات أن أستمع إلى «محددات» قصيدة النثر كما صاغها أنسي الحاج، نقلاً عن سوزان برنار. بل لن يكون لي أن أعرف بكتاب سوزان برنار إلاَّ من خلال ما كتبه عنها شعراء «شعر».
دور سري - لأنه جرى في العمق الدفين لدى حلقات الشعراء العفوية - لعبته «شعر» ومؤسسوها ممن التزموا بأطروحاتها الأولى، في تأسيس حقبة السبعينات الشعرية العربية، على رغم أن بعض المؤسسين انقلبوا - مع الوقت - على أنفسهم وكتاباتهم، بلا اعتذار أو حتى تبرير.
فقصيدة النثر- التي تبنتها «شعر» لن يحققها شعراء المجلة (على رغم أنهم كتبوا أعمالاً فريدة فيها)، بل هؤلاء الشعراء القادمون بعد سنوات. هم مَن سيجعلون قصيدة النثر القصيدة العربية السائدة لا المهمَّشة، المتن الأصلي لا الهامش.
ذلك أن «شعر» كانت الطلقة الأولى في المعركة، القادمة بعد سنوات ليست قليلة. شارةٌ على طريق أو اختيار آخر، أو اكتشاف قبل الأوان.
ترجمات أحتفظ بها
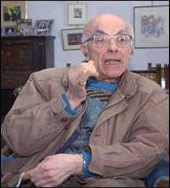 تلعب اللحظة التاريخيّة التي تقرأ فيها صنيعاً أدبياً، كتاباً كان أو مجلّة، دوراً معتبراً في تلقّيه وتمارس على تذوّقه أثرها الواضح. قرأتُ بعض أعداد مجلّة «شعر» في صباي في العراق، ثمّ قرأتُ أعدادها الكاملة لدى أوّل وصولي باريس في منتصف العقد السبعينيّ من القرن المنصرم. ورائي كان المعترك الأيديولوجيّ الذي أثير حول المجلّة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بما يشبه امتداداً لنظريّة «الفنّ للفنّ» بدت المجلّة وهي تشيعه منذ عددها الأوّل. كان ثمّة ولا شكّ الكثير من السّذاجة (إن لم يكن الأمر صادراً عن اختيار هو نفسه أيديولوجيّ) في هذه الحرب التي خاضتها المجلّة من أجل شعر لا تتمثّل غايته إلاّ في نفسه. فالشعر، ونقول هذا باستعجال يمليه ضيق المجال، لم يكن مفصولاً يوماً عن هواجس البشر وصبوات الإنسان. والشكل الشعريّ الأرقى لا يتمتّع بأدنى فرصة للتأثير ما لم يرتبط بمضمون، ومن أين تأتي المضامين إن لم تأتِ من آمال الفرد أو الجماعة ومعيشهما المعتكر الصّاخب؟ ورائي، إذاً، كان ذلك الصّراع السياسيّ وردود الأفعال المتباينة. وما حملته لي المجلّة، في فترة لم أجد فيها بعدُ طريقي إلى القراءة بأيّة لغة أجنبيّة، هو شيء مختلف، غريب بالمعنيين، غربة الأجنبيّ وغرابة الجديد، نافذة إلى أصوات أخرى تهدر في العالم العريض بلغاتٍ شتّى. هكذا كانت الأبواب المتعلّقة بالترجمة، مِن نقل منتخبات شعريّة إلى التعريف بالشعراء الأجانب، هي ما اجتذبني في المجلّة أكثر من سواه إن لم أقل دون سواه. وعلى ما يقدر المرء أن يتقدّم به الآن من آراء وتصويبات في ترجمة المجلّة لهذا الشاعر أو ذاك، فلم يكن بالشيء الهيّن أن تقرأ تلك «البورتريهات» الوجوديّة والفنيّة، الموجزة والعميقة، للشعراء. لا وما كان بالشيء العديم الدلالة أن تجد بين يديك ترجمات يجهد أصحابها في صياغتها موسيقيّاً، بالإفادة من أدائيّات قصيدة النثر العربيّة (أبيات مفصولة بلا عروض)، بدل أن تقتصر على ترجمة المعنى. وإلى الآن أحتفظ بـ «طعم» بعض هذه القراءات، وأتذكّر الرجّة الفنيّة التي حصلت لي وأنا أقرأ بالعربيّة آرتو وهو يصرّح أنّه «لم يعد من مريء / ولا من معدة»، وأنّه انتهى أخيراً إلى تشكيل جسد بلا أعضاء، أو أبولينير وهو يقول لبرج إيفل الذي ينعته هو بـ «الرّاعي»: «قطيع الجسور يثغو هذا الصّباح»، أو رينيه شار وهو يقلّب بعض «صحائف هيبنوس»، أو لوركا وهو يهتف في رثاء صديقه مصارع الثيران أغناثيو سانتشيث مخيّاس: «كانت الخامسة بعد الظّهر في جميع السّاعات».
تلعب اللحظة التاريخيّة التي تقرأ فيها صنيعاً أدبياً، كتاباً كان أو مجلّة، دوراً معتبراً في تلقّيه وتمارس على تذوّقه أثرها الواضح. قرأتُ بعض أعداد مجلّة «شعر» في صباي في العراق، ثمّ قرأتُ أعدادها الكاملة لدى أوّل وصولي باريس في منتصف العقد السبعينيّ من القرن المنصرم. ورائي كان المعترك الأيديولوجيّ الذي أثير حول المجلّة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بما يشبه امتداداً لنظريّة «الفنّ للفنّ» بدت المجلّة وهي تشيعه منذ عددها الأوّل. كان ثمّة ولا شكّ الكثير من السّذاجة (إن لم يكن الأمر صادراً عن اختيار هو نفسه أيديولوجيّ) في هذه الحرب التي خاضتها المجلّة من أجل شعر لا تتمثّل غايته إلاّ في نفسه. فالشعر، ونقول هذا باستعجال يمليه ضيق المجال، لم يكن مفصولاً يوماً عن هواجس البشر وصبوات الإنسان. والشكل الشعريّ الأرقى لا يتمتّع بأدنى فرصة للتأثير ما لم يرتبط بمضمون، ومن أين تأتي المضامين إن لم تأتِ من آمال الفرد أو الجماعة ومعيشهما المعتكر الصّاخب؟ ورائي، إذاً، كان ذلك الصّراع السياسيّ وردود الأفعال المتباينة. وما حملته لي المجلّة، في فترة لم أجد فيها بعدُ طريقي إلى القراءة بأيّة لغة أجنبيّة، هو شيء مختلف، غريب بالمعنيين، غربة الأجنبيّ وغرابة الجديد، نافذة إلى أصوات أخرى تهدر في العالم العريض بلغاتٍ شتّى. هكذا كانت الأبواب المتعلّقة بالترجمة، مِن نقل منتخبات شعريّة إلى التعريف بالشعراء الأجانب، هي ما اجتذبني في المجلّة أكثر من سواه إن لم أقل دون سواه. وعلى ما يقدر المرء أن يتقدّم به الآن من آراء وتصويبات في ترجمة المجلّة لهذا الشاعر أو ذاك، فلم يكن بالشيء الهيّن أن تقرأ تلك «البورتريهات» الوجوديّة والفنيّة، الموجزة والعميقة، للشعراء. لا وما كان بالشيء العديم الدلالة أن تجد بين يديك ترجمات يجهد أصحابها في صياغتها موسيقيّاً، بالإفادة من أدائيّات قصيدة النثر العربيّة (أبيات مفصولة بلا عروض)، بدل أن تقتصر على ترجمة المعنى. وإلى الآن أحتفظ بـ «طعم» بعض هذه القراءات، وأتذكّر الرجّة الفنيّة التي حصلت لي وأنا أقرأ بالعربيّة آرتو وهو يصرّح أنّه «لم يعد من مريء / ولا من معدة»، وأنّه انتهى أخيراً إلى تشكيل جسد بلا أعضاء، أو أبولينير وهو يقول لبرج إيفل الذي ينعته هو بـ «الرّاعي»: «قطيع الجسور يثغو هذا الصّباح»، أو رينيه شار وهو يقلّب بعض «صحائف هيبنوس»، أو لوركا وهو يهتف في رثاء صديقه مصارع الثيران أغناثيو سانتشيث مخيّاس: «كانت الخامسة بعد الظّهر في جميع السّاعات».
في قلب السجال الراهن
مجلة «شعر» التي مضى على تأسيسها خمسون سنة، ما زالت في قلب السجال الثقافي العربي وإشكالاته وقضاياه. لا شك في أنها تتمتع بمكانة خاصة وأهمية ريادية جديرة بها، على مر هذه السنوات بتحولاتها وأحداثها الجسام على الصعد كافة. «شعر» التي تأسست عام 1957 على يد تلك الكوكبة المبدعة من اللبنانيين والعرب، جاءت في مناخ مشحون برؤيا التجديد والتحديث وبمد المشروع الثوري الذي يشاهد المثقف العربي الآن بكل حزن وأسى، انكساره مع تلك الأحلام الكبيرة، وما بلغ اليه الوضع العربي من مآل كارثي ودموي.
وحين نقرأ المشهد الشعري والثقافي العربي، نجد الكثير من أطروحات مجلة «شعر» يأتي ثماره الأدبية والجمالية عبر الأجيال الجديدة.
وعندما أتذكر مجلة «شعر» أتذكر بالكثير من الامتنان والمودة أحد رموزها الكبيرة يوسف الخال، رحمه الله، وكنت التقيته في باريس وتوثقت علاقتي به حيث كنت اذهب اليه مع أصدقاء كثيرين، منهم حمزة عبود وجميل حتمل ورشيد صباغي وآخرين، وكان الفندق الذي ينزل فيه وسط جادة فكتور هيغو. كان متواضعاً في المعنى النبيل وداعماً لكل الأدباء الذين يقصدونه في غمرة العوز والحاجة والاغتراب. كان رجلاً من طراز نادر خصوصاً في تلك الظروف الحالكة بصفاته الأخلاقية والمعرفية. واستطاع ان يقود مجلة «شعر» على رغم تباين الاتجاهات والقناعات بين شعرائها، الى هذه المكانة الخاصة التي لا تطوى مع الزمان. وعندما رأى الخال ان المجلة وصلت الى النهاية في دورها، أعلن عبارته الملتبسة تلك، أي ارتطامه بجدار اللغة... وربما بجدار الجماعة والفريق المؤسس.
مختبر تحاورت فيه النصوص
ربما ذهبت الى أن صدور مجلة «شعر» سنة 1957 كان من أهم الأحداث الأدبية التي شهدتها الثقافة العربية خلال القرن العشرين. فهذه المجلة كانت بلا منازع خميرة الحداثة الشعرية ومهادها الأول، على صفحاتها أعاد الشعراء النظر في معاني الثقافة العربية، هذه المعاني التي اكتسبت، من أثر تكرار بعد تكرار، قداسة متوهمة، كما أعادوا النظر في أسئلة الكتابة وفي وظائفها وفي مجمل القيم التي تنهض عليها. كانت هذه المجلة مختبراً كبيراً، في حيزه ترافدت النصوص، وتحاورت القصائد، وتقاربت الثقافات على بعد المسافة بينها، لهذا أزعم أن الثقافة العربية باتت بعد ظهور المجلة غير الثقافة العربية التي كانت قبلها. فنصوص أدونيس والخال والسياب والماغوط وحاوي وخالدة السعيد والجيوسي وجبرا ابراهيم جبرا، وكذلك نصوص الشعراء الأجانب التي ترجمتها المجلة مثل إليوت وباوند واراغون ولوركا وشار وسان جون بيرس، كل هذه النصوص مجتمعة قد أسهمت في تأسيس ثقافتنا الجديدة وبناء رموزها وتشكيل ذاكرتها. لكن حماستنا لهذه المجلة لا تمنعنا من الاستدراك عليها، فقد تلامحت في بعض نصوصها عناصر ايديولوجية ترتد الى الفكرة المتوسطية حيناً والى النعرة الفينيقية حيناً آخر في وقت كانت تدعي المجلة حيادها السياسي واستقلالها الفكري وربما كانت هذه العناصرالايديولوجية هي السبب الذي جعل بعض المثقفين ينظرون اليها بتوجس وارتياب.
لكن على رغم استدراكنا هذا، فإننا نعتقد أن مشروع مجلة «شعر» ما زال قائماً في وعي ثقافتنا ولا وعيها في آن، لأن هذا المشروع ينهض على ثقافة السؤال والسؤال لا يكبر ولا يهرم ولا يموت.
مجلة صنعها شعراؤها
مضى نصف قرن إذاً على مغامرة يوسف الخال التي أشرك فيها عدداً من حالمي تلك الفترة الذين أرادوا تغيير العالم عبر الشعر. مغامرة لم تكن لتنجح لولا حاجة «المجتمع الأدبي»، يومذاك، إلى صوت جديد يختلف عن السائد. من هنا حفرت عميقاً في مكانها وزمانها على رغم كلّ النقد الذي يمكن أن نوجهه لها اليوم، أي أن قراءتنا لها راهناً، عليها ألا تنسينا الشروط التاريخانية التي تحركت في فضائها.
لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: ماذا بقي من «شعر» بعد مرور هذه السنين؟ على الأقل تركت وراءها أسماء لا يمكننا أن نتجاهلها في حركة الشعر العربي الحديث. في معنى آخر، هل نستطيع ألا نلتفت إلى أنسي الحاج ومحمد الماغوط وشوقي أبي شقرا وأدونيس وسعدي يوسف وغيرهم الكثيرين إذا أردنا أن نقرأ، مجدداً، حركة الشعر العربي الجديد؟ أشك في ذلك إذ انها أسماء أسست «تراث الحداثة»، ولا يزال بعضها حاضراً ومؤثراً في الحراك الشعري. أي أن «شعر» ليست أعجوبة أدبية، بل هي وقبل أي شيء آخر، شعراء صنعوا اسمها.
أعترف بأنني لم أقرأ أعداد «شعر» إلا منذ سنين قليلة، وأعترف بأنني فوجئت بنصوص لا يمكنني تصور أنها وجدت فرصة النشر. ولكن مع ذلك، كانت المغامرة تستوجب ذلك. مغامرة فتحت آفاقاً لا يمكننا تجاهلها، بخاصة نحن الذين نكتب هذا المفهوم الشعري الذي انسل من تلك الحركة، التي فتحت لنا الباب كي نذهب بالتجربة إلى أمكنة أخرى.
ولكن هل يعني هذا أننا تأثرنا بتلك الكتابة؟ جوابي الشخصي هو أنني آتٍ من كتابة أخرى - هكذا أدعي - لا وجود فيها لأي فضاء من «شعر».
النظرية الأولى لماهية الحداثة
تكمن أهمية مجلة «شعر»، في خلخلة مفهومنا لبنية الشعرية العربية، وإعادة النظر في نموذج الشعر الكلاسيكي وأصوله، عبر رفع إهاب القداسة عن التراث الشعري، ومحاورة أو مساءلة بناه المعرفية والفنية والجمالية والإيقاعية. وهي بذلك، شكلت ثورة حقيقيةً، تمثلت في تقديم أول نظرية متكاملة لماهية الشعر الحديث، الذي رأى فيه أدونيس، في بيان تأسيسي محوري أواخر الخمسينات، رؤيا جديدة للعالم تصدر عن حساسية ميتافيزيقية، تتخطى العلائق المنطقية، وتسعى للكشف عن جوهر العالم المخبوء. ويكفي المجلة أنها أطلقت مفهوم ما أسماه أدونيس قصيدة الرؤيا، التي تعتمد لغة الإشارة، أو الإيحاء، وتنبذ التبشيرية، بمستوياتها الأخلاقية والسياسية والأيديولوجية. قصيدة الرؤيا هذه، التي تدمج أساليب ومستويات تعبيرية مختلفة، استطاعت أن تكسر حواجز النوع الأدبي، وتؤسس للمرة الأولى في تاريخ الشعرية العربية المعاصرة، لمفهوم التناص أو النصّية. ناهيك أن «مجلة شعر» استطاعت أن تدخل مصطلحات جديدة إلى قاموسنا النقدي والجمالي والشعري، بخاصة ربط أدونيس مفهوم القصيدة الحديثة بمفردات التخييل، اللانهاية، الحلم، الحدس، الإشراق، الشطح، الكشف، وغيرها.وتكمن عبقرية «مجلة شعر» في جمعها تيارات فنية وشعرية ونقدية، متباينة ومختلفة، إذ استطاعت، خلال سنوات عمرها السبع، أن تكون منبراً ليبرالياً حراً جمع بين يوسف الخال، المؤسس الكبير، الذي دعا إلى اعتماد اللغة اليومية البسيطة، وليس اللغة الرؤيوية المتعالية التي نادى بها أدونيس، وأنسي الحاج الذي ظلت جملته النثرية صافية كهنوتية ومباغتة، ومحمد الماغوط الذي نبذ الصنعة والتجريب وظل محافظاً على بساطة مدهشة، وعصام محفوظ الذي أدخل نبرة نقدية مثقفة لخطاب المجلة الشعري، وخليل حاوي الذي ظلّ أسير قلقه الفلسفي والوجودي، وشوقي أبي شقرا الذي ظلّ سريالياً، غرائبياً، يبحث عن اللامألوف.
الحياة
9/02/2007
10/02/2007

كولاج الغلاف من تصميم جمانة حداد |
في خمسين مجلة "شعر" (1957 – 1964 الإصدار الأول ثم 1967 – 1969 الإصدار الثاني) وجّه "الملحق" السؤال الآتي الى عدد من الشعراء والكتّاب والنقاد، العرب واللبنانيين: أنت، كأحد ورثة هذه المجلة، شاعراً وكاتباً وناقداً، كيف تقرأ هذه المجلة الآن، في ضوء كل ما جرى في الشعر العربي، وله، خلال الخمسين عاماً الماضية، والتحولات التي طرأت عليه، والمواقف منه، وهل لا تزال هذه المجلة اليوم، مجلة مرجعية وراهنة في الوقت نفسه، أي أن يشكل جوابكَ استخلاصاً للدور الذي لعبته هذه المجلة، وتركيزاً على ما يبقى منه الآن، ليس في الشعر والنقد والترجمة فحسب، بل أيضاً في الحداثة، وما بعدها، وفي الثقافة عموماً، وأيضاً في العقلية العربية مطلقاً؟
يطمح "الملحق" من خلال هذا الملف الخاص إلى فتح باب الأسئلة مشرّعةً على مصاريعها. لأجل هذه الغاية، وجّه سؤاله المركّب هذا إلى عدد كبير جداً من المعنيين على امتداد العالم العربي ولبنان. وحرص على ان يشمل هذا الملف آراء شعراء وكتّاب ونقّاد من مختلف الأجيال، والبلدان العربية، مستثنياً من السؤال شعراء "شعر" نفسها. فالمجلة، منذ ان باتت في عهدة قرائها و"ورثتها"، لم تعد ملكاً لهؤلاء في طبيعة الحال.
لم يكن خافياً بالنسبة الينا عمق العلاقات والوشائج التي تربط الحديث عن "شعر" المجلة ببيروت المدينة. فهذه المدينة التي ولدت "شعر" فيها هي، في اضعف احوالها، الرحم التي رعت طراوة عودها، وحمتها من الموات واليباس الذي يلف العالم العربي منذ زمن. لكن علاقة "شعر" بالمدينة لا يمكن اختصارها بعلاقة الام بوليدها فحسب، بل تتعداها إلى اعطاء المجلة معنى اوسع من مضمونها الحرفي. فـ"شعر" في بيروت الستينات والسبعينات، اكتست بعض رزانتها النقدية والفكرية والريادية من المدينة نفسها. فضل المدينة على الشعر والأفكار ليس بخافياً على احد.
الملف في هذا المعنى هو ايضاً، واولاً، قراءة في بيروت المدينة، التي اغنت الشعر واغناها، وربّت الأفكار والتمعت في سمائها. بيروت تلك، ما الذي بقي منها اليوم؟ وما الذي نفتقده فيها في هذه الأيام الحوالك؟
هذا الملف يصوّب على الشعر ليصيب المدينة. وليس افضل من النظر إلى المدينة بعين "ابنائها" الأبعدين والأقربين على السواء. ففي مثل هذا النظر ما يجعلنا نعرف في اي زمان ومكان ما زلنا نقيم، نحن الذين لا نزال في هذه المدينة العريقة بالشعر والمجبولة بعرق الأحرار ودمهم.
لهذا كله ولأسباب تقنية بحتة، أي لأسباب خالية من كل أحكام القيمة، ننشر المساهمات على النحو التقني والتسلسلي المبوّب الذي تظهر عليه. فليس في هذا التبويب ما يجعل المقدّمين فيه اعلى كعباً من المتأخرين، على ايّ وجه من الوجوه. إذ ان هذا العدد الخاص يساوي بين المشاركين جميعاً، في أشخاصهم، وفي احترام مساهماتهم، وفي عمق علاقتهم ببيروت وشعرها ومجلتها.
وإذ يخلي أهل "الملحق" المنبر، في هذا العدد، لضيوفه، فإيماناً منهم بأن الضيوف، عرباً ولبنانيين، هم أيضاً وخصوصاً يشاركون في صناعة هذا المنبر. على غرار بيروت، ومجلتها "شعر"، وإن تغيّر الزمان.
في هذا المقام، لا نجد انسب من خالص الشكر نقدمه الى هؤلاء الذين شاركوا في هذا العدد، واولئك الذين حالت ظروف مختلفة دون مشاركتهم معنا، او الذين فضلوا المشاركة في منابر اخرى. فهؤلاء جميعاً، على اختلاف المنابر والأقلام، ساهموا، كلٌّ من موقعه، في نصرة المدينة قبل الشعر، ولهم منا عميق مودتنا وخالص شكرنا.
"الملحق"
تقع مجلة "شعر" في قلب تيار التحديث في الشعر العربي المعاصر، وكذلك في النقد والفكر والاجتماع، وربما السياسة العربية زمن صدورها. وهي على رغم غيابها المبكر في نهاية الستينات من القرن الماضي، واصطدامها بحاجز اللغة لحظة غيابها، كما قال مؤسسها يوسف الخال، إلا أنها بقيت حاضرة في المشهدين الشعري والنقدي بأشكال عديدة: عبر شعرائها ونقّادها الذين واصلوا مشروعها من خارجه، وعبر من ألهمتهم كمجلة ومشروع، وكطريقة تفكير في الشعر والنقد والثقافة والفكر، من الأجيال الطالعة بعد غيابها. وهي في هذا المعنى غابت كمجلة ولم تغب كمشروع؛ كفّت عن الصدور ومتابعة دورها كمساحة للجدل وحوار الأشكال والتجارب وبقيت كتجربة ومثال وطريقة فهم للإبداع والحداثة. ورغم أن عددا من المجلات صدر بعدها مستلهماً مثالها، محاولا تزويج تجربتها للأسئلة الجديدة التي طرحتها نكسة 1967 على الشعر والنقد والفكر، والثقافة العربية بعامة، إلا أن تأثير "شعر" المحوري في مشروع الحداثة العربية ظل مدار أخذ وردّ، وهدفا للبحث والتساؤل، والكتابة، والكتابة المضادة، وموضوعا دائما للرسائل الأكاديمية المكتوبة بالعربية، إضافة إلى اللغات الأخرى.
هكذا كانت "شعر"، بكوكبة الملتفين حول مؤسسها يوسف الخال وحول مشروع مجلته الليبيرالي، المتفتح على أسئلة الحداثة، وتحديث الشكل الشعري، وتطوير العقل النقدي، وفتح الأبواب، على وسعها، على الثقافات الإنسانية المختلفة، وخصوصا الغربية منها، نوعاً من الرد على مشاريع ثقافية عربية أخرى تدعو إلى الإجابة عن أسئلة الالتزام والقومية، والثورة على الاستعمار. لا يعني هذا أن "شعر" كانت بعيدة كل البعد عن التيارات الشعرية والنقدية والفكرية التي حاولت الإجابة عن تلك الأسئلة، بل يشير إلى كون تلك المجلة، التي صدرت في فترة كان الصراع قد اشتد فيها على هذه المنطقة من العالم، أقرب إلى أن تكون مهمومة بتحديث الأشكال والابتعاد ما أمكنها عن الاصطفاف السياسي، والتعصب لفكر في عينه، والمساهمة في النزاع الحاد الذي نشب بين الشرق والغرب في فترة الحرب الباردة.
وإذا كانت مجلة "الآداب" مثّلت، في تلك الحقبة العاصفة من حياة العرب المعاصرين، الناطق الثقافي باسم التيار القومي، الأقرب إلى المشروع الناصري، فقد نظر إلى "شعر" في وصفها ممثلة التيار الليبيرالي في الثقافة العربية، ذلك التيار الذي يعدّ نفسه أقرب إلى الغرب ومشروعه الديموقراطي التحديثي، المعادي في ذلك الحين للماركسية والتيارات القومية العربية الصاعدة في خمسينات القرن الماضي وستيناته. ونحن نعرف أن هذا التصنيف الذي دمغ مجلة "شعر" قد أقصاها، خلال فترة صدورها القصيرة نسبيا، عن التيار القومي العريض الذي اكتسح الشارع العربي في تلك المرحلة، وألحقها، ظنا أو عن سوء نية، بالفكر السوري القومي الاجتماعي، بسبب انتماء يوسف الخال، وعدد من محرري المجلة وبعض كتّابها، إلى الحزب في فترة من فترات حياتهم. لكن النظر إلى مشروع "شعر"، بعد خمسين عاما من صدورها الأول، يبرّئها من الانتماء الحزبي والعصبوي الفكري الضيق، ويدخلها، كمجلة ومشروع، في إطار من المشروع التحديثي الليبيرالي الذي اهتم بإحداث انعطافة في الكتابة الشعرية، والتفكير النقدي بالشعر بعد حوالى عشر سنين من انفجار الشكل التقليدي في القصيدة العربية المعاصرة.
ما يهمنا التشديد على مركزيته في مشروع "شعر"، بعد نصف قرن على صدورها، ليس الرحم السياسية الفكرية التي طلع منها مؤسسها والكوكبة الشعرية النقدية التي التفّت حوله، بل ما تركته المجلة من بصمات على الكتابة الشعرية، والنقدية، والرؤية الثقافية الداعية إلى التواصل مع الشعر والنقد والفكر في الصقع الغربي من الكرة الأرضية. صحيح أن مجلة "الآداب" عرّفت القارئ العربي في تلك الحقبة على تيار الالتزام في الأدب والنقد والفلسفة، وجعلت جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار جزءا من المعركة الثقافية الفكرية التي خاضها المثقفون القوميون العرب، بمختلف تلاوينهم، في تلك الآونة، لكن "شعر" شكلت، في الجهة المقابلة، مشروعا تنويريا انكسر بسبب هزيمة العرب في حرب حزيران، ووصول يوسف الخال ومعاونيه في المجلة لا إلى حائط اللغة، بل إلى حائط اليأس من الاستمرار في مشروعهم الشعري ــ الفكري. وأظن أن هذا اليأس لا يزال يرجّع صداه إلى هذه اللحظة التي يبدو فيها التفتت والتشظي وافتقاد الطريق علامات بارزة في حاضر العرب وتجربتهم الوجودية خلال ما يزيد على نصف قرن من الزمان.
مع ذلك، فإن ما تركته "شعر" في الجيل الذي أنتمي إليه، في الكتابة والشعر والنقد، وهو جيل السبعينات، وكذلك في الأجيال التي تلتنا، هو تشديدها المهووس على الحداثة الأدبية والفكرية والسياسية والاجتماعية، والرغبة غير المحدودة بتحديث الأشكال الأدبية المتخشبة، والدعوة المستمرة إلى أشكال جديدة من المقاربة النقدية للإبداع والثقافة. كان مشروع "شعر" تغريبيا في جوهره، لكن ذلك لاقى هوى في نفوسنا، وجعل عيوننا مشدودة إلى الغرب الثقافي، لا الغرب الاستعماري المعادي لأحلامنا القومية، والمساند لإسرائيل التي زرعها في قلب فلسطين الدامي، في الأمس وفي الحاضر كذلك.
كانت "شعر"، عندما بدأت قراءتها في منتصف سبعينات القرن الماضي، قد كفّت عن الصدور منذ سنوات. لكنها مثّلت بالنسبة اليَّ سجل الحداثة الشعرية والنقدية العربيين، وأطلعتني على المغامرة المغايرة، بالمقارنة مع مجلة "الآداب" التي بدأت قراءتها في الفترة الزمنية نفسها، التي تتطلع إلى بناء وعي شعري ونقدي وفكري طالع من النصوص لا من السياقات السياسية الاجتماعية المتغيرة. لعل ذلك هو الذي ساقني، وعددا من أبناء جيلي من النقاد، إلى المدرسة البنيوية، وما يحفّ بها من تيارات نقدية كانت تدعو إلى النصية والتركيز على النص الإبداعي نفسه دون انغماس في القراءة الانطباعية التي تأخذ لبوس القراءة التاريخية أو الواقعية الشاحبة التي كانت مهيمنة في خمسينات القرن الماضي وستيناته. كانت "شعر" الدليل الذي هداني إلى زمان آخر لم تكن هي في الحقيقة جزءاً منه.
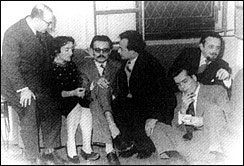 بالمعنى التقني لشعرية الكتابة، يصعب أن تبقى مجلة "شعر" مرجعاً للنصوص المهمة التي تكتب في السنوات العشرين الأخيرة. أقول "النصوص المهمة" لكي أعني المواهب الشعرية العربية التي باتت هي الآن نوعاً من الإضافة النوعية الى التجربة المبكرة التي اقترحتها تلك المجلة قبل خمسين عاماً.
بالمعنى التقني لشعرية الكتابة، يصعب أن تبقى مجلة "شعر" مرجعاً للنصوص المهمة التي تكتب في السنوات العشرين الأخيرة. أقول "النصوص المهمة" لكي أعني المواهب الشعرية العربية التي باتت هي الآن نوعاً من الإضافة النوعية الى التجربة المبكرة التي اقترحتها تلك المجلة قبل خمسين عاماً.
غير أن المجلة ذاتها، على مستوى الرؤيا الشعرية والروح الأدبية والفعل الثقافي، ربما هي، من بين عدد قليل من علامات ستينات القرن الماضي، تمثل انتقالة جوهرية ليس ممكنا تجاوز مساهمتها في تأسيس المناخ التحديثي الصارم والصادم في آن واحد. ويمكننا النظر الآن بقدر كبير من الأسى لفرط التراجع المبالغ فيه عن تلك الأطروحات على صعيد الفكر الثقافي عموماً، وفي جوانب كبيرة من الفعل الشعري بشكل خاص. فبالرغم من النصوص الشعرية الممتازة كفعل تغييري في شعريتنا العربية، إلا أن الفكر الشعري النقدي، كمنظورات مهيمنة ومكرسة، أصبح على درجة من المحافظة يصعب احتمالها في سياق أحلام الفعل الشعري العربي الجديد ومقترحاته.
وسوف نصادف استثناءات نادرة، وأحيانا عميقة الموقف النظري، لكنها تظل، قياسا للمسافة الزمنية التي تفصلنا عن أطروحات تجربة مجلة "شعر"، تبدو أكثر ضآلة وتواضعا مما هجست به التجربة في عمومها.
وعندما نرى إلى معطيات مجلة "شعر" على الأصعدة الفردية، سنصادف التفاوت، الذي يبلغ التناقض أحياناً، بين تجربة وأخرى، بناء على نوع الموهبة ودرجة جديتها ورصانتها.
بل اننا سوف نصاب بالخيبة أحياناً حين نلاحظ جانبا من بعض جيل شعري، صدر عن درس مجلة "شعر" بامتياز، قد وقع لفرط حماسته لتلك التجربة، في ارتباكات وقصورات فادحة، ليس فقط في فهم تلك التجربة في حجمها الحقيقي، بل أنه فرّط في الدرس الشعري العميق لمجلة "شعر"، وخصوصاً عندما يتعلق الموضوع بحبس الدرس الشعري للمجلة (بالذات وخصوصا وفقط) في تجربة قصيدة النثر، مما يفقد تجربة المجلة أطروحاتها الحداثية البالغة التنوع، والمتمثلة في تعدد واختلاف المواهب التي شاركت في مشروع المجلة، وساهمت في صياغة رؤيتها، نصوصاً ومنظورات. فليس من غير دلالة أن يكون من بين أبرز الفاعلين في تجربة مجلة "شعر"، بالإضافة إلى الشعراء، النقاد والتشكيليون والروائيون والمسرحيون والمترجمون، ذلك أن البرهة الإبداعية التي طلعت في خضمها تلك المجلة كانت من الغنى بحيث كان طموح الحداثة وتطلعاتها يلتقي في نوع جديد من رحابة التجاور (في بواكير التجربة على الأقل)، ليتيح ذلك لأن تبدو الحداثة أبعد من القصيدة، وأقرب إلى فعل الاختلاف النوعي للعمل الفني والأدبي.
هذه الروح سوف لن تستمر كثيراً، لكي نصادف تلك المواهب تختار طريقها بمفردها في مختلف حقول التعبير الثقافي.
الآن، أين تلك الفاعليات في وصفها معطيات حية في الواقع؟
علينا، لكي نلمس تجليات مجلة "شعر"، أن نذهب إلى الحالات الفردية المستقلة الخارجة عن السياق، وربما لهذه النتيجة علاقة متوارية بطبيعة النزوع الشخصي في عناصر المجلة ذاتها لحظة ورشتها، وهو ما سنعكس جزئياً في "شخصانيات" التجارب الشعرية اللاحقة، متنقلة، متناسخة بين الأجيال و المراحل.
بقي أن أقول بأنني اعتمدت المجلة كمصدر ثقافي لمعرفتي الأدبية والشعرية طوال سنوات بحثي العفوي في غموض الأفق العربي المشحون بكل تلك الأسئلة التي تبدأ بالايديولوجيا وتنتهي بالفوضى. تلك فوضى تحرض عليها بعض أطروحات المجلة وتستفز القطاع (لئلا أقول القطيع) المستقر ليقينه الشامل في شتى الحقول، مما سيدفعه طرح صوت (هل قلت سوطاً) التشهير ضد مشروع المجلة الفكري والأدبي معاً، لدوافع وبروافع بعيدة كل البعد عن العمل الشعري. وأذكر أن ذلك لم يرق لي يوماً، لشعوري العفوي بأن من يخاف من الفكرة والقصيدة لا بد أن يكون أقل منهما.
بعد ذلك،
حين توقفت المجلة بعد دفقتها الأولى، لم تعجبني فكرة عودتها، رأيت ثمة افتعالاً في شكل مرحلة الإصدار الثانية ومضمونها.
الآن،
سوف أعود بين وقت وآخر لكي استمتع ببعض مواد المجلة، لكن من دون الخضوع لوهم مقارنتها بتجارب مثيلة راهنة. المسألة لن تكون عادلة. "شعر" كانت مختلفة وليس من الحكمة استعادتها لأي شكل كان.
الآن،
فيما أشتغل على تحرير "جهة الشعر"، أشعر بفداحة الخسارة التي تتكبدها الأجيال الشعرية الجديدة بدون الاطلاع على درس مجلة "شعر" تلك. لذلك سوف أظل أرغب في نشر مختارات ممتازة من مجمل أعداد مجلة "شعر" في ملف خاص بـ"جهة الشعر"، وسوف أتمنى على من تعجبه هذه الفكرة أن يساعدني في تحقيق هذه الفكرة لكي يكتمل مشروع نشر مختارات مشابهة لمجلات أخرى أعمل على تحقيقها منذ سنوات، لولا صعوبة العمل. وهي دعوة مفتوحة في مناسبة من هذا النوع، احتفاء بما يستحق.
الآن،
لا بد أن نرى في درس مجلة "شعر" ما يجعلنا نثق بأن حرث الأرض وبذرها ورعايتها والسهر على فصول مستقبلها، هو من بين أجمل مشاريع المعرفة والإبداع في حياة الإنسان.
سنرى إلى تجربة "شعر" في اعتبارها مكوّنا محوريا من حياتنا الشعرية المعاصرة، أشخاصاً ونصوصاً.
عصرها اجترح معجزته واختفى بأسرارها
(1)
لو سئلت وأنا اتهيأ لصعود آلة الزمن: ايّ عصر من العصور التاريخية تود الذهاب اليه والاقامة فيه؟ لأجبت: عصر مجلة "شعر". وأن يكون "الخميس" هو يوم هبوطي في بيروت، لكي تتاح لي فرصة رؤية المبشرين بالشعر في لقائهم الأسبوعي.
لقد صنعت تلك المجلة عصرا، افتتحته بمغامرة الافلات من تعريف الشعر لتنهيه باعتراف نادر: للغة جدار يعوق وجوده الشعر. تكاد البداية تنبئ بالنهاية، وتكاد النهاية تعرف البداية. فالشعر الحقيقي لا يقيم في اللغة، بل في تجاوزها. إلى أين؟ لعبة الوصول لا يراهن عليها الشعراء الحقيقيون. كل المتعة الجمالية تكمن في الطريق الى الشعر. كل الشعر الرديء انما نتج من خطأ في ارتياد طرق لن يكون في امكانها أن تؤدي الى الشعر. كان رهان المبشرين بجنة الشعر (اللبنانية) يكمن في حساسية غامضة، لا يمكن المثول بها امام الفحص المادي. حساسية هي في حقيقتها نوع من التسليم الديني. يقين ليست لديه من القرائن إلا ما يتلعثم به: متمردا، متوترا، مرتبكا، حائرا، متأوها، معذبا، مهتاجا، منشرح الصدر، مفتونا وساحرا، وهو يلقّن الأشياء أسماءها الاولى. لم يكن لدى اولئك الفتية الذين آمنوا بالشعر فزادهم ذلك الايمان هدى سوى أن يعلنوا أن الشعر كما الحياة في مكان آخر. مكان يشبه لبنان وقد يتشبه لبنان به. كما لو أن يوسف الخال بعد خمسة الاف سنة يومئ للعراقي جلجامش بعشبة الخلود ولسان حاله يقول: لقد عثرت عليها أخيرا، في المكان عينه الذي كنت تبحث عنها فيه يا جدي. يوسف الخال هو الآخر، لم يكن سوى حيز في فضاء سعى التاريخ من خلاله الى أن يجسد واحدة من أفكاره الغامضة: المعلم الضليل.
(2)
لم يكن يوسف الخال نبياً. كان شاعرا. غير أنه مع الوقت صار نبياً، اما الشاعر فلن يلتفت اليه الا القلة. هل انصف التاريخ النبي وأهمل الشاعر؟ لعب القدر دورا كبيرا في أن يظهر يوسف الخال في اللحظة الحرجة، تلك اللحظة العصية على العبور من غير أن تخدش جدار الوقت لتترك عليه آثارا لن تكفّ بروقها عن اللمعان الجبار والمخيف. هل كانت مجلة "شعر" هي اختراعه الوحيد؟ كان الرجل استثناء جماليا غامضا ومقلقا ومتشنجا. نظر الى الحياة العربية كما لو أنها بعد خفي من أبعاد شخصيته المتشظية بين الدين والدنيا. فلم يجد سوى الشعر حلا موقتا لاشكالية الكائن الذي يود أن يعيش قريبا من النبع. لكن شعره الشخصي (صنيعه الكتابي المباشر) ظلمه. ذلك الشعر على اهميته، لم يكن ينبئ عما كانه الرجل وعما سيكونه في المستقبل. ما فعله يوسف الخال كان أكبر من فعل الكتابة. كان لديه من الاسرار ما يلهم الحجارة على أن تستعيد صفتها الالهامية. كان وعدا بواقعة كونية لم يحل بعد موعد انبثاقها. واذا كان الفتية المشاغبون قد شكّلوا من حوله نوعا من الصحابة والمريدين الذين سعوا الى طمأنة قلقه، فإنه في بيانه الختامي أفصح عن احتراق يده بالجمرة التي لم ينتجها كل هذا الحطب المنتقى بعناية الهية. جمرة كانت غير مرئية وستظل كذلك. هل كان على لسانه شعر لم يقله ولم يكتبه؟ حقاً، كان هنالك شعر لم يُكتب، غير أن ذلك بالنسبة الى موقف الخال من الشعر لن يُكتب أبدا. فالشعر الذي هو نوع من اللغة، لا يحبو بين صفحات المعاجم الجاهلية مثل طفل رضيع. إنه يصنع لغته ولا يختارها، ينقّيها ولا يصفها، يذهب بها ولا يرجوها، يفجّرها ولا ينتظر انبثاقها. الشعر هو اللغة، لكن في صيغتها المفارقة. كان ضروريا أن ينأى الشعر باللغة بعيدا عن سطحها.
(3)
رجل عجيب يوسف الخال هذا. صنع مدينته الفاضلة على الورق. لا في كتاب كما فعل افلاطون او الفارابي، لكن في مجلة، كانت في حالات كثيرة نوعا من المطبوع السري الذي تنطوي قراءته على أخطار غير متوقعة. بالنسبة اليَّ كادت مجلة "شعر" أن تجعلني شيوعيا. لم أكن قد اكملت السنة الخامسة عشرة من عمري حين انتبه معلم العربية قيس مجيد الى اني اكتب الانشاء المدرسي بسلوك لغوي مختلف. حينذاك همس في اذني قائلا: من الضروري أن تقرأ مجلة "شعر". فما كان مني سوى أن ذهبت الى أبو طه وهو صاحب كشك المجلات والكتب في الباب الشرقي (مركز بغداد) الذي تعوّدتُ شراء الكتب منه كلما تجمعت لديَّ نقود، وقلت له بصوت عال: اريد مجلة "شعر". فاذا بالرجل يتلفت مرتبكا فيما بدا عليه كما لو أنه يراني للمرة الأولى. قال لي طاردا: عد بعد أسبوع. وحين عدت اليه ناولني كيسا مغلقا وهو يقول لي: اذهب من هنا، لا اريد النقود الان. ابتعدت عنه حاملا الكيس المغلق وأنا احلم بمحتوياته. حين وصلت الى البيت اكتشفت انه وضع في الكيس عددين من مجلة "شعر" و"البيان الشيوعي" و"العائلة المقدسة" لانغلز. كانت افتتاحية "البيان الشيوعي" التي لا ازال احفظ اجزاء منها بالنسبة اليَّ يومذاك، نوعا من الشعر. لقد شعرت يومذاك بالذعر والغواية. ولو كان هناك شيوعي قريب مني لاصبحت شيوعيا، ذلك لاني مزجت في لحظة سوء فهم بين الشيوعية و"شعر" يوسف الخال. بعد سنوات تمكنت من حل اللغز: لقد مزج الرجل بين الممنوعات الثقافية كلها ووضعها في كيس، شاءت الاقدار أن اكون حامله. لكن في النهاية، كنا، أنا ويوسف الخال وأبو طه وماركس، شيوعيين بطريقة أو بأخرى.
(4)
لم تكن "شعر" مجلة ادبية، لا في المعنى الضيق ولا في المعنى الواسع لمفهوم الادب. كانت: مجلة "شعر". خالصة للصنيع الشعري، المنقّى من أي هدف أدبي. لذلك فهو صنيع لا يمكن تصنيفه أو القياس عليه أو تعبئته بالشروح والتأويلات والتفاسير الأدبية، إلا من جهة التلفيق الاجتماعي والثقافي الساذجين والمؤدلجين. بما يعني أن "شعر" لم تقم في مدينة مأهولة ولم تنشر بذورها في أرض مهيأة للحرث ولم تضع خطواتها على آثار سبقتها في طريق وعرة. كان لكل واحد من بُناتها المسافرين خريطته البيضاء التي يهتدي بخطوطها غير المرئية في دروب لم تطأها قدما انسيّ من قبل. وكان اولئك المسافرون يعودون كل خميس الى "شعر"، حيث المعبد والمختبر والمحجة والخلوة والغار الذي لا تدخله الا الصفوة من المنذورين لقول كلام مختلف، لا سلّم له ليرتقى، ولا مسافة تفصله عن الكلام الادبي لتمشى. ذلك لأنه يمت بصلة الى جوهر الشعر من قبل أن يفتن به اللسان فيذروه كلاما. شعر تصبو اليه الحواس لأنه جُبل من طينة أخرى، في امكانها أن تكون مصدرا للفتك. لم تكن "شعر" في جوهر وجودها دعوة الى إصلاح الادب بقدر ما كانت ارتجالا لحساسية جمالية تبدأ من نقطة صفر خفية. وهو الصفر الذي حيّر الكثيرين ممن سعوا الى أن يرثوا "شعر"، رغبة منهم في المضي في دروبها. وهي دروب أتضح لهم في ما بعد أنها من هواء. فهي وليدة ذلك الصفر الجنائزي، المحتفي بالعالم في لحظة نشوة فريدة لا تتكرر. فما قالته "شعر" وما لم تقله هو سواء. صحيح أن العالم قد تغير بسببها، غير أن العالم وقد اصبح آخر لن يحتاج الى من يعيده اليها. وهنا تكمن معجزة "شعر". لقد استغنى العالم عنها لانها أصبحت تقيم في الخلية التي تدفع في نسغ ذلك العالم أسباب الحياة. حينذاك اختفت "شعر" ولم يعد لظهورها المحتفى به أي معنى. لقد عادت من حيث بدأت صفرا كونيا.
طريق حياة ووجود
خمسون عاما مرت على تأسيس مجلة "شعر" الطليعية في التحديث الادبي والتجديد. هذه الخمسون هي عمر الجيل اللاحق على ذلك الجيل التأسيسي الذي واصل حفريات البحث لمن سبقوه، بجرأة ومغامرة، اجترحت تلك الثغرة الحادة في الادب واللغة العربيين، عبر اراض سكونية وعرة من الانكفاء على الماضي، بقداسة انماطه وقوالبها الجاهزة.
خمسون عاما ليست عادية. انها أرخبيل أزمنة ضوئية متراكمة من الاحداث والتحولات الكبرى في الوعي والمعرفة والتاريخ.
عالميا، لا تزال آثار المجزرة الكونية وجراحاتها الغائرة، وتشكيل خريطة القوى الجديدة والافكار والعلوم والاشكال للحقبة اللاحقة اوروبيا وعالميا.
وعربيا، لم يمض على قيام الدولة العبرية الا سنوات قليلة، وكانت الأرض العربية على حافة زلزال من الطموحات الثورية والانقلابات والمشاريع والغضب على الاوضاع القائمة والموروثة من الحقبة الاستعمارية بأنظمتها الثيوقراطية التي أوشكت على الانقراض والافول امام زحف الافكار والاحلام الجديدة.
فترة التوترات والغليان مندفعة كالصاعقة، وما هو ثوري وتقدمي في السياسة، محافظ حد الرجعية في جبهة الادب والافكار المؤدلجة التي من فرط أدلجتها الدوغمائية تتبنى اليقين اللاحق بإلغاء الوعي النقدي المخالف والغاء اي تعددية ممكنة محل اليقين السابق المذموم والمنهار.
في هذا الجو الزلزالي على الاصعدة كافةً، تأسست مجلة "شعر" اللبنانية العربية عبر طليعتها المتنوعة المشارب والافكار، لكن المنحازة دائما الى التجديد الادبي والفكري الطليعي الذي كانت تمور به تلك المرحلة عالميا. والى تحطيم اشكال التابو كافة وفتح المجال شاسعا للتجريب والتيه والابتكار، في اللغة والرؤى.
كانت الحرية هي كلمة السر الجامعة بين أفراد ذلك الفريق التأسيسي للمجلة الذي ذهب به الطموح الابداعي المشروع والمنطقي، الجنونيو العاصف، الى اقتحام المرحلة الجديدة في الادب والشعر العربيين والتي تقف على عتبة الانعطافات الاساسية في تاريخ الادب، او هي في العمق منها.
***
كانت مجموعة "شعر" ورمزها القيادي يوسف الخال، بشخصيته المتسامحة المقنعة ونزوعه الأبوي "في المعنى الحر" والرسالي، كما عرفته عن قرب، وان في فترة متأخرة من تلك المرحلة. كانت المجموعة المتحلقة حول المجلة تعي ان المناخ الادبي مشبع بعناصر التحول حتى الانفجار، فأطلق شرارة هذا التحول الذي سيصيب البنية الشعرية والثقافية العربية في الصميم كما تعيش نتائجه البرهة الراهنة. كانت "شعر" مسكونة بالهم الادبي والابداعي، مبتعدة في حدود الممكن عن الاستقطابات الايديولوجية التي كان تعج بها، وتفيض، تلك المرحلة برمتها. عكس مجلة "الآداب" ومنابر أخرى لعبت دورا أساسيا في هذا السياق، اذ كان وضوح التوجه القومي السياسي بتنظيراته وشعاراته واهدافه عالي النبرة والخطاب.
لكن من يستطيع الزعم ان "شعر"، بتبنيها أكثر للخطاب الشعري والثقافي، كانت بعيدة عن ذلك التوجه في الكثير من عناصرها، كما يقول خصومها، الذين ذهب بهم الاتهام التخويني الى حدود غير ديموقراطية ولا منطقية كعنصر من سمات تلك المرحلة الكاسحة بالهواجس والاحترابات النظرية تجاه كل ما هو مفارق ومخالف. اذ تحول الخطاب اليساري القومي والماركسي، على نبل اهدافه، الى سد منيع لا يأتيه الشك حول المستقل المفروش بجثث الثورة المقبلة وزهورها، لا محالة.
***
نحن الجيل الذي وصل الان الى الخمسين من عمره، وهو عام تأسيس تلك المجلة الرائدة التي اضاءت مع غيرها، الكثير من دربنا الادبي والحياتي المثخن بالجراحات والحروب وكل انواع الشتات والتصدع والانهيار، نحدق في تلك السنوات كأنما على شفا هاوية قيامية ستجرف الجميع الى حلقات اعماقها السحيقة. كم من المشاريع والاحلام والثورات انكسر في بداية الطريق او في منتصفه، لا فرق. كم من المفاهيم والتنظيرات الواثقة استحالت الى غبار وحطام؟ كم من الحروب والمجازر العبثية المجانية التي لا يزال اوارها يشتعل على الارض العربية ويلتهم اليابس والاخضر، اذا كان لا يزال من بقايا لهذا الأخير الأخضر. لبنان الذي تأسست على أرضه تلك المنابر والطموحات والمفاهيم، نال قسطه الاكبر وما زالت الاحتمالات مفتوحة على صحارى القسوة والضياع.
ماذا تبقّى في وعينا وكتابتنا من مجلة "شعر"؟ محاولة الاجابة تحتاج الى بحث اكثر تمعنا من هذه العجالة. لكن هناك الكثير مما تحبل به وتعيشه لحظة الكتابة العربية الراهنة، كانت "شعر" سباقة الى طرحه عبر الترجمة والابداع. اشكال تعبيرية كان طرحها مستهجنا كقصيدة النثر وغيرها، اصبحت الان الخيار الأوسع في الحياة العربية. هذا لا يعني بالطبع عصمة الاطروحة، لكن ليس من غير دلالة حقيقية. وربما الخيار الابداعي والجمالي الذي تمسكت به "شعر" للتغيير وجافت من أجله السياسة في أشكالها السائدة المباشرة، اصبح الان ما يشبه طريق حياة ووجود، في ظل الحصر الطائفي والتهريج المفتوح على مصراعيه الذي انحطّت بسببه السياسة الى أرذل السلّم المعرفي وادناه.
حين نقرأ المشهد الشعري والثقافي العربي الراهن، نقرأ عناصر التأثير لمجلة "شعر"، بإيجابها وسلبها، اذ ان هذا الاخير جزء عضوي في كل تأسيس أو مغامرة. ويبقى الكثير امام الزمن الذي من غير رحمة يكتسح الافكار والاجساد والجماد.
"شعر" في قلب كل سجال ثقافي عربي عبر ذلك الارخبيل المهول من السنين وعبر المستقبل.
أفكـــــار سريعـــــة
 على عكس جل المجلات الأدبية التي سبقتها (مجلات نادت بتجديد للشعر وفق بوصلة التحولات السياسية أو الجمالية المنعزلة)، تميزت مجلة "شعر" بقدرتها على إدخال مفهوم التساؤل في صلب العملية الشعرية التي يختبرها الشاعر الحديث.
على عكس جل المجلات الأدبية التي سبقتها (مجلات نادت بتجديد للشعر وفق بوصلة التحولات السياسية أو الجمالية المنعزلة)، تميزت مجلة "شعر" بقدرتها على إدخال مفهوم التساؤل في صلب العملية الشعرية التي يختبرها الشاعر الحديث.
فإذا كانت مجلة "ابولو" تنادي بالتجديد، فإن ما كان يدور في خلدها هو الاستمرارية التراثية بتنويعات إيقاعية مستحدثة من صلب المعطيات الوزنية المتوافرة، ومجلة "الآداب" لم يكن لها هدف سوى جعل حركة "الشعر الحر" (شعر التفعيلة) وانتصاراتها الشكلية وبالتالي كل شظايا المحاولات التجديدية التي كانت تلتمع هنا وهناك، تعبيراً شعريا للغليان السياسي الذي كانت تعيشه المنطقة، وللرغبة في الاستقلال الوطني، فإن مجلة "شعر" تعتبر أول مجلة ادخلت مفهوم "الحداثة" بنبذها الرومنطيقية التي كان الشعر العربي بكل تياراته غارقا في مياهها... وبالتالي أعادت الاعتبار إلى الشعر كموقف من العالم مستقل بذاته، واضعةً العملية الشعرية بوجه ما كانت تريد مجلة "الآداب" تعميمه: تسييس الشعر.
وما الحرب الباردة التي كانت سائدة سوى عامل مساعد في تغذية هذا الشعور السياسيّ الهدف أولا، والشعريّ التعبير ثانيا. الحرب هذه، كانت تغذي نزعات التجديد الشعري بمقاربات متعارضة إزاء الفعل الشعري... حدّ أنها (الحرب الباردة) ولّدت، بل قوقَعَت، تيارا رجعيا (مجلة "الشعر" المصرية) أخذ يعتبر عدوا للقيم الشعرية المتوارثة وبالتالي تهديدا للوجود العربي نفسه، كلَّ ما كان يتنامى في تلك الظروف من محاولات شعرية يسمى "شعرا حرا". بل اعتبر هذا التيار أعداءً، حتى الذين هم في قرارة أنفسهم أكثر محافظة من أقطاب هذا التيار على التراث والوجود العربي كنازك الملائكة وأحمد عبد المعطي حجازي.
لو راجعنا نشريات تلك السنوات من مجاميع شعرية أو كتب نقدية أو عروض في مجلات، لوجدنا كلها تدور في حلقة مفرغة: قضية الشكل بمعزل عن المضمون.
في ظل هذا المعمعان من القول الشعري المتفتح على تحرر شكلي جديد من البناء الشعري، ومن المضمون المعبّر عن الانتماء الإيديولوجي للشاعر، شهد المشهد الشعري أيضا صعود أصوات شعرية متهربة من أي انتماء سياسي واضح، بل لنقل غير منتمية بالمعنى الذي طرحه كولن ويلسن في كتابه "اللامنتمي"؛ أصوات شعرية (توفيق صايغ، جبرا ايرهيم جبرا... الخ) كان غرضها صياغة مضامين شعرية جديدة من خلال التحرر الشكلي من الوزن. لكن هذه التجارب الشعرية الليبيرالية كان عليها أن تنتظر مجيء شاعر اسمه يوسف الخال لإحداث الأزمة التي تثير التساؤل النقدي حول مفهوم الشعر بشكل عام، وبالتالي ترغم كل شاعر على أن يحدد رأيه على نحو واضح من كل القضية الشعرية.
ففي محاضرته التي القاها في "محاضرات الندوة اللبنانية" قبل صدور العدد الأول من المجلة بأشهر، أوضح يوسف الخال أنه يجب: "تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله على ضوء المضامين الجديدة. فليس للأوزان التقليدية أية قداسة". ذلك أن المضمون هو الذي يخلق الشكل المناسب له؛ فالشاعر هو الذي يعطي ما لا شكل له شكلا... وعلى هذه الصخرة التحررية، تم تشييد مجلة "شعر" لفتح نوافذ التعبير الذاتي على آفاق جديدة من القول الشعري والوقوف وجها لوجه مع التيار الايديولوجي لشعر التفعيلة. خير تلميح نقدي وجّهته مجلة "شعر" الى شعراء التفعيلة للخروج من اللغة الإيديولوجية، هو قصيدة "ميت في بلد السلامة" لأحد شعراء التفعيلة الطالعين آنذاك سعدي يوسف. فقصيدة سعدي يوسف المستوحاة من حادث حقيقي في الجنوب العراقي، نقلت تجربة حياتية نقلاً جعلت من هذا الحادث موقفا سياسيا من دون أيّ إشارة إيديولوجية. اختيار الخال لها لتكون فاتحة العدد الأول من المجلة، لم يكن اعتباطيا، بل كان إشارة الى حركة شعرية جديدة، ويلبي هذا الاختيار البند الأول لمحاضرته في "الندوة اللبنانية": "التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه/ أي بعقله وقلبه معا". قصيدة سعدي يوسف فذة ورائدة في هذا الكتابة الشعرية، وصلت ذروتها في ديوانه "قصائد مرئية" وتعثرت في ما بعد. كما فضل الخال نشر مقطع نقدي بقلم ارشيبالد ماكليش مترجم عن الانكليزية، ليكون أشبه ببيان المجلة الشعري، يؤكد فيه أن الشعر هو فعل سياسي في جوهره وليس بحاجة إلى أن يخضع إلى خطاب سياسي ما. وهذا ما لم يكن في حسبان معظم النقاد والشعراء المتصارعين حول مسيرة "الشعر الجديد" آنذاك.
يوسف الخال الذي عاش في أميركا واطلع على تطورات "الشعر (بمعنى النظم) الحر" Free Verse كان متفتحا على كل تجربة شعرية جديدة وواعيا إلى أن التحرر الشكلي الذي قامت به حركة "الشعر الحر" العربية، سيؤدي في نهاية المطاف إلى شعر حر خال حتى من الأوزان، كما حصل للشعر الحر الأوروبي والأميركي. فها هو شاعر جديد اسمه محمد الماغوط الذي عاين عن كثب لغة الواقع البوهيمية بكل تشردها ومتاهتها في شوارع العيش الخلفية، مأخوذا بتدفق الصور وتدفق المعاني بأوزانها الخاصة، من دون أن يستذكر العروض والتفعيلات أو يلبي التزاماتها، يكتب شعرا حرا وليس قصيدة نثر كما يتصور معظم النقاد. وها هو شاعر شاب آخر اسمه أنسي الحاج المتطلع إلى تكسير النحو العربي وتوتير المفردات العربية لكي تتنفس العربية شعرا جديدا أقرب إلى قصيدة النثر والشعر الخالي من الأوزان، أخذ على عاتقه مساءلة نقدية تكسيرية لما كان يصدر من دواوين شعرية إيديولوجية. وسرعان ما هجر شوقي ابي شقرا الوزن ليعبث بالجُمل والتراكيب من أجل شعر يخرج من صلب اللغة المستعملة، إذ "حصان العائلة" بحاجة إلى "ماء". أما أدونيس، فكان كعادته يلعب دور المنظّر المتلهف إلى احتواء كل ما يظهر من تنظير جديد. وهناك عشرات من رفاق الطريق، شعرا ونقدا. في المحاضرة نفسها، طالب يوسف الخال أيضا الشعراء بأن يعوا "التراث الروحي – العقلي العربي، وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة كما هي، دون ما خوف أو مسايرة أو تردد... وبالتالي الغوص إلى أعماق التراث الروحي – العقلي الأوروبي، وفهمه وكونه، والإبداع فيه".
في الحقيقة، وعت مجموعة "شعر" التراث وبينت خلله وعدم صلاحيته في مواكبة روح العصر، وعيا جريئا سيجعلهم في عزلة وموضع شبهة في نظر السلطة الأدبية آنذاك. وتجلى الوعي هذا ليس فقط في مقالات ونقد ونماذج شعرية شاذة، من وجهة نظر النحو العربي، بل خصوصا في الغوص في أعماق التراث الأوروبي وترجمته.
وإذا تعوّدنا من المجلات قراءة ترجمات لتراث أوروبي لم يعد له مفعولية، فإن مجلة "شعر" كانت تقدم لنا ترجمات تواكب آخر التجارب الشعرية العالمية، وتضعنا في مرآة هذه التجارب، والأخطر في أسلوب كان في حد ذاته محرضا على كتابة شعرية جديدة. وكما قلت سابقا ولا أزال، أؤمن بأن الشعر العربي المعاصر مدين إلى ما تراءى من نماذج عبر ترجمات مجلة "شعر" أكثر مما هو مدين للإنتاج الأدبي العربي الحديث نفسه! فمن خلال ترجمات "شعر"، برز أمام الشعراء الشباب syntax تركيب جديد للجملة الشعرية لم يُعهد من قبل. إن ما يعتبره السلفيون بشتى تجلياتهم، عربية مكسّرة، وجملا لا علاقة لها بالبناء الكلاسيكي للجملة العربية، كان هو الشعر عينه الذي لا يزال يلهم عشرات الشعراء والشاعرات الجدد اليوم.
لكن... نعم لكن،
يبدو أنه في غمرة التجريب والدخول في معمعان النقاش مع شرطة مجتمع متحجر في تراثيته، لم يكن هناك متسع أمامهم لتوضيح عدد من المفاهيم وفي الأخص مفهوم قصيدة النثر الأوروبية ومفهوم الشعر الحر. يا تُرى، ماذا كان حدث للكتابة العربية الجديدة، لو خصصت مجلة "شعر" عددا كاملا لنماذج قصيدة النثر الفرنسية، مثلا، وعلى نحو مدرسي!
ومع هذا، فإني أستطيع القول إن هناك شعرا قبل "شعر"، وشعراً ما بعد "شعر". وإن رغبة يوسف الخال العميقة في أنه من الضروري أن تكون حديثا دائما للمرة الأولى، ستكون هي ما يتبقى من مشروع "شعر" ساريَ المفعول. وإن العربية فقدت الطاقة الإبداعية التي كان يمدها الآخر، المسيحي اللبناني، عندما كان يتنفس في هواء العربية الطلق، لا تحاصره خفافيش الظلام كما اليوم.
نعم، لا يمكن الاحتفال بالعيد الخمسيني لهذه المغامرة الشعرية، دون الانحناء للآخر المسيحي اللبناني، الذي لولاه لما كان تغيّر الشعر العربي إلى قصيدة مفتوحة للجميع.
أزمنــــة المجلــــة
(1)
من يجرؤ على نسيان مجلة "شعر" بما هي ملحمة التحديث الشعري العربي، في لبنان وعبر لبنان؟ لا أطرح هذا السؤال سعياً إلى وصف أو تشبيه أو مقارنة. قد لا ينفع كل ذلك. قريباً أو بعيداً عن أزمنة "شعر"، تبدو المجلة، اليوم، مثبتة في مدار منفصل. تماماً. الفصاحة تحجب عنا أجنحة هذه المجلة مثلما الفظاظة. شيء منهما يزهو بالطنين، لكن "شعر" هناك. تراقبنا ونحن لا ندرك ما هي تفعل بنا. نافذتها خائنة ككل نافذة. خيانة الأقفال التي وضعها الحارسون لموتـنا. للموت الذي يبتغون له أن يكون ميراثاً نتقاسمه خلف النافذة.
تماماً. وأنا أعلم أن صدور مجلة "شعر" كان في سنة كنت فيها التحقت، بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، بمدرسة ابتدائية حرة. 1957. شتاء. عندما صدر عددها الأول لم تتعدّ معرفتي بالعربية ما كنت قرأت من القرآن وما شرعت في متابعته من تعليم عربي حديث في مدرسة "ابن كيران"، منبهراً بالدفاتر والريشة والمداد، مترنماً بنصوص كتاب القراءة اللبناني. وفي بيروت كانت المجلة توالي الصدور. ثماني سنوات قبل أن تتوقف للمرة الأولى. وعندما علّمتني مدرسة "العدوة" كيف أقرأ الكتاب والمجلة لم يكن لمجلة "شعر" أثر في كشك "باب السلسلة"، القريب إلى معرفتي بخريطة فاس آنذاك. هناك عثرت على مجلة "الآداب" ومجلة "حوار". كانت المجلتان متكاملتين بالنسبة الى مراهق مثلي، بدون أي طموح أدبي واضح. القراءة وحدها. والشعر لغة مفضلة. وكان عليَّ أن انتظر عودة "شعر" إلى الصدور في شتاء/ ربيع 1967. وتحديداً الأعداد الثلاثة الأخيرة، التي كان نشر فيها شابان مغربيان كنت على صلة أولى بهما. إدريس الخوري، الأول من حيث النشر في العدد 42 ثم إلى جانبه محمد زفزاف في آخر عددين صدرا من المجلة، 43 و44، بين ربيع وخريف 1969. كانت جريدة "العلم" الرباطية، في ما أظن، هي التي أشارت بتمجيد الى مجلة "شعر" وحضور صوتين مغربيين فيها. وقد عثرت لأول مرة على أحد العددين في كشك في الرباط، ثم أطلعني إدريس الخوري على أعداد أخرى، فأصبح الحديث معه ومع محمد زفزاف عن المجلة مألوفاً. حديث ممتزج بالإخبار عن علاقتهما بيوسف الخال.
لم أنتسب، إذاً، إلى مجلة "شعر" ولا إلى مناخها التحديثي، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية. ولم يتسنّ لي أن أتعرف بدقة وتفصيل عليها إلا بعدما أهدى اليَّ أدونيس مشكوراً طبعة جديدة مجلدة من المجلة، أثناء زيارتي الأولى لبيروت في صيف 1979، بدعوة كريمة منه ومن خالدة سعيد. وفي سنة 1985 دعاني سيف الرحبي في باريس الى حضور حفل ودي في بيته في حي بيغال، على شرف يوسف الخال، فكان اللقاء حميماً ومؤثراً. يوسف الخال وأنا تبادلنا التحية كما لو أن كل واحد منا كان يعرف الآخر منذ عهد طويل. معه، في ذلك الحفل، فتحت حواراً دام حتى وقت متأخر من الليل. ثم كان لقاءان أو ثلاثة وهو يتابع العلاج في مستشفى باريسي.
(2)
إن قلت إني لم أنتسب إلى مجلة "شعر" ولا إلى مناخها التحديثي، فهذا يقتصر على فترة صدور المجلة وانتشار دعوتها، سنة بعد سنة. لكني كنت تعرفت الى "شعر" في بداية الستيـنات من خلال ديوان "أنشودة المطر" لبدر شاكر السياب، وهو الديوان الذي حاز جائزة المجلة سنة 1960. كان الديوان وصل إلى المغرب وأنا في بداية شغفي بالشعر العربي المعاصر فأصبح أنشودتي الشعرية المفضوحة. لم يكن الديوان يفارقني. أحسست آنذاك أن السياب ينادي عليَّ، بقصيدته المتنقلة بين الفردي والجماعي، بأنشودة للموت والحياة. نداء هو فاتحة قراءة قصيدة عربية لا تتوقف عند التحديث العروضي، بل تجعل من العمل الشعري رؤيا تتفاعل صورها الغريبة مثلما تتحرك في بناء عناصرها.
"أنشودة المطر" وجه للمجلة لازمني. من ثم عليَّ أن أقول إن مجلة "شعر" كانت تشتغل وفق مشروع تحديثي، يفتح نافذة الحرية بقدر ما يحمي النافذة والمستعملين لها من سطوة التقليد. مجلة ودار نشر ورواق فني وأمسيات الخميس. شعراء ونقاد ومترجمون يلتقون بفنانين رسامين ومسرحيين. بذلك كانت المجلة مشروعاً يصبر على آلام المرحلة كي يصبح التحديث الشعري مدخلاً الى تحديث أوسع، هو التحديث الثقافي والاجتماعي – التاريخي. ما زلت احتفظ بطبعة مجلة "شعر" لديوان "أنشودة المطر". أحتفظ بها، معتـنيا بصيانتها. كنت، عندما اقتنيتها، شعرت برهبة الجمال. طبعة أنيقة على ورق غير معتاد. تلمسه فإذا بالأصابع تلمس جسداً منعشاً. حُبيـبات تكاد تتنفّـسها من دون أن تراها. وصفرة لا تشبه صفرة سواها. نعم، كنت أحب الورق الأبيض، ولكن كان لصفرة أوراق "أنشودة المطر" ما يترك العين مرتعشة.
(3)
لم أتخلّ قط عن مجلة "شعر". هي دائماً نصب عيني. كثيراً ما أعود إليها لأقرأ لا ما كان يُنشر فقط استجابة لفترتها بل أيضاً لما هو أبداً مستقبل كل فعل شعري تحديثي عربي. هي مجلة ذات أزمنة متعددة. وسواء كنت قرأتها في فترة صدورها أو قرأتها بعد تلك الفترة فإني أعتبر نفسي ابناً من أبنائها. هي الآن ماضينا لكنها ماضينا الحديث. أي أنها أصبحت تستحق أن تكون مستقبلنا الشعري ومستقبلنا الثقافي. كذلك هو الشأن مع الماضي الشعري، عربياً وغير عربي، أو مع الماضي الثقافي الإنساني، الذي هو ضوؤنا الوحيد لأجل أن يبقى الإنساني، المبدع، الحر، متكلماً على لساننا وسارياً في كلماتنا. "شعر" هي خلف مجلة "أبولو" في القاهرة. وإن كان ثمة وعي شقي يطاردنا في حياتنا الشعرية والثقافية، ويتركنا عراة في شوارع البرد، متنكرين لذاكرتنا الثقافية، ولمغامرة مبدعين كانوا سبيلنا ومرقانا إلى الصافي والمتألق، فإنني أعتبر نفسي من بين هؤلاء الأوفياء الذين لا يخونون هذه الذاكرة ولا يلقون بها وبأصحابها إلى النسيان.
العودة إلى مجلة "شعر" (وقبلها مجلة "أبولو") تفيد أن مشروعها التحديثي كان يترصد الأسئلة التي لم يكن أحد من التقليديين يفكر فيها. وأنه، في الوقت نفسه، مشروع كان ينقل المغامرة من فضاء الممنوع إلى فضاء الحق. تجديد لمعاني الكلمات. من هذه المعاني الحدود بين الشعر والنثر، بين الماضي والحاضر، بين الكتابة والترجمة، بين الأدب والحياة، بين الشعر والفكر، بين الأدب والفنون، بين اللغة والزمن، بين الكتابة والقراءة، كما بين الكتابة والنظرية. مشروع لن نراه من وراء الجدران، مهما يكن اسمها، لأنه لن يسمح لنا بأن نراه إلا إذا نحن غيّرنا ما تعوّدنا استطابته من انغلاق ومن كسل ومن قيم تتعارض مع المصاحبة والضيافة والصداقة. مجلة "شعر" خرجت إلى العالم من أجل اللقاء بالعالم. إنه معنى النافذة المفتوحة، التي منها وحدها يصبح اللقاء بالعالم ممكناً. نافذة اللغة العربية التي عرفت عبر تاريخها المتشعب كيف تكون لغة البحر المتوسط لعهود، لغة يتآلف الشعري فيها مع الفني، والعلمي مع الفكري. تلك النافذة المفتوحة هي ما كانت مجلة "شعر" تحفر لأجله الجدران حتى تبلغه، في اختلافات المشرفين عليها وتنوع كتاباتهم ومصادرهم الثقافية والفكرية.
(4)
لا شك أن ليوسف الخال الدور الكبير. فهو الرحّالة، المهاجر إلى الولايات المتحدة، المطّلع، قبل غيره، على تيارات شعرية وفكرية كانت تتجاوب وتتلاطم. تجربته في رئاسة تحرير مجلة "الهدى"، وهو في نيويورك، ذات شأن خاص. ومعرفته العريقة بالإنكليزية سمحت له بأن ينظر أبعد مما كان متداولاً عن الثقافة الأنكلو- أميركية. رحلة السياحة بلغة أهل التصوف. السياحة التي كانت تهدف إلى التعلم الصعب، البعيد عن الاقتناع بما يجود به المكان المنطوي على نفسه. ولا يمكن أن نتخيل إقبالاً على مشروع، كمشروع مجلة "شعر"، دونما اعتبار لاختراق الفضاء المشرقي المغلق والانغمار اللامشروط في استعادة حق الشاعر العربي في التحديث وفي الكلام الحر.
لا نمتلك، للآسف، حتى اليوم، ما يمنحنا إمكان التعرف من الداخل الى يوسف الخال. جدار قيم اللامعرفة السائدة يزداد ضخامة وجبروتاً. ولا مباهاة بمستقبل قريب، على الأقل. لكن الآثار المتفرقة بين صحف ومجلات وكتب يمكن أن تسعف يوماً ما في الانتصار على الجدار. كان يوسف الخال يربط بين الشعر والتنظير للشعر. ثم كان مدركاً الصلة بين الكتابة والترجمة. أو بين الشعر والدفاع عن الشعر، كما لو كان يهتدي ضمنياً بإزرا باوند، الذي غيّر الوضع الشعري في كل من أميركا وإنكلترا. فالأفق الشعري، المتشابك مع الأفق النظري والأفق التواصلي، كان أفقه الذي تعبّر عنه خطة المجلة في عددها الأول، أو كما اتضح أكثر فأكثر في الأعداد اللاحقة. لكنه، في الوقت نفسه، كان شديد الارتباط بالحس العربي. من بداية المجلة حتى نهايتها كان هذا الحس يتنوع عبر ما تنشره المجلة لشعراء من أقطار مشرقية عدة، أو لشعراء وعنهم في بلاد غير مشرقية، كما هي حال حضور العناية بالكتّاب الشبان في المغرب، وفي مقدمتهم إدريس الخوري ومحمد زفزاف، أو بمجلة "أنفاس".
أتحاشى الافتراض والتخمين. وقائع ثابتة في المجلة عن هذا الأفق الكلي وعن هذا الحس العربي. لا أخترع شيئاً. هي هناك تخاطبنا كلما تواضعنا واقتربنا منها، متعلمين، مسترشدين. فالمجلة، التي استقبلت في عددها الأول كلا من سعدي يوسف وأدونيس ونازك الملائكة وفدوى طوقان، كأسماء لها رمزيتها في التحديث الشعري، هي نفسها التي استقبلت في أعدادها المتوالية أنسي الحاج وبدر شاكر السياب وخليل حاوي وجبرا إبرهيم جبرا ونزار قباني وشوقي أبي شقرا وتوفيق صايغ ومحمد الماغوط وفاضل العزاوي من الكاتبين بالعربية، وهم بدورهم يمثلون رمزية ضمن حركة التحديث الشعري. لكنها هي نفسها التي استقبلت في مرحلتها الثانية (أي بعد استئناف الصدور في ربيع 1967) أسماء مثل محمود درويش وسركون بولص وسميح القاسم ومحمد عفيفي مطر وفوزي كريم ومحمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البياتي وتيسير سبول وصنع الله إبراهيم ومحمد عبد الحي، دونما إغفال لكل من إدريس الخوري ومحمد زفزاف، السابق ذكرهما.
أسماء المرحلتين تدل على أن يوسف الخال، الاسم الذي لم يتغير، لا حضوراً ولا مسؤولية، كان مدركاً لما خطته "شعر" من سياسة للنشر أو سياسة للشعر والثقافة. وبين المرحلتين، الأولى والثانية، ضم يوسف الخال إليه شباناً متضامنين مع مشروع المجلة، فيما هم طعّموها بكتاباتهم وبوجهات نظرهم المتباينة، إلى حد التعارض. أذكر تخصيصاً أدونيس، الذي أصبح رئيس تحرير المجلة ابتداء من العدد الرابع، ولاحقاً (مع العدد 17) شوقي أبي شقرا وأنسي الحاج، في المرحلة الأولى؛ أو أنسي الحاج وفؤاد رفقة وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ ورياض نجيب الريس، في المرحلة الثانية.
(5)
ليس لي هنا أن أفصل في إيراد الأسماء. لكن المجلة أنشأت داخلها حياة نقدية راقية. قدرات برزت، على يد شعراء ونقاد، في تقديم الشعر الحديث من خلال دراسات ومراجعات وقراءات لدواوين. واللافت هو حضور المرأة الشاعرة والناقدة. إنه الحضور الذي يشير، أول ما يشير، إلى ضرورة أن يكون للمرأة حق الكلام، بدون تفاضل. نازك الملائكة، فدوى طوقان، سلمى الجيوسي، خزامى صبري (خالدة سعيد)، سنية صالح، بكتابات تظل حتى الآن مرجعاً لكل من يقرأ الشعر العربي المعاصر.
ولعل الانفتاح على الشعر في العالم من الموجهات الدالة على جدارة المجلة بأن تبقى إشارة إلى مستقبلنا الشعري. ففي كلمة افتتاحية للعدد 15 (صيف 1960) جاءت الفكرة ناضجة: "تحقق مجلة شعر، في هذا العدد، خطوة إلى الأمام. فلمرة أولى، في ما نعلم، يقبل شعراء كبار في العالم على نشر نتاجهم الجديد في مجلة عربية، ولمرة أولى كذلك ستـنشر مجلات العالم، على نحو جدي، قصائد مترجمة لشعراء اللغة العربية". هي استراتيجيا جديدة للمجلة من أجل حوار مباشر مع شعراء في العالم، مع تجارب وحضارات شعرية. هذا الممكن، في رأيي، أبعد ما ولّد الطفرة التي لم تتوقف حتى الآن، بصيغ سمحت لشعراء عرب أن يبنوا الجسور الصلبة لما يكثر اللغط حوله في سنواتنا الأخيرة، أعني حوار الحضارات. وكم سيكون مفيدا أن نعيد قراءة هذه "الخطوة" لكي نتأمل جدياً في مبادرة الشعراء العرب، شعراء التحديث، ليبدأ زمن حوار فاعل بين عالمين شعريين (وثقافيين) لا يزال كل منهما يجهل الآخر، بهذا القدر أو ذاك.
(6)
مجلة "شعر"، بكل ما حققت، ذات أزمنة يصعب الوقوف عليها واستنطاقها دفعة واحدة. أو هو زمننا الذي يمنع ذلك. لا بأس. ولنا أن نقدم على التصريح بفعل له، اليوم، تاريخه. لكنه تاريخ مشدود إلى ما قبله، بما هو تاريخ قطائع. لدينا في المعرفة الحديثة ما يحمينا من تكرار ما لا فائدة فيه. أهمية "شعر" تتضح في قوة قطيعتها من أجل أن يستمر الكلام الشعري ويستمر التحديث نبضاناً في سريان الزمن. كذلك كانت مغامرة "أبولو"، التي تستحق من كل واحد منا التحية، أو كانت مغامرات موالية، في المشرق والمغرب، بأصوات تختلف قبل أن تتنافر، وهي تنصت الى الزمن شعرياً ومعرفياً، تنصت اليه اجتماعياً وتاريخياً.
من المستقبل تبدأ القراءة. ما تختزنه مجلة "شعر" من قوة لن نكشف عنها ولن نستحقها إلا إذا نحن أتينا إليها من المستقبل. مستقبل ما نقاوم من أجله لكي يكون. حرية القصيدة ومغامرتها في حوار تلقائي مع العالم. إنه بُـدّ القصيدة. مشرقاً ومغرباً. لغة الحرية. حيث ما يضيء طريق من لا يعودون.
ملاحظات جوهرية
 قرأتُ في صباي في العراق بضعة أعداد من مجلّة "شعر"، وأكملتُ قراءة كامل أعدادها لدى وصولي إلى باريس في منتصف السبعينات من القرن الماضي. كانت المجلّة محاطة في العراق بهالة من التقدير والإعجاب يرافقها شيء من الحذر. ففي بلد تسيطر عليه الثقافتان الشيوعيّة والقوميّة ما كان أحد ليفهم هذه الحماسة التي أبداها رعاة المجلّة أو محرّروها في الترويج لأفكار تهدف إلى عزل الأدب عن كلّ ممارسة سياسيّة وعن كلّ انهمام مجتمعيّ. الآن أيضاً، خارجَ أطروحات الثقافتين المذكورتين، يعجب المرء بكامل الحقّ من هذا الموقف الذي ستضطرّ المجلّة، بفعل قوّة الأحداث اللاّحقة، إلى مفارقته، فتنشر مختارات من الشعر الجزائريّ المقاتل ومن شعر المقاومة الفلسطينيّة والشعر الأميركيّ الشماليّ المناهض لحرب فيتنام. العجيب أنّ المجلّة، في افتتاحيّة عددها الأوّل، لم تحرص على تقديم نظرتها إلى فنّ الشعر بكلام محرّريها وشعرائها أنفسهم، بل عبر صفحة أو اثنتين للشاعر والناقد الأميركيّ أرشيبالد مكليش. ممارسات كهذه، إضافة إلى الرصيد الواسع المعطى فيها للترجمات، هي التي جرّت في اعتقادي على المجلّة تهمة الانضواء تحت لواء الغرب. لكنْ يتضّح اليوم أنّ طرفين اثنين ومتعارضين كانا ينطلقان من الاعتقاد الخاطئ نفسه: مؤسّسة فرانكلين الأميركيّة لرعاية الأدب، التي كانت تعتقد، بتشجيع من أصحاب القرار السياسيّ الأميركان، أنّ تمويل ترجمات للأدب الغربيّ سيشيع في الشرق أنماط التفكير الغربيّة، والأدباء العرب الذين كانت اعتقاداتهم اليساريّة أو القوميّة تدفعهم إلى الارتياب من كلّ أدب غربيّ لا يصبّ في مجرى نضاليّ مباشر. لا يرتبط الأدب الغربيّ الحقيقيّ بالسياسات الغربيّة، بل إنّ شعراء من أمثال لوتريامون ورامبو وآرتو، حتّى لا أذكر سوى بعض الفرنسيّين، تحمل شحنة من التمرّد والغضب والتفكيك تفوق إلى حدّ بعيد الشحنة التي يحملها أدب نضاليّ، بما فيه أدب بريخت وأراغون. كان يكفي الوفاء للّغة، وانتظار أن يمارس الشّعر في نماذجه الرّاقية فعله أو أثره، وهذا ما لم تعرف مجلّة "شعر" في اعتقادي المتواضع أن تعمل به، فضاعفت من قوّة الحصار المفروض عليها برفعها لواء نظريّة "الفنّ للفنّ" بصورة مواظبة وشائكة. وممّا زاد في التباس الأشياء صدور بعض محرّريها في ماضيهم أو حاضرهم يومذاك عن انخراط سياسيّ، في الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ بخاصّة. إنخراط كهذا جعل الشعار المرفوع، والمتمثّل في إفراغ الشعر (على مستوى الأهداف المعلنة وليس في الضرورة على صعيد الممارسة) من كلّ همّ تواصليّ أو تغييريّ، أقول جعل الشعار يبدو كما لو كان تمويهاً أو محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الآخرين.
قرأتُ في صباي في العراق بضعة أعداد من مجلّة "شعر"، وأكملتُ قراءة كامل أعدادها لدى وصولي إلى باريس في منتصف السبعينات من القرن الماضي. كانت المجلّة محاطة في العراق بهالة من التقدير والإعجاب يرافقها شيء من الحذر. ففي بلد تسيطر عليه الثقافتان الشيوعيّة والقوميّة ما كان أحد ليفهم هذه الحماسة التي أبداها رعاة المجلّة أو محرّروها في الترويج لأفكار تهدف إلى عزل الأدب عن كلّ ممارسة سياسيّة وعن كلّ انهمام مجتمعيّ. الآن أيضاً، خارجَ أطروحات الثقافتين المذكورتين، يعجب المرء بكامل الحقّ من هذا الموقف الذي ستضطرّ المجلّة، بفعل قوّة الأحداث اللاّحقة، إلى مفارقته، فتنشر مختارات من الشعر الجزائريّ المقاتل ومن شعر المقاومة الفلسطينيّة والشعر الأميركيّ الشماليّ المناهض لحرب فيتنام. العجيب أنّ المجلّة، في افتتاحيّة عددها الأوّل، لم تحرص على تقديم نظرتها إلى فنّ الشعر بكلام محرّريها وشعرائها أنفسهم، بل عبر صفحة أو اثنتين للشاعر والناقد الأميركيّ أرشيبالد مكليش. ممارسات كهذه، إضافة إلى الرصيد الواسع المعطى فيها للترجمات، هي التي جرّت في اعتقادي على المجلّة تهمة الانضواء تحت لواء الغرب. لكنْ يتضّح اليوم أنّ طرفين اثنين ومتعارضين كانا ينطلقان من الاعتقاد الخاطئ نفسه: مؤسّسة فرانكلين الأميركيّة لرعاية الأدب، التي كانت تعتقد، بتشجيع من أصحاب القرار السياسيّ الأميركان، أنّ تمويل ترجمات للأدب الغربيّ سيشيع في الشرق أنماط التفكير الغربيّة، والأدباء العرب الذين كانت اعتقاداتهم اليساريّة أو القوميّة تدفعهم إلى الارتياب من كلّ أدب غربيّ لا يصبّ في مجرى نضاليّ مباشر. لا يرتبط الأدب الغربيّ الحقيقيّ بالسياسات الغربيّة، بل إنّ شعراء من أمثال لوتريامون ورامبو وآرتو، حتّى لا أذكر سوى بعض الفرنسيّين، تحمل شحنة من التمرّد والغضب والتفكيك تفوق إلى حدّ بعيد الشحنة التي يحملها أدب نضاليّ، بما فيه أدب بريخت وأراغون. كان يكفي الوفاء للّغة، وانتظار أن يمارس الشّعر في نماذجه الرّاقية فعله أو أثره، وهذا ما لم تعرف مجلّة "شعر" في اعتقادي المتواضع أن تعمل به، فضاعفت من قوّة الحصار المفروض عليها برفعها لواء نظريّة "الفنّ للفنّ" بصورة مواظبة وشائكة. وممّا زاد في التباس الأشياء صدور بعض محرّريها في ماضيهم أو حاضرهم يومذاك عن انخراط سياسيّ، في الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ بخاصّة. إنخراط كهذا جعل الشعار المرفوع، والمتمثّل في إفراغ الشعر (على مستوى الأهداف المعلنة وليس في الضرورة على صعيد الممارسة) من كلّ همّ تواصليّ أو تغييريّ، أقول جعل الشعار يبدو كما لو كان تمويهاً أو محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الآخرين.
عندما قرأتُ المجلّة في الفترة الزمنيّة المذكورة، لاحظتُ، كما لاحظ سوايَ، أنّ في مجلّة "شعر" مجلاّت، أو أنّها تنطوي على حساسيات متباينة. كان هناك تيّار يجمع بين التجديد والمحافظة، يمثّله يوسف الخال وأدونيس وآخرون. ويلاحظ المرء أنّ شيئاً من التقليديّة بقي يطبع إنتاجهم حتّى أيّامنا في حالة الشعراء الأحياء. ولا أحسب - ولستُ هنا في صدد القدح والمماحكة بقدر ما أنا في صدد التقويم – أنّ إنتاج شاعر كأدونيس نال ما ناله من رواج إلاّ بثمن تنازلات مستمرّة للذوق السائد ولعاطفة الجمهور، وذلك مهما قيل عن غموضه (أدونيس غامض؟) وتفلسفه. تيّار آخر، يضمّ أنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ وبعض قصائد لويس عوض وجبرا إبرهيم جبرا وآخرين تميّز بحداثة أكثر جذريّة، ما كان للثقافة القائمة إلاّ أن تحيلها على الهوامش، وقد يلاحظ المرء نوعاً من التشتّت لحق بها بعد توقّف مغامرة "شعر". عصام محفوظ مثلاً اتّجه إلى المسرح (هو ليس اختياراً خاسراً في الضرورة) وأنسي الحاج، بعد الرجّات العميقة التي أحدثتها مجموعاته الأولى وفي مقدّمتها "لن"، طبعَ شعره بيقينات روحانيّة نحترمها فكريّاً ونلاحظ آسفين الفارق بينها وبين حرارة البدايات التأسيسيّة، وشوقي أبي شقرا واصلَ إلغام اللّغة بألعابه البارعة من دون أن يسبغ عليها كثير تجديد، من دون أن يعني هذا أنّه تنازل عن خصوصيّته الداعية إلى الاحترام.
الجانب الذي أثارني في المجلّة قبل أن أجد طريقي إلى القراءة في بعض اللّغات الأوربية، ولا يزال يثيرني إلى اليوم، هو اشتغالها على ترجمة الشعراء الأجانب، الغربيّين بخاصّة، بأسلوب جديد وطلاوة غير مألوفة يومذاك. إلى هذا يُضاف عملها على تقديمهم في كلمات تعريفيّة ونقديّة مكثّفة. كلمات شديدة التأثّر بالطبع بعمل النقّاد الغربيّين أنفسهم لكنّها تعرب عن مقاربة جديدة، إنطباعيّة وذوقيّة في الغالب الأعمّ، وجوديّة وفنيّة، للشعراء.
يمكن أن يتقدّم المرء اليوم بانتقادات منهجيّة حادّة لبعض الترجمات، لكن هذا لا ينفي جدّتها بالقياس إلى ما سبقها، وصمود بعض صفحاتها حتّى اليوم. معروف أنّ أغلب ترجمات الشعر، السابقة لمحاولات مجلّة "أبولو" في الثلاثينات من القرن المنصرم، كان يُقام بها نظماً. ومجلّة "شعر" نفسها نشرت نوعاً من هذه الترجمات وعرضته للنقاش، عبر صيغة موزونة ببحر الرمَل وضعها مصطفى الخطيب لقصيدة "المقبرة البحرية" للشاعر الفرنسيّ بول فاليري وصدرتْ في العدد الثاني عشر. عندما تقارن بين الأصل والترجمة (وهذا ما أقوم به في كتابي عن ترجمة الشعر عند العرب الذي يصدر بالفرنسيّة في غضون شهرين في منشورات آكت-سود تحت عنوان "حصّة الغريب") تلاحظ كيف تحوّل فاليري، وهو واحد من آباء الحداثة في القرن العشرين وأحد المؤثّرين في شعراء السورياليّة، وإن لم يعترف أغلبهم بذلك، أقول تحوّل في الصيغة العربيّة إلى شاعر رومنطيقيّ مولع بالإطناب والنعت، هو المقتصد بهما في شعره.
أكثر من جميع من سبقوهم، خرج مترجمو مجلّة "شعر" بترجمة القصيدة من ترجمة المعنى إلى عناية واضحة بالشكل، وأثبتوا أنّ في الإمكان نقل الأبيات الأصليّة في أبيات غير موزونة، كهذه المستخدمة في قصيدة النثر العربيّة الماغوطيّة إذا جاز التعبير لتمييزها عن قصيدة النثر المتلاحمة السطور، ما صار يُدعى بقصيدة الكتلة (تسمية غير دقيقة، فقصيدة الأبيات تشكّل هي أيضاً كتلة). هو إذَاً، انهمام موسقيّ وشكليّ وبحث عن نصاعة الكلمات والصّوَر يستحقّ التحيّة بحد ذاته. أضف إليه الاختيارات الموفّقة واللاّفتة في الغالب، فلم يكن بالشيء العديم الدلالة والتأثير أن يتلقّى شابّ مثلي (أقصد يومَ قرأتُ أعداد المجلّة) معرفة برينه شار وقصائده غير الشعاريّة في الحريّة والقطيعة والعشق، وببافيزي وما كتب عن "مهنة العيش" نثراً وشعراً، وبمرثيّة لوركا لصديقه مصارع الثيران أغناثيو سانتشيث مخيّاس، وبأبولينير واندهاشه المؤسي والعميق وراء بساطته الظاهريّة من أنّ جميع مَن انتظرَهم جاؤوا إلاّ... أبولينير.
لقد بدا لي ولا يزال يبدو لي أنّ بضع ترجمات قام بها مترجمون شبه "عابرين" في المجلّة لتبذّ هذه التي قام بها القيّمون على المجلّة وشعراؤها المكرّسون، لا بل قد تتخطّاها. أفكّر هنا بترجمة منير بشّور لـ"أربعاء الرّماد" لإليوت، المنشورة في العدد الثاني من "شعر"، وبترجمة نذير العظمة لقصائد مختارة لدايلان توماس، الصادرة في العدد العاشر، وبصياغة صبحي محيي الدين لمرثية لوركا السابقة الذّكر، المنشورة في العدد الثامن عشر.
من بين ما آخذه، أخيراً، على ممارسة المجلّة لترجمة الشعر خلوّها من كلّ جهد بحثيّ أو فقهيّ - لغويّ أو نقديّ، خلا الكلمات التعريفيّة المكثّفة التي تسبق الترجمات أو تلحقها. خذ الترجمة التي اشترك في وضعها يوسف الخال وأدونيس لقصيدة "الأرض الخراب"، وضمّها كتاب مختارات إليوت الشعريّة الصادر عن المجلّة. فبالإضافة إلى بعض استعجال في القراءة، كأن يقرأ المترجمان hands بدل lands، ويترجما أحد الأبيات إلى "هل سأرتّب يديَّ قليلاً؟" بدل أن يترجماه إلى "هل سأرتّب أراضيَّ (أو ممتلكاتي) قليلاً؟"، بالإضافة إلى هذا، أقول، تلاحظ تضحيتهما بجميع الحواشي التي سهر على وضعها إليوت نفسه، والتي تضيء استعاراته من كبار قدامى الشعراء و"تناصّاته" مع آثار قديمة وحديثة واشتغاله على بضع لغات ميتة وحيّة، إلى جانب إشارات مخصوصة إلى عناصر موسيقيّة وتشكيليّة وسواها. ولا يحذف المترجمان قبستين يستهلّ بهما الشاعر عمله باللغتين اللاتينية واليونانية فحسب، بل يقدّمان بعض العبارات بلغاتها الأصليّة دون التفكير بالسؤال عنها وترجمتها في حاشية أو في المتن نفسه. يطالع القارىء العربيّ مثلاً عبارة Datta, dayadhuam, damyata مطبوعة هكذا بالحروف اللاتينيّة، ولا يدرك فحواها ولا يحيط بوظيفتها في العمل الشعريّ. لكنّ حاشية ترافق الأصل الإنكليزيّ وكذلك ترجمته الفرنسيّة التي وضعها المترجم الشهير بيار ليريس تُفهمنا أنّ هذه الكلمات الثلاث تلخّص في الحقيقة المبادئ الثلاثة الكبرى في "الأوبانيشاد" (أحد أجزاء "الفيدا"، أقدم النّصوص الروحانيّة الهندوسيّة)، وتعني ببساطة: "أعطِ، تعاطَفْ، وَجِّهْ". العطاء والتعاطف (روح اللّطافة) يسبقان فعل القيادة، فما أبلغها من حكمة!
لحظة تحول مهمة
لست من جيل مجلة "شعر" ولا حتى من الجيل الذي تلاه، لكن تأثري، شخصيا، بما فتحته هذه المجلة من آفاق امام القصيدة العربية كان اكثر، ربما، من اي مطبوعة ادبية عربية اخرى. فالاسئلة التي طرحتها "شعر" على الحياة الثقافية العربية تعدت، في نظري، سؤال الشعر ذاته، بما هو فن مخصوص، الى التفكير في مصادر الشعر ووظيفته وفي الحياة العربية التي كانت تجتر، وقت ذاك، القديم، الى حد بعيد، وتحاول اعادة انتاجه. هذه الاسئلة التي طرحتها المجلة ظلت تدوم في الفضاء العربي حتى بعدما توقفت "شعر" وتفرق شمل القائمين عليها، وجئت الى بيروت التي انتقلت الى طور آخر غير طور مجلة "شعر"، إلاّ ان اسئلة المجلة ورموزها والتجديد الشامل الذي دعت اليه ظلت موجودة على نحو او آخر في المساحة الشعرية.
علينا ان نتذكر ان يوسف الخال، راعي المجلة، ربط في محاضرة مبكرة له بين القصيدة والعالم، بين التجربة الشعرية وزمن انتاجها، واظنه استخدم مصطلح الاتباعية (وانا اكتب، هنا، من الذاكرة، او ما تبقى من فكرة الخال في ذاكرتي وليس من وثيقة امامي) وهذا مصطلح سنراه يتكرر، لاحقا، في تنظيرات ادونيس حول القدامة والحداثة والابداع والاتباع. المهم ان الخال اشار كذلك الى ان تغيير القصيدة لا يتم الا من خلال تغيير النظرة الى العالم. هذه فكرة مبكرة ومهمة، وهي، على الارجح، كانت مثار سجال في الحياة الثقافية العربية في خصوص الشعر، تحديدا، والادب على نحو عام.
كما ان علينا ان نتذكر، نحن الذين سنكتب ما يسمّى قصيدة النثر، لاحقا، ان اول تنظيرات واعية في خصوص هذا النوع الشعري كتبت في مجلة "شعر"، سواء من خلال ترجمة ادونيس وانسي الحاج لفصل من كتاب سوزان برنار او من خلال مقالة لادونيس انطلاقا من تنظير سوزان برنار. كما ان علينا ان نتذكر، نحن الذين سنحار حيال هذه التسمية ونتحفظ عنها، ان اول التباس حول هذا النوع الشعري صنعته هذه المجلة ايضا. فراح الشعراء يكتبون قصائد على غرار محمد الماغوط معتبرين ذلك قصيدة نثر، وهي، قياسا بالاصل الغربي، لم تكن سوى قصيدة حرة.
مفيد ان نتذكر، كذلك، ان المجلة حاولت ان يكون للشعر قضيته الخاصة به، لا في اعتباره صوتا لقضايا اخرى، حتى وان كانت مقدسة كالقضية الفلسطينية. وهذه فكرة لم يتم تقبلها تماما في لحظتها، وإن كانت ستعود بعد ان تتوارى الشعارات الكبيرة وتخمد نيران النضال البلاغي. وهنا اتذكر رسالة من يوسف الخال الى السياب ينفي فيها، على ما يبدو، اتهام الشاعر العراقي له بعدم اهتمامه شعريا بقضايا الواقع العربي، فيقول الخال انه يهتم بهذه القضايا، لكن الفرق بينه وبين الذين يسمّيهم السياب (لا يذكر الخال اسماءهم) هو في المفهوم الشعري، وليس عدالة تلك القضايا او اهميتها.
لكن عندما نتحدث عن مجلة "شعر"، فنحن نتحدث، في الوقت نفسه، عن مجلة "الاداب"، رفيقتها في الفترة والمكان وشريكتها في السجال حول الشعر والثقافة والحرية وقضايا الحياة العربية. ولا شك عندي ان الفصل بين المجلتين واسئلتهما والمجال الذي تحركتا فيه، لا يجدي نفعا في فهم قضية مجلة "شعر". فرغم ما بدا من انقسام حاد بين المجلتين، او بين الفكرتين اللتين دعتا اليهما، الا ان هناك تأثرا وتأثيرا متبادلين بينهما. لكن هذا ليس مجال الحديث عن الترابط، او حتى الانقسام حول الافكار بين هاتين المجلتين الرائدتين، فلذلك مجاله الخاص.
في العودة الى مجلة "شعر"، اقول ان تأثيرها في الشعرية العربية من الكبر بحيث يمكن القول ان هناك قصيدة عربية قبل "شعر" وقصيدة اخرى بعد صدورها. وهذه مهمة لم تقيض، بحسب ظني، لأي مطبوعة اخرى. هناك فضل اخر لمجلة "شعر" هو في ربط الحداثة والتجديد بالترجمة او بالتثاقف بين القصيدة العربية وما يُكتب في الغرب. ترجمات "شعر" كانت رائدة على هذا الصعيد، وهي ساهمت، كما اعتقد، في عرض صورة مختلفة للشعر امام الشعراء العرب.
كما ان من "شعر"، وفيها، تبلورت تجربة ادونيس وطلعت تجربة انسي الحاج الخاضّة، المتمردة، الهاذية، غير المسبوقة في الشعرية العربية، ومنها عرفنا محمد الماغوط الذي لم يكن له مثيل في شعر تلك الايام، وتعرض بدر شاكر السياب لتأثيرات اجوائها التجديدية، وبدأ نزار قباني يختلف، وقدّم جبرا ابرهيم جبرا ترجمات وافكارا نقدية، وحصلنا على شوقي ابو شقرا الخ...
هكذا عندما جاء جيلنا السبعيني، وجد روادا واسئلة مطروحة بجرأة وعمق على الحياة العربية، وكان هناك اول الطريق الذي شقّته الحداثة، وكانت قصيدة النثر قد ولدت وانتجت شعراء كبارا. ليس هناك منصف من جيلنا لا يقرّ بدين، غير مباشر، لهذه المجلة ولأسئلتها، رغم المسار الاعمق الذي شقّته تجربة الجيل الذي انتمي اليه، وهي، بحسب تصوري، التجربة التي جذّرت، نهائيا، بذور الحداثة ووضعت ما يسمّى "قصيدة النثر" في قلب الشعرية العربية على نحو لم يعد ممكنا معه الرجعة الى الوراء.
لكن هذا المنجز الجديد كله لم يكن ممكنا، ايضا، لولا الارض التي مهدت لها مجلة "شعر" وجعلتها تربة صالحة للقصيدة التي ستأتي لاحقا وتذهب بفكرة تجديد النص الشعري العربي وفتحه على فضاءات الشعريات العالمية الى مدى بعيد.
نعم هذه المجلة لا تزال راهنة!
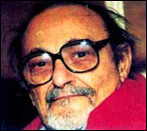 تعدّ المجلات الأدبية عموماً مصدرا ثميناً بالنسبة الى الباحث في مجال الأدب كما بالنسبة الى مؤرخ الأدب، ليس فقط من حيث أن هذه المجلات تحدد معالم تاريخٍ للأدب بعيدٍ عن أن يكون قابلا للاختزال في الأعمال المنشورة في كتب، بل أيضا من حيث أنها تعبير مميز يقدم في كل فترة شيئا أكثر ابتكارا وأكثر موهبة وأكثر جسارة، وأخيرا، من حيث كونها تأكيدا لجماليات ضد جماليات أخرى ولقيم طليعية ضد قيم متمأسِسة. في هذا المعنى، يمكن القول إن مشروع مجلة "شعر"، كمشروع كل مجلة أدبية هو "فعل تأكيد جيل معين من الكتاب والنقاد على المساحة الأدبية، فعل تأكيد غالبا ما يأخذ شكل البيان الذي يعين من خلاله خصمه ويحدد اتجاهاته الجمالية ويختار قراءه"، بحسب ما جاء به أوليفييه كوبي في موسوعة "أونيفرساليس" (المجلد 19، ص 914). فمجلة "شعـر"، في وصفها موقع رصد حقيقيا للإبداع الشعري في العالم العربي وفي العالم بصفة عامة (وذلك عبر شبكة مراسليها)، ومختبرا حقيقيا للتجريب والتفكير حول الحداثة الشعرية العربية، كانت مجلة مهمومة بالشعر أولا وأخيرا. فهي، بإعلائها من شأن حرية الإبداع والفكر، وبتشجيعها التجارب الجديدة الأكثر جموحا (وخصوصاً قصيدة النثر والكتابة بالعامية العربية أي باللغة المحكية)، تتمايز تمايزا حاسما عن كثيرات من أخواتها، وبينها، وخصوصاً مجلة "الآداب" (1953ـ ) التي دعت إلى طليعية ملتزمة، ثم، برغبتها في إدارة ظهرها الى أي التزام إيديولوجي، وبتبنيها هوية متوسطية (بل إنسانية عالمية)، وبدعوتها إلى الفصل الحاسم بين الإبداع الأدبي للشاعر والتزامه السياسي، وهذا ما لم يكن من شأنه أن يجعلها ذات شعبية في سياق عربي قوامه النضالات القومية في سبيل الاستقلال والأزمات المتعاقبة منذ قيام إسرائيل.
تعدّ المجلات الأدبية عموماً مصدرا ثميناً بالنسبة الى الباحث في مجال الأدب كما بالنسبة الى مؤرخ الأدب، ليس فقط من حيث أن هذه المجلات تحدد معالم تاريخٍ للأدب بعيدٍ عن أن يكون قابلا للاختزال في الأعمال المنشورة في كتب، بل أيضا من حيث أنها تعبير مميز يقدم في كل فترة شيئا أكثر ابتكارا وأكثر موهبة وأكثر جسارة، وأخيرا، من حيث كونها تأكيدا لجماليات ضد جماليات أخرى ولقيم طليعية ضد قيم متمأسِسة. في هذا المعنى، يمكن القول إن مشروع مجلة "شعر"، كمشروع كل مجلة أدبية هو "فعل تأكيد جيل معين من الكتاب والنقاد على المساحة الأدبية، فعل تأكيد غالبا ما يأخذ شكل البيان الذي يعين من خلاله خصمه ويحدد اتجاهاته الجمالية ويختار قراءه"، بحسب ما جاء به أوليفييه كوبي في موسوعة "أونيفرساليس" (المجلد 19، ص 914). فمجلة "شعـر"، في وصفها موقع رصد حقيقيا للإبداع الشعري في العالم العربي وفي العالم بصفة عامة (وذلك عبر شبكة مراسليها)، ومختبرا حقيقيا للتجريب والتفكير حول الحداثة الشعرية العربية، كانت مجلة مهمومة بالشعر أولا وأخيرا. فهي، بإعلائها من شأن حرية الإبداع والفكر، وبتشجيعها التجارب الجديدة الأكثر جموحا (وخصوصاً قصيدة النثر والكتابة بالعامية العربية أي باللغة المحكية)، تتمايز تمايزا حاسما عن كثيرات من أخواتها، وبينها، وخصوصاً مجلة "الآداب" (1953ـ ) التي دعت إلى طليعية ملتزمة، ثم، برغبتها في إدارة ظهرها الى أي التزام إيديولوجي، وبتبنيها هوية متوسطية (بل إنسانية عالمية)، وبدعوتها إلى الفصل الحاسم بين الإبداع الأدبي للشاعر والتزامه السياسي، وهذا ما لم يكن من شأنه أن يجعلها ذات شعبية في سياق عربي قوامه النضالات القومية في سبيل الاستقلال والأزمات المتعاقبة منذ قيام إسرائيل.
بيد أن مجلة "شعر"، بتخصصها في الشعر، تتمايز أيضا عن المجلات الأدبية والثقافية اللبنانية الأخرى المعاصرة لها والتي تقاسمت معها عددا لا بأس به من الأقلام، كمجلة "الأديب" (1942 - 1983) ومجلة "صوت الأجيال" التي حملت في ما بعد اسم "المجلة" (1956 - 1969)، أو أيضا مجلة "الورود" (1947 - 1961). الواقع، أن التحليل الموجز لهذه المجلات يوضح التنوع الصارخ للموضوعات التي عالجتها، وملمح "الثقافة العامة" الذي يسمها، ويكشف بذلك عن غياب ما يسمّيه يوسف الخال "الرسالة تجاه الشعر"، أي يكشف عن غياب مشروع أدبي مدروس تجاه الشعر، ويكشف، في ما يخصنا، عن غياب مشروع حداثي شعري أولا وأخيرا.
تمكن يوسف الخال من أن يحيط مجلته بشبكة كاملة من المنابر الحافزة لتطور حركته الحداثية، مشكّلا بذلك أقطابا مؤازرة ومكملة لمشروع ثقافي واحد: فعلاوة على ندوة "خميس مجلة شعر" والتي لقيت أصداء لها في الصحف المحلية وخصوصاً في صحيفة "النهار"، لا بد من الإشارة في الواقع الى الأهمية الاستراتيجية لـ"دار مجلة شعر"، التي نشر يوسف الخال من خلالها مجموعات شعرية عربية ومختارات من الشعر الأجنبي ودراسات تمضي عموما في اتجاه مفهومه الحديث للشعر؛ وإن كان يجب أن نشير أيضا إلى مجلة "أدب" (أنشئت في عام 1962) و"غاليري وان" (أنشئت في عام 1963)، وهما منبران أنشئا لأجل مد طموح مجلة "شعر" الحداثي إلى الآداب والفنون. والحال، أن "قنوات الميديولوجيا" canaux de médiologie هذه، إذا ما استعدنا تعبير ريجيس دوبريه ، قد شكلت، على مدار بضع سنين، مؤسسة ثقافية حقيقية، ثرية بـ"أرحام المعاشرات الاجتماعية" matrices de sociabilités، بما يمكّنها من التأثير على مختلف مجالات الإبداع والكتابة، ومن أن تحفز، برسالتها الثورية وعزمها على تقويض أسس مسلّمات التراث الثقافي والأدبي ـ توخّيا لتغيير حياة الإنسان العربي ـ نقاشات حامية النبرة ميّزت عقد 1960 - 1970، بل وما بعده. الواقع، أن تحليل مضمون مجلة "شعر" يتيح قطعا، فك رموز الحياة الأدبية والفكرية لفترة الستينات والتعرف الى الإشكالات الجمالية التي تميزها، ومن ثم رصد القضايا الرئيسية التي ميزت وجود مجلة "شعر" وأدت لا سيما إلى توقفها الموقت (1964)، ثم إلى توقفها النهائي (1970). إذ تطرح المجلة أسئلة جوهرية حول الشعر والنقد واللغة والعقل العربي وعلاقته بالحداثة وبالتراث، وحول دور الشاعر بصفة خاصة ودور المثقف بصفة عامة داخل المجتمع العربي.
اليوم، وبالرغم من اصطدام "شعر" بما سمّاه الخال "جدار اللغة"، والذي يمكن التعبير عنه بطريقة أخرى هي العقلية العربية غير المتقبلة للتفاعل وللتغيير، وبالرغم من الاتهامات الخطيرة التي تعرضت لها "شعر"، وذلك بسبب أخذها عن الغرب وتذويبها للتراث العربي في سياق إنساني عالمي، وبسبب طليعيتها نسبةً إلى مجتمع عربي يسوده الشعور القومي وتطغى عليه قيم الثبات (أو، بحسب خصوم آخرين، بسبب كون معظم حاملي نهضة "شعر" مسيحيين أو من مناصري الحزب القومي السوري)، بالرغم من هذا كله، استطاعت "شعر" أن تتخطى العقبات الشكلية وأن تفرض نفسها على الأجيال اللاحقة التي ردّت إليها اعتبارها الأدبي، بدءاً بالأخت المنافسة، مجلة "الآداب"، التي كرست لها ملفا خاصا (مجلة شعر: أسئلة الحداثة القديمة الجديدة) عام 2001.
لا مفر إذاً اليوم، من معاينة أن مجلة "شعر" قد أثرت في عصرها كما في أجيال الشعراء التالية (خصوصاً في المشرق العربي) والتي خلعت عليها ، نوعاً ما، طابعا أسطوريا ورفعتها إلى مقام مجلة تأسيسية لنهضة جديدة. كما أنه لا مفر من معاينة أن الجيل الشعري والأدبي اللاحق قد كرّس غالبية مبادئها الرئيسية: قصيدة النثر، الإنسان كموضوع أول وأخير للشعر، والانفتاح على التجارب الأخرى والتواصل معها، لا سيما عبر حركة الترجمة.
فعلى مستوى الشكل، نلاحظ أن قصيدة النثر التي أطلقتها المجلة عبر مقال أول لخزامى صبري (خالدة سعيد) حول "حزن في ضوء القمر" لمحمد الماغوط، وعبر اشتقاق المصطلح العربي المترجم عن الفرنسية والتنظير له بقلم أدونيس، وأيضا عبر ديوان "لـن" لأنسي الحاج الذي تبنته "دار مجلة شعر"، والذي يعدّ أول ديوان شعر عربي يقدّم نفسه كديوان قصائد نثر، نلاحظ أن هذه الظاهرة الجديدة في كتابة الشعر أصبحت اليوم سائدة ومهيمنة. معظم الصحف والمجلات الأدبية العربية تفتح صفحاتها للجدالات القائمة حول الحداثة والحداثية. وفي ما يخص الشعر، ثمة سؤال هاجسي يعود بانتظام، مثيرا مناظرات حامية: هوية قصيدة النثر العربية وشعريتها وشرعيتها. ولعل أول مؤتمر من نوعه أقيم حول قصيدة النثر في الجامعة الأميركية في بيروت في أيار المنصرم، خير نموذج لذلك. فتطور الشعر العربي المعاصر خلال نصف القرن الماضي يشهد بالفعل على مستوى الشكل، لهيمنة "قصيدة النثر"، وربما كان استنتاج هذه الهيمنة، كما يقول بعض النقاد، يرجع إلى كون معظم المشرفين على الصفحات الثقافية في الصحف العربية التي تروّج هذا النوع الأدبي الجديد، شعراء قصيدة نثر (عبده وازن في "الحياة"، بول شاوول في "المستقبل"، عباس بيضون في "السفير"، أمجد ناصر في "القدس العربي"، جمانة حداد في "النهار"، عقل العويط في "ملحق النهار"،...إلخ). طبعا كان للترجمة في مجلة "شعر"، ترجمة الشعر الأميركي والفرنسي، دور أساسي بالنسبة الى المتلقي العربي، في تدعيم فكرة أن يحمل نصٌ ظاهرُه نثر اسمَ قصيدة. ولعل تطور موقف شاعر كمحمود درويش من قصيدة النثر خلال السنوات الأخيرة، يؤكد استنتاج هيمنة قصيدة النثر كنوع جديد على المساحة الشعرية العربية، وذلك عندما صرح أنه يستحيل للشاعر المسؤول جماليا وثقافيا أن يجتنب ضرورة الحوار مع الظاهرة الأكثر هيمنة في الشعر العربي المعاصر: "القصيدة المكتوبة بالنثر"، وقد سمّاها عن قصد "القصيدة المكتوبة بالنثر"، مسترعيا الانتباه إلى الطابع الإشكالي للمصطلح ـ الذي ترجمه أدونيس عن الفرنسية (poème en prose) والذي تبنّاه أنسي الحاج ومجلة "شعر" والذي تداولته في ما بعد الأجيال اللاحقة رغم إثارته مناظرات لا حصر لها.
أما على مستوى الموضوع، فإن الكتابة الحميمية التي تتخذ من الإنسان كفرد أساسا محوريا، أصبحت لا شك مهيمنة على المشهد الشعري اللاحق بتجربة شعر. فسواء اندرجت الكتابات الشعرية المعاصرة بالنثر في الخط الذي نهجه الرواد (شعراء "شعـر") أو ابتعدت عنه، فهي تعلن انهيار الأفكار الكبيرة التي كانت تجعل من الشاعر نبيا وتخلع على الشعر دورا ثوريا. وإذا كان تعدد الأصوات المعاصرة وتنوع الموضوعات يحملان سمة العصر، أي التشظي، أو بحسب عبارة إيف فاديه "اللاكاملية أو النقص" (l’incomplétude)، فإن ثمة وحدة تتجاوزهما، نستطيع تلخيصها في ذلك البحث الهاجسي المرضي على الحيز الداخلي الحميمي وفيه (l’espace du Dedans)، والذي يتعارض والحيز الخارجي الجماعي الذي لطالما حدّ من حرية الشاعر وإبداعه مستلزما منه أن يأخذ على عاتقه الذاكرة الجماعية. من هنا أصبحت الكتابة الشعرية العربية التي كانت عبارة عن إجابة جماعية على ظلم التاريخ، أصبحت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أساسا لوجود الشاعر الذاتي. انتصار الحميمي الذي لطالما امتزج بالجماعي داخل حيز القصيدة، رافقه في ظل التوترات السياسية والاجتماعية الأخيرة، استبدال الـ"نحن" بـ"أنا" الشاعر التي تطمح إلى انتماء إنساني لا قومي فحسب.
كانت مجلة "شعر" ولا تزال، بمثابة الكلمة المحرِّرة التي يشتاق إلى سماعها كل فرد عربي حديث في جوهره لا في زمن عيشه أو في طريقة عيشه فحسب. فكما جاء في مداخلة يوسف الخال خلال مؤتمر روما عام 1961، بعنوان "الأديب العربي في العالم الحديث": "أن يصبح العالم الحديث عالمنا، أي أن لا يقوم بيننا وبينه حاجز، لا يعني أننا أصبحنا تماماََ فيه، أي أننا تبنينا جميع معطياته ومفاهيمه – الصالح منها والطالح – في حياتنا. فلو كان الأمر كذلك لما كانت القضية المصيرية التي تجابه العرب اليوم، على اختلاف بيئاتهم، هي: كيف ننشئ مجتمعاَ حديثاَ في عالم حديث. هذا التناقض بين كوننا شكلاَ في العالم الحديث وكوننا جوهراَ خارجه، يضطرنا – نحن الأدباء العرب – إلى معاناة قضايا مجتمع قديم في عالم حديث، ومعاناة قضايا عالم حديث في مجتمع قديم. في التعبير عن معاناتنا الأولى نعرض أنفسنا لإنتاج أدب يجده القارئ الحديث بعيداَ عن قضاياه ومشكلاته، وفي التعبير عن معاناتنا الثانية نعرّض أنفسنا، من جهة أخرى، لإنتاج أدب يجده القارئ العربي مستورداََ غريبا". ألا ينطبق كلام الخال على الأديب العربي الراهن؟ وكم كان طليعيا هذا الإنسان الفيلسوف حين أضاف: "كنا نستطيع، قليلا أو كثيرا، أن نتخطى هذه الصعوبة، فنكتب أدبا يعكس حياتنا ويعالج قضايانا الخاصة على نحو يهم القارئ في كل مكان، لو لم نكن في عملنا الأدبي مكبلين بصعوبات أخرى هي أيضا، في أساسها، قائمة أو لا تزال قائمة، لفقدان "الحداثة" في عالمنا العربي". أولى هذه الصعوبات اللغة. "هل تعلمون أننا نفكر بلغة، ونتكلم بلغة؟ ونكتب بلغة؟ (...)، هذا الحرص الذي يبديه العرب على تجميد اللغة في قواعدها القديمة المتوارثة دليل واحد على أن العقل العربي ليس حديثا بعد – أي ليس، بهذا الصدد، علمياَ ولا علمانيا. فهو لا يزال يخضع الحقائق الموضوعية للرغائب الذاتية". ثانية هذه الصعوبات التي يواجهها نمو الأدب العربي وازدهاره ما يصفه الخال بـ"التقطع التاريخي": "نحن الذين لعبنا أعظم أدوار التاريخ الحضاري، ماذا فعلنا منذ ألف سنة، بل ماذا نفعل اليوم؟ عندنا ثورة بالقوة. نحاول أن نصّيرها ثورة بالفعل. حتى هذا لا يعدو كونه أملا. وإذا كان لهذا الأمل أن يتحقق يوما – وهو سيتحقق بإذن الله – فلن يكون إلا بعد صراع بيننا وبين أنفسنا، وبين القوى الخارجة عنا – صراع سيقلب الأرض تحتنا ويبدل دنيانا (...) مشكلتنا أننا، منذ القدم، نعشق الأفكار الكبيرة أولا، ثم نسعى إلى تجسيدها. وكثيرا ما ازداد عشقنا لها كلما بدت لنا مستحيلة التجسيد. بل طالما اضمحل عشقنا لها حالما تتجسد أو ندرك أنها لا محالة ستتجسد". وهناك صعوبة ثالثة يعتبرها الخال أشد الصعوبات وأبعدها أثرا في ما يعانيه العربي في العالم الحديث: "انغلاقنا على أنفسنا وانفصالنا عن جهد الإنسان الحضاري المتواصل المتصل. (...) فإذا أردنا أن نحيا، علينا أن نتصل وأن ننفتح. وإذا كان شيء في تراثنا يحول دون هذا الاتصال والانفتاح، فبئس هذا الشيء. كنا في ما مضى شركاء عاملين في حضارة الإنسان، ويجب أن نظل كذلك اليوم. أعطيناها حين أمكننا العطاء، فلا عار علينا إذا أخذنا منها اليوم. بل العار في أن لا نأخذ اليوم، لكي نستطيع العطاء غداَ. (...) كل ما يقف عائقا أمام اشتراكنا في تجارب الإنسانية كلها، أمام وحدتنا مع الحياة الإنسانية، أمام دخولنا التاريخ الإنساني، أمام مواكبتنا سائر الشعوب في العلم والأدب والفن، أمام جهادنا الإنساني المشترك في سبيل تحقيق حياة أفضل – كل ما يعوقنا عن الصيرورة واحدا مع العالم، هو ليس من تراثنا الحقيقي الأصيل في شيء. قد يكون في عرض هذه الصعوبة على هذا النحو شيء من المبالغة بل من التشاؤم. فنحن اليوم نتصل بالفعل وننفتح. (...)، إنما النقل شيء والخلق شيء آخر (...)علينا أن نفضّ السر بعقولنا لا بعقول سوانا. علينا أن نتواضع وأن نتضع لكي نتعلم ونعرف. علينا أن نكون لكي يتاح لنا، في نهاية الأمر، أن نصير". بغض النظر عن أن العالم العربي حاز بعد هذا الخطاب بسنوات جائزتي نوبل (واحدة في الأدب وثانية في الفيزياء)، فإنه يظل في رأيي راهنا. أما الصعوبة الرابعة والأخيرة التي ذكرها الخال واصفاً إياها بالآنية (!)، فهي الطغيان السياسي في بعض مجتمعاتنا العربية، ويكفينا هنا أن نختم بمقتطف مفعم بالمعنى في ظل ما يعيشه الإنسان العربي عموماً واللبناني خصوصاً هذه الأيام: "حياتنا أعطيت لنا نحن، ونريد أن نحياها نحن، لا أن يحياها أولادنا عنا. وكما أن لا أحدا يموت عن أحد. كذلك لا يحيا أحد عن أحد. لكل حياته وموته. ولكل جزاؤه عن نفسه هو لا عن سواه، عند ربه في اليوم الأخير. الطغيان السياسي، من أجل تحقيق غاية مُثلى، وسيلة عتيقة حان لها أن تبلى. الإنسان الحر وحده يحقق كل غاية، بعبوديته لا يتحقق شيء. الإنسان، في كمال حريته وكرامته هو قبل أي غاية. من له أذنان للسمع، فليسمع. إذا كان ما نهدف إلى بلوغه حق، ونؤمن أنه حق، لا حاجة بنا قط إلى أن نتوسل إلى بلوغه غير وسيلة حق. والطغيان السياسي، بما يزرعه من رعب في النفوس، وبما يقيم من موازين الفكر والسلوك، ليس بالوسيلة الحق. الوسيلة الحق هي احترام حرية الرأي، وإفساح المجال للنقد والجدل والنقاش، واعتبار أن لا شيء، مهما يكن، محرم على العقل".
في الذكرى الخمسين لانطلاقة تجربة مجلة "شعر" الوجودية، كم محزن أن تكون مداخلة الخال هذه التي حرّرت عام 1961 لا تزال راهنة وفعلية. اليوم، في 2007، يظل العالم العربي في حاجة إلى كلمة محرِّرة كالتي جاءت بها مجلة "شعر"، ويظل في حاجة إلى طليعيين فلاسفة يحملون على عاتقهم رسالة تحديث العقل العربي، عبر الشعر وغير الشعر، وربما نحن في زمن غير الشعر: الرواية؟ السينما؟ التلفزيون؟...
- تمت المطالبة لها بوضعية جنس أدبي مستقل: "فكما أنّ هناك رواية، وحكاية، وقصيدة وزن تقليديّ، وقصيدة وزن حرّ، هناك قصيدة نثر"، أنسي الحاج، لـن (المقدمة)، دار الجديد، 1994، ص 20
- Régis Debray, Cours de médiologie générale, Gallimard
- ملف"مجلة شعر: أسئلة الحداثة القديمة الجديدة"، الآداب، المجلد 49، عدد أيلول/ سبتمبر ـ تشرين الأول/ أكتوبر 2001، بيروت، ص ص 45ـ77.
نص إطاحة القناع
مع مجلة "شعر" اللبنانية التي ولدت كبيرة بين العام 1957 والعام 1964 ، نشأت موجة شعريّة ونقديّة تلتها أمواج اعتملت جميعها حول قصيدة النثر بوصفها تعبيرة راهن حداثيّ، منفجر وقد انسحبت تأثيراتها من ثمّة على الخارطة العربية ومثقّفيها لتكون على حداثتها منعطفا لسؤال الحداثة وما بعدها.
من رموز هذه الحركة يحضرنا يوسف الخال وانسي الحاج وادونيس ومحمد الماغوط وفؤاد رفقة وشوقي ابي شقرا وعصام محفوظ وتوفيق صايغ وجبرا ابرهيم جبرا وابرهيم شكر الله وآخرون، معهم عاشت الأنتليجنسيا العربية بمشرقها ومغربها هاجس التجريب والخوض الجريء في أتون الأسئلة الحارقة بدءا من الجانب الاكسسواري للقصيدة وما ينتظمه من بعثرة مدروسة لإيقاعه الخارجي والداخلي في آن واحد، وانتهاء بتيماتها ذات القيم العاصفة بما تآكل من مضامين قديمة أفرزتها سياقات مجازية واستعارية وذائقات تقليدية لا تتناغم والإيقاع المتسارع للقرن العشرين.
مع مجلة "شعر" ذات الطرح الطليعي والهاجس الحداثيّّ الآسر، نجمت تيّارات وحداثات، إن بشكل أو بآخر، سواء في الحقل الإبداعيّ، قصيدة النثر تحديدا، أو في حقول معرفية ونقدية موازية، على خلفية أن مجلة الشعر لم تكن، وإن كانت كذلك، مجرد مجلة لتجلّي النصّ الشعري فحسب بل كانت القادح التاريخي لمنعرج داهم تنتظره بل تقتضيه المرحلة، تلك المرحلة بزخمها وإرهاصاتها وبرغباتها الكاسرة في القطع مع سلطة النص المهيمن و/ أو مع الأب المتسلط. فكان لا بدّ من قتل ذلك الأب الجائر كي يتحقق نصر الحرف والقفز في فضاءات جديدة تناغماً مع تقليعات المرحلة ومتغيراتها.
إيبيستيمية الخروج
لعل يوسف الخال، ومن معه، وعوا المسألة باكرا بحيث أمكنهم أن يحدثوا الفجوة بين التقليد والتجديد عبر الوسيط الشعريّ: قصيدة النثر وما جاورها من أطروحات تنظيرية ونقدية جادّة ومثيرة للجدل، وهذا ما انعكست ظلاله على المساحة العربية عبر النصوص المتصادية أو عبر العدوى العابرة للحدود كي يكون لذلك الشكل الشعري الذي قالت به مجلة "شعر" صوت وصدى وحياة.
من هنا لا يمكننا الآن وهنا أن نغمط مدى أهمية ذلك الفضاء الرمزيّ، إذ لم يكن مجرد مجلة حاضنة لتجارب أو لمشارب شعرية ناجمة أو جديدة، بل كان أيضا منعرجا حاسما مفتوحا على المستقبل والمبادرة بالمغامرة.
إنه في عبارة أخرى، نظام إطاحة القناع: مع قصيدة النثر كما قالت بها مجلة "شعر"، سقط القناع الصوتي والصرفي والنحوي والبياني ليستعاض عنه ببنى بديلة جاذبة ونابذة ومحتفية بالحياة في أسمى تمظهراتها الراهنة. بنى تنشد الاختلاف وتبني حكمتها تأسيسا على جنونها، وهو الامتداد المنهجيّ والطبيعي لما قال به أيضا الريحاني وجبران، ومن لفّ لفّهما.
فتجربة مجلة "شعر"، في رأينا، لم تنبع من فراغ ولم تجىء كموضة شكلية وقشريّة أملتها ذاتٌ ما من باب الإشباع لنزوة احتفائية عابرة، إنما جاءت بناء على ما تقدم من اعتمالات فكرية شتى وتمخضات، لتدشّن عصرا جديدا عبر قصيدة النثر وتداعياتها المنعكسة على بقية الحقول المعرفية الأخرى. هي في هذا المعنى، تجربة رائدة، حتى وإن لم تعمّر طويلا. يكفيها أنها أسّست لشيء شائك هو خلخلة البنية التقليدية السائدة، واقتراح ما به يكون الإيقاع مختلفا.
إذاً احتجبت مجلة "شعر" وما زال الصدى، صداها، في ذاكرة النخبة من شعراء المرحلة ومبدعيها.
مرآة عاكسة
لعلني ألتقي مع أحمد دعدوش الذي شخّص المجال الحيوي لتلك التجربة بقوله: "إن بيروت كانت في ذلك الحين تموج بكل ألوان الثقافات والايديولوجيات، وبحكم الانفتاح على الغرب إلى حد الاستباحة لم يكن فيها شيء يحظى بالقدسية أو الاحترام، فكل شيء مباح ومطروح على الساحة، بل ومدعوم من قبل أنصاره ومسانديه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وعليه، فقد وجدت مجلة "شعر" التي جمعت بعض الأصوات الحداثية الشابة لنفسها موطئ قدم في ذلك الوسط الصاخب". وهذا ما أراه مشروعا في ظل تلاقح الحضارات، قولاً بعلمانية التمشي والطرح والرؤية، وعصفا برجعية المرجعيات المنمطة.
لقد كان لمجلة "شعر" قصب السبق في إثارة أهمّ الموضوعات مجلبة للنقاش، منها الحداثة، والتراث، والغرب؛ والحداثة والواقع، وتأسيس نظرية للشعر العربي الحديث، لتبرزمسألة حارقة من أجل إعادة النظر في المسلّمات الشعرية المتعارف عليها كالوزن والقافية، ولينتهي الإبداع تجاوزاً لما تصنّم من أشكال وتحطيماً للقيم الشعرية الثابتة .
ان مجلة "شعر" كما قال أحد الباحثين المغاربة، لم تكتفِ بتذويب التراث العربي في إطار إنساني عام؛ بل أن هذا التراث الذي شكل هاجسها في التنظير للشعر؛ كان يدعوها كي تجعل تأطير التراث العربي في التراث الإنساني إبداعاً، وأن تأخذ من الغرب وفي الوقت ذاته تجاوز الحساسيات التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
لم تحرّم إلاّ الركون الى التقليد
شهادة زائد شهادة
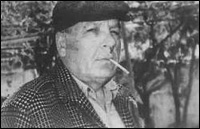 صدرت "شعر" عام 1957 وكان عمري 11 شهراً، واحتجبت عام 1964 وعمري 7 سنوات. وعندما عادت إلى الصدور عام 1967 كنت قد بلغت العاشرة، ولما توقفت نهائياً عام 1969 كنت أودّع الثانية عشرة. فما علاقتي بهذه المجلة العظيمة التي أسسها يوسف الخال، والتي ما أن تفتّح وعيي على القراءة حتى كانت قد اختفت من الوجود؟ وما دورها في تأسيس ذائقتي الشعرية ووعيي الجمالي بالشعر؟ وهل أدين مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لهذه المجلة بكوني شاعراً من طراز يسمّونه حديثاً وحداثياً؟
صدرت "شعر" عام 1957 وكان عمري 11 شهراً، واحتجبت عام 1964 وعمري 7 سنوات. وعندما عادت إلى الصدور عام 1967 كنت قد بلغت العاشرة، ولما توقفت نهائياً عام 1969 كنت أودّع الثانية عشرة. فما علاقتي بهذه المجلة العظيمة التي أسسها يوسف الخال، والتي ما أن تفتّح وعيي على القراءة حتى كانت قد اختفت من الوجود؟ وما دورها في تأسيس ذائقتي الشعرية ووعيي الجمالي بالشعر؟ وهل أدين مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لهذه المجلة بكوني شاعراً من طراز يسمّونه حديثاً وحداثياً؟
لم ألتق بيوسف الخال، لكني قرأت شعره ومسرحه وبعض نثره بيانات ويوميات. عشت في بيروت مطلع الثمانينات وكان هو في غزير بعيداً عن صخب بيروت. ولما تركتُ إلى قبرص ومنها إلى لندن أواسط الثمانينات، كان في باريس، على ما أظن، للعلاج من المرض. فلم يكن لي نصيب أن ألتقي صاحب "بيان الحداثة" ومؤسس "شعر" لكني سأكلف بعد سنوات، مع نهاية الثمانينات، الإشراف على جائزة للشعر ستحمل اسمه هي "جائزة يوسف الخال للشعر" كجزء من عملي مديراً لتحرير مجلة "الناقد"، شراكةً مع زكريا تامر، ولأكون بالتالي أحد قارئين اثنين للمخطوطات الشعرية المتسابقة، ثانيهما زكريا تامر. ومعروف أن الجائزة أسسها في لندن رياض الريس وفاء لذكرى يوسف الخال الذي نشر في "شعر" رسائل ثقافية موقّعة باسم الريس الذي أرسل بها من لندن وكامبريدج في الخمسينات.
***
أول عدد من مجلة "شعر" وقع بين يدي وكنت في سن الرابعة عشرة، اشتريته من بائع كتب مستعملة على رصيف الصالحية في دمشق مقابل مبنى البرلمان. كان ذلك عام 1970 قبل أسابيع قليلة من وقوع انقلاب عسكري جديد ووصول حافظ الأسد إلى قصر المهاجرين المجاور لبيت أبي. كان ذلك العدد قد ضم قصائد لمحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وشعراء آخرين من الأرض المحتلة، وكان قد مرَّ على صدور العدد عام أو اثنان. ولم أقرأ فيه إلا قصائد هؤلاء الشعراء.. بل إني اقتنيت العدد من أجل شعرهم. وسوف يتأجل اكتشافي لمجلة "شعر" بضع سنوات أخرى.
***
خمسون عاما على ولادة مجلة "شعر" التي لم تعش أكثر من 9 سنوات، وأكثر من ثلاثة عقود على احتجابها الثاني. عشرون عاماً على غياب مؤسسها يوسف الخال (آذار 1987)، الشاعر والمحرك الأدبي المغامر والمتمرد، المؤمن بقدرة الأدب على تغيير التاريخ. مجلة لم ترتبط مسيرتها بمسيرة شخص مؤسسها وحده، إنما تجاوزته، كما أراد لها، لترتبط بمجمل حركة تحديث الشعر العربي في أكثر فصولها راديكالية وقدرة على التأثير. كان يوسف الخال طرازاً من المثقفين الرساليين الذي عارضوا الواقع من طريق الأدب. إنه المثقف الأنغلوفوني العائد من أميركا إلى وسط فرنكوفوني في بيروت، ومعه حلم تغيير وجه الثقافة الشعرية العربية. فلم يكن في وسع صاحب "بيان الحداثة"، ومؤسس المجلة التي ستلعب أخطر الأدوار وأكثرها جذرية في تاريخ الشعر العربي الحديث، أن يفعل ذلك في وطنه الأم سوريا، فقد كانت بيروت مدينة الحرية الثقافية في وقت كانت دمشق تتهيأ لتدخل ربقة الحزب الواحد وتعيش في كنف جبل قاسيون، وحيث قتل قابيل هابيل، بياتاً شتوياً قارساً سيمتد عقوداً أربعة، يتجمد معها كل شيء في الحياة السورية، إلا القمع الفكري.
***
غداة نكبة فلسطين، وفي ظل حيرة الأسئلة بإزاء جرح عربي مفتوح على وسعه، ورغبة الأجيال الجديدة في تجاوز سنن التقليد، واستقبال الجديد، على كل صعيد في المأكل والملبس والسلوك اليومي، والعلاقات بين النساء والرجال، والموقف من الدولة، وشكل أنظمة الحكم، ودور الفرد في المجتمع، وخصوصاً الأدب، واستقبال الأدب الجديد، وجد يوسف الخال في بيروت المسرح الحي الذي سيطل منه على العالم العربي بأسره، وليطلق من تلك المدينة مشروعه التحديثي الباهر، وقد التفَّت من حوله جماعة مؤثرة من تلك النخبة المفكرة والمبدعة الساكنة في بيروت واللاجئة اليها، العاصمة العربية الموعودة بأدوار لن تكون متاحة لأي عاصمة عربية أخرى: ريادة الحداثة بأكثر طبعاتها راديكالية وإغراء. ولسوف تلعب بيروت هذه الأدوار طوال النصف الثاني من القرن العشرين، وحتى اليوم.
في طبيعة الحال، لم يكن عدد المجلة "المقاوم" ذاك، هو النموذج الشعري الذي أرادت المجلة التبشير به. ولو عدنا اليوم إلى ذلك الشعر الفلسطيني المقاوم الذي نشر في العدد وقارنّاه بما كانت المجلة تنشره في أعدادها السابقة، لعرفنا أن "شعر" كانت تحاول أن تدفع ضريبة الانتماء إلى اللحظة العربية الجارحة، وأن تواصل معارضة الواقع، واقع النكسة بصوت الاحتجاج الغنائي الطالع عكس توجهات جماعة "شعر" التي قالت بشيء آخر، ودعت إلى نوع أكثر راديكالية من التحرر الشعري.
***
بمفعول رجعي، قرأت في دمشق أواسط السبعينات جل أعداد مجلة "شعر". كانت مغرية، ومثيرة للقريحة والخيال، وفتحت عيني على الخطب الجديدة حول الشعر. لفتني أيضاً أنها نشرت في العدد الأول شعراً بالمحكية اللبنانية لميشال طراد. كان شعراً مدهشاً. لم تكن هناك محرمات. لم تحرّم "شعر" إلا الركون إلى التقليد.
لكني، وبمنتهى الصدق مع الذات أقول إن "شعر" لم تلعب دوراً يُذكر في تأسيسي الشعري، لكنها بالتأكيد لعبت هذا الدور مع غيري من الشعراء ممن صرحوا بذلك، واعترفوا بتأثيرها عليهم. ربما جاء تأثيرها عليَّ من طريق غير مباشر، واعني بذلك المناخ الذي خلقته وتواصل الأثر والتداعي، وتلك المنجزات التي راكمتها وتسرب تأثيرها إلى العديد من الشعراء الجدد، لأن هذا التأثير كان قد تفشى في الهواء الذي هبّ على الحركة الشعرية العربية في بلاد الشام والعراق على نحو خاص، ولم يعد أحد في منجاة منه، إلا المكمّمون.
***
بعد غياب يوسف الخال المؤسس، وغياب بعض ألمع المشاركين في المجلة، أو المعاصرين للتجربة والمشاركين في "خميسها"، كمحمد الماغوط، وجبرا ابرهيم جبرا، وعصام محفوط، لعل أفضل من يتحدث عن تجربة "شعر" هم من تبقّى من المشاركين فيها أحياء، أنسي الحاج، علي أحمد سعيد (أدونيس) وشوقي أبي شقرا، وبخلاف هؤلاء، هناك المؤرخون. أما نحن الذين عرفنا "شعر" بمفعول رجعي، فالمسألة بالنسبة إلينا ستكون حديث قراء وقراءات مستعادة أكثر منها استعادة لقراءة لعبت في حينها دوراً حاسماً في حياتنا كشعراء.
***
سأختار، لنفسي، إذاً، أن أكون وسيطاً بين سلمى الخضراء الجيوسي، التي ارتبطتُ معها بصداقة أعتز بها، وهي شخصية ثقافية عربية نافذة التأثير؛ وشاعرة وناقدة عاصرت تجربة "شعر"، وعرفت شعراءها وكانت عضواً في "خميس شعر"، وبين هذه التجربة الرائدة، لتكون وساطتي تحرير شهادة حول مجلة "شعر" قدّمتها لي سلمى الخضراء الجيوسي في مطلع النصف الثاني من الثمانينات في جلسة معها في منزلها اللندني، وقد أسقطتُ أسئلتي منها لتخرج من حالتها كنص نقدي شفوي، وتتخذ موضعها كوثيقة شخصية ذات أهمية خاصة، لما تتميز به من نزاهة وموضوعية عاليتين.
لمناسبة مضمون هذه الشهادة، وما يمكن أن نخاله ونتوهمه عن فكرة الجدة والجديد والحداثة والحديث، إخال بدوري أن الحركة الشعرية العربية الحديثة، لم تتوقف عند ما تطلع إليه يوسف الخال وأصحابه في "شعر"، بل إن شعراءها الجدد ذهبوا أبعد، وفي ظل فوضى ايديولوجية عربية مذهلة، ونكوص فكري عربي مريع، ولعلهم باتوا العلامات المضيئة في واقع عربي دامس الظلمة ويشبه فخاً بلا أمل في خلاص. ففي الوقت الذي يستيقظ فيه القتلة على الهوية، ويتهيأون لاقامة حواجز الموت على طرق العالم العربي، يتسلح الشعراء بالحب بصفته الشعر، وبالشعر بصفته اليتم.
الروّاد الشطّار
(الى رياض نجيب الريس)
يفاجئني ويعجبني اصرار الزملاء في "الملحق"، وعنادهم في استعادة اندلس لبنان. لبنان الرائد، مصرفاً وفندقاً وجامعة ومستشفى ومطبعة وجريدة وكرخانة وسوقاً عموميا وصالة سينما، ومجلة "شعر" طبعا!
مجلة "شعر" المغفورة، ليست بالنسبة اليّ مقاما ازوره لأشفى، او لأقدّم نذورا، ولم يكن اصحابها اولياء صالحين اقاموا معجزات، وليس من طبعي زيارة القبور للترويح عن الصدور. لكن للحقيقة، ان مجلة "شعر" كانت شعلة كبريت هبّت من هنا، أنارت ونوّرت وانطفأت وترمّدت يوم تحطمت الطائرات عند الفجر في 5 حزيران 1967، حيث الهزيمة التي دلّلوها وغنّجوها بلقب نكسة. يومذاك انطمرت المجلة تحت رمل صحراوي، وانجرف لبنان من بعدها، وكان للمجلة الثائرة الهادرة ان انقلب ثوارها الى ليلة الخناجر الطويلة، وحركات تصحيحية شعرية!
لا تنفصل مجلة "شعر" عن دور لبنان بكونها ترانزيتاً شعرياً لمرور السلع الغربية الى الشرق الاوسط والادنى، فانبرى الرواد كوكلاء لقصائد بروتونية (بروتون) ورامبوية (رامبو) واليوتية (اليوت).
الرواد الشطّار في التجارة، هم يتشابهون مع الشعراء المتمردين، فيتشابه وكيل السيارات مع الوكيل الشعري. وكالات حصرية من الغرب للبرادات او التلفزيونات، مع الوكيل المترجم والمعدّ والمقتبس للغات الاجنبية ولاعادة تصريف الشعر العالمي وحركاته ومجلاته وتياراته الى داخل لبنان وخارجه.
هنا الستينات، هنا بيروت الستينات، التي تستقبل المهاجرين العرب الهاربين برؤوس اموالهم من التأميمات في دول الجوار العربي! هي بيروت نفسها تفتح ذراعيها للمتمردين الشعراء الهاربين من تأميمات اللغة العربية وآدابها خوفا من تجميد ارصدتها! هل كانت مجلة "شعر" هي مصرف لبنان للتحويلات الشعرية العربية، واستقبال تلك الودائع من مواهب، واستثمارها؟!
هل يمكن التفتيش عن قصيدة حرة، ومجلة حرة، من خلال اقتصاد حر؟ هل يمكن مراجعة دور النظام الاقتصادي في نظام القصيدة الحديثة؟
مجلة "شعر" المرحومة او الشهيدة البطلة، ولدت، كما كل الخرافات اللبنانية، من وادٍ ما، حيث تم استدعاء الاسطورة الفينيقية. طبعا ابصرت المجلة النور في "الهلال الخصيب"، من خلطة قوميات خرافية (امة لبنانية + امة سورية) على يد فتى من وادي النصارى في سوريا يدعى يوسف الخال.
هم النصارى الحافظون اللغة العربية في خوابي الاديرة من التتريك، هم انفسهم، انجبوا احفادا تمردوا على اللغة نفسها وطوّروها وحرّروها من نيرها، كما فعل الرائد الحقيقي جبران خليل جبران الذي تسلّم الشعلة من اليازجيين والشدياقيين والبساتنة!
اكرر، لا يختلف رواد مجلة "شعر" عن تجار العاصمة في الستينات في اعادة تغليف سلع الغرب وتوضيبها وتصديرها الى العمق العربي! هم الشعراء انفسهم، والتشكيليون والمسرحيون انفسهم، اعادوا الماركات العالمية والعلامات التجارية الشعرية، واعدّوها واقتبسوها وتأثروا بها وسرقوها وزوّروها، ونصّبوا انفسهم وكلاء حصريين للحداثة! ثم باعوا سلعهم على انها بضاعتهم وانها من شغل اناملهم ومخيلتهم ومقصاتهم وماكينات خياطتهم للازياء الشعرية. سيمرّ زمن طبعا ونعرف، لنشكر العولمة، لتكشف لنا لصوصا ومزوّرين لنهضة شعرية ومسرحية حيث كان الاقتباس والنسخ على قدم وساق تحت وهم ان لا احد سيكتشف مصدر هذه الجملة الشعرية او المسرحية او التشكيلية. يومذاك كانوا لصوصاً ظرفاء حتى في اقتباس الاحزاب الاوروبية (فالانج، نازية، شيوعية...).
مرّ مئات الشعراء على صفحات مجلة "شعر" ولم يبق من تلك الايدي، سوى حفنة من اصابع اسماء في حجم الكف، شعراء قلائل صمدت قصيدتهم لأنها كانت اصلية!
ملاحظة ثانية، لم يفز احد من رواد مجلة "شعر" بجائزة نوبل، وبقي جبران وحده العالمي.
ملاحظة ثالثة: يعتقد كاتب هذه السطور، ان يوسف الخال الذي نفتقده، هو المنشط، والحاضنة الشعرية، اكثر مما هو صاحب مجلة شعرية. لذلك حين نلت "جائزة يوسف الخال للشعر" عام 1988 التي انشأها صديقه الوفي رياض الريس كتحية لرائد، وتحية لصاعد مثلي، اكتشف الآن، ان رياض الريس كان الوارث الشعري لتجربة يوسف الخال كمنشط ومحفّز، من خلال مجلة "الناقد" المأسوف على شبابها، وكذلك من خلال منشوراته الغاضبة وجوائزه! وهنا ادين بالشكر الى رياض الريس الذي قال شكرا بدوره الى يوسف الخال!
ولد لبنان من خرافة ميشال شيحا. ها هم بعض احفاده، احفاد لبنان العظيم الشعري، يتظللون تحت شجرة ارز من عمائم لآيات الله!
لا بد من العودة الى الوراء
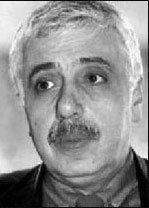 بعد مرور قرن من الزمن على ولادة الحداثة الشعرية الغربية، ونصف قرن على ولادة مجلة "شعر" الأميركية، جاءت ولادة مجلة "شعر" في بيروت لتؤرخ لولادة الحداثة الشعرية العربية، ولتكون الحدث الأهم في مسار الشعر العربي على مدى القرن المنصرم.
بعد مرور قرن من الزمن على ولادة الحداثة الشعرية الغربية، ونصف قرن على ولادة مجلة "شعر" الأميركية، جاءت ولادة مجلة "شعر" في بيروت لتؤرخ لولادة الحداثة الشعرية العربية، ولتكون الحدث الأهم في مسار الشعر العربي على مدى القرن المنصرم.
إذا كان على فرنسا أن تنتظر شعراء مثل بودلير ورامبو ومالارميه كي تأخذ جرعاتها الأوليّة من الحداثة، وبريطانيا شعراء مثل ييتس وأودن ومينا لوي، وأميركا شعراء مثل ويتمان وباوند وإليوت، فقد كان على عالمنا العربي أيضاً أن ينتظر شعراء مثل يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا ومحمد الماغوط وفؤاد رفقه وغيرهم ممن ساهموا في تأسيس مجلة "شعر"، وشاركوا في اجتماعاتها، وممن تبنّوا قصيدة النثر كتابةً وتنظيراً وعملوا على نقل نماذج منها عن اللغات الأخرى.
لعلّ أهم ما يميّز مجلة "شعر" أنها كانت حَدَثاً ثقافياً تخطى الواقع العربي المكبّل آنذاك بهزائمه العسكرية والسياسية، ومشكلاته الإقتصادية والإجتماعية، فجاءت لتُثقل كفّة الميزان التي شالت، ولتمنح الإنسان العربي في ستينات القرن الماضي متنفساً أدبياً لكسر التابو والخروج على الأجوبة الجاهزة، والبحث عن آفاق جديدة لمخزونه الوجداني، متمثلةً بثيمات فجّة عذراء، لم تقربها الشعرية العربية قبلاً إلاّ بخجل، كمقاربة اليومي والذاتي والهامشي، وتعمّد التغريب، والتجريب، فضلاً عن الإنشغال بالبعدين النفسي والإيروتيكي للمحتوى الشعري، وأيضاً متمثلةً بشكلٍ شعري جديد يكون أكثر عطاءً وأقلّ تطلباً؛ شكل لا يخرج عن كونه شكلاً لمضمون شعري من المفترض أنه هو الأساس بحيث أن على الأول أن يتكيّف وشروط الثاني وليس العكس.
رغم قصر حياة مجلة "شعر" والتي عاشت بين الظهور والإحتجاب، إلا أنها أحدثت زلزالاً في صميم المفاهيم الشعرية العربية السائدة، لا يزال مفعوله سارياً إلى اليوم. ذلك أنها لم تكن دورية شعرية فحسب، بل ورشة عمل حقيقية أخذت على عاتقها تلقين درس الحداثة من منطلق تجريبي لا أكاديمي. بمعنى أن قصيدة النثر العربية لم تكن لتتخلّى عن ولائها الأصيل للغتها وتراثها، وإلاّ لما عاشت، وهي لذلك لم تأخذ من تعاليم سوزان برنار إلا الخطوط العريضة لتستخدمها في ابتكار نفسها على خلفية تراث شعري متجذّر في اللاوعي، وتبعاً لتطلعات ومتطلبات كانت تصبو إليها هذه القصيدة من خلال تفاعلها مع الثقافات الأخرى، وأيضاً من خلال النظر إلى حاجياتها هي نفسها، هي التي ضاقت على نفسها، ومن خلال العمل على تمزيق ثوبها والظهور بحلّة جديدة شكلاً ومضموناً.
ونتساءل، إلى أي مدى نجحت مجلة "شعر" في تلقين درس الحداثة؟
في رأينا أن ما حققته في زمانها لم تستطع أن تحققه اليوم في زمن العولمة والإنترنت، كل المنابر الثقافية التي تعنى بالشعر الحديث. السبب في ذلك غياب أي مشروع ثقافي يحتضن قصيدة النثر نقدياً. إذ أهمية مجلة "شعر" أنها كانت مشروعاً ثقافياً احتضن هذه القصيدة كتابة وتنظيراً ونقداً. توقف النقد العربي لقصيدة النثر عند تعاليم سوزان برنار ولم يتقدم بعدها خطوة واحدة إلى الأمام، في حين أن قصيدة النثر العربية لم تتوقف عن التجريب، وهي منذ توقف مجلة "شعر" مرّت بمراحل كثيرة إنما من دون أن يستطيع النقد مواكبتها. والحال، فإنه في غياب النقد، لا فرق أَكَثُر عدد المنابر التي تحتضن قصيدة النثر أم قلّ، لا سيما أن الكثير منها أشبه بالبازارات التي تعرض ما هبّ ودبّ، وتسيء إلى قصيدة النثر أكثر مما تفيدها.
تخلّف النقد يُدخل الشعر في سوق أشبه بالبورصة حيث من الصعب التنبؤ بمستقبله. وفي زمن يتضاءل جمهور قراء الشعر في العالم أجمع، حيث أن الشعر ليس فقط مفقوداً من اهتمامات الناس، بل ايضاً - وهنا الأعظم - غير مُفتقَد، وفي زمن ينشغل العالم في إيجاد وسائل جديدة لمنح الشعر منزلة أرفع في حياة البشر، نجدنا في عالمنا العربي، (لن نشكو من أن قصيدة النثر لم تدخل بعد مناهجنا التعليمية، فهذا ترف) لا نزال منشغلين بأسئلة شعرية تخطاها الزمن، كموضوعة أن يُكتب الشعر موزوناً او منثوراً، ولا نزال نحتفي بقصيدة النثر كما لو أن الخمسين سنة الماضية كانت كلها "لعب أولاد". والحق، ما همّ كيف يُكتب الشعر إذا كان لن يُقرأ؟! ويبدو أنه لا غنى لنا عن العودة إلى الوراء، إلى مجلة "شعر" تحديداً لتعلّم درس الحداثة مجدداً، والعمل على خلق قصيدة حديثة (ليس بالشكل فقط)، تنطوي على حساسيات جديدة وليدة التجربة المُعيشة من أجل ضمان تفاعل القارىء المعاصر معها.
الخشية من الريادة المؤبّدة
بالتأكيد، مجلة "شعر" رائدة ومؤسسِة في الثقافة اللبنانية والعربية. لا يستطيع أحد أن يجادل في ذلك. لقد خاضت المجلة معركة قصيدة النثر بعدما خاضت مجلة "الآداب" معركة قصيدة التفعيلة. المؤكد أيضاً أن معركة "شعر" ليست معركة في فراغ. أقصد أن بيروت في الخمسينات والستينات كانت تخوض معارك الحداثة على أكثر من جانب. في هذا المعنى، فإن معركة "شعر" استكمال لتلك المعارك المتنوعة. هكذا أفهم المجلة من الناحية التاريخية على الأقل. وهذا ما يحتاج إليه كل مشروع: الزمن. لكن بعيداً من هذا التمهيد النافل على فكرتي، أود النظر الى "شعر" بعيون جيلي.
من الصعب على واحد مثلي من جيل شاب، التعاطي مع مجلة "شعر" اليوم على أنها مشروع حي. جئتُ إلى الدنيا بعدما توقّفت المجلة عن الصدور. الأرجح أننا - جيل الآن - نتعاطى مع أثر "شعر" الذي يبدو بدوره منجزاً منذ زمن طويل. أنهت "شعر" معركتها واستراحت ليأتي آخرون بمعارك أخرى أقل شأناً أو أكثر حاجة. وعليه، لم تعد "شعر" مصدراً ثقافياً ووحياً أو هدياً، وإنما أثر. وبمعنى إضافي، كفّت المجلة عن أن تكون شجرة بظلال كثيرة. إنها شجرة تظلل نفسها فقط. كانت "شعر" البداية التي أعقبتها بدايات. كانت الخطوة الأثقل والأصعب والأكثر وعورة وفجاجة. لكن اليوم، يستطيع أي شاعر وناقد طليعي أن يواصل حياته من دون أن يقرأ المجلة أيضاً. ثمة تراكمات معرفية في الخمسين سنة الأخيرة، شعراً ونقداً وترجمات، ليس من السهل حسبانها بصفحة أو نقضها بجملة.
والحال، أخشى أن تتحول "شعر" إلى معطّل في الثقافة اللبنانية. أخشى أن تصبح معياراً يُنتزع من زمنه للقياس عليه الآن. هذا الفعل سيحوّل المجلة الرائدة الى طوطم مثلما سيدفع بالمشروع الجديد الى التشبّه والتقليد من دون وجه شبه أو تشابه. هكذا تصبح "شعر" نموذجاً للتعطيل بسبب اختلاف الزمنين. إذ سيبدو القياس هنا (في استعارة فقهية) لحظة مؤبّدة. مجدداً، أخشى أن تغدو الريادة مسألة دهرية. الريادة - في الأصل - مسألة تاريخية لا فكرة مطلقة. هناك من يضع بعض آيات القرآن في سياق تاريخي مثل نصر حامد أبو زيد، وليس هذا صعباً على مجلة رائدة.
هكذا نحمي "شعر": أن نكون أمينين للحرية والتجاوز والرفض والتحطيم والقبول وحيازة الثقافة التي تجيز لنا الاختيار.
التجربة الطازجة
نكتب الآن عن مجلة "شعر" كما لو انها طازجة، كأنها خرجت من المطبعة قبل قليل. هذه ليست مبالغة. المجلة الصادرة منذ نصف قرن، لا تزال تمثل شرعية الابداع الشعري اللبناني، ومثاله المحتذى. صحيح ان الاجيال التي أتت مباشرة بعد تلك التجربة، أضافت الكثير الى رصيد التجربة الكتابية اللبنانية في النثر، لكن الأصح ان المعيار والمثال بقيا هناك، حيث تجرأ الاباء على اللغة والسائد والمعترف به، وحيث محطة الانطلاق والمغامرة. لا حاجة في "الملحق" الى ان نتحدث عن "لن" أنسي الحاج، أو عن سوزان برنار وشروطها الصارمة في قصيدة النثر. عن يوسف الخال وأدونيس، ولاحقاً عن محمد الماغوط وشوقي ابي شقرا. لست في معرض الكتابة التأريخية لتلك التجربة الرائدة، ولا في صدد البحث الاكاديمي التوثيقي. اتحدث عن تفاعلي المباشر مع تلك التجربة، وعن أثرها عليَّ في الموروث الشعري والادبي. أذكر الآن مشاعري المتدفقة حين رأيت أنسي الحاج وصافحته اول مرة، وكيف سألته لماذا تزعّم يوسف الخال تلك التجربة، واجابني ان يوسف الخال كان الأكبر سناً وتجربة، وان هذا ما قدّمه على الآخرين.
خمسون عاماً على ولادة هذه التجربة، ولم نستطع تجاوزها حتى الآن. ولا يزال روّادها محط اجماع وتقدير. عندما نتحدث عن مرجعية قصيدة النثر اللبنانية، نتحدث عن "شعر". في رأيي، هذا وحده كافٍ ليدل على حرارة هذه التجربة، وقوتها في منطوق كل كتابة نثرية معاصرة، وعلى صدقها كمفتتح لكتابة مغايرة ومضادة.
لا أعرف لماذا كلما خطرت في بالي مجلة "شعر"، اقترن هذا بمقدمة "لن" لأنسي الحاج؟ أحسب انها بيان التأسيس للمجلة، وإن كُتبت بعد صدور أعدادها الأولى، وأنها مختصرها في الهدف والرؤية والمراد. المقدمة تلك، هي الفكرة التي توسعت لاحقاً في أعداد من المجلة، وفي تجارب بدأت تجد لها في ذاك الجنون طريقاً.
رواد "شعر"، بالنسبة اليَّ هم آباء شعريون لا اعرفهم جميعاً. واذا كان لا بد من احصاء الذين اعرفهم من آبائي الشعريين لا يبقى من هؤلاء الآباء غير اسم او اثنين، أنسي الحاج وسراب محمد الماغوط. الحديث عن الابوة الشعرية هنا ليس مباشراً. أي اني في الجيل الخامس او السادس بعدهم. أتحدث عن أبوة معنوية لكل التجربة الشعرية الحديثة. وهذا لا يضير من أتى بعدهم في شيء، فربما يكون الخلف منتجاً ومضيفاً أكثر على عمارة القصيدة التي وضعها الآباء. الابوة هنا تأتي في معناها الزمني والتأسيسي والمغامر. على سبيل المثال، تأسست الدولة الاموية على يدي معاوية ابن ابي سفيان، لكن الفتوحات كلها جاءت في عهود لاحقة. ليس سهلاً على شخص ان يكتب عن مرحلة لم يكن قد ولد فيها بعد، الا اذا كان مؤرخاً. ما أحاول ان اقوله، اننا لولا تجربة مجلة "شعر" ربما كان ينقصنا المرجع والمصدر والمثال.
عنقاؤنا ونمضي
تحيات كثيرة يطلقها الشعر في اتجاه المجتمع ولا يردّها الاخير، لا بأحسن منها ولا بمثلها. بارانويا السلطة - الرعب، وقطّاع الطرق المتحزبون لهم حصة طاغية في تضاعيف البلاد، وأصوات المعركة لطالما حملها وأطلقها أنصاف المثقفين وأرباع الثوار ضد جملة شعرية.
أنت متهاون، متخاذل، ومتعالٍ، فقط لإنك حقيقي وتذهب الى الجوهر. القصيدة فجأة عدوّة لإنها خارج مديح الأمة والقضية ومشاريع الاستبداد. لإنها فضّاحة للذات وتُعنى بالتفاصيل الصغيرة والاحاسيس الخاصة. أخيراً، أنت خائن للوطن والأمة والقضية لإنك تكتب شعراً. هذا ما يعلنه المستبدون جهاراً ونهاراً، ويأخذونك بالوشاية والنبذ والسجن المظلم.
أحبّكم يا يوسف الخال ويا أنسي الحاج ويا محمد الماغوط ويا شوقي أبي شقرا ويا أدونيس ويا رياض الريس ويا عصام محفوظ ويا...
لن تعنيني فيكم ألوهة أو قدسية أو نرجسية أو صراع. أراكم وأظنّ فيكم قائلاً: "يا روّاد الضنك والوحل والعرق والفجور الشعري، أنتم آبائي جميعاً، وأمّي مغارة قصائد وكلمات وحكايات محرّمة. "شعركم" كانت وعاشت ولم تمت. ليست مجلة، بل صندوق سحري سرّي على بساط الريح يأتي من المستقبل. "شعركم" كانت ولا تزال موصولة بجدائلنا، وسرجها على أكتافنا. نحن حمير الشعر وبغال القصائد وكلاب الحب، نمشي و"شعر" تنظر الينا كيف نسلخ كل يوم عن جلودنا جوع "القائد" المفدّى لموتنا. نحن مهرّبي الافكار المحرّمة والكلمات الكاسرة والعبارات الفاجرة، نمضي في وديان ملأها القناصون وأشاوس "مولانا الديكتاتور"، نشيل على ظهورنا بالأطنان عار الأمة لننشره على الجبال كالرايات، وأنت يا "شعر" تظلليننا كالعنقاء، ولا يزال عطرك ماضياً في أنوفنا، يسلكها كي تظل تشمّ الحقيقة.
لزوم إعادة إنتاجها
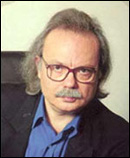 يمكن الواحد أن يتساءل، اليوم، وبعد لا أدري كم من الوقت على "توقف" مجلة "شعر"، لكنه على الأرجح وقت طويل: هل "شعر" أهم أم الروح التي أنتجت "شعر"؟ لأنه، منطقياً، لو اخترنا الاحتمال الأول فهذا يعني أن ننكفىء إلى تقويم تاريخي وتصنيف بيبليوغرافي ربما، أو إلى ذلك الطقس التكريمي إياه، مغفلين أن تلاوة خطبة ما في محاسن الميت ومزاياه، إنما تعني بين ما تعنيه، أنه ميت حقاً.
يمكن الواحد أن يتساءل، اليوم، وبعد لا أدري كم من الوقت على "توقف" مجلة "شعر"، لكنه على الأرجح وقت طويل: هل "شعر" أهم أم الروح التي أنتجت "شعر"؟ لأنه، منطقياً، لو اخترنا الاحتمال الأول فهذا يعني أن ننكفىء إلى تقويم تاريخي وتصنيف بيبليوغرافي ربما، أو إلى ذلك الطقس التكريمي إياه، مغفلين أن تلاوة خطبة ما في محاسن الميت ومزاياه، إنما تعني بين ما تعنيه، أنه ميت حقاً.
أختار شخصياً الاحتمال الثاني، وهو في رأيي ما يبقي "شعر" حية، وما يبقيها باستمرار مشروعاً قابلاً للاستئناف أو التجديد. أحد عرّابي "شعر" (ولننته قليلاً من ذاك السجال الأبدي حول من فعل ماذا، أو لاً)، أنسي الحاج، بصرف النظر عن اختلافي معه في بعض تفاصيل خطابه الأخير في مؤتمر قصيدة النثر الذي عقد في بيروت قبل أشهر قليلة، امتلك جرأة أن يتحدث، مجدداً، عن دور الشعر، ربطاً بزمانه، وهذا بالنسبة إليَّ كان أهم ما في خطابه. "الدور"، دور الفن، مفهوم فضفاض، وحمّال أوجه، بعضها بالغ السوء أحياناً، بحسب من يزعمه، ولماذا، وفي أيّ سياق، وقد درجنا "نحن"، الشعراء الشباب، أو كثر منا، على رفض "الدور"، أياً يكن، من حيث المبدأ والأساس، وهذا الرفض في عمقه، يحمل الكثير من الادعاء: مرة أخرى ثمة من يزعم أنه الأفضل والأنقى، وكأن الكلمات يمكن أن تنجو حقاً من أن تتشكّل في سياق ما (صوت ما على الأقل)، ما إن تصبح في الهواء أو على الورق. على أي حال، يمكن أن نقول اليوم، بكل راحة ضمير، إن "شعر" أدّت، في زمنها، دوراً أساسياً، وهذا الدور، ببساطة، أنها تفاعلت مع زمنها، على نحو ما يمكن، بمقارنات ليست بعيدة تماماً، أن نتحدث عن الدور الذي لعبه "نبي" جبران، أو "ويك إند" غودار، أو "غيرنيكا" بيكاسو، كل في زمنه ومحيطه وجمهوره وظروفه وتأويلاته. في مجال الشعر يمكننا أن نتحدث طويلاً عن "لن" أو "أكياس الفقراء" أو "حزن في ضوء القمر"، وبعض هذه الأعمال (من حيث البيئة التي احتضنته على الأقل) هو على نحو ما، في المعنيين العريض والضيق للكلمة معاً، إنتاج مختبر مجلة "شعر". أنسي الحاج وصف زمننا الراهن هذا، زمن أصبح فيه الخراب واقعاً، وأصبح فيه دور الشعر (الفن) ليس الدعوة إلى الخراب، بل محاولة الخلاص من هذا الخراب الراهن؛ تشكيك (ندم؟) في الدعوة السابقة؟ لا أظن. لكنه للقول إنه بقدر ما كانت الدعوة إلى الخراب، نهاية الخمسينات وبداية الستينات، حاجة ثقافية، وثورة وعي ضرورية، هي الحاجة اليوم إلى "التفاؤل": طريقة أخرى، ولو مناقضة تماماً، لترميم الأعطاب الهائلة في الروح المعاصرة، وعي مغاير؛ روح "الستينات" كانت في حاجة إلى الإنعاش من طريق الصدمة، صدمة اللغة والمعنى والمشروع، أما روح بدايات الألفية الثالثة، الغارقة في الصدمات المتتالية، إلى حدّ أننا أصبنا معها بخمول ينبغي أن يدفع بنا إلى الانتحار، على حدّ قول ساراماغو أخيراً، فتحتاج ربما إلى بعض السكينة. "شعر" وجماعتها نجحوا في لعب هذا الدور، التحفيز والصدم، من جهة، وطرح الأسئلة الجدية على الذات، والتواصل مع العصر من جهة أخرى. بالطبع، الدور غير المسبوق لـ"شعر"، كان في القول إننا كمجتمعات وبشر وثقافات (عربية، شرقية...)، لسنا وحدنا في هذا العالم، وأننا ينبغي لنا أن نشارك هذا العالم الذي كان يغلي بالحركات السياسية والثورية، قلقه وتطلعاته، لأننا سنشاركه (أو نشارك في دفع ثمن) مصيره أيضاً. المشاركة الجدية تكون عبر اللغة، وهكذا كانت الترجمة (ماذا نترجم، وقتذاك؟ عملاً طليعياً بامتياز، موازياً للعمل الإبداعي الخاص).
أقول إن هذا غير مسبوق، وهو في الواقع "غير متبوع"، إذا جاز القول. ذلك أن الروح التي بثتها "شعر"، وهذا أحد أسباب أننا لا نزال نستحضر هذه التجربة حتى الآن، لم تتكرّر. كان ولا يزال هناك محاولات متقطعة هنا وهناك، في لبنان وخارجه، جميعها اصطدمت رؤوسها بالسقوف المنخفضة لمزاعمها، وإذا كان هذا مثيراً لرثاء النفس من جهة، أي واقع أننا اليوم في هذا العالم العربي الشاسع لا نملك مجلة واحدة متخصصة بالشعر، وأعني هنا المجلة - المشروع، لا إصدار الأعداد التي تتضمن شعراً، فإنه ينبغي في أقل تقدير أن يكون مثيراً للغضب، لبعض الغضب على الأقل. من المفارقات الكبرى هنا أن الشعراء أنفسهم، الرواد أو من أصبحوا بمرور الزمن رواداً، كانوا الأكثر استسلاماً وتصديقاً لمقولة "نهاية الشعر"، وهذا يعفي في حدّ ذاته من محاولة "ارتكاب" أي مشروع جديد. لكن، هذه ليست المشكلة، إلا إذا اعتبرنا أن عنوان "شعر" الجوهري، رغم الاسم، كان الشعر وحده. أما إذا تجرأنا إلى حدّ اعتبار "العالم" هو العنوان، وتبعاً لذلك: الحاضر، المستقبل، المصير، السياسة، اللغة، الوعي... فإن زمننا هذا أحقّ بما لا يقاس بأن تستعاد فيه روح مغامرة "شعر".
اليوم باتت الأمور أكثر وضوحاً. لم يعد أحد يبحث فعلاً عن بطل ينسب إليه إنجاز "شعر" التاريخي. مرّ ما يكفي من الوقت، وحصل ما يكفي من التحولات، وخاض كل من فرسان "شعر" تجربته، بطلعاتها ونزلاتها. اليوم، في منطقة (تنا)، التي تغلغل فيها العفن الكبير، وطاول كل شيء تقريباً، أصيب الجميع على ما يبدو بحمّى "الاعتراف" و"المكانة". لم يعد في إمكاننا أن نحصي "الرواد": رواد يهرعون إلى "نوبل" ولا يصلون، رواد لا يعترفون بأنهم يهرعون إلى "نوبل"، لكنهم يهرعون ولو في صالونات بيوتهم، رواد يهرعون برفقة (بمعية) رواد آخرين إلى "العالمية"، رواد لا يكفّون عن الضجيج، وآخرون ينجحون في توليد الصخب حتى في صمتهم. لا أعرف كيف كانت الحال في الستينات من القرن الماضي، لكن ثمة من فكّر وقتذاك بمشروع بسيط: إنشاء مجلة، ونجح في ذلك، ثم أخفق في الاستمرار بالطبع.
لذلك، وأمام هول ما يحدث، بما في ذلك في بيروت، وأمام إلحاح الحاجة إلى إعادة التفكير بأنفسنا وبالعالم وبالشعر، وإعادة صياغة معظم العناوين التي طرحتها "شعر"، لا يسعني سوى التفكير بضرورة إعادة إنتاج "شعر"، في الزمن الراهن، وهو الاستحضار الوحيد المجدي لـ "شعر". ذلك أن تكريم الميت، ليس دائماً دفنه، وخصوصاً إذا كانت لا تزال فيه قابلية للحياة.
إذاً، ما الذي تنتظره يا أنسي؟
خلاص اللحظات الشعرية أن تهدَّد
ورث: يَرِث وٍرثاً ووُرثاً وإرثاً وإرثةً وٍرثةً وتراثاً فلاناً: انتقل إليه مال فلان أو مجده بعد وفاته.
(لسان العرب)
هل أنا "وارثة" مجلة "شعر"؟ لا أعرف.
في ستّينات بيروت كنتُ بعدُ فكرةً، او احتمالاً بعيداً في قصة حب ولدتْ لتوّها، على أحسن تقدير. لم أولد إذاً في زمن المجلة، ولم أعش عصرها الذهبي وفتوحاتها وأمجادها. جلّ ما عرفته عنها في ما بعد، أي ايام الطفولة واكتشاف لذّة (رذيلة؟) القراءة، مجموعة من الاصدارات في مكتبة والدي، وتحديدا على الرف الثالث من الجهة الشمال. مجلدات أوراقها مصفرّة، تماما كما أحبّ، وفي متناول اليد. لكن رغم هذين الاغراءين، لم يدفعني فضولي الى ان أفتحها وأتصفّحها يومذاك. كنتُ اؤثر عليها "الممنوعات" الفرنسية الموجودة على رفّ أعلى، والتي كنتُ مدمنة على سرقتها، فضلا عن روايات "دار المكشوف" التي تربّيت عليها لأن والدي، الذي كان يعمل في تلك الدار، دأب على إمدادي بها بغزارة. هكذا كنتُ متآلفة مع يوسف حبشي الأشقر ورئيف خوري وخليل تقي الدين وتوفيق يوسف عواد وجورج مصروعة، الذين كنت أقرأ أعمالهم وأصغي الى اخبارهم وقصصهم مع الشيخ فؤاد حبيش على لسان أبي، بينما لم أكن قد سمعتُ بأدونيس وأنسي الحاج ويوسف الخال. ذلك أني كنتُ، شِعراً، غارقة في عالم الحداثويين الفرنسيين، كون طعم الشعر العربي الذي رحنا نذوقه سنة بعد سنة على مقاعد المدرسة، لم يكن محفّزاً لاكتشاف المزيد. وكنت أظن أن ذلك العنوان الفضفاض والمبهم، "شعر"، سيحمل اليّ المزيد مما لم أكن متحمّسة لتلقّفه من كلاسيكياتنا العربية، وتقوقع غالبية مناصريها على تقديس الشكل بدل البناء، والوزن بدل الايقاع، والتقليد بدل التجديد.
ثم جاء الوسواس "المنقذ من الضلال"، وامتدّت اليد اليانعة في أحد الأيام الى ذلك الرف الثالث من الجهة الشمال من المكتبة الضخمة. واكتشفتُ المجلة. وكانت الشهقة الأولى، الأقوى، (الأكذب)، التي ترافق ادراك كلّ ما لم يكن في الحسبان. واكتشفتُ شعراء المجلة. وكان الانسحار والاحساس بحبل سرّةٍ ما، بانتماءٍ (وهمي على الأرجح)، وبـ"انتقامٍ" منقذ أيضاً: انتقام للغربة التي كنتُ اشعر بها إزاء لغتي العربية، وإنقاذ لها فيَّ ولي فيها. وكم أحببتُهم، أولئك الملاعين! جزء كبير منهم على الأقل. أحببتُ شعر أنسي الحاج، والكثير من شعر محمد الماغوط، والبعض من شعر شوقي أبي شقرا، الخ... أحببتهم، وأحبّهم. نعم. ولكن، هل هذا يجعلني، أنا "المحسوبة" (رغماً عن إرادتي) على جيل الألفية الثالثة، "وارثتهم"؟
***
لأتحدث قليلاً عن دور المكان الذي ولدتْ فيه مجلة "شعر"، عن تلك العاصمة التي لم اعرفها. لأتحدث عن ريادة بيروت الستينات، وغليانها المخصب، وغناها، وشساعتها، وزعرنتها، وحريتها. كم كنتُ أحسد اولئك الذين عاشوا في تلك الفترة! كنتُ أنظر الى صور اجتماعات "شعر" وأمسياتها في الجرائد: هنا أنسي كشيطانٍ سكوت، هناك أدونيس وسيكارته الأبدية، وبينهما الماغوط متربّعاً على الأرض. أتأملهم فتحكمني غصّة: لِمَ لم أولد آنذاك، معهم، بينهم؟
الآن، بتّ أكثر رضا على ما أنا فيه، وأقل انبهاراً بما كان. طبعاً، لم أزل أرفع الشكوى إياها الى الله، وبالحرقة نفسها، لكن لأسباب أخرى مختلفة تماما، متعلقة بأحوال هذا البلد التعيسة على زمني، والتي لم أكد أعش فيها يوماً "مثل الخلق"، منذ ولدتُ وحتى هذه اللحظة...
الآن، ايضاً، "كبرت". وبتّ أدع نفسي تنجرّ الى التساؤل "الخبيث" الآتي: الى أي حدّ يعود جزء كبير من الهالة "الأسطورية" التي أحاطت بـ"شعر" وأركانها، الى الأجواء التي كانت تعيشها بيروت في ذلك العقد، والى كاريزما تلك المدينة (الماضية) المذهلة؟ ثم الى تساؤل أشد خبثاً: لو كانت مجموعة "شعر" موجودة هنا، اليوم، هل كان "صار ما صار"؟
أراني مدفوعة الى أن أجيب، بصراحةٍ "كافرة": لا. فبيروتنا الحاضرة رحم عقيمة، قاحلة، لو زرعتَ فيها منيّاً عجائبياً، يذوي الجنين ويموت.
الكفر مشروعٌ إذاً، ومبرّر، ومحتوم، ولازم. أنظروا إلينا اليوم: لا طنّة، ولا رنّة. لا دهشة ولا تعجّب ولا انبهار، مهما علا الاكتشاف ومهما تجرأ التجاوز. ليس مبالغاً أن نقول إن بعض ما يُنتَج راهناً لا يقل اهمية عمّا كان يُنتج يومذاك، ولكن، أي إناء يحتضن مياهنا؟ العقول والأرواح والضمائر في مكان آخر (ربما ذلك احسن، في معنى ما، رغم مأسوية ذلك "المكان الآخر" وبشاعته). ذلك أحسن، لأنه الشعر كما افضّله. يحفر بصمت ماكر ويجد طريقه، ولا يصرخ: "ها قد وجدتُ فصفقوا لي وهللوا". إنه الشعر كما أفضّله. يمشي في الدروب الجانبية، بلا بيانات ولا إشعارات ولا بلاغات ولا استعراضات. يفعل فعلته كاللص. ويمضي.
أعود لأسأل: هل كان الشعر العربي ليكون ما هو عليه اليوم، لو لم يكن ثمة "لحظة تاريخية" إسمها مجلة "شعر"؟
قدريتي ومنطقي العِلمي يحرّضانني على أن اجيب بالصراحة "الكافرة" إياها: نعم. فما "يجب" أن يحدث لا مفرّ له، ولنا، من أن يحدث. وقد كان مقدّرا للشعر العربي ان ينتقل الى هذه الضفة الأخرى، ضفّتنا، لأسباب كثيرة لا مجال لمناقشتها اليوم، لكن أبرزها اللحظة الشعرية العالمية، واحتكاك لبنان بها بسبب طبيعته المنفتحة على ثقافات الآخر. الدادائيون ثم السورياليون في فرنسا، المستقبليون في إيطاليا، جماعة 47 في المانيا، البيت نيك في الولايات المتحدة، الخ... أي أن "شعر" وتأثيراتها وروافدها هي، بكل بساطة، من مقتضيات التطوّر بحسب المنطق الدارويني البحت. ليست حداثتنا الشعرية معجزة، بل قدر. قدرٌ وواقعة عِلمية (رغم تناقض الاثنين الظاهري). القدر، والعِلم، لا مفرّ من أن يتحققا، مهما يكن منفّذهما أو معجّلهما أو ناقلهما.
إذاً، ما كان، كان سيكون، بـ"شعر" وبلا "شعر".
لكنه كان ليكون بفتنة أقلّ، ورعونة اقلّ، وأناقة اقلّ. خسارة هذا الثالوث فادحة. أليس كذلك؟
***
لن أمجّد مجلة "شعر" في ذكرى إشراقتها الخمسين، فهي في غنىً عن ذلك (في غنىً عن التمجيد).
لن اقول إنها "لحظة تاريخية ومنعطف حاسم في شعرنا العربي"، فهذه من بديهيات إرثنا الثقافي. وهي جملة باتت تجعل الكثيرين، وأنا منهم، يتثاءبون من فرط تكرارها كمانترا محفوظة عن ظهر قلب، ومُفرغة غالباً من معناها.
ولن أصفها بالمرحلة التأسيسية الجوهرية، وبالحالة الفريدة من نوعها، اذ (يكاد) لا يختلف اثنان على ذلك.
لكن (ثمة دائما لكن، وهذه الـ"لكن" غالية على قلب جماعة "شعر" أنفسهم):
خلاص اللحظات التاريخية من الجمود يكمن في ألا تظل معلّقة في مكانها، فوق، أعلى برجها العاجي. خلاصها في أن تُهدَّد، تتزحزح، تنزل قليلا، وربما تطلع بضعة سنتيمترات، ولكن في ألا تكفّ عن التململ وعن إعادة النظر في موقعها وطبيعتها وأفكارها و"إنجازاتها"... والا صارت من المحرّمات. والتابو ضد "شعر".
وضد الشعر.
***
فاتحني بعض الأصدقاء الشعراء منذ مدّة: ما رأيكِ في أن نؤسس مجلة شعرية معاً؟ كان أوّل ما فكرتُ فيه، وقلته لهم بفجاجة: لماذا؟ ما نفع المجلات، والتيارات، والأجيال؟ ما جدواها، ومعظمها ما ولد سوى ليكرّس ديكتاتورية شعرية تريد أن تقول: "هذا هو الشعر، وكل ما عداه ولا يشبهه لا مكان له على المائدة؟".
ثم تذكرتُ: أليس هذا ما فعلته (ولحسن حظّنا)، في معنى ما، مجلة "شعر"؟
ثم تذكرتُ: أليس من طبيعة الشعر أن يكون ضيّق الصدر ونافد الصبر؟
ثم تذكرتُ: ألا يقول بودلير إن للإنسان حقّين مطلقين: الحق في ان يختار ساعة موته، والحق في أن يناقض نفسه ويغيّر رأيه؟
"ما نفع المجلات الشعرية؟":
لعلي سأغيّر رأيي في أحد الأيام...
***
يقول فرسان "شعر"، في افتتاحية بعنوان "العودة"، استهلّت العدد الأول من زمن المجلة الثاني: "لا وقت لدينا لنجفّف الشِعر تحت شمس الثقافة المجرّدة. نحن لسنا مثقفين. نحن جسديون".
ونحن، يا زمرة "شعر" الجميلة، لا وقت لدينا (ولا نريد أن يكون لدينا وقت) لنحنّط الشِعر تحت كِلس النسبيات والسلالات والسلفيات.
نحن، أيها السادة، لقطاء شعرياً. لقطاؤكم، نعم، ولقطاء غيركم... ولقطاء أنفسنا. لكننا لقطاء.
"شكراً"، أسمعكم تهمسون، وتتنفسون الصعداء.
الجماليات والوحش الطائفي!
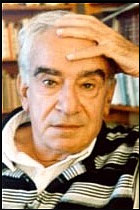 مجلّة "شعر" لا تنفصل عن المناخ الثقافي العام الذي واكبها. وكانت، من هذا المنطلق، تشكل انعكاساً للحظة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث. كانت جزءاً من تلك الحركة التي شهدتها الحياة الثقافية في لبنان على أصعدة مختلفة، أدباً وفكراً ومسرحاً وفنوناً تشكيلية ومشهدية متنوّعة. كما عكست، بصورة جليّة، انفتاح العاملين فيها على الثقافات الأخرى، وعلى التيارات الشعرية، الفرنسية والأنكلوسكسونية.
مجلّة "شعر" لا تنفصل عن المناخ الثقافي العام الذي واكبها. وكانت، من هذا المنطلق، تشكل انعكاساً للحظة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث. كانت جزءاً من تلك الحركة التي شهدتها الحياة الثقافية في لبنان على أصعدة مختلفة، أدباً وفكراً ومسرحاً وفنوناً تشكيلية ومشهدية متنوّعة. كما عكست، بصورة جليّة، انفتاح العاملين فيها على الثقافات الأخرى، وعلى التيارات الشعرية، الفرنسية والأنكلوسكسونية.
غير أنّ هذا التململ الثقافي الذي عرفه لبنان آنذاك، والذي تجرأ البعض ووصفه بالمشروع الثقافي، كان يتحرّك وسط تململ أكبر، شكّل هو الآخر مشروعاً بالفعل، لكنه مشروع انفجار كبير وطويل الأمد. وكانت أدوات هذا الانفجار ومقوّماته جاهزة في الداخل والخارج على السواء. من هنا، فإنّ الوثبة الثقافية التي تألقت نهاية الستينات ومطلع السبعينات من القرن العشرين، كانت أشبه بالرقص على شفير الهاوية.
من يراقب تلك الحقبة التي كان يعيشها لبنان، أي المرحلة السابقة للحرب الأهلية التي تداخلت فيها الحروب، يتبيّن له أنّ المنتصر الأول في بلد الأرز هو السياسة لا الثقافة. السياسة بمعناها السوقي والبذيء. لقد انتصر القتلة والمجرمون وواضعو السيارات المفخخة على الحالمين بمجتمع جديد قادر على الانفتاح على المستقبل وإيجاد موقع في العصر. انتصر مجتمع الانقسام الطائفي والارتهان للخارج، وانتصر المستنجِدون بالإله الواحد لدحر أعدائهم في البلد الواحد.
هكذا يتضح اليوم أنّ الوحش الطائفي قادر أن يبتلع كلّ شيء بما في ذلك الذاكرة الثقافية ومن ضمنها مجلّة "شعر". التاريخ هنا دائري، يقوم على التآكل المستمرّ، على غرار كاتوبليباس في الأسطورة الإغريقية، والذي لا يشبع من التهامه لنفسه.
إنّ تحويل الكائنات البشرية إلى مجرّد انتماءات عائلية، قبلية وطائفية، يجرّدهم من الشروط الأولية للمواطَنة، ويجعلهم يقيمون في مرحلة ما قبل نشؤ الدول، أي مرحلة العصبيات والغرائز التي يصعب معها التوصّل إلى أبسط القواسم المشتركة لتأسيس الأوطان.
***
إنّ الذي تراجع ويتراجع اليوم، هو الحالة الشعرية، وليس الشعر بما هو كلمات وقصيدة أو مجموعة قصائد. التراجع عام وشامل، هنا وفي كلّ مكان، ويأتي متزامناً مع تراجع مختلف الفنون الراقية التي يتطلّب تذوّقها فسحة من التأنّي والتأمل والعمق. إنه تراجع للفلسفة والميتافيزيقا والروح، بالمعنى الإنساني والجمالي، لا بالمعنى الديني. وهو أيضاً تراجع للعقل ذاته. لأنّ الفكر العقلاني لا يستقيم فعلاً إذا ما جرّدناه من تكامله مع تلك الأبعاد الأخرى، ولا يستطيع الحركة والتقدم وسط بؤرة محض مادية ونفعية.
مع تغيّر المعنى الثقافي في العالم، وغلبة منطق الاستهلاك والمردودية المادية واتساع رقعة الابتذال وتعميمه، يبدو الجمال محاصَراً. وهو حصار يضاف عندنا إلى ما تفرضه نزاعاتنا الأهلية وجهوزيتنا الدائمة للحروب. إنها محاصرة ما هو إنساني في الإنسان، وهذا ما يفتح الأبواب، أكثر فأكثر، على الرعب. لكن، وكما يقول هولدرلين: "تنمو إمكانات الإنقاذ حيث ينوجد الخطر".
ضرورة تحديث الحداثة
ثمة ثلاث مسائل في أساس الحداثة الشعرية العربية أثيرت مع تحرّك الاسئلة حول هذه الحداثة منذ أواسط القرن العرشين الفائت ولا تزال تثار حتى يومنا هذا، ما يعني اضطراد إشكالياتها، وضرورة تحديث الحداثة ذاتها بلا توقف وبلا انقطاع. هذه المسائل هي: الأولى، مسألة الصلة بالثقافة الاجنبية، الاوروبية والاميركية على وجه الخصوص، من خلال ترجمة جزء وافر من القصائد المكتوبة بالفرنسية والانكليزية، والتعريف بأصحابها. الثانية، مسألة النقد وحيويته في تبيان صلة الماضي بالحاضر (التراث والمعاصرة) وحدود العلاقة الثقافية والإبداعية مع الغرب. والثالثة، مسألة حدود المغامرة الشعرية العربية وآفاقها، من حيث كسر البلاغة القديمة والايقاع القديم. وقد دار الحوار في أقصى عنفه من خلال مصطلح "قصيدة النثر" الوافد مع مجلة "شعر" بشكل خاص.
كان لشعراء هذه المجلة من أمثال المؤسس يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وعصام محفوظ وشوقي أبي شقرا جهد مبكّر في ترجمة الشعر الفرنسي الحديث والشعر الاميركي والشعر الانكليزي من خلال أبرز ممثليهم، وإلقاء أضواء على الدادائية والمستقبلية والسوريالية.
يُذكر أنه تمّ التعريف من خلال الترجمة بكل من إميلي ديكنسون وعزرا باوند وجيمينيز في العدد الاول من المجلة، وترجمت قصيدة "مقتلة في الكاتدرائية" لـ ت. س. إليوت في عدد كانون الثاني 1958، وترجمت لوالت ويتمان خمس قصائد في عدد الصيف والخريف من عام 1958، وفي شتاء 1959 ظهرت ترجمات لكل من رولان طوماس ولوتريامون، وتوالت بعد ذلك ترجمات لكل من كوازيمودو ولويس مكنس وايف بونفوا. وترجم أنسي الحاج في عدد خريف 1960 إحدى عشرة قصيدة لأنتونان آرتو، مع دراسة عنه مدهشة، متوترة، ومنفعلة بالحالة العصبية والجسدية لآرتو بالذات. هاتان الترجمة والدراسة، مع الترجمات والدراسات الاخرى، كانت المؤسسة لترجمات ودراسات لاحقة. بمعنى أن الصلة بينابيع الحداثة الشعرية والدراسية في الغرب وأميركا، لم تنقطع بل تواصلت من خلال شعراء ومترجمين آخرين. يذكر على سبيل المثال بول شاوول، وماهر شفيق فريد (بعد جبرا ابرهيم جبرا) الخ...
لقد تمّ الكشف عن أسس اللعنة والغيبوبة والجسدية والهلوسة المرضية وعلاماتها في الشعر من خلال نماذج تحديثية مرضية مثل لوتريامون وآرتو. وهي مسألة ذات تأثير بالغ الأهمية في الثقافة الشعرية العربية الجديدة، واللبنانية منها بشكل خاص. واشار الحاج بلغة لم تعرف مثلها العربية من قبل، الى أنه رأى في آرتو تحقيقاً حسياً لنبوءة رامبو في ضرورة تشويش الحواس لتنطلق الكتابة حرّة من جوف هذياني وبركاني. كتب الحاج جملاً متأثرة بموضوعه يقول: آرتو طليعي بالمعنى اللزج. مات حياته: "لقد ظل يموت، بل كلاّ لقد ظل لا يحيا بل كلا لقد لا ظلّ...".
الحاج كما هو واضح، "آرتوي" في عباراته هذه، ويميّز بين السورياليين الذين اكتفوا بالمبهج والمدهش (الغريب) لكنهم لم يطلّوا على المهلك كما فعل آرتو. السبب عضوي. فقد كان مصاباً بالسرطان في الدماغ. قصائده لعثمات، مزق عقلية يشرشر منها الدم. أشعاره صرخات تجحظ خارج الكلمات بذاتها. والكتابة خنزرة.
بشكل أو بآخر، ترددت أصداء آرتوية في أنسي الحاج، وأحوال لدى الماغوط، وتمادت في عباس بيضون، ما يعني تمادي الحداثة وتجددها أو تحديث الحداثة البادئة مع مجلة "شعر". هؤلاء الشعراء، يظهر وكأن كلاً منهم خنيق جسده، أو كأن كلاً منهم "انتحره المجتمع"، بعبارة آرتو عن فان غوغ.
ظهرت ترجمات ايضاً لأشعار من بيار جان جوف وبريفير وبوسكيه وتزارا وساباتين وهنري ميشو، ثم في خريف 1962 ترجم أنسي الحاج 13 قصيدة لأندره بريتون وكتب مقالاً تعريفياً بزعيم السوريالية في الغرب، مشيراً الى كون الصورة السوريالية مستبدة ولا تفسيرية ولا منطقية، شاردة وصاعقة، من حيث أن الجمال يكون تشنّجاً أو لا يكون، ومن حيث أن الصورة عند بروتون "تصفع تفرقع تهين تلجأ وتبكي". هنا، حيث في السوريالية الجمال أرعن فائص عن القاعدة والكلاسيك.
ترجم شوقي ابي شقرا 28 قصيدة لبيار ريفردي مع دراسة عنه في عدد شتاء 1963. وترجم الياس عون 9 قصائد لـ ي ي كمنجز في العدد نفسه. وفي صيف 1963 قام عصام محفوظ بالتعريف ببول ايلوار من خلال ترجمة 13 قصيدة له، مشفوعة بدراسة عنه. وفي خريف 1963 ترجم يوسف الخال قصائد من والت ويتمان، وعرفت السنة الثامنة من المجلة العام 1964 قبل التوقف الاول لها، ترجمات لكل من أبولينير وعزرا باوند ولويس أراغون وميشو وأودن. احتجبت المجلة في العام 1964 وعادت في مطلع العام 1967 حيث استمرت الى خريف 1970. الترجمة الأهمّ قامت بها في العام 1986 (عدد الخريف) حيث قدمت الشاعر الاميركي ألن غينسبرغ من خلال ترجمة قصيدته المشهورة "عواء"، والملاحظات عليها. احتجاب المجلة العام 1964 كان مشفوعاً ببيان المؤسس الخال باصطدامه بجدار اللغة. ما جدار اللغة؟ وهل عادت المجلة الى الصدور بعد اختراقه؟ وهل ما زال جداراً حتى اليوم؟
جدار اللغة، تعريفاً، على حد البيان، "كونها تُكتب ولا تحكى"، وهو جدار لم تستطع الثقافة العربية اختراقه، بل تعايشت فيها ولا تزال، شعريتان واحدة للفصحى وواحدة للمحكية.
في مسيرة مجلة "شعر" ثمة محطات تاريخية وشعراء تاريخيون فيها. ترجمات أنسي الحاج ويوسف الخال وعصام محفوظ وشوقي أبي شقرا ودراساتهم جوهرية في إدخال توتّر غير مسبوق الى الشعرية العربية. هذا التوتّر لا يزال يتدافع حتى اليوم. فمن المدارس والشعريات الحديثة استمرت حساسيات جديدة متفاعلة ومتدافعة في مغامرة غير محدودة بحيث أن الحداثة تصبح فعل تحديث دائماً يحدّث الحداثة نفسها، ويدفعها الى ارتياد المجهول وتفتيح الابواب على المستقبل. فالحداثة دائماً تومئ وترسّم لما بعدها. هذا هو الاستمرار في مناخات مجلة "شعر"، تيارات وأسماء، التثاقف والنقد، الحرية والمغامرة، تحطيم الاصنام والابتهاج بالفتوح.
لا كلام على مجلّة "شعر" من دون بطريركها المؤسس يوسف الخال. مجلة "شعر" هي مجلته، بمعنى مشروع حياته. هو تلميذ شارل مالك فكرياً وفلسفياً، والشعرية الاميركية التي منها أخذ اسم مجلة "شعر"، وكان عزرا باوند كاهنها الاكبر. يوسف الخال كان متيّماً بعزرا باوند، وسرّب الى المجلة حساسياته وأشعاره. يوسف الخال كان صاحب لغة انجيلية وتوراتية وصيغ شعرية أميل الى التأثّر بالاسلوب الانجيلي منه بالاسلوب البلاغي العربي (القرآني) في الضرورة. مثله كان، وإن تغيّر الاسلوب، أنسي الحاج. شوقي أبي شقرا طلع من مكان آخر في الرعوية السحرية اللبنانية. يوسف الخال، في حضاناته ونظرياته، أكثر حسماً وفعلاً مما هو في مجمل أشعاره. أعني أن شعره على العموم لم يكن معادلاً إبداعياً وتقنياً لما حضنته مجلته من أفكار وأشعار مترجمة على وجه الخصوص. وما أدى اليه اصطدامه بجدار اللغة، هو الوصول الى لغة ثانية (بين الفصحى والعامية) كتب بها عدداً من الكتب مثل "كليلة ودمنة" (كليل ودمن) و"وصيّة كلب" وهي ذات مستوى إبداعي أدنى من أشعاره بالفصحى.
في الكلام على مجلة "شعر"، تبرز ايضاً مسألة قصيدة النثر. كان لأدونيس من هذه القصيدة موقف ثم تغيّر. فقد كتب مقالاً مسهباً في عدد ربيع 1960 عنوانه "في قصيدة النثر"، يعترف فيه (على غرار ما فعل أنسي الحاج في مقدمة "لن") باستناده في بعض آرائه فيها الى كتاب سوزان برنار عن "قصيدة النثر من بودلير الى أيامنا هذه" الصادر العام 1959، وينحاز بحماسة قوية الى هذه القصيدة فيرى أن قصيدة النثر "كائن متحرك مفاجئ حرّ... وحوار لانهائي بين هدم الاشكال وبنائها"، وأن "الايقاع الخليلي يختص بالأذن، يثير الطرب ولا يخدم الفكر"، وأن "القافية تشدّ للحشو وأن الذهنية القديمة ترى في قصيدة النثر لقيطاً مخيفاً ومخلوقاً مشوّهاً لا يمكن أن يعيش"، وهو يربط بين الحضارة وقصيدة النثر ويرى أنها خطيرة لأنها حرّة، وهو على أساسها يميّز بين شاعر وزن منسجم يقبل بقواعد السلف ويتبناها بينما شاعر النثر متمرد ورافض فهو ليس تلميذاً بل خالق وسيّد، ويحدّد لها ثلاث خصائص: البناء المغلق لتمييزها عن النثر الشعري أو الشعر المنثور، والمجانية بمعنى أنها بلا هدف في عينه لتمييزها عن الحكاية والرواية. والوحدة العضوية، والكثافة. وينهي مقالته بقوله: "لا بد للعالم العربي من الرفض الذي يهزّه، لا بد له من قصيدة النثر كتمرّد أعلى في نطاق الشكل الشعري". ملاحظتنا اليوم، بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على هذه الملاحظات، أنها بقيت في إطار نظري سواء بالنسبة الى الشاعر نفسه الذي كتب مقالات كثيرة بعد ذلك، تنصّل فيها من قصيدة النثر ومن كتابته لها في ذات يوم، أو بالنسبة الى انساق الشعرية العربية وتقنيات التعبير وإيقاعات الشعر، وموسيقاته (جمع موسيقى) كثيرة ومتشعبة وتحتاج الى دراسة تفصيلية على حدة. كل ذلك تولّد في الشعر العربي الحديث والمعاصر على امتداد نصف قرن من الزمان، جزء منه هو عمر مجلة "شعر"، وجزء آخر عمر "الآداب"، و"مواقف"، و"حوار" و"ملحق النهار"، وسواها من المجلات والملاحق الثقافية المعنية بالشعر، وهي تكشف في مجملها عن تجربة خصبة من حيث المغامرة، وتعدد الاساليب، وتعدد الايقاعات، وتنوّع اللغات والرؤى والآفاق، بحيث أن في الامكان ملاحظة اقتحامية للشعر العربي الحديث والمعاصر، سواء لجهة الحرية في اجتراح الاساليب والاشكال والرؤى، أو لجهة المؤشّر النقدي الحواري مع الأزمنة والثقافات. سواء أكانت غربية أم ذاتية تراثية، ولجهة عكس اضطراب الافراد والجماعات في رقعة بركانية لا تتشكل فيها الجزر والأطر إلا بألسنة النار.
الشعر لا يغيّر شيئاً في العالم العربي
في ستينات القرن الماضي، وكنت بعد فتىً اسكن في قريتي شبطين ولم اكن زرت بيروت بعد ولا سمعت بمجلة اسمها "شعر"، اذكر اني ذات يوم تمشيت لساعات على سطيحة بيتنا قلقاً وحائراً، وسبب القلق والحيرة اني قررت أن أمزق قصائدي العمودية وأبدأ في كتابة قصائد نثرية لا تتقيد بوزن وقافية، متوجساً من كيفية تلقّي القارىء لهذا النوع من الكتابة. فقد كنت ارى في الاوزان والقوافي ليس فقط قيودا ولكن لا وظيفة لها سوى اضفاء ايقاع موسيقي على الشعر بات ممجوجا، وان هذا الايقاع لا يضيف شيئا الى الشعر بل احيانا يسيء اليه، وانه ليس ايقاعا موسيقيا في الاساس لكنه صار كذلك بسبب ترداده وانتمائه الى الذائقة العامة.
كان هذا احد اسباب قراري حينذاك تمزيق قصائدي العمودية وكتابة قصائد نثرية. وبعد ساعات من القلق والحيرة مزقت تلك القصائد وبدأت في كتابة شعر نثري، لكن القلق ظل يلازمني الى ان نزلت الى بيروت، في اواخر الستينات، وتعرفت الى مجلة اسمها "شعر". وارجو هنا، الا يسيء القارىء فهمي ويفسّر بنيّة اخرى كلامي عن كتابتي الشعر النثري قبل تعرّفي الى مجلة "شعر". فما اقوله هو فقط للأمانة وليس للاعتداد، ولكي اقول ايضا ان اول ما فعلته بي مجلة "شعر" هو انها منحتني الثقة بالقصيدة النثرية التي كنت اكتبها، شكلياً على الاقل.
لا شك في ان لمجلة "شعر" تأثيراً لا ينحصر في الشكل وحده، ولو ان في طليعة تأثيراتها كان الشكل الشعري لقصيدة عربية قبعت قروناً في اشكال جامدة. انا ارى ان القيمة الكبرى لمجلة "شعر" هي الحالة الشعرية التي جمعت شعراءها ودعوتها الى روح شعرية جديدة. القيمة في رأيي تكمن في تلك الحالة وتلك الروح وليس في الشعر الذي تضمنته مجلة "شعر". ففي ذاك الشعر الكثير الذي لا ينتمي الى الحداثة التي دعت اليها المجلة. في ذاك الشعر الكثير من "الشكل" والقليل من "المحتوى". الكثير من القديم والقليل من الحديث. فإذا عدنا الى اعداد مجلة "شعر"، وحدنا الكثير من القصائد "جديدة" شكلاً، وقديمة في المضمون والمفهوم والرؤية الى العالم والحياة.
في المقابل، هناك بالتأكيد في مجلة "شعر" شعراء ارسوا جديداً في الشعر العربي، وهم قلة، وقلة من هذه القلة تركت تأثيرا في الاجيال التي تلتها.
اذاً، ضمت مجلة "شعر" الداعية الى الحداثة، شعراء لم يكن لهم من الحداثة الشعرية سوى شكلها وشعراء آخرون اقتحموا الحداثة شكلاً ومضموناً. هذا يعني ان "شعر" لم تكن مجلة واحدة انما مجلتين: مجلة "حديثة" ومجلة "قديمة". ويعني انها لم تكن "مجلة الشعر الحديث" كما وصفها كل من كتب عنها، انما كانت "مجلة شعراء" بعضهم حديثون وبعضهم "قدامى".
هكذا اقرأ مجلة "شعر" اليوم، بعد خمسين عاما على صدور العدد الاول منها. وأمام هذه القراءة لا اظن اني "وارثها" كما يشير سؤال هذا الملف. هذا لا يعني بالتأكيد ان اي شاعر ليست فيه نسمة روح من شعر قرأه، لكن نسمة الروح هذه لا تعني انه احد ورثته. الشعراء هم ابناء كل الذين قرأوا لهم، لكنهم في النهاية ليسوا سوى ابناء انفسهم.
ما فعلته مجلة "شعر" هو انها حطمت صنم الفراهيدي في الشعر العربي ودعت الى روح جديدة، ومن نقيض دعوتها أن نحوّلها نحن الى صنم ايضا. مجلة "شعر" دعت الى التجاوز (بغض النظر عن المدى الذي تجاوزته هي)، وقد تجاوزها اليوم في العالم العربي شعراء، وهذا يجب ان يكون مدعاة فخر لشعرائها بهم لا مدعاة تجاهل وانكار، لأن تجاوزهم يعني صدق دعوتهم، أما إنكار هذا التجاوز فيعني أن دعوتهم كانت كذلك "شكلاً شعرياً".
بالنسبة الى المواقف من مجلة "شعر"، بأن "قصيدة النثر" مثلاً ليست شعراً، فهذه تجب إحالتها على صنم الفراهيدي، والى الناكرين على الحياة حقها في التقدم، والى الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الشعر ويدّعون أنهم أصحاب "المراعي".
أما اتهام مجلة "شعر" بأنها كانت عميلة الـ"سي. آي. إيه" وغايتها تخريب الثقافة العربية، فهذا شبيه بكل اتهامات العرب لـ"المؤامرات" الخارجية عليهم، ويكونون هم المتآمرون على أنفسهم!
ربما خلاصة كل هذه الاتهامات، لمجلة "شعر" أو لغيرها، أنها تفضح المثقفين العرب، الذين تغاضوا عن المتآمرين الحقيقيين عليهم وعلى العرب، أو دافعوا عنهم، واتهموا الادباء العرب بما اقترفه سواهم.
بعد هذا، هل يجوز السؤال عن مدى تأثير مجلة "شعر"، أو الشعر عموماً، في العقلية العربية أو في الثقافة العربية؟
فبعد خمسين عاماً لا تزال الثقافة العربية تتهم مجلة "شعر" بالعمالة، وتنكر أن قصيدة النثر شعر، وتقبع تحت صنم الفراهيدي وتحت عباءة الخميني وعباءات كل الاصوليات والظلاميات. فكيف يمكن أن نقول، إذاً، إن الخمسين عاماً قد غيّرها الشعر في شيء؟
العالم العربي بطيء التغيّر، أو مستحيله. والشعر آخر ما يغيّره. العقلية العربية مجمّدة منذ قرون: لا نقد، لا فلسفة، لا نقض لـ"ثوابت"، لا تأويل، لا قبول بحركة، فكيف يمكن أن يتغيّر هذا العقل إذاً؟
هل نكون سذّجاً ونقول إن مجلة غيّرت هذا العقل؟ لا. الشعر لا يغيّر شيئاً في العالم العربي. ما جُمّد قروناً لا يغيّره نصف قرن. مجلة "شعر" لم تغيّر شيئاً في الذهنية العربية. الشعر لا يغيّر فرداً، فكيف يغيّر مجتمعات؟ هو بالكاد يغيّر لحظة من حياة كاتبه، هي لحظة الكتابة. أما أن ندّعي أن أيّ شعر، أو أيّ مجلة شعرية، غيّرت في عقلية مجتمع بكامله، فهذا مجرد ادّعاء، لا سيما في المجتمع العربي.
قراءة في العدد الأول
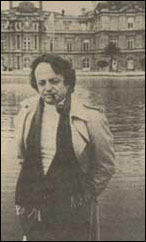 قد لا يكون العدد الاول من مجلة "شعر" الصادر في الشهر الاول من العام 1957 قادراً بمفرده على تقديم صورة شاملة ووافية عن المفاهيم والقيم الجمالية والنقدية التي حملتها المجلة على امتداد أعوام عدة، لكني وجدت فيه الكثير من الارهاصات الابداعية والفكرية التي ساهمت في رفد الحياة الثقافية اللبنانية والعربية بأسباب التطور والتجدد والتغيير. ولما كان الوقت المتاح لتقديم هذه المداخلة هو من الضيق بما لا يتسع لتقديم قراءة وافية ومعمقة لمجلدات المجلة الاحد عشر، فقد وجدت في الوقوف عند العدد الاول بنصوصه الشعرية والنقدية ما يلقي الضوء على المشروع برمته وما يتيح للقارئ أن يصوّب النظرة المسبقة التي كوّنها البعض عن المجلة في وصفها امتداداً لمفاهيم الحداثة والشعر الغربيين من جهة، وفي وصفها منبراً للتبشير بقصيدة النثر من جهة أخرى.
قد لا يكون العدد الاول من مجلة "شعر" الصادر في الشهر الاول من العام 1957 قادراً بمفرده على تقديم صورة شاملة ووافية عن المفاهيم والقيم الجمالية والنقدية التي حملتها المجلة على امتداد أعوام عدة، لكني وجدت فيه الكثير من الارهاصات الابداعية والفكرية التي ساهمت في رفد الحياة الثقافية اللبنانية والعربية بأسباب التطور والتجدد والتغيير. ولما كان الوقت المتاح لتقديم هذه المداخلة هو من الضيق بما لا يتسع لتقديم قراءة وافية ومعمقة لمجلدات المجلة الاحد عشر، فقد وجدت في الوقوف عند العدد الاول بنصوصه الشعرية والنقدية ما يلقي الضوء على المشروع برمته وما يتيح للقارئ أن يصوّب النظرة المسبقة التي كوّنها البعض عن المجلة في وصفها امتداداً لمفاهيم الحداثة والشعر الغربيين من جهة، وفي وصفها منبراً للتبشير بقصيدة النثر من جهة أخرى.
لا يختلف اثنان على الأرجح حول الدور المهم والفاعل الذي لعبته المجلة التي تنادى الى تأسيسها كل من يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وفؤاد رفقة وشوقي أبي شقرا وغيرهم في دفع الحداثة العربية خطوات كثيرة الى الأمام وفي النأي بالشعر عن الوظائف والمهمات التي حاول البعض جرّه اليها، كمهمات الخطابة والتحريض والتبشير السياسي والايديولوجي.
كما يجب أن لا نغفل في هذا الاطار تأثر القيّمين على المجلة بالرياح الوافدة من الغرب والمحمّلة دعوة الى الحرية والى تحرير الشعر من القيود المفروضة عليه من الداخل أو الخارج، لكن ذلك لم يدفع شعراء المجلة وكتّابها للتحول الى "جالية" ثقافية غربية تتخذ من بيروت رأس حربة للانقضاض على التراث العربي. وهذا شأن يدحضه العدد الاول من المجلة، والاعداد الكثيرة الاخرى، ويكشف عن بهتانه والمبالغة في تعظيم شأنه، على ما سيتضح من خلال قصائد العدد وأسماء الشعراء المشاركين فيه. واذا كان العدد يتضمن بعض النصوص الغربية المترجمة الى العربية، فإن ذلك لا يضير المجلة في شيء بل هو يأتي في صالحها تماماً لأن هذه الترجمات أسست للترجمات اللاحقة التي تلتها ومكّنت الكتّاب والمثقفين العرب من التفاعل مع ثقافات العالم الاخرى والخروج من العزلة والجمود والتقوقع في اتجاه الفضاء الانساني الرحب. فالشعراء الصغار والمنتحلو الصفة، وحدهم هم الذين يمكن الترجمة أن تفسدهم أو تشجعهم على النقل والانتحال، أما الكبار منهم فيهضمون ببراعة كل ما يفدهم من الخارج ويحولونه الى مادة فريدة ومختلفة.
إن استعراضاً سريعاً للمواد المنشورة في عدد "شعر" الاول يجعلنا نلاحظ غلبة النصوص الشعرية العربية على مثيلتها المترجمة عن الاجنبية. نلاحظ في الوقت نفسه طغياناً للجانب الشعري على الجانب النقدي الذي اقتصر على نص تمهيدي شاءت أسرة التحرير أن يكون لأرشيبولد مكليش الذي رأى المؤسسون في نظرته الى الشعر ما يتوافق مع آرائهم وتصوراتهم. ولأن الآراء النقدية التي اختيرت من نص مكليش وآخرين تعكس الى حد بعيد رؤية مؤسسي المجلة الى الشعر، فقد آثرتُ الكشف عن بعض هذه الاراء المبثوثة بين ثنايا العدد قبل أن أعرض للقصائد المنشورة، مبيّناً مدى انسجامها أو تعارضها مع المفاهيم النظرية المطروحة.
ان أبرز ما جاء في نص مكليش التمهيدي اعتباره ان الشعر "هو الاداة الوحيدة التي يستطيع بها الانسان كفرد، ككائن وحيد واثق ومضطر الى الوثوق بما يجابهه هو بنفسه، ان يدرك اختباره فيعرف نفسه. كما ان صلب الازمة المتغيرة انما هو مشكلة الكائن الانساني الفرد في عالم يزداد تقولباً". لعل هذا المفهوم للشعر يقع بدوره في قلب التوجه الذي نادت به المجلة في اعتبارها الشعر مسألة فردية وجودية لا مسألة تفرضها الجماعة وتحدد معاييرها، كما في أدبيات الواقعية الاشتراكية. "فما لم تكن مدركات الانسان خاصة به ومتصلة باختباره للحياة فلن يستطيع أن تكون له حياة الا عن طريق سواه. انه لا يملك نفسه بل لا نفس له"، يقول مكليش الذي لا يرى في الشعر السياسي أي فائدة تذكر، معتقداً ان الشاعر الحقيقي يلامس الحياة بواسطة الفن نفسه لا بواسطة الشعارات العابرة.
ليس بعيداً من هذه الرؤية، يذهب رينه حبشي في مقالته "الشعر في معركة الوجود" الى أن كل شعر حقيقي هو شعر ملتزم في الضرورة. لكنه ملتزم المعرفة والكشف عما وراء الظاهر والمحسوس. والشاعر عنده هو "مكتشف الوحدة، جامع القارات وسفير وطن في غيهب النسيان". أما السياسة فهي وليدة يأس الشعر لأنها تحول العلاقة بين الشاعر والجمهور الى علاقة تسويقية زبائنية. وفي باب نقد الشعر يرى بيار روبان في قراءته شعر جورج شحاده ومسرحه، ان هذا الاخير يجعلنا نبحث معه عن الوطن الضائع تارة ونستسلم تارة أخرى لدوخة العدم. كما انه يشكّل جسراً للتواصل بين الغرب الذي تحس فيه جوهر الكشف الشعري والشرق الذي تربطه به تعاويذ السحر القائمة. وبقدر ما يتعاطف روبان مع تجربة شحاده، فإن انطون غطاس كرم يذهب الى الخانة المضادة في مقاربته مجموعة نزار قباني، "قصائد"، التي يرى فيها نموذجاً لشعرية المراهقة والتطلع الى اللذة الجنسية الغرائزية. وهي بحسب كرم "لذة البدوي امام وليمة الحضارة وليست اللذة البودليرية الاريستوقراطية الرفاه". وهو اذ يأخذ على الشاعر سعيه الملحّ الى جعل الشعر جماهيرياً وشعبياً، بما ينسجم ايضاً مع رؤية القيّمين على المجلة، يرى في استخدام قباني المفردات الشعبية والاجنبية كالبنطال والصندل والشال والدانتيل شأناً "غير مستطاب"، وهو ما يحتاج الى الكثير من المناقشة لأنه يتعارض مع سعي الحداثة الشعرية الى كسر اللغة القاموسية الباردة وملامسة المعيش واليومي واللصيق بالحياة.
على أن متفحص النصوص الشعرية التي نشرتها المجلة في عددها الاول لا بد ان يستوقفه التباين الواضح بين التنظيرات النقدية التي تبدو جذرية في دعوتها الى الحداثة والمغامرة والتجديد، وتلك النصوص المتغايرة والموزعة بين المدارس والاساليب والمفاهيم. فنحن نقرأ قصيدتين على النمط العمودي الخليلي، أولاهما لبدوي الجبل بعنوان "اللهب القدسي"، والاخرى لرفيق المعلوف بعنوان "وحي البواكير"، كما نقرأ العديد من قصائد الشعر الحر أو قصائد التفعيلة لكل من سعدي يوسف ونازك الملائكة وفدوى طوقان ونذير العظمة وفؤاد رفقة وموسى النقدي ويوسف الخال، وهي قصائد متفاوتة الاهمية من حيث العمق واللغة والابتكار الاسلوبي. لكن ما يلاحظ في هذا المجال أن بعض الشعراء المعروفين بالتصاقهم بقضايا الوطن والالتزام السياسي والنضالي تحاشوا نشر قصائدهم السياسية في المجلة واختاروا بدلاً منها قصائد الحب والشغف والتأمل الرومنطيقي تماشياً على الارجح مع "سياسة" المجلة نفسها، في حين أن هؤلاء كانوا ينشرون في مجلة "الآداب"، وفي الفترة ذاتها، قصائد أخرى مهمومة بالقضايا الوطنية والقومية. في العدد ذاته نقرأ قصيدة باللغة المحكية اللبنانية لميشال طراد، كما نقرأ مسرحية شعرية بأربعة مشاهد لأدونيس، وهي تصوّر عالم جندي خارج من الحرب وقد تشوّه واصيب بخلل عقلي. نقرأ ايضاً قصيدة ضعيفة لبشر فارس يحاول من خلالها أن يخلط بين بحرَي البسيط والرمل بشكل مفتعل ومتعسف. لكن ما يثير الدهشة هو سماح هيئة التحرير بنشر قصيدة غاية في الرداءة لألبر اديب يغيب فيها الوزن وتحضر القافية التي تحوّل النص الى وجه من وجوه السجع وتجعله مشابهاً لما يكتبه المبتدئون وطلبة المدارس.
واذا كانت بعض النصوص الشعرية العربية المنشورة في عدد "شعر" الاول لا تمثل طموح المجلة الهادف الى تغيير الحساسية الشعرية السائدة، فان النقطة الايجابية التي تُحسب للمجلة في المقابل هي اعتناقها الحرية وجعل صفحاتها منبرا للاختلاف والتنوع وتعدد الاساليب وعدم الغرق في العصبوية والحزبية والرأي الواحد. اما القصائد المترجمة فهي للاسباني خوان رامون خيمينيز الحائز جائزة نوبل، والذي "وقف شعره على النخبة غير مبالٍ بتصفيق الجمهور"، وللأميركي عزرا باوند الثائر ضد الرومنطيقية والداعي الى تحرير الشعر من الاوزان والمفاهيم القديمة والذي حوكم في بلده بتهمة التآمر مع الفاشية وأطلق بحجة الجنون، وللأميركية اميلي ديكنسون التي وقعت في غرام كاهن متزوج. وقد يكون اختيار الشعراء الغربيين في غالبيتهم الانكلوسكسونية وبغرابة تجاربهم وسيرهم الشخصية، أقرب الى روح المجلة وأهدافها من نظرائهم العرب.
قد لا يكون العدد الأول من مجلة "شعر" كافياً للحكم على المجلة او لتكوين صورة وافية عن كتّابها المميزين الذين انضموا اليها في اعدادها اللاحقة، ومع ذلك، ورغم بعض الشوائب والهنات التي اعترت ذلك العدد، فإنه يحمل الكثير من عناصر الجدة والتنوع والانتصار للشعر والحرية. واذا كانت السنونوة لا تختزل الربيع برمته فإن لها فضل التبشير به على الاقل.
إبنة المكان
قرأت "شعر" متأخراً نسبياً. حين صدرت اعدادها الاولى كنت لا ازال صغيراً لم اتجاوز العاشرة او الحادية عشرة. وكنت اعيش في مراهقتي ضمن جو يتصل بالقصيدة الرومنسية الموزونة العمودية وقد نشرت قصيدتين في "الحكمة" عندما كنت لا ازال في الرابعة عشرة. ولم تكن "شعر" هي المجلة الوحيدة يومذاك، كان ثمة مجلات "الحكمة" و"الأديب" و"الآداب" ومجلة "الشعر" المصرية على ما اذكر. تعرفت الى شعراء مجلة "شعر" اكثر مما تعرفت الى المجلة نفسها. وكان لديَّ وهم ان مجلة "شعر" في اعدادها الاولى كانت موئلاً للثوار في اللغة وقصيدة النثر والجنون والتمرد، لكني ما ان عدت إلى اعدادها الأولى حتى اكتشفت انه لم يكن لمجلة "شعر" اي ملامح هوية في بداياتها، حتى انها كانت تنشر كل ما كان، ومن كان، سائداً في تلك المرحلة، من نزار قباني إلى جورج صيدح إلى بدر شاكر السياب. ولم يتضمن عدداها الأولان قصائد نثر إلا لابرهيم شكور. هذا يعني ان قصيدة النثر سبقت "شعر"، مع توفيق صايغ في الاربعينات.
اظن ان تصنيف قصيدة النثر الذي اعتمد بناء على نظرية سوزان برنار مثّل خطأ فادحاً وقعت فيه انا نفسي عندما طبعتُ رسالتي الجامعية عن قصيدة النثر العربية استناداً الى "لن"، واعتمدت فيها شروط سوزان برنار وقوانينها، وتلك شروط لا علاقة لها بقصيدة النثر، إذ ان شروط برنار مستنبطة من مئة عام من الشعر الفرنسي، وجاءت نظريتها بعد النصوص ولم تسبقها في طبيعة الحال. انها شروط مقيدة إلى الشعر الفرنسي. ادونيس وانسي الحاج اخذا شروط سوزان برنار بحذافيرها مترجمة وجعلاها معياراً لقصيدة النثر قبل ان تكون القصيدة، مما حوّل هذه القواعد والشروط إلى ما يشبه اوزاناً خليلية جديدة. من جهتي انا، اعتقد ان جبران خليل جبران كتب قصيدة نثر، وكذا امين الريحاني وابو حيان التوحيدي والنفّري والمحاسدي، وما عدت أومن اليوم ان هنالك فارقاً بين النثر الشعري وقصيدة النثر، ذلك لأني اعتقد اننا تجاوزنا زمن القصيدة، ودخلنا في زمن ما بعد القصيدة وما بعد الشعر بحسب النظرة المفاهيمية السائدة. ذلك لاني اعتبر ان الشعر اليوم غير موجود اصلاً. ليس هناك شيء اسمه الجوهر الشعري، وهذا الجوهر، كما اظن، تحدر إلينا من الارث الديني، فنحن نتكلم عن الجوهر الديني كما لو اننا نتكلم عن الجوهر الالهي، ذلك ان الشعر انما يأتي بعد النص وليس قبله. واظن ان تصنيف الشعر والنثر مسألة يعود إلى القارئ الحق في تقريرها وليس إلى الكاتب. وهذه حال سائدة ومعروفة، لكن سيادتها وشيوعها لا تقلل من عظمتها. هناك جمهور واسع لا يزال يعتبر ان قصيدة النثر ليست شعراً وهناك من يقول هذا اشعر الشعراء، وذاك شاعر والآخر ليس بشاعر، وهذا شعر وذاك ليس شعراً. والحال، كل فرد يملك مفاهيمه المتحولة والمتغيرة للشعر، مما يعني ان الجوهر الثابت والقبلي للشعر غير موجود إلا في مخيلتنا. انه بدعة ان نقول هذا شعر بالمعنى القديم، ولهذا اقول ان الريحاني هو كاتب قصيدة نثر. إذ لو قررنا اعتماد مقاييس سوزان برنار وتطبيقها على قصيدة النثر، فإن انسي الحاج او شوقي أبي شقرا او انا، لا نستطيع ان ننجح في امتحانها.
مجلة "شعر" لم تبدأ بالشعر النثري بل اعتمدت الشعر السائد وصدرت في بداياتها من دون هوية شعرية، فتجاور الشعر العمودي على صفحاتها مع التفعيلة، وجمعت شعراء من اتجاهات مختلفة، من فدوى طوقان إلى نازك الملائكة. كانت بلا هوية ولم تكن تختلف كثيراً عن "الاديب" و"الاداب" في هذا الشأن. كان ثمة اختلاف في زاوية النظر السياسية ربما، وليس في النصوص. فما كان ينشر في "الاداب" كان ينشر في "شعر". لهذا اعتقد ان اهم ما نشرته تلك المجلة في بداياتها كان الترجمات، الانغلوساكسونية والفرنسية. كما اني لا اظن انها ارتبطت في شكل مباشر بالهوية اللبنانية بل معظم مؤسسيها، من يوسف الخال إلى ادونيس ومحمد الماغوط وفؤاد رفقة، كانوا غير لبنانيين، وبعضهم كان ينتمي عقائدياً وسياسياً إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. كانت مجلة "شعر" تموزية وتتصل بالانبعاث، وإلى حد ما اليوتية مع يوسف الخال الاليوتي. ربما في المراحل اللاحقة حملت نزعة لبنانوية ما، انما ليس بالمعنى الضيق للبنانوية. كانت على عكس ما يشاع مجلة ذات هوية عربية وعالمية. سعيد عقل، وهو ابرز دعاة اللبنانوية لم ينشر في "شعر" مثلاً، لكن جورج غانم نشر. معظم الكتّاب في العددين الاول والثاني كانوا عرباً، وهيئة تحريرها تألفت من سوريين ولبنانيين. لكن هؤلاء سوريون تبيرتوا بالمعنى اللبناني في تلك المرحلة، اي بمعنى تحت سقف لبنان الحرية والديموقراطية. والحق ان "شعر" كانت بلا هوية ثم اكتسبت هوية الحرية. الكتابات المتمردة جاءت في اعدادها اللاحقة مع الماغوط وجبرا ابرهيم جبرا وانسي الحاج. قصائد النثر الاساسية في اعدادها الاولى كانت تلك المترجمة. وانا لم اتأثر فيها شخصياً لأني في تلك المرحلة من سنوات الستينات، حين كنت اعيش لحظة تفتحي الثقافي، كانت "شعر" لا تزال محافظة، ولا تختلف في رأيي كثيراً عن "الآداب". في تلك الفترة من الزمن كنت قد بدأت اتصل بالشعر الفرنسي لكني احببت كتابات السياب وانسي الحاج والبياتي من دون ان يكون لديَّ خيارات محددة. فتلك المرحلة كانت تتنازع فيها تيارات ضاربة، من رمزية مع سعيد عقل إلى التفعيلة فالشعر غير المؤدلج أي الشعر الذي كتبه الماغوط وانسي الحاج وشوقي ابي شقرا. واقع الحال ان "شعر" حملت كل تناقضات الشعر العربي واتجاهاته ولم تحسم في خيار او اتجاه. خلاصة القول، لم يكن عند مجلة "شعر" تيار نتأثر به او مذهب او مدرسة. كان هناك نصوص مغايرة ونصوص اخرى محافظة واخرى مخضرمة وقديمة بأقلام كجورج صيدح وبدوي الجبل، وكانت علاقتي بـ "شعر" لا تختلف عن علاقتي بـ"الاداب" و"حوار" و"الاديب"، كلها كانت متشابهة، بل ان "الاديب" كانت اكثر تطرفاً في الحداثة الشعرية من حيث النصوص التي نشرتها. اظن ان بعض الشعراء الذين كتبوا في مجلة "شعر" هم من قدّم عنها هذه الصورة الثورية وهي لم تكن يوماً كذلك. ولا اظن ان يوسف الخال شاعر ثوري، ولا ادونيس في تلك المرحلة، ولا شوقي ابي شقرا الذي كان يكتب شعراً موزوناً. اكثر ما تأثرت به في ذلك الزمن هو الترجمات وكانت مهمة جداً وقد شارك فيها الجميع من ادونيس إلى انسي الحاج إلى شوقي ابي شقرا.
اسست "شعر" تيارها بالنصوص وليس باتجاهها العام. نصوص الماغوط وانسي الحاج وشوقي ابي شقرا وجبرا ابرهيم جبرا اسست حساسية جديدة، ويعود الفضل إلى تلك النصوص في هذه التجربة وليس إلى السند النظري لقصيدة النثر العربية التي لم تكن موجودة كتراكم بعد. تلك النصوص اشاعت جو الحرية والتمرد وكانت الموقع النقيض لـ"الآداب". هذه النزعة إلى الحرية وما بعد الاوزان والكتابة خارج القيم الاجتماعية السائدة هي التي اعطت "شعر" وهجها، لكن اعود واكرر ان هذا لمسناه عند بعض الشعراء وليس في هوية مجلة "شعر" التي كما كتب في مقدمة عددها الأول: لا تنتمي إلى اي مذهب فني.
سطعت "شعر" بسطوع بيروت وتأسطرت مع اسطورتها. بيروت في تلك المرحلة كانت مدينة جنون الحرية والثورات والتمرد، وقد تلازم صعود "شعر" مع صعود بيروت كمنارة للحرية والديموقراطية، تماماً كما صعدت "الآداب" مع موجة اليسارية العربية والقومية. "الآداب" ابنة المرحلة و"شعر" ابنة المكان. ومن المكان الذي كانته بيروت في ذلك الزمن، اخذت وهجها مثلما اخذ منها المكان بعض صيته. "الآداب" كانت ابنة الايديولوجيا اما "شعر" فكانت ابنة مناخ المكان البيروتي. واحسب انها لو صدرت في عاصمة اخرى لما تمكنت من تحقيق هذا الوهج. في هذا المعنى هي تدين لبيروت اولاً وآخراً. الدليل على ذلك انها جمعت كل المنفيين من العالم العربي. كانت مجلة المنفيين والهامشيين واللامنتمين اللبنانيين والعرب، الذين وجدوا انفسهم في حضرة فضاء بيروت الحر. لهذا اقول ان اهمية "شعر" ليست في بداياتها بل في سياقها. في ذلك الزمن كانت قد بدأت الانقلابات العربية والشعر الملتزم والثوري والقومية العربية. و"شعر" تأسست على ايدي ملتزمين حوّلهم المكان إلى متحررين من التزاماتهم. كانت التعببير الحي عن المجتمع المدني في بيروت ازاء عسكرة المجتمعات العربية، والثقافات المدنية ازاء الثقافات المعسكرة. وكانت تنتمي إلى هوامش المجتمع المدني. ولا ننسى ان مجلة "شعر" كانت تشبه المجتمع والواقع وهي تحاول جاهدة الخروج إلى افق جديد، مثلما كان المجتمع اللبناني يحاول الخروج من التقاليد القبلية. وليس صدفة ان يتزامن صعود "شعر" مع صعود الحركات النقابية والسياسية. كانت "شعر" تشبه المجتمع المدني وتقاوم الانظمة العربية المعسكرة يومذاك. لم تخرج من العدم. لقد خرجت من رحم المكان.
ملحق النهار الثقافي
11 شباط 2007
عصــــــر البــــــراءة
 قبل أن نسأل عما بقي من مجلة «شعر» يجدر بنا ان نعرف ماذا وجد فيها. كثيرون يتكلمون بغموض عن «روح شعر» محتفظين بها سراً ما زالوا قائمين عليه، هذه كهانة لا تختص بـ«شعر» وليسوا قليلين أولئك الذين يلمحون الى ان علمها في صدورهم. لا نعرف بيانا خاصا بـ«شعر»، ان هي إلا إشارات متفرقة ومتباينة احيانا عديدة، اذ تخطينا تلك الدعوة الى تجديد بلا حدود وتجريب حر، وهي دعوة ثمينة، لا نعود نجد شيئا آخر بهذه الصراحة والوضوح، نجد بالعكس تلاوين مختلفة، هناك استطرادات بـ«النهضة» الشعر فيها «فكر أو فلسفة» الأمة وروحها، وهو على ذلك نص ثقافي وتاريخي، بل هو بناء لأسطورتها التأسيسية أو تجديد لأسطورتها التأسيسية. استطرادات للنهضة فيها ذلك النقد لزخرفية الثقافة العربية وشكلانيتها وضعفها الفلسفي. الشعر في الاستطرادات نفسها هو تعالي الاصل والنواة على غوغاء الحاضر ولغطه الجماهيري وخطابيته وسوقيته، انه الأسطورة الواحدة الموحدة مقابل تشعث اللحظة الجماهيرية وخليطها. في الاسطورة ذاتها يغدو الشاعر هو الموقظ والمحيي وحافظ الأسرار وحامل اللوح.
قبل أن نسأل عما بقي من مجلة «شعر» يجدر بنا ان نعرف ماذا وجد فيها. كثيرون يتكلمون بغموض عن «روح شعر» محتفظين بها سراً ما زالوا قائمين عليه، هذه كهانة لا تختص بـ«شعر» وليسوا قليلين أولئك الذين يلمحون الى ان علمها في صدورهم. لا نعرف بيانا خاصا بـ«شعر»، ان هي إلا إشارات متفرقة ومتباينة احيانا عديدة، اذ تخطينا تلك الدعوة الى تجديد بلا حدود وتجريب حر، وهي دعوة ثمينة، لا نعود نجد شيئا آخر بهذه الصراحة والوضوح، نجد بالعكس تلاوين مختلفة، هناك استطرادات بـ«النهضة» الشعر فيها «فكر أو فلسفة» الأمة وروحها، وهو على ذلك نص ثقافي وتاريخي، بل هو بناء لأسطورتها التأسيسية أو تجديد لأسطورتها التأسيسية. استطرادات للنهضة فيها ذلك النقد لزخرفية الثقافة العربية وشكلانيتها وضعفها الفلسفي. الشعر في الاستطرادات نفسها هو تعالي الاصل والنواة على غوغاء الحاضر ولغطه الجماهيري وخطابيته وسوقيته، انه الأسطورة الواحدة الموحدة مقابل تشعث اللحظة الجماهيرية وخليطها. في الاسطورة ذاتها يغدو الشاعر هو الموقظ والمحيي وحافظ الأسرار وحامل اللوح.
من استطرادات النهضة دفع «التغريب» الى الاقصى. نمحو الحدود فنغدو جزءا من غرب شعري ويغدو الشعر عملا كونيا نلتحق فيه بكوكبة عالمية من سارقي النار وعشيرة الحداثة الشعرية التي يتقدمها رامبو ولوتريامون. الشعر عندها، لا عبرة فيه بالطبع للخصوصيات والحواجز الثقافية والبيئات اللغوية. في المسيرة ينتظم جنس آخر ويتحول الشعر بطاقة وهوية ووطنا ومكانا.
ما زلنا هنا في الماكرو، في الشعر بوصفه «كونا» خاصا، هنا تتوتر نرجسية الشعر ونرجسية الشاعر ويغدو الشعر نهاية ذاته وأفقها وشمسها. تتعدد الاسقاطات فالشعر طوبى كاملة والشعراء عرق خاص، الشعر من ناحية اخرى فن الفنون والبديل الثقافي الكامل، الشعر هو أم الكتاب وبديل اللغة والتاريخ، الشعر وحده وبذاته الثورة والرؤيا والزمن والمستقبل. انه أقنوم مفارق وكون بديل. هنا بالطبع يصل تمجيد الشعر الى درجة هذيانية، ويكلم الشعر نفسه بلغة بلا مادة وبلا موضوع سوى تكرير سموّه وتفوقه وكماله. في تألهه لا يني الشعر يحطم ويخلق ويبتكر، انها سكرة الخلق، النفي من عل، الولادة من غير أب، النقض كلعبة كونية، الثورة والبناء هنا كتواتر العدم والوجود، خراب بلا سابق وولادة بلا سابق والشاعر قطب وإمام وشريك لله.
هناك ايضا الميكرو. يتحول الكون الخاص الى زنزانة داخلية، الى عزلة في الجسد والنفس، ويصاعد الشعر كمونولوغ متشنج لاعن محصور أحيانا أو متقطع أو لاهث أو نابح. يصاعد عواء وغضبا ودمدمة لكنه مع ذلك ليس بلا بيان، وليس بلا مؤلف، ثمة بيان تدميري إعدامي، لكنه قتل داخل النفس وإعدام داخل النفس، فمن داخل النفي الكامل والعزلة يتم تدمير العالم داخل النفس ويبني المعزول الفريد أسطورته التدميرية، انه ايضا مشروع كبير على الشعر ولا يتهيأ له إلا بوهم كبير عن نفسه وعن قوته وحدوده، هنا ايضا يبدو الخلق الشيطاني مقابل الخلق الالهي وهنا يملك الشاعر جبروت التخريب والقدرة على إعادة بناء العالم أو تحويله رمادا. لنقل انها بطولة مضادة ونرجسية مقلوبة.
في الحالين لا ينفصل الشعر عن مشروع كوني. انه بالطبع فكر ومعنى ومعاناة كما يقال. لكن إشارات اخرى تقودنا الى سبيل آخر. فإذا كان «المعنى» هو في مكان آخر وفي ذلك الزمن الديماغوجي، واذا لم يكن الشعر دائما مصدر المعاني، فإن استقلال الشعر وتسيده على حيزه وفضائه ورسمه ومعانيه، من أسس دعوة «شعر». الشعر طلاق من المعاني السائدة ومعناه له وحده، وهو في الغالب المعنى الضدي، إلا ان ذلك يوقعنا ثانية في محنة المعنى، ويقودنا الى منحى آخر، فالمعنى في الشعر التماس وتهيؤ وهم بالمعنى لا تصريح به ومن الممكن هنا الكلام عما تحت المعنى وعما قبل المعنى. فالمعاني الناجزة التامة تخرج عن نطاق الشعر، المعاني الشعرية في ضمير الايقاع والشكل، انها محتملة فيه كامنة مندغمة بحيث لا يمكن عزلها. هنا جاز للبعض في «شعر» إنكار المعاني اصلا بل والحذر من شعر المعاني أساسا، واعتبار المعنى مغامرة بالشعر وتعدياً عليه. إنها إشارات متباينة كما ترون، فالشعر في واحدة منها فكر وبديل ثقافي وبيان ثوري أي انه يتوسل الشعر ويتعداه الى مشروع أوسع. لكنه في اشارة اخرى محبوس داخل تقنيته ولعبته الصغيرة في الصورة والايقاع، إشارات متباينة. فالشعر ثورة ونقض وتدمير وتخريب وتفجير لكن ذلك محصور فيه، وكل هذه القوة تنبع على نحو سحري منه، وتصب داخله. اذ لا تمنعه هذه الثورة من ان يداري أنفته من الخارج ومن الواقع ومن السياسة. انها ثورة الشعر في الشعر، وانحصارها فيه جعلها ثورة زخرفية، لقد بدا غضبها مجانيا واصطلاحيا. كانت مديحا للرفض والتخريب والتفجير، يكاد يتحول الى كليشيهات والى لفظية صاخبة. تبرؤها من الاثم السياسي بوجه خاص جعلها ساذجة وطنانة وبلا فحوى، ولم تبد متلائمة مع تمري الشعر لنفسه أو تعاليه الطوباوي أو غرقه في مونولوغ داخلي.
إشارات متباينة، فهناك من يرى الشعر نوعا آخر من الفلسفة وهناك من يقصره على لعبة تغريب لفظي، وهناك من يراه الرافعة الوحيدة للنهضة والبديل الوحيد للثقافة والتاريخ والواقع الوحيد الباقي لنا والثورة الوحيدة، فيوضع الشعر لذلك موضعا لاهوتيا «في البدء كان الشعر» ويغدو بديلا عن الواقع برمته. انه سحر بالطبع لكنه ايضا حلم إيجاد حداثة بالشعر وبالشعر وحده، وحلم انخراط عالمي بالشعر وحده، وحلم تغيير بالشعر وحده، كان لا بد لذلك من ان يجعل الشعر نوعا من ايديولوجيا المستقبل، وان يغدو بيانا عاما، وان يتعدى نفسه، وأن يتخذ من حيث لا يدري سيماء تبشيرية ودعوية، وان لا يبرأ من طفاوات ايديولوجية.
إشارات متباينة، فالشعر في مفهوم هو اللغة الكاملة، التي هي ايضا، في التداعي القرآني، سابقة على التاريخ والواقع. لغة لاهوتية الى حد، انها أسطورتنا الجامعة والأساس وأصلنا الاول، والشعر يعيد إنتاج أوليتها وإنتاجها كأصل وكتأسيس مستمر وتاريخ متعال لا زمني. لكن هناك ايضا بالمقابل تلك الدعوة الى كسر الفصاحة لاهوت اللغة وعمودها وتحريرها من إيقاع دهري. كانت هناك ايضا دعوة الشفوية، لا نعرف لماذا بدت أضعف ولا تزال أضعف، فمجاري اللغة لا تتعقل دائما ولا تسلك على نسق معلوم.
إشارات متباينة، اذا تجاوزنا التجديد والتجريب واستقلال الشعر صعب ان نجد بيانا واحدا لها، هناك بالطبع ترجمات الشعر العالمي التي كانت حقا بنت لحظتها (ترجم باث شابا وبيرس قبل فوزه بنوبل) كما فاقت فعاليتها أي جانب آخر في المجلة، ولعلها كانت «البيان» العملي للمجلة ومدرستها الاساسية، وفي مقابلها بدت النصوص المحلية أقل نضجا. لكن الارجح ان «شعر» كانت مناخا عاما وربما حساسية. لقد جمعت بين نزعة سيبرمانية واخرى عدمية واخرى زخرفية. تعددت البيانات لكن تجمع بينها أمزجة، مع ذلك نحن لا نزال في عصر البراءة. لا نزال لم نشك بعد في التحاقنا بالركب العالمي واتخاذنا مقاعدنا فيه بمجرد إرادتنا، لقد صرنا بالتمني وحده أحفاد رامبو ولوتريامون، ولم نتعب حتى تجاوزنا كل الفوارق، وحملنا مشاعل الحداثة في المسيرة المتخيلة. خفة بالتأكيد لكنها أيضا جرأة وتكيف لكنها ايضا سنوبيه الى حد. فالماركة العالمية يتم إنتاجها بأقل الشروط تقريبا. عصر البراءة، فهناك تلك الدراماتيكية التي لا يزال الشعر فيها فاعلا وقادرا ولا يزال ممكنا تشخيصه في ابطال وسير عليا ونماذج واسماء من الشرق والغرب. ولا غرو ان تكون الدواوين الاولى مونولوغات طويلة أو رموزا تاريخية. عنصر البراءة في تلك السيريالية التي لم تكن فتية لكنها اجتلبت أقوى مما كانته في حينها وكان عليها ان تغدو رافعة ثورات زخرفية أو لاهوتا لغويا أو زنزانات رومانطيقية. عصر البراءة لثورة يمكن ان تحصل في قمقم ولشعر يحلم بأن يغدو تاريخا. عصر البراءة في الاكتفاء الارستقراطي بالذات واحتقار الخارج والواقع والمعيش اليومي. عصر البراءة في الفصل بين الثورة والسياسة، بين التجربة والحياة، بين اللغة والأشياء. عصر البراءة في اختصار تجارب وأسماء كبيرة ورؤى في كليشهات سريعة.
ماذا بقي من «شعر». هناك بالطبع حنيننا الدائم الى عصر البراءة نفسه، الذي لم نخرج منه تماما ولا جميعا. هناك بالطبع مناخ الحرية واستقلال الشعر وتقليد العالمية وقصيدة النثر. لكن هذه جميعها لم تعد متوفرة بالسهولة ذاتها. مع الوقت تحول التجديد والتجريب الى إنجازات بطيئة وصعبة، وغدا الدفاع عن استقلال الشعر إشكاليا مع النزوع الى توسيعه وكسر تابوات «الحداثة» عليه. كما ان العالمية لم تعد طريقا ملكيا. مع انكسار المدارس والمسارات غدا لكل عالميته وطريقه اليها. أما قصيدة النثر التي تدين لشعر فهي في مساءلة قلقة حول نفسها لا يستطيع تراث «شعر» ان يعينها كثيرا عليها.
مع ذلك غدت «شعر» في التاريخ، والكلام عن «روح شعر» لا يخرجها منه. لم يعد الشعر مصدرا للعالم والواقع والتاريخ والثورة، ولم تعد الأنا الشعرية بطلا او بطلا مضادا. انه «الشعر» الآن يشكك في نفسه وماهيته ورسومه كلها ويضيع حدوده فلا تقوم بينه وبين النثر والخارج والأشياء والفنون والأفكار والعلوم عوازل. انه الآن يسعى لأن يلابس أنظمة شتى. كانت «شعر» في تبايناتها دعوة عارمة مفتوحة لكنها تنحبس أحيانا في قمقم، في دراماتيكيات مبالغة وزنزانات غنائية ورومانطيقية. كان الشعر فيها لا ينفصل عن بياناته وطالما قُرئ على انها هي. اليوم علينا ان نتحرى هذه البيانات وان نفصل بينها وبين الشعر الذي لن يكون دائما مطابقا. لم تعرّف «شعر» الشعر إلا ببعض نتائجه وتفاصيله لكنها انطلقت من قوته المفترضة وسموّه وانفراده. ليس الشعر الآن بهذه البطولة، لقد انطوى هذا اللون من الصراع، اننا نبحث عنه، وغالبا ما يغزونا السؤال الهيدغري اذا كان وجد بعد.
أُهْمِــل السائــد وســاد المُهْمـَـل
 بعد نصف قرن على صدور العدد الأول من مجلة شعر ما يزال السؤال قائماً ما هي الحاجة الى مجلة شعر؟ وماذا تبقى منها؟ وهل ما زالت القضايا والإشكاليات التي أثارتها في تاريخها العاصف تمتلك حضورها وقابليتها للترهين؟ أم أنها آلت الى مجرد جزء من تاريخ يشكل أحد ميادين مقاربات تاريخ الأدب على غرار ما سبقها؟ مما لا ريب فيه ان مجلة شعر قد باتت جزءا من تاريخ، إلا أنه إذا ما كان ممكنا التمييز بين تاريخ «راكد» او «مستقر» قد بات «عادياً» وبين تاريخ يمثل في بعض وجوهه تاريخا حيا او «مستمرا»، فإن مجلة شعر ما زالت تنتمي الى النوع الثاني على الرغم من اندراجها «الاشكالي» في النوع الأول.
بعد نصف قرن على صدور العدد الأول من مجلة شعر ما يزال السؤال قائماً ما هي الحاجة الى مجلة شعر؟ وماذا تبقى منها؟ وهل ما زالت القضايا والإشكاليات التي أثارتها في تاريخها العاصف تمتلك حضورها وقابليتها للترهين؟ أم أنها آلت الى مجرد جزء من تاريخ يشكل أحد ميادين مقاربات تاريخ الأدب على غرار ما سبقها؟ مما لا ريب فيه ان مجلة شعر قد باتت جزءا من تاريخ، إلا أنه إذا ما كان ممكنا التمييز بين تاريخ «راكد» او «مستقر» قد بات «عادياً» وبين تاريخ يمثل في بعض وجوهه تاريخا حيا او «مستمرا»، فإن مجلة شعر ما زالت تنتمي الى النوع الثاني على الرغم من اندراجها «الاشكالي» في النوع الأول.
وتتمثل المؤشرات القياسية لذلك على المستوى الكمي في معدلات حضور اسمها وترداده والإحالة إليه في ورشات الجدل والحوار والسجال والكتابة اليومية والبحثية بأكثر مما يتم الى غيرها، كما تتركز المؤشرات القياسية النوعية في أنه على الرغم من نهضة الدراسات المتعلقة بها فإنها ما تزال حتى الآن مجالا مفتوحا للدراسة والبحث على خلاف حركة مجلة «أبولو» مثلا التي وصل فيها تراكم البحث الى درجة عليا من الإشباع لم يعد فيه مسوغ لأي دراسة عنها إذا لن تكون ابتكارية وتضيف شيئا جديدا الى ما تراكم في مجالها. كما تتمثل تلك المؤشرات في ان العديد من القضايا الأساسية التي ارتبطت بحركة مجلة شعر في مرحلة بزوغها ما تزال محلا للدراسة الاشكالية المتفاوتة الاستقبال بين مجال شعري عربي ومجال آخر مثل قصيدة النثر، بين مجال يستقبل قصيدة النثر كشكل شعري «طبيعي» ومجال آخر ما يزال يرمي هذا الشكل بشبهة «الشرعية» و«دستورية» اندراجه في الشعر. كما باتت مصادر تأثر المجلة بطرح قصيدة النثر ولا سيما كتاب سوزان برنار مثار اهتمام ترجمات ومقدمات عديدة واستعادة لها تلقى استهلاكا نوعيا مكثفا في اتجاهات العمل الشعري والنقدي العربي.
في الجوهر، وإذا ما قفزنا فوق التفاصيل المثيرة التي ميزت تاريخ هذه المجلة، فإنه كي يكون لاستعادة مجلة شعر معناه النقدي الذي يتجاوز الاحتفالية، لا بد من التمييز بين الشعر الذي كانت تنشره المجلة وبين الاتجاه الذي عبرت عنه. وفي مجال الشعر الذي كانت تنشره مجلة شعر تثار كافة الأسئلة التي تثار عادة في مجال المقاربة النصية إلا أنه في مجال الاتجاهات التي تلعب دوراً شديد التأثير في إعادة تعريف الشعري وإعادة النظر بمعناه وأدواته وطبيعته ووظائفه ارتبطت حركة مجلة شعر بمحاولة تحويل حركة الشعر الحر التي ارتبطت بوحدة التفعيلة وتعديل الشكل المجالي للقصيدة الى ما سمته بحركة الشعر الحديث.
وفي منظور تاريخ الأدب فإن حركة مجلة شعر لعبت دورا حاسما في ترسيخ مصطلح الشعر الحديث كبديل من مصطلح الشعر الحر الذي كان قاصرا عن استيعاب نوعية التحولات التي أصابت القصيدة العربية ومفهوم الشعري عموما، حيث بات مصطلح الشعر الحر مثقلا بدلالات شكلية تجاوزها مصطلح الشعر الحديث المثقل بدلالات نوعية تتجاوز الحدود الشكلية الفقيرة والمحدودة والمقيدة لمصطلح الشعر الحر، مع ان ما نصفه اليوم بحدود فقيرة كان في زمنه إشكاليا ويثير قضايا كبيرة تتمثل بطبيعتها من حقل الشعر بحد ذاته الى حقل الثقافة والتاريخ الشامل.
المصطلح
ساهمت مجلة شعر في ترسيخ مصطلح الشعر الحديث، ولم تكن دلالة ذلك شكلية لأن هذا المصطلح قد فرض مقاربة جديدة للحركات والاتجاهات التي سبقت تلك الحركة. وكما يحدث في اللحظات الديناميكية للثقافات الراسخة التي تمر بمرحلة التغير الثقافي فإن ترسيخ مصطلح الشعر الحديث قد ارتبط بجدل آخر ما يزال مستمرا حول: ما لحداثة؟ والآن بما بعد الحداثة وربما ما بعد الشعر وما بعد القصيدة، فهذه «الما» تشير في ظاهرها الى القطيعة، لكن التبصر بمعناها في مرحلة لاحقة قد يحتمل الى ان تركيزها على القطيعة هو بهدف تحقيق دورها في التغيير. وفي ذلك قامت مجلة شعر بقطيعتها لكن الشعر الذي أنتجه شعراؤها او من نشرت لهم لم يكن ينطوي بالضرورة على تلك القطيعة، بقدر ما كان ينطوي على التطوير وبالتالي يقع في فضاء الاستمرارية في شروط مغايرة. فقصائد أدونيس مثلا في المجلة إبان صدورها كان ينظر اليها في ضوء القطيعة غير أنه ينظر إليها نفسها الآن جزءا من استمرارية. وما لا ريب فيه ان هذه الاشكالية كانت حاضرة لدى المجلة، فاستهدفت جعل الشعر العربي الحديث جزءا لا يتجزأ من الشعر العربي، اي انها انطوت على تحويل ما اعتبرته قطيعة الى جزء طبيعي وتوطينه في السلسلة الشعرية ـ الثقافية العربية. وهو ما كان شديد الوضوح لدى أدونيس منذ أوائل الستينيات في عز المجلة واشتداد ألقها وإشعاعها ومشاكلها، إذ كان أدونيس المنظر الأكثر فعالية لاتجاهات المجلة.
في هذا السياق واستئنافا لتلك الفكرة السابقة فإن حركة مجلة «شعر» بوصفها تعبر عن اتجاه او اتجاهات قد ارتبطت باتجاه محدد اكثر من غيره، وهو اتجاه تمييز الشعر الحديث في القصيدة ـ الرؤيا. ما فعله هذا الاتجاه هو في انه قد قال ان الشعر الحديث رؤيا، اي ان الشعر الحديث لا ينهض إلا بواسطة هذه الرؤيا، هو ما يختلف عن درجة حضور مفهوم الرؤيوي في المفاهيم التي كانت تحكم النظر الى الشعري، بينما كان الشعري نفسه في الممارسة النصية أبعد من التنظيرات تلك. وهذا ما أعطى الاتجاه تميزه كأتجاه قوي فتح جدلا آخر عن مضامين الرؤيا ودلالاتها.
التهميش
تأثير مجلة شعر في مفهوم الشعري في الستينيات وحتى أواسط السبعينيات في الحدود النسبية للتحقيب، اي على مستوى تحقيب المهيمن يشير الى ان مفهوم الشعر ـ الرؤيا قد غدا مفهوما سائدا تنتسب اليه السلالة الشعرية الناهضة يومئذ. وفي هذه الهيمنة ارتبطت بمجلة شعر أنواع شعرية من القصيدة ـ الرؤيا كالقصيدة الميتافيزيقية والقصيدة التموزية، وفتحت المجال الشعري أمام تغيرات أفضت في جانب منها الى النصوصية وكسر النوعية. وفي هذا المجال بلغ إنجاز المجلة أوجه واكتهاله في آن واحد، إذ غدا نفسه جزءا من مفهوم تحول الى مفهوم مهيمن تهيمن عليه شبه «عموديته» الجديدة او نمطيته، فما كان بازغا يتحول الى نمطي. وكاستئناف لهذه الفكرة لم تشكل مجلة شعر 69 في العراق أكثر من تراكم نوعي على اتجاه تحول من التغيير الى الهيمنة، وتحديدا تمثل التعبير الأدونيسي عن هذا الاتجاه الذي سيبقى حاضرا في تحولات الشعرية العربية حتى زمن قادم.
كل حركة بازغة مهما كانت شابة تنطوي على آليات تهميشها لاتجاه كامن في داخلها. ينطبق ذلك على مجلة شعر. لقد همش اتجاه تمييزها للشعر الحديث في القصيدة ـ الرؤيا اتجاها كامنا فيها، وهو ما سنصطلح على وصفه بقصيدة التفاصيل او مقاربة جماليات نثر الحياة اليومية، وإعادة الاعتبار للمهمل والاعتيادي مقابل الطبيعة الميتافيزيقية والحدسية للقصيدة ـ الرؤيا التي تنقل معرفة داخلية مباشرة بواسطة المجاز الرؤيوي. ولقد برز هذا الاتجاه الكامن منذ العدد الاول من المجلة مع قصيدة حمدان السعدي يوسف مع أنه لا يعتبر نظاميا من الأعضاء العاملين في المجلة، لكن من عبر عنه بين أعضائها العاملين (العضو العامل تسمية حركية وتنظيمية للمنخرط عضويا في المجلة، ومستعار على الارجح من خلفية العضوية الحزبية لمعظم أعضائها) هو محمد الماغوط وشوقي أبو شقرا.
احتضنت مجلة شعر تجربة الماغوط لكن الاتجاه المهيمن على مفهوم الشعري لحركة مجلة شعر حاول تهميش ما لم يكن ممكنا تهميش طزاجته، وفي خميس شعر وكوريدورات الحياة النقاشية اليومية للمجلة جرى وصف شعر الماغوط بأنه ينتمي الى الشعر المنثور، وهو ما ساهم في غضبة الماغوط اللاحقة ورده في حدود عام 1963 إبان معركة الآداب/شعر التي امتزج فيها الشعر بالسياسة ومع قضايا الهوية الثقافية على يوسف الخال ووصفه بـ«تشومبي الشعر الحديث» وتشومبي كان مقابل لومومبا في حقل التداول السياسي لثورات الشعوب وربيعها التحرري البازغ يومئذ. كما احتضنت التجربة الجديدة لشوقي أبي شقرا الشاب، غير انها لم تستطع ان تستوعب «ماء لحصان العائلة» الا بوصفه نثرا، فظلت داخل خانات التصنيف التقليدي الثنائي، حيث نشرته كنثر في مجلة «أدب» وهي شقيقة شعر ووليدتها في آن واحد.
سعدي يوسف من خارج المجلة، والماغوط وأبو شقرا من داخلها عبروا عن هذا الاتجاه الكامن، كان أبو شقرا يصف بحساسيته الشعرية الطازجة والمتألقة في فتح الشعر العربي امام مجال جديد الحداثة والرؤيا بصهاريج طنانة اي خاوية. لكن المجلة سرعان ما أصدرت ما اعتبرته نثرا على أنه شعر.
ما يهمنا من ذلك ان الاتجاه العام البازغ الذي عبرت عنه المجلة بوصفها حركة إبان نهوضها قد تحول لاحقا الى اتجاه ساند، بينما ما كان مهملا من اتجاه الماغوط ـ أبي شقرا ـ يوسف قد تحول في الثمانينيات الى اتجاه بازغ مارس في بعض المجالات هيمنة وتوليد هيمنة مفتوحة. وفي ذلك ما يزال ما همشته مجلة شعر لاتجاه كان كامنا فيها ويتمتع اليوم بقوة الحضور والتأثير والاستمرار حاضرا الآن في فضاء متعدد وفسيح على تطوير مستمر او تشظية مستمرة.
في ذلك تنتمي مجلة شعر الى نوع حيوي من التاريخ هو التاريخ المستمر، تحضر فيه تأثيراتها في شروط مختلفة لتغني ما أثارته تلك المجلة. وهذه سمة الحركات الشعرية والفنية الديناميكية في التواريخ التي تمر بمرحلة التغيير الثقافي. وبكل بساطة ما تزال المجلة حاضرة لأن التغير الثقافي الذي مثلت أحد أبرز فاعليه المؤثرين ما يزال مستمرا، ولهذا ستبقى قابلة لإعادة القراءة والاكتشاف.
"شعر"ان وبيروتان
مجلة «شعر» مثلما لاحت لي هي مجلتان. واحدة صدرت فعلاً في زمن ما من أزمان بيروت الستينيات والسبعينيات، واخرى قُرئت في الثمانينيات والتسعينيات. ولا أحسب ان ثمة قراءة ثانية للمجلة موادّ ودوراً ما زالت ممكنة. «شعر» المجلة لم تكن من بين المجلات التي كنت أحفظ بعض أعدادها قرب سريري، كانت مجلة كأي مجلة أخرى. أقرأ فيها ما تيسر عرضاً وأمر على بعضها الأغلب مروراً سريعاً، حتى اني لا أذكر جيداً أسماء كتّابها. تلك المجلة التي بدت لنا في أواخر الثمانينيات أيقونة سياسية وشبه ايديولوجية، متصلة بصناعة نوستالجيا لزمن لم نعشه أصلاً، لم تكن مجلة مقروءة. كانت المجلة بموادها العارية تعجز عن مواكبة صيتها وسمعتها، وكنت أؤجل قراءتها خوفاً من انكشافها وانكسار إطارها. كما لو انني أدركت يومها بغريزة المؤمنين استحالة القراءة. أي قراءة منصفة للمجلة يومذاك كانت كافية لتدمير هالتها تدميراً كاملاً. هكذا تجنبنا قراءتها وجاهدنا في تجنيب الآخرين أي قراءة ممكنة لها. والحق انني قرأت بعناية التلميذ المجتهد بعض المجلات التي انطفأ ذكرها ولم تستطع أن تعمر، ولتلك المجلات التي ماتت لحظة ولادتها ما زلت أدين ببعض مما حصلته. لكنني لا أدين لـ«شعر» بشيء، وعلى الأرجح فإنها تدين لي أكثر مما أدين لها بطبيعة الحال. فأنا الذي لم يقرأ «شعر» مثلما ينبغي على المؤمن أن يقرأ في كتاب إيمانه، دافعت عن المجلة وما جاء فيها دفاع المؤمن وهو ينافح عن حياض دينه. لكنني ككل المؤمنين ايضاً كنت أربي خطيئاتي في السر وأخفيها في العتم.
الحنين
هكذا قرأت «شعر» المجلة. لكن «شعر» الظاهرة والدور كانت في مكان آخر. كان ثمة من قرأ عنا «شعر» ممن سبقنا، وما كان علينا إلا ان نتبنى قراءته. إذ لم تكن قراءتها مجدداً ممكنة من دون إسقاط الهالة التي بُذل من أجل تنويرها حبر جليل وكثير على صفحات الجرائد والمجلات وفي مقاهي الشعراء والمثقفين. وأحسب ان حرصي على تأطير تلك القراءة التي تحدرت إلينا من جيل معلمينا المباشرين، كان في أصله وأساسه حرصاً على الهويات الصغيرة التي كنا نداوم على تغذية عصبها الرقيق. «شعر» الظاهرة في حقيقة أمرها من مواليد قرائها الكبار وليست من مواليد كتابها. بل اننا تساهلنا طويلاً وكثيراً مع صمت كتابها وهجراتهم، وأغفلنا التطرق إلى هذا الصمت وتلك الهجرات لأننا ما كنا نريد ان ينكسر الحلم الذي ربيناه بأناملنا وبين ايدينا.
يوم حاضر ادونيس في هجاء بيروت على مسرح من مسارحها، لم أشأ أن أدافع عن بيروت. وبذلت جهداً كبيراً في تجاهل ما قاله. كان ادونيس واحداً من فرسان «شعر» المجلين، ومحاضرته بدت لي خيانة للأمل الذي ربيناه طويلاً وحرصنا على تغليفه وتسويره ومنع سيوف النقاش من تقطيع أواصره. قلت في نفسي: هذه ليست خيانته الاولى، والأرجح ان ما كان يشاع في أوساط زملائه في المجلة صحيح. فهو خان الـ«شعر» بالـ«مواقف» من قبل. وما محاضرته هذه إلا إمعان في خيانته الأولى وإصرار عليها. لم تكن محاضرة ادونيس دقيقة ولا جميلة، وكان في وسع أي كان ممن يعملون في الثقافة ان يهشمها بضربة نقد واحدة. لكن ذلك كان بالنسبة لي محذوراً لأنني كنت أراه يتحدث عن بيروت يعرفها هو ونحن إليها نحن، عايشها هو ونؤلهها نحن، وأدرك في قراراتي أن تلك البيروت التي يتحدث عنها نالت من الأهلة ما يفيض عن حقيقتها فعلاً. لكننا نحن الذين ولدنا في زمن بيروت ذاك، لم نكن نملك غير تلك الأهلة مدينة نأوي إليها ونطمح إلى استعادة زمنها الذهبي. وحرصنا على دوام تنوير تلك الأهلة لأننا لم نشأ ان نعيش في اللامكان. لذا آثرنا ان نعيش في تلك المغالبة الطويلة النفس حقاً لانحدار المدينة ونحن نرى بأم العين هشيمها وركامها.
حتى في زمن الإعمار بقيت أهلة الحنين، و«شعر» واحد من أنصابها الشفوية، أقرب إلى مزاجنا من المدينة التي يعاد إعمارها. كنا نعيش في الحنين ونخاف أن ندخل في المدينة التي كانت تعبق بغبار الاسمنت وقرقعة الجرافات، لئلا نستفيق من الحلم على كابوس لعين. فأدرنا ظهورنا وعيوننا لما كان يجري وكتبنا شعراً من منفى الحنين. وأود أن أكذب ظني الآن وأنا أفكر ان الانعزال الذي طبع شعرية الجيل الذي أنتمي إليه زمنياً كان خيارنا حقاً. ولم يكن ابداً بسبب ضيق رقعة الحلم الذي كنا نعيش فيه وانكشاف شرايينه اليابسة على الجميع واحداً تلو الآخر ومن دون رحمة أو رفق بأعصابنا.
ما ان اغتيل الحريري حتى تحول انعزاليو الشعر والثقافة من الجيل الذي أنتمي إليه زمنياً والجيل الذي خلفنا في الزمن إلى شعراء وكتاب أكثر حرارة وحماسة وشغفاً في ما يكتبون. والأهم انهم باتوا أكثر اتصالاً بما يجري حولهم شعراً ونثراً ومواقف. كان اغتيال الحريري إشارة، بل لنقل انه كان شهاباً ساطعاً ينير كارثتنا المقبلة. ومع هذا الحدث الجلل بتنا على قاب قوس أو أدنى من وداع بيروت الثانية. بيروت التسعينيات وما بعدها، تلك التي لم يسعفها الزمن لتتجلى في قصائد الشعراء. لقد أصيبت بيروت التسعينيات بعطب قاتل مع اغتيال الحريري قبل أن يتسنى لنا أن نصنع أهلتها. رثيناها وودعناها قبل أن يتسنى لنا إحسان استقبالها.
أيقونات
اليوم يكون قد مر نصف قرن على ولادة «شعر» المجلة، وأكثر من ربع قرن على ولادة «شعر» الظاهرة. لكن الزمن الذي تقطع بيننا أطول من هذه المسافة بما لا يقاس. اليوم ثمة بيروت الثانية التي نستعد لرثائها وتوديعها، وثمة نجوم آخرون نجد أنفسنا مجبرين على تنصيبهم أنصاباً لماضينا. لكن جلهم هذه المرة من السياسيين والفنانين الذين لا تربطنا بهم صلة قرابة من أي نوع. مع ذلك لا نجد مفراً من صناعة أيقونات لهذه البيروت الثانية. وأحسب اننا تمهيداً لمثل هذا التنصيب نريد أن نحطم تماثيلنا السابقة أو نركنها في متاحف الذاكرة لنحل محلها آلهة جدداً. إذ ان آلهة البيروتين لا تستطيعان التعايش معاً بحسب ظننا. فإذا كنا نستعد لتنصيب نانسي عجرم أيقونة لبيروت الثانية يتوجب علينا أن نطيح بتمثال فيروز من ذاكرتنا الحية. وإذا كان ادونيس قد هجر بيروت قلباً وقالباً، فليس في وسعنا أن نبقي نصبه مجاوراً لنصب زاهي وهبي.
بيروت الثانية التي فقدناها قبل أن نعقلها استطاعت بسبب الدم الذي ما زال حاراً وغبارها الذي ما زال عابقاً في الجو أن تزيح بيروت مجلة «شعر» من المكان الذي حفظناه لها طوال هذه الأعوام. وها نحن نحاول جاهدين ان نقيم نصباً لمدينة جديدة لم تكن بعد قد شبت عن طوقها حين ضربتها الفاجعة.
عقيــدة الحداثــة
 عندما اجد ان مجلة «شعر» تخصص أعداداً متتالية بشعر المقاومة في فلسطين والعالم العربي والعالم الثالث والولايات المتحدة، فإن ذلك لا ينفى ان مجلة «شعر» مجلة فنية. ولكنه يضفي عليها في نفس الوقت صفة اخرى من حقها، وهي انها مجلة سياسية. انها مجلة سياسية بهذا المعنى الشامخ الذي يرتفع على صغائر الصفات المحلية للسياسة.
عندما اجد ان مجلة «شعر» تخصص أعداداً متتالية بشعر المقاومة في فلسطين والعالم العربي والعالم الثالث والولايات المتحدة، فإن ذلك لا ينفى ان مجلة «شعر» مجلة فنية. ولكنه يضفي عليها في نفس الوقت صفة اخرى من حقها، وهي انها مجلة سياسية. انها مجلة سياسية بهذا المعنى الشامخ الذي يرتفع على صغائر الصفات المحلية للسياسة.
وهي ليست مجلة شيوعية او بعثية او قومية عربية. فهذه كلها تسميات مصكوكة محليا من وحي التخلف الحضاري المرعب الذي نعيشه.. واذا قدّر لأجيال القرن الحادي والعشرين ان تقرأ لشاعر عربي من جيلنا الراهن، فإنها سترى فيه شاعراً وحسب، رسولاً بين رسل السياسة الذين يخترقون اسوار الحاضر من الزمان والمكان، ويرفعون حجب المستقبل..». (غالي شكري ـ شعر عدد 41ـ1969)
في الذكرى الخمسين لصدور مجلة «شعر» اللبنانية، والتي شئنا ان نقدم لها تعريفا، من احد كتابها او المساهمين فيها، ترانا نلتفت، ولو بشيء من الارتباك، الى جهود جماعة من الشعراء، من امثال يوسف الخال وادونيس وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقه وعصام محفوظ، وغيرهم، الذين سعوا الى «تأدية الرسالة التي اخذتها المجلة على عاتقها» (عدد 3ـ ص: 161)، وهي الدعوة الملحاح الى «ابداع اشكال جديدة مستمدة طبعا من عبقرية اللغة العربية، ومستفيدة الى اقصى حد من تجارب الشعراء في العالم المتحضر» (ص: 114)، على حد ما قاله الخال، في العدد نفسه.
ولا يلبث مدير التحرير، اياه، ان يضيف، في موضع آخر، بأنه «لا حاجة بأي صراع مع القديم»، «لان الحياة بدأت تتجدد فينا، او تجددنا. «
ولكن، اتراها الدعوة الى التجديد الشعري، كانت كافية وحدها لجعل مجلة «شعر» قطبا ثقافيا راجحا، وسط الحياة الأدبية اللبنانية والعربية، على امتداد عقد الخمسينيات والستينيات؟ ام ان ماثر «شعر» تجاوزت كونها منبراً للشعر الحر وقصيدة النثر، الى كونها منصة كبرى تعرض فيها كل صنوف الاعمال الأدبية، وبأنواعها كافة، وصولا الى الترويج للفنون كافة، شريطة ان تكون مجددة، أسلوبا ومضمونا؟
في الواقع ان نظرة بانورامية وتحليلية الى أعداد مجلة «شعر» التي تجاوزت الخمسين، والتي ضمت في دفاتها نتاجا، قد لا يفوق بكمه المنشور في المجلات اللبنانية، من زميلاتها، من مثل «الطريق» و«الآداب» وغيرهما، من دون ان ينماز بالتأكيد عن نتاجيهما لاسباب نفصلها لاحقا، ان نظرة كهذه الى النتاج تكشف لنا الامور التالية:
- «شعر» منبراً عربياً: من البداهة القول ان مجلة «شعر» كانت منبراً لاكثر من مئة شاعر لبناني وعربي واجنبي، وان مئات من القصائد سطت على صفحات المجلة، فكان الغالب عليها طابع الشعر الحر، في الاعداد الثلاثة الاولى، من العام ,1957 عام التأسيس. وكان اغلب الشعراء هؤلاء من رعيل الرواد، امثال أدونيس ويوسف الخال، وفؤاد رفقه، وقد حرص مدير التحرير، في حينه، على اضفاء السمة العربية على الشعر والشعراء، فكان ضيفا العدد الاول من المجلة، وبالتسلسل، الشاعرين سعدي يوسف (وقصيدته بعنوان «حكاية»( ونازك الملائكة (وقصيدتها «خصام»).
ولئن عاود يوسف الخال اطلاق اسماء شعراء لبنانيين، في اعداد لاحقة، من مثل جورج غانم، وشوقي أبي شقرا، وجورج صيدح وغيرهم، فإنه لبث محافظا على موقع ثابت للشعراء العرب، ولا سيما العراقيين منهم، امثال بدر شاكر السيّاب، الذي اختار اطلاق قصيدته الشهيرة «المسيح بعد الصلب» من المجلة (ص: 21ـ ,24 العدد 3)، وبلند الحيدري، وفدوى طوقان وغيرهم.
- ان ظاهرة الشعر الحر كانت لا تزال طاغية في السنوات الثلاث الاولى من انطلاقة المجلة، وان الحداثة التي كان حشد لها يوسف الخال اعلاما في التحليل الاكاديمي، مثل انطوان غطاس كرم ـ مساهما في اول دراسة نقدية صارمة بالعدد الاول من المجلة، لقصائد نزار قباني ـ كانت تعني استئنافا لثورة الشعر الحر، وترسيخا له في دنيا العرب، من على المنبر اللبناني، ورفداً له بالكثير من خواض الرمز، ونأياً به عن الخصوصية اللبنانية، التي كانت لا تزال موضع اعتبار من قبل فئة من الشعراء اللبنانيين من امثال صلاح لبكي وسعيد عقل، وللايحاء بأن الثورة الشكلية التي تخوضها المجلة لا تستلزم انقطاعا كاملا عن التراث، ممثلا بالبحور الشعرية، وانما هي خير اطار لغوي وفني، يحمل هموم العرب، ويكشف عن مشاكل هذا المخلوق الغريب.. اي الإنسان، ويبلسم جراح البؤساء على حد ما قاله ماجد فخري، في كلامه على مادة الشعر، بالعدد الثالث من العام التأسيسي نفسه1957.
والواقع ان الناظر الى التحشيد ـ بل اكاد اقول التعبئة، لولا دلالتها الحزبية ـ الذي انساق إليه المؤسس يوسف الخال، اذ دفع شعراء الشعر الحر، الى طليعة المعركة ضد عدو الجديد، ايا يكن، يرى مسارا خفيا وجليا في الآن نفسه، لبلورة شعر حر، مستقل بأساليبه وأبعاده ومنابعه السياسية والفكرية عن العديد من المنابر والمراجع الجاهزة، والتي لطالما تكوكب حولها العشرات، بل المئات، من شعراء الشعر الحر، من ذوي التزامات قومية واشتراكية وحزبية معلومة.
- وان الرمزية التموزية والفينيقية والوجودية التي لوّنت نتاج شعراء الشعر الحر، المؤسس والمساهمين الرواد فيها، على السواء (سعدي يوسف، بدر شاكر السيّاب، نازك الملائكة، أدونيس، خليل حاوي، يوسف الخال، فؤاد رفقه، شوقي ابي شقرا، ثريا ملحس، جورج غانم، جورج صيدح، وغيرهم)، كانت طوابع، بل سمات لازمة، في الآن نفسه، تضاف الى صفة الشعر الحر المشتركة بين الشعراء العرب من ذلك الجيل. وبذلك وحده يصح تمايز مدرسة مجلة «شعر» وامتيازها عن مدارس الشعر الحر العديدة، وما لم تقو قصائد هؤلاء على اشاعته، من رمزية مثلثة الأبعاد ـ او رباعية، اذ يضاف إليها البعد المسيحي ـ على ما أشرنا، عمدت الابحاث النقدية، في الاعداد الاولى، على اعلانه صراحة، وبأقلام مفكري المجلة وفلاسفتها، من امثال رينه حبشي وماجد فخري وانطوان غطاس كرم وايلي حاوي.
قصيدة النثر
- وان قصيدة النثر لم تكن، على ما يشاع، ابنة مجلة «شعر» المدللة، ولا سيما في القصدية الاولى التي سبق تعليلها، بدليل ان العددين الاولين من المجلة، تضمتا قصيدتين نثريتين، اولاهما لابراهيم شكر الله، من ليبيا، وكان ألفها في العام ,1943 وثانيهما لادفيك شيبوب، اما الشاعر أنسي الحاج، والذي قضى سحابة السنة التأسيسية الاولى للمجلة متواريا خلف نقاب النقد ـ وهو المكوّن الرابع في المجلة ـ فلم يدفع بقصائده للنشر إلا في العدد الخامس، من العام 1958 (ثلاث قصائد)، وبالمقام السابع من حيث تراتب الاسماء، في حين احتل محمد الماغوط المقام الاول، من العدد عينه، بقصيدتيه (حزن في ضوء القمر، والخطوات الذهبية) ومن دون ان تتضح الدواعي الحقيقية لهذا التغيير في سلم الاسماء، والاولويات، الذي لطالما أحسن يوسف الخال ادارته.
ولعل الملفت في الامر، ان الشاعر أدونيس، الذي كانت لا تزال قصائده تجلجل ايقاعا ونغما، في ما نشره على امتداد السنتين الاوليين من حياة المجلة، شرع ينظم قصائد، يختلط فيها الشعر الحر الموقع بالشعر النثري، وذلك بالعدد السابع من المجلة، من العام .1958 وللتدليل على التحول الارادي او غير الارادي لأدونيس نحو قصيدة النثر، نشير الى ان الاخير كان قد اعد دراسة في تعريف الشعر الحديث، في العدد العاشر من العام .1959 ثم رأيته يعد دراسة في قصيدة النثر، بربيع العام 1960 وبعدئذ، تجده وقد نشر قصيدته «الصقر»، صيف العام ,1962 خالطا فيها بين النثر والشعر الحر.
وعليه، فإن مجلة «شعر» التي شاءها مؤسسها الخال منبرا عالي النبرة، مكين الموقع، ثابت التطلع الى الاهداف الانسانية ومجد العروبة ـ بلا التزام حزبي ـ ومجالا لاعزاز الشعر الحر دون غيره، أمست، بعد حين وبسبب من تيار الحرية الاسلوبية الذي اطلقته وغذته ارضا متحركة وبرزخا واصلا بين ضفتي التجديد والعصرنة، فرأيت العديد من شعراء المجلة يحذون حذو الشاعر أدونيس، فينتقلون من الشعر الحر الى قصيدة النثر، وهذا دأب رياض الريس، وعبد الرحمن الربيعي، ويوسف الصائغ وغيره. ولسوف يفعل الامر نفسه، الشاعر شوقي أبي شقرا وفؤاد رفقه وعصام محفوظ وغيرهم.
اما شعراء قصيدة النثر (او بالنثر) الذين لم يعرفوا تبديلا، من العرب واللبنانيين، من امثال سركون بولص والياس مسوح وتيريز عواد، ومحمد عفيفي مطر والياس عوض ـ والاخير تجرأ على التلاعب بالفضاء الطباعي على غرار ما فعله ما لارميه ـ فقد رأيت صفوفهم تتسع، وقصائدهم تتناسل، على صفحات المجلة، فلا يبقى سوى اصوات قليلة، تجرؤ على الانشاد بالشعر الحر، الموزون. وقد يشاء القدر ان تكون القصيدتان الناميتان الى الشعر الحر، الوحيدتان في العدد 42 من ربيع العام ,1969 عائدتين الى يوسف الخال (الحديقج) وبلند الحيدري (حديث السبت القادم) من اصل احدى عشرة قصيدة لثمانية شعراء عرب ولبنانيين كانت تضمهم المجلة.
تيار الحرية
وقد يكون ان مجلة «شعر» هذه تعدت كونها مجرد منبر حر للشعراء اللبنانيين والعرب، الى اعتبارها مجالا للتنشئة والاندماج في حركة المجتمع المديني اللبناني، يقيسون بها ابداعهم الشعري، ويوازنونه بايقاعها وعالمها واصدائها. وقد لا يعني ذلك ان قصيدة النثر التي امكنها ان ترفع لوائها عاليا، في المجلة، بدءا من العام ,1963 وحتى مستهل السبعينيات، كانت الجنس الادبي الابقى والارفع، الذي طرحته المجلة على العالم العربي، وانما يعني، برأينا، ان تيار الحرية الذي فرضته المجلة ـ حرية في الالتزام والابداع ـ هو الذي دفع المنضوين في عملها الى تحريك مواقعها الاسلوبية، والبحث عن الحساسيات اللغوية والوسائط الكتابية الاكثر ملاءمة لهم، واسقاط ما يتنافى مع تجربتهم اليومية الآخذة في الاتساع والتعمق.
ولئن احتج البعض، وهو محق، في ان كثيرا من قصائد النثر التي ظهرت في مجلة «شعر»، كانت قد كتبت في تواريخ سابقة لظهور المجلة، وفي مدن عربية متباعد (طرابلس الغرب، دمشق)، فإننا نرجح ان تكون الارادة في العصرنة، التي كانت شاعت من مؤسس المجلة الى انصار الشعر الحديث والحر وما بعده، هي التي حفزت الشعراء الى ان يترجموا الذوق الجديد لغة شعرية جديدة كليا، مع ان معالمها ونتاجاتها ومناخاتها كانت مبثوثة في غير موضع، وكامنة في مراحل مخاضها الاولى. وقد لا يضير ان يتجاور الغث والسمين من القصائد، على صفحات المجلة ـ وذلك شأن كل المجلات ـ حسب المشرفين عليها انهم كانوا يدأبون على صياغة ذوق جديد، وصور لا عهد للقراء العرب بها. اما الاسماء، اما مصير الشعر الجديد ومستقبله وأساليبه فهذا شأن تتعهد به الحياة الثقافية في المدينة، وجودة العطاءات التي يأتيها كل شاعر بمفرده، ومن هذا المنطلق، يمكننا تعليل افول اسماء كثيرة كانت لشعراء مساهمين في المجلة، من امثال ابراهيم شكر الله والياس مسوح وموسى النقدي والياس عوض وادفيك شيبوب وغيرهم.
ترجمات
- على ان ما انجزته اقلام كتاب «شعر» من ترجمات، على مدار الاعداد كلها، يمكن ادراجه في باب الرغبة العارمة ـ التي لطالما صرح بها يوسف الخال ـ في رفد التجربة الشعرية العربية الفتية يينابيع شعرية اجنبية (فرنسية، اسبانية، انكليزية، المانية، روسية، ايرانية...) قصد ترسيخ التجديد ومده بإمكانات وأساليب غير مستنفدة.
ولقد رأيت الترجمات، خلال السنوات الثلاث الاولى من حياة المجلة، وقد بسطت على صفحات المجلة، فجعلت في نصين متوازيين، الاصل في مقابل النقل، واتبعت بشروح وتحليلات، على أحسن ما تكون الترجمة الرصينة. ولدى استعراضنا اسماء الشعراء المترجم عنهم، على توالي الاعداد (جوان رامون جمينيز، عزرا باوند، اميلي ديكنسون، ت. س اليوت، ايف فونفوا، رينه شار، سان جون بيرسو، بول كلوديل، ديلان طوماس، لوتريامون، ارثور رامبو، وليم بيتس، وليم شكسبير، بول فاليري، بيار ايمانويل، تريستان تزارا، انطونان ارتو، اندريه دي بوشيه، ارثر غريغور، ايلي شارل فلامان، بيار ريفردي غاستون ميرون، جون هولوي، ابوليتير، وغيرهم..) من دون التفاتنا الى الشعراء الاجانب المساهمين في المجلة، وسعنا الاستخلاص بأن نتاج الشعراء المترجمين، الى كونه مادة رافدة في الابداع الشعري، فقد عكس في حينه، الاختيارات الاسلوبية لدى كل شاعر مترجم، في شعر، بمثلما اتاح التعبير عن الامداء التي يتصور بلوغها في ابداعه. والحال هذه، فإن الترجمات المنجزة هذه في «شعر»، والتي يمكن وصفها بالكافية، زمنها، والمتزامنة مع الابداع الاصيل، انما كانت مندرجة في سياق المرافعة المستمرة التي جعل يقيمها كل شاعر بمفرده على مسلكه ولغته وتعابيره ونظرته الى الوجود وفلسفته وطموحه في التصرف بفضاء نصه، وغيرها من الامور مما يدخل في باب «الرؤيا» او «التجربة» او «الاسلوب» التي راجت على ألسنة الشعراء. وتلك هي قرينة دالة على نماء فردية كل شاعر، واطراد شخصيته، غصنا يانعا، في شجرة المجلة المخضوضرة والمثمرة في آن.
- وفي حين كانت المساهمات النقدية والاكاديمية الجادة، في الخمسينيات، والقراءات التحليلية التقريبية، في الستينيات، الصوت الصريح والدال على هوية الشعر الجديد، في المجلة، بأقلام الكتّاب امثال: رينه حبشي وانطوان غطاس كرم، وخزامي صبري ونذير عظمة، واحمد مكي وغيرهم من الشعراء المساهمين، والتي لبثت معايير عامة للغة شعرية سامية ومثالية وحاملة هموم امتها وانسانها، كانت فنون المسرح والسينما والرسم تخطو خطوتها الاولى، الى رحابة المجلة، العام .1967 وبهذا، يكون القيمون على المجلة قد وضعوا اللمسات الاخيرة على دخول المجلة الى الحياة المدينية، دخولا ممتلئا وتاما. غير ان زمن الصحيفة، كان اسبق واعتى من زمنها، فحال دون فرحة ذلك الشمول.
واليوم، اذ نلتفت الى الصنيع الذي بقي من مجلة «شعر»، نكتشف انه: اليقين بالحداثة والعصرنة، يقين عملت المجلة على ترسيخه في الخاصة، قبل العامة، وسعت الى توسيع امدائه الى آفاق، هي نفسها آفاق الرحابة المدينية. وبلغت في عملها هذا حدود العقيدة، التي تهون معها كل فكرة او محاولة او تجريب، ولكن، أتراها افلحت ام لا؟ لا احسبني قادرا على الجزم في هذا الشأن.
ملحق السفير الثقافي
9/02/2007