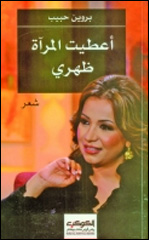 قد يكون عنوان الديوان الجديد للشاعرة البحرينية بروين حبيب «أعطيت المرآة ظهري» (دار الكوكب، رياض الريس 2009) خير مدخل الى عالمها الشعري الذي تشكل المرآة أحد أسراره. فالمرآة كما تتخيلها الشاعرة أو كما تتمثلها، ليست البتة مرآة نرسيس «البطل» الأسطوري الإغريقي الذي ارتبط اسمه بمقولة «النرجسية». لا تقترب الشاعرة الشابة (مثل نرسيس) لحظة من «صورة» هذا البطل الذي افتتن بنفسه حتى غرق فيها أو في صورته المنعكسة على صفحة الماء. تعلن الشاعرة جهاراً أنها أدارت ظهرها للمرآة متخلية عن «الأنا» النرجسية الممتلئة، لئلا أقول «المنتفخة» بذاتها. فالأنا هنا لا تحضر إلا عبر قدرتها على الإيحاء بغيابها الشفيف الذي يترك وراءه أثراً أو جرحاً. وتمضي الشاعرة في لعبة الإيحاء بالغياب حتى لتجاهر بأن «لا وجه لها» كما تقول و «لا اسم» و «لا وطن يلمّ تراب أغنيتها». كأن حال التجرّد من الوجه (أي من المرآة في معنى ما) يفترض التجرّد من الاسم والانتماء أيضاً. وإذا نظرتْ ذات مرة في المرآة، فهي لن ترى سوى «خيال ضاحك» كما تعبّر و «فراشة عزلاء». فالمرآة هي التي تنظر الى الشاعرة وترسمها بل هي التي تقرأها وتكتبها، كما ورد في إحدى القصائد. ولا تتوانى الشاعرة عن وصف هذه «المرآة» بـ «اللص الحائر». وهذا تشبيه معبّر جداً، فالمرآة هي التي تسرق الوجه وترمي صاحبه (أو صاحبته) في حالٍ من الحيرة. بل ان الشاعرة عندما تكتب قصيدة حبّ في ديوانها، لا تغفل المرآة العاشقة أو لأقل مرآة العاشقة التي تنظر إليها لتبصر في وجهها أثر الحبيب الغائب. تقول الشاعرة مخاطبة هذا «الغائب»: «هكذا أدمنت مرآتي أثرك». هنا تحلّ المرآة محل الوجه أو لعلها تصبح الوجه نفسه، الوجه الذي يدمن «أثر» الرجل الغائب، لامعاً في العينين أو محفوراً في المقلتين.
قد يكون عنوان الديوان الجديد للشاعرة البحرينية بروين حبيب «أعطيت المرآة ظهري» (دار الكوكب، رياض الريس 2009) خير مدخل الى عالمها الشعري الذي تشكل المرآة أحد أسراره. فالمرآة كما تتخيلها الشاعرة أو كما تتمثلها، ليست البتة مرآة نرسيس «البطل» الأسطوري الإغريقي الذي ارتبط اسمه بمقولة «النرجسية». لا تقترب الشاعرة الشابة (مثل نرسيس) لحظة من «صورة» هذا البطل الذي افتتن بنفسه حتى غرق فيها أو في صورته المنعكسة على صفحة الماء. تعلن الشاعرة جهاراً أنها أدارت ظهرها للمرآة متخلية عن «الأنا» النرجسية الممتلئة، لئلا أقول «المنتفخة» بذاتها. فالأنا هنا لا تحضر إلا عبر قدرتها على الإيحاء بغيابها الشفيف الذي يترك وراءه أثراً أو جرحاً. وتمضي الشاعرة في لعبة الإيحاء بالغياب حتى لتجاهر بأن «لا وجه لها» كما تقول و «لا اسم» و «لا وطن يلمّ تراب أغنيتها». كأن حال التجرّد من الوجه (أي من المرآة في معنى ما) يفترض التجرّد من الاسم والانتماء أيضاً. وإذا نظرتْ ذات مرة في المرآة، فهي لن ترى سوى «خيال ضاحك» كما تعبّر و «فراشة عزلاء». فالمرآة هي التي تنظر الى الشاعرة وترسمها بل هي التي تقرأها وتكتبها، كما ورد في إحدى القصائد. ولا تتوانى الشاعرة عن وصف هذه «المرآة» بـ «اللص الحائر». وهذا تشبيه معبّر جداً، فالمرآة هي التي تسرق الوجه وترمي صاحبه (أو صاحبته) في حالٍ من الحيرة. بل ان الشاعرة عندما تكتب قصيدة حبّ في ديوانها، لا تغفل المرآة العاشقة أو لأقل مرآة العاشقة التي تنظر إليها لتبصر في وجهها أثر الحبيب الغائب. تقول الشاعرة مخاطبة هذا «الغائب»: «هكذا أدمنت مرآتي أثرك». هنا تحلّ المرآة محل الوجه أو لعلها تصبح الوجه نفسه، الوجه الذي يدمن «أثر» الرجل الغائب، لامعاً في العينين أو محفوراً في المقلتين.
لا يغيب عن شعر بروين حبيب هاجس الصورة، فمثلما هي شاعرة هي وجه تلفزيوني أو إعلامي أيضاً، وقد راجت صورتها هذه أكثر مما راجت قصائدها، وهذا أمر طبيعي، فالشاشة الصغيرة تغزو المنازل والحياة اليومية بينما الشعر يظل وقفاً على النخبة التي تزداد ندرة. ولا غرابة أن تحيا الشاعرة حالاً من الصراع بين وجهيها أو بين صورتيها، صورتها الخاصة كشاعرة مرهفة وصورتها العامة كوجه تلفزيوني لامع ومعروف. تقول الشاعرة: «أدخل في الكادر ولا أخرج أبداً». انها تنسى نفسها في «كادر» الكاميرا، تنسى صورتها الفوتوغرافية ببسمتها التي تفتن الآخرين، و «تنهر قلبها» بالسرّ، كما تعبّر. وهذه الابتسامة التي تشرق على الشاشة تخفي قلباً هو «رماد يوم مضى».
تعيش الشاعرة إذاً حال الصراع هذا، منحازة الى صورتها السرّية التي قد تكون «باكية» في أحيان والتي لا تجد لها مكاناً: «أين أعلّق صورتي الباكية؟» تسأل. ولا تلبث أن تعترف أنها «خانت» صورتها السرّية عندما أطلّت على العالم بصورتها الأخرى وكأنها لم تطلّ: «كم خنت صورتي/ أطلّ على العالم/ ولا أطل/... الكادر هو هو». انها حال التمزّق بين وجه يكتسي بأسراره ويذرفها، مثلما تعبّر في إحدى قصائدها، ووجه ليس هو بوجهها الحقيقي بل العابر.
تحتل مقولة «الغربة» جزءاً غير قليل من المعجم الشعري في ديوان بروين حبيب. واللافت أن تتجلّى الغربة في اللغة نفسها، وفي الاسم الغريب الذي يحمل «شذى» هذه اللغة. والشذى تصنعه، كما تكتب الشاعرة، «باء بكت راء» و «واوٌ أورقت ياءً على الألواح»، وكذلك «الشمس» التي هي «خمرة فكرة في كأس نون». ويكفي جمع هذه الأحرف ليتشكل اسم «بروين»، هذا الاسم الغريب الذي لا يخفي «وتره» الفارسي كما يرد في إحدى القصائد. اسم مجروح، إن أمكن القول، تبكي الباء فيه الراء، واسم منتشٍ بنفسه أيضاً تورق فيه «الواء ياء» وتستحيل النون كأساً. هذا الاسم يعني في ما يعني بالفارسية «الفراشة»، ولعلها هنا فراشـة الشـعر «العزلاء» كما تـقول الـشاعرة.
إلا أن الغربة لا تكتفي هنا بجذرها اللغوي الذي هو جذر وجودي أيضاً، بل تشمل العالم والروح والجسد والزمن، هذه العناصر كلها تسبغ الشاعرة عليها صفة «الغربة»، بل ان الشاعرة نفسها تغدو «الغريبة» تحت «الأنظار»، والغريبة في «عتمة الحكاية» كما تعبّر.
لا يغيب الحبّ عن قصائد بروين حبيب، لكنه يحضر بأثره العميق كما لو كان جرحاً لا يلتئم. فالشاعرة لا تتغزّل ولا تجاهر بالحبّ بمقدار ما تصمت وتخفي حبّها. تخاطب الشاعرة الحبيب مخاطبتها رجلاً غائباً أو رجلاً رحل للحين أو رجلاً سوف يرحل: «رأيت أثرك في الضوء الخجول» تقول، أو: «في صوتك يختبئ البرق» أو: «العتمة صديق وصوتك الأمنية المرجأة». وكم وفّقت الشاعرة هنا في تذكير العتمة مجازاً فوصفتها بالصديق وليس بالصديقة وكأنها تعوّض بها الحبيب نفسه والحب الذي يقع في منزلة التمنّي. وفي قصيدة «زليخة» يستحيل الحبّ «العاطفي» حباً أمومياً فتخص الشاعرة أمها (زليخة) بقصيدة تنضح رقة وحنيناً. انها الأم «سيدة المزارات»، صوتها «ترتيلة نهار أخضر» و «وجهها ضوء الأسفار» و «دعاؤها غيمة»... وتبلغ القصيدة ذروتها عندما تخاطب الشاعرة أمها قائلة «لديني ثانية». وليست هذه الدعوة الطالعة من القلب والروح إلا حلماً بالعودة الى طفولة الحياة، باستعادة الطفولة مرة ثانية، بالحقيقة لا بالتوهم. فالشاعرة التي تحتل الطفولة سريرتها لا تستطيع أن تنظر الى العالم إلا بعيني تلك الطفلة، العينين اللتين تفيضان براءة وحزناً: «يتيمة ألهو هناك/ الشاطئ صامت كشريط قديم/ وصورتي الطفلة تهبّ بفستانها الملوّن».
تبتعد بروين حبيب في ديوانها عن «الأطناب» والاستفاضة والإطالة وتكتب قصائد قصيرة، عمادها اللحظة الشعرية الكثيفة و «اللقطة» اللامعة والصورة الموحية. لكن الإيجاز لا يعني التخلّي عن النزعة الغنائية المتوهّجة ذات البعد الذاتي ولا عن التأمل والوجد. فالقصائد المنبثقة من صلب المعاناة الداخلية لا تنغلق على نفسها، بل تحاور العالم، وتنفتح على الحياة، مستمدة من العالم والحياة كليهما، جذوة نارها المشتعلة.
أما المفاجأة التي حملها ديوان «أعطيت المرآة ظهري» فتتمثل في طغيان صورة الشاعرة في شخص بروين حبيب، على صورة «النجمة» الإعلامية، فإذا الشعر هو الهم الأول والأخير، بحقيقته الجارحة وحزنه الشفيف وقلقه الوجودي العميق. مرة أخرى تنتصر بروين حبيب للشعر متخطية الشرك الذي تنصبه «النجومية» التلفزيونية للشعراء.
Hgpdhm
الخميس, 27 أغسطس 2009