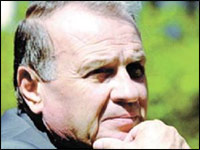 يقول الشاعر محمد علي شمس الدين إن الكتابة هي مرضه الجميل الذي لا يتبرأ منه، ولا ينكره. ويرى المولود في قرية تقع في الجنوب اللبناني العام 1942، أن الحياة وحدها لا تكفي، ويضيف: من دون الكتابة، الحياة مشوبة بالنقص .
يقول الشاعر محمد علي شمس الدين إن الكتابة هي مرضه الجميل الذي لا يتبرأ منه، ولا ينكره. ويرى المولود في قرية تقع في الجنوب اللبناني العام 1942، أن الحياة وحدها لا تكفي، ويضيف: من دون الكتابة، الحياة مشوبة بالنقص .
ويشير الحاصل على إجازة الحقوق من الجامعة اللبنانية العام 1963، والدكتوراه في تاريخ الفن في معهد التعليم العالي، إلى أن القصيدة أجمل من الحياة، وهو يلجأ إليها بدافعٍ من شيءٍ من الانتقام، أو التعويض أو الادعاء.
ويبين الشاعر أن سيرته تأثرت بالفلسفة الشعبية التي ترى أن الموتَ شكلٌ من أشكال الحياة، وأن الإنسان لا ينتهي كفقاعةٍ في مستنقع بموته الجسدي، فهو منحازٌ للحياة رغم هذا الدمار الدهري، فحمل شعره ظلالا من حزن جنائز الجنوب وكربلائياته، وهو يؤكد أن الخطير في الشعر، بل المخيف، هو حقيقته من حيث هو حقيقة في الحقيقة ، أو حقيقة موازية بالكلمات لحقيقة الوجود .
شمس الدين الذي صدر له في الشعر نحو عشر مجموعات، منها: قصائد مهربة إلى حبيبتي آسيا ، منازل النرد ، ممالك عالية ، و شيرازيات التي عربها عن الفارسية، وكتب في السيرة: الطواف ، رياح حجرية ، حلقات العزلة ، يقرر أن الرواية لا قيمة لها مستمدة من الواقع، بل إن قيمتها الحقيقية تكمن في ما تضيفه على الموصوف الواقعي أو التاريخي فنيا وجماليا.
حول علاقة القصيدة بحال الشاعر، تالياً الحوار:
المقروءات الأربع
* الثقافي ثمة علاقة بين الأشياء تنبه أحيانا، وأخرى تؤثر، ما العلاقة بين اسم محمد شمس الدين وقصيدته؟
- يقول الرسول الأعظم: لكل امرئ من اسمه نصيب ، وأسأل: هل ثمة مِن تناسُب بين هذه المقروءات الأربع (أي محمد علي شمس الدين)، وبين الجوهر الشعري الذي يشكل مجمل ما كتب من قصائد مؤسسة على بعد ميتافيزيقي من جهة أولى، وعلى شجن كربلائي من جهة ثانية، فضلا عن أن نخبوية الاسم من بعد، جعلت أن لا مفر منه في الأشعار.
الاسم يأتي نتيجة تواطؤات بين الأهل والمجتمع، إن شئت أو أبيت، ومهما دخل مزاجي في تأليف القصيدة، ومهما دخلت الثقافة الحرة التي تبنيتها بالتدريج، فإن ثمة عصباً حساساً في الاسم..
أعترف بذلك، ولكن ما ينطبق عليّ لا ينطبق على كل اسم ومسمى بالمطلق، إن في العربية مفارقات، فالعرب يطلقون اسم الشيء بضده، فيعطى للعبد اسم جوهر، وللخادم اسم مسرور وسعيد..
وأعود للقول: إن علاقة الاسم بصاحبه ليست علاقة آلية، أنا شخصياً كتبت قصائد كأنها مكتوبة للاسم ذاته مثل: شمس محمد ، الوجه والقناع و الفراشة :
فالسلام على التي ولدت محمد
وهو نور النور
واغتسلت ضحى بالماء
فانبعثت على الأشياء صورتها البهية
فهي أول ما يُرى عند الصباح
وآخر الأحلام عند تشابك الأحياء بالموتى
وقبل هلاكها .
ليس ذلك وحده، بل إن هناك قصائد أوردت فيها اسم أمي آمنة .
إن اسمي له نصيب في تكوين شخصيتي الشعرية.
خيانة الطفولة
* الثقافي في غالبية الكتابات التي تتصل بالطفولة، هناك خيانةٌ ما تعيد استحضار الماضي بوعي المستدرك أو اللحظة، كيف نكتب عن الطفولة دون ارتكاب فعل الخيانة لطهرانية البراءة؟
- الأمر صعب.. أنت أمام كيان تمزقه الأيام، الطفل مات.. ولكن أنت ترفض أن تدفنه.. يطل برأسه بين معنى وآخر، بين سطر وآخر، تطرده ويعود، فلماذا يريد هذا الطفل أن يحتمل كل مساحات الأزمنة والأمكنة.
أعتقد أن ما أسميته الخيانة لطهرانية الطفل، هي تكوّن الوعي من روافد ملوثة بالحياة. وكلمة ملوثة ليست بالمعنى الأخلاقي، بل بمعنى ضرورة تدفق مياه عديدة في مجرى واحد.. إنه لمضحك حقا أن أبقى طفلاً.
انظر إلى جنون قيس.. لماذا جنَّ؟ لأنه لم يأخذ مسافة الزمن بالحسبان في علاقته بليلى، هو كبر، وهي كما قال الشاعر:
لم تزل ليلى بعيني طفلة
لم تزد عن أمس إلا إصبعا .
إن سبب التنويع على جنون قيس، رفضه لحكم الزمان.. وأنا متردد بين حضور الطفل وموته. وبالتالي كان تعبيري عن ليلى رمزياً بمزيج ملتبس بين حقيقة من كانت ليلى، وحقيقة ما صوّرتها الأسطورة، وما تلقيتها أنا حتى الآن، وما صوّرتها في القصيدة.
كان عشقي لها يعذبني
وموتي جميلاً
على قاب قوسين من بابها
يصطفيني.
تقول:
*وهل أنت قيس العليل؟
- أقول: نعم
وأضيف: القتيل
... ... ....
إن ليلى
- التي متُّ في حبها ألف عام-
تخون .
سارق النار المقدسة
*الثقافي أين تقف القصيدة من الشاعر، وأين تقف من الواقع الذي منحها صورتها ووجودها؟
- القصيدة عصفور واقف في غابة، أو كالصورة التي رسمها أحد الفنانين، هي غزال في غابة في غزال .
مكونات القصيدة كيمياء متنوعة، لكنها مضطرة لأن تكون مختزلة، كما هو العصفور اختزال للغابة، أو الغزال اختزال للغابة.
السؤال، أين تقف القصيدة؟ أقول: إنها تقف في وسط الغابة، جزء مفارق منها، أو لو شئت أن أشبه القصيدة من حيث علاقتها بالوجود فإنني أشبهها بالمحارة من حيث علاقتها بالبحر.
استمع إلى المحارة، ضعها على أذنك، تسمع هدير البحر حتى لو كنت في الجبل.. القصيدة إيقاع الوجود.
الخطير في الشعر، بل المخيف، هو حقيقته من حيث هو حقيقة في الحقيقة ، أو حقيقة موازية بالكلمات لحقيقة الوجود .
الله خلق العالم، والإنسان كتب القصيدة، وباعتقادي أن أهمية الفن تكمن عموماً في شيئين:
الأوَّل: أنه يقول ما لا يقوله التاريخ، ويقول ما لا يقوله الواقع، هو تجليات الشيء، لكنه ليس هو.
والثاني: أنه يكشف المستور، ومن المهم القول: إن قصيدة في الحب، ليست هي الحب، قصيدة في الجبل ليست الجبل، قصيدة في الحرب ليست الحرب.
*وبالمقابل فإن لوحة لامرأة ليست هي المرأة.. ماذا يعني ذلك؟
- إنه يعني أن ثمة وجودين: وجود الحقيقة، ووجود المخيلة، وهما متباينان أشد التباين.. لذلك قال الفلاسفة اليونان القدماء: الشاعر سارقُ النار المقدسة ، هذه النار المقدسة هي نار الخلق.
وربما يكون من الأمثلة الجلية على ذلك، الشاعر المتنبي الذي كان هاجسه دينياً من القصيدة، واستعار شيئاً من علم الكلام الإسلامي في شعره، مثل قوله:
أنا السابق الهادي إلى ما أقوله
إذا القول قبل القائلين مقول .
غموض الشعر
*الثقافي يستعير الشاعر شمس الدين مفردات قصيدته من البيئة الثقافية، غير أن ما يكتبه من شعر ينطوي على غموض يصعب على المتلقي العادي ، فلمن يكتب؟
- وأنا أسأل نفسي: لمن أكتب؟
هناك جانب غامض في الشعر، أنه لا يحب أن يعطي أسراره كاملة لأحد، أعتقد أن الشعر هو معنى ناقص دائماً، بل محكوم بالنقصان. ولا أدري سبب الغموض سوى أنه هكذا.. الأشياء مخلوقة هكذا..
ليس فقط المقولات أو الأشخاص أو الأماكن التي تؤثث القصيدة هي وحدها تنتهي بين يدي القصيدة إلى عتماتها أو تختبئ في ظلالها، بل كل شيء مادياً كان أو تاريخياً مُلزم بأن تُطرح عليه أسئلة ميتافيزيقية.
هل تظن أن حبة الماء الصغيرة بسيطة؟.. فما بالك إذا دخلنا إلى الحياة.. الموت، الروح، توالي الأيام، الزمن.. كل ما في هذا العالم غامض وناقص..
إنني ترجمان هذا الغموض.. أو بما يوازيه على الأقل، جاء في الذكر الحكيم: يسألونك عن الروح.. قل الروح من عند ربّي ، ليس الروح وحدها من عند ربي.. بل كل شيء.
الشاعر ملزم بتعليل الوجود، والدليل على ذلك أن النظرية النقدية للشعر في العربية ليست نظرية أدبية، إن الذين صاغوها هم الفلاسفة، أمثال: ابن سينا، الفارابي وابن رشد، تأسيساً على كتاب الشعر لأرسطو، فقد رأوا أن الشعر: هو المخيلة مسكوبة في الوزن، وهي نظرة فلسفية لا مفر منها، حتى الشعر المغرق في الميكانيكية أو النثر واليوميات الشعرية، ما لم تغسل بماء ميتافزيقي تبقى نثراً جرائدياً.
القصيدة كما قال الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي: مغامرة لغوية ومغامرة وجودية في آن معاً.. .
أقول: الرواية أصلاً لا قيمة لها مستمدة من الواقع، أو كما سبقت الإشارة، من التاريخ، فقيمتها الحقيقية تكمن في ما تضيفه على الموصوف الواقعي أو التاريخي.. هل تصدق حينما أكتب سيرة ذاتية أنني أكتب الواقع كما وقع؟.. حتما لا تصدق!
حين كتبت قصة شمس محمد عددتُها قصيدة في السيرة، ومثل ذلك كتاب الطواف و حلقات العزلة ، وفي هذا النوع من الكتابة يكون الشخص أكثر من شخصه.. إنه الشخص مضافاً إليه قيمة المتخيل، وهنا المتعة.
وأظن أن أولئك الذين يسجلون يومياتهم ب صدق ، يقدمون حروفا ميتة، فالسيرة الذاتية هي سيرة الذات المبدعة، واقتراحاتها الجمالية بشكل ما.
شعراء الجنوب
*الثقافي ماذا عن شعراء الجنوب، هل انتفى الشرط الواقعي والفني لوجودهم، أم هي مجرد مرحلة لم تكتمل سماتها؟
- إنها تسمية كما قلت، وهي لم تكن وحدها كافية لتكوين مدرسة شعرية أو تكوين شاعر أو حالة شعرية، وأظن أن مصدر التسمية سياسي بالإطلاق، وبشكل أكثر دقة يساري، ووراء ذلك المجلس الثقافي اللبناني الجنوبي الذي كان يتولاه وما يزال الشاعر والمناضل اليساري حبيب صادق، وكنا نحن في مقتبل الحياة الشعرية، نبحث عن مكان نبيض فيه القصيدة، فجاءت الحاضنة وشاءت أن تسمينا شعراء الجنوب ، لأننا من الجنوب اللبناني، ولأن خيطاً ما يجمع بين قصائدنا، ولأننا كنا في اتجاه يساري سياسي.
ومثلما أن أكبر الأيديولوجيات لا تصنع شاعراً، ولا حتى القضايا الكبرى والمصيرية، فإن الشاعر تصنعه أخلاط عجيبة غريبة من عصب، ولاوعي، وقراءة.. فإن شعراء الجنوب انتهوا ليصبحوا شعراء بلا الجنوب.
القصيدة أجمل من الحياة
*الثقافي ماذا أعطت القصيدة للشاعر شمس الدين، وماذا منح الشاعر القصيدة؟
- ببساطة، أنا كاتب القصيدة، بمعنى أنني من دون هذه القصيدة لا أكون في الوجود الذي وُجدت فيه. القصيدة هي كينونتي، هذا ما أعطيتها وما أعطتني.
قلت لها: كوني، فقالت لي: كن، ولو سألتني: كان فيك ما تكون شاعر ، أقول: لا. كان فيك تعمل شي غير الشعر .. أقول: لا.. فيك تكون تاجر ، لا. فيك تكون امبراطور ، أقول: لا. لماذا؟ لأن الكتابة هي مَرَضي الجميل الذي لا أتبرأ منه، ولا أُنكره، وأرى أن الحياة وحدها لا تكفي. من دون الكتابة، الحياة ناقصة، ولو شئت شيئاً من التطرف وهو ما أعتقد به.. لقلت لك: نعم، هي مَرَضي. القصيدة أجمل من الحياة، ربما ألجأ إليها بدافعٍ من شيءٍ من الانتقام أو التعويض أو الادعاء.
القصيدة أمي
*الثقافي علاقة النص بالأم، من يسبق الآخر؟
- أنا لا أعرف أمي تمام المعرفة، وأرى أنها ولدت يوم ماتت، فكتبت قصيدة الفراشة ، أعرِّف فيها تكوين أمي، بل إن القصيدة هي التي ولدتها، وفي قصيدة سابقة بعنوان الناي أرسم هذه العلاقة المفقودة بيني وبين أمي فأقول:
سأدخل في الناي كي تذكريني
وأترك جسمي على خشب النهر كي تذكريني .
إذن ثمة نسيان. وتوسل للتذكر، ولو دققت في خاتمة القصيدة لوجدت المقطع التالي:
فلا تحزني
واعلمي أنني
خاتم ضاع في ليلة العرس
تحت الغطاء .
هذه السيرة الناقصة بيني وبين أمي ملأت بحدتها القصيدة، فالقصيدة أمي:
دفنتُ أمي
وأهَلْتُ آخر حفنة فوق التراب من التراب
وقلت: ها إني أعود لعلّني
أجد الجميلة تستريح على سرير جمالها
في البيت
حيث تمدُّ نحوي كفّها البيضاء
*تسألني معاتبة: لماذا غبت يا ولدي؟
- وتعلم أنني ما غبت
لكنّ الجميلة دائما
ينتابها قلق الغياب
وأنها تنأى
وتبعد حين تقرب
ثم تنأى
ثم تنأى
كي تُرى حُلما
وقد أبصرت حلمي .
الرأي
17 ابريل 2009