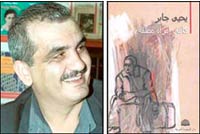 حيال مجموعة شعرية على غرار مجموعة "كأنني امرأة مطلقة" ليحيى جابر الصادرة لدى "دار النهضة العربية"، لا يمكن البقاء على الحياد. الا ان الاقتراب منها والغوص فيها (في وحولها) لا يخلو من المجازفة. المجازفة بالانسياق اللاواعي (او الواعي) الى مواقف راديكالية، بحيث قد لا يبقى بين الرفض التام حتى حدود نفي جنس النص: "هذا ليس شعراً!"، وبين التبني الخالص الذي لا يساوم على ولائه، قد لا يبقى مكان للمواقف المتريّثة.
حيال مجموعة شعرية على غرار مجموعة "كأنني امرأة مطلقة" ليحيى جابر الصادرة لدى "دار النهضة العربية"، لا يمكن البقاء على الحياد. الا ان الاقتراب منها والغوص فيها (في وحولها) لا يخلو من المجازفة. المجازفة بالانسياق اللاواعي (او الواعي) الى مواقف راديكالية، بحيث قد لا يبقى بين الرفض التام حتى حدود نفي جنس النص: "هذا ليس شعراً!"، وبين التبني الخالص الذي لا يساوم على ولائه، قد لا يبقى مكان للمواقف المتريّثة.
بعيداً من الاحكام المطلقة، يعمد يحيى جابر هنا الى ولوج الشعر من بابه الخلفي. لكنه ولوج مدوٍّ هذا الذي يحققه. اقتحام نزق لا يأبه لأي شروط او قواعد او قوانين، سوى تلك التي تمليها اللحظة الحارة. نحن في التخريب حتى اقصاه، حيث فضاء القصيدة ينفتح على كل شيء، وخصوصاً على ما اتُّفق على رميه خارجه. هل يمكن ان نسمّي ذلك اعادة تدوير للغة؟ البحث في نفاياتها عما يصنع قصيدة؟ ربما، لكن الاكيد ان الشاعر ينزع هنا عن اللغة لحمها الميت. يرمي خارجها ما ألصقته بها دواعٍ جمالية بدأت ظرفية قبل ان تتجذر كخلايا سرطانية خبيثة، ولا يُبقي الا لغة الاندرغراوند البدائية، لغة الشارع الخام، في كل فطريتها التي تراوح بين مزاج زجلي شعبوي على الطريقة اللبنانية، وواقعية قذرة هي سليلتها العالمية. نحصل تالياً عما يمكن ان نسمّيه الشعر - التراث، الأنتي - شعر الذي يطيح كل الجماليات المتعارف عليها وينسف الموروث الشعري نسفاً تاماً، القديم منه كما الحداثي كما المعاصر.
في هذا الشعر المضاد لن نجد المفردات والعبارات والصور "النظيفة" والسياحية في معنى من المعاني، واذا وُجدت فلأنها بنت لحظتها الاصيلة لا الأحكام الجمالية المسقطة من الخارج. هو شعر لا يهمّه ان يسمو بالحياة الى مصافٍ ما، بل نراه ينزل الى قاعها، "يتمرمغ" في وحولها قبل ان يقدم نفسه مضرّجاً بها، موارياً عطوبيته خلف فكاهة سوداء او حمراء او صفراء او مهما يكن لونها. لكنها فكاهة تخريبية يرفدها بنبرة لاذعة ومتّقدة، تنبض بالحياة في صلب لحظات الغضب والعشق والحزن والوحدة والحب والخيبة والفقد والسعادة الموهومة. ذلك كله في اسلوب لا يخلو من بعد مسرحي من حيث طريقة تأطير اللقطة العاطفية وتحديد مسارها الدرامي.
"لا يهمني رضى سيبويه/ أشبّه وجهك/ بقرص الفلافل في المقلي البحري/ وإن تململ الفراهيدي في قبره/ آخر همي!". بهذا النزق اللامبالي الذي لا تخلو نبرته من تعنّت طفولي على شيء من الافتعال، كأنما لا يهمّه الا ان يكون "ضد"، بغض النظر عن جمالية موقفه، يفتتح الشاعر مجموعته بسلسلة من القصائد قد لا تكون افضل ما في الكتاب الا انها تشكل نقطة انطلاق الى شعريته لا يمكن اهمالها: "لن أقول وجهك شمس/ أو قمر/ وجهك/ يا روح شراب التوت/ يا قمر الدين.../ لن أمدّ يدي الى تشابيه الآخرين./ لن أسرق لغة غيري./ أخاف من حبل مشنقة في الليل./ الله يكره اللصوص!!". اذا وضعنا الاستهجان الفوري جانباً، وتلافينا تعليقات من نوع: "لا اعرف كم عدد النساء اللواتي سيسعدن لوصف وجوههن بقرص الفلافل في المقلي!" او: "لا بد ان الطريق الى قلب الرجل يمر حقاً بمعدته!". اذا وضعنا هذا جانباً، يكشف هذا النوع من المقاربات الذي يعتمد التشابيه مع الاطعمة عن ميل حسي وشهواني وفيزيائي يتصدى لتجريدية تشابيه من نوع الشمس والقمر (الذي اكتشفنا انه ليس اكثر من صخور جافة وتراب ميت) يتركها الشاعر لعلماء الفلك او، في احسن الاحوال، لرومنطيقية تقبع اسيرة ادوات بائدة.
تغرق قصيدة يحيى جابر في لحظتها التاريخية، الشخصية والعامة على السواء، ولا تعلن ولاءها الا لاختباراتها المعيشة، بحيث تبدو ابنة خصوصيتها العاطفية الراهنة لا غير. هكذا نجدها تتسع لابي مصعب الزرقاوي، ولليورانيوم المخصب، ولقطارات الانفاق المفجَّرة في باريس ولندن، ولماروني في الشوف، ولمحجبة في باريس، ولسيارة مفخخة في الاشرفية... وايضاً لمفردات عامية او حتى اجنبية: نهستر، ok، what’s up، شو بكِ؟ وسواها الكثير. هذه المفردات والتعابير والصيغ تتبناها القصيدة وتوفر لها المساحة الخصبة لاستقبالها بمدلولاتها الاوسع افقاً.
الا انه، وفي مقابل هذا النوع من الاحالات، يحل الموروث الشعري العربي، القديم منه والاكثر حداثة، ليشكل خلفية الصورة، كما لو لإعلان خروج القصيدة عن بداوتها ومنحها تالياً مسوغاتها المدينية المعاصرة. نستعيد هذا الموروث بشخصياته ورموزه المطاحة: من قيس وسيبويه والفراهيدي، الى محمود درويش ونزار قباني وانسي الحاج... كما نستعيده على شكل تعابير وجمل تعتمد المقابلات الثنائية المباشرة وتأتي نبرتها الفكاهية لتنقذها من فخ الافتعال: "أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري./ وتحب سيارتها "الهوندا" سيارتي "نيسان"/ حولنا لهاث زجاجي/ دخان من اشبمانات الشتاء./ هذا حب... صنع في اليابان"، يكتب الشاعر تحت عنوان شديد الدلالة هو "بداوتي".
من ناحية اخرى، تُسجَّل نقطة مهمة في شأن الصورة الذكورية التي تكشف عنها القصائد. انطلاقاً من العنوان نفسه تتخذ هذه الصورة على طول المجموعة اتجاهين يتكاملان رغم تناقضهما الظاهر: من ناحية، شهوانية حادة لا تخلو من بدائية ما وتولّه جنسي (fetichisme) يجد ارتواءه في نهد حبيبة او في كولونات سوداء. ومن ناحية ثانية، رقة حتى حدود الانكسار: "غضبي ناعم كرفسات جنين"، وعاطفية حتى حدود الغضب الهدّام، وحنان أنثوي مرتبك: "ما تزعلي../ ها أنذا اضمّ صورتك، وأندبك كأرمل"، ايضاً: نزق طفولي لا يخفي ان في خلفيته "جوعاً قديماً لمرضعة".
ودوماً، ثمة فكاهة خفيفة (عندما تبتعد عن السوداوية: "لم تكن ضرورية تلك السفينة/ يا نوح") يلجأ اليها الشاعر ليداري عطوبيته: "هذا حب برعاية "سيليس" سابقاً،/ "ألفا" حالياً./ وأترك الفواتير ليوم الحساب"، يكتب تحت عنوان "اضحكي". او نراه يستخدمها من اجل تحطيم الصورة النمطية للرومنطيقية: "كلما أيقظتُ اميرة نائمة/ بقبلة/ عضّت شفتي"، لتحل محلها رومنطيقية من النوع الاكثر تعقيداً: "الحب خيانة.../ خيانة شخص لا نعرفه/ كان في انتظارنا/ سامحيني... هل تأخرت؟".
هذه العناصر المتناثرة على طول المجموعة، تأتي لتجتمع في القصيدة الاخيرة بعنوان "كيف اصبحت انتحارياً؟"، التي يبلغ فيها الشاعر ذروة توهجه الهدّام. تبدأ على الشكل الآتي: "لو سجد ابليس لآدم./ ... لما أنجبت حواء هذه الشيطانة حبيبتي!"، لتنبني بعد ذلك تصاعدياً في ما يشبه الانفجار الغاضب كأنها مكتوبة "على الحامي". هنا الخيبة العاطفية لا مكان فيها لتأوهات ملتاعة على طريقة الطرب العربي البكّاء، بل غضب متألم وصارخ لا يوفر الشتائم والتنكيل بما كان سابقاً شواهد حب. نعاين هنا فيتيشية من النوع المضاد، ها هو العاشق المخذول يقول عن "القطة الهدية في سان فالنتين": "حسناً، سألتقط القطة من ذيلها، ألوّحها كمحرمة راقص دبكة/ وأدبك.../ سأغطّسها في البانيو/ سأفطّسها في الماء يا بلا ماء./ عيناها تشبه عينيك/ هيا، اجحظي./ ارى ارواحك السبع،/ رغوة تطفو/ واجلس على حافة البانيو/ أدخن/ مثل كلينت ايستوود". ثم يضيف في ما بعد: "سأفتح فمك في الصورة./ وأدس بين اسنانك حبة زرنيخ/ إبلعي./ موتي امامي في الالبوم".
بين دفق الاصدارات الشعرية التي أطلقتها "دار النهضة العربية" اخيراً، وحتى بين اصدارات دور نشر اخرى، يوجِد كتاب "كأنني امرأة مطلّقة" لنفسه مكاناً على الهامش. لا بل على هامش الهامش. كطير يغرّد خارج كل سرب، تأتي المجموعة لتشكل ما يشبه ذروة المسار الذي بدأه في 1988 في "بحيرة المصل" التي فازت بجائزة يوسف الخال للشعر، وتحمله الى اقصى اقصاه. هذا المسار الأدبي المتنوع بين الشعر والمسرح والادب والصحافة التي يتنقل جابر بينها بخفة وتلقائية الى الحد الذي يجعله يضع بعض الكتابات في خانة خاصة بعنوان "الادب السياسي". هذا كله مدعوماً بشخصية تتورّط في نصها الى ما بعد هذا النص، وتحمل الشاعر مثلاً على تذييل الكتاب الأخير بالعبارة الآتية: "لمكاتبة المؤلف مدحاً او هجاءً او رثاءً" في معرض اشارته الى عنوان بريده الالكتروني!
الا ان ما تشي به هذه المجموعة قبل كل شيء ربما، هو وصول هذا الاتجاه الى ذروته، الى حدود الخيط الواهي الذي يفصله عن اللاشعر. في المقابل، نلمس اتجاهاً آخر في الشعر العربي يحمل لواءه شعراء شباب تبدو اللغة معهم كأنها لم تعد ذلك الجدار الذي إما تحطمه وإما تتحطم عليه. لكأن علاقتهم بها لم تعد من النوع الصدامي، وبدل كسرها وتحطيمها نراهم يلجأون الى "ليّها" اذا جاز القول، بمعنى اننا على الارجح لن نراهم يلجأون الى افتعال قصة حب بين "سيارتها الهوندا وسيارته النيسان"، فقط من اجل القول اننا خرجنا من زمن النوق والبعير ولو على سبيل الفكاهة، بل نرى الرموز المعاصِرة تدخل القصيدة في عفوية اكبر.
النهار
9 مايو 2007