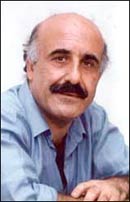 لا أعرف الغاية الشخصية التي حدت بعباس بيضون إلى عنونة مجموعته الأخيرة "ب. ب. ب." على هذه الشاكلة، في إشارة إلى مدنٍ ثلاث هي باريس وبرلين وبيروت، والتي يفرد لكل منها قسماً يضمّنه قصائد من أجوائها، لكن يحلو لي أن أتخيل أنه يتهجأها، كأنما ليشير إلى أننا نظل أبداً تلاميذ في عرف المدن، نتجرّع دروس الحياة فيها درساً درساً، جرحاً جرحاً، ولا نكتفي.
لا أعرف الغاية الشخصية التي حدت بعباس بيضون إلى عنونة مجموعته الأخيرة "ب. ب. ب." على هذه الشاكلة، في إشارة إلى مدنٍ ثلاث هي باريس وبرلين وبيروت، والتي يفرد لكل منها قسماً يضمّنه قصائد من أجوائها، لكن يحلو لي أن أتخيل أنه يتهجأها، كأنما ليشير إلى أننا نظل أبداً تلاميذ في عرف المدن، نتجرّع دروس الحياة فيها درساً درساً، جرحاً جرحاً، ولا نكتفي.
باريس، برلين، بيروت: ثلاث مدن، ثلاثة اختبارات، ووعيٌ مدينيّ للحياة التي تطل هنا خريفية على شكل غيمة موحلة أو جرح في الصدر. وفي هذه الأجواء الملبّدة، وفي هذا الجرح العرضة للبرد، يكمن الخيط الرفيع الذي يجمع بين أقسام الكتاب الثلاثة، وإن على تفاوت في المدى بحسب كل قسم، لنصير إزاء حياة باريسية تنظر بعين متحسرة إلى أحلام هُدرت ذات صيف، وبرلينية متنازَعة بين غربة لغوية وألفة ثقافية، وأخيراً بيروتية لا تتوانى عن إسقاط أصنامها وآلهتها، محقِّقةً مسافةً وقائية بينها وبين الواقع.
في المجموعة الصادرة لدى "دار الساقي"، نستعيد لغة عباس بيضون المعتادة، بوقعها والإيقاع، وبالقدرة التي له على تفريغ القصيدة من غنائيتها الشعريّة وإعادتها في مرحلة أولى إلى حالتها اللغوية الخام، ومن ثم إلى ما يتعدى هذه اللغة. لكن قبل ذلك، نعثر مرة أخرى على اللغة المُعاد تشكيلها وفق قواعد القصيدة الخاصة وليس العكس، والحاضرة هنا في بعديها الصوتي والإيقاعي أولا، ومن ثم في بعدها الدلالي الذي تعيد إنتاجه بحسب ما تقتضيه أصالة هذه القصيدة المشدودة ابداً إلى داخلها. فإذا بالجملة تبتدع إيقاعها وشروطها وصورها وأبعادها الجمالية، فتتوالد العبارات من ذاتها وتسترسل، مشفوعةً ببعد سردي واضح ذي نفس طويل لا ينفكّ يتنقّل بين توكيدٍ ونفي فاستدراك واعتراض ثم تشكيك واستطراد، وذلك حتى حدود إنهاك الجملة والمعنى على السواء. كأنما الشاعر يريد إفراغ العبارة من ذاتها ومما تحمله في الوقت نفسه، فلا يتوانى عن ان يضخ فيها كل احتمالاتها الدلالية حتى حدود تجريدها منها، بحيث لا يبقى في النهاية الا هذا الجوهر الذي يفوق اللغة ويتخطاها، أو يجعل منها بالأحرى قيمة في حد ذاتها خارج حقل المعاني المتعارف عليه الذي تختنق داخله. وبالتالي يصير القارئ مرغماً على التخلي عن أفكاره اللغوية المسبقة وأحكامه الدلالية الجاهزة، لو شاء الدخول اليها وسبر أغوارها.
في القسم الاول بعنوان "كفّار باريس"، نلمس فوراً هذه النظرة إلى المدينة المشوبة بشعور هائل بالعفن والترمّد، وهو شعور سنجده على طول المجموعة كقاسم مشترك بين أقسامها الثلاثة، وإن كان يبدو هنا أكثر وضوحاً ومباشرة. فباريس هنا لا تحلّ بصورتها النمطية المعتادة، أي كفضاء ايجابي خصب ومضيء لمثقف لا يني يعثر فيها على أسباب تحرّضه على الخلق والابتكار. بل نشعر بها مدينة باردة تعبت مقاهيها ومعابدها وحدائقها "لتبدو حقاً أجنبية"، نتنفس فيها هواء ميتاً والغيم يبصق "مخلفات أسماء وأفكار". باريس هنا هي "باريس التي خسرناها"، المدينة التي "تتفل فوق صلعاتنا". كأنما المدن أيضا تشيخ مع الوقت، تستهلكنا ونستهلكها، نظل ننفخ فيها أحلاما وأفكارا وآمالاً حتى يصيبها الجفاف والترهل ويصيباننا، ذاكرةً ولغة، ليحل اثر ذلك "صقيع طويل"، قاتل وحتمي، لأن كل ما قيل ذات يوم "لُفظ في البرد/ ولم يُطل مكثاً في البرد".
"لعبنا على باريس وخسرناها"، يقول الشاعر ويكرر في ما يشبه الإقرار الموجع برهان خاسر، ويضيف: "لعبنا بالكلمات التي غيّرت جنسها/ بالأحرف التي لم تغيّر جنسها/ بأسمائنا النادرة - بأسماء قطعاننا/ وأسماء ديداننا/ بالحظ الأبيض، بالحظ الأسود/ لعبنا بالوشم المأكول/ بميناء أسناننا/ لعبنا... لعبنا". وهنا لا يمكن الا ان نتساءل: هل ينعى بيضون دوراً كان لباريس ذات يومٍ عاجقٍ بالثورات والايديولوجيات والأحلام والأوطان والأسماء، هذه التي حملها جيل بكامله إلى مدينة واحدة في ما يشبه النذور، يوم كان تغيير العالم حلماً قابلاً للتصديق؟ ربما، الا ان الأكيد أنه يسعى إلى مداراة يأسه بإقرار يحاول ان يكون قنوعاً: "لا تأسفي/ كان صيفاً"، يقول، لكنه مع ذلك لا يستطيع ان يخفي حسرةً ما: "ما سُكب على الفراش/ لم يترك أثراً"، قبل ان يقول: "وجهك وحده ثقيل ككوكب/ لكنه لن يعود قمراً"، كأنه يقطع كل أمل في إمكان ان تعود هذه المدينة ما كانته يوماً، مساحة تضج بالحياة وأحلام تغيير العالم.
بين صيفٍ لم يبق منه الا أضغاث ذكريات، وخريف لا ينفكّ يزداد برودة، تصير الحياة "حطباً" نجرّه خلفنا ويترك فينا شعوراً حاداً ومزمناً بالعجز والثقل والشيخوخة يطول مظاهر الحياة كافة حتى الأكثر حميمية منها: "شعركِ ثقيل/ لن تستطيعي رفعه عن المخدة/ لن ترفعي بسهولة مشابكه الكبيرة كالأقفال/ ولا جدائله/ المقصومة من وسطها/ لن تستطيعي/ هكذا هي الحياة/ التي فجأة/ لا نستطيع تحريكها/ بإصبعٍ قصير". حياةٌ هي أشبه بقطارٍ يسير "عكس النهر/ يرحل إلى الوراء/ الشجرة التي تولّي أمام النافذة/ تركض بسرعة/ إلى الماضي/ نرمي رزمنا الثقيلة/ نرمي المحطات/ التي سبق ان اجتزناها/ في العتم السحيق/ نرمي متاعنا كله/ ولا نجد له مصرفاً/ هو ثروتنا/ من قناني البيرة الفارغة/ نرمي الكلّ/ فلا يبقى سوى خيالات على المقاعد/ تقتتل ولا تموت/ ولا ينتبه احد/ إلى ان/ القطار/ قد مرّ". هي فرصة ضائعة باريس اذاً، رهان خاسر، وحلم جرى إجهاضه. هكذا ينظر اليها الشاعر ولا يتوانى عن إطلاق تحذير أخير من الاستسلام لفتنة هذه المدينة التي مهما بدت الأحلام فيها قريبة وفي المتناول، فإنها ستجعلك تفقد نفسك في الطريق إليها: "الطريق تسابق المساء/ ولا تصل قبله/ تصعد أنت من النفق/ فتجد المدينة/ عائمة بالطرق/ دعها تتوثب تحت المصابيح/ ولا يفتنك غناؤها/ غناء الدلافين الضائعة/ الزم الجدار/ لئلا تفقد نفسك وسط اللمعان والزفير".
 وربما انطلاقاً من هذا التحذير، يلتفت صوب برلين، متنبهاً هذه المرة ان يحافظ على المسافة اللازمة بينه وبينها. وإذا كانت باريس تظهر تحت قلمه كهاجس حلمي خريفي بسماء موحلة، فإن برلين في القسم الثاني الذي يحمل عنوان "فصل في برلين"، تبرز كهاجس لغوي أولا وثقافي ثانياً لكن بالسماء الموحلة نفسها والرماد الذي سال من "شهوة لم تتحقق". هاجس يأخذ بدءاً شكل سوء تفاهمات لغوية "غير مؤذية"، قبل ان يترك المكان لمرجعيات فنية وأدبية ألمانية يعمد الشاعر إلى مقاربتها من زوايا مختلفة. لكن هنا لا وجود للالتزام الثقافي في معناه الباريسي. لا رهانات ولا نذور. فالمسافة محققة لا محالة، لغوية ربما قبل أي شيء، وتحول دون تورط الشاعر بالمدينة تورطاً من النوع الباريسي، وتالياً لا يعود ثمة مجال للخيبة. اما التأثير والتبادل فيتمّان بمعزل عما يسميه الحاجة الحارقة إلى اللمس، ف"عليك ان لا تترك بصمات هنا"، وان تكتفي بالنظر إلى العالم من نافذة قطار حيث "الشارع يصفر أمامي وأنا أرى كل شيء بدوني".
وربما انطلاقاً من هذا التحذير، يلتفت صوب برلين، متنبهاً هذه المرة ان يحافظ على المسافة اللازمة بينه وبينها. وإذا كانت باريس تظهر تحت قلمه كهاجس حلمي خريفي بسماء موحلة، فإن برلين في القسم الثاني الذي يحمل عنوان "فصل في برلين"، تبرز كهاجس لغوي أولا وثقافي ثانياً لكن بالسماء الموحلة نفسها والرماد الذي سال من "شهوة لم تتحقق". هاجس يأخذ بدءاً شكل سوء تفاهمات لغوية "غير مؤذية"، قبل ان يترك المكان لمرجعيات فنية وأدبية ألمانية يعمد الشاعر إلى مقاربتها من زوايا مختلفة. لكن هنا لا وجود للالتزام الثقافي في معناه الباريسي. لا رهانات ولا نذور. فالمسافة محققة لا محالة، لغوية ربما قبل أي شيء، وتحول دون تورط الشاعر بالمدينة تورطاً من النوع الباريسي، وتالياً لا يعود ثمة مجال للخيبة. اما التأثير والتبادل فيتمّان بمعزل عما يسميه الحاجة الحارقة إلى اللمس، ف"عليك ان لا تترك بصمات هنا"، وان تكتفي بالنظر إلى العالم من نافذة قطار حيث "الشارع يصفر أمامي وأنا أرى كل شيء بدوني".
عن هذه المسافة التي تبدأ لغوية يقول بيضون: "ثمة أمور لا تقال بلغتين لن يفهموك اذا قلت انك أكلت ذاكرتك تقريباً وتدفأت على النار التي أشعلتها جمجمتك"، قبل ان يعود في قصيدة أخرى للتأكيد مستدركاً: "ما جدوى ان اسمع كلمة عربية في هذا المطر الذي يُسمع بكل اللغات". ذلك ان المعضلة في مكان آخر، في الملاك الذي لم يصرخ في قصيدة ريلكه ربما، او في جدار برلين الذي زرع ميشائيل جزءاً منه في حديقته ليقطع ذاكرته نصفين، او داخل جدران "المتحف اليهودي" حيث "الشهود ماتوا ولم يعد هناك سوى الجلادين المحتملين"، او في الحيوانات الجديدة التي لا تنفك تستيقظ في مخيلة الضمير الالماني، او حتى في ألعاب بروليتارية "صارت في ما بعد وحوشاً".
هنا المعضلة البرلينية اذاً، عند التقاء الفن بالأدب، بالسياسة، وبالتاريخ، والتي تبرز في أبهى تجلياتها في قصيدة عنوانها "تماثيل شايب"، يمكن اعتبارها من أجمل قصائد هذا القسم وربما المجموعة كاملةً، يقول: "خشبيات شايب لن تشفى من الضربات السيئة التي تركتها بكماء إلى الأبد، ولا من رغبتها المكبوتة في رد العدوان./ سيصاب النحات باللعنة ذاتها وسيتخشب شيء في روحه وعينه./ عنف يفوق الفن لذا يترك تشويهات شبه إنسانية. من القسوة الزائدة على الأشياء يولد قبح يشبه طبيعة البشر".
لكن برلين أيضا هي مدينة الحرية القاسية كما يراها الشاعر، "الحرية القاسية مع برد كافٍ دائماً"، برد كفيل هو الآخر ومرة أخرى إيقاظ الحياة التي قد تكون في الجرح، هذه البقعة التي لا تنفكّ تتمدد على صدرك وفي جلدك، فالحياة هنا "تستمر مكشوفة ومشبوهة"، والأخطاء "تعيش طويلاً (...) وتترك بقعاً أكبر". أما الوصية الأخيرة فتأتي على الشكل الآتي: "لا تقل وداعاً مرتين. (...) لن تصيح أيتها المدينة التي غدرتِني (...) هنا لا نكرّر أموراً تقتل/ ولا نسلّم للنسيان/ أشياء لا يقوم بها عادةً".
تحت عنوان "دقيقة تأخير عن الواقع، أبواب بيروتية"، ندخل القسم الثالث الذي يبلغ فيه المنحى "الخريفي" أوجه: "الشيخوخة هنا فصل لا ينتهي (...) الشيخوخة أطول من الحياة نفسها"، يقول بيضون عن الحياة في هذا البلد الذي لم تعد فيه قوة "حتى للأساطير". ويتوقف عند المدينة التي تحاول محو آثار الحرب عنها فلا تنجح الا في ترسيخها و"أيقنتها": "الحروب المتروكة لا تترك كتباً والأثر الوحيد يتركه من يحاولون إزالتها. يفعلون ذلك بوسيلة أسوأ، وسيكون منظرها وهي ممحوة أكثر بشاعة". ثم يلتفت إلى المدينة الجديدة التي نحتال عليها وعلى الذكريات فيها بلغات أخرى نداري فيها خياناتنا المتكررة: "ما من مسدسات اذا قلناها بلغة أجنبية. ستكون آمناً أكثر اذا نقلت خيانتك اليها. لن يهددك ثأر او حرب أهلية". ومن خيانة إلى خيانة لا يتورع عن الاستنتاج المرير الذي ينطلق من ماضٍ، من أحلام مجهضة، ومن حاضر يبدو أسير الحطام الذي فاض عن الزمن البيروتي المحروق: "نعرف عندئذ ان الحرب لا تنتهي ونفهم لماذا نجد القديسين بوفرة هذه الأيام".
إزاء هذا المشهد المحمَّل كل الخيبة والمرارة الممكنتين، وشعوراً بالاختناق بحروبٍ نحاول تخطيها بوسائل أسوأ منها، لا يتوانى بيضون عن الإقرار في عنف ضمني شديد الدلالة: "العطب يولد أيضا كاملاً". من هنا، تصير حال الشاعر، وحالنا جميعاً على الأرجح، مثل حال "س" ذي الرجلين الخشبيتين حيث "الألم هو الفرق الذي لا يلاحظه احد"، و"بين الخشب والجلد لا نسمع المنشار الذي يغنّي". في هذه المجموعة من القصائد بعنوان "ساقان من خشب" (من ص 103 حتى ص 113) يصب كل النزعة الرفضية المنطوية كذلك على شيء من التهكم المرير الذي لا يوفّر عباداً أو آلهة. في إحدى هذه القصائد نقرأ: "هل يمكن لساقين مقطوعتين ان تصعدا مع كثير من النقرس والتقرحات (...) ستظنان ان قدماً عليا في انتظارهما وأنهما ستجدان الملائكة مصطفة كالأقدام السليمة تحت العرش. ستصلّيان لإله الأرجل الصحيحة بالإيمان الذي ينقل جبلاً بحاله ولا يساعدهما على ان يتقدما خطوة". وفي مكان آخر يقول بالحس التهكمي نفسه: "ولدتا لتمشيا وستفعلان ذلك أيضاً. مع ان هذا العصر انتهى في السماء حيث غلبوا الموت وغلبوا الله نفسه بالطاعة، لكن هذه قضية قديمة (...) يستمر الإيمان على الأرض في نقل الجبال وتفجيرها لكن هنا يتحدثون عما بعد الله".
انطلاقاً مما سبق، نفهم المسافة التي يضعها الشاعر بينه وبين الواقع البيروتي: "أصل على الموعد دائماً لكن الوقت هو الذي يتأخر وأقول ان هناك بضع دقائق بيني وبين الواقع"، يقول، معلناً ما يشبه الانسحاب من اللحظة وإيثاره مساحة هامشية في صلب متغيرات يبدو كأنه يفضل مراقبتها من الخارج.
ربما من المبالغة القول ان عباس بيضون يكتب في "ب. ب. ب." انهيار حلم المدينة بنماذجها الثلاثة، الباريسي والبرليني والبيروتي، كل بحسب نسبة التورط فيه ونوعه، لكنه على الأقل يوحي بفصلٍ خريفي يظللها كلها، وبسماء ملبدة بالخيبات والجروح ولا تبدو مستعجلة للإنقشاع.
sylvana.elkhoury@annahar.com.lb
النهار
الخميس 14 كانون الأول 2006