عن حفرة جسدي
1

ليس الفرح سائلاً فيخرج
من الجسم المعطوب بالشظايا
لكن إذا ما اعتصرتني بقوة
ربما يسقط في يدك
قشره السميك الحامضيّ؟
قد كنت أدّخره في شقوق المفاصل
وفرجات اللحم والحلقوم
لمثل هذا اليوم
حين تأبين كل شفاعة
حتى اختناق العيون بالامتنان
2
حين تعانقنا ما
أهديتُ إليكِ
كان جسداً لم أمتلك
ونزقاً لم يخترقني
أو جنوناً لم يصطفني
لم يمسّ ذلك نواة قلبك
التي بقيت كريمةً كشجرةٍ
تجود بما يفيض عن حفرة جسدي
فيُدْرِس أثرها.
نوطة في جمجمة
إلى عباس
1
سيكون خطيراً بالطبع
أن ننسى نوطةً في جمجمة
أو قلم حبرٍ في درج خشبيّ
ما ينشع على حواف الأصداغ أو المفاصل
من أنينٍ مستأنف
قد يوقظ فيَّ من جديد
قوّة السورات أو الطرب
2
الغضب حانٍ بحدب الطيور على أبنائه
فيما الحسد يبري، كالسنّور، أظفاراً
ويجرّبها في الجسد
وحدها القواميس لا تتهيأ
وتقتصر عدواها على أثر الغبار
بعد أن تلاشى إنشادها وخَفَت.
ليس في الساحات غير شجن الملائك وبرد أنفاسها
3
... ويقيناً لو أن للشمس هلالاً
أغزر حضوراً بقليل
لنصبنا من وسواس الترقّب
هرماً مقلوباً منغرزاً في اليافوخ
غير أن للبشارات أفلاكاً
تدور كطائرات ورقية يشدّها
ويطير بها خيط مربوط بهدب الطفل.
أعين غير مستعملة
إلى عباس أيضاً
القصائد كالقطط الوليدة
تجهل أن لديها أعيناً
غير مستعملة
الصمت، كل مرة، طويلاً،
كي أبلغ النسيان
أن أنسى اني أبحث عنه ـ
الصمت كي أعاود تحسس فضائي
بالأصابع
وتلمّس جسدي
بالأصابع
والكلمات
ذلك العيّ يسبر فقرات العنق والظهر
فتولد قطّة من الاضلاع
أو رزمةٌ من الخطط الجهيضة
من سنّ مقلوعة
العالم يلبس معطف الخفاء
غير أن لبعض الكلمات المسنّنة أن تتناتش قماشته
أثر لونٍ ها هنا، او شكل هناك
قد يدومان عشرين قرناً
وأحتاج لساناً أسود لأدلّ عليهما
وأفتح أهدابهما المقذّاة
أحتاج حرقةَ جرحٍ بورقةٍ
أو روعةً قاطعة
عليَّ أن أعمل بهمّة خرساء كي أنسج
شبكة العين
وأرميها على العالم.
صوت كَلَيْل
1
عن صوتٍ كلَيْلٍ
أين المنتأى؟
صوتك الداجي المكحول
بأسىً وسيع
مكنوز
كعتمة القلب
2
في فيئه
الموشى بلمعاتٍ كتيمةٍ
سمر وإنشاد
ظل الظل يحيق بنا
هو، كحدقة حوراء لا تغمض
ولا هو يقرّ
3
لغورها يسبر بأناةٍ
حنجرةً قانيةً تتغرغر بوعدٍ
تتضرّج بأوردةٍ شفقيةٍ
يتقلّب كبرزخ رجراج
بين الحلوق الظمأى والآذان المستغرقة
في متاهاتها الغامرة.
سباق
أولم لأملي
كشحّاذ
يطعم جراءه التي
بها يستجرّ عطف العابرين
أولم لألمي أيضاً
كشحّاذ
يطعم جراءه...
قامرت بكل ما لديّ على هذين
ولم يبق في يدي شيء
ماذا لو أتى
الرضا أسرع الراكضين؟
النهار الثقافي
اغسطس 2010
***
قصائد محبوسة
 في حين كان يرقد عباس بيضون في مستشفى الجامعة الأميركية في وضع صحّي حرج، كنتُ على سفر وعلى عادتي اللعينة في عدم قراءة بريدي الألكتروني، أو المرور السريع على عناوين الأخبار في جرائدنا المحلية، أو فتح هاتفي النقّال. كان يرقد في مُصابه، وكنت في انقطاعي عن كل ما ذكرت كمن تحمي نفسها من عذاب معرفة ذلك المُصاب. حين عدت وعلمت أصابني غمّ وفزع شديدان، ليس خشية على صديق فحسب بل فزع أسود من تلك القوى الجبّارة الخفية، التي تتآمر على الشعر، القوى المجهولة التي نغفل عن وجودها، قوى تستطيع إذا شاءت أن تُضيء التفاهة وتُطفئ نور القصائد وكأن القصيدة ليست إلا عود ثقاب.
في حين كان يرقد عباس بيضون في مستشفى الجامعة الأميركية في وضع صحّي حرج، كنتُ على سفر وعلى عادتي اللعينة في عدم قراءة بريدي الألكتروني، أو المرور السريع على عناوين الأخبار في جرائدنا المحلية، أو فتح هاتفي النقّال. كان يرقد في مُصابه، وكنت في انقطاعي عن كل ما ذكرت كمن تحمي نفسها من عذاب معرفة ذلك المُصاب. حين عدت وعلمت أصابني غمّ وفزع شديدان، ليس خشية على صديق فحسب بل فزع أسود من تلك القوى الجبّارة الخفية، التي تتآمر على الشعر، القوى المجهولة التي نغفل عن وجودها، قوى تستطيع إذا شاءت أن تُضيء التفاهة وتُطفئ نور القصائد وكأن القصيدة ليست إلا عود ثقاب.
هكذا بصدمة كتلة معدن شرسة، هوى الجسد المضطرب، فحزم الشاعر قصائده في رأسه، غافلاً عن عوّاده، متحلقين حوله ريثما يفيق من إغفاءته، فيبهر بالقصائد العيون والرؤوس، مُشبعاً غرور الكلمات التي تتدفّق من حنجرته، سريعة ومؤلمة.
أُحبّ عباس مثلما يُحبّ كل ولد أمهُ وأباه. أحبّهُ على علاّته كما تكون عليها علاّت الأهل ونحبهم. هو الغريب تماماً، وأن يكتب يقترب دفعة واحدة، ودفعة واحدة يُصبحُ حبيباً.
حين عدت من سفري وعلمت بإغفاءته، نمت نوماً عميقاً. لم أنتظر أن يُخيّم الظلام كي أدخل فراشي وأنام، تكوّرت بثيابي مُحتشدة بألم عباس وبالقصائد التي تكدّست في رأسه، وربضت على صدره ككنوز من ذهب في مغارة مسدودة.
في كلمات عباس يمتد مشهد واحد، مشهد موجوع، لكنه عنيد، عناد صلابة جسده، وصلابة فكره.
ارتباك إنساني مُذل هذا النوم يا عباس، وارتباك في رأسك وفي كلماتك المجزوز فروها.
ارتباك هو الحزن، حيث عاشت كلماتك وتحرّكت مُتفكّرة، مُتهيّجة، رطبة وتنزّ شعراً. هو ارتباك يشبه ارتباكي وأنا أكتب زاويتك هذه.
أنا من تبتلع كلماتك، وتُشير إليها بإصبعها وهي تُربّت عليها واحدة واحدة، الآن بسبب من هذه الكلمات المحبوسة في رأسك، أنام كما تنام تماماً، ريثما تفيق لتكتب عن رقدتك وأقرأها، تكتبها كما لو كانت أصابت أحداً سواك.
لن أعودك في المستشفى، وسأنقل وزن جسدي من رجل الى أخرى، أقيس بالغ كسورها، وأتنفّس بعمق، أُعين رئتيك التي عاودت الهواء. لن أزورك، وأبتلع مثلك الكلمات حتى تبادر إليها صريحة وواضحة قريباً.
***
مثقفون عرب يطمئنون على صحة عباس بيضون
شيئاً فشيئاً، يستعيد الشاعر والزميل عباس بيضون عافيته. يتقدّم تدريجاً نحو الشفاء. أمس، تحدّث إلى بعض أصدقائه. تناول وجبته الأولى. تحرر من آلات التنفّس. يحتاج إلى بضعة أيام ليستعيد وعيه الكامل. لكن الوقت كلّه له، كي يعود إلى حياته الطبيعية. كي ينهض كلّياً من فراشه في غرفة العناية الفائقة. ثم يخرج من مبنى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، إلى منزله ومكتبه وأصدقائه وعاداته. والأصدقاء، إذ أقلقهم وضعه قبل أيام وارتاحوا إلى الخطوات البطيئة لكن الثابتة في اتجاه الشفاء، ظلّوا على تواصل مع أسرته وزملائه. اتصلوا هاتفياً. أرسلوا رسائل إلكترونية. زاروه في المستشفى. هؤلاء الأصدقاء لا يرتاحون إلاّ بعد الاطمئنان عليه. لعلّهم اليوم، بعد أمس، باتوا أكثر اطمئناناً.
لم يكتف الأصدقاء والأقارب بهذا. الكتابات الأدبية مستمرة في استعادة أشكال العلاقات المختلفة التي جمعت عباس بيضون بعدد كبير جداً من معارفه ومحبّيه في لبنان والخارج. كتابات جعلت الألم المعنوي أخفّ وطأة، ولا شكّ في أنها ستساهم في تخفيف الألم الجسدي أيضاً عن بيضون، عندما يتسنّى له قراءتها قريباً، إن لم يكن قريباً جداً. فالمؤشّرات الصحية أكّدت تحسّناً ملموساً سبق تصور الأطباء، يتمنّى أفراد أسرته وزملاؤه وأصدقاؤه ومحبّوه هنا وهناك أن تزداد وتيرة هذا التحسن في المقبل من الأيام.
الاتصالات الهاتفية والزيارات مستمرّة، هي أيضاً. نضال الأشقر زارته. هيثم حقي وهالا محمد وسمر يزبك وديمة ونوس وفايزة شاويش (أرملة الراحل سعد الله ونوس) ومحمد مظلوم وأسامة الرحباني اتصلوا. قاسم حداد ومنصورة عز الدين وكاظم جهاد والفرنسي دانيال ريو وعاليه ممدوح وسعيد الباز وجليل حيدر أرسلوا رسائل إلكترونية للاطمئنان. أما الشاعر والروائي التونسي محمد علي اليوسفي فقرأ قصائد لعباس بيضون في مهرجان «سيت» الذي أقيم مؤخراً في فرنسا، وكان زميلنا مدعواً إليه في دورة هذا العام.
السفير
6 اغسطس 2010
* * *
عباس بيضون.. نحتاج إلى صوتك ووضوحك
نعم نحتاج إليك، فلا تذهب بعيدا كما ذهب آخرون. نحتاج إليك شاعرا وناثرا وسياسيا عرف كيف يوائم بين هذه "الأقانيم" الثلاثة. نحتاج إليك في حواراتك التي اعتدنا عليها في مكتبك بجريدة السفير وفي بيوت بعض الأصدقاء، ليس لأنك تعبر عن مواقفنا، بل على العكس، لأننا نختلف معك بحب وود كبيرين، ونبقى أصدقاء. لذلك نحتاج إلى اختلافنا معك، إلى رأيك المختلف معنا، وإلى شعرك الذي لم يتوقف عن التطور والتغيير والاختلاف.
عباس بيضون، الذي يرقد في مشفى الجامعة الأمريكية في بيروت على أثر حادث السير المؤلم، ليس شاعرا متميزا وحسب، وليس شاعرا مختلفا فقط، إنه الشاعر الذي بدأ بالسياسة والحزبية بمعناهما السائد، ثم سرعان ما غادرهما إلى الفهم المستقل للمثقف الذي ينتمي إلى قضية ورؤية ولا يتخلى عن التعبير عنهما، بصرف النظر عما إذا كانتا صحيحتين أو قابلتين للجدل والنقاش، فهو- وحسب لقاءاتنا- شخص جدلي وقابل للنقاش حول أدق التفاصيل، سياسيا وثقافيا وإبداعيا، لكن من الصعب مجاراته لاتساع أفقه الثقافي في مجالات الثقافة كافة.
شخصيا أكتب: هو نمط خاص بين من نعرفهم من المثقفين العرب، وربما كان قريبا من مقولة "إنني أختلف معك، ولكنني مستعد لأدفع روحي في الدفاع عن حريتك في إبداء رأيك". كنت ألتقيه في زاوية من زوايا شارع الحمرا غالبا، فأراه ساهيا في مشيته، قليل الانتباه لمن حوله، حتى أنني أمر بجانبه فلا أثير انتباهه إلا إذا صرخت به "كيفك؟"، فيتوقف ليبدو أنه يعيش في عالم آخر غير عالم شارع الحمرا الغاص بالحياة والجنون، يتوقف كما يخرج شخص من تأملاته و"سرحانه" في عوالمه الخاصة. فهو في طريقه من بيته إلى مكتبه في جريدة السفير يبدو شخصا غائبا في فكرةٍ ما يريد أن يكتبها في مقالته الأسبوعية للملحق أو لزاويته شبه اليومية أو في قصيدته المقبلة.
هل يكون هذا "السرحان" ربما سببا وراء سقوطه ضحية حادث السير الأليم، فهو كما قلت شاعر وكاتب قليل الانتباه لما حوله، فهل عبر ذلك الأوتوستراد البيروتي اللعين دونما تقدير، لتصدمه تلك السيارة اللعينة، أم أن سائقا طائشا صدمه دون أن يعرف أنه عباس بيضون، الشاعر الذي ترك أثرا كبيرا في الشعر العربي المعاصر، وتحديدا في قصيدة النثر العربية؟
وشعريا كان عباس بيضون ممن شكلوا ذاكرتنا الشعرية المختلطة، فقد فتح جيلنا الشعري، جيل الثمانينيات، عينيه على أصوات شعرية لبنانية كثيرة، بعضها من قصيدة التفعيلة (حسن عبد الله ومحمد عبد الله وشوقي بزيع وجودت فخر الدين وغيرهم)، والآخر من قصيدة النثر (خصوصا عباس بيضون وبسام حجار)، وكان من أبرز أصوات هذه القصيدة الأخيرة عباس بيضون، بدءا من قصيدته "صور" تحديدا، التي كانت فتحا شعريا في عالم "شعر المقاومة"، ضمن ما سمي حينه بهذا الاسم، رغم الاختلاف الذي أنبأت به هذه القصيدة- الديوان، وكان تأثرنا بها كبيرا.
لم يختلف موقف عباس بيضون ما بين المراحل التي تنقل بينها، بل ظل عنيدا ومعاندا رغم تغير المواقع، والانتقال من البعث إلى الماركسية ومنظمة العمال ثم وصولا إلى الموقف المناهض للجميع والاقتراب من الموقف المستقل، فقد ظل حادا وملتزما بموقفه المختلف والمغاير، وهو بهذا لم يجامل أحدا، واصطدم بالكثيرين بلا مبالاة بالمخاطر رغم ما تمر به الساحة اللبنانية من كوارث.
ينبغي الاهتمام بشاعرنا الكبير الذي نتمنى له السلامة والعناية، ليعود ويكتب لنا، ليكتب في "نقد الألم" كما كتب في "صور"، وكما كتب في "لمريض هو الأمل"، و"ب ب ب"، وغيرها مما يفجر طاقات الأمل الكامن في قصائد الشعراء الجدد الذين يرسمون مسار قصيدة النثر، أو القصيدة العربية بعامة. وخلال هذا الوقت من غيبوبة بيضون في عوالمه البيضاء نقول لشاعرنا: عد لنا، فما نزال نحتاح إلى كل ما فيك من شعر وأفكار واختلاف.
* * *
متأكد أني طرتُ قليلاً
لا أعرف متى شعرت بأني أفكر. لا أذكر عمري آنذاك ولا هيئتي ولا طولي. كنت نحيلاً ونحيلاً جداً. يتعجب الكثيرون من نحولي ويروزونني بسواعدهم وأكفهم أحياناً مظهرين أنهم لا يشعرون بوزن. كانت أمي تنظر إليّ كممروض وتجتهد في أن تُقيتني بكل ما هو أهم في اللحم. ابتلعت بالرغم مني كثيراً من الطحالات التي تعج بدمها وكثيراً من الكبد النيئ والكروش المحمرة التي أغالب قرفي منها. كانت تلحقني بها وتكرر على سمعي أني ضعيف وأضعف من ريشة. لم أسمن لكن استقر عندي أني ضعيف.
كان أبي معلم المدرسة الوحيد ومديرها يقوم وحده بعدة صفوف، أما أنا فتعلمت القراءة قبل سن الدراسة. كنت ألحقه إلى المدرسة وأجثم في تجويف النافذة، ومن هناك أجاوب بدلاً من التلاميذ. كانوا فخورين بي في البيت والقرية ما جعلني معتداً ومدللاً. هكذا رحت أدفع التلاميذ وأضربهم وأقفز عليهم إلى أن لاحظ أبي أني استبد بهم فقال لهم، ليردعني، ردوا عليه. بهتني ذلك ومنذ ذلك الحين كففت خوفاً. وقع في ظني أنهم سيجازونني ويقسونني إذا تجرأت عليهم. لم يبق حديث أمي عن ضعفي في الهواء. وجد بسرعة محكاً. كنت حقاً ضعيفاً وخوّافاً ولا أجسر على أن أبدأ عراكاً.
لا أعرف متى شعرت بأني أفكر، ولا أعرف ما صلة ذلك بنحولي وضعفي. لا بد من سبب لأفكر فيهما معاً. كنت أخفّ من ريشة، الريشة تفكر بسهولة أكثر من كومة لحم. إذا كان الضعف لا يقوى على العراك فهو أقدر على التفكير. لا بد أن هناك أموراً تجمعهما، فالأفكار هي أيضاً بلا وزن وهي أيضاً خفيفة طائرة، كنت خوّافاً وضعيفاً في حين أن كل شيء كان يحسم عندها بالعراك. لا بد أن هذه الأفكار التي تزورني بلا انقطاع لم تأتِ للاشيء.
كنت أدور مع صاحبي في القرية، لا أذكر أين، فالقرية كلها بهتت في ذاكرتي، وحين زرتها بعد خمسة وعشرين عاماً وجدت جميع ما فيها بحجم أقل بكثير مما تخيلته. البركة أصغر والنهر أقرب والأشجار أقل. أذكر فقط أني كنت أجرّ فيها شنتتي (ثوب كالجلابية) التي عانيت لدى استبدالها بالبنطلون تروما حقيقية وحنيناً فعلياً. لا بد أن اقترنت في بالي بالفضاء والتجول والحرية... والتفكير. كنت حينها ابن خمس أو ست، لا أذكر، لكن بات لي منذ ذلك العمر ماض وصار في وسعي أن أنظر إلى الوراء. لا أعرف من الذي كرهته في البنطلون. أظن أن الشنتة ارتبطت في ذهني بتلك السياحة في الحقول وفي الأفكار. لم أكن أتنقل فيها برأسي فحسب، بل بحسدي وبالطبع بشنتتي. لربما أحسست أن البنطلون يعوقني عن الانتقال بسرعة في أفكاري. إن الشنتة تحملني أسرع. هذه الأفكار التي كانت أيضاً تجوالاً يحتاج إلى الهواء والفضاء والشنتة المفتوحة تؤمن ذلك أكثر. التفكير لم يكن في الذهن فقط، كان يتم بالأيدي والأرجل والرأس ويتم بالمشي والركض بالتأكيد، وحين كنت أفكر أفعل ذلك وأنا أرقص وأقفز وأتعمشق وأطير. لم يكن البنطلون كما توجّست، مواتياً تماماً لذلك، لذا كرهته وظللت وقتاً غير قليل أتحسر على شنتتي. تراءى لي أنه سيثقل حركتي وتفكيري وأنني معه لن استطيع أن أكون فيهما حراً بما يكفي.
التفكير لم يكن أسئلة فحسب. كان في الغالب قصصاً وسيناريوهات. لا أذكر تماماً كيف كان. كان شيئاً يسير من تلقائه وينتشر، نوعاً من سياحة لطيفة. ربما لم يكن الأمر كذلك تماماً، إنما لا بد أن وقتاً مضى قبل أن ننتبه إلى أن هناك فرقاً بين أن نفكر أو أن نعيش، قبل أن نخلص هذا من ذاك. حين انتبهت غمرتني السعادة. كنت عند نفسي الوحيد الذي يفكر، الذين أحجّهم لا يظهر عليهم أنهم يفكرون، يصمتون لحظة قبل أن يقرروا شيئاً، لكن هذا لم يكن التفكير. التفكير لم يكن للاختبار بين الذهاب إلى البركة أو إلى الدكان. لم يكن لأي سبب، كان لنفسه فقط. أن أفكر يعني أن أفعل كل شيء بخيالي، يعني أن يكون هناك واقع آخر في رأسي. أن تكون هناك أمور تحصل بمجرد أن تخطر، فإن هذا إعجازي، سحر خالص، وبالتأكيد امتياز هائل.
كان عالمي، كما أظن، يزيد على الذي لأصحابي أضعافاً مضاعفة. ليس هناك أصلاً سبب للقياس، كنت بالقياس لهم هائلاً. جميعهم لا يملكون ما أملك. ليست لديهم بالأصل تلك الملكة التي أعطيت لي. كنت تحت رعاية خاصة. لي طبيعة أخرى. وحدي، وربما في العالم كله، أفكر.
لي وحدي أيضاً قدرات أخرى، كنت قادراً على أن أفعل بالجسد شيئاً أفعله بالفكر. لم أشك في أن ذلك ممكن حتى وإن لم أفعله. لاحظت في يوم أني أسير بخفة نشابة الطيران. حين فكرت في ذلك بدأ مشيي يشابه الطيران أكثر، لدرجة أني بدأت أسير بارتفاع قليل عن الأرض. بدا أني، على نحو ما، أسبح في الهواء. كان هذا تمريناً يندمج فيه خيالي وجسمي، ولوقت طويل بقيت أمارسه، ولا أذكر متى فقدت القدرة عليه، لكني حتى الآن متأكد من أني طرت قليلاً من قبل.
حين تخليت عن شنتتي عصر قلبي حنين قاس إلى الشنتة، وإلى شيء أكبر من ذلك، لا أعرفه، لكن بدا لي أني أفارقه مع الشنتة. كان الحنين اكتشافي الثاني. دون الآخرين كنت آنذاك الوحيد الذي يحن. سيعترضني هذا الحنين كل فترة من حياتي. كل قفزة ستخلف وراءها ماضياً جديداً لا عودة إليه.
حين غادرت القرية كنت أعرف أني لن أبقى فيها. ولدت فيها وأمضيت طفولتي لكنها لم تكن قريتي ولا بلدي. في هذه البلاد قلما نولد في مواطننا ولا ندين بشيء إلى حيث نُولد. نعرف مهما طال الوقت أننا عابرون وسنغادر في يوم بلا عودة. مع ذلك عصر قلبي حنينٌ ممزوج بالخوف، أو خوف كبير ممزوج بالحنين. كان عليّ ثانية أن أترك بدون أن أنظر إلى الخلف. كنت في الثامنة أو التاسعة يومذاك، لكن بدا لي أننا ننتقل دائماً إلى شيء أضيق. جعلني البنطلون مرئياً أكثر ومسؤولاً أكثر ومراقباً أكثر. أخرجني من الإغفال الواسع الذي خلت أن الشنتة تضعني فيه، وها هو الانتقال إلى المدينة يجعلني مجدداً تحت العين، ولن يكون بعد في وسعي أن أختفي بالقدر نفسه، أو أسوح على راحتي.
الحنين كان أيضاً لعنتي، أو هو طبيعتي الثانية التي أتناساها إلى أن تداهمني مجدداً وتملأني خوفاً من نفسي. ينعصر قلبي لدى ذكر أي فراق. أذكر كيف شق عليّ في فتوتي أن أتخيّل فراقاً لعادة كالتدخين قضى فيها الواحد 40 عاماً. كان هذا بالنسبة إلي خوفاً من الأبدية. أقول في نفسي كيف يستطيع الإنسان أن يترك إلى الأبد شيئاً ما، أي شيء. أتخيل أن في هذا ذهاباً في العدم إلى لا عودة. حين لا تكون هناك أقل فرصة لبقاء أثر ما، حين لا يعود هناك سوى التبدد الكامل.
مع ذلك كان حنيني للشنتة وحنيني للقرية بلا موضوع تقريباً. لعله ليس سوى خوف من شيء أكبر. لم أحاول العودة إلى القرية رغم أن هذا يكلف أقل من ساعة في السيارة. لم أفكر في العودة. لم نعش اللوعة أكثر من يوم. كان همي فقط أن لا يلحظ أحد أنني ابن ريف. بالفعل بدلت لهجتي في ليلة واحدة، فلم ينتبه أحد في الغد إلى أنني أميل بالألف. كأن لم يكن الحنين حقيقياً، وليس سوى فكرة تعذب أكثر بكثير من الواقع، أو كأن ذلك كان معروفاً إلى شيء آخر، إلى فجوة أصلية، وجرح أصلي، لا أعرف متى تكون.
تبدو الأشياء مرعية في الخيال والفكر أكثر مما هي في الحقيقة. ربما أعاني من «ميوب» في عقلي. أعيش في رأسي غالباً وكأني لا أرى أو أرى دائماً بشيء من الانحراف.
وصلت إلى صور ابن تسع تقريباً، منذ أن اجتهدت لأنخرط، ونجحت بمقدار. تقدمت، ما حسبت أنه يكفيني ولم أتجاوزه. فعلت ذلك بتصميم وكلفتني كل خطوة شيئاً من العناء. وكان لا بد من أن أتوقف قبل مسافة وأن لا أكمل. الاندماج لا يتم بإرادة وحساب، وأنا لم أملك حتى الفضول لأفعل. لم أكن مهتماً. بقيت هكذا بين بين. أنجح حين لا يجربني أحد في أن أبدو صورياً. صحيح أني لم أتقن السباحة، لكن لم أكن الوحيد. لم أعرف بما يكفي أخبار الحي وأهله لكن أحداً لم يمتحني. بالطبع لاحظوا شرودي لكن الأسوأ كانت ملاحظتهم لتفوقي. تباهيت بقدرتي على قراءة القرآن وتلاوته، وكان هذا أعلى بكثير من قدرات أولاد جاؤوا من بيوت لم يروا فيها كتاباً، لكنه لم يكن، مع ذلك، تحدياً حقيقياً. لم يكونوا قادرين على فهم أن شيئاً كهذا قد يكون مجالاً للتسابق. لقبوني «الشاعر»، لكن بعضهم مرقها على «الشارع». كان تفوقي على رهان خاسر، جرحني هذا لكني لم ألبث أن تسلّيت. امتلكت باستمرار هذه الحياة الموازية التي أطير فيها على كيفي. لم أندمج كلياً. لم أكن بحاجة إلى الاندماج، أخذت منه حاجتي وما بقي بقي لي. كنت ألعب وحدي. ألعب بخيالي وقدمي معاً. لم أكن بحاجة إلى آخرين. أقرأ ساعات وأغيب في القراءة إلى أن أنتبه لصياحهم يدعونني إلى الغداء. اتعمشق على سطح المطبخ لأصل إلى الدالية المنشورة فوقه، ثم أسقط بخفة عنه كالعصفور. لي أصحاب في الصف لا أشاركهم في اللعب. أصحاب في الحي ألعب معهم باحتراس. الاحتراس هو طبيعتي ولا أصل إلى تطابق مع أحد وشيء. في رأسي باستمرار هذا الفرق غير المرئي الذي يجعلني جانباً.
بقي لي أيضاً، ما حسبته، تفوقي بالفكر والخيال وبعدهما بالقراءة والكلام. هنا لا مجال للمقارنة، لم أحتج حتى لإظهار قدرتي. تفوقي على أصحابي ثم على أساتذتي كان واضحاً. تقدمت فيه بسرعة شيطانية. كنت من هذه الناحية طفلاً متعملقاً، أما هم فلا أعرف كيف كانوا يرونني. استضعفوني بالتأكيد، وكنت أرتجف منهم وأحمي نفسي بجواب سديد، أو استعطاف خفي، حتى يجعلني أقواهم تحت حمايته...
([) مقتطع، غير منشور، من كتاب للزميل عباس بيضون بعنوان «مرآة فرانكشتاين»، يصدر قريباً عن «دار الساقي»، تليه مقاطع أخرى في هذه الزاوية، ننشرها تباعاً، إلى أن يتعافى شاعرنا وكاتبنا، ويمسك قلماً وورقاً، ويعود قريباً إلى الكتابة.
***
عباس بيضون... شقيق ندمنا
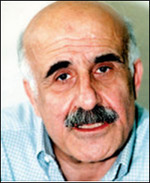 قليلون يعرفون أن عباس بيضون لم يعدّ نفسه ليكون شاعراً في البداية. لقد بقي حائراً فترة طويلة. يكتب ويتوقف عن الكتابة، معتبراً أنّ الشعر لا يكفيه وأنه كالغناء واللهو، وأن الناس يكتبون شيئاً آخر أكثر جدية في حياتهم. والواقع أن السبب الفعلي لحيرة عباس وتأخره، بالتالي، عن إعلان نفسه شاعراً مردّه إلى شغف بالعمل النظري والفكري. كان حلم عباس أن يكون مفكراً، ولم يغب هذا عن باله حتى بعد قبوله بصفة “الشاعر” وممارسته الشعرية الطويلة التي نشر خلالها 13 مجموعة شعرية. إضافة إلى حلم “المفكر”، انخرط عباس في العمل السياسي والحزبي المباشر، وتوقف خلالها ست سنوات عن كتابة الشعر وسجن مرتين، الثانية منهما في معتقل إسرائيلي، قبل أن يعود ويكتب قصائد سياسية وتحريضية أشهرها “يا علي” التي غنّاها مارسيل خليفة وذاع صيتها وأحبّها كثيرون. إلا أن عباس تبرّأ منها، ولا يزال يرى أنها مكتوبة في مديح شخص قام بعمل إرهابي.
قليلون يعرفون أن عباس بيضون لم يعدّ نفسه ليكون شاعراً في البداية. لقد بقي حائراً فترة طويلة. يكتب ويتوقف عن الكتابة، معتبراً أنّ الشعر لا يكفيه وأنه كالغناء واللهو، وأن الناس يكتبون شيئاً آخر أكثر جدية في حياتهم. والواقع أن السبب الفعلي لحيرة عباس وتأخره، بالتالي، عن إعلان نفسه شاعراً مردّه إلى شغف بالعمل النظري والفكري. كان حلم عباس أن يكون مفكراً، ولم يغب هذا عن باله حتى بعد قبوله بصفة “الشاعر” وممارسته الشعرية الطويلة التي نشر خلالها 13 مجموعة شعرية. إضافة إلى حلم “المفكر”، انخرط عباس في العمل السياسي والحزبي المباشر، وتوقف خلالها ست سنوات عن كتابة الشعر وسجن مرتين، الثانية منهما في معتقل إسرائيلي، قبل أن يعود ويكتب قصائد سياسية وتحريضية أشهرها “يا علي” التي غنّاها مارسيل خليفة وذاع صيتها وأحبّها كثيرون. إلا أن عباس تبرّأ منها، ولا يزال يرى أنها مكتوبة في مديح شخص قام بعمل إرهابي.
عودة عباس بيضون النهائية إلى الشعر جاءت بعد قراءته للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس الذي يسميه “المعلم الشخصي”، فقد عثر فيه على لغة لطالما فضّلها في التفكير والكتابة. لغة مادية وجزئية ومسنّنة وشيئية ومحايدة وقاسية وبلا رحمة. تأخّرُ عباس بيضون في الإعلان رسمياً عن نفسه كشاعر، رافقه تأخّرٌ في النشر أيضاً، وكان ذلك بسبب كسل النشر لا كسل الكتابة والاقتناع بها هذه المرة. وهكذا نشر مجموعته الأولى “الوقت بجرعات كبيرة” (1982) وهو في الثامنة والثلاثين. وكانت قد سبقتها قصائد وكتب كاملة لم ينشر منها سوى قصيدة “صور” التي أنهاها عام 1975 ونشرت بعد عشر سنوات. والفضل في ذلك يعود إلى الروائي إلياس خوري الذي احتفظ بنسختها الوحيدة أثناء الحرب ونشرها لاحقاً في مجلة “شؤون فلسطينية”. مع ريتسوس، وقبلها إليوت وريلكه وبيار جان جوف، وجد عباس نفسه ولغته. وحين كتب قصائد مجموعته الأولى كان ذلك بإيعاز ريتسوسي راح يعثر، في ضوئه، على نبرته الخاصة. هذه المجموعة التي كانت بمثابة إعلان عن بيان شعري شخصي لم تستمر لغتها سوى فترة قصيرة. ظل عباس محتفظاً بحساسيته وافتتانه اللغوي ذاك، إلا أنه أفصح، في مجموعاته اللاحقة، عن تدرجات وطبقات واختبارات وتحولات بلا حصر. في “الوقت بجرعات كبيرة” (1982) نجد حياداً سردياً، جافاً على سطح جملته الشعرية ورطباً في أعماقها. ونقع على جملة متولّدة من نفسها في “نقد الألم” (1987)، ولغة قاسية ومسننة في “خلاء هذا القدح” (1990) و“حجرات” (1992)، ولغة وقائعية تقريباً في “أشقاء ندمنا” (1993)، ولغة عضوية وبيولوجية وفضلاتية في “لفظ في البرد”(2000)...
عباس بيضون أحد أهم شعراء الطور الثاني في الشعر العربي الحديث. عاد أخيراً من مؤتمر “طاولة الأصوات الحرة” الذي أقامته منظمة “دروبينغ نولدج” في برلين، بمشاركة كتّاب ومفكّرين وإعلاميين من أنحاء العالم. وتصدر قريباً ترجمة فرنسية لبعض أعماله الشعرية عن دار “آكت سود” (برنار نويل وكاظم جهاد)، في انتظار أعماله الشعرية الكاملة، لاحقاً، في لغة موليير.
الاخبار- ٢٦ أيلول ٢٠٠٦
***
بريد لندن
عباس و«نقد الألم»
 لا أعرف لِمَ لم يؤخذ كلام عباس بيضون عن الألم على محمل الجد. أقصد على محمل شخصيّ. الألم مفردة أثيرة عند عباس. ومع ذلك أسيء فهمها. مع ذلك ظلت تعاني وحدها أو تكلّم أشباحها. قد يكون السبب ظنّنا أن عباس لا يتألم، وأن القصيدة، أو الكلمات، هي التي تفعل. الكلمات التي يجرجرها، بلا رحمة، فوق الحصى والدبش والأخلاط وحطام الحب والجسد. ظلَّ الألم حكراً على الكلمات، وظلّت الكلمات مقيمة في قلعة القصيدة. ترفع نُصباً لغوياً للألم، نعجب به ولكننا، للغرابة، لا نصدّقه. الألم هناك في الكلمات. والكلمات، في زمن موت المُنشئ أو تواريه عن صنيعه، لا علاقة لها بالجسد، رغم أنها تطلع منه! اخترع للألم ألف اسم، أعطاه ألف قناع، سيكون جميلاً، وربما قوياً، أن تفعل، ولكن ليس علينا أن نصدِّق. ولأن الشعر مجاز، نظنُّ أنَّ الألم مجاز أيضاً. فالشِّعر لا يُصدَّق. كلما كَذب كان أحسن!
لا أعرف لِمَ لم يؤخذ كلام عباس بيضون عن الألم على محمل الجد. أقصد على محمل شخصيّ. الألم مفردة أثيرة عند عباس. ومع ذلك أسيء فهمها. مع ذلك ظلت تعاني وحدها أو تكلّم أشباحها. قد يكون السبب ظنّنا أن عباس لا يتألم، وأن القصيدة، أو الكلمات، هي التي تفعل. الكلمات التي يجرجرها، بلا رحمة، فوق الحصى والدبش والأخلاط وحطام الحب والجسد. ظلَّ الألم حكراً على الكلمات، وظلّت الكلمات مقيمة في قلعة القصيدة. ترفع نُصباً لغوياً للألم، نعجب به ولكننا، للغرابة، لا نصدّقه. الألم هناك في الكلمات. والكلمات، في زمن موت المُنشئ أو تواريه عن صنيعه، لا علاقة لها بالجسد، رغم أنها تطلع منه! اخترع للألم ألف اسم، أعطاه ألف قناع، سيكون جميلاً، وربما قوياً، أن تفعل، ولكن ليس علينا أن نصدِّق. ولأن الشعر مجاز، نظنُّ أنَّ الألم مجاز أيضاً. فالشِّعر لا يُصدَّق. كلما كَذب كان أحسن!
* * *
ليس دليلي على تردّد مفردة الألم عند عباس، وما يشعُّ منها، كتابه الشعري الموسوم بالمفردة ذاتها (نقد الألم). ذلك دليل سهل، ولعله يضاعف سوء الفهم. هناك معجم كامل للألم، للجرح، عند عباس بيضون: العقاقير، المراهم، الأقراص البيضاء، التعقيم، الشرايين، المصل، الدبابيس، الخرف، الندوب إلخ.
نقرأ لعباس عن الألم ونظن أنَّه أنين الكلمة، عن الأرق ونعتقد أنَّه رنينها أو إيقاعها الداخلي. هل نُقرأ، كلّنا، هكذا؟ هل تترك كلماتنا هذا الانطباع لدى الآخرين الذين هم نحن؟
* * *
الأغرب أن عباس بيضون بدا (لي على الأقل) أشبه بشخوص الأنيميشن. تقفز من بناية، تنطرح على سكة حديد، تهرسها مدحلة، تسوّى أطرافها بالأرض ولكنها تنفض نفسها وتنهض! فلا جرحها يسيل منه دم، ولا سقوطها من حالق مؤلم، ولا دحل أطرافها يترك طعجة فيها، فها هي تنهض، أمامنا، شقية، كاملة، عنيدة، كعهدنا بها.
ومع أنني أعرف أن لعباس أرومة في الجنوب (لها امتداد في الأردن) لكنه، لسبب ما، بدا لي أنه مقطوع من شجرة.. تلك التي تشبه حطّابها.. فهو ليس مثلنا تشغله العائلة، وتربكه الجيرة، وتفتت أعصابه استحقاقات البيت، وينكّد عليه أقارب قادمون من بعيد!
هل هذا ما جعلني أعتقد، حتى في اللحظة التي كان يرزح فيها تحت غيمة الخدر الثقيلة، أنه سيعود؟ أنه سينجو من تلك المكيدة التي يسقط فيها غيره بسهولة، أنه سينفض نفسه ويلملم أطرافه التي تناثرت، في سهوة عادية، وينهض؟ ربما.
* * *
عباس غامض رغم أنه يتكلم كثيراً، رغم أنه، تقريباً، لا يسمعك وأنت تكلِّمه. فكيف يكون المرء غامضاً وهو يتكلَّم بلسانه ويديه وصلعته وشاربيه الكثين؟ ربما لأن عباس لا يتكلَّم عن نفسه. نادراً ما سمعته يشكو أو يبوح، فإن فعل يغمغم. كلامه غير شخصيّ. وكل كلام غير شخصيّ يزيد مساحة الغموض. فهل نعرف عباس فعلاً؟ لست متأكداً من ذلك. نعرف كيف يفكِّر في الشعر والسياسة والفن التشكيلي، ولكن لا نعرف ماذا يخبّئ خلف قفصه الصدريّ المُربَّع.
* * *
لكن الأكيد (وقد كتبت هذه الأسطر، باستثناء الفقرة الأخيرة، في لحظة خدره الطويلة) أنني أردته أن يقرأ كلماتي ويضحك، أن يحكَّ صلعته ويغمغم بما يشبه القول: هل أنا هكذا؟ وها هو أصبح، كما علمت، قادراً على ذلك.
سلامات يا عباس.
* شاعر أردني
الاخبار- ٤ آب ٢٠١٠
*****
عباس بيضون... الوقت بجرعات إضافية
(هيثم الموسوي) نواصل نشر نصوص وردتنا من مثقفين ومبدعين وأصدقاء للشاعر اللبناني، بعد التجربة الصعبة التي مرّ بها. صاحب «زوّار الشتوة الأولى» تشهد حالته الصحيّة تحسّناً تدريجياً، ومن المتوقّع أن يغادر المستشفى قريباً
 «حين تتقدّس الكراهية... حين يظن المثقف نفسه أنّه الله»، مقالة قرأتها في جريدة «السّفير» عام 2008 لعباس بيضون، في وقتٍ كان فيه الغليان السياسي سيّد الموقف، ولغة التخوين المتبادلة خبزاً يومياً. فلا بأس باستنشاق فكرة من هنا، والارتشاف من كأس اتهامٍ محلّاة بالصراخ، ومزيّنة بـ«قلوبات» توقّع عودة الاغتيالات والانفجارات.
«حين تتقدّس الكراهية... حين يظن المثقف نفسه أنّه الله»، مقالة قرأتها في جريدة «السّفير» عام 2008 لعباس بيضون، في وقتٍ كان فيه الغليان السياسي سيّد الموقف، ولغة التخوين المتبادلة خبزاً يومياً. فلا بأس باستنشاق فكرة من هنا، والارتشاف من كأس اتهامٍ محلّاة بالصراخ، ومزيّنة بـ«قلوبات» توقّع عودة الاغتيالات والانفجارات.
معمعة مدوّخة أودت بنا إلى القرف، وأصبح التواصل بيننا شبه مفقود. تصوّروا مثلاً أن امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم لكن من غير مذهب، تقول بعد ثلاثين سنة على زواجها: «إللي بيتزوج من غير مِلتو بيموت بعلتو». هذا عدا عن انقسام طلاب المدارس والجامعات، حيث انسحب ذلك على كيفية توزّعهم على المقاعد... إلى أن قرأت مقالة عباس بيضون عن المثقف الذي أوصله غروره إلى أن يظن نفسه الله. مقالة تعرض لمسألة الكراهية والتخوين المجاني. جاءت المقالة في وقتها، فما كان مني إلّا أن اعتمدتها موضوع الدرس. وزّعت الأوراق على التلاميذ، فسألوني «من هو عباس بيضون؟... لم نسمع به من قبل».
طرحت تلك المقالة للنقاش لأكثر من سبب: أردت أولاً تعريف تلاميذي إلى كاتب اسمه عباس بيضون، الشاعر والمفكّر والكاتب. وفكّرت ثانياً: لعلّ ما كتب بيضون يسهم في تخفيف حدّة التشنج لدى تلاميذي، وينمّي فيهم روح النقد والتحليل.
هكذا كان مدخلي إلى عباس بيضون وتعرّفي الشخصي إليه، وأنا التي تعرفه منذ سنين طويلة عبر شعره الذي لا يشبه شعر أحدٍ من مجايليه. يشبهه وحده، بفكره وحدّته وقساوته وعبثيته وابتعاده عن العاطفة الظاهرة والمباشرة المعروفة... وذات يوم التقيت بعباس مصادفة في الطريق، يمشي ورأسه محنيّ صوب الأرض. أخبرته بما فعلت بمقالته. وكانت مناسبة لأبلغه إعجابي بكتاباته. قلتُ له: «بمقالة واحدة، كنت أشدّ تأثيراً مع تلاميذي من مناهج عام دراسي كامل». وطبعاً دهشتُ لتواضع ذلك الشخص الممتلئ ثقافة وظرافة. هكذا أصبحنا أصدقاء، عباس وأنا. أستشيره في أمور الكتابة والشّعر والنشاطات الثقافية، هو المقيم في الحي نفسه الذي أقيم فيه، لا تحلو جلسة الأصدقاء من دونه.
عباس بيضون الذي يرسم مساراً في الثقافة اللبنانية، الشاعر الملتقط الإشارات، والرجل العبثي المتّهم بالسهو والنسيان، يكتب بدقّة فائقة، وتحمل نصوصه أبعاداً بوليفونيّة. لكَم كنت أعجب لشروده ومشيته الضائعة في حيّنا. لا يلحظ من حوله، ويكتب عن كلّ ما حوله. لا يسمع من يناديه، لكنه يلتقط كلّ الأفكار والإشارات العابرة في الجوار.
عباس بيضون، عليك أن تعرف أنه ليس في مقدورك أن تنهزم، ما زال الوقت مبكراً لذلك. بحاجة نحن إليك وإلى ينبوعك الدفّاق شعراً ونقداً وضحكاً وإبداعاً.
ليس في مقدورك أن تضيف عبوساً على المشهد القاتم يا عبّاس. أقولها لك الآن، أتجرّأ على ذلك بعد أن تخطّيت الخطر، وفتحت عينيك مفتّشاً عن محبيك وهم كُثُر. أنت من يفرش جلساتنا شعراً وسخرية من حياة مهدّدة، سماؤها ملبّدة بالبكاء. عليك أن تتجرّع الوقت بكميات إضافية وكبيرة من الشفاء، لأننا في انتظارك، وانتظار ما ستكتبه بعد تجربتك مع ما يشبه «الموت»، كما فعل كتّاب بارزون بينهم محمود درويش بعد خروجه من موته الأول.
لا تترك المقعد طويلاً ينتظرك. البطاقة لك. التقطها جيداً، وعُدْ إلى قرّائك مع كل النصوص التي تنتظر أن تخرجها إلى النور...
* رئيسة «حلقة الحوار»
جنبلاط والفأل الحسن
عباس بيضون في حالة تحسّن ملموس، بدأ يتعافى من آثار صدمة السيّارة التي تعرّض لها قبل أسبوعين على جسر فؤاد شهاب في بيروت. بعد نقله من غرفة العناية الفائقة، استعاد الشاعر اللبناني نشاطه في القراءة اليوميّة. ونظراً إلى تجاوبه مع العلاج، وعودته إلى تناول الطعام طبيعياً، فإنّ الأطباء يفكرون في إمكان مغادرته المستشفى ونقله إلى منزله خلال أيام. صاحب «مقعد لشخصين» يستقبل الزوّار في غرفته في المستشفى، وقد زاره أول من أمس، للمرة الثانية، النائب وليد جنبلاط، وأهداه رواية ساراماغو «سنة موت ريكاردو ريس».
الاخبار
١١ آب ٢٠١٠
* * *
الزاوية المصدومة
هذه الزاوية اخترعها عباس بيضون، وقد اتفقنا مؤخراً ألاّ تذهب في إجازة مع صاحبها، وألاّ تنتظره ليعود، أو تخضع لمزاجه. هذه الزاوية وجدت ليبقى نبضها وتستمر مشاغبتها وضحكها ونقدها وسخريتها السوداء والبيضاء والرمادية. اليوم موعد عباس في «الإشكال». كنا نذكّره به عندما يصل يوم الأحد إلى المكتب، وغالباً ما كان يضرب رأسه بيده شاتماً ذاكرته المثقوبة، ويقول امهلوني عشر دقائق ويكون النص معكم، ولا ينسى أن يقول: «صرت مهنياً زيادة على اللزوم»... اليوم لم يكتب عباس بيضون «إشكاله» ولم ينسَ، لكننا نحن ضربنا رؤوسنا، وضرب كفاً بكف العديد ممن ينتظرون دبابيس نقده وسخريته، خائفين أو مهللين.
كان يمكن لعباس أن يكتب «إشكاله» من المستشفى، لو أن الأطباء فكوا عن دماغه رباط المورفين. فهو لا يحتاج إلى الوقوف أو الجلوس كي يكتب، فوجع الظهر المزمن صالحه مع الكتابة ممدداً على السرير، أو على صوفا المكتب.
أملنا أن عباس لن يتأخر عن الكتابة، اطمئنوا، أصدقاء وخصوماً، إنْ خانته رجلاه في معاودة «المشي المقدس»، فإن يده معه، ونحن حواليه، وسوف يكتب عن حادث «تافه» عاكس رياضته المسائية، أو عن قضية كبرى تخرج من تفصيل بسيط في السرير. وسوف لن يترك للثقافة وحدها أن تلوّن حبره، فالسياسة متربعة أيضاً في ذاكرته وله فيها قول كثير، لأنه، أساساً، لا يطمئن عليها في أحضان السياسيين، ولا بين أقلام المحللين السياسيين.
لن يتأخر عباس عن الكتابة، خصوصاً كتابة هذه الزاوية، التي أرادها مشاكسة، ومساحة «للزعرنة» أحياناً، ومسرحاً للأسئلة المفتوحة على السخرية والغضب وصيد الهفوات، والغوص الحر في شؤون وشجون الثقافة، حتى لو أدت الحرية إلى بعض الفوضى، فلا بأس ببعضها، الذي يكون أحياناً أهم من النظام، بحسب عباس.
لا نستطيع أن نسلّم هذه المساحة لأصدقاء عباس، فصفحات الجريدة كلها لا تكفي ليعبروا يومياً عن علاقتهم به، وحاجتهم إليه، وتمسكهم بصحته، والدعاء له بالشفاء، ورغبتهم في أن يسمعوا ويقرأوا، في أقرب وقت، تعليقاته الساخرة التي تتفتق بالضحك.
هذه الزاوية تنتظر عباس بيضون بشوق ولهفة وتعطش. هي زاوية مصدومة مثله، ومثل أصدقائه، الذين لم نكن نتخيل أن يصلهم هول الحادث بهذه السرعة، وأن تنقله وسائل الإعلام، وتتناقله الوسائط الالكترونية بهذا الأسف وهذا الحب.
لن نخفيك يا عباس أن كثافة الاتصالات، منذ الصباح الأول الذي طلع على وجهك المثلّم بالألم، كانت أكثر من طاقتنا على التحمّل، وأن المتصلين من لبنان وأنحاء العالم، على مدار الساعة، لم يكن يهمهم إلا الاطمئنان على صحتك وقلمك وروحك وجسدك وضحكتك. ونحن موعودون بأن عينيك وضحكتك سوف تتفتح معاً، وردَ وفاء لأصدقائك ومحبيك وقرائك ومريديك.. والجميلات التي تعبر قبلاتك فوق خدودهن.
السفير
26 يوليو 2010
***
إرتكابات بيضونية
 غافلني عباس بيضون واستغلّ فترة سفري وغيابي عن البلد وذهب في مشيه اليومي الذاهل، مُستدرجاً سيارة الى صدمه، ما لبث أن أكل حديدها الصلب نتفاً من جسده، داخله وخارجه.
غافلني عباس بيضون واستغلّ فترة سفري وغيابي عن البلد وذهب في مشيه اليومي الذاهل، مُستدرجاً سيارة الى صدمه، ما لبث أن أكل حديدها الصلب نتفاً من جسده، داخله وخارجه.
غافلني وكنت، أنا التي أمارس أمومتي عليه وعلى كافة زملائي في المكتب، لنصحته به.
لو لم أكن على سفر، بالكورنيش البحري يمارس عليه هوسه بالمشي، حيث مشهد المياه المتنامي الى ما لا نهاية، حيث الممّر الرحب للمشاة والإضاءة الناعسة الخلاّبة، وفي المقابل الرحمة الإيحائية يُشعلها القرب الغامض من الماء.
كان لهذا المشي على الكورنيش البحري الذي كنت لنصحته به لو لم يكن غافلني في أثناء سفري، سطوة روحية لا تُثمّن على سلامته. لكنني كنت مسافرة، وغافلني وذهب يمشي على الأوتوستراد بهناءة أرنب في حرج، لا يُعكرّ صفو خطواته فحيح سيارات مسرعة، مؤرقة في تبرّؤئها من المشاة العابرين، كل العابرين متيقظين وغير متيقظين، فكيف بعباس المتعثّر العبور أساساً بين مكاتبنا وكراسينا وفناجين قهوتنا.
على 'الرينغ' وفي المناخ المُسمم من ذكرى الحرب الأهلية المتخثّرة فيه، أطلق عباس لرجليه حرية المشي والإرتفاع قليلاً حدّ الطيران. والحال أن مشيه هناك قاطعاً ' الرينغ' لم يكن الأول، سبقته مرّات من الإرتكابات البيضونية التي أخبروني عنها في ما بعد.
شريط من الرعب أراه يلتصق بعادات لعباس جهد الى نكرانها، وأرخى عليها ظلاً في فسحات صمته. عادات يصطفيها صنف من الناس الغريبين، ويصل معها الأمر الى حدّ خسران أنفسهم، لكن عباس ينجو دائماً، ولا تتمهّل المكائد على جسده الصلب، وبجرعات فكاهاته نفسها يُدافع عباس عن عمره.
حين زرته في المستشفى مُمدّداً على سريره نائماً، وقد ألبسني الممرض المسؤول عنه في غرفة العناية الفائقة، مريولاً ليمونياً شفافاً واقياً من الفيروسات، فاح من مشهده هكذا، إحساس يربط بين كتاباته وأهوائه. لا أتحدّث عن رقدة مريض عاديّ، وإنما عن الصلة المباشرة بين طريقة نوم عباس وأسلوبه الكتابي. رقاد مشحون بنفاد الصبر، وشعرت أنا القريبة من أنفاسه أنه ما زال في عناد المشي، ويلهث من فرطه. ماذا يحصل إذا بقي يمشي نائماً، محروماً من التوقّف، من نعمة الإستيقاظ تحوطهُ وتُنجيه؟. عبّاس! ناديته نداء خافتاً، احد أصدق النداءات التي ناديته بها طوال فترة عملنا معاً وصداقتنا. عبّاس! لم يُجب، لكأن نومه الآن يمتلك مغزى ومنطقاً في سياق أرقه المعروف، وفي هيكل تودّده المزمن الى النوم الذي لم يصالحه يوماً، ورقاده الذي يعمّه الآن أفضل ما حصل له في المطلق. عبّاس! لم يرّد بل فلش نوماً إضافياً أمامي وبين يدّي، والحال أن دخول الأطباء لم يُعنّي على مزيد النداء، فخرجت وحيدة من دون صوته، بغية الهروب من عالم الأطباء العدائي باستخدام لطفي كحجة للإنسحاب، فضلاً عن إحساسي بالوحدة القصوى، والإهانة من عدم ردّ عباس، وكنت أرغب أن يفعل لأوقن أن نومه هو مجرّد نوم .
تريّثت على باب غرفته. عيناه مغمضتان كثيراً وشفتاه رقيقتان على نسق شفتيّ عجوز.
جاهدت للإشاحة عن وجهه، كما لو علّق عليه إبتسامة ونسيها مُعلقة حتى ما بعد الحادث.
عبّاس أحد أصدقائي، ويعرفُ من أيّ روح تحدّرت، وهو نائم تركته للأطباء منسحباً من معرفتي. ثمة ناس لايمكن تركهم على حالهم، ومناداتي المتكرّرة له، هو النشاط اليتيم الذي أتممتهُ بعد عودتي من السفر ومعرفتي بما جرى له. عباس، قلتها في الأسانسير الذي ينقلني الى مدخل المستشفى في رغبتي الى تبديد خشية تشبّثت بي.
كان طلب إليّ ذات يوم أن أحفظ عن ظهر قلب بعض الشعر القديم الذي يحفظه، وأعارني بعض أبياته. فهمت لاحقاً أن قدر القصيدة الحديثة وحياتها وأحقيتها، تشبه قدر وحياة وأحقية تلك القديمة، وأن 'القصة وما فيها' كامنة في جمالنا نحن. جمال من يكتب وماذا يكتب، وليست قصيدة حديثة أو قديمة. لم أُحبّ تماماً الأبيات التي حفظت لكنها متّعت قصيدتي بحاسة سادسة أعانتها على الهرب من الرداءة والقبح.
في طريق عودتي الى البيت، راودتني بعض الأفكار في شأن الفظاعة التي تُكمن لكل منّا في بعض مفاصل حياته، لكنني كنت واثقة تماماً وأعرف، أنه ينجو.
القدس العربي
8/13/2010
***
من أصدقاء عباس بيضون.. باقات كلام
لم يضئ عباس بيضون قلمه بعد، ولم يخبر أصدقاءه عن الحادث الذي تعرض له ذات ليلة بموهبته الحكائية المعهودة، فبعض العتمة لا تزال تربض على مخيلته. هو مسكون ببعض القلق، نعم، لكننا بتنا مطمئنين تماماً على صحته، إذ قد يغادر المستشفى غداً، بعدما تعافى تماماً من جروحه. ينتظر أسابيع قليلة كي يطلق قدميه للريح، ويطلّق سريره الذي كثيراً ما كان سبباً في انزعاجه. هو في سريره يقرأ جريدة الصباح، ويقلب في بعض الكتب التي تصله إلى المستشفى، لكنه يؤجل القراءة المكثفة والكتابة المركّزة إلى موعد ليس بعيداً.
منذ اليوم الأول للحادث كان علينا أن نتلقى وكل أصدقائه القريبين اتصالات يومية لا تتوقف، من لبنان والخارج. أصدقاء كثر علقوا أوقاتهم للسؤال عن صحة عباس، معهم مثقفون يعرفون جيداً أن من تعرض لحادث خطر هو واحد من أخطر المثقفين العرب، بل علم من أعلام الشعر في العالم. لم تهدأ الأسئلة، فعدد كبير من الأصدقاء كرروها يومياً، وعبروا عن خوفهم ثم عن اطمئنانهم، ثم عن فرحتهم بخبر مغادرته القريبة للمستشفى.
كان عباس يبدو مرتبكاً أمام عيون زواره في المستشفى، لا يحب لحظات الضعف تلك، وإن كان يُكبر فيهم حبهم واهتمامهم ودعاءهم الحار له بالشفاء. إلا أن بعض الأصدقاء رأوا أن يكتبوا له بعض كلام لطيف، وهو يستعيد نفسه بالقراءة، فتكون نصوصهم أول ما يقرأ، ويكون الحب أول عنوان للصداقة، ثم تكون هذه الصفحة في «السفير الثقافي»، التي طالما لوّنها بجرأته ونقده وأفكاره، وعوّد العديد من القراء انتظارها على جمر الأحداث الثقافية وحتى السياسية، حاملة باقات الكلام المهداة إلى ذاكرة عباس.
تطول لائحة المهتمين بالسؤال عنه عبر الهاتف من الخارج، حتى أن البعض تكبدوا مشقة الحضور للاطمئنان من قرب، كما فعل فخري كريم رئيس مجلس إدارة جريدة ومؤسسة المدى، الذي زاره أكثر من مرة. وكان الفنان مرسيل خليفة العائد للتو من سفر آخر من زار صاحب قصيدة «يا علي» أمس. وبلفتة كريمة كان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط زاره للمرة الثانية، ولمرة ثالثة زاره أيضاً وزير الصحة محمد خليفة. وتطول اللائحة، لكننا نعتذر عن ذكر العديد من الشخصيات، فالمجال هنا مفتوح لنصوص تمسّد قلب عباس وتفتح عينيه واسعتين على بحر من المحبة.
***
الآتي إلى الشعر من غربة صديقٌ يُحسَب حسابُه
في الستينيات، يوم كان أدونيس يحرر الصفحة الثقافية في جريدة «لسان الحال»، لصاحبها الراحل جبران الحايك، جاءني بمجموعة أوراق وقال لي، على عادته حين يعجب بنص، «خذي انظري».
كانت نصوصاً غير موزونة، أدهشتني شعريتها، وفاجأني ألقها وتوترها، فاجأني بالأخصّ غياب كلّ قصد جمالي بالمعنى المعروف الغالب. كان فيها فورية وفوران بل عنف لاجمالي عفوي مدهش. فكرت في نفسي: من أي منبت سرّيّ وعر ثريّ يطلع هذا الفتى؟ وقلت لأدونيس: عرّفني إليه.
عندما طلب مني عباس كتابة مقدمة لأعماله الشعرية، سألته عن تلك النصوص التي طالما طالبته بنشرها. فقال إنها نصّ «البحر» المنشور مع قصيدة «صور». لا ذاكرة عباس في هذه الأمور مرجع ولا ذاكرتي عادت كذلك.
صحيح أنّ نصّ «البحر» هو من تلك الأجواء، لكنه، بحسب انطباعاتي، أقلّ عنفاً (على الرغم مما يميزه من العنف). فوق ذلك، يقول عباس إنّ نص «البحر» كتب في مطالع السبعينيات، وكانت مجلة «مواقف» قد بدأت الصدور منذ 1968. وبالتالي ما كنت سأعيد تلك النصوص الأولى إلى عباس قبل أن تُنشَر في «مواقف». لكنني لم أناقش عباس لأنني لم أملك دليلاً يطمئن ويحسم.
وعندما أفكر في عباس تحضر تلك النصوص الغائبة الحاضرة في بدائلها، يحضر شعور غامض بدغلٍ شعريّ ضاع منّا؛ ولا تفارقني الرغبة في البحث عمّا تكون النصوص العديدة التالية التي أضاعها هذا الشاعر المسرع في المكان والزمان. أتذكّر الآن شعراء صمتوا أو توقفوا عن الإعلان عن أعمالهم، ولا يهدأ في رأسي البحث عما يمكن أن يكونوا قد كتبوه، عمّا يمكن أن يكتبوه في الصمت؛ كما لا يفارقني الهلع من احتمال ضياع هذه الممكنات النادرة. ولا أتوقف الآن عن تصور ما يمكن أن يجتمع في رأس عباس، وهو راقد في سرير الإصابة، من غيوم الشعر المثقل بالأسرار.
عبّاس صديق حاضر، لكنه قلّما يحضر عمليّاً، لأنه قلّما يتذكّر موعداً (لا أقصد مواعيد العمل)؛ وإذا تذكّر جاء متأخراً. وإذا تأخّر فإنه يُنتَظَر. حتى أستاذه في السوربون جمال الدين بن شيخ انتظره ذات يوم طويلاً، كي يصل ويلقي مداخلته أو بحثه حول الشعر الحديث. لكنه متى وصل نظنّ أننا نحن من أخطأ حساب الوقت.
عباس بيضون من مجموعة مثقفين (في لبنان خاصة) لا نقدر أن نرسم ضفاف معرفتهم، ولا حدود قدرتهم على المفاجأة، وعلى ابتداع الرأي والموقف.
وهو صديق حقيقيّ بلا أي التباس. حقيقيّ إلى درجة أنه لا يمكن أن يجامل صديقاً أيّاً كان الموقف. وأنا شخصيّاً أستشيره (متى استطعت) وأحسب حساب جوابه، لأنّ جوابه جواب عارف لا يعرف المجاملة. ويدهشني في عبّاس احتفاله بالآخرين في شكل خاصّ. أقرأ ما يكتبه حول الشعراء، وأحتفظ به وأعود إليه.
ولا يمكن أن ننسى أنّ عبّاس بيضون من نخبة في لبنان قادرة على التوجّه، بلهجة واحدة ودرجة واحدة من الحرص والعدل والصدق والمعرفة، إلى جميع الأطراف المتناحرة. هذه النخبة التي منها عباس هي صوت ضميرنا الجمعي الأصفى.
وعباس فوق ذلك كله والد الرائعين بانة وزكي.
خالدة سعيد
(باريس)
***
«حيث يوجد الخطر ينمو أيضاً ما يساعد على النجاة»
في باريس، رأيتُ فيكَ ما فاتني أن أراه في لقاءاتنا المتقطّعة في بيروت، وكذلك في غرناطة حيث التقينا مرّة وكنّا قريبين من لهاث لوركا المنتشر فوق التلال القريبة من «قصر الحمراء» وحدائق «جنّة العريف»، وقريبين من نشيده الذي لم يتمكّن من إخماده القَتلَة. ألا تزال تذكر؟
في المرّة الأخيرة، ذهبنا معاً إلى متحف «غيميه» للفنّ الآسيويّ وشاهدنا معرضاً للفنّان الياباني هوكوساي الذي ترك أثره على عدد كبير من الفنانين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. على غير عادتك، لم تتحدّث كثيراً ذلك اليوم. وكلامك الذي يفتتن بنفسه ويفتن سامعيه لم يتدفَّق كشلاّل. لحظة صمت رافقتنا إلى المقهى المجاور، ربّما لأنّ أعيننا كانت مثقَلَة بثمار ما رأت وحلّ فيها ما يشبه الخَدَر الجميل. استوقفتني تلك اللحظة يا عبّاس لأنّها انطوت على إشارة، والإشارات، كما تعرف، تبقى في حالة حَمل دائم.
اللقاء الذي سبق هذا اللقاء جاء قبل يوم واحد من عودتك إلى بيروت، وكنّا احترنا بين معرضَين جديدَين: الأول في «متحف بيكاسو» ويتضمّن أعمالاً لبيكاسو مستوحاة من أولغا، المرأة التي عاش معها الفنان علاقة عاصفة ككلّ علاقاته العاطفية، والثاني في «متحف الفنّ الحديث»، وكان معرضاً استعادياً شاملاً لبيار بونار.
لستُ أدري لماذا وقع الاختيار على بونار. ربّما لشعورنا بأنّ متحف بيكاسو بعيد، داخل منطقة «الماريه»، وأنّ ذلك يتطلّب منا وقتاً أطول، وكنتَ تحصي وقتك وتجعل الثواني تنوء بما كنت تريد حينها أن تحمّلها إياه.
داخل المعرض لفتتني عينكَ التشكيلية وثقافتها المرهفة. ونسيتُ لبرهة أننا نأتي من مكان يندر التواصل فيه الآن بين أنواع الفنون المختلفة، وبينها من جهة وبين المعرفة ككلّ، من جهة أخرى.
كان حاضراً في حديثنا وتجوالنا بين أقسام المعرض، الفنان اللبناني الراحل شفيق عبود الذي كان يروي لنا مازحاً كيف أنه، لفرط تأثره ببونار، يشعر بأنّ الفنان الفرنسي يسرق منه أفكاره. كان عبّود يعيش هاجس الكمال نفسه الذي عاشه بونار. ومن المعروف عن هذا الأخير أنه كان يلاحق أعماله في المتاحف، متحَيّناً الفرصة «لروتشتها» بالريشة التي كان يخفيها في جيب معطفه... لا أزال أذكر بأيّ طريقة تحدّثتَ عن بونار وكيف وصفتَ لعبة اللون والضوء في أعماله التي تفيض بالضوء. ولفتتكَ اللوحات التي تمثّل المرأة وهي تستحمّ، والمرأة الخارجة من حوض الماء. في تلك اللوحات، لا يعود استحمام المرأة حدثاً عادياً على الإطلاق.
أتذكَّر الآن وأذكّركَ بذلك كلّه، مع أنّي أعرف أنّك لا تحتاج إلى من يذكِّرك بهذا الموضوع، وأنّ بعض اللحظات التي نعيشها لا تدخل في خانة الذكريات لأنها من طبيعة ما يحضر على الدوام.
تأخرتُ عمداً يا صديقي في الكلام على الأمسية الشعرية التي جمعتنا معاً في «المركز الثقافي المصري» إلى جانب أحمد عبد المعطي حجازي وحسن طلب. كانت العاصمة الفرنسية يومها مليئة بالتظاهرات، وكان الطلاّب يجوبون الشوارع، فيما كنتَ أنت، من وراء زجاج المركز المطلّ على حديقة اللوكسمبورغ، تتحدّث، بجرأتك المعهودة، عن واقع الشعر. تشير إلى «الشعراء» الذين أحيوا تلك الأمسية وقد شبّهتهم بالفرسان الذين أبوا إلاّ أن يموتوا واقفين وجاؤوا ليشهدوا على النهايات. كنتَ وأنتَ تعلن حقيقة الوضع الذي آل إليه الشعر كأنما تعلن عن خسوف ما، وفي الخسوف، في الغالب، شيئا من نهاية العالم.
كنتَ تتحدث عن موت الشعر بالطبع، لكن بأسلوب مختلف. بأسلوب يبدو معه الشعر حياً أكثر من أيّ وقت مضى. وكان كلامكَ دقيقاً وجارحاً، وكان عابثاً. لكن هل تظنّ أنّ ما آل إليه الشعر ينفصل عما حوله، أم أنه جزء مما آل إليه العالم نفسه والذي يظنّ أنه قادر على العيش بدون الشعر وبدون الأسطورة والحلم والفنّ والفكر والفلسفة والجماليات؟ وبقدر ما كنت تستطرد في الكلام، كان يحضرني «دونكيخوته» لثرفانتس. فهل تحوّل شاعر الزمن الحديث إلى دونكيخوته، أم أنّ الزمن الذي يشيح بنظره عن الشعر، إنما يبتعد عن المفاهيم الثقافية التي ينتمي إليها هذا الصنف من الإبداع، ماضياً في اتجاه ثقافة أخرى، من نوع آخر؟
قلتَ في تلك الأمسية إنّ الشعر لا ينازع، بل يموت. تكلّمتَ على موته بجمال آسر وبشيء من السخرية العالية المبطّنة بوعي ثقافي وسياسي عميق. شعرتُ وأنتَ تنعى الشعر كأنكَ تنعى مرحلة تاريخية بأكملها، وتنعى ثقافة عرفتها البشرية منذ خمسمئة عام قبل الميلاد، أي منذ أن تمّ ابتكار الحوار الفلسفي على ايدي الفلاسفة الإغريق. ذاك الحوار الذي لا يقلّ أهمية، في مسار الإنسان وسيرورته، عن ابتكار الكتابة، وقبلها اكتشاف النار. بل إنّ اكتشاف الحوار هذا كان ناراً أخرى أخذت البشرية إلى فكر عصر الأنوار وفلسفة القرن التاسع عشر وصولاً إلى النصف الأول من القرن العشرين. كانت الأسئلة الفلسفية التي طرحها فولتير وديدرو وكانت ونيتشه، بداية مواجهة جديدة للإنسان مع نفسه ومع الكون...
لماذا لا نقول إننا على عتبة زمن جديد يا صديقي، بل داخل هذا الزمن الذي يحتاج منّا، بغية التعبير عنه، إلى لغة بل لغات أخرى جديدة؟ وأنتَ من أولئك الذين ينحتون تلك اللغة بأدوات معرفية ونقدية، وتنحتها أيضاً في سجالاتك وفي ما تغذّيه من حوار نفتقده الآن، لكننّا سنتابعه معك، بلا شكّ، في وقت قريب. وسنردّد معاً قول هولدرلين: «حيث يوجد الخطر، ينمو أيضاً ما يساعد على النجاة».
عيسى مخلوف
(باريس)
***
حالة تخصني أيها الشاعر
ها أنت تستعيد وعيكَ بعد أن غادرك أياماً، لا ندري إلى أين... ربما إلى استراحة، وربما إلى جولة داخل أقانيم الزمن!!
تستعيد وعيك، أو يعود إليك، ربما نادماً وآسفاً على فراق من له كل هذا العالم الداخلي، الثري، وقد أتحت لهذا الوعي التجوال فيه.
تستعيد وعيك، فنعد أنفسنا، نحن أصدقاءك ومحبيك، بعودتك القريبة إلى سابق عهدنا بك، إلى لقائك على صفحات جريدة «السفير»، وفي مكتبك فيها، نقرأك، وتحدثنا بطلاقتك المدهشة.
أيها الصديق القديم، العزيز دوماً. لا أدري ما الذي جعلني أعيش معاناتك بعد أن استعلمت عن تفاصيل الحادث الذي وقع لك. لعلها حالة مماثلة تخصني وقد ركدت طويلا في الذاكرة، أو لعله ذلك الزمن المديد الذي كرّس لصداقتك حضورا خاصا عندي، أيقظه هذا الحادث المفاجئ الذي وقع لك ورحت أتملاه غير مصدّقة!!
اعذرني أيها الصديق على قول ما قد لا تكون قادراً اليوم على التفكير فيه. ولكن تمثلي لمعاناتك ألح عليّ، وعلى ما جاء من الكلام إلى فمي وقلمي، فحررته بقوله.
دعني إذاً أخبرك الآن عن إعجابي الفائق بما قرأته لك مؤخراً في الملحق الثقافي لجريدة «السفير». عنيت النص المقتطع من كتاب سيرتك «مرآة فرانكشتين» الذي ننتظر، بشوق، صدوره.
استوقفني ما ذكرته عن علاقتك بالحنين، إنه مدهش، فهو يعبّر عن حالة إنسانية مرهقة. وحد من الكتابة الإبداعية القادرة، شأن كتابتك، على نقلها من الخاص إلى العام.
أما ما تقوله عن علاقة الولد، الذي هو أنت، بالآخرين الذين كنت، كما تذكر، ترتجف منهم، فإنه بتأكيدك أنك طرت قليلاً، وبالتالي علوت فوقهم، فيرتقي إلى مستوى الأدب السحري.
لقد ذكّرني ما قرأته من سيرتك بقصيدتك الطويلة عن صور. ولئن كانت هذه القصيدة، «صور» هي من أجمل ما قرأته، يومذاك، شعراً، فإن ما قرأته من سيرتك، «مرآة فرانكشتين»، هو من أجمل ما قرأته من أدب السيرة الذاتية.
إنه حَفرٌ داخل الذات يتسم بالعمق والصدق والجرأة، أي يتسم بما يميز كتاباتك كشاعر، وسارد، ومثقف يكتب في السياسة والفكر والأدب.
أيها الصديق الجميل نحن بانتظار عودتك إلينا معافى. محبتي ودعائي لك بالشفاء القريب.
يمنى العيد
***
شكراً لأنك نجوت
شكراً يا عباس لأنك نجوت. هكذا سنحبّك أكثر. سنحبّك لأنك عاندتَ وقاومتَ وأظهرتَ أن لك جسداً ذا صلابة وقوة رغم كل ما يبدو عليه من ضآلة وخرق، وروحاً تطفو كالزيت فوق مياه التخلّي، وقدَراً متواضعاً بالرغم من غواية تكرار مصير أبيك وأخيك. وسنحبّك يا عبّاس أكثر لأنك جنّبتنا مرثيةً أخرى وحداداً ومواتاً لا ينقطعان، ولأنك رأفتَ واستجبتَ فخلّصتنا من نهاياتٍ لا تني تطحن أفئدتنا وتكشط أرواحنا الرقيقة المهلهلة.
شكراً لأنك نجوت وأنت شاعر «الانتحار» و«شقيق ندمنا» والرائي القاطن «مدافن زجاجية». أعرف كم يشبه شفاؤك المعجزُ هذا كراهيتَك للقسوة ونفورَك من العنف، رحمةً مقيمةً فيك أبداً، وصبراً وقدرةً على تحمّل طعنات الحياة. وشكراً لأنك أدركتَ أنك لو متّ، كنا سنقتلك عجزاً وقهراً ونكاية بالله.
الآن وأنا على يقين من أنك عائد أيها الحبيب، لك منّي سلام وقبلة وكرسيّ فارغ متروكٌ لك، «لمريض هو الأمل».
نجوى بركات
(باريس)
***
من شـدّة الشـعر
أرجو، في البدء، أن ترى هذه السطور النور وقد صار في وسع عباس بيضون أن يرى وجوه أحبّته، الحاضرين معه هناك، في بيروت، والشاخصين إلى سريره من أربع رياح الأرض. ثمّ لعلّي، كما فعل كثيرون غيري، أستذكر في هذه المحنة مجموعة بعينها، «لمريض هو الأمل»، تعينني في عيادة هذا المريض الحبيب، كما تشدّد الأمل في أنه سيتعافى قريباً.
وقبل سنوات، في تعليق على هذه المجموعة، استذكرت أنّ عباس يكتب قصيدة نثر ممتازة منذ مطلع السبعينيات، وليس منذ أواخرها كما هو شائع. ولقد جرّب وجازف وتمرّس وأنجز، وكانت أطوار مشروعه الشعري مُلزَمة موضوعياً بالاختمار في سياق مزدوج الضغوط: مآلات القلق التعبيري المضطرم الذي اكتنف نماذج «الموجة الأولى» من قصيدة النثر العربية الخمسينية والستينية، وأقدار السكينة التعبيرية التي هيمنت على الكثير من نماذج «الموجة الثانية»، وهدّدت مراراً بزجّ قصيدة النثر في عماء أسلوبي مستكين إلى شكل واحد متماثل، خامل أو مُعْرِضٍ عن التجريب.
ولم يكن في وسع عباس أن يتنصّل من مفاعيل الضغط الأوّل حين كان الزخم التطويري العارم يقود قصائده الناضجة الأولى بعيداً عن نهايات الموجة الأولى، كما لم يكن من حقّه أن يتخفّف من استحقاقات الضغط الثاني حين أخذت القصائد ذاتها تلعب دوراً ريادياً إزاء بدايات الموجة الثانية. وهكذا ظلّ الصوت الأبرز الذي حمل أعباء تلك الحقبة «العالقة»، وتحمّل عواقبها أيضاً! على سبيل المثال، قصيدته الطويلة «صور» (كُتبت عام 1974، وصدرت في كتاب عام 1985)، لم تكن باحة خلفية لأيّ من الكبار أبطال الموجة الأولى، ولكنها في الآن ذاته لم تكن ملاذاً طليعياً يستريح في فيئه السواد الأعظم من الحائرين، أبطال الموجة الثانية: كانت «صور» معياراً رفيعاً لشعرية أخرى تتعامل مع التحدّيات الجديدة التي لا مهرب منها، وكان عباس أشبه بأقصى القياس في تدوين قواعد ذلك التعامل.
ننتظره، إذاً، نحن قرّاء الشعر، لأنّ حاجتنا إلى ذلك القياس الأقصى ليست ماسة جمالياً فحسب، بل هي عارمة «من شدّة الشعر» أيضاً، كما كانت دعد حداد تقول.
صبحي حديدي
(كاتب سوري مقيم في باريس)
***
عباس بيضون حاضراً في مهرجان «سيت» الشعري
عندما اتصلت بي مديرة مهرجان «سيت»، السيدة مايتي فاليس بلاد، لتهيئة قراءة من أشعار عباس بيضون، أؤديها بالعربية بينما تقرأ ترجمتها الممثلة إيزابيل بوشلستراد، لم تكن أمامي إلا مشكلة واحدة: النصوص العربية غير متوافرة. طلبت محرك البحث غوغل، لكن المشكلة كانت في عدم توافر اللغة العربية على لوحة المفاتيح. وقبل محاولة اللجوء إلى اللوحة الافتراضية خامرني شك في أن إعدادات الحاسوب قد لا تتضمن اللغة العربية الأمر الذي سيدخلني في متاهة البرمجة، وربما التخريب! لذلك غيرت وجهة البحث إلى صور عباس بيضون. وعندما رأيت صورة له في موقع «جهة الشعر» استبشرت خيرا... وتوفيقا.
وكانت النتيجة أفضل من ذلك بكثير: فالقصائد الموجودة بالفرنسية، والتي لا بد من البحث عن أصولها العربية في الأنترنت كانت هي نفسها وبالترتيب نفسه أيضا:
رئيس التحرير الزائر- عباس بيضون - في ملف من إعداد ناظم السيد.
هكذا عثرت على قصائد الحديقة الألمانية (يوميات برلينية) المتكونة من أربعة وعشرين مقطعا، تفي بالحاجة وربما تزيد عن الوقت المخصص للقراءة مع الترجمة.
[[[
يكفي ان تصير هنا لتستحق كل شيء.
لغتك ونقودك باطلة، حياتك صنعت في مكان آخر لكن تعال
ايها الغريب تعال وتستحق كل شيء.
لن يسألك احد عن اسمك، ان جرحا في صدرك يعني اكثر بالتأكيد. مفتاح صغير سيعطيك كل هذه الابواب. لا تنظر اليه حائرا كاللص، انه ليس اكثر من مفتاح صغير. لا تخف من هذه القدرة ستنساها بعد وقت. النافذة تعطيك ايضا الخريف والبحيرة. انك تملك كل شيء وعليك ان تعرف متى ترده.
الجمال يستمر طويلأ بعد ان نتوقف عن انتظاره. الكتب تبقى طويلأ بعد ان ننساها. تعال ايها الغريب يكفي ان تصير هنا لتستحق كل شيء.
[[[
قبل الموعد المحدد يوم الخميس 29 تموز/ يوليو، وكان بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت فرنسا، امتطينا الحافلة التي ستأخذنا إلى بانوراميك سانت - كلير. والمكان كما يدل اسمه البانورامي يقع على تلة عالية تشرف على البر والبحر والسماء.
كان الطريق مذهلا في تعرجاته. لكن المفاجأة الأكبر كانت في قوة الرياح العاتية! تشبثتُ بأوراق عباس بيضون، المبعثرة دائما، حتى في سيت:
[[[
أوحلت السماء، تفكر أن الرائحة المحبوسة لا بد ستهرب من البراد، ان عليك أن تحمل عارك بعيدا عن الغرفة. تقول بأي سرعة تتكوم الصحف. لماذا وضعت طعاما على طاولة الكومبيوتر؟ حيث على أسوأ الأفكار أن لا تترك اثرا؟
إنهم يعرفونك من قمامتك ونحن لا نملك سرا أمام الخادمات.
السماء أوحلت وهكذا يمكنك أن تهرب بجريمتك. الطبيعة تترك بلا خجل قذارتها على الطريق، السماء تبصق بلا احتياط.
تستطيع أن تدفن بلا حرج قميصك الوسخ لكنك لا تقدر على أن تتحرر من كلمة غير مناسبة.
أوراق كثيرة على الأرض، حتى لغتك تترك بقايا...
لكن الخادمة من بين كل الأشياء المرمية تعيد كل
كلماتك المكروهة.
على العكس ستجد فوق سريرك نقودك الصغيرة وبطاقاتك.
وحدك عليك أن تغرقها.
ثم ان أحدا لن يعرف أنك وضعت كلمات كثيرة زائدة في قصائدك. المعاني المسروقة بعناية، والتي كبدتك رحلات طويلة، ضائعة بينها. هناك أيضا الطفيليات المتسللة من حقول جيرانك، عليك وحدك أن تغرقها.
[[[
ومع هبوب الريح التي تغلبنا عليها؛ إيزابيل وأنا، بمزيد التمسك بأوراق عباس، وعلى الرغم من زئيرها المتواصل، كان الميكروفون قادرا على إحضار ارتباكات عباس بيضون، للمنصتين إليه، عبر وسيطين، ولا شك أن عباس وصل إليهم أيضا من خلال التقديم لسيرته الذي قرأته إيزابيل، وتفاصيل الحادث كما تحدثت عنه أنا... وصلهم ممزوجا بأنين الريح وحفيف الأوراق واضطراب الموج ... هناك في الأسفل...
محمد علي اليوسفي
([) شاعر وكاتب من تونس
***
لستَ مِن شعراء الطرق الآمنة
مريد البرغوثي
أنت لست من شعراء الطرق الآمنة على أي حال. إنه حادث مرور يا عباس. دعنا نحصره في هذا الحيّز: صدمة فمستشفى فعلاج فشفاء فعودة إلى ما تتقنه في كل الأحوال: الكتابة. الكتابة في تعريفها العفيّ، أي الكتابة التي تجد لها أنصارا حقيقيين وخصوماً حقيقيين، ثم عودة إلى ملحق «السفير» الذي أعطيته وأعطاك لنكون نحن الرابحين، ثم عودة إلى المرور مجددا عبر الطرق التي تريد وتختار كما يليق بشاعر مجازف أدمن الصدامات التي تؤدي إلى جدل لكنه بلا نزف. أنت لست من شعراء الطرق الآمنة، وهنا بالضبط موقع قلبك وعقلك وخطاك. معناك في شجارك الدائم مع «بستانيّ حياتك». ولأن الدنيا عدوّة لكل شغَف، سوف تستمر في المجازفة الجميلة. إنه حادث مرور يا عباس، غادره بسرعة وعد حتى نتشاجر معك قليلاً، وربما كثيراً لكن بدون مرارة، فمن هدايا الثقافة لأهلها أن نجد من يخالفنا الرأي برأي هو صاحبه الأوحد.
عباس بيضون، لك السلامة.
مريد البرغوثي
(شاعر فلسطيني مقيم في القاهرة)
***
كم أحبّـه
هدى بركات
لن تقول لي نجوى أختي الحقيقة. تعرف أني معطوبة. تعرف كيف عطبني موت جوزيف الذي ما زلت أجره بين أسناني ولا اعرف أين ألقيه، في اية غابة، لابتعد من اجل ما تبقى لي من قلبي سليماً من تآكل جوزيف المستمر. قلت لن تقول نجوى الحقيقة فلأتصل بعزة. إن كان... ستقول عزة.
ـ ألو... شويا عّزة؟ عباس؟
ـ قالوا لكِ؟ كيف عرفتِ
ـ عرفت ماذا يا عزة؟
بما انها لم تغص ولم تبكِ ولم... وراحت تتكلم عن العناية الفائقة... في الاتصال الثاني قالت: نصفه الأسفل محطم و... قلت مش مهم نصفه الأسفل...
وأنا أفكر ان الإنسان يموت من نصفه الأعلى... ثم اتصلت عّزة وقالت انه الآن نفد، لم يعد من خطر على حياته. موجوع ودائخ قليلاً.
ثم اتصل جورج وقال فرحاً: صحي عباس وتكلم قال انه جائع... وبالفرنسية! تندّرنا على نحو ما نفعل دائماً حين يتعلق الأمر بعباس.
[ [ [
في الباص الذي استقل الى عملي رحت امشي، الى جانبه على الرينغ كنت غضبانة أكثر مني عاتبة. أنا اصلا لا استطيع تخيّله متريضا. وعلى الرينغ؟!
هذه المرة بالغت كثيراً... لن يكون لك تندرنا بذهولك وشرودك وبسهوك؟؟ الذي نقرنه دوما بالعبقرية... تبا للأفكار البركانية التي تبقبق دائما في رأسك، وتبا للاشعار. التفت يمينا ويساراً حين تقطع الطريق... على الرينغ!
أنا المعجبة بعباس على طريقة اعجاب المراهقين بالبيتلز لم اكن أحبه من اجل الثقافة والأدب. ولم اكن موافقة على خوفنا الدائم عليه من الانتحار، او عمليا من كل شيء.
لا يكون سعيداً في الحياة من له رأس عباس، أفكاره وحدة الذكاء المقرون بهذا القدر من الحساسية. لذا لم احدثه يوما عن ذلك البكاء السري اعجابا بما يكتب... دائما كنت اريد ان اسحبه الى المنطقة العادية التي للبشر «الموزونين».
كان عباس ينام عندنا مرة في الاسبوع، على الشرفة البحرية في شقة الروشة التي هجرنا إليها كنت اتقصد ألا أكون متفهمة وظريفة وأنا آمرة ألا يحمل معي الصحون الى المطبخ حتى لا يزرع الزيت والصلصات على البلاط الرخامي. أقول له وهو يحلق ذقنه «سكّر الحنفية، ما في ميّ». وفي الغرفة التي كانت له، الخالية إلا من سرير وكرسي كنت اضع يدي على خصري واقول: كيف تنجح في خلق كل هذه الفوضى من لاشيء؟ وعلى الدرج: حاول ألا تضيّع حقيبتك هذه المرة... حاول.
لم يكن يعجبني ان «أرث» عشيقاته كصديقات. لكن كثيرات منهن اصبحن صديقاتي بالفعل لكثرة ما تعلّقت بهن كخشبة قد تسحب عباس الى شاطئ جسده... ان هذا هو قلب مشكلتي معه: اخاف عليه من فصام لا أكف مفزوعة عن رؤيته بين رأس عباس وجسمه... هكذا اتخيّل ان «رأسه» لم يكن هناك حين ضربت السيارة جسمه... لذا ربما بقي رأسه سليما... اقول هكذا لنفسي في الباص...
لا يحق لي هذا الخوف عليه، الذي يشبه خوف الأمهات. منذ تعرفت اليه في كلية التربية التي كان يطل عليها ليضبط قواعد النقاشات الحادة ويذهب، وأنا انظر إليه على تلك المسافة التي تجعلني وأنا اضحك لنوادر عثراته ونسياناته وسهوه اشعر بانقباض في القلب... وفي أيام يثقل فيها عليّ ذلك الانقباض كنت اقول لنفسي: يعجبه هذا الدور وهو يستغرق فيه... تمثيلاً... خبيث عباس، يصنع حبّنا صناعة.
حين تزوج، رحت افتش في بيته الجديد في عبرا عن مدى اهتمام زوجته به... في نظافة المغسلة وترتيب المآكل في البراد والثياب في الخزانة. قلت لعزة... عزة انتبهي له... العروس يبدو تنقصها الخبرة... قالت عزة لا عليك.
انقطعت «رقابتي» القريبة على عباس حين غادرت البلاد. غلبت فرنسا القوة التي كانت لي في اشكال حب الأصدقاء. صار هذا الحب في قعر قلبي ولا تلزمه الجلسات على الشرفات البحرية والسمر لساعات والمواعيد المتلاحقة. وصار الأصدقاء قليلين، وصرت أخاف ان التقيتهم كثيراً ان أزعل منهم... هكذا، لأي سبب، فصرت أراهم قليلاً وأرتضي بحب الكهول هذا.
ماذا سأقول لعباس حين سألتقيه في بيروت؟
الحمد لله أنك لم تمت؟ الله سترني؟
الأرجح أني سأخترع طريقة خفيفة لطيفة لأقول كم إني أحبه.
هدى بركات
(باريس)
***
هِبة عودتك
منصورة عز الدين
متجاهلةً تماماً أنه لقائي الأول بك، بادرتك بمجرد لقائنا في دوسلدورف بسيل متدفق من الكلمات. أنا المنحازة بطبيعتي للصمت، كنت كأنني أعرفك من قبل، ليس فقط ككاتب وشاعر أقرأ له منذ سنوات، إنما أيضاً كصديق قديم تأجل لقائي به لسبب أو لآخر. ساهم ميشائيل كليبرغ بكتابه «الحيوان الباكي» في خلق هذه الألفة. إلا أن الدافع الأساسي لها هو موهبتك في مد الجسور بينك وبين الآخرين مهما بلغت درجة حذرهم مع غيرك.
لم يكن لدينا الكثير من الوقت، كان علينا حضور افتتاح مشروع «الشرق الجديد: القاهرة ـ بيروت» بعد ساعة فقط من وصولنا دوسلدورف. بعد الافتتاح تحدثنا طويلاً. في الصباح التالي سألتك إن كنت ترغب في مرافقتي في جولة بالمدينة حتى يحين موعد قراءتنا مع إيتيل عدنان. مشينا لساعات في دوسلدورف القديمة. نقاشنا، الذي امتد لأكثر من ساعتين، في ذلك المقهى على ضفاف الراين، أعود إليه من وقت لآخر، وأندم لأنني لم أسجله. لم أكن أعرف وقتها أن «عمل الذاكرة الوحيد هو النسيان».
كتبت لي صديقة عزيزة، وأنت لم تفق بعد من أثر المخدر، أنك تحتاج إلى معجزة، وأنها تؤمن بالمعجزات الصغيرة، فقلت لنفسي المعجزات الصغيرة تليق بالشعراء، تليق خصوصاً بعباس بيضون، ذلك الباحث عن الشعر خارج الشعر.
في ندوتك، هناك في دوسلدورف، أعلنت أنه ليس لديك مفهوم للشعر، ولست حتى واثقا من وجوده، وأن الدليل الوحيد عليه هو القصائد الموجودة. وأنا أقول لك الآن إن الدليل على وجود الشعر هو وجود شعراء مثلك، يعيشون الشعر طوال الوقت، ويبحثون عنه خارجه. وهل كانت رؤيتك لصورة ميك جاجر المعلقة في ذلك المطعم الصغير إلا ضربا من الشعر؟ تأملتَ الصورة من مكاننا بعيدا عنها، قبل أن تسأل إن كانت إحدى لوحات فرانسيس بيكون. أخبرتك بعدما اقتربت منها أنها صورة لميك جاجر لكنّ وجهه مموه بالدخان الكثيف لسيجارته. «تبدو لي كبورتريهات بيكون» رددت بهدوء فاتحاً أمامي باباً سحرياً لرؤية الروابط العميقة بينها وبين لمسات بيكون المزلزلة.
سامحني، أشعر بأن كل الكلام مبتذل وفائض على الحاجة أمام ما تشعر به من ألم. الحياة نفسها تبدو أحياناً كما لو كانت دراما بلهاء، لكنها (أي الحياة) لم تبخل على قرائك وأصدقائك ومحبيك ـ لحسن الحظ ـ بهبة عودتك إليهم. فكن بخير دائماً.
منصورة عز الدين
(كاتبة مصرية)
السفير 13 اغسطس 2010
يتبع ...