ما من وصفة مثالية للرسم أو النحت. هذا صحيح. ولكن صحيح أيضاً القول إن مزاج العصر (كل عصر) يُغلّب صيغاً معينة في التعبير على صيغ أخرى. ينصر ذلك المزاج أساليب في ذاتها، ويخذل بالقوة نفسها أساليب مجاورة. مزاج العصر، وهو تعبير غامض، تساهم في صناعته عناصر كثيرة، منها ما هو ثقافي، حيث يكون للفن تأثير كبير في توجيه ذائقة البشر، التي لا يمكنها أن تكون على قدر من الحرية والاستقلالية في ظل نظام سياسي واقتصادي شمولي، يملي على الافراد صيغ استقبال ثقافية محددة. هكذا يكون للأوضاع السياسية والإقتصادية دور لافت في صوغ ذلك المزاج. وإذا كان تذوق الفنون يعبّر عن نزعة فردية خالصة، فإن صعود تيار فني أو هبوطه في المشهد الثقافي انما يرتبط بالسياقات التربوية التي تنتج من وضع الجماعة، وهو ما يُخضع التذوق الجمالي للرقابة غير المباشرة. هناك مصفى لامرئي تصل من خلاله المحاولة الفنية الى الفرد. ربما يكون هذا المصفى هو التجسيد الأمثل لمزاج العصر.

ولأنني على يقين من أن المسألة أكثر تعقيداً من هذا التبسيط الذي بدأت به، فسأنتقل إلى ضالتي مباشرة وأقول: لست الوحيد الذي صار يشعر بأن غالبية الرسّامين والنحّاتين العرب تنتج منذ عقود فناً قديماً، لا ينسجم مع مزاج العصر ولا يستجيب متطلباته، إنْ في التذوق أو في التعبير. يقاسمني هذا الشعور الكثير من الفنانين الذين يقفون اليوم حائرين بين ذائقة شعبية تتمدد لتشمل للأسف قطاعاً واسعاً من المثقفين الذين كانوا إلى وقت قريب يُحسَبون على تيارات الحداثة، وبين ما يصله من أنباء وصور (ربما مشاهدات مباشرة) عن التحولات الجوهرية التي تعيشها الفنون في مختلف بقاع الأرض، وليس في الغرب وحده. فالصين على سبيل المثال تقدم إلى العالم بين حين وآخر عدداً من رواد الحركات الفنية الثورية، التي صارت تقطع الطريق أمام قدرة الأنواع الفنية التقليدية على الاستمرار في العيش.
أي وي وي من الصين، أنيش كابور من الهند، وزها حديد من العراق، إنما يمثل إنتاجهم الفني اشارة نموذجية قاطعة الى التغير الذي عاشته الفنون طوال الثلاثة عقود الماضية، في وقت كان الفن العربي نائماً على وسادة أوهامه.
شيء ما تبدّل. شيء له علاقة بالمفهوم، وهو ما انعكس بوضوح يقيني على الممارسة. سألجأ إلى التبسيط مرةً أخرى لأقول: إن الفنان الجديد لم يعد صانع صور. بالنسبة الى عدد كبير من الفنانين العرب فإن هذا التحول يعتبر كارثة، بالمعنى الذي يعكس شعوراً مأسويا بأن الفن قد انتهى. وهذا صحيح إلى حد كبير. لقد انتهت المدارس والاساليب والتيارات الفنية القديمة التي ارتبطت بعصر الحداثة الفنية، مثلما انتهى عصر الباروك على سبيل المثال.
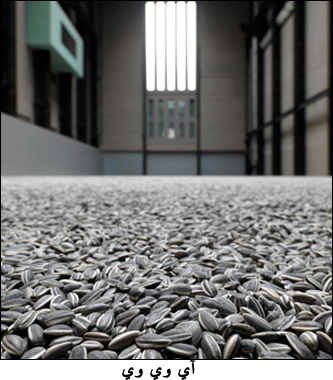
باروكيون
عصر الحداثة بكل تقنيات خياله انتهى. علينا أن نصدّق ذلك.
وكما أرى فإن الهوة التي علينا أن نجسرها، تكمن هنا بالضبط. لا يزال الرسّام العربي يرسم مثل وليم دي كونينغ وروشنبرغ وتابييس. لا يزال النحّات العربي ينحت مثل جاكومتي وهنري مور وبرانكوزي. لست هنا في صدد المقارنة، إنما تهمّني الاشارة الى المنهج الذي اتخذته طريقة التفكير في الفن لدى الفنان العربي، وهو منهج تلذذي، تعبيري، متحذلق، فيه الكثير من الميل إلى الرخاء، وصولاً إلى الترهل الذي يشير إلى شيخوخة ذلك المنهج. التزامه انما يعبّر عن سوء فهم للبعد التاريخي الذي يلحق بالفنون من غير أن يتخللها. بالنسبة الى الفنان العربي، فإن فهمه للتاريخ ينحصر في الماضي، وهو الفهم الذي ألحق بالفن اعاقة دائمة.
الإنتاج الفني العربي يولد اليوم معوقاً، يستلهم عافيته من الذكريات، التي غالباً ما تكون متخيلة. علينا أن لا ننسى أن فنوننا كانت دائما معزولة عن العالم، على مستوى العرض بالتحديد، إلا في حالات نادرة. أتذكر هنا اللبناني شفيق عبود، السوري مروان قصاب باشي، اللبناني أيضا صليبا الدويهي، المغربي محمد المليحي، العراقي ضياء العزاوي. من المؤكد أن هناك آخرين. مع ذلك فإن هذه الاستثناءات لا تنفع في زحزحة القاعدة: أكثر من سبعين سنة والعرب ينتجون فناً حداثوياً محلياً، لم يغادر عتبة البيت. وسيكون مثيراً للدهشة فعلاً، لو اعترفنا بحقيقة مجاورة: معظم الفنانين العرب المقيمين في الغرب كانوا ينسجون وجودهم الفني وفق حسابات مستلهمة من الفن الذي يتم انتاجه في أوطانهم الأصلية. أي أنهم عاشوا في حالة امتناع عن الانتساب الى المكان الذي هم فيه. هذه معضلة تعبّر بطريقة لا لبس فيها عن انسداد الإفق. لقد قُضي الأمر إذاً. هناك مفهوم أحادي للفن يحمله الفنان العربي معه أينما رحل. تعريف واحد للفن: إما أن يكون موجوداً وإما لا وجود للفن حين يغيب ذلك التعريف. هذه الجناية الفكرية هي المسؤولة عن الواقع المتردّي الذي تعيشه الفنون التشكيلية في العالم العربي الآن.

سؤال البراءة الاول
لم يكن الفنان العربي راغباً في رؤية الطريق التي تذهب فيها الفنون. كان عالم الخرافة قد تمكّن منه، فظنّ أن الفنون مقيمة في مكان خالد، لا تلمسه التغيرات. ينبغي أن نكون حذرين في التعميم. هناك استثناء دائماً. لكن الكثرة تغلب. كانت هناك محطات شهد فيها الفن التشكيلي نوعاً من الازدهار. جاذبيته كلها تعود إلى تلك المحطات. خمسينات القرن العشرين مثلاً كانت حاضنة لاستيعاب الدرس الحداثوي العالمي. تلتها الستينات، كونها حاضنة للتمرد الشبابي الذي عمّ العالم. في السبعينات حلّ ترف الصنعة، فصارت الفنون تكرّس أحوالها باعتبارها فضاء للتزيين. يومذاك حل الزيف والنفاق وفقد الفنان العربي أعظم ما فيه: تمرّده المستقل. لقد نجحت المجتمعات العربية يومها في توظيف ذلك التمرد، ليكون مصدراً للإناقة البورجوازية. ومن ذلك اليوم عاش الفنان العربي تابعاً لذائقة الماضي.
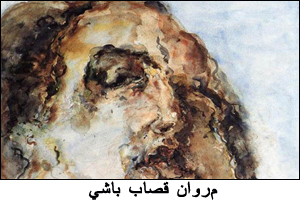
لم تكن كل هذه التحولات منقطعة عن صعود طبقات اجتماعية وهبوط أخرى. غير أن مزاج العصر العالمي لم يحظ بأيّ قدر من اهتمام الفنان العربي. لقد انصبّ اهتمام ذلك الفنان على المزيج السحري الذي يتلوّن أمام عينيه وهما تراقبان المجتمع من حوله وهو ينهار. لقد شبِّه له أن ما كان يفعله هو نوع من العلاج، وحين تبيّن له أن ما كان يفعله قد ساهم في استفحال المرض، لم يعد لديه ما يكفي من الوقت للتراجع. صار علينا أن نرضى بقدرنا. ألسنا قدريين في الكثير من أفعالنا؟ في هذا المجال هناك نوعان من الفنانين: نوع لا يعرف ولا يريد أن يعرف شيئاً عن التحولات التي شهدها مفهوم الفن في العالم، ونوع آخر يعرف كل شيء، غير أنه لا يجرؤ على تغيير عاداته. وإذا كان النوع الأول يشير إلى بلادة مستفحلة، فإن النوع الثاني يخطئ في حق الفن حين يعيش حيرته صامتاً. هنا تحلّ نقمة الفن الزائف. الفن الذي يخون عصره حين يستجيب وظيفته القديمة: ماكينة لاستخراج اللذة من مكان قريب.
وإذا أردنا الحقيقة، فإن الفن التشكيلي العربي لم يكن متماهياً مع مزاج العصر يوماً. سيرته تشهد على أنه كان تابعاً لماضي الفنون في الغرب. غير أن مزاج العصر نفسه قد تبدل حين تجاوز الغرب، منفتحاً على العالم. وهذا ما يضع الفنان العربي في حيّز المساءلة. وهي مساءلة قد تبدأ ببراءة، بسؤال الوجود الأول: في أيّ عصر تعيش؟
النهار- 2012-07-01