حوار : سلام سرحان
صبحي حديدي أحد أبرز النقاد والباحثين والمترجمين العرب، له خارطة فريدة من التخصص الرفيع في ميادين النقد والبحث والترجمة، وجميع جهوده في تلك الميادين تستند الى رؤية فردية تحكم تجانس ما يقدمه للثقافة العربية.
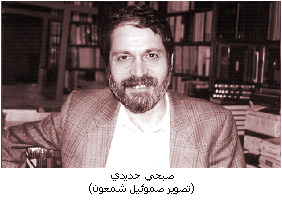 من تلك الرؤية الرفيعة نقل حديدي الى العربية العديد من الأعمال، في الفلسفة والتاريخ السياسي والنظرية النقدية والرواية والشعر. كما قدم عددا كبيرا من الدراسات النقدية والأبحاث، إضافة الى متابعته الدقيقة للثقافة العالمية وللمشهد الشعري العربي المعاصر.
من تلك الرؤية الرفيعة نقل حديدي الى العربية العديد من الأعمال، في الفلسفة والتاريخ السياسي والنظرية النقدية والرواية والشعر. كما قدم عددا كبيرا من الدراسات النقدية والأبحاث، إضافة الى متابعته الدقيقة للثقافة العالمية وللمشهد الشعري العربي المعاصر.
من أبرز أعماله النقدية التي يواصل تطويرها منذ سنوات، دراساته الكثيرة للغنائية الملحمية في شعر محمود درويش، ومشروع آخر متواصل لدراسة تجارب قصيدة النثر العربية، ودراسات أخرى لا مجال لحصرها هنا.. يستعد حاليا لإصدار عملين آخرين: "إدوارد سعيد: النظرية النقدية وصورة الآخر"، و"النظرية النقدية المعاصرة: القارئ، ما بعد الاستعمار، والتاريخانية الجديدة".
لكن في الوقت نفسه يصعب الاكتفاء بتلك المقدمة، فمثابرة حديدي على متابعة ما يجري في الثقافة العالمية من خلال أبرز نافذتين هما اللغتين الفرنسية والإنكليزية، أمر يثير دهشة الكثيرين في الأوساط الثقافية، حتى ليمكن اعتباره من أبرز شهودنا على الثقافة العالمية. وقد اخترنا هذه الزاوية لمحاورة صبحي حديدي حول واحدة من أبرز مظاهر الخلل في الثقافة العربية اليوم، وهي تراجع إطلالتنا على المشهد الثقافي العالمي خلال العقود الأخيرة، بسبب تلكؤ آليات وصولنا الى ذلك المشهد، وهي بشكل أساسي الترجمة.
نسأل صبحي حديدي:
* ما الذي يضمن أن تقدم الجهود المتناثرة هنا وهناك صورة متجانسة ومعبرة عن المشهد الإبداعي العالمي؟ تلك الجهود التي تبدو لأول وهلة وآخر وهلة عشوائية وفي غاية الارتجال؟
من حيث المبدأ البسيط، لا شيء يضمن أن تفلح الجهود المتناثرة في تشكيل صورة متجانسة! المترجم ليس هيئة ضمان ثقافية أوّلاً، وكفى به داءً أنه يبادر إلى اختيار النصّ، ويترجمه، ويسعى بعدئذ إلى "إغواء" ناشر ما يوافق على مغامرة النشر، إذا وضعنا جانباً مسألة هضم الحقوق: حقوق المؤلف، وحقوق المترجم. الجانب الثاني في المسألة أن تقديم " صورة متجانسة ومعبرة عن المشهد الإبداعي العالمي" ليست بالغاية السهلة في مجتمعاتنا الثقافية الخاضعة لشروط تقييد معقدة، تبدأ من الرقابات السياسية والفكرية والأخلاقية والدينية، ولا تنتهي عند أعراف النشر والتوزيع والترويج والقراءة. في الغرب وحده، وليس في جميع بلدان الغرب أيضاً، يُتاح عكس صورة شبه متجانسة لآداب الأمم الأخرى، والأسباب عديدة ومعروفة. ولكن حتى هنا لا تكتمل صورة مقبولة لكتلة من الآداب المترجمة التي يمكن أن تستحقّ تسمية "الثقافة الكونية"، وثمة مناطق فراغ كبيرة وفاضحة حيث تغيب ثقافات عريقة، أو تُختزل على نحو مخلّ تماماً ولأسباب شتى قد تكون تجارية أو سياسية، ولكنها في كلّ حال غير ثقافية وغير إبداعية.
وفي حدود ما أعلم، لا توجد حتى اليوم مؤسسة، خاصة أو عامة أو جامعية وأكاديمية، تشتغل ضمن المنطق الذي يبحث عنه سؤالك، أي تقتفي سياسة ترجمة مدروسة شاملة تهدف إلى تقديم مشاهد بانورامية متجانسة عن ثقافات الأمم الأخرى. ثمة ما يعزّينا قليلاً، والحال هذه!
* في غياب المعايير والبرامج المدروسة وأي آلية للانتخاب تفرزها الحياة الثقافية، فان الأساس الوحيد الذي تستند إليه الترجمة الى العربية هو أهواء المترجمين وأمزجتهم التي هي عرضة لمؤثرات كثيرة. هل يكفي ذلك دليلا ونافذة للإطلاع على الثقافة العالمية؟
هذا صحيح تماماً: أهواء المترجم هي الأساس الأوّل، إذا لم يكن الوحيد بالفعل. صحيح أيضاً أن هذا "الأساس" ليس كافياً وليس أساساً أيضاً! هو، مع ذلك، مفيد تماماً حتى من باب اعتماد أضعف الإيمان، وسوى هذا فإن جهات الترجمة الرسمية والحكومية سوف تنشغل بترجمة ما يفيد الأنظمة والقوى الحاكمة، وتتفادى ما يجلب لها وجع الدماغ وهذا النمط أو ذاك من الحرج. نتذكر، مثلاً، أنّ أهواء مترجمي "دار العلم للملايين" أطاحت لنا قراءة الرواية الأمريكية (همنغواي، شتاينبك، كالدويل...) على نحو عريض فعلاً وجيّد التمثيل. أهواء مترجمي "دار الآداب"، في مثال ثانٍ، عرّفتنا على الأدب الفرنسي الوجودي (سارتر، كامو...)، وأهواء مترجمي "دار عويدات" انصبت على الأدب الفرنسي الكلاسيكي، في حين أنّ الترجمة في مصر انشغلت بالآداب الأنغلو - ساكسونية، وهكذا...
هل كانت تلك "الأهواء" الإختصاصية مفيدة؟ نعم، بالتأكيد... وليتنا نستعيد اليوم بعض حيويتها ورصانة اختياراتها!
* ما الذي يدفع مترجما للاعتكاف لترجمة كتاب جاد، يتطلب جهدا كبيرا، ولا يعود عليه سوى بالمتاعب؟ فهو إن وجد ناشرا له، فلن يحصل على أي حقوق، إن لم يشترط الناشر عليه دفع جانب من تكاليف الطباعة. في حين يمكنه أن يترجم كتابا عن كرة القدم أو التنجيم أو الفضائح، فيركض إليه الناشرون بمكافآت مجزية.
ليس في وسعي سوى أن أتحدث من واقع تجربتي الشخصية في ميدان الترجمة. تعريف القارئ العربي على الجديد النوعيّ في مختلف أنواع الإبداع، وكذلك في النظرية الأدبية والفكر النقدي أو الدراسات والبحوث التي تمزج بين الفكر والنقد. هذا هو المعيار الأوّل الذي يحكم اختياري لهذا النصّ الإبداعي أو ذاك الفكري - النقدي، وتجربتي بدأت بترجمة كتاب رائد حول الفلسفة الإسلامية للمستشرق الاسكتلندي الكبير مونتغمري وات، صدر في بيروت سنة 1978 بعنوان "الفكر السياسي الإسلامي". ثمّ ترجمت رواية أعتزّ بترجمتها أشدّ الاعتزاز، هي "طيران فوق عش الوقواق" للروائي الأمريكي كين كيسي الذي رحل مؤخراً، وبعدها "ضجيج الجبل" للياباني الكبير ياسوناري كاواباتا. المرحلة التالية كانت نقل أعمال فكرية - نقدية، مثل "منعطف المخيّلة البشرية"، "الأسطورة والرواية"، و"الأسطورة والمعنى". بعد حرب الخليج الثانية قمت باختيار وتحرير عدد من الدراسات الرصينة المعمقة التي تناولت تلك الحرب من زوايا أخرى غير تلك العسكرية والسياسية، مثل التوترات الثقافية والتاريخية والنفسية بين الغرب والشرق، وفلسفة القوّة في حقبة القطب الكوني الواحد، وصدق أو زيف مفهوم "الحرب العادلة"، وقد صدر الكتاب بعنوان "حرب العالمَين الأولى". وكان احترامي العميق لعمل إدوارد سعيد قد دفعني إلى ترجمة مختارات من ردوده على نقّاد نظريته في الاستشراق، صدرت في كتاب بعنوان "تعقيبات على الاستشراق"، وأعمل الآن على ترجمة كتابه الأحدث "تأملات في المنفى" الذي سيصدر قريباً عن دار الآداب اللبنانية.
هذا لا يعني التخلي عن واجب المساهمة في أيّ مناخ سجالي تشهده الساحة الثقافية العربية. على سبيل المثال، في العدد ما قبل الأخير من فصلية "الكرمل" ثمة ملفّ واسع عن موضوعة القصيدة الغنائية، قمت بإعداده وترجمته بغرض الإسهام في تصويب النقاش العربي الراهن حول هذه القصيدة، وتوضيح معنى المصطلح وأشكال القصيدة الغنائية وأغراضها ونماذجها في مختلف الثقافات (من القصيدة السومرية والآشورية والمصرية واليونانية، القديمة إلى قصائد رامبو وبودلير وريلكه في العصر الحديث، مروراً بنماذج من الهند واليابان والصين وأفريقيا وروسيا والبلقان). كذلك فإنّ النقاش العربي الراهن، القديم والجديد والمتجدد، حول قصيدة النثر يحرّضني على ترجمة نصوص إبداعية ونظرية تتناول هذا الشكل الشعري، وتلقي الضوء على إشكالياته ومشكلاته كما رأتها وعالجتها ثقافات أخرى، وتساعد بالتالي في توسيع نقاشنا ووضعه في إطار مقارن مع نقاشات الآخرين. الترجمة في نهاية الأمر ممارسة ثقافية حيوية بالغة الأهمية والخطورة، وهي واجب لا يصحّ التهرّب منه أياً كانت الذريعة. وإنني استغرب حقاً أن يعفّ عن ممارسة الترجمة أيّ وكلّ ناقد عربي يتقن لغة أجنبية. وأزعم أنني حققت مقداراً معقولاً من طرفَي المعادلة الصعبة: التنويع والرصانة، أما المثوبة المالية فدَعْ أمرها لله!
* في ظل التضييق العالمي على تطبيق قوانين الملكية الفكرية، أصبحت ترجمة أي عمل إبداعي تتطلب شراء حقوق نشر الكتاب من المؤلف أو الناشر الأجنبي؟ إلا يؤثر ذلك على ما يمكن أن يصلنا؟ في ظل الحجم المحدود لتوزيع الكتاب في العالم العربي، وما يمكن أن يكون عليه سعر شراء حقوق الترجمة؟
إنه لا يؤثر حتى الآن، كما يلوح، والهوامش ما تزال واسعة أمام الناشرين. ولكن إذا جرى تطبيق مبادئ حقوق الملكية بشكل سليم، فالأمر خير وأبقى لأنه في أقلّ تقدير سوف يكرّس أخلاقيات الحقّ القانوني والأدبي والمالي في ملكية الأثر، ولسوف يساعد على ترسيخ معنى "الصناعة" و"البضاعة" في إنتاج واستهلاك الكتاب، وهذا كله في صالح القارئ والقراءة وليس ضدهما كما أعتقد.
* في الخمسينات والستينات نشأت شريحة من المترجمين الكبار، في حين نجد اليوم الصورة مختلفة. إذ نجد اليوم الكثير من المترجمين الذي لا يجيدون اللغة، التي يقومون بالترجمة عنها. ترى ما هي المعايير العلمية والثقافية التي تؤهل للقيام بالترجمة؟
الترجمة خيانة، كما تقول الحكمة الإيطالية. غير أنها قد تكون الخيانة الوحيدة التي لا غنى عنها! ثمة اليوم مترجمون ممتازون، وثمة "مرجّمون"، تماماً كما كانت عليه الحال في العقود التي تشير إليها. الأمر دائماً يحتمل النسبية، سواء على صعيد تمكّن المترجم من اللغة التي يترجم عنها وإليها، أم على صعيد وعيه (الحاسم والضروري) بأنّ الترجمة الأدبية ليست نقلاً للمعاني وليست ترجمة محلّفة، ولا يعقل أن نترجم جيمس جويس وجين أوستن بالأسلوبية ذاتها.
أما المعايير العلمية والثقافية التي تؤهل للترجمة فهذه بدورها نسبية، إذا لم يكن من الأفضل عدم التنطح لتحديدها وتصنيفها وتوزيعها مثل الألقاب. وللشاعر الكبير رسول حمزاتوف تعبير جميل يقول فيه إنّ ترجمة الشعر أشبه بقَلْب السجادة الملوّنة على قفاها. فأيّ معايير إذاً يا صاحبي؟
عن مجلة إيلاف
بيت القرآن
أعود من زيارتي الأولي إلي البحرين بانطباعات شتّى، ثقافية وفكرية وسياسية وجمالية، لا أرتاب البتة في أنها سوف تجد تعبيراتها المتباينة في ما سأكتب مستقبلاً عن هذا البلد الصغير الجميل. لقد ذهبنا، الصديقان الشاعران أمجد ناصر وعبد المنعم رمضان وكاتب هذه السطور، للمشاركة في الاحتفال بيوم الشعر العالمي، وفي تكريم ضمير البحرين المعاصرة وشاعرها قاسم حداد. ثمّة، إذاً، هذا الرجل الصديق أوّلاً. وثمة بعدئذ أصدقاء آخرون نعرفهم من قبل، أو نتعرّف إليهم مجدداً: عبد القادر عقيل، أمين صالح، عبد الله عبد الرحمن يتيم، محمد أحمد البنكي، يعقوب المحرقي، فوزية السندي، منيرة فاضل...
وثمة، في موقع مختلف تماماً، المهندس الدكتور عبد اللطيف جاسم كانو.
وهذا الرجل هو صاحب فكرة إنشاء بيت القرآن ، المعلم الحضاري الفريد الذي لا تكتمل زيارة البحرين إلا بزيارته، والمتحف العصري الذي تأسس قبل 12 عاماً ليكون مركزاً جامعاً وشاملاً وحافظاً للقرآن الكريم، أو هادياً للآية الكريمة إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، الأمر الذي يعني أنّ الحفظ هنا يتعدّى المحافظة والتخزين وحتى العرض المتحفي، كما يقول الدكتور كانو.
ماذا في هذا البيت ـ المتحف ـ الصرح الحضاري حقاً؟
هنالك أوّلاً، خصوصية المبني الفاتن الذي يجمع بين عناصر العمارة الإسلامية الأصيلة وأحدث معطيات وتقنيات العمارة المعاصرة. هنالك زخارف ومشربيات وقباب ذات زجاج معشّق ونافورة ماء، وثمة مسجد صغير يتسع لحوالي 250 مصليّاً، تتوسط سقفه قبّة بديعة من الزجاج الملوّن صُنعت في بريطانيا ويبلغ قطرها 15 متراً وتعدّ أضخم قبّة من الزجاج الملوّن في المنطقة. ثمة، بعدئذ، مدرسة لتحفيظ القرآن وتعليم قراءته وتجويده وترتيله، مزوّدة بالكومبيوتر وبأحدث وسائل التعليم. وثمة المكتبة القرآنية (وهي غير المكتبة الإسلامية العامّة كما ينبّهنا الدكتور كانو)، تضمّ نحو خمسين ألف مجلّد باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، ذات اختصاص واحد وحيد هو علوم القرآن. وهنالك، بالطبع، قاعة مؤتمرات رائعة التصميم، تتسع لنحو 150 شخصاً، مجهزة بلوحة عرض إلكترونية، وأجهزة للترجمة الفورية، ومعدّات سمعية ـ بصرية مختلفة. وأمّا مفخرة البيت وحجر الأساس فيه فهو المتحف، المصمّم علي هيئة ممرّات متصلة تذكّر بالزيقورة البابلية، تتيح تنقّل الزائر بسهولة تامة من جناح إلي جناح.
وقاعات المتحف تسعٌ، تحتوي الأولي علي معلومات عن تاريخ القرآن، ونزوله، وأسماء كتّاب الوحي، ومعلومات تاريخية عن كيفية جمع الآيات في عهد الرسول، ثمّ الجمع الثاني في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، والجمع الثالث في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. القاعة الثانية تحتوي علي مخطوطات القرآن التي كُتبت علي الرقّ بالخطّ الكوفي في أماكن مثل المدينة المنوّرة والعراق وشمال أفريقيا والأندلس، حين كانت الكتابة بدون تنقيط. القاعة الثالثة مخصصة لأنماط الخطوط العربية المستخدمة في نسخ القرآن، وأنساق الزخارف التي تزيّن صفحاته، وتفاصيل الطباعة الأخرى. القاعة الرابعة تعرض نفائس المخطوطات القرآنية القادمة من أصقاع إسلامية بعيدة مثل الهند وموريتانيا، وجزءاً كاملاً محفوراً في الخشب، بالإضافة إلي مخطوط صغير الحجم بطول 4سم وعرض 2.5سم.
القاعات الأخرى تحتوي علي نماذج نادرة من المصاحف وأنواع الورق المستعمل لأوّل مرّة في كتابة القرآن، وأدوات الكتابة التي استُخدمت علي مرّ العصور، ونماذج القرآن بعد دخول آلات الطباعة إلي البلاد الإسلامية، فضلاً عن القاعة الثامنة المخصصة لعرض أولي تراجم القرآن إلي اللغات الأجنبية الأوروبية والآسيوية، والقاعة التاسعة التي تضمّ طائفة بديعة من الأعمال التشكيلية الحديثة المرتبطة بالآيات القرآنية.
معظم هذه النفائس مقتنيات شخصية للدكتور عبد اللطيف جاسم كانو، جمعها من أربع رياح الأرض! والرجل، الذي يمتاز بهواية ليست شائعة البتة عند أثرياء العرب، فضّل أن توضع نفائسه في متحف للعموم علي أن تظل حبيسة جدران بيته. وبالإضافة إلي النفائس القرآنية وضع الدكتور في بيت القرآن مجموعة مدهشة من مقتنياته الأثرية النادرة الثمينة، من حليّ وزجاج وقطع نقدية وخزف وسجّاد. والرجل يحدّثك عن قطعة خزف إسلامية بالشغف والافتتان ذاته الذي يكتنف حديثه عن مخطوطة قرآنية نادرة.
ذلك لأنّه فنّان في الأساس، منفتح الروح والعقل والضمير، حسّاس للمستويات الإنسانية والحضارية العميقة التي انطوي عليها تراث الإسلام، علمانيّ بقدر ما هو مؤمن، ومعاصر بقدر ما هو أصيل.
ولم يكن غريباً، والحال هذه، أن يحتوي قسم المطالعة في مكتبة بيت القرآن على أحدث الدوريات العربية والأجنبية في مختلف ميادين الثقافة والأدب والعلوم الإنسانية، بينها مثلاً آخر أعداد مجلة بانيبال !
جريدة (القدس العربي) - لندن